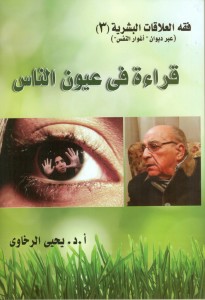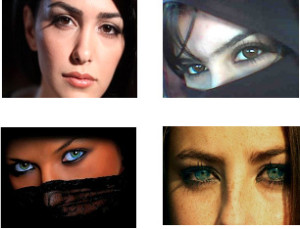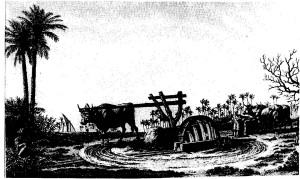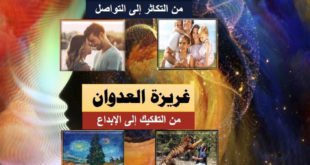فقه العلاقات البشرية (3)
(عبر ديوان “أغوار النفس”)
قراءة فى عيون الناس
(خمس عشرة لوحة)
أ.د. يحيى الرخاوى
تصـْـدير:
اشتمل الكتاب الثانى من هذه السلسلة عرض سبع لوحات من اللوحات الشعرية التى تضمنها ديوان “أغوار النفس” ، نقدنا من خلالها ما أسميناه “العلاج النفسى “المـَكـْلـَمـَة؟”، ومع الإقرار بأن الكلام هو وسيلة من أهم وسائل العلاج، إلا أنه ليس دائما الوسيلة الوحيدة، ولا الوسيلة الأولى، ولا الوسيلة الأنجح، كما يتبين من خلال كل فصول كل هذه السلسلة، ذلك أن الحاجة إلى التواصل بين البشر تتجاوز الكلام إلى مستويات تليق بتاريخ الجنس البشرى ومرحلة تطوره!!
العلاج النفسى ليس إلا استثمار علاقة بشرية ممنهجة لحفز عملية نمو اثنين فأكثر إلى ما خلقا به وله، وأعنى: المريض الذى يعانى ويتوقف ويسأل النصح، والطبيب (المعالج) الذى يواكب مريضه مسئولا يتحرك معه وبه، وهو يقرأ نصـّيْن بشريين معظم الوقت: “نفسه” و”المريض”، فيعاد تشكيلهما معا (معظم الوقت).
ولـِـيتحقق ذلك: فهو يستعمل كل قنوات التواصل، ومعظم ما يناسبها من معلومات علمية، وخبراتية، وتجريبية.
نقد النص البشرى “معاً”:
منذ اكتشفتُ أن ما أمارسه فى العلاج عامة، وفى العلاج النفسى خاصة هو نوع من النقد، وأطلقت عليه مصطلح “نقد النص البشرى” وأنا مطمئن إلى ما وصلنى، ربما لأننى أمارس نقد النص الأدبى من قديم. ولأننى أعرف أن النقد الحقيقى هو إعادة تشكيل النص، وقد ترددت طويلا قبل الفرحة بفرحتى باكتشاف هذا المصطلح الذى يعبر فعلا عن ما أمارسه، فالنص البشرى، مهما اخـُـتـِـبر بمحنة المرض، ليس مجال تشكيل من خـُـارجـَـه أساسا، أو: أولا، فخشيت أن يصل من هذا المصطلح الجديد معنى أننى أقوم بإعادة تشكيل النص البشرى كما أعيد تشكيل النص الأدبى، ثم رويدا رويدا، وأنا أراجع ما أفعله مع مرضاى، خاصة فى العلاج الجمعى، اكتشفت أن نقد النص البشرى (المريض) يختلف عن نقد النص الأدبى: فى أنه نقدٌ لنصـَّين معا: “النص الأول” هو المريض نفسه الذى يشارك فى عملية النقد تلقائيا، ثم إن الطبيب نفسه هو نص بشرى آخر، وبالتالى فلا بد أن يكون عُرضة للنقد من الطرفين طول الوقت. بهذا عدت للتصالح مع المصطلح الوليد، وتمنيت أن أضيف كلمة واحدة له هى “معا”، أى: “نقد النص البشرى معا“، ومن ثمَّ فإعادة التشكيل هى واردة لكلا النصّين طول الوقت.
الكتاب الثانى كان بمثابة نقد العلاج النفسى التسكينى الكلامى بالذات، وكان الاختيار الأول لعنوان اللوحات الشعرية المقدمة كما جاء فى الديوان (أغوار النفس) هو “جنازات” وكان المقصود بذلك هو التنبيه إلى خطورة أن تتوقف حركية النمو (الحياة) من خلال سلبية أو خمول العلاج النفسى إذا اقتصر على عمليات التفريغ الكلامى، فالتسكين فالتأويل حتى التسكين ونحن “ندع القلق”، لا أعرف ندعه لِمَاذَا ولا لِمَنْ، ولعل القصائد السبع التى احتواها هذا الجزء الأول من هذه اللوحات (الكتاب الثانى) قد أظهرت سلبيات هذا العلاج حين يدور فى دائرة مغلقة (اجترار ذات الأحداث والنصوص السابقة المحدودة طول الوقت طول العمر)، وذلك حين لا ينتبه المعالج (والمريض) إلى خطورة دلالات الحركة فى المحل، أو إلى احتمال أن المعالج يعامل المريض من على مسافة، كذلك أشرنا إلى احتمال الافتقار إلى المُواكبة الحقيقية فى العملية العلاجية، وكانت ثمة إشارة أيضا إلى الرعب من التغيـّر من حيث المبدأ، ومن ثم السماح لإرادة التوقف الداخلية بالتسكين حتى التثبيت، كما تمت تعرية وقفة النمو مع استجداء الشفقة حتى الاعتمادية الرضيعية المـُـشـِـلّة، وأخيرا بَيّنا كيف يمكن أن يكون التوقف بسبب الانغلاق فى سجن مرحلة باكرة غير آمنة من العلاقات البشرية، وهى مرحلة الحب الاحتياجى الاحتوائى الاعتمادى.
كان هذا الكتاب الثانى نقدا خالصا لكل من العلاج النفسى التسكينى، وما يقابله فى الحياة العامة بشكل أو بآخر، مما يؤدى إلى جمود حركية النضج، وتوقف النمو، حتى أسمينا ذلك باسم: “الموت النفسى”، وكانت أهم سلبية يمكن أن تؤدى إلى مثل ذلك حين ينقلب العلاج النفسى إلى “مـَكـْلـَمـَة” تأويلية، وأحيانا تبريرية تسكينية، لا أكثر.
قنوات أخرى للتواصل:
من حق أى شخص أن يتساءل أنه إن لم يكن الكلام هو الوسيلة (القناة) الأمثل للتواصل بين البشر، فى العلاج وغير العلاج، فما هى الوسائل والقنوات الأخرى؟
هذا الكتاب الثالث يقدم ما أسميناه “قراءة فى عيون الناس” بديلا عن الاسم الذى استعمل فى الطبعة الأولى وفى الديوان وهو “لعبة السكات”، وقد تم هذا التعديل خشية أن نتصور أن حديث العيون، هو صمتٌ مطلق بشكل ما، فى العمل الحالى أريد أن أبين كيف أنه ثمة لغة أخرى أكثر ثراء وعمقا وصدقا من الكلام اللسانى بالألفاظ: تجرى بين المعالج والمريض أو بين المعالج والمرضـَى فى العلاج الجمعى وعلاج الوسط.
العيون البشرية فى هذا الفصل لم تكن عيون مرضى بوجه خاص، ولم تكن أيضا عيون أشخاص محددين فى عالم الواقع الملموس، وبالتالى فهذا الفصل هو أبعد ما يكون عن عرض حالات، أو وصف أشخاص بعينهم، هذا التأكيد ضرورى. لا أنكر أننى استلهمت بدايات بعض القصائد (اللوحات) من خبرة شخصية شارك فيها أصدقاء كرام، بلغ من شجاعتهم وصدقهم أنهم أتاحوا هذه الفرصة بهذا العمق، لم أقرأ ما قرأت فى عيونهم حرفيا، بل استلهمت من صدق مواقفهم ما أكملت به قصائدى دون أن أعنى شخصا بذاته. فكان – كما ذكرت – أقرب إلى ناتج الجدل مع وعيى الشخصى.
لم يقدم لنا فرويد وسيلة أفضل من الكلام، أو بصراحة غير الكلام، حتى حدسه التفسيرى، وشرحه التأويلى كان يستمده من الكلمات أساسا، بل إن وضع التداعى الحر والمريض مستلق على أريكة العلاج والمحلل يجلس خلفه بعيدا عن التقاء نظراته، كان نفيا عمليا لأى احتمال لاستعمال أى وسيلة أخرى غير الكلام، وبالذات لغة العيون، الوضع شديد الدلالة من حيث أنه وضع تجنب التقاء النظرات، حتى وصف “بيرلز”([1]) (أحد رواد العلاج الجمعى) فرويد – ربما مازحا – بأنه كان مصابا بعرض تجنب التحديق Gaze Avoidance، وبالتالى كان يخشى أن تلتقى نظراته بنظرات المريض، ومن ثـَـمَّ أصر – وأوصى – أن يجلس المحلل خلف المريض أثناء التداعى الحر، الذى نقدناه بقسوة فى الفصل الأول ونحن نسخر من هذا الوضع بشكل خاص حين نقول:
“واحد نايم متصلطح، وعنيه تتفرج، على رسم السقف،
وعلى أفكاره اللى بتلف، تلف تلف، والتانى قاعد لى وراه …إلخ “
مخاطر التواصل بالجسد
انطلاقا من فرويد، ونقدا له، ظهرت مدارس تؤكد أهمية التواصل عبر قنوات أخرى غير الكلام، بالإضافة إلى الكلام، ولعل أكثر القنوات مخاطرة هى القنوات التى سمحت بدرجة من التواصل عبر الجسد، سواء فى العلاجات الشعبية أو فى بعض تنويعات العلاج السلوكى والخبراتى، فقد ظهرت مضاعفات ليست قليلة من استعمال الأيدى والجسد، من بينها العدوان، وأيضا التجاوزات الجنسية، حتى اختلط الأمر على أحد أتباع فرويد – ويلهلم رايخ ([2])– وقد انفصل عنه، حين تمادى فى الشطح واستعمل أدوات مساعدة لتوصيل رسائله العلاجية حتى زادت حالته تماما (بالمعنى السلبي) وسجن قبل أن يقضى، وقد كان مبالغا فى ضرورة الالتحام الجسدى والتحرر الجنسى فى العلاج وغيره، ثم ظهرت لاحقا محاولات ليست أقل خطورة ومضاعفات مثل العلاج الذى ابتدعه جانوف، وأسماه علاج “الصرخة الأولى”([3]) Primal Scream.. إلخ.
القصائد (اللوحات) فى هذا الفصل تؤكد على قنوات التواصل بالعين والوجه والجسد عموما، مع التركيز على العيون باعتبارها نافذة على الوعى الشامل.
الاختراق بالنظر:
لغة الاختراق بالنظر (التحديق الكاشف)([4])، فى عمقها وثباتها هى لغة خطيرة ومهدِّدة، وقد استعملتُـها مؤخرا (منذ سنوات) أثناء الفحص الإكلينيكى التعليمى فى الكشف عن كثير من طبقات النفس البعيدة عن متناول الكلمات.
الحزن مثلا حين تصفه الكلمات بالاكتئاب (أو للأسف بـ “الدِّبْرِشَن”)، أو حتى “الهم” أو “الزهقان” أو “الغم”، ليس هو الحزن الذى اكتشفته من خلال خبرتى فى هذا الصدد. حين أسأل المريض عن حزنه الخاص جدا، الدفين فعلا، أو عن حقه فى الحزن، أو عن: من ذا الذى سمح له بالحزن (وليس فقط بالبكاء) صغيرا أو كبيرا، أو عن: متى سمح لنفسه بالحزن؟ أسأله كل ذلك وعيناى تُواكبُ ألفاظى، محاولا مشاركته بالنظر، وقد لا ننطق حرفا، ولمدة دقائق قد تطول أحيانا (نادرة) إلى أكثر من نصف ساعة صامتين تماما أمام زملاء ومتدربين، من خلال هذا التواصل فى الـ “هنا والآن” تتكشف الطبقات التى نتعارف من خلالها على نوع آخر من التواصل، ثم لعل وعسى…
أصعب من ذلك تكون المشاركة حين نقترب من خبرة معايشة “الألم” النفسى “معا”، أعنى الحق فى الألم “معا”، دون الإحالة إلى الأسباب ودون الوصف بالألفاظ، قد تتدرج المشاركة إلى معايشة احتمالات الحرمان من الحق فى الألم، حين نصمت وندع عيوننا تتكلم،….الخ.
كتبت هذه القصائد قبل أن أغامر باستعمال هذه الآلية فى العلاج، أو فى التدريب، أو فى البحث، ولم أكن أتصور أن هذه المشاعر فى العيون هى بكل هذه الرقة والحدة والزخم والصدق والدقة إلى درجة لا يمكن وصفها بالألفاظ، وحين عدت لقراءة لغة العيون الآن فى هذا العمل لأقوم بما تيسر من شرح ثقيل، بما يشمل من احتمال تشويه الشعر، عرفت أننى كنت أمارس هذا المستوى من المشاركة عبر الوعى البينشخصى عبر نافذة العيون.
إطالة النظر بجدية سَلِسَة تعمّق النظر تلقائيا، وهى تكشف دون استئذان عادة.
فى البلاد المتحضرة، على ما أسمع، يـُـعتبر “التحديق” نوعا من الوقاحة، فلا يجوز لك أن تطيل النظر فى راكب أو راكبة فى حافلة عامة (أتوبيس)، هذا بالنسبة للنظر إليها عشوائيا بأية صورة، فما بالك لو كان النظر فى غور العينين مباشرة، أعتقد أنك (هناك) سوف تحوّل نظرك فورا، أو تتفقان على موعد دون كلمات، أو قد تلعنك فى سرها، أو جهرا.
أما فى سياق العلاج، ولأن هذا الموقف غريب مهما مهدتُ له بالشرح، قد يخطر على المريض حين أطلب منه أن نتواصل دون كلمات (وأضيف أحيانا ودون المسارعة بتفسير أسباب ما يشعر به من حزن أو ألم أو غيره، لا بأحواله الراهنة، ولا بذكرياته) أقول إن المنظر هو غير مألوف لدرجة أنه يمكن أن يوصف بالشذوذ.
اللغة هنا لا تتواصل عبر غور العيون منفصلة عن تعبير الوجه، ونبض اللون، والحركة عموما، وفى الوجه خاصة، وكل هذا يؤكد أهمية لغة الجسد بصفة عامة، وكثيرا ما يستنتِـج الطبيب تناقضا داخليا من خلال تأمله العميق للتناقض بين الكلمة والتعبير الجسدى، أو بين تعبير جزء من الجسد (الوجه مثلا) وتعبير جزء آخر (اليدين أو العينين… إلخ).
حين أطلب من المريض أن نتواصل بالنظر دون كلمات، يرفض، ويتساءل، ويتردد، وقد يصبر، ويحاول، وقد لا يستطيع أن يكمل، وقد يتهيج، وقد يعود يحاول، ثم يستمر… إلخ، وأحيانا لا أطلب منه ذلك صراحة بالكلمات، وإنما أصـُـمتُ فيصمت، ونطيل النظر! خبرات متنوعة تؤكد كم أن الكلام، مجرد الكلام، ولو بوصف المشاعر، قد يكون حاجزا دفاعيا برغم أنه – أساسا – وسيلة تواصلية.
إذا بلغت وظيفة “الكلام” الهروبية أن يغترب الإنسان عن إحساسه، يصبح التوقف عن الكلام مخاطرة قد تصل بالشخص إلى أن يدرك حقيقة اغترابه (وموته النفسي) من خلال الكلام وغيره، فيتألم حتى لا يطيق ويتراجع إلى الكلام، وقد يدفعه الألم إلى انتهاز فرصة إعادة البناء أو إعادة الولادة فى أزمة تطور جديد على طريق النمو البشرى.
لا أريد أن أنهى هذا التصدير قبل الإشارة إلى فضل الكلام فى التواصل حين يحتوى معناه ليصبح واجهة صادقة للوعى، ووسيلة فاعلة للحوار البينشخصى، ثم الجمعى إلى الجماعى، حيث يسترجع وظيفته البدئية وقد كان “هو البدء” قبل أن يغترب.
وهذا ما أنهيت به رفضى لشجب الكلام بشكل مفرط حين استدركت لأنهـِي مقدمة الكتاب الثانى قائلا:
اللفظ قام من رَقْدِتُـه.
ربك كريم يِنْفُخْ فى صُورْتُه ومَعْنِتُه.
يرجعْ يغنى الطِّير عَلَى فْروعِ الشَّجَرْ.
ويقول”ياربّ”،
وتجيله ردَ الدعْوَهْ مِنْ قَلْبُه الرِّطِبّ. ([5])
“لوحة” مقدمة هذا الكتاب الثالث:
فى العلاج الجمعى الذى نمارسه فى قصر العينى منذ حوالى نصف قرن (47 عاما) نبالغ فى التركيز على ما هو “هنا <=> الآن” وكذلك “انا/أنت” فيتراجع دور الكلام فى التواصل، ويتحول إلى قناة مساعدة للمواجهة المباشرة التى تتطور مع طول الممارسة، لتصبح حواراً أعمق بين مستويات الوعى الثنائية، فالجماعية، فالممتدة.
حوار مستويات الوعى يشمل الكلام لكنه لا يتبعه، وهو يتواصل بكل قنوات التواصل الظاهرة والخفية، ويكاد الوجدان – مثلا – يمارس دوره عبر الوعى مباشرة، وهو يتجلى فى كل مظاهر التواصل الحسى والإدراكى والوجدانى وما يتجاوز كل ذلك مما لا مجال لتفصيله.
أشرت فى التصدير حالا كيف أن الصمت مع استمرار المواجهة وجدل مستويات الوعى على محاور أخرى: يمثل مخاطر غير مألوفة، لكن مع الإصرار وإعادة المحاولة يمكن أن تصل رسائل أعمق وأكثر دلالة من خلال نبض الصمت، وربما أكثر إسهاما فى دعم مواصلة الحوار فالجدل بين دوائر مستويات الوعى البينشخصى، فالوعى الجمْعى فالوعى الجماعى إلى ما هو أكبر وأشمل اتساعا وامتدادا.
يالاّّ بـْنـَـا نلعب يا جماعة: لعبة ”هُسْ”.
فتَّــحْْ عينَـكْ بُصْ،
إنْ كنت شاطـرْ حِـسْ.
“أنا مين؟”!
ما تقولشْْ.
مجنونْ !!؟؟
ما تخافشْ.
جرّب تانىِ، مِالأَولْ:
… راح تتعلم تقرا وتكتب من غير ألفاظ:
مش بس عْنيك،.. تدويرةْْ وِشــّـك
وسلام بُـقَّـكْ عَلَى خَدّك،
والهزّه فْ دقنك،
حتى درجات لون البشرة بل ظلال الألوان، وحركات عضلات الوجه والأطراف، والجسد، وتنوعها تشارك كلها فى الإسهام فى التعبير والتواصل بشكل أو بآخر.
وكلامِ اللون:
اللون الباهتِ الميّتْ، واللون الأرضى الكـَلـْحـَان،
واللونِ اللى يطق شرارْ، واللون اللى مالوش لونْ،
وعروق الوشْ،……، والرقبهْ،
وخْطوط القورةْْ، وطريقةْ بَلْعَكْ ريـقــكْ
تشويحةْْ إيدكْْ…
إلى آخرُهْْ.
وقد وجدنا أنه كلما استغنينا عن تفضيل الكلام كوسيلة أولى أو وحيدة فى التواصل أتيحت الفرصة لقراءة أعمق للتركيب البشرى، وبالتالى ربما زادت فرصة التغير الكيفى بعد تراجع الاغتراب الكلامى.
يختم المتن المقدمة هكذا:
لما حانسكت حانحسْ،
أو نِعلن موتنا.
وخلاصْ!
مشْْ يمكن لمَّـا نْـحس،
نقدر نبتدى ما لأول ؟
*****
ثم نبدأ فى قراءة الخمس عشرة لوحة .
اللوحة الأولى:
قهوة سادة، وكلام
لولا أننى أضفت الفقرة قبل الأخيرة لهذه القصيدة، لعدلت عن نشرها فى هذه الطبعة فى هذا السياق، إذْ ما علاقة خبرة شخصية أكثر منها مهنية بالعلاج النفسى، الذى هو موضوع هذا العمل فى صورته الجديدة؟ هل هناك سبيل لتصور ثمة علاقة دون تعسف؟
أكرر مرة أخرى أن هذا العمل الحالى فيه قدر أقل من آليات العلاج النفسى، لكننى أعتقد أن فيه قدر أكبر من التعرية، والحدْس، والإسقاط المحتمل، ومن ثم مساحة أكبر للنفسمراضية (السيكوباثولوجى) التركيبية، هذه وبالرغم من أننى أكدت فى المقدمة الآن أنه لا توجد حالة واحدة – اللهم إلا حالتى الشخصية – هى حالة واقعية لشخص بذاته، وأن اللوحات الشعرية – فى نهاية النهاية – هى من نسج خيالى، برغم ذلك فإنى أجد نفسى أحتاج إلى تنبيه جديد يؤكد نفس التنويه، بالنسبة لهذه اللوحة بوجه خاص.
ربما يكون من الأفضل أن أقدمه على أنه صديق برغم أن مجمل اللوحة من نسج الخيال، وهو صديق من أعز من عرفت، كنا فى فورة الشباب برغم فارق السن، نحلم كما يحلم الشباب، ولكن للكلام نهاية محدودة، وقدرات مختنقة، ولا فائدة حقيقية منه قبل أن يُختبَر، ولم تكن فى الستينيات ثمة فرصة لاختبار كلامى أو كلامه أو كلام أى واحد أو واحدة، فقد تولت الحكومة أمر الناس أكثر من اللازم، وأخفت عنهم ما أخفت، ولم نكن قد دخلنا امتحان نهاية المرحلة فى يونيو 1967. قبل هذه الكارثة بعام أو أكثر، سافر صاحبى للخارج بكل ريفيته الأصيلة، و”خواجايته” المكتسبة، وتواصلت المراسلات بييننا بشكل حميم، لا نحن كففنا عن الحلم بمستقبل أفضل لنا ولبلدنا، ولا نحن اقتربنا من الحلم بشكل يبرر استمرار تكرار نفس الكلام.
سافرت بدورى للخارج بعد أن رسبت الحكومة، فى الاختبار السالف الذكر، فزادت المراسلات حِدة بيننا عبر الأطلنطى، وزاد محتواها شطحا وأحلاما، (تذكـَّـرْ: مازلت أكتب من نسج خيالى، وحتى نهاية القصيدة).
سجلت اللوحة هذه المرحلة فى علاقتنا هكذا:
(1)
يَامَا قُـلْـنا ويامَا عِـدْنَا، ويَامَا أحْلامْنا خَـدتـْـنَا،
كـنّا بنخطط ونرسم، فى الرمال نِبْنى بيوتنا.
صاحبى سافرْ. خُـفـْنا نـِنْـسـَى،
قلنا نكتبْْ: حلم أيّـامنا اللى جايّةْ.
والكلامْْ فوق الورق: بيخطــط الدنيا اللى هيّهْ.
حِلْمِنا بالعدل كان دايما شاغلنا،
والوَلاَيَا والغلابَا كانوا وصْلةْ حب بينّا.
كل خلق الله تـَـبَـَعْـنَـاَ.
نشترى حتى اللى باعْــنـَا.
والسّمــاحْ، …. والمِـلاحْْ،
والشهاداتْ، والنجاحْ.
كل ده، قال و”احنا بــره”،
يعنى: بالحـلم المسرّة.
وحين لاحت لى إرهاصات أن صاحبى على وشك اتخاذ قرار هجرة دائمة، فزعتُ، ورفضتُ، كتبت له أصارحه بذلك، وقد أعدت تفاصيل هذه المصارحة شعرا فى نهاية هذا الديوان حين قلت:
“يا طير يا طاير فى السما رايح بلاد الغُربْ ليه؟
إوعى يكون زهقك عماك، عن عصرنا،
عن مصرنا،
تقعد تلف تلف كما نورس حزين،
حاتحط فين والوجد بيشدّك لفوق،
الفوق فضا، الفوق قضا..
(انظر بعد).
عاد صاحبى حين سمحت له ظروفه بالعودة، و يبدو أننى تصورتُ أن كتاباتنا المتبادلة كانت أحد أسباب عودته، ولكن هذا كان مبالغة منى غالبا، فقد كان ارتباطه بناسنا، وطين أرضنا، شديدا طول الوقت.
 (2)
(2)
قلت له: دى بـَـلـَـدْنــا أوْلى،
ناسْنـا واخْدينها مِقاوله.
صبْر، والشغلِ ”عَلاَوْلــَـه”.
حَنّ قلبه وجانى طاير،
بالبشاير.
بعد عودته استمرت المحاورات على مستويات متعددة، عملية، ومهنية، ومادية، وتجريبية، وإبداعية، وكان ظهور هذا العمل “ديوان أغوار النفس” هو أحد مظاهر هذه الحوارات المتعددة المستويات، بالاشتراك مع آخرين، وثقوا فى جدية ما نحاول، واستصعبوه، لكنهم دعمونا بمشاركة صادقة حميممة، لكن ظلت العلاقة الثنائية بينه وبينى محورية، وأساسية معظم الوقت، وكانت الأمور قد تكشفت عن مصائب السياسة، وتضليل الإعلام، وتشويه المهنة، وتمادى الظلم والاغتراب، لكن لم تتبين لنا سبل عملية للإسهام فى التغيير العام، وإن كنا لم نكف، أو نتراجع عن المحاولات الذاتية، فرادى، وأصدقاء، ومع عمق الرؤية أكثر فأكثر، تأصل الألم أكثر فأكثر، ومع الاقتراب الفعلى بينى وبينه، تجسد الاختلاف الجوهرى، وكان صديقى يشبهه بالاختلاف بين موقف “لاو تسو” (هو) و”كونفووشيوس” (أنا) فى تاريخ الصين!! وبدأت أتبين أن الاختلاف بيننا ليس يسيرا ولا ثانويا، فأحلامى طينية، وأحلامه رقيقة طائرة:
(3)
قلنا يالله نغوص سوا فْ طين أرضنا،
واحدة واحدة نـِجْتِهِدْ على قدّنا.
وابتدينا من جديد،
حَطّ إيده ف إيدى، قلنا مش بعيد.
صاحبى راجع “حُرّ خالص”،
والكلام جاهز وهــــايص.
صاحبى لابس عـمّة خضره
بس يرطـن مالشمال، ولا عندهْ فكرةْ،
مش على بالـُـه اللى جارِى،
فى الزوايَا، فى التُّرَب، أو فى الحواري.
قلت اشوف مين اللى هلّ علىَّ يانى
حين اقتربنا أكثر وجدت أن صدقه أبلغ، لكن أحلامه أكثر طموحا، وأكثر نعومة، ويبدو أن تربيته المدرسية الأجنبية، وطيبته الاجتماعية، ورقته الأخلاقية، قد غلبت على موقفه العملى الواقعى الإقدامى، أو هذا ما خيل إلىّ آنذاك: رحت أتساءل من واقع الاختبارات العملية إن كان هذا الصديق هو مَنْ عرفته طوال سنوات سلفت، مع طول الحوار، وصِدق المحاولة، أم أن السفر غيّره، أم أننى لشدة حاجتى إليه لم أعرفه أصلا كاملا متكاملا، وأننى فقط أكتشف بقيته مع تمادى الاقتراب والاختبار، والاختبار والاقتراب، وقد تبينت وأنا أعيد قراءة هذه الفقرة من القصيدة، أننى حين لم أجده “هو هو”، لم أجدنى أيضا “أنا أنا”، (مالقيتوش، ما لقيتش نفسى):
قلت اشوف مين اللى هلّ علىَّ يانى
هّوه هوّه؟ ولا جانى حدّّ تانى؟
قلت اجرّب،
قلت أقرب،
ما لقيتوشْ مالقيتْشى نفسِى
قلت جوعِى بْيِعْمٍى حـسِّى.
يبدو أننى لم أيأس، وتواصلت محاولاتى للقرب، جنبا إلى جنب مع بداية القراءة فى العيون:
بسْ برضُهْ فْضِلـت ادَوَّرْ
قلت أبص فْْ ْعينُـهْْ أكترْ:
مش يمكن ألاقى البذره الناشفَهْ الخايفَه الضاَّيْعَه فْ بحر كلام:
عايزةْ تنّبت، مشْْ قادرةْْ؟
مش يمكن قـُرْبِــنَا يِرْوِى الأرْض العطشانةْ؟
لا أحد يرتوى من داخله بنفسه لنفسه دون أن يتعرض إلى أن تخدعه ساقية مغلقة تصب ماءها فى بئرها ذاتها مهما دارت، لا بد من “آخر”، بالمعنى الحقيقى لمن هو “آخر”، ولو بنسبة ما.
هذه “البذرة الناشفة الخايفة” هى كامنة فينا جميعا، هى تجف حين يكون ما يصلنا من الآخرين غير كاف لإروائنا، إلا بقدر ما يجنون ثمارنا كما تصوروها، تجف بذرتنا بداخلنا، ثم يأتى الكلام مهما كان صادقا، وجميلا، ليعمل بمثابة غطاء يحمى هذه البذرة الجافة من الذبول حتى العفن، لكنه لا ينبتها، فلا تترعرع إلا باقتراب آخر.
هذا ما تصورت أنه قد حدث فى صاحبى، (وفى نفسى غالبا، أو لاحقا)، لم ننتبه بدرجة كافية، أو فى الوقت المناسب أن علينا أن نكف عن الأمل فى إبداع أنفسنا والناس بالكلمات والنوايا الحسنة.
حاولنا باقترابنا من بعضنا، ومعنا بعض الأصدقاء أن يكون عائد ذلك ريا لبذورنا ولبذور البشر الجافة من حولنا، الجاهزة للإنبات لو وصلها تواصلنا بهم إليهم، أعتقد أن الأمل كان يتجسد فى هذا الاتجاه كلما التقينا أو حاولنا، أو هكذا كنت أحلم، وهو كذلك (غالبا).
مش يمكن نشرب شفطة حب بدال الجوع ما يغّرقنا؟
مِش يمكنْْ شوفْــنا لْــنَاسْـنا يفوّقنَا؟
يبدو أن الشك ساورنى فى واقعية أحلامى هذه، ما دمنا قد وصلنا إلى كل هذا الجفاف، بكل هذا الجوع، ربما يكون العيب عيبه، أو عيبى، أو عيبنا كلينا.
واستمرت المحاولة بلا كلل أو ملل، وباضطراد متدرج، مع محاولة مزيد من الرؤية، ما أمكن ذلك حتى لا نهرب من بعضنا إذا زادت الجرعة، لكن يبدو أن الإحباط كان ينتظرنى بشكل لا حل معه، فواجهت السكون البعيد الخامد المغطى بعباءة الكلمات، وروائح حـْسن النية:
قلت أشوفُهْ، ماظْــْـلموشْ،
دُخْـت تدويرْ، مالْقيتوشْ،
قالُوا جوَّهْ،.. لسـَّهْ حبَّــهْ
قلت أَدْخـُلْ، حـبّة حـبّة
(4)
ولاقيتْنِى جوّا بحور ضَلمَهْْ، مالْهاشْ شُطآن،
ولا حِسّ لْـمّـوج،
ولا نِسمهْ تلاعبْ قلع شْرَاع،
أو حتى تهزّ القشهْْ العايمهْ المنسيهْ.
ولا ضربةْ ديلْ سمكهْ، ولا طُحلبْ،
ولا قَوقْع، ولا أَىّ حياهْ !!!
هـُـوَّا الهِـِوّّ اتْــْــهـَـوَّى ازاى ؟!!
راح فين يابْـنى أنين الناى؟!
وأنا أحدّث هذا العمل الآن جاءتنى الإفاقة التالية، وقد مرّ على كتابة القصيدة الأصل أكثر من خمس وثلاثين سنة، شعرت أنها ليست تراجعا، بقدر ما هى محاولة رؤية عادلة، ولو بأثر رجعى.
أظن أنها إفاقة صالحة لهدف هذا العمل بصورته الجديدة، أعنى توظيفه للإفادة فى العلاج النفسى: ذلك أننا كثيرا ما نحكم على آخر أنه تبلّد حتى أصبح لا يشعر بنا، وربما نحن الذين لا نشعر به، أو نتهمه أنه “بعيد”، وربما نكون نحن المسئولين عن هذا البعد، من هنا جاءت هذه الفقرة تقول:
(5)
مش يمكن كان نِفسى أرمى حِملى عليهْ؟
مش يمكن جوعى صوّر لى حاجات مش فيهْ؟
مش أحسن أبص على اللى بيجرالى من جوّهْ؟
مش يمكن يطلع كل ده :”أنا” مش “هوّه”
حين نكتشف اغترابنا فى الكلام، لا يكون الحل هو أن نكف عن الكلام، بل لعل الكلام يكون هو الممكن المتاح فى كثير من الأحيان، وليس أمامنا إلا أن نستعمله بما هو حتى تدب فيه (فينا) الحياة، إذْ يلتحم بقنوات التواصل الأخرى.
هذا الاستسلام للكلام فى نهاية القصيدة، وبرغم أنه بدا يأسا كاملا، وكأننا نعلن موت الفقيد، إلا أنه غالبا نوع من تأجيل الحكم، ربما انتظاراً لبعث ما، بشكل ما.

يا خبر يا جدع!! كدهُهْ؟ !!!
لا ياعَـمْ.
نتكلّم أحسنْ!
ما هو أصل المعزى:
”قهْوهْْْ سادهْْ، وكلامْ”.
وبعد
مرة أخرى: ما دخل هذه الصورة التى تبدو شخصية تماما بتوظيف النص الشعرى فى هذا الديوان فى الإرشاد إلى طبيعة العلاج النفسى؟
بالإضافة إلى ما ألمحت فيما سبق، فإن التعرف على الخبرة الشخصية للطبيب النفسى فى محاولته لتحقيق ما يدعو إليه مرضاه، يمكن أن يكشف جانبا إنسانيا فى خطوات الطبيب النفسى على درب النمو المضطرد.
لا يمكن فصل الخبرات الشخصية – المعلنة والسرية – للطبيب النفسى، صغيرا أو كبيرا، عن ممارسته مهنته، بل عن اختياره طرق علاجه، بل وعن مسار تنظيره ومبعث وضع فروضه إن كان قد وصل إلى مرحلة تسمح له بذلك، إن حياة سيجموند فريد شخصيا، وأحلامه، وعلاقاته، وتاريخه، وجذوره الدينية (اللادينية) والعرقية، قد أثرت جميعها ليس فقط فى ممارسته، بل أيضا فى تنظيره.
إن تعرية تعامل الطبيب، مع صعوباته الشخصية، داخل المهنة وخارجها، هى التى تمهد الطريق الذى يتعلم منه جوهرية احترام المريض، وهى أيضا التى تسمح للمريض أن يرى أن ما يسرى عليه، يسرى على من يعالجه.
ولهذا فصلت العين السادسة عشر، وهى عيونى شخصيا، لأفرد لها الكتاب الرابع من هذه السلسلة، مع إضافة ما يعين لى من السيرة والمسيرة، من أعمال أخرى أغلبها صور شعرية أيضا وإن كانت غير واردة فى هذا الديوان “أغوار النفس”.
وإليكم المتن كاملاً:
(1)
يَامَا قُـلْـنا ويامَا عِـدْنَا، ويَامَا أحْلامْنا خَـدتـْـنَا،
كـنّا بنخطط ونرسم، فى الرمال نِبْنى بيوتنا.
صاحبى سافرْ. خُـفـْنا نـِنْـسـَى،
قلنا نكتبْ: حلم أيّـامنا اللى جايّةْ.
والكلامْْ فوق الورق: بيخطــط الدنيا اللى هيّهْ.
حِلْمِنا بالعدل كان دايما شاغلنا،
والوَلاَيَا والغلابَا كانوا وصْلةْ حب بينّا.
كل خلق الله تـَـبَـَعْـنَـاَ.
نشترى حتى اللى باعْــنـَا.
والسّمــاحْ، …. والمِـلاحْْ،
والشهاداتْ، والنجاحْ.
كل ده، قال و”احنا بــره”،
يعنى: بالحـلم المسرّة.
(2)
قلت له: دى بـَـلـَـدْنــا أوْلى،
ناسْنـا واخْدينها مِقاوله.
صبْر، والشغلِ ”عَلاَوْلــَـه”.
حَنّ قلبه وجانى طاير،
بالبشاير.
(3)
قلنا يالله نغوص سوا فْ طين أرضنا،
واحدة واحدة نـِجْتِهِدْ على قدّنا.
وابتدينا من جديد،
حَطّ إيده ف إيدى، قلنا مش بعيد.
صاحبى راجع “حُرّ خالص”،
والكلام جاهز وهــــايص.
صاحبى لابس عـمّة خضره
بس يرطـن مالشمال، ولا عندهْ فكرةْ،
مش على بالـُـه اللى جارِى،
فى الزوايَا، فى التُّرَب، أو فى الحواري.
قلت اشوف مين اللى هلّ علىَّ يانى
هّوه هوّه؟ ولا جانى حدّّ تانى؟
قلت اجرّب،
قلت أقرب،
ما لقيتوشْ مالقيتْشى نفسِى
قلت جوعِى بْيِعْمٍى حـسِّى.
بسْ برضُهْ فْضِلـت ادَوَّرْ
قلت أبص فْْ ْعينُـهْْ أكترْ:
مش يمكن ألاقى البذره الناشفَهْ الخايفَه الضاَّيْعَه فْ بحر كلام:
عايزةْ تنّبت، مشْْ قادرةْْ؟
مش يمكن قـُرْبِــنَا يِرْوِى الأرْض العطشانةْ؟
مش يمكن نشرب شفطة حب بدال الجوع ما يغّرقنا؟
مِش يمكنْْ شوفْــنا لْــنَاسْـنا يفوّقنَا؟
قلت أشوفُهْ، ماظْــْـلموشْ،
دُخْـت تدويرْ، مالْقيتوشْ،
قالُوا جوَّهْ،.. لسـَّهْ حبَّــهْ
قلت أَدْخـُلْ، حـبّة حـبّة
(4)
ولاقيتْنِى جوّا بحور ضَلمَهْْ، مالْهاشْ شُطآن،
ولا حِسّ لْـمّـوج،
ولا نِسمهْ تلاعبْ قلع شْرَاع،
أو حتى تهزّ القشهْْ العايمهْ المنسيهْ.
ولا ضربةْ ديلْ سمكهْ، ولا طُحلبْ،
ولا قَوقْع، ولا أَىّ حياهْ !!!
هـُـوَّا الهِـِوّّ اتْــْــهـَـوَّى ازاى ؟!!
راح فين يابْـنى أنين الناى؟!
(5)
مش يمكن كان نِفسى أرمى حِملى عليهْ؟
مش يمكن جوعى صوّر لى حاجات مش فيهْ؟
مش أحسن أبص على اللى بيجرالى من جوّهْ؟
مش يمكن يطلع كل ده :”أنا” مش “هوّه”
يا خبر يا جدع!! كدهُهْ؟ !!!
لا ياعَـمْ.
نتكلّم أحسنْ!
ما هو أصل المعزى:
”قهْوهْْْ سادهْْ، وكلامْ”.
اللوحة الثانية:
السويقة!!
حركية البشر
حين أعدت قراءة متن هذه القصيدة، فوجئت بهذا التكثيف المركز، والنقلات السريعة، تقتحم شعرى من نافذة رحبة الاتساع والجمال هى عيون ريفية عفية من بلدنا.
الصورة هنا كانت أكثر تنوعا وتداخلا وتدفقا، لو صح الحدس الذى شكلّها إذن فمهمة الطبيب النفسى تزداد صعوبة ومسئولية، وهو ما يصلنا حين نقرأ صلاح جاهين فى رباعيته الرائعة:
إيه تطلبى يا نفس فوق كل ده،
حـَظـِّك بيضحكْ وانتى مِتـْنـَكـِّدَه،
ردِّت قالت لى النفس قول للبشر،
ما يبصّـوليش بعـْيونْ حزينة كـِدَهْ.
حتى تحترم هذا التلقى لعمق عيون البشر ووصفها بأنها حزينة، الأمر لا يتوقف عند تصنيف جاد مبدع: شعرى أو طبى، بأن هذه نظرة حزينة، وتلك نظرة باهته، وأخرى فرحة، وغيرها مندهشة، إذْ يبدو أن هناك بعدا، بل أبعادا أخرى، على مستوى إنسانى كلى، ومن خلال العيون أساسا، وهو مستوى أكثر ثراءً وازدحاما من أن يوصف!
هل يمكن رصد هذه النداءات وهذه اللغات وهذه الألوان فى العيون مع العجز التام عن تسميتها؟ وما العمل لكى نستطيع بعض ذلك؟
الجانب الآخر الذى وصلنى حين قرأت هذه القصيدة من جديد، هو أن الحياة الطبيعية الحقيقية قد تكون بنفس هذا التداخل والتكثيف، وأن أى اختزال أو تحليل لها يكاد يكون نوعا من الاغتراب أو التشويه، فالسويقة (والسوق، والمولد، ومحطة القطار، وميدان فى حى شعبى.. إلخ) فى حركتها المتداخلة المتكاملة تكاد تكون هى الوجه الخارجى لهذه الوجدانات المتنوعة كما تطل من عيون تجلت فى هذا التشكيل.
الطبيب القادر على أن يتلقى هذا الازدحام دون الإسراع باختزاله أو تصنيفه يمكنه أن يتعرف على مريضِهِ بشكل أكثر حركية فى وعىٍ أكثر رحابة، يسرى ذلك على سائر العلاقات الحقيقية المبدعة بين البشر.
هل يمكن أن ينمو هذا النوع من العلاقات من خلال مواصلة ممارسة الحياة بطريقة أقرب وأعمق؟
هل يمكن أن نتواصل دون الإسراع بحبس مشاعرنا فى ألفاظ هى غير قادرة على احتوائها إلا بعد تفتيتها وتسطيحها وحبسها داخل ما لا تحتاجه من تعبير أو تعريف؟
هل يمكن التدريب على تعليق الحكم بعض الوقت قبل الإسراع فى لصق أقرب صفة (أو اسم عَرَض) لما يصلنا من الآخر (مريضا أو سليما) أولا بأول؟
حين نقرأ هذه القصيدة، برغم أنها – مثل كل قصائد هذا الفصل – لا تصف تحديدا حالة بذاتها: مرضية، ولا سوية على أرض الواقع، لا بد أن نتردد بعد ذلك فى أن نسارع بوصف المرض والناس والعيون استقطابا: إما حزين وإما فرحان، إما خائف وإما مطمئن. هذا أمر وارد، وقد يكون مفيدا أحيانا، لكنه ليس كل القصة، وليس غاية العلاقة ولا غـَوْرها ولا طبقاتها.
يبدأ تشكيل اللوحة من أرض الواقع الخارجى، من السويقة، وأعتقد أن منظر السويقة التى كانت تعقد مرتين فى الأسبوع فى قريتنا([6]) – الإثنين والخميس – كان مازال عالقا فى وعيى وأنا أكتبها، السويقة هى تصغير سوق غالبا، لكن هل يوجد تصغير للسويقة نفسها؟
بالإضافة إلى السويقة التى كانت تعقد على طرف البلدة فى نهاية مبانيها مع بداية حقولها، كانت هناك سُوَيقـِيـَّة السويقة (إن صح التصغير) تعقد صباح كل يوم سبت على شريط قطر الدلتا قرب محطته، هى تجمـُّعٌ صغير يعقد قبل طلوع الشمس على قضبان القطار فعلا، ولم يكن مـُـعـْـترفا به من كل الناس باعتباره سويقة رسمية!! (مثل سويقة الاثنين والخميس)، كان بمثابة تسهيل مرحلى لتبادل الأغراض والحاجات قبل ركوب قطار الدلتا إلى سوق السبت فى قرية أكبر على بعد خسمة كيلو مترات (أصبحت هذه القرية هى مركزنا مؤخرا) ([7])، سُوَيقـِيـَّة السويقة هذه كانت تغنى بعض الذين عزموا على شد الرحال إلى المركز من السفر، هذا إذا نجحوا أن يقضوا حاجتهم شراء أو بيعا أو كليهما أثناء انتظار قطار الدلتا ذى الخط الواحد، وهكذا يوفر الذى أتم غرضه قبل السفر على نفسه المشوار، ويعود وقد تحقق مأربه من السوق المصُغـّر هذا (سُوَيقـِيـَّة السبت الصغرى على قضيب قطر الدلتا قد تغنى من شد الرحال إلى سوق السبت الكبير فى “بركة السبع”).
قطار الدلتا له شخصيته الخاصة ومواقيته المتباعدة غير المنتظمة وآثاره فى كل من عايشه طفلا، وهو يمثل لطفولتى علامة شخصية جدا لم أستطع أن أنساها، هذا المنظر الذى بدأت به هذا التشكيل كان يثير دهشتى، بل وخوفى طفلا حين تصر نسوة البلد أن يكون اجتماعهن لتسويق حاجياتهن على شريط القطار ذاته، وهن يعلمن تمام العلم أن القطار قادم، ولكن يبدو أن جميعهن (بعكسى طفلا) كن متأكدات أنه لن يدهسهن من ناحية، وفى نفس الوقت فإنه ليس له ميعاد ثابت فلا داعى لوضعه فى الحساب، ومع ذلك فقد كان يداخلنى خوف من أن تخيب حساباتهن مرة، ويدهمهن القطار على غرة، رغم أنه لا يعرف المباغتة.
كان القطار يأتى ويصفر ويتلكع حتى يتفرقن فى مرح وفزع حقيقى أو مصطنع، ولا يلبثن أن يـَعـُـدْن كما سبق بعد مروره، وبعد أن يركبه منهن من سوف تواصل السفر إلى سوق السبت.
(1)
والنظرةْ ْْالصاحـْـيـَـهْ الواسعهْ الزحمهْ ،
زىّ سُوَيقـِيـَّة السبتْ، فى بلدنا.
زى القفف المليانهْ حاجاتْْ وحاجاتْ،
محطوطهْْ بالذاتْ،
على قلب شريطْْ قطر الدَّلتا.
كلّ ما القطر يصفَّر، بتلاقى الزحمة اتفضتْ.
والقفف السودا النسـِّوان بتشيل القفف البيضاَ الملْيَانهَ
حاجات وحاجات.
وَمَّا القطر يعدى: ترجعْْ كومْة القففِ النسوانْ، القففِِ النسوانْ:
تتلخبط على بعض، كما دقن الشايب.
المرأة فى بلدنا ليست مجرد قفة تنحط وتنشال، تـُملأ وتفرغ، التشبيه هنا لا يحط بالمرأة لتصبح مجرد قفة، بل آمـَـلُ أنه يرتقى بالقفة (الشىء) لتصبح كائنا حيا تشارك صاحبتها التشكيل.
أظن أن ما جاء بعد ذلك فى هذه العيون هو غير قابل للشرح دون أن يتشوه، بل لعله أيضا لا يمكن استلهامه ليفيدنا فيما نحن بصدده لفهم النفس الإنسانية، شعرت أنى لو حاولت شرح هذه المشاعر المتداخلة المُعـَبـِّرة فى هذه العين كما جاءت فى اللوحة، لاضطررت أن أشرح الطب النفسى كله وعلم السيكوباثولوجى والعلاج النفسى معا، إن غاية ما يمكن أن أتوقف عنده آمِلاً ألا يخل بتكامل الصورة كلها على بعضها بشكل أو بآخر، هو بعض الإشارات، كما يلى:
-
إن العين، فى لحظة بذاتها، قد تقول كل شىء معا، فى نفس الجزء من الثانية “كل كلام الدنيا، وف نفس الوقت“. هذه الحقيقة تذكرنا بجهلنا بقيمة هذه الوحدة الزمنية المتناهية الصغر، والتى بلغتنى بشكل رائع من “باشلار” فى “حدس اللحظة”، ثم من العلوم الكوانتية مؤخراً)[8] ) والتى أعتبرها ثروة للعلاج النفسى، الجمعى خاصة، وفى نفس الوقت أتصور أنها هى هى لحظة التحول النوعى فى أزمات التطور، وبعض خبرات الإبداع، “كل كلام الدنيا وفْ نفس الوقت”.
-
الغوص فى العين فى هذه اللحظة واستيعاب كليتها هو ممكن وفقط، أما ترجمتها إلى ألفاظ أو إلى أى تشكيل آخر فهى الاستحالة نفسها، هذه المحاولة هى ليست إلا تقريبا لا يمكن أن أكون قد قصدت إليه بوعى ظاهر حتى أجمعها هكذا.
-
إن الشعر، هو الأقدر على احتواء مثل هذا التكثيف من أى تعريف علمى أو نثرى مجتهد.
-
إن ممارسة الطب النفسى الحديث بدون تدريب مثل هذا الحدس الفنى على هذه الإحاطة الكلية، قد تكون تراجعا عن ممارسات علاجية كانت فى يوم من الأيام أقدر وأشمل.
-
إن الأمل معقود فى الاستفادة والإفادة مما استـُـحـْـدث من إضافات علمية أمينة (لا استثمارية ملتبسة)، يمكن أن يثرى هذه الخبرة التشكيلية النقدية التى نزعم أنه يمكن تدريبها بشكل أو بآخر.
هيا نقرأ هذه الفقرة ونكتفى بها دعوة لما قصدنا إليه من إبداع التلقى بشكل آخر
(2)
أهى نظرة عينهْ زى سويقة السبت
فيها كل كلام الدنيا، وفْ نفس الوقت
فيها”رغبهْ” على ”دعوهْْْ”، على ”إشمـِـعـْـنَى”، على”رعشِةْ خوفْ”،
على “صرخة طفلْ”، على حَـلَمةْ بزْ،
على “عايزه اختارْ”،
“وانا مالى ياعمْ”،
”مش عايزه ألمْ”،
على “نِفْسِى أعيش”، “بس ما تمشيشْ”،
”خلينى معاكْ”، “خلينى ْبعيدْ”،
التناقض هنا ليس تناقضا بقدر ما هو تداخـُـلٌ حركىّ جدلىّ متضفر، إذْ يختلط النداء بالدفع فى نفس اللحظة، ويتداخل الألم مع الرغبة.. إلخ إلخ، مما يمكن أن يمسخ التشكيل كلما تمادينا فى التوصيف. قف!! ينتهى هذا المقطع بإعلان الرغبة فى الحياة بالمعنى البسيط، وفى نفس الوقت بالمعنى الحقيقى.
قرار “أن تعيش” هو أصل كل الوجود، وهو قرار يستحيل بنوعية بشرية حقيقية إلا فى وجود آخر، إن مجرد الاعتراف بهذا القرار “قررت أن أعيش بشرا“، يعلن اعترافا ضمنيا بأنه لا عيش هكذا إلا فى رحاب وعى بشرٍ “آخر” يقرر نفس القرار.
اكتشفت، برغم طول الخبرة، ندرة رصد حضور الطور الاكتئابى الأكثر نضجا على مسار النمو عند أغلب الناس مع أنه هو الذى يميز (المفروض يعنى) الإنسان الحالى النامى وهو يواصل تطوّره ليتحمل مسئوليته الجديدة، لم تتضح لى ندرة هذا الموقف (الطور) الاكتئابى إلا مؤخرا جدا، فما هو؟
عن الطور العلاقاتى البشرى: (سابقا: الاكتئابى):
اكتسب الإنسان الوعى، ثم الوعى بالوعى، كمرحلة متأخرة هى الغالبة الآن، وبما أن هذا قد تم حديثا – بحسابات التطور– فإن مسيرة نموه عليها أن تمر بكل المراحل السابقة([9]) لتحتويها وتتجاوزها وتتكامل بها لتنطلق منها:
تكرر عرض فروضى فى هذه المسألة (أطوار التطور : طبيعتها، ودلالاتها ومغزاها، وحركيتها) فى السنوات الأخيرة فى أكثر من موقع، وخلاصة ما يتعلق بالنقطة الحالية هى : أن أغلب البشر اليوم لم يصلوا إلى هذه المرحلة العلاقاتية البشرية الحقيقية بحق، وأن أغلب الجهود الصحيحة المبذولة إبداعا، وتربية، وتصحيحا، وتكافلا إنسانيا إنما تهدف لزيادة حجم جرعة هذا النوع من العلاقات التى تميز البشر دون غيرهم من الكائنات، لكن يبدو أننا نسير ببطء شديد فى الاتجاه الصحيح.
المصيبة أن مزاعم الحب والتضحية والسماح والمساواة ومثل هذا الكلام، تمثل أغلبها ردة شيزيدية أكثر من أنها محاولات تطورية لاقتحام المرحلة التالية بما فيها من خبرة علاقاتية مؤلمة رائعة.
الإنسان المعاصر ما زال يعيش الطور الكرَ فرّى، وأغلب المحاولات الجارية، لتجنب هذا الطور أو التخفيف منه تجري بالنكوص إلى الطور الشيزيدى، وليس بالتقدم إلى الطور العلاقاتى البشرى.
الطور العلاقاتى البشرى الصعب: هو الذى يضع الإنسان على قمة هرم الحياة التى نعرفها، فهو يعلن أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا فى وجود – ومع– إنسان آخر، ويكون هذا الإنسان الآخر، هو مصدر الاعتراف به، وهو مرصد شوفانه، وهو أيضا مصبّ مشاعره المتبادلة من نفس هذا النوع، وهنا يبدأ التميز البشرى فى فرض صعوباته الرائعة.
لما كان الإنسان قد اكتسب الوعى، ثم الوعى بالوعى كما قلنا، فقد أدرك أن ثم “آخرا” هو ضرورى لأنـْسَنـَتـِه، الآخر الحقيقى هو مصدر الحياة الأرقى الذى يسمى “الحب”، ثم يكتشف الإنسان فى منطقة ما من مناطق وعيه، ليست ظاهرة على السطح عادة، أن هذا الآخر الذى هو مصدر هذا الحب (الحياة كإنسان) هو هو أيضا مصدر التهديد بالترك، بالهجر، تبعا لطبيعة حركية العلاقة لا أكثر:
هنا لا يصل الحذر من هذا المُحب (بدءا بالأم) لدرجة إلغائه كما هو الحال فى الطور اللاعلاقاتى (الشيزيدى)، وهو أيضا ليس حذرا لدرجة تبرير استمرارية الكر والفر كسبيل أوْحَد للحفاظ على الحياة (الطور البارنوى) ، لكنه حذر من فقد المحِبّ بالهجر (أو الترك أو النسيان) مع أنه هو مصدر الحب (انظر بعد).
ولقد طورتُ تفسير الموقع الاكتئابى الذى قالت به ميلانى كلاين حيث اعتبرتُ أن ثنائية الوجدان فى الطور الاكتئابى (الشعور بالتهديد بالترك من مصدر الحب وبالتالى الحب والكره معا)، اعتبرت أن هذا دافع أن يدفع الطفل أن يتخلص من أمه بالقتل فى خياله (وليس فقط بالهجر)، ثم ينشأ الاكتئاب نتيجة لشعور الطفل بالذنب باعتبار أنه قام بإعدام مصدر الحب([10]) وقد رفضتُ ذلك تماما واعتبرت أن ثنائية (بل تعدد الوجدانات) هى علامة تميز البشر على مسار النمو ، وأن المعاناة فيها أمر طبيعى ونمائى ودافع.
فيكون خلاصة هذا الطور هكذا:
أنا على يقين من أن مصدر بشريتى هو هذا الآخر المحــِـب
أنا لا أستطيع الاستغناء عنه أو عن من هو مثله
أنا على يقين – فى نفس الوقت – من أنه قد يتركنى
أنا سوف أتألم حين يتركنى،
بل إننى متألم الآن لمجرد التفكير فى هذا الاحتمال
أنا لن أتركه
أنا لن أتركه يتركنى
أنا أحبه
أنا أمارس معه نفس الدور تماما
هو يحبنى
هو يمارس معى نفس الدور تماما
كيف أحتفظ بهذا وذاك الآن هنا معا
هذا مؤلم جدا
لكنه بشرى جدا
وهو أفضل من أى حل آخر، أفضل من العودة إلى الكر والفر
وأفضل من إسقاط آخر من داخلى بالمواصفات التى لا تهددنى
وأفضل من العودة إلى قوقعتى لاغيا كل آخر
يا لروعة الألم الحب الرؤية الاستمرار
يا لفخرى بى ساعيا، فرحا، متألما (معاً)([11])
حيوية المكان والزمن، وحيوية العلاقة:
لا يمكن أن تفهم إشكالة العلاقة البشرية الناضجة بحجمها وموضوعيتها إلا من خلال بُعـْدىْ الزمن والحركة.
“حتمية بُعد الحركة” هو هو الذى علّمنى أنه لا علاقة بشرية حقيقية إلا بتفعيل برنامج الدخول والخروج مع ترجيح جانبه الإيجابى الذى يحتم عدم تساوى ذراعىْ الدخول والخروج، لا يمكن اختزال هذا البرنامج إلى ما هو إيجابى خالص، أو ما هو سلبى خالص، إذ يبدو أن المراوحة هى أيضا بين الحركة اقترابا وابتعادا نشطا، وبين التوقف ترقبا وجمودا وخوفا،
“خلينى معاك، خلينى بعيد”.
يمكن أن نقرأ هذا الطور باعتباره طور تردد سلبى قبيح، أو تناقض للوجدان، لكننى أقدمه ايجابيا باعتباره وعى بالجانبين معا، دون إيقاف نبض الحركة، مع تحمل الألم، واستمرار تبادل الوعى والرؤى، فهو الحزن النمائىّ المتحدى الصابر الدافع، فهو الحضور الإنسانى العلاقاتى المتعدد المستويات!!
عن حركية المسافة أيضا
الفقرة التالية فى اللوحة تركز على : “المسافة” وحركيتها:
وِاذَا قلت أنا أههْ، أنا جىْ،
يـِسْمعنى كَمَا صُفارة القطر، ويْخَافْ.
وينط كلام العين جُوَّهْ: فى البطنْ،
أو تحت الأرضْ.
وتْلاقى سوادْها وِبَياضها بيجرُوا ورا بعض،
زى النسوان اللى بتجرى بقففها.
ثم نكمل :
ترجع كلِّ الكلمات الساكته المليانه ألم وحاجات،
و”تعالَى” و”رُوحْ” و”قوامْْ” و”استنَّى”،
”وانَا نِفسى تْقَـرّب .. إٍلا شويةْ” “طبْ حبّه كمانْ”
”يانهار مش فايتْْ !!
”أنا خايفة “
“أنا ماشْيهْ”
إن إحياء حيوية المكان هو ضرورة لفهم وتأكيد وتعميق حيوية العلاقة، جنبا إلى جنب مع حركية الزمن.
لا توجد علاقة حقيقية بدون مسافة متغيرة، المسافة الثابتة تعلن ضمنا أن العلاقة إما خامدة متجمدة، وإما هى غير موجودة أصلا، وأن كلا من برنامجى “الدخول والخروج” و”الإيقاع الحيوى” إما يعملان بطريقة آلية فى المحل، وإما هما متوقفان فعلا أو وظيفيا، وإما أنها علاقة التهامية يحتوى طرف منها الطرف الآخر داخله أو العكس.
نرجع نتذكر نقدنا فى الكتاب الأول للتحليل النفسى التقليدى من مسألة غلبة التركيز على الماضى والتداعى الحر، ثم نضيف هنا هامشا على رؤيتنا لشكل المسافة وطبيعة الحركة فى هذا الطور.
يبدو أن التحليل النفسى التقليدى قد ارتاح بوضع المريض ممددا على الحشية، والطبيب (أو المحلل) قابع خلف رأس المريض دون النظر فى عينيه تحديدا، فى العلاج الأحدث “وجها لوجه”، لكن فى العلاج الجمعى، يختلف الأمر تماما، حيث تتحرك المسافات ونحن جلوس فى مواقعنا تحركا فاعلا واقعا يكاد يرى بالعين المجردة.
نكتشف أثناء الخبرات النمائية العميقة – ومنها العلاج النفسى العميق – أن الإنسان (مريضا أو غير مريض) قد يُرعب رعبا شديدا من الاقتراب الحقيقى من إنسان حقيقى من لحم ودم، له وعى ووعى ووعى بالوعى مثله، هذا هو ما أسميه فى كثير من صورى الشعرية: خطر الحب، برغم تحفظاتى من الالتباس المحيط بهذه الكلمة كما ذكرت مكررا، الخوف من الحب (مثل الخوف من الحرية) هو أعمق خوف يمكن أن نقابله فى أعماق النفس الإنسانية وبالتالى فى المريض، حتى وإن لم يظهر بشكل مباشر أو ظهر العكس.
نحن نواجه هذا الطور فى خبرة النمو أثناء العلاج الجمعى خاصة حيث لا يكون “الآخر” عدوا ولا منافسا فقط، بل رفيق طريق أيضا، مما يفتح الباب لاقتحام هذه المنطقة البشرية بديلا عن لعبة الكر والفر تحت أوهام المطاردة، وأيضا مختلفا عن الحب الناعم اللاغى للآخر برغم زعم وجوده. هذا الرعب من هذا النوع الحقيقى من الحب هو نتيجة الخوف من التخلى عن دفاع الكر والفر، الذى يوهمنا أنه هو وحده الذى يحافظ على الحياة والبقاء، وأيضا التخلى عن دفاع العمى التسكينى المؤقت.
وبما أن هذا الخوف من الحب له ما يبرره فى الواقع حيث المجتمع التنافسى مازال يحافظ على بقاء الأفراد فيه بآليات الكر والفر، فعلى المعالج أن يضع ذلك دائما فى اعتباره قبل أن يحاول أن يكسر هذا الدفاع الواقى أو ذاك.
ثم تنتهى القصيدة نهاية قاتمة، لكنها مفتوحة.
(3)
والقفف المليانهْ الغلّهْ الكوسهْْ البادنجانْ،
الحُـبّ العطفْْ الخوفْ العَوَزَانْ،
تِفْضَى من كلهْْ.
ولا يفضلْْ غير قضبان القطر.
زىّ التعبان الميتْ.
مستنيَّه السبت الجىْ،
اللَّى ما بــيــجيشْْ.
هذه النهاية تقول إن ما يبدو من استحالة تحقيق النقلة البشرية المنتظرة، مع تزايد ألم المحاولة، قد يبدو مبررا للتنازل عن مواصل المحاولة، فتنسحب كل هذه الحركية إلى المجهول، إلى الداخل، إلى سكون الظلام، إلى جحر الثعبان الميت، كل هذا وارد لكنه ليس نهاية المطاف ما دام الإنسان إنسانا مازال به وعى ينبض.
نوع الانتظار هنا لم يقفل تماما بالرغم من هذه الصورة القاتمة، ذلك لأنه لم يترتب عليه انسحاب مطلق عودة إلى كهف الدار، استغناء عن زخم السويقة، بل إن علينا أن نستنتج أن صاحب أو صاحبة هذه العيون الحية، تظل قابعة بجوار قضبان القطار حتى لوبدت ثعبانا ميتا فربما ذلك هو نوع من الاحتجاج وليس إعلانا للانسحاب، حتى لو قالت “أنا ماشية” فهى لم تمش، وهى لم تعلن أن “السبت الجى” “عمره ما هو جى”، وإنما التعبير يوحى أنها سوف تنتظر مثلها مثل قضبان القطار، وأن هذا الانتظار واعد، وبرغم أن القطار لا يأتى “الآن”، فهو سوف يأتى،
وإلا فلماذا ثبات القضبان فى موقعها؟
هنا تتجلى أهمية فعل الانتظار الإيجابى، تتحدَّى سلبية التوقع الانسحابى.
وبعد
إليكم القصيدة كاملة فهى الأبقى رغم مكابدة الشرح وعلميته:
(1)
والنظرةْ ْْالصاحـْـيـَـهْ الواسعهْ الزحمهْ ،
زىّ سُوَيقـِيـَّة السبتْ، فى بلدنا.
زى القفف المليانهْ حاجاتْْ وحاجاتْ،
محطوطهْْ بالذاتْ،
على قلب شريطْْ قطر الدَّلتا.
كلّ ما القطر يصفَّر، بتلاقى الزحمة اتفضتْ.
والقفف السودا النسـِّوان بتشيل القفف البيضاَ الملْيَانهَ
حاجات وحاجات.
وَمَّا القطر يعدى: ترجعْْ كومْة القففِ النسوانْ، القففِِ النسوانْ:
تتلخبط على بعض، كما دقن الشايب.
(2)
أهى نظرة عينهْ زى سويقة السبت
فيها كل كلام الدنيا، وفْ نفس الوقت
فيها”رغبهْ” على ”دعوهْْْ”، على ”إشمـِـعـْـنَى”، على”رعشِةْ خوفْ”،
على “صرخة طفلْ”، على حَـلَمةْ بزْ،
على “عايزه اختارْ”،
“وانا مالى ياعمْ”،
”مش عايزه ألمْ”،
على “نِفْسِى أعيش”، “بس ما تمشيشْ”،
”خلينى معاكْ”، “خلينى ْبعيدْ”،
وِاذَا قلت أنا أههْ، أنا جىْ،
يـِسْمعنى كَمَا صُفارة القطر، ويْخَافْ.
وينط كلام العين جُوَّهْ: فى البطنْ،
أو تحت الأرضْ.
وتْلاقى سوادْها وِبَياضها بيجرُوا ورا بعض،
زى النسوان اللى بتجرى بقففها.
وامّا ابعد تانى:
ترجع كلِّ الكلمات الساكته المليانه ألم وحاجات،
و”تعالَى” و”رُوحْ” و”قوامْْ” و”استنَّى”،
”وانَا نِفسى تْقَـرّب .. إٍلا شويةْ” “طبْ حبّه كمانْ”
”يانهار مش فايتْْ !!،
”أنا خايفة “
“أنا ماشْيهْ”
(3)
والقفف المليانهْ الغلّهْ الكوسهْْ البادنجانْ،
الحُـبّ العطفْْ الخوفْ العَوَزَانْ،
تِفْضَى من كلهْْ.
ولا يفضلْْ غير قضبان القطر.
زىّ التعبان الميتْ.
مستنيَّه السبت الجىْ،
اللَّى ما بــيــجيشْْ.
اللوحة الثالثة:
القـط
تتداخل مراحل النمو (أثناء النمو، أو أثناء العلاج) تداخلا خفيا ومتنوعا يحتاج إلى فحص متأن طول الوقت. لا يوجد طور “كر– فر” (بارنوى) خالص، كما لا يوجد طور “علاقاتى بشرى” (اكتئابى) منفصل تماما، التداخل يشمل التذبذب والمراوحة طول الوقت([12]).
فى التشكيل الحالى المسألة لا تقتصر على التأكيد على الخوف من: الاقتراب، من الحب، من الهجر، من الترك، معا، التشكيل هنا لا يبدأ بالصد والدفع بعيدا، بل بمبادأة الاقتراب لاختبار إمكانية العلاقة دون التخلى عن التوجس والخوف، هو ليس طور “كرَ- فر” صرف، بل إنه بمثابة محاولة نقلة، تذبذب خطواتٍ تصف تنويعات متنوعة متبادِلة ما بين عدة أطوار فى نفس الوقت، طول الوقت، لكنها تنتهى – من فرط غلبة عدم الثقة والتوجس – إلى الطور اللاعلاقاتى (الشيزيدى) فنهاية اللوحة تقول:
“حاخطف حتة لحمة من ستى،
واجرى آكلها،
تحت الكرسى المش باين”.
ولكن دعنا نبدأ من البداية:
الصورة تبدأ بإعلان محاولة التراجع عن طور “الكر- فر” (البارنوى) بالتقدم نحو الطور العلاقاتى البشرى (سابقا: الاكتئابى) بشكل ما، كأنه يقدم أوراق اعتماده للآخر، ليعتبره “موضوعا بشريا” له حق الشوفان والاعتراف، وهو فى نفس الوقت يجس نبض وجود الآخر فى وعيه، وبالعكس، لعل وعسى.
(1)
والعين الخايَفَةْ اللى بْتِلْمَعْْ فى الضَّلْمَهْ
عمّالة تِختبرِ الناسْ:
بِتقرّب من بَحْر حَنَانْهُمْ،
زى القُطّ ما بـَيـْشـَمـْشِمْ لَبَن الطفل بشاربُهْْ.
فى قصيدة “جلد بالمقلوب” فى ديوان “سر اللعبة”، كان الخوف من الاقتراب هو الأصل، بدأت القصيدة هناك بأمر كأنه نذير أو تحذير من الاقتراب (من العلاقة البشرية) دفاعا ضد أى اقتراب:
لا تقتربوا أكثر، إذ أنى: ألبس جلدى بالمقلوب، حتى يـْـدْمى من لمس الآخر، فيخاف ويرتد: إذْ يصبغ كفّيه نزْفٌ حى!
أما فى الخبرة الحالية فقد حاولت أن أكشف كيف أنه فى الطور “الكرّ فرِّى” (=التركيب البارنوى) حين يحاول الكيان النامى أن يخطو خطواته الأولى للتعرف على الموضوع، إنما يفعل ذلك بتلقائية حذرة، وهو يتحسس طريقه للحصول على صك الوجود من خلال أن “يُشاف”، أن يُعترف به، هذه هى البداية التى تتيح له فرصة أن “يكون” فـ”يتواصل“. قصيدة “جلد بالمقلوب” (بالفصحى/سر اللعبة) تبدأ من بؤرة الطور البارانوى (الكر-فر) بالدفع بعيدا، فى حين أن التشكيل هنا يبدأ بإعلان تجربة الاقتراب برغم استمرار الخوف:
 بِتقرّب من بَحْر حَنَانْهُمْ،
بِتقرّب من بَحْر حَنَانْهُمْ،
زى القُطّ ما بـَيـْشـَمـْشمْ لَبَن الطفل بشاربُهْْ.
عمّالَـهْ بْتِسْأَل:
عـــايزينّى؟
طبْْ ليه؟
عايزينَّى ليه؟
توظيف هذا العمل (الشرح/الاستلهام) فى خدمة الإمراضية النفسية (السيكوباثولوجى) والعلاج النفسى، مع مخاطرة تشويه ومسخ الشعر شعرا، يسمح لنا بالإشارة إلى كيف أن محاولة عمل علاقة مع صاحب هذا التركيب فى هذا الطور هى مغامرة تحتاج إلى مهارة علاجية فائقة، علاقة حقيقية تحتوى أوهام المطاردة ولا تكتفى بكبتها، ولا تتسطح بالنصائح والإقناع، فى خبرتى وجدت أنها مرحلة عادة ما تحتاج إلى ما هو أكبر من العلاج الفردى، (بالإضافة إلى اللازم من عقاقير) لاحظت أن العلاج الجمعى، وكذلك علاج الوسط هما الأقدر على احتوائها بإعطاء المريض فرصة اختبار أكثر من “موضوع بشرى” واحد، بما يزيد من فرصة نجاحه فى محاولته مواصلة مسيرة النمو.
تبدأ هنا المحاولة انطلاقا من موقف التوجس الحذر، بمراجعة الأمر عبر الاحتمالات الأخرى، وذلك من خلال طرح تساؤلات بديلة عن أن الموضوع (مَنْ هو “ليس أنا”) هو خطر طول الوقت، الشخص فى مسيرته النمائية فى هذه المرحلة لا يكف عن التساؤل عن ما إذا كان “مرغوبا فيه” أم لا (عايزنّى!!؟). وهو بذلك يحاول أن يتجاوز يقينا سابقا كان يبرر له كـَـرِّه وفـَـرِّه طول الوقت، هذا اليقين الذى أكد، لوّح له بأن: “أحدا لا يريده، لا يعترف به، لم يره، لا يرغب فى الاعتراف به“، فهو بطرحه هذه الأسئلة يبدو أقرب استعدادا لتصديق الإجابة إن جاءت بالإيجاب، وهكذا يبدو أنه بدأ يخلخل يقينه من تجربته المريرة السابقة (توهما أكثر منها حقيقة) التى ضاعفت عنده ما وصله من مشاعر: الإنكار، والإهمال، والرفض، فهو يتساءل – يسائل نفسه أساسا – ما الذى جدّ، فيه أو فيهم، بحيث يشجعه على المضى فى المراجعة ربما يصله أنه أصبح “مرغوبا فيه” الآن؟
إشـِمعنى الْوقْـتـِى؟
وهو يواصل التساؤل – مهما وصله من إجابات إيجابية – فهذه طبيعة المرحلة، التى لا تستبعد وصول أية رسالة ذات فاعلية نمائية إليه.
من الطبيعى أنه يلزم للإقرار بالرغبة فى قبول “وجود” آخر، أن تعترف به، أن ترى حقيقته الكلية ابتداء ما أمكن ذلك، الحاجة إلى “الشوفان”، إلى الاعتراف، لا تتطلب مجرد الإعلان التقريرى أو إطلاق ألفاظ الحب والرضا، ولا حتى الرعاية الظاهرية! إن الأم تريد ابنها بداهة و”تعوزه” (إلا ما ندر)، لكن هل هى تريده وتظل تراه وهو فى طريقه أن يكون كيانا مستقلا منفصلا عنها بشكل حقيقى؟ أم أنها تراه غالبا، أو تماما، امتدادا لذاتها وكأنه ما زال قابعا فى رحمها؟ ثم هل هى تراه “كله”؟ أم ترى الشكل الذى يظهر منه ويسمح لها بامتلاكه؟ حتى الطفل فى هذه السن الباكرة يريد أن يُرى كله، وأن يُعترف به كما هو – له، وليس باعتباره شيئا مضافا إلى ملكية الأسرة، إلى ملكية الأم بالذات، هذه المرحلة هى طبيعة بيولوجية حيوية، وهى تستمر حتى نقضى.
اختفاء هذا الطور البارنوى من ظاهر الوعى هو أدعى لافتراض أنه اختفى بالإنكار، لا أكثر، وذلك يتفق ما أشرنا إليه من غلبة هذا الطور (الكر– فر) على معظم سلوك الإنسان المعاصر فى مرحلة تطوره الحالية.
بـِصحـِيحْ عـَايـْزِنَّـى؟
بقى حـَدْ شايـِفـْنـِى يـَا نـَاسْ؟
مِـشْ لازم الواحـِدْ منكم يعرفْ:
هوّه عـَايـزْْ مـِينْ؟
بقى حد شايـِفـْنـِى أنا؟
أنا مينْ؟
أنا أطلـع إيه؟ وازاى؟
طبْ لـِيه؟
الله يسامـِحْـكُمْْ مـِشْ قصدِى .
السماح هنا ليس سماحا حقيقيا بقدر ما هو تسليم لمختلف الإجابات عن أسئلته اللحوح:
“عايزنى؟ – بقى حد شايفنى “أنا”؟ – أنا أطلع مين؟”.
إن الاشتراط الضمنى الذى يربط “العوزان” بـ “الشوفان” بهذا القدر من الموضوعية، والكلية، قد يبدو أنه للتعجيز أكثر منه مطالبة حقيقية بالاعتراف، يبدو أن المناورة هنا تهدف للوصول إلى تبرير تجنب الخوض فى علاقة حقيقية، إذ كيف يطالب الإنسان – فى هذه المرحلة – الآخرين أن يروا داخله أيضا، أن يروه كله، فى الوقت الذى يبذل فيه كل جهده لتحقيق عكس ذلك؟!!!
وصل الأمر بأحد مرضاى من الصعيد جدا أنه كان يطلب من زوجته أن تجيب على السؤال الذى يطرحه، بنفس الإجابة التى فى ذهنه بنفس “اللفظ” هو هو جدا، مثلا: إذا كان فى ذهنه أنها سوف ترد بالإيجاب بـ“حاضر“، فهو ينتظر هذا اللفظ تحديدا دون أية لفظ آخر مثل “ماشى“، “موافقة“، أو “تمام”، وكانت إذا لم تأتِ باللفظ المحدد الذى فى ذهه، يرفض إجابتها، بل يرفضها ويشك فيها، وقد يعطيها فرصة أخرى وأخرى حتى إذا عجزت تماما ثار واعتدى عليها عدوانا بدنيا قاسيا تحت زعم أنها لا تراه، ولا تحس به، وكأنه يطلب منها أن ترى اللفظ الذى يدور فى ذهنه دون أن ينطقه، ثم يتطور الأمر إلى ما هو أخطر فأخطر حتى الاتهام بالخيانة لمجرد أنها لم تنطق بما توقع.
حين تشتد الحاجة للآخر بمثل هذا الشخص، فإنه قد يرضى بأية علاقة حتى لو كانت سريعة، أو مؤقته، وهو قد يكتفى أن تكون من جانبه هو فحسب، ولو كبداية، ثم إنها حين تكون من جانبه بهذه المبادرة، فإنها قد تطمئنه إذ يظل هو المتحكم فى شروطها، وكانه يخطفها خطفا دون إذن صاحبها، هذا الموقف يطمئنه جزئيا برغم استمرار توجسه ورفضه، وهو موقف انتظار بشكل ما، فيه درجة من البصيرة، لا تمنع استمرار المحاولة بل إنه يدل على عدم فقد الأمل فى علاقةٍ مهما كانت واهية أو مؤقتة أو مذبذبة، لكن المحاولة مستمرة.
(2)
أنا قاعـِدْْ راضى بْخوفِى المِـشْ راَضـِى.
أنا قاعد لامِمْ أغـْراَضـِى.
قاعد اتْـصنـَّتْ، فاتح وعْيى الجوّانى
على همس السِّتْ المِـشْ شايفانى،
وأسَهّيها،
واتمَسّح فِ كْـعوب رجليها.
تـتـْمـَلـْمـِلْ،
أخطف همسةْْ “أَيـْوَهْْ”، أو لـَمـِسـَة “يـِمـْكـِنْْ”.
واجرى اتدفَّى بْـ “يَعْنِى”،
وانسى الـ “مـِشْ مـُمْكـِن”.
شرحنا كيف أن هذا التشكيل يغلب عليه محاولة حقيقية للاقتراب الحذر، ونحن نبدأ هنا من مفاجأة أن هذا الشخص بدأ يتحسس سبيله إلى “علاقة” ما، لكنه كان قد اتخذ موقف “الانتظار”، أكثر من استعداده لمواصلة برنامج “الدخول والخروج”، الذى أشرنا إليه فى الحالة السابقة (السويقة)، وأيضا هو يختبر هذه الخطوة الجديدة تجنبا للانسحاب الذى يغرى بأن يعفيه من مواصلة استجداء الرؤية تبادلا مع أشواك التحفز.
موقف الانتظار هذا يتجسد فى هذا التشكيل كنوع من “الرضا النـَّـزق بالبقاء على مسافة”، حتى لو ظل الخوف يلازمه، تجسيده للخوف هنا ككيان مستقل يشير إلى رفض موقف الانتظار هذا. الخوف هنا قد أضيف إليه الضجر حتى أصبح حالة لا تطاق مهما كانت مبررات تطويل موقف الانتظار
“راضى بخوفى المشْ راضى“
هذا المقطع يظهر أنه مهما أعلن صاحب هذا الموقف رغبته فى الاقتراب، ومهما حاول بداية مشواره نحو تقليل المسافة بينه وبين الآخر، ومهما رضى بالقليل من الاعتراف به، أو سرقة بعض الدفء العاطفى حتى من وراء صاحبه أو صاحبته، فإنه يبدو كما لو كان لا يرحب بالتمادى فى هذا الموقف. إنه يتبين – حقيقةً أم توجـُّسـًا – أن ما يصله غير كاف، بل غير خالص، وسواء كان ما يصله أصيلا أو تفضلا زائدا، فإنه سرعان ما يفترض أنه عطاء مشكوك فيه، مغلف بضجر يبطل احتمال أية علاقة حقيقية.
“وأسَهّيها،
واتمَسّح فِ كْـعوب رجليها،
تـتـْمـَلـْمـِلْ”
ينبغى التذكرة بأن كل هذه المشاعر هى استقباله هو، أكثر منها حقيقة الحادث خارجه، إنه هو الذى يتصور أنه غير مرغوب فيه لهذه الدرجة، وذلك استكمالا لموقفه التوجسى الذى شرحناه أعلاه، وهو أيضا امتداد لموقف خطف العواطف، وسرقة بعض الدفء، إن كل ذلك إنما يؤكد أن الثابت فى قاع وعيه هو أنه مستحيل أن يُرى، أن يُقبل، أن يعترف به.
يحتاج اضطراد النمو، إلى المغامرة بقبول الاعتراف بأن ثم مصدرا للحب موجود كموضوع حقيقى يشجع حفز التقدم.
الذى يحدث هنا هو غير ذلك تماما، بل هو عكس ذلك، إذْ سرعان ما تقفز ردّة حادة بشكل أكثر توجسا، وأحدّ شكا، والأرجح أن هذه الردة بهذا العنف هى نتيجة أنه سمح لنفسه ببعض التصديق الذى سرّب إليه الدفء هكذا (الفقرة السابقة)، ولعل هذا يقابل الحذر من القـُرْب، والخوف من الحنان الصادق، فالإسراع بالهرب أو التشويه، وهو ما جاء فى قصيدة ديوان سر اللعبة ”جلد بالمقلوب” وهذا نص ما جاء فيها يدل على ذلك:
وبقدر شعورى بحنانـِك:
سوف يكون هجومى لأشوه كل الحب وكل الصدق،
فلتحذرْ :
إذ فى الداخلْ
وحشٌ سلبى متحفزْ
فى صورة طفلٍ جوعانْ
وكفى إغراء
وحذار فقد أطمع يوما فى حقى أن أحيا مثل الناس
فى حقى فى الحب([13])
الأمر هنا فى هذه اللوحة الحالية مختلف برغم أننا مازلنا فى نفس الطور (الكرّفرّى =البارنوى) من حيث إن هذا الجائع إلى الحب والاعتراف، هو هو الذى اقترب، هو الذى يتحسس طريقه، هو الذى يخطف أية بارقة حنان، هو المستعد أن يرضى بأقل القليل حتى توهما، لكنه لا يكاد يـُقـِرّ أن ثمَّ آخر يعطى دفءًا ما، حتى يرتد على عقبيه فيدور مائة وثمانين درجة وهات يا توجس، وهات يا شك، وهات يا استخوان، وهات يا دفع بعيدا، ومن ثم الهجوم، والتهديد، والعدوان، بلا تردد، ولا هوادة…الخ
كيف يمكن فهم هذا التناقض الظاهر؟
فى الموقف العلاجى (والنمائى) يبدو أن هذا هو الذى يجرى بدرجات مختلفة من عمق معين:
بمجرد أن تلوح علاقة حقيقية، يقفز دفاع التوجسن فالعدوان، والتهديد، والتربص، والدفع، هذا المقطع بالذات يذكرنا بشدة بالفرض القائل:
إن هذه المواقف المتتالية، (التى أصبحت أعاملها كأطوار تتكرر) ليست فقط مترتبة على علاقة الأم بطفلها فى مراحله الباكرة، بل إنها برامج منزرعة فى الإنسان نتيجة أنه يحمل فى تكوينه – بفضل الله – كل تاريخ تطور الحياة البيولوجية حتى مرحلة الإنسان، وبالتالى فإن دور الأم يكون بمثابة “المُطـْلِق” Releaser يبسط Unfold هذه البرامج بناء على فرض القانون الحيوى Biogenic Law (= نظرية الاستعادة Recapitulation Theory)([14])، ثم تستكمل الأم دورها بتدعيم هذا الموقف أو ذاك، حسب طريقة تربيتها له، وأيضا حسب تكوينها هى فى نفس الوقت، ثم تظل هذه الأطوار تتكرر وتتدعم كما بدأت غالبا من خلال النبض الإيقاعحيوى المعاوِد.
(3)
وأُبصّ لْكمْْ مِن تَـحْـتِ لـْتَـحْـت،
واستَـخـْوِنـْكُـمْْ، واتعرّى يـِمـْكـِنَ اطـَفـَّشـْكُـمْ،
وأبويَا النِّمر يفكّركمْ:
زى ما هوَّه بياكل التعلبْ،
أنا باكل الفارْ.
لكنى لمّا بقيت إنسانْ، باكل الأطفالْ،
والنسوانْ المِـلْـــكْ.
هذا الطور “الكر– فر” (البارنوى) لا يتميز فقط بالشك والتوجس، ثم الهجوم والهرب، لكنه يتميز أيضا باللجوء إلى طرق أخطر لإلغاء الآخر دون محوه، ليس فقط بالرجوع إلى تنشيط الطور الشيزيدى (العودة إلى الرحم)، وإنما بإلغاء الآخر باحتوائه بداخله، إن جوع البارانوى إلى الحب، وفى نفس الوقت خوفه الشديد من الحب، أو بألفاظ أخرى: إن مغامرة البارنوى، وهو حريص كل الحرص على الاحتفاظ بالآخر (الموضوع) حتى لا يرتد هو إلى قوقعته وحيدا، تجعله يلجأ إلى آلية الاحتواء، التى تظهر غالبا فى الاندفاع نحو التملك المطلق حتى الالتهام. هذا ما يشير إليه هذا المقطع من هذا التشكيل:
“لكنى لمّا بقيت إنسانْ،
باكل الأطفالْ،
والنسوانْ المِـلْـــكْ”
الموقف الالتهامى هنا، وهو أحد تجليات هذا الطور الكرّفرّى: البارنوى، وهو يبين كيف أن الإنسان المعاصر عامة، مازال يمارس معظم أشكال سلوكه من خلال هذا الطور البارنوى، وأن هذا الطور هو الذى يفسر الحروب والتنافس وسياسة السوق، ونضيف هنا: إنه يفسر أيضا التهام الكبير للصغير، ومعظم صنوف الاستغلال والاستعمال الظالم، والإبادة للمختلف، عرقيا أو دينيا أو مذهبيا (أيديولوجيا).
ومع هذه الرِّدة إلى عنف آلية الكر والفر، يتواصل الطرد، والإبعاد (التطفيش)، وهو هو موقف (طور) “لا تقتربوا أكثر” الذى جاء فى قصيدة “جلد بالمقلوب”.
(4)
ما تخافُوا بقى منَّى وتتفضّوا
مِنـتــِظْرينْ إيه؟
.. لسّه الحدوتةْ ما خُــلـْصـِتْـشِى؟
”ما لْهاش آخر”؟
{طب قولىّ كان فين أولها ؟…،
أو مين كان أصـْله اللى قايلها؟}
ثم ها هى التساؤلات تعود وكأنها تهدئ من تسارع التراجع، تساؤلات تكمل محاولة التحمل وإعلان الحرص على مواصلة المحاولة:
(5)
أنا نــِفــْسى أصدّقْ:
إنى مـِتـْعـَازْ.
مِـتـْعـِاَزْْ وخلاَصْ.
إنشالله كَـلاَمْ!!
…
عايـْزِنـِّى ازاى؟
عايـزنـى كما الـوَحـْشِ الكَـاسـِرْ،
ولا مكـسُورِ القـَلـْب ذليلْ؟
دانا حِمْلى تقيلْ.
مـوَّالِى طويلْ.
والناسْْ مـَلـْـهَّيـةْ.
إنما حـَاعـْمـِلـْها….
لسّه حوالىّ ماحدّش خاف، ولاَ كدّبنى؟
طب هِهْ:
راح اسيبْ.
من أخطر المواقف التى قد يمر بها المريض البارنوى (أو أى إنسان يمر بحدة فى مرحلة الطور البارنوى) هو أن يتخلى عن دفاعات الكر والفر، والتوجس والتآمر، وبالتالى أن يترك نفسه مطمئنا (جدا أو فجأة!!)، أو بتعبير أدق، أن يجرب خبرة الطمأنينة قبل أوانها، الخطورة تأتى من أنه ينقلب فجأة إلى كائن طيب، رخو، هلامى، يكاد يكون بلا دفاعات، ومن ثم بلا حول ولا قوة، من الناحية النظرية يمكن أن نتصور أن هذه التجربة يمكن أن تعتبر فرصة رائعة يتخلص بها البارانوى من احتمال وقفته فى هذا الطور بقية عمره، على اعتبار أنه بهذا التخلى عن شوك القنفذ وأنياب النمر معا، قد تتاح له فرصة جديدة لبداية مختلفة لمسار أكثر تـَـدَرُّجـًـا، ودعما، لكن من واقع خبرتى: العملية والمهنية، لا يسير الأمر هكذا، لأن هذا التنازل عن الدفاعات فى غير أوانها، يجعله نهبا لنفس الهواجس (أو الحقائق) وهو بلا حول ولا قوة، فيعانى أقسى المعاناة وأرعبها وهو يحاول أن يلملم نفسه أمام نفس القوى المغيرة (حقيقة أو تخيلا) وهو يتصور ساعتها أنها انتهزت فرصة تنازله عن دفاعاته فانقضـَّت عليه([15]).
واقع الحال أن هذا الموقف لا يمكن أن يصل إلى وعى صاحبه لا أثناء العلاج، ولا فى خبرات النمو، بهذه التفاصيل المحددة، ليس لأنه لا يحدث، وإنما لأنه إذا حدث بكل عمقه هكذا، لا يستغرق أكثر من ثوان، بل أقل، لكنه يحدث، ويتجلى فى الإبداع كما يتجلى فى الجنون، ونحن لا ندرك عادة فى الممارسة إلا آثاره الإيجابية، أو السلبية، على المدى الطويل، الآثار السلبية هى الأكثر تواترا إذا لم نحسن الإعداد، والاستعداد له، وهى تحدث غالبا نتيجة لسوء التوقيت، واستسهال التخلى والنسيان البعدى.
أشرنا – وسوف نشير كثيرا – إلى هذه اللحظات الشديدة القصر، التى تتم فيها النقلات النوعية المتناهية الصغر (والتى لها علاقة بحدْس اللحظة عند باشلار، وربما الفيمتوثانية عند زويل وفى العلوم الكوانتية)، هذه اللحظات الدقيقة جدا، يعرفها المعالج بحدسه اليقظ أكثر مما يرصدها بملاحظاته وحساباته، أما المريض (أو أى شخص ينمو)، فهو عاجز عادة عن رصدها إلا إحساسا غامضا إجماليا، لكن مهما ضؤلت هذه اللحظات، ومهما استعصت على الوصف، فإنها تثبت أن لها أثرا باقيا حقيقيا وممتدا، ولو بعد سنوات، لسنوات.
ولعل محمود درويش كان يعنى شيئا من ذلك فى قصيدته “أثر الفراشة”.. يقول درويش:
أثر الفراشة لا يُرَى
أثر الفراشة لا يزول
هو جاذبيةُ غامضٍ يستدرج المعنى، ويرحلْ
حين يتضح السبيلُ
هو خفة الأبدىِّ فى اليومى
أشواق إلى أعلى
وإشراق جميل
هو شامة فى الضوء تومئ
حين يرشدنا إلى الكلماتِ
باطننا الدليل
هو مثل أغنية تحاول
أن تقول، وتكتفى
بالاقتباس من الظلالِ
ولا تقول..
أثر الفراشة لا يُرَى
أثر الفراشة لا يزول!
المسئولية العلاجية بالذات (والعلاقاتية عامة) المحيطة بهذه اللحظات العابرة الزاخرة الغامضة هى جسيمة فعلا، ومتى شعر المعالج باحتمال مرور مريضه بمثل هذه الخبرة مهما ضؤلت، فإنه لو غامر بالسماح بها، فلا بد أن ينتبه إلى ما يمكن أن يترتب عليها، من فرصة رائعة وتغيير جذرى، أو من نكسة تراجع فاندمال بشع.
إن التخلى عن مثل هذا الشخص (أو المريض) الذى أمِنَ فترك نفسه بلا دفاعات، فى رحاب من اعتقد أنه أهل لثقته ولو للحظة أو بعض لحظة، هو من أكبر الأخطاء التى يمكن أن تـُرتكب على مسار العلاج، والحمد لله أن قلة من المعالجين هم القادرون على التلويح بمثل هذا الأمان، أو السماح به، لكن المريض، من فرط وخز شوك الطور البارانوى، ولهيب توجسه وحذره، قد يغامر بخوض التجربة من تلقاء نفسه بدون اختبار احتمال استعداد المعالج أن يتحمله، إن ذلك إذا ما حدث بمبادرة من المريض أو بدعوة ضمنية من المعالج، فإنه ينبغى أن يسارع المعالج بالتواجد المحيط الواثق بجوار المريض، فى متناوله، ولكن من على مسافة مناسبة، حتى لا يتمادى المريض فى الأمل فى الركون إلى أمان مطلق (عادة حسب تصوره)، أمان يسحبه إلى احتمال الانمحاء فى الرعاية الحاوية، ومن ثَمَّ يجد نفسه فى موقف الاحتواء، المغرى بالانسحاب للطور الشيزيدى ربما بغير رجعة([16]).
فى حالة حدوث سوء التوقيت هذا، على مسار العلاج، بما يترتب عليه ما ذكرنا بما يمكن أن ينتهى إليه من تراجع، ومهانة، وإحباط، إذا حدث ذلك فإن معاودة طرح استعادة الثقة بالمعالج، أو بالوسط العلاجى، تصبح أصعب مما كانت عليه قبل بداية العلاج بشكل أو بآخر.
قبل أن ننبه إلى التحفظات اللازمة لتجنب ذلك، دعونا نعود إلى الصورة المقابلة فى “لوحة القط” من هذا الديوان الحالى، فهى أخف.
وجدت أن هذه الخبرة الباكرة كما وردت فى ديوانى “سر اللعبة” تتميز عن الخبرة هنا فى أنها أدق وصفا لهذه المغامرة غير المحسوبة عادة، فى هذه اللوحة الحالية من أغوار النفس، سمح الشخص لنفسه أن يتنازل عن دفاعاته بمجرد أن بلغه أن الآخر (الآخرين) لم يتركوه، ولم يكذّبوه:
“لسّه حوالىّ ماحدّش خاف، ولاَ كدّبنى؟
طب هِهْ: راح اسيبْ”.
“لسّه حوالىّ ماحدّش خاف، ولاَ كدّبنى!!؟
طب هِهْْ: راح اسيبْ”
دعونا نلاحظ الفرق بين هذا السيبان، وبين ما جاء فى قصيدة جبل الرحمات، فلعلنا ننتبه إلى أن “السيبان” هنا هو تخل عن دفاعات الطور البارنوى، حتى يصل إلى الشعور بعودة الجسد نفسه إلى معالم بدائية ممتزجة، بلا حول ولا قوة:
(6)
أنا جِسمى اتبعزقْ،
زىّ فطيرة مشلتتة لسّهْ ما دخلتشِى الفرنْ.
ولا عادْ لى إيدْْ ولاَ رِجْل،
ولا قادر اتـْـلَـمْ..
ياحلاوةِ دَقةْ قلبى وهىَّ بْـتِـحويكُمْْ
يا حلاوة نَفَسىِ الطـَّاِلعْْ داخلْ وسْطــيكُمْ.
طايرْ نواحيكمْ. ناحيةْ ربنا فيكُـمْ.
يا حلاوةٍٍ الحنّيةْ الهاديةْ الناديةْ:
لا بْتسألْْ مينْ ولا ليهْ!!
ولا عادْْ لى إيدْ ولا رجلْ ولا عارف اتـــلمْْ.
ربما يكون الفرق المهم بين هذه الخبرة، وبين ما جاء فى القصيدة الفصحى، هو فى أمرين:
أن صاحب هذه القصيدة هنا لم يكن مريضا، وبالتالى بدت تلقائيته فى التنازل عن الدفاعات أقوى وأكثر مبادرة ودافعة إلى مواصلة السعى إلى الآخر
“رايح نواحيكم”
كما أن القوة الضامـَّـة المركزية التى أشرت إليها فى مواقع كثيرة من قبل، وهى التى تستلهم قوتها ومشروعيتها من انجذاب الوعى الشخصى إلى ما، وإلى من، يجمع الناس بعضهم ببعض (اجتمعا عليه وتفرقا عليه)، بل إلى من يجمع الأكوان إلى بعضها دون أن ينفصل عن الوعى الشخصى (أقرب إلى حبل الوريد) ربما هذا هو ما عبر عنه الحدس الشعرى.
“يا حلاوة نــَفــَسـِي الطـَّاِلعْْ داخلْ وسْطــيكُمْ
طايرْ نواحيكمْ، ناحيةْ ربنا فيكُـمْ”
(هذا ضمان موضوعى أتعامل معه فى العلاج الجمعى عمليا، وفى علاج الوسط، وإلى درجة أقل فى العلاج الفردى، بشكل واقعىّ شديد الإفادة).
أيضا تتميز هذه القصيدة هنا بإضافة تشير إلى أن عدم تدعيم هذا الطور بالألفاظ (والتفسير) هو أمر مطلوب وجيد، (لا بْتسألْْ مينْ ولا ليهْ!!) كما نلاحظ أن ثمة إشارة إلى أن ما يسمى التغير النوعى لإدراك الذات depersonalization (وهو هنا من علامات النمو أكثر منه عرضا مرضيا) قد تم التنويه عنه فى المتن أيضا:
“وأنا برضه نسيت أنا مين، وأنا إيهْ”
التراجع هنا فى هذه القصيدة بدأ من صاحب الخبرة نفسه حين لم يصدق أن هذا الحال يمكن أن يدوم، وأنه لا يمكن أن يُصبر عليه: “ولإمتى كده؟؟ لأ مش قادِرْ”. لم يكن نتيجة أن الآخر انتهز الفرصة فانقض عليه، إن المطمئن هنا (قبل الأوان) قد يتملكه الخوف، وهو لا يسارع بلوم الآخرين واتهامهم بالتخلى أو الخيانة، بل إنه يتبين فى نفسه التنشيط الذى حدث للطور البارنوى داعيا للتراجع، بدءا بالخوف من الاقتراب (لا تقتربوا أكثر)، بالخوف من الثقة، بالخوف من الحب، بالخوف من الآخر، وهو هنا يدرك مسئوليته فى الدفع والرفض، حتى أنه هو الذى يجهض التجربة، ويسارع بالعودة إلى ميكانزماته البارانوية بكل زخمها:
(7)
“أصـْل انـَا خايفْ، أنا خايفْ موتْ، إخص عَــلىَّ، خايف من إيه؟
من لمسْ أْيدين أيها صَاحــىِ.
أهى كِـدا باظتْ،
باظت منّى،
رِجعتْ “لكـنْ”:
خايف تِـفْـعـَصـْنـِى انـْتَ وهـُوَّهْْ،
وتقولوا بـِنـْحـِبْْ.”
وهو يبرر ذلك ليس بانقضاضهم عليه، وإنما بعجزهم عن رؤيته، عن الاعتراف به، عن حبه.
“إيش عرّفكمْ باللِّى ما كانشِى،
باللِّى ما لُوهشِى،
باللِّى ما بانْــشىِ”
وبعودته إلى دفاعاته البارنوية، يرجع التوجس، واليقظة البشعة المتلفتة، “
عمّال باحـْسبْْ هـَمـْس حـَفِيفـْكـُمْ.
باحـْسـِبْ خوْفكُـمْ.خوفـِى مـِنْـكُـمْْ.
مخّى مصـَهـْللِ، وبـْيـِتـفرّج،
ولا فيش فايدة”
يبدو أن هذه الخبرة هنا هكذا يمكن أن تنتهى بمضاعفات أقل، فنلاحظ أن ثمة عودة تلوح فى اتجاه استعادة دفاعات الطور البارنوى دون اندمالات ظاهرة، فيعلن مثل هذا الشخص الجوع إلى الآخر شريطة ألا يقترب، إلا بمقدار، فهو الشك والتوجس، فالتذبذب بين الإقدام والإحجام الذى يتصف به الطور البارنوى، لكنه يبدو هنا أنه يتزايد باضطراد لا يعد بنهاية قريبة
(8)
“نـطـّ منّى، غصب عنّى،
جوعه مسعورْ،
ويعايرنـِى،
شككنى فى الكُـلْ كليـِلهْ”
مع هذا التراجع والتمادى، يقفز تهديد جديد يلوح بالعودة إلى الخلف أكثر، إلى الطور الشيزيدى،
رجّعنى للوِحدة النيلة!
بلا طائل:
لمَّيـتْـنِى، وياريتْنِى لقيتْنى…
ثم مزيد من التراجع إلى التحوصل.
من الصعب تماما أن يواصل مثل هذا الشخص (أو أى شخص) معايشة هذا الموقف وقتا أطول، وهو إذ يحبط بكل هذا القدر، يجد نفسه فى مواجهة واقع قاس متربص بعيد مستعد للانقضاض، فيحاول أن يلملم نفسه وكأنه بذلك يحميها من استجداء آخر بلا أمل، ولكن هذا اللم لا يحقق له وجودا بشريا حقيقيا “يأخذ ويعطى”، فهو موجود فردا منفصلا، فهو غير موجود:
لمَّيـْتـنِى، وياريتْنِى لقيتْنى
ومع استمرار هذا الوضع يكون المعروض هو نكوص كامل إلى الرحم، أى إلى مكافئاته الممكنة، (الانسحاب– التقوقع – اليأس من الحب… إلخ) لكن المتن هنا يعرى هذا الانسحاب باعتبار أن العودة إلى الرحم هى نكسة وهزيمة، لكنها الحل المطروح الجاهز ظاهر .
(9)
“فينك يا مّه؟
نفسى اتكوّم جوّاكى تانى،
بطنك يامّه أَأْمـَنْ واشرف من حركاتـْـهم”
ولكن هل هو حل فعلا؟؟!!
التراجع المتمادى يقدم هذه الخطوة كأنها حل ممكن، يعفى صاحبنا (يعفينا) من شوك الشك، وإهانة الصد، وقسوة الترك، ليكن، لكن لا بد أن نعلم أنه مهما بدت رغبة المريض (أو السليم) فى تجنب كل ذلك بالانسحاب الأقصى، فإن طبيعة دفع الحياة فى داخله، وفى خارجه أيضا، ترفض هذا الحل، المتن هنا ينبه إلى صعوبة هذا التراجع مهما لوح بأنه الحل، فيُجرى حوارا بين الرحم (الأم) الملجأ التى تنبه أنه ليس سهلا هذا القرار، وبين المتراجع، تـُحـَذّر الأم:
وانْ ما قدرتشْْ!!؟
نرى من خلال هذا الحوار كيف ان الطور البارنوى المحبـَـط بعد إلقاء سلاح دفاعاته هو أصعب من الموت نفسه، حتى الموت يبدو بعيد المنال:
(إلموت أهون
– وان ما حصلشِى؟
= تبقى الفُرجَة، وْشـَكّ الغُــرْبـَة، وشـُوكِ الوحـْدهْ.)
إذا تبينتْ حقيقة قنوات النكوص إلى الرحم هكذا، وظهر مدى صعوبتها، وأيضا إذا امتنع العدم (الموت) لم يتبق للشخص إلا العودة إلى الطور البارنوى الذى يكون قد فقد زخم حدته بعد أن ألقى صاحبه سلاحه، فيغلب الجانب السلبى فيه: فهو لم يعد موقف كر وفر، بل أصبح موقف شلل، وغربة، وتوجس وألم، وشكوك وانتظار، وهذا هو أقسى وأذل أوجه الطور البارنوى: حين يعجز عن الخطو نحو الطور العلاقاتى (الاكتئابى)، وفى نفس الوقت يعجز عن النكوص إلى الرحم، وأيضا عن الاختفاء العدمى (الموت)، وأيضا وفى نفس الوقت يعجز عن أن يواصل شحذ آليات دفاعه كرا ولا يبقى أمامه إلا خزى الفرّ شبه الدائم.
حين تسد الطرق هكذا يعلن المتن شكل المآل المهين.
“تبقى الفُرجَة،
وْشـَكّ الغُــرْبـَة،
وشـُوكِ الوحـْدهْ”
وهو فى تسجيل وقفة لالتقاط الأنفاس، دون تراجع كامل، ودون الإسراع بالعودة للمحاولة وكأن هذا هو غاية الممكن بعد ذلك الإحباط القاسى.
فى العلاج النفسى، نحاول أن نتجنب هذا المآل الاستسلامى المؤلم، حتى لو صاحبه اختفاء الأعراض المزعجة مثل الضلالات والهلاوس، خاصة ضلالات الاضطهاد، ليحل محلها ضلالات الإشارة (مثلا)، ولعل هذا هو المقصود بـ
“تبقى الفرجة“،
وشك الغـُـرْبة،
وشوك الوحدة”.
تنتهى الفقرة بأن هذا المصير هو الأمر الواقع الجديد (ولو كان مؤقتا على مسار النمو).
“أهو دا اللى حصل!!”
هل يمكن أن يكون ذلك، أو بعض ذلك، هو مآل (أو مضاعفات) بعض العلاج النفسى غير الموفق؟
الإجابة هى بالإيجاب للأسف، لو توقف العلاج عند هذا الحد:
إن تعريض المريض للتخلى عن دفاعاته، دون جاهزية الإحاطة العلاجية، والدعم، والحوار الممتد، يمكن أن يؤدى إلى تأكيد الإمراضية الغائرة (السيكوباثولوجى) برغم احتمال تخفيف الأعراض الظاهرة.
لا توجد فائدة، والموقف كذلك، فى التركيز على بحث الأسباب، أو لوم المحيطين، ذلك أن الشخص (أو المريض) فى هذا الموقف يكون مشاركا فاعلا فى تفاقم أحواله، الذى انتهت به إلى هذا الاستسلام الذى يبدو أبعد ما يكون عن احتمال إعادة التحريك، فماذا يفيد التساؤل أو البحث عن الأسباب، ونحن أمام واقع جسيم حصل ورسخ؟
” – طب ليه يا بنى؟
“أهو دا اللى حصلْ”
فى كثير من الأحيان، يتجمد الموقف عند هذا الاستسلام، شعوريا أو لاشعوريا، فهى لم تعد معركة كر، ولا هى تجاوزت ذلك إلى مخاطرة علاقة حقيقية بالموضوع مهما كانت مؤلمة، ولا هى سمحت بعودة إلى الرحم تراجعا طلبا لراحة سلبية وكرامة تجنبية، فلا يتبقى أمامه من فرصة تلامس مع آخر إلا “بخطف لمحة عاطفية من هنا“، أو “توهم رؤية محتملة لوجوده من هناك“، ثم عودة سريعة إلى الحوصلة الشيزيدية، وهكذا طول الوقت، هذا ما يقوله النص:
(10)
“راجع “كما كُـنْـتْ”،
قاعدْ ساكتْ تحتِ سرير الستْ،
حاخطــفْ حتة نظرة، أو فتفـُوتـِةْ حُـبْ،
واجرى آكلها لْوَحْدى، تحت الكرسى الـ”مِش باين”
من هنا وجبت إعادة التأكيد من جديد على ضرورة إتقان حسابات التعرض لمثل هذه الخبرة، لأنها ما لم تكن محسوبة ومدروسة وتجرى فى مجتمع علاجى سليم، ووسط خاص وداعم وممتد للفترة الكافية، .. مالم تكن هذه الشروط متوافرة فإن التعريض لهذه الخبرة يصبح تخبطا عشوائيا خطرا لا علاجا مسئولا.
أنا لا أنكر أننى فى أول حماسى لهذه الطرق العميقة الرائعة فى العلاج النفسى المكثف، لم أكن كثير الحسابات ولا دقيقها مثل الآن([17])، ولذلك فقدت كثيرا من أصدقائى ومازلت متألما ليس فقط لفقدهم، ولكن لما يمكن أن يكون قد أصابهم من جراء حماسى، وبرغم هذا الإحباط المبدئى فإن المتابعة بعد ذلك بسنوات أثبتت لى أن هذه الخبرة مهما اختفت وحاول صاحبها أن يتناساها أو يطمسها يمكن أن تعود لتثرى وجوده باختياره ولو بعد حين، الأمر الذى بدأ يخفف من ألمى، ويؤكد لى دائما قدرة الإنسان على استيعاب خبراته الإيجابية ولو طال الزمن.
وهاكم المتن كاملاً، مرة أخرى. عذراً:
(1)
والعين الخايَفَةْ اللى بْتِلْمَعْْ فى الضَّلْمَهْ
عمّالة تِختبرِ الناسْ:
بِتقرّب من بَحْر حَنَانْهُمْ،
زى القُطّ ما بـَيـْشـَمـْشمْ لَبَن الطفل بشاربُهْْ.
عمّالَـهْ بْتِسْأَل:
عـــايزينّى؟
طبْْ ليه؟
عايزينَّى ليه؟
إشـِمعنى الْوقْـتـِى؟
بـِصحـِيحْ عـَايـْزِنَّـى؟
بقى حـَدْ شايـِفـْنـِى يـَا نـَاسْ؟
مِـشْ لازم الواحـِدْ منكم يعرفْ:
هوّه عـَايـزْْ مـِينْ؟
بقى حد شايـِفـْنـِى أنا؟
أنا مينْ؟
أنا أطلـع إيه؟ وازاى؟
طبْ لـِيه؟
الله يسامـِحْـكُمْْ مـِشْ قصدِى .
(2)
 أنا قاعـِدْْ راضى بْخوفِى المِـشْ راَضـِى.
أنا قاعـِدْْ راضى بْخوفِى المِـشْ راَضـِى.
أنا قاعد لامِمْ أغـْراَضـِى.
قاعد اتْـصنـَّتْ، فاتح وعْيى الجوّانى
على همس السِّتْ المِـشْ شايفانى،
وأسَهّيها،
واتمَسّح فِ كْـعوب رجليها.
تـتـْمـَلـْمـِلْ،
أخطف همسةْْ “أَيـْوَهْْ”، أو لـَمـِسـَة “يـِمـْكـِنْْ”.
واجرى اتدفَّى بْـ “يَعْنِى”،
وانسى الـ “مـِشْ مـُمْكـِن”.
(3)
وأُبصّ لْكمْْ مِن تَـحْـتِ لـْتَـحْـت،
واستَـخـْوِنـْكُـمْْ، واتعرّى يـِمـْكـِنَ اطـَفـَّشـْكُـمْ،
وأبويَا النِّمر يفكّركمْ:
زى ما هوَّه بياكل التعلبْ،
أنا باكل الفارْ.
لكنى لمّا بقيت إنسانْ، باكل الأطفالْ،
والنسوانْ المِـلْـــكْ.
(4)
ما تخافُوا بقى منَّى وتتفضّوا
مِنـتــِظْرينْ إيه؟
.. لسّه الحدوتةْ ما خُــلـْصـِتْـشِى؟
”ما لْهاش آخر”؟
{طب قولىّ كان فين أولها ؟…،
أو مين كان أصـْله اللى قايلها؟}
(5)
أنا نــِفــْسى أصدّقْ:
إنى مـِتـْعـَازْ.
مِـتـْعـِاَزْْ وخلاَصْ.
إنشالله كَـلاَمْ!!
…
عايـْزِنـِّى ازاى؟
عايـزنـى كما الـوَحـْشِ الكَـاسـِرْ،
ولا مكـسُورِ القـَلـْب ذليلْ؟
دانا حِمْلى تقيلْ.
مـوَّالِى طويلْ.
والناسْْ مـَلـْـهَّيـةْ.
إنما حـَاعـْمـِلـْها….
لسّه حوالىّ ماحدّش خاف، ولاَ كدّبنى؟
طب هِهْ:
راح اسيبْ.
(6)
أنا جِسمى اتبعزقْ،
زىّ فطيرة مشلتتة لسّهْ ما دخلتشِى الفرنْ.
ولا عادْ لى إيدْْ ولاَ رِجْل،
ولا قادر اتـْـلَـمْ..
ياحلاوةِ دَقةْ قلبى وهىَّ بْـتِـحويكُمْْ
يا حلاوة نَفَسىِ الطـَّاِلعْْ داخلْ وسْطــيكُمْ.
طايرْ نواحيكمْ. ناحيةْ ربنا فيكُـمْ.
يا حلاوةٍٍ الحنّيةْ الهاديةْ الناديةْ:
لا بْتسألْْ مينْ ولا ليهْ!!
ولا عادْْ لى إيدْْ ولا رجلْ ولا عارف اتـــلمْْ.
(7)
“أصـْل انـَا خايفْ، أنا خايفْ موتْ، إخص عَــلىَّ، خايف من إيه؟
من لمسْ أْيدين أيها صَاحــىِ.
أهى كِـدا باظتْ،
باظت منّى،
رِجعتْ “لكـنْ”:
خايف تِـفْـعـَصـْنـِى انـْتَ وهـُوَّهْْ،
وتقولوا بـِنـْحـِبْْ.”
“إيش عرّفكمْ باللِّى ما كانشِى،
باللِّى ما لُوهشِى،
باللِّى ما بانْــشىِ”
عمّال باحـْسبْْ هـَمـْس حـَفِيفـْكـُمْ.
باحـْسـِبْ خوْفكُـمْ.خوفـِى مـِنْـكُـمْْ.
مخّى مصـَهـْللِ، وبـْيـِتـفرّج،
ولا فيش فايدة”
(8)
“نـطـّ منّى، غصب عنّى،
جوعه مسعورْ،
ويعايرنـِى،
شككنى فى الكُـلْ كليـِلهْ”
رجّعنى للوِحدة النيلة!
لمَّيـتْـنِى، وياريتْنِى لقيتْنى…
(9)
“فينك يا مّه؟
نفسى اتكوّم جوّاكى تانى،
بطنك يامّه أَأْمـَنْ واشرف من حركاتـْـهم”
وانْ ما قدرتشْْ!!؟
(إلموت أهون
وان ما حصلشِى؟
= تبقى الفُرجَة، وْشـَكّ الغُــرْبـَة، وشـُوكِ الوحـْدهْ.)
“تبقى الفُرجَة،
وْشـَكّ الغُــرْبـَة،
وشـُوكِ الوحـْدهْ”
– طب ليه يا بنى؟
“أهو دا اللى حصلْ”
(10)
 “راجع “كما كُـنْـتْ”،
“راجع “كما كُـنْـتْ”،
قاعدْ ساكتْ تحتِ سرير الستْ،
حاخطــفْ حتة نظرة، أو فتفـُوتـِةْ حُـبْ،
واجرى آكلها لْوَحْدى، تحت الكرسى الـ”مِش باين”
اللوحة الرابعة:
البـِـركة
مقدمة:
مضطر أنا للعودة إلى إشكالة أن المنطقة الحساسة التى تميز الإنسان كائنا راقيا لا يستحق هذا الاسم “الإنسان” إلا حالة كونه “متواصلا مع إنسان” مثله، دليل هذا هو ما يوصف عشوائيا بأن “الحب”!!
مرة أخرى: كلمة “الحب” مثل كلمات الحرية والديمقراطية وحتى كلمة “الله”، (وليس حقيقة الله طبعا – النفّرى)، تمثل عندى إشكالة بلا حدود، لن أكرر ما سبق أن قلته فيها عشرات المرات، فالمهم([18]) هو أن نفرق بين الحب الحب، والحب كنظام الحب، والحب اللاحب.
العلاقات التجاذبية السريعة، تتم غالبا، خاصة فى بلاد تسمح بعلاقات حرة سهلة (هكذا تسمى)، دون تردد أو خوف، كما أنها تكسر القيود (إن كانت ثمة قيود) سواء كانت قيودا أخلاقية فوقية، أم دينية، أم تقاليد، لأنها تحدد الغرض منها: رغبة متبادلة، واتفاق معلن، وتخلٍّ جاهز، شىء أشبه بالوجبات السريعة اللذيذة.
هذه العلاقات تقوم بالواجب أحيانا، ولا يمكن شجبها على إطلاقها إلا بمقاييس أخلاقية ترتبط أساسا بالثقافة التى تتم فيها، فلكل ثقافة منظومتها الأخلاقية التى تسمح أو لا تسمح، تقر أو تجُبّ، ونحن إنما نسعى إلى التعرف على الطبيعة البشرية بما تيسر من حدس وتجارب وإبداع، وما أتيح من العلم.
يبدأ المتن هكذا:
(1)
 والعين الهادية الناعمة:
والعين الهادية الناعمة:
ْْ بتقول أنـا اهُـهْ.
أنا مـِشْ خايفهْ
لو الاقى حد يقرّب لى
ولاقينى برضُهْ بأقـَرَّبَ لهْ
حاخده بالحضن،
وكإنى باحب.
ميـَّتى رايقهْ، و هاديْه، وخضراَ…‘
….. وخلاصْ.
أهم ما يميز مثل هذه العلاقات هو أنها لا تدّعى الحب، بل أحيانا تشترط ألا يكون فى هذا التقارب المحدود حبا([19]) التعبير قرب نهاية هذه الفقرة فى القصيدة “وكأنى باحب”، لا يظهر عادة فى وعى من يتعاطون هذه الوجبات اللذيذة المؤقتة السريعة، وهو تعبير لا يتهم هذه العلاقات بالزيف، لكنه قد يكون قد حضرنى – شعرا – بمعنى ما دام الحب الحقيقى (انظر بعد) غير موجود، فهيا “نلعب حبا”، (مثلما كنا صغارا نلعب “بيوتا” فى الشرفة، ونهدّها بمجرد أن تنادى علينا أمنا، أو نسمع صوت المفتاح يعلن قدوم والدنا من العمل).
كل ما أرجوه منكم هو أن نؤجل الأحكام الآن ومن لا يستطيع أن يفصل حماسه الجاهز، وقيمه الخاصة، وهو يقرأ معنا هذه الاجتهادات غير المألوفة، فليعتبر أننا ننقد شعرا لا أكثر (هذه الملاحظة لم أضعها هامشا لأهميتها)
إذا تأملنا أن مجموعة هذه القصائد تكشف – ضمن ما تكشف – ذواتنا المتعددة، فتعرى الزيف أو تبرره أو تسميه تلطفا باسم أرقّ، وربما أصدق، فإننا سوف نجد أن أغلب قراءتنا لهذه القصائد فى هذا الكتاب بصفة عامة، ونحن نستلهم منها الطبيعة البشرية، نحاول أن نفك من خلالها بعض شفرة النص البشرى، ربما نضيف ملاحظات هامة، وربما أساسية على عملية العلاج النفسى.
فكرة العيون التى بداخل العيون هى أساسية من حيث إنها شهادة مباشرة عن إمكانية الحوار مع ذوات متعددة، وبالتالى هى فكرة تتجاوز لغة الشعور واللاشعور، مع أنه لابد من الاعتراف بالفضل لسيجموند فرويد بهذا السبق بالاشارة إلى العالم التحتى، على الرغم من تعامله مع “الهو” باعتباره “شـُواشاً” Chaos ليس له حضور إلا من خلال الشعور الظاهر (الأنا)، القراءة هنا تتجاوز ذلك، كما تتجاوز أيضا ثلاثية إريك بيرن، (الذوات الثلاثة: الطفل واليافع والوالد) فهى تتعامل مع أى عدد من االذوات باعتبارها كيانات كاملة، كل ذات منها (تنظيم – مستوى وعى – عقل آخر) لها موقف، ومشاعر، وفلسفة، ورؤية، لا تناقـِض بالضرورة الظاهر، لكنها قادرة بشكل غير مباشر على التعبير عن كل ذلك، إما بالأعراض، وإما من خلال آليات العلاج النفسى، وإما غير ذلك.
القصائد عموما فى هذا العمل تجرى على لسان صاحب أو صاحبة العيون، ثم على لسان الذوات داخل العيون، ثم داخل داخل العيون، إلى ما يمكن من مستويات وتنظيمات متعاقبة متكاملة متبادلة، أومتعارضة ناقدة محذرة ساخرة.
نبدأ بالنافذة الخارجية، و”صاحبتنا الواجهة” تفتحها وتنادى، وتسمح، فهى تنكر خوفها، وتعلن استعدادها وجاهزيتها بنداء هادئ وسْـنان، مرة أخرى:
والعين الهادية الناعمةْ، بتقول أنـا اهُـهْ.،
أنا مـِشْ خايفهْ،
لو الاقى حد يقرّب لى،
ولاقينى برضه بأقرّب له،
حاخده بالحضن،
وكإنى باحب”.
لكن ثـَمَّ عينٌ داخل هذه العين هى العين الداخلية الناقدة الحذرة المحَــذِّرة تتربص بها، فتنقض بمجرد إعلان هذا الاعتراف الضمنى بزيف الجارى: “وكإنى باحب”. تنتهز هذه العين الأخرى الداخلية الفرصة فتقفز متمادية فى تعرية هذه العلاقة قبل أن تبدأ هكذا:
(2)
والعين التانية جوّاها ْ بتقول عـنـْـدِكْ:
باين على شكلـِك مش خايفهْ؟
خايفة ليقولوا عليكى هايفة؟
دانا خوفى اتجمّد من خوفى،
دانا خايفه أخاف.
والمية هاديهْ عشانِ بِـركَـة،
مش نيلْْ ولا بحـــْـر.
حسب تحذير هذه العين الأخرى الناقدة نكتشف أن اختفاء الخوف كان خارجيا، وهو الذى سمح بالنداء الظاهرى الجاهز، فهو إنكار للخوف، أكثر منه طمأنينة حقيقية، إذن فالدعوة الجريئة البادئة، ليست سوى الغطاء الذى يسهل مثل هذه العلاقات السطحية السريعة المؤقتة، لحساب الانسحاب إلى الداخل الذى يساوى ما أشرنا إليه مكررا تحت لافتة الموت النفسى، وكأنه اعتراف بأن هذه الوجبات لا تسمن ولا تغنى من جوع، وإنما هى تؤكد اختيارا إمراضيا انسحابيا خامدا.
مشوارى طويلْ.
خلّونى فْ حالي.
البـِنْـج حَـلالـِى.
موتِى بيحلالى، يا خـــالى.
هل كل ذلك يبرر شجب هذه العلاقات السطحية التسكينية على طول الخط؟
بصراحة: ليس بالضرورة.
قد ينجح مستوى العلاقات من نوع “الوجبات السريعة“، تلك، طالما أن هذه العين الداخلية الناقدة المتربصة موافقة، أو نائمة، أو مُستبعِدة، حتى لو أقرت – ساخرة أو راضية – بأن هذا التخدير الإنكارى هو موت لذيذ “موتى بيحلالى ياخالى”.
فى العلاج النفسى – كما هو فى الحياة عموما – ليس المطلوب أن نرفض ومن البداية هذه المستويات التى نسميها مسطحة أو سريعة أو مؤقتة ما دامت هى العلاقات الممكنة فى البداية على الأقل.
إذا بدأنا بتصديق كل هذه التعرية القاسية كما جاءت فى القصيدة، فكيف يتدرج نضج العلاقات بقدر تدرج الكشف وجدل النمو!!
ليس المطلوب هو أن نعلن ومن البداية كل هذا الشجب الذى يتبدى لنا من خلال هذه التعرية القاسية هكذا، بل دعونا نقرأ هذا الشجب فى عكس الاتجاه حين نقرأ هذه التعرية باعتبارها ليست دعوة حقيقية للتقدم نحو علاقات أعمق واصدق، بقدر ما هى مبرر لرفض العلاقة مع الآخر من حيث المبدأ، إعلانا للخوف الأزلى الأعمق من الحب الأعمق والأصدق، من الاقتراب، وبالتالى فإن هذا النقد الساخر – برغم صدقه – قد لا يوظف إلا لدفع الآخر بعيدا، تمهيدا للانسحاب الشيزيدى (إلى الطور اللاعلاقاتى).
“الخوف من الحب” الحقيقى، هو الإشكالة الأساسية فى كل هذا العمل (هذا الديوان، هذه التداعيات)، هنا ننبه أن المبالغة فى التحذير من تجنب العلاقات جميعا هكذا من حيث المبدأ، فى انتظار الأضمن والآمَن، هو تعرية قاسية تُجهض أية محاولة بدئية أن نقبل أن “نلعب حبا“، إلى حين أن نعرف “كيف نحب“، أرجو ألا تُستقبل وجهة النظر هذه باعتبارها دعوة للاستسهال أو تبريرا للإنكار، فلعلها نوع من نقد النقد، وأيضا دعوة لتقبل الواقع، والتدرج على الطريق.
الذين يمارسون العلاج النفسى المكثف (العميق)، يقعون فى مأزق حرج حين يتصورون أن ممارستهم لا بد أن تقتصر على تعهد إتاحة الفرصة لعلاقات موضوعية أبقى وأرقى، المفروض أن العلاج النفسى هو علاقة مثل أية علاقة بشرية، تبدأ بالموجود، وتتدرج إلى الممكن، فالممكن، وهكذا، بدون توقف، وكلما انتقل العلاج من مرحلة إلى مرحلة، تعاد صياغة الاتفاق، إلى ممكن آخر، أبعد وأرقى، وهكذا. هذا ما يمكن أن نسميه: تجديد مستويات التواصل نحو الأعمق، وهو وارد دائما فى كل مجال ومع أى بشر يمارس العلاقات الإنسانية من أى نوع، والعلاج النفسى بعض ذلك.
هذه القصيدة، مثل معظم قصائد الديوان، تبالغ فى تعرية ما أسميناه “نلعب حبا“، لعبة “الوجبات السريعة”، مع أن هذا المستوى قد يكون جيدا من حيث المبدأ، حتى فى العلاقات المستمرة المنظمة اجتماعيا أو دينيا، لكنه ليس بالضرورة غاية المراد، أو كل الإيجابى لكل مراحل النمو.
إن تحديد الفرق، بين “الحب“، و بين أن “نلعب حبا“، هو أمر مهم على الأقل من الناحية النظرية، ومن الناحية المهنية العملية فهو يمثل مسألة هامة فى قدرة المعالج على قياس مهمته، خاصة فيما يتعلق بمنع النكسة، “اللعب حبا” – خاصة على مستوى العلاج النفسى – عمره قصير عادة، والكائن البشرى يرضى به كمرحلة، وأيضا المعالج يفعل ذلك، ربما يكون هذا مثلما يرضى الطفل بالزحف حتى يتمكن من المشى، أما أن يكون الزحف هو البداية وهو النهاية، فهذا ليس إلا إعلان لتقزيم النمو، وتوقفه.
الفرق بين المستويين:
تـُواصِلُ العين الناقدة هنا التعرية والتوعية بطبيعة الصفقة الظاهرة، فتنبهنا إلى ما ينخدع فيه “الآخرون” من أن هذه الواجهة من الوجود التى أتمت الاتفاق على لعبة الحب، هى منطقة، مهما بدت جميلة ولذيذة، هى فى النهاية ساكنة بلا موج ولا حركة ممتدة إلا فى مجالها المحدود، وأن الخضرة التى كانت توحى بالنضارة والطزاجة قد تتكشف عن قشرة من الفطر”.
والمية هاديهْ عشانِ بِـركَـة،
مش نيلْْ ولا بحـــْـر“
هذه الوجبات السريعة، على فرض سماح المجتمع، وتماشيها مع منظومة قيم صاحبها، يمكن أن تعد ممارسة لذيذة أو مفيدة، باعتبارها أيضا حق طبيعي لجوعٍ طبيعى، ومع ذلك يبدو أنها ليست هى ما تميز الفطرة البشرية فى حركتها النمائية طول الوقت، ولا هى غاية تواصل الإنسان كما أكرمه الله، وإذا كانت أغلب الحيوانات لا تجد بديلا عن مثل هذه العلاقات الشهوية المؤقتة، ولو كرشوة لمعظم إناثه حتى يواصلن مهمة التكاثر (دون شرط التواصل)، فإن الإنسان قد تجاوز هذه الرشاوى (المفروض يعنى)، وأصبح التواصل عنده متعدد المستويات معا، بما فى ذلك هذا المستوى الّلِذى الظاهر الذى رضى بلعبة الحب اضطرارا، هذا المستوى نفسه، يود لو أنه يكتمل ببقيته، فهو “يعرض” ضمنا على وعيه الداخلى أن يشارك فى العلاقة، بدلا من أن يبتعد استسلاما بعد أن ألقى فى وجه اللاعبين كل هذا النقد الذى كاد يفسد تلك الوجبة من البداية.
هذا “الكيان ” الناقد الساخر، هو الذى ارتضى التخدير طواعية وهو يعلن “الخوف من الحب“ الحقيقى، بانسحابه، وكأنه يعرف – متألما أو مستسلما أو كليهما – أن الحب الحقيقى له مواصفات أخرى، كما أنه يحتاج إلى تعاقدات أخرى، أهمها: ذلك الاطمئنان إلى عدم التخلى، والذى يبدو أنه افتقده فى هذه الوجبات السريعة، فكان كل هذا النقد الساخر، فالانسحاب المتمادى.
يمضى هذا الكيان الداخلى يؤكد موقف عدم الأمان الأساسى فى الوجود البشرى، فهو يرفض منح الثقة للآخر دون ضمانات (مستحيلة عادة)، الخوف من العلاقة المهتزة، هو خوف من التخلى قبل الأوان، خوف من الخداع، من عدم تبادل مغامرة الخوض فى علاقة، ويبدو أنه هو السبب فى إفساد كل مستويات التقارب.
(3)
عايزنّى أصحَى؟
 وجهنّم خوفى مالْـيانِى،
وجهنّم خوفى مالْـيانِى،
كما إبر التـَلـْج المحميّة؟!
والناس حوالىّ بتتمنظر، زى ما هيَّهْ!!!؟
من حقــي أبعدهم عـنـى،
ولا أيّها حاجة تطمِّنَّى.
هذا المستوى الداخلى، الذى بدا لنا فى أول الأمر أكثر يقظة، وأمانة فى الرؤية، أصبح – بانسحابه هكذا – مشاركا ضمنا فى لعبة نفى الآخر، أو على الأقل: هو يعلن أن العلاقة المعروضة بديلا عن العلاقة السطحية ليست حاضرة لإروائه، إنه بإعلانه ذلك يقول: أنه لا يوجد ما يطمئن فى كل ما حوله ومن حوله، وبالتالى فإنه بإصراره على إبعاد الآخر الحقيقى (إن وجد أو وعد)، إنما يعطى مشروعية لما بدا أنه يرفضه ابتداء، مع أنه بذلك يعطيه مبرراته.
هذه المشاركة من الوعى الداخلى يمكن أن تكون نوعا من المناورة لتشويه ما بدا أنه وافق عليه، فهو يتمادى فى تعريتة للصفقة الظاهرة أكثر سخرية وقسوة، وكأنه يؤكد مرة أخرى من جديد أنها لعبة “كنظام الحب”، بل إنها لعبة “الحب الزائف”: حتى تبدو الصفقة رسما كاريكاتيريا متحديا وهو يقول:
أعملها وكإنِّى كإنِّـى،
أتمايلْ، يتـقربْ مِـنّى.
أرسمْها: عايزة، ومــَغـْمـُوزَةْْ،
أشاورْ لـُـهْ، يفتحْْ لى كازوزةْ.
الشائع عن هذه الوجبات السريعة، أنها رغبة صريحة متبادلة بين اثنين، وهذا صحيح.
“ارسمها عايزة، ومغموزة”،
أشاورله، يفتح لى كازوزة“،
لكن إذا كان هذا الكيان الداخلى غير راض بهذه الصفقات، أو على الأقل غير قانع بها، فلماذا لا يستيقظ، وينشط ويغامر وهو يلوّح بعلاقة حقيقة؟
ها هو يرد علينا بمبرراته التالية:
(4)
مانا لو حاصْحَى،
ما انَا لازمْ اخافْ
وأموتْْ مالخوفْ
وارجعْ أصحَى ألقانِى باحِسْْ.
وانا خايفهْ أحـِسْ، وخايفـَةْ أبـُصْ
هكذا أعلن الداخل صراحة أن “الخوف من الحب” ليس خوفا من الحب ذاته، بقدر ما هو تحسّبا للترك، يتعاظم هذا الخوف لدرجة الرضا بالموت جوعا، أو الموت شللا بلا حراك، تجنبا لهذا الرعب من الترك، وهذا ما جاء أيضا فى ديوانى “سر اللعبة” تحديدا: فى نفس قصيدة “جلد بالمقلوب” بالفصحى كالتالى:
لكن الموت الواحد، أمرٌ حتمى ومقدَّر
أما فى بستان الحب، فالخطر الأكبر:
أن تنسونى فى الظل
ألا يغمرنى دفء الشمس
أو يأكل برعم روحى دود الخوف،
فتموت الوردة فى الكفن الأخضر،
لم تتفتح،
والشمس تعانق من حولى كل الأزهار،
هذا موت أبشع
العلاج النفسى هو فن تقدير التناسب بين جرعات الرؤية، وصعوبة الموقف، وقدر الخوف، ثم هو فن تقسيم هذا التقدير على مراحل العلاج المختلفة ما أمكن ذلك.
الخوف المشروع والضرورى يأتى من مغامرة خوض عمق التداخل فى العلاقة بين البشر، العلاقة العلاجية وغير العلاجية، ذلك العمق الذى يسمح بإعادة الولادة (البعث) من خلال تجديد الوعى “معا”.
هنا تصبح البصيرة رائعة ومعطلة أيضا، وهى تنشط فى العلاج كما تنشط فى أية علاقة نمو بين بشر وبشر، هى خبرة موت فبعث بشكل ما، والبعث هنا هو تخليق لوعى جديد يتولد من تجديد العلاقة من خلال اختراق هذا الخوف لاستعادة صدق العلاقة وحركيتها وأصالتها، فى قصيدتنا الحالية نقرأ:
“وارجع أصحى ألقانى باحس“،
هذا خوف آخر غير الخوف من الترك أو النسيان الذى أشرنا إليه حالا، هو خوف جديد مسئول ومبرر، لأنه المغامرة فى اتجاه الإقرار باحتمال الاعتراف المتبادل مع آخر حقيقى، يُعتمد عليه، ويبقى فى وعينا حتى لو رحل.
هذا نموذج بعيد المنال جدا جدا، وذلك نظرا لقصور مرحلة نمو البشر فى مرحلة تطورهم الحالية، وإن كانوا على الأرجح فى الطريق إليه أكثر فأكثر، العلاج النفسى هو فن اختراق هذه الصعوبة من احتمال اقتراب يعطى فرصة حياة تستأهل.
ليس معنى أن “الآخر” هو نفسه “فى حال” لا تسمح له بإعطاء كل الأمان المطلوب، أن نلغى محاولة عمل علاقة بشرية كلية كما يلوح الأمل فى ذلك برغم الخوف كما يلى:
خايفة أطمع فْ وجـُوْدك جـَنـْبِى
على ما اصـْحـَى وامُوتْ وارْجَـعْ أصـْحَـى،
حاتكونْ مش فاكر حتى انا مين
أوْ كُـنـَّا فْ إيهْ.
إن ضمان التخفيف من رعب “الترك” (الهجر)، هو ألا تكون العلاقة ثنائية استبعادية بشكل مطلق (إنت وبس اللى حبيبى)، وبالتالى فحضور الناس (الآخرين) سواء بالعلانية، أو باعتبارهم “موضوعات مشارَكة“، أو”احتمالات بديلة“، هو مصدر لطمأنينة من نوع آخر، وربما هذا هو الذى أعطى للعلاج الجمعى مشروعيته وأفضليته أحيانا، وهذا ما تقوله الفقرة قبل الأخيرة.
لكن العين الداخلية المتوجسة الناقدة المرتعبة تسارع بنفى حتى هذا الاحتمال أيضا، ربما لفرط الخوف من القرب حتى أنها تعمم الإنكار إلى الناس جميعا “طب فين الناس؟”، فهى لم تقصر إنكارها للآخر على افتقادها لوجود فرد آخر مشارك لا يتخلى، وإنما بالغت حتى عمّمت هكذا:
(5)
بتقولوا ان الدنيا الواسعَـهْ:
عمرها ما حاتبقى صحيح واسعة
إلاّ بالناسْ!!
طَـبْ فـِين الناس؟؟
إن الشك فى احتمال وجود الناس بهذا الحسم، يعقبه تأكيد جديد على الخوف من الترك، والهجر، والإلغاء:
“حاتكون مش فاكر حتى انا مين،…. أو كـُنـَّا فْ إيه“
حين يصل الأمر إلى هذا المستوى من الرؤية، لا يتبقى إلا إعلان اليأس من الحب، ولو بوضع شروط معجـِّزة لاستمراره، ولو بمحاولة تهيئة ظروف لضمان تجديده بلا توقف.
تنتهى القصيدة بإعلان اليأس الساخر تسليما عبثيا بالموجود المُفـرغ من كل حب!!
ما فيش احسن مالحب العيرَةْْ،
واللعب اللى مالوش تسعيرة
بس إوعى يا روحى تجيب سيرة
والآن إلى المتن مجتمعاً:
(1)
والعين الهادية الناعمة:
ْْ بتقول أنـا اهُـهْ.
أنا مـِشْ خايفهْ
لو الاقى حد يقرّب لى
ولاقينى برضه بأقرب لهْ
حاخده بالحضن،
وكإنى باحب.
ميـَّتى رايقهْ، و هاديْه، وخضراَ…‘
….. وخلاصْ.
(2)
والعين التانية جوّاها ْ بتقول عـنـْـدِكْ:
باين على شكلـِك مش خايفهْ ؟
خايفة ليقولوا عليكى هايفة ؟
دانا خوفى اتجمّد من خوفى،
دانا خايفه أخاف.
والمية هاديهْ عشانِ بِـركَـة،
مش نيلْْ ولا بحـــْـر.
مشوارى طويلْ.
خلّونى فْ حالي.
البـِنْـج حَـلالـِى.
موتِى بيحلالى، يا خـــالى.
(3)
عايزنّى أصحَى؟
وجهنّم خوفى مالْـيانِى،
كما إبر التـَلـْج المحميّة؟!
والناس حوالىّ بتتمنظر، زى ما هيَّهْ!!!؟
”من حقــي أبعدهم عـنـى،
ولا أيّها حاجة تطمِّنِّ”
أعملها وكإنِّى كإنِّـى،
أتمايلْ، يتـقربْ مِـنّى.
أرسمْها: عايزة، ومــَغـْمـُوزَةْْ،
أشاورْ لـُـهْ، يفتحْ لى كازوزةْ.
(4)
مانا لو حاصْحَى،
ما انَا لازمْ اخافْ
وأموتْْ مالخوفْ
وارجعْ أصحَى ألقانِى باحِسْْ.
وانا خايفهْ أحـِسْ، وخايفـَةْ أبـُصْ
خايفة أطمع فْ وجـُوْدك جـَنـْبِى
على ما اصـْحـَى وامُوتْ وارْجَـعْ أصـْحَـى،
حاتكونْ مش فاكر حتى انا مين
أوْ كُـنـَّا فْ إيهْ.
(5)
بتقولوا ان الدنيا الواسعَـهْ:
عمرها ما حاتبقى صحيح واسعة
إلاّ بالناسْ!!
طَـبْ فـِين الناس؟؟
ما فيش احسن مالحب العيرَةْْ،
واللعب اللى مالوش تسعيرة
بس إوعى يا روحى تجيب سيرة
اللوحة الخامسة:
النداهة ([20])
المأزق الذى وجدت أن علىّ أن أواجهه ونحن نتقدم نحو المزيد من كشف أزمة (أزمات) التواصل فى مرحلة تطور الإنسان المعاصر، هو مأزق تناول العلاقات البشرية بعد أن بلغ هذا الكائن الحى الشقى الرائع: هذه الدرجة من الوعى بنفسه، وبضرورة الآخر شرطا لتواجده بشرا سوياً، أو ما يسمى عادة الحب، وبين ما أسميه جدل الموت والحياة، وكلتا القضيتين متعلقتين بدرجة الوعى (الأمانة) التى تورط فيه هذا الكائن الخاص جدا المسمى الإنسان.
اكتشفت أن تناولى لإشكالة العلاقات البشرية من خلال هذا المتن تحتاج إلى توضيح مبدئى، وإن بدا مكررا، قبل المضى قدما فى ذل: رحت أكتب مقدمة لهذه الحالة الخامسة فإذا بها تصلح مقدمة للعمل كله:
مقدمة: نلتقى حين نسعى
هذه هى الحالة الخامسة، وتبدو بمثابة شرح على متن الحالة السابقة، لاحظت حتى الآن – للأسف – أن تعريه العلاقات المسماة “الحب” حتى النخاع هكذا، تنتهى إلى ما يشير إلى يأسٍ ما، أو قل إلى إيحاء باستحالة أن يتحاب البشر فيما بينهم بما وصلوا إليه من أزمة “الوعى، والوعى بالوعى” وأضيف الآن: بما يشمل “مسئولية المشاركة فى جدل نمو الإنسان فردا ونوعا”.
فكرت أن أتوقف عن التمادى فى توصيل رسائل مثل هذه قد تحمل فى ظاهرها جرعة من اليأس أو العجز لم أقصدها، قلت أنبه القارئ ببعض التوصيات التى قد تعيننى على توضيح ما قصدت إليه من هذه المحاولة هكذا:
أولاً: أن يتذكر القارئ أنها محاولة لفك شفرة النص البشرى، أو لعلها “نقد النص البشرى” كما يغلب علىّ حاليا، فهو ليس حكما دامغاً.
ثانياً: أن هذا العمل مرتبط بنص محدد هو متن شعرى كتب منذ نحو 40 سنة، وينشر كما هو إلا ما ندر من تصحيح شكلى لجملة أو تحديث محدود فى شطر، ذلك أننى راعيت أن أى تغيير فى المتن أكثر من ذلك هو تجاوز لا مبرر له.
ثالثا: إن أعمال الكاتب تكمل بعضها بعضا، فإذا وصلت رسالة مثل الرسالة الحالية بها هذا القدر من التعرية لدرجة التلويح باليأس أو الاستحالة، فهى ليست فصل الخطاب، فهى مثل حروف وأرقام الشفرة (الكلمة المفتاح فى بريدك الالكترونى “مِيِلَكْ” مثلا) لا يمكن أن تفتح الشفرة إلا باكتمال إدخال الكلمة المفتاح حَرْفا رقماً.
رابعاً: أن يتحمل معى القارئ قدرا من التكرار، لا أريد أن ألزم نفسى بتجنبه فى المرحلة الحالية.
تُرَى: هل يستطيع القارئ الصديق أن “يعلق الحكم” (بلغة الفينومينولوجيا)، فيضع رأيه بين قوسين حتى ينتهى من قراءة مجمل كل حالة، والأصعب والأهم: حتى ينتهى من قراءة العمل كله،([21]) والأصعب جدا: حتى يلم بما يكمله من أعمال الكاتب الأخرى؟
إن ما أحاول توصيله لا ينتهى بحكمٍ يحتاج إلى تعليق (تعليق الحكم) بقدر ما هو دعوة لتحريك الوعى فى اتجاه أرى أنه يصلح أن يجمعنا معا كلما مضينا قدماً أكثر فأكثر، وعندى يقين بأننا نلتقى حين نسعى إلى أن نلتقى، لا حين نلتقى فعلا (انظر بعد).
المستويات (الأولى) للتجاذب البشرى:
ذكرنا أن هذه القصيدة إنما تقوم بتعرية المستويات الأولى للتجاذب البشرى :
المستوى الأول: الجذب النداء، والانجذاب الذاهل.
المستوى الثانى: اللذة المشتركة بعض الوقت.
المستوى الثالث: اللعب الحر معا – أحيانا.
قصيدة اليوم تـُظهر بعض هذا التعدد المتداخل فى محاولة عمل علاقة حب: حيث يظهر أن مستوى صفقة الغواية الخارجية، هو السائد على حساب أى تطور للحوار الأعمق والأكثر تكاملا، وقد حذرنا من الميل إلى شجب هذه المستويات البدئية، اللهم إلا إذا طغت حتى غطت على فرص التبادل والجدل مع سائر المستويات النابضة الأخرى، كما سوف نتبين مثل ذلك فى هذه القصيدة، وبالذات قرب نهايتها، فنهايتها:
فى بداية هذه القصيدة، يبدو أن التركيز كان على مستوى الجذب والانجذاب، وهو ما يمسى أحيانا الكيمياء الوجدانية المتبادلة، وهو مستوى – كما أشرنا – ليس مرفوضا من حيث المبدأ، بل لعله بداية لازمة مهمة، ويبدو أن وسائل الجذب كانت تبدو فاعلة فى بداية القصيدة، لدرجة ثقة النداهة بسحرها القادر على جذب السائر على شط الترعة، حتى تسحبه إلى غير رجعة (هذا ما يُحكى عن الجنية النداهة فى بلدنا، وهو بعض ما استلهمه يوسف إدريس فى قصته النداهة). وهو ما خالج صاحبنا من أن هذا الجذب الساحر، يحمل وراءه الاختفاء الغامض.
القصيدة هنا تبدأ بتعرية هذا المستوى من النداء والغواية، وهو مستوى قد يقابله بعض بدايات التعاقد فى العلاج النفسى، الذى قد يتم بشكل مباشر أو غير مباشر بين معالج له حضور قوى يبعث على الثقة، وبين مريض يحتاج هذه الثقة فيستجيب لها بسرعة، وبأقل قدر من الشروط والحذر:
(1)
وعيون مكـْحُـولة مْـنَـدِّيــة.
تِسْحِـَر وتشِدْْ.
منديلْها على وش الميّة
مِـستنّى تمـدْ:
إيدك، تسحبْـها تروحْ فيـها،
ولا مينْ شـَافْْ حـدْ.
لابد أن لحكاية أو أسطورة النداهة أصل شديد الغور فى النفس الإنسانية، أسطورة النداهة من الأساطير الريفية المصرية، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين، فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها، ثم يجدونه ميتا في اليوم التالي، أو يلقونه وهو يهيم على وجهه جنونا، وقد يـُـسخـَـط حيوانا عقابا له أنه ترك النداهة الغاوية فى عالمها السفلى بعد أن شدته إليه بغوايتها.
(2)
ماتكونشى يا واد الندّاهة؟
حركات الجنّية اياها؟
أنا خايف مـِاللـِّى مانـِيشْ عارْفُهْ.
أنا شايفْ إِللِّى مانيش شايفُــهْ.
وتـْلاحِـظْْ خوفى تْـطَـمّنى.
وتقولّى كلام، قال إيه يعنى :
ماتبصّش جوّهْ بـزْيادة،
خلّــيك عالقَــدْ.
شوف حركة عودى الميـّادَة،
شوف لــون الخدْ
هذه القصيدة لا تستوحى أسطورة النداهة إلا من حيث هذا الانجذاب المسحور إلى النداء، ذلك لأنه فى حين تؤكد الأسطورة على أنه حين يقترب صاحبنا من السطح، يكون منجذبا انجذابا خالصا لسحر الغواية، وهو يبدو أنه يريد ما وراء ذلك بشكل ذاهل، نلاحظ فى هذه القصيدة من البداية أنه منجذب بقدر ما هو خائف، يقترب ويرجو ما تحت السطح، فتنبهه الغاوية أن الصفقة ينبغى أن تقتصر على هذا المستوى، وأن عليه ألا يتجاوز الحدود، وأنه غير مسموح له أن يخطو إلى ما بعد السطح (ما تبصش جوه بزياده، خليك عالقد) ولتحقيق ذلك تذكره بجمال خارجها، وميادة عودها، ووردية خدودها… إلخ.
هو يستمع إلى كل ذلك، لكن يأتيه همسٌ من أعماقها، يناديه بلغة أخرى، وكأنه يستغل هذا الجذب المبدئى ليتعرف من وراء الظاهر إلى طبقة أكثر عمقا وتلقائية، وأقل صفقاتية وذهولا، وكأن على من يحاول أن يواصل حركية جدل العلاقة، أن يستوعب مستوى الجذب ليتجاوزه وهو يحتويه، لينطلق منه إلى نكوص مشروع، ولعب حر، وهو ما تعنيه هذه الفقرة من تنشيط ما بالداخل من جاذبية الطفولة، وتلقائية الفطرة، وحلاوة اللعب، وبهذا نقترب من المستوى الثانى والثالث (اللذة المشتركة، واللعب الحر معا) مع الحذر الواجب من احتمال التوقف عند الجذب والانجذاب واللذة المنفصلة.
(3)
وأحس بهمْس اللى معاها،
أنــوِى أَقــرَّبْْ.
وأشوف التانية جُــوَّاهَـا،
أحلى وأطيبْ.
والخوف يغالبنى من ايـّاهـَا،
لأْ، مش حَـاهـْربْ.
هذه الأخرى التى تناديه من عمق أبعد من جذب منديل السطح، ربما هى الفطرة عروس البحر، ولكن من يضمن له إذ يتقدم إلى هذا العمق الأجمل أن تستولى عليه النداهة المرتبطة بالمنديل السطحى، فيختفى فيها ومعها دون أن يكمل مشوار الحب التكاملى الجدلى ، وحين يستشعر هذا الخطر، وتراوده فكرة التراجع يجد أنه لا سبيل إلى ذلك إن أراد لجدل العلاقة أن يتواصل، فيقرر أن يواصل: فيتراجع عن التراجع: لأ مش حاهربْ
استجابة لهذا التصميم يأتيه نداء الداخل، مع الحذر المناسب من الاقتراب.
“مستنى تمدّ:
إيدك تسحبها تروح فيها،
ولا مين شاف حد“
الحب بقدر ما فيه من سعى نحو ما هو قرب، فيه قدر مساوٍ – وأحيانا أزيد – من الخوف من القرب.
يسرى ذلك على من يقترب، وعلى من يستجيب لمحاولة الاقتراب.
والطفلة تشاوِرْ وتعـافرْْ،
بتقـّربْ، ولاّ بـْتـِتاَّخـِرْ؟
وانّ مدّيت إيدى ناحيتها، بتخاف وتكشْ.
والتانية تنط تخلــّـيها: تـهـْرَبْ فى العـِشْ.
دى غيامةْ كــِدب وتغطــيّة، ومؤامرة غِشْ.
الوعى الداخلى، الطفولة المستجيبة، ضعيفة بطبيعتها، بقدر ما هى جميلة بتلقائيتها.
الظاهر الجاذب المكتفى بهذا المستوى حتى لو كان الاختفاء فى الذهول هو نهايته، لا يتزحزح عن محاولته إفساد أى خطوة تحاول تجاوزه إلى داخل الداخل الصادق الواعد، بل إنه يكبت هذه المحاولة الأعمق حتى تنسحب الذات الأجمل والأعمق على أثر التخويف من الاقتراب الحقيقى، وبمزيد من الإغراء بالاستكفاء بظاهر الجذب فالانجذاب، وهما ليسا إلا بديلا عن حقيقة العلاقة وعمقها، ومن ثم نفهم كيف أن هذا الإبدال أو التوقف ليس إلا: “غيامة كدب وتغطيّة، ومؤامرة غش”.
مع تواصـُـل السعى إلى الحوار والجدل مع المستوى الأعمق والأجمل، يرفض هذا الانسحاب من أثر الإحلال والتغطية، فهو لا يصدق أن المستوى الأعمق غير موجود، أو كان وهما، بل هو يعلن أن “حلوة الداخل” لم تمـُتْ، لأنها لا تموت، مهما بعدت أو اختفت.
(4)
وماصـدّقشى،
ولا اسلّمشِى،
أنا واثق إنها ما مَـتِـتْـشٍى
أنا سامع همس الماسْكِـتْشِـى
مش حاجى، لو هيه ما جَاتْـشِى.
فهو يواصل الإنصات، ويشترط لمواصلة الحوار (الحب) وجودها ليكمل معها (وربما مع غيرها، لكن معها أساسا)
“أنا سامع همس المـَـاسـْـكـِـتـْـشـِى“.
تلك الأخرى – على السطح – تتصور أنه وهو يقترب، يقترب منها هى، استجابة لغوايتها، لكنه ينبهها، وربما ينبه نفسه أنه:
“مش حاجى لو هيا ما جاتشى“
مهما بدا إغراء جذب السطح.
تنبيه واجب هنا:
-
إن المسألة هى ليست “إما وإما”، اللهم إلا إذا أصر “السطح” على استبعاد كل ما عداه، وهذا نادر إلا فى بعض اضطرابات الشخصية القصوى.
-
إن علاقة الحب الحقيقية هى حب لكل المستويات، بكل المستويات، بما فى ذلك حب الغاوية السطحية، ولو بابا إلى العمق، ولكن ليس على حسابها، التى على السطح هنا لا تعترف إلا بنفسها، ولو وصل الأمر إلى تفضيل أن “تلعب حبا” بدلا من “أن تحب“، ها هى تنبرى لتحول بينهما، بين داخلها، والساعى إلى حب حقيقى، تحول بالمنع والتحذير والتشريط:
(5)
– جرى إيه يا أخينا؟ عَـلى فـِينْ؟
حَاتْـصـَحّى النايـِمْ؟ بـِـضمانْ إيه”؟
جَـرَى إيهْْْ؟
مش عاجـْبـَك رسمى لـِحـَواجـْبى، ولاََ لُـونْ الُّروجْ؟
مش عاجبك تذكرةِِ الترسو، ولا حتى اللوجْ؟
ما كَفاكشِى زْوَاق البابْ؟
هيّا وكالة من غير بّوابْ؟
هذه الغاوية على السطح إنما تعلن وصايتها على سائر المستويات، معترضه على مواصلة السعى، فهى تدافع عن مشروعية الوجبات السريعة وتلوّح للاكتفاء بلذتها، وربما نستشهد قياسا أنه: “إيش رماك على أن تلعب حبا، قال قلة الحب“. هذه التى على السطح تريد ضمانا (بضمان إيه؟)، وهى مهما قدم لها من ضمانات (بما فى ذلك ورقة الزواج أيضا) لن تسلـّم – طالما هى منفصلة هكذا – و هى لا تسمح لجميعها أن يشاركوا فى العلاقة المتعددة المستويات، أى فى علاقة حب. وليس لعبة حب، فهى تتعجب من عدم رضاه بكل ما فـَـعـَـلتـْـه لإغوائه ليكتفى بهذا الظاهر (ما كفاكشى زواق الباب، هيا وكالة من غير بواب؟)
وقفة:
ماذا يحدث فى العلاج النفسى؟
على أى مستوى تتم العلاقة؟
بصراحة، إن العلاقات (العلاجات) المطروحة على مستوى الاقتصار على الإيحاء والطمأنة والتسكين (بالعقاقير أو بدونها) هى أقرب إلى مستوى الغواية والجذب والانجذاب، لا نزعم أن نهايتها هى بالذهول أو العدم مثلما هو الحال فى أصل أسطورة النداهة، وإنما قد تكون نهايتها هى توقف مسيرة النضج.
تواصل العلاج النفسى الأعمق الذى قد يرتقى بالعلاقة إلى هذا التحاور على هذا المستوى، هو الذى يحفز النمو ويطلق جدل التطور بحيث يتم إعادة التشكيل من خلال أزمة المرض ما أمكن ذلك.
لماذا يخاف أغلب المرضى من المضىّ قدما إلى أبعد مما يسمى العلاج التسكينى؟ لا يوجد علاج حقيقى فيه إطلاق نمو أو إعادة تشكيل إلا ويمر المريض فيه بما نسميه “مأزق التغيير” بكل مخاطـِـرِه وصعوباته والتهديد بمضاعفاته، من هنا، وبالذات فى العلاج الجمعى، يكون الحذر والتحذير، مصاحب بالخوف والتخويف، وكثيرا ما يتمادى هذا الخوف والحذر إلى ظهور آليات دفاع أكثر حدة تجمّد مسيرة النمو، فينقطع العلاج فجأة، أو تنتقل الزملة المرضية إلى زملة أكثر صلابة وأقدر مقاومة.
إن الزملاء الذين يبدأون بالتسكين، وأحيانا يسمونه الطمأنينة، وينتهون بالتسكين، مفضلين “السلامة” أولا وأخيرا (وأن الطيب أحسن) لا ينتمون إلى مسيرة النمو من خلال العلاج، وربما إلى مسيرة النمو برمتها، لأنه لا يوجد نمو دون آلام ومخاطر من حيث المبدأ.
أنا مش ناقصة التقليبهْ ديّــةْ،
ولا فيش جوّاىَ “الْـمِشْ هيّةْْ”،
ولاَ فيه بنّـوتــة بـْمَـرايلْهـَا،
ولا فيه عيّـل ماسك ديلهاَ،
وبرغم كل ذلك التحذير والإنكار والمحو، فالطبيعة البشرية هى الطبيعة البشرية، وهكذا يستمر النداء الخفى، ويتواصل إصرار حفز النمو، فيتواصل بالمقابل التحذير، ويحل الصد وإعلان الدفاعات المانعة من التواصل، محل الجذب الذى يثبت من خلال ذلك أنه كان “كنظام الحب” وليس “الحب”.
(6)
إوعى تخطّى، أبْعـَدْ منّى، حاتْلاقى الهِـِوْْْ.
البيت دا مالوهْشـى اصْـحـَاِبْ.
دُولْ سـَافروُا قَـبـْلِ ما يـِيـِجـُوا.
من يوم ما بنينا السدْْ.
السد الجوّانى التانِى.
وانْ كان مش عاجبكْ، سدّى البرّانـِى.
تبقى فقست اللعبة،
ومانيـِشْ لاعبةْ.
هنا وقفة مهمة:
إن العلاقات البشرية تنبنى على أساس سلامة لبِنَات التواصل الأولى التى توضع فى محلها، منذ الطفولة توضع فى وقتها، لغرضها، وهى التى يبنى بها بيت الثقة الأساسية فالكيان النابض النامى.
إن التى (أو الذى) تستطيع أن تطلق داخلها ليشارك فى (لا ليستقلّ بـ) عملية الحب، لا بد أن تكون قد اطمأنت طفلةً (ثم بعد ذلك فى أى ولادة جديدة فى أزمات النمو) إلى أنها ليست وحيدة، إلى أنها جزء من آخرين يريدونها ويعترفون بها فتريدهم وتعترف بهم، هكذا تتاح لها الفرصة أن تبنى نفسها “بيتا” (وليس لنفسها بيتا)، بيتا له أصحاب، هى أولهم، وليست آخرهم.
فالقصيدة هنا وهى تعرى هذا الخواء الداخلى: “البيت دا ما لوهشى اصحاب” إنما تعلن سبب هذا الهروب الكبير، وتعرىّ إحلال المنديل على سطح الترعة، محل جنية البحر الطفلة الفطرة الجميلة، “البيت” ليس له أصحاب لأنهم كانوا أشباحا لم يحضروا واقعا مغذّيا أمنا أبدا، وهم مهما تحركوا إنما يلعبون لعبة تشبه الحياة، تشبه الحب، تشبه التواصل، يلعبونها سرا مع أنفسهم، ويختفون قبل أن يظهروا.
“دول سافروا قبل ما ييجوا“
لكن هل يعقل أن يبنى طفلا ذاته (بيته) دون أن “ينتمى” أصلا؟
وكيف ينتمى وهو منذ وُجد لم تواجهه إلا الحواجز التى أقيمت لتحول دون التواصل الحقيقى (القبول والاعتراف والأخذ والعطاء) فحالت فعلا منذ البداية، بل قبل البداية، دون إلقاء بذرة الحب التى يمكن أن تؤتى أكلها كل حين “حبا حقيقيا متجددا”؟ ذلك الحب المتعدد المستويات الذى حيل بينه وبين أن يتنامى بواسطة تلك التى أدت إلى الميكانزمات (الاستغناء عنه) بإقامة السدود، ليس فقط سد الغواية البرانية البديلة عن العلاقة، وإنما السد الجوانى التانى، وهو الذى يشير إلى عدم الأمان الأولى.
إذن: فالحاجز الذى تقيمه من الغواية الآن ليحول دون العلاقة المتكاملة ليس هو السبب الأساسى فى الإعاقة الحالية، وإنما يرجع السبب إلى الحاجز القديم “السد الجوانى التانى“، أما هذا السد البرانى، فكل المطلوب منه هو أن يقوم باللازم ليحقق المراد الجزئى فى وجبة سريعة، أو فى واجبات رسمية راتبة، كنظام الوجبات المستخرجة من “الديب فريزرعلى طول المدى (الزواج الساكن الخامد). دون أن يكون بداية لنبض جدلى تصعيدى منتظم إلى المستويات الأخرى، مع أنه يمكن أن يكون بابا إلى ذلك.
تنتهى القصيدة الحالية بتوصية ساخرة، بنكوص هروبى أيضا بديلا عن مسيرة النمو، وربما يكون هذا أكثر تمثيلا لمستوى العلاقة التى أسميناها “اللذة المشتركة بعض الوقت” (المستوى الثانى)، وهو ليس أفضل كثيرا من مستوى الجذب والانجذاب، فهو جاهز لتوقيف مسيرة النمو أيضا:
(7)
دوّر على واحدة تكون هبْلهْ،
بتْسوُرَقْ مِنْ حَصْوِة نِبْلهْ.
تديلك قلْب الخسّاية!!
ومالكشِى دعوة بْجُوّايَا
…...
يا ما كان نفـِسى،
بس ياروحْ قلبى “ما يُحْكمشِى”.
يبدو أن من يريد أن يحب، ولا يكتفى بأن “يلعب حبا”، عليه أن يغامر بأن يعطى ويأخذ “قلب الخساية” ولايكتفى بأوراقها أو رأسها.
ولكن هل يكون للخساية قلب إلا إذا أحاطته كل هذه الأوراق التى ذبلت وجفت من فرط قيامها بدورها الرائع فى الحماية والدفاعات؟ إن من يريد أن يلقى بهذه الأوراق الصلبة ليكتفى بقلب الخساية هو أيضا ليس محبا، وإنما هو قناص مستسهل.
وبعد (مرة أخرى):
خيل إلى أن المسألة أصبحت أصعب.
ليكن.
قلنا من البداية، حتى لو لم يكن لدينا بديل: “نستعمل الواقع (الخطأ)، لا نستسلم له، ونرفضه ونحن نستعمله حتى نغيره”.
فهل نستطيع ذلك فى مسألة الحب هذه؟ (ربما مثلها مثل مسألة الديمقراطية والحرية والمال، وأشياء أخرى كثيرة)، وإذا لم نستطع فهل يمكن أن نرضى بالموجود باعتباره النقص الواجب الدافع للتحريك؟ أم نستسلم له باعتباره البديل الدائم طالما لا يوجد غيره؟
تـُرى هل أصبحتْ المسألة أسهل أم أصعب؟
هل نشتغل فى المستحيل ليكون ممكنا؟ أم نستسلم للمكن ليصبح استمراره مستحيلا؟
وبعد
ها هو المتن متكاملا لمن شاء أن يتخلص من وصاية التنظير.
(1)
وعيون مكـْحُـولة مْـنَـدِّيــة.
تِسْحِـَر وتشِدْْ.
منديلْها على وش الميّة
مِـستنّى تمـدْ:
إيدك، تسحبْـها تروحْ فيـها،
ولا مينْ شـَافْْ حـدْ.
(2)
ماتكونشى يا واد الندّاهة؟
حركات الجنّية اياها؟
أنا خايف مـِاللـِّى مانـِيشْ عارْفُهْ.
أنا شايفْ إِللِّى مانيش شايفُــهْ.
وتـْلاحِـظْْ خوفى تْـطَـمّنى.
وتقولّى كلام، قال إيه يعنى:
ماتبصّش جوّهْ بـزْيادة،
خلّــيك عالقَــدْ.
شوف حركة عودى الميـّادَة،
شوف لــون الخدْ
(3)
وأحس بهمْس اللى معاها،
أنــوِى أَقــرَّبْْ.
وأشوف التانية جُــوَّاهَـا،
أحلى وأطيبْ.
والخوف يغالبنى من ايـّاهـَا،
لأْ، مش حَـاهـْربْ.
والطفلة تشاوِرْ وتعـافرْْ،
بتقـّربْ، ولاّ بـْتـِتاَّخـِرْ؟
وانّ مدّيت إيدى ناحيتها، بتخاف وتكشْ.
والتانية تنط تخلــّـيها: تـهـْرَبْ فى العـِشْ.
دى غيامةْ كــِدب وتغطــيّة، ومؤامرة غِشْ.
(4)
وماصـدّقشى،
ولا اسلّمشِى،
أنا واثق إنها ما مَـتِـتْـشٍى
أنا سامع همس الماسْكِـتْشِـى
مش حاجى، لو هيه ما جَاتْـشِى.
(5)
– جرى إيه يا أخينا؟ عَـلى فـِينْ؟
حَاتْـصـَحّى النايـِمْ؟ بـِـضمانْ إيه”؟
جَـرَى إيهْْْ؟
مش عاجـْبـَك رسمى لـِحـَواجـْبى، ولاََ لُـونْ الُّروجْ؟
مش عاجبك تذكرةِِ الترسو، ولا حتى اللوجْ؟
ما كَفاكشِى زْوَاق البابْ؟
هيّه وكالة من غير بّوابْ؟
أنا مش ناقصة التقليبهْ ديّــةْ،
ولا فيش جوّاىَ “الْـمِشْ هيّةْْ”،
ولاَ فيه بنّـوتــة بـْمَـرايلْهـَا،
ولا فيه عيّـل ماسك ديلهاَ،
(6)
إوعى تخطّى، أبْعـَدْ منّى، حاتْلاقى الهِـِوْْْ.
البيت دا مالوهْشـى اصْـحـَاِبْ.
دُولْ سـَافروُا قَـبـْلِ ما يـِيـِجـُوا.
من يوم ما بنينا السدْْ.
السد الجوّانى التانِى.
وانْ كان مش عاجبكْ، سدّى البرّانـِى.
تبقى فقست اللعبة،
ومانيـِشْ لاعبةْ.
(7)
دوّر على واحدة تكون هبْلهْ،
 بتْسوُرَقْ مِنْ حَصْوِة نِبْلهْ.
بتْسوُرَقْ مِنْ حَصْوِة نِبْلهْ.
تديلك قلْب الخسّاية!!
ومالكشِى دعوة بْجُوّايَا
…...
يا ما كان نفـِسى،
بس ياروحْ قلبى “ما يُحْكمشِى”.
اللوحة السادسة:
العين الحرامية
فى هذه الخبرة اتضحت لى ضرورة التمييز بين برنامج “الدخول والخروج” in–and–out program وبرنامج الكر والفر “الكرّفرّ” Fight–Flight، علما بأن هذه الحالة لم تكن تمارِس أيـًّا منهما، وإن كانت أقرب إلى موقف الدخول والخروج على مستوى تحسس الطريق “نحو الموضوع” (الآخر)
فى الكر والفر دفعٌ حتى الطرد، أو انسحاب حتى الهرب، وهما يتبادلان، وفى الدخول والخروج، إقدام إلى الآخَر والشوط على أرض الواقع، كما هو مؤقتا عادة، ثم انسحاب إلى الرحم الحانى للكمون والإعداد، وهكذا بالتبادل.
الحالة هنا تعلن شيئا آخر، هى تـُظـْـهـِر أن الخوف من الاقتراب له تشكيلات وتجليات متنوعة من أرقّها: هذا النوع من الإقدام الحذر المتوجس، يتبادل مع الإحجام الناقص، على خلفية من الشعور بذنبٍ مـَا، وفى نفس الوقت الرغبة فى أخذ “الحق فى القرب”، فى الحب، فى الاعتراف، التى تترجح مظاهرها فى تجليات خاطفة ما بين السرقة والاستجداء والخوف والتردد:
(1)
والعين المهزوزَةْ الخايفة الحرامِيَّة،
زى الكلب السارق عضمةْ:
بتبص لتحتْْ، وساعات للجنبْ.
وساعات بتبرّق وتحدق حبّـهْ نونو،
ترجع تانى، تهرب منى،
وتبُصّ لفوق.
أجرى وراهَا قبل ما توْصلْ شُرّاعةِ البابْ،
أو تنزل تتسحب منى: كده تحت دولابْْْْ.
وساعاتْ تِتْرَقّصْ وبياضها يغطى سوادْهَا،
وكأنه بيخبِّى بريئةْ واتَّهمُوهَا:
قَرِّت بالذنبْ،
مِنْ غير ولا ذنبْ
حين تُحرم من حقك فى القرب، سواء كان ذك نتيجة لهذا الموقف المترقـِّب المتردد، أو لأنهم نسوك أو تجاوزوك أو أهملوك، أو فى الواقع: نتيجة لكل ذلك معا، قد تضطر إلى أن تحصل عليه بما يبدو أنه خطف أو سرقة، هذا الموقف الذى بدأتُ به واصفا هذه الحالة يشير إلى أن الإقدام على عمل علاقة بآخر، حتى ولو بخطفها سرقة، لا يكشف تحايلا للحصول على غير حقك، بل هو يعلن جوعا لا يعرف طريقا للإرواء غير ذلك، جوعا للحصول على حق لم يصل صاحبه.
الواضح من هذا المقطع هو أنه بالرغم من الجوع الشديد إلى الآخر، فإن ثم شعورا حقيقيا بأن المسئول عن ذلك ليس بالضرورة هو الآخر وحده. هذا الشعور، فى هذه الحالة، كنموذج، ينبع أساسا من صعوبات صاحب هذا الموقف أكثر مما أنه نتيجة لرفضٍ يأتيه من خارجه.
الشعور بالذنب لدرجة الاعتراف بإثم لم يرتكبه الشخص أصلا، قد يكون هو العائق الدفاعى لاستقبال رسائل إيجابية من الآخر تعفيه من الاضطرار لسرقة العواطف أو خطفها هكذا، كما تعفيه من الاستجداء ومن غير ذلك مما سيأتى ذكره، هنا لا يوجد إثم أصلا يحتاج أن نشعر إزاءه بذنبٍ ما، هذا هو الغالب عند معظم البشر كمرحلة من التطور إلى البشرية الأكثر حرية ووعيا ومَعِيّة، إذن نحن لا نحتاج لاختلاق قصص أو الاستشهاد بأساطير لتفسير هذا الشعور الأساسى بالذنب فى التكوين البشرى المعاصر، إلا إسقاطا لتفسير تكوينٍ أساسى.
فى أطروحتى عن الشعور بالذنب، ربطت بين الوعى بالوعى، وبين الوعى بانفصال الإنسان كائنا واعيا مستقلا نسبيا عن الوعى الكلى، عن الوعى الهيولى الهلامى الأصلى، قدمت تفسيرا لهذا الشعور الأساسى أنه: إعلان لورطة اختيار الإنسان أن يكون كائنا متفردا له وعى مستقل، لا يحتاج الأمر– إذن، كما ذكرنا حالا ونكرر – لتبريرات لاحقة، جنسية أو أوديبية أو محارمية، اللهم إلا كنوع من التفسير اللاحق لإسقاط هذا الشعور الأساسى على منظومات التحريم والتنظيم، الفرض الذى طرحته سابقا يوجز هذه القضية فى هذه الجملة:
“أنا موجود، أنا لى كيان مستقل،
أنا واع بذاتى منفصلا عنهم وعنه،
إذن أنا مذنب، (دون أن اذنب)”([22])
هذا الشعور بالانفصال عن الأصل الكلى الهلامى، هو نفسه الدافع لمحاولة الوصل طول الوقت “ كل من انفصل عن أصله، يطلب أيام وصله”([23])، وهو الشعور الذى يكمن أيضا وراء مأزق السعى إلى المعرفة، المعرفة هى فى ذاتها ذنب من هذا المنطلق الأساسى، ذنب رائع أيضا، وهذا هو ما يغلب على كثير من تفسير حكاية (أسطورة فكرة/حقيقة) الأكل من الشجرة المحرمة فى الجنة (بالإضافة إلى ما يقابل ذلك من جنان الأساطير والإبداع الأدبى)، إن ما ترتب على الأكل من الشجرة المحرمة هو العقاب بإنزال الإنسان إلى أرض الواقع المسئولية، مع منحه حرية الاختيار وأدوات التواصل الأساسية (الأسماء كلها/الأمانة)، وهى حرية شائكة، وأدوات ملتبسة، فهو قادر على الاختيار والكشف، وفى نفس الوقت خائف من المجهول والعجز.
لا يحل هذا الموقف، أو حتى يخفف منه مجرد اقتراب صادق من آخر، فالمسألة تحتاج تجربة ومثابرة لعل رسالة مطمئنة تصل بدرجة تسمح بعلاقةٍ ما.
التشكيل هنا يكشف من جوانب متعددة عن حركية الاقتراب المغامر إلا قليلا، يقابله الانسحاب الحذر إلا قليلا.
الجوع إلى العلاقة ليس دافعا تلقائيا للتقدم نحوها، بل كثيرا ما نجد أن العكس هو الذى يحدث، فصاحبة هذا الموقف هنا ترفض الاقتراب حتى لو جاءت المبادأة من الآخر: وأنت كلما حاولت الاقتراب منها حاولت هى الابتعاد، ربما لتحافظ على مسافة، تعد ولا تفى، لكنها (المسافة) لا تكفّ عن الوعد مجددا.
الحاجة إلى الاقتراب أو الحب قد تحتد حتى تبدو تسولا من بعدٍ معين، وهذا من أصعب ما يضطر إليه بشر لا يجد فرصة حقيقية للأمان والاعتراف، قد يظهر ذلك التسول فى شكل تنازل عن كرامة، أو قد يتم بصفقة سرية بها ظلم شديد عليه، أو قد يتجلى فى تنقل سريع بين مصادر الحب المحتمل، دون ارتواء حقيقى.
هذا الموقف يقدمه المتن بقسوة عارية حين يصف هذا التنازل بأنه تسول، مع إلحاق أن هذا التسول لا يحقق لصاحبه إلا فتاتا من فضلات لا تـُغنى، بل إنها قد تزيد الجوع حدة وسعارا.
هذا الموقف يبين كيف يمكن أن يترجـَّحَ صاحبه بين خطف ما تيسر من عواطف، أو رائحة علاقة، أو إشارة اعتراف، وبين نوع من التسول الذى يصاحبه اعتذار أو استغفار عن الذنب الأساسى، ذنب الانفصال عن الوعى الكلى سعيا إلى وعى ذاتى متفرد، وهو موقف لا يحل الإشكال من جذوره بقدر ما يعلن طبيعة هذه الوقفة فى هذه المرحلة، وصعوبة المحاولة، وللأسف، فإنه موقف إذا طال وتكرر بلا عائد، فهو ينتهى إلى نتيجة سلبية كما انتهت الحالة فى هذا المتن، ذلك لأن الذى تظهره الحالة هو أنه:
إذا تذبذبت المحاولات إلى هذه الدرجة وطالت المدّة، فإنها تـُـجـْـهـَـضُ جميعها فى النهاية مهما استمرت وتكررت، ومهما قفزت من موقف إلى موقف فهى ليست فى النهاية إلا نوع من الخطف أوالسرقة، ثم استجداء وتردد، فى مقابل الوعد بما لا يكون.
بيقولوا ظبطوها بتتسوّل: فضلات الحُبْ.
وارجع ابصَّلها تنُطْْ،
وتْفُـطْ.
كمَا طفل على سِلـّم تُـرُمَاىْ،
بيْبِيع كبريتْ أو باغةْْ،
أو إيده خفيفةْ، عالسَّاعة والولاّعةْ.
يخطف وينطْ.
هكذا يعرى المتن عمق هذا الموقف الذى لا يحله مجرد إعلان الإقرار بالوجود، أو التلويح بالإعفاء من مسئولية “سرقة الرؤية“ و“تسول القبول“، هذه الحالة تكشف استمرار إصرار صاحبة الصورة على الحفاظ على نفس الموقف الحذر المتوسط المترجِّح بلا نهاية، ها هو المتن يعلن بشكل مباشر أن هذا التردد الـُـمـِـشـّل لا يوصل إلى شىء:
(2)
عايزاكمْ.. مِش عايزاكمْ.
باسْتَخْونِـْكُم، وباجِيـكُمْ.
وباخَـافْ مِالْقُـربْ.
وما طـِيقْـشىِ البُعـد.
وباخافْ لو عِينى جت فى عْـنينْ مِش “هيـّهْ”،
وباخاف أكترْ لوْ طِلعتْ “هـِيّـهْ”.
هذه الحالة تصف مرحلة انتقال حذرة، وليس “تناقض الوجدان” كعرضٍ، فهى تبدو نقلة حساسة من الطور البارنوى إلى الطور الاكتئابى، بالمعنى الذى أشرنا إليه سابقا موضّحين أن ما يسمى الطور الاكتئابى (وليس الاكتئاب) هو طور محاولة اختبار، وتقبل صعوبه العلاقة بالآخر بوعى متبادل مسئول، (لهذا اقترحنا تسميته الطور العلاقاتى الإنسانى).
الموضوع (الآخر)، فى هذه النقلة هنا، لا يمثل خطرا يهدد وجودى، أو يقتحم هويتى، بل هو (الموضوع – الآخر) يحضر بداية بإقرار الاعتراف الحذر باكتشاف أن ما هو “آخر” هو مصدر حب ووعد بالتكافل معا للاستمرار دون أن يمحو أحدنا الآخر، وفى نفس الوقت هو يحمل – بطبيعته – تهديداً بخطر الترك أو الهجر، ووجود هذين الشعورين معا معظم الوقت يترتب عليه ما يسمى “بتناقض الوجدان”
نكرر: التناقض هنا غير تناقض الوجدان المتصادم الـُمـِـشّل فى الأحوال المرضية، حيث التضاد فى المرض لا ينتهى إلا بنتيجة صفرية فارغة، هذا بعكس التناقض النمائى هنا الذى إنما يعلن طبيعية جدل العواطف التى نختزلها عادة بالاستقطاب باستمرار.
هذا الجدل النابع من حيوية التناقض الإيجابى هو الذى يفرز طاقة الدفع إلى استمرار نبض الحركية نحو الآخر، محصلة ذلك إن استمرت هذه الإيجابية هى ظهور الألم البشرى الأرقى، الذى ظهرت إحدى تجلياته فى هذا المتن فى نص عبارة:
“والدِّمعة يا دوب حاتبان”.
لاحظتُ فى خبرة العلاج الجماعى خاصة، وأيضا فى لقاءات الفحص الصامت لإطلاق التعبير عن “الحق فى الألم” (أو الحزن)، لاحظت أن هذا الموقف الذى تترقرق فيه العين باقتراب دمعة تلمعُ ولا تهطل، هو الموقف الذى تمثله هذه العبارة تحديدا، وقد ثبت أنه – فى تقديرى بعد عشرات بل مئات الحالات – موقف يعبر عن الألم الإنسانى الناتج عن الإصرار على مواصلة التواصل مع آخر مختلف، وفى نفس الوقت وعى بأن هذا الآخر هو كيان مستقل منفصل يحاول نفس المحاولة، مع إدراك الصعوبة والتهديد فى آنْ، وكل هذا هو من علامات ما أشرت إليه باعتباره الحزن النمائى الجدلى المسئول.
فى خبرة العلاج الجمعى (وأيضا فى اللقاء الإكلينيكى الصامت من حيث تجنب استعمال الكلمات المنطوقة) حين نصل (المريض وأنا) إلى مرحلة تعلن مثل هذا التواصل المؤلم، يتجلى هذا “الألم الحى” بعذوبته وصدقه فيما يعبر عنه عادة بتعبير هو ما يسمى: “اغرورقت عيناه بالدموع”، هنا نلفت النظر إلى أننا لاحظنا مكررا أنه إذا امتدت هذه الخبرة حتى إدرار الدموع، فإن هذا البكاء يجهض المحاولة، وتنقلب العلاقة إلى مستوى آخر أقل فاعلية، بل ربما يكون سلبيا دفاعيا، الأمر الذى دعانى – غالبا – إلى اتخاذ موقف علاجى يحول دون أن ينقلب اغروراق العيون، إلى دموع منسكبة.
هذا الموقف – حين أساعد أحد المرضى أن يسمح للألم بالظهور دون الإسراع بِلصْقـِـهِ بسبب جاهز، أو قديم، وفى نفس الوقت ألا يسمح لنفسه بالتعبير عنه بالألفاظ حتى لا يجهض الخبرة – يبدو موقفا غير مألوف إذا قيس بتعبيرات علاجية سهلة مثل الفضفضة أو التنفيث، وكان بعض المرضى الآخرين، وبعض الزملاء والمشاهدين يستقبلون محاولاتى هذه باعتبارها قسوة مؤلمة، ولم يكن الحال كذلك عند أغلب المرضى فى داخل التجربة، بل إن الناتج فى النهاية كان، ويكون، نوعا من الطمأنية الواعية بحقيقة صعوبات وأبعاد العلاقة بالواقع، وبالآخر، بل ويكون هو هو الدافع إلى استمرار العلاقة العلاجية إلى المرحلة التالية من محاولات تنـشيط مسيرة النمو التى هى غاية هذا النوع من العلاج.
إذن ما تحفل به هذه النقلة من تناقض الوجدان الإيجابى، بمعنى حضور أكثر من عاطفة فى نفس مستوى الوعى، بعضها يبدو عكس الآخر، إنما هو إعلان لحركية التعاطف المتبادل اختبارا، وتراجعا، وتقدما، وحذرا، (ومن ثم: جدلا)، نقرأ مرة أخرى:
وباخَـافْ مِالْقُـربْ،
وما طـِيقْـشىِ البُعـد.
وباخافْ لو عِينى جت فى عْـنينْ مِش “هيـّهْ”،
وباخاف أكترْ لوْ طِلعتْ “هـِيّـهْ”،
فى خبرتى أيضا لاحظت أن إطالة هذا الموقف هو مرهق لدرجة الخطر، لا أحد يستطيع أن يواصل كل هذا الألم الناشئ عن وعد لا يتحقق، وفى نفس الوقت لا يتراجع، وعد بعلاقة حقيقية، برؤيةٍ ما، باعترافٍ ما، بتواصلٍ ما، أقول إن إطالة هذا الموقف دون أن يحقق أية درجة من الاقتراب الموضوعى الداعم الدافئ، إنما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الإنهاك فالتراجع عن محاولة الاستمرار فى هذا الجدل الضرورى لتنشيط دائم لعلاقة بشرية حقيقية.
العلاقة الحقيقية بين البشر هى حركة دائبة، فالحذر هنا يصحبه احتمال الأمان، والإحجام يسير جنبا إلى جنب مع محاولة الاقتراب، والأمل فى وجود آخر رغم التهديد المصاحب لذلك هو أمل متجدد حقيقى وفعال.
وفى خبرتى – مصداقا لهذا التنظير – وجدت أن ظهور علامات هذه المشاعر المشتملة للألم والحزن والدهشة وقدر من الطمأنينة لجدية المشاركة، هو من أهم ما يدل على نجاح العلاج والتقدم على طريق النمو، وهذا يختلف تماما عن السائد من أن هدف العلاج هو “إراحة المريض”، أو حتى هو السماح له “بالتفريغ” أو “التنفيث”.
لابد من التنويه هنا إلى أن الحرص على “بسط” Unfolding هذه المشاعر المؤلمة لا ينبغى أن يكون هدفا علاجيا فى ذاته، وإنما يلتزم المعالج بأن يضبط الجرعة والمدة المناسبة لمعايشة هذه الخبرة بما يحقق دفع عجلة النمو بالقدر البناء، ولا مانع من العودة إلى نفس الخبرة مع كل نقلة نمو لاحقة.
إذا أساء المعالج (أو أى آخر) حسبة الجرعة وطالت خبرة الألم بلا ناتج حالىّ أو واعد، تهدَّدَ الكيان النامى بالتفسخ من فرط الألم، هنا – مع التهديد بالتفسخ – تقفز الحاجة إلى التغطية بأية آلية (ميكانزم) قديمة أو جديدة، بالكبت مثلا (غطونى كويس) أو بالانسحاب (خلونى بعيد) تجنبا لهذا التفسخ المهدد نتيجة لفرط الألم بلا عائد، هكذا يعلنها النص قرب النهاية:
(3)
غطونى كويس،
خلونى بعيد،
لاتْبَعْزقْ.
نهاية هذه القصيدة (الحالة اللوحة) تبدو سلبية لكنها واقعية بشكل منبّه ومؤلم، ذلك أنها أقرب إلى الحل اليائس الذى يعلن صعوبة الاستمرار فى معاناة هذه المشاعر بلا تقدم كاف نحو غاية العلاج (أو العلاقة).
فى العلاج الجمعى خاصة، وفى العلاج عامة، يمكن أن نقابل هذا الميكانزم الذى لا يكتشفه إلا خبير، أو ربما يتكشف نفس الميكانزم بعد بداية العلاج بفترة ليست قصيرة، وأحيانا يظهر بعد تحسن مؤقت، فتراجع منظم أو غير منظم، هذا الميكانزم، ميكانزم “الفـُرْجهْ”، ونعنى بـ “الفـُرْجهْ” هنا: المشاركة بالمشاهدة، والفهم بالعقل، وأحيانا الحكم على الجارى، بالتفكير بل وبالرأى، يتفرج مثل هذا المريض على زملائه، وأيضا على الأطباء، من مسافة آمِنة، كما أن ثم احتمال أن بعض المعالجين (خاصة فى موقف ما يسمى البحث العلمى) يتفرجون على المرضى، وهم يتعلمون منهم نظريا، إذْ يرصدون أحوالهم وتركيبهم، لينشروه بحثاً أو يشرحوه لدارسين: (وقد سبق أن أشرنا لمثل ذلك فى لوحة سابقة “الحالة دى صعبة ومهمة تنفع للدرس”)([24])، يفعل الواحد منا هذا دون أن ينتبه إلى أن كل ذلك يجرى على حساب المشاركة الحقيقية، أى مواكبة المعالج للمريض أثناء مسيرة نموه، هذا نوع من الفرجة مهما كانت أغراضه نبيلة لتحقيق غرض آخر.
فى العلاج الخاص، يمكن أن تتم “الفـرجة” المتبادلة بعيدا عن الوعى الظاهر لكل من المريض والطبيب، طالما أن التعاقد مستمر على مستوى أن وقت الطبيب هو بضاعة قابلة للشراء، وأن حضور المريض ليشغل هذا الوقت، وهو يعرض نفسه أيضا لفرجة ما، هو أيضا ضمن الاتفاق التحتى الذى يتم بينهما، وهكذا قد تستمر العلاقة بينهم على مسافة (أنا تذكرتى بلكون) ما دامت شروط العقد التحتى سارية (بفلوسى) كما تقول النهاية نصـًّا:
(4)
أنـا تذكرتى بلكونْ،
وراح اتفرّجٍ للصبح.
……بـِفْـلوسى
إن اتخاذ موقف المتفرج، حتى على مسافة، قد يكون هو الحماية المناسبة ضد فرط جرعة التلويح بأمل لا يتحقق، أو التهديد بتفاعل إنسانى غامض المعالم وذلك أثناء العلاج، خاصة العلاج الجمعى.
من هنا نرى أن ميكانزم “الفرجة” الذى قد يخفف من خبرة التعرض للألم الرائع السالف الذكر، هو أقرب إلى ما أسميناه سابقا “الهرب إلى الصحة، أو ما يشبه الصحة”، من حيث إنه مع اختفاء هذا المأزق المؤلم بالتراجع، واتساع المسافة والفرجة: يعتبر المريض نفسه، والطبيب أحيانا، أن العلاج قد حقق أغراضه، وهذا احتمال يمكن قبوله على مستوى معين من تعريفات “الصحة”، و”العادية”.
هنا يحضرنا سؤال يقول:
ألا يكفى اختفاء الأعراض سببا وجيها يقرر أن يتوقف العلاج ما دام قد حقق هذه الأغراض مهما كانت متواضعة أو متوسطة؟
الإجابة الجاهزة المنطقية هى: نعم، هذا أوان مناسب لوقف العلاج([25])
بحسابات الواقع، وقرار المريض، وقدرة المعالج معاً.
ثم هاكم المتن مكتملا (كما تعودنا مؤخراً)
(1)
والعين المهزوزَةْ الخايفة الحرامِيَّة،
زى الكلب السارق عضمةْ:
بتبص لتحتْْ، وساعات للجنبْ.
وساعات بتبرّق وتحدق حبّـهْ نونو،
ترجع تانى، تهرب منى،
وتبُصّ لفوق.
أجرى وراهَا قبل ما توْصلْ شُرّاعةِ البابْ،
أو تنزل تتسحب منى: كده تحت دولابْْْْ.
وساعاتْ تِتْرَقّصْ وبياضها يغطى سوادْهَا،
وكأنه بيخبِّى بريئةْ واتَّهمُوهَا:
قَرِّت بالذنبْ،
مِنْ غير ولا ذنبْ
بيقولوا ظبطوها بتتسوّل: فضلات الحُبْ.
وارجع ابصَّلها تنُطْْ،
وتْفُـطْ.
كمَا طفل على سِلـّم تُـرُمَاىْ،
بيْبِيع كبريتْ أو باغةْْ،
أو إيده خفيفةْ، عالسَّاعة والولاّعةْ.
يخطف وينطْ.
(2)
عايزاكمْ.. مِش عايزاكمْ.
باسْتَخْونِـْكُم، وباجِيـكُمْ.
وباخَـافْ مِالْقُـربْ.
وما طـِيقْـشىِ البُعـد.
وباخافْ لو عِينى جت فى عْـنينْ مِش “هيـّهْ”،
وباخاف أكترْ لوْ طِلعتْ “هـِيّـهْ”.
“والدِّمعة يا دوب حاتبان”.
وباخَـافْ مِالْقُـربْ،
وما طـِيقْـشىِ البُعـد.
وباخافْ لو عِينى جت فى عْـنينْ مِش “هيـّهْ”،
وباخاف أكترْ لوْ طِلعتْ “هـِيّـهْ”،
(3)
غطونى كويس،
خلونى بعيد،
لاتْبَعْزقْ.
(4)
أنـا تذكرتى بلكونْ،
وراح اتفرّجٍ للصبح.
……بـِفْـلوسى
اللوحة السابعة:
الدمعة الحيرانة
ملاحظة بادئة:
الرؤية/التعرية هنا لا تستبعد رؤية صعوبة العلاقات البشرية، بل لعل هذه الصعوبة تقع فى بؤرتها، وهى المرحلة التى تميز محاولة الإنسان المعاصر أن يقيم علاقة جدلية واقعية بآخر حقيقى، وهذا هو موضوعنا الأم فى هذا العمل.
على أن اللوحة تكشف بشكل أكثر شمولا عن الثمن، والألم، الذى يصاحب البصيرة الموضوعية لرؤية الخارج أو الداخل أو كليهما، بصفة عامة.
تمهيد
كنت ، حين أجلس صغيرا بجوار الساقية (الحلزونة) فى بلدنا أتعجب لماذا يُحكمون الغُما (الكيس المجدول على ناحيتين لتغطية نصف وجه البقرة الأعلى، وخاصة العينين) أثناء دورانها منفردة (أحيانا تدور مزدوجة فى صحبة أخرى!!) و”الناف” على رقبتها متصل بعمود محورى يقع فى مركز دائرة الساقية تماما. لم أعرف إلا مؤخرا أن حدس الفلاح المصرى قد وصل إلى أن هذه الطريقة توحى للبقرة أنها تسير قـُدُما فى خط مستقيم، فتنسى – أو هو يرجو بحدسه أن تنسى – أنها تدور فى نفس الدائرة طول الوقت، حين أدركت هذا أو تصورته، فزعت للخدعة، ورفضتها، لكننى حين عدت أتأملها، وجدت أن بها نوعا من الرحمة الخبيثة، التى يمكن أن تكون ضمن ما يسمى لؤم الفلاح المصرى (تنطق بعامية بلدنا “لؤن”، بمعنى الذكاء الخاص!!) الذى لم أكن أتصور أنه يشمل نشاط حدسه.
كنت أشاهد أيضا تلك البقرة الأخرى المربوطة فى شجرة التوت أو الجميز، تنتظر دورها بعد أن تجهد البقرة المـُغـَمـَّاة من الدوران مغمضة العينين، فتحل البقرة المربوطة محلها، وتنتقل البقرة المربوطة إلى الساقية، فى حين تربط البقرة التى كانت مغماة فى نفس الشجرة، لتأخذ قسطها من الراحة بعد أن يفكوا عنها غماها.
هذا المنظر وهذا التبديل واحتمالات المغزى هو الذى أوحى لى بهذا التشكيل الشعرى، وأنا أنظر فى هذه العين (غالبا فى المرآة).
(1)
والعين الواعية الصاحية المليانة حُزْن.
…….
عمركشِى شفتِ بقرة واقفه لـْوًحْديهَا،
مربوطة فْ شجرة توتْ، جنب الساقية،
وعْنـِيهَـا الصاحية تحتيها دمعةْْ،
لا بتنزلْ ولا بتجفْ؟
عمّالة تْبُصّ لزميلتْهَا المربوطةَ فى النـَّافْ،
والغُمَى محبوكْ عالراسْ،
والحافِر يُحْفُرْ فى الأرضِ السكةْ اللِّى مالهاشْ أوّل ولا آخـِرْ؟
مع كل أزمة نمو، أو خبرة إبداع حقيقى، تحدث مثل هذه الوقفة بوعى فائق: هى وقفة نقد يقظ، وقفة مراجعة، وقفة استعداد لبداية جديدة فى اتجاه مجهول، وهى وقفة حتمية يمر بها كل إنسان ما دام مازال حيا ينمو، لكنها قد لا تصل إلى الوعى الظاهر فى كثير من الأحيان، وإن وصلت فقد يتم محوها بعد ثوان حتى لا تجرؤ أن تطل ولو كذكرى عابرة، هذه الوقفة تتجلى أكثر وضوحا وأطول عمرا فى عملية الإبداع الحقيقى طول الوقت، وهى تحتدّ فى البداية، وإن لم تكن بالضرورة تسمى وقفة أو تدرك بما هى كما هى، لكن نتائجها تدل عليها عادة.
فى أزمات النمو، وخاصة أثناء المراهقة وأيضا أزمة منتصف العمر، بل وسائر أزمات النمو، قد تعاش هذه الوقفة مددا أطول فأطول بعمق كاف ومسئولية مؤلمة، فتحفز النمو، وتسهم فى إعادة إبدا ع الذات (أو الإبداع عامة).
فى المرض، (بدايات أى مرض نفسى جسيم تقل فيه الميكانزمات فجأة) تحتد هذه الوقفة، ومن ثمَّ: تتعاظم الرؤية بشكل مضاعف حتى تصبح معجِّزة برغم نفس حدة الكشف، وعمق النقد، وبدلا من أن تكون فرصة مراجعة لبداية جديدة، تصبح سببا أو مبرر إعاقة من فرط الألم الذى عجز “الوعى/الفعل” أن يستوعبه، أو يحتويه، يحدث ذلك أكثر فى الاكتئاب الحيوى اليقظ (أسميه أحيانا الاكتئاب البيولوجى النشط تمييزا له عن عكسه تماما، الذى أسميه الاكتئاب اللزج النعّاب، وأسماء أخرى).
فى العلاج، تتم المواجهة، باحتواء هذه الرؤية الأعمق باعتبار أنها خطوة ضرورية لا بد من دفع ثمنها، إن كان العلاج هو “مواكبة عملية النمو” للحفز على استكمالها، وليس إجهاض نبضة النمو.
المتن هذه المرة أوضح من أن يحتاج إلى شرح. هو يعرى الاغتراب الذى يلزم لاستمراره أن تظل الميكانزمات العامِيةْ نشطة طول الوقت، بحيث تنقلب مسيرة النمو إلى “دائرة مغلقة”، التى هى ليست إلا وقفة دائمة خادعة، وهى أكثر خداعا من “السير فى المحل”، فهى تمثل سيرا إلى الأمام، أو ما يشبه الأمام، ينتهى إلى نفس النقطة طول الوقت، باستمرار.
هذه الرؤية الكاشفة قد تحدث تلقائيا كما ذكرنا، وقد تحدث نتيجة إفاقة تحدث كنوع من التلقى المبدع. تأتى الاستثارة من مُحبٍّ صادق مُواكب، أو من إبداع محرِّك، أو من علاج مغامر.
العلاقة بين تبديل البقرة بزميلتها، لتحصل على نوبة راحتها، وهكذا، تذكرنا من جديد بطبيعة الإيقاع الحيوى، وحتمية تناوب نشاط مستويات الوعى.
الأحلام هى نوع من هذا الكشف السرى، حتى دون أن نتذكرها أو نحكيها؟ إن التقليب الذى يحدث أثناء النشاط الحالم (نوم الريم REM: نوم حركة العين السريعة) يشمل نوعا من الرؤية البيولوجية السرية، التى ينتج عنها إعادة تنسيق المعلومات Re-patterning، من البديهى هنا أن كلمة “الرؤية” تـُـستعمل مجازا بشكل مـُـبالغ فيه، الرؤية هنا مفترضة، لا تُـستنتج إلا من خلال نتائجها حين تكون كل “دورة” “نوم/حلم/يقظة” هى دورة إعادة ولادة بشكل أو بآخر (الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور – كما أشرنا سالفا مرارا).
حين يقول المتن على لسان البقرة المربوطة فى شجرة التوت:
“أنا كنت بالـِفّ ومش داريةْ،
كان لازمته إيه؟
بتشيلوا الغُما من على عينى، وتفكونى ليه“،
هى لا تـَحـْتـَجّ، بل تعلن ألم الكشف الذى أكد لها أنها لم تكن تسير إلى الأمام، بل كانت تدور فى نفس الدائرة مثلما تدور زميلتها الآن،
“والغما محبوك عالراس،
والحافر يحفر فى الأرض السكة اللى مالهاش أول ولا آخر”.
كثيرا ما يرجو الإنسان، ويسعى، أن يرى الحقيقة عارية أكثر فأكثر، وهو يتصور أن هذا حقه من ناحية، وأنه سوف يرتاح حين يرى ما يريد أن يراه، هذه طبيعة بشرية ترتبط بآليات المعرفة المتجددة المغامرة بشكل عام، (حتى يمكن ربطها بأكل الفاكهة المحرمة)، وبقدر الحرص على رؤية ما فى “الحجرة المغلقة” المحظور فتحها، وبقدر السعى إلى اختبار ما بداخلها بالذات، تكون مفاجأة المعرفة، والأسف المبدئى، الذى يلحق هذه المعرفة المفاجـِئـَة إنما يعلن رغبة شكلية فى التراجع عن هذه الرؤية، لكن مـَـنْ رأى، حتى لو أغمض عينيه بعدها، فسوف يظل ما رآه ماثلا أمامه، حتى يتمكن من طمسه بأية ميكانزمات، فإن لم يستطع فسوف يظل ماثلا له، بل وربما مانعا له أن يرتد إلى الاغتراب العامى من جديد.
أغلب العلاج الميكنى المخمِّد، هو نوع من “تلبيس” “الغـُمَا تانى”، وهذا هو ما جاء فى المتن حرفيا:
(2)
والبقرة الواقفة تقول:
أنا كنت بالـِفْْ ومشْ دَاريْـَةْ كان لازْمـِتُهْ إيه؟
بتشيلُوا الغُمَا من عَلَى عينِى وتْفكُّونىِ ليهْ؟
عَلَشانْ أرْتَاحْ؟
هىَّ دى راحَـةْ إنى أشُـوفْ ده ؟
لو حتى لْبِسْت الغُمَى تانى مانـَا برضه حاشُوفْ.
وساعتها يا ناس:
مش حاقْـدر ألفّ.
…. ما هو لازمِ الواحدْ ما يشوفشِى،
لو كانْ حايلِفْ.
العلاج النفسى المنطلق من منظور نمائى لا يكتفى بأن يستوعب هذه الرؤية بحجمها الموضوعى، وأن يساعد المريض الذى حضر بها أو عاشها أن يحتويها، ويواكبها حتى يتجاوز آلامها دون أن يتنازل عن مواصلة مسيرته، بل إن العلاج يستثير مثل هذه الرؤية بجرعات مجزأة، وذلك لمن يخشى أن يخوضها وحده، هذا النوع من العلاج النفسى لا يكتفى بالحفاظ على هذه الرؤية مع ضبط جرعة الألم، وإنما هو يعمل على ضبط جرعة التنشيط بتعرية محسوبة، بالحد من اللجوء إلى الميكانزمات تدريجيا، بحيث يسمح لمن يمر بها تلقائيا – من خلال أزمة المرض – أن يعايشها بالقدر الذى يمكن به أن يستوعبها. يتم ذلك بوجه خاص فى العلاج الجمعى.
حين تشترك المجموعة، بما فى ذلك المعالجون، فى هذا الكشف، للإقلال من الميكانزمات، يصبح الألم المصاحب أكثر احتمالا، ومن ثم يصبح حفز النمو أكثر جاهزية، أغلب – إن لم يكن كل – ما عرضناه كعينات مما أسميناه “الألعاب النفسية“([26])، كانت تقوم بدور تحفيز الرؤية حتى لو بدت مؤلمة، وليس الحد منها، الفرق بين أن تمر بهذه الخبرة من خلال مفاجأة مرعبة، وأنت وحدك تماما، وبين أن تمر بجرعة فجرعة منها، وأنت وسط آخرين (المجموعة) يمرون بنفس التجربة، هو الفرق بين بداية ما يمكن أن يتطور إلى مرض أو إبداع وبين العلاج النفسى الجماعى بوجه خاص (الذى هو ضمناً: إبداع الذات “معا” ما أمكن ذلك).
كثيراً ما نعيش محاولة من أحد المرضى (أو المعالجين) لمحو الرؤية الجديدة التى مارسها أثناء العلاج الجمعى، بنسيانها، أو التراجع عنها، أو سوء تأويلها، وقد يلاحظ ذلك زميل مريض آخر، أو معالج، حين يهم أحدهم بالإنسحاب لعدم قدرته على تحمل هذه الجرعة، فيقول له: “وحاتعمل إيه بعد ما اتدبست وشفت ده دلوقتى؟ (وماذا ستفعل بمعرفتك ورؤيتك التى مرت بك هنا الآن؟)” فيرد قائلا: “إيه يعنى، حانسى واغمض أو أطنش تانى” (سأحاول أن أنسى وأغمض عينى من جديد)” فيسخر الأول “ابقى قابلنى“… وقد يعلق ثالث “دا بـُعدك” أو “بعيد عن شنبك“، وغير ذلك من تعليقات تشير إلى أن هذه الرؤية يصعب محوها، بعد ظهورها فى هذا السياق وضبط جرعتها.
الهدف الأهم لما يسمى “العلاج النمائي التوجه” هو استيعاب هذه الرؤية للنمو من خلالها لتكملة المسيرة بإيجابياتها وآلامها.
ينتهى المتن بالإشارة إلى ما يصاحب هذه الرؤية، الأقرب إلى الإبداع منها إلى المرض، من سماح وصبر وأمل فى أن تكون بداية التعرف على “آخر” يصاحبه وهو يعايش هذه الخبرة عبر مسيرته، مسيرتهما، مسيرتهم، معا.
هنا تتأكد علاقة: المعرفة، بالعلاقة بالآخر، بالألم الحى الخلاق، بالحزن الإبداعى – لِتَوَاجُدِنَا معاً فى العلاج الجمعى.
(3)
الله يسامحكم، دلوقتى:
لا انا قادرةْْ ارتاحْ،
ولا قادرة ألفْ.
لا الدمعه بْتِـنْزلْ،
ولا راضيةْ تجفْ.
أشرت فى المقدمة كيف أن هذه الرؤية مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوعنا الأساسى “فقه العلاقات البشرية”. الإنسان المعاصر يعيش أزمة ممتدة هى أقرب إلى ما يسمى “الموقف الاكتئابى” كما أسمته ميلانى كلاين، وهو الذى – كما ذكرت– فضلت أن اسميه “الطور العلاقاتى البشرى” وهو الذى يحاول الإنسان المعاصر فيه أن يرسى قواعده من ألم، ورؤية، وإقدام وتحمّل، وفرحة معاً، ليكون بذلك هو النوع الأغلب فى العلاقات بين البشر، ليكونوا بشرا. الإنسان – كما ذكرنا – لا يكون إنسانا إلا إذا كان واعيا بدرجة ما بوعيه حالة كونه يتجادل (لا يتحاور فحسب) مع وعى إنسان آخر يحاول معه نفس المحاولة، هذه العلاقة الأرقى هى التى يتكون منها نوع من الحزن الذى وصفناه بأنه “حزن” “إيجابى” “نشط”، وعلى ذلك فالمفروض أن نفرح به شريطة أن تضبط جرعته، هذه الخبرة التى هى أقرب إلى ما يسمى “الحزن الصامت الأصيل” يكون فيها:
الألم صحوة،
والمثابرة اقترابا،
والاحتياجبر طلبا شريفا،
والعطاء فرحة،
والفرحة طيبة لا تلغى ألم الرؤية،
ولا تقف بعيدا عن الخبرة،
ولا تتجاوز عدل التبادل العلاقاتى.
إنه بالرغم من الألم الذى يعانيه من يمر بهذه الخبرة الرؤية الضرورية ليكون “بشرا”، فإن ذلك لا يترتب عليه سخط أو سخرية أو انسحاب، أو عدوان، بل الأرجح أنه يجذبنا إلى بعضنا فى إطار من التسامح المؤلم، ( “الله يسامحكم… إلخ”).
قمة إيجابية تجربة هذا الحزن اليقظ الذى يمثله هذا الموقف تشمل: التوقف للمراجعة، والسماح بالاقتراب، والرغبة فى ”الحياة معا“، مع الاعتراف بالعجز المرحلى.
وهاكم المتن كاملا:
(1)
والعين الواعية الصاحية المليانة حُزْن.
…….
عمركشِى شفتِ بقرة واقفه لـْوًحْديهَا،
مربوطة فْ شجرة توتْ، جنب الساقية،
وعْنـِيهَـا الصاحية تحتيها دمعةْْ،
لا بتنزلْ ولا بتجفْ؟
عمّالة تْبُصّ لزميلتْهَا المربوطةَ فى النـَّافْ،
والغُمَى محبوكْ عالراسْ،
والحافِر يُحْفُرْ فى الأرضِ السكةْ اللِّى مالهاشْ أوّل ولا آخـِرْ؟
(2)
والبقرة الواقفة تقول:
أنا كنت بالـِفْْ ومشْ دَاريْـَةْ كان لازْمـِتُهْ إيه؟
بتشيلُوا الغُمَا من عَلَى عينِى وتْفكُّونىِ ليهْ؟
عَلَشانْ أرْتَاحْ؟
هىَّ دى راحَـةْْ إنى أشُـوفْ ده ؟
لو حتى لْبِسْت الغُمَى تانى مانـَا برضه حاشُوفْ.
وساعتها يا ناس:
مش حاقْـدر ألفّ.
…. ما هو لازمِ الواحدْ ما يشوفشِى،
لو كانْ حايلِفْ.
(3)
الله يسامحكم، دلوقتى:
لا انا قادرةْْ ارتاحْ،
ولا قادرة ألفْ.
لا الدمعه بْتِـنْزلْ،
ولا راضيةْ تجفْ.
اللوحة الثامنة:
نايم فى العسل
تكاد تكون هذه الحالة تطبيقا أكثر مباشرة وتوضحيا لما أسميناه “تسول الحب”، يتجلى ذلك هنا فى موقف علاجى محدد، يكاد يعرض مقارنة حادة بين العلاج النفسى الفردى التسكينى بالكلام، وبين العلاج الجمعى الذى نمارسه من منظور إيقاعحيوى تطورى أساسا.
هذه الحالة بوجه خاص، كانت لها تاريخ طويل فى العلاج النفسى الفردى معى، أنجزتْ من خلاله درجة معقولة من التكيف، والتسكين حتى تخرّج صاحبها من كلية قمة، واختفت الأعراض البادئة، ثم إنه طلب بوضوح أن يواصل العلاج الجمعى، فأعطيته الفرصة، باعتبار أنها مرحلة لاحقة قد تفيده فى استكمال النمو، خاصة وأنه – بتخرجه – لم يعد فى حاجة إلى جرعة زائدة من آليات الدفاع العامِية، وقد كان صادق النية فى أن يحاول أن يكمل.
الذى حدث هو العكس تماما، فقد عرّت تجربة العلاج الجمعى المواجِهِى الجرعة المفرطة من الاعتمادية التى ربما اعتادها صاحبنا أثناء العلاج الفردى، وقبله، لكنه أصر على مواصلة المحاولة، وكلما تقدم فيها، أكد موقف “المتفرج” دون مشاركة، وازدادت ميكانزمات العقلنة والاعتمادية، حتى صار واضحا للجميع أنه لا ينوى أن يتقدم إن لم يتراجع.
كان صاحبنا شاطرا تماما فى وصف ما به، بل وما بغيره، كما كان حاذقا فى الإعجاب بما يجرى حوله فى المجموعة العلاجية من محاولات وتجارب، ومفاجآت مخاطر، لكنه كان دائما يحمى نفسه بمزيد من الطلبات من موقف سلبى متلق، بلا محاولة جادة من جانبه لأى حركة نحو التغير الكيفى الحقيقى.
كان صاحبنا مثابرا منتظما فى حضور اللقاءات كلها تقريبا، دون أى تغيير من جانبه، وحين تكررت المواجهة، وتعرى موقفه أكثر فأكثر، بدأ العدوان الاحتجاجى يحل محل المقاومة الاعتمادية، ليختم تجربته بالاحتجاج على قائد المجموعة، معالجه القديم، وكان احتجاجه موضوعيا منبها، مؤكدا ما ذهبنا إليه فى العلاج النفسى بأنواعه، من ضرورة ضبط جرعة الرؤية الجديدة، لتتناسب مع فرص احتوائها، وظروف واقعها، على مسار النمو.
المتن أيضا تعرض لمقارنة مباشرة – ساخرة – ما بين الاقتصار على العلاج بالتسكين والضبط والربط باستعمال العقاقير أساسا، وبين العلاج التكاملى الذى يستعمل العقاقير دعما لمسيرة النمو بجرعات متغيرة حسب مسيرة الحالة كما ذكرنا دائما.
والآن إلى القراءة فالتداعى:
(1)
والعيون التـَّانـْيـَه دى بتقول كلامْ،
زى تخاريف الصيامْْ؛
الصيام عن نبضِة الأَلـَم اللى تِـبْنى،
الصياْم عن أىَّ شئ فيه المُـغـامْـرَهْْ،
الصيام عن إن لازم كل بـنِـى آدم يـِفَتّح،
مش يتنَّـح
الصيام عن أى حاجة فيها إنى: عايز أكونْْ:
زىّ خلقةْْ ربنا”
مسألة أن أكون “زى خلقة ربنا” تكررت كثيرا فى هذا العمل، وأنا – بصراحة – لا أجد لذلك بديلا، حتى كلمة “الفطرة” أجدها بديلا أكثر غموضا فعلا من “زى خلقة ربنا”
يتحفظ العلماء عادة على هذه اللغة، وربما عندهم حق، فما أن تنطق بهذا التعبير “زى خلقة ربنا” أو “كما خلقنا الله” ينبرى أهل السلطة الدينية ليستولوا على كل ما بعد ذلك لصالح تعميق سلطتهم، وترصين أبجديتهم الخاصة، وليس لصالح إطلاق المسيرة البشرية لتكمل مشوارها “إليه”، وأيضا ينبرى العلماء المحدودون يتهمونك بالقفز وراء الحقائق العلمية المحددة إلى ما يسمونه الميتافيزيقا، الذى أقصده، وغالبا يقصده الناس، بهذا التعبير، هو أن يكون الإنسان إنسانا، كائنا متميزا، يحمل تاريخ تطوره كله، لا يلغى أوله لصالح آخره، ولا يطلق لأوله العنان على حساب مكاسب تطوره، هذا ليس حلا توفيقيا وسطا، لكنه تاريخ الحياة وتاريخ الإنسان، هو الحركة الدائبة، المتناوبة، لتحقق الجدل فى دوراتها المتعاقبة، هذا تحديدا ما أتصور أن الحق تعالى من خلال التطور قد هيأه لهذا الكائن الفائق الرقى، الظالم نفسه برقيه المنقوص.
حين يقول المتن إن صاحبنا قد أغلق وعيه فَصَام عن أى احتمال أن يكون كذلك، فإن المقصود (وهو الذى حدث فى هذه الخبرة) أنه راح يقاوم كل محاولة تفاعل يمكن أن تهز ما استقر عليه من دفاعات مجمّدة، (مريحة!!) وربما بالذات تلك الدفاعات التى قويت أثناء العلاج الفردى، وكذلك، وحتى انتهت الخبرة (القصيدة) كان يضع اللوم على قائد المجموعة معالـِـجـُـهُ الفردى السابق: كل ذلك وهو لا يتحرك من موقعه، خوفا من: “نبضِة الأَلـَم اللى تِـبْنى“، من “أىَّ شئ فيه المُـغـامْـرَهْْ”، من الرؤية الجديدة “إن لازم كل بـنِـى آدم يـِفَتّح، مش يتنَّـح“.
حتى لو كنت قد حددت هذا التعبير “زى خلقه ربنا” بفكرى التطورى ضمنا بأن ربنا خلقنا نحب بعضنا، حتى من واقع برامج التطور للبقاء، وأن ما يحدث بعد ذلك ليحول دون ذلك، هو بفعل فاعل، حين يرفض هذا الصديق أن يكون “زى خلقة ربنا”، فإن هذا يعنى أنه متمسك بميكانزماته التى اكتسبها لتحميه من التهديد بعلاقة مغامِـرة ربما فيها شطح غير محسوب حتى لو كان على مسار النمو، هذا ليس عيبا ولا نقصا فى مرحلة معينة، أما أن يكون هذا هو نهاية المطاف، فهو الأمر الذى نتوقف عنده، ونتعلم من مثل هذه الحالة أن المسألة ليست كذلك.
حين أتيقن من مثل هذه الحالات أن موقفها صلب وحاسم، أتراجع عن الحماس للنصح بالعلاج الجمعى خاصة، وأحيانا، ولو أنها نادرة، أنصح مثل هذا الشخص بالتوقف فعلا عن المشاركة فى علاجات تعرضه لما ليس فى حسبانه، نعم، أن يتوقف – ولو لفترة– عن التردد على هذا النوع من العلاج النفسى الجمعى، لكن الذى يحدث عادة هو أن يصر مريضٌ ما على أن يخوض التجربة، وله كل الحق، وفى هذه الحالة أستسلم للانتقاء الطبيعى، فكم من مريض تصورت أنه لن يتحمل أن يكمل معنا المسيرة، وإذا به يفعلها ونصف، وكم من آخر بدا متحمسا جاهزا للتغير، لكن ما إن تبدأ الخبرة حتى يتراجع بسرعة إلى دفاعاته المتينة تماما، حتى ينقطع عن العلاج المهدد بخلخلتها.
أهم صفة تصف هذه الوقفة الحالية فى هذه الحالة هى الاستسهال، ومحاولة تجنب الألم، وتصور العلاج تصورا سحريا يحل المشاكل بدون ألم (بالبنج).
ورغم انبهار صاحبنا الكلامى بما يجرى، وإعلانه البدئى أنه يريد أن يكمل المسيرة، إلا أنه، ومن البداية، يحدد طريقه الذى يؤدى به إلى عكس ما يعلن دون أن يدرى. هذه الصورة الاعتمادية المرفوضة من حيث المبدأ لها ماوراءها من مبررات، أهمها، كما بدَت وفى هذه القصيدة بالذات: تجنب الألم مهما ضؤلت درجته، ناقشنا فى الحالة السابقة “ألم البصيرة”، لكن الذى مر بجرعة مفرطة من الألم (يحدث ذلك عادة فى بداية أزمات التطور الحادة أو بداية الخبرة المرضية) ثم لم يجد أحدا بجواره، ولم يجد دفعا بداخله لتحمله أو تجاوزه، ثم لملم نفسه بدفاعات أيا كانت، إن من مر بمثل هذه الخبرة يأبى – عادة – أن يعود إليها تحت أى إغراء، ولو رأى أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة دفع الخطى على مسار النمو. لكن العجيب فى مثل هذه الأحوال أنه لا يستسلم لدفاعاته – مثل أغلب العاديين – بل يظل يتصور أن فى الإمكان أن يحقق أمنيته النظرية، بجرعات جاهزة من الهدهدة والتفريغ والاعتمادية. ويظل الموقف هكذا طول الوقت، كما تبين القصيدة: لا هو يكف عن إعلان المحاولة دون محاولة، ولا هو يحاول فعلا، ولو بأى درجة كانت، صاحبنا كان يبدو، دون بقية المجموعة، مرتاحا، حالما، مستقرا، لكنه دائم الإعلان عن نيته فى المشاركة، ولكن بشروطه.
(2)
العيون دى صرّحت إنِّ صاحـِـبـْـنـَا
عمره ما حايعلن يسيبنا
بس شرطه يَتّنه نايمْ فى العسل، عمال بيحلَم،
بَسْ عامل نفسه بيحاول، ويتكلمْ، ويحكُـمْ،([27])
شرطِ إنه لمْ يـِـخـَـطـىِّ أو يِسلّـمْ
مشْ على بالُه اللى جارِى،
”كل همّه، يستخبَّى أو يدارى”.
وان وَصلُّه، غَصْب عَنُّهْ
يترمى سْطيحَهْ ويُطْلُبْ حتّه مـِنُّـهْ:
شرط إنه يجيله فى البزازة دافْيَةْ، جَنْب فُمُّهْ.
أعتقد أن هذا الجزء من المتن، هو المقابل الشعرى المباشر لما سبق شرحه حالا قبل عرض النص، إن الذى كان يميز هذا الموقف بوجه خاص هو إلحاح صاحب هذه العيون لإعلان “نيته” فى المشاركة، وفى نفس الوقت طلبه المباشر أن يعطيه أحدهم ما يتصور أنه حقه دون سعى من جانبه.
هذه الرؤية المعقلنة هى مكافئة تماما للعمى الدفاعى النفسى، “مش على باله اللى جارى”، لأنها رؤية مع وقف التنفيذ إلا بهذه الشروط التى هى ضد كل قواعد ما يسمى “مسيرة النمو”.
مرة أخرى: إن مما يستدعى العجب هو تساؤل يقول: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يصر صاحب كل هذه الدفاعات القوية، على استمرار المحاولة بهذا الإلحاح والانتظام فى طرق الأبواب؟ بالرغم مما يصله من صعوبات، وما يرى من مشقة وألم لازمين للخوض فى التجربة؟
إن التفسير الأقرب هو نجاح آلية (ميكانزم) العقلنة بشكل فائق بما يجعله يواصل الرصد لما يجرى من على مسافة آمنة، بحيث يصبح العقل النشط المتفرج مصدًّا قويا طول الوقت، ضد التغير، ويصبح صاحبه غير مهدد فعلا بالتغير الفعلى، وكأنه يكتفى بالفهم المعقلن، فهو لذلك يواصل المطالبة بالتغيير ألفاظا منطوقة لا أكثر.
ويمكن إيجاز الخطوط البدئية لهذا الموقف كالتالى:
أولاً: لا يكتشف صاحبنا أن المسألة لا تقتصر على قناة التوصيل بالكلمات والرموز المعقلنة، فالجسم يتلقى، والوجدان يتلقى، والوعى – بمستوياته – يتلقى، ومن هنا تأتى أهمية البيت فى المتن “وان وصل له غصب عنه”، نعم الذى يحدث أن الرسائل التى تصل لمثل صاحبنا من وراء ظهره، تصله فعلا غصبا عنه، وهو لا يرفضها بل يمحوها فورا بعكس ما نتصوره، يمحوها بأن يتقبلها ويطلبها من الوضع مستلقيا رضيعا فاهما.
“وان وصل له غصب عنه،
يـِـرتمى سطيحة ويطلب حتة منه”!!!
ثانيا: فى هذه المرحلة يستغنى صاحبنا عن فعل التغيير بمتابعة كل ما يجرى، وبالتالى يتجنب مواجهة داخله وكأن أفراد المجموعة تحقق بالنيابة عنه أمانيه وتحل صراعاته أما هو فيتصور أنه “عرف” الحكاية فلا توجد مشاكل ولا خطوات بعد ذلك.
ثالثا: فى نفس الوقت يجد صاحبنا نفسه فى موقف المقاومة العنيفة بإعلان “عدم الفهم” متى ما اقتربت الرؤية الذاتية منه، أو متى تهدد بضرورة التفاعل.
رابعا: هذا لا ينفى أبدا أن يصله ما يغيرّ تركيبه الدفاعى ولو من خلف ظهره، أو من خلال ما يسمى الانتباه السلبى، فلاشيء بهذه الجدية يمكن أن يُهْدَرُ بلا جدوى تماما حتى ولو توقف وصوله عند مرحلة التنظير والعقلنة.
خامسا: وبسبب هذه الزحمة من المتناقضات: (مثل الحضور مع المقاومة، والفرجة برغم الاستيعاب السرى) يستمر هذا الموقف ربما إلى أجل غير مسمى، وينبغى على المعالج أن ينتبه إلى ذلك كله وأن يتعامل معه على هذا الأساس فى حينه.
(3)
كان صاحبنا حلو خالص فى الكلام
كان بيتفرج، وهوه بعيد تمام،
كل ما نديله حتـّه، يترسم ويقول كمان.
عايز أخطى، بس شرطى، فى الأمان
كان مركـِّـز عاللى كان واخد عليه
لما كان بيحكَّى للى شافُهْ “بيهْ”:
كلٌّه “مين”، و”زمان” و”ليه”!!
……….
………..
بس ده ياناسْ لقاهـَا حكاية تانية ـ
يعنى شغل “هنا” و “حالا” كل ثانية
كل ما واحد يهمّ
نفسه يعنى يهم زيّه، بس لأْ، من غير ألمْ !!
يقلب الخبرة مشاهدهْ كإنه فيلمْ:
…………….
قالُّهْ سمَّعْنَا كمان حبّةْ نغَمْ:
كِيدِ العدَا،
يا سلامْ!! هوا جوّاك كلّ دا!؟
أنا نِفْسِى ابقَى كده؟
بس حبُّونِى كمانْ.
حُط ّ حتَّهْ عالميزان.
أصلِى متعَّود زمانْ:
إنى انام شبعان كلامْ.
تأكيد جديد لنفس الموقف، لكن يضاف إليه الحذر من موقف المتفرج، الذى انفصل عن المشاركة حتى بدا مستلذا بألم الذى يحاول، “بس سمعنا كمان حبة نغم”، أما إضافة “كيد العدا” فقد تكون إشارة إلى أنه يقر أن هذه المحاولة يرفضها أغلب الناس، بل وقد يدمغونها باعتبارها اختلافا يصل إلى درجة مخاطرة الجنون، لكن صاحبنا يتصور أنه يربأ بنفسه أن يكون من هؤلاء، فهو يصفق لمن خاض هذه التجربة الجديدة، وبالتالى هو “يكيد العدا” بالتصفيق والانتظام فى الحضور فحسب
ليس هذا فقط، بل إنه يبدى إعجابه بالمؤدى ويقصد أى فرد فى المجموعة، “يا سلام!! هوه جواك كل ده!!”، وكان يعلن أمنيته (الكلامية) أن يتقمصه “أنا نـِـفـْـسِى ابقى كده”.
هذا الموقف يعتبر أكثر سلبية بكثير من موقف الشخص الذى رضى بالعادِيـّـة، أو حتى بفرط العادية كنهاية للمطاف، فصاحبنا هنا لا يرفض المحاولة كما قلنا، لكنه حتى وهو يعلن أنه يتمنى أن يمر بمثل ما يمر به زميله هذا المتقلب على جمر الحقيقة، يلحق نفسه بما يكشف أن هذا التمنى نفسه هو الذى يخدعه ويحول بينه وبين المحاولة الحقيقية، فهو يلحق أمنيته فورا بأن يمد يده “متسولا”:
“بس حـِـبُّـونِى كمانْ.
حُط حتُّهْ عالميزان”
وهو يعزو ذلك إلى خبرته السابقة فى العلاج الفردى الكلامى التسكينى التأويلى
“أصلِى متعَّود زمانْ:
إنى انام شبعان كلامْ”.
الذى حدث أن المجموعة وقائدها انتبهوا إلى كل هذه السلبيات التى جعلت وجود صاحبنا مثيرا للدهشة من ناحية – لماذا يستمر؟ – ومانعا للمشاركة الزائفة السطحية التى كان يمثلها أصدق تمثيل، حتى أن الباقين لم يكتفوا بتنبيهه والتفاعل معه لإفاقته، بل خافوا ورفضوا أن يسلكوا سبيله.
ويتكرر الموقف وكأنه سوف يهم أن يفعلها، لكن سلوكه، وإعلانه، وإصراره على التمسك بموقع المتلقى طول الوقت، يكشفه بسرعة هائلة:
هذه الفقرة بالذات، وتعبير “بنج اللذاذة، كله دايب فى الإزازة”، هى من أصرح الفقرات نهيا عن المفهوم الشائع: أن العلاج النفسى هو ترييح وتسكين وتفريغ. معظم المرضى، وأهلهم أكثر منهم، لا يطلبون من الاستشارة النفسية، أو العلاج النفسى وبالذات فى البداية إلا “أن يرتاحوا”، وقد ناقشنا ذلك فى هذا الكتاب مرارا، (وغيره) ونكرر هنا أن هذا حقهم، ولكن ليس على حساب رحلة نموهم.
كل هذا لا يعنى أن يمتنع المعالج أن يعطى جرعة “الترييح ” الضرورى بين الحين والحين، وخاصة فى البداية، ولو على سبيل الرشوة حتى تستمر مسيرة العلاج إلى أن يعاد التعاقد لدفع عجلة النمو.
المقطع التالى يمكن أن نقرأه على لسان حال المجموعة، أو على لسان حال قائدها وهو يبدأ بتنبيه صاحبنا أن يكف عن التسول ويشرع فى المبادأة، إن كان صادقا فى أنه “أنا نـِفـْـسـِى ابقى كده”.
(4)
”يا أخينا مِدّ إيدك
يا أخينا هِـمّ حبَّـهْ.
الحكاية مِش وِكالة بْتَشتِرِى منها المَحَبّةْ”.
قام صاحبنا بانْ كإنه مشْ مِمَانـِعْ،
بس قاعد ينتظر “بِنجِ اللذاذة”
كـلّه دايب فى الإزازة
رضعة الحب اللى جىّ جاهز ودافى
رضعه كامـِلـَةْ إلدّسم، سـُكـّـرها وافى !!
(5)
والمعلّم صْبُرهْ بحباله الطويلةْْ،
قال “لابد أشوفْ لُه حيلهْ”:
قال لـه يا ابنى تعالى جنبى
إنت تطلب، وانا الـــَــبّى،
راح صاحبنا معرّى جوعه، نطّ كل اللى مْدَارِيهْ
عرضحال كاتب جميع ما نـِفـْسُه فيه:
“.. بعد موفور السلامْ،
نِفْسِى حبِّةْ حُبْ، أو حتِّةْ حقيقهْ،
نفسى أشارك فى اللى جارى ولو دقيقهْ،
نفسى أعرف فى اللى بتقولوا عليهْ،
نفسى اشوف دا إسمه إيه”
موقف صريح آخر لإعلان التسول، لكن التسول هنا يتجاوز تسول الحب، فهو يتسول أيضا المشاركة كما يتصورها، فهو يدرك – من بعد أعمق – أن كل رؤيته لحقيقة الجارى، بما في ذلك معاناة من يحاول أن يخوض التجربة جادا ، ليست إلا رؤية زائفة، بل إنها يمكن أن توصف بأنها حتى: “ضد الرؤية” (قارن الحالة السابقة)، وقد عرى المتن داخل صاحبنا حين يقرن تسوله للحب، بتسوله للحقيقة، ويلحق ذلك مباشرة بإعلان جهله بما يجرى حوله برغم كل مزاعمه أنه يراه ويعرفه، وبالتالى يطلب منه، ويحاول أن يكونه، بل إنه يعترف أن كل الأسماء التى أطلقها على هذه الخبرة أو الخبرات، غير كافية للإحاطة بها:
“نفسى أعرف فى اللى بتقولوا عليه،
نفسى أشوف دا إسمه إيه”.
فى خبرتى كنت أترك مثل هذا الشخص وكأنى أهمله، لعله يُستثار من بعيد لبعيد، وبعد فتره تطول أو تقصر حسب حساباتى أحاول بداية الحوار معه، ومن ثم الأمل فى التفاعل، ولكنه فى العادة يعود يكرر الكلمات الجارية فى المجموعة، دون إحاطة كافية بمضمونها، أو تحمل مسئوليتها، أو حتى محاولة احترام حفزها.
الذى حدث – كما قلنا سابقا – أن المعالج السابق لصاحبنا (أنا) كان هو هو الذى ظهر فى المتن وكأنه يحاور صاحبه القديم، وهو يحاول أن يظهر له الفرق بين خبرة العلاج الفردى، وخبرة العلاج الجمعي.
الفقرة التالية من المتن تظهر محاولات هذا المعالج استدراج صاحبنا إلى كشف مدى ما يريد من هذه الاعتمادية، التى حلّت محل المواكبة التى لوّح المعلم بها:
“المعلم قال له: ماشى ياللاّ بينا”، ولكن …..،….،
(6)
المعلّم قالّه: “ماشى، يالله بينا”
يالله بينا!!! يالله بينا؟ على فين؟
دانا مستنى سعادتكْْ.
روح وهاتْْ لى زى عادتكْْ.
أى حاجة فيها لذّة،
الكلام الحلو، والمنزول، ومزّة.
أنا أحكى، وانت تتصرف براحتكْْ.
أنا تعجبنى صراحتك،
يبدو فى هذه الصورة من جديد الأثر السلبى للإصرار على مفهوم أن العلاج النفسى ليس إلا تفريغا بالكلام، الحنين هنا إلى مرحلة العلاج الفردى الكلامى التسكينى واضح بصورة صارخة.
كثير من المرضى يتصورون أن دورهم ينتهى عند الحكى، والباقى على المعالج “آنا أحكى، وانت تتصرف براحتك”، وإعجاب صاحبنا بصراحة المعالج وتعليماته قد يكون إشارة إلى استقباله هو وليس إلى دور المعالج الحقيقى، فأى معالج مهما بلغ تعاطفه مع مريضه، وتأثره بفكرة الترييح والتسكين والتفريغ، لا يمكن أن يقبل أن يطول هذا الوضع، وإلا انتهى إلى السلبية، صراحة المعالج حتى فى رفض القيام بهذا الدور، قد يقلبها مثل هذا المريض إلى تصفيق للمعالج دون أن يصله رفض المعالج لكل هذه الاعتمادية.
وهنا أحب أن أشير إلى أن التحسن الظاهرى الذى قد يتوهم المريض والمعالج معا أنه تم فى العلاج الفردى، قد تتبين طبيعته الهروبية والدفاعية إذا ما أتيحت الفرصة لاختباره فى بوتقة العلاج الجمعى بما يحمله من مواجهة وتفاعل ومقارنة واختيار، خاصة حين يتصاعد موقف المعالج حتى يرفض مثل هذا المريض، وكأنه يعاقبه “يزعل منه” يهمله، يكشفه، يواجهه، يلوّح بقطع العلاج، لكن صاحبنا يكاد يكون على يقين من حقه فى ألا يتغير مهما تغيّر نوع العلاج، وهو يواصل طلب المعونة، ولكن بشروطه.
نقرأ المتن (وهو يواصل):
إٍوعَى تزعلْ منّى: دنَا عيّل باريّل،
لسَّه عندى كلام كتير أنا نفسى اقولهْْ،
عايِز اوْصف فى مشاعرى وإٍحساساتى،
واقعد اوصفها سنين،
مش حا بَطّلْ، خايف ابطّلْ،
لو أبطّل وصف فى الإحساسْ حَاحِسّ،
وانا مِش قد الكلام دهْ.
يلاحظ هنا أن الخطاب هو بلغة الجزء الأعمق من النفس. كما هو الحال فى هذا العمل كله، لأن كل هذه الدفاعات تحدث – طبعا – بعيدا عن وعى المريض الظاهر، أمّا الطبيب “أو المعالج” فإنه يلتقطها من خلال تقمصه بالجزء الأعمق لمريضه، ثم قد يتبينها المريض فيما بعد، أو لا يتبينها.
عندما أستشهد بهذه الفقرة التى تقول “لو أبطل وصف فى الإحساس حا حس”، لا يصدقنى أغلب تلاميذى أو زملائى الأصغر، ناهيك عن مرضاى.
المعتقد العام هو فى الاتجاه العكسى (كما أشرنا سابقا غالبا)، معظم الناس يعتقدون أن وصف الإحساس هو سبيل إلى تعميق الإحساس، النص هنا ينبه إلى أنه فى كثير من الأحيان، ولا مجال للتعميم بداهة، يكون وصف الإحساس بالألفاظ هو بديل عن معايشة هذا الإحساس، وفيما يلى مشهدان يؤكدان ذلك، الأرجح أننى أشرت إليهما سالفا أيضا، وهما:
أولا: فترات الصمت التى تحدث مصادفة فى العلاج الجمعى، فتتفجر خلالها أحاسيس مختلفة، لمن يحمى نفسه بسبات خفيف أو عميق، أو على الأقل بسرحان ممتد، قد تكسره زيادة فترة الصمت أكثر وأكثر، فى هذه الحالات التى عايشتها فى العلاج الجمعى عددا متوسطا من المرات، كانت المشاعر الحقيقية التى تظهر خلال الصمت أعمق، مما يسهـِّل علينا التقدم إلى طبقات أخرى من الوجدان، ومستويات أخرى من الوعى.
ثانيا: تلك التجربة التى وصفتها أيضا فى حلقات سابقة: حين أعرض على مريض فى لقاء إكلينيكى – تعليمى فى الغالب – أن يسمح لحزنه أن يظهر دون (ا) أن يعزوه إلى سبب، حالى أو سابق، وأيضا (ب) دون أن يعبر عنه بالألفاظ، (أحيانا أستعمل تعبير: يمارس حقهُ فى “الألم”)، وإذا بنوع آخر من الأحاسيس يطل من العينين والوجه والجسد دون ألفاظ مؤكدا الفكرة التى جاءت فى المتن هنا: أنه “لو أبطل وصف فى الإحساس حا حس”.
داخل “صاحبنا” هنا، يعلنها : أنه لن يسمح لمشاعر أصدق أن تطل منه رغما عنه.
ينبغى أن ننبه هنا إلى أن وصف الإحساس ليس منهيا عنه على طول الخط، فالقدرة على ترجمة الأحاسيس إلى ألفاظ هى أداة للفنانين والشعراء خاصة، وإن كانت قد مرت علىّ فترة شعرت فيها أن الشعر بالذات قد يكون ضد الثورة، اللهم إلا شعر التحريض، وهو ليس شعرا جدا، أو على الأقل ليس من أفضل الشعر، وإذا كنا نشجع الطفل فى نموه العادى أن يتعلم الرموز (الكلام) فى طريقه إلى التفوق الإنسانى، فإن الرموز اللفظية التى تصف الانفعال بوجه خاص هى من أعجز الرموز وأكثرها غموضا وتداخلا. إن النمو عند الأطفال وغيرهم لا يعنى أن يحل الرمز محل الخبرة، الكلام يساعد الطفل ليستطيع وصف بعض خبراته بما تيسر من رموز.
فى هذه الصورة التى أقدمها هنا يخرج اللفظ عن هذه الوظيفة – كما ذكرنا – ويصبح بديلا عن الخبرة، يصبح اغترابا عن الوجود.
حين يتأكد هذا الموقف هكذا، من داخل داخل المريض، يصبح الاستمرار بنفس شروط التعاقد البدئى مضيعة للوقت فى أغلب الأحوال، وهنا يحق للمعالج أن يفرض توقف العلاج الأمر الذى قد يحتاج إلى إعلان فرصة “إعادة التعاقد” حفزا للمريض بالحرص أكثر على المشاركة.
المقطع التالى فى المتن يعلن مثل هذا الموقف من المعالج ببساطة “شوف لك حد غيرى”، ولعل هذا يبين أيضا أن النصح بإيقاف هذا العلاج بالذات ليس حرمانا للمريض من العلاج عامة، وإنما هو اقتراح بعلاج آخر، قد يكون المريض فيه أقل مقاومة، وأكثر استفادة حسب شروطه.
المقطع التالى يعرض أيضا مقارنة ساخرة بين العلاج التسكينى بالعقاقير المهدئة أو القامعة (مع أنها هى هى التى تستعمل منظّمة، ومنسِّقة مع اختلاف الطريقة والجرعة والتوقيت بحسب مسيرة العلاج التكاملى)، وهذا المقطع يشير أيضا إلى وسائل هروبية أخرى، من أول الهجرة الهروبية إلى التوقف عن مسيرة النمو تماما مما نسميه أحيانا – برغم قسوة الاسم – الموت النفسى، وهو يقابل الاغتراب المزمن، وما يسمى “فرط العادية” أحيانا.
المقطع التالى لا يصرَّح به الألفاظ طبعا، وإنما هو يترجم لسان حال المعالج المسئول الحريص على إنهاء الموقف السلبى بشكل أو بآخر.
(7)
المِـعـَـلـِّم قالُّه: شوفْ لَكْ حد غيرى،
جَنْبِنَا دكّانة تانيةْ،
فيها “بيتزا” مِالّلى هيَّهْْ،
أو “لازانْيَا”.
فيها برضكْ وصفهْ تشفى مالعُقدْ،
إسمها “سيبِ البلد”.
فيها توليفةْ حبوب من شغل برّة.
تمنع التكْشيرهْ، والتفكيرْ، وْتمِلاكْ بالمسرّة.
فيها حقنةْ تخلِّى بَالَكْ مِستريـَّـحْ.
تِنتشِى وْتفـضَلْ مِتَنَّحْ.
فيها سرّّ ما يِتْنِسِيشْ.
لِلـِّى “مِشَ لازِمْ يـعـــيش”!!
المتن يظهر لنا كيف استجاب صاحبنا لهذا الطرد الصريح بأن أعلن مقاومته للتغيير رغما عنه، وهذا لا يتعارض مع إصراره البدئى على التغيير مثل الآخرين “أنا نِفْسى ابقى كده”، لكن حين وصل الأمر إلى التهديد بـ “إنهاء التعاقد” هكذا، استثار هذا الموقف مقاومة صاحبنا فراح يكشف عن أسبابه للمقاومة.
هذا النوع من العلاج بالمواجهة والتعرية، إن لم تضبط جرعته، ويمتد زمنه إلى درجة كافية، ومهما كانت حسن نية من يشترك فيه، وموافقته على شروطه، وأيضا مهما سمى أنه علاج من منظور النمو والتطور ومثل هذا الكلام، فإن فيه خطورة أن يطغى عليه فكر مثالى، تحت تأثير معالج له حضور قوى، أو منظومة ذاتية طاغية ظاهرة أو خفية، وبالتالى، فإن المريض الذى يلتقط أيا من هذا مهما كان حماسه، يخشى على هويته، على منظومته الخاصة من الاهتزاز، سواء كانت منظومة دينية، أو أيديولوجية سياسية، أو ذاتية ظاهرة أو خفية، يخشى عليها لدرجة أن أية دعوة للمخاطرة بالتغيير تترجم لديه بانها إغارة من منظومة المعالج الأقوى، أو من منظومة المجموعة ككل، وهنا تقفز المقاومة (المشروعة بصراحة)، ولا تهدأ إلا حين يكتشف المشارك أن له حق الاحتفاظ “بنفسه وهُويته كما هى”، وأن المطلوب هو السماح بإضافة جدلية من خلال الاختلاف الموضوعى المقيس بمقاييس النمو والتكيف والإنجاز معا.
هذا ما أعلنه صاحبنا بصريح العبارة هكذا:
(8)
قام صاحبْنَا إِنْقَمَصْ، بسْْ ابْتَسَمْ.
قالْْ عليكْ نور يا معلم،
”بسّ انا مش ناوى اسلِّم”
قال لـِنَفْسُهْ: مشْْ حاشوفْ غير اللِّى انا قادر أشوفه.
هيـّا لعبهْْ؟
هوه عايزنى أكون من صنع إيده؟
واللى بيْقُولُهْ، أعيدُهْْْ؟
إنما بعيدْ عن شوارْبُـهْ،
مشْ مِصاحْبُهْ.
حا نزل اتدبّر شُؤونى
وسط هيصهْ الناس حاَضِيـعْ.
لما أصِيعْْ،
زنقة الستات ألذْ.
مالِحقيقه اللى تهزْْ.
بس ياخْسَاره مانيش راجل يِسـدْ،
والنِّسـَا واخداها جَدّ.
الاحتجاج هنا والمقاومة يعلنهما “داخل” صاحبنا، وليس ظاهره، كما أشرنا سالفا، وحين تـُـرفض علاقة الاعتمادية العلاجية بهذا الوضوح، سواء بسبب لاجدواها، أو بسبب تناقضها مع قيم هذا النوع من العلاج وأهدافه، تتجلى فى داخل المريض بدائل استسهالية ليس فيها مخاطر الرؤية، ولا أشواك العلاقة الموضوعية، ومن أهمها الاعتماد على المواد أو الاكتفاء بالجنس المنشق، وهذه البدائل الهروبية لا ينبغى الحكم عليها بأحكام أخلاقية أو دينية ابتداء، وإنما بمدى سلبيتها أو إيجابيتها على مسيرة النمو، فقد يكون فى مثل هذا الاستسهال تنازل عن الهوية الحقيقية بقبول الضياع وسط كتلة الناس الممتزجة “وسط هيصة الناس حاضيع لما اصيع”.
مثل هذه الحلول الواردة على لسان حال صاحبنا ليست بالضرورة سلبية على طول الخط، حسب الثقافة التى تتم فيها، وحسب العائد منها على المشاركين فيها، وعلى المجتمع الأوسع، فى ثقافتنا هنا، الأرجح أنه يتم استعمال المرأة بشكل يخلو من العدل نظرا لظروفها الأكثر انسحاقا، تاريخا وحاضرا.
صاحبنا هنا يأمل أن يجد مَنْ تقبله هكذا مستسهلا، أو حتى مُستعمِلاً، لكن يبدو أنه حتى هذا ليس متاحا لمثل هذا الشخصيات الاعتمادية المرتعدة، وها هو داخله يعلنه أنه لن تتحقق ذاته، ولا حتى لذته، وهو بهذه الصفات، لأن المرأة التى يمكن أن تمارس علاقة حقيقية، لا تريد هذا النوع من الاعتماد من ناحية، ولا تستطيع أن تملأ احتياجا مثقوبا هكذا، من ناحية أخرى.
المقطع التالى يعلن أن هذا الحل “الدون جواني” هو فاشل أيضا لأن صاحبنا (وأمثاله) ليس حتى دون جوانا.
كثيرا ما ينخدع الناس فى مثل هذه التصرفات الدون جوانية وكأنها تصرفات ناجحة مثرية، إلا أنى فى خبرتى المهنية على الأقل، كنت أتبين من خلال معلومات متراكمة أن كثيرا من هؤلاء الذين يلجأون إلى هذه الوسائل لتأكيد الذات، كثير منهم يعانى من ضعف جنسى إن عاجلا أو آجلا بشكل أو بآخر، وتفسير ذلك عندى أن هذه المحاولات الدون جوانية تتم بشكل نكوصى منشق (وليس نكوصا واعيا) وبالتالى تأتى الإعاقة من جانب من النفس فى مواجهة الجانب الناكص على المستوى اللاشعورى، وكأن أحدهما يقول للآخر: إذا كنت نجحت فى الإغراء فسأُفْشِـلـك فى التواصل، ومن ثمَّ ستعرف ما هو الفشل الحقيقى، مع استمرار السعار وراء تعدد العلاقات، واستبدالها وتكرارها بلا جدوى.
ها هو المتن يعلن على لسان “داخل صاحبنا الناقد” احتمال فشل هذا الحل هكذا:
بس ياخْسَاره مانيش راجل يِسـدْ،
والنِّسـَا واخداها جَدّ
“النِّسَا عايزالْها راجل يِملى راسها،
مش يبيع روحه لِها علشان ما باسْها.
النِّسَا عايزهْ اللى عيبُه مش فى جيبه، وماشِى حالُهْ،
عايزهْ واحد يِنْتبه لِلِّى فى بالها، زى مايشوف ما فى بالُهْْ،
النِّسَا عايزهْْ اللى يعرف امتى بيقولْهَا “انّ لأَّه”،
أيوه “لأهَّ”، بس “لأهَّ” ليهَا بيهَا.
عايزهْ واحد تحِتويهْ، بس تضمن إنُّه قادرْ يِحتويَها.”
وانا مش قد الكلام ده!!
الاعتراف هنا صريح من جانب هذا “الداخل الناقد” برغم كل ظاهر اعتماديته، اعتراف بأن هذا الحل الذى لاح له فى البداية سوف يفشل أيضا، والمتن هنا يعبر عن أن العلاقة الحقيقية التى تبنى الطرفين، هى علاقة نـِـدّية بها من العدل والرؤية ما يؤكد أنها علاقة بين اثنين من جنس البشر، وليس بين مُلتهمٍ ومأدبة، ولا بين مستعملٍ وأداة، من هنا، وعلى لسان نفس الناقد الداخلى، وليس المعالج، ولا زملاء التجربة، يـُظهر المتن بوضوح فشل الهرب فى اللذة العاجلة بالمقارنة بحاجة مثل هذا الشخص وغيره لامرأة تقبل وتستطيع أن تمنحه الاعتراف، وليس مجرد اللذة والتفريغ، مثل هذه المرأة تريد شريكا يمثل لها آخر حقيقيا، بما يشمل تواصلا متعدد القنوات، من أول أن يملأ كل منهما وعى الآخر، “يملا راسها“، وليس من يذل نفسه طلبا لرضاها، أو رشوة للحصول عليها، أو يشتريها بما فى جيبه ليس إلا، وأيضا: تتعدد قنوات التواصل لتشمل الحدس المتبادل “عايزهْ واحد يِنْتبه لِلِّى فى بالها، زى مايشوف ما فى بالُه”.
وأيضا: صاحبنا ينبهه داخله إلى أن العدل المتبادل يسمح له أن يعترض على شريكته بأمانة موضوعية، وليس مجرد دفاعا عن النفس، فلا يتنازل عن حق الاعتراض المسئول لمجرد إرضائها، ويكون حق الاعتراض “إن لأه” متبادلا ومسئولا بقدر ما يعود عائده على دفع العلاقة أكثر فأكثر إلى علاقة إنسانية حقيقية،
النِّسَا عايزهْْ اللى يعرف امتى بيقولْهَا “انّ لأَّه”،
أيوه “لأهَّ”، بس “لأهَّ” ليهَا بيهَا.
وأخيرا، فيبدو أن داخل صاحبنا يعرف مدى بعده عن كل ما تتطلبه المرأة التى تجاوزت أن تكون مجرد جسم أنثوى منحشر فى “زنقة الستات”، بهذا الشكل، والمتن ينهى هذه الرؤية بإظهار أن العلاقة الحقيقية، سواء مع امرأة، أم فى العلاج الجمعى، وما شابه، هو تبادل الاحتواء لتعميق حركية “الدخول والخروج”، بديلا عن الالتهام، أو الاستعمال،
“عايزهْ واحد تحِتويهْ، بس تضمن إنُّه قادرْ يِحتويَها”.
يعود صاحبنا الذى نحمد له استمراره هكذا، ينتبه إلى أن هذا الوعى الناقد الذى كشف له شخصيا فشل مهاربه، هو ناتج من خبرته فى هذا النوع من العلاج، وبالتالى جعله كمن رقص على السلم، فلا هو أعمى تماما يمشى حاله مثل غيره، ولا هو يواصل رحلة النمو ويدفع ثمنها، حتى الحل الهروبى اللذّى الذى يبدو أنه أفشله قبل أن يبدأ، مع ملاحظة أن الإفشال لم يأتِ من نصائح المعالج، ولا من القياس على خبرة الذين يحاولون فى المجموعة، لكنه جاء من واقع رؤيته الأمينة، برغم أنها لم تنفعه حافزا لاستمرار تجربة نموه، فهى رؤية صادقة وكاملة، برغم أنها عاجزة، وذلك لأنها معقلنة تماما.
هل هذه الرؤية الناقدة دفعت صاحبنا، أو تدفع مثله، أن يواصل رحلة النمو الصعبة، من خلال المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والألم الواعد بالتجاوز؟ الإجابة هى أن الوعى المعقلن، حتى من داخل الداخل ناقدا قويا هكذا، ليس كافيا – عادة – للتغلب على مثل هذه المقاومة القوية.
وها هو صاحبنا يعلن أسفه أنه لم يستطع أن يتخلص مما وصله من رؤية، وفى نفس الوقت لم يستطع أن يكمل، فيروح يضع اللوم كل اللوم على من عرّضه لهذه الجرعة المفرطة، دون أن يتأكد من قدرته على تحملها، هذا هو ما تناولناه سابقا مكررا عن ضرورة ضبط الجرعة، ليس فقط جرعة العقاقير وتناسبها مع مسيرة النمو، وإنما أساسا جرعة الرؤية، وتناسبها مع الألم، والحركة.
نسمع عتاب صاحبنا الهجومى على المعالج، وهو محق فيه، برغم احتمال عدم موضوعيته:
(9)
كله منَّكْ يا مِعلمْ:
ليه تفتَّح عينىٍ وِتْوَرينى نَفْسى؟
ليه تلوَّح باللى عمره ما كانْ فِى نِفْسِى؟
واحده واحده، كُنت هَدِّى،
قبل ما تْحَنِّسْنِى، يعنى، بالحاجاتْ دِى.
ليه تخلِّى الأعمى يتلخبط ويرقص عالسلالم ؟
كنت سيبْنِى فى الطَّرَاوةْ، يعنى صاحى زى نايمْ.
داهية تلعنْ يوم مَا شُفتَكْ.
يوم ما فكرت استريحْ جُوّا خيمتكْ.
يوم ما جيتـْلَكْ تانى بعد ما كنت سبتكْْ.
يا معلّم: إما إنك تقبل الركاب جميعاً
اللى واقف، واللى قاعدْْ، واللى مِتشعبط كمان،
أو تحط اليافطةْْ تعلن فين خطوطْْ حَدّ الأمانْ.
كل واحد شاف كده غير اللى شايفُهْ،
يبقى يعرف إنه يمكن لسّه مِشْ قَدّ اللى عِرْفُهْ.
ثم نختم بشىء من الإعادة، وهى إعادة تتعلق بنفس القضية الخطيرة التى تبدأ بالتساؤل: إلى أى مدى يحق للمعالج أن يغير من نوع وجود المريض، وقيمه؟
إن احتجاج صاحبنا الأخير هذا هو إعلان من جانبه محذر رائع، الاختلاف حول هذه القضية شديد، وأغلب الآراء ترجح صراحة أنه ليس من حق المعالج أن يتدخل بأية صورة فى نوعية وجود آخر، أو منظومة قيمه، وبرغم أننى مع هذا الرأى ابتداء إلا أننى أعيد صياغة التعبير هكذا:
ليس من حق المعالج من حيث المبدأ أن يتدخل فى نوعية وجود آخر، أو منظومات قيم من يعالجه، أو نوع وعمق رؤيته بشكل مباشر، ولكن أيضا ليس مطلوبا منه أن يخفى عن مريضه نوع وجوده هو (وجود المعالج)، خاصة مع المريض الذهانى، فالأرجح أن هذا الأخير سوف يلتقط منه ما يشاء دون إذنه، وعلى ذلك: فكلما كان التدخل واعيا كان آمن وأكثر انضباطا.
وأضيف: إن الحديث عن المعالج والعلاج يختص بدائرة محدودة فى المجتمع، وإن الذى قد يسمح للمعالج بهذا التدخل الواعى المسئول هو عاملان أساسيان:
أولا: وجود أعراض ضاق بها المريض وبالتالى فهو ساع إلى التغيير ابتداء.
ثانيا: حضور المريض باختياره النسبى للعلاج، ثم تأكيد حضوره هذا بانتظامه فى الحضور برغم كل شىء.
إذا ما توفر أحد هذين الشرطين فهو اعتراف ضمنى بأن المريض يوافق على تغيير ما، والمعالج عادة – كما تبينت أثناء خبرتى – يعرض تغييرين:
أحدهما تغيير على مسار النمو والتطور (وعليه أن يكون ناجحا شخصيا فى ممارسة هذا السبيل ولو جزئيا، وإلا فالخدعة أخطر من كل تصور)، فهو يقف مع هذا التغيير ويساهم بالمشاركة فى استمراره، وهو يشير ضمنا، من واقع ممارسته إلى نتائجه.
أما التغيير الآخر الذى يعرضه المعالج – بطريق غير مباشر – فهو تعديل ما استجد من أحوال مرضية (أعراض وإعاقة) بالرجوع إلى نوع الوجود القديم شريطة اختفاء الأعراض والاستمرار فى الأداء على أرض الواقع.
على المعالج أن يترك المريض يلجأ إلى هذا التغيير الأخير بنفسه – وربما ضد محاولات دفعه لمواصلة النمو – حتى يتحمل مسئولية نتائجه، أما الذى ينبغى أن يرفضه المعالج فهو الحل الوسط المائع المتذبذب فى صورة استمرار الأعراض أو استمرار الاعتمادية أو استمرار الخداع “بالرقص على السلم” بين الاختيارات المطروحة.
الخلاصة:
نستنج من كل هذا أن المطلب الذى انتهى به المتن على لسان صاحبنا المحتج، هو مطلب حر فى ظاهره، لكنه تبريرى سلبى فى نهاية الأمر، لأنه لم يدفع المريض للانسحاب من الخبرة، وتحمل مسئولية ذلك.
صاحبنا هنا يتمنى – ويطلب ويعمل على – أن يوقف المسيرة، لكنه يفتح الباب بأمانة شديدة، لاحتمال استمرار النمو إذا أحسن ضبط الجرعات جميعا، وتناسب البصيرة، مع الألم، مع الحركة، مع المواكبة، مع النمو.
يا معلّم: إما إنك تقبل الركاب جميعاً
اللى واقف، واللى قاعدْْ، واللى مِتشعبط كمان،
أو تحط اليافطةْْ تعلن فين خطوطْْ حَدّ الأمانْ.
كل واحد شاف كده غير اللى شايفُهْ،
يبقى يعرف إنه يمكن لسّه مِشْ قَدّ اللى عِرْفُهْ.
****
وأخيرا هاكم المتن مكتملاً:
(1)
والعيون التـَّانـْيـَه دى بتقول كلامْ،
زى تخاريف الصيامْْ؛
الصيام عن نبضِة الأَلـَم اللى تِـبْنى،
الصياْم عن أىَّ شئ فيه المُـغـامْـرَهْْ،
الصيام عن إن لازم كل بـنِـى آدم يـِفَتّح،
مش يتنَّـح
الصيام عن أى حاجة فيها إنى: عايز أكونْْ:
زىّ خلقةْْ ربنا”
(2)
العيون دى صرّحت إنِّ صاحبنا
عمره ما حايعلن يسيبنا
بس شرطه يَتّنه نايمْ فى العسل، عمال بيحلَم،
بَسْ عامل نفسه بيحاول، ويتكلمْ، ويحكُـمْ،
شرطِ إنه لمْ يـِـخـَـطـىِّ أو يِسلّـمْ
مشْ على بالُه اللى جارِى،
”كل همّه، يستخبَّى أو يدارى”.
وان وَصلُّه، غَصْب عَنُّهْ
يترمى سْطيحَهْ ويُطْلُبْ حتّه مـِنُّـهْ:
شرط إنه يجيله فى البزازة دافْيَةْ، جَنْب فُمُّهْ.
(3)
كان صاحبنا حلو خالص فى الكلام
كان بيتفرج، وهوه بعيد تمام،
كل ما نديله حتـّه، يترسم ويقول كمان.
عايز أخطى، بس شرطى، فى الأمان
كان مركـِّـز عاللى كان واخد عليه
لما كان بيحكَّى للى شافُهْ “بيهْ”:
كلٌّه “مين”، و”زمان” و”ليه”!!
بس ده ياناسْ لقاهـَا حكاية تانية ـ
يعنى شغل “هنا” و “حالا” كل ثانية
كل ما واحد يهمّ
نفسه يعنى يهم زيّه، بس لأْ، من غير ألمْ !!
يقلب الخبرة مشاهدهْ كإنه فيلمْ:
قالُّهْ سمَّعْنَا كمان حبّةْ نغَمْ:
كِيدِ العدَا،
يا سلامْ!! هوا جوّاك كلّ دا!؟
أنا نِفْسِى ابقَى كده؟
بس حبُّونِى كمانْ.
حُط حتَّهْ عالميزان.
أصلِى متعَّود زمانْ:
إنى انام شبعان كلامْ.
“قام صاحبنا بانْ كإنه مشْ مِمَانـِعْ،
بس قاعد ينتظر “بِنجِ اللذاذة”،
كـلّه دايب فى الإزازة”.
(4)
”يا أخينا مِدّ إيدك
يا أخينا هِـمّ حبَّـهْ.
الحكاية مِش وِكالة بْتَشتِرِى منها المَحَبّةْ”.
قام صاحبنا بانْ كإنه مشْ مِمَانـِعْ،
بس قاعد ينتظر “بِنجِ اللذاذة”
كـلّه دايب فى الإزازة
رضعة الحب اللى جىّ جاهز ودافى
رضعه كامـِلـَةْ إلدّسم، سـُكـّـرها وافى !!
(5)
والمعلّم صْبُرهْ بحباله الطويلةْْ،
قال “لابد أشوفْ لُه حيلهْ”:
قال لـه يا ابنى تعالى جنبى
إنت تطلب، وانا الـــَــبّى،
راح صاحبنا معرّى جوعه، نطّ كل اللى مْدَارِيهْ
عرضحال كاتب جميع ما نـِفـْسُه فيه:
“.. بعد موفور السلامْ،
نِفْسِى حبِّةْ حُبْ، أو حتِّةْ حقيقهْ،
نفسى أشارك فى اللى جارى ولو دقيقهْ،
نفسى أعرف فى اللى بتقولوا عليهْ،
نفسى اشوف دا إسمه إيه”
(6)
المعلّم قالّه: “ماشى، يالله بينا”
يالله بينا!!! يالله بينا؟ على فين؟
دانا مستنى سعادتكْْ.
روح وهاتْْ لى زى عادتكْ.
أى حاجة فيها لذّة،
الكلام الحلو، والمنزول، ومزّة.
أنا أحكى، وانت تتصرف براحتكْْ.
أنا تعجبنى صراحتك،
إٍوعَى تزعلْ منّى: دنَا عيّل باريّل،
لسَّه عندى كلام كتير أنا نفسى اقولهْْ،
عايِز اوْصف فى مشاعرى وإٍحساساتى،
واقعد اوصفها سنين،
مش حا بَطّلْ، خايف ابطّلْ،
لو أبطّل وصف فى الإحساسْ حَاحِسّ،
وانا مِش قد الكلام دهْ.
(7)
المعلم قالُّه: شوفْ لَكْ حد غيرى،
جَنْبِنَا دكّانة تانيةْ،
فيها “بيتزا” مِالّلى هيَّهْْ،
أو “لازانْيَا”.
فيها برضكْ وصفهْ تشفى مالعُقدْ،
إسمها “سيبِ البلد”.
فيها توليفةْ حبوب من شغل برّة.
تمنع التكْشيرهْ، والتفكيرْ، وْتمِلاكْ بالمسرّة.
فيها حقنةْ تخلِّى بَالَكْ مِستريـَّـحْ.
تِنتشِى وْتفـضَلْ مِتَنَّحْ.
فيها سرّّ ما يِتْنِسِيشْ.
لِلـِّى “مِشَ عايز يــعـــيش”!!
(8)
قام صاحبْنَا إِتقَمَصْ، بسْْ ابْتَسَمْ.
قالْْ عليكْ نور يا معلم،
”بسّ انا مش ناوى اسلِّم”
قال لـِنَفْسُهْ: مشْْ حاشوفْ غير اللِّى انا قادر أشوفه.
هيـّا لعبهْْ؟
هوه عايزنى أكون من صنع إيده؟
واللى بيْقُولُهْ، أعيدُهْْْ؟
إنما بعيدْ عن شوارْبُـهْ،
مشْ مِصاحْبُهْ.
حا نزل اتدبّر شُؤونى
وسط هيصةْْ الناس حاَضِيـعْ.
لما أصِيعْْ،
زنقة الستات ألذْ.
مالِحقيقه اللى تهزْْ.
بس ياخْسَاره مانيش راجل يِسـدْ،
والنِّسـَا واخداها جَدّ.
“النِّسَا عايزالْها راجل يِملى راسها،
مش يبيع روحه لِها علشان ما باسْها.
النِّسَا عايزهْ اللى عيبُه مش فى جيبه، وماشِى حالُهْ،
عايزهْ واحد يِنْتبه لِلِّى فى بالها، زى مايشوف ما فى بالُهْْ،
النِّسَا عايزهْْ اللى يعرف امتى بيقولْهَا “انّ لأَّه”،
أيوه “لأهَّ”، بس “لأهَّ” ليهَا بيهَا.
عايزهْ واحد تحِتويهْ، بس تضمن إنُّه قادرْ يِحتويَها.”
وانا مش قد الكلام ده!!
(9)
كله منَّكْ يا مِعلمْ:
ليه تفتَّح عينىٍ وِتْوَرينى نَفْسى؟
ليه تلوَّح باللى عمره ما كانْ فِى نِفْسِى؟
واحده واحده، كُنت هَدِّى،
قبل ما تْحَنِّسْنِى، يعنى، بالحاجاتْ دِى.
ليه تخلِّى الأعمى يتلخبط ويرقص عالسلالم ؟
كنت سيبْنِى فى الطَّرَاوةْ، يعنى صاحى زى نايمْ.
داهية تلعنْ يوم مَا شُفتَكْ.
يوم ما فكرت استريحْ جُوّا خيمتكْ.
يوم ما جيتـْلَكْ تانى بعد ما كنت سبتكْْ.
يا معلّم: إما إنك تقبل الركاب جميعاً
اللى واقف، واللى قاعدْْ، واللى مِتشعبط كمان،
أو تحط اليافطةْْ تعلن فين خطوطْْ حَدّ الأمانْ.
كل واحد شاف كده غير اللى شايفُهْ،
يبقى يعرف إنه يمكن لسّه مِشْ قَدّ اللى عِرْفُهْ.
اللوحة التاسعة:
نيجاتيف
هذه الحالة (مرة أخرى: التى هى ليست حالة مريض ولا شخص بذاته) تصف ظاهرة بشرية معاصرة لما يحدث للإنسان المعاصر من اغتراب حتى لا يعود إلا ظل كيان خال من المعالم، مجرد رقم مفرغ من وجوده الذاتى تماما، (كأنه هو)، مشروعا لم يكتمل “زى نيجاتيف صورة مش متحمضة”.
هى تشكيل لموقف “متفرج يائس عنيد”، أعدم أية بارقة أمل من هول الألم، واكتفى برؤية ورصد بشاعة وجودة الممثل لما يراه الوجود العصرى الغالب فى مرحلة الإنسان الحالية، حين يعجز أن يحوّل الألم إلى طاقة تدفعه لمواصلة التحدى.
الكلام الذى وصلنى من هذه العيون كان على لسان حال صاحب الصورة نفسه، كما هو الأمر فى معظم المتن.
صاحبنا يعرى هذا الموقف الاغترابى بشجاعة، وهو يعلن بكل وضوح أن الألم الساحق يمحق الوجود البشرى النابض ويقلبه شبحا بلا حضور، ثم هو ينسحب إثر ذلك رافضا أى مزيد من المواجهة أو التعرية، فلم تعد ثمة مساحة لتحمل ألم جديد، شجاعته فى آخر جولة قبل إعلان الهزيمة هى أنه قادر على إعلان موقفه الرافض لأية حركة تلوّح بحتمية مزيد من تحمل الحقيقة العارية للانطلاق منها، ولذلك فهو يبحث عن وسيلة (آلية = ميكانزم) يعمى بها من جديد، وينبه الذين لم يخوضوا التجربة حتى النخاع مثله، أن يبتعدوا عنه، حتى لا يسدوا عليه سبل هربه الذى لم يعد أمامه إلا أن يلجأ إليه تجنبا لمزيد من الرؤية، أى مزيد من الألم:
راح اسيبكم تحلموا
آنا من كتر الألم بطلت حِلم.
صرت حِلم.
صرت نيجاتيف صورة مش متحمَّضَه.
بكره حَاتحمَّضْ فى أُوضه مُظلمهْْ.
اسمها أُودةْ العَمَى.
ليه بِتيِجُوا تْنَوَّرُوهَا بالحقيقةْْ.
حاكِمِ النُّوْر– ما انت عارف –
بَوّظ التحميض ياعمْْ.
الحلم هنا يشير إلى معنى آخر، غير معنى حلم الليل أثناء النوم، هو ظل الشخص أو صورته المسطحة التى تحل محله، برغم أنها تحمل اسمه، ويا ليتها صورة، بل هى “نيجاتيف” هذه الصورة، ويا ليته “نيجاتيف” يكتسب مشروعيته من أنه قابل للتحميض ليصبح صورة، بل هو مشروع مجهض من فرط التعرية بلا حركية مجرد ظل باهت يحل محله. إن المطروح الوحيد على أى منا، إذا أفرغوه، أو أفرغ نفسه من ذاته، هو أن يستمر “كأنه هو”، فى حين أنه غير موجود أصلا، وكلما همَّ أن يحقق بعض “ما هو” بمزيد من البحث والرؤية، لحقه ألم المواجهة ساحقا حتى يفسد المحاولة، التى تشلها شدة جرعة الرؤية الصارخة
“حاكم النور – مانت عارف – بوّظ التحميض يا عم”.
قمة هذا النوع من اليأس هو الموقف العدمى المشوِّه حين يصبح الوجود مجرد “عفريته” لإمكانية وجود لا يتحقق، ما يحدث هو أقرب إلى صورة نفسه المشوهة([28])،
بألفاظ أخرى: هذه إشارة إلى أن الذات الداخلية، إذا بلغت درجة بشعة من التشويه من فرط ما لحقها من إنكار، وإلغاء، وإهمال، وإيلام، وسحق، لا يكون هناك حل إلا إخفاءها تماما بميكانزمات شديدة التغطية،
“بكره حاتحمض فى أوضه” مظلمة، إسمها أوضة العمى“
الذى يخفى صورة النفس المشوهة هى الحيل الدفاعية (العمى)، وحين تتراجع هذه الحيل أو تضمحل وفى نفس الوقت تشتد البصيرة يعجز الإنسان عن أن يخفى على نفسه هذا الإدراك المؤلم، وفى نفس الوقت يعجز أن يعيش مجرد صورة – مثل سائر الناس – وليس كيانا حيا متطورا.
والآن نقرأ نصف المتن على بعضه:
(1)
والعيون دى رخره واضحه مصمِّمةْ؛
بالصِّراحةْ والشجاعةْْ تقول بصدق:
راح اسيبكُمْْ تحلمُوا.
(2)
”إقفل الباب وانت خارج”.
هوّا ده شرط الحياة اللى احنا عايشنها النهارده.
إٍما تحلم، وانتََ قاعِدْ، فى العَصَارِى، أو حوالين الشوالى،
وِسْط ناسْ مُغمى عليها من حلاوة الحلم أَوْ مِنْ ظَبطْ معيارْ المزاج.
إٍما تحلم من هنا للصبح أو:
أَوْ تصير الحلم نفسه.
مرة أخرى: هو يضع اختيارين سلبيين:
-
إما مشاركة الأغلبية العمى والضياع والاغتراب، والتخدير الجماعى.
-
وإما الاستسلام لوجود زائف “أوتصير الحلم نفسه”، تصير الحلم بالمعنى الذى أشرنا إليه أعلاه.
والمتن يفرق بعد ذلك بوضوح بين هذا الحلم الشبح (النيجاتيف) كما يصفه، وبين الحلم الذى هو أمل أن نعيش كما خُلقنا دون تشويه، الذى يقوله الجزء الثانى من القصيدة أننا نتربى على أن تحقيق حلمنا المشروع – أن نكون بشرا كما خلقنا الله – يكاد يكون هو المستحيل نفسه.
أى أنه: حين حيل بيننا وبين أن نكون أنفسنا، أن نواصل تحقيق أسطورتنا الذاتية، لم يعد أمامنا إلا الاستسلام بأن نلغى وجودنا لنصبح هذا الحلم الشبح نيجاتيف الصورة، وهذا ما يعنيه المتن:
(3)
ما هو مش ممكن يا عَالَم غير كِدَهْْْ!
لَماّ قالو “الحلم دُكههْ” مستحيل يبقى حقيقهْْ،
يبقى لازم: إلحقيقة تبقى حلمْ
تبقى نيجاتيف صورة مش متحَّمضَهْ،
حتى لو حمّضتها آهى بَرْضُه صورةْ،
مش حقيقه.
برغم أن هذه اللوحة لا تصف حالة فصام بالذات، إلا أننا نتعلم من الفصام جذور وأصول إشكالة الإمراضية داخلنا، هذه الرؤية تعتبر تمهيدا لإمراضية الفصام مع أنها يمكن أن تكون عامة وكامنة عند الأسوياء.
يقول “شولمان”([29]) فى كتابه “مقالات عن الفصام”: إن مشكلة الفصامى هى أنه يسعى إلى المثالية المطلقة، ويصر على تحقيق التكامل الإنسانى التام، وإذا به يجد الطريق إلى ذلك مستحيلا، وليس مجرد شاق، “بعكس الثائر الذى يصر على تحقيق نفس الحلم ولكن بأسلوب واقعى متدرج”.
وأضيف من واقع المتن هنا:
إن الإنسان (وليس بالضرورة الفصامى) الذى يواجَهُ باستحالة تحقيق هذا التكامل الإنسانى المثالى المطلق، الذى لا يقبل فكرة التدرج المتناغم المضطرد على مسار نبض النمو المتزايد، إنما هو يسارع بتشويه وجوده بأن يسقط أبشع ما فيه على العالم. ثم هو لا يستقبل إلا هذه البشاعة المشوهة حتى دون اللجوء إلى الحيل الدفاعية التى تخفى هذه الرؤية المزعجة، وهو بذلك يكتفى بهذه الوقفة فى موقف ذى البصيرة المستقلة الحادة المخترقة، وفى نفس الوقت العاجزة اليائسة، وهى التى برغم أنها لا تنطفئ بسهولة، لا تدفع لعمل أى شىء نحو التغيير، هذا الإنسان لا يقبل أن يعيش الحياة العادية بصورة جيدة، مقبولة والسلام، لكنها ليست الحقيقية، وفى نفس الوقت هو لا يستطيع أن يتكامل مطلقا وأبدا، فلا يتبقى له إلا وجود شائه، يمثل جزءا من الحقيقة ولكن بلا فاعلية .
استرجاع جزء محذوف
حين انتهيت من شرح هذا المتن الآن، افتقدت فقرة أخيرة كان لى بها علاقة طيبة، وفيها ذكر لمُثُلِ أفلاطون، وعالمه المثالى وكلام من هذا، وتصورت أنها سقطت سهوا من سكرتاريتى، طحت فيهم لوما وتأنييبا، وإذا بهم يذكرونى أننى أثناء مراجعتى متن الديوان استعدادا لنشره فى طبعة ثانية، قمت بحذف هذه الفقرة بنفسى، فتذكرت، وتساءلت، لماذا يا ترى حذفتها، ثم عادت تحضرنى الآن بهذه الحميمية، فكتبتها من ذاكرتى، وهاهى ذى:
صبّحك بالخير يا عمى أفلاطون
لما قلت ان السرير:
هوا أصله مش سرير
دا بس صورة
والبنى آدم كمانِ لـِـيّام دَهِهْ
برضه صورهْ
…..
بس وكفاية كده!
هيه سورة؟!!!
الآن فهمت، لقد اكتشفت أنها أقل شاعرية، وكأنها مناقشة نظرية فلسفية بشكل مسطح، وأن الشطر النهائى سخيف، ويبدو أنه حضرنى لمجرد أن أقفل التشكيل عند هذا الحد، “بس وكفاية كده”، وحين عادت هذه الفقرة الآن بشاعريتها الضعيفة، وقفلتها السخيفة، وجدت أن بها ما يضيف إلى ما أريد قوله وتوصيله كالتالى:
من قديم وأنا لم أقبل أبدا قبل أن أكتب هذا النص الشعرى ما وصفه أفلاطون بعالم المـُثـُل، وأذكر أننى رفضته من حيث المبدأ حين قرأته لأول مرة.
ثم إننى حين اشتغلت بعمق فى موضوع “الإدراك” ومحاولة تفسير الهلوسة بوجه خاص، وصلت إلى مايلى:
(1) بدأت أتبين أكثر فأكثر أبعاد التمييز بين الموضوع الحقيقى Real Object، والموضوع الذاتى Self Object، وأننا نبدأ فى التعرف على ما فى العالم فى هذه الدنيا من خلال إسقاطاتنا، أى أننا نبدأ بإدراك الموضوع (الآخر – الأشياء) على أنه موضوع ذاتى، أى أننا نرى الأشياء كما نريد أن نراها، وليست كما هى.
(2) ثم مع تواصل النضج، يتراجع الإسقاط ويتواصل اضطراد إدراكنا للموضوع على أنه أكثر موضوعية = “موضوع حقيقى” Real Object.
(3) هذا ما فهمته من دعوة السيد البدوى([30]) “اللهم أرنى الأمور كما هى”، ويتم الانتقال من استقبال الموضوع على أنه موضوع ذاتى إلى موضوع حقيقى ليس فقط على مسار النضج العادى الذى يتواصل أو لا يتواصل، وإنما يبدو أنه هو أيضا آلية رحلة الكدح إلى التناغم مع الوعى المطلق، إلى وجه الحق تعالى، أو لعلهما واحد.
(4) إذن يمكن القول إن المسألة هى عملية متصلة، مدى حياتنا المحدودة، تبدأ من إدراكنا الأمور بما هو داخلنا، وتنتهى (حقيقة الأمر أنها لا تنتهى، وإنما تستمر نحو…) أن نرى “الأمور كما هى”.
(5) أعتقد الآن أن أفلاطون حين أدرك أن رؤية الأمور، والأشياء، والناس، والموضوعات “كما هى” مستحيلة، اعتبرها كيانات مجردة ثابتة بعيدة فى عالم “الماوراء” الذى أطلق عليه عالم المثل.
“أفلاطون، يقول إن الذي نراه من هذا العالم الذي نلمسه، ونختبره من خلال الحواس هو عالم غير حقيقي، بل هو عالم مشابه أو مستنستخ من العالم الحقيقي بصورة غير كاملة. إذن عالمنا ليس عالما حقيقيا لكنه عالم مبصومة أو مطبوعة عليه فكرة الحقيقة. لذلك يقول أفلاطون: إن معرفتنا عن الحقيقة هي كمعرفة الجالسين في الكهف أمام النار ويرون ظلال أشخاص يمرون من خلفهم على جدار الكهف، لذلك فالعالم المادي هو غير كامل، بل هو عالم النقص، إذا ما قورن بعالم المثل أو العالم الحقيقى.
(6) ثم إنى عدت أقرأ فكر أفلاطون من منطلق بيولوجى فاستطعت أن أترجمه إلى فكر تطورى نمائى بشكل أو بآخر، فأُنزل المثُل التى زعم أوليتها وأصالتها من سمائها إلى أنها مجرد “الموضوع الحقيقى” الذى نأمل أن نراه (ندركه) كما هو، وجعلت الصورة التى زعم أنها مجرد طبعة مستنسخة من الأصل المثال لتظهر لنا تقليدا للأصل فى العالم المادى، رأيتها أنها تقابل ما نسميه الآن “الموضوع الذاتى”، أى ما نبدأ به إدراكنا للأشياء من خلال إسقاطاتنا التى تتراجع بانتظام مع تراجع آليات (ميكانزمات) دفاعاتنا، فيقل الإسقاط باستمرار، لحساب أن يتجلى الموضوع الحقيقى “هنا والآن” بالتدريج وحسب درجة النمو، وهكذا نأمل طول الوقت، عن طريق التطور والنمو، عبر اضطراد التطور الذاتى، أن نرى الأمور كما هى.
(7) ثم إن قراءتى مؤخراً فيما يستحدث فى النيوربيولوجى وبعض الفروض المخترقة([31])، وأن المخ يلتقط موضوعاته من خارجه مثل التليفزيون ولا يستدعيها من تركيبة مثل شريط التسجيل، كل ذلك جعلنى أعود لقبول أفلاطون بشكل أو بآخر وبالتالى لقبول ايحاءات هذه الصورة الشعرية.
(8) وأخيرا، فنحن إذا افترضنا أن نفس العملية التى تتم بالنسبة لإدراك الخارج واستحالة إتمامها حتى نهايتها فى خلال حياتنا الفردية بهذا التدرج، فإن الأمر قد يسير على نفس الدرب وبنفس الآلية بالنسبْة للمواضيع الداخلية (داخلنا) وفرص إدراكها بواسطة “العين الداخلية”، وهو الفرض الأساسى الذى أصبحت أفسر به الهلوسة (وغيرها مما يوازيها من أعراض ([32]) مما يوازيها من أعراض باعتبارها نوعا من إدراك موضوعات الداخل.
(9) الأرجح أننا ندرك دواخلنا على مسار متدرج أيضا من “الموضوع الداخلى الذاتى، إلى الموضوع الداخلى الحقيقى“، وبالتالى، نحن معرضون لخبرة رؤية حقيقة داخلنا مرحلة فمرحلة، حسب كدح النمو، وتناسب المسئولية، فإذا اختل هذا التناسب يبدأ التخوف والتحذير واحتمال المفاجآت (كما ظهر فى المتن والشرح).
(10) وهكذا يمكن إدراك ما جاء بالمتن، وكيف يتوقف الإنسان من فرط الألم عن مسيرة الكشف، ثم يرضى أن يكون معكوسا “يشبه الإنسان”، “نيجاتيف” غير قابل للتحميض أصلا، وفى نفس الوقت، يظل محتفظا ببصيرته الحادة بهذه الإضاءة الكاشفة حتى ولو يكمل ما يترتب عليها.
والبنى آدم كمان ليام دهه، هوه صورة”
وإليكم القصيدة مكتملة:
(1)
والعيون دى رخره واضحه مصمِّمةْ؛
بالصِّراحةْ والشجاعةْْ تقول بصدق:
راح اسيبكُمْْ تحلمُوا.
آنا من كتر الألم بطلت حِلم.
صرت حِلم.
صرت نيجاتيف صورة مش متحمَّضَه.
بكره حَاتحمَّضْ فى أُوضه مُظلمهْْ.
اسمها أُودةْ العَمَى.
ليه بِتيِجُوا تْنَوَّرُوهَا بالحقيقةْْ.
حاكِمِ النُّوْر– ما انت عارف –
بَوّظ التحميض ياعمْْ.
(2)
”إقفل الباب وانت خارج”.
هوّا ده شرط الحياة اللى احنا عايشنها النهارده.
إٍما تحلم، وانتََ قاعِدْ، فى العَصَارِى، أو حوالين الشوالى،
وِسْط ناسْ مُغمى عليها من حلاوة الحلم أَوْ مِنْ ظَبطْ معيارْ المزاج.
إٍما تحلم من هنا للصبح أو:
أَوْ تصير الحلم نفسه.
(3)
ما هو مش ممكن يا عَالَم غير كِدَهْْْ!
لَماّ قالو “الحلم دُكههْ” مستحيل يبقى حقيقهْْ،
يبقى لو إن إلحقيقة تبقى حلمْ
تبقى نيجاتيف صورة مش متحَّمضَهْ،
حتى لو حمّضتها آهى بَرْضُه صورةْ،
مش حقيقه.
(ولم أضف الفقرة التى استرجعتها للشرح دون المتن)
اللوحة العاشرة:
الترعة سابت فى الغيطان
“الرىّ “بالراحة”، هو تعبير من بلدنا، وهو ذلك النوع من الرى الذى لا تستعمل فيه أية آلة (ولا حتى الطنبور أو الحلزونة). لا يمكن الرى بهذه الراحة إلا حين يكون مستوى الماء فى الترعة أعلى من مستوى الأرض، ويكفى الفلاح أن “يقطع” مدخل المياه من الترعة فتنساب المياه إلى الأرض “بالراحة”.
كانت هذه اللوحة التشكيلية، لصاحبة هذه العيون – كما تخيلها شعرى– تملك هذه القدرة التى تسمح بأن ينساب نهر حنانها وحبها وطيبتها إلى كل من يطلب منها “شفطة” مياه، سواء كان عطشانا، أم كان يرى هذه السيدة الكريمة سبيلا من حقه أن يأخذ منه نصيبه “بالراحة”، وكانت هى تكاد لا تمانع بنفس السهولة والكرم، وحين هممت أن أتقمص بعض الجارى، اكتشفت التناقض بين ما دار بخلدى، وبين ما أنا أنبح صوتى به ليل نهار لأبين صعوبة العلاقات البشرية، وأظهر مدى التناقضات الشائكة والمحيِّرة، التى تحفز إلى المثابرة المستمرة، حتى تتحول أسهم المواجهة المتصادمة فى التواصل البشرى إلى حركية الجدل فالنمو المتجدد.
كنت أتعجب من صاحبة هذه العيون التى لا تضع شروطا ولا مواصفات لمن تغرقه بمياه حنانها وغمر دفئها. ما هذا الذى تمنحه هذه السيدة الفاضلة؟ هل هو الحب الذى نتحدث عنه أم شىء آخر؟
ملأنى العجب وأنا أصف الجارى (أو المتخيل):
(1)
والنظره دى رخْرَهْ عجب.
ماباشوفشى فيها إلا شئ كما الحنان.
لا لُهْ شروط ولا سبب.
وأقول لنفسى يا ترى:
هوّا حنان الدنيا كله اتجمّع الليله هنا؟
عمال بِيْغمُرْنَا كَدِه من غيرْْ حِسَابْ،
كَمَا تِرعَه سابـِتْ فى الغيطانْْ،
إللى بطونها اتْشَقَّقِتِ
الحاجة إلى الحنان حاجة ملحة وشاملة، وهى تحتد فى الحزين، والوحيد، والمنعزل، كما أنها تظهر تلقائيا مثلما تحتاج أى أرض إلى مياه الرى، كما أن هذه الحاجة تحتَد أكثر بعد توالى الإحباط، وعند شدة الاحتياج، كما أن كل هؤلاء، يعمون عادة عن إشكالة طبيعة هذا الحب السهل المنساب بلا حساب.
فى قريتى أيضا، تـُـترك الأرض مددا طويلة فى فصل الجفاف حتى تتشقق تماما جوعا إلى المياه، ويفيد هذا الجوع فى أن يعرض باطن الشقوق للهواء والشمس بدرجة تجعلها أكثر خصوبة وإثمارا، وحين يأتى وقت الرى بعد فترة معلومة، يقال إن الفلاح “يطفي الشراقى”، وهو تعبير مختلف عن “يروى الأرض”، لأنه فعلا يغمر هذه الأرض المتشققة من الجفاف، الملتهبة من التعرض للشمس المشتاقة إلى المياه، يطفئها غمرا بما يملأ شقوقها حتى تفيض، وتشبع، ويقال إن هذا الغمر يقوم بوظيفته التخصيبية استعدادا للزراعة المناسبة.
المقابل فى كرم طوفان حنان هذه السيدة – ومن تمثله – وصلنى من ملاحظتى أن الغالبية الغالبة تطلبه، وتسعى إليه، سواء فى الحياة، أو فى مقام العلاج النفسى، وأشرت أن هذا حقهم من حيث المبدأ، سواء كان طالب الارتواء: قلبا حزينا، أو قلبا وحيدا، أو قلبا جفّ وتقشف، أو قلبا مجروحا “من عمايل الناس”، أو قلبا متهالكا “متمهمطا” من كثرة القهر والتمزيق والإهانة والاستهانة، أو قلبا منبوذا موصوما بالتجاوز أو حتى بالهرطقة لمجرد أنه تجرأ على النظر فى المقدسات، أو نقد السلطة، أو قلبا مبدعا تجرأ فكشف عن جانب من الحقيقة فلم ينل إلا الرفض والنبذ، (كما سيرد فى المتن حالا).
كل هؤلاء يمثلون جمهور العطاشى الذين يتقبلون الغمر من مصدر المياه “بالراحة” بدون تمييز، وأيضا بلا صعوبة.
لكن هل يرتوون هكذا بدون جهد من جانبهم؟ بدون إسهامهم فى السعى إلى الرى؟ ناهيك عن تحمل أن تكون العلاقة متكافئة، والمسئولية مشتركة؟
فى كثير من الأحيان يأتى المريض طلبا للعلاج ليرتاح، ليعتمد، ليجد الحل جاهزا، والتفسير مقنعا، والعقدة لها من يحلها دون أن يشارك هو بالقدر الكافى فى ذلك، وقد يتحقق له ذلك، أو بعض ذلك فى بداية رحلة العلاج، أو مع تعاطى بعض المسكنات، أو المريّحات من عقاقير وسماح([33])، لكن العلاج الحقيقى، مثله مثل التربية والنمو فى أى مجال يتطلب غير ذلك، ويسرى فى طريق مختلف.
(2)
والمّيهْ بالراحةْ بتطفِى فى ”الشراقىِ”
مِنْ دُونْ ولاَ ساقيهْ تِنوُح،
ولا قادُوسْ ولا شَادُوفْْ.
المية تُغْمُرْ والحَنَانْ بِيْبَشْبِشِ القلب الحَزِيِنْ،
والقلب إللى مَالُوش حبيبْ،
والقلب إٍللى من عمايل الناسْ بقى حتِّةْ خشبْْ،
والقلب إٍللى اتمهمطت دقاته أصبح مثل كوره مْنِ الشراب،
تضربها رجلين العيال طول النهارْْ.
وانْْ جت على أْزاز ام هاشم يبقى يوم أزرق وطين،
يالـْـكـُـوره تتشرمط يا إِمّا ان العيال يتفركشوا.
حتى إٍذا ازازْْ “ام هاشم” ما اتْكَسَرِشْ.
مش صحت “الأسطى إٍمام” من غـفْلِتُهْ..!؟
”واللَّى يصحى الناس يانَاسْ أكبر غلط”!!!
هؤلاء العطاشى لا يرتوون عادة “بالراحة” لمجرد أن لهم حقهم فى الرى، قد يخدّرون أو يهدأون، لكن الارتواء شىء آخر، مع التأكيد أنهم عطاشى فعلا، بغير ذنب جنوه غالبا!! إذن ماذا؟
فى خبرتى، لاحظت أن هذا الحب السهل الجاهز، حتى مـِن معالج نفسى طيب، ليس هو الذى يـَلـْزَم المريض لينمو به ومن خلاله، هو حب أقرب إلى الفيض الذى لا يتوجه تحديدا إلى واحد بذاته، ليس بمعنى القدرة على الحب، ولكن بمعنى أن هذا الغامر بلا تمييز لا يحدد الفروق الفردية فى الذات المعنية (الموضوع)، موضوع الحب، بل إنه يغمر من يجده دون تفرقة: “من يعطش يشرب” (وخلاص)، فهل يا ترى هذا هو الحب الذى يميز الكائن البشرى بما سبق أن أشرنا إليه من أنه اكتسب الوعى، ثم الوعى بالوعى، ثم هو يثابر طول الوقت، ليميز الموضوع “كما هو”؟ هل هذا هو الحب الذى يحاول أن ينمو باضطراد حتى يقلب “الموضوع الذاتى” إلى “موضوع حقيقى” يسمح بعلاقة بشرية تليق بالبشر؟ هل لهذا الغمر دون تمييز ودون جهد عمر يسمح بتطوره، لنتغير من خلاله إلى ما هو أكثر مسئولية، وأقوى اقترابا من بعضنا، وأصعب أيضا؟
(3)
وارجَعْْ أشوف نهر الحنَانْ
ألقاه بيطفى فى الشراقى بْدون “أوان”
لكين الشراقى مَهْما شَّققْها الجفاف؛
الميه راح ترويها صُحْ،
لكنْْ كمانْ:
إن سابتْْ الميّه على العمَّالْ على البطَّالْ حاتغرق أرضنَا،
حتى لو الأرض شراقى مْـَشَقَّقَهْ،
ولاّ الزراعةْْ بدونْ أصُولْ؟
مش لازم الأرض تجف وتتعزق؟!
أو ضَرْبِةِِ المحراتْ تِشُقّ الأرض تقلبِ تبْرِهَا؟!
فى العلاج النفسى، مثلما هو الحال فى التربية والنمو والزراعة، يكون عامل التوقيت من أهم العوامل، إن لم يكن أهمها فى دفع النمو (والشفاء) فى مساره الطبيعي، لذلك، فإن كثيراً من التوصيات، والتوجيهات، والاستشارات، – أثناء الإشراف على هذا العلاج تنتهى ليس إلى أن علينا أن نفعل كذا أو كيت، بقدر ما تنتهى إلى “متى نفعل ما تقرر أن نفعله”، أى متى يكون القرار فاعلا، فيكون صوابا، ومتى يكون نفس القرار خطأ فى وقت آخر، وهكذا، أضف إلى ذلك عامل “الوقت” اللازم لسبك عملية النمو مع التذكرة بأن “الوقت” غير التوقيت.
لا يمكن أن يتم نمو بدون وقت، قفزات التغير لها دلالتها الرائعة، لكنها وحدها، بدون أن يتم الإعداد لها فى وقت كاف لإنضاجها، وبدون أن يلحقها بعدها فعل مناسب لاستثمارها، لا تدل على شىء إيجابى بالضرورة.
وارجَعْْ أشوف نهر الحنَانْ،
ألقاه بيطفى فى الشراقى بْدون “أوان” ،
بدون أوان هنا، إشارة إلى سوء التوقيت.
نتكلم دائما فى العلاج النفسى والتربية والنمو عن “الجرعة“، إضافة إلى التوقيت، إن ضبط جرعات الدعم المباشر، وجرعة المسافة، وجرعة النصح، لا يقل أهمية وحساسية عن ضبط جرعة الدواء، شعرت من هذه الخبرة أيضا أن فرط غمر الحنان هكذا قد يأتى بعكس الرى، وهو الغرق.
لكن الشراقى مَهْما شَّققْها الجفاف؛
الميه راح ترويها صُحْ،
لكنْْ كمانْ
إن سابتْْ الميّه على العمَّالْ على البطَّالْ حاتغرق أرضنَا،
حتى لو الأرض شراقى مْـَشَقَّقَهْ،
ولاّ الزراعةْْ بدونْ أصُولْ؟
أصول الزراعة، مثل أصول التربية، مثل أصول العلاج النفسى: لابد لها من الإعداد، والتدرج، وضبط جرعة المسافة المتغيرة، وتسميد الأرض مثل تسميد الوعى، ثم خذ عندك تقليب التربة، وتخطيط الخطوط، مثل تعتعة الوعى، ورسم المسار فى التربية والعلاج النفسى (وكذا الإبداع). إذن فالمسألة ليست غمرا بالحب والحنان والود والإراحة، بقدر ما هى تخطيط مناسب لحركية الوعى بمستوياته “معا”، وتحريك منضبط على مسار معَدّ، هذا ما يشير إليه المتن هكذا:
مش لازم الأرض تجف وتتعزق؟!
أو ضَرْبِةِِ المحراتْ تِشُقّ الأرض تقلبِ تبْرِهَا؟!
العلاج النفسى كما أشرنا، يحتاج – بالإضافة إلى عاملـْى الوقت والتوقيت الذى ذكرناهما حالا – إلى خطوات منظمة، وإلى ضبط العواطف وأحيانا منعها حتى تجف الأرض، ليس بالإهمال ولكن بالحساب، ثم إلى جرعات منظمة من الألم والعمل (العزيق) أو جرعات قاسية من الرؤية العميقة للوصول إلى الجوهر (ضربة المحراث تشق الأرض تقلب تبرها).
كما لاحظنا فى اللوحات السابقة، يتأكد هنا أيضا أن سوء فهم العلاج النفسى، يؤدى إلى فرط الاعتمادية، وانتظار الحل السحرى من المعالج، كما أن أغلب الناس، وبعض الأطباء والمعالجين، يتجنبون كل ما يؤلم المريض، ونحن نكرر باستمرار أنه لا يمكن عمل علاقة حقيقية بين البشر بدون صعوبة حقيقية، ولا يوجد نمو بدون ألم، ومع ذلك فإن الإعلام وبعض التربويين يبالغون فى التأكيد على التفويت، والإراحة، ويحتجـَّون احتجاجا قويا على أى ضغط، على طالب النصح، أو المريض، مثلما يحتجـَّون مؤخرا على صعوبة الامتحانات، وعلى صعوبة الالتزام، وعلى صعوبة انضباط المواعيد، كل ذلك هو ما كتبته فى المتن وأنا أصف موقف هذه السيدة الكريمة، وكأنها تتقطع شفقة على الأرض وسلاح المحراث يخترق طبقاتها، كما تخترق رؤية المعالج والمريض نفسه طبقات وعيه حين يكتسب البصيرة، تحتج هذه السيدة الكريمة فى المتن على أى احتمال شدة مهما كانت لازمة فيقول لسان حالها:
والنظره إللى بْتُغْمر الكونْْ بالحنانْ من غيِر حِسَاب بتقول:
”حَرامْ..،
يانَاس حَرامْْ:
أرض الشراقى مْشَقَّقَةْْ، جاهزه،
بلاشْْ نِجْرح شُعُورْها بالسَّلاَحْ…”
أعود إلى رفضى ما يجرى، وأنا أتعجب من هذه الشفقة الرجراجة، ينبه المتن أن غمر المياه، ليس هو الرى المناسب دائما، فهو يحتاج إلى “صرف” سريع لزائد المياه حتى لا تفسد البذور، وقد أحلـُّوا الرى بالتنقيط، أو بالرش، محل الرى بالغمر حتى لا تفسد البذور، وأيضا توفيرا لجهود الصرف الضرورى اللاحق، بل إن الاهتمام بالرى المتدفق (وهو ما يقابل هنا: الحنان والشفقة والمبالغة فى تخفيف الألم على حساب معاناة النمو فى العلاج النفسى) قد يلهينا عن ضرورة وضع البذرة ابتداءَ لعل البذرة فى العلاج النفسى هى: المعنى، والعزق هو حركية التغيـّـر أما الثمرة فهى، إشراقة النقلة الكيفية…
من هنا فاض بى فصرخت محتجا:
يا ناس يا هُوه: بقى دا كلامْ؟ بقى دا حنانْ؟
”الزرع لازِمْ يِتْروِىِ ”! أيوه صحيحْ،!!
بس كمانْ: الَزرِعْ لازم يِتْزَرَعََ أَوَّلْْ،
ماذَا وإٍلا: البذرة حاتْنَبِّتْ وبسْ.
تأكيد جديد لنفس المعنى، وللأسف فهذا المعنى الذى يبالغ فى تجنب العقاب على طول الخط هو الشائع فى الكذبة التى كادت تضيع أطفالنا تحت اسم “التربية الحديثة”، وهى هى التى تشوه معنى العلاج النفسى، وتصوِّرُه وكأنه مجرد نزهة للتبرير والطبطبة، وكثيرا ما قابلت شبابا ونساء كانت ثورتهم الحقيقية فى داخل داخلهم هى أن المسئولين عنهم فى مرحلة ما من مراحل عجزهم كانوا أجبن من أن يقولوا لهم “لا”، وأعنى بها “اللا” المحبة المسئولة مهما بدت قاسية أحيانا. وهو المعنى الذى سوف يأتى ذكره فى لوحة لاحقة.
“وعْيال لياّم دى غلابة،
لا فى عصا ترحمهم ولا حكمة،
مِنْ مس الجان!”
إن الغمر بالحنان إذا لم يسبقه ويلحقه ويصاحبه تهيئة النظام التربوى النمائى الذى يستوعبه ويستفيد منه يصبح إطلاقا للسلبيات تحت عناوين حديثة براقة.
وهكذا يعلن المتن التخوف من أن تكون هذه العواطف المنسابة هكذا دون حساب، هى نوع من التخلى عن مسئولية العلاقة الموضوعية، المميِّزة، أن تكون خوفا من هذا المستوى الآخر من الجدل الشائك، والحركة المغامرة الضرورية فى إرساء علاقة بين البشر.
وهكذا رجح عندى فرض يعتبر أن هذا الحب هكذا “بالراحة”، ليس إلا خوفٌ من الألم، ونوع من الهرب من المواجهة ومن التناقض اللازم للجدل العلاقاتى التطورى، وأيضا هو تجنب للجهد والمشقة.
(4)
يا ستّْ ياصاحْبِةْْ بُحور الحب والخير والحنان:
إٍوعِى يكون حُبَّك دا خوف،
إٍوعى يكون حبك دَهُهْْ “قِلّـةْ مافيش”([34]).
إوعى يكون حبك طريقه للهرب من ماسْكهْْ المحْرَاتْ،
وصُحْيانك بطول الليل لَيِغْرق زرعنا.
وبرغم كل هذا النقد، والمحاذير، فإن العطشان جدا، الوحيد جدا، الجائع جدا، حتى لو أدرك أن هذا الغمر بالحنان، والحب “بالراحة” ليس هو حاجته تماما، فإنه من فرط احتياجه يجد نفسه بعد كل تخوفاته، وحساباته يجد نفسه غير قادر على رفض النهل من المتاح، لأن عطشه الجائع لا يتمنى أكثر من قطرة واحدة مما يجرى أمامه، فلا يستطيع الرفض، بالرغم من أنه يعلم أن الهلاك ينتظره فى التمادى فى أى من الاتجاهين، فينتهى المتن بهذه النهاية الواقعية المؤلمة قائلا:
(5)
من كُتْر ما انا عطشان بَاخَاف أشربْْ كَـدِهْ من غير حسابْ!
لكن كمانْ:
مش قادرْ أقول لأَّه وانا نفسى فى ندْعِةْ مَيّهْ من بحر الحنانْْ!
يا هلْترى:
أحسن أموت من العطش؟
ولاّ أموت من الغَرق؟!
نأسف للتكرار
لكننى أشعر – كالعادة – بالحاجة إلى عرض المتن مرة أخرى مكتملاً:
(1)
والنظره دى رخْرَهْ عجب.
ماباشوفشى فيها إلا شئ كما الحنان.
لا لُهْ شروط ولا سبب.
وأقول لنفسى يا ترى:
هوّا حنان الدنيا كله اتجمّع الليله هنا؟
عمال بِيْغمُرْنَا كَدِه من غيرْْ حِسَابْ،
كَمَا تِرعَه سابـِتْ فى الغيطانْْ،
إللى بطونها اتْشَقَّقِتِ
(2)
والمّيهْ بالراحةْ بتطفِى فى ”الشراقىِ”
مِنْ دُونْ ولاَ ساقيهْ تِنوُح،
ولا قادُوسْ ولا شَادُوفْْ.
المية تُغْمُرْ والحَنَانْ بِيْبَشْبِشِ القلب الحَزِيِنْ،
والقلب إللى مَالُوش حبيبْ،
والقلب إٍللى من عمايل الناسْ بقى حتِّةْ خشبْْ،
والقلب إٍللى اتمهمطت دقاته أصبح مثل كوره مْنِ الشراب،
تضربها رجلين العيال طول النهارْْ.
وانْْ جت على أْزاز ام هاشم يبقى يوم أزرق وطين،
يالـْـكـُـوره تتشرمط يا إِمّا ان العيال يتفركشوا.
حتى إٍذا ازازْْ “ام هاشم” ما اتْكَسَرِشْ.
مش صحت “الأسطى إٍمام” من غـفْلِتُهْ..!؟
”واللَّى يصحى الناس يانَاسْ أكبر غلط”!!!
(3)
وارجَعْْ أشوف نهر الحنَانْ
ألقاه بيطفى فى الشراقى بْدون “أوان”
لكين الشراقى مَهْما شَّققْها الجفاف؛
الميه راح ترويها صُحْ،
لكنْْ كمانْ:
إن سابتْْ الميّه على العمَّالْ على البطَّالْ حاتغرق أرضنَا،
حتى لو الأرض شراقى مْـَشَقَّقَهْ،
ولاّ الزراعةْْ بدونْ أصُولْ؟
مش لازم الأرض تجف وتتعزق؟!
أو ضَرْبِةِِ المحراتْ تِشُقّ الأرض تقلبِ تبْرِهَا؟!
والنظره إللى بْتُغْمر الكونْْ بالحنانْ من غيِر حِسَاب بتقول:
“حَرامْ..،
يانَاس حَرامْْ:
أرض الشراقى مْشَقَّقَةْْ، جاهزه،
بلاشْْ نِجْرح شُعُورْها بالسَّلاَحْ…”
يا ناس يا هُوه: بقى دا كلامْ؟ بقى دا حنانْ؟
”الزرع لازِمْ يِتْروِىِ ”! أيوه صحيحْ،!!
بس كمانْ: الَزرِعْ لازم يِتْزَرَعََ أَوَّلْْ،
ماذَا وإٍلا: البذرة حاتْنَبِّتْ وبسْ.
(4)
يا ستّْ ياصاحْبِةْْ بُحور الحب والخير والحنان:
إٍوعِى يكون حُبَّك دا خوف،
إٍوعى يكون حبك دَهُهْْ “قِلّـةْ مافيش”
إوعى يكون حبك طريقه للهرب من ماسْكهْْ المحْرَاتْ،
وصُحْيانك بطول الليل لَيِغْرق زرعنا.
(5)
من كُتْر ما انا عطشان بَاخَاف أشربْْ كَـدِهْ من غير حسابْ!
لكن كمانْ:
مش قادرْ أقول لأَّه وانا نفسى فى ندْعِةْ مَيّهْ من بحر الحنانْْ!
يا هلْترى:
أحسن أموت من العطش؟
ولاّ أموت من الغَرق؟!
اللوحة الحادية عشرة
فانوس ألوان
هذه اللوحة تشكيل جديد يحذر من التمادى فى تعرية الذات، أو الآخر، تحت زعم صدق الرؤية، وتعميق البصيرة، لدرجة قد تصيب صاحبها بالعجز عن التغيير الممكن فعلا، هذا ما أسميته فى شرح سابق “الرؤية المعطـِّلة”، أو “الصدق المعوِّق”. كانت محاولات هذه السيدة – كما حضرت فى شعرى– بوجه خاص محاولات عنيدة وهى تصر على مواصلة الكشف دون حذر، وكنت أحيانا أتمنى لها العمى، وأحذرها من أن فرط بهر النور قد يعشى البصر. لكن، والحق يقال، كانت كلما ازدادت صدقا، زاد إصرارها على مواصلة الرؤية، دون الانتباه إلى ضرورة التناسب اللازم بين ثالوث “الرؤية – الحفز – الفعل“. كانت حركية الجماعة التى تحاول معهم نفس محاولتها، ولكن بدرجات مختلفة، تجذبها إلى صحبتهم متصورة أنها كلما رأت داخلها، وواقعنا أكثر، كانت أقرب للطريق السليم الذى نحاول السير فيه، وأقدر على التغيير اللازم لذلك.
فى نفس الوقت لم تكن تنكر أن هذه الرؤية مؤلمة غاية الألم، ويبدو أنها كانت تكتفى بالألم تكفيرا، عن المسئولية فعلا، وحين كانت تستعبط لتوهم نفسها أنها لا ترى ما ترى، كانت سرعان ما تكتشف أنها تكذب على نفسها أولا، فى محاولات تعمية نفسها بأى مستوى من الوعى، بلا طائل، وكان كل ذلك يجعلها تخاف أن ترى أكثر، وتخاف أن ترى أقل (تعمى)، تخاف أن تتألم أكثر، وتخاف أن تتبلد فتنخدع، كانت تحافظ على المسافة بينها وبين أى آخر، دون أى استغناء، وأيضا دون أية مغامرة باقتراب أكثر.
(1)
والنظره دى صادقهْ، وْمحتاره، وْخايفهْ؛
خايفهْ مِنْ الصَّدق وكُتْر الشّوفْ المُرْْ.
خايفه مِنْ بُكَرَهْْْ.
عمّالَه بتقولْ:
”نفِسى آجى معاكُو.. حتى ماشيَهْ حافيهْ
بس شوك الأرض بيَخزَّقْ عِنَيّهْ.
نفِسى اغَمّضْ، نفسى أًعـْمَى.
بس برضُه الشوكْ فِى قَلْبِى،
حتى لو قلت الضلام ستر وغطا،
أبقى شايفه، إنى عاميه”.
وحين كانت هذه السيدة الفاضلة تبلغ درجة قصوى من الخوف والألم وبهر الرؤية، كانت تحاول أن تشكك نفسها فيما يجرى، بما فى ذلك ضرورة أو جدوى أو معنى هذا الكشف المتلاحق، فتحاول أن تسمح للشك فى صدق الجارى ولزومه أن يتسحب إلى داخلها، وهى لا تشك فى الآخرين بقدر ما تشك فى نفسها، بل وأيضا فى رؤيتها شخصيا، أعنى فى صدق رؤيتها، لا فى فاعليتها أو ما يترتب عليها.
(2)
والشك الشوك بيشكشِكْْ:
”مش يمكن كل الصحّ الصحّ: مش صح؟
مش يمكن أنا باعملّكوا فخ؟
مش يمكن باكْذبْْ.
لاجْلَ أهْرَب والعبْ..؟
هذه كلها صورة مؤلـَّـفة تسمح لى أن أبين كيف أنه فى العلاج النفسى ينبغى الحذر من هذا التعميق فى الرؤية بجرعة أكبر من القدرة على استيعابها، ويعتبر ضبط جرعة التعرية بتغيير الدفاعات النفسية المعيقة (وأحيانا العادية) من أصعب مهام المعالج، أصعب كثيرا من ضبط جرعة العقاقير حسب مرحلة مسار العلاج، ثم إن ضبط جرعة الرؤية لا يلزم بالنسبة للمريض فحسب، بل هو يشمل المعالج أيضا وباستمرار، ولا توجد مؤشرات، أو خطوات، أو تعليمات محددة تُحفظ فتنفذ، فتساعد المعالج على ضبط جرعة تعرية المريض بل والمعالج أيضا. المعالج هو دائم التجربة، دائم المراجعة دون تردد، هو يعمل على استيعاب كل جرعة أولا بأول، وعليه ضبط الخطوة تلو الخطوة من خلال النتائج المرحلية بخبرته المتنامية.
أحيانا، من فرط صعوبة وثقل جرعة الرؤية يتعامل المريض معها، بشكل قد يخدع المعالج، وذلك باللجوء إلى استعمال ما تيسر من ميكانزمات أخرى أهمها العقلنة([35])، وأحيانا تقوم هذه العقلنة بتعطيل مسار العلاج بقدر أكبر.
فى العلاج الجمعى بالذات قد تخدع آلية “العقلنة” كلا من المعالجين والمرضى على حد سواء، وقد يطمئن صاحب هذه الرؤية إلى انبهار الآخرين بقدرته على الغوص ليس فقط فى داخله، وإنما فى داخلهم، بشكل عميق ومخترق أيضا، وفى هذه الحالة قد يكون الاستمرار فى التصفيق (بمعنى فرط القبول بإعجاب وحماس) لهذه الرؤية هو ضد مسيرة العلاج النمائى بشكل أو بآخر. ثم إن بعض من هم مثل هذه الحالة قد يفخر بأنه يرى حجم سلبياته وطبيعة ميكانزماته التى عرّاها لدرجة تصور له أنه – بذلك – قد كفَّر عنها، مع أن واقع وقفته منظـِّـرا تقول إنه لم يخطُ بعد ذلك أية خطوة فى محاولة تغييرها، وكأنه يعلن سلبياته ليثبتها لا ليتخلص منها.
وحين ينتبه صاحب هذه البصيرة، المعقلنة جزئيا، إلى لعبة العقلنة التفكير دون تغيير، قد يحاول أن يخفى بعض رؤيته هذه عن المعالج، وربما عن الآخرين، وأحيانا عن نفسه، لكنه عادة لا ينجح:
(3)
الناسِ بتْحَاوِلْ تِخْفِى الِكْذب،
إٍنما صاحْبِتْنا بِتِخْفِى الصِّدْق.
والكذب حْبالُه طويلَهْ،
والصدق مصيبته تقيله،
هذا ما حدث مع صاحبة هذه اللوحة – تخيلاً – حتى تصورتُ أن محاولتها أخذت تتمادى فى كل اتجاه دون أن تعلم هى أنها تدور حول نفسها، فطغت الحلول المثالية، والأحلام المؤجـَّـلة على كل ما يمكن أن يترتب على إدراك هذا الواقع العارى من حركة نمائية مسئولة، وبرغم ذلك يتواصل استمرار الرؤية المعقلنة، وكانت هذه السيدة تتخفى طول الوقت من الجميع ومن نفسها بكثرة النقلات بين التفاعلات والانفعالات المتنوعة الصادقة أيضا:
خُدْ عندكْ: حتة كدْب،
على نبضة صدقْ،
على رسمة حبْ،
على صرخة همْْْ،
على سكتة غمْ،
وتلخبط كل حاَجاتها على كل حاجاتها،
بالقصد.
فى العلاج النفسى حين يحدث مثل ذلك لا يكون عادة دليلا على خوض مأزق التغير بقدرْ ما يكون ربكة تعطل صاحبها وتخدع المعالج أو المجموعة بالتالى، ومن ثَمَّ لا يترتب على هذا الموقف أى تحفيز نحو التقدم للخطوة التالية.
صاحبتنا كانت تبدو أنها تلجأ إلى هذه الخلطة المقصودة المتنقلة بسرعة من حال إلى حال فلا تسمح لأحد بالاقتراب، لأنه يمكن حين يقترب الآخر أكثر أن يفاجأ بنقلة إلى موقع آخر، أو مشاعر أخرى، أو موقف آخر دون توقع فينسحب، وتطمئن هى إلى ثبات موقفها وموقعها محتفظة بمسافة من الأمان الدفاعى الحامى.
فى مثل هذه الأحوال تنجح الحالة أن تحافظ على تلك المسافة ثابتة بينها وبين “الآخر” (الموضوع)، أو على الأقل تتحرك فى دائرة مغلقة، أى أنها برغم ظاهر الاقتراب والابتعاد لا يتغير وضعها فى النهاية. وتزداد مقاومتها مع استمرار انسحابها أمام أى اقتراب، برغم حاجتها إلى الآخر “الموضوع”، بشكل متزايد.
وانْ جَهْ وَاحِد وْشاوِرْ عقله يقرّبْْ:
تحرَن وترفـَّصْ،
تضرب تْتِملـَّصْ
وتعاند زى العيَّل لما يزق البزْ،
مع إٍنه جعانْ.
يتضاعف الموقف باللجوء إلى درجة من الاستعلاء حين تعلن لنفسها ولغيرها أنها تفهم أكثر، وترى أعمق، وتحس أصدق، وتفكر ألمع، وكل هذا يكون صحيحا من حيث القدرة على الفهم والوصف والتنظير، لكنه يكون غالبا بعيدا عن اختبار الواقع، فتهرب أكثر فأكثر فى المثالية التى نبهنا إلى سلبيتها فى أكثر من لوحة تشكيلية فى هذا العمل، ويظل الزعم بالمثالية هو المطروح والمسئول عن إطلاق الشعارات، والتعامل مع أحلام اليقظة الشاردة كأنها واقع محتمل:
وتقول أنا مخِّى مافيش زيُّـه،
وتدوَّر عاللى مافيش زيُّه :
وتلاقى: “يسقُط شر الناس،
ويعيش الحب”
وخلاص.
– إزاى؟
– مِشْ شغلى.
المفروض أن مرارة الرؤية، وشوك المسيرة، هما الناتج الطبيعى لصدق الرؤية، وهما الدافع لحركية النمو، أما المثاليه المزركشة فهى عكس ذلك، إذْ ترسم الأهداف جميلة جذابة، لكنها تلحق ذلك بتعرية صعوبة الطرق الموصلة إليها بطريقة مبالغ فيها تجعل الوصول إلى هذه الأهداف يكاد يكون مستحيلا، فتُحِل ذلك النكوص الطفلى ومزيدا من المثالية، محل التوجه الهادف المسئول، دون التخفيف حتى من آلام كل ذلك.
وبحور المّر بْتِرْوِى الشوك ِالصبرْ.
والبحر بعيدْ، ومالوش شطآنْ.
ولا فيش مقداف ولا دفّهْْ،
ولا ريّـِسْ، ولا بمبوطِى.
كان من أكثر الأمور إيلاما لى، ما واجهنى حين كنت أتابع صاحبة هذه اللوحة وهى تتمزق بين ما تراه من تناقض ظاهر بين أمومتها الطيبة، وبين طموحها المثالى الطوباوى تقريبا، وكانت تحاول أن تحل المشكلة بحل وسط، أقرب إلى التسوية الطفلية المثالية المعقلنة منه إلى حركية النمو الواقعية المسئولة الأصعب:
والطفلة تشقّل فى اللفة وتقول:
رمضان اهُو جىْ، وحاقولْ وَحَوِى،
واستَنّى الفجــر.
وليالٍ عشر.
وراح افتح طاقة القدْرْ.
وأطَلَّع منها فانوس ألوانْ.
بس كبير خالِصْ.
قد الدنيا بحالها.
ولاَقِينِى قَاعْدَهْْ فْ وسْط عِيالىِ،
وعيالى كـتـار، وكـبـار.
يبقى حلِّيتْهاَ يا حَلُلِّى.
لا انا سِبْت عْـَيالىِ،
ولا سِبْت النَّاسْ.
بصراحة، ومن خلال خبرتى، فى العلاج النفسى، لاحظت أن المريض الذى يصل إلى هذه الدرجة من الرؤية المخترقة المعقلنة معا، وفى نفس الوقت يتوقف عند هذه التسوية المثالية الساكنة، لا يحاول أن يهرب من رؤية داخله مهما بدا شائها أو متمزقا أو مؤلما، قد ينجح أن يخفيه فقط عن الآخرين، بعض الوقت، حسب مقتضى الحال لا أكثر.
أحيانا تستعمل مثل هذه الرؤية العميقة المخترقة منطلقا لإبداع فائق، هذا إذا ما أفرغها صاحبها فى إبداع خلاق خارجه، حتى ولو على حساب نموه شخصيا، بمعنى أنه بدلا من أن يبدع ذاته من خلال ما رأى، يكتفى بأن يسجل بأدوات إبداعه تشكيلا جميلا جديدا بديلا عن إبداع ذاته، وقد سبق أن ذكرت أننى قد مرت على فترة رفضت هذا الإبدال، لكننى عدت فقبلته باعتباره محطة قد تكون لازمة، ومفيدة، لكل من صاحب الرؤية المبدعة ومن يتلقى نتائجها على السواء.
كثيرا ما تختلط أجزاء رؤية الحقيقة مع محاولات إخفائها عن الآخرين بشكل مشوش مما يزيد الموقف غموضا، وقد يكون ذلك مقصوداً من عمق آخر، وبالتالى تتوقف مسيرة النمو بحل سلبى مختار نسبيا، فى هذه الحالة لا ينفع العلاج النفسى التقليدى عادة، لأن مثل هذه الحالة قد تعرف وتفسر كل ميكانزماتها أدق وأعمق من المعالج نفسه، أما العلاج النفسى المكثف المخترق فهو يقابـَـل من صاحبة هذه الرؤية بعناد وتحد بلا هوادة، وكأنها مبارزة تحدٍّ مستمر، وتصبح كل طاقة المريض موجهة إلى تصوُّر تملك ناصية الوعى والإرادة يستعملهما ضد أية محاولة تغيير أو اقتراب من الخارج. وبرغم هذا العناد القوى، إلا أنه لا يؤدى إلى أى حل حقيقى مهما نجح ظاهريا، فهو موقف تتصاعد مرارته باستمرار نتيجة اصطدام حدة الرؤية، مع عناد الجمود، مع الخوف من الاستسلام والاعتماد على آخر، مع العجز عن النسيان والعمى، أو حتى التعامى، ولا يأتى الغد الموعود أبدا.
وقد يخفف من وطأة هذا الموقف بعض الوقت، تكرار ظهور تلك الأحلام الوردية ولو فى أفق بعيد، إلا أنه بالنسبة لهذا التشكيل، كانت هذه الأحلام دائما مضروبة بحقيقة الرؤية ومرارتها.
وبرغم وضوح عناد التوقف، وأوهام المثالية، وقوة المقاومة، إلى أننى لم أستطع أبدا أن أستلسلم لأى حكم سلبى على صاحبة هذا التشكيل، وانتهت اللوحة وأنا بين التصديق والتكذيب، بين اليأس أو أن يتفتح أمامى باب احتمال آخر لا أعرف ما وراءه، فأتركه مفتوحا، آمِلاً منتظرا إلى ما لا نهاية.
(4)
وأبص بشكّْْ، وأحاول أصدّقْْ.
وتبص بعِند، وتقول أنا قَدَّكْْ.
والطفل اللى جواىَ يقول “أنا مالى، مِش يمكن!”
والشيخ اللى بَرَّاىَ يقول: “لا ياعَمْْ، مش ممكن”.
وتبصْ، وأبصْ.
وأشوفْلَكْ طاقةِ القدر فْ عينها،
من غير فوانيس، ولا ناس.
والنور بقى نار بِتْلَهْلِبْ.
إنما جواها: فيه “بكره”. أو “يمكن!”.
“… مش يمكن!!!؟”
حين يـُفرض تحدٍّ مثالى على الطبيب – أو المعالج – النفسى، فلابد أن يفتح عقله لاحتمال تحقيقه وألا يبادر بالرفض أو التعجيز، وخاصة إذا كان صاحب التحدى يحمل مسئوليته، (وهو أمر نادر فى موقف العلاج النفسى وإلا فلماذا للعلاج؟) والطبيب (أو المعالج) عموما يستفيد من فتح أبواب عقله لكل الاحتمالات الجديدة الممكنة ليتطور هو ذاته، وفى نفس الوقت يسمح للمريض أن يحس بذاتيته، ويتحمل مسئوليته فى النهاية، سواء نجح فى مواصلة الطريق، أم رضى بالتوقف.
****
ثم إلى المتن مكتملاً كالعادة، لعله يجتمع فيجمعنا متواصلاً:
(1)
والنظره دى صادقهْ، وْمحتاره، وْخايفهْ؛
خايفهْ مِنْ الصَّدق وكُتْر الشّوفْ المُرْْ.
خايفه مِنْ بُكَرَهْْْ.
عمّالَه بتقولْ:
”نفِسى آجى معاكُو.. حتى ماشيَهْ حافيهْ
بس شوك الأرض بيَخزَّقْ عِنَيّهْ.
نفِسى اغَمّضْ، نفسى أًعـْمَى.
بس برضُه الشوكْ فِى قَلْبِى،
حتى لو قلت الضلام ستر وغطا،
أبقى شايفه، إنى عاميه”.
(2)
والشك الشوك بيشكشِكْْ:
”مش يمكن كل الصحّ الصحّ: مش صح؟
مش يمكن أنا باعملّكوا فخ؟
مش يمكن باكْذبْْ.
لاجْلَ أهْرَب والعبْ..؟
(3)
الناسِ بتْحَاوِلْ تِخْفِى الِكْذب،
إٍنما صاحْبِتْنا بِتِخْفِى الصِّدْق.
والكذب حْبالُه طويلَهْ،
والصدق مصيبته تقيله،
خُدْ عندكْ: حتة كدْب،
على نبضة صدقْ،
على رسمة حبْ،
على صرخة همْْْ،
على سكتة غمْ،
وتلخبط كل حاَجاتها على كل حاجاتها،
بالقصد.
وانْ جَهْ وَاحِد وْشاوِرْ عقله يقرّبْْ:
تحرَن وترفـَّصْ،
تضرب تْتِملـَّصْ
وتعاند زى العيَّل لما يزق البزْ،
مع إٍنه جعانْ.
وتقول أنا مخِّى مافيش زيُّـه،
وتدوَّر عاللى مافيش زيُّه :
وتلاقى: “يسقُط شر الناس،
ويعيش الحب”
وخلاص.
– إزاى؟
– مِشْ شغلى.
وبحور المّر بْتِرْوِى الشوك ِالصبرْ.
والبحر بعيدْ، ومالوش شطآنْ.
ولا فيش مقداف ولا دفّهْْ،
ولا ريّـِسْ، ولا بمبوطِى.
والطفلة تشقّل فى اللفة وتقول:
رمضان اهُو جىْ، وحاقول وَحَوِى،
واستَنّى الفجر.
وليالٍ عشر.
وراح افتح طاقة القدْرْ.
وأطَلَّع منها فانوس ألوانْ.
بس كبير خالِصْ.
قد الدنيا بحالها.
ولاَقِينِى قَاعْدَهْ فْ وسْط عِيالىِ،
وعيالى كـتـار، وكـبـار.
يبقى حلِّيتْهاَ يا حَلُلِّى.
لا انا سِبْت عْـَيالىِ،
ولا سِبْت النَّاسْ.
(4)
وأبص بشكّّْْ، وأحاول أصدّقْْ.
وتبص بعِند، وتقول أنا قَدَّكْْ.
والطفل اللى جواىَ يقول “أنا مالى، مِش يمكن!”
والشيخ اللى بَرَّاىَ يقول: “لا ياعَمْْ، مش ممكن”.
وتبصْ، وأبصْ.
وأشوفْلَكْ طاقةِ القدر فْ عينها،
من غير فوانيس، ولا ناس.
والنور بقى نار بِتْلَهْلِبْ.
إنما جواها: فيه “بكره”. أو “يمكن!”.
“… مش يمكن!!!؟”
اللوحة الثانية عشرة:
البيت المسحور
مقدمة:
هذه اللوحة تمثل واحدة من أصعب الخبرات التى مررت بها فى هذا الاستكشاف، كنت كلما وصلت فيها إلى تصور لمستوى من مستويات الوعى (أو حالة ذات أو سمّها كما شئت) أطمئن كأنى حللت اللغز، لكننى أجد وراء هذا المستوى من الأسرار والمفاجآت ما لم أكن أتصور، وقد تتالت السراديب والأبواب المسحورة، حتى إذا ما انتهيت إلى آخر سرداب، أو ما تصورته كذلك، فوجئت بأننى ربما كنت أسير إلى عمق صعب لايزال مغلقا علىّ، أكثر منى مستكشفا لما حيرنى باباً من وراء باب، وسردابا بعد سرداب.
قراءة اللوحة
دعونى أعترف أننى أخرت تشكيل هذه اللوحة أثناء المحاولة الشعرية الأولى شهورا طويلة، إذ يبدو أننى كنت أتوقع تلك الصعوبة فعلا، أما من ناحية الشكل فقد وجدت أنها أقرب اللوحات إلى القصص الشعبى وهو كما أشرت فى البداية أقرب إلى هذا العمل الذى أقدمه ربما كجزء من هذا الفن الذى كاد ينقرض تحت وطأة ضربات التقنية والسرعة، إلا أننى بعد أن انتهيت من صياغتها شعرا، على مراحل، تماما كما كان استكشافى لها على مراحل، رحت أقرأها مجتمعة، وإذا بى أكتشف أنها ليست لهذا الشخص الذى استلهمت منه اللوحة، ولا لغيره، ربما هى تكاد تكون صورة طبقات الوجود البشرى وتراكماته عموما بشكل أو بآخر.
ما زلنا فى مجال استكشاف “فقه العلاقات البشرية”، هذه اللوحة بالذات، لا تتناول هذه القضية بشكل مباشر مثل ما سبقها أو ما سوف يلحقها، إنها تشكيلات “واعدة طاردة” طول الوقت، وكأنها بقدر ما تغرينا أن العلاقات البشرية ممكنة، وأن التعرية لا تمنع تحمل رؤية بعضنا لبعض ومن ثم مغامرة الاقتراب، هى تكشف لنا أن وراء كل باب سرداب، ولكنه سرداب لا ينتهى إلى الحجرة المسحورة التى تكشف السر كما يبدو لأول وهلة، وإنما ينتهى إلى باب آخر لا نعرف ما وراءه إلا بما يشبه الوعد، فأى باب مغلق، يغرينا أن نتصور أن وراءه شيئا يحتاج أن يغلق عليه باب ما.
أكاد أشفق على قارئ المتن أن يرفض هذه الصورة برمتها من كثرة تتالى الإحباط، أحب أن أشير ابتداءً إلى ضرورة الصبر فى إصدار الأحكام فى مجال العلاج النفسى خاصة (والحياة عامة) وإلا عوَّقـَت الأحكام مسيرة التقارب والنمو، وعلى المعالج أن يكون متفتحا للمفاجآت، وأن يتذكر أن أى تفسير إمراضى (سيكوباثولوجى) هو مجرد فرض، وأن الفرض الجيد هو القادر على توليد فروض أجود، وليس بالضرورة أن ترتبط جودته بمدى صحة إثباته.
وبرغم ضرورة التمسك “بنظريةٍ ما” كبداية، إلا أن المعالج ينبغى أن يكون هو سيد النظرية لا عبدا لها، وفى رأيى أن فرويد رغم تطويره نفسه ورؤيته ونظرياته باستمرار، إلا أنه كان سجين فكره خاصة بالنسبة لما اعتبره هو أهم فتح فتحه التحليل النفسى عليه، وهو كتابه فى ”تفسير الأحلام”، أردد كثيرا رأيى آسفا: إنه سجن نفسه فيما فرحَ به إلى هذه الدرجة، ثم إنه، لظروف تطوره واكتفائه بعمله العيادى الخاص، لم تُتَح له فرصة ممارسة علاج الجنون بالعلاج النفسى، ولا معايشة المجانين كما كان الحال مع جاك لاكان مثلا أو مع سيلفانو أريتى، تلك الخبرة التى أتاحتها لنا العقاقير الحديثة، أكثر فأكثر حتى سمحت لنا أن نتخطى حدود فرويد، مع احترامنا لكل محاولاته.
كانت واجهة عيون صاحب هذه اللوحة رائقة هادئة، قوية النداء، وكأنها سوف تبوح بكل ما فيها إلى ما بعدها لمن يتقدم نحوها، إذا ما اقترب منها، كانت واعدة بأسرار جاهزة، لكننى كنت كلما اقتربت منها، أكتشف – كما قلت – أن وراء الأسرار أسرارا، ووراء كشف اللغز، ما هو ألغـز.
نبدأ بالفقرة الأولى من المتن:
(1)
وعيون عمّالة بتوعدْ من غير وعْـد.
بِتْشاوِرْ: على باب مكتوب فوق منه:
“سرداب السعد”،
بوابة تصب فْ بوابةْ،
والجـِـنـِّى بينفُخْ فى الغابةْ،
والبَنُّورةْ قْـدَّام الساحرْْ،
والآخِـرْ: ما بايِـنْـلُوشْ آخِـرْ.
يا ترى حانـْلاقى قلب نضيفْ وصْـغّيـر وبرئ،
كما قلب العصفور فى الجنّة،
ولاّ حانـْلاقىِ نَقَايـَةْ مـِشْمـِشْ: جامدة وناشفة، وخايفة؟
واذا حـَتّـى اتكسرتْْ، مرارِتْهـَا صـَعْـبْ؟
هذا التساؤل البادئ هو إكمال لما جاء حالا فى المقدمة، وهو يشير بوضوح إلى مدى حاجتنا إلى فتح هذا الملف الصعب، إن عمق الوجود البشرى هو نتيجة لتراكم وتداخل مستويات تطوره، وأنه فى جدل دائم لن يتم أبدا حالة كونه يتشكل باستمرار فى رحلة تطور كتب عليه أن يعى بعضها، وأن يشارك بقدر ما يستطيع فى توجيه مسارها.
يبدو أن الاستقطاب فى نهاية المقطع هو ضد ما عشته بعد كتابة هذا المتن منذ نحو أربعين سنة، فلقد تبينت بوضوح أن عمق الوجود البشرى لا يمكن اختزاله إلى “إما… وإما…”، ربما كان ما تركـَـتـْـنـِـى فيه هذه العين من حيرة بعد هذه الرحلة الطويلة هو الذى جعلنى أتصور أن استقطابا ما يمكن أن يريحنى من طول ومشقة هذه الرحلة المحيرة، هذا الاستقطاب يرجعنا إلى بؤرة إشكالة الوجود البشرى: هل أصل الفطرة هو تلك الطفولة الطاهرة البريئة المنطلقة؟ أم هو قلق المادة غير الحية الجافة التى تولدت منها الحياة بفضل الله؟ مهما كان هذا التصور حقيقة مرة تهز أحلامنا عن أنفسنا بشكل أو بآخر. (قضية ماهية الفطرة وطبيعتها) ولن أُستًدرج الآن للعودة إليها، فأكتفى بأن أعلن رفضى لهذا الاستقطاب الذى جاء بالمتن هكذا، وإن كان لا بد أن أختار فأنا أميل إلى ترجيح هذا القلق المخفى وفى نفس الوقت المفجر للحياة: مهما كان مـُـرًّا، أو مهما بدا مرا، أفضل من السذاجة التى قد يثبت عجزها برغم أنها “قلب نضيف وصغير وبريء كما قلب العصفور فى الجنة” فأنا أميل أن نفهم الفطرة كقانون وبرنامج حركى قادر أن يخلق الحياة مهما بدا ظاهره أنه: “نقاية مشمش جامدة وناشفة وخايفة“
ما وراء “الباب الأول” البومة!
بمجرد أن فتحتُ هذا الباب الأول، اختفى هذا النداء الواعد الذى لاح لى وأنا لم أطرقه بعد، فأطلّ علىّ نذيرَ الشؤم، والخراب، ينعق بسخرية لاذعة.
(2)
ولقيت فى الأول صورة البومة
بتبصْ، تبحـْلق:
وتقول جرَى إٍيهْْ؟
بتبصـُّولـِى ليهْ؟
أنا مالِى؟
حوَالىّ خرابْْ؟
دا خرابـْكُمْْ إٍنتمْ.
دانا كترَّ خيرى.
عمالهْْ بازَعّق وأقولْْ:
”فيه لسَّهْْ حياة، حتى فى خرابهْ”.
الطبقة السطحية فى الوجود الإنسانى المغترب هى طبقة تبدو خاوية (خراب) يمكن أن تتصف باللامبالاة، ولكن بالتأمل فيها قد يثبت أنها دفاع ضد الانجرار إلى النفاق من خلال التعبير السطحى بالامتلاء، أو تردد أصوات أوهام حب عابر أو انجذاب ظاهر.
هذا هو ما نحاول التأكيد عليه باستمرار ونحن نشرح للمبتدى فى مهنتنا كيف أن وصف الفصامى مثلا (ناهيك عن الشخص العادى) باللامبالاة، أو التبلد، أو فقد المشاعر، هو وصف سريع جائر، فكما ألمحتُ سابقا فإن مثل هذه الأعراض ما هى إلا إعلان خراب “وجود” ما، وعدم جدواه، وميزتها الأساسية – رغم طبيعتها المرضية – أنها تعلن فشل هذا الوجود وعجزه، ومن هنا أصبحتْ، برغم وصفها عادة بالسلبية، ذات قيمة دالة إذا أحسنّـا ترجمتها إلى ما تقوله، وإن كانت فى ذاتها تمثل مصيبة لصاحبها إن لم يستفد منها ويستوعب ماوراءها.
المجتمع (نحن) عادة ما يرفض المريض النفسى (المجنون خاصة) لأنه يعلن فشل وجودنا المغترب هذا، فنقابل ذلك بأن نهاجم المريض، أو ننفيه، أو ننظر إليه من أعلى بنفس منطقنا الذى انفصل عنه ليحكم عليه، إن دفاعاتنا لتغطية ما فى داخلنا مما يشبه هذا الذى يعلنه المجنون هى دفاعات هامة ومطلوبة فى كثير من الأحيان، لأنها تحمينا من مواجهة هذه الحقيقة: فينا من يخاف المجنون ويفر منه فراره من الأسد، وفينا من يشفق عليه شفقة تنفيه تماما وتبعده عنا ونحن ننظر إليه من أعلى نمصمص شفاهنا.
قابلت فى خبرتى أشخاصا عاديين أصيبوا برهابات مختلفة، من بينها رهاب فقد السيطرة، لمجرد أنهم قابلوا مجنونا من الذين يهيمون فى الشوارع.
وثمة مجموعة أخرى من الأسوياء الدارسين للطب العام، أو لعلم النفس، أصابهم مثل ذلك وغيره، بعد زيارة عابرة، هى جزء من مقرر دراسى، لمستشفى أمراض عقلية.
صحيح أن نعيق البومة ليس رمزا كاملا يصلح للمقابلة بصيحة المجنون، لكننى اخترت جزئية تشاؤمنا من نعيقها، وتطيرنا من رؤيتها.
المجنون – على لسان البومة هنا – ينبهنا إلى أن البومة المتهمة بأنها لا تهوى إلا العيش فى الخرابات (الخراب)، إلا أن هذا الخراب الظاهر هو أقل خطرا وأجهز للتعمير من خراب خفى قد يعشش داخلنا.
ونحن لا نفعل إلا أن ننكر هذا الخراب، ونغطيه برفضنا أى تلميح له إو إعلان عنه كما يرمز إليه نعيق البومة هنا.
إذا كان الجنون عارا سلبيا فى طريق مسيرة الحياة، فهو الوجه الآخر للوجود المـُفـْرغ الذى نعيشه، وميزة الجنون أنه يعلن ذلك صريحا.
المرض بهذه الصورة هو رفض للموت النفسى الخبيث الذى يلبس ثوب الحياة العادية المتجمدة المغتربة، لكنه رفض فاشل، لأنه هو فى ذاته موت آخر متحلل، لكنه عموما صيحة منذرة قد تبعث حياة فيمن يحسن تلقيها، حتى لو لم يتحمل مسئوليتها مـَـنْ أطلقها: (المريض).
وتواصل البومة تعريتـها لنا:
تكونوش عايزينْهَا: تِخْرَب فى السرْْْ؟
“خليها تعدّى”، “خلّيها تمرّ”!
ولا حد ينبّـه، ولا حد يزنّ
والإسم حياة، والفعل ” كإن”
وبدال ما نغيّر، نحكـِى ونْـفِـنّ؟
كما سبق أن أشرت، كنت أميل باكرا إلى رفض الفن كمهرب بديل عن الحياة، كما رفضته كتفريغ إسقاطى لما يعتمل بنفوسنا، ولم أفهم رفض أفلاطون للفن واعتباره “تقليد التقليد” إلا خلال هذه الفترة تحديدا، رفضتُ الفن التنفيثى، أو التفريغى أو الإبدالى، أو حتى بلغة أرسطو: “التطهيرى”، رفضته – فى تلك الفترة – واعتبرته خدعة مخدِّرة تؤجل مواجهتنا بالتزام اللحظة الراهنة، وكنت آنذاك فى أشد حالات إصرارى على أننا “إما أن نعيش الآن، وإما ألا نعيش”، ثم مرّت الأيام وصدمنى الواقع والفشل، وأدركت أن بـُعد الزمن ضرورى للتطور ورأيت قصور مرحلة وجودنا البشرى الحالى، وعدت أتصالح مع الفن كرؤية للمستقبل، وإيقاظ للوعى، وبديل عن الجنون وتعلمت أنه لا يضير الفنان ألا يعيش – شخصيا – رؤيته العميقة فى الحياة اليومية، فهو يبلغ الرسالة إلى أهلها، ويقوم بدوره بغض النظر عن نوعية وجوده الشخصى، كما تعلمت أن إيقاظ الوعى التنويمى السائد إنما يتم بنجاح أكبر بصدمة الفن الحى، وأيضا هو قد يتم بثورة الجنون برغم سلبياته، ومخاطر التناثر من جرائه.
يبدو أننى حين كتبت هذه اللمحة كنت أعلن احتجاجى على لسان المريض الذى يعلن خراب حياتنا على هذه الصورة لو أننا اكتفينا بطرح وجودنا الآخر ومشاكلنا فى صورة فن “بديل عن الحياة” (مرة أخرى كما قال أفلاطون: تقليد التقليد)، لكننى تراجعت كثيرا كما ذكرت.
تجمدت الصورة، تصنمت اللامبالاة، وصارت العين التى كانت نذير الشر من الزجاج تعمل كزر للباب الثانى.
وِأقَرَّبْ أكتر مالصَّورهْ،
وأبص فْْ عين البومه.
واستغرَبْْ!:
دى عيونها إزاز.
عاملين كده ليه؟
حسِّس، جرَّب، يمكنْْ،
وألاقى العين مش عين،
دِى زْرَارْْ،
وأجرّب أزُقُّّّ: تتحرك كُـلِّ الصوره،
والباب التانى يْبان:
سيدنا سليمان! وراء الباب الثانى:
برغم ما يـَـعـِـدُ به أى باب مغلق بفك الطلسم إذا ما فتحناه لنعرف ما وراءه، فإننى لم أجد فى هذه اللوحة وراء بابها المغلق إلا سرداب يغرينا بالسير إلى نهايته لعلنا نجد ما يشفى الغليل، غليل المعرفة ابتداءً.
الذى حدث أننى اكتشفت أن وراء هذا النذير الصادر من البومة المحذرة، والتى قلنا حالا أنها كانت تنبهنا إلى احتمال أن الخراب هو فى داخلنا وليس فى خارجنا كما نزعم، أقول إننى حين انتبهت إلى هذا التحذير، اكتشفت أن وراءه حكمة بالغة، تمثلت لى فى حكمة سيدنا سليمان بكل الحقائق والأساطير المنسوجة حوله، بما ذلك عمره، وكيف أن الجان ظل يحسبه حيا وهو ميت متكئ على عصاه، إلى أن نخرها السوس فانكسرت، فانكفأ على وجهه، فعرف الجان، لست أدرى بعد كم من السنين، أنه مات، فانطلق فى نشاطه العبثى والتعددى من جديد.
ما يقابل الجان عندى هو حقيقة واقعية كما الأحلام وكما الواقع سواء بسواء، كل ما فى الحكاية أننى آراه وجودا ماثلا فى داخلنا، كما أرى الأحلام بما هى، لا بما نحكيه عنها كأنها هى، وجودا ماثلا أيضا يُـكـَـمـِّـلنا، وهذه الرؤى (الفروض) تسهل الأمر علىّ وأنا أتعامل مع مرضاى حين يسألونى عن إيمانى بوجود الجان، فأقر بصدق أننى أفعل، وأحترم، وأتفاهم مع هذه الذوات الأخرى بما يفيد الكل النامى، كل الفرق أننى أراها فى الداخل وأسميها أسماء أخرى أحيانا نيوروبيولوجية!، وأتعامل معها باحترام يسمح بالجدل فالتكامل فى كل نبضة نمو.
الحكمة التى يمثلها هنا سيدنا سليمان هى التى تكمن وراء البومة النذير المحذِّر وفى نفس الوقت هى تمثل غلبة العقل والتعقل (وليس العقلنة)، العقل “القادر الحاسب المحاسب”، ولها أسماء أخرى فى مدارس أخرى،
نحن – فى ثقافتنا – نبالغ فى تقييم دور هذا الحكيم القابع داخلنا، وهو ليس بالضرورة مرادفا للضمير، أو للأنا الأعلى (فرويد)، أو حتى للذات الوالدية (إريك بيرن)، هو تنظيم يحترم الواقع بقدر ما يحتوى بقية مستويات الوعى ويحيط بها.
الأرجح أن هذا المستوى الحكيم من الوعى قد يمثل تكثيقا لمفهومين من مدرستين متباعدتين: المفهوم الأول هو مفهوم يونج (كارل جوستاف) عن اللاشعور الجمعى وأن الإنسان عمره لا يبدأ يوم يولد ولكنه يحمل دهورا من الحكمة والغرائز البناءة فى أعماق أعماقه، والمفهوم الثانى مستمد من لغة إريك بيرن (مدرسة التحليل التفاعلاتي) فى حديثه عن حالة الأنا الوالدية التى تشمل الجد وجد الجد (فى التحليل الأعمق)، هذه الحكمة العميقة والجاهزة هى إشارة إلى أن التركيب البشرى ممتد عبر الأجيال: ليس فقط بوراثة استعداد بذاته بالمعنى السطحى، ولكن بمعنى البصم ببرامج بيولوجية معقدة تتكون منها الذاكرة الجينية بكل طبقاتها.
ربما ما أردته هنا، أو ما وجدته، أو قرأته فى هذه اللوحة، هو أن القديم المتجدد، والحكمة المحيطة، لهما تمثيل كامل فى وجودنا، ومن ثم فإن استيعابهما وتمثلهما فى الحاضر فى تكامل مع طاقة الغريزة ودفعها هو السبيل الحقيقى لمسيرة التطور، وإلا فإهمال أى جزء جهلا أو خوفا لا ينتج إلا إنسانا ناقصا أو مشوها.
(3)
ودى صورة مين؟
عمره كام دهر؟
الشيخ قاعدْ وِشُّهْ منوّرْ،
مركون على عصا بيفكر.
وعنيه بتشع الحكمةْْ.
أسطورة المرأتين فى قصة سيدنا سليمان، حين احتكمتا إليه وكل منهما تدعى أنها أم الطفل، ثم حـُـكم سيدنا سليمان المبدئى بأن الحل هو أن يشق الطفل مناصفة بينهما، قاصداً أن يتبين من هى الأم الحقيقية، ربما يكون فيها تلميح رمزى إلى الإنقسام الذى يحدث أثناء النمو للنفس البشرية، عندى أن الترجمة النفسية لهذه الأسطورة هى أن الأم التى تمارس أمومتها بنجاح هى التى تستطيع أن تتعهد هذا الانشقاق، لكنها ترفضه إذا كان انشقاقا يعنى الاغتراب المتباعد فى اضطراد، حتى أنها تفضل أن تحافظ على “كلية” حياة طفلها ولو لمرحلة ما، حتى لو تعهدته أمٌّ سيئة فى تلك المرحلة، وحين يكتشف سيدنا سليمان من هى الأم الحقيقية، لا يتحقق الانشقاق بمعنى الاغتراب أو الهلاك، ولكن يظهر الأمل فى خلخلة تؤدى إلى تحريك مرحلى فى رحاب أمٍّ مرنة، ومن ثَمَّ إلى تلاحم جدلى نامٍ، وهكذا، فضلا عن الانشقاق الدورى الطولى من خلال نبضات الإيقاع الحيوى (دورات “النوم/الحلم/اليقظة” أساسا).
“فاكرين القصة ؟؟([36])
مين أنقذ طفل الأم
من جشع الست التانية !!؟
سيدنا سليْمان.
” مين كلّم نملة، وهزّ الملكة” ؟
– سيدنا سُليْمَانْ
هذا النوع من تقديس الحكمة الغائرة فى وجودنا يعطى لهذه الحكمة قـُـدُرات وينسج حولها معجزات مبالغا فيها تسمح بـ، أو تدعو إلى، اعتمادية معطلة للنمو، وإذا كانت حكمة سيدنا سليمان قد تجلت فى حكمه بقسمة الطفل، فظهرت الأم الحقيقية، فإن قدراته على التحكم فى الجان (مستويات الوعى التحتية)، والتخاطب مع الحيوانات والحشرات والطيور، هى من قبيل هذا التقديس، وهكذا، يمكن أن يتجاوز هذا المستوى دوره الإيجابى بشكل أو بآخر، خصوصا فى التربية.
هكذا تـَعرّت أمامى طبيعة وحقيقة القوة الظاهرة التى تكمن وراء باب الحكمة الراسخة، وحينذاك قفزت إلى ذهنى إشكالة علاقة هذا المستوى بالنمو عامة، وبتربية الأطفال بوجه خاص، وأنه حين تثبت هشاشة هذه القوة، وأنها قوة من فوق السطح، يفتقد الأطفال إلى من يلمـّهم إلى نفسهم، بديلا عن التسيب بلا معالم، تحت رحمة القوى البدائية (الجان) أو الانشطار بلا عودة، وتنطلق التساؤلات، وتتوجب المراجعة:
يبقى البومة كان عندها حق
طب فين الكدب وفين الصدق؟
وفين الضرب وفين الحب
وفين العفو وفين الذنب
إزاى نسمح لعيالنا:
بالشق، الضم، النبض، الود،
اللعب، الجـَـرْى، العَـــدّ:
حانربى عيالنا ازاى؟
على عزف الناى
وعيالْ لـِــيّامْ دِى غـَلاَبـَهْ،
لا فى عَـصـَا تـرِحَـمْـهُمْْ ولا حـِكْمَة،
مـِن مـَسَّ الجـَانْْ
والجانْ أيَّامْنَا، لابسين جلد الإنسانْ.
ولا عادْْ بـِيْهم الواحدْْ منهم سورة “الكرسى”،
ولا سورة “الناسْ”.
والحكمةْْ مـَا مَـاتـِتْ مـِنْ مُدَّهْْ.
ما فاضلشى إلا الحكمة الموضهْْ،
تِلقَاهَا مَلْفُوفهْ،
حوالين حِتَّةْ شكولاتهْ، جوّا الصالونات.
المخاطر البشرية التى تحيط بالبشر، وبالأطفال بالذات، من خلال القهر والسحق والظلم والبلبلة والتخبط، وأحادية التوجه، واستقطاب القيم، هى مخاطر واقعة ومتزايدة، وإذا لم نضع ذلك فى الاعتبار فى تربية الأطفال بتهيئة التناسب بين جرعات الحنان والقسوة وحسن توقيتهما، فالنتيجة هى السحق تحت أقدام الشر المعاصر الذى استحوذ على طاقة العدوان، واستعملها فى العنف القاتل المغير على بعضنا، هذا العدوان الصريح الذى جعل من الإنسان المعاصر قاتلا لأفراد من نفس نوعه دون عائد بقائى.
لم يعد مطروحا حاليا ما يمكن أن يسمى “العصى الرحيمة” فى تربية الأطفال
“لا فى عصا ترحمهم،
ولا حكمة، من مس الجان”
لم يعد العنف البشرى العدوانى يرتدع بردع داخلى أو خارجى، ولم يعد للكبير أو الإله أو الحكيم قيمة فاعلة، مات كونفوشيوس فى العصر الحديث، وأرى أن كل ذلك يحرمنا أصلا من التفاعل الجدلى الضرورى للنمو والتكامل، وقد بلغت تفاهة الحكمة المطروحة فى السوق، واغتراب النصائح مبلغا جعل الاستشهاد بأى من ذلك مدعاة للسخرية أكثر منه سبيلا للنمو.
ثم يتجلى لى العجز الغائر وراء صورة هذا الشيخ المقدسة التى تعرت عن هشاشة داخلية، لكننى أكتشف أنه برغم إعلان موته، وأنه لم يتبق منه إلى ما يشبه الحكمة، مازال يستطيع أن يتألم، ليس لنفسه فحسب، بل لنا أيضا، وهو ينبهنا أن يتولى كل منا أمر نفسه دون انتظار معجزة من مقدس، بل إنه نفسه يطلب أن نلحقه هو أيضا، نخفف عنه ما ألمّ به، لا أن نكتفى باستنقاذه ليلحقنا لينقذنا مما آل إليه حالنا.
– إٍلحقنا يا عمّى الشيخ شُفْـنَا.
– “أَلحقكو ازاىْ؟
إنت اهبلْ؟ ولاّ بْـتـِسـتهِبلْ؟
دَانـَا صورهْ”
دا انا ميت.
وأَبُص كويسْ جوا عنين الصورة
وألاقى النملة بتزحف فى بياضها
والنمل اصحابه من مدة
إنما كات عينه يا خوانّا مليانة أَلـَمْ،
مش قادر يستحمل ألمه، وبيبكى بدال الدمع الدم
– إعمل معروف شيل النملة دى بتقرصنى،
وعَصاتى السوسْ بهدلها،
حانْكِفىِ عـَلـَى وِشِّى تَوْ مَا تبقى دِقـِيقْ،
حين يتكشف هذا المستوى من الحكمة الطيبة، والقدرة الواعية، عن كل هذا الضعف الذى يحتاج إلى أن يعان لا أن يعين، دون إعداد كاف لضمان استمرار النمو فى اتجاه التكامل، أى النضج الحقيقى، تنقض القوى البدائية بعنفوان فجاجتها (الجان) لتخرب الدنيا، وهى تبرر النكوص وما يشبه الحرية، وكذا تبرر وتدعم اللذة قصيرة العمر.
والجانْ الإنسان الجِنّ،
حايقيم أفراحه مش حايِوْنّ
فى الخمارة: وفْ الحارة السّدْ
فى الدايرة المقفولة الضّلْمهْ، ما فيهاش حدْ
“دقِّـى يا مزيكا،
شمِّمـْـنـَـا يا ويكا”.
إن ما يمثله القديم الحكيم، سواء بجذوره فى اللاشعور الجمعى، أو فاعليته كحالة من حالات الأنا الوالدية، أو علاقاته الزائفة المغلقة على نفسه، هو هذا الذى ينطلق حين ينكشف عجز هذه الحكمة عن قيادة واحتواء سائر المستويات.
وفى استغاثة أخيرة يصيح المتألم:
إعمل معروف شيل النملة
فأستجيب رحمة به واحتراما لألمه، وإذا بى أكتشف وراء كل هذه الحكمة، مستوى وعى آخر لم يكن فى حسبانى.
وِأَحاول اشيِلها،
أًتاريها التانية زرار،
والباب المسحوْر بـِيْــزَيـَّقْ.
نعم باب آخر لم يكن فى الحسبان.
وراء الباب الثالث: موناليزا ([37])
مازالت نظرة “موناليزا” وبسمتها تحير النقاد، وبالذات نظرتها الخاصة جدا، الغامضة، الواعدة، الحاوية، ولقد حاولوا تفسير هذه النظرة من أول أنها تمثل ما تبقى عند ليوناردو دافنشى من نظرة أمه، إلى أنها تمثل جوعا أو كبتا جنسيا عند الفنان نفسه.
ما أردت توضيحه هنا باستعارة صورة الجيوكندا هكذا هو تكملة، دون تطابق، للوحة السابقة بعنوان “الترعة سابت فى الغيطان([38])”، فى هذه الحالة حين وصلتُ إلى ما بعد طبقة الوعى السابقة، التى حذرت فيها من الاستسلام إلى اعتبارها إيجابية على طول الخط، فوجئت بمستوى أكثر تحييرا من مجرد شكل الحكمة، أو شؤم البومة وتحذيرها، وهو المستوى من الوجود الأقرب إلى دعوة للكشف من خلاله منه إلى إبلاغ بالواقع، فما يميز لوحة الجيوكانده، هو أنها تسمح بالإسقاط بشكل متنوع متعدد، بحيث يبلغ الناظر إليها، أو الذى يتلقى نظرتها المتابعة له حيث ذهب، أن يسقط عليها مايريد، إلى أن يجد نفسه فى رحابة الإبداع يأخذ منها ما شاء لما شاء.
وصلني أن هذه النظرة هى تعبير عن مستوى من الوعى فج راق فى نفس الوقت، يكمن داخل كل منا، وهو يحمل ما يحمل من نداء الغموض، وتداخل المشاعر، بحيث لا يمكن تسميته أو تجريده رمزا، فالتعبير عن المشاعر البشرية فى لفظ واحد أمر شديد الصعوبة، برغم ظاهر سهولته، وهو يؤدى عادة إلى اختزال المشاعر المكثفة والمتداخلة إلى ما لا يمكن أن يحتمله هذا اللفظ، وغالبا ما يترتب على ذلك أن تختنق المشاعر داخل الألفاظ بما قد يعيق التواصل الأشمل والأرحب.
قبل أن نعرض للفرض، دعونا نقرأ معا ما جاء فى المتن:
(4)
هوّا انْـتِى!!!
بالبسمة الهاديهْ الناديةْ،
بالعين اللى بْتجرِى وراكْ بِحنانْهاَ،
وْبتـنِـْدهـَلـَكْْ ماطْرحْ ماتْـرُوحْ.
هوّا انتِ؟ موناليزا الطاهرة الفاجرة؟
الواحد عايز إِيه غير بسمة حُبْ، وِحنَانْْ،
والصدق الدافىِ وْكُلَّ الطيبَهْ يـْـلِـفــُّـونى،
وكإن الشر عمرُه ما كان.
وكإن الدنيا أمان فى أمانْ،
وكإِن البسمهْْْ الصادقة تْدَوِّبْ أيها حقد، وأيـُّـهَا خوف.
هذه الطبقة من النفس قد تكون أقرب إلى الفطرة وهى تلامس فى نفس الوقت ما يسمى الغريزة (الطاهرة الفاجرة)، وبديهى أنه يصعب على الشخص العادى أن يتصور اجتماع هذين النقيضين (ظاهرا)، إلا أن اجتماعهما – على عمق بذاته – هو أكثر تواترا من كل تصور، بل إن البديل عن قبول تواكبهما هو: إما الاختزال، وإما الإنكار والتجنيب.
فى هذا المستوى من الوعى، أطل علىّ تحدى هذه اللوحة، إذ وجدت وراء باب الحكمة (هذا المستوى الغامض الواعد الساحر المغرى، فوصفته كما سبق، لكننى أسرعت بنقد ما وصلنى من حيث إنه لو استقبلنا ظاهره وحده كما يبدو، استقبلناه استسلاما لغواية غموضه ووعوده، قد يكون خدعة لا تخدم فهم عمق العلاقات البشرية، إذ قد نلتقط مما يصلنا الجانب السهل الظاهر من التشكيل، وبالذات من النظرة.
هيا نقرأ كيف تشكل الاحتجاج والنقد “فى المتن” لهذا الاحتمال:
جرى إيه؟
الواحد كان حايصدق، وكإن الصورهْ حقيقـَهْ؟
يا أخينا:
مين المسئول عن بعضيـنَا ؟
عن أكل العيشْ؟
عن قتل الغدر؟
عن طفل عايزْ يِتَربَّى وِسْط المْكَنِ، القِرْشْ الدَّوْشَه الدَّمْ؟
عن جوع الناسْ؟
عن بيع الشرف الأَمل اْلبُكْرَه: امبارحْْ؟
وأبصّ لْهَــا تانى واقول:
بالذمه بتضحكى على إيهْْ؟
دى البسمةْْ الحلوةْْ الرايقةْْ المليانـَهْ حنانْ، وخلاصْ،
يمكن تبقى مصيبه الأيام دِى!
حا تخلِّى الواحد يتهيأ لـُه إٍن الدنيا بخير، وينْامْ،
يحلم بالجنهْْ…،
وِخلاصْْْ!
فى العلاج النفسى، وخاصة العلاج الجمعى، نتواصل مع بعضنا بالألفاظ بداهة، إلا أن ثم تواصلا آخر يجرى طول الوقت من خلال قنوات أخرى، لا نعرف أغلبها، ولا نعرف أنها نجحت أم فشلت إلا من خلال نتائجها كما ذكرنا مرارا من قبل.
هذا المستوى الذى ظهر لى هكذا فى هذه اللوحة يعلن بوضوح أن التواصل البشرى لا يتم، وبالتالى يصعب أن يكون بناء وحقيقيا وخليقا بما هو إنسان، إلا على مستويات متعددة، ومنها، أو لعله أهمها هذا المستوى الغامض الواعد هكذا. علينا إذن أن نحترم الألفاظ التى نتبادلها فى العلاج وغير العلاج، لكن علينا أيضا ألا نتوقف عندها، ولا نقدس مضمونها الشائع فى نفس الوقت، خذ مثلا الألفاظ التى تعبر عن الحب على ناحية، وتلك التى تعبر عن الحقد (مثلا) الناحية الأخرى، إن قبول التناقض، وتحمل الغموض Tolerance of ambiguity هو أساس حركية الإبداع سواء على مسيرة النمو، أو على مستوى الإنشاء التشكيلى، أو على مستوى النقد، فى أطروحتى عن العلوم النفسية والنقد الأدبى، والتى ظهرت أيضا فى كتابى “تبادل الأقنعة”([39])، أخذت على عباس العقاد الذى يعد ناقدا رائدا، عجزه عن استيعاب تناقض العواطف خاصة فى نقده الرائع لابن الرومى، ذلك التناقض الذى تتشكل منه المسيرة الولافية التى لا يمكن استيعابها إلا باحتمال رؤية – وممارسة – ومواجهة الضدين للتفاعل الخلاق والتوليد التصاعدى، لكن يبدو أن العقاد لا يحتمل ذلك أصلا، فاهتمام (العقاد) المفرط بتأكيد نمط محدد للشخصية إنما يشير إلى موقفه الساكن، ومن ثم تسكينه لما يرى، وبالتالى: الميل إلى الاستقطاب أو الاختزال. العقاد يميل غالبا إلى افتراض رجحان أحد الضدين، وهو يلتمس التأويلات لظهور الضد المقابل، على سبيل المثال نراه يفسر شهادة ابن الرومى على نفسه بالحقد بأنه ادعاء للحقد وليس حقدا، أو بأنه لتخويف الناس من قدرته على الحقد، أو بأنه كان يتعاطى صناعة البرهان فأحب أن يمتحن قوته فى المنطق والفلسفة ويستشهد على ذلك – ضمن شواهد أخرى – بأن ابن الرومى قد ذم الحقد كما مدحه. وكل هذه الاستنتاجات والدفاعات تشير إلى أحادية زاوية الرؤية نتيجة للعجز عن استيعاب الحركة الجدلية، وعن عدم تحمل مواكبة “قفزات النمو الكيفية”. وقد يرجع ذلك إلى شخصية العقاد الصارمة – برغم موسوعيته – كما قد يرجع إلى منهجه الفكرى الذى يميل فى أحيان كثيرة إلى الإفراط فى “الالتقاط – فالتعميم”.
ولكن من أين لابن الرومى أن يقول:
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفتى * وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض
(ابن الرومى) قد أبلغنا رؤية متداخلة لا فكاك من الاعتراف بأنها إنما تعلن لحظة حدس عميق، اكتشف فيها الشاعر المبدع كيف ينتسب الحقد إلى الشكر والعكس بالعكس. وهذا الانتساب لا يقتصر على وحدة الأصل بل على ولاف المسار. (وقد) ذهب العقاد ينفى بالحجة تلو الحجة حقد ابن الرومى أصلا، ويذهب إلى أن اعترافه به أدل على عدم وجوده. والناقد هنا تجاوز حدْس الشاعر وسطـّح إبداعه([40])…الخ
هذه اللوحة، على هذا المستوى من الشعور تعلن بوضوح أهمية استيعاب الكائن البشرى لمستويات من التواصل، ليس لها اسم من ناحية، كما أنها كثيرا ما تكون مزيجا مما لا نقبله عادة إلا استقطابا.
يختتم المتن تشكيل هذه اللوحة بالتحذير من الاستسلام إلى تأثير ظاهر السهولة التى تصلنا من عيون الجيوكانده، وذلك بتعرية مبالغ فيها لما وراء هذه الابتسامة الواعدة.
وعشان أبـْعـدْ تأثيرها:
قهقهت كما بْـتُـوع الحـتِّــهْ،
فى المُــولـِدْ.
بصِّيتْ لـلصـُّورَهْ،
طَلَّعتِ لـْسـَانـِى:
تكشيرهْ امّال،!. . كـدَهـُهْْ!
تبويزه امّال،!. . كـدَهـُه!”
وتغيظنى ولا تـبـوزش.
وأنا أعمل عقلى بعـقلـيـها من كـتر الغـيظ،
“بـلا نيلة بتضحكى على إيه؟”
نلاحظ فى هذا التشكيل المتعدد الطبقات أن الانتقال من مستوى إلى آخر، يتم بعد تعرية المستوى الذى بدا وكأنه غاية المراد، كما نلاحظ أن التعرية تبلغ عادة من القسوة ما يكاد ينسينا دور هذا المستوى من الوعى فى تشكيل العلاقات البشرية، وهذا خطأ بحت، فليس معنى أننا نعرى مستوى فنكشف حدود دوره دون أن نرفضه، أن ننكر موقعه ودوره، كل المطلوب هو ألا نتوقف عنده أو نخدع بظاهره، إن تعريته ليست سوى تنبيه لما بعد ذلك، لنقبل التعدد لنؤلف بين المستويات أبدا على طريق النمو.
وهكذا يلوح لنا من جديد فى نهاية هذا السرداب أيضا، وقد كنا نحسبه نهاية المطاف، باب جديد، يغرى بتواصل حركتنا إلى مستوى وعىٍ أعمق هكذا:
وأحاول اشوّه ضحكتها، وأغطيها،
يا خرابى !!
الصوره دى رخره بتتحرك،
وبيفتح باب:
وراء: الباب الرابع: صورة دوريان جراى
تذكرة : لابد ونحن نقترب من فتح آخر باب أن نتذكر أننا نصف صعوبة تكثيف وجود أحد أفراد المجموعة، وفى نفس الوقت نقرأ احتمال تداخل طبقات تاريخ البشرية معاً
هانحن نواصل فتح آخر الأبواب، الذى فتح لنا حين حاولنا – ساخرين – أن ندفع بخدىّ “الموناليزا” إلى أعلى حتى نمحو ابتسامتها الغاوية الغامضة الواعدة، وإذا باللوحة تتحرك، ونكتشف أنها هى هى الباب الأخير، الذى يظهر من ورائه سرداب يؤدى إلى هذه الصورة هكذا:
والساحر قاعد متّـاخِـر،
والآخِـرْ، ما بايلنـْلوش آخِـر.
وعيونه بتوعدْ،
من غير وعد.
يا ترى حانـلاقى قلب نضيفْ وصغيـّر وبرىء ،
كما قلب العصفور فى الجنة؟
ولا حانـلاقى نقايـة مـشمـش، مافيهاش ريحـة الـروح.
واذا حـتـى اتكسرتْ، مرارِتْهَـا صـعْـبْْ ؟
ويأتى الجواب بظهور ما وراء هذا الباب الأخير وهو تشكيل يعلن التحذير من المراوغة وإخفاء البشاعة وراء وجه أملس، بالغ البراءة، أو حتى هو يورى كأنه الجمال الخادع، كل هذا تجسد لى فى أسطورة “دوريان جراى”.
(5)
الشاب وسيم وحليوه، واقف مـنـطور،
والوش بريء ربـانـي، مافيهوش ريحة التعبير،
لكنْ باينْ، وكإنه جميلْ،
واسمه “دوريان”
هوا انتِ؟ إلصوره اياها؟
ودا صاحبك إللى اتمنى ف يوم يخدعنا
ما تبانـشـى عليه بصمات السن،
ولا خـتم الشـر، ولا صـوت لـضمـير.
وان كان لازم تتسجل كل عمايـلـه:
راح عامل صورة يبان فيها التغيير.
وكأنها صـورة الحــق الجـوانـى الـبـِــشِع العـريـان”.
قصة صورة “دوريان جراي” لأوسكار وايلد” أشهر من أن تحكى، فكرت أن أكتب موجزا لها، إلا أنى اكتفيت بما ورد فى المتن هنا، أما ورود هذه الصورة على هذا العمق الرابع فى هذا التشكيل، فكان تعبيرا عن أن هذه البراءة والهدوء والتلميح بالخلود فى المستوى السابق (موناليزا)، لا يدل على عجز فقط عن مواجهة الواقع، بل إنه قد يخفى وراءه نقيضه تماما.
هذه القضية تواجهنى بشكل مؤلم يحذرنى كثيرا من تصديق ظاهر رقة الناس وبراءتهم فى مجتمع قاهر قاس كما هو حالنا الآن، وقد تكرر إعلان شكى فى أكثر من نقطة وصورة فى هذا العمل.([41])
الحذر من هذه الصورة البريئة والبسمة الفطرية الساحرة، هو حذر الانخداع بها وهى تخفى وراءها الوجه الآخر لبشاعة الوجود إذا استسلمنا لها ولم نعتبرها مجرد بداية لرحلة النمو والجدل، فى مواجهة بشاعة تشويه التركيب البشرى حين تنفصل طبقاته عن بعضها، فتصبح عرضة لنهش أى ظالم مفترس.
بعد كل هذه الرحلة الطويلة والافتراضات المتلاحقة، تركنى صاحب هذه العيون فى حيرة من أمره، لا أدرك ماذا يقبع فى سراديب أغواره فى نهاية النهاية، بصراحة، عزوتُ هذا الغموض بسبب تكثيف كل هذه الطبقات هكذا، إلى أنه قد أسقط كل ضعفه وشره وقسوته ونوازعه على شريكه هذا وهو (هى) أقرب الناس إليه، وبذلك بدا هو رائقا رقيقا ملغزا، فى حين بدا هذا القريب الحميم مشوها عاجزا، وهذا أشبه بما يعرف فى الطب النفسى بالجنون المُقحم Folie imposé الذى قابلته متواترا فى خبرتى فى ثقافتنا بالذات حين رحت أشاهده فى بعض حالات الإدمان التى أسميتها “الإدمان بالنيابة”، حين يدمن الابن نيابة عن والده، أو بعض حالات الانفلات الجنسى بالنيابة حين تنحرف البنت “نيابة” عن أمها… إلخ.
إنما دى الصورة هنا مايعه ؟.
ما يكونشى جواها البـِشــعه؟
أقلـبـها:
يظهر لى الباب الأخراني.
دا مفيش ورا آخر باب، ولا أوده ولا بواب!!
(6)
والاقيلك بحر التيه، من تحت البحر الميت،
والطفلة الغلبانة بتبكى، ولا حد شايـفــها.
والميه مية نار، والجلد صدف ومحار،
لا هى قادره تصرّخ، ولا راضية تموت.
يا ترى يا جماعه الطفله دهه “صورة، صورة” دوريان؟
ولا انا غلطان ؟
أنا نفسى أطلع غلطان،
أحسن ما أشوف:
طفل بيتشوهْ،
من كتر الخوفْ،
وسط العميانْ.
خاتمة:
اكتشفتُ مصادفةً أثناء بحثى فى حاسوبى أننى قمت بتحديث نهاية هذه القصيدة بإضافة ستة أسطر، وقد أرجعت سبب هذه الإضافة إلى أننى فزعت من نهاية هذه اللوحة (التى تمثلت فى العثور على طفل فى آخر سرداب وهو يبكى إذْ يتقلب فى “ماء النار”، وقد تجمد جلده (صدف ومحار) وهو لا يستطيع أن يصرخ، ولا حتى أن يموت، ومن هول هذه النهاية رجّحت أن تكون رؤيتى هذه هى مبالغة شديدة، نتيجة الخوف من أن يكون هذا هو حقيقة داخل داخلنا إذا مضى الأمر هكذا، وقد تمنيت أن أكتشف خطئى: “أنا نفسى أطلع غلطان” حتى لا أرى كل هذه التشوية الذى يمكن أن يلحق بفطرتنا لأننا لا نراها أصلا، من فرط رعبنا أن نرى الحقيقة (طفل بيتشوه، من كثر الخوف وسط العميان).
هل يا ترى نجحت هذه الفقرة المضافة أن تخفف من هذه الرؤية المتألمة المرتعبة؟ هل يمكن أن ينجح هذا الاستدراك فى أن يفتح باب الأمل، إذا نحن غامرنا بالتعرف على بعضنا البعض بما هو نحن “خلقة ربنا”، وبالتالى استطعنا أن نحمل أمانة “أن نكون معاً”، بأقل قدر من إلغاء أحدنا للآخر، وبأكبر من قدر من التحمل للاستمرار، وبالتالى نستحق أن نكون بشرا بحق إذ نتعرف على حقيقتنا الجميلة؟؟
ما تيالاّ نقايس نستحملْ، نفضل مع بعض،
دا الموت الوغد بيتسحب من تحت الأرض،
إنما فيه بذرة منسيّهْ،
مِسْتنية،
نرويها نشوفها انها هيه،
تكبر، تمتد!
بهذه السلاسة، تصورت أن المسألة، برغم كل السراديب الخادعة والنهاية المرعبة، لا تحتاج منا إلا أن نتذكر ما نسيناه، وما أنسانا إياه إلا الرعب والجشع الشيطانى أن نذكره، يبدو فعلا، كما يقول المتن فى هذه المقدمة أن كل ما علينا هو أن نُقِرّ بوجود هذه الطبيعة الجميلة الحيوية كأصل للوجود البشرى، وأنها قابلة للنمو والترعرع بمجرد أن نعترف بها ونطلقها على سجيتها معاً .
“بذرة منسية، مستنية،
نرويها نشوفها انها هيّه، تكبر تمتدْ”.
لقد أردت من مجمل هذا التشكيل هنا أن أوضح مدى الصعوبة فى إدراك طبقات النفس حين تغطى إحداها الأخرى وكيف أن علينا ألا نتوقف عند مستوى تحتىّ وكأنه نهاية المطاف مهما بدا مفاجأة، فربما وراءه ما هو أكثر غورا وأهم دلالة.
الفقرة الأخيرة فى المتن كانت من البشاعة والإرعاب ما جعلنى أخففها بهذه الإضافة المزيدة، والتى كررتها فى نهاية القصيدة لعل وعسى!
ثم إلى المتن متكاملاً بعد إضافتة الخاتمة المزيدة:
(1)
وعيون عمّالة بتوعدْ من غير وعْـد.
بِتْشاوِرْ: على باب مكتوب فوق منه:
“سرداب السعد”،
بوابة تصب فْ بوابةْ،
والجـِـنـِّى بينفُخْ فى الغابةْ،
والبَنُّورةْ قْـدَّام الساحرْْ،
والآخِـرْ: ما بايِـنْـلُوشْ آخِـرْ.
يا ترى حانـْلاقى قلب نضيفْ وصْـغّيـر وبرئ،
كما قلب العصفور فى الجنّة،
ولاّ حانـْلاقىِ نَقَايـَةْ مـِشْمـِشْ: جامدة وناشفة، وخايفة؟
واذا حـَتّـى اتكسرتْْ، مرارِتْهـَا صـَعْـبْ؟
(2)
ولقيت فى الأول صورة البومة
بتبصْ، تبحـْلق:
وتقول جرَى إٍيهْْ؟
بتبصـُّولـِى ليهْ؟
أنا مالِى؟
حوَالىّ خرابْْ؟
دا خرابـْكُمْْ إٍنتمْ.
دانا كترَّ خيرى.
عمالهْْ بازَعّق وأقولْْ:
”فيه لسَّهْْ حياة، حتى فى خرابهْ”.
تكونوش عايزينْهَا: تِخْرَب فى السرْْْ؟
“خليها تعدّى”، “خلّيها تمرّ”!
ولا حد ينبّه، ولا حد يزنّ
والإسم حياة، والفعل ” كإن”
وبدال ما نغيّر، نحكى ونْـفِـنّ؟
وِأقَرَّبْ أكتر مالصَّورهْ،
وأبص فْْ عين البومه.
واستغرَبْْ!
دى عيونها إزاز.
عاملين كده ليه؟
حسِّس، جرَّب، يمكنْْ،
وألاقى العين مش عين،
دِى زْرَارْْ،
وأجرّب أزُقُّّّ: تتحرك كُـلِّ الصوره،
والباب التانى يْبان:
(3)
ودى صورة مين؟
عمره كام دهر؟
الشيخ قاعدْ وِشُّهْ منوّرْ،
مركون على عصا بيفكر.
وعنيه بتشع الحكمةْْ.
“فاكرين القصة ؟؟([42])
مين أنقذ طفل الأم
من جشع الست التانية !!؟
سيدنا سليْمان.
” مين كلـــِّـمْ نملهْ، وهزّ الملكهْ” ؟
– سيدنا سُليْمَانْ
يبقى البومة كان عندها حق
طب فين الكدب وفين الصدق؟
وفين الضرب وفين الحب
وفين العفو وفين الذنب
إزاى نسمح لعيالنا:
بالشق، الضم، النبض، الود،
اللعب، الجرى، العَـــدّ:
على عزف الناى
حانربى عيالنا ازاى؟
وعيالْ لـِــيّامْ دِى غـَلاَبـَهْ،
لا فى عَـصـَا تـرِحَـمْـهُمْْ ولا حـِكْمَة،
مـِن مـَسَّ الجـَانْْ
والجانْ أيَّامْنَا، لابسين جلد الإنسانْ.
ولا عادْْ بـِيْهم الواحدْْ منهم سورة “الكرسى”،
ولا سورة “الناسْ”.
والحكمةْْ مـَا مَـاتـِتْ مـِنْ مُدَّهْْ.
ما فاضلشى إلا الحكمة الموضهْْ،
تِلقَاهَا مَلْفُوفهْ،
حوالين حِتَّةْ شكولاتهْ، جوّا الصالونات.
– إٍلحقنا يا عمّى الشيخ شُفْـنَا.
– “أَلحقكو ازاىْ؟
إنت اهبلْ؟ ولاّ بْـتـِسـتهِبلْ؟
دَانـَا صورهْ”
دا انا ميت.
وأَبُص كويسْ جوا عنين الصورة
وألاقى النملة بتزحف فى بياضها
والنمل اصحابه من مدة
إنما كات عينه يا خوانّا مليانة أَلـَمْ،
مش قادر يستحمل ألمه، وبيبكى بدال الدمع الدم
– إعمل معروف شيل النملة دى بتقرصنى،
وعَصاتى السوسْ بهدلها،
حانْكِفىِ عـَلـَى وِشِّى تَوْ مَا تبقى دِقـِيقْ،
والجانْ الإنسان الجِنّ،
حايقيم أفراحه مش حايِوْنّ
فى الخمارة: وفْ الحارة السّدْ
فى الدايرة المقفولة الضّلْمهْ، ما فيهاش حدْ
“دقِّـى يا مزيكا،
شمِّمنا يا ويكا”.
إعمل معروف شيل النملة
وِأَحاول اشيِلها،
أًتاريها التانية زرار،
والباب المسحوْر بـِيْــزَيـَّقْ.
(4)
هوّا انْـتِى!!!
بالبسمة الهاديهْ الناديةْ،
بالعين اللى بْتجرِى وراكْ بِحنانْهاَ،
وْبتـنِـْدهـَلـَكْْ ماطْرحْ ماتْـرُوحْ.
هوّا انتِ؟ موناليزا الطاهرة الفاجرة؟
الواحد عايز إِيه غير بسمة حُبْ، وِحنَانْْ،
والصدق الدافىِ وْكُلَّ الطيبَهْ يـْـلِـفــُّـونى،
وكإن الشر عمرُه ما كان.
وكإن الدنيا أمان فى أمانْ،
وكإِن البسمهْْْ الصادقة تْدَوِّبْ أيها حقد، وأيـُّـهَا خوف.
جرى إيه؟
الواحد كان حايصدق، وكإن الصورهْ حقيقـَهْ؟
يا أخينا:
مين المسئول عن بعضيـنَا ؟
عن أكل العيشْ؟
عن قتل الغدر؟
عن طفل عايزْ يِتَربَّى وِسْط المْكَنِ، القِرْشْ الدَّوْشَه الدَّمْ؟
عن جوع الناسْ؟
عن بيع الشرف الأَمل اْلبُكْرَه: امبارحْْ؟
وأبصّ لْهَــا تانى واقول:
بالذمه بتضحكى على إيهْْ؟
دى البسمةْْ الحلوةْْ الرايقةْْ المليانـَهْ حنانْ، وخلاصْ،
يمكن تبقى مصيبه الأيام دِى!
حا تخلِّى الواحد يتهيأ لـُه إٍن الدنيا بخير، وينْامْ،
يحلم بالجنهْ…،
وِخلاصْ!
وعشان أبـْعـدِْْ تأثيرها:
قهقهت كما بْـتُـوع الحـتِّــهْ،
فى المُــولـِدْ.
بصِّيتْ لـلصـُّورَهْ،
طَلَّعتِ لـْسـَانـِى:
تكشيرهْ امّال،!. . كـدَهـُهْْ!
تبويزه امّال،!. . كـدَهـُه!”
وتغيظنى ولا تـبـوزش.
وأنا أعمل عقلى بعـقلـيـها من كـتر الغـيظ،
“بـلا نيلة بتضحكى على إيه؟”
وأحاول اشوّه ضحكتها، وأغطيها،
يا خرابى !!
الصوره دى رخره بتتحرك،
وبيفتح باب:
والساحر قاعد متّـاخِـر،
والآخِـرْ، ما بايلنـْلوش آخِـر.
وعيونه بتوعدْ،
من غير وعد.
يا ترى حانـلاقى قلب نضيفْ وصغيـّر وبرىء ،
كما قلب العصفور فى الجنة؟
ولا حانـلاقى نقايـة مـشمـش، مافيهاش ريحـة الـروح.
واذا حـتـى اتكسرتْ، مرارِتْهَـا صـعْـبْْ ؟
(5)
الشاب وسيم وحليوه، واقف مـنـطور،
والوش بريء ربـانـي، مافيهوش ريحة التعبير،
لكنْ باينْ، وكإنه جميلْ،
واسمه “دوريان”
هوا انتِ؟ إلصوره اياها؟
ودا صاحبك إللى اتمنى ف يوم يخدعنا
ما تبانـشـى عليه بصمات السن،
ولا خـتم الشـر، ولا صـوت لـضمـير.
وان كان لازم تتسجل كل عمايـلـه:
راح عامل صورة يبان فيها التغيير.
وكأنها صـورة الحــق الجـوانـى الـبـِــشِع العـريـان”.
إنما دى الصورة هنا مايعه ؟.
ما يكونشى جواها البـِشــعه؟
أقلـبـها:
يظهر لى الباب الأخراني.
دا مفيش ورا آخر باب، ولا أوده ولا بواب!!
(6)
والاقيلك بحر التيه، من تحت البحر الميت،
والطفلة الغلبانة بتبكى، ولا حد شايـفــها.
والميه مية نار، والجلد صدف ومحار،
لا هى قادره تصرّخ، ولا راضية تموت.
يا ترى يا جماعه الطفله دهه “صورة، صورة” دوريان؟
ولا انا غلطان ؟
أنا نفسى أطلع غلطان،
أحسن ما أشوف:
طفل بيتشوهْ،
من كتر الخوفْ،
وسط العميانْ.
ما تيالاّ نقايس نستحملْ، نفضل مع بعض،
دا الموت الوغد بيتسحب من تحت الأرض،
إنما فيه بذرة منسيّهْ،
مِسْتنية،
نرويها نشوفها انها هيه،
تكبر، تمتد!
اللوحة الثالثة عشر:
الزير
هذه اللوحة مستوحاة من حالة استلهمها خيالى من حالة شخصية منى جدا، لم أسمح للخيال أن يقترب من حقيقتها الطيبة، إلا بعد أن أخفيت معالمها، فجاءت هذه اللوحة لتكمل بعض أبعاد إشكالة “فقه العلاقات البشرية”.
هو شخص ذو طبع صامت هادئ، يوحى بالطمأنينة لكل من يقترب منه، أو يسأله، أو يستنصحه، أو يستعين به، كان من البديهي أن أشارك فى ذلك لشدة حاجتي للطمأنينة، والدعم، والتصديق، بل والاعتماد، أحسست أن فى ذلك ظلما له، فمعنى أن يطمئن الجميع له بهذه الدرجة وبهذا الإجماع أنه لن يأخذ حقه بدوره فى مثل ذلك، وقد ينوء بحمله، أو تتعثر خطاه، المعنى الأصعب هو أن يستمد هو معنى وجوده من هذه الطمأنينة إليه، والاعتماد عليه، فتتوقف خطى نموه شخصيا.
فى العلاج النفسى ينبغى أن يكون المعالج على وعى كامل باعتماده على مرضاه، أو بتعبير أشمل وباعتماده على اعتماد مرضاه عليه.
وفى العلاج النفسى الجمعى خاصة قد يظهر مثل هذا الشخص المغرى بالاعتماد عليه من الجميع، فيقوم بهذا الدور المـُطـَمـْئـِن طول الوقت (على العمال على البطال)، فيعوق مسيرة اعتماد الآخرين على أنفسهم بشكل ما، ويستمد وجوده – على حساب نموه شخصيا – من ذلك الاعتماد الذى يلعب فيه بشكل غير مباشر دور المعالج Playing Psychiatry .
نبدأ المتن قائلا:
(1)
وعيونه الرايقه الهاديه،
قال إيه؟! بتطمن ؟!!
بس أنا مش قادر اتطمن،
أصله بعيد عن بعضه قوى!!
ينبغى أن نفرق بين أن تكون مستويات الوجود البشرى للفرد بعيدة عن بعضها، من أن تكون متصارعة مع بعضها من أن تكون متصادمة مع بعضها.
وعلى الجانب الآخر أن تكون: متعاونة مع بعضها، أو متفقة ساكنة مع بعضها، أو متكاملة فى بعضها.
فى هذا التشكيل نحن أمام أول صفة: أن تكون بعيدة عن بعضها.
وصلنى أن هذا البعد الذى بدا لى أكبر من تصور الجميع (ومن هنا ثقتهم واعتماديتهم) هو نتيجة لتنامى قشرة صلبة اضطر صاحبها لتقويتها بكل ما أوتى من صبر وعناد، وقد رجحتُ أن ظروف الواقع طوليا قد اضطرته أن ينمى هذه القشرة لمواجهة العالم الخارجى القاسى المتحفز من البداية، هذا الاضطرار هو مشروع من حيث المبدأ، شريطة أن يكون مرحليا، أما إذا كان نهائيا وثابتا حتى تطغى هذه القشرة على حاجاته الفطرية وحقه فى الضعف والأخذ، فإن الأمر يصبح تقزيما وإعاقة دائمة معجزة.
أن يبتعد بعضنا (مستوى من مستويات وجودنا) عن بعضنا (مستوى آخر) هو مقبول لو كان مرحلة ضرورية لها عمرها الافتراضى، ثم تنبعث الحركة وتتغير المسافات باستمرار.
فى العلاج النفسى كثيرا ما نواجَه بهذه القشرة القوية لدرجة تكاد تهدد باحتمال أن التوقف دائم وأنه لا سبيل إلى التعتعة للتقريب بين المتباعدين، وعلينا أن نحترم ذلك، ونعطى الفرصة الكافية من الزمن والإصرار، ونحن حريصون كل الحرص ألا ننخدع بحركة زائفة، أو عقلنة تعلن الحاجة إلى الحركة، لكنها لا تؤدى إلا إلى مظهر الحركة دون حركة، بمعنى الحركة الزائفة (أو المغلقة فى المحل) بشكل أو بآخر.
فى اضطراب الشخصية، وفى العصاب المزمن، وفى فرط العادية Hyper–normality نقابل هذا الابتعاد ويحتاج الأمر إلى ما ذكرنا.
فى المرض النفسى الجسيم العقلى-الجنونى، تتشقق هذه القشرة وتنفلت منها فقاعات طاقة عشوائية، أو تتكسر تماما، ويحدث التناثر.
وقد يتم التفاهم أو التعاون بالتناوب بين المستويين (أى مستويين أو أكثر) مما يتفق مع قانون جيد هو أساس جوهرى فى تفكيرى، ألا وهو الإيقاع الحيوى، ويحدث هذا التناوب عند كل الناس بطريقة منظمة أظهرها التناوب بين النوم واليقظة، وبين الحلم واللاحلم أثناء النوم، وكذلك التناوب بين العمل والراحة، بين المنطق الأرسطى والانطلاق الخلاق، ولكن هذا التناوب يكون صحـِّـيا وصحيحا إذا لم يتم فى دائرة مغلقة، وهو يصبح ضابط إيقاع التكامل حين تنتهى كل دورة أعلى من موقعها بأى قدر حتى لو لم يكن النمو ملموسا حالا.
هذا هو ما نأمل أن نوضحه فى مسيرة كل من العلاج النفسى، والنمو، فما العلاج النفسى إلا موجز مهنى مبرمج يتوجه نحو إطلاق سراح الطبيعة فى نبضها النامى، المفروض أن العلاقة بين هذين المستويين تنقلب بفضل هذا النبض الحيوى إلى تناقض تأليفى حيوى نابض، فيصبح عمل القشرة فى ذاته إثراءا للجوهر الأعمق، ويصبح الجوهر الأعمق هو الطاقة المختزنة القادرة على خلخلة جمود القشرة، ومن ثم تهيئة مسامية سامحة منضبطة فى نفس الوقت، ولا يتم هذا التكامل إلا بحوار تطورى يؤلف بين الأضداد دون تسوية حلوسطية.
حاولت أن أرصد مثل هذا النبض بطريقة تطمئننى إليه مثل سائر المطمئنين، فعجزت، وكثيرا ما عزوت هذا العجز لطمعى فى تحريكه، ربما لنفسى، أكثر مما ينبغى، أو يستطيع.
البعد بين أجزاء صاحبنا (أصله بعيد عن بعضه قوى) لم يصلنى فى شكل الصراع أو التصادم، وإنما حضرتنى صيغة أكثر عدلا، فأسميته “تصالحٌ مؤجَّل“، وقد كان علىّ أن أرصد محاولات اقتراب صاحبنا هذا من بعضه قبل أن أسمح لنفسى بالتفاؤل باستمرار مسيرة التكامل.
فى العلاج النفسى، لا بد من هذا الإصرار على رصد أية بارقة حركة مهما ضؤلت أو خفت صوتها، إن أى تراخ يبعد بنا عن صلابة التفاؤل من خلال احترامنا المطلق للطبيعة البشرية هو ضد ما هو علاج نمائى حقيقى، الأمر الذى أُصـِـرّ على ترادفه بأنه ضد “خلقة ربنا”. (ربى كما خلقتنى).
شايف حاجـتـين بقليله:
إشـِى جـُوَّهْ قـوى. . قـوى خـالـص،
واشى بـره قوى .. قوى خـالـص،
والـِهـّـو بنـاتهـــم بيخوف.
(2)
نظراته تمــــــــــد.
وسْـــكاتــه يـخـض،
وحســــابـــه يـْعِـــد.
ويبقــلـل لما بيضحك،
وبيـضحك لما بـيـسكـت،
وبـيـسكت لـمــا بـيـحس.
راكن على سور التراسينه،
كما زير فـخـار شـكـلـه مـزوق.
والعطشان مـنا يروح جنبه،
يمكن يشرب.
ولأن هذا البعد بين أجزاء صاحبنا ليس صراعا أو تصادما، فإنه كان كثير الصمت، حاد الانتباه، حاذق الحسابات، إلا أن ذلك كله كان مدعاة لتساؤلي وانتظارى للمفاجآت.
كان هذا الوجود الخاص المتباعد عن بعضه إلى هذه الدرجة – من وجهة نظرى – يعلن العجز عن التعبير عن الخبرة الداخلية أو معايشتها إلا بتفجرات تكاد تصل إلى ما يشبه التشنج أحيانا، كانت أحيانا تفجرات ضاحكة، وأحيانا انقضاضات صاعقة، يتبادل ذلك مع صمت دفاعى ممتد، وكأنه قلب النبض الحيوى المتبادل إلى نبض آخر (فى المحل غالبا) بين طورين بديلين هما: الانقضاض الصارخ، والانسحاب الصامت. صمته هذا كان يصل إلى الأغلبية على أنه حكمة هادئة، فى حين أننى كنت أشعر وراءه بمزيج من خوفه الذى قد يصل إلى الجبن، واحتمال التأجيل الذى يدل على متانة الأمل فى الخطوة الواثقة التالية، فأطمئن إلى التفسير الأخير، لكن لا يستمر هذا الاطمئنان طويلا.
فى العلاج النفسى، لا ينبغى أن يسمح المعالج لنفسه بالاستقرار فى مرحلة معينة أكثر من اللازم، إن ما يصلنا من معلومات نبنى عليها رأينا فى مرحلة ما، هو مجرد فرض قابل للاختبار باستمرار على طول مسيرة العلاج المتغير أبدا.
(3)
وارجع وأشك ف تسهيمـْتـُــهْ:
ما يكونشى الزير دا مـْنـَحـَّس؟
ولا هـَوَا يـلطـُشـُهُ ولا يـِبـْـرَد،
ولا بيطرّى عالقـــلب.
الاقتراب من هذا التركيب المتباعد عن بعضه، الصلب القشرة، الواعد بتفاؤل هادئ عنيد، المهدد بتفجر صاخب خطر، ينبغى أن يتم بمنتهى الحذر حتى لا يتفجر منك بغير احتمال رأب الصدع، وهنا تصبح الحسبة مع مثل هذا التركيب من أصعب ما يمكن، لكن لا مفر من المحاولة، كنت كلما اقتربت منه بأمل أن يطمئن هذا الذى يطمئن إليه الجميع فيحرمونه من حقه فى الطمأنينة بدوره، كان يقابلنى بمقاومة لا حدود لها، تظهر فى اعتراضات غاضبة، أو انفجارات صاخبة، أو عشوائية، وكل ذلك لا يسمح بأى تمهيد للسبيل إلى تواصل مهما بدت المحاولات جادة من الجانبين.
مـَانـَا كل ما اجرّب أمّيـله حبّـه: بـيـكَـْركـَرْ، وْيـِبـَقـْـلِـلْ،
والميه لما بتنزل – إذا نزلت – بـتـْطـَرطـَـشْ،
وتغـَّرق وشى قبل ما تـوصـل زورى،
إذا وصـلـت خـالـص.
فى العلاج الجمعى خاصة يكون الأمر شديد الصعوبة، وبالتالى فإن الحذر وضبط الجرعة هو من أهم أسلحة التعامل مع مثل هذا التركيب، وقد كنت أخشى طول الوقت أن يكون هذا الصمت والحكمة المبكرة هو نوع من الدفاع الخادع الذى يبدو كأنه الحكمة، وهو ليس سوى الحذر من الاقتراب.
اقتحام هذا التركيب بالتلويح بالعطاء، والطمأنة، والاقتراب الواعد، يـُقابـَل عادة بالرفض، والتأجيل، والثقة بالقدرة على الاعتماد على النفس، دون حاجة لأى عون خارجى، وبـِرفضٍ عنيف لأى مبادرة بالعطاء مهما كانت جادة وأصيلة.
(4)
وأحاول أخـْـرُم حَــلـْـقُـهْ،
أو اصـنْـفـَـر جلده.
وصاحبنا يـزرجن ويقوللى:
”أنا حا تصنفر من جوه”.
ينفخ نـفـسه ويْـبـَعـْـجَـر،
وأخاف يـتـفـجر.
لا ينبغى أن تؤخذ هذه الدرجة من المقاومة على أنها علامة سلبية تحول دون استمرار العملية الآملة فى إزالة عرقلة حركية النمو، إن المبالغة فى الحرص على الاستقلال، وعلى تفضيل البدء من داخله دون اعتمادية (أنا حا تصنفر من جوه)، قد تثبت فى النهاية أنها طريق أضمن تجنبا للتقليد أو الاعتمادية أو التبعية.
فى العلاج النفسى الجمعى خاصة تصعب تماما التفرقة بين هذا العناد الاعتزازى الصريح الواعد بانطلاق مستقل منضم إلى التوجه المشترك المحيط، وبين العناد المغرور المعتز بذاته على حساب أى علاقة حقيقية فيها تهديد لما استقرت عليه صورة الذات بما يشمل الثقة المفرطة التى تصل إلى الغرور.
وما دمنا نتكلم عن “فقه العلاقات البشرية“، فدعونا نتعرف بأمانة على هذه الصعوبة الجديدة من شخص له كل هذا الحضور الواعد الإيجابى، ومع ذلك هو يمارس كل هذه المقاومة بكل هذا العناد الذى قد يتمادى حتى يحمّل صاحبه ما لا طاقة له به، مما قد يوقفه فى النهاية، هذا بعض ما حيرنى طول الوقت وأنا أصر على ترجيح إيجابية محاولته.
(5)
وأبـَحـْلـَق جوا عنيه:
يتهيأ لى الهِوْ بيصغر،
ويقـرب حـبـّه مـن نـفسـه
ويقـرب بعضـه عـلى بـعـضه
واسمع لـك قـَرْش سـْنـَانُـهْ،
وعنيهْ بتـطـَقّ شرار،
وصـْدَاغـُه بتنفخ نار.
المسار الصحيح على طريق النمو هو أن تكون المسيرة صحبة إيجابية، صحبة تسمح “بالانفراد” بقدر ما تمارس احترام المسافة والاختلاف، وفى نفس الوقت تكون حاضرة جاهزة لرفض الانسحاب مهما بلغ الخوف من الاعتماد والتبعية، لا أريد أن أكرر تعبير “أن تكون وحدك مع” To be alone with ([43]) بشكل يفقده أهميته، دعونا نبتدع تعبير “أن تكون نفسك معهم وبهم” بدلا من “أن تكون وحدك مع” ونترجمه بالمرة حتى لا يزعل أحد To be yourself along with = them .
الإنسان (مريضا أو متطورا) يحتاج إلى رفيق سلاح، ولا يحتاج إلى محفة نقل، ولا إلى مخبأ مصفحة، وهكذا، هكذا فقط يمكن أن تقترب أبعاضنا من بعضها، مهما بلغت المشقة وتضاعف الجهد.
(6)
لا يا عمْ، الطـيب أحـسـن.
مالناش غير إننا نمـشـى، ونمـشـى، ونمـشـي.
وما دام ما احناش حا نبطـل،
يبقى لمْ بد حانوصل.
يا حلاوة المشى الجدْ
حتى لو قال العنْد:
لأَّهْ، مش عايز حَدْ.!!
فى النهاية – كما هو فى البداية – فإن الضمان الأوحد على طول الطريق مع اليقين بالمعْيه، هو الاستمرار بجدية الكدح المثابر، أما تبادل الطمأنينة مؤقتا فهو دور محدود، وقد يكون مقبولا لفترة، ولكنه لا يقوم مقام “جهاد البقاء” وهو الجهاد الأكبر.
مواصلة السير، مع الائتناس بأن هناك من يقوم بنفس المحاولة، لنفس الهدف العام هو السبيل الوحيد للطمأنينة والأمان، ومن ثم النمو.
وهكذا تصبح كل صعوبة هى بعث لأمل واقعى جديد.
***
ثم نختم كالعادة بالقصيدة مجتمعة:
(1)
وعيونه الرايقه الهاديه،
قال إيه؟! بتطمن ؟!!
بس أنا مش قادر اتطمن،
أصله بعيد عن بعضه قوى!!
شايف حاجـتـين بقليله:
إشـِى جـُوَّهْ قـوى. . قـوى خـالـص،
واشى بـره قوى .. قوى خـالـص،
والـِهـّـو بنـاتهـــم بيخوف.
(2)
نظراته تمــــــــــد.
وسْـــكاتــه يـخـض،
وحســــابـــه يـْعِـــد.
ويبقــلـل لما بيضحك،
وبيـضحك لما بـيـسكـت،
وبـيـسكت لـمــا بـيـحس.
راكن على سور التراسينه،
كما زير فـخـار شـكـلـه مـزوق.
والعطشان مـنا يروح جنبه،
يمكن يشرب.
(3)
وارجع وأشك ف تسهيمـْتـُــهْ:
ما يكونشى الزير دا مـْنـَحـَّس؟
ولا هـَوَا يـلطـُشـُهُ ولا يـِبـْـرَد،
ولا بيطرّى عالقـــلب.
مـَانـَا كل ما اجرّب أمّيـله حبّـه: بـيـكَـْركـَرْ، وْيـِبـَقـْـلِـلْ،
والميه لما بتنزل – إذا نزلت – بـتـْطـَرطـَـشْ،
وتغـَّرق وشى قبل ما تـوصـل زورى،
إذا وصـلـت خـالـص.
(4)
وأحاول أخـْـرُم حَــلـْـقُـهْ،
أو اصـنْـفـَـر جلده.
وصاحبنا يـزرجن ويقوللى:
”أنا حا تصنفر من جوه”.
ينفخ نـفـسه ويْـبـَعـْـجَـر،
وأخاف يـتـفـجر.
(5)
وأبـَحـْلـَق جوا عنيه:
يتهيأ لى الهِوْ بيصغر،
ويقـرب حـبـّه مـن نـفسـه
ويقـرب بعضـه عـلى بـعـضه
واسمع لـك قـَرْش سـْنـَانُـهْ،
وعنيهْ بتـطـَقّ شرار،
وصـْدَاغـُه بتنفخ نار.
(6)
لا يا عمْ، الطـيب أحـسـن.
مالناش غير إننا نمـشـى، ونمـشـى، ونمـشـي.
وما دام ما احناش حا نبطـل،
يبقى لمْ بد حانوصل.
يا حلاوة المشى الجدْ
حتى لو قال العنْد:
لأَّهْ، مش عايز حَدْ.!!
اللوحة الرابعة عشر:
دراكيولا

هذا التشكيل مستوحى من تصور مبالغ فيه عن نوع من العلاقات بين البشر، هو أقرب إلى التهلكة المتبادلة، وإن كانت تسمى فى بعض مراحلها بنفس الاسم: “الحب”، هو تشكيل من أبشع ما تصورت (وبينى وبينكم، ما عايشت) مما أسميه أيضا “الصفقات القاتلة لطرفيها“، برغم أنه شائع تحت نفس الاسم (مرة أخرى:) “الحب”.
هذه علاقة تتجاوز كثيرا صفقة الاحتياج المتبادل، والتأمين الثنائى([44])، وهى أيضا تعرى مستوى أخطر وأخبث لا يقارن بمستوى ما سبق أن نقدناه من الغمر بالحنان حتى الإغراق بلا علاقة حقيقية، مثلما ورد فى (اللوحة العاشرة: “الحب بالراحة”).
ترددت كثيرا فى محاولة مواجهة هذه الخدعة، وتشريح أبعادها، ولكنى لم أملك إزاء حقيقة ما وصلنى من مخاطرها وخداعها إلا أن أعريها وهى بكل هذه البشاعة، والإيلام معاً.
التناول هنا يعرى تلك الطبقة الأعمق من النفس البشرية التى لا تحقق أمانها إلا من خلال الالتهام المسعور، بكل عواقبه السلبية حتى: الهلاك والإهلاك.
الموت الذى يتكرر ذكره هنا هو نوع آخر من المفاهيم التى استعملت فيها نفس اللفظ “الموت”، هذا النوع من الموت المذكور هنا يمكن أن يطلق عليه “حركية العدم“، وهو غير “الموت السكون ضد الحركية” أصلا، وهو أيضا غير “الموت الهيام التلاشى” فى بعضنا (باموت فيه ويموت فيّا)، كل هذه تنويعات لبعض أشكال الموت بمعناه السلبى الساكن العدمى، أما الموت الذى سبق أن تناولته باعتباره “نقلة الوعى الشخصى إلى الوعى الكونى“، وأيضا باعتباره “أزمة نمو”، فهو عكس كل هذا الإهلاك والعدم والإعدام على طول الخط.
الموت هنا فى هذا التشكيل هو خليط من أنواع المجموعة السلبية الأولى، وهو أقرب إلى غريزة الموت التى قال بها سيجموند فرويد ولم يتعهدها بالقدر الكافى، وهى الغريزة المسئولة عن التدمير، والتهلكة، والانسحاب فالعدم، ضد الحب والقرب والإبداع وإعادة الولادة، والتعرية شديدة الصعوبة حيث الخلط وارد، والإنكار جاهز، والأسماء التى يسمى بها هذا الموت قد تكون العكس تماما،(تصور أنه يـُسـَمـّى أيضا!!: “الحب”!).
(1)
……….
أنا مــش عندى إلا الموت.
باشترى بيه الناس وباسمّيه “حب”.
والناس عايزه تحب تحب تموت،
أيوه تموت،
جوا بطن الحوت
هذا التشكيل هو أخطر أنواع ما يسمى الحب الثنائى حصريا (إن صح التعبير)
نقد الحب الثنائى المتفرد وارد منذ أفلاطون الذى نقده ووصف حبا أرحب وأرقى، فاتهموه ظلما بأنه دعى إلى ما تصوروه أنه ”الحب العذرى”، حتى أصبحت كلمة الحب الأفلاطونى دالة على الخيال واللاواقعية وهى غير ذلك، حقيقة أن الإنسان برغم مرور آلاف السنين لم يرتق بعد إلى ممارسة القدرة على الحب انطلاقا من هذا الحب الثنائى، الحب الثنائى طبيعة حيوية بشرية، وتنظيم اجتماعى، وتطور طبيعى، لكن ليس على حساب القدرة على الحب، أو على حساب الانطلاق منه إلى مزيد من الحب، التوفيق بين هذا الحب الثنائى والحفاظ على القدرة على الحب إنما يتم بأن يكون الشريك هو ممثلا للجنس الآخر، أو للجنس البشرى عامة، بما عبرت عنه هكذا: “أحبك بالأصالة عن نفسك، والنيابة عن سائر النوع، أو سائر البشر”، وهو ما تبينت صعوبته حتى الرفض.
أن تكون العلاقة الثنائية مجرد تنظيم اجتماعى ودينى يحتوى حب اثنين فأكثر، هو أمر طبيعى ومهم ووارد باعتباره اختبارا للتطور والتكامل معا، بما يتيح أيضا أفضل مجال صحى لتربية الأطفال، لكن الانطلاق منه إلى حب أكبر فأكبر، ليس على حسابه، (ليس على حساب الحب الثنائى) هو أمر صعب كما بينّا أكثر من مرة، كما أن العجز عن تحقيق ذلك الحب الممتد الأكبر لا ينبغى أن يقلل من ضرورة السعى لتحقيقه، فهو الحب الأرقى والأبقى حتى لو أجلت ممارسته على أرض الواقع مهما أجلت، إن الصعوبة لا ينبغى أن تنتقص من لزومه أو تخدش من صلابته، (دع جانبا الآن العوامل التى تسمح بذلك سواء فى الفرد أو فى المجتمع أو فى التربية أو فى العلاقة بالكون… إلخ).
فى نفس الوقت علينا أن نحترم النقد المتواصل لأنواع الحب الأخرى، لأنها ليست كلها سطحية أو بلا لازمة، ولكن لأنها تعلن عن مرحلة نقص رائعة، ربما ضرورية، على طريق مسيرة الإنسان الحالية. إن فشل المؤسسة الزواجية الذى تُعلَنُ زيادته باستمرار، هو بمثابة دعوة إلى الانتقال منها وبها إلى ما يعد به التقارب بين البشر من تطور وتكافل لصالح النوع كافة.
أود لو أعتذر ابتداء عن البشاعة التى قد رسمتُ بها هذه الصورة (كما سترد: هكذا)، إلا أنى لا أملك أمام التزامى بمحاولة الصدق فى تقديم ما رأيت – فحرّك شعرى إلى تشكيل هذه اللوحة– إلا أن أقدمها كما وصلتنى فشكــَّلتها بما رأيت، وقد ترتب على ذلك أننى لم أعلق على بعض أصول المتن، مع إثباتها فى النهاية مع ذكر المتن مجتمعا، وقد يغفر لى ما انفتح فى آخرها من باب أمل واعد برغم كل ما تقدم من قبح وموت والتهام وعدم، فلقد أطلَّ واثقا فى النهاية وصاحبة اللوحة تعلن عزمها وثقتها فى الانتصار على كل هذه السلبيات المتوحشة:
لو ما لاقيش الموت حوالىّ حاموّت موتى
…….
لحظة كل شواهد القبر تطلعّ خـُضـْرة
…….
لحظة طفلة صـْغـُيـًّرةْ ثايرة تـِقـْدر تـِقـْتـِل
تقتل وحش يمص الدم
ولكن دعونا نبدأ من البداية:
تبدأ الصورة، بتعرية تعلن أن المتحدثة البادئة هى العيون الأخرى (عيون جوه عيون بتقول = مستوى منظومى أعمق من الوعى)، وهى عيون تبدو محذِّرة (حاسب عندك)، لكنه ليس تحذيرا بالمعنى العادى، لكنه نوع من التحدى المنذر بالتمادى إن لم نتبه إلى جدية النذير.
وعيون جوا عيون بتقول:
حاسب عندك:
إوعى كـَـمـِنـَّك عطشان تـِعـْمـَى وتشرب منى،
أنا مــش عندى إلا الموت.
باشترى بيه الناس وباسمّيه “حب”.
والناس عايزه تحب تحب تموت،
أيوه تموت،
جوا بطن الحوت
والبوسـَهْ بـِتـْشلـِبْ دَم،
والـُحضن مـَغــَاره مـَلَانه البنج السـِّحـْر السـُّمْ.
يبدأ الطفل حديث الولادة فردا يتحسس طريقه خائفا من العالم الخارجى، وهو يبنى علاقاته الأولى مع هذا العالم بقوانين عدم الأمن (وهو الطور البارنوى أساسا) الذى اسميته لاحقا “الطور الكرّفرى” فيروح يمارس علاقته بالآخر من خلال الكر والفر، الذى هو اعتراف ضمنى بالآخر، برغم ظاهر الحذر واحتمال سلبية المآل، ومع ذلك فهى علاقة موضوعية لا تسمى حبا طبعا، لكن بها من التواصل ما يتفق مع قوانين هذا الطور، وقد يتعمق هذا الطور الكرفـّرى البارانوى بمزيد من عدم الأمان المتضاعف يتزايد حتى يبرر الانسحاب إلى حيث “لاموضوع” (الموقف الشيزيدى = الطور اللاموضوع)، وقد سبق أيضا الإشارة إليه فى نفس اللوحة.
“قاعد ساكت تحت سرير الست،
حاخطف حتة نظرة من ستى أو فتفُوتِه حُب، واجرى آكلها لوحدى،
تحت الكرسى المِشْ بَايِنْ”،
وقد يحل الطور البارنوى بحل أكثر عدمية، وذلك باقتحام التهامى يختفى معه الموضوع من العالم الخارجى فى داخل المهاجم الملتهم الخائف فى نفس الوقت، هذا ما أشرنا إليه سابقا فى نفس قصيدة القط أيضا:
“باكـُلْ الأطفال والنسوان المِلك”
دراكيولا هنا لا تلتهم الموضوع لتستمتع بذلك، بقدر ما أنها تلتهمه لتلغيه، هذه الصورة هنا تجسد الجانب الالتهامى أكثر، وفى نفس الوقت هى تعلن أن الضحية تشارك فى التسليم لهذا الالتهام، وأنها (الضحية) تتغافل – فى مستوى أعمق من الوعى- عن خطوره الجارى، حتى تسميه بنفس الاسم “الحب”، (والناس عايزة تحب تحب تموت)، لكن “دراكيولا” هنا تبدو أكثر أمانة وأقل مناورة، فهى تعلن أن هذا الذى تسميه الضحية حبا، ليس إلا الموت، وأن هذا النوع من الموت هو هو ما تستسلم له الضحية، وهو ما تنخدع فيه تحت اسم الحب، مع أنه – من نص أقوال الملـْتـَهـِم – ليس إلا الاحتواء الماحى داخل “بطن الحوت”، مع أن آثار الجريمة ماثلة للعيان، والدم يلطخ الشفاه
أنا مــش عندى إلا الموت.
باشترى بيه الناس وباسميه “حب”.
والناس عايزه تحب تحب تموت،
أيوه تموت،
جوا بطن الحوت
والبوسة بتشلب دم،
يبدو أن هذا النص فى المتن، يريد أن يؤكد أنه مهما تواتر هذا النوع من العلاقات، ومهما كان هو المتاح، إلا أن تعريته ربما تكون أول خطوة لتجاوزه.
أحيانا يكون الدافع لقبول هذا النوع من التسليم لمثل هذه العلاقة، وبرغم ما تحمل طبيعتها من إرهاصات الإلغاء والمحو بالالتهام وغيره، وأيضا برغم ما يعلن من أنه جريمة ملطخة بالدم، أحيانا يكون مطلوبا كنوع من التخدير، هربا من وحدة بشعة لا تطاق.
يقول المتن إن هذا النوع من الحب ما هو إلا الموت نفسه فى أخفى صوره، التخدير هنا ليس فقط تغييبا للوعى، لكنه تخدير بسم زعاف مدسوس داخل كهف العدم الذى يمثله هنا: “بطن الحوت”، ربما كرمز للعودة إلى الرحم القبر، (وليس الرحم لإعادة الولادة([45])= كما خرج يونس من بطن الحوت.
إن “العلاقة الثنائية” وجها لوجه، دون رابط جامع يجمعهما، ويتصاعد بهما إلى الآخرين فالمطلق، هى التى أنشأت كل هذه الصعوبات الحالية، وقد سبق أن أشرت بحذر شديد، إلى معنى “اجتمعا عليه”، و”افترقا عليه”، فى الحديث الشريف وأيضا “تحابا فيه”، وبالتالى فلابد من أن ثمَّ برنامجا آخر يلزم للحفاظ على التواصل والاستمرارية بين اثنين، التفرقة هنا بين العودة إلى بطن الحوت بلا رجعة، وبين العودة إلى الرحم (فى النوم، أو فى الحلم، أو فى النكوص، فى خدمة الذات([46])، هذه التفرقة يعززها الفرض الذى أقدم من خلاله فقه العلاقات البشرية هنا، هكذا:
إذا لم يتواجد وعى جمعى يجمع بين وعى الأفراد بعضهم لبعض، فإن الصعوبة تزداد أضعافا مضاعفة بالنسبة للعلاقات الثنائية حصريا،
ويضيف الفرض الذى أطرحه:
إن الوعى الجمعى نفسه يمتد فى وعى النوع إلى وعى الكون لتتواصل دورات التناسق بين هارمونية الذات وهارمونية الكون (إلى وجه الحق تعالى). فإذا أنكرت هذه الوصلة (تحت أى اسم) تتعرى هذه الصفقات المهلكة بمثل هذا التقارب القاتل لطرفيه، كما يعلمنا المتن.
والحضن مغاره ملانه البنج السحر السم.
وبــدال ما الزهره الطفله تنبت جوه الورده القلب،
بنبيع بعضينا لبعـــض، والقبض عـَـدَمْ.
ولا فيش معجزه حا تطـلع يونس زى زمان،
ولا فيش برهان،
نكــروا الرحمان.
تشريح واستئصال “سرطان” عدم الأمان
برغم أن عنوان الشرح بدأ بكلمة “فشل” ما هو: علاقة الموت المتبادل عدما“، مع أنه يسمى حتى لو حبا، إلا أنه لابد أن ما نشر من هذا التشكيل حتى الآن أثار نفورا واشمئزازا واستبعادا بشكل أدهشنى، علما بأن بعض هذه المشاعر كانت لدىّ شخصيا حتى أعلنت حرجى من تعرية هذا النوع من العلاقات كل هذه التعرية.
رجعتُ إلى المتن الشعرى قبل أن أكتب بقية الشرح، فوجدت أن القصيدة إنما تعلن فشل هذا النوع من التواصل العدمى مهما سمى “حبا” أو “عشقا” أو “غراما” أو “هياما”، بل إن التحذير من مضاعفات هذا الحب جاء بلسان “بصيرة” غائرة وحادة داخل “دراكيولا” نفسها طول الوقت تقريبا.
رحت أجمع من القصيدة (المتن) ما وصف هذا الحب الالتهامى (الجريمة المشتركة) الذى أسميته بصريح العبارة “التهلكة المتبادلة“، فوجدت أننى لم أورد على لسان دراكيولا، ولا الطفلة بداخلها التى انتصرت فى النهاية أية إشارة إلى أن هذا الجانب السلبى البشع يمكن أن ترجح كفته مهما بلغ عنفوانه وتغطرست قوته وتمادى تحديه.
مسحتُ بمقياس الأورام الذرى مساحة هذا الجزء الذى يمثل هذا الجانب السرطانى مصاص الدم، وفى نفس الوقت يعلن ألاعيبه ومناوراته، ثم قمت بتشريحه جراحيا حتى أتممت فصله عن الجزء السليم (الأصل) الذى يقاومه ويتحداه، وهو “خلقة ربنا” داخلنا، فاكتشفتُ أننى طوال الحدس الشعرى الذى أفرز القصيدة، كنت منتبها إلى قوة الفطرة فى الداخل التى تجسدت فى طفلة جميلة طيبة قادرة عملاقة وهى التى انتصرت فى النهاية.
شعرتُ وأنا أفعل ذلك أننى إنما أقوم بعملية جراحية صعبة، لاشك أنها قد تشوه المتن شعرا، لكننى أحسست أنه لا مفر من إجرائها لانقاذ الفطرة وإظهارها، فصلتُ الجزء السرطانى عن الفطرة القوية المتحدية، المنتصرة فى النهاية، فوجدت أن المسألة ليست بها أى لبس، وأن عملية استئصال السرطان قد نجحت وانتصر الحب الحياة، القدرة، الخلق، البناء، الإيمان على العشق الالتهامى، مصاص الدم، “الموت العدمى معا”.
قررت أن أغامر بعرض خطوات العملية ونتيجتها، بعد تشريح المتن واسئصال الورم، فأعرض الجزء السرطانى وحده أولا مستقلا، ثم أعرض ما تبقى من حياة ونبض بعد نجاح العملية سعيا إلى وجه الحق تعالى.
لست متأكدا إن كان هذا سوف يزيد الأمر وضوحا، أم أنه لن يقدم إلا مزيدا من التشويه للمتن الشعرى.
التشكيل التركيبى:
الفكرة التى قد تساعد على قبول إجراء هذه العملية أن فى هذا التشكيل المتداخل عدة كيانات معاً:
-
كيان ظاهر غير آمن، مرعوب ملتهم جائع، يندفع إلى احتواء “الموضوع” الآخر، حتى الموت العدمى، وهو (هى: دراكيولا) تتصور أن هذه هى الطريقة الوحيدة للحصول على الأمان وكأنه الحب:
هذا الكيان يعرف ماذا يفعل، وهو يحدد فريسته بشكل صريح، ولفرط ثقته بأنه قادر على التهامها، يحذر فريسته طول الوقت من أنها مسئولة ليس فقط عن مآلها العدمى، وإنما أيضا عن ضياعه هو، فهو يعرف فى قرارة نفسه أنه لن يحصل على الأمان مهما تمادى فى الالتهام ومص الدم “ولا يروينى إلا الدم، ولا يروينى الدم”
-
يوجد داخل هذا الكيان، كيان آخر،
“وعيون جوه عيون بتقول: حاسب عندك”،
هذا الكيان الناقد المتداخل يعلن كلاما فيه محاولة إيقاف التمادى فى طريق خاسر، لكنها بصيرة عاجزة تساعده فى النهاية على التمادى فى جريمة الإعدام الانتحارى.
“بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمَعاً”.
بصراحة هذا المستوى البصيرى الناقد محيـِّر فعلا، ذلك لأنه يبدو أنه يريد من يوقفه شخصيا عن التمادى فى هذا السعار الهلاكى حتى أنه يستنقذ بفريسته ألا تقبل التسليم له، ربما يكون فى ذلك إنقاذ لهما معا، لكنه فى نفس الوقت يشلُّ حركتها، الاستنقاذ يظهر جليا فى قولها:
“لو بتحب الدنيا صحيح: إوعى تسيبنى لنفسى”،
وأيضا هى تتهم فريستها أنها ترفض أن تتراجع عن التمادى فى التسليم بالالتهام، فالموت:
“بس الموت جواك بيقولـّى: “إوعِكْ تصحى”.
بلغت حدة بصيرة دراكيولا مصاصة الدم أنها أعلنت موقفا مـُرَاجِعا يتساءل:
ما الذى أتى بها إلى وسط هؤلاء الناس (الناس الذين يحاولون مع بعضهم أن يكسروا احتكار الحب الثنائى حصريا لتنطلق منهم القدرة على الحب)؟ ما الذى أتى بها إليهم بعد أن كانت قد ألغتهم من حسابها أصلا؟ هل كانت تناور؟ أم تخدع؟ أم توهم نفسها بأنها تريد أن تتراجع أو تتوب عن جرائمها المسعورة؟ حتى إذا عجزت عن ذلك، تمادت فى مص الدم والالتهام، فالإعدام المشترك.
” أيوه صحيح !!! أنا جيتكم ليه؟
أخفى جريمتى؟
جيت أتعلم لما أمصّ الدم ما بانـْشـِى؟ ما يـْطـَرْطـَشـِّى؟
جيتكو أموت وسطيكم يعنى، واسـْمـِى بـَاحـَاوِل، ولا ابيّنشى ؟”
برغم كل هذه البصيرة الناقدة المتسائلة، إلا أن هذا الكيان غير الآمن “دراكيولا” يتمادى فى جريمته وهو لا يفيق أبدا بمحض إرادته، إلى أن يأتيه الفشل/الإفشال من انتصار داخله الفطرى الأقوى “الطفلة الفطرة العملاق الطيب”.
حضور الفريسة فى القصيدة كان متوترا، لكنها لم تتكلم بلسانها مباشرة أبدا، ولم تدافع عن نفسها، مع أنها متهمة من جانب دراكيولا المفترسة مصاصة الدم، بأنها مشتركة فى عملية الإعدام المشترك، وذلك بالتمادى فى العمى إنكارا للعدم، مع أنها لا تحقق إلا العدم نفسه بهذا الاستسلام، ودراكيولا تتحدى فريستها (شريكها) أن تستغنى عنها:
“لو ما تخافشى الموت حاتشوفنى إنى الموت، وبامص الدم”
وهكذا لا يتحقق الوجود العدمى لكليهما إلا من خلال هذه المؤامرة العدمية الانتحارية معا:
“بكره حاتحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا”
وكل هذا نجد له بعض معالمه فى علم الضحيةVictimology الذى يفترض أن الضحية مشتركة فى فعل الجريمة.
وبعد
أقوم فيما يلى بإعادة تقديم أغلب المتن، بعد تشريحه بالعملية الجراحية، وفصل هذا عن ذاك، فأقدمه من جديد بالترتيب التالى:
أولا: السرطان (العدم المشترك) الذى تم استئصاله.
“الحب التهلكة معا”:
(1)
…..
أنا مــش عندى إلا الموت.
باشترى بيه الناس وباسميه “حب”.
والناس عايزه تحب تحب تموت،
أيوه تموت،
جوا بطن الحوت
والبوسة بتشلب دم،
والحضن مغاره ملانه البنج السحر السمْ.
وبــدال ما الزهره الطفله تنبت جوه الورده القلب،
بنبيع بعضينا لبعـــض، والقبض عدمْ.
ولا فيش معجزه حا تطـلع يونس زى زمان،
ولا فيش برهان،
نـَـكـَـرُوا الرحمان.
(2)
لكن الدم المالح ينزل يهــرى ف جوفى،
ويخلــينى أعطش أكتر.
ولا يروينى إلا الدم.
ولا يروينى الدم.
ولا يروينى إلا أشوفك ميت زيي.
وارمى مُصاصتك،
وأرجع أشكى وأبكى وأحكى،
”نفس القصـــة”.
(3)
بكره حا تحتاج موتى يا موتْ، ونموت جمعا.
بكره حاتحتاج تخفى جريمـتـك، جوا جريمتى،
بكره بتاع الناس بينور.
بكره بتاعى وحش يعوّر،
(10)
إوعى تلومني.
إنتَ عايـزنى كده.
تقتل روحك وبتتمسكن، وتقول حاسْبي؟
هوا انا ممكن أقتل إلا اللى اختار قتلـه؟
تبقى جريمة عاملها اتنين.
كل جريمة عاملها اتنين.
يبقى المقتول هوّه القاتل، أصله استسلم.
ثانيا: “الطفل الفطرة” (داخل كل هذه البشاعة)
(5)([47])
ولا كنت اعرفْ.…
ولا كنت اعرف إن الناس الحلوهْ كـْـتَارْ.
ولا كنت اعرف إن صْباع الرجل الحى،
أقوى كتير من مليون ميت.
….
وانا فرحانه،
وخايفه،
وعايزه،
ورافضه،
نوركم جامد يعمى عـنيه.
زى فراشه تحب النور،
تجرى عليه، وتحوم حواليه
وتموت فيه،
ترقص قبل ما تطلع روحها،
”آه يا حلاوه النور موِّتني”
لأ ماحصلشِى!!
….
هوا النور بيموّت برضه إلا الضلمه؟
بعدها نور الفجر بيشرق من جوايا.ٍ
(7)
بس انا خايفة
أصلى ضعيفةْ، وطفلة لـوحدى، وباحْبى فْ حجر الناس واتلخبط.
لأ، حاستني..، لأ مش طالـعـة.
خايفه لـدكـْهـَهْ تمثل دورى:
تختفى تحت الجلد، أو ورا ضحكة،
أو تتصرف زى الناصحة،
تعرض فكرهْ !!،
يمكن تنسُـوا.
وانت تعوزها تانى فى السر.
(8)
………..
ترجع برضه الطفلة تعافر، وبتستنجد:
شمس الحق اللى فى عـْـنِيكم تقتل ليلها اللى اسمه بكره،
ليل اللعبة الضلمة التانية،
ليل السرقة الوسخه العامية.
ليل الوغد يموّت روحى، وروحك فيـّه.
وغد الطمع الخوف الهرب الكـَلـْبشـَهَ فينا،
حاكم الخوف عايز يسحبنا بـعـيد وحدينا.
(9)
لكن الطفله الأصل الصَّحْ عفية وصاحية،
تضرب تقلب، وبتتنطط وبتتحدّى:
– أنا صاحيالـِك،
إنتى تموتى تروحى فْ داهيه، أنا ماباموتشي.
أنا باستنى اللحظة بتاعتى، علشان أطلع.
أنا جايباكى هنا برجليكى. . علشان أشبع.
من ورا ضهرك.
بعد شويه أجرى وابرطع.
غصبن عنـِّـك.
غصبن عنـُّه.
أنا طول عمرى واقفه استـنى اللحظه دهيه:
لحظة كل شواهد القبر تنبِّت خـُـضره.
لحظة كل الناس الحـلـوه تموّت موتي.
لحظة طفله صغيره ثايره، تقدر تقتلْ.
تقتل وحش يمص الدم.
لحظة لما الله سبحانه يرضى عليّأ
أحلف يحصلْ
أصله وعدنى
وانا صدَّقـتُهْ
ملاحظات مضافة:
وجدت هنا فرصة للكشف عن مزيد من معالم ما أسميناه سابقا “الارتباط التحطيمى التهلكى”، وهو ما أسميناه “الارتباط التهلكى المتبادل”، وأيضا: “الحب التهلكة معا”.
ينبغى أن نؤكد مرة أخرى على ما أشرت إليه من أن كل أنواع العلاقات يمكن أن تعتبر مرحلة، بما فى ذلك هذا الارتباط التهلكى، إذ أنه من البديهى – إلا فى الحالات المرضية فعلا، ولو لم تـُسـَمَّ كذلك – أنه بمجرد أن يشعر أحد الطرفين، أو كلاهما، أنها تهلكة، فسوف يجد نفسه مضطرا إلى فصم هذا الارتباط، أو استبداله بما هو أقل خطرا منه، وهكذا
ثم إننى لاحظت: أن النوع التكافلى (رقم “1” الذى هو الأفضل) قد ركز على توصيف إيجابيات هذه العلاقة بين “اثنين” بما فيها من حركة وتنوع، ومسافة، وفائدة لكلا الطرفين، دون إشارة ولو ضمنية إلى امتداد هذه العلاقة الخلاقة – بطبيعتها – إلى الآخرين بما أسميناه فى “القدرة على الحب”، وهو ما ورد فى هذه اللوحة مثل التأكيد على
“أن الناس الحلوة كتار”
وأن “صباع الرجل الحى أقوى كتير من مليون ميت!!”
وهو ما ركزنا عليه كعلامة على نوع الحب الإيجابى الذى يبدأ باثنين ولا ينتهى بهما، أى الذى يكون فيه حب الاثنين لبعضهما هو المدخل إلى حب الآخرين، فالتناغم مع الطبيعة، فالمطلق، وهذا ما وصفناه بالتوجه نحو القاسم المشترك الأعظم، إلى وجه الحق تعالى. هذا الامتداد التلقائى تناغما وتناسقا وصلاة وإيمانا (بكل التشكيلات الإبداعية الممكنة)، هو نوع الحب الذى لا يحل محل الحب الثنائى ولا يستغنى عنه، لكنه ينطلق منه.
العلاج النفسى فيه كل هذه الاحتمالات:
أما علاقة فقه العلاقات البشرية، بالعلاج النفسى، وبهذا الفرض فهى علاقة وثيقة ومباشرة، من حيث إن العلاج النفسى هو مساعدة المريض لاستعادة خطى نموه وتوازنه إنسانا يعيش مع آخرين، ليتميز إنسانا أكثر فأكثر، وذلك من خلال علاقة بشرية بإنسان آخر (المعالج) له خبرة فى تنظيم هذه المسائل، وفى نفس الوقت يسير هذا المعالج فى نفس الاتجاه وهو يواصل مسيرته، سواء فى مهنته أو فى مسيرة حياته شخصيا (المفروض يعنى) بنفس الصعوبات التى يعايشها مع مريضه.
تتجسد العلاقة الثنائية وتتطور فيما يسمى “العلاج الفردى”، ثم تختبر وتتاح الفرصة إلى الانتقال منها/بها – دون إلغائها – إلى العلاقة الجماعية فى كل من “العلاج الجمعى” و”علاج الوسط”، هذه هى الحكاية.
وطبعا ثمــَّة احتمالات أخرى حين نواجه أثناء العلاج أنواعا أخرى من العلاقات، وهى تعتبر من “مضاعفات” العلاج النفسى بجرعة تزيد أو تنقص نتعامل معها أثناء الإشراف.
وبعد
فإن إعادة عرض اللوحة الشعرية كاملة كما ظهرت مباشرة من الحدس الشعرى قد يحمل رسائل لم يستطع الشرح أن يلم بها وها هى ذى القصيدة من المتن هنا وليس من الديوان بعيدا عن العملية الجراحية التشريحية:
(1)
وعيون جوا عيون بتقول:
”حاسبْ عندكْ”! .
إوعى كـمنك عطشان تعمى وتاخد منى،
أنا مــش عندى إلا الموت.
باشترى بيه الناس وباسَمِّيه “حب”.
والناس عايزه تحب تحب تموت،
أيوه تموت،
جوا بطن الحوت
والبوسهْ بتشلبْ دم،
والحضن مغارَه ملانَهْ البنج السحر السم.
وبــدال ما الزهرهْ الطفلهْ تنبت جوه الورده القلب،
بنبيع بعضينا لبعـــض، والقبض عدم .
ولا فيش معجزه حا تطـلع يونس زى زمان،
ولا فيش برهان،
نَكَــرُوا الرحمان.
(2)
لسه عيونها بتقول:
إوعـــك منى ..!
… لو بتحب صحيح ما تصحصح.
لو تتأمل حبه حا تعرف،
لو ماتخافش الموت حاتشوفنى إنى الموت،… وبامصّ الدم .
لكن الدم المالح ينزل يهــرى ف جوفى،
ويخلــينى أعطش أكتر.
ولا يِرْوينى إلا الدَّمْ.
ولا يروينى الدَّمْ.
ولا يروينى إلا أشوفك مَيِّت زيِّي.
وارمى مصاصتك ،
وارجع أشكى وأبكى وأحكى،
”نفس القصـــة”.
(3)
لو ماتخافشى الموت: مُوِّتنى،
موِّت موتى،
لو بتحب الدنيا صحيح، إوعى تسيبنى لنفسي.
(4)
بس الموت جواكْ بيقولىِّ: إوعِكْ تصحى .
(5)
أيوه صحيح أنا جيتكو لوحدى !
جيتكم ليه ؟
أخفى جريمتى ؟
جيت أتعلم: لما أمصّ الدم ما بانـشى ؟
ما يطرطــشى ؟
جيتكو أموت وسطيكـم يعني؟
واسمْىِ باحاَوِلْ ؟
ولا بَيِّـنْـشى ؟
(6)
إنما باظت منى اللعبه،
ولا كنت اعرف.
ولا كنت اعرف إن الناس الحلوه كتار.
ولا كنت اعرف إن صباع الرجل الحى،
أقوى كتير من مليون ميت.
آه ياخساره فقستوا اللعبه.
وانا فرحانه،
وخايفه،
وعايزه،
ورافضه،
نوركم جامد يعمى عْـنَيَّه.
زى فراشه تحب النور،
تجرى عليه، وتحوم حواليه
وتموت فيه،
ترقص قبل ما تطلع روحها،
”آه يا حلاوه النور مُوِّتنْي”
هوا النور بيموت برضه إلا الضلمه ؟
بعدها نور الفجر بيشرق من جوايا.
(7)
بس انا خايفة
أصلى ضعيفة، وطفلة لـْوَحدى،
وباحْبِى فْ حجْر الناس واتلخبط.
لأ، حاستني..، لأ مش طالـعـهْ.
خايفه لـِدكْـهَـهْ تْمَثِّل دورى:
تختفى تحت الجلد، أو ورا ضحكة،
أو تتصرف زى الناصحة ، تعرض فكره،
يمكن تِنْسُوا.
وانت تعوزها تانى فى السر.
(8)
دكــهه التانية الوغدة تقول:
بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جَمَعاً.
بكره حاتحتاج تخفى جريمـتـك، جوا جريمتى،
بكره بتاع الناس بينور.
بكره بتاعى وحش يْعَوَّرْ،
آه فين بكره، آه من بكره.
(9)
ترجع برضه الطفلة تعافر، وبتستنجد:
شمس الحق اللى فى عنيكم تقتل ليلى اللى اسمه بكره،
ليل اللعبة الضلمة التانية،
ليل السرقة الوسخه العامية.
ليل الوغد يْمَوِّت روحى، وروحَك فَيَّا.
وغد الطَّمِع الخوفِ الهربِ الكَلْبشة فينا،
حاكم الخوف عايز يسحبنا بـعـيد وَحِدْينا.
(10)
بس التانية الناصحة كهينهْ وعارفه طريقها:
واقـفه تعايـره:
إوعى تلومنى، إنت عايـزنى كده.
تقتل روحك وبتتمسكن، وتقول حاسْبي؟
هوا انا ممكن أقتل إلا اللى اختار قتله ؟
تبقى جريمة عاملها اتنين.
كل جريمة عاملها اتنين.
ذنب المقتول زى القاتل، أصله استسلم.
وانا حذرته وقلتله حاسب.
إوعك تعمي.
إوعى لاموتك يحـليلى موتي.
أنا نبـهتك .. إوعك تنسي.
لو مالاقيش الموت حوالَيَّا، حَامَوِّتْ موتي.
………………
لكن الطفله عفية وصاحيه، تضرب تقلب، وبتتنطط:
- أنا صاحيالك،
إنتى تموتى تروحى ف داهيه، أنا ماباموتشي.
أنا باسْتَنَّى اللحظة بتاعتى، علشان أطلع.
أنا جايباكى هنا برجليكى .. علشان أشبع.
من ورا ضهرك .
بعد شويه أجرى وابرطع.
غصبن عنك .
غصبن عنه.
أنا طول عمرى واقفه استـنى اللحظه دهيَّا:
لحظة كل شواهد القبر تْزَرَّع خُضْره.
لحظة كل الناس الحـلـوه تْمَوِّت موتي.
لحظة طفله صغيره ثايره، تقدر تقتل.
تقتل وحش يمص الدم.
لحظة لما الله سبحانه يرضى عليَّا:
”أحلفْ، …. يِحْصَـلْ.
أصلــه وعـدنـى ،
وانا صدَّقـْـتــُــه.
اللوحة الخامسة عشر:
يا ترى ([48])
أما قبل
هذه هى آخر لوحة تشكيلية مستلهمة منهم، وهى تقع فى موقع متوسط بين ما أشرتُ إليه مما نبهت أنه أقرب إلى السيرة الذاتية، وبين ما استلهمته من أقرب من سمحوا لى بالاقتراب، وهى كما ننوه دائما مع كل لوحة، لا تصف شخصا بذاته إلخ…
تقديم
الرؤية الموضوعية هى مشكلة الوجود، ولا يدّعيها أحد إلا إن كان لا يعرف حقيقة ما تعنى، إنها أقرب إلى بعض صفات ما يسميه ماسلو “الوجود شبه الإلهى”، وقد تصورت أيضا أن تصاعد درجات الوعى عند هيجل إنما يرسم سهاما نحو الطريق إلى احتمال مثل هذه الرؤية الموضوعية المطلقة، كما أعتقد أن معظم التطورات فى مناهج البحث والمعرفة حاليا، إنما تعلن أمرين معا: عجز الإنسان فى مرحلته الحالية عن الرؤية الموضوعية، وحاجته الشديدة إليها فى نفس الوقت.
الذى يجعل الرؤية ذاتية (ضد موضوعية) هو “حالة احتياج” الإنسان أساسا، بما يستتبع ذلك من تحيز وهوى وخوف وتفكير آمـِل… إلخ.
صاحبة هذه الصورة، أعنى من استلهمتُ من حضورها هذا التشكيل، أقرب الناس إلىّ، وحاجتى إليها لا سبيل إلى إنكارها أو التخفيف من قدرها، ولذلك جاءت رؤيتى لها محفوفة بالحذر والتردد والمراجعة، وإذا كان لنا أن نعترف أن ”الرؤية الموضوعية” المطلقة هى هدف بعيد المنال، فأول الطريق إليه هو أن نقرّ أن رؤيتنا جميعا هى “ذاتية” ابتداء، ثم نأمل من هذه البداية أن نعترف بنسبيتها وقصورها، لعل ذلك يحد من غرورنا وغلوائنا فى تصور إمكانية موضوعيتنا قبل الأوان.
صاحبة هذه الصورة ليست بالغموض التى توحى به القصيدة، لكن أحيانا يكون فرط سلاسة الوجود هو مدعاة للدهشة حتى الرفض، بما يشمل افتراض صعوبات وتعقيدات غير موجودة، لمجرد بساطتها، ومباشرتها. هذه السيدة كانت تتميز بقدرة حدسية خاصة أرمز لها هنا “بقراءة الفنجان” (وفى الواقع كانت تمارس ذلك فى لقاءات ودّية طيبة أحيانا) وكنت أحتار فى تقييم هذه القدرة هل هى حدس معرفى مخترق يمكن الاعتماد عليه، أو يسمح باستلهامه، أم أنه نكوص استسهالى غير مسئول؟
إذا كان الطبيب النفسى له رؤية أعمق بطبيعة عمله – أو المفروض أن يكون كذلك – فى مجال ممارسته مع الذين يحضرون إليه يسألونه النصح، فلا يصح أن نتصور أنه يملك نفس حدة الرؤية بعيدا عن مجال عمله، وبالذات: فى محيطه الخاص، بل إنه قد يعوّض ما يتحمله من أعباء الرؤية الموضوعية أثناء ممارسته مهنته بأن يتجاوز عنها ربما أكثر من الشخص العادى – دون أن يدرى عادة – وذلك خارج نطاق هذه الممارسة، فيرى أموره الخاصة، وصـُوَرَ ناسه الأقرب، كما يحب، أو كما يخاف، وليست كما “هى“، ربما نعطيه بعض العذر احتراما لضعفه واعترافا بمحدودية قدراته الإنسانية، هذا الاحترام والسماح، وخاصة من جانبه لنفسه، قد يساعدانه على استمرار تحمل مسئولية مهنته، إلا أن هذا العمى الانتقائى – فى عمق العدل – يترتب عليه ظلم يقع على الأقرب فالأقرب ممن يحتاجهم هذا الإنسان المرهق، فهو قد يمارس – من خلال نظرته غير الموضوعية أكثر فأكثر – تحويل أقرب من حوله إلى ما يرى ويظن، وليس إلى ما هم، وهو بذلك يفقد من يحتاجه بحق، لأنه لا يعود “آخر” أصلا، بل يصيِّره كيانا من صنع إسقاطاته، يستعمله لسد احتياجاته، ويا ترى هل يستطيع أن يخرج من هذا المأزق أم لا؟
هذا يتوقف على مسار نضجه، ومدى قدرته على مواصلة نموه.
بيجماليون
هذا التشكيل، يمكن فهمه أكثر إذا تذكرنا الخطوط العامة لأسطورة بيجماليون، وهى ليست صورة مطابقة للقصيدة، لكنها على الأقل موازية، مع اختلافات كثيرة خاصة فى النهاية. أسطورة بيجماليون تبين لنا كيف أننا حين نسقط احتياجاتنا على من حولنا، فنحن نصيغهم كما نريد، وكأننا ننحتهم بأنفسنا أصناما وتماثيل مادية “بالمقاس” لتغذى فينا احتياجاتنا فقط، لكننا إذْ نكتشف أنها ليست إلا أصناما جميلة، لا بشرا “آخرين”، نصلى للآلهة (داخلنا غالبا) أن تبعث فيهم الحياة ليصيروا بشرا فعلا نمارس معهم ومن خلالهم بشريتنا بحق، لكن ثمَّ خطر وارد حين يكتسب هذا الآخر إرادته المستقلة، وهو أنه يمكن أن يتركنا، بفعل الآلهة أيضا (ربما فى داخله كذلك)!! لأنه يستحيل أن يظل مجرد أداة فى يد من صنعه صنما بعد أن تحول إلى كائن بشرى حى، فنكتشف الفرق بين ما هو آخر: (كيان مختلف) ينبض لحسابه (ومعنا ومع غيرنا، لا مانع!)، وبين الآخر (الوهمى): تمثال مصنوع لا إرادة له، بما يشمل احتمال أن يختار هذا الكائن الحى ذا الإرادة، أن يختار أن يخرج عن نطاق هذه الثنائية المغلقة، إذ يفضل صحبة ثالث دوننا، يختاره بإرادته، فيحدث لنا هلع عدم الأمان والضياع، ومن ثم أمنية التراجع عن الأمنية الأولى التى حققتها الآلهة، حتى لو أدى هذا التراجع إلى إعدام هذا الآخر الحى، بإعادته جمادا بعد أن دبت فيه الحياة بشرا، ولا يهدئ من هذا الهلع وعدم الأمان أن يكون هذا الآخر – بإرادته الحرة أيضا – قد عاد راضيا مرضيا يختارنا من جديد، فإن عدم الأمان يجعلنا نفضل أن نعاشر تمثالا من صنعنا نحن، على أن نعاشر “اخر” من لحم ودم، آخر يختار ويعيد اختياره، حتى لو اختارنا نحن فى النهاية.
هذه الأسطورة تنبه بوضوح إلى الفرق بين ما نسميه “الموضوع الذاتى”Self Object والموضوع الحقيقى Real Object ، وبرغم اختلاف النهاية، وأيضا تركيز المتن فى القصيدة، لا الأسطورة، على رؤية الصانع، وحيرته، ورغبته فى أن يرى الموضوع الحقيقى، وليس الموضوع الذاتى، ولو من خلال رؤية الآخرين.
“الشوفان” المتبادل فى العلاج النفسى
نرجع الآن إلى قراءة المتن مع التركيز على ما يتعلق بالعلاج النفسى ما أمكن ذلك.
(1)
أنا مانسيتكــيشْ.
أنا خليتــِكْ للآخرْ.
(2)
أصل عيونها صعب.
أصلها يا خوانـّا ساعات وساعات.
ساعه تعرف سر الدنيا فْ كنكة قهوهْ.
وساعات أظبطها بتعرف سِرّى عـَلـَى سـَهـْوَه
وساعــِـة ما تخاف، تعْمَى وتموت.
والعدسة بتاعتى اللى بتكبـَّر،
تيجى لحديها وتصغـَّر،
وتـْدغوش.
إشمعنى ؟
إكمنى باشوفها لنفسى، مش ليها،
مش بس بشوفها زى ما عايز
دي ساعات تبقى كما العـَوَزَان !
إضافة إلى ما ذكرنا نؤكد أن رؤية الطبيب (المعالج) النفسى تكون أقل موضوعية إذا ما استعمل نفس العينين اللتين يمارس بهما مهنته، فى حياته الخاصة ثم نضيف أن المعالج هو إنسان عادى يحتاج أيضا أن يُرى “كله”، بمعنى أنه لا يكفى أن تُرى كفاءته، أو مهارته، أو نتائج عمله، بل إنه – مثل أى واحد – فى حاجة إلى أن يُرى إنسانا ضعيفا عاديا محتاجا هو أيضا أن يكشف نفسه وداخله لآخر، ولعل هذا ما كان يقوم به التحليل النفسى التدريبى فى المدرسة الفرويدية الكلاسية، حين يشترط على المحلل أن يقبل أن يحلله محلل أكبر حتى يُسمح له بممارسة التحليل النفسى، لكن ذلك كان شرطا صعبا، وأحيانا معجزا، وأيضا إجراءً مصنوعا فى أحيان أخرى، المفروض أن نجد سبيلا يحقق هذا الهدف من الفرص المتاحة من “الممارسة تحت إشراف”، مباشر أو غير مباشر عبر كل مستويات الإشراف التى سبق ذكرها([49]) بما فى ذلك أقرب الأقربين إليه.
فى هذا التشكيل نلحظ كيف أن صاحبة هذه العيون الصعبة المختـَرقـَة ذات الحدس الجيد، قد تـَبـَيـَّنَ من المتن أنها قد تكتشف داخل صاحبنا (أنا) مصادفة، رغما عنه، أو رغما عنها “وساعات أظبطها بتكشف سرّى على سهوة”، وهنا لا يوجد ما يوحى أن صاحب الشأن يرفض ذلك على طول الخط، لكنه سرعان ما يرفض أن يستسلم له أيضا على طول الخط، فيسارع بالتقليل من شأن قدرتها، فتصغر فى عيونه “والعدسة بتاعتى اللى بتكبر، تيجى لحديها. …. وتصغر”!!
فى العلاج النفسى “يرى” المريض معالجه كما “يرى” المعالج مريضه، وأحيانا قد تصدق رؤية المريض أكثر فإذا استبعد المعالج هذا الاحتمال (أن يراه المريض مثلما يرى هو المريض) فإنه يفقد الكثير من فرص نموه الشخصى، وفرص التعلم من المريض، بل وفرص الاستفادة من إشرافه. مثل هذا المعالج إنما يأخذ موقفا “حُكميا” متعاليا، يدعمه بتأويلاته المستمدة عادة من تنظيره أو أيديولوجيته، ومن ثم تقل فرص العلاج الأعمق، وأيضا فرص الإشراف الذاتى العملى الإيجابى المستمر من واقع الممارسة.
(3)
وفْ لحظة صدق أظبـُـطــْـنِى
فيه حاجة خطيرة تلخبطَـْـنى:
دانا كل ما اقرَّبْ حبّهْ كمانْ
ألاقينى ماشـُـوفـْـشـِـى غير الشوفان
فى ثقافتنا بوجه خاص سرعان ما يتنازل الشخص عن رؤيته لصالح رؤية قائد الجماعة باستعمال، كل من ميكانزم “التقديس” و“الإنكار” معا، وكأن رؤية القائد وتفسيراته هى الأصل، وهى المرجـِـع، وبالتالى ينقلب هذا الشخص ليكون أقرب إلى ما يراه القائد، بما فى ذلك الصورة التى رآه عليها، أى أن الشخص يشترك فى هذا التزييف للإدراك الذى يصبح نتاج فعل الاثنين معا، فيختفى كيانه “كآخر”، وتتراجع فرص الحوار الموضوعى والاستفادة المتبادلة، وقد يمتد هذا النوع من العلاقة إلى حياته الخاصة بعيدا عن مهنته.
(4)
لو شايف خوفها: أتلخبط،
وساعات أنكرهُ، يعنى استعبط!
مش يمكن نـِفـْسـِى أخاف على حـِـسّ أمانها.
قومْ دغرى تخبّـى خــوفانها،
وتخاف مالــخوف.
هذه الفقرة لا تصلح بشكل مباشر أن يقاس عليها فى العلاج النفسى، ذلك لأن خوف المريض النفسى هو متعدد التجليات والأنواع، ونادرا ما يعتمد المعالج على ما يبدو على المريض من الطمأنينة ولو كانت طمأنينة ظاهرة، لأنها تكون أقرب إلى الإنكار واللامبالاة، فلا يصلح قياس المتن هنا على ممارسة العلاج النفسى “إكمنى نفسى أخاف على حس أمانها”، فالطبيب الحاذق لا ينبغى أن يستمد طمأنينته من أمان المريض، هذا من حيث المبدأ، لكن علينا ألا ننسى ما يتعرض له الطبيب النفسى من تقليب يجعل رؤيته أقرب إلى الكشف الذى يمر به المريض الذهانى خاصة، وفى هذه الحالة قد يشارك مريضه بعض أفكاره مع اختلاف مآلها، وحمل مسئوليتها، فإذا ما تمادى خوف المريض حتى من رؤيته الكاشفة هذه، فقد يتراجع الطبيب عن مشاركته، فينطبق عليه نسبيا، ولو بدرجة قليلة جدا ما جاء فى هذه الفقرة، وهذا قياس أستعمله دون تطابق طبعا فصاحبة هذه اللوحة (مثل أغلب لوحات العمل) ليست مريضه أصلا، لكن قواعد فقه العلاقات واحدة تقريبا.
ثم إن الذى يشجع الطبيب أن يتعلم من مريضه فيغامر برؤية ما يتجاوز المسموح به: هو مشاركة المريض له هذا الخوف من كشف المخبوء، والذى قد يتمادى عند المريض سلبيا إن لم يحتوِهِ العلاج لإعادة توجيهه، فى حين أن فرصة الطبيب – أن يستوعبه إيجابيا إلى إبداع ونمو محتملين هى أكبر لو كان يسير على مسار النضج المهنى والشخصى..
المريض الذى يخفى خوفه، لأنه لم يجد من يشاركه، أو لأن معالجه – كما المحيطون به – خاف منه، قد يفعل ذلك نتيجة خوفهم من خوفه ومن ثم خوفه هو من خوفه نفسه:
“قوم دغرى تخبى خوفها، وتخاف مالخوف”،
وهذا يعتبر إعاقة للمسار النمائى الذى يسعى إلى استيعاب الخوف واحتوائه، لا إلى إنكاره على طول الخط.
(5)
واذا شفت عيونها عدّت خط الصــدّ،
تبدأ حسابات الجمْع، الطرْح، الضرب، الشكّ، الرفْض، الـعـَدّ:
ودى مين؟ حاتشوفنى بإيه ؟!!
دا انا مِتـْمنـَظر، دَانـَا بيـِهْ !!
دى عنيها أنا اللى عاملها
دى قصيدة انا اللى قايلها
على طول أرفض شوفانها.
(ماهو لازم مـنْ عَـوَزَانِها)
يبدو أننى استوحيت هذه الفكرة أكثر من موقف العلاج النفسى: حين تتجاوز رؤية المريض ما يسمح به الطبيب (أو ما يقدر أن يسمح به حفاظا على تماسكه هو)، وربما هذا هو ما يعنيه المتن بـ “خط الصد”، حين تتجاوز رؤية المريض هذا الحاجز المصنوع من المنطق، والفوقية، والحسابات التأويلية، والأيديولوجيات الجاهزة، وتعاليم السطلة الدينية([50])، أقول حين تتجاوز رؤية المريض هذا الحاجز، يبادر الطبيب – عادة – بالتأويل، ولصق لافتات الأعراض والتشخيص، ثم يـُلحق الطبيب هذا وذاك بمذكرة “حيثيات الحكم” حسب النظرية التى ينتمى إليها، وهنا تكمن خطورة المسارعة بالتصنيف والتوصيف ظاهرا، وبالتأويل والتفسير على مستوى أعمق. الدفاع الذى يلجأ إليه الطبيب فى هذه الحال عادة يكون بأن يصعد فوق مستوى المريض (المستوى الذى يفترضه) درجتين أعلى منه،
دا انا مِتـْمنـَظر، دَانـَا بيـِهْ !!
ثم يصدر أحكاما أكثر حبكة من بينها: أن ما وصل إلى الآخر من رؤية لا يمكن إلا أن تكون صدى لرؤية الطبيب اقتناعا برأيه،
“دى عنيها أنا اللى عاملها، دى قصيدة انا اللى قايلها”،
وهو عادة ما يفسر رؤية الآخر بأن كُلَّ ما خالف رؤيته هو ليس إلا نتيجة لاحتياج المريض لا أكثر
“ما هو لازم من عوزانها”.
(6)
أنا قلت أشوفها ف عين الناس.
وأتارى الناس بتشوفها بعيونى،
ما هو أصل الناس دول يعنى: من صنعى شوية
ما هى خيبة قوية !!
ثَمَّ نوع من المصداقية يسمى “المصداقية بالاتفاق”Consensual Validity نعتمد عليها كثيرا بحق، وأحيانا بغير وجه حق، وهى أن تتفق مجموعة من المشاهدين على رؤية (أو رأى)، وبالتالى تصبح هذه الرؤية صادقة، اعتمادا على هذا النوع من المصداقية، وهو منهج له عيوبه وضعفه، لكنه من أهم أنواع مناهج المصداقية العملية التى حافظت على مسيرة التطور حتى لو كانت مصداقية ضعيفة بمقاييس البحث العلمى الأحدث. فالأحياء عامة تتفق، دون رموز أو حسابات، على ما يصلح لبقائها، وتتعاون فى تطبيقه، وتتكافل مع بعضها من خلال ذلك أيضا، فتبقى، وكذلك هذه المصداقية هى أقرب إلى بعض أشكال الديمقراطية التى تزعم أن اتفاق الأغلبية على رأى (أو على شخص) هو دليل على أنه الأقرب للصحة أو الأقدر على القيام بالمهمة، إلا أن ذلك ليس صحيحا على طول الخط، فالأنواع التى انقرضت اتفقت على أسلوب فى الحياة أهلكها، والديمقراطيات الزائفة، والمزيفة، تتفق على شخص قد يكون هو الأكثر خبثا، وليس الأقدر فعلا.
فى العلاج الجمعى، نستعمل “المصداقية بالاتفاق” دون تسليم، ولكن كمشروع (فرض) قابل للاختبار، وكلما كان المعالج من النوع المقتحم القادر المؤثر، أصبحت المصداقية بالاتفاق أقل موضوعية، فقد يميل أغلب أفراد المجموعة، أو كلهم، إلى مشاركته الرأى، أو ترديد إحساسات أقرب إلى إحساسه، وهذا أمر لا يمكن تجنبه إلا بمواصلة اختباره بأكثر من اقتراب وأكثر من طريقة.
المتن هنا ينبهنا إلى احتمال اختبار هذه الرؤية من خلال الاستعانة برأى المجموع
“أنا قلت أشوفها فْ عين الناس”
“وأتارى الناس بتشوفها بعيونى،
ما هو أصل الناس دول يعنى: من صنعى شويّة،
ما هى خيبة قويّة!!”.
لكنه فى نفس الوقت يحذرنا من احتمال الخداع للأسباب السالفة الذكر، وهكذا تتواصل المراجعة والنقد دون تسليم تلقائى حتى لإجماع الرؤية.
(7)
وابص كويس فى عـْـنيها
ألاقينى فيها !!
يا ترى دى مرايتى،
ولاّ أْزازْها..؟
يا ترى عايزانى؟
ولاّ انا بس اللى عايزها !!
هذا المقطع يعيدنا ثانية إلى التنبيه إلى الفرق بين “الرؤية الذاتية” و“الرؤية الموضوعية”، وضرورة التساؤل عن ما إذا كانت الصورة التى تصلنا من رؤية الناس لنا (بما فى ذلك رؤية المريض للمعالج) هى صورة منعكسة من رؤية المعالج (مرايتى) أم صورة واصلة من خلال شفافية رؤية الآخر (ولا إزازها).
(8)
يا ترى دا الخير اللى يطمّـن؟
يا ترى دا الخوف اللى يجنن؟
يا ترى ده الحب اللى يونْـوِن؟
وهكذا يمكن أن يتصور لنا (بما فى ذلك المعالج أحيانا) أن الآخر هو الأكثر احتياجا لنا، فى حين أن الحقيقة قد تكون العكس “يا ترى عايزانى؟ ولاّ أنا بس اللى عايزها”.
وهكذا أيضا يظل الباب مفتوحا للنقد، ونقد النقد، ويصبح التساؤل الممتد هو صمام الأمن ضد التسليم الساكن سواء فى العلاج النفسى أو فى حركية النمو.
(9)
كان نِفـْسى أشوفها إنها هيّا
يبقى الشوفان ليها وليّا
ربنا أرحَمْ بيها وبيَّا
نختم هذه القراءة من جديد بالتذكرة بأن العلاج عموما، والعلاج النفسى خاصة، إنما يؤتى ثماره للمريض شفاءً، وللطبيب (المعالج) نماءً وخبرة، كلما زادت جرعة النقد الذاتى، وكلما رأينا “الأمور كما هى”، وبالتالى نرى الآخر على مسافة موضوعية: لا هو مرآة نرى فيها أنفسنا كما نحب أن نراها، ولا هو صدى لما يدور داخلنا مهما كانت صحته، هنا تصبح المسألة أنه كلما زادت الرؤية موضوعية، حققت العلاقة الإنسانية وظيفتها: أن نكون بشرا معا، وهذا هو غاية العلاج فى نهاية النهاية! وربما غاية الحياة.
وبعد
للأمانة، قد يكون مناسبا أن أعلن رحيل صاحبة هذه اللوحة مؤخرا، وأن أعتذر لها، واستسمحها أن تغفر لى ما لحق بها منى، وأعاهدها أن أرد لها جميلها لكل من تحب، والحمد لله أنها كانت تحب كل الناس، فأنا أحاول أن أحذو حذوها لعلها ترضى، فيرضى!
ثم إلى المتن مجتمعا:
(1)
أنا مانسيتكــيشْ.
أنا خليتــِكْ للآخرْ.
(2)
أصل عيونها صعب.
أصلها يا خوانـّا ساعات وساعات.
ساعه تعرف سر الدنيا فْ كنكة قهوهْ.
وساعات أظبطها بتعرف سِرّى عـَلـَى سـَهـْوَه
وساعــِـة ما تخاف، تعْمَى وتموت.
والعدسة بتاعتى اللى بتكبـَّر،
تيجى لحديها وتصغـَّر،
وتـْدغوش.
إشمعنى؟
إكمنى باشوفها لنفسى، مش ليها،
مش بس بشوفها زى ما عايز
دى ساعات تبقى كما العـًوزَان!
(3)
وفْ لحظة صدق أظبٌطْنى
فيه حاجة خطيرة تلخبطَنى:
دانا كل ما اقرب حبّه كمان
ألاقينى ماشـُـوفـْـشـِـى غير الشوفان
(4)
لو شايف خوفها: أتلخبط،
وساعات أنكرو يعنى استعبط!
مش يمكن نـِفـْسـِى أخاف على حسّ أمانها.
قومْ دغرى تخبّـى خــوفانها،
وتخاف مالــخوف.
(5)
واذا شفت عيونها عدّت خط الصــدّ،
تبدأ حسابات الجمْع، الطرْح،
الضرب، الشكّ، الرفْض، الـعـَدّ:
ودى مين؟ حاتشوفنى بإيه ؟!!
دا انا مِتـْمنـَظر، دَانـَا بيـِهْ !!
دى عنيها أنا اللى عاملها
دى قصيدة انا اللى قايلها
على طول أرفض شوفانها.
(ماهو لازم مـنْ عَـوَزَانِها)
(6)
أنا قلت أشوفها ف عين الناس.
وأتارى الناس بتشوفها بعيونى،
ما هو أصل الناس دول يعنى: من صنعى شوية
ما هى خيبة قوية !!
(7)
وابص كويس فى عـْـنيها
ألاقينى فيها !!
يا ترى دى مرايتى،
ولاّ أْزازْها..؟
يا ترى عايزانى؟
ولاّ انا بس اللى عايزها !!
(8)
يا ترى دا الخير اللى يطمّـن؟
يا ترى دا الخوف اللى يجنن؟
يا ترى ده الحب اللى يونْـوِن؟
(9)
أنا نِفـْسى أشوفها إنها هيّا
يبقى الشوفان ليها وليّا
ربنا أرحَمْ بيها وبيَّا
المحتوى
صفحة |
العنوان |
3 |
تصدير |
11 |
“لوحة” مقدمة الكتاب الثالث |
13 |
اللوحة الأولى: قهوة سادة، وكلام |
27 |
اللوحة الثانية: السويقة!! |
43 |
اللوحة الثالثة: القط |
71 |
اللوحة الرابعة: البركة |
87 |
اللوحة الخامسة: النداهة |
103 |
اللوحة السادسة: العين الحرامية |
117 |
اللوحة السابعة: الدمعة الحيرانة |
127 |
اللوحة الثامنة: نايم فى العسل |
157 |
اللوحة التاسعة: نيجاتيف |
169 |
اللوحة العاشرة: الترعة سابت فى الغيطان |
183 |
اللوحة الحادية عشرة: فانوس ألوان |
197 |
اللوحة الثانية عشرة: البيت المسحور |
231 |
اللوحة الثالثة عشر: الزير |
243 |
اللوحة الرابعة عشر: دراكيولا |
267 |
اللوحة الخامسة عشر: يا ترى |
انتهى الكتاب الثالث وسوف يليه:
الكتاب الرابع:
فقه العلاقات البشرية (4)
تجليات “يحيى الرخاوى” بين السيرة والمسار
[1] – فريدريك بيرلز (8 يوليو 1893 – 14 مارس 1970) هو عالم نفسي ألماني. يعتبر صاحب نظرية الإرشاد والعلاج النفسى الجشطالتىGestalt therapy.
[2] – ويليام رايخ: محلل نفسي باحث جنس ، عالم إجتماع نمساوي ، وعضو الجيل الثاني من التحليل النفسي بعد سيجموند فرويد ، واحدا من الشخصيات الأكثر راديكالية في تاريخ الطب النفسي , مؤلف كتب و مقالات، أبرزها تحليل الشخصية (1933)، علم النفس الجماعي للفاشية (1933) والثورة الجنسية(1936) .
[3] – علاج الصرخة الأولى Primal Scream علاجا نفسيا ظهر فى أمريكا لمبتدعه “آرثر جانوف” Arthur Janov يقوم على فكرة السماح للمريض (العصابى، ومضطرب الشخصية أساسا)، بعد فترة قصيرة من الحرمان الحسى، وبعد إعداد مناسب، والسماح للمريض أن “يصرخ” بآهته بأعلى ما عنده مع معالجه مرارا وتكرار لعدة أيام، وقد زعم هذا المعالج أن نتائجه إيجابية برغم ما ثار حولها من شكوك وتحذيرات.
[4]– كنت قد استعملت كلمة “البحلقة” بالعامية لكننى اكتشفت أن “التحديق” بالفصحى يفيد ما أردت، وربما أدق.
[5] – انظر الكتاب الثانى: “هل العلاج النفسى مَكْـلـَمَة ؟” ص 13
[6] – هورين
[7] – بركة السبع
[8] – Quantum Sciences
[9] – كنت قد كتبت فى أصول هذا العمل بتفصيل متوسط عن هذه المراحل السابقة: الطور اللاعلاقاتى (سابقا الموقع الشيزيدى: مدرسة العلاقة بالموضوع، والطور “الكرّ فرّى”) (سابقا: الموقع البارنوى : نفس المدرسة) لكننى فضلت أن أحذف – فى المراجعة – هذه التفاصيل التى قد تبعدنا عن النص الشعرى، ثم تمادى الحذف (مقارنة بما صدر فى نشرات الإنسان والتطور اليومية ) ليس بالنسبة لهذه اللوحة فحسب وإنما فى كل العمل الحالى.
[10] – وهذا هو ما صوّرته شعراً فى ديوانى “سر اللعبة” منذ خمسين عاما حين كنت معتقدا بصحته، حين قلت :
لكن البقرةْ، قد تذهب عنى وأنا لم أشبعْلا .. لن أسمحْْليسـَـتْ لـُـعـْـبـَـة هـِىَ مـِلـْـكـِى وحدي: أضغط ْْ: تحلبْأتركْ: … تنضبْ |
أضغطْ تحلبْ،.. أتركْ تنضب،لكن هل تنضبُ يوماً دوما؟؟ أفلا يعنى ذاك الموت؟ملكنى الرعب .. واللبن العلقم ..، يزداد مرارةفكرهتُ الحبْ وقتلت البقرة |
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى