الطب النفسى والغرائز (1)
“غريزة الجنس” (من التكاثر إلى التواصل)
“غريزة العدوان” (من التفكيك إلى الإبداع)
أ.د. يحيى الرخاوى
2022
الإهــــداء
إلى زملائى وطلبتى ومرضاى
******************
آمِلاً – منتظِرًا
المقدمة:
محتويات العمل الحالى ليست مترابطة بشكل محكم، ولا هى كتبت بنفس المنهج ولا فى ظروف متشابهة، ذلك لأن الخبرة ممتدة ومتواصلة طوال نصف قرن (على الأقل) بما يحتم المراجعة وإعادة النظر طول الوقت، من هنا فإن لكل جزء ملابساته وظروفه، مع محاولة ربط متواضع كلما أمكن ذلك.
بحسب التسلسل التاريخى، فإن جذور هذا المدخل يمكن أن يرجع إلى انتماء الكاتب إلى ما سـُمـِّى لاحقا “الطب النفسى التطورى”، وهو ما طوّره الكاتب إلى ما صار يسمى: “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى”، علماً بأن الكتاب الأم “دراسة فى علم السيكوباثولوجى”(1979)([1]) ثم النظرية الأساس “النظرية الإيقاعية التطورية” (1980) يمثلان البنية الأساسية لفكر المؤلف.
الباب الأول هنا هو عن “غريزة الجنس: من التكاثر إلى التواصل“، وترجع أصوله إلى محاضرة ألقيتها فى منتدى أبو شادى الروبى، وهو بعض نشاط لجنة الثقافة العلمية، إحدى لجان المجلس الأعلى للثقافة حين كنت عضوا فيها.
ثم يأتى الباب الثانى يعرض موجزاً عن “غريزة العدوان: من التفكيك إلى الإبداع”، وقد كتبت أصول هذه الأطروحة ابتداء سنة (1980) ([2])، ثم أعيد نشرها بعد تحديثها المحدود فى مجلة فصول (1986) ([3]).
وقد حاولت أن أبدأ باحترام هذه الغرائز باعتبارها نعمة ضرورية توارت إيجابياتها بعد أن بولغ فى التركيز على سوء استعمالها واختزالها وانحرافها.
.. هذا، وقد ألحقتُ بكل باب ملحقاً مناسباً من نشاطى فى النقد الأدبي، ذلك لأبين مارحت أكرره مؤخرا من أننى أمارس مهنتى فنًّا علاجيا أسميته “نقد النص البشرى”، فرأيت أن ألحق بتنظيرى العلمى/المهنى عن مـَادتـَىْ هذا العمل “الجنس والعدوان”، هذه الملاحق، وهى دراسة نقدية لروايتين: الأولى: “ليالى ألف ليلة”: لـ نجيب محفوظ، والثانية: “بيع نفس بشرية”: لـ محمد المنسى قنديل.
وسوف تتواصل السلسلة لتكون الغريزة التالية فى كتاب مستقل أكثر إشكالا فتصدر أملاً فى أن تنال أحقيتها فى الاهتمام والتوظيف على مسار النمو والإبداع الذاتى والتطور، وسوف يصدر الكتاب بعنوان: “الغريزة التوازنية الإيمانية”.
يحيى الرخاوى
المقطم: 15 مايو 2022
[1] – يحيى الرخاوى “دراسة فى علم السيكوباثولوجى (شرح ديوان سر اللعبة)”، (1979). ويعاد طبعه حاليا بعد التحديث فى أربعة أجزاء.
[2] – يحيى الرخاوى: “العدوان والإبداع” مجلة الإنسان والتطور (1980)، المجلد الأول العدد الثانى (ص49-80).
[3] – يحيى الرخاوى “جدلية الجنون والإبداع” مجلة فصول المجلد(6) العدد(4) (يوليه، اغسطس، سبتمبر1986)، (ص30-58)
*****
الباب الأول
غريزة الجنس
من التكاثر إلى التواصل ([1])
الفصل الأول
أصول ومنهج التعرف على ماهية الجنس
مقدمة:
كان هذا اللقاء من بعض نشاط منتدى أبو شادى الروبى لأصدقاء الثقافة العلمية([2]) (فاللجنة هى: لجنة الثقافة العلمية)، وهذه محاضرة فى المجلس الأعلى للثقافة، عن الجنس: ما هو وما إليه، فما هو الفرق بين ما يجوز أن يُلقى فى هذا المجتمع بهذه الدرجة من الثقافة المتميزة، وبين ما يمكن أن يلقى فى نفس الموضوع فى المجمع العلمى، أو مركز الأبحاث، أو فى كلية الطب، أو كلية الآداب، أو لطلبة الثانوية العامة.
ظللت طوال السنوات الخمس الماضية (وأنا أشْـرُفُ بعضويتى لهذه اللجنة)، وأنا ألح إلحاحا متصلا، لأفهم أولا، ثم لأحاور ثانيا، ثم لأسوّق ثالثا ما هو “ثقافة علمية”، وقد وضعت لذلك تعريفات كثيرة، ونشرت رأيى فى أماكن عديدة، وخلاصته تبدأ بنفىٍ يقول:
إن الثقافة العلمية ليست هى العلم،
وليست هى المعلومات،
وليست هى تبسيط العلوم،
وليست هى تسويق العلوم،
وإن كان كل ذلك من أدواتها ([3])
وأضيف بهذه المناسبة عرض موقفى بألفاظ أخرى تقول: إن الثقافة العلمية:
(1) هى تفعيل المعلومة العلمية لتصبح فى متناول الوعى العام لغالبية الناس المنتمين إلى ثقافة خاصة لها موقعها المتميز.
(2) ومن ثَمَّ : هى الإسهام فى تشكيل هذا الوعى.
(3) وَهى ترويج لاتباع منهج فرضى إستنتاجى فى التفكير، وهومنهج مفتوح النهاية بالضرورة.
(4) وهى تسعى لتدعيم الموقف النقدى الموضوعى فى معظم أمور الحياة فى الفعل اليومى.
ومن هنا كنت كلما حَضَرت محاضرة “علمية” فى هذا المنتدى أتساءل:
1- هل هناك فرق يميز هذا اللقاء عن لقاءات “علمية” أخرى.
2- هل استطاع اللقاء (أوالمحاضرة) أن يوصل المعلومة بطريقة مختلفة بحيث تكون “فعلا “/”وعيا”، يمتزج بالوعى العام ويغير السلوك، وليست مجرد إضافة معقلنة تُحفظ وتـُـنسى أو لا تُـنسي.
3- هل كان المخاطـَـب فى المقام الأول هو:الوعى ليتشكل، أم العقل ليتمنطق؟ (باعتبار أن الثقافة العلمية تخاطب الوعى من خلال العقل ولا تكتفى باستعمال الوعى خلفية يقظة لتشحذ به العقل الطاغى سيد المواقف برغم قصوره)
4- وعن ما تبقى بعد هذا اللقاء -إن تبقى شىء-: هل هو تبقى فى وعى الحضور أم فى ذاكرتهم؟ وما الفرق؟
5- وهل سينتقل ما تبقى – تلقائيا ما أمكن- إلى أصحاب المصلحة ؟عامة الناس؟
وكنت أجد الإجابات على كل ذلك: مشكلة وغير حاسمة، وأحيانا: قاسية، ومؤلمة، وأحيانا أقل: متواضعة وآمـِلة .
وحين جاء دورى، وقدمت محاضرتى الأولى فى هذا المنتدى عن ”الصحة النفسية والتطور، والإيقاع الحيوى”، لم أستطع أن أحسن الإجابة على هذه الأسئلة إجابات تبرر إصرارى على تمييز ما هو ثقافة علمية عن أية نشاطات “علمية أخرى” لا تذكر كلمة ثقافة ([4]) قبلها. بل إننى فى تلك الندوة السابقة عن الصحة النفسية والإيقاع الحيوى حين ربطت بين رقصة التنورة، وبين الذِّكر، وبين ضربات القلب، وبين دورات الجنون ودورات الكون ودورات العبادة، قوبلت باستهجان شديد من زملائى باللجنة من المنهجيين التقليديين من حيث اعتراضهم على خلط “العلم” “بالميتافيزيقا ([5])
كل هذا أعاقنى وأنا أحضّر لهذه المحاضرة التى أعترف أننى السبب فى تورطى فيها: ذلك أننى تابعت حدثين هامين على مدار الستة أشهر السابقة للمحاضرة، حدثين ليس لأى منهما علاقة مباشرة بالآخر، الأول طبى علمى، والثانى سياسى فضائحى (إعلامى)، الأول هو اكتشاف عقار الفياجرا، والثانى هو مسلسل حياتى/سياسى/واقعى (ليس تلفزيونيا) مسلسل “كلينتون/مونيكا”، وقد لاحظت أن استقبال ناسنا لهذين الحدثين يختلف اختلافات جذرية عن استقبال ثقافات أخرى، سواء فى بلد المنشأ (منشأ الحدثين: الولايات المتحدة) أو حتى عبر الأطلنطى، إذن فكل ثقافة من الثقافات قد عايشت (قرأتْ، وانتقدتْ، وشجبتْ، وحبذتْ، وتفرَّجتْ على..إلخ) الحدثين معايشة مختلفة، فتساءلتُ: أى المواقف كان أكثر موضوعية؟، أكثر علمية؟ وأى الثقافات أقرب إلى ما ندعو إليه مما يسمى الثقافة العلمية؟ وبما أن الحدثين يربطهما موضوع “الجنس”، فماذا يعلم ناسنا عن هذا الذى إسمه “الجنس”؟ أين يقع فى إطارمعارفنا النظرية، ثم أين يقع مانعرف عنه -صوابا أم خطأ- من ممارساتنا اليومية وسألت زملائى فى اللجنة عن دورنا فى كل هذا، فكان ما كان من ورطة ترتـَّـب عليها تكليفى بهذه المحاضرة، ومن ثَمّ: موقفى هنا بينكم الآن.
كيف المحاضرة؟
لهذا سوف أحاول هذه المرة أن أحدد ابتداء المنهج الذى سوف أتبعه فى تقديم هذه المحاضرة عن هذا الموضوع الشائع الشائك معا، كنوع من التجريب لما يمكن أن تكون عليه مهمة محاضرة يطلق عليها “ثقافة علمية ” وليس فقط “علمية”، وقد اجتهدت فى هذا السبيل على الوجه التالى:
1- ألاّ ألزم نفسى بتقديم إجابات محددة، ذلك لأننى من ناحية لا أعرف أغلب الإجابات مغلقة النهاية، ومن ناحية أخرى لأن مهمة الثقافة العلمية أن تحفز التفكير فالتساؤل، لا أن تكتفى بتقديم المعلومات السابقة التجهيز! .
2- ألا أزحم المتن باستطرادات إستشهادية من أدبيات الموضوع، وما أكثرها
3- أن ألحق بالمتن هوامش شارحة أو داعمة أو ناقدة، ليست مراجع تقليدية.
4- أن أحاول أن أخاطب الحضور بصفتهم عينة ممثـِّـلة لثقافة فرعية محدودة Subculture يمكن أن يتشكل وعيها من خلال إضافة أو إثارة معرفية مسئولة.
أسئلة مبدئية (وحرج شخصى):
أطرح فى البداية عدة أسئلة، على سبيل المثال لا الحصر، كمدخل إلى الموضوع:
1) هل “علم الجنس” هو علم بكل المقاييس التقليدية أو الحديثة، لما هو “علم”؟
2) وهل يـُـدرج هذا العلم (إن استحق هذا الوصف) تحت العلوم الإنسانية، أم العلوم البيولوجية؟
3) وما هو منهج علم الجنس هذا؟ وما مدى تنوعه؟ ومدى مصداقيته؟ حتى يمكن أن نحدد موقفنا من معطياته، بمعنى أن نقرأ ما يقول قراءة نقدية من واقع منهجه.
4) ألا يتناول علم الجنس واحدا من أكثرالسلوكيات شمولا وجذرية (إذ يشمل كل الناس، ويلمس عمق الوجود: فردا ونوعا)؟
5) أَلاَ يمكن أن يكون اختبارنا -هنا والآن- لعلاقة ما هو علم الجنس، بما هو ممارسة الجنس، وبما هو ثقافة الجنس: هو فرصة لاختبارنا لموقعنا من مهمتنا الأولى فى هذه اللجنة وهى “تفعيل المعلومة العلمية” فى الوعى الخاص فالعام”؟
6) وهل يؤثر موقفنا من المعلومات والمعارف عن ماهية الجنس وتوظيفه فى سلوكيات أخرى بعيدا عن منطقة الممارسة الجنسية. (مثلا موقفنا من التطور، ومن التواصل، ومن الحرية، ومن الجسد، ومن الإبداع، ومن ثـَّـم من العلاقة بالآخر، ونوعية الوجود البشرى وغير ذلك؟)
ثم أنتقل، وأنا أدعى الحرج لأقصى درجة، من هذه الأسئلة العامة إلى أسئلة شخصية، لا أطلب الإجابة عليها أصلا، بل إننى أنصح الحضور ابتداء ألا يحاولوا الإجابة عليها، (إلاّ أن تأتيهم الإجابة وحدها، الآن أو فيما بعد، أو لا تأتى أبدا).
وعلى الرغم من يقينى من سخف موقفى هذا، إلا أننى لكى أكون أمينا مع نفسى، ومعكم، مضطر أن أثير ما أضمن به أننى أخاطب وعى الحضور من خلال حضور وعيى شخصيا، وبذلك أتصور أننى أحاول أن أتجنب ما أخذته على غيرى، بأن أعمّق قصداً الفرق بين خطاب العلم، وخطاب الثقافة العلمية.
لكل هذا فضلت أن أبدأ بتوجيه الخطاب لنفسى قبلكم، بحيث يكون تغيير ضمير المخاطب هو على مسئولية من يفعل ذلك إذا أما أراد أن يلحق بى، ولم يكتف بأن يتفرّج علىّ:
1- من أين استقيتُ معلوماتى عن الجنس؟ فى الطفولة([6])، ثم وأنا مراهق، ثم وأنا ممارس، ثم وأنا ناضج ثم وأنا هكذا الآن؟
2- وهل تغيرتْ نظرتى للجنس، وللحياة، بتغير مصدر، ونوع المعلومات التى وصلتنى.
3- وبالنسبة لهذه المحاضرة، هل يمكن أن تساهم فى إعادة تشكيل وعيى شخصيا (باعتبارى مواطنا من المواطنين المستهدفين لنشاط لجنتنا الموقرة)؟ سواء فى ذلك وأنا ألقيها، أو وأنا متقمص أحد أو إحدى الحضور.
4- وهل ثمة أسئلة حول المسألة الجنسية ما زالت متبقية تشغلنى بلا حل حتى تاريخه وأنا فى هذا السن أعمل في هذا التخصص؟!
5- وهل يمكن اختبار أى من هذا، فى مجتمعنا هذا، والمؤسسة الزواجية لها وعليها، ما لها وما عليها؟
وبديهى أننى لن أجيب، بل إننى أكاد أعترف أن الإجابات التى راودتنى لم تكن إجابات بالمعنى المباشر.
وربما كان من السخف أن أكرراعتذارى عن هذا المنهج الذى اخترته، فلأبرره إذن:
إن ما اضطرنى إلى مثل ذلك هو أننى رأيت أن لهذه الأسئلة جانب تطبيقى مباشر من حيث علاقة ذلك بقضية “تدريس الثقافة الجنسية” فى المدارس الإعدادية والثانوية، وربما فى الجامعة، بل وقبل كل ذلك فى المرحلة الإبتدائية، (كما تتكرر بعض التوصيات)، ثم إننى رحت أتصور أنه إذا لم يسأل المدرس نفسه مثل هذه الأسئلة، التى سألتها لنفسى الآن، وإذا لم يحاول الإجابة عنها ولو جزئيا، فما الذى سوف يقوم بتدريسه بالله عليكم؟ تشريح الجهاز التناسلى لكل من الذكروالأنثى؟، الأضرار المرعبة!! (كما يتصورها) للعادة السرية؟ وما شابه؟! فإذا كنا نطالب المدرس (وكل تربوى) أن يضع موقفه الشخصى فى الاعتبار، ألاَ يجدر بنا أن نتقمصهم لنرى هذا الذى نطلبه منهم على مستوى أصعب وأشمل: هل هو ممكن أم لا: بالنسبة لمن يتصدى لنفس المسألة على هذا المستوى المحدود مع الخاصة هكذا؟
ولا بد أن أعترف أن هذه المواجهة بهذه الأسئلة كادت تعيق انطلاقى فى محاولة جمع المعلومات الأساسية، بقدر ما أشعرتنى بالأسف وأنا أفكر فى محاولة التراجع والاعتذار عن المحاضرة أصلاً، ثم إنها نبهتنى إلى خطورة وصعوبة ما يسمى “الثقافة العلمية”.
2- المنهج ومصادر المعرفة عن الجنس
أولاً: إستحالة فصل المعلومة عن منهجها
إذا كان همنا - فيما هو ثقافة علمية - أن نرسى قواعد المنهج أكثرمن (أوعلى الأقل: جنبا إلى جنب مع) تقديم المعلومة، فقد وجدته مناسبا، حتى لو لم أقدم أية معلومة ذات قيمة فى ذاتها، أن أحدد المنهج الذى من خلاله يمكن أن نـتواصل بدرجة مناسبة من الصدق والنفع.
تأتى المعلومات عن الجنس، سواء ارتقى ذلك حتى سمى “علم الجنس”، أم ظل فى حدود النظرية، أو كان مازال فى مرحلة الفرض أو أنه لم يتجاوز تأملات الانطباع، تأتى من مصادر متعددة، وبالتالى فلا بد أن تـُقرأ كل معلومة على حدة، فى حدود مصداقية منهجها، وفى هذه المحاضرة -كمثال- سوف تكون المعلومات التى سأقدمها من مصادر متنوعة، أرجو أن تكون متكاملة فيما بينها حتى لو بدا ظاهرها متناقضا، ومن ذلك:
أولاً: معلومات تاريخية: (مثلا تاريخ الدافع الجنسى لـ كولن ولسون([7])، وتاريخ الجنسانية لفوكو([8]) …. الخ) وهى مثل كل المعلومات التاريخية، عليها كل مآخذ مناهج دراسة التاريخ، الذى يتراوح بين خيالات خصبة، ووقائع ناقصة، وتحيزات عفوية أومقصودة إلخ، وبالتالى فلا بد أن تؤخذ بحذر مناسب.
إلا أن هناك تاريخا حاضراً بيننا: “هنا والآن”، بشكل مباشر، وهو تاريخ الجنس فى تطور الأحياء، وهو من أَثـْـرَى المصادر، لكنه للأسف مبنى على نظرية مازالت قيد النقاش والمراجعة، وهى نظرية النشوء والارتقاء (داروين)، ومع أن أغلب الهجوم عليها هو هجوم متحيز متعجل: إلا أن كثيرا من المراجعات التى جرت عليها مؤخرا تلزمنا بإعادة النظر دون رفضها، وبمجرد أن نأخذ هذه النظرية كأساس للتفكير فى التاريخ حاضرا، فإننا سوف نفاجأ بثروة هائلة من سلسلة الأحياء التى يمكن أن تقدم لنا التاريخ الحيوى([9]) – بمافى ذلك تاريخ الجنس- ماثلا أمامنا (مرة أخرى: هنا والآن)
ثانياً: معلومات إنتشارية إحصائية عن السلوك الجنسى فى السواء والمرض([10]) وتأتى هذه المعلومات بواسطة منهج محكم ذى مصداقية وثبات عالـيين، لكننا بعد أن تسجـِّـل المطبعة الأرقام وتصبح فى متناولنا، لابد أن نتساءل كيف نقرأ هذه الأرقام، ولابد فى هذا الصدد من الإقرار بأنه ينبغى أن ننظر إلى كل رقم يصلنا فى سياق عينة البحث الذى صدرت عنه، وطريقة الحصول على المعلومات (مثلا: هل العينة ممثلة فعلا لمن ثـَّـم فحَصهم؟ وهل تم الحصول على المعلومات بالهاتف، أم بالبريد، أم بالمقابلة الشخصية؟ …إلخ) بل ويـمتد الأمر -حديثا- إلى ضرورة السؤال عن مصدر تمويل مثل هذه الأبحاث، وأيضا عن ضمانات مصداقية عملية ملء استمارة جمع المعلومات إلخ: مثلا: إذا سألت نساء مجتمع-ثقافة- معينة عن نسبة وصولهن إلى ذروة الشهوة فى الممارسات الجنسية، فكم منهن يعرف حقيقة وفعلا ما هى ذروة الشهوة أصلا orgasm([11])؟ وهل توجد ذروة واحدة، أم أنواع متصاعدة، فإذا أضفنا إلى ذلك الظروف الخاصة بمجتمعات مغلقة مكبوتة مثل مجتمعنا، إذن لزادت الصعوبة، وبالتالى زاد التنبيه للحذر من التعميم واحتمالات التحيز، لأسباب حقيقية وزائفة، شعورية ولا شعورية.
ثالثاً: معلومات نظرية (وتنظيرية)، وهى المعلومات التى تقدم وجهة نظر أو نظرية، وهى عادة لا تنبع من فراغ، وإنما تستند على “أولا، أو “ثانيا” أو كليهما أو غيرهما (أنظر بعد) وقد تصل إلى مستوى النظرية، أو تقف عند مستوى الفرض، أو حتى عند ”الانطباع”، وهذه المعلومات ليست أقل فائدة أو أضعف دلالة، ففى تقديرى أن كل أو أغلب نظريات فرويد فى الجنس حتى الآن مازالت فى هذا المستوى، وتختلف هذه المعلومات حين تصدر من مجرد منظـِّـر (قد يصل حدسه إلى عمق صادق رائع) عنها حين تصدر من ممارس كلينكيى قادر على تعديل موقفه وتنظيره باستمرار من خلال ما يمارسه من لقاءات وشكاوى ومصارحة مع بشر حى مع اختلاف أنواع “من هم”، و”ما هم”، وما يمثلونه.
رابعا: معلومات خبراتية، (وهى غير المعلومات الذاتية الصرف، (أنظر بعد “سادساً”) وهى تبدو لأول وهلة من أضعف المصادر، إلا أن النظرة الأحدث للتطوارات التى حدثت للمنهج، والتى تؤكد تراجع المغالاة فى مسألة الموضوعية فى مقابل الذاتية، وتنامى وصـَـقـْـل المنهج الفينومينولوجى، كل ذلك يعطى لمثل هذه المعلومات الخبراتية مصداقية يـُـعتد بها، حيث أنه لكى تــُـسمى كذلك (خبراتية وليست ذاتية صرفا) لابد وأن يكون صاحبها فى حالة جدل مستمر مع الواقع من خلال ذاته وتقمصاته وإبداعاته لنفسه وخارجها.
خامسا: “معلومات عبر الإبداع” (القص خاصة)، وقد أنشأت هذا التعبير إنشاءً لأنبه أن المعلومات التى تصلنا من خلال الإبداع ليست بالضرورة معلومات مـُـسقطة، ولا هى مجرد خيال، كما أنها – فى نفس الوقت – ليست واقعا عيانيا بالضرورة، وإنما هى نتاج حدْس بشرى ملتزم فى نشاط سياق إبداعىّ خاص، وفى خبرتى النقدية والعلمية على حد سواء، وجدت أن مصداقية هذه المعلومات تصل أحيانا لدرجة عالية تماما، سواء كان المبدع قد مارسها،أم تقمص من تصور أنه يمارسها، والأغلب أن تكون نتاج عمليات متداخلة متضفرة ذاتية وموضوعية معا، بحيث يصبح ما تصل إليه وتصفه إضافة معرفية فيها إثراء حقيقى لأهم مشاكل وتحديات السلوك البشرى، حتى فى مجال التواصل بما فى ذلك فى مجال الجنس (أنظر الملحق)([12])
والفرق بين هذه المعلومات الواردة فى الإبداع المتميز، وبين المعلومات الخبراتية المباشرة هو نوع القصدية، وطبيعة الناتج، ففى الحالة الثانية تكون الخبرة هى حضور “الموضوع”، ويكون الناتج تغير ذاتى قابل للترجمة إلى معلومات عملية أو قولية، أما فى الحالة الأولى “المعرفة بالإبداع” فإن الإبداع يكون هو المقصد الأول محتويا كلا من الخبرة والمعلومات والخيال والحدس وغير ذلك من أدواته، ويكون الناتج نسيجا إبداعيا يكشف ويضيف دون أى قصد معرفى مباشر، ومن هنا جاءت التفرقة بين ما يسمى الأدب الجنسى أو أدب الإثارة الجنسية، والأدب المحتوى لما هو جنس فى سياق لا يمكن فصله عن سياق العمل المبدع عامة.
وهذه المعلومات قد تصل فى مصداقيتها إلى أن تكون أصلا يعتد به فى كل من العلم والنقد الأدبي، مثلما كانت ملحمة أوديب (وهاملت) أصل فى فهم فرويد للجنس (برغم المبالغة فى التأويل التحليلى الخاص)، وهكذا.
سادسا: معلومات ذاتية صرف، وهى أضعف الأنواع مصداقية، وخاصة إذا كانت لم تـُـختبر إلا من واقع الخبرات الذاتية المحدودة بالذات دون إبداع جدلى يضمن تجاوز مجرد الإسقاط، جـَـدَلاَ مع كل أنواع المعلومات والخبرات المعيشة والمُتَقَمَّصة بما يسمح بتجاوز الذات إلى ناتج الجدل مع الموضوع فى سياق واقعى (واقع الداخل والخارج معا).
وبالنسبة لهذه المحاضرة بوجه خاص، فأغلب المعلومات الواردة فيها، هى من النوع “ثالثا”، و”رابعا” و”خامسا”.
منهج التلـقـى
فى مثل موقفنا هذا لا يصح أن نكتفى بأن نتحدث عن منهج الرصد والكتابة دون أن نعرج إلى منهج المتلقى، لأنه يبدو،(وخاصة فى مسألة توظيف العلم لتشكيل الوعى = الثقافة العلمية) أن منهج المتلقى لا يقل أهمية، إن لم يزد عن منهج الحصول على المعلومة، وعن منهج أسلوب تقديمها، بمعنى أن أيا من الحاضرين هنا، أو حتى ممن تتاح له قراءة هذه الورقة، فيما بعد، سوف يتلقى ما ورد فيها، بطريقة تحددها عوامل لا بد أن تؤثر على تشكيل وعيه بشكل متفرد إن كان لنا أن نأمل فى ذلك، ويصح هذاسواء كانت المعلومة أرقام إحصاء أم تنظير عالم أم فرض ممارس أم وعى مبدع أم تشكيل مبدع أو ناقد؟
والأسئلة التى تطرح نفسها فى هذا المقام تتساءل عن مصير المعلومة التى تصل إلى وعى المتلقى، وأحسب أننا لو وضعنا المسألة فى شكل أسئلة محددة لكان ذلك أكثر اتساقا مع منطلقنا فى هذا اللقاء، ولنحاول أن نـتساءل حول معلومة تصل إلى السامع (أو القارئ)، معلومة تشير إلى: دلالة، أو ضرورة، أو مغزى ممارسة جنسية بعينها، سواء كانت فى تفسير النشاط الجنسى نفسه، أو ما يتعلق به من تواصل أو وداد أو حب أو ما شابه، فماذا يمكن أن يكون منهج المتلقى لهذه المعلومة؟
(1) هل سيكتفى بأن يقيسها بما سبق أن عرفه من معلومات حول نفس المسألة؟([13])
(2) وهل معلوماته السابقة هذه – سواء اتفقت مع ما سمع أم اختلفت - هى نابعة من مسلمات دينية، أم أحلام يقظة، أم أيديولوجيات ثابتة، أم خبرة ذاتية؟
(3) فإذا كانت الأخيرة، فهل سيغامر بأن يراجعها أو يراجع ممارسته؟
(4) فإذا حدث اختلاف بين ما سمع وما يمارس، هل سيسارع برفض المعلومة حتى لا يقلق نفسه أو شريكه (فيكون الرفض دفاعا مشروعا)
(5) ثم هل سيذهب بما وصله ليتحقق منه من مراجع أخرى، أو خبرات أخرى؟ وأين المجال والفرص؟
هذه كلها تحديات أمام من يتصدى لتقديم معلومات يهدف إلى توظيفها فى تشكيل ما هو ثقافة، وبالذات ما هو ثقافة جنسية.
إشكالة التواصل البشرى:
عنوان المحاضرة يقول: “الغريزة الجنسية من التكاثر إلى التواصل”، ويبدو لأول وهله إنه لا ينقصنا فهم علمى لما هو “جنس”، ودوره فى التكاثر، إذ أن هذا من أبسط مستويات ما انتهى منه العلم، لكن الإشكال يحتد فى فهم طبيعة وأبعاد التواصل، لأننا-فى واقع الحال- لا نعرف ما هو التواصل الذى نفترض أنه من أهم غايات النشاط الحيوى الجنسى للإنسان.
تعريف التواصل بين البشر بالمعنى الإنسانى الموضوعى، لتحقيق الوجود الصحيح القادر على تخليق كيانات مستقلة متفاعلة متولدة من خلال التقائها طول الوقت: هو التحدى الحقيقى الذى يلقى فى وجه العلم والممارسة على حد سواء، وهو الذى يميز البشر فى أرقى مراحل تواجدهم.
وقد حاولتْ مدارس نفسية كثيرة أهمها مدرسة أو “مدارس العلاقة بالموضوع”، وهى مدرسة تحليلية نفسية (بعد فرويد مع ارتباطها بفكره) ([14])، أن تحدد مراحل التواصل بين البشر أثناء رحلة النمو، وأن تحاول أن تؤكد على أنه بغير ”آخر” حقيقى (ليس موضوعا ذاتيا مـُسـْـقـَـطا: الذى هو موضوع ليس بموضوع) لا يمكن أن نـُعتبر أننا بشر بحق، وبما أن التعامل مع ”آخر” “موضوعى” تماما هو أمر أقرب إلى اليوتوبيا، فإن غاية المراد أن يكون تطور البشر يسير فى اتجاه محاولة ذلك، أى أن يرتقى الإنسان باستمرار من “استعمال” الآخرين “كما يراهم”، إلى “التفاعل معهم ”كما هم”، وهذا ضد الاستسلام الشيزيدى تحت عنوان الحرية أو الديمقراطية أو الاعتراف بالخلاف وادعاء التحاور السطحى، وإنما هو يعنى فى المقام الأول: التفاعل الخلاّق الذى يترتب عليه إعادة النظر بعد كل جولة التحام، سواء كان التحاما جنسيا أم التحاما عدوانيا، ولكنه أبدا ليس ادعاء تحرّرِياً، أو حوارا لفظيا.
ومن كل الآراء والأفكار التى عرضتها سابقا، وعلى وفرة تناول هذا الموضوع فى مدارس علم النفس التحليلى وغيرها، فإن الإبداع الأدبى خاصة هو الذى أسهم إسهامات فائقة فى توصيف هذه الإشكالية البشرية بحق
وفى الحياة العامة تظهر مشاكل التواصل على أكثر من مستوى: من أول إشكالات الحب والخيالات التى تدورحوله، حتى مزاعم الديمقراطية (وادعاء احترام الرأى الآخر) مارين بالصراع بين الأجيال وتحديات الاختلافات الفردية مما لا مجال للاستطراد فيه حتى لا نبتعد عن موضوعنا الأصلى.
[1] – تحديث محدود لمحاضرة “الغريزة الجنسية” ألقيتها فى منتدى أبو شادى الروبى (15/12/1998) ضمن نشاط محاضرات لجنة الثقافة العلمية: المجلس الأعلى للثقافة.
[2] – أنظر الهامش السابق.
[3] – سبق أن حاولت تعريف الثقافة العلمية لتتميز عن العلم فى كتابى “مراجعات فى لغات المعرفة” سلسلة أقرأ، دار المعارف 1997، ثم فى سلسلة مقالات فى الأهرام فى سنة 1996.
[4] – مازالت كلمة ثقافة، وما يقابلها فى الإنجليزية culture تثير إشكالية عند الخاصة والعامة على حد سواء، وفى حديث قريب مع أ.د. جابر عصفور سأله د. عمرو عبد السميع: (الأهرام العربى العدد 90 بتاريخ 12 ديسمبر 1998)
دعنى أسألك سؤالا مباغتا..لماذا وزارة الثقافة، فالموسوعة الفرنسية - مثلا- تعرف الثقافة بوصفها لفظا كليا مرادفا للحضارة يشتمل على العمل المهنى والمجهود البدنى، ومن ثم فإن وزارة الثقافة هى تعنى فى أحد مفاهيمها وزارة ككل الوزارات، وبالتالى دعنى أكرر السؤال لماذا توجد وزارة للثقافة،
ورد د.عصفور قائلا: “هى الوزارة المعنية بالتربية الإبداعية لقدرات الأمة” …إلى أن قال “الثقافة هى الرؤية الشاملة للحياة، على نحو يستلزم أن ينتقل الإنسان من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية”….الخ.
وعندى أن الثقافة هى جماع وعى مجموعة من الناس فى وقت بذاته فى بقعة بذاتها، والمثقف هو من يستوعب ويمثل هذا الوعى بقدر أكبر.
فثمة ثقافة تسمى ثقافة الخرافة، وثقافة الكلمات دون الفعل (ربما أكثر ثقافة العرب حالياً) والثقافة السلفية والثقافة العلمية، وكل هذا كان وما يزال يشغلنى وأنا أحاول أن أمارس دورى فى هذا المجلس الأعلى للثقافة
[5] – لا أظن أن استعمال كلمة “الميتافيزيقا ” أصبح يستحق نفس المشروعية التى كان يتمتع بها سابقا بعد أن امتدت الفيزيقا إلى كل ما بعدها !!! فهل عاد شيء إسمه “ميتا” “فيزيقا “؟
[6] – أذكر أن الأستاذ عباس العقاد ذكر أن الذى ينشأ فى الريف تتاح له فرصة أن يتثقف جنسيا من سلوك الحيوانات والطيور الداجنة، بحيث لا يحتاج إلى ما يسمى الثقافة الجنسية التى فشلت النظم التعليمية -عندنا على الأقل- أن تقدمها بأى قدر من الموضوعية للأطفال خاصة. ويبدو أن حيرتى بدأت من مثل ذلك
[7] – كولن هنرى ولسون كاتب إنجليزى ولد فى ليسستر فى إنجلترا. ولد كولن لعائلة فقيرة من الطبقة العاملة. تأخر فى دخول المدرسة، وتركها مبكرا فى سن السادسة عشر ليساعد والده، عمل فى وظائف مختلفة ساعده بعضها على القراءة فى وقت الفراغ، بسبب من قراءاته المتنوعة والكثيرة، نشر مؤلفه الأول (اللامنتمى) 1956 وهو فى سن الخامسة والعشرين
[8] – Michel Foucault History of sexuality An Introduction Transtlated by Robert Herely Penguin Books Reprint 1984
– ميشال فوكو “تاريخ الجنسانية، إرادة العرفان” ترجمة: محمد هشام، الناشر: أفريقيا الشرق، (2004).
[9] – كتب د. أحمد شوقى (زميلنا فى اللجنة) فى مجلة سطور العدد سبتمبر 1998 “..التاريخ يبدأ بالبيولوجيا”
…بدأت الحكاية بجزيئات عضوية تستطيع أن تكررنفسها، بعد تاريخ طويل من التطور الكيماوى وذلك بأن يعمل أحدها كقالب يتكرر عليه الثانى، أول حالة تزاوج فى تاريخ الحياة
بعد التزاوج جاء الازدواج الذى يسمح بتكرر أكثر دقة ..يسمح بتوارث المعلومات المتضمنة فى هذه الجزيئات، وككل إنجاز بيولوجى يتم تثبيته وانتشاره بالانتخاب الطبيعى، وتجمعت الجزيئات ونواتج نشاطها فى تكوين معقد أكثر كفاءة: الخلية الحية الأولى، الشبيهة بالبكتيريا الحالية وتعلمت الخلايا الدرس اذى يمارسه الإنسان الآن بعد بلايين السنين: تبادل المعلومات لتكوين توليفات وراثية متنوعة، أكثر قدرة على مواجهة الظروف الصعبة.
قبل ذلك كان التكاثر لا جنسيا….لكن التنوع الذى ينتج عن التكاثر الجنسى يزيد من القدرة على التكيف
[10] – مثل تقارير ألفريد كينزى، وآخرون، عن السلوك الجنسى لدى الذكور والإناث. نيويورك، 1954داتون، جامعة إنديانا بالولايات المتحدة
[11] – أثناء الممارسة الكلينيكية، وفى قمة السرية والثقة، أعجز كثيرا عن أن أحصل على إجابات ذات دلالة عن مسألة ذروة الشهوة، وكثير من السيدات اللاتى قررن أنهن يتمتعن بذروة الشهوة يتراجعن فى ذلك بعد سنين من النضج والوصول إلى ذروة أخرى فأخرى تشككهن – مثلى – فيما كان قبل ذلك! ومن خلال مثل هذه الملاحظات، وبالمقارنة بطريقة ملء الاستمارات لا بد أن نتحفظ على أرقام الإحصاءات الانتشارية، ولا نستسلم لها أو نروج لها بطريقة تلقائية وثقانية، كما نفعل عادة دون تحفظ
[12] – الملحق (1) نقد: يحيى الرخاوى “تنويعات فى لغة الجنس ودلالاته (عبر النقد الأدبى) فى: رواية “بيع نفس بشرية”(ص 65) تأليف: محمد المنسى قنديل.
[13] – ختان الإناث جريمة إنسانية، وليس مجرد خطيئة جنسية، ولكن الختان النفسى الذى يحدث للإناث فى بعض المجتمعات المتخلفة مهما بلغ ظاهر تمدنها يكاد يكون أكبر من الختان الجسدى، فماذا لو سمع الحاضرون بحثا يثبت فيه أن المتختنات نفسيا (بالدفاعات والقهر وزيف المعلومات) أكثر برودا من المتختنات جسديا، وبنفس القياس ماذا لو سمع الحاضرون بحثا إحصائيا يشير إلى أن المنقبات أكثر استجابة جنسيا من المحجبات اللاتى هن بدوهن أكثر استجابة من السافرات اللاتى ربما يكنّ أكثر استجابة من العاريات، كل هذه أمثلة، ولكننى أعرض فى هذا الهامش تساؤلات حول طبيعة تلقى ما لا نتوقع، لا أكثر .
(ملحوظة: للأمانة أعترف أن ممارستى الكلينيكية تشير إلى مشروعية هذه التساؤلات).
[14]– Harry Guntrip, Schizoid phenomena, object-relations, and the self, Published by International Universities Press in New York, 1969 .
***********************
الفصل الثانى
الجنس “فى ذاته”: لغة كاملة
أولاً: بأى لغة نتحدث عن الجنس؟
لا أعنى بداهة العربية أم الأجنبية، الفصحى أم العامية، وإنما أنا أتكلم عن الاختيار بين اللغة الصريحة المباشرة التى تسمـِّى الأشياء بأسمائها، فى مقابل اللغة الغامضة المغتربة (المسماة المحتشمة)، ناهيك عن وضع نقط فى الكتابة محل ما يسمى الألفاظ الخارجة (خارجة عن ماذا بالله عليكم؟) أو إصدار أصوات مهمهمة فى الخطاب الشفاهى.
إن مجرد عزوف العـلم عن الحديث عن أمر مثل الجنس بلغة جنسية مباشرة هو ضد العلم، بل ويكاد يكون ضد مصداقية المتحدث، وهذا التراجع المهذّب، أو المنافق، عن استعمال اللغة الصريحة، لايـُـسأل عنه الدين ولا الأخلاق الحميدة، فلا يكاد يوجد أصرح فى الدين من فقه النكاح، ولا يوجد أصرح فى التراث من المراجع التى تناولت هذا الأمر بكل جسارة، ليس فقط فى كتب مجهولة للقارىء مثل رجوع الشيخ إلى صباه، وإنما فى كتب معروفة ومتداولة مثل: “الروض العاطر فى نزهة الخاطر”([1]) وقد اعتبر “فوكوه” أن هذا الاحتشام الزائف الذى ساد حتى طغى فى القرن التاسع عشر بالمقارنة بالصراحة والمباشرة التى كانت منذ القرن السابع عشر، هو من أهم السمات التى تميز قهر العصر الفكتورى، وأحسب أننا نمر هنا فى مصر والعالم العربى، بمثل هذه النكسة، وهأنذا، وعلى الرغم من كل هذه المقدمة الحذرة، إلا أننى لا أملك إلا أن أجارى النفاق الاحتشامى فى حديثى اليوم، وغاية ما آمل فيه هو أن أستطيع أن أخفف جرعة الصراحة وأقصرها – إذا اضطررت إليها – على بعض الهوامش أو الملاحق.
مناقشة هذا التحول الذى طرأ على خطابنا بشأن الجنس هو فى ذاته مفتاح ما آلت إليه وظيفة الجنس من إحاطة بالصمت (الرهيبِ!!) وخاصة بالنسبة للأطفال، أو من إنكار كامل حتى داخل حجرات النوم الشرعية، ولو أن بحثا أجرى على تواتر إطفاء الأنوار، وإغماض العيون ودلالة هذا وذاك فيما هو ممارسة جنسية مشروعة، فى المؤسسة الزواجية بوجه خاص، لا بد أن يفيدنا إلى أى مدى ننكر على وعينا ما نفعل، ونحن ندعى تقاربنا مع الآخر، وقد تـُـظهر لنا نتائج هذه الأبحاث أننا نمارس الجنس وكأننا لا نمارسه، أو كأننا نمارسه مع مجهول، أو: وكأننا نسرقه من ورائنا (وليس فقط من ورائهم).
وثمة اقتراح ببحث آخر يستقصى ماهية اللغة التى يستعملها أطفالنا – من مختلف الطبقات والثقافات الفرعية- لتسمية الأعضاء الجنسية (البوبو، الكلمة العيب…الخ) وسوف نكتشف كيف ننكر، أو نتنكر لكل ما هو جنسىّ منذ البداية.
إن تعبير أن هذا اللفظ أو ذاك “يخدش الحياء” يحتاج إلى وقفة، لأنه تعبير يدل على أن النفاق عندنا قد أزاح الحياء الحقيقى، ليحل محله حياء زائف “سابق التجهيز”، ولابد أن يكون هذا الحياء الزائف هش أو زجاجى القوام، وأن يكون، اللفظ الجنسى الصريح، ماسىّ الجوهر قادر على الخدش بمجرد أن نتلفظه، وإلا فما معنى هذا التعبير!!!!
لقد حدث انشقاق بين الكلام ومضمونه الحقيقى فى هذا المجال خاصة، بين اللغة الحقيقية، والمتولدة والمباشرة وهى لغة الناس (الذين يسمون “بيئة”، وهى أقرب كلمة لمعنى الثقافة الحقيقية) ولغة الطبقة المحتشمة (أو الموصوفة بالاحتشام) وهى اللغة التى تكاد أن تصبح “لا لغة” لتفريغها من وظيفتها الدالّة، وكان بعض نتيجة ذلك، هو ما لحق بموقفنا من الجنس، بل إن هذاالانشقاق نفسه يمكن أن يصبح دلالة على هذا الموقف، بقدر ما هو تدعيم لهذا الموقف وإبقاء على استمراريته.
وأورد هنا بعض مظاهر دلالات استعمال اللغة الجنسية بصورها المختلفة فى حالتنا الآن:
1) أصبح الحديث عن الجنس بلغة جنسية يصنف المتحدث فى موقع طبقى بذاته فهو إما فى أدنى الشرائح، أو أعلى أعلاها، وإن كانت الشرائح الأعلى قد تلعب لعبة أكثر خفاء فتتحدث عن الجنس بلغة جنسية صريحة لكنها أجنبية وهو نوع من “الصراحة المستورة” (إن صح التعبير) وهى أكثر كذبا لا تجملا ..
2) حلت الأفلام الجنسية فى النت والموبايل محل الحديث الجنسى المباشر، (ربما كما حل التليفزيون، والشـَّـاتْ عبر المحمول، محل الحوار الحيوى الحى)
3) أيضا: حلت النكت الجنسية محل المصارحة الجنسية (وأحيانا محل الممارسات الجنسية)
4) أصبحت القصص المطعمة باللغة الجنسية (وليس بالخبرات الإبداعية ذات البعد الجنسى) من المحظورات (!!!=!!!”، ربما أيضا لتعويض النقص).
5) أصبح علم الجنس، ومنه هذه المحاضرة، وربما تدريسه: يدرس بلغة باردة باهتة، وكأنك تصف رائحة زهرة بعدد من معادلات على كمبيوتر ملون.
6) أصبح التراث الأكثر صراحة وجرأة ليس فى المتناول أصلا، حتى “ألف ليلة وليلة”، أو “كتاب الأغانى”، بل إن الأيدى امتدت إلى التراث المعاصر بالحذف الانتقائى، ليس فقط بواسطة الرقابة والسلطات الرسمية، وإنما بواسطة بعض الناشرين هنا وهناك.
الخلاصة: إن انفصال لغة الجنس عن الجنس، سواء فى الحديث عنه، أو تعليمه، أو حتى ممارسته، هى من علامات انفصال الجنس نفسه عن تكاملية الوجود مع الجسد من ناحية، ومع اللغة ككيان فينومينولوجى غائر من ناحية أخرى، وعن “الكلام” كوسيلة للتعبير من ناحية ثالثة.
ثانيا: الجنس لغة فى ذاته
لن أدخل فى تعريف اللغة كثيرا، لكننى سوف أكتفى بالإشارة إلى أن اللغة هى من ناحية كيان غائر جاهز منظم، لها تجليات دلالاتية تفيد فى التعبير والتواصل، والجنس فى ذاته وبذاته يوفى بكل ما تعنيه اللغة من تركيب ووظيفة.
يقوم الجنس بذاته فى تحقيق الحوار الواجب تفهمه لمعرفة طبيعة الصعوبات ودلالات اللقاء، على أى مستوى فى السواء والمرض، وهو يستعمل كل الأدوات المتكاملة التى تحقق له فكرة الحوار فالتواصل، أو اللاتواصل، بمعنى أنه يستعمل اللغة اللفظية واللغة غير اللفظية من أول نظرة العين، حتى رائحة العرق، مارا بكل خـلجات ونبضات واستجابات الجسد، ومثل أى حوار ولغة توجد إشارات نداء، وعلامات استجابة، ودلالات قبول أو رفض، وتطور اقتراب، وسياقات جدل، وتوجه نحو غاية، واستيعابٌ وردّ، فـ: نداء، وأهم ما يهم بين كل هذا هو موضوع توظيف الجنس لـلتواصل، وكيف يعبر الجنس عن نجاح أو فشل أو تجاوز أو صعوبة عمل علاقة مع آخر، ومن خبرتى أستطيع أن أزعم أنه من الممكن أن نترجم كل الصعوبات الجنسية إلى ما يقابلها فى اضطرابات اللغة، فخذ مثلا العُـقلة (فى الكلام) Stammering، وما يقابلها فى الجنس من العجز عن المبادأة أصلا، وبما أن المبادأة (لا النداء) تبدأ عادة من الرجل، فإن هذه العقلة الجنسية تظهر فى الرجل أكثر من المرأة: حيث تعلن العـِـنـّة (العجز عن الانتصاب) ما يقابل ”العقلة” فى الكلام، فى حين أن المرأة قد لا تكـتشف عِيّها الجنسى (برودها عادة) إلا فى مراحل متأخرة من الحوار (الجنسى)،.
ثم مثال أخر، وهو “التهتهة” Stutteing، وهذا ما يصيب الرجل فى الجنس أيضا، كما يصيب المرأة وإن كان كلٌّ بطريقته، حيث تتذبذب الاستجابة حدة وفتورا، وكأن الخطاب الجنسى بعد بدايته يجد من المعوقات الداخلية والخارجية، الحقيقية والمتخيلة، ما يعرقل اكتماله بانتظام وكفاءة.
ودون الإطالة فى تعداد أنواع أخرى من الاضطرابات الجنسية وترجمتها إلى ما يقابلها من اضطرابات اللغة، دعونا نتساءل عن ما هو المضمون الذى تريد اللغة الجنسية أن تعبر عنه، أو تكونُه، أو تمارسُه، وبالتالى يمكن أن نتصور قصورنا دون تحقيق هذا المضمون أو نجاحنا فى ذلك. وفى هذا أطرح الأمر كالتالي:
إن الجملة المفيدة التى لا تنطق بالألفاظ، والتى يريد الإنسان أن يقولها بالممارسة الجنسية (بعد تجاوز اقتصارها على ”التكاثر”) وانطلاقها إلى وظيفتها الجديدة وهى “التواصل“ إنما تقول:
”إن وجودى لا يتحق إلا بوجودك معى: معى أقرب، أَدْخـَـل، أكثر التحاما
أبتعد لأكون نفسى، لأعاوِد وأنا أشعر بنا (برنامج الذهاب والعودة in and out program)
أسمح لك ولا أخشى الانسحاق، وأتركك ولا أخشى اختفاؤك،
وكذلك تفعلـــ “ين”، حتى نتلاشى معا، فينا، لنتخلق من جديد: جديدين: معاً، وكلّ على حدة: معاً.. أيضا”
نلاحظ هنا أن هذه الجـُمـَل لم تظهر فيها اللذة لذاتها، ولكن الجملة من بدايتها لنهايتها محملة بمحاولة الحفاظ على تحمل كل هذه المخاطرة بالتلاشى فالتخلّق من جديد، (أنظر بعد)، فإذا تمت هذه الجمـلة من خلال “حوارات الوعى والجسد” وحققت مضمونها، فإن الجنس يؤدى وظيفته التواصلية كأروع ما يكون الإبداع .
فإذا صح أن الجنس – عند أغلب البشر– قد تجاوز – دون إلغاء – دوره التناسلى (التكاثرى) إلى هذا الدور التواصلى الإبداعى، فإن التكاثر البشرى يمكن أن تعاد صياغته من خلال تطور نوعية الوجود البشرى، وليس مجرد الحفاظ على النوع.
بمعنى أنه إذا كان التكاثر ينشأ من اندماج خليتين حتى لا يعودا كذلك إذ يتخلق منهما كائن جديد، وأن هذا يتم عن طريق رشاوى الدافع الجنسى، فإن التواصل يحقق نفس الوظيفة ولكن على مستوى الفرد نفسه، بمعنى أن الممارسة الجنسية فى صورتها الإبداعية المطلقة إنما تحقق هذا الامحاء فالتجدد الإبداعى (أنظر لاحقا: الجنس/والموت/ والبعث)
وفى نطاق هذه الفقرة الخاصة بإيضاح المضمون الذى يمكن أن توصله لغة الجنس ينبغى التنبيه على عدة أمور:
الأول: أن فحوى هذه الجملة ليس فى بؤرة الوعى فى الأحوال العادية، بل إنها غالبا ما تكون بعيدة عن دائرة الوعى الظاهر أصلا.
الثانى: إن مصاحبات الخبرات الجنسية، ومقدماتها، وبدائلها، وتجلياتها قد تعبر – بشكلٍ ما – عن هذه الجملة المفيدة، فى حين أن الممارسة الجنسية ذاتها قد تخلو منها بدرجات مختلفة (على مستوى الوعى على الأقل)، وهذا لا يدل على خلوها الحقيقى منها، وإنما يشير إلى صعوبة التحام الجسد مع الوعى فى وجدانٍ كيانىّ لحظىّ بشكل مباشر ومتكرر، مع التذكرة أن الجسد هو: “وعى متعين” Comcretized Constiousness.
الثالث: إذا زاد الإدراك الحاد المعقلن بما تفيده هذه الجملة، حتى أصبح صريحا ماثلا، فقد ينقلب إلى معوّق للممارسة الجنسية الطبيعية السلسلة.
لكل ذلك، فإن جملا أخرى، و إن كانت تبدو هامشية، إلا أنها تقوم بوظيفة التدرج، والتيسير، حتى يحقق الجنس هدفه التواصلى الإبداعى، دون مواجهة بصعوبات بـَدْئية، تتزايد حين تطرح سلبيات المشاركين معا، ذلك أنه لكى يتحقق مضمون هذه الجملة، فإنها تحتاج إلى المشاركة من جانبين لا من جانب واحد، وبديهى أن مستوى الوعى بها، ومستوى التطور البشرى لكل شريك، ومستوى القدرة على تحقيقها يختلف مثل كل الاختلافات الفردية، ومن ثم تقوم الدفاعات النفسية، والاحتياجات الجزئية، والأوهام الغرامية: باللازم للتخفيف من وطأة هذا التحدى الصريح الصعب .
الكشف عن المستوى الأخفى للغة الجنس:
على أن لغة الجنس لا تقتصر على هذا الحوار الجاذب للطرفين، وإنما هى تتنوع وتتشكل حسب أبعاد متعددة ومختلفة من القرب والبعد، والقبول والتردد والرفض…الخ، وأورد فيما يلى بعض الجمل الجنسية الجزئية البادئة، وإن بدت لأول وهلة بعيدة عن الهدف الإبداعى التواصلى للجنس، فإنها جزء من الجدل الجنسى حتى تبدو خطوة نافعة، شريطة ألا تحل محل الجملة الأكمل، والولاف البعث، وهى جـَـمـَـلَ تمارس حوارات الوعى.
مثلا:
(1) أنا خائف أريد أن أرجع لرحم أمى
(2) أنا خائفة أريد أن أحتمى فى ظل أبى
……..
……..
I- هل تريدنى (أنت تريدنى): إذن أنا موجود
II– هل أرضيك؟ (أنا أرضيك) إذن ثمَّ من يحتاج وجودى: إنّ لىِ معنى.
هذه أمثلة لحضور “الآخر” فى وعى المشارك بدرجات وتشكيلات متنوعة وبقدر ما تكون مثل هذه الجمل تمثل اللغة التى يقولها الجنس (دون ألفاظ طبعا ودون لزوم الحضور فى بؤرة الوعى) يمكننا إذا أحسنا الإنصات أن نستمع إلى جمل أخرى بديلة  مغتربة، ومجهـِـضة، وهى جمل بكل تجلياتها تمثل غالبية ما يمارَسُ من جنس اغترابى (عمره قصير عادة)، ذلك لأنه مبنى على ما لا يحفظه أو يحافظ عليه، لأنه إذا كان لم تعد بنا حاجة – تطوريا – إلى الجنس بهذه الصورة المتواترة للحفاظ على النوع، وفى نفس الوقت هو لم يَرْقَ ليقول الجمل المفيدة للممارسة الإبداعية السوية، فإنه يصبح فعلا ممارسة مغتربة، قهرية أحيانا، منفصلة عن الوجود الكلى، عاجزة عن تحقيق وظيفتها الجديدة أصلا.، كل ذلك يمكن رؤيته من خلال الموقف الأساسى لهذا الجنس المغترب الذى تبرره اللذة من ناحية، والذاتوية من ناحية أخرى، وهو ينبنى على: نفى الآخر من البداية (فلا يعود إلا مسقطا لاحتياجات الذات ووسيلة لتحقيق اللذة الذاتوية الاغترابية التى يمكن أن تتحقق دون اعتبار للآخر)، إذن: ثمة لغة أخرى يقولها الجنس، وهى وإن كانت ذاتية صرف، فهى لغة أيضا، وقد وردت فى الجزء الثانى لشرح “سوء استعمال الجنس” لغير ما هو (ولا حتى للتكاثر أو للتناسل)، مثلا فى صورة الآخر كمُذَبْذِبٍ (للمرأة) والأخرى كوسادة إستمنائية (للرجل)
مغتربة، ومجهـِـضة، وهى جمل بكل تجلياتها تمثل غالبية ما يمارَسُ من جنس اغترابى (عمره قصير عادة)، ذلك لأنه مبنى على ما لا يحفظه أو يحافظ عليه، لأنه إذا كان لم تعد بنا حاجة – تطوريا – إلى الجنس بهذه الصورة المتواترة للحفاظ على النوع، وفى نفس الوقت هو لم يَرْقَ ليقول الجمل المفيدة للممارسة الإبداعية السوية، فإنه يصبح فعلا ممارسة مغتربة، قهرية أحيانا، منفصلة عن الوجود الكلى، عاجزة عن تحقيق وظيفتها الجديدة أصلا.، كل ذلك يمكن رؤيته من خلال الموقف الأساسى لهذا الجنس المغترب الذى تبرره اللذة من ناحية، والذاتوية من ناحية أخرى، وهو ينبنى على: نفى الآخر من البداية (فلا يعود إلا مسقطا لاحتياجات الذات ووسيلة لتحقيق اللذة الذاتوية الاغترابية التى يمكن أن تتحقق دون اعتبار للآخر)، إذن: ثمة لغة أخرى يقولها الجنس، وهى وإن كانت ذاتية صرف، فهى لغة أيضا، وقد وردت فى الجزء الثانى لشرح “سوء استعمال الجنس” لغير ما هو (ولا حتى للتكاثر أو للتناسل)، مثلا فى صورة الآخر كمُذَبْذِبٍ (للمرأة) والأخرى كوسادة إستمنائية (للرجل)
ومن بعض هذه الجمل الاغترابية غير المعلنة بالألفاظ:
(1)
أنا ألتذ، بأن أستعملك منفيا …….(فأبقى كما أنا)
(2)
أنا أسيطر عليك حتى لايبقى غيرى ….(هذا أضمن)
(3)
أنا ألتهمُكَ فلا يبقى منك شيء بعد تمتعى بلذة التهامك…….. (فأرضى بما هو أنا فى موقعى)
(4)
أنا أحتاجُك حتى أشبع، على شرط أن أنساك تماما….. (فلا يهددنى التلاشى فالبعث)
إلى غير ذلك بالرغم من إعلان ما يشبه كل مظاهر الحب والغرام.
وعلى النقيض من احتمال ظهور الصعوبات الجنسية إذا وصلت لغة الجنس الصريحة إلى الوعى، فإن الجنس الاغترابى ينجح عادة، ويستمر نجاحه كلما خَفِىَ اغترابه!!
وبتعبير آخر:
إن الصعوبات الجنسية إنما تظهر وتشتد حين تكون اللغة الجنسية السليمة هى المطلوبة، وفى نفس الوقت غير موجودة.
أما إذا ألغى احتمال التواصل أصلا، وأصبح الجنس مغتربا ذاتويا، فإن الممارسة الجنسية تبدو مجرد عادة مكررة، قادرة على أن تستمر ربما لخفض التوتر بأقل قدر من جدل التلاقى، دون إبداع.
وإليكم بعض الإيضاحات:
(1) تظهر العنّه مثلا حين يهدد “الموضوع” (الشريك) أن يكون “موضوعا” حقيقيا، أو ملوّحا، أو واعدا بذلك، أو حين يشترط الشريك ذلك (ليس بإعلانه بالألفاظ عادة)، وكأن العنة تقول:
أ- إختلت إسقاطاتى، فلم أعد أستطيع أن أستعملــُـك ”موضوعا حقيقياً!!” ليس فى مقدورى أن أكذب .
أو لعلها تقول:
ب – إن لذتى لا تتحقق إلا بأن أستعملك دون أن أتعرف عليك.
(2) وسرعة القذف قد تقول:
أ- رجعت فى كلامى، لا أحتمـلكِ كأخرى، لا أطيق الاستمرار، نــُـنـْـهـِـهـَـا أحسن.
أو لعلها تقول:
ب- أخاف من التلاشى. قد أموت بلا عودة، يكفى هذا.
أو ربما تقول:
جـ- خـِفـْتْ أن أدخل لا أخرج، أو أن أخرج لا يُسمح لى ثانية. سلامْ.
(3) وقد تقول المرأة بالبرود الجنسى:
أ- أعرف كذبك ولا أريد أن أشارك فيه، رغم البداية الخادعة معك
أو لعلها تقول:
ب- اكتشفت كذبى، ولم أستطع أن اتمادى فيه.
إعتراضات وردود:
الاعتراض:
الأغلب فى الأبحاث الحديثة هو تفسير القصور الجنسى عند الرجل خاصة بخـلل عضوى فى الأجهزة المنوطة بالانتصاب؟ حتى قيل - مؤخرا- إن نسبة القصور الناتج عن أسباب عضوية – تصل إلى 80 % أو 90 % من حالات العنّة (فشل الانتصاب)، وهذا الزعم كان مقولة أطباء الذكورة والتناسلية قديما، لكن الحديث هو أن أغلب الأطباء النفسيين أصبحوا يوافقون عليه، ويرتاحون له، ربما تبريراً للصعوبات التى يلقونها فى مساعدة مرضاهم بالعلاج النفسى وحده لتصحيح علاقتهم بالجسد والجنس والآخر والحياة.
الرد:
لقد تدهورت تفسيرات الأمراض النفسية عامة وأصبحت تُعزى إلى خلل كيميائى، أو خلل عضوى، فى المقام الأول (والأخير أحيانا)، وذلك حين عزف أطباء النفس عن أن يبذلوا الجهد لفهم لغة الجنس الطبيعى حتى يمكنهم أن يستعملوا العقاقير بشكل انتقائى يؤكد إسهامها فى قطع الحلقة المفرغة حتى يستعيد المريض قدرته على استعمال كل مستويات وعيه فى اتساق صحى.
ولنفس الأسباب التجارية والاستسهالية أصبح الأسهل على الطبيب أن يفسر القصور الجنسى بهذا الخلل العضوى البحت أو ذاك فى أجهزة الأداء، ناسيا أن المخ هو قائد المسيرة وهو العضو الأساسى للوظيفة الجنسية.
لا يمكن إنكار أن ثمَّ خللا كيميائيا محتملا يمكن أن يوجد فى حالات الاضطراب النفسى عامة، ولكن هل هو خلل مُسَبِّب؟ أم خلل مصاحِب؟ علما بأنه لا يجوز إنكار أن ثمَّ عجزا وظيفيا محتملا قد يصيب الجهاز الطرفى المسئول عن الانتصاب فى بعض حالات العنّة، ولكن المهم هو البحث عن سبب هذا العجز: هل هو نتيجة لانصراف الدماغ؟ أو إجهاض التواصل؟، أو استمرار عدم الاستعمال؟، أم أنه الخلل الأساسى بغض النظر عن ماذا ”يقول”؟
وكما أن العقاقير المضادة للذهان تثبـِّط المخ الأقدم، وتسمح للمخ الأحدث أن يقود وبالتالى يمكن – بالعلاج المناسب – أن يتم تصالح تكاملى بين المستويات (مستويات الوعى= الأمخاخ)، فإن العقاقير المالئة للجهاز الجنسى الطرفى إنما تسمح للمخ الأعلى إن شاء أن يمارس مهمته الجنسية، سواء كانت اغترابية، أم تواصلية مبدعة، ومن ثم فإن فضل الفياجرا - ولو كحل مؤقت – هو أنها تعمل بمثابة تأكيد ضمان كفاءة الجهاز الطرفى بما يتيح – ولو فيما بعد- للجهاز المركزى أن يستعمله كيف شاء متى شاء.
ويظل الجنس لغة بعد كل هذا، لأنه لو مورس الجنس بصفة مستمرة نتيجة هذا الضخ الطرفى المصنوع: فإنه لا يؤدى وظيفته التواصلية فهو يفشل – ولو بعد حين– فى اختراق الحاجز الماثل بين الطرفين قسرا، لأن السلبية تظل سمة هذه الممارسة المصنوعة من حيث عجزها عن تحقيق تواصل وتكامل وبعث.
بل إن الخطر كل الخطر، هو أن تساعد مثل هذه الحبوب على اختزال دور الجنس من لغة للتواصل إلى أداة للتفريغ واللذة وإزالة التوتر لا أكثر، ذلك أن الانتصاب الطبيعى فى حد ذاته يعلن أن المخ وافق على الاقتراب، فأرسل رسائله التى أعلنها هذا النجاح الفسيولوجى ممثلا فى الانتصاب، ومن جهة أخرى تتلقى المرأة الرسالة، حيث أن هذه العملية فى ذاتها هى إعلان لها أنها مرغوب فيها بدليل (بأمارة) هذا الانتصاب، فإذا نحن فرحنا بتجاوز هذه الخطوة، واستسهلنا استعمال الضخ الكيميائى (بالفياجرا مثلا)، فإن معنى ذلك أننا نفرح بترديد صوت ببغائى كأنه الكلام، مع أنه خال من مضمون التواصل على الرغم من الإبقاء على شكل الصوت (اللذة).
إذن للفياجرا دورين نقيضين، إما الاستعمال الإيجابى، وهو الاستعمال المؤقت، لكسر حلقة التردد المغلقة فاستعادة الثقة، ومن ثم تعود اللغة السليمة تعبر عن القدرة والرغبة فالتواصل، أو الاستعمال السلبى حين يحل هذا التنشيط الكيميائى الميكنى (الميكانيكى) محل الاختبار التواصلى بصفة دائمة، فيصبح الكيان البشرى الذكرى مجرد مُذَبّذِب مغترب لا أكثر، ويصبح الكيان الأنثوى وعاء للتفريغ يختلف موقفه حسب نشاط خياله، وحسب العمر الافتراضى لهذا الاستعمال المصنوع، وهكذا نفقد فرصة الإنصات الواعى والدال للغة الجنس أصلا.
[1] – كثير من المناقشات التى دارت حول مسألة اللغة المستعملة فى تناول المسألة الجنسية حتى فى سياق أدبى كان وراءها بحث فى دلالات ذلك عبر التاريخ من أول الموقف من عوليس جيمس جويس حتى كتابات د،هـ لورنس، هذا بالإضافة إلى دلالة ما لحق بديوان الحسن بن هانئ، وألف ليلة وليلة، وغيرها من مصادر التراث العربى.
وقد تراجعت فى آخر لحظة عن أن أقتطف استهلال هذه المحاضرة من كتاب “الروض العاطر فى نزهة الخاطر” تأليف قاضى الأنكحة أبى عبد الله محمد بن محمد النفزاوى وهو يقول ” الحمد لله الذى جعل اللذة الكبرى فى ..إلخ”، وسوف أكتفى بالإشارة إلى خطاب الوزير الأعظم “عبد العزيز صاحب تونس وهو يدعوه إلى تأليف الكتاب بعد اطلاعه على كتاب سابق (تنوير الوقاع فى أسرار الجماع)، يقول الوزير “..لا تخجل ..فإن جميع ما قلته حق،..(و) هذا العلم …يحتاج إلى معرفته…….، ثم يضيف: ولا يجهله ويهزأ به إلا كل جاهل أحمق قليل الدراية”….الخ
**************************
الفصل الثالث
الجنس والجسد
اغتراب الجسد:
غُيِّب الجنس حين غـُـيـّـب الجسد، فالإنسان المعاصر – غالبا– قد انفصل عن جسده:
(1) حين طغى العقل مستقلا نتيجة فرط الذهننة Hyper intellectualization))
(2) حين أهمل الاستماع إلى لغة الحواس حتى أصبحت الحواس مجرد مداخل ونوافذ ومحطات إنذار، وليست قرون استشعار، ولبنات تكامل .
(3) حين سُخـِّـر الجسد كمجرد أداة للاستهواء ومجال للاستهلاك منفصلا عن تكامل الوجود البشرى.
(4) حين أُهـْـمـِـل الجسد كوسيلة معرفية، تشارك فى الإبداع ولها حضور وجودى دال، باعتباره وعيا متـَـعـَـيـِّنا Concretized Consciouness
وقد ترتب على كل ذلك أن الجنس المُفَعْلنَ فى جسدٍ مغترب، أصبح مغتربا بدوره، واقـتصر دورهما (الجنس والجسد) إما على تحقيق لذة منفصلة، وإما على إعلان عجز إنشقاقىّ دال.
الجنس والموت والبعث
ذكرنا فى الجملة المفيدة السالفة الذكر التى يمكن أن يقولها الجنس التواصلى الإبداعى كيف تكون الممارسة الجنسية هى الوسيلة إلى التكاثر الوجودى بمعنى اختفاء الاثنين المتلاحمين فى سبيل تخليق اثنين آخرين جديدين، وأجد من المناسب أن أعيد هذه الجملة المفيدة هنا من جديد، إذْ تقول:
”إن وجودى لا يتحقق إلا بوجودك معى: معى أقرب، أدْخـَـل، أكثر التحاما، لا أختفى إذ نذوب فى كيان واحد لا نعرفه من قبل، أبتعد لأكون نفسى بك، بنا (برنامج الذهاب والعودة in and out program)، أسمح لك ولا أخشى الانسحاق، وأتركك فلا أخشى اختفاؤك، وكذلك تفعلين حتى نتلاشى معا، فينا، لنتخلق من جديد جديدين معا وكل على حدة: معاً أيضا”.
ومعنى الاختفاء هنا هو تلاشى الفرد فى اللقاء كخطوة لازمة لكى يعود جديدا، وهذه الخطوة ليست مجازية فى التناسل البيولوجى، وهى كذلك بالنسبة للجنس التواصلى الإبداعى، فإن نفس الخطوات تتم ولكن يحل محل التناسل البيولوجى تخليق الذات (الذاتين) أى التغيـّر النوعى للشريكين إلى ما هو أكثر نضجا، بمعنى إعادة الولادة أو إبداع الذات من خلال لقاء الآخر والاندماج فيه حتى ”التلاشى للتخلّق” (وإن كان لا يكون بهذا الوضوح ولا هو فى بؤرة الوعى الظاهر، لكن أى قدر منه هو نجاح كافٍ غالبا).
ولو أننا صورنا هذه الجملة المفيدة بالتصوير البطئ، ثم تصورنا توقيف التصوير: إذن لضبطنا هول لحظة التلاشى، (العدم / الموت) وكأننا بذلك نكتشف أن الجنس التواصلى الإبداعى لا يتم إلا إذا تحقق ما يفيد “موتٌ فـَـبـَـعـْـث” ومن ثم إعادة البعث([1])، من هنا يأتى الشعور بالمخاطرة، إذْ من يضمن؟
وقد كنت أرفض قديما بشكل ساخر تعبير”أموت فيك، وتموت فىّ“، ثم انتبهت مؤخرا إلى احتمال أن هذا الموت بالجنس قد يكون فى نفس اللحظة إعادة ولادة، وبالتالى فإن فينومينولوجيا الجنس تؤكد على هذه العلاقة الوثيقة بين “الجنس التكامل” و”الموت/البعث“.
ومن ثم فإن الخوف من الجنس حتى العجز، يمكن أن نتابع معناه من عمق معين، حتى يثبت فى بعض الحالات أنه ليس إلا خوف من الموت، وهو ما أشرنا إليه فى الفقرات السابقة فى جملة “الذهاب بلا عودة”، أو جملة ”الدخول بلا خروج”.. إلخ.
كما أنه قد يكون خوفا من التهام الآخر حتى التلاشى فيه، بلا عودة كذلك!!
الجنس والدين:
علاقة الجنس التواصلى بالدين (والإيمان) علاقة وثيقة تماما، وقديما كانت الأعضاء الجنسية (خاصة القضيب) رموزا تُعبد([2])، وكان التفسير الذى قيل فى تقديس العضو الذكرى هو أن هذا دليل على حرص الانسان من قديم على التكاثر واستمرار النوع، إلا أن هذا التفسير ليس مقنعا بشكل كافِ، ذلك لأن الأوْلى كان تقديس الرحم وهذا يحتاج إلى بحث خاص لمعرفة هل المسألة هى تقديس الجنس احتراما للتكاثر؟ أم تقديس الذكورة تمييزا متحيزا لها؟ وقد غلب ذلك فى معظم مراحل التاريخ، إذ لو أن التقديس منشؤه الحدس البيولوجى لعلاقة الجنس بالتكاثر، لكان الأولى – كما ذكرنا– تقديس عضو المرأة التناسلى أو الرحم، لأنه الألزم والأهم لحفظ النوع. وسواء كان تفسير علاقة الجنس بالدين من خلال الحرص على التكاثر واستمرار النوع أو غير ذلك، فإننا نحتاج إلى تفسير مواز لعلاقة الجنس بالبعث ونحن نقدم الجنس كوسيلة للتواصل ليست قاصرة على وظيفة التناسل.
وهكذا أطرح الفروض التالية التى تحتاج إلى تقصٍّ خاص ومراجعة:
أولا: إن فى الدين إلى الإيمان: امتداد فى الكون،
وفى الجنس امتداد للأخر فى الآخر إلى الدوائر الأوسع (فى الكون وما بعده….)
ثانيا: إن فى الدين خضوع لله،
وفى الجنس خضوع للشريكين أحدهما للآخر، وبالعكس، ثم: معا إليه، فهو خضوع لما يمثله اللقاء، وما يعد به البعث الجديد.
ثالثا: إن فى التصوف ذوبان (تلاش) فى المطلق إلى بعث،
وإن فى الجنس تلاش فى الآخَر إلى عودة دون استبعاد المطلق.
رابعا: إن فى الدين/الإيمان: تأكيد على العلاقة بالآخر (الناس، الجماعة، الغير)،
كما أن الجنس لا يكون بشريا تواصليا إلا إذا كان ممتدا فى دوائر الوعى إلى الآخر، فما بعده.
الجنس والحب:
أين يقع ما يسمى “الحب” فى هذه الممارسة التى أسميناها الجنس التواصلى الإبداعى؟
إن الحب، وعلى الرغم مما طرأ عليه من تشكيلات وتنويعات (على اللحن الأساسى) مازال يشغل أغلب الناس وهمًا أو حقيقة، وهو يتجلى فى الحياة الواقعية بقدر ما يتجلى فى الخيال والإبداع، وتصانيف الحب وتجلياته من الاتساع والاختلاف بحيث يمكن أن نكتشف من خلالها أنها محاولات لإنكار صعوبات التواصل البشرى كما أشرنا إليها سالفا.
وسوف نكتفى هنا بالإشارة إلى عناوين متواضعة عن علاقة الحب (بأى معنى كان) بالجنس على الوجه التالى:
(1) الحب ليس تساميا عن الجنس، ولا هو شرط مسبق دائما: لممارسة الجنس
(2) الحب هو من مقدمات الجنس (عادة) لكن الجنس لا يظهر صريحا فى كل خبرات الحب، إلا فى ظروف واقعٍ يسمح بذلك
(3) الجنس التواصلى يحقق بدايات وعمق غاية الحب: التلاشى معا للبعث جديدن معا، وهو بذلك إنما يرتقى بالحب
(4) الحب الخاص جدا (الامتلاكى عادة) هو احتياج مشروع، لكنه ليس هو الأرقى تواصلا وإبداعا
(5) القدرة على الحب هى الأكثر اقترابا من التواصل الجنسى الأرقى، بالمقارنة بخصوصية الحب الاحتكارى الامتلاكى.
(6) الحب، بالتعريف الأحدث (الرعاية والمسئولية وتـَـحـَـمـُّـل الاختلاف والاستمرارية) هو أيضا أقرب إلى تحقيق الإبداع الممكن بالجنس.
(7) الفصل بين الحب والجنس هو فصل وارد، وهو تنظيمى تاريخى نسبى، ولكنه ليس فصلا طبيعيا كبديل مناسب للمستوى الأرقى للوجود البشرى
(8) الجنس بغير حب ظاهر إما أن يكون اغترابا لذّيا مؤقتا،
أو أن يكون قد احتوى الحب تكاملا حتى لم يعد يمكن التمييز بينهما.
[1] – لعل فى ذلك ما يوازى فاعلية النوم الصحىّ السليم “الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور”
[2] – أظن عند بعض قدماء المصريين
********************
الفصل الرابع
الجنس، وتحرير المرأة..!! ([1])
مقدمة:
بالرغم مما يبدو ظاهرا من سلبية الدور الذى تقوم به المرأة فى هذه الملحمة الإبداعية الأرقى (الجنس) إلا أنه برغم دور الرجل فى الإقدام والمبادأة إلا أن حقيقة الأمر هى أن المرأة هى الأصل، وأن دورها يكاد يفرقُ دور الرجل فى نجاح العلاقة واقترابها من المستوى البشرى (الإبداعى) الذى تقدمه هذه المداخله.
استشهاد من التراث
المقتطف: تقول: عائشة القرطبية “نزهة الجلساء لأشعار النساء” للسيوطى([2])
“أنا لبْوَة لكننى لا أرتضى نفسى مناخا طول دهرىَ من أحدْ
ولو أننى أختار ذلك لم أجـِـبْ كلبا، وقد غلّــقت سمعِىَ عن أسدْ”
قضية تحرير المرأة هى من أشهر قضايا التحرير عبر التاريخ، وقد أخذت فى مصر حجما خاصا له دلالاته، ولنا فى هذا الأمر وقفة مبدئية قبل أن نعلن ما أثاره هذا المقتطف من مواقف، ولهذا نبدأ بهذه المقدمة:
(1) إن قضية الحرية (والتحرير) لا تقتصر على امرأة أو رجل بل هى قضية إنسانية أزلية لها تجليات ومظاهر، بعضها صريح وأغلبها خفى، ولا أحد يمكن أن يكون حرا إلا وسط أحرار، وكل نقص من حرية شخص أو فئة هو نقص من حرية كل فرد فى هذا المجموع، لا أحد يتحرر وحده، حتى أننى أرى أن هؤلاء الأبطال الذين حاولوا تحرير شعوبهم كانوا يطلبون نوعا أرقى من الحرية، فـَـلأَنْ تـُـحرر ناسك هو السبيل الأمثل لكى تحرر نفسك.
(2) إن قضية تحرير المرأة فى مصر – مثلا – قد سلكت سبيلا مخادعا أحيانا وزائفا أحيانا وسطحيا أحيانا أخرى، وذلك حين ركزت المرأة على مسألة المطالبة بالمساواة بالرجل أساسا. (وهو ليس حرا أصلا، أنظر بعد)
(3) إن المرأة الإنسان التى احتد وعيها فالتقطت وضعها المقهور قد شغلت نفسها بهذا الكفاح أحادى الجانب: “لتحرير المرأة”، وكأن قضية الحرية والتحرير يمكن تجزئتها، وهى لم تركز - بالتالى – على إبداع الحياة الذى هو السبيل الوحيد لتحريرها وتحرير كل الناس نساءً ورجالا.
(4) إذن، فلا سبيل لتحرير المرأة إلا بتحرير الإنسان: ولا مفر لتحرير المرأة من تحرير الرجل فى نفس الوقت، وقد يثبت بالنظر الأعمق أن الرجل أكثر عبودية، من المرأة المقهورة المـَـضـَـيـَّعة، ولكن السؤال هو: من أين نبدأ؟
(5) إن المجالات التى تناولت فيها قضية تحرير المرأة دارت أساسا فى فلك الحقوق المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، وظروف العمل وما شابه، مع أن إشكالة تحرير المرأة (والرجل) تظهر أكثر ما تظهر فى العلاقات الحميمة التى تصل قمتها فى عمق الالتحام الجسدى (الجنس)، ولو أن المرأة (والرجل) انتبها إلى ممارسة الحرية “معا” أثناء ممارسة الجنس، إذن لاقتربا من حقيقة العلاقات البشرية الصحيحة، ذلك لأن مجال العلاقة بالموضوع (بالآخر) هو الاختبار الحقيقى لأية حرية مزعومة، إذن، فلا مفر من اقتحام هذه الصعوبة باعتبارها السبيل الأمثل، أو الأساسى، لتأنيس الإنسان،
فإنما تتأكد أَنـْـسـَـنـَـة الإنسان بأمرين:
الأول: أنه يمكن أن يختار (بسائر مستويات اختياره) متحملا نتائج ذلك،
والثانى: أن يمارس هذا الاختيار فى “حضور” آخر له اختياراته أيضا، (المختلفة عادة).
والآن، نرجع إلى المقتطف:
تأبى المرأة (على لسان عائشة القرطبية) أن تكون “مناخا” لأحد، (لرجل) كائنا من كان هذا الأحد، والمناخ (بفتح الفاء) هو موْضعٌ ينخّ فيه الجمل، وهو تعبير شديد الدلالة فى هذا الموقف بالذات، وفى ريف بلدنا لا يسمى مناخا إلا المكان الذى اعتاد أن “ينخ” فيه الجمل، وليس أى مكان ينخ فيه والسلام، أى أن الجمل إذا نخ أثناء سيره هنا أو هناك: لا يعتبر المكان الذى نخ فيه “مناخا”، وإنما يطلق لفظ المناخ عادة على المكان الدائم فى الحظيرة أو خلف الخيمة، المكان الذى اعتاد أن ينخ فيه عند عودته إلى داره (حظيرته)، فتصور معى وضع المرأة فى المنزل، وهى تنتظر جالسة أو مضطجعة، حين يعود بعلها من شقائه، أو من مزاعم شقائه، مثلما يعود الجمل من رحلته، ثم تكون كل مهمتها أن ينخ عليها متعبا مكدودا، وهى تحته يحيط بها ما يحيط المناخ من بقايا وروائح، هذه صورة مقزِّزة منفّرة لو وعتها أى امرأة لأبت أن تنطرح أرضا لأىّ مـَـنْ كان، وحين وصل الشاعرة القرطبية أن المجتمع أو القيم السائدة أو سوء تفسير الدين يفرضون عليها هذا الوضع، أبت إباء مطلقا، فجعلت هذا الإباء خالدا فى الزمان (طول دهرى)، ثم عَمَّمَت الرفض على كل الناس “من أحد”، أيا كان هذا الأحد!.
ونلاحظ أيضا أن إباءها تحدد فى أنها تأبى أن تجعل”نفسها “مناخا، وليس فقط “جسدها”، وهذا من أهم ما يغفله الرجل (والمرأة) حين يفصلون الجسد عن كلية الوجود، وحين يوصف الجسد مستقلا عن صاحبه أو صاحبته، سواء فى قبح استعراض كمال الأجسام للرجال أم فى مسابقات جمال النساء، حين يحدث ذلك يتم اختزال الإنسان رجلا أو امرأة إلى جسد عضلى مُقَسَّم، أو ناعم متناسق، وفقط.
وموقفنا تجاه هذا المقتطف المختصر جدا لا يُـنظر إليه من وجهة نظر واحدة، فهو بقدر ما فيه من إباء حقيقى، وثورة كريمة، نرى فيه ميلاً شديداً إلى ما يعرف باسم ”الشيزيدية” أو العزوف عن العلاقة مع الآخر، أيا كان هذا الآخر. ومن إشكالات هذا العزوف الشيزيدى([3]) أن صاحبه هو الذى يدفع ثمنه، ومن هذا الثمن ما يعانيه من آثار الوحدة والجوع العاطفى وربما خدعة الاستكفاء الذاتى، وكلها أثمان باهظة تجعل صاحبتها (صاحبها) تفكر فى التراجع عن هذا القرار الأبىّ فتعيد النظر، ولكنها هنا فى هذا المقتطف تؤكد عزوفها عن الجميع حتى تصنف – تخيلاً – أن هذا الذى يمكن أن تكون له مناخا، ليس إلا كلبا، وهى قد غلـّقت نفسها حتى عن الأسد ، فتجد مبررا آخر للرفض، وهو أنها “غلـّقت” نفسها دون من هو أفضل منه، غلقت نفسها عن الأسد شخصيا وهو الأكثر تلاؤما معها وهى اللبؤة الأبية، فكيف ترضى بأن تستلقى تنتظر كلباً لا يساوى.
هذا الموقف الرافض قديم عند النساء قدم علاقتهن بالرجال، حتى لو جاء إعلانه بالألفاظ، أو بالكتابة متأخرا، وهو قديم حتى عن نشاطات تحرير المرأة مؤخراً، فرفض المرأة للرجل أقوى من كل حركة تحرير وأقدم، وقد يرجع إلى أنه فى معظم الأحياء ترفض الأنثى - بـيولوجيا- الذكر بصفة دائمة، اللهم إلا وقت الاستعداد للتكاثر، وبالنسبة للمرأة فمن البديهى أنه إذا لم يحقق لها الجنس دورا آخر غير التكاثر، فإنها ترتد إلى معظم سابق إناث الأحياء فترفض الجنس إلا للتكاثر، وتختلف مجالات الرفض: فقد ترفض المرأة الرجل رفضا صريحا منذ البداية، أو رفضا أثناء الأداء، أو رفضا بتخيل آخر، أو رفضا بعدم التمادى فى اللذة حتى النهاية، وكل هذه الأشكال قد تصل إلى الرجل أو لا تصل، حسب حساسية وعيه ويقظة احتياجه.
ثم إن لنا ملاحظات على هذا المقتطف كما ذكرنا، ونضيف إليها:
(1) إن الشاعرة قد استعملت – كما ذكرنا – تعبير غلـّقت “سمعى” مع أننى استقبلته على أنه غــلقت “نفسى”، وأحسب أن هذا أشمل، وأنها ما أحلت سمعى محل نفسى إلا لتجنب تكرار لفظ “نفس” فى البيتين، ولكن واقع الحال أن الإغلاق الأهم والأصعب هو إغلاق النفس.
(2) نلاحظ أيضا دقة تعبير “غلـَّـقتُ”، وهو أبلغ وأحسن من تعبيرات أخرى مثل: منعت نفسى، صُنت نفسى، حجبت نفسى، فالإغلاق هو فعل شديد الدلالة على ما هو شيزيدى، أكثر من كل ما ذكرنا من بدائل.
(3) نلاحظ أخيرا أن هذه المرأة رفضت أن تكون مناخا، حتى لأسد، مع فخرها بأنها “لبوْة” ومع ذلك هى ترفض الأسد إذا اعتبرها مناخا، وهى لم تشر إلى البديل، سواء فى الممارسة الجـنسية، أو فى الحياة العامة، وقد شجبت الشاعرة هذا الاحتمال وأن يكون دورها سلبيا: مجرد مكان للإناخة، وهكذا تقفز ”اللا” ألف مرة، ويحتد الرفض، دون البحث عن بديل علاقاتى أرقى، أو هو يحتد ليعلن العجز عن ذلك تماما كما هو الحال هنا.
(4) كما يبدو لنا أن هذا الرفض “مبدئى” قبل الاختبار، وهو يختلف عن رفض التى تتزوج (قسرا أو بالصدفة أو بزعم حب قصير العمر) ثم إذا بها تكتشف سلبية زوجها أو بلادته أو قسوته أو اعتماديته، فتنفر منه بعد خبرة حقيقية، ذلك الأمر الذى تمثل فى شعر امرأة عربية أخرى، حمـلت من مثل هذا الزوج البليد، فراحت تنعى حظها وهى تقوم بعملها المنزلى ناظرة إلى بطنها الممتلئة بالجنين يتكون، فجعلت تنشد:
”وما هندُ إلا مهرةٌ عربية سليلةُ أفــراس تحلـَّـلَها بغلُ
فإن ولدت مهرا فلله دَرُّها وإن ولدت بغلا فجاء به البغل
*- كتبت هذين البيتين من الذاكرة ثم عثرت على أصل لهما مختلفاً، لعله الأصح، تقول الشاعرة حميدة بنت النعمان بشير([4]).
وهل أنا إلا قمرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل
فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى وإن يك إقراف([5]) فما أنتج الفحل
كما أن المثل المصرى العامى الذى يقول :”قالك إيه يحرر النسا قال بعد الرجال عنهم” إنما يلخص باقتدار ذلك النوع من الحرية الذى يتحقق بالحرمان، وهو حرمان مختار أبىّ..إلخ، لكنه حرمان على كل حال، ثم إن المرأة قد تكون على حق حين يتخلى الرجال عن زعم أسودتهم، أو يكونوا أسودا ولكنهم يصرون على استعمال المرأة مناخا، فلا يعودون أسودا، فيختفى الرجال كرجال، ويصدق مثل آخر يقول:”قالو لِكْ إيه عيب الرجالة، قالت قـِـلـَّـتهم”
مظاهر معاصرة عن تفاقم الوضع الشيزيدى على الجانبين:
لعلنا نلاحظ أن رفض النساء المعاصرات، لا يظهر فى صورة صريحة دالة إلا فى بعض ما يسمى (خطأ) الأدب النسائى، أما فى الحياة العامة فإن رفض النساء وتفضيلهن حياة الأنفة، أو الانسحاب، أو الاستمناء، أوالاستقلال، فقد يأخذ أشكالا اجتماعية وسلوكية عديدة، ومن ذلك:
(1) تأخر سن الزواج للمرأة حتى تبلغ ما بعد الثلاثين، ليس فقط فى مصر ولكنه امتد ليشمل المثقفات (أو المتعلمات أو الجامعيات)، فى كثير من البلاد العربية دون استثناء الخليجيات، هذا إذا تزوجن أصلا.
(2) إرتفاع نسبة الطلاق الذى يتم بناء على طلب الزوجة، بالخـُـلع أو بغيره، وخاصة إذا صاحبه تنازلها عن حقوقها المادية، وأحيانا عن حضانة الأولاد.
(3) إرتفاع نسبة من يحاولن ممارسة علاقة فيها قدر أكبر من الاختيار، أو من أوهام الاختيار، وهى التى لا يسمح بها مجتمعنا عادة (إلا سرا، ونادرا) لدرجة لابد وأن تنقلب معها إلى ما يـدمغها باعتبارها فاحشة أو دعارة لا أكثر، ولا أقل: (الأمر الذى يتخفى حاليا تحت أسماء مثل زواج المتعة، وزواج المسيار، والزواج العرفى، وما شابه)
(4) ارتفاع نسبة الاستكفاء الذاتى (بالاستمناء وما يقابل)
(5) ارتفاع نسبة أنـَـفـَـة الاستغناء من سلبية الرجال (حتى ينقلب المثل الشهير إلى: “ضل حيطة ولا راجل طيطة” بديلا عن المثل الأصلى “ضل راجل ولا ضل حيطة”
(6) إرتفاع نسبة الشذوذ الجنسى (نتكلم عنه هنا بين النساء، وخاصة فى المجتمعات الغربية)، وهذا يبدو ردا بليغا، ويحتمل أن يواكب ما ذهبنا إليه من زعم أن المرأة حين تأكدت أن “عيب الرجال قلتهم” راحت تمارس، ولو بالتبادل دورهم لسد العجز فى أعداد الرجال الحقيقيين كما تراهم.
وحتى داخل المؤسسة الزواجية قد نجد أن الزواج أصبح يمر بأطوار نمطية تكاد تنتهى إلى أى شكل من اشكال الرفض السابقة.
وفى تأويل ذلك نقول:
ترتبط المرأة بزوج تتصوره كما تتمناه، أو كما ينبغى (رجلا يأبى أن يستعملها مناخا كما اكتشفت عاشئة القرطبية) ثم تأتى الممارسة فتثبت أنه لا يعدو أن يكون البغل زوج هند، أو الأسد المغرور والمرفوض أصلا طالما هو لا يريد لبوة شريكة، وإنما مناخا ومفْرخاً، أو يثبت أنه الكلب المرفوض ضمنا لموقعه الأدنى، وأيضا لاحتمال أن يكون مطلبه هو أيضا، حتى وهو الكلب، هو أن يركن فى دعه سلبية، وليس أن يجادل شريكا.
هذه الصور تتبدى فى مناخ في الزواج الذى تنتهى مدة صلاحيته بعد أجل مسمى
فالزوج الأعمى الذى يستحل زوجته لأنها هى أو وليها قد وقعا ورقة تسمح له بذلك، هو البغل الذى وصفته ”هند”
أما الزوج “الحمش” الذى يلغى زوجته أصلا اللهم إلا كمناخ له بعد تعبه (وهو ليس بالضرورة سى السيد) فهذا هو الأسد الذى ترفضه عائشة (لأنه لم يعد إلا فحلا)، ذلك المعنى الذى ترفضه الشاعرة “أم حكيم”، حين تأبى أن تسلم جرمها(جسدها) لرجل همه أن يضاجع، كما تقول:
وأكرم هذا الجرم عن أن يناله تورُّكُ فحلٍ هـَـمـُّـه أن يضاجعا
ثم يتبقى الزوج البليد الذى يعتمد عليها أو على أى مصدر آخر (أمه مثلا) فهو الزوج الأدنى الذى يرضى بالأدنى، ومع ذلك قد يمارس دور الحماشة الكاذبة، وهذا هو الكلب الذى ترفضه هند أيضا.
وقديما كان الزواج يستمر لأسباب أخرى لا علاقة. لها بالحرية ولا بالاختيار، أمَا وقد تطور الأمر وأصبح الاختيار واردا، فإن هذه الزيجات أصبحت تنتهى بمجرد انتهاء عمرها الافتراضى فى الظروف التالية:
(أ) حين يتبين للمرأة من هو زوجها على حقيقته وليس كما تخيلته،
(ب) حين يعجز الرجل أن يكون رجلا حاضرا محتويا متميزا مجادلا
(جـ) حين تأبى المرأة أن تستمر مناخا لغير ذى صفة.
مسئولية المرأة (وهى تتصور تحررها بالعزلة والحرمان):
أغلب ما سبق يوحى بأن المرأة ترفض الرجل لأن الرجل لم يستطع أن يكون رجلا إنسانا يمارس علاقة مع إنسان(ة) آخر مختلفا، وهذا صحيح، ولكنه صحيح جزئيا فقط، فالمرأة التى تفعل ذلك ربما تكون هى أيضا عاجزة عن أن تمارس دورها إنسانا ودورها أنثى تتكامل مع ذكورتها الكامنة.
وقد بالغ المجتمع الغربى فى إعطاء المرأة حق الرفض حتى لا تصبح “المناخ” الذى وصفته عائشة، ففى المؤسسة الزواجية يمكن للزوجة -عندهم- أن تقيم قضية اغتصاب ضد زوجها إذا أتاها دون رغبة منها، وهذا تماما عكس ما شاع (خطأ فى الأغلب) من أن على الزوجة المسلمة -تدينا- أن تطوف بسرير زوجها عدّة مرات قبل أن تنام، تعرض عليه نفسها -ضمنا- حتى تتأكد أنه لا يريدها هذه الليلة وإلا أصبحت آثمة (أو تلعنها الملائكة!!) وكذا وكيت، وأحسب أن كلا الصورتين هما مبالغة فى تصوير درجتين من البشاعة والتسطيح وسوء الفهم.
فبأى أسلوب يمكن أن تعلن المرأة قبولها لرجلها؟ بالألفاظ، أم بالتوقيع على لقاء يتجدد كل ليلة؟ أم بالتجاوب المبدئى؟ أم بالتجاوب الدائم؟
وبأى طريقة يمكن للرجل أن يفرق بين الرفض من باب أساليب الدلال والتمنع المبدئى، وبين الرفض الذى قالت به عائشة فى المقتطف (رفض أن تكون “مناخا” حتى لأسد).
وقد بدا لى أن الوعى الشعبى المصرى قد اقترب من هذه المشكلة فى أغنية بسيطة، لم أفهمها بحقها إلا بعد حين، حتى أنى استعملتها فى علاج بعض صعوبات الرجال الجنسية خاصة فى خبرة ليلة الزواج الأولى، تقول الأغنية:
ليه يانا يانا، ليه يا غرامى،
خايف أقولـّـك… ولا ترضيشى،
وان مارضيتيشى: لانزل وآيـس،
واحط عـِـيـِـنى فى وسط راسى،
….
أرضى لك إنت يا “سى العريس” مارْضاش لغيرك.
فرفـض العروس هنا هو رفض الخجل، وربما الدلال أو الدهشة، وحين يأخذ العريس هذا الرفض الظاهرى باعتباره عـُـزوفا عنه، وتقليلا من شأن رجولته، فإنه يصاب بما يصاب به المتزوجون حديثا ليلة الزفاف (ويقال أنه مربوط)، لكن هذه الأغنية (التى تقال عادة مع أغانى الفرح) تعلمه ألا يـَـعـْـتـَـدّ بهذا الرفض المبدئى، وأن ينزل و”يقايس “(يغامر أو يخاطر)، وأن يغمض عينيه إلا على افتراض أنها الرغبة المتبادلة التى تجمعهما، وليس فقط العقد أو الورقة، وإذ يصل هذا الاقتحام المحب إلى العروس فإنها تعلن القبول الخاص الذى يؤكد له تفرّده بالاختيار “أرضى لك أنت ياسى العريس مارضاش لغيرك”.
الخلاصة:
إن ما يبدو تحررا وإباء من جهة المرأة هو أمر محمود، وشكل تحرّرى، لكنه قد يخفى وراءه عجزاً إنسانياً عن عمل علاقة حقيقية، وهى صعوبة عامة لا تقع مسئوليتها على الرجل وحده، ولا على المرأة وحدها، ولا يوجد حل سهل لها، ولا بد أن توضع الأمور بترتيبها التصعيدى بشكل يسمح بتحديد البدايات الفارقة بين الرجل والمرأة، ومن ثم التدرج فى الممارسة، حتى ينجح الشريكان فى تأنيس وجودهما “معا”.
فبداية المرأة كينونتها وأنوثتها فعلا، وحين تقول عائشة القرطبية “أنا لبوة”، فهذه بداية صحيحة، فهى لم تدّع أنها أسد، وهى لم ترفض الأسد – فى عمق التفسير- لكنها رفضت أن تكون مناخا لأحد (أسدا أو غير أسد). وهذه المرأة المؤكِّدة لأنوثتها “أنا لبوة ” تريد أسدا يعاشرها لا يستعملها مناخا، أى أنها تريد رجلا يبدأ هو أيضا من رجولته، فالذى تريده المرأة حتى لا تغلق نفسها دونه هو رجل، مجرد رجل بِحق، وحين لا تجد، أو تقرر أنها لا تجد هذا الرجل، تبرر الانسحاب أو الحرمان أو الإباء أو الجنسية المثلية، وهكذا تقع المرأة فى مأزق جديد، فتكاملها لا يكون بأن تحل محل الرجل أو تمارس ما عجز هو أن يمارسه، ولكن يكون التكامل أوالتحرر بأن تعمق هى أنوثتها حتى تتفجر إنسانيتها متكاملة فتلتحم بها لتصبح إنسانا حرا يحتوى ويبادئ، يقتحم ويخلق، يعطى ويأخذ بوعى عميق وحوار متصل.
ويستحيل ذلك - بداهة - إلا إذا تم مع رجل يمارس نفس الدور، وإن كانت البداية مختلفة، ذلك أن الرجل يبدأ رحلة تحرره بتعميق رجولته أسدا لم يتخل عن أنوثته المبدعة الخلاقة، التى لا ترضى له أن يستعمل أنثاه الخارجية ـاللبؤة- مناخا بل رفيقا مواكبا يتحرر معه فى رحاب تحرره، وبالعكس.
[1] – يحيى الرخاوى: مجلة “الإنسان والتطور” الفصلية: عدد أكتوبر1998 – مقتطف وموقف: “تحرير المرأة بالحرمان”
[2] – جلال السيوطى ” نزهة الجلساء في أشعار النساء”
– عائشة القرطبية هي أديبة شاعرة كاتبة فنانة، عاشت في القرن الرابع الهجري الذي شهِدَ فيه القطرُ الأندلسيّ نهضة علمية واسعةً ونشاطاً أدبياً وثقافياً عاماً
[3] – فضلنا تعريب لفظ Schizoid إلى “شيزيدي” بدلا من الترجمة الخاطئة “شبه فصامي” هذا أفضل من الاختزال المخـل إلى لفظ انطوائى، والظاهرة الشيزيدية تعنى عجز الإنسان عن عمل علاقة بالآخر، وهذا العجز الظاهر هو نوع من الاختيار الغائر، فهو فى عمقه يشمل كلا من العزوف عن عمل هذه العلاقة، والخوف منها فى نفس الوقت: (أنظر بقية المتن).
[4] – حميدة بنت النعمان بن بشير شاعرة عربية من العصر الأموي، لها شعر هجاء في أزواجها الأربعة، إضافةً إلى مسجلات شعرية مع اثنين منهم
[5] – الإقراف: (أقرف له): أى داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذى دانى الهُجْنة. ويقال: الإقراف من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرفِ.
***************
الفصل الخامس
الانحراف الجنسى([1])
مقدمة:
لم يعد تعبير “الانحراف الجنسى” يستعمل هكذا فى اللغة العلمية، وخاصة فى التقسيمات الأحدث للاضطرابات النفسية (مثلا فى التقسيم العالمى العاشر1990 أو الحادى عشر ICD 10 أو التقسيم الأمريكى الرابع DSM IV أو الخامس لا يوجد شئ إسمه الانحرافات الجنسية”Sexual deviation )، ومع ذلك ما زال هذا التعبير هو المستعمـل عند كثير من الأطباء النفسيين وخاصة عندنا هنا فى مصر (وفى البلاد العربية فى الأغلب)، والأهم من ذلك أنه هو هو المستعمـل عند العامة ويطلقون عليه عادة صفة “شذوذ” وليس انحراف، ويقصدون فى جميع الأحوال ما “ليس كذلك”، أى: ليس الجنس الذى يعرفونه، وربما يرجع ذلك إلى الغموض النسبى لما هو “كذلك”.
ويبدو أن تعبير الانحراف هو المشكل الأساسى فى قراءتنا هذه، لذلك يجدر بنا أن نتذكر ابتداء كيف أن تعبير “انحراف” كان ومازال مشكلا ليس فقط فى الاضطرابات الجنسية، ولكنه مشكل بصفة عامة بالنسبة للاضطرابات النفسية جميعا، لأنه ما إن يذكر لفظ “انحراف” حتى يقفز تساؤل يقول: “انحراف عن ماذا؟” ثم بعد ذلك تلحقه تساؤلات أخرى: ” انحراف فى أى اتجاه: أو “انحراف بأى قدر، إلى أى مدى؟ حتى يسمى انحرافا؟”
ومازالت إشكالة تحديد ماهية السواء النفسى قائمة لم تحل تماما، فنحن لا نكاد نعرف حدود ما يسمى بالصحة النفسية، ولن ندخل الآن فى نقاش حول الحد الفاصل بين السواء والمرض، وإنما سنكتفى بالتذكرة بأن تعريف الصحة بمفهوم “السواء الإحصائى” قد رفضه أغلب المشتغلين بالقضية ([2])، والمقصود بقياس الصحة النفسية بما هو “السواء الإحصائى” (ضد الانحراف) هو أن يُعتبر الصحيح نفسيا هو الذى يماثل سلوكه سلوك أغلب الناس (أو على الأقل: يقترب كثيرا من ذلك)، فمثل هذا التعريف يثير شبهة أن يعتبر الأشخاص المتميزين مثل العباقرة، والثوار، والمبدعين، مرضى حيث أنهم كلهم -تقريبا- يخترقون سلوك السواد الغالب ويختلفون مع ما يألفه معظم الناس، بل هم قد يقودونهم إلى التغيير والتطور الإيجابى عادة.
وعلى الرغم من تواضع المفهوم الإحصائى للسواء فإننا يمكن أن نصل إلى درجة تقريبية مساعدة لمثل هذا “النمط النموذجى”، مما يمكن أن يسمى “عادى” أو “فى حدود الطبيعى” أو “فى حدود المقبول”. (فى ثقافة/مجتمع بذاته) فلنأخذ مثلا نمطيا يصلح للمواطن المصرى، فالأرجح أن الشخص العادى فى مصر:
“هو الشخص الذى يعمل بانتظام، أويذهب إلى العمل، وله أسرة تشاركه ويشاركها فى مسارات الحياة، ويخرج مع الأصدقاء أحيانا، ويشاهد التليفزيون عادة، وقد يقرأ صحيفة يومية (إن كان يفك الخط!!) وينام ليلا ما يكفى لمواصلة عمله فى اليوم التالى!
فإذا جئنا للسلوك الجنسى، فإننا حتى نتكلم عن الانحرافات الجنسية فيبدو أن علينا أن نبدأ بأن نحدد ما هو النموذج السوى للممارسة الجنسية، بحيث يمكن أن نعتبر أى ممارسة أخرى شذوذا أو انحرافا (عن هذا السواء)، وهنا تـُـواجهنا صعوبة تطبيق النموذج الإحصائى، أكثر مما هو الحال فى تحديد نموذج السواء النفسى عامة، فالحق يقال: إنه لا يوجد نموذج واحد متفق عليه يحدد طبيعة وحدود السواء الجنسى، فثمة بعد أخلاقى، وآخر دينى، وآخر تناسلى، وآخر بيولوجى، وهكذا.
وكما أن الأديان تختلف فى تحديد الممارسة السليمة (المشروعة، الحلال) للجنس، فإن النظريات النفسية أيضا تختلف اختلافا ليس يسيرا.
ثم إن التاريخ يحكى لنا أشكالا وألوانا من الممارسة الجنسية الغريبة كانت سائدة يوما ما، ومازالت كذلك فى بعض المجتمعات (البدائية أو الخاصة) ثم أصبحت نادرة (أو شاذة).
أما ما طرأ على الممارسة الجنسية فى العصر الحاضر، وخاصة ما أعلن منه فى الدول المتقدمة فإنه زاد، وتنوع، حتى فاق كل ما تركه لنا التاريخ من أشكال وألوان
ومادام تحديد ما هو “عادى” فى الجنس هو بهذه الصعوبة، فينبغى أن نحذر ونحن نطلق تعبير “انحرافات جنسية”على أى سلوك لا يروق “لنا”، أو لم نتعود عليه، أو لا نستطيع أن نعلنه.
ومن الناحية العلمية البحتة، فقد تمت التفرقة الواضحة بين الاضطرابات الجنسية التى يمكن أن توصف بـ” الإعاقة”، أو “عدم الكفاءة” عند الرجل (مثل اضطرابات الانتصاب عند الرجل Impotence، أو اضطرابات صعوبة الإستثارة عند المرأة – والتى كانت تسمى برودا جنسيا Frigidity) وبين تلك التى توصف بأنها “انحراف”، بمعنى توفر الكفاءة، مع غرابة أو شذوذ أو عدم ألفة موضوع الجنس أو وسائله أو مثيراته أو أسلوبه.
وكل هذا هو ما نريد فتح ملفه فى هذه المحاولة المحدودة.. ولكن دعونا نبدأ من البداية:
ظلت الممارسة الجنسية عند أغلب الحيوانات تمارس بهدف التناسل وحفظ النوع أساسا، فأنثى الحيوان – غالبا – لا تسمح باقتراب الذكر منها إلا لفترة قصيرة جدا (أحيانا ساعات، وأحيانا أياما حتى يتم التلقيح)، ذلك أن أنثى الحيوان – غالبا- تتقبل الذكر -فقط- وهى مهيأة تماما (بالتبييض) للحمل بمجرد التلقيح، وما إن يتحقق هذا الغرض (التلقيح) حتى ترفض الأنثى مجرد اقتراب الذكر طول العام، أو طول الوقت.
ويقال أنه مازال بعض غلاة الكاثوليك - مثلا- لا يسمحون أو يسامحون بالجنس، للبشر، إلا لهذا الغرض أساسا (أو فقط) – بغرض التناسل.
لكن الوظيفة الجنسية قد تطورت عند الإنسان بشكل تخطى هذه المحدودية البيولوجية (التكاثر) فأصبح الجنس يمارس لـِـذَاته، أو لما يصاحبه ويعنيه، ويقوم به من عواطف وتواصل وإبداع.
يبدو أن فرويد قد أعاد للجنس موقعه المحورى فى السلوك الإنسانى فعاد الانتباه إلى دور آخر للوظيفة الجنسية، وبقدر ما بالغ فرويد فى تأويلاته للسلوك البشرى، وخاصة السلوك الجنسى عند الرضيع والطفل الصغير، فإنه قد أسئ فهمه إساءة بالغة حين قصروا تفسيراته على مفهوم الممارسة الجنسية الحسية، ولم يصلنى أن هذا هو موقفه الذى وسع من مفهوم الطاقة المرتبطة بالجنس لتشمل كل “الطاقة الحيوية الجاذبة” والتى أسماها “الليبيدو”Libido .
ومن نافلة القول أن ننبه أن فرويد لم يختلق هذا التوسع لما أسماه جنسا، وهو لم يكن صاحب دعوة لتوظيف الجنس فى مجال أوسع من التناسل، وإنما هو اكتشف ذلك من واقع الممارسة والاطلاع والمراجعة وقراءة التاريخ والواقع الكلينيكى دون استبعاد خبراته شخصيا.
ولم تأخذ الوظيفة الجنسية عند الفرويديين حقها الأشمل فى التنظير الكافى لفهم دورها الإنسانى الجديد، ألا وهو دورها فى توثيق التواصل بين البشر، أساسا بين الجنسين، أى دورها كدافع حيوى لا يقتصر على هدف التكاثر، ودورها كلغة دالة لها ما تفيده وتحققه.
هذا على مستوى التنظير، أما على مستوى الممارسة فإن الإنسان عبر مراحل تطوره، وحتى وقتنا هذا، راح يمارس هذا الدور وينظمه، ويبرره ويشكله، ويغلقه ويكشفه، ويخفيه ويظهره، فتجلّى الجنس فيما يسمى “الحب”، والغرام، والهيام، والزواج، ولكن واقع الحال أن كل هذه التجليات لم تكشف عن وجهها الحقيقى، حيث أنها لم تعلن بلغة مباشرة أنها ليست إلا مظاهر لنشاطات الغريزة الجنسية فى محاولة الإنسان لكى يؤكد وجوده إنسانا من خلال حضور الآخر فى وعيه متغيرا فاعلا، متداخلا، راضيا مرضيا.
وأريد أن أنبه ابتداء أن هذه التجليات التواصلية النابعة من الغريزة الجنسية ليست تساميا بها كما يبدو لأول وهلة، برغم أن فرويد قد دعم ما هو قريب من ذلك، ولكنها توظيف واقعى مباشر لها كما سنرى حالا.
ثم لابد أن نقر ونعترف أن العلاقة بالآخر صعبة إلى درجة بالغة أحيانا، وقد ظلت الغريزة الجنسية تقوم بدورها الدوافعى، وتحقق لذة شديدة التميز وافرة الجذل، إلا أنه لا الدافعية، ولا الرشوة باللذة يمكن أن يؤديا وظيفتهما التواصلية ما لم يـَتمـّا من خلال لغة حوار عميق، يقول، ويعيد، ليحقق تشكيل وعى الإنسان الفرد من خلال حضوره مجتمعاً فى وعى آخر وجدله معه وبالعكس.
نعم، لا يقوم الجنس فى ذاته بوظيفة التواصل إلا إذا أصبح لغة لها أبجديتها القادرة على عزف لحن الإنسان فى سعيه لتأنيس وجوده وهو يضطر لـلتنازل عن ظاهر دعة وِحـْدته تخلصا من -أو عجزا عن دفع – ثمن آلامها، فيروح يحاور آخر على مستوى يتجاوز التجريد، ولا يُسجن فى الرمز إذ يستعمل الجسد فى أرقى تجليات حضوره، وهو الممارسة الجنسية.
قيل وكيف كان ذلك؟
نبدأ من البداية:
إذا نحن عرّفنا الجنس عند الإنسان كما هو عند الحيوان باعتباره وظيفة لحفظ النوع لا أكثر، فإن كل ما لا يهدف للتناسل (حفظ النوع) يعتبر انحرافا، والعجيب – كما ذكرنا– أن بعض المذاهب فى بعض الأديان (بعضغلاة الكاثوليكيين) يمكن أن تتبنى هذا الموقف حتى عند الإنسان، من حيث أنه يستبعد الجنس للجنس كنشاط إنسانى نفسى مستقل عن وظيفته التناسلية.
من كل ذلك يمكن أن نصل إلى خلاصة تقول:
إن الجنس نشاط، بيولوجى (غريزى)، جـُـعـِـل أساسا فى التاريخ الحيوى لحفظ النوع، وهو مخاطرة قديمة، على الذكور أن يتصارعوا ليتبين أى منهم أوْلى بالقيام بهذا الدور، وذلك حين كان التناسل من نصيب الذكر الأقوى دون غيره، ربما لضمان أجيال قادمة أقوى، وكانت اللذة الشبقية الفائقة هى الدافع الذى يبرر للذكر معركة التفوق للحصول عليها، ثم يبرر للأنثى أن تسمح له بالاقتحام لـلتلقيح والتناسل.
ثم إنه لما صار الإنسان إنسانا أرقى اختلفت أساليب التنافس، واختلفت أسباب البقاء، واختـلفت وسائل تحقيقه، لكن ظلت البيولوجيا تحافظ على دافعيتها، وعلى رشوتها اللذّية فى نفس الوقت، فكيف صار ذلك؟
الفرض (من جديد)
لكى يتحمل الإنسان آلام وصعوبة التواصل بينه وبين إنسان آخر، تحولت الغريزة الجنسية، بشكل مباشر، وغير مباشر، لتكون دافعا إلى مواصلة السعى فى اتجاه الآخر، بدءا بفرد من الجنس الآخر، يتواصلان ليحققا نوعية “الوجود معا”، أى ليؤكدا كينونتهما فى حالة وعى تبادلى، يميز الإنسان خاصة، أملا فى أن تمتد هذه المهارة الأعمق- مهارة التواجد معا لهما معا- إلى من بعدهما حسب مختلف السياقات ودوائر التواصل وامتدادات الوعى.
وقد وجدتُ أن هذا الفرض قد يبرر تعميم فرويد لوظيفة ما هو “ليبيدو”، كما وجدتُ أنه يمكن أن يـَـثـْـبـُـت ليس بتحقيقه، وإنما بتصور نفيه، بمعنى:
إن لم يكن الأمر كذلك، (أى إن لم يصح هذا الفرض)، فما لزوم هذا الدافع الجنسى طول الحياة، طول الوقت، إذا كانت ممارستان لكل زوجين كافية لاستمرار النوع للحفاظ على هذا العدد الحالى من الأحياء؟
ثم هاهو التلقيح الصناعى يقوم باللازم وكأنه يذكرنا بإمكان الاستغناء عن الرجال فى الجنس إذا توفر العدد الكافى من بنوك الحيوانات المنوية “السوبر ذكية” “والمبدعة” بمبالغة ساخرة أو حسب الطلب!!، ثم -مع التمادى فى السخرية – قد تنجح تجارب الاستنساخ المبدئية فيتحول العرض إلى إمكانية توصيل الأطفال إلى المنازل دون حاجة إلى ذكور أصلا، وربما دون حاجة إلى إناث مستقبلا وتكتفى المرأة بطلب من تشاء من أطفال (ديلفرى)!!)، ويتمادى الخيال السافر المرعب الخطير إلى إمكانية إنتاج نوع من البشر “سابق التجهيز”، فما لزوم غريزة الجنس إذن؟
من هذا التسطح الخيالى الساخر يمكن أن نخرج باستنتاج تال يقول:
إنه إن لم تكن للوظيفة الجنسية هذا الدور التواصلى لحفز الإنسان أن يواصل السعى إلى الآخر، فهى سوف تضمر أو ينقرض البشر،
ثم نخطو خطوة متأنية لننظر للإشكال من بعيد متسائلين:
هل التواصل الحقيقى العميق بين البـشر هو بكل هذه الصعوبة التى تحتاج لكل هذه الدافعية، وهذه الرشاوى اللذية؟
وقبل أن نحاول الرد نقول: لابد من الاعتراف ابتداء، ومكررا، إن الإنسان لا يكون إنسانا لأنه حيوان ناطق أو حيوان ضاحك، أوحيوان اجتماعى أوحيوان مفكر، ولكن:
يكون الإنسان إنسانا إذا هو مارس وجوده فى رحاب وعى بشرى آخر يمارس نفس المحاولة، ليواصلا معاً…. إلى باقى من حولهم من البشر والأحياء والطبيعة امتداداً لمسيرة التطور التى نعرف بدايتها ولا نستطيع أن نجزم بمنتهاها!.
ويحتاج هذا التوصيف الأخير إلى إيضاح فنقول:
إن الوجود مع الآخر ليس مجرد امتلاك، أو استعمال ظاهرى، أو سد حاجة عابرة، مع أن كل هذا وارد، ولكنه هو ما يميز الإنسان تحديدا بوعيه الفائق، وتواصل تطوره المتاح، مع قرين: “إليه”.
إن التواجد مع الآخر هو “إعادة التخلق” من خلال احتواء وعى مخالف ثم الانفصال عنه مختلف التشكيل نتيجة لصدق الحوار على مستويات متعددة:
(مستوى الجسد = الجنس،
مستوى الوعى = التواصل،
مستوى الامتداد = فى ثقافة مشتركة
مستوى التشكيل = الإبداع المنجز + التلقى المبدع([3]) إلى غـَـيـْـب مفتوح النهاية….إلخ) فهو: إبداع الإيمان.
وواقع الحال يقول إنه يكاد يستحيل، فى حالة “الوعى الفائق” أن نفصل أيا من ذلك عن غيره، مع قبول غلبة إحدى هذه التجليات عن الأخرى حسب اللحظة والقدرة، والسياق.
وما أصعب كل ذلك، وما أحوجه لدافعية قصوى، ولمكافأة لذّيــة مناسبة، لعلها تتمثل فى الوظيفة الجنسية بأبعادها الأشمل.
إعادة تعريف الانحراف الجنسى
واضح أن هذه المغامرة بوضع هذا الفرض السابق ذكره الذى يحدد تطور الوظيفة الجنسية، يعرضنا لأن نزعم أن أية ممارسة غير ذلك، ما لم تكن تمهيدا لذلك أو طريقا إليه، هى نوع من الانحراف الجنسى بشكل أو بآخر.
ومن البديهى أن هذه مبالغة لا يمكن التسليم لها .
ولكن، حتى إذا تنازلنا عن الشكل المطلق لهذه العلاقـة فإن الاعتراف باحتمال صدقها مُلزِمٌ بالسعى نحوها، أو على الأقل بوضعها فى الاعتبار ونحن نعيد النظر فى ماهية الانحراف الجنسى قائلين:
يعتبر انحرافا جنسيا كل استعمال للجنس، دون الوفاء بمواصفاته الإنسانية الأحدث حتى يؤدى وظيفته البشرية.
ولنبدأ ببعض صور ما كان يسمى انحرافا من قديم:
(1) فالجنس الذى يكون الألم فيه أكثر من اللذة أو بديلا عنها أو تشويها لها مع وجودها، بحيث يكاد يصبح – فى النهاية- فعلا طاردا لا جاذبا لأحد أطراف من يمارسه: هو انحراف من حيث المبدأ (مثل المازوخية Masochism مثلا).
(2) والجنس الذى يحل فيه الجزء أو الرمز محل الشخص كله، مثـلما يحل عشق كعب القدم (أو الحذاء، أو بعض الملابس الداخلية) محل الافتتان بالجسد كله فالشخص كله، يعتبر انحرافا (الفيتيشية أو التوثين Fetishism)
(3) والجنس الذى يتحقق مع غير البشر (مثل الجنس مع الحيوانات Zoophylia ، أو الجثث Necrophilia، أو مع الأطفال الصغار Pediphilia، لا يؤدى وظيفته التواصلية السالف الإشارة إليها (وطبعا: ولا التكاثرية)، وبالتالى يعتبر انحرافا.
(4) والجنس الذى لا يحتمل أن يحقق وظيفة التناسل ويكتفى بوظيفة التواصل اللذى أكثر أو فقط، يعتبر انحرافا (أنظر بعد: الجنسية المثلية)
(5) والجنس الذى لا يرتبط بآخر إذ يلغيه أو يستعمـله مسقــطا عليه ذاته لا أكثر (أى أنه يصبح نوعا من الاستمناء من خلال آخر) يعتبر انحرافا (وإن كان يصعب اكتشافه).
(6) والجنس الذى يمارس عن طريق القهر بأنواعه ضد كل مستويات الإرادة يعتبر انحرافا يشمل ذلك:
القهر الشرعى حتى بوثيقة زواج،
والقهر العضلى والإجرامى بالاغتصاب،
والقهر السلطوى والمادى بالرشوة والدعارة،
والقهر العاطفى بالغرام اللذة.
(كل هذا يحتاج لعودة تفصيلية!! وأحيانا تسمى بعض صوره القهر المؤلم بالسادية Sadism).
(7) والجنس الذى يمارس منفصلا عن لغة الجسد، وكأنه مجرد وسيلة ميكانيكية مبرمجة لخفض التوتر يعتبر انحرافا
إعادة النظر فى تطور محاولة تبرير وتشريع الجنسية المثلية:
دعونا نبدأ بأن ننظر بهدوء فى الجارى عند من تقدموا فى هذا الطريق مراحل صريحة:
فقد وصل الأمر فى بعض الدول الغربية المتقدمة!! ألا تعتبر هذه الممارسات الجنسية المثلية انحرافا أصلا، تحت زعم قد يتفق ظاهريا مع ما ذهبنا إليه، زعم يقول (مع شئ من التكرار): إنه مادام الجنس عند الإنسان هو “لغة”، و”دافع”، و”تواصل” أساسا (وتناسل أحيانا) فلماذا يعترض المعترض على أن يحقق الجنس أغلب وظائفه (فيما عدا التناسل والتكاثر الذى يبدو أنه لم يعد الجنس البشرى فى حاجة إلى الحرص عليه طول الوقت لحفظ النوع)، وكأن هذه الممارسة المثلية تؤكد - بشكل أو بآخر- الوظيفة التواصلية للجنس دون اشتراط الحفاظ على النوع (الذى يقوم به بقية البشر وهم الأغلبية!!!).
البداية تقول إن التواصل وظيفة بشرية بين إنسان وإنسان أيا كانا (“رجل >=<رجل” أو ”امرأة >=< امرأة” دون تمييز)، وهى وظيفة صعبة كما أشرنا، لذلك فهى قد تحتاج إلى تلك الدافعية البيولوجية والرشوة اللذية، فإذا أضيف إلى ذلك مدى الحرية التى يتمتع بها الفرد فى تلك المجتمعات التى أقرّت بذلك وشجعته، فإننا يمكن أن نفهم مدى السماح الذى وصلوا إليه، وبرروا به هذا السلوك (إذا كان هذا هو تبريرهم).
ولكن هل يمكن أن يكون هذا التبرير قابلا للتعميم فى كل الثقافات الحالية والمستقبلية، هكذا على إطلاقه، أو على علاته؟ وهل يمكن أن يكون هذا فى اتجاه التطور الطبيعى لهذه الوظيفة؟!
لا شك أن الأمر يختلف، ليس نتيجة لغلبة الموقف الدينى والأخلاقى والثقافى، فهذه أبعاد تحتاج إلى نقاش ، ويمكن أن تهتز، وإنما أساسا احتراما للطبيعة البشرية، بدءا بالنظر فى التركيب البيولوجى (والتشريحى ضمنا). إذ لا يمكن تصور إقرار ممارسة ما، جنسية أو غير جنسية، لا تتفق مع طبيعتنا الجسدية، ذكورا وإناثا، فكل من الرجل والمرأة له تركيب تشريحى نفهم من خلاله، بطبيعته، أنه مهيأ للاقتراب التكاملى مع شريكه من الجنس الآخر، أما الممارسة الجنسية المثلية، فهى تتم من خلال مواضع تشريحية غير مهيأة لذلك، أو هى تستعمل وسائل صناعية تعويضية أو مساعـدة لا يمكن إقرارها على أنها “جزء من تقدم التكنولوجيا”، لأنها تحل محل الفطرة السليمة، وتشوه الطبيعة السوية.
، ويمكن أن تهتز، وإنما أساسا احتراما للطبيعة البشرية، بدءا بالنظر فى التركيب البيولوجى (والتشريحى ضمنا). إذ لا يمكن تصور إقرار ممارسة ما، جنسية أو غير جنسية، لا تتفق مع طبيعتنا الجسدية، ذكورا وإناثا، فكل من الرجل والمرأة له تركيب تشريحى نفهم من خلاله، بطبيعته، أنه مهيأ للاقتراب التكاملى مع شريكه من الجنس الآخر، أما الممارسة الجنسية المثلية، فهى تتم من خلال مواضع تشريحية غير مهيأة لذلك، أو هى تستعمل وسائل صناعية تعويضية أو مساعـدة لا يمكن إقرارها على أنها “جزء من تقدم التكنولوجيا”، لأنها تحل محل الفطرة السليمة، وتشوه الطبيعة السوية.
ولو تمادينا فى فهم “معنى” الغاية الأولى (ولو تاريخا) من الجنس، وهى التناسل فالتكاثر، إذن لأدركنا أن هذه الممارسات، إذا عممت وشرعت، هى فى النهاية ضد الحياة لأنها ضد”حفظ النوع”، ولا توجد ممارسة طبيعية مسموح بها لدرجة أن يتصدى فريق متزايد من الناس للدفاع عنها وتبريرها على الرغم من أنها – بطبيعتها- ضد الحياة وضد استمرار حفظ النوع.
لذلك لابد من الاجتهاد الأعمق لقراءة معنى ظهور هذه الممارسات -على شذوذها- فى تلك المجتمعات – على تقدمها، ونعرض اجتهادنا على الوجه الآتى:
يبدو أن الإنسان بدل أن يرتقى بالوظيفة الجنسية من التكاثر إلى التواصل، فى مسارها الطبيعى، بدءا بالتدريب مع فرد من الجنس الآخر، يبدو أنه انحرف بها (بالوظيفة الجنسية) إذْ راح يستعملها استعمالات أدنى من توظيفها للتناسل، مع تصور قدرته على تركيزها للتواصل فحسب. ودعونا نورد هنا بعض الاجتهادات لما آل إليه حال الجنس مما قد يبرر هذا الانحراف المتزايد إلى ما يسمى “الجنسية المثلية”
بعض الصور السلبية:
فيما يلى بعض الصور السلبية التى آل إليها تشويه واختزال الوظيفة الجنسية فى حياتنا المعاصرة
1- ممارسة الجنس باعتباره نشاطا يباع ويشترى، بمقابل مادى تحكمه آليات السوق، وبذلك انضم إلى النكسة الكمية الاستهلاكية التى “تعلن احتمال نهاية التاريخ”، (بالمعنى السلبى بعد إذنكم) ذلك النظام الذى طغى واكتسب شرعية أكبر من حجم نفعيته وخاصة بعد الفشل المرحلى لسوء تطبيق العدل عامة.
2- ممارسة الجنس باعتباره جزءا من صفقة اجتماعية دينية بشكل أو بآخر “بالذات لإنشاء والحفاظ على استمرار المؤسسة الزواجية فالمجتمع” صفقة – ربما ناجحة - حلت محل الصفقة التناسلية البيولوجية من جهة إلا جزئيا، ومحل صفقة التواصل البشرى الأرقى المختار المتجدد -بين الجنسين- من ناحية أخرى.
3- ممارسة الجنس للتناسل دون توظيفه للتواصل (بعض ما أشرت إليه مما بلغنى عن بعض غلاة الكاثوليكيين).
4- ممارسة الجنس لـ “خفض التوتر” ليس إلا (يقاس ذلك -ضمنا- بالمسافة بين الشريكين بعد الانتهاء منه، هل هما أقرب أم أبعد؟ ففى حالة اقتصار وظيفته على خفض التوتر: الأرجح أن تكون المسافة أبعد).
5- ممارسة الجنس ليؤدى بعض وظائفه النفسية المنفصلة كلية عن التواجد البشرى التواصلى، كأن يستعمل لتأكيد الذات، أو استعادة الثقة، أو الشعور بالتفوق، أو ممارسة الخضوع الاعتمادى، دون أن ينتقل أى من ذلك إلى لغة إنسانية حوارية ممتدة مع الآخر.
6– ممارسة الجنس كنوع من الطقس الوسواسى القهرى.
7- ممارسة الجنس ثمنا للحفاظ على فرص تربية الأولاد معا، باعتبار أن الأسرة مازالت هى الوحدة الاجتماعية القادرة على إنتاج جيل صحيح (يجرى هذا شعوريا أو لاشعوريا).
8- ممارسة الجنس لأغراض جانبية (ثانوية) مثل تزجية الوقت (بعد انقطاع النور أثناء مسلسل تليفزيونى)، أو بالمصادفة (مثل الأرق الطارئ فى ليلة باردة) أو تحت الوعى (مثل الممارسة قبيل اليقظة استجابة لانتعاظ صباحى فسيولوجى)
9- ممارسة الجنس بالصدفة العابرة، مثل لقاء رجل وامرأة فى صحراء البادية: الأمر الذى مازال يمارس فى بعض صحارى الخليج، حيث قد يتم اللقاء الجنسى إذا التقى رجل وامرأة فى البادية دون تعارف ودون كلام، والنسخة المتحضرة لهذا الطقس هو ما يجرى فى إيطاليا وفرنسا مثلا، إذ قد تتم الدعوة فالاستجابة فى مطعم، أو على رصيف شارع حين يحدث ما يسمى “التماس” بالنظرات من خلال لغة عيون سريعة ومختصرة وحاسمة، فيقوم الرجل أو المرأة وينتقل إلى جوار من تبادل معه النظرات، أو يغير السائر على الرصيف اتجاهه، ويعود مع شريكه أو شريكته فى نفس الاتجاه، ثم يعودا معا (أو ينطلقا معا من المطعم) وقد تخاصرا ليتم اللقاء الجنسى فى الموقع المتاح، وقد يفترقان دون أن يعرف أيهما إسم الآخر، ودون مقابل عادة غير اللقاء([4]).
كل هذه الممارسات وغيرها إنما تعلن بشكل مباشر وغير مباشر أن الوظيفة الجنسية تشوهت وخرجت عن مسارها
وأكاد أتصور أن الجنسيين المثليين قد أدركوا – بدرجات مختلفة من الوعى- كل هذه التشوهات التى لحقت بالوظيفة الجنسية، وبالتالى عمدوا – بوعى أو بدون وعى أيضا- إلى تأصيل وظيفة الجنس التواصلية بغض النظر عن نوع من يتواصل معه، ذكرا كان أم أنثى.
فإذا كان هذا هو الحل (الجنسية المثلية هى الحل!!) – كما يزعم قطاع متزايد فى بعض المجتمعات الغربية – أى إذا رجحت كفة التفاهم والتواصل مع نفس الجنس دون الجنس الآخر، فنحن أمام الاحتمالات التالية:
* إما أن تضمـر الوظيفة الجنسية نتيجة لإساءة استعمالها واختزالها، وتشويهها، وتصادُم أدائها مع التركيب التشريحى والنفسى الأرقى إبداعا.
* وإما أن يتغير الجنس البشرى إلى نوع لا نعرفه، نوع قد يستغنى تماما (بالتناسخ والهندسة الوراثية مثلا) عن توظيف الغريزة الجنسية فى التناسل، ويُصَرِّف أموره وحفظ نوعه بأدوات حديثة لم نعرفها بعد.
* وإما أن ينقرض الإنسان كلية إذ يثبت أنه قد اختلت حساباته - تطوريا- فيتمادى فى نوع من الانحرافات السلوكية المتعارضة مع الطبيعة، والمتناقضة مع مسيرة وقوانين التطور غير المعروفة لنا جملة وتفصيلاً!
وأعتقد أن كل هذه الاحتمالات هى ضد الحفاظ على ما حققه هذا النوع من الأحياء حتى ارتقى بكل غرائزه إلى ما يمكن أن يجمع بين اللذة والتواصل واحتمال التكاثر والإبداع إلى ما يرتقى بإنسانيته “إليه” (إجتمعا عليه وافترقا عليه).
[1] – يحيى الرخاوى: “إعادة قراءة فى مصطلحات شائعة، قراءة مصطلح الانحراف الجنسى” مجلة الإنسان والتطور الفصلية – عدد أكتوبر – ديسمبر 1998.
[2] – يمكن الرجوع إلى محاولاتى المتلاحقة لتناول إشكالة تعريف وتحديد ما هو صحة نفسية وكمثال:
– يحيى الرخاوى: (“مستويات الصحة النفسية” من مأزق الحيرة إلى ولادة الفكرة) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، الطبعة الأولى 2017، الطبعة الثانية 2020
[3] – تناصّ Intertexuality النصوص البشرية
[4] – أذكر كيف انتهى فيلم آخر ”تانجو فى باريس” إنتاج عام 1972 وإخراج برناردو بيرتولوتشى بطولة مارلون براندو وماريا شنايدر وجان بيير لاود. انتهى بعد كل ما كان: والبطلة تجرى وراء مارلون براندو صائحة: ”ما اسمك”؟.
*******
الملحق (1)
تنويعات فى لغة الجنس ودلالاته (عبر النقد الأدبى)
فى رواية “بيع نفس بشرية”
الجنس الفيْض – الجنس الصفقة – الجنس اليأس
“بيع نفس بشرية”([1])
لـــ: محمد المنسى قنديل
الجنس”الفيْض”، والجنس “الصفقة”، والجنس “اليأس”
مقدمة عن الجنس والأدب والنقد:
لاحظت أن كثيراً من تناول الأدب – عندنا – لموضوع الجنس يواكب غالبا مفاهيم شائعة، لا هى صحيحة ملـتزمة، ولا هى عميقة إبداعية، مثل استعمال الجنس بقصد الإثارة، أو إدعاء الجسارة، أو تزيين الحكى، أو دغدغة القارىء..،
لكن توجد أعمال أكثر جدا واجتهادا فى تناول المسألة الجنسية من خلال فن القصة:
1 – فالجنس عندنا قد يقاسى بمنطق “الأخلاق”، وفى هذه الحال، قد يتناوله القاص وهو يدور حول محور القيود والسماح، أو الكبت والإباحة، أو الإلتزام والتخطى إلى آخر هذه الاستقطابات الخلقية أساسا، التى يصاحبها الذنب أو اللذة المستباحة حسب السياق ومقتضى الحال.
2- أو قد يقع ما هو جنس فى منطقة “الغرام”، حيث يظهر مواكبا، أو مـكـمـلا، أو دافعا لموضوع عاطفى، حيث تجرى العلاقة على محور الجذب أو المطاردة، أو كليهما مع مصاحباتهما من أشواق وهجر وارتباط وانفصال، دون أن يستثنى الكاتب من ذلك ما هو جنسى، يقدمه بشكل صريح أو خفى حسب أداة الكاتب ومساحة حركته.
3- كما قد يطل الجنس من شرفة التحليل النفسى، سواء نبع ذلك من حدس الكاتب الأعمق (الموصى عليه عادة بمفاهيم التحليل النفسى)، أو استلهمه من قراءاته أو ثقافته، فيبدو هذا البعد وكأنه أعمق وأكثر دلالة حين يتعرض لتشكيلاته وانحرافاته باستعارة أساطير وإبداعات حكى مثل عقدة أوديب، أو عقدة الخصاء.. الخ.
لكننا نادرا ما نلقى الجنس باعتباره لغة إبداعية وجودية، بدنية، لها أبجديتها الخاصة، وعطاؤها الجوهرى الغائر، بحيث يمثل فيضا يغمر الكيان البشرى فى مختلف جوانب وجوده وعلاقاته، ولا أعنى بذلك أن يكون الجنس مفسِّرا خفيا أو وحيدا للسلوك البشرى (خصوصا حسب مقولة فرويد كما شاعت)، وإنما أشير إلى الجانب الكيانى فى الحضور البدنى والجنسى فى وعى البشر بصوره المختلفة ليحقق رسائل متنوعة أغلبها إيجابى إذا اتخذت المسار الطبيعى وهذا نادر حاليا.
ثم أنتقل إلى دراستى النقدية الحالية هنا، ذلك أن كاتبنا فى هذه المجموعة التى سنقدمها فى هذا الفصل قد تقدم لنا من هذا المدخل إلى ما هو “فيض الجنس” كما أسميته، وفى نفس الوقت فقد تناول الجنس على مستويات متعددة دالـّة كما سنرى حالا:
1- فالجنس فى القصة الأولى “بيع نفس بشرية” قد ظهر فى شكل فيض أو ”طوفان طبيعى“، وإن “حضر” هذا الطوفان فى صورتين هما وجهان لعملة واحدة.
(أ) الأولى هى صورة ذلك الجسد الصغير، كأنه عينة خام من طبيعة نقية، سمحة، ينتح الشهوة فى انسياب تلقائى، ويتأرجح مع نبض الكون دون عوائق أو شروط، فكأنه صلاة الطبيعة وتسبيحها فى شكل طلّ ندىّ يغمر الكل بلا تمييز، أو يتجمع فى نهر دائم الجريان، لا يوقف تدفقه ما يـُلقى به من قاذورات، أو ما يمكن أن يروى من نباتات سامة تتغذى منه بالرغم منه.
(ب) أما الصورة الثانية لهذا الطوفان الطبيعى فهى حين يظهر الجنس فى شكل فيضان مخترق ملاحق، يشعل الحياة فى الكل دون استئذان، حتى لو لم يجد من يستوعب دفق لهيبها بما هو.
2- أما الجنس فى القصة الثانية “الوداعة والرعب”. فقد ظهر لنا فى صورة صفقة لحم نىِّء، صفقة جسدية محسوبة وفجة وعارية، ومنفصلة عن بقية المكوّنات الكلية للوجود البشرى الشامل، وكأن الجنس فيها جسم غريب: حى وشبق، لكنه بلا ”بـَعد”، ولا حتى “قـَبل”، إلا لما هو جنس فى جنس، ثم هو يـُـعرَض “هكذا” ثمنا لما هو أبشع منه.
3- وفى القصة الثالثة “اتجاه واحد للشمس”، لا نجد خطا واحدا يمكن أن يلضم خرزات الجنس المتناثرة طول القصة، لكننا نلحظ جليا علاقته بالجوع واليأس، وأنه يـُـستعمل للتعبير الجسدى البديل، للتعبير عن الضياع أحيانا واليأس دائما، والصفقات الجانبية الجزئية هنا وهناك، لكنه بدا لى فى هذه القصة الأخيرة كأنه: تصادم جسدين بفعل الجوع واليأس، ليطلقا صيحة يأس “شهية” و”مرعبة”، “محدودة” و”مـُجـْهـَضة”.
هامش حول نقد متزامن:
حين صنـّفت حالا كيف يتناول القاص عندنا المسألة الجنسية - عادة وليس دائما- لم أعرج إلى موقف النقد من ذلك، أولا لأننى غير متابع للحركة النقدية بالدرجة الكافية، وثانيا لأنى أتصور أن النقد – عندنا- إما أن يغفلها، أو هو يخضع لوصاية التحليل النفسى تحت تأثير ما يسمى بالنقد النفسى التحليلى، لذلك فقد فرحت حين فوجئت بهذه الصدفة الطيبة التى أتاحت لى فرصة قراءة نقد متميز لهذا العمل:
1- فقد صدر عدد ديسمبر (1987)([2]) من مجلة إبداع، وفيه دراسة الناقد الحاذق “عبد الله خيرت” عن نفس المجموعة، ولم أكد أقرأ كيف قرأ الناقد الحاذق المتمرس الخط الجنسى فى القصص الثلاث حتى شككت فى نفسى ورؤيتى، فرحت أعيد قراءة ما كتبتُ، مع الرجوع للأصل مرة ومرات حتى لا أكون قد اقتطفت ما لا يتفق مع السياق، فتأكدتُ مما ذهبتُ إليه حتى أصررتُ عليه، وسوف أكتفى بأن أنقل هنا الفقرات الخاصة بالجنس لأضعها أمام القارئ مباشرة دون تعليق، وحتى يرى القارىء منذ البداية مدى التباين – لعله تباين ذو دلالة- كما يمكن أن نقف سويا لمراجعة دور النقد فى هذه المسألة بحجمها الموضوعى، يقول الناقد:
”ولا أظن المؤلف لا يزال يعتبر الجنس، بل والعلاقة الجنسية والمرأة عموما، إثما وجريمة يعاقب مرتكبوها حتى لو كانوا شبابا قليلى الخبرة”، ثم يمضى قائلا:
”وهكذا نرى الجنس فى القصة الأولى يسجل على شريط الفيديو بكل أسراره ليصبح فضيحة كبرى، ويقف البطل وهو مدرس أطفال مهانا أمام أولياء أمور تلاميذه” وفى القصة الثانية تنتهى العلاقة الجنسية بين الفتى والفتاة بجريمة القتل المروعة، وكأن هذه لم تكن علاقة حب، حيث انقلبت- كما يقول ابن الرومي- إلى غابة من البغضاء(!!) وفى القصة الثالثة يعقب الحب بين العامل وزميلته فى مصنع النسيج تجمهر كل العمال وصاحب المصنع وكانوا على وشك أن يقتلوا هذا العامل النجس(!!).
وللأسف، فإن الناقد لم يكتف بعرض رؤيته تلك، بالتماس العذر للكاتب وأنه لم يوفق فى هذه النقطة بالذات، إذ مضى الناقد يقول:
ولكن هذه الملاحظة الصغيرة (عن موقف الكاتب من الجنس) لا تقلل من قيمة وأهمية هذه المجموعة… الخ.
وأدعو القارئ أن يشاركنى جزعى من الاختلاف مخافة الخطأ، لأنى قد بنيت دراستى كلها على ما هو عكس ذلك ذلك تماما، وللقارئ الرأى فى النهاية.
2- ثم أقرأ لأستاذنا الدكتور على الراعى ما هو أرق وأرحم، لكننى أيضا أظل مندهشا لاختلافى الشديد معه، يقول د. الراعى:
ريشة قادرة وملهمة تصور قصر الشيخ ومن فيه وما فيه: الدخان والخمر وعروض الفيديو الداعرة وجسد ماتيلدا العارى يتحرك على شاشة كبيرة يحمل آثما اللحم المحترق، والريشة ذاتها تصور ما يقوم بين مصطفى والفتاة من علاقة جسدية هى نقيض الشهوة والرغبة فى الافتراس، غير أن طاغوت الشهوة هو الذى ينتصر وليس التآخى والحب عبر الجسد.
فنرى رغم الإيجاز الضرورى، أن الناقد الكبير”قد التقط الفرق”، وإن كنا نتحفظ قليلا على حكاية “نقيض الشهوة”، وكذلك على أن “طاغوت الشهوة هو الذى انتصر”…الخ (انظر بعد).
هذا عن القصة الأولى.
أما رؤية الناقد عبدالله خيرت للجنس فى القصة الثانية “الوداعة والرعب” فإن اختلافنا معه أدق، حين يقول:
”وبالقصة لحظات يرقص فيها كلُّ من طارِق والصهيونية رقصا رقيقا متناغما، يوحى – للحظات- بما كان يمكن أن يقوم بين الشباب فى الناحيتين من ود وتفاهم، لو لم تكن إسرائيل دولة عنصرية عدوانية، غير أن هذه اللحظات ما تلبث أن تتبدد”..الخ.
ورغم أن تعقيب الناقد كان على لحظات الرقص دون الجنس، إلا أنه من الصعب فصل هذه اللحظات عن السياق العام الذى تطورت فيه العلاقة الجنسية بين الشابين بكل هوامشها
والآن، نشعر أن الآوان قد آن لنقدم ما قرأناه من تنويعات جنسية فى القصص الثلاث، واحدة فواحدة، بعد أن عرضنا على القارئ وجهات نظر مختلفة مما نتصور معه أن القارىء سيتحفز أكثر، فنتحسب أكثر:
********
القصة الأولى: “بيع نفس بشرية”
الجنس الفيْض
(أ) صلاة الطبيعة: فيض نهر جار
(ب) فيضان الشهوة يقتحم
هذه القصة وصلتنى كأفضل قصص المجموعة: – مع تميز المجموعة كلها- وكان المحور الأساسى الذى تدور الأحداث حوله فى هذه القصة هو محور “القهر” بكل تنويعاته، فمصطفى (المدرس المصرى المغترب فى الخليج) مقهور بفقر أهله، وإلحاح حاجته، والخادمة الفلبينية “ماتيلدا” مقهورة بفقر وطنها وأسرتها وبطالتها..، وصديق وزميل مصطفى (المواطن) المدرس الخليجى “صالح” مقهور بطبقته الأدنى، وتاريخ الظلم اللاحق بأسلافه، وحتى ”السيد” الشيخ نفسه- يمكن لمن يريد أن يراه- مقهورا باستعباد لذته وشذوذه له.
ووسط هذا الجو من القهر من الداخل والخارج، كان للقارئ أن يتوقع أن يظهر الجنس كأحد أبعاد هذا القهر لو أن المؤلف قد تسطح فرسم لنا صورة شيخ سيد فرعون، وجارية مهيضة سلبية، الأول يفرض على الثانية ما يشاء، فلا تملك إلا أن تستسلم رغم إرادتها، أو رغم تعلق قلبها بحبيب شاب تركته فى بلدها، أو حتى رغم أحلامها بالتحرر ضد ضغط أهلها المحتاجين..الخ، وحين يحدث ما يتوقع القارئ “هكذا”فإننا نكون قد ابتعدنا عما هو إبداع راسخ آمادا بعيدة، لكن هذا، أو مثل هذا لم يحدث إلا قليلا، فماتيلدا ليست خادمة أسئ استعمالها جنسيا ضد ما توقعت، أو غير ما توقعت، فهى لم تأت شغالة ففوجت بنفسها جارية فى حريم السلطان، بل هى واعية طول الوقت بطببيعة العقد وشروطه غير الخفية.
ولعل أول صدمة إبداعية تفيق القارئ من الاستسلام لتوقعاته هو هذا الاعتراف السهل الذى يعلن وعى ماتيلدا بما يجرى، بل إنه يتضمن إرادة له، ذلك أنها أعلنت -بشكل أو بآخر- رضاها بهذا الدور الذى تقوم به، من حيث المبدأ على الأقل،
يقول مصطفى لها متسائلا (مثل القارئ):
- عندما جئتِ إلى هنا… ألم تكونى تعرفين أنك ستصبحين عشيقة؟
فترد:
- هذا لايهم، أخ أكبر، أنا أحب ممارسة (الجنس)، هذا أفضل من الأعمال المنزلية.
ثم نتبين بعد قليل أن اعتراضها، ومن ثم هروبها، لم يكن على أنها استُعْمِلت جنسيا، بل على أن طريقة الشيخ كانت مـُرعـِبة .
ومن هذا المنطلق نبدأ فى التعرف على الوجه الأول لهذا الفيض الجنسى، إذ نتعرف على هذه الطفلة السهلة القوية فى تسليمها واختراقها معا، ولعل القارئ العربى بوجه خاص لا يستطيع أن يستوعب – بسهولة- هذا النوع من الطفولة الجنسية القوية السهلة، مع أنه كان الأولى بذلك بما يحمل تاريخه من “زواج الطفلات”، وأصناف الجوارى فى أروقة الحريم من كل لون، وسن، وطبع، فهذه الجوارى الأحدث من الفلبين (أو لبنان..أو فلسطين!! أو البوسنة) لا يفترقن فى كثير أو قليل عن الجوارى الأقدم، اللهم فى ألفاظ العـَقـْد، وتحديد المدة، وطريقة إشهار العقد.. وما إلى ذلك، فقديما كانت الجارية المشتراة تصبح ملكا لسيدها لحين إشعار آخر (البيع أو العتق أو الموت)، أما الآن، فالجارية الأحدث تؤجـَّر بعقد محدد المدة، بمقابل مادىّ شهرى فى العادة، وما أسهل أن تـُـلفظ أو تستبدل بأقل التكاليف، وأحسب أن هذا النظام الأحدث هو أقسى وأنذل، فليس فيه أمان التسليم من سيد إلى سيد، وليس فيه ضمان ضد سوء الاستعمال، أقول: إنه كان أولى بالقارئ العربى أن يفهم، أو على الأقل “يحسن استقبال” هذا النوع من العطاء الجنسى، حيث على المرأة (الجارية) أن تعطى جسدها- بل نفسها أيضا- بلا تمنع أو حرج، ولا تململ من قهر وبلا أمل فى مقابل أكثرمما ورد فى عقد الشراء أو الإيجار، فلماذا- فى تقديري- صَدَم الكاتب قارئه بهذا التسليم الاختيارى من ماتيلدا؟ أو قل كيف حدث ذلك؟
خيل إلى أن الجنس قد أصبح فى كثير من الأحيان عند العربى (أو قل عند المصرى المتوسط كما عاينته من خبرتى المحدودة) قد أصبح علاقة قهرية بالضرورة، فلم يعد واردا على وعى الإنسان المصرى – مثلا – حتى فى العلاقة الزوجية المدعمة بعقد مكتوب، ودين مشروع، ومجتمع شاهد، حتى فى هذه العلاقة الظاهرة: شرط التراضى، فإن الجنس قد لا يعدو أن يكون قهرا طبيعيا مشروعا بعقد، وليس فى جنس ماتيلدا أى قهر ظاهر، وهكذا يفاجأ القارىء العربى العادى بهذا النوع من العطاء الجنسى السهل، الإرادى والواعى، فى ظروف تسمح بكل هذه السهولة والجاهزية.
ومن خلال هذا الحضور “الجاهز” لهذه الطفلة الفلبينية “تحت الطلب” حتى لو كان الطالب الشيخ الشاذ نفسه، أقول من خلال ذلك بدأنا نتعرف على وجهى “الجنس الفيْض”:
أما الوجه الأول فهو ما أسميناه “النتح السهل النشط” أو “النتح الدافق”: حين يبدو لنا العطاء ليس مرتبطا بمومسية “للتصدير” كما تورط المؤلف ففسره فى البداية، حين أعلن أن هذه الإباحية متعلقة بغربة ما تيلدا: “خارج الوطن كل شئ مباح”، ذلك أن ماتيلدا بعد أن أعلنت تفضيلها هذه “الخدمة” عن أعمال المنزل، راحت تؤكد أن هذا هو موقفها المبدئي. “هنا” و “هناك”، فإنها بعودتها إلى الوطن، سوف تسترد “روح الأرز”… (سوف آكل قليلا، وأمارس الحب كثيرا، ولكن مع من أختار، النقود تأتى بعد ذلك)([3])، وهى لا شك تفضل، بعد هذا الموقف المبدئى المعطاء، تفضل أن يكون شرط عطائها أن يرغبها الشريك رغبة حقيقية، متضمنة بداهة فهما وتقبلا، وربما احتراما، لكل ذلك فهى حين عرضت نفسها على مصطفى، راحت تنفى طبيعة الصفقة كأساس للتقارب، وإن لم تنفها ضمنا، فراحت تؤكد أن عرض نفسها عليه ليس ثمنا لكرم إجارته، فهى لم تكن أبدا فى حاجة إلى التنبيه الذى أعلنه فى قوله “لا أريد ثمنا، حياتك ملكك، وجسدك أيضا”، فقد أكدت له أن المسألة ليست ثمنا أو مقابل، بقدر ما كان شرطها الأول (وربما الوحيد) هو أن “يريدها”، أن “يرَغب فى ذلك”، وقد تدخل الكاتب بوعى “لاحق”، حين أردف شارحا: “… كانت تريد أن تدفع له، ولم تكن تملك غير هذا الجسد الصغير”، وقد رفضتُ - قارئا- هذه الوصاية من جانب الكاتب على شخوصه الذين كانوا يستقلون عنه معظم الوقت لكنه كان أحيانا يلاحقهم بتفسير هنا، ووصاية هناك، فأزيحه – قارئا- وأمضى إلى مخلوقاته مباشرة دون خالقهم، ولقد أشرت إلى مثل ذلك فيما سبق حالا حين فسر سماحها الجنسى بغربتها خارج الوطن، ولعل هذا بعض ما عنيته بقولى فى التقديم العام أنه مبدع رغم أنفه فى بعض الأحيان.
ثم أعود إلى المخلوقة الصغيرة – دون خالقها الكاتب- لأؤكد مرة أخرى أنها صاحبة موقف مبدئى قوى بغض النظر عن الشريك أو الثمن اللاحق، وهى لا تهتم بتسمية ما تفعل، لكنها حتما “تفضلهم راغبين” (..يجب أن ترغب فىّ حقا، أرجوك كن راغبا فى).
ثم ننتقل إلى مزيد من إيضاح معالم هذا الوجه “النتح الدافق” لهذا “الجنس الفياض” فنشكر المؤلف على تفصيلات المشهد (ص 39 وما بعدها)، حيث أورد تفصيلات هامة ومحددة قد تؤيد ما ذهبنا إليه:
1- فقد أكد على أنه: صلاة:
”… وضعت يدها على رأسها وأخذت تحرك شفتيها كأنها تتلو صلاة جنسية خاصة” (ص39). “…. يتلو من خلال عرقها المشترك صلاتها الخاصة لإله المتعة” (ص 40).
وهى صلاة فى ذاتها، وكذلك فهى صلاة فى تأليهها للشريك الرجل:
“… أنت إلهى - دع عبدتك تقوم بكل العمل- أنا عبدتك الصغيرة، أنت إلهى الصغير” (ص 39). “…علمتنى أمى أن الرجل إله صغير- تركته ينهض ويمارس الوهيته الصغيرة” (ص 40). “.. ثم كأنها تقوم برقصة وثنية لإله شره، تقبل أصابع قدميه وأطراف شعر رأسه فى آن واحد”(ص40).
(ملحوظة): شعرت أنه لم يكن هنا مبرر لذكر الشراهة بالذات، وكان هذا من بعض ما اعتبرته “الوصاية اللاحقة”، أو “التزيد المـُخـِل”، مثل ذلك مثل السؤال الذى بدا لى جسما غريبا حين قال لها:
”… أنت تقومين بكل شئ، أين متعتك الخاصة” (ص 40) فلم يكن السياق يسمح بذلك: لا حرارة الفيض، ولا تلاشى الكيانات، هذا ما خيل إلىّ، (ولكن: المؤلف أعلم!!)
2- ثم كـَـمْ هو واضح فى هذا الجنس: حوار الأعماق:
فهو ليس مجرد صفقة “لحم فى لحم” (أنظر بعد: القصة الثانية)، وهو ليس تنويعات على لحن اللذة الخالصة، لكنه تكامل الوجود من خلال لغة جسدية لها حرارة التواصل إلى أعمق طبقات الوعى بالآخر. “ … وكان لسانها داخل فمه… كأنها تحاول النفاذ إلى أعماقه” (ص 39) (قارن المقابل لذلك فى الجنس الصفقة- القصة الثانية حيث كان اللسان هو ذنب ملكة النحل القاتل) ([4]):
”… تدس أنفها فى كل قطعة من الثياب، تدخل رائحته بداخلها حتى تتشبع بها، رغبتها الحارة تنبعث من داخلها مباشرة” ([5]).
3- “حولت كل خلية من خلايا جسده إلى نقطة بالغة الرهافة تتشرب بالمتعة” (ص40). ” … تتجمع كل أحاسيسه فى نقطة ثم تنفرط على جسده كله”(ص 40).
هذا، وقد وصف “جانوف”([6]) أثناء علاج الصرخة الأولى أن أحد مرضاه من الرجال كان يشعر بذروة الشهوة (الأورجازم) مركزة فى طرف قضيبه ليس إلا، لكنه حين يخترق حواجز جسده بعلاج الصيحة(!!!) ينتشر الشعور اللذى فى قمة عضوه إلى سائر جسده، والمؤلف هنا يحسن التعبير الذى يوحى بأن الجسد ككل، وليس العضو الجنسى كموضع معزول، هو الذى يمارس هذا النوع من التواصل المتكامل.
وهذا الحوار (حوار الأعماق) لا يتوقف عند عمق الداخل، لكنه ينتشر إلى دوائر الخارج:
”عندما قبض على جسدها أحس كأنه قد أوقف النجوم عن حركتها”(ص40).
ثم إن المؤلف يعلنها صراحة، على مستوى الأجساد، نعم.. الأجساد تتحاور (لا تساوم، ولا تختزل): “… وأصبح الجسدان يتبادلان حوارهما المشترك” (ص 40). (ملحوظة): أعتقد أن هذا العمق لن يتبين بوضوح كما تبين لى إلا بالمقارنة بجنس آخر، وخاصة ما ورد فى القصة الثانية([7]).
تخلو هذه الصورة الجنسية من تحقيق حدْسٍ فرويدىٍّ هام ذلك أن الكاتب هنا صور هذا الجسد الصغير، وكأنه 0فى جملته يمثل العضو الجنسى الذكرى شخصيا، وهذا بعض ما ذهب إليه فرويد مما لم أفهمه طوال حياتى العلمية والمهنية بهذه الصورة إلا من هذه القصة “هكذا”.
“.دعنى أتلوى فوقك كالثعبان، وابق أنت ساكنا كالعشب الأخضر”(ص39). “….-…. لم يدر أين هى بالضبط، تحته فوقه، أم بداخله” (ص 40). “دخل جسدها النحيف بين أضلاعه” (ص 38-39)، “غاصت فيه” (ص 40).
وفى نفس الوقت لم تمنعه وضوح هذه الصورة الرائعة من أن يتنبه إلى تبادل الأدوار، فيجعل هذا الجسد (المكافئ للقضيب) هو نفسه رحما حانيا حاميا “….احتوته فى جسدها” (ص 39).
وقد بدا لى أن أهمية هذا التعبير الشمولى لدور الجسد ككل هو إعلان وعى الكاتب، أو حدسه، بشمولية هذا النوع من الجنس، كما أننا نفيـْـناَ ابتداء أن هذا الجنس هو صفقة “لحم فى لحم” (انظر بعد) كذلك فإن هذا البعد ينفى تحديدا اختزال الجنس إلى لذة موضعية حيث اللذة هنا تغمر كل الجسد، كل الخلايا، كل الحول والطول، بالالتفاف، والاحتواء، والتداخل، والتمازج الكلى الغائر الممتد.
4- وهنا يحتاج الأمر إلى تناول هذه المسألة الأخيرة بقليل من التفاصيل التى لم تغب عن الكاتب أصلا، فقد أشار إلى بُعد “الالتحام/ المحو”، وبالعكس فى أكثر من موقع، فـَـهـُـمـَـا يصيران واحدا جديدا ناميا على حساب التفرد السابق فى واحدية مستقلة، بما يصاحب ذلك من محو لكل ما عدا ذلك، لكل ما قبل ذلك، بل وما بعد ذلك “.. كانت تمحو بداخله كل الماضى والحاضر والمستقبل” (ص 40).
”…ومن أجل أن يصل إلى هذه النتيجة (أنها المرأة الوحيدة التى كان يرغبها طول حياته) كان قد أتلف كل شئ” (ص 41). “التحما فى توقيت نادر” (ص 40). “أصبح لهما نفس الجسد ونفس الرائحة..الخ” (ص40).
وقد ذكرنا حالا أن هذا المحو لم يكن تلاشيا، ولكنه كان تخليقا لكلِّ جديد، وهو ما يبدو لنا قانون الديالكتيك الأعظم، ذلك القانون الذى أطل علينا فى مجمل العمل، كما ظهرت ملامحه فى بعض تجليات التعابير “.. الحب بارد كحقول الأرز لاسع كنيران التنين” (ص 40)، تقوده فى أناة ومهل دون عهر أو براءة” (ص 40) (لاحظ أن التعبير بالنفى هنا أروع فى إظهار الطبيعة الجدلية).
الوجه الآخر لهذا الفيض الجنسى (فيضان الشهوة يقتحم):
ويشاء الكاتب، بقدرة فائقة، أن يفجعنا مرة أخرى ونحن نعيش هذا الفيض الجنسى الراقى والرائق، فإذا به قرب نهاية القصة، أو قل فى نهايتها، يكشف عن وجه آخر لماتيلدا الفلبينية إذ تظهر على شاشة الفيديو فى صورة طوفان آخر، له توجه آخر يروى جوعا آخر، والكاتب لم يـُـستدرج إلى موقف أخلاقى مسطح فيعرض لنا فسقا علنيا مقززا فى قصر الشيخ لمجرد أن يضيف صورة العهر والعربدة على من يمثل القهر والطغيان، أو ليعرى أكثر فأكثر حياة الرفاهية والفراغ التى يعيشها من يملك بغير عرق، لا .. لم يفعل شيئا من ذلك، إذ أنه لو كان قصد إلى ذلك لما جعل بطلة جنس الفيديو هى هى ماتيلدا، أما وقد جعلها هى، فقد استشعرت أنه قد استطاع أن يخترق الاستقطاب الأخلاقى والإيدلوجى الجاهز بهذاالاقتحام المنظم، فبدلا من أن يكتفى برسم ماتيلدا وهى رقيقة معطاء بمحض إرادتها لمن أجارها دون شرط، وبدلا من أن يؤكد على أنها هاربة مقهورة ليس إلا، جعلها هى بطلة هذا الفيلم الجنسى أيضا، فماذا نحن- القراء- فاعلون بتعاطفنا معها منذ البداية، وهى صغيرة، هشة، مجروحة، فائرة، معطاء فى حضن مصطفى ومن حوله؟
ننظر فى مشهد الفيديو أولاً:
قبل أن تظهر ماتيلدا وجدنا أنفسنا نشاهد أشخاصا غير مميزين، وإذا بنا وسط إرهاصات دفق غامر بما يبرر ما ذهبتُ إلى تسميته” بالطوفان الجنسي”:
”…. .كانت هناك مطاردة بين رجل وامرأة، الرجل يجرى عاريا، والمرأة عارية أيضا، تمسك فى يدها رمحا طويلا تطارده فى شراسة وعدوانية خالصة” (ص 49).
إذن فنحن أمام هجوم جنسى برمز محدد، ومن جانب المرأة التى لم نتبين من هى حتى الآن، ثم تظهر ماتيلدا:
”…. ولكنه يفاجأ بماتيلدا على الشاشة.. كانت تتلوى فوق جسد رجل لم يكن شكله واضحا فى الصورة، أهو الشيخ؟ أم أحد أصدقائه؟ أم يكون هو مصطفى نفسه؟”…(ص 50).
وهذه اللقطة تؤكد أمرا، وتضيف آخرا، فهى من ناحية تقول لنا إن الجنس الذى تعاطفنا معه منذ قليل هو هو الذى يعرض على الشاشة “… تتلوى فوق جسد رجل.. الخ”، وهى من ناحية أخرى تعلن فقد الخصوصيية وذوبان الهوية أمام سحق القهر، وفى حدود علمى أنه لا توجد وسيلة تكنولوجية تسجل الصوت والصورة بكل هذه التفاصيل دون علم صاحبها، مما يرجح أن هواجس مصطفى ومخاوفه هى التى سهلت عليه تقمص شريك ماتيلدا فى الفيديو، فضلا عن دهشته واستبعاده أن ما ذاقه طواعية واختيارا قد أعطته ماتيلدا لغيره علانية واستعراضا، فالأرحم له أن يعتبر رجل الفيديو هو نفسه، ليتعرى رغما عنه، بدلا من أن يشوه ما تصوره عطاء خاصا به وحده، وهذا التقمص يتضمن عرضا آخر مما نسميه فقد أبعاد الذات Loss of ego boundariesحيث يصبح الكيان نهبا للآخرين بلا حدود، فيذاع ما بالداخل على الملأ، وفى هذا الموقف بالذات، ومصطفى قد سلب كل شئ حتى صدق تجربته مع ماتيلدا، فإن فقد الهوية بهذه الصورة لدرجة تسهيل التقمص برجل الفيدو هو أقرب التفسيرات وأرجحها حيث تداخل ”عـَـرَضُ الإذاعة” Broadcasting مع ”حيلة التقمص والانكار” Identification &Denial حتى جعل مصطفى يعتقد أنه قد أذيع ما كان بينه وبين ماتيلدا، وهو يتقمص الشخص الذى فى الفيديو حتى لا يكون غيره (مما لا يحتمله)، وبذلك ينكر أن تعطى ماتيلدا لغيره ما أعطته له هكذا بحذافيره.
وكان من أروع ما وفق إليه الكاتب أنه، وحتى نهاية القصة، أنه لم يجزم إن كان مصطفى هو رجل الفيديو نفسه أم لا.
وينبغى أن نتوقف ثانية عند إصرار الكاتب على أن جنس الفيديو هو هو جنس الحجرة الخاصة على سطح بيت متواضع “.. قالت نفس الكلمات، وضج وجهها بنفس الشهوة، ونزت نفس حبات العرق” ثم هو يذكرنا أن عطاءها هذا يفيض ولا يفرّق، يغمر ولا يـُغرق، إذ سرعان ما يردف: “كأنها تضاجع كل الموجودين فى القاعة” (ص 50).
لكن هنا- ومن خلال كشف هذا الوجه الآخر لنفس الجنس- يكاد يؤكد أن هذه الشهوة الجامحة هى القائد لهذا كله، بل لعلها هى هى المسئولة عن إثارة شذوذ الشيخ “كانت شهوة ماتيلدا عارمة حتى أن المنظر كاد يصبح ضبابيا من أثر الصهد المنبعث من جسدها”، وقبل ذلك كان قد أشار إلى أنه:
“…لعل هذا الانكسار والذوبان فى ممارسة الحب هو الذى دفع بالسيد الشيخ إلى شهوة جنونه، هذا التفانى الجسدى هو الذى جعله يصنع من جسدها مطفأة لسجائره…”
فهل بقى بعد ذلك شك فى أن ماتيلدا هى ماتيلدا مع كائن من كان، وأن هواجسه عن شخص الفيديو أنه هو نفسه ليست إلا نتاجا لما ذكرنا؟ فهو يقارن ويخاف ويستبعد فيتقمص، فيتعرى:
“.. يعرف هذه الانتفاضة، وهذا الإحساس الغامر بالمتعة، والشعور الطاغى بامتلاك ما لا يمتلك، بالألم والفرح والخوف والانبهار” (ص50).
فلما كانت ماتيلدا هى ماتيلدا، والشهوة هى الشهوة، والفيض هو الفيض، فلماذا نعتبره وجها آخر لنفس الجنس، ولماذا لم نكتف بأن نقول أنه هو هو مع مصطفى أو مع غيره؟؟
أعتقد أن هذه التفرقة الدقيقة هى من أفضل ما حدَس المؤلف، ذلك أنه لم يستسهل، ولم يستقطب، فمن أبرع براعة الكاتب أنه قدم لنا صورة تفان جنسى رائق، وماصاحبه من ذوبان وولاف والتحام وامحاء.. وصلاة وخشوع فى إيقاع نابض فشمول وانتشار، فلم نكد نقول “هذا هو” حتى راح يفاجئنا بأنه أيضا، وربما قبلا: شهوة عارمة: وصهد صاهر، ومومسية معلنة (وكأنها تضاجع كل الموجودين بالقاعة) (ص 50).
وقد لاحظت أنى شخصيا- وخاصة فى القراءة الثانية فالثالثة- لم أعد أشعر بأى تناقض فى كل هذا، ثم رحت أحمد له هذه الجرعة الإبداعية الجسور، وفى نفس الوقت فإنى لم أقبل أن يكون جنس الفيديو مجرد تسجيل متجسس لجنس الحجرة، لا.. أبدا: جنس الاخنتيار الحر والنتح الفيض الدافئ ليس هو هو جنس الطوفان الغامر والفيضان الصاهر، صحيح أنهما ينبعان من مصدر واحد هو التصالح مع الجسد، وتلقائية العطاء، لكن الذى يوجه المسار إلى هذه الوجهه، أو تلك، هو المجال والتلقى، فحين كان المجال إنسانا شهما متواضعا خائفا اتضحت صورة النتح الطبيعى والصلاة المذيبة.. الخ. أمّا حين صار المجال إثارة وشيوعا وتحديا واستعراضا تميزت صورة الطوفان الشهوى والفيضان اللذى فى دفقات صاهرة متدفقة، ولعلنا نذكر تعبير الكاتب: “دون عهر أو براءة” فى محاولة تنبيهنا إلى هذه القضية التى تجعل البراءة هى النقيض للعهر مما يوقع الأزواج -على غبائهم وحسب طلبهم- بين اختيارين انشقاقيين متضادين: فإما الخيانة مع من تعرف مفاتيح الجسد فى دور اللهو وأمثالها، وإما الجفاف أوالبرود مع وسائد لَحْمية شرعية خالية من الحياة، فرحت أعتبر هذه اللقطة العميقة من أبرز اقتحامات المؤلف، عساه إذْ أفْجعنا أيقظنا، وإذْ واجَهَنا عرّانا، لعلنا نرفع الوصاية عن أجسادنا وأجساد أولادنا دون خوف من عهر أو براءة، إذ ندرك أن تحرير الجسد ليس معناه التفريط فيه، بل إنه يعنى مزيدا من احترامه، فإذا تحرر الجسد ابتداء ناغم الطبيعة، ثم تأتى بعد ذلك المسألة الأخلاقية يحددها المجال لا تشويه الفطرة بفرض اختيارات ثلاثة منفصلة: على الأقل: إما الحرية السائبة، أو الثلاجة الجبانة، أو الصفقة الدعارة.. أما الولاف الطبيعى بين براءة ناعمة وعهر قارح، فهو غير مطروح إلا كما نتعلمه من هذا الإبداع المتميز.
****
القصة الثانية: الوداعة والرعب
”الجنس الصفقة” (الجسد اللحم)
تأتى قصة “الوداعة والرعب” (الثانية فى المجموعة) لتؤكد موقف الكاتب وقدرته على معايشة الواقع الآنى بسبقٍ سوف يذكر له، ففى هذه القصة راح يقتحم موضوع التطبيع مع الجارة اللدود، فرسمه بحدة تحدياته على مختلف المستويات، دون استقطاب مسطح، فهو قد أوضح وجهة نظر الابن الشاب اليائس الضجر المهاجر (مع وقف التنفيذ)، وموقف الأم الخرساء حزنا على ضناها الشهيد، ثم موقف الأب المتردد بين قبول الأمر الواقع وألم الشعور بالغفلة والخضوع للعبة أكبر من مقاومته، فردا منهكا مكلوما، وقد اتخذ الكاتب لشخوصه مسرحا يتحركون فيه بعيدا عن أرض الوطن (مصيف فارنا) مما أتاح له مساحة أكبر للحركة والمراجعة والحوار المتنوع، لكنه كان بمثابة من نقل معه الوطن (ممثلا فى بقية أفراد الفوج السياحى)، فاستطاع أن يرسم لنا صورة رجل الأعمال الذى يستنفع من التطبيع – بالمرة- ثم قدم الأستاذ الجامعى الإسرائيلى الذى يتقن “الجاسوسية العلمية” الأحدث والأخبث، وابنته التى تـُـذكـّـرنا بالصورة القديمة لليهودية البائعة جسدها بالمقابل المناسب حسب احتياجات السوق وتعليمات الطائفة، وقد استطاع الكاتب أن يقدم لنا صورة عصرية مواكبة حيث جعل الثمن فى هذه القصة هو وعى الشاب المصرى وكيانه، وتليين الوالد المصرى وترويضه، غير المكاسب الأخرى المحتملة مما لم يُعْلَن.
وجاءت الصورة الجنسية- إذن- فى هذه القصة مختلفة تماما عما قدم الكاتب فى القصة الأولى، وهذا فى حد ذاته دليل على أن الكاتب لا يكرر نفسه، وأنه لا يستقى معلوماته عن الجنس من مصادر جاهزة – علمية أو أدبية- بل من حدس إبداعى يفيض فى كل خـَلـْق يحييه، فى هذه الصورة نفتقد المعالم التى ميزت الجنس فى القصة الأولى، معالم الوجهين معا، فرغم أن الجسد هنا أيضا يحتل الواجهة، إلا أننا نفتقد هنا السلاسة والسهولة والتكامل الجسدى فى الوجود الكلى، كما نفتقد العطاء الحر الغامر،… الخ، وقد كان علىّ – كقارئ- أن أنتبه إلى الفروق الجوهرية وراء الشهوة الجامحة هنا (أيضا) حتى لا أخدع فى شـَبـَهٍ ظاهرى، وهذا ما كان:
فالجنس هنا هو جنس وقح، منفصل، ملتذ، مؤقت بوقته، يبدأ جسديا وينتهى جسديا، مفرزا على جنبيه بنود الصفقة، بما تعلن وما تخفى من منافع متبادلة، وشروط محددة.
كانت صفقة طول الوقت، حتى الألفاظ التى استعملت فى وصف البضاعة أو المساومة أو العملية كانت أقرب إلى لغة التجارة بشكل أو بآخر:
تبدأ الصفقة مثلما يفعل أى تاجر شاطر بالملاحقة والإثارة: “… لكن طارق أحس بها وهى تلاحقه بصمتها الغريب، بجمالها الغامض”.. الخ (ص 72).
ويمضى الزبون فى مقارنة العينة بسائر البضاعة المعروضة، لكنه يستسلم فى النهاية لبضاعة التاجر الأشطر الواثق من نفسه “… تستحوذ عليه وتفقده أية متعة يمكن أن يشعر بها وهو يرى كل تلك الأجساد العارية التى يمتلئ بها الطريق” (ص72) “وكأنه يتفرج على بضاعة مرصوصة على الأرصفة على الجانبين، ثم يظهر ما يشير إلى أن المسألة محسوبة بشطارة غير معلنة “….يحيط بهما جو من الريبة والتواطؤ” (ص 78)
(لاحظ كلمة التواطؤ هنا بما يقابل “سيم” التجار، وخاصة السيم السرى بين التاجر وولده والذى لا يعرفه حتى العامل بالمحل).
ثم تتعرى المسائل، ويوفق الكاتب توفيقا شديدا حين يتكلم ويعاود تكرار أن العلاقة الجارية ليست إلا علاقة بين جسدين بل “لحمين”، ليست بين كيانين أو شخصين، ياله حين يقول: “… فى أى لحظة عند انطلاق أى شرارة، سوف يمتزج اللحمان…”(ص78)
إذن لم يعد هناك شك أن المسألة برمتها هى صفققة جسدية محددة: ملاحقة، استحواذ امتزاج اللحمين، (ولا بد من وقفة عند استعمال لفظ اللحم هنا فى صيغة المثنى).
ثم تمضى الصفقة اللحمية “…. يد فى يد، وصدر فى صدر”، “… لحمها يتوثب من خلال ثوب الموسلين” (ص 80).
وربما كان مما يخفف من وقع التجارة والشطارة أن الصفقة جرت فى جو شبابى حار، مما يجعل الصفقة مبلوعة بعض الشئ، شك أن ثمة جذب لحمى “كان من ضمن البنود والشروط والعوامل المساعدة”.. اكتشفا أنهما خفيفان لا تكد أقدامهما تلمس الأرض([8]). لكنهما ليسا سوى جسدين حتى للناظر من الخارج “… ألا يمكن لهذه الموسيقى أن تتوقف، وهذان الجسدان أن ينفصلا… “ (ص 82).
ثم يتأكد ما ذهبنا إليه فى المشهد الجنسى العارى، حيث الخلفية كلها أجساد فى أجساد، بكل ما فيها من “قبح وجمال” (والذى لا يشترى يتفرج) حيث كان العرى هو إذْن الدخول: ”عرى الجسد والأحاسيس والرغبات” (ص 92) لكنه لم يحدثنا- ربما حدسا إبداعيا- إلا عن عرى واحد هو عرى الجسد، وفى هذا المشهد بالذات يبدو أن الصفقة كادت تكتمل، فالبضاعة واثقة وحاضرة، والزبون مجذوب، وكأنه قد فقد إرادته (.. لم تبال حتى بالالتفات، كانت متأكدة من أنه يتبعها (ص 98) ثم انظر كيف لم يفت المؤلف تحديد “ماذا” يتبع: “… كان فقط يتبع رائحة جسدها” (ص 98).
وحين التقى الجسدان، كان لقاء ذا دلالة هامة، حتى وكأن الثقل الميكانيكى للجسد هوالذى أدى إلى الالتحام الأولي: “… خطا الخطوة الأخيرة إليها، أحس بنفسه فوق جسدها” (ص98) ولأنها مسألة ميكانيكية، فالمحرك و “الموتور” ما زال باردا، وربما احتاج بعض الوقت للتسخين (قارن حرارة وصهد ماتيلدا فى القصة الأولى) فهو يردف: “كان (جسدها) باردا مرتعدا، فتشبث فيه بكل قوته” (ص 98).
فإذا كانت صفقة كما استقبلناها فإنه من المناسب أن نعرف طبيعتها ما هي؟ ماذا مقابل ماذا؟ أو بكم؟، وأحسب أن الكاتب ألمح، وصرح، بطبيعة هذه الصفقة، وتصوُّرِى أنه يمكن صياغتها كالتالي:
”خذ جسدي- بضمان والدى وعلمه- فى مقابل أن تسلمنا- أنا وأبى وناسي- كيانك ووعيك وانتماءك”.
إذن فالثمن هو الثمن الذى يدفعه ذكر النحل ليواقع الملكة، وقد ذكر الكاتب هذا القياس الرمزى تحديدا حين قال: “… لسانها لاذع كأنه ذنب شهد الملكة التى تودى بكل الملوك”. (لعله يقصد بكل الذكور).
وقد أشار عبد الغنى (الوالد المصرى) إلى طبيعة هذه الصفقة وكأنه يكتب المذكرة التفسيرية لبنود العقد، إذ طلب وعدا من والد ليزا (البروفيسور الصهيونى) وعدا تحفُّظيا ” .. هل يمكن أن تعدنى ألا تقتلوا طارق أيضا؟” وللقارئ أن يقرأ “القتل” كما شاء: الإستيلاء على إرادته؟ تهجيره إلى “السلمية”؟ “.. جاءوا، وأقاموا وتناثروا كنباتات الحلفا” (ص66) ”والمتاعب الدفينة، يدرسونها ويحللونها لتصبح نقاطا فى صالحهم، كل سر صغير يساعدهم على قتل المزيد من الناس” (ص 93). أليس هذا هو “القتل” الذى كان يطلب عبد الغنى من والد ليزا أن يعده ألا يحدث؟
إذن فالثمن هو “الكيان” هو التلاشى، ليس تلاشيا بالمعنى الأول فى القصة الأولى، أى تلاشى النقيضين فى الجديد المتخلق، لكنه تلاشى الكيان الأضعف- وإن بدا ذكرا- فى الكيان الملتهم، فهل يا ترى كان الكاتب يقدم هذا البعد الموازى ليعلن رأيه فى طبيعة الصفقة الأكبر أى: تسليم الأرض (سيناء) فى مقابل استسلام الكيان المصرى (كشخصية حضارية مستقلة واعدة)؟؟
وعلى ذكر مقارنة التلاشى هناك (القصة الأولى) بالتلاشى هنا (القصة الثانية) فإنه يمكن البحث عن مقابلات أخرى موازية مثلما أشرنا إليه فى دلالة لغة اللسان فى الفم، والتى نكررها هنا للأهمية ومزيد الإيضاح:
هناك: “كان لاذع كأنه ذنب الملكة (ص99).
هناك: “تقوده بأناة ومهل دون عهر أو براءة، ولم تفقد وعيها بما يحدث، ثم شاركته فى نفس اللحظة، غرست أظافرها فاختلطت المتعة بالألم” (ص 40).
هنا: “تعض عضلات صدره، وتخمش ظهره بأظافرها ويتحول صوتها إلى نوع من العواء الحيوانى الجائع” (ص 99).
غرس وخمش، ولكنه شتان بين لحظة ألم محدد يؤكد التداخل والتوحد، تعقبه قيادة متمهلة متأنية “دون عهر أو براءة” (هناك) وبين عواء ذئبة تعض وتخمش فريستها طول الوقت (هنا):
هناك: “… كان يريد أن يعرف مَنْ صاحب هذا اللحم الذى يمتزج مع لحمها ” (فى الفيديو) (ص 50).
هنا: “… عند انطلاق أى شرارة سوف يمتزج اللحمان” (ص 78).
ومع أنى لا أستطيع أن أميز فرقا دالا بين امتزاج لحم ولحم، إلا أن مصطفى (فى القصة الأولى) لم يتكلم بهذه اللغة إلا حين انفصل عن الموقف وهو يشاهد الفيديو مغيظا غيورا متقمصا ناكرا.. الخ، ومن ثم اقتربت الصورتان.
على أن ثمّ بعدا آخر فى هذا الجنس الصفقة فى هذه القصة الثانية، وهو أن طارقا إذ راح وراء “البضاعة” مجذوبا مخدرا، قد عومل هو أساسا كبضاعة مـُشـَيـَّأة فعلا، أنظر حين سألها أصدقاؤها مشيرين إليه “… من أين أتيت بهذا الشاب؟” (ص 100) وكأنها كانت تتسوق فاقتنته، فسألوها مثلما يسأل الواحد منا صاحبه: “من أيت أتيت بهذا الجورب، أو هذا الحذاء.. الخ”، كذلك فقد تأكدت معاملته كالآلة” الجنسية” التى تفرغ لتمتلئ ” … سوف نبعث فيه النشاط من جديد” أو: “…. وأخذت تسكب على رأسه البيرة” (ص 101) وكأنها تملأ الخزان بالوقود (التنك بالبنزين).
ثم تأتى النهاية لتعلن فشل الصفقة، لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقدين، لكن يبدو أن البنود السرية التى كانت تجرى موازية للصفقة الجنسية كانت جزءا لا يتجزأ من “الإتفاقية”، ولعل التحام الشابين فى الجنس كان المعادل الموضوعى لالتحام جسد الوالدين الدموى فى العراك البدنى (وبالعكس)، ورغم اعتراضى على النهاية، (فلم أفهم لم يكون القتل متبادلا، فالسياق يغرى باعدام القاتل لا الضحية مما لا داعى لتفصيله هنا) فقد أعلنت (النهاية) بشكل أو بآخر أن الجنس إذا انفصل عن الكل، أو كان وسيلة لغيره، وإذا كان تخديرا ماديا محدودا، فهو العدم ذاته، حتى لو تأخر إعلان هذه الحقيقة.
****
القصة الثالثة: “اتجاه واحد للشمس”
الجنس اليأس (تراكمات الجوع والفقر)
وددت لو اكتفيت بهذه المقارنة بين جنس وجنس من واقع قصتين طويلتين، أو قل روايتين صغيرتين، كتبتا – فيما يبدو – فى زمن متقارب، إلا أنى عدت فقدرت أن النظر إلى قصة أقدم (وأقل جودة) قد يضيف بعدا زمنيا لتطور الكاتب،، كما قد يكشف لنا أشكالا أخرى للجنس لم تغب عن وعى الكاتب، مما يؤكد ما ذهبنا إليه مقدما من أنه إنما صارَ يستهدى بحدسه بأقل قدر من الوصاية.
وقد فضلت أن أكتفى بالاشارة السريعة إلى ما ورد فى هذه القصة الثالثة من تنويعات جنسية للوفاء بالغرض الذى أوضحته حالا، لكننى توقفت عند نوع منها غلب على أجوائها، وهو ما تعلق بالجنس مدفوعا بالفقر والجوع (على أكثر من محور) معلنا اليأس (تراكما.. ففجأة).
وقبل ذلك أقدم خطوط وجوّ هذه القصة الثالثة فى إيجاز:
تجرى أحداث هذه القصة فى مصنع له صاحب (“حاج” كالعادة)، وله مدير، ومساعد مدير، وبه عمال ورئيس لهم، بينهم أسطى (نقابى أو كالنقابى) يحب الآلات ويكره توقفها كما يكره أصحابها، وثمة كاتبة وعاملات.. الخ، ويدور الصراع تقليديا بين العمال من ناحية وصاحب المال من ناحية أخرى، وتتحدد العلاقات بالطريقة التقليدية، على محاور متعددة، لا تخلو من عاطفة هنا، وشذوذ هناك، وأفكار وتلميحات جنسية طول الوقت. ثم تنتهى بلقاء جنسى غير محسوب، بين عاملة شهية، وعامل فتى، على أكياس القطن فى عز النهار، فيضبطان، فينتهزها صاحب المصنع فرصة ليصرخ: “.. كأنه يعلن صيحة الجهاد: نجاسة” ويفسر بذلك ما أصاب آلات المصنع من عطب حتى توقفت جزاء وفاقا لهذا الإثم الذى يجرى بين عماله “..قطعت عيش العمال يا نجس يا ابن الكلب” (ص142).
فكيف ظهر الجنس متخللا نسيج القصة من البداية للنهاية؟
كان الجنس دائما فى خلفية الأحداث، كل الأحداث تقريبا، فكنت تشعر به، إن لم يظهر صريحا، وهو يتحفز متلمظا على جانب ما من وعى الجميع، وكان التعبير عنه فى كثير من الأحيان تعبيرا جسديا بدائيا، فالريس أحمد “.. تزداد حدة الأكلان لديه حين يشاهد بهية بجسدها الملفوف وساقيها.. الخ” (ص 115)، “واكتشفت بهية أن الريس أحمد مازال جالسا يحتك فى الجدار وهو يحدق فيها” (ص 118).
كذلك فقد فهمت، أو قدرت، أن قئ سامية المفاجئ كان تعبيرا جسديا عن مساومة إبراهيم (خطيبها مساعد المدير) الذى يقول لها: “الأمر لا يتطلب أكثر من أن تكونى ظريفة معه (مع المدير) متجاوبة قليلا” (ص 126)، “.. وكان لحمها حينذاك باردا مقشعرا، ولم يبد على وجهها تعبير من أى نوع” (ص 126).. وهكذا كنت أشعر فى كثير من الأحيان أن الجسد والأحشاء تتحدث بلغة بديلة وقوية ودالة كلما اقتربنا من ما هو جنس على أى مستوى.
كذلك تعددت الصفقات الجنسية بشكل صريح وعلى مختلف المحاور وبمختلف المقايضات، فهى لم تقتصر على صفقة لحمية مثل القصة الثانية، ولم تتحدد بثمن باهظ كما تحددت هناك، (جسد مقابل كيان)، لكنها كانت صفقات عابرة متناثرة ناقصة مجهضة دائما أبدا، هنا وهناك، على أن ثمة صفقة أساسية- لم تتم أيضا – تعلن صراحة وتحديدا هى تلك التى تتحدث عنها بهية “لم يتقدم من يشترى الصفقة كلها.. هى، ولحمها، ورطوبة فقرها..”، “.. كل الذين تقدموا كانوا يريدون التقاطها هى فقط.. جائزة ثمينة عن مجهود لم يقوموا به” (ص 120) وتبدو طبيعة الصفقة أكثر صراحة قالت لها أمرأة عجوز (بعد أن شهقت وبسملت): “… إن ثمنك غال فلا تفرطى فى نفسك.. – الرجال حيوانات لكنهم يفهمون الشئ الجيد وهم على إستعداد لدفع الثمن المناسب” “.. ثم دعِى المساومة لى” ثم “.. لا تتركى نفسك بالمجان” (ص 132).
كانت هذه أصرح صفقة معلنة ومباشرة، ومع ذلك فهى لم تتم، لأن تراكم الجوع وإلحاح اليأس أفسدا الحسابات (أنظر بعد).
ولعل الصفقات الثانوية الأخرى كانت تسير على نفس المنوال، صفقات بالأجل، وفى الخيال، ومع وقف التنفيذ.. الخ قس على ذلك علاقات رتيبة مع شنودة أفندى (دواء للخوف والوحدة فى مقابل القرش والزواج) “… خيل إليه أن جسدها يمكن أن يكون تابوتا دافئا لجسده”، إبراهيم مساعد المدير وسامية الكاتبة، علاوة للخطيب مقابل لين المدير “فى حدود الأدب”، ثم بنايوتى (صاحب المصنع السابق) مع شنودة أفندى: إرضاء شذوذ بنايوتى فى مقابل الاستعلاء… “القفز على أسيادك يا شنودة” وهكذا كلها صفقات مادية مختزلة ومحسوبة ومجهضة يحيط بها الحرمان ويطل من خلالها اليأس.
وتأتى النهاية لتؤكد أن الجنس هنا قد تفجر تلقائيا بلا صفقة ولا حتى غاية، فبهية صاحبة الجسد الذى يساوى الشئ الفلانى تجد نفسها فى لقاء عفوى مع عبد التواب، لقاء بدا أبعد ما يكون عن المساومة أو حتى اللذة الواعية المختارة، فكشف هذا اللقاء عن تراكمات الجوع والفقر حين تصل إلى حدة ملحة، فتدفع بهية – وهى تعلم – جسدها من اليأس إلى الجنس، فتلتقط بالصدفة رغبة ميتة من زميل منهك “… كانت جائعة.. وعليها أن ترضى بفتات الطعام.. وفتات الرجال.. إذا كان هناك رجال” (ص 120)، وقد كانت تظن أنه لا يوجد من يملأ عينها ويستأهل جسدها فضلا عن أنها كانت محاطة طول الوقت بــ “رطوبة فقرها” “… كانت بهية متعبة وجائعة إلى درجة الحزن” (ص 137)، ثم “.. يطل عليها وجه عبد التواب يحملق فيها ولا يحمل إلا مزيدا من الغبار والتعب والرغبات الميتة…” (ص 132)، لاحظ إلى أى مدى وصل الانهاك، ثم لاحظ “الرغبات الميتة” فماذا يقفز إلى وعى بهية بالمقابل وقد وصلت رطوبة الفقر ولسع اليأس إلى مداهما؟ فورا تتذكر قول المرأة العجوز: “لا تتركى نفسك بالمجان” (ص 132) لكن الواقع والانهاك لا يسمحان بالمساومة فالشوارع تضيق من حولها وتمتلئ بالعيون الواسعة بدون أهداب، بالدكاكين الفقيرة الترابية، إذن فالفقر يتحدى، واليأس يتقدم، وكل شئ يضيق، وحين التقى الجسدان لم ينجذبا إلى بعضهما، وإنما التقيا بفعل قوى طاردة (الجوع والفقر واليأس) وكأنهما تصادما إبتداء، لم تكن ثمة رغبة دافعة أو دافقة، ولكن بعد الصدام تحرك المجهول بشرارة المصادفة، وليكن ما يكون، فلم يعد هناك ما يعد بانتظاره “..كانت مشمئزة ومتعبة، تحس برغبة لشئ مجهول”، “..كان مقبلا عليها ككابوس، كحلم بلا لون” (ص139) فهل بقى بعد ذلك مجال لتأويل؟
وهكذا نرى نوعا آخر من الجنس يحدث عفوا بفعل قوى طاردة تتصادم بسببها أجساد وكيانات منهكة يحيطها اليأس وينخر فيها الجوع ويذلها الحرمان فلا صفقة لـَـحـْمـِـية، ولا تفجر طبيعة، ولا شئ يبقى بعد شرارة المصادفة، اللهم إلا الوشم بالنجاسة والنبذ والاتهام.
وبعد
فلقد حاولت بهذه القراءة أن أقدم للقارئ (وللكاتب على حد سواء) محاولة قراءة مجتهدة، فيما هو جنس، تلك المنطقة التى يتصور الناس أن العلم قد أحاطها من كل جانب، فى حين أن الإبداع الصادق هو القادر على كشف طبقاتها، ولغاتها، ومحاورها، طالما يحرك الإبداع وعيا مخترقا، وحدسا نشطا، دون وصاية أو نمطية.
وهذا ما فعله محمد المنسى قنديل قبل وبعد كل شئ.
[1] – محمد المنسى قنديل: رواية “بيع نفس بشرية” روايات “دار الهلال” (عدد أغسطس 1987(
[2] – عبد الله خيرت دراسة لـ “الأحداث الدامية فى قصص المنسى قنديل” (ص 22)، مجلة ابداع، (العدد 12 ديسمبر 1987)، السنة الخامسة.
[3] – أنظر هامش (30) “ص67”
[4] – انظر الهامش السابق
[5] – انظر هامش رقم (26)
[6] – Janow A. (1970) Primal Scream، New G.P. PPutman،s Sons
[7] – وعندى أمل أن يعود القارئ إلى هذا الوصف – هنا مرة ثانية – بعد الإنتهاء من القراءة الأولى.
[8] – ولعل هذا ما جذب انتباه د. على الراعى إلى اللحظات التى رقصا فيها رقصا رقيقا متناغما.
*******
الباب الثانى
غريزة العدوان
من التفكيك إلى الإبداع
العدوان وحركية الإبداع
العدوان غريزة بقائية
يمر إنسان عالمنا المعاصر بأخطر مراحل تطوره، فقد أصبح تحت يديه من وسائل الدمار ما يبدو للوهلة الأولى أنه غير قادر على السيطرة عليها، ولابد أن قانونا – لا نعرفه فى الأغلب – يقوم بالمحافظة على استمرار بقاء حياة البشر على الأرض حتى الآن على الرغم من وجود كل هذه القوة المدمرة بين أيدى من لا يستعمل بقية خلايا مخه بنفس الكفاءة، ذلك أن طريقة تفكير الساسة الكبار عبر العالم، وسلوكهم الشخصى الدال على وفرة الدفاعات (الميكانزمات) التى تتحكم فيهم دون وعى منهم لا تــُـطـَـمـْـئـِـنُ أى شخص بأبسط حسابات المنطق السليم، ناهيك عن العالــم اليقظ.
من واجب العلماء البحث عن هذا القانون الخفى إن كان موجودا أصلا، ثم اختبار فاعليته واستثـماره وتطويره إذا احتاج الأمر، فإذا ثبت (أو صور لنا جهلنا) أن الحياة مستمرة بالصدفة، تحت زعم أنه ليس ثم قانونا خفيا أو ظاهرا: فالواجب أكثر إلحاحا هو العمل على إنشاء ذلك القانون الذى يساعد فى استمرارها بوعى لائق، ومسئولية مناسبة وحساب علمى قويم، وفاءً بأمانة ما نحمله بشرا!!.
مـِن أوْلى المناطق بالتنقيب لتحديد طبيعة مخاطر الدمار الذى يتعرض لها الإنسان المعاصر بجرعات متزايدة تلك التى تتعلق بالغرائز عامة التى يبدو أننا لم نعد نأخذها بالاهتمام اللائق بها، وذلك بعد ما لحقها من اختزال وتشويه باعتبار أنها أقرب إلى البدائية وليست من صميم نـِـعـَـم الفطرة.
الغرائز هى أقدم وأعرق وأهم تطوريا مما تلاها من وظائف، وهى التجلى الطبيعى لما هو فطرة، فطرة الله التى فطر الناس عليها، بل التى فطر كل الأحياء عليها، ومن حـَـمـَـل أمانة ما فـُـطـِـر عليه بحسن استعمال برامج النمو والبقاء استطاع أن يستمر، وهو للأسف لم يتعــَـدَّ الواحد فى الألف من كل الأحياء([1])، ومن بقى -وهو الواحد فى الألف! – عليه أن يواصل حمل الأمانة أو أن يلحق بالأغلبية،
ومن أولويات حمل الأمانة أن نتعرف على ما هو “ربى كما خلقتنى”: بالبدء فى مراجعة ماهية فطرتنا واحترام دور غرائزنا، بدلا من تهميشها واختزالها، فضلا عن تشويهها وسوء استعمالها لعكس ما خلقت له.
هذه المداخلة هى محاولة على هذا الطريق وهى تتناول الغريزة التى تمثل أصرح مظاهر القوة المنبعثة من طاقة طبيعية إذا عجزنا عن دراسة قوانينها وتوجيه مسارها، قد تنطلق -وفى يدها كل أدوات الدمار الجاهزة حاليا- فتقضى على البشر كافة، وقد تقضى على الحياة كلها بلا وعى، خاصة وأن الإنسان – كما يقول لورنز وتينبرجن - دون كثير من الحيوانات- لم ينمُ لديه جهاز للضبط والتوازن والتحكم فى نزعاته العدوانية، وهذا النقص قد يكون مسئولا عن تماديه فى الفعل العدوانى حتى أقصى نهايته، وهو القتل.
ذهب لورنز(وتينبرجن)([2]) إلى اعتبار أن الإنسان- دون كثير من الحيوانات المفترسة- ليس عنده كف غريزى للقتل بوصفه مفتقدا أية جوارح قاتلة (مخالب وأنياب)، بالتالي، فى رأى لورنز، أنه لم يعد يحتاج لهذا الكف الغريزي، وهذا أمر يتطلب مراجعة بعد التدهور التدميرى الذى يعيشه إنسان العصر الحديث الذى خلق لنفسه مخالب وأنياب أمضى وأشمل تدميرا للحياة برمتها وليس فقط لعدوه من نوعه أو غير نوعه، ثم إن الإنسان هو الحيوان القادر على قتل أفراد من نفس جنسه، فهو يقتل:
(أ) بشرا لا يعرفهم “شخصيا”
(ب) وعن بعد دون أن يراهم
(جـ) وفى مجموعات.
بل لقد أصبح هذا القتل البشع فى ذاته من المنجزات الجديرة بالفخر، كما يقول روبرت جاى ليفتون([3]): “…إن كمية القتل قد أصبحت مقياس الإنجاز”. وفى ظل هذه الظروف، فإن مصيبة الدمار الفنائى قد باتت شديدة القرب بحيث لو حدثت هذه المصيبة فقد تكون إثباتا مروعا لزعم قائل: إن التركيب الانسانى فيه ما يشير إلى خطإ تطورى([4]) لو أنه استمر فهو سوف يؤدى إلى انقراض النوع ما لم نحول دون ذلك بكل سبيل ممكن!!.
لا يمكن أن ننساق وراء هذه المخاوف الانطباعية فى تشاؤم عدمى إلا أننا أيضا لا يمكن أن ننكرها لمجرد أنها بعيدة الاحتمال.
نبدأ البحث بتساؤلات محددة نحاول من خلال الإجابة عليها أن نحدد أبعاد المشكلة، ومن ثـَمَّ إمكان الخروج منها:
1- هل العدوان غريزة أصيلة لها صور تعبيرية مختلفة مع اختلاف الأزمان والأجناس، أم أن العدوان هو مجرد سلوك مكتسب طارئ، نتوقع له أن يزول بزوال مستدعياته؟
2- ما هى وظيفة العدوان البقائية، وما هى فرص التعبير عنه فى حياتنا المعاصرة وخاصة بالمقارنة بغريزة الجنس التى تتعلق أساسا ببقاء النوع؟
3- ما هى الاحتمالات المطروحة لمواجهة هذه الطاقة الغريزية تعليما أو ترويضا، أو تحويرا، أو إدماجا؟
محاولة تعريف مبدئى
لا يحتوى لفظ “العدوان” مضمونا واحدا (جامعا مانعا) متفقا عليه بالقدر الذى يـُـطـَـمـْـئـِـن إلى تناوله من نفس المنظور من كل الأطراف، فالتعريف السلوكى يصوغه “تينبرجن”([5]) كالتالى:
”العدوان - باعتبار السلوك الفعلى - يتضمن الإقدام تجاه خصم، وإذا كان فى متناوله فإنه يتضمن دفعه بعيدا وإصابته ببعض الأضرار بشكل ما، أو على الأقل إرغامه بمؤثرات تكفى لإخضاعه”.
نلاحظ هنا منذ البداية، ذلك التحفظ الذى وضعه تينبرجن، من حيث تحديد التعريف بنص اعتراضـى بقوله – باعتبار السلوك الفعلي- فلعل الخلط بين السلوك الفعلى وبين الموقف التهيئى دون فعل ظاهر، ثم بين هذا وذاك وبين غريزة العدوان- فى كمونها ونشاطها-، هو الذى وراء إغفال الأصل وإهمال الطبيعة الإيجابية، المحتملة التي تعرضها هذه المداخلة وبالتالى مضاعفات الجهل والتشويه؟
لتوضيح قصور مثل هذ التعريف المؤكِّد على الإقدام والإضرار دون غيرهما نطرح بعض التساؤلات كالتالى:
هل يمكن أن نقسم سلوكَىْ الكر والفر، باعتبارهما سلوكين متضادين ظاهرا، ونقصر كلمة العدوان على سلوك الكر Fight دون سلوك الفر Flight على الرغـم من أنه يصاحبهما نفس التغيرات الفسيولوجية تماما (مـثل زيادة نشـاط الجـهاز العصبى السمبثاوي)، مع أن سـلوك الفر قد يكـون تمـهيدا لسلوك الكر أو جزءا منه أو تناوبا معه لتحقيق نفس الغرض؟
وهل يمكن أن نتناسى صور العدوان السلبى: بالانسحاب أو الإلغاء أو المحو؟
الإجابة على مثل هذه الأسئلة هى بالنفى “لا يمكن”، وبالتالى فالمراجعة واجبة.
نبدأ بعرض تعريف مبدئى بديل يقول:
”العدوان هو الدافع أو السلوك (أو كلاهما) الذى يهدف للحفاظ على الفرد وجودا وذاتا -على حساب الآخر (من غير النوع عادة أو من نفس النوع، مؤقتا) وهو يشمل فى صورته البدائية: السلوك المقاتل المهاجم حتى الطرد أو القتل، ولكنه يتحور – مسلكا وموضوعا- بتحور مراحل نمو الفرد والمجتمع جميعا، وذلك من خلال تداخلاته مع مستويات الوجود الأخرى فى جدل وُلافىّ متصاعد على مسار النمو.
لن أبدأ بالدفاع عن هذا التعريف لأنه فى واقع الأمر غاية هذا البحث أكثر منه مسلمة ابتدائية.
نظرية الغرائز: موقعها الآن:
أصاب الغرور الإنسانى الأحدث “نظرية الغرائز” فى مقتل دون وجه حق، فقد ثارث نزعة مضادة ضد نظرية الغرائز وخاصة بعد مغالاة ماكدوجال([6]) فى تقديمها وتقسيمها، وقد توالت الضربات على نظرية الغرائز هذه من اتجاهين أساسيين: وهما الاتجاه السلوكى من ناحية، والاتجاه الاجتماعى من ناحية أخرى، وحتى فرويد لم يستطع أن يمتد تأثير موقفه بالنسبة لغريزة الجنس أساسا إلى ما يسمح بالدفاع المناسب([7])، فقد هوجم فرويد من خصومه، كما هوجم من أتباعه على حد سواء، ذلك أن كثيرا من الفرويديين المحدثين قد هاجموا بيولوجيته لحساب “نظرية العلاقة بالموضوع”([8]) Object relation أو العلاقات البينشخصية Interpersonal، فى حين أن أغلب السلوكيين قد ركزوا على التعـلم ونظرياته وآثاره فى إحداث المرض وإزالته على حد سواء، مستبعدين بإصرار أولوية أية غرائز ثابتة أوجاهزة، أوموروثة (من حيث التفاصيل على الأقل). ورغم زعم علماء النفس الإنسانيين (أمثال أبراهام ماسلو) بتغليب الخير فى أصول الإنسان البيولوجية (الشبغريزيةInstinctoid)، إلا أن لغتهم الأقرب إلى “الشعر الحالم” لم تدعم نظرية الغرائز بقدر ما غـَـيّـمت الجو حولها، الأمر الذى تفاقم أكثر فأكثر من جراء النظريات البعشخصية والعبرشخصية Transpersonal مما أفضّل أن أسميه “علم النفس التجاوزى”، ذلك أن هذه النظريات أفرطت فى التجاوزية الغائية حتى كادت تنفصل عن جذورها البيولوجية الغريزية.
إن مواقف اتجاهات علم النفس المعاصر، فى أغلبها، لم تدعم نظرية الغرائز بقدر ما حطت من قدرها أو أهملتها، وحتى غريزة الجنس (وهى أظهر وألمع من العدوان كما هى، وكما قدمها فرويد)، لم تأخذ حقها فى الاستيعاب البيولوجى/الوجودى المناسب، بل لعل بعض المشتغلين بالتحليل النفسى قد أساء إليها، وأضاف إلى تشويهها، بل إن فرويد نفسه لم يعطها حقها على الرغم مما شاع عن فكره، بل جعل كبتها والتسامى فوقها (بما هو “أخلاق” أو حضارة) هو السبيل إلى التحكم فيها، ثم إنه بالغ فى عقلنتها (فيما هو نظرية) على حساب إحيائها باعتبارها لغة تواصل أرقى وأشمل، حتى ليمكن أن نأخذ قول “لـورنز” مأخذ الجد حين يقول… “إن تناول فرويد للعمليات الغريزية فى الإنسان كان مـُـحـَـمـَّـلا بثقل الشعور بالذات لدرجة خليقة بأن تكتفى بإعلان الميل الشبقى بعيدا عن “فعل” الحياة، لتطيح باحتمال أن يحقق الانسان براءته التلقائية وانبعاثه الخلاق بحق”، ثم يمضى لورنز فيقول “..إن نظرية التحليل النفسى قد أعــدت لتصيبنا بحالة من “الجنس فى الرأس”Sex in the head([9])(الدماغ)، ولا أحسب أن هذا هو المكان اللائق به”
الأرجح أن المبرر وراء كل هذه المحاولات لتهميش الغرائز هو مبرر أخلاقى على مستوى ما من لاشعور أغلب هؤلاء المفكرين، بمعنى أنهم تصوروا أن التسليم بوجود غريزة مسبقة (أية غريزة كانت) يبدو تقييدا لحركة تطور الإنسان بشكل أو بآخر، والنتيجة المنطقية، والاستسهالية لهذه المسلمة الخطأ هو أن ننكر دور الغريزة الإيجابى ابتداءً، أو على الأقل أن نتنكر له، متصورين أننا بذلك نفتح الآفاق، إذ يحدونا الأمل أن يحل التغير البيئى والتطور الثقافى محل التغيير البيولوجى (من وجهة نظرهم)، وقد دعم هذا المبرر الأخلاقى موقف الدارونيين المحدثين من علماء الوراثة الأقدم (فايتسمان ومندل أساسا) بتأكيدهم على استحالة وراثة العادات المكتسبة.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الغرائز مثلها مثل أى حقيقة صعبة، لا تختفى بالإجماع على تخطيها أو الخوف منها، أو نتيجة العجز عن تفسير مظاهرها السلوكية فى الوجود الانسانى المعـقـد، فكـان لابـد من إعادة النظـر فيها من مـدخل آخر، ومن عـجب أن يكون هذا المـدخل الجديـد هو من علم الإثـولوجى Ethology وبواسطة علماء الحـيوان Zoologists أسـاسا. وقد كـان لإسـهام لـورنزLorenz وتينـبرجـن Tenbergen ([10]) فى دراسـة ظـواهـر مـثـل البـصـم Imprinting والــطـاقة الخـاصة الفـعـالة Action Specific Energy وإزاحة النشاط Activity Displacement. كان لكل ذلك أكبر الأثر فى فتح ملفات نظرية الغرائز بشجاعة مضاعفة، وكذلك إعادة النظر فى آراء الدارونيين المحدثين. وخاصة بعد تلاحق الأبحاث المهتمة بالتأكيد على إمكان وراثة العادات المكتسبة.
العدوان غريزة أم اكتساب:
يؤيد لورنز الرأى القائل بأن العدوان دافع أولى (غريزة) ويؤيده فى ذلك تينبرجن برغم اختلافهما فى تفاصيل أخرى: إذ يقول الأخير عن الأول معترضا جزئيا “… إن لورنز يفترض أن العدوان هو دافع أولى موروث، وإنه مثله مثل الدوافع الأولية- فى تصوره- يسعى إلى الإطلاق والإشباع”.
ويعارض مونتاجو فى مناقشته مقولة تينبرجن منكرا أن يكون العدوان غريزة ويعدد إثباتا لرأيه هذا أجناسا وقبائل مثل الإسكيمو([11]) والأستراليين البدائيين الذين لا يحارب بعضهم بعضا، وينتهى بالتساؤل التقريرى قائلا “ألا يجوز أن الرغبة فى القتال هى شكل من أشكال السلوك المكتسبة”([12]).
ولا سبيل إلى الفصل فى هذا الموقف دون التعرض للموقف الأخلاقى السابق الذكر الذى يبرر الهجوم على نظرية الغرائز عامة، ونظرية العدوان كغريزة بشكل أكثر تحديدا، ليبدو الإنسان بعيدا عن التوحش.
ثمة محاولات للخروج من المأزق من خلال تبنى منظور أن الغرائز -تطوريا على الأقل – هى سلوك سبق طبعه imprinted عبر تاريخ تطور الحياة. حتى على فرض أنه كان مكتسبا فى يوم من الأيام، فقد أصبح بلغة علمية حديثة: غريزة تُوَرّث، ذلك لأن التعلم بالبصم (غير التعلم الشرطي) يختص بالسلوك اللازم للبقاء فى مرحلة ما، وقد كان السلوك العدوانى من ألزم أنواع السلوك اللازم للبقاء فى معظم مراحل التاريخ الحيوى.
حتى باعتبار ما ذهب إليه إريك فروم([13]) معتمدا على آخرين فى أن العدوان قد اكتسب اكتسابا لاحقا فى العصر الحجرى الحديث مع تغير الإنسان من كائن صائد جامع إلى كائن منتج خازن مع بداية الزراعة (حوالى تسعين قرنا قبل الميلاد) فإن مرور آلاف السنين، ومتطلبات الوضع الجديد للإنسان كمنتج منافس لا يمكن أن نعتبرها مجرد اكتساب مؤقت، وبدءا من حدس هربرت سبنسر([14]) القائل “إن عادات اليوم هى غرائز المستقبل” حتى دراسات علم الوراثة الأحدث تتزايد الحقائق الدالة على ربط المكتسب بالغريزى، وخاصة فيما يتعلق بالبقاء والتطور.
لكل ذلك لا ينبغى أن نكتفى بالتلويح بموقف أخلاقى سطحى لمجرد رغبتنا أن نتميز عن الحيوانات التى نصفها بالتوحش دون الإنسان، بل إن الاعتراف بهذا الأصل التكوينى يدفعنا إلى البحث الأمين فى تصور فائدة هذه الغريزة ليس فقط فى تاريخها الحيواني، وإنما فى تجلياتها البشرية، مع العلم بأن ما نصفه بالحيوانية لا ينبغى أن يكون بمثابة الوشم بالدونية أو النكوصية كما يلمح وليام كورنينج متسائلا: “..وما هو النفع المنتظر إذا كان تحت السطح، رائحة بيولوجية كريهة”([15]) وإنما علينا أن نتذكر أن إنكار الحقائق ادعاءً أو استسهالا يزيد من عجزنا عن التحكم فى الجانب السلبى منها، أو بتعبير أدق: يزيد فى احتمال توظيفها توظيفا سلبيا ضد النوع و ضد الحياة.
تقييم وظيفة العدوان إيجابيا وفرص التعبير عنه:
1- إن العدوان قد حفظ أجناسا([16]) بأكملها فى صراعها ضد أجناس أخري، وذلك فى إطار قانون “البقاء للأقوى”.
2- إن سيطرة الذكر الأقوى على قطيع الإناث واستبعاد الذكر الأضعف قد ضمن البقاء للسلالة الأقوى، نتيجة استبعاد الذكر الأضعف من القطيع بالعدوان الذى ينتهى بالقتل أو بالطرد أو بالإذعان.
3- إن العدوان يعتبر جزءا متضمنا فى كل الوسائل المسئولة عن الحياة، بل وعن تطويرها.
4- إن العدوان يحدد معالم الذات: فالذات إذ تنفصل عن الآخرين فى الولادة النفسية، فى المراهقة خاصة، وفى كل أزمات النمو عامة، إنما تحقق ذلك حين يضطر “الفرد” أن يدفع “الآخر” فى عملية الانسلاخ منه، تحديدا لذاته الخاصة، الأمر الذى يتبعه بعد ذلك جدل الآخر الموضوعى من خلال تحمل الاختلاف وبرنامج الدخول والخروج، هذا، وقد ذهب الكاتب فى دراسة سابقة([17]) إلى تقرير يقول: “إذا كان الحيوان يحافظ على وجوده ككيان فيزيائى بالعدوان، فإن الإنسان يحافظ على وجوده ككيان مستقل واع (أى يحافظ على فرديته) بالعدوان كذلك، وفى حين يستعمل الحيوان عدوانيته ضد احتمال افتراسه (ولافتراس الآخرين) فإن الإنسان يستعمل عدوانيته (دفاعا) ضد احتمال سحق ذاته وسط الآخرين”.
كل هذه الجوانب المهمة فى وظيفة العدوان لابد أن تؤكد ضرورة إعادة النظر، فيما ذهب إليه فرويد (على الأقل فى بداية تنظيره) مما شجع على فروض استقطاب الجنس فى مقابل العدوانية، باعتبار الجنس هو التعبير عن التواصل المتبادل فى حين أن العدوان Aggression هو مرادف للتحطيم Destructiveness لدرجة جعلت فرويد يرادف بعد ذلك بين العدوان (التحطيم) Aggressiveness وبين ما أسماه بعد ذلك: ”غريزة الموت” Thanatos ([18]).
تطور توجـّـه غريزة العدوان فى السلوك الإنسانى المعاصر:
إذا قبلنا فكرة أن العدوان هو غريزة بهذه القوة، وأنها ضرورية للحفاظ على الحياة والذات كخطوة سابقة لـ (ومتبادلة مع) غريزة الجنس وليست نقيضا له كما صورها فرويد فى المقابلة فى أواسط أعماله متبعا النظرة الاستقطابية التى غمرت فكره حينذاك، فما هى المظاهر المعاصرة الإيجابية المباشرة والمحــورة التى تظهر فيها غريزة العدوان بالمقارنة بغريزة الجنس؟
لقد نالت غريزة الجنس من الانتباه والدراسة ما جعلها تبدو وكأنها تمثل الغرائز جميعا، فضلا عن أنها كانت وما زالت محورا يدور حوله تنظير التحليل النفسى وتطبيقاته، وأيضا نظرا لطبيعة الجنس اللذية فى معظم الأحيان: كانت فرص التعبير المباشر وغير المباشر عن هذه الغريزة متواترة ومتنوعة، خصوصا إذا قورنت بفرص التعبير عن غريزة سيئة السمعة مثل العدوان. خذ مثلا بعض الأمثلة:
1- الجنس يجد مخرجا شرعيا ودينيا مباشرا فى الزواج (قبل وبعد فرويد).
2- الجنس يجد مخرجا اجتماعيا (ومدنيا أحيانا) فى صورة العلاقات التلقائية: في، وقبل، وخارج منظمات الأسرة فى كثير من المجتمعات شديدة البدائية وفى المجتمعات المتقدمة “جداً” على حد سواء.
3- الحديث عن الميل الجنسى بما يحمل من فرص التنفيث والإرضاء الجزئى يعتبر حديثا مقبولا ومحببا وأحيانا فخرا وزهوا (للرجال على الأقل)، وذلك فى الإطار والمجال الذى يحدده كل فرد لنفسه، فمن المألوف السهل أن يتحدث الرجل عن رغبته الجنسية سواء تحققت أم لم تتحقق، أو حتى عن قدرته الجنسية، ولدرجة أقل تفعل المرأة نفس الشئ ولو مع قريناتها فى بعضالمجتمعات.
4- الجنس له حضور كاف، وأحيانا غالب فى صورته الصريحة أو المحورة، فى كثير من الأعمال الأدبية والفنية وحتى فى بعض مظاهر التدين (العشق الإلهى والغزل فى الأنبياء والأولياء… الخ).
5- يصاحب ذلك، أو لعله نتيجة له أن الجنس قد يجد بسهولة مخرجا مناسبا ومتواترا فى الخيالات والأحلام على حد سواء.
والآن هل للعدوان نفس الفرص للتعبير المباشر أو غير المباشر؟
الإجابة بالنفى، و بعض تفصيل ذلك:
1- إنه لا توجد صورة اجتماعية أو شرعية يمارس فيها الإنسان المعاصرعدوانه بشكل مباشر ومعترف به، اللهم إلا فى بعض أنواع الرياضة البدنية الالتحامية (فى المصارعة والملاكمة مثلا) التى يثار ضدها هذه الأيام اعتراضات متزايدة، ثم إنها ليست ممارسة شائعة أصلا يمكن أن نزعم أنها مجال عام يصلح لاستيعاب العدوان عند كل الناس.
2- لا يوجد أى تقدير أو تقبل طبيعى يسمح للفرد بالحديث عن رغباته العدوانية أوميوله العدوانية ، بغض النظر عما إذا كانت هذه الرغبات قابلة للتنفيذ أم لا (فى حين أن ذلك مقبول بالنسبة للجنس بترحيب خاص - من الرجال أكثر- كما ذكرنا).
3- لا توجد صور أدبية أو فنية تـُعلى من قدر العدوان، اللهم إلا صور البطولة (والفـَـتـْـوَنـَـة) التى تعلى من قدر عدوانية فوقية من الجانب المسيطر دون التابع.
4- يبدو أن كل هذا القهر والكبت الساحقين قد أثـّرا حتى على الأحلام والخيالات، فمن واقع خبرتى الكلينيكية، نجد أن حكايات المرضى عن أحلام (أو خيالات) القتل أو حتى القتال، هى أكثر ندرة من أحلام المطاردة والاضطهاد وكذا من أحلام الجنس والتعاطف مثلا.
صور العدوان البديل (مكافئات العدوان).
إذا كانت غريزة العدوان بصورتها الصريحة لا تجد الفرصة الإيجابية للتعبير عن نفسها بشكل مباشر مقبول فى الحياة العادية، فهل يوجد شكل غير مباشر يمكن أن يحقق التعبير عن غريزة العدوان بأى صورة محورة؟
بالنظرة الأعمق يمكن أن نستنتج خطوطا عامة تبدو وكأنها تؤدى هذا الغرض، ومنها:
1- التنافس الدراسى والأكاديمي. كما يرى كل من انتونى ستور Storr وألفرد أدلر.([19])
2- التنافس الرياضى: الذى يظهر بشكل مباشر فى الرياضات الالتحامية فى المصارعة والملاكمة كما هو متضمن بشكل غير مباشر فى معظم الرياضيات التنافسية).
3- السيطرة الطبقية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع تذكر أن السيطرة الطبقية قد أصبحت مؤخرا تتم فى الخفاء وبأساليب سرية مغلقة، أو بشعارات أخلاقية أو دينية أو أيديولوجية أو ملتبسة، وهى وسيلة القلة على كل حال.
عموما فقد اتجهت التربية الحديثة، ومحاولات المساواة الممكنة وغير الممكنة إلى تغيير القيم إزاء فكرة التنافس أصلا، حتى كاد التنافس أن يصبح غير كاف لامتصاص طاقة العدوان، فضلا عن احتمال الضرر من الإفراط فى تقديسه، فالتنافس الرياضى مثلا لا يشمل إلا نسبة ضئيلة من الناس، ثم هو يحاط بالترويض المستمر للعدوان المغلف به فى شكل تنمية ما يسمى بالروح الرياضية، ولا يشارك عامة الناس فى إطلاق غريزة العدوان التنافسية اللهم إلا بتقمص المتنافسين مشاهدة من الوضع جلوسا مصفقين على أحسن الفروض(!!) وهذا غير كاف. فضلا عن احتمال الخداع والتشويه.
إذن: فالأمر يبدو وكأنه لا توجد فعلا فى عالمنا المعاصر أية فرصة حقيقية لإطلاق غريزة العدوان ولا للتنفيس عنها أو حتى لمجرد الاعتراف بها على مستوى الجموع.
وكأننا يمكننا إعلان أن درجة الكبت والمنع والإنكار لغريزة العدوان قد وصلت -بإجماع تقريبا- إلى أضعاف ما أزعج فرويد بالنسبة لغريزة الجنس وآثار كبتها.
وإذا كان ما لحق من كبت لغريزة الجنس: تظهر آثاره السلبية أساسا فى مجال المرض النفسى المسمى “العصاب”، كما يقول فرويد، فإن آثار كبت غريزة العدوان تظهر فى مجال الأمراض الأخطر، الأمراض الذهانية خاصة، ثم هو يتعدى الخطر على الفرد إلى ما هو أخطر على الجماعة والمجتمع.
نتائج كبت العدوان:
يمكن استقصاء بعض جوانب النتيجة الطبيعية لكبت العدوان كما يلى:
أولا: تراكمت هذه الغريزة كطاقة مقهورة تستنزف الطاقة البشرية فى محاولة إبقائها فى حالة كامنة خفية.
ثانيا: استعار العدوان مظاهر غرائز أخرى للتعبير عن نفسه كالتالى (كأمثلة):
(أ) غريزة الجنس: فى بعض الأحيان يختلط الجنس بالعدوان، ليس فقط بمعنى السادية، وإنما أصبح السلوك الجنسى فى بعض الأحيان تعبيرا عن العدوان، رغم مظهره الجنسى (حالات الاغتصاب المتزايدة، وحالات أخرى من الشذوذ مثل السادية).
(ب) غريزة الجوع: أحيانا لا يتوقف الالتهام عند الشبع (إرواء حاجة الجوع) بل يتمادى حتى ليعبر فى بعض الأحيان على نوع من العدوان على الذات والآخرين معا، مما يذكرنا ببعض أنواع الزواحف والعناكب، (وهو ما صوّرته فى إحدى قصائدى:)
الديوان الثانى”شظايا المرايا” قصيدة: “التهــــام”([20])
أخاف: ألتهمْ
حسبتُ أن الثــقبَ سوف يلتــــئــــــمْ.
أزاحــــم الرموز أنتقمْ.
تعلو جبالُ موج الرعـــــبِ والنَّــــهمْ.
فى بؤرةِ الظَـــــلاِم والعــــدمْ.
أدوس أشــــلاء الأجــــــنّةِ، أرتــــــطمْ.
تخَــثَّرَ الوعىُ المغـــلف بالغــــباء والنـــــدمْ،
تمزّقَ النغمْ.
23/7/1982
(جـ) غريزة التملك: ثمّ نوع من التملك يتزايد حتى يصبح عدوانا، مثل سلوك التخزين Hoarding (مع التذكرة بأن التخزين دافع أولى)، بما فى ذلك ما فيه من العدوان على الذات (تكاثرا مغتربا) وعلى الآخرين (حرمانا).
ثالثا: أُسقطت ظاهرة العدوان فى أشكال فنية أو شبه فنية فى شكل أفلام العنف والإجرام والكاراتيه، وقد تقوم هذه الأشكال بالسماح بالتقمص الذى قد يمتص طاقة العدوان عند المشاهد، أو هو يفجرها فى الخفاء عادة.
رابعاً: تزايدت وتنوعت الألعاب الإلكترونية الأحدث التى تبدو أنها تُستعمل كبديل لتفريغ طاقة العدوان بشكل أو بآخر.
مظاهر العدوان (الضار) الصريح
حين يفشل كبت العدوان أو استبداله أو إزاحته: يظهر صريحا فى صور متعددة، وقد يتخذ ذرائع تبريرية، كما قد يكون مباشرا تسلطيا ظالما، ومن أمثلة ذلك:
أولا: تتفجر العدوانية بين الحين والحين فى شكل حروب محلية أو عالمية، عادة غير مشروعة ولا مُبررة.
ثانيا: تتفجر الصراعات الطبقية، والعنصرية، بكل ما تحمل من حقد وانتقام واستغلال من كل جانب للآخر: الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى (باعتبار هذا الأخير هو الوجه السلبى لـعدوان “العبد على السيد” بالإذعان فى ديالكتيك هيجل).
ثالثا: قد يأخذ العدوان شكلا لفظيا مباشرا مثل الهجاء، والسخرية، والتنمر والأحكام الفوقية.
رابعا: تتعدد صور العدوان السلبى مثل العدوان بالإهمال أو بالتخلى (حتى ولو كان هذا التخلى تحت الشعار الأحدث: “أنت حر” مثلا) أو فى شكل “الرقة المتفرّجة” مما لا مجال لتفصيله هنا.
خامسا: هذا فضلا عن العدوان المباشر والمـُجـَرَّم فى صور جرائم العنف خاصة.
الأهمية البقائية للعدوان:
إذا كان العدوان بهذه القوة وهذا الإلحاح، فى نفس الوقت ليس له إلا أقل قدر من فرص التعبير الإيجابى والمسار البنـّاء، ثم كانت صوره المـُحـَوَّرة والخفية، وأيضا الصريحة العارية، هى من أخطر ما يمكن تصوره على مسيرة الإنسان عامة، فما هو الموقف المسئول تجاه كل هذا؟
تجليات العدوان ومحاولات احتوائه:
(1) توجه المهتمون بالأمر (من الإثولوجيين خاصة) إلى العودة إلى استلهام الحيوانات، نسألهم ماذا فعلوا هم وعجزنا عنه نحن بورطتنا المرعبة، ذلك أن العدوان بين نفس النوع Intraspecies هو أمر شديد الخطر على نوع بذاته، بحيث حاولت أغلب الحيوانات تحقيق غايتها دون ممارسته الى نهايته، أى دون القتل، وقد أثار إريك فروم([21]) تساؤلا مزعجا يقول: هل الإنسان نوع واحد؟ حيث عرض احتمال أنه نظرا لاختلاف اللغات والألوان والأوطان، فإنه قد يكون استقبالنا لبعضنا البعض قد وصل إلى اعتبارنا أجناسا متعددة، لا جنسا واحدا كما أن تينبرجن([22]) شرح ذلك نصا فى قوله:
“..إن القاعدة أن كل الأنواع قد نجحت فى تحقيق النصر دون أن يقتل أفرادها بعضهم بعضا، وفى الحقيقة أنه حتى مجرد إسالة الدماء يعتبر حدثا نادرا فيما بينها، والإنسان هو النوع الوحيد الذى يمارس القتل الجماعي، الوحيد ذو الوضع الناشز فى مجتمعه”.
إن الحيوانات قد حذقت فيما بين أفراد نوعها لعبة الإنذارات والتهديد (فيما يشبه الحرب الباردة) بدرجة أعفتها من القتال الفعلى أساسا، فضلا عن قتل أفرادها من نفس الجنس…، وقد درس علماء الحيوان وعلماء الإثولوجى هذه الإنذارات وتمنى بعضهم أن يحذق الإنسان مثل هذه الإنذارات وما يقابلها من علامات “الإذعان”، وأن يتعلم ترويض العدوان لإحلال التهديد محل القتل، حتى ضربوا مثلا سطحيا لذلك، وهو الضرب بقبضة اليد على المائدة بدلا من ضرب الخصم، وشبه بعضهم توجيه المسار هذا بعملية التسامى (أو الإعلاء) التى قال بها فرويد بالنسبة للجنس.
لكن الإعلاء والتسامى – أمل هؤلاء الباحثين- لا يمكن أن يـُـقبل إلا كمرحلة من مراحل النمو، وحتى فرويد، الذى أعلى من شأن “التسامى” خصوصا بالنسبة لغريزة الجنس، قد هوجم بشدة لحماسه لتأييد هذا التوجه.
(2) بالغ البعض فى قيمة إعادة التعليم كحل ترويضى (حضارى) يستنكر العدوان ويـُـحل محله أساليب أخرى تبدو أكثر إنسانية ورقيا مما يليق بالإنسان، وإن كان هذا الحل يـَـعـِـدُ بترويض العدوان وإبداله، فإنه يتجاهل قيمته البقائية الأساسية. إن مثل هذا الحل الذى يقلبها حربا داخلية قد ينقلب إلى مظهر مرضى لبعض من الاضطرابات النفسية.
ومع التسامح تجاه هذه التمنيات الطيبة !!!، والحذر من أن ينقلب الإنسان على نفسه لمجرد الخوف من الاعتراف بالحقيقة، علينا أن نبحث فى كيفية احتواء الغرائز عامة ومسارها وأولها غريزة العدوان.
احتواء الغرائر ومسارها:
علينا ألا نمل من مواجهة هذين السؤالين:
أولا: ما هو الموقف الحالى تجاه غرائزنا البدائية التى كانت فى صورتها الفجة لازمة لحفظ البقاء الفردى والنوعى معا؟
ثانيا: كيف يتم احتواء مثل هذه الغرائز واستيعابها وتحويرها مع تطور الحياة والأحياء، وكيف يسهم الوعى بذلك كله فى توجيه المسيرة؟
أبدأ بوضع تصورى للإجابة على هذين السؤالين فى صورة الافتراضات الأساسية للمداخلة الحالية، على الوجه التالى:
1- إن الغريزة، باعتبارها سلوكا أوليا مطبوعا، ومن ثم موروثا للنوع كافة، وموروثا للفرد، مع بعض التفاصيل المختلفة بين الأفراد، هى تنظيم “خلوى نيورونى” قائم بذاته، كما أنه تنظيم قائم ضمن ارتباطات وتنظيمات أكبر فى نفس الوقت، وهو قابل للبسط unfolding بقدر ما هو قابل للتكامل integration فى الكل الأكبر.
2- إن لكل غريزة تعبير بدائى مباشر، كما أن لها فى نفس الوقت، من خلال ارتباطات تنظيمها الحيوى النيورونى والخلوي، تعبيرات محورة تخدم أيضا المستويات الأعلى من الوجود الحيوى للنوع أو الفرد على حد سواء.
3- إن الغريزة لا تظهر فى صورتها البدائية الأولية الفجة تماما إلا إذا انفصلت عن سائرالغرائز من ناحية، وكذلك إذا انفصلت عن سائر الوظائف الحيوية النفسية من ناحية أخرى.
4- يمر نمو الغريزة على مستوى تطور النوع والفرد معا فى خطوات متتالية تصاحب اتساع دائرتها وشمول ارتباطاتها، بما يشمل الوعى بها حتى فى صورتها البدائية، وبما يشمل القدرة على تأجيلها وتنظيمها.
5- تتعرض هذه الارتباطات الأشمل للتفكيك المرحلى فى الحلم، أو أزمات النمو، تمهيدا لولاف أعلى وأشمل، فهى لا تُمْحى أبدا بصورتها البدائية إلا فى مرحلة “التكامل القصوى” التى تعتبر هدفا مستمراً متجدداً فى تطور الإنسان الحالي.
6- يستمر نمو الغريزة وتتسع ترابطاتها حتى تصبح قادرة على الالتحام الولافى فى حركية التكامل الجدلى، سواء كان ذلك مع ما يبدو نقيضها، أو مع صور تجاوزاتها، أو مع الواقع المكتسب من تحويرها.
يمكن النظر فى غريزة العدوان وتنويعات مسارها كما يلى:
1- إن غريزة العدوان فى صورتها البدائية (القتل والالتهام) موجودة فى التركيب الحيوى ثم البشرى، وقتل الأكبر سنا (مثلا: الوالد) لتوفير الطعام وإعطاء فرصة للاستمرار الحيوى قد لا يحتاج(!!) بالتالى إلى تفسيرات درامية ذكرياتية فرودية أوديبية تثبيتية خاصة.
2- إن وظيفة غريزة العدوان (البدائية) الرئيسية هى حفظ الحياة (الاستمرار الفيزيائى) وذلك بالقتل أساسا، أما وظيفتها الأرقى فهى السيطرة للتنظيم الطبقى التمييزى المرحلى، أو حسب ظروف الواقع.
3- إن التعبير المعاصر عن هذه الغريزة هو “تأكيد الذات” فى مواجهة الآخرين.
4- إن الميكانزم الإبدالى فى حالة عجز هذه الغريزة (النسبى أو المطلق) عن التعبير المباشر وغير المباشر هو التعويض التفوقى بالنجاح والمكسب والسيطرة والانتصار بكل صوره، ومثال ذلك ما يتم فى التنافس الرياضى إما على حساب الفريق الآخر، أو فى مواجهة الرقم القياسى السابق “كسر الرقم القياسى”.. (لاحظ تعبير “كسر”).
5- إن الكبت المفرط لغريزة العدوان إنما ينتج عنه استنفاذ طاقة أكبر لازمة لهذا الكبت بالإضافة إلى قمع طاقة العدوان ذاته، مما قد يترتب عنه توقف النمو، وفى بعض الأحيان يسبب ارتداد هذه الطاقة إلى الداخل فى شكل إعاقة ذات داخلية للأخرى، ثم احتمال تناثر الاثنين معا (فى الفصام مثلا)، هذا وبرغم دعم “لورنز” لفكرة فرويد عن وجود غريزة خاصة بالعدوان إلا أنه ذهب- كما نحاول التأكيد هنا- إلى أنها غريزة تحترم الحياة بشكل ما، فى حين ذهب فرويد إلى أنها أقرب إلى التحطيم والموت.
6- إن الإبداع الذى يستوعب الطاقة العدوانية هو الإبداع الخالقى الذى تتضمن إحدى مراحله تحطيم القديم إلى مكوناته وجزئياته لإعادة صياغته مع أجزاء كلّ آخر تم ( أو جارٍ) تحطيمه بدوره، ثم صناعة ولاف أعلى من كل ذلك، وهو ليس إبداعا تواصليا إبتداء (كما سيأتى).
7- إن التطور الأرقى لهذه الغريزة هو “الإبداع الخالقى” على مستوى عالم الواقع (وليس عالم الفن كبديل)، ويشمل ذلك الثورة الاجتماعية والسياسية الحقيقية (غير الدموية خاصة)، كما يشمل العديد من موجات التطور الثقافى بما فى ذلك ما يسمى الحداثة!!.
8- إن الهدف الأعلى هو الولاف بين النقائض ظاهريا (الجنس مع العدوان) ثم الولاف الأعلى فالأعلى (الوظائف الدوافعية مع الوظائف الترابطية تحقيقا للتكامل الأقصى)، وهذه المرحلة حاليا هى مرحلة نظرية حتى الآن فى أغلب الأحوال.
هذا الحل الصحى الذى يتم على مراحل: قد تناول مرحلته الوسطى ألفريد أدلر كما نوّهت قبلا، وذلك بالنسبة لحديثه عن الميل إلى السيطرة، وعما أسماه “التأكيد الذكرى“، وهى المرحلة المقابلة للتسامى بالنسبة لحل تطور غريزة الجنس، على أن هذا الحل وذاك - كما أشرنا قبلا- هما حلان إبداليان.
فى الأطروحة الحالية سوف أركز على الإبداع الخالقى أكثر من الإبداع التواصلى لأنه هو الذى يستوعب العدوان أساسا، على الرغم من أن فصل نوعـَىْ الإبداع عن بعضهما هو فصل تعسفى لأن علاقتهما جد وثيقة، حيث أن الغريزتين (الجنس والعدوان) فى هذه المرحلة الأعلى من النشاط: تقتربان من بعضها البعض فى الإعداد للولاف الأعلى من خلال تلاحم تناقضهما الظاهرى.
وعلى الرغم من هذا التقارب الحتمى، فإن تمييزا بين نوعى الإبداع قد يكون مفيدا للتوضيح، مع الاعتراف ابتداء بأنه تفسير صعب بشكل أو بآخر.
إن الإبداع الخالقى يحتوى العدوان كما يلى:
1- تحطيم القديم فى مغامرة فردية صعبة تتصل بعامل الأصالة وتأكيد الذات أساسا.
2- إعادة خلق الجديد من جزيئات القديم المحطم، بما يشمل المخاطرة بالوحدة والرفض.
3- يتم هذا التحطيم وإعادة البناء عادة فى البداية وظاهر الأمر، على حساب الآخرين ذلك أنه يهزهم ويقلقل استقرارهم ويشكك فى رؤيتهم ويهدد سكينتهم ويلوّح بضرورة إعادة النظر.
4- يلاقى المبدع من جراء إبداعه الخلّاق من الرفض والنبذ والقسوة والاضطهاد ما يجعله فى معركة للاستمرار وتأكيد الذات.
5- يقاوم المبدع بكل حركيته وهو يعايش الوحدة والإصرار والاستمرار معا، مما يحتاج إلى كل طاقة الرفض المسئول والتجديد المغامر فى مواجهة الأغلبية السائدة والرأى الثابت (الآخرين)([23]). وبديهى أن هذه الوحدة ليست عزلة بقدر ما هى مواجهة تحمل فى طياتها فرصة أن تصب فى النهاية فى تجديد تشكيل العلاقات والنمط السائد (حتى ما يسمى “الثورة”).
تشكيلات ومجالات الإبداع الخالقى:
لابد من توضيح أن ما أعنيه بالإبداع الخالقى لا يقتصر على الإنتاج الإبداعى فى مجال الفن أو الأدب خاصة، وإنما هو أعمق وأشمل، فهو يسعى –ضمنا- إلى تحريك:
أ- المتلقى الناقد المبدع الذى يعيد صياغة ما يتلقى بنفس القدر من الهجوم، فإعادة الصياغة.
ب- التغيير الذاتى الإبداعى المشتمل على مغامرة طرق باب المجهول ثم إلى الجديد حتما إلى مرحلة نمو مختلفة نوعيا.
جـ – الإنشاء العلمى أو الأدبى أو الفنى الإبداعى المغيــّــر.
د- الموقف الإبداعى الحياتى المتجدد للذات وللمحيط الأقرب لنقلة مميزة فى النمو.
هـ- الثورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحقيقية المغيـّرة والمسئولة.
وكل ذلك بلا استثناء بما فيه من تحطيم القديم وتحدِّيه، ومن صناعة الجديد ومخاطره، يتفق مع المعالم الأولية لوظيفة غريزة العدوان الإيجابية كما أوضحناها.
أما الإبداع التواصلى فقد يكون مرحلة سابقة أو تالية أو بديلة عن الإبداع الخالقى، (وهو ليس بعيدا عنه أو مناقضا له) فالتواصل مع الآخر (وليس مواجهته واحتمال تفكيكه، فالاقتحام) هو الأصل فى هذا النوع من الإبداع التواصلى، حيث يثابر المبدع ويستمر حتى يثير التنظيم المقابل الجديد فى المتلقى.
ويتميز هذا النوع “التواصلى” من الإبداع بما يلى:
1- لا يلزم تحطيم القديم تماما، وقد يكتفى بتحسينه حتى القبول.
2- ولا يشترط إعادة خلق جديد من جزئيات قديمة بقدر ما يشترط تناسق الجزئيات القادرة على التناغم مع نفس المستوى عند المتلقى.
3- ولا تتم غالبا هذه العملية على حساب (وفى مواجهة) الآخر – كخطوة حتمية- وإنما تتم لحساب، وسعيا إلى الآخر منذ البداية.
4- ولا يعانى مثل هذا المبدع رفضا وتهديدا حتميين، وإنما عادة ما يجد تقبلا واستحسانا من البداية.
5- والمبدع هنا لا يؤكد وحدته بنفس الحدّة المطلقة – كخطوة أيضا- وإنما هو يأتنس بمن يتحدث – ويتلقى – على نفس موجته بشكل نسبى على الأقل، ومنذ البداية أيضا.
وقد يكون الإبداع التواصلى أقرب شئ إلى الفن الموهبة وهو فن تنمية القدرات الفنية الخاصة، وبالتالى فهو يشمل أغلب الإنتاج الفنى والأدبى بصوره المتميزة والمألوفة، دون الوصول إلى القفزات الطفرية التى تغير مسار صوره وأشكاله، بل ومسار الحياة برمتها وقد اقتطف سيلفانو أريتى([24]) فى كتابه “الإبداع” رأى ناثانيل هرش فى كتابه الذكاء الخلاق حيث فرق بين “الموهوب” و”المبدع الخلاق” الذى أسماه “العبقري” تفرقة هامة تختلط على الكثيرين حتى كاد يعتبرهما نقيضين:
وفيما يلى التفرقة التى قدمها أريتى:
- “ففى حين أن الموهوب Talented يحسن الأداء فإن العبقرى يصنع الجديد،
- والموهوب يتقن التحليل الجزئى فى حين أن العبقرى يعتمد على حدسه،
- والموهوب يتكيف ويحقق المكاسب فى حين أن العبقرى يعطى حياته كلها لهدف الخلق الإبداعى”.
هذه التفرقة رغم فائدتها ووجاهتها، ورغم موافقتى عليها من حيث المبدأ، إلا أنها تكاد تدعم الاستقطاب، وهو ما لا أوافق عليه، وما يهمنى هنا هو أن هذا النوع من الإبداع التواصلى ليس بديلا عن الجنس (وإلا كان الأولى أن يسمى تساميا) ولكنه منطلــق من الجنس ويحتويه.
كذلك فإن الإبداع الخالقى ليس بديلا عن العدوان ولكنه منطلق من العدوان ويحتويه محققا لوظيفته الأصلية فى أرقى مراحل تطوره دون، أو قبل، الاندماج فى الولاف التكاملى الجديد.
هامش عن الذكورة والأنوثة والإبداع والعدوان
من الصعب أن ينتهى هذا العرض المحمل بالثقل البيولوجى دون أن نواجه تحديا صريحا صادرا من نتائج الأبحاث المتعلقة بالسلوك العدوانى وما لوحظ من مصاحباته من ارتفاع فى نسبة هرمون الذكورة (التستسترون)Testosterone فى الدم، فقد ثبت أن مستوى هرمون التستسترون فى الدم يتناسب تناسبا طرديا مع السلوك العدوانى فى عديد من حيوانات التجارب حتى أصبحت هذه المشاهدة من الحقائق العلمية التى لاجدال فيها، وقد فسرها بعضهم تفسيرا تطوريا يشير إلى أن الذكر الأقوى عدوانا هو الأقدر جنسيا، وبالتالى فهو الأضمن للتناسل وتأكيد قوى النسل القادم، ومن ثمَّ حفظ النوع غير أن هذا التفسير الاجتهادى لم يقنع الكثيرين.
ذهب آخرون إلى التعمق فى دراسة شكل هذه العلاقة وارتباطاتها “كسبب ونتيجة” وقد وجدوا أن إثارة السلوك العدوانى فى ذاته يضاعف مستوى هذا الهرمون الذكرى فى الدم صعودا إلى خمسة أضعاف، مما جعل احتمال أن تكون هذه الزيادة هى نتيجة للسلوك العدوانى وليست سببا له.
ومع احتمال صدق هذه التفاسير من زاوية بذاتها، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الإيضاح الذى يمكن أن نتناوله من منطلقين كالتالى:
أولا: إن السلوك العدوانى ليس مرادفا لغريزة العدوان ولكنه أحد تجلياتها، وهو الشكل الظاهر لها، أما الغريزة نفسها فقد يكون لها تجليات أخرى غير السلوك المعروف بالعدوانية، وأيضا قد يكون لما أسميناه العدوان الإيجابى ارتباطات بيوكيمائية أخرى غير السلوك العدوانى الضار المتعارف عليه لمثل هذه الدراسات.
ثانيا: إن السلوك العدوانى عند الرجل (الذكر) انبعاثى ظاهر يتعلق ببقاء الفرد أساسا ثم النوع، أما السلوك العدوانى عند الأنثى (المرأة) فهو احتوائى ملتهم أساسا يتعلق ببقاء النوع أصلا باعتبار أن الذكر يقوم بالدفاع الأول، ويمكن أن تَدعم ذلك مراجعتنا لظهور أقسى أنواع السلوك العدوانى عند الإناث (القطة مثلا) عند تهديد أطفالها حديثى الولادة بوجه خاص، أى أن الحفاظ على النوع (أطفالها) يثير لديها العدوان الصريح مباشرة.
وعلى نفس القياس يمكن تصور الفرق بين إبداع الرجل وإبداع المرأة، الأمر الذى أشرت إليه فى دراسة سابقة ([25]). حيث أكدت على اختلاف المرأة عن الرجل اختلاف بداية وليس اختلاف هدف أو غاية وجود، كما أوضحت أن عجز التاريخ عن أن يرصد للمرأة تفوقا أو مساواة فى الإبداع مع الرجل لايمكن أن يفسره القهر الاجتماعى والاقتصادى الذى لحق بالمرأة فحسب، وإنما التفسير الذى طرحته هناك كان يتعلق بأن إبداع المرأة وقيامها بالدور الأهم فى الإنجاب: لم يحسب لها فلم يوضع فى الاعتبار أصلا، لأنه لم يكن فى بؤرة الانتباه ، مع أنه إبداع حيوى أساسىّ، فهو: إبداع الإسهام فى التطور: “إفرازا للحياة وليس بديلا عنها”، ثم يأتى إبداعها بالرموز والعلامات بعد ذلك نتاجا طبيعيا لتكاملها وليس بديلا انشقاقيا عن التكامل، كما يحدث للرجل فى بداية الأمر، وهذا يتفق مع مقولة وينيكوت([26]) التى كانت أحد الأسس التى بـَـنـَـت عليها ذلك الفرض، وهى:
…. أن الرجل “فاعل”-ابتداءً- “ليكون” “to do ==> to be”،
أما المرأة فهى “كائنة – أصلاً – لتفعل” To be ==> to do.“
كما أن هرمون التستسترون لا يصح أن يعتبر هرمونا ذكوريا مجردا، فهو موجود فى الإناث من إفراز قشرة الغدة فوق الكلوية، كما أنه قد ثبت أن نسبته فى الإناث مسئولة مباشرة عن كفاءة الحياة الجنسية لدى المرأة، كما أن له وظيفة بنائية أيضية (ميتابوليزمية metabolic) كذلك.
وهكذا نعود لنؤكد أن دراسة الجذور الغريزية والبيولوجية للعدوان وتطوره ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار كل مظاهر السلوك على سائر المستويات، الأدنى فالأرقي.
كما نؤكد مرة ثانية أن الفروق بين الجنسين هى فروق بيولوجية دالة، ولكنها فروق بداية مـَسـيـَرةْ وليست فروق غاية ومصير.
تطبيقات باكرة ومتابعات:
1- لاحظت أن بعض الأمراض النفسية، الدورية خاصة الطيف الفصامى (أخطر إبداع مرضى) تتناوب مع الإبداع الخالقى بوجه خاص، بمعنى أن هؤلاء المرضى إذا أبدعوا فى فترات الإفاقة تميـَّـزّ إبداعهم بالأصالة والاقتحام وجرعة أكبر من الغرابة، كما لاحظتُ نفس الملاحظة ولكن بدرجة أقل بالنسبة لحالات صـَـرْعية معينة (والتاريخ يشير لمثل هذا التبادل أيضا فى حالة ديستويفسكى ونيتشة مثلا). مما جعلنى أفكر فى التكافؤ الوظيفى العكسى وراء هذا التبادل، وأبحث عن البديل الثالث فى الفترات الخالية من الصورتين، وكان هذا البديل الثالث هو العدوان المباشر بصور مختلفة([27]).
2- فى العلاج الجمعى كانت صور التعبير عن العدوان بمختلف أشكاله فى جو من “سماح” مسئول: ينفى احتمال السادية الانشقاقية، وكان مما يصاحب هذه النقلة -أحيانا- علامات بداية الولادة لإعادة الخلق الذاتى من جديد، مع اختفاء الأعراض([28]). هذا مع التذكرة بأن تحريك العدوان في أزمات النمو، ليس مرادفا للسلوك العدوانى دفاعا أو هجوماً.
3-فى علاج بعض حالات اضطراب نمط الشخصية (وخاصة الشيزيدى منها، النوع الرقيق الحساس بوجه خاص) كان ما يتفجر من وراء هذه الرقة بعد المرور “بالمأزق العلاجى” Therapeutic Impasse فى العلاج الجمعى خاصة هو طاقة عدوانية وافرة لا يفسرها إلا التغير الذاتى الجوهرى أو الطاقة الثائرة المسئولة بما نعنيه بالإبداع الخلاّق([29]).
4- أثناء الإشراف على عدد من الرسائل الجامعية المتضمنة لخطوات تتطلب الحسم بالرأى الشخصى بمعنى الترجيح الإبداعى لتفسير جديد، أو لطرح الفروض، من خلال معايشة فينومنولوجية ذاتية، كان المعوّق الأول للباحث هو العجز عن العدوان، وبتعميق أكثر أو بتعبير أدق: الخوف من العدوان، وكان تدريبى لطلبتى لتخطى هذه الخطوة هو الممارسة لعبور هذا الخوف، وكان الباب الذى ينفتح بالممارسة ليدخل منه التفكير الخلاق بعد المناقشة المغامرة المسئولة يتضمن رعبا من الحسم: ثم انتصارا مقداما بما يشبه العدوان.
5- فى خبرتى الشخصية كان أهم ما ساعدنى على اتخاذ موقف نقدى مغامر من أية مقولة أو بحث أو معلومة مطبوعة أو شائعة مسلم بها مهما كان مصدرها أو قائلها هو اجتيازى مرحلة الخوف من العدوان، إلى مرحلة التمكن من العدوان، وطمأنينتى للقدرة على ممارسته بسيطرة مناسبة على حساب القديم لصالح الجديد والآخر فى آن واحد، وأعتقد أن مما ساعد على ذلك مباشرة هى التجربة الخبراتية من خلال ممارسة علاجية طويلة فى مجال نوع العلاج الجمعى الذى أمارسه، والذى قمت فيه ومن خلاله بأبحاث متنوعة([30]).
المتابعات النقدية (فى الأدب)
خلال العشر سنوات الأخيرة، صدرت لى أعمال نقدية متعددة، رحت أبحث فى طياتها عن بصمات هذه الدراسة عن العدوان والإبداع، فاكتشفت أننى لم أعرض لها صراحة بأى قدر من المباشرة، وفرحت أننى لم ألتزم بتحقيقها، بل لعلى نـَـحـَّيتها جانبا بعيدا عن ظاهر وعيى بشكل ما.
لكن ثمة ملاحظات جديرة بالإشارة فى بعض هذه الأعمال، لا بد وأن تدل على موقفي، بقدر ما تُنَبّه إلى تحديد يمنع الخلط المحتمل من جراء تداخل المستويات وغلبة المضامين الشائعة، وأورد بعض هذه الملاحظـات التى رصدتها من خلال هذه المراجعة:
1- إن غياب السلوك العدوانى من عمل ما، مثلما أوضحت مباشرة فى قراءتى لرواية “الأفيال” لفتحى غانم([31]) لا يستبعد زخم طاقة العدوان التى احتواها .. وقد وصلنى أن هذه الطاقة هى التى حركته فى إبداع هذا العمل ليتحقق هذا العمل المنتمى للإبداع الخلاق، بغض النظر عن خلو المضمون من صريح الفعل العدواني، كما أشرت فى النقد.
2- إن علاقة سمات الكاتب الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب العدوانى فيها، تكاد لا ترتبط مباشرة لا بنوع الإبداع (خالقى/ تواصلى)، ولا بقدرته على تضمين عمله بما هو سلوك عدوانى صريح، ففى حين بينت فى قراءتى لرباعيات نجيب سرور أن ثمة تناسبا طرديا بين عدوانيته (شخصيا) وبين جرعة الهجوم الحاد المتلاحق الوارد فى رباعياته هذه، أشرت- على الجانب الآخر- إلى قدرة نجيب محفوظ (فى ليالى ألف ليلة خاصة) على تحريك القتل الإيجابى والسلبى فى كل اتجاه، الأمر الذى يكاد يتناسب عكسيا مع دماثته شخصيا وسماحه.
3- ضبطت نفسى – شاعرا – متلبسا بوصف القتل بالفروسية🙁[32])
القتلُ فعلُ فارسٌ،
حتماً يموتُ إنْ ظَلَمْ،
لكن دسَّ السمِّ فى نبض الكلامْ
قتلٌ جبان
5- فيما يتعلق بحركية الإبداع فى علاقته بالعدوان ما يرتبط بإسهام هذا المـُـنـّـطـّلق فى تفسير وتقييم بعض ما يحيط قضية الحداثة كما تتداولتها الآراء نقدا: قبولا ورفضا:
ذلك أن الأعمال المتميزة حقيقة وفعلا، فيما يسمى الحداثة، هى التى تنتمى إلى هذا النوع الخالقى أكثر من غيرها، مع الاعتراف الأمين بأنه لا يوجد تصنيف سهل يعرف هذا النوع من الإبداع، وخاصة فى الشعر.([33]) ولكن هذا لا ينفى أن هذا النوع من الإبداع الخالقى الذى يكشف، ويقتحم، ويضيف، ويغامر بأشكال جديدة، ويخلق لغات ورؤى جديدة هو وارد فى أشكال أخرى، لا تنطبق عليها هذه التسمية -الحداثة- بشكل مميز (مثل ما ظهر فى دراستى لملحمة “الحرافيش” لمحفوظ)([34])
الخلاصة:
المأزق – المواجهة – المخرج – المأزق
المراجعة:
مع إعادة تحديث هذه الرؤية الباكرة (1980) وجبت مراجعة ما جاء فيها من خلال النظر فى المراحل اللاحقة.
المأزق:
التساؤل الذى راح يطرح نفسه بداهة يقول:
إذا كان الإبداع فعلا يوميا، يحدث تلقائيا مع الإيقاع الحيوى فى النوم الحالم (الحلم)، وبالتالى يصبح الشخص العادى مبدعا بالضرورة، وإذا كانت جدلية الجنون والإبداع – على مختلف مراحل العملية الإبداعية- هى الفصل الختامى فى أية عملية إبداعية، فما هى الحاجة إلى طاقة غريزية بكل هذا الدفق والدفع؟
المواجهة:
1- نعترف ابتداء بصعوبة – أو استحالة وضع العملية الإبداعية ذاتها تحت مجهر البحث العلمى – إذ كل ما هو متاح لنا هو: إما ناتجها، وإما مبدعها، هذا فضلا عن تناهى صغر الوحدة الزمنية التى تستغرقها المرحلة اللازمة لانبثاق الإبداع، إذ هى لحظة شديدة التكثيف شديدة القصر، وقد تكون هذه الحقيقة فى ذاتها هى التى تسمح وتبرر بتنوع المداخل إلى العملية الإبداعية، مع اختلاف الرؤى، الأمر الذى يؤدى إلى بعض ظاهر التباين.
2- لابد من التدقيق فى الأبجدية المستعملة فى تناول هذه القضية المكثفة المعقدة، فلا يجوز الخلط بين نبض الإبداع، الذى ينتمى إلى جذور العملية الإبداعية، وبين ناتج الإبداع علما أو أدبا أو تشكيلا، أو بين أى من ذلك وبين سمات المبدع ومواهبه وقدراته.
3- لابد أيضا من التمييز بين تناول طبيعة أصل الإبداع باعتباره أحد محاور الحياة لكل الناس (بل لكل الأحياء، بلا استثناء)، وبين تناولها فى حدود العمل المبدع ناتجا مـُـتـَـاحاً فى أى مجال من مجالات المعرفة علما أو أدبا أو تشكيلا.
4- لا مفر من تصنيف الإبداع المنتج ( رمزا أو عيانا) فى أشكال متعددة، متوازية أحيانا ، متبادلة أحيانا، مكثفة أحيانا، ومتصاعدة (هيراركية) كثيرا، فمنذ البدايات (فى دراسة العدوان والإبداع) فـَـرّقتُ بين الإبداع الخالقي، والإبداع التواصلى، وفى آخر ما نشر لى فى هذا الصدد ميزت بين الإبداع الفائق والإبداع البديل([35])، فضلا عن الإشارة للإبداع المجهض، ومحاولة تعرية الإبداع الزائف، وأهمية هذا التصنيف هى التأكيد على ضرورة التعامل مع كل نوع بجرعات مختلفة من التناول.
المَخرج:
وفى محاولة لتقديم موقف قد يستطيع الإلمام بأطراف القضية بدرجة تخفف قليلا أو كثيرا من التناقض الظاهر، اجتهدت فى محاولات للتأليف بين هذه المراحل على الوجه التالى:
استطعت أن أحدد أن دراسة الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع([36]) كانت تركز- كمنطلق- على أحقية الشخص العادى أن يكون مبدعا بالضرورة البيولوجية، سواء ظهر ذلك فى صورة الإبداع اليومى (الحلم: غير المحكى أكثر) أوالإبداع الحياتى (تطور الحياة وارتقاء النوع)، ثم ليكن الإبداع المنتج رمزا أو عيانا حاضراً فى شكل أحد صور الإبداع لا أكثر.
لكن دراسة العدوان الباكرة قد ركزت على دور طاقة العدوان فى تحطيم القديم واختراق الوعى والتقدم للآخر، ولا يظهر هذا أصرح ما يكون إلا فى نوع خاص من الإبداع المُنْتَج فعلا، وهو ما أسميته الإبداع الخالقي، وإن كان فى نفس الوقت هو دفع جوهرى فى سائر الأنواع.
ثم جاءت دراستى عن ”جدلية الجنون والإبداع”([37]) لتربط ما بين مرحلة التنشيط التلقائى، وكيفية المحافظة على ناتج هذا التنشيط بمحاولة توظيف السماح بحركية التنشيط أن تبقى فى الوعى أو قريبا منه، ثم التأليف من ذلك اقتحاما للوعى ثم إقداما نحو الآخر.
وعلى ذلك، نعود فنؤكد أن ثم فرقا ضروريا بين التنشيط البيولوجى العادى اللازم لحركية المعلومات التى لم تُتَمثل فى الكيان الكلى تمثلا كافيا، وهى العملية اليومية التى تحدث فى اعتمال المعلومات باستمرار، وخاصة أثناء النوم وخاصة مع نوم حركة العين السريعة REM النوم الحالم، بين كل ذلك، وبين التفكيك شبه الإرادى الغائى اللاحق والمُوَاكب، وخاصة تفكيك التركيب الجامد فى عملية إنتاج إبداع غائى أو إرادى بالتفكيك لإعادة التوليف.
وإذا كانت عملية التنشيط الأولى تنتمى إلى الإيقاعية البيولوجية أساسا، فإن عملية التحطيم والاقتحام تنتمى إلى إيجابية العدوان بدرجة مناسبة من الإرادة الغائية والوعى الفاعل النشط.
وبتعبير آخر:
إن الانتقال من مرحلة الإمكانية البيولوجية المتاحة (فى فعلى التعتعة والبسط/إيقاع)، لا تصبح ناتجا إبداعيا متميزا ومرصودا إلا إذا انتقلت إلى مرحلة الصياغة فى جرعة مكثفة مخترقة وكاشفة، وبإرادة حاسمة ووعى مسئول، وهذه المرحلة الأخيرة -مرة ثانية- هى التى تحتاج قدرا هائلا من الطاقة الملتحمة بالوعى والإرادة (وخاصة فيما أسميتـُـه الإبداع الخالقى أو الفائق) طاقة تكون قادرة على الحفاظ على جرعة التنشيط إلى غاية الإبداع المنتج.
وهكذا نرى أن طاقة العدوان إنما تسهم أساسا فى المساعدة على استيعاب التناثر (البيولوجى التلقائي)، ومن ثم الحيلولة دون العودة الساكنة التى تمحو تلقائيا كل ما يتيحه النبض الحيوى من حركية وتنشيط قادر على التمادى للخلق والإبداع .
وعلى ذلك يكون إسهام العدوان الإيجابى (فى الإبداع الخالقى بوجه خاص)، كما جاء فى هذا الفرض هو:
(1) العمل على تكثيف جرعة التنشيط
(أ) لاختراق طبقات الوعى الذاتى،
(ب) وتأكيد الوحدة والتميز عن الآخر،
(جـ) وتحمـّل التهديد بالفناء كأحد مخاطر عمق التغيير.
(2) ثم يرتبط دوره أيضا بالحفز لاختراق وعى المتلقى (وليس الاكتفاء بدغدغته).
(3) ثم إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الطاقة للحيلولة دون التناثر (كإبداع بديل مجهض أو سلبي، فى بعض صور الجنون والانسحاب والتجمد).
(4) وأخيرا فإنها (طاقة العدوان) تساعد على المثابرة لإكمال وصقل حركية الإبداع وتصعيدها إلى أن يتم الناتج الإبداعي، خاصة من النوع الفائق.
إن الدعوة إلى استيعاب العدوان فى حركية الإبداع لا يمكن أن تقتصر على تنمية المواهب، أو الحفز على الإنتاج الإبداعي، بقدر ما تشير، وتوصى بضرورة خلق محيط من الحرية والحركة والمحاولة فى كل مجالات الحياة تسمح باستيعاب هذه الطاقة فى مختلف أشكال، ومراحل، ومستويات الإبداع.
الخلاصة
من هذه المقدمة، فالمراجعة، نستطيع أن نخلص إلى ما يلى:
1- إن نظرية الغرائز – كما عرضت من خلال هذه الغريزة كمثال – بصورتها الجديدة من منطلق علم الإثولوجيا قد عادت لتأخذ حقها فى فهم سلوك الإنسان وتطوره.
2- إن التسليم بنظرية للغرائز يرتبط ارتباطا مباشرا بالتأكيد على إمكان وراثة العادات المكتسبة الغائرة ذات الدلالة التطورية (التعلم بالبصم) وبذلك لايصبح الأمر تسليما للغريزة وإنما انطلاقا منها.
3- إن غريزة العدوان أعمق وربما أقدم وأكثر خطورة من غريزة الجنس، ومع ذلك فهى لم تأخذ حقها فى الدراسة والبحث بالقدر المناسب.
4- إن الفرص المتاحة للتعبير عن العدوان فى حياتنا المعاصرة نادرة وخطيرة فى آن، بحيث تجعل إهمال دراسة هذه الغريزة خطرا أكثر تهديدا.
5- إن الصور المحورة للتعبير عن هذه الغريزة وتراكماتها شديدة الخطورة أيضا لافتقار الإنسان إلى الجهاز المناسب الصالح للتحكم فيها مباشرة.
6-إن إنكارها-أو إهمالها- هو استسهال خطر لا يتفق مع مسئوليات العلم والعلماء مهما كان التبرير مقنعا تحت وهم أى تحفظ أخلاقى أو حلم مثالي.
7- إن محاولة ترويض غريزة العدوان بالتعليم الشرطي، أو إبدالها بالإعلاء والتعويض السطحى بالنجاح والسيطرة هى وسائل مرحلية، إن نجحت فينبغى أن نؤكد على طبيعتها المرحلية وإلا أعاقت النمو فى النهاية.
8- إن التغافل عن حسابات غريزة العدوان وتأثيرها قد يكون مسئولا عن الحروب والتمييز الطبقى المعلن والخفى بين الأجناس والطبقات الاقتصادية والاجتماعية والأديان، الأمر الذى زادت مضاعفاته وتضخمت مخاطره وخاصة بعد انتشار أدوات الدمار الشامل، مما يهدد السلام البشرى، بل وبقاء النوع الإنسانى أصلا.
9- إن الحل المسئول يتطلب إعادة فهمنا لمراحل تطور الغرائز، غير الإبدال والتسامى دون إغفالهما، وذلك نتيجة لتآلفها مع وظائف أخرى، ومع بعضها البعض فى تصعيد مستمر.
10- إن الإبداع الخالقى بمواصفاته الفائقة وخطواته المميزة من تحطيم وإعادة صياغة، ثم ما يترتب على ذلك من نبذ واضطهاد وإصرار وتحد، هو أقرب الصور التى يمكن أن يتجلى فيها العدوان فى إبداع حضارى فائق.
11- إن إتاحة الفرصة لمثل هذا الإبداع الخالقى بجرعات متصاعدة ولأعداد متزايدة هى الوقاية الأولى من مخاطر الدمار الشامل أو الانقراض، تلك المخاطر التى تهدد وجود الإنسان فى مرحلته الحالية.
12- إن توظيف طاقة العدوان فى الإبداع – بكل أشكاله ومستوياته- لا يتناقض مع نظرية التنشيط الدورى لأبجدية الإبداع، ولا مع الجدلية الضرورية فى مواجهة نقيض الإبداع (الجنون السلبى التناثري).
13- إن ثم تعديلا قد أضيف فى هذه المرحلة من تطوّر فكر المؤلف، فقد عدل عن التركيز على دور طاقة العدوان فى تحطيم القديم وتفكيكيه – ما دام التنشيط الدورى يقوم بالتعتعة تلقائيا، وراح يركز على قدرة هذه الطاقة على الاقتحام، اقتحام طبقات الوعى للمبدع ذاته، واقتحام استاتيكية السكون، ثم اقتحام وعى المتلقى فضلا عن اقتحام جمود الواقع.
14- إن دراسة أنواع الإبداع من منظور بيولوجىّ الجذور، وظيفى المحتوى، غائى الدافع.. يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لبحوث تبنى على تفرقة جديدة تساهم فى مسار الإنسان وتكامله، ولاتركز على سماته وإتقاناته الطرفية.
جدول للمقارنة بين الجنس والعدوان: طبيعة ومسارا
|
|
الجنس |
العدوان |
|
الشكل البدائي |
الالتحام الجسدى المتداخل |
القتل (أو الالتهام) |
|
الوظيفة الأصل |
التناسل |
حفظ حياة الفرد |
|
الوظيفة الأرقى |
التواصل (العلاقة) |
تأكيد الذات (فى مواجهة الآخرين) النجاح |
|
التعبير المعاصر (الاحدث) |
الغرام |
التفوق |
|
الميكانزم الإبدالى |
التسامى |
(السيطرة) |
|
آثار الكبت المفرط
|
توقف النمو (اضطرابات الشخصية وخاصة اضطرابات سمات الشخصية) والمرض النفسى (وخاصة العصاب) |
توقف النمو (اضطرابات الشخصية وخاصة اضطرابات نمط الشخصية) والمرض النفسى (وخاصة الذهان وبالذات الفصام) |
|
التطور الخالقى الأرقى |
الإبداع التواصلى والولاف بين النقائض |
الإبداع الخالقى (أساسا) الولاف الأعمق بين النقائض الأصعب: |
جدول مقارنة بين الإبداع الخالقي
والإبداع التواصلى (دون فصل حاسم)
|
الابداع الخالقى (النابع x من العدوان أساسا) |
الإبداع التواصلي (النابع x من الجنس أساسا) |
|
1 – تحطيم القديم فى مغامرة جذرية صعبة |
1- لا يلزم تحطيم القديم، وقد يكتفى بتحسينه حتى القبول |
|
2- إعادة خلق الجديد من جزئيات القديم المـحـطـم بما يشمل المخاطرة بالوحدة والرفض. |
2- العملية الأساسية تهدف إلى تناسق الجزئيات القادرة على التناغم مع المستوى المقابل عند المتلقي. |
|
3- يتم هذا التحطيم وإعادة البناء عادة على حساب الآخرين- فى البداية وظاهر الأمر. |
3- تتم هذه العملية لحساب، وسعيا إلي، الآخر أساسا. |
|
4- يلاقى المبدع عادة من جراء إبداعه الخلاّق قدرا من الرفض والنبذ والقسوة والاضطهاد مما يجعله فى معركة حقيقية. |
4- عادة ما يجد المبدع تقبلا واستحسانا من البداية |
|
5- يقاوم المبدع كل هذا بالوحدة والإصرار والاستمرار، مما يحتاج إلى كل طاقة عدوانه الإيجابية تجاه الآخر، وهى وحدة تعبّر فى النهاية عن موقفه من السائد، ومن الآخرين |
5- المبدع هنا لا يؤكد وحدته بنفس الحدة المطلقة-كخطوة أيضا- وإنما هو يأتنس بمن يتلقيعلى نفس موجته بشكل نسبى على الأقل، ومنذ البداية أيضا. |
|
6- لا يقتصر هذا النوع على الإنتاج الفنى أو الأدبي، وإنما يشمل ، التغيير الذاتى الإبداعى فى النمو الفردي، والإنشاء العلمى والثورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المبدعة المسئولة إلخ .. |
6- يمكن أن يكون هذا النوع مرادفا للإبداع “الموهبة” المرتبط بتنمية القدرات الفنية الخاصة، وبالتالى فهو يشمل أغلب الإنتاج الفنى والأدبى بصوره المتميزة والمألوفة، دون القفزات الطفرية التى تغير مسار صوره وأشكاله، ومسار الحياة برمتها . |
قراءات ومراجع
– لا تستند هذه الدراسة إلى نصوص بذاتها بقدر ما تستعين، تآنسا فى السياق، بمقتطفات من قراءات مواكبة، لذلك فضلت أن أحتفظ بالمراجع الأولية كما أثبتت فى العمل فى صورته الأولى، ليس باعتبارها مراجع محددة، وإنما باعتبارها إطارا عاما متداخلا مع الأرضية التى نشأ فيها هذا الفكر، فهى قراءات مواكبة، ولكنها ليست جوهرا لابد أن يُراجع اليه، بحيث تظل الأطروحة فى نفس موقعها حتى لو رفعنا منهما هذا الدعم، ولا أود أن أسن بذلك سنة لا أوافق على تعميمها، لكنى متمسك بحقى -حالا- فى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن ثمة قراءات لا غنى عن الالمام بها مكتملة غير مكتفين منها بما أقتطفت، بحيث أحسب أنه لا يجدر بمن يرجو الحوار مع ما جاء بهذا العمل ألا يتعرف عليها.
ومن أهم تلك القراءات الموصى بها استثناء لما أثبتناه فى سائر هذه الأعمال:
* Alliso, C .C. (1972) Guilt, Anger and Cod”. New york: The Seabury Press
* Arieti, S. (1976) “Creativity: The Magic Synthesis” New york: Basic Books.
* Corning,W.C. (1975) “Violence Depends on your Point of View .
* Dyal, J., Cornin, W. & Willows, D. (1975) “Readings in Psychology: The Search for Alternatives” New york: Mc Graw-Hill Book Company.
* Fromm, E. (1973) “The Anatomy of Human Destructiveness”. New York: Fawcett Crest
* Storr, A. (1970) “Human Aggression” New York: Atheneum Publisher
– سيجموند فرويد: “ما فوق مبدأ اللذة”: ترجمة محمد عثمان نجاتى، دار المعارف 1966.
– يحيى الرخاوى (1975) “تحرير المرأة وتطور الإنسان، نظرة بيولوجية” المجلة الإجتماعية القومية، العددان (2- 3).
– يحيى الرخاوى “حركية الوجود وتجليات الإبداع” [جدلية الحلم والشعر والجنون] “الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع” المجلس الأعلى للثقافة (2007)
يحيى الرخاوى “جدلية الجنون والإبداع” (1986) مجلة فصول – المجلد السادس – العدد الرابع (ص 30 –58)
– يحيى الرخاوى “مقدمة فى العلاج الجمعى: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق” (2019) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[1]– داڤید م. روپ “الانقراض” (1998) ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمى، الناشر: المجلس الاعلى للثقافة
المشروع القومى للترجمة – القاهرة
[2]– لورنز وتينبرجن- Tenbergen فى كتاب:
-Kaplan H. (1967) Comprehensive Text Book of Psychiatry، Williams & Wilkins Company. P.180-188
– Linda R. Williams (1993) Sex In The Head Visions of Femininity and Film in D.H.
[3] – روبرت جاى ليفتون ناشط سلام واستاذ جامعه وطبيب نفسى ومؤرخ من امريكا درس فى كليه طب نيويورك وكليه طب ويل كورنيل فى جامعة كورنيل، روبرت جاى ليفتون من مواليد 16 مايو 1926
[4] – يقول آرثر كوستلر Arthur Koestler The Case of the Midwife Toad (1971).. إننا لو تتبعنا الخط المجنون الذى سار عليه تاريخ الإنسان فإنه قد يظهر أن هناك احتمالا كبيرا أن هذا الكائن العاقل Homo Sapien ليس سوى مخلوق بيولوجى شاذ، ناتج من خطأ واضح فى عملية التطور’ ويقول فى موضع آخر: إن ظهور القشرة المخية الجديدة Neocortex (فى الإنسان) هى المثال الوحيد فى التطور الذى أعطى نوعا من الأحياء عضوا لا يعرف كيف يستفيد من استعماله.
[5] – انظر هامش (38)
[6]– ماكدوجال هو صاحب نظرية الغرائز حيث أبرز أهميتها ووصفها بأنها المحر الأساسى والدافع الهام للسلوك وفى سنة 1920 أكد “مكدوجال” عل فكرة العقل الجماعى Group Mind واعتبره بأنه يسيطر على سلوك الجماعات المختلفة ويميز بينها ويرى أن العقل يمييز بين مكوناته الفردية.
– William McDougall. “The group mind” a sketch of the principles of collective psychology with some attempt to apply them to the interpretation of national life and character. (1920) Putman.
[7] – وكان الموقف أضعف بالنسبة لغريزتى الموت Thanatos والحياةEros اللتين تصدى لهما فرويد أيضا
[8]-Harry Guntrip, Schizoid phenomena, object-relations, and the self , Published by International Universities Press in New York, 1969 .
[9] – Sex In The Head Visions of Femininity and Film in D.H. Lawrence By Linda R. Williams, by Routledge, 1993
[10] – انظر هامش (38)
[11] – هذا ما لاحظه مونتاجو فى أربع عشرة من القبائل غير إسكيمو الأرض الخضراء (مثل قبائل الإنكاس والباشيجاس.. وغيرها) ممن اعتبرهم مجتمعات لا تتصف بالعدوان التحطيمى أصلا.
[12] – دولارد، جون، ليونارد دبليو دوب، نيل إى ميلر، أورفال إتش مورير وروبرت آر سيرز. الإحباط والعدوان . نيو هافن: مطبعة جامعة ييل ، 1939
يذهب بعض السلوكيين (مثل ج. دولارد وزملائه) إلى اعتبار العدوان ببساطة أحد مظاهر التفاعل للإحباط أساسا.
[13]- يمكن الرجوع إلى عرض إريك فروم فى كتابه “تشريح عدوانية الإنسان” لتطور وجهة نظر فرويد فى نظرية العدوانية والتحطيم Freud’s Theory of Aggressiveness and Destructivenes فى تسلسل رائع منذ اعتبرها أولا (ثلاث مقالات فى الجنس 1905) جزءا من المكونات الغرائزية Component instincts لغريزة الجنس، ثم أخذ يشك فى وجودها كغريزة مستقلة (حالة هانز الصغير سنة 1909) حتى أعلنها مستقلة فى ‘مافوق مبدأ اللذة 1920 دون اقتناع كامل، وكيف قرنها ابتداء بما أسماه غريزة الموت, أى أنه نظر إلى فاعليتها السلبية والتحطيمية أساسا، وظل فروم يستعرض التطورات التالية حتى قرب وفاته (1938) حيث أكد أخيرا “..إن العدوانية بصفة عامة هى ظاهرة غير صحية وتؤدى إلى ألم (لاحظ استعمال عدوانية Aggressiveness وليس عدوانا Aggression التى نادرا ما كان يشير إليها.
[14] – يحيى الرخاوى: “تزييف الوعى البشرى، وإنذارات الانقراض، بعض فكر الرخاوى”، الناشر: جمعية الطب النفسى التطورى، 2019، (ص 205)
[15] – نعلن تحفظنا ضد استعمال كلمة كريهة Offensive لأى أثر بيولوجي, حيث العيب الذى جعله كريها ليس فى وجوده وإنما فى انفصاله عن الكل.
[16] – ولعل هذا ما حاول أليسون فيتزسيمون تأكيده فى حديثه عن الغضب والعدوان (وهو يستعملهما كمترادفين) فى قوله: ‘إن الغضب.. هو جزء لا يتجزأ من الحب ومن كل الدفاعات والتحفظات ضد الموت والقوى المهددة، وبالإضافة فإن هناك شيئا صحيا ومفيدا فى العدوان: هو أنه جزء من كل الأساليب الإبداعية’. (وهو لم يذكر كيف كان ذلك، وهذا ما سنحاول الوصول إليه فى نهاية الكتاب).
[17] – يحيى الرخاوى: (1979) “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” (شرح سر اللعبة) (ص 184).
[18] – انظر هامش (38)
[19] – أنتونى ستور، طبيب نفسى، يتبع جمعية علم النفسى التحليلى ومن كتبه: (الانحراف الجنسى 1964) و(عدوان بشرى 1968) و(تدمير الإنسان 1972):
– Anthony Storr, Sexual Deviation, Penguin Books, 1964
– Anthony Storr, Human Aggression, Penguin Books, 1968
– Anthony Storr, Human Destructiveness: The Roots of Genocide and Human Cruelty, Chatto, 1972
ألفرد ادلر: هو طبيب عقلى نمساوي، مؤسس مدرسة علم النفس الفردى اختلف مع سيجموند فرويد وكارل يونغ فراح يؤكد أن القوة الدافعة فى حياة الإنسان هى الشعور بالنقص والتى تبدأ حالما يبدأ الطفل بفهم وجود الناس الآخرين والذين عندهم قدرة أحسن منه للعناية بأنفسهم والتكيف مع بيئتهم
[20] – يحيى الرخاوى: ثلاثة دواوين (1981 – 2008)، الديوان الثانى: “شظايا المرايا” قصيدة: “التهام” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، الطبعة الأولى 2018
[21] – أنظر هامش رقم (49)
[22] – انظر هامش رقم (38)
[23] – قد يكون موقف سارتر عن “جحيم الآخر” موقفا مبدعا، من هذا المنطلق بالذات.
[24] -Silvano Arieti: (1976) Creativity The Magic Synthesis. Basic Books, Inc. Publishers، New York, p12.-13
[25] – يحيى الرخاوى “تحرير المرأة وتطور الإنسان، نظرة بيولوجية’ (1975) المجلة الإجتماعية القومية،(12)، العددان (2- 3)، (انظر أيضا ص 41، وما بعدها).
[26]– Winnicott، D. W. (1958) Collected papers: Through pediatrics to psychoanalysis. London: Tavistock publications.
[27]– وهو مما قد نواجهه فى صورة واضحة فى الطب النفسى المهتم بدراسات السير الذاتية للمبدعين.
– يحيى الرخاوى، حركية الوجود وتجليات الإبداع، الفصل الثالث، “قراءة في شهادات المبدعين والنقاد، ص320، المجلس الأعلى للثقافة، 2007
[28] – وقد أوحت هذه الملاحظة بفرض اقترحته على إحدى طالباتى د. عزة البكرى، فقامت بعمل بحث ضمن رسالة دكتوراة فى الطب النفسي، لبحث التفرقة بين مظاهر العدوان السلبى والإيجابى فى مسار العلاج الجمعى رسالة دكتوراة، كلية الطب، جامعة القاهرة 1990 (غير منشورة).
El Bakry, Azza (1990) Depressive and Aggressive Phenomena in Group Psychotherapy. M.D.Thesis, Faculty of Medicine, Cairo University
[29] – وقد تحقق ذلك فى البحث المشار إليه فى الهامش السابق، بقدر ما تحقق فى بحث آخر (تحت اشرافى) فى نفس مجموعة العلاج الجمعى العميق والممتد:
نجاة النحراوي، (1981) ”دراسة اكلينيكية فى بعض حالات البارانويا من خلال أعراضها (محاولة توضيحية)”. رسالة ماجستير. (تحت اشرافى أيضا) كلية البنات. جامعة عين شمس.
[30] – يحيى الرخاوى (1978) ”مقدمة فى العلاج النفسى الجمعي: عن البحث فى النفس والحياة” دار الغد للثقافة والنشر، وتم تحديثه فى (2019) بعنوان: (مقدمة فى العلاج الجمعى: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق).
[31] – يحيى الرخاوى: “قراءة فى مستويات وجدل الوعى البشرى .. من خلال النقد الأدبى” (2019) دراسة “الحلم .. القبر.. الرحم في “الأفيال” لـ (فتحى غانم) (ص 81) - منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[32] – يحيى الرخاوي: جريدة الدستور بتاريخ 17-5-2006 بعنوان: “الذكاء والغباء فى السياسة والحكم !!”
[33] – يحيى الرخاوى: “رباعيات.. و..رباعيات” (2017) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[34] – يحيى الرخاوى: ”دورات الحياة وضلال الخلود .. الموت والتخلق فى حرافيش نجيب محفوظ” مجلة فصول المجلد التاسع – العدد الأول والثانى. أكتوبر 1990 (ص 153- 188)
وأيضا – قراءات في نجيب محفوظ” الطبعة الأولى (1990) الهيئة العامة للكتاب والطبعة الثالثة (2017) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[35] – يحيى الرخاوى: “عن الإبداع والعدوان والجنس” (1992) مجلة فصول – المجلد العاشر العددان (3-4).
[36] – يحيى الرخاوى “الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع” (1985) مجلة فصول – المجلد الخامس – العدد الثانى.
– “حركية الوجود وتجليات الإبداع” [جدلية الحلم والشعر والجنون] (2007) المجلس الأعلى للثقافة
[37] – يحيى الرخاوى “جدلية الجنون والإبداع” (1986) مجلة فصول المجلد السادس العدد الرابع (ص 30 –58)
******************
الملحق (2)
.. (عبر النقد الأدبى):
“ليالى ألف ليلة” لــ “نجيب محفوظ” القتل بين مقامـَـىْ العبادة والدم([1])
القتل بين مقامـَـىْ العبادة والدم([1])
القتل: بين مقامى العبادة والدم:
رغم أنها قراءة شاملة للعمل الروائى المتميز ليالى الف ليلة لنجيب محفوظ، فقد اخترت لها هذا العنوان الفرعى، لما وصلنى أن هذه الفكرة (القتل/العبادة) هى محورية عبر أغلب الحكايات، ورغم أن نص العنوان لم يرد إلا فى عبارة متأخرة فى الحكاية الثالثة: (ص: 67) على لسان الشيخ على البلخى (العارف-المعلم) مخاطبا عبدالله الحمال (الميت-المتناسخ)، إلا أنها كانت أوضح ما يكون منذ البداية، وبالذات فى الحكاية الأولى (صنعان الجمالى)، وإن كانت الحكايات كلها تجرى فوق أرضية مرعبة من شلالات الدم التى تدفقت من شهوة وجبن وأنانية وذعر شهريار معا.
وقد كان القتل دائما سهلا على نجيب محفوظ يدفع إليه أبطاله أو يجعلهم ضحاياه بشكل سلس مفزع معا، وربما يحدث ذلك دون مبرر ظاهر، مما يجعل قارئه يكاد يوقن كم هو (القتل) حدث تلقائى من صلب طبيعة الحياة، إن لم يكن فى جوهره هو الحياة ذاتها، وحتى الموت (الطبيعى) كان كثيرا ما يبدو عند محفوظ وكأنه قتل بشكل ما، وذلك فى أوائل رواياته وقصصه حيث كان يوكل المهمة للقدر أو المرض، لكنه تقدم فى مرحلة لاحقة ليوكل به الفتوات والأبطال، كل فيما يخصه !!، ثم ها هو يفاجئنا إذ يقتحمــنا وهو يمد إبداعه فى داخل داخلنا ليجذب جذور القتل الغائرة خلف ما نتوهم أنه نحن، فنتبين أننا قتلة أصلا – بالحق والباطل- وأننا سنظل كذلك ما لم نواصل المسيرة إلى تكاملنا بشرا بحق.
نـظرة سريعة نتعرف بها على كم القتلة والضحايا فى عمل متوسط الحجم مثل هذا العمل، قد يثبت للقارئ أحقية اختيارى لهذة القضية محورا لقراءتى هذا العمل:
فالقتلة يشملون: شهريار- صنعان الجمالي-جمصة البلطجي-(= عبدالله الحمال = عبد الله المجنون البرى) -جلنار- سـُـمـّـار حفل سهرة اللسان الأخضر(شروع) -المعين بن ساوى (شروع)- فاضل صنعان، هذا فضلا عن أحكام الإعدام التى تبدو أحيانا قتلا، وأحيانا قصاصا، وأحيانا تكفيرا، هذه الأحكام التى اغتالت: علاء الدين أبو الشامات (شهيدا) وحسام الفقي، والمعين بن ساوي، ودرويش عمران وابنه، وحبظلم بظاظة عقابا، وفاضل صنعان تكفيرا- أما الضحايا و المقتولون فيشملون الأبرياء والمقتولين، وبالصدفة: من أول الطفلة المغتصبة ثم خذ عندك: عَلِى السلولي، كرم الأصيل-زهريار-شملول الأحدب (مع وقف التنفيذ!!) يوسف الطاهر-قوت القلوب (مع وقف التنفيذ أيضا ثم القضاء عليها بالسم) علاء الدين أبو الشامات-المعين بن ساوي-درويش عمران-حبظلم بظاظة، توأم شاور- العجان بائع البطيخ (إعدام بتهمة باطلة) (حتى وفاة قمر العطار بالسم كانت تعتبر قتلا أيضا).
الداخل والخارج:
ويجدر بى إبتداء أن أعود لقضيتى القديمة، فما زالت تلح علىّ، وما زال الرفض يُــشهر فى وجهها معظم الوقت، وهى قضية أو إشكالية الرواية/الراوي/المجتمع، وسأحاول أن أعيد رأيى فى هذا الصدد بشكل جديد، فأوجزه قائلا:
أولا: إن الكاتب لا يكتب إلا ذاته،
ثانيا: إن ذلك لا يعنى أنه يتكلم عن تجارب شخصية أو عن فرد محدود باسم وتاريخ، وإنما أعنى به أن الكاتب يحتوي-بحيوية نَشِطة-كل تجاربه وانطباعاته ومنطبعاته([2]) من خارجه وداخله جميعا، وإذْ تصبح ذاته ثرية – مرنة- مُـقَـَـلْـقَـلة ـ فى آن: يمضى يعيد تنظيمها من كل ذلك بتوليف جديد، وهو ما قد يظهر فى شكل عمل جديد متميز.
ثالثا: إن ما يساعد على هذه الرؤية هو تبنى مفهوم تعدد الذوات والتنظيمات والكيانات داخل الذات الفردية الواحدة، ذلك المفهوم الذى أعتبره المدخل لفهم عالم النفس فالعالـَم، إذ هو المصهر والمحتوى لكل العالم، وعلى قدر مرونة الحركة وجِـدة التوليف بين هذه الكيانات الكثيرة: يكون الابداع.
وعلى ذلك – فإننى أستطيع أن أتقدم خطوة نحو إيضاح أبعاد هذا العمل من حيث واقعيته، فالواقعية فى العمل الروائى تتجلّى بقدر ما يكون هذا العمل موضوعيا، وليس بقدر التحامه بالواقع الخارجى أو وصفه له، فيكون العمل موضوعيا بقدر صدقه وقدرته على استقبال قلــقلة شخوص ذات كاتبها بحجمها الحقيقى، ثم مدى قدرته على الإضافة لها وتحريكها وإعادة إفرازها فى عمله بأقل وصاية فكرية مسبقة، أو خيال مصنوع.
هذه الليالى واقعية فى مجملها رغم الاسم والجو الأسطورى، لكن جرعة الواقعية تخف حتى تكاد تختفى كلما تقدمنا خلال العمل حيث يغلب فى نهايته الخيال (لا الحلم) حتى ليفرض نفسه على الحلول المطروحة، كما يطغى الأسلوب التقريرى وتعلو لهجة الخطابة ونبرة الحكمة قرب النهاية أيضا، يحدث ذلك بشكل ملح، لكنه لا ينجح فى أن يبعد العمل عن واقعيته الغالبة، فى البداية خاصة.
والعمل فى مجمله، ورغم تراجع نهايته، إنـما يمثل مرحلة متقدمة من رحلة كاتبه فى أغوار نفسه/العالم، وبه نجح نجيب محفوظ فى إعادة إبداع هذا الأصل الفريد، فأعاد خلق بعضه فى دورة تناسخية رائعة، ورغم كل هذه المساحة بين الأصل والتجديد، فنحن لا نملك لهما فصلا، ولكن أية مقارنة تفصيلية تبدو أبعد ما تكون عن المطلوب فى قراءة مثل هذا العمل.
العفريت.. والوجود:
سبق أن بينت أن نجيب محفوظ قد أخذ بيدنا ليرينا أن عالم عفاريتنا هو وجود ماثل فى دواخلنا، وقد صرح بذلك بشكل مباشر، كما كرر الإشارة إليه بشكل غير مباشر فى عمل آخرسبق أن قدمت قراءته([3])، وفى هذا العمل الحالى يعود ليؤكد هذه المقولة، والوقوف عندها مرة ثانية هو لإثبات بعض أوجه الفرض الذى أعلنـه ابتداء عن القتل فى داخلنا – وظيفته وأشكاله-، والعفاريت فى هذا العمل تمثل شخصيات أساسية تتبادل مراكزها بين الشكل والخلفية مع الشخصيات الإنسية التى يحركها الكاتب فى براعة مناسبة.
يعلن نجيب محفوظ فى الحكاية الأولى و منذ ظهور العفريت الأول (قمقام عفريت صنعان الجمالى) أنه وجود داخل الوجود، أو بتعبير أدق: هو وجود مع الوجود، فهو يتحدث عن كثافة هذا الوجود وثقله، وغشيانه وحلوله واصطدامه بتجسيد آنىّ لا يسمح للقاريء اليقظ أن يذهب بعيدا عن الذات وتركيبها المتداخل، يقول:
1 - “وغشيه الوجود الخفى.. وسمع الصوت..” (ص33)
2 – ”هيمن عليه الوجود الأخر“ (ص27) (وهو هنا يشير إلى أن هذا حدث حين أخلد للنوم، لكنه يعلن بشكل لم يعد يحتاج إلى شك أنه لا فرق بين نوم ويقظة، بين وعى الحلم ووعى الصحو: “إن يكن حلما فما له يمتليء به أكثر من اليقظة نفسها” (ص16)
3 – ”ارتطمت ذراعه بكثافة صلبة“ (ص13) (لاحظ هنا تعبير كثافة وليس جسما صلبا).
4- “جاء صوت غريب…… صوت اجتاح حواسه“ (ص14) واجتياح الصوت للحواس جميعا دون الاقتصار على الأذن.. يذكرنا بطبيعة الكثافة والإغارة ومصدرها، ودور الجسد فى المعرفة!!
5- ”وتلاشَى الغبار تاركا وجودا خفيا جَثَم عليه فملأ شعوره” (ص38) (لاحظ تعبير ملأ شعوره ).
6- “شعر بنفاذ وجوٍد جديد هيْمَنَ على المكان” ( ص40) (ولا أنكر أنى ربطت، ربما متعسفا بين النفاذ والوجود و المكان، ورجّحِت أن المكان هو الذات: أساسا!!).
7- ”مضى الوجود المهيمن يخف حتى تلاشى تماما” (ص 41).
8- “طرح تحت ثقل وجود غليظ احتل جوارحه… ” (ثم) ”فاجأه الصوت مقتحما وجدانه”. (ص 48).
9- ”ولكن الآخر أطلق ضحكة ساخرة، ثم سحب وجوده بسرعة وتلاشى” (ص50).
وأحسب أن استعمال الكاتب لألفاظ الوجود، والاقتحام، وامتلاء الشعور، واحتلال المشاعر، والثقل، والكثافة، والغلظة، والسحب، والالتحام، لم يعد يحتاج إلى مزيد من التأكيد بأن الأمر هو كما ذهبنا إليه: عفريتا فى داخلنا = وجود ثان:عيانى الحضور: تكثيف حركية مستويات الوعى.
وأهمية هذا الاستطراد هو فى ترجيح ما ذهبنا إليه من أن هذا العمل يكشف عن القتل فى الداخل، ذاك الذى يتحرك مع تنشيط الوعى الآخر، القتل بمختلف دوافع انطلاقه وتنوع مساراته ونتاجه.
والآن لنواكب القتل حكاية حكاية:
1- صنعان الجمالى
التنشيط الخطر.. بين التفكير والتروى
هنا: قتل غريب حقا !!
1- لأن القاتل ليس قاتلا بطبيعته !! فهو رجل طيب، رجحت كفة خيره بشهادة العفريت ذاته وشهادة الناس: “فهو من “الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم”، أما شهادة العفريت.. ”لا أنكر أيضا مزاياك، ولذلك رشحتك للخلاص (ص28)”، “.. قلت ”هذا رجل خيره أكثر من شره” (28)، أما شهادة الناس..” كانت له منزلة بين التجار والأعيان، وكان من القلة التى يحبها الفقراء” (ص35)
2- وهو غريب لأن القتيل ليس واحدا، والقتيلان ليسا متجانسين، فالضحية الأولى طفلة بريئة، والقتيل الثانى حاكم ظالم
3-وتشتد غرابته حين يبدو الدافع للقتل بلا مبرر شخصىّ ظاهر.
فما هى الحكاية ؟ لم القتل؟ هذا القتل؟ ومـَـنْ هذا القاتل بالذات؟
إن هذه الحكاية الأولى أزعجتنى حتى كدت أعدل عن أخذها بكل هذه الجدية التى لاحت لى إبتداء، تلك الجدية التى غمرتنى فور قراءتها بتكثيف متلاحق، ولكنى عجزت عن التهرب وتماديت، وليتحملنى القارئ:
صنعان الجمالى شخص عادى، تاجر تغلب عليه الطيبة، لكن عليه أن يساير ويمالئ، وأن يُسكت ضميره حتى يسيـّر حاله مثله مثل الأخرين، وهو يحاول التكفير والتعويض بالطيبة والصدق وبعض العبادة (المحسوبة)، غير أن هذه الحياة الوديعة المتصالحة مع الظلم-رغما عنها بشكل ما-ليس لها ضمان، إذ لادوام لاستقرارها لمن يتورط فى إكمال المسيرة، أو بتعبير أدق: لمن يضطر لإكمال المسيرة، وحين يَحْبس مثل هذا الشخص العادى داخله بما فى ذلك حسه الجماعى إذ يخدّرُه بالتدبير والسلبية والانسحاب: ”استأنسنى بسحر أسـَوَد” (ص15)، فإنه قد يـُـنـَـشط فجأة إذ “يدق الزمن… دقة خاصة فى باطنه فيوقظه” (ص13) (لاحظ: فى باطنه)، حين ينشط هذا الكيان الداخلى الفطرى الحر([4]) فإنه ينطلق ابتداء بقوة الغرائز الدافعة نحو ارتقاء تكفيرى، وقد تحدد التكفير هنا بقتل رأس الظلم (الحاكم)، هكذا: مرة واحدة !، ومن ذا الذى يقتله؟ شخص لم يَعْرِف من قبل شيئا عن القتل، ولأن المسافة واسعة بين الحياة الأولي، واليقظة الأخيرة، فان التنشيط يندفع فى عنف تخبّطى، فلا يكتفى بإحياء القتل: وسيلة لتحقيق إلهام بقصاص عادل، ولكنه يـنـشــط معه- ربما بحق الجوار!: الجنس الغريزى الفج، وكذا القتل العشوائى الجبان، وذلك نتيجة التوازن بين الداخل والخارج: فلا الداخل النشط - بغير مناسبة ظاهرة-قادر على ضبط الجرعة (جرعة الثورة للتكفير عن مسالمتـه للظلم وممالأته للجارى) ولا الخارج القديم بمستطيع العودة إلى السيطرة على الموقف برمته (بما فى ذلك ثورة الداخل)، فالمتغيّر الذى حدث ببداية حسنة الاتجاه (ومُرعبة معاً) سرعان ما غيَّـر اتجاهه إلى غير ذلك بلا قصد واضح، وبألفاظ أخري: إن التغير الذى فرضه الداخل بدا وكأنه حفـْـزٌ إلى أعلى، وإذا به يتردى (بمساعدة المنزول-ولكن ليس فقط بسببه ) إلى حيث لا يدري، وها هو صنعان يخرج فى الصباح لأول مرة فى حياته منذ صار صبيا دون صلاة (ص19)، ثم توغل فى حال يتعذر الهيمنة عليها (ص29)، فهو الجنون أو ما شابه، فراح يخبط فى الظلام مشعث العقل (ص21)، ويمضى هذا التنشيط الغريزى الفج يسحبه إلى أدنى فأدنى تسوقه أخيلة مٌعَرْبِدة (ص21)، وإذ يستيقظ الجنس البدائى المندفع، يفجر خياله إلى ما سبق حظره: إلى المحرمات دون موانع… وتذكّر نساء من أهله شبعن موتا، فتمثلن له عاريات فى أوضاع جنسية، فأسف على أنه لم ينل من إحداهن وطرا(ص21).
إذن، فقد ثار الداخل (العدوان أساسا) نحو الخير من حيث المبدأ (قتل الحاكم الظالم)، ولكن من أين له بضبط الجرعة وتوجيه الدفـّـة؟ ومع نشاط الجنس المحرم والشهوى بلا ضابط يندفع عدوان آخر ليقتل طفلة إذ يغتصبها ثم يزهق روحها رعبا ونذالة، فيجتمع الجنس والعدوان فى أدنى مراتب البدائية،.. فهو وجه الجنون القبيح.!
وهنا يصل نجيب محفوظ بحدْسه إلى ما لم تصل إليه أى من العلوم النفسية إلا فرضا مجتهدا غير مقبول من أغلب المختصين، فهو يؤكد وجهىْ الجنون([5]) معا، فبالاضافة إلى هذا التردي، يظهر الوجه الإيجابى بشكل مباشر.. ”ما طالبتك بشر قط” (ص23)، ولكن أليس الذى نشـَّـط الدفع نحو قتل الظلم هو هو الذى نشــط الجنس البدائى والقتل الجبان الهارب؟ نعم هو كذلك، ولست أدرى كيف استطاع محفوظ أن يلتقط هذه الحقيقة المعقدة، حيث لا يقتصر تنشيط المستوى البدائى للوجود على جانب دون آخر، كما لا يمكن ضمان التحكم فى مسار تنشيط أى منهما وخاصة حين يثور هذا المستوى فى سن متأخرة، وبعد حياة راتبة، نجح صاحبها فى اخفاء بقيته بتسكين دفاعى متزايد.
ولألتمس العذر مرة ثانية من القارئ، وأعيد سلسلة أفكارى (فروضى) بأسلوب آخر:
(1) صنعان الجمالى رجل هادئ، تاجر، فى منتصف العمر،
(2) خدّر داخله ليواصل إنحرافا مشروعا (مثله مثل غيره)
(3) كان فى ذلك يمالئ الدنيا ويدارى الحاكم
(4) لم يثنه ذلك عن مواصلة العبادة وعمل بعض الخير الظاهر
(5) وفجأة: (بدون مقدمات ظاهرة) ثار داخلــه وقرر التكفير بمبالغة غير مفهومة فى الظاهر، إذ تــقـرر له أن يقتل الحاكم (خلاصَّا لروحه وللناس)
(6) بدلا من أن يتم التغيير فى هذا الاتجاه الخيــّر، فوجيء صنعان أنه غير قادر على تحمل مسئولية الحقيقة أو الإلمام بأبعادها
(7) ثار فى نفس الوقت-مع ثورة الداخل-دافع الجنس المكبوت (نحو المحارم والأطفال.. الخ)، وكذلك ثار دافع الهرب الجبان قتلا وكذبا
(8) فى الجولة الأولى رجحت كفة هذه الدوافع فى صورتها السلبية دون قدرة من جانبه على كفها شعوريا بعد انهيار الكبت التلقائى (الآلى) فحدثت جريمة هتك العرض وقتل الطفلة.
وهكذا يتجاوز محفوظ نفسه، ويخرج من الصورة التى كان محبوسا فيها فى أول كتاباته حين كان يرسم المقدمات (الظاهرة) بحيث تؤدى - حتما- إلى النتائج المتوقعة، بشكل يؤكد معنى الحتمية السببية (النفسية)([6]) وبعض النقاد لا يرتاحون إلى هذا النوع من الحتمية الذى لا يطمئن إليه إلا مستوى معّيِن من القراء.
هكذا استطاع محفوظ أن يوصل إلينا بكل جسارة: أن رجحان كفة هذا التنشيط البدائى فى الاتجاه السلبى لم ينجح أن يلغى استمرار الاتجاه الإيجابى الذى ما نشط-أصلا-إلا ليحققه، فينقذ صنعان نفسه مرة أخرى إذ يواصل سعيه لإنجاز مهمته الأولى، فيؤكد الحقيقة التى قدمناها ويعلنها مباشرة بأنه: ليس هو مغتصب الطفلة فقاتلها.. إنه شخص آخر، القاتل المغتصب شخص آخر، نفسه تتمخض عن كائنات وحشية لا عهد له بها (ص23)، إلا أن إنكاره نفسه هذا لا يصح ولا يفيد، لأنه هو القاتل المجرم دون غيره، وفى نفس الوقت فهو أيضا كان التاجر الطيب المثالئ، ثم هو هو-أخيرا-القاتل العابد الأوّاب، وإنكاره القتل الجبان المجرم يعلن ضمنا رفضه أن يكون هو كله ليس سوى هذا الجزء القاتل، مجرد جزء من ذاته دون بقية الآخرين (داخله)، إذن فليواصل ليتعرف على الباقي، على بقية ناس الداخل، وخاصة القاتل العابد فيه، وما أشق ذلك.([7])
إنها مهمة شاقة جدا ….، وها هو يريد أن يتردد، ولكن إذا كان الذى أطلق دافع القتل العبادة هو رفض الاستمرار فى انحراف خفى لم يعد يطيقه (من داخل)، فإن قتل الطفلة قد أصبح دافعا جديدا إلى تكفير ألزم.. ولكنها (مهمة القتل العبادة) أسهل من قتل البنت الصغيرة ! (ص27)، بل لعلها أصبحت الطريق الوحيد للخلاص، ويحاول صنعان أن يعزو الجريمة إلى التنشيط البدائى لداخله (كما يحاول البعض أن يعفى المجنون من مسئوليته دون تحفظ)، فلا يجد أمام صدق الداخل إلى ذلك سبيلا، يقول لقمقام ([8]) مدافعا (ص28):
– لولا اقتحامك حياتى ما تورطتُ فى الجريمة
فقال (قمقام) بوضوح
– لا تكذب، أنت وحدك مسئول عن جريمتك
وهذه رائعة أخرى من روائع محفوظ الحدْسية، فهذا هو الجنون بعمق تناقضاته، وهذه هى المسئولية بعمق الوجود، وليس بمنطق الشفقة الخائبة أو تبريرات القانون الوضعي، وإذا كان للجنون جانب تدميري، فجانبه الآخر ارتقائى بنـّاء لو واصل المسيرة، الفرصة متاحة: ما زالت الحياة تتسع للتكفير والتوبة: خلاص الحى من رأس الفساد وخلاص نفسك الآثمة (ص 28).
وهكذا يتواصل الدفع، وتقام صلاة القتل! فيتوكل على الله([9]) ويقتل الظلم ويدفع الثمن، وهو لا ينجو هذه المرة كما نجا من الجريمة الحقيقية الأولى إلا ليتم الثانية التى تبدو أنها ليست جريمة أصلا بل قصاصا وصلاة، فيأتى بعد ذلك إعدامه جزاءاً للجريمة الأولي، واستشهادا فى الصلاة الثانية فى نفس الوقت، وهكذا يذهب بطلا-ولو رغم أنفه ”كن بطلا يا صنعان، هذا قدرك” (ص34).
2- جمصة البلطى
قتل تكفـيرى آخر
وأحسب أن محفوظ قد انزعج – مثل انزعاج القارىء أو مثل انزعاجى على الأقل -من إقحام قتل الطفلة فى طريق خلاص صنعان (والناس)، فعاد يؤكد جانب العبادة فى القتل التكفيرى الهادف فى حكاية جمصة البلطي، وجمصة يتفق مع صنعان فى أمور مبدئية، منها: أنه-أيضا-من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، (رغم مركزه فى السلطة:، ”فى قلبه موضع للعواطف، وموضع للقسوة والجشع” (ص37) “لا يوجد قلب فى الحى كقلبه فى جمعه بين الأسود والأبيض” (ص43)، ولكن موقفه (تركيبه) أصعب من صنعان، فمهمته أثقل، فإذا كان صنعان قد ابتعد عن داخله بالانحراف التدريجى بالملايَنَةٍ والاستغلال المستور بما له من علاقات مريبة مع كبير الشرطة، ولم يتورع عن الاستغلال أيام الغلاء (ص 28)، فإن جمصة البلطى هو سيف السلطة نفسها، وحتى يواصل قهره للناس، فضلا عن قهره لنفسه، فقد كان عليه أن يحبس داخله فى قمقم، إذ لم يكن ليكفيه-مثل صنعان-أن يزيحه بعيدا عن الواجهه، وأن يسمح له بالتجوال المحدود فى أحلام غامضة، فالسلطة لها متطلبات قهر لايصلح معها نشاط داخلى معاكس أصلا، وجمصة حامل سيفها شخصيا، ولكن سبحان من له الدوام!!، حتى سيدنا سليمان يموت، فما هو إلا بشر، وجمصة السلطة يموت أيضا فى لحظة اختلاء بالذات مع ذكريات مؤلمة مؤنّبة، الذى رباه.. هو الذى قبض عليه (على صنعان: جاره) هو الذى رماه فى السجن، هو الذى قدمه للمحاكمة، ثم ساقه أخيرا للسياف شبيب رامه، هو أيضا من علق رأسه بأعلى داره، وصادر أمواله، وطرد أسرته (ص37)، يتذكر ذلك وقد اختلتْ به نفسه: قطرات من الراحة فى خضم العمل الشاق الوحشى (ص37)، وفى نفس الوقت يمضى يؤكد مبررا اضطرار السلطة الى ما تفعل، فهذا هو قانونها الأول أليس السلطان نفسه هو من قتل المئات من العذارى والعشرات من أهل الورع والتقوى ؟ فما أخف موازينه (موازين جمصة) إذا قيس بغيره من أكابر السلطة (ص37)، إلا أن التبرير لم ينفعه طويلا، فما أن اختلت به نفسه حتى كان ما كان.. بغتة تحول وعيه إلى يده.. وتلاشى الغبار تاركا وجودا خفيا جثم عليه فملأ شعوره بحضوره الطاغى (ص38) ولا أكرر هنا كيف أن ظهور سنجام هو - مرة أخرى- إعلان يقظة الداخل (فجأة)، انكسر الكبت (القمقم) وانطلق عملاق الداخل، ولم يتعجل هذه المرة فى إصدار أوامر القتل تحديدا، تركه لتطوّره الجديد، فماذا فعل؟
انطلق جمصة (سنجام) لا يصب غضبه إلا على الطغمة المستغلة للعباد (ص48)، وهو لا يدرى أنه هو، فأصبح صاحب السلطة على الناحيتين، هو من الطغمة الفاسدة، وهو يسرقها عقابا لها استجابة لهواتف شريفة، ولكنها لعبة خبيثة ليس لها قرار، ففى النهاية: يمضى يطارد هذه الهواتف الشريفة كما يطارد الشرفاء (ص49)، ويتمنى أن يستمر التحايل على نفسه ليرسم خطة استيلاء أكبر، لكن داخله يقف له بالمرصاد ”تود أن تمكر بى لتحقق أحلامك الدفينة فى القوة والسلطان؟” (ص50)، ويتركه انتظارا لترجيح تسخير هذه القوة الجديدة المنطلقة من قمقم الداخل الى خلاص نفسه وخلاص الناس ويصبح التغييرحتما محتوما، ولكن دون إملاء مباشر اذ يصبح القتل العبادة هو قرار العقل والإرادة والروح وليس قرار الشيخ العارف، عبد الله البلخى. ”الحكاية حكايتك وحدك والقرار قرارك وحدك” (ص53)، فهو ليس قرار العفريت الـمنطلق: “لك عقل وإرادة وروح” (ص50).
ولا يجد جمصة سبيلا إلى التنصل، من المهمة الملقاة عليه، لأنها واجبة، بل… بل هى هى قراره: إنى أقوم بواجبى، فوجَّه إلى عنقه ضربة قاضية، فاختلطت صرخته المذعوره بخواره، واندفع الدم مثل نافورة([10]) (ص55)
وهكذا قتل الحاكم خليل الهمذانى بعد أن أطلق سراح الثوار جميعا..أفرج بقوته الذاتيه عن الشيعه والخوارج فى ذهول كامل شمل الجنود والضحايا جميعا (ص54)، ويتقبل قرار القصاص بشجاعة فائقة تختلف عن موقف صنعان الجمالى الذى أخذ يستنجد بعفريته دون جدوي، فهنا: القرار قراره هو جميعه، وليس مجرد تنفيذ لقرار صدر من بعضه، من داخل لم يلتحم مع بعضه البعض، وحين تحمل مسئوليته تماما وتوازنت الكفتان: أنقذ داخله من ذاته الظاهره، فأنقذ الناس ونفسه من الظلم، انعتق بالموت الأصغر، ما قتلوا إلا صورة من صنع يدى (ص59) ليخلد بالاستمرار وسط الآخرين وفيهم (بأى صورة كانت)، فهنا معنى جديد للخلود، وتصنيف مبدع لأنواع الخلاص، فالخلاص الانتقامى المنشق عــُـرْضَة للتخبط والتردي، أما الخلاص المسئول الإرادي، فهو لايأبه للموت ولايسجن فى ذات فردية محدودة،([11]) بل يستمر فى أى صورة، تحت أى اسم.
فهذه خطوة جديدة فى تصعيد الرؤية الأعمق للمسيرة البشرية تقول: إن الإنسان حين يستجيب لداخله بصدق ومسئولية لا بانفصال وبدائية: لا يموت..، حتى لو مات.
3 – الحمـّال
تأكيد… واستمرار
وتأتى الحكاية الثالثة أضعف من حيث أن بطلها ليس هو الانسان الخير الشرير معا، المهلك نفسه الساعى للخلاص فى آن، لكنه الإنسان الذى تخطى هذه المرحلة ليقوم بدوره الإيجابى العادى (فى القتل أيضا)-و كأن نجيب محفوظ لايدعنا نتصور أن القتل حادث عارض، يخرج من داخلنا تكفيرا أو خلاصا فى ظروف محدودة، ولكنه يبدو فى هذه الحكاية الثالثة وكأنه يعلن القانون الطبيعى الذى يحقق التوازن بين ظلم الحاكم وعائد هذا الظلم، فها هو عبدالله الحمال يستلم العهدة من (نفسه) جمصة البلطى ليقوم بالقتل المنظم ومساعدة الثوار (ممثلين فى فاضل صنعان)، وهو يملك من قدرة التناسخ الكامنة ما يمنحه سلطة عادلة، وهو يعلن أنه لا معنى للخلود (بشتى صوره) ان لم يكن لعمل جليل، وإلا فما جدوى المعجزة ؟ هل بقيت فى الحياة بمعجزة لأعمل حمالا؟ (ص67)، وحين يذهب يسترشد برأى الشيخ البلخى يرفض-ثانيه-أن يقوم عنه باتخاذ القرار، ويكتفى بأن يعلن له موقعه بين مقامَىْ العبادة والدم (ص67)، وهو الموقف الكيانى الأصيل الذى يخرج منه كل منا..كل على قدر همته (ص68).
وعبدالله الحمال بصورته هنا يمثل تحديا لمحاولات النقد والتفسير، فهو ليس عفريتا، ولكنه أيضا ليس إنسيا، فهو يخوض تجربة لم يمارسها من قبل (ص62)، وهو يحقق ما ينبغى أن يحققه الانسان الفرد العادى وهو يمارس حياته فى طيبة لا تستبعد القتل إحقاقا للحق، وهو لا يخلو من ضعف بشرى يخلط عليه الأمور، فبعد أن يقرر ويختار طريق القتل العبادة بادئا ببطشة بمرجان، يقتل ابراهيم العطار، ويتذرع لذلك-بأثر رجعى بأنه كان يساهم فى دس السم فى أدوية أعداء الحاكم، ولكن الأمر لا يخلو من نوازع شخصية (إنسية).
وهنا يقفز تحذير هام، ومـمـن؟ من ثائر شاب كان المتوقع منه أن يكون أكثر اندفاعا و… وقتلا، ذلك أن فاضل صنعان يقول: “ليس الاغتيال ضمن خطتنا” (ص78)، وظهور سنجام بعد تناسخ البلطى يؤكد الجانب الإنسى، لعبدالله الحمال، فليس ثمَّ وجود داخلى آخر إلا لمن هو إنسي، أى أن الإنسان هو وحده الذى يتميز بهذا التعدد والتناقض الحتميين، أما العفريت أو الملاك أو حتى الإله فكل منهم واحد صحيح، وهنا تبدو دقة الكاتب، وصدق حدسه، وهو يرتقى بالإنسان نحو الكلية والتفرد والتناسق الداخلي. ولكن دون أن يستسهل فيختزل الطريق إلى ما لا يكون على هذه الأرض، وهكذا يفيق عبد الله الحمال من شبهة عثرته بقتل إبراهيم العطار، ويؤكد استمرار مسيرته بقتل عدنان شومه كبير الشرطة.
تناسخ جديد:
ولست أدرى لم استسهل الكاتب عند هذه النقطة أن يبدله من عبدالله الحمال إلى عبدالله البري، هكذا بخبطة من خبطات العجائب المباركة، ولكن يبدو أن هذه الخبطة قد سمحت لعبدالله الحمال أن يستمر وفى نفس الوقت أن يعترف دون أن يـُعدم، غير أن الطريقة التى تمت بها هذه النقلة وقد كانت نهاية الحكاية المفاجئة بإرساله-فى صورته الجديدة-إلى دار المجانين، هذه السهولة قد تعلن وقفة إنهاك من الكاتب فى رحلة الغوص إلى كل هذه الأعماق، وهذا حقه على كل حال.
وقبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية، يجدر بنا أن نشير من جديد إلى اعتراض فاضل صنعان الثائر على هذه الوسيله (الاغتيال) حتى لو كانت لتحقيق العدل، إذ يبدو طوال الحكايات - رغم تبرير “القتل/ العبادة” من خلال ثورة الداخل (العفاريت) – أن الحل الفردى (الاغتيال) مشكوك فيه من البداية، حتى لو كان عبادة، ولكن ثمة تأكيدا أسبق يقول أن البادى أظلم، فما ظهور العفاريت أصلا إلا لأن الظلم استشري: ”على الوالى أن يقيم العدل.. فلا تظهر العفاريت” (ص75).
4 – نور الدين ودنيازاد
(حتى) لعبة القدر (لا تخلو من قتل إزاحى)
ويزداد نجيب محفوظ تلطفا بنا، فيخفف عنا رؤيتنا لداخلنا: قاتلا يتأرجح أبدا بين العبادة والدم، ويتقدم نحو مرحلة وسطى من الليالي، تبدو وسطا بين مغامرة الإبداع الأعمق (الثلث الأول)، وبين الأسلوب التقريرى والتكرارى (الثلث الأخير)، وفى هذه المرحلة لا يتمثل داخل فرد بذاته له فى شكل عفريت خاص، بل تظهر العفاريت باعتبارها تمثل قانون الداخل عامة، قانونا لا يعرف قوانيننا، ولكنه ليس “لا قانون” على كل حال، فهو إذ يخل بنظام ما هو واقع محسوس يعلن أن المقادير تجرى بحسابات تفوق ظاهر معلومات وأحاسيس البشر وواقعهم المعلن، فكل من “سخربوط” “وزرمباحة” يمثلان الأمل والحدس العشوائي، وما هو قبل وبعد الواقع وبالرغم منه، ولكنهما لا يمثلان كل الداخل، بل يمثلان جانبا دنيويا أو لذيا أو حسيا مقترنا باتجاه عابث لدرجة الشر والأذى فى سخرية مفيقة، فهما يرسمان فى أول حكايات هذه المرحلة الوسطى لعبة عابثة تجمع بين دنيازاد (أخت شهرزاد) وبين نور الدين بائع العطور، تجمع بينهما فى حلم الواقع الآخر، وكأن نجيب محفوظ يريد فى هذه المرحلة من تطوره أن يؤكد فى أكثر من عمل على أن الحلم هو واقع أيضا، أو حتى أنه واقع قبلا. وهو حين يظهر الوجود الآخر فى شكل عفريت، يغامر بأن يعلن أنه حلم يجرى فى حالة النوم فعلا: “لما أخلد إلى النوم ليلا هيمن عليه الوجود الآخر، وسمع الصوت يقول متهكما… الخ” (ص27)، ثم إنه يذهب ليؤكد أيضا موقع الحلم من الجنون: “وثبتُ إلى الأرض، فاكتشفت عريها، أكتشفت حبها المسفوح… هتفت فى يأس: إنه الجنون….”،…. ولاح لها الجنون كوحش يطاردها (ص94)، فحين يفرض الوجود الآخر نفسه حتى ليترك آثارا عيانية (الدم: من حبها المسفوح)، فإنه بذلك يعلن واقعا جديدا، ويفرض احترامه على الواقع الظاهر، بل إنه يحتويه إحتواء: ”هل سمعت من قبل عن حقيقة تتلاشى فى حلم”؟ (ص98) (لاحظ التعبير: لم يقل عن حلم يتلاشى فى حقيقة) فالحلم هنا هو الأقدر، وهو الأصل (وهو الجنون من بُعْدِ أخر)، وهو المستقبل ”من مـَـلـَـكَ الحلم ملك الغد” (ص12)، يؤكد على أن هذا كله هو عقل آخر، إنه الجنون نفسه… والعقل أيضا (ص112) فكما أن للحلم واقع فللجنون عقل.
وتمضى لعبة الحلم/الجنون/الواقع الجديد: فارضة نفسها ضد كل الحسابات، ولكن محفوظ لا يستطيع أن يواصل ملاطفة مشاعرنا التى أزعجها ما أثاره فينا من قبل حين عرى القتل داخلنا، فتفلت منه بارقة حل مرعب، يظهر فى شكل حل سافر يدبره الداخل وهو يتسلي:
- تسلية نادرة
- ترى هل تنتحر الجميلة أم تقتل
- الأجمل أن تقتل وينتحر أبوها (ص107)
هكذا، ببساطة، لا رفضا للظلم، ولا نكسة إلى بدائية جنسية عدوانية غير مميزة، ولكن ما دام هذا هو الداخل بقانونه الغامض، فليكن الحل بلا حسابات ولا منطق ولا هدف، وها هو القتل يتحرك مثل حركة الأمعاء، مجرد ظاهرة طبيعية تحل المشاكل عبثا أو تسلية أو مصادفة أو قصدا… لا يهم.
لكن ثم داخلاً أيضا مواكبا يتحرك فى نفس الوقت، فيخيف العبث، ويخيف القتل نفسه، فيوقف المسخرة، فيعلن سخربوط خوفه من: أن يتسلل الخير من حيث لا ندرى (ص108)، فكما تسلل الشرإلى نفس صنعان من حيث لا يدرى فقتل الطفلة وهو الذى كان يعد نفسه للخلاص بقتل الظالم، كذلك قد يتسلل الخير هنا من حيث لا يدرى العبث الشرير.
وبهذا يؤكد نجيب محفوظ أن الوجود الآخر فى الداخل ليس شرا وليس خيرا، ولكنه حركة على طريق التكامل، يتوقف مسارها ومآلها على أمور كثيرة فى الداخل والخارج جميعا، ولاتوجد ضمانات فى طبيعة تكوين هذا الداخل تحدد المسار وتطمئن من يطلق سراحه إلى ترجيح كفة على الأخرى، ولعل هذه الحقيقة هى قمة مأساة طبيعة النمو البشرى الصعب.
وها هو الخير المتسلل-رغم أنف سخربوط وزرمباحة-يفرض نفسه بعد أن تتعقد الأمور وتنذر بكارثة، وبعد أن تقبل شهرزاد خطبة (فعقد قران) كرم الأصيل (المليونير) على دنيازاد، أملا فى دعمه للمجهود الحربي!! ويقترب موعد الزفاف، إلا أن ثلاث مصادفات تحدث ترجيحا لكفة الخير:
1- يقابل عبد الله المجنون بعد أن أطلق سراحه سحلول([12]) من دار المجانين بشق نفق عجيب، نور الدين، فيثبـت أقدامه ويكسر يأسه
2- ويقابل شهريار فى تجواله السرى نور الدين فيحكى له حلمه/حكايته، فيعده بتحقيق الحلم واقعا (ما دام واقعا)
3-ويقابل عبدالله المجنون دنيازاد بعد هروبها للانتحار ثم عدولها عنه فيرجعها إلى نور الدين ويقرر السلطان أن يفى بوعده، إلا أن نجيب محفوظ لا يدع النهاية تسير بسلام!، وإنما يسارع بإزهاق روح كرم الأصيل بيدى عبد الله المجنون الذى يسارع بدوره ! بالاعتراف بجريمته فيحميه جنونه من القصاص، ولا يصدقه أحد، وكأن محفوظ لم يعجبه أن يترك حكاية تمضى بلا قتل، ربما من باب الجمال الدموي(!!)
فى هذه الحكاية كما قرأتها: عدة حلقات لم أستطع أن أتبين تماسكها مع ما حولها، أو ضرورتها أصلا، فتكليف سحلول – وهو الذى أعلن الكاتب صراحة عن هويته- ولكنه ملاك، “نائب عزرائيل فى الحى” (ص80)، وكذلك ”أنت ملاك الموت” (ص227) تكليفه بإخراج عبد الله المجنون من دار المجانين يبدو بلا مبرر خاص، فهذه مهمة ملاك الحياة، لاملاك الموت، ولا يصح أن نعتبر عبدالله المجنون فى عداد الموتى فيصبح إنقاذه من اختصاص ملاك الموت، كما لم أقبل أن يكون ملاك الموت قد أنقذه بالموت، وأن من قام بالدور بعد ذلك هى روحه، وليس هو، فعبد الله يدور حول محور الخلود، وهو نفى لموته (مرحليا على الأقل).
كذلك كان ظهور عبدالله المجنون -رغم كل ما يمثله- ظهورا ثانويا فى هذه الحكاية، فرغم أنه قد ساهم فى حل العقدة، الا أن المصادفة بدت أقل من دوره كثيرا، ولكن يبدو أن محفوظ قد اختار للمجنون دورا جديدا بدءا من هذه الحكاية وحتى نهاية الليالى حيث يظهر عادة عند لحظة الحسم حلا للمأزق، وخاصة حين يستعمل معرفته الغائرة لإحقاق الحق، ثم هو يظل يحوم حول مشاعر الناس (وفى ضمائرهم)، وكان لابد له إذن من إطلاق سراحه ليقوم بدور الحاضرالغائب أبدا.
وأخيرا، وكما أشرت، فإن قتل كرم الأصيل بيد عبدالله المجنون لم يكن له مبرر كاف، لا من الداخل ولا من الخارج، فقد كان بوسع السلطان أن يفرض عليه الطلاق مثلا..
ولكن لعل ما غاب عنى دلالته أو أهميته هو ناتُج عن إصرارى على محاولة أن أرى الحكايات كلها فى وحدة ما، وهذه مغالاة لا أعفى نفسى من مسئولية المخاطرة بها.
5- مغامرات عجر الحلاق
العجز عن القتل
ثم تأتى مغامرات عجر الحلاق لتعلن جانبا آخر من طبيعة الوجود البشري، حين يعجز الانسان عن القتل ابتداء، بكل صوره: القتل فى الحلم، القتل للخير، القتل للشر…،هو عجز عن العدوان إذن، بل هو عجز عن الإقدام أصلا، فهل يعنى ذلك أنه إذا نجح إنسان أن ينفذ بجلده من حفز داخله الى هذا الاتجاه القاتل، أنه نجا بنفسه؟ أبدا: بل لعل بدائل القتل أبشع منه، ربما لأن أغلبها أدنى وأخفى.
عجر الحلاق طفولىّ عريق (ص125)، يحب النساء، فتأتيه الفرصة حتى قدميه من دعوة غامضة، فيمضى إليها غير عابئ بتحذير المجنون ”عقلك فاسد فلا تطاوعه” (ص126)، ويعيش حلمه الفاجر فى حضن جلنار ليلة كل أسبوع، وتتفتح شهيته للجنس والأكل (دون القتل) ولا يكتفى -طبعا- بجلنار، بل يزوغ بصره الى أختها زهريار([13])، وسرعان ما يتورط-بعد خيانة جلنار مع شقيقتها.. بتدبير منها كما سيتضح- بأنها مقتوله بجانبه، فيدفنها فى حديقة دار اللهو بعد أن يسرق عقدا ثمينا كانت تتحلى به، وهنا يحدث تقاتل بين المجنون وبينه، وهو يتهم المجنون (محدثا الطبيب المهينى) بأنه “قلبى يحدثنى الآن بأن هذا المجنون قاتل خطير” (ص130)،إن ظهور المجنون، ورفض عُجَر له، لا يعنى أنه لم يحرك ما يقابله فيه، يقول المجنون لعجر ”لا يدعونى الا أمثالك يا جاهل..” (ص130)، وهذا ما يؤكده الطبيب من أن ظهور الجنون هو إعلان لعجز العلم المتاح عن الإلمام بأبعاد الجاري، فهذه إضافه لدور الجنون المعرفي، يقول الطبيب أنه (الجـُـنـُون) يدعى عادة إذا عجز علمنا عن الخدمة (ص130)، فليس المجنون هو القاتل لأنه مجنون، ولكن القتل جزء من طبيعتنا مع اختلاف صور التعبير، فما أكثر القتلة يا عجر المهينى (ص131).
إذن، فقد تحرك فى عـُـجـَـر شىءٌ ما رغم أنه لم يقتل، ولا يستطيع أن يقتل.. ولن يألوا أن يذكّر نفسه بأنه لم يرتكب طيلة حياته جريمة قتل، هيهات، ولا قتل دجاجة مما يستطيعه (ص133)، ومع إعلان العجز عن القتل، يعجز عن الجنس والطعام والشراب، أطبقت الكآبة متجسدة وران الاحباط على الطعام والشراب وجفت ينابيع الرغبة (ص132)، لكن ما تحرك تحرك، ومضى يتلصص ويتجرأ حتى خطب حسنية صنعان، يعتذر فاضل شقيقها، فيواصل هياجه الجنسى: خاض فى أجساد العذارى كالمراهقين (ص134)، ويقع فى حب قمر أخت حسن العطار، بلا طائل، وفى ضربة مصادفة يجد ما تحرك فيه سبيلا للتفريغ والظهور، وبعد أن شارك مقتحما فى سهرة جمعت زبائنه بما فيهم مهرج السلطان شملول الأحدب تقع جريمة القتل (مع وقف إزهاق الروح) فى صورة شرب وضرب، ويتبرع عُجَر أن يقوم عنهم بالدفن والإخفاء، ثم يكتشف-بمساعدة المجنون-أن الجثة حية، فيخبئها فى بيته، ويمضى فى ابتزاز زبائنه، ويتصاعد الطمع بلاحدود، وبظهور شملول الأحدب، بمكيدة من زوجة عجر التى غارت من زواج عجر الإرغامى بقمر العطار- يقع عجر فى مأزق عجز جبان جديد، لكن طمعه لا ينتهى فيسوقه حلم السلطة إلى مشاركة جماعة يلتقى بهم عشوائيا وهم يسيرون مقبوضا عليهم من الثوار، يفعل ذلك بإيحاء من سخربوط (طمع جديد) وبأنهم سيتولون القيادة !! إذ تنكشف الخدعة ويضبط عـقد القتيلة-مصادفة-حول وسطه، ويكاد يـعدم لولا تدخل المجنون لدى شهريار ليعلن الحقيقة، وتنتهى الحكاية هذه النهاية السطحية([14]) التى يقوم فيها المجنون بدور الضمير المنقذ.
ومع ذلك، فما هو مناسب لمحور قضيتنا هنا كما قرأتـُـها يقول: إن العجز عن القتل ليس فخرا وليس فضلا، وبالتالى فشتان بين العجز عن القتل وبين الامتناع عنه، وبين توجيهه وبين إطلاق طاقته فيما هو أبقى، كما يعلن أن تحريك القتل فى الداخل-دون قتل فِعْلى إذا اتخذ مساره السلبى ظهر فى صورة جشع مكافئ له، يستغرق صاحبه فى لذائذ حسية وسلطوية، لابد وأن تقضى عليه مع تصاعد أطماعه بلا حدود.
ولا يستطيع أحدنا أن يتعاطف مع عجر الحلاق الذى لم يقتل ولا دجاجة، فى حين أننا نستطيع أن نتعاطف مع صنعان الجمالى نفسه رغم أنه هو قاتل الطفلة البريئة بكل بشاعة. هذا هو الإبداع !!!!
6- أنيس الجليس
سحر الدنيا… وعفة الجنون
فى هذه الحكاية، تتمثل الدنيا فى فتنة لا يقاومها عاقل فتتجسد فى صورة أنيس الجليس، التى تنجح فى إغواء كل من يقترب منها دون إستثناء، والدنيا فى داخلنا ابتداء: هى التى تسبى عقولنا وتستدرجنا إلى الهلاك الظاهر، وفى مقابلة بين زرمباحة وسخربوط من ناحية وبين سنجام -فى حضور قمقام -من ناحية أخري، ينشأ ما يشبه التحدى بين الدنيا و الهدى: بشكل يدفع زرمباحة- بتدبير وموافقة سخربوط-إلى الإقدام على هذه المغامرة، فيقع فى حب الدنيا كل الناس، من أول عم ابراهيم السقا حتى شهريار نفسه مارين بيوسف الطاهر وحسام الفقي، ثم بعد أن يقتـل الأخير الأول بسببها (جريمة قتل جديدة) يخيل للقاريء أن السحر سيهدأ لكنه يطغى ويستمر ليوقع بيومى الأرمل الذى ما فتيء يأسف على صديقه القديم حسام الفقى وهو يحاكم بسبب جريمته، ولكنه يمضى فى غوايته، لا يتعظ: حتى يُضبط فيتهم الجنون السلبى فى داخله: اغتاله المجنون الذى حل فىّ (ص166) (شتان بين هذا الجنون([15])، وبين جنون عبدالله البري!)، وتواصل فتنة الدنيا إغارتها فتوقع المعين بن ساوى وتضرب له موعدا يتبعه موعد آخر مع الفضل بن خاقان (كاتم السر) ثم سليمان الزيني… حتى نور الدين (عديل شهريار وزوج دنيازاد) والسلطان نفسه ووزيره الحكيم دندان، وفى تسلسل قديم جديد تحبسهم الدنيا عراة الواحد تلو الآخر فى أصونة تعدها للبيع فى المزاد، وهنا يظهر المجنون ليتحداها، وهو الوحيد الذى ينجح فى أن يواجه سحرها حتى تختفى دخانا بلا أثر، ويدفع الرجال ثمن تكالبهم عليها خزيا أمام أنفسهم دون الناس: بما ينفعهم ولا يضر العباد.
وقد بلغت المباشرة فى هذه الحكاية مبلغا لم يكن الكاتب - فى ظني- فى حاجة إليه، فهو يصف أنيس الجليس بصفات الدنيا كما هى شائعة عند الجميع، فهى ”ساحرة فاتنة”، تحب الرجال، لا يرتوى لها طمع… لا يستأثر بها أحد ولا يزهد فيها أحد (ص159)، “ثم فى موقع آخر: “إنها القدر الذى لا ينفع معه حذر ولا ينتفع لديه بمثال” (ص165)، وهذا يفسر أنه حتى نور الدين بعد ما تحقق حلمه فى زواج دنيازاد بمعجزة طيبة، وشهريار وهو فى موقفه الجديد من المراجعة والتعلم ومحاولة التكفير، ودندان والد شهرزاد الوزير الناصح، لم يسلموا من إغرائها (الدنيا)، إذ لو كانت الشر فقط، أو الجنس، أو الحس فقط، لأعفى الكاتب نفسه من أن يجمع تحت لوائها كل الناس خيرين وأشرارا، مجتهدين وفجارا، واحد فقط هو الذى استطاع أن يبطل مفعولها هو المجنون، لم تسكره لأنه سكران بالحقيقة “رأسى مليء بالدنان” (ص170)، ولأول مرة لا يحدث وجهها أثره ثم مباشرة إنها فتنة ولكن للعقلاء لا للمجانين.
وهذه مخاطرة من الكاتب حين يصور قوة الجنون بهذه الإيجابية، بعد أن صور ثورة الداخل بشقيها، حتى قمقام وسنجام (خير الداخل) لم يسمح لهما بالتدخل المباشر لصالح البشر: “لماذا لا يسمح لنا بمساعدة الضعفاء؟” (ص161) جاءهم الرد جاهزا ”وهبهم الله ما هو خير منكم، العقل والروح” ([16]) (ص161)، لكن العقل تـفتنه الدنيا، هكذا تقول هذه الحكاية، فكيف يكون الجنون هو الوقاية الوحيدة من سحر الدنيا؟
قد يمكن تفسير ذلك بأن جانبا محددا من الجنون يجعل صاحبه زاهدا بالضرورة ولكنه للأسف إنما يحقق الزهد بما يشبه العجز لا بما هو استغناء أو رضا: اللهم إلا فى الجنون الذى هو ليس جنونا، وهذا مأزق الكاتب، فالبدايات واحدة، والأسماء واحدة، والكاتب مضطر لأن يعلن رؤيته فى كل لحظة على حدة، ليكن، ولتكن دعوة لأن نحتمى بالدنيا ولو بالجنون شريطة أن نكون مسئولين عنه، قادرين على قوانينه الأخرى مرجحين إيجابيات مسيرته دون غيرها، ولكن، ما هو موقع هذه الحكاية من مسألة القتل بين مقامى العبادة والدم؟
لم أجد علاقة مباشرة، فلم أحاول أن أفتعل علاقة مصطنعة، إلا أن للقارئ أن يتساءل معى عن هذا الإلحاح الذى يلح على نجيب محفوظ حتى لا يدع حكاية دون جريمة، فلو أن حسام الفقى -مثلا- لم يقتل يوسف الطاهر لما تغيـر السياق كثيرا، كما أن ما ورد فى الحوار بين حسام الفقى (القاتل) وبيومى الأرمل-كبير الشرطة-من أنها ليست سوى قصة قديمة يستدفئ بها العجائز: قصة الحب والجنون والدم (ص162)، يذكرنا هنا بالعلاقة الوثيقة بين الجشع الدنيوى حتى التقاتل من أجل اللذة (بأشكالها: الجنس والسلطة والمال)، وبين تحريك العدوان فى الاتجاه السلبى، وفى موقع أخر أثناء مساءلة كبيرالشرطة لأنيس الجليس عما يفعله الرجال عندها، فتجيب أنهم ”انما يتحدثون فى الشريعة والأدب يجيبها: عليك اللعنة، ألذلك أفلسوا وتقاتلوا؟ (ص164)، فكأن الكاتب يذكرنا، ولو فى أرضية الحكاية، بأن تحريك القتل فى الاتجاه السلبى ! إنما يواكب حب الدنيا، وهو فى نفس الوقت يسخر من عقلنة ولفظنة من يدعى أن الحديث فى الشريعة والأدب هو ضد الإقتتال على الدنيا، بل لعله-إذا أفرغ من جوهره-هو فتنه أخرى أخبث وأضل.
وأخيرا، فإن نشاط سحلول رجل المزادات، ومندوب الموت كان مفرطا وهو يحوم حول الضحايا الموشكين على الافلاس، وترجيح هذا الجانب من دوره على حساب الموت الذى يمثله سطَّــح أكثر فأكثر من دوره، وجعلنى أواصل رفضى له، مع أنه كان يمكن أن يكون الموت هو المقابل المتحدى للدنيا، أو أن يكون الترياق المفيق من سحرها وفاعليته الإيجابية (أعنى فاعلية الوعى به) وهى أكثر من فاعلية الجنون فى هذا الصدد.
7 – قوت القلوب
قتل مع وقف إزهاق الروح
وسط هذا الجو اللاهث حول الحب والجنون والدم، تطل علينا حكاية ليس فيها إلا شروع فى قتل، حيث تم إحياء القتيله قبل طلوع الروح وشتان بين هذا الذى كان لقوت القلوب (جارية الحاكم سليمان الزينى) التى دبر قتلها المعين بن ساوى بناء على تحريض من جميلة زوجة الزيني، وبين إحياء شملول الأحدب مهرّج السلطان فى حكاية عجر الحلاق، كذلك شتان بين فتنة قوت القلوب الهادئة الحزينة وبين سحر أنيس الجليس الطاغى المدمر، حكاية قصيرة، لم تَخْلُ من قتل، وإن كان الحب قد أنهاها نهاية وديعة بالعفو وعرفان الجميل، كذلك كان إدخال شهريار ودندان فى الحكاية حشرا ليس له دلالة كبيرة.
وقد خيل إلىّ أنه بدءا من هذه الحكاية وإلى نهاية الليالي-فيما عدا طاقية الاخفاء-خيل إلى أن حدة الإبداع بدأت تفتر، حتى أصبحت الحكايات أقرب إلى الليالى السلفية، حيث نجد فى مفاجآتها أنس الحكاية وطيب النهاية، أكثر مما تعرضنا لتعرى الداخل وتناقض المسار والنهايات المفتوحة.
8 – 9 – علاء الدين أبو الشامات، و السلطان
مقام الحيرة بين مذهب للسيف، ومذهب للحب
القتل فى هذه الحكاية مؤلم غاية الألم، هو استشهاد بلا شك، فالمقتول بريء، والقاتل فاجر كاذب متسلط، لكن من يقرأ الحكاية ويرى كيف رجـح علاء الدين (إبن عجر الحلاق) مذهب الحب، فاتــبع سبيل شيخه عبدالله البلخى حتى زوّجه الأخير ابنته، ثم فجأة يـحاكم بلا جريمة، ويقتل بلا ذنب، من يراجع هذا التسلسل لابد وأن يعتصر قلبه الألم الحاني، لكنه ألم قديم عادى، مثل ما يثيره القصص القديم، افتقدنا فيه التكثيف الرائع لتضارب الداخل، كما كثرت حوله الحكم والمواعظ ([17]) وقصص الصوفية المعادة، كما تكرر فيه النقاش الذى يدور حول دعوة الثورة العنيفة التى يمثلها فاضل صنعان، ودعوة الإصلاح المسالم التى تميل إليها نفس علاء الدين، أى بين من يمثلون جنود الله، ومن يمثلون دراويشه، بين سيف الجهاد… والحب الألهى (ص201). جسدت هذه الحكاية حيرة علاء الدين من البداية للنهاية و”لكنى دائر الرأس فى مقام الحيرة، إنى فى مقام الحيرة” (ص195)، “حقا إنى لفى حيرة” (ص201) ولم يـنــه علاء الدين هذه الحيرة باختياره، وإنما بناء على رأى شيخه-ولو غير المباشر- بأن يسلك طريق الحب.، وما إن فعل حتى قـــتل.
لتنتهى الحكاية بأنه ربما يكون قد نجــاه الله من الموت بالموت (ص202).
ماذا يريد أن يقول لنا نجيب محفوظ بهذا القتل الجديد؟
أيريد أن يقول إنه لو لم يُـقتل علاء الدين هكذا لكان ثـَـمَّ احتمال أن اختياره لمذهب الحب (دون مذهب السيف) هو موت أخر؟
ولكن رمز الحق والحقيقة-الشيخ البلخي-هو الذى شجعه على ذلك حتى خطبه لابنته، كما أن الرواية التى أوردها الكاتب فى نهاية الحكاية -على لسان البلخي-هى رواية غاية فى السلبية، لدرجة أعترف بأنها نفّـرتنى بلا موعظة.
وأخيرا فإن التحيز لمذهب السيف (الذى يمثله فاضل صنعان) قد انهار بشكل أو بأخر حين تشوهت صورة صنعان بمجرد أن استطاع أن يستر ذاته الظاهرة عن عيون الآخرين (بطاقية الاخفاء) فاذا به يتورط فى إطلاق عدوانه، فجنسه، فجنونه الفج، بلا رادع (أنظر طاقية الاخفاء).
إذن ماذا ؟
حكاية أخري، غلب عليها الأسلوب التقريرى من جهة، وأطلت منها ألف ليلة القديمة من جهة أخرى، رغم ظاهر حداثة مقام الحيرة بين مذهبى السيف والحب.
القصاص:
ويبدو أن نجيب محفوظ قد استاء مثلما استأنا من هذه النهاية الماسخة، فسرعان ما ألحق بها حكاية إصلاحية قصيرة، ما كان لها أن تستقل أصلا، فوظَّفها توظيفا مباشرا لينال الظالم جزاءه، ومن خلالها-على أى حال- رأى شهريار نفسه فى مغامرة إبراهيم السقا الذى عثر على كنز أنفقه فى تجسيد أحلامه بتنصيب نفسه سلطانا مسرحيا كل ليلة، مع تنصيب أصدقائه من الحفاة والجياع وزراء وقادة هذه الحكاية التى تنتهى بأن يدرك السلطان الحقيقة فيأمر بتنفيذ حكم تعلمه من السقا: فيقتل ثلاثة، ويعزل اثنين، مع مصادرة أملاكهما.
وبهذا القصاص العادل الماسخ يتأكد تراجع نجيب محفوظ عن الجريمة المفككة التى قدمها فى حكاية علاء الدين.
وقد لاحظت-أيضا-أن دور المجنون أخذ يتوارى فى ضباب الأحداث المهزوزة، فمرة يظهر فى حلم علاء الدين ينصحه بأن يترك لحيته شبكة للصيد، ولكن هذه النصيحة لا يتولد منها شيء، ومرة يــنذر درويش عمران بمصير سلفه كبير الشرطة المعين بن ساوي، ثم يفد على فرح علاء الدين بلا دعوة، ولم أكن أتوقع من النسيج المحكم لشخصية المجنون فى بداية الليالى أن يتسع ليسع كل شيء بهذه الصورة.
10- طاقية الأخفاء
ماذا لو خلعنا القناع([18])؟
وفجأة، يعود نجيب محفوظ إلى نشاطه الإبداعى المزعج.
هو يجعل ضحيته هذه المرة رمز الثورة طوال رحلة الليالي: الشاب اليقظ الأمين، الجاد الغاضب “فاضل صنعان”، والكاتب لم يتوان فى إعلان ما يمثله فاضل، حتى قال عنه سخربوط ساخطا فى أول هذه الحكاية ”إنه مثال حى للعمل المفسد لنوايانا وخططنا” (ص211)، وقد عرفنا ما هى نواياهم وخططهم من مسخرة طفلية، وتعرية فاضحة، ودنيا لاهية، ومجون لذّى، وشر محاك، ولم أستطع-بسهولة-أن أهتدى إلى ما دفع نجيب محفوظ لإستعادة نشاطه الابداعى فجأة قرب النهاية بعد أن فتر حتى التخلخل، إستعاده بهذه الصورة المزعجة من جديد، وكيف تجرأ أن يـعــرى فاضل صنعان هكذا.. فيفجعنا فى حلم طيب.
هل هو حبه المجرد للحقيقة حتى على حساب مقدمات واعدة ؟
هل هو رد شخصى على بعض حماس صغار الثوار أحاديى النظرة؟
هل هو تنبيه لخطورة الفضيلة الظاهرة المستمرة ما استمر رأى الناس ورؤيتهم فى دعمها – يريد بذلك أن ترجح كفة الفضيلة التلقائية- الفطرة النامية ؟
لعله كل ذلك، تقول هذه الحكاية: إن الاختبار صعب، وإن أى واحد منا: حتى لو كان فاضل صنعان نفسه، لو لم يراع الناس ورأيهم، مطمئنا إلى فطرة خام، فلا ضمان للسلامة أو للنقاء. وحين عرض هذا العرض عفريت صنعان فى صورة طاقية الاخفاء زاد الامتحان صعوبه حين اشترط عليه ألا يفعل ما يمليه عليه ضميره، فاذا تذكرنا أن الضمير ما هو الا ناس الداخل يراقبوننا كما يراقبنا ناس الخارج، لأمكن أن نفهم أن الامتحان كان لاختبار الفطرة الأولى خالية من كل تطوير أو تأثير، حتى أثر الضمير.
لكن الفطرة الأولى لا تعيش فى فراغ، فظروف الخارج وطول الحبس يفعلان فعلهما حتما، ثم ما هى تلك المساحة التى تقع بين ما يحث به الضمير وما لا يضر الناس، يقول له عفريته: “وبين هذا وذاك أشياء كثيرة لا تضر ولا تنفع” (ص213)، فأى فطرة تلك التى لاتضر ولا تنفع، فهى لعبة تشويه لا محالة، وهذا ما جعل سخربوط يثق من نهايتها، حيث لا مسار لحرية مطلقة: بلا ناس ولا ظاهر يحاسب عليه صاحبه، ولا مسئولية، إلا نحو الهاوية.
وقد كان: فسرعان ما بدأ الميل بزاوية صغيرة، لكنها محسوبة (من مانح طاقية الاخفاء بشروطها): ثلاثة دراهم لا أكثر من درج قصاب، ودين يرده فى ميسرة، ويستر به فاضل عن آل بيته لعبه طول النهار، ولكن هكذا يبدأ الانحراف أبدا، زاوية صغيرة ومأزق فــتبرير، ثم تظهر فرصة لتأديب شملول الأحدب الذى سخر من فاضل فى غيبته، (وهو حاضر لا يراه)، فيسكب على رأسه الكركديه وتتواتر المناظر القديمة بنفس الصورة التى يذكرها حتى من شاهد الفيلم المصرى القديم.
لكننا نقترب سريعا من قضيتنا-القتل- إذ سرعان ما يظهر القتل نشطا بشعا، ليذكرنا بخطورة إطلاق سراح العدوان الفردي، (حتى لفعل الخير مخالفا الشرط) دون قانون أو ضابط، نفس: القضية التى بدأت بها الليالى (مثل: خلاص صنعان الجمالي-والد فاضل-بقتل الحاكم).
فها هو الإبن يقتل بريئا أيضا، وها هى روح توأم شاور السجان تـُـزهق، وفاضل يحسب نفسه أنه يعمل عملا بطوليا ناسيا أن شاور نفسه ليس إلا منفذا لأوامر السلطة، وناسيا فى نفس الوقت (أو متناسيا) العهد الذى قطعه على نفسه مع سخربوط باعتبار أن قتل السجان من عمل الضمير، ولو كان كذلك لقفز له الوجود الآخر يمنعه، وبعد تمام الجريمة يفاجأ فاضل أنه إنما قتل بريئا.
وهكذا تتدهور الحال من السرقة - للسخف - للجريمة – فيسقط فاضل صنعان فى الهاوية، ويعود القتل يضطرم، أطلقت سراحه من جديد صحوة نجيب محفوظ قبيل النهاية، فيعدم بائع البطيخ بتهمة قتل توأم شاور، وينفتح باب الجنون الأحمر (ص217)، فيجر وراءه الجنس الفج الذى كان مختبئا وراء الكتب والالتزام وثوب الفضيلة وخطب الثورة.
وحين يضاجع فاضل-بفضل الطاقية-قمر أخت حسن العطار، وقوت القلوب زوجة سليمان الزينى (التى تزوجته باختيارها بعد إنقاذها)، يعود محفوظ ليخلط الحلم بالحقيقة، مثلما سبق أن فعل مع نور الدين ودنيا زاد، ولكن بدناءة بشعة هذه المرة، فيجعل استقبال المرأتين لهذه المضاجعة فى حلم، كانت إثارة ملموسة، ساقت كلا منهما إلى الموت بعد أن تماثل لهما كل على حدة، خافتـَـاً الفضيحة، فكان الموت بالسم البطيء، إلا أن قرارهما معا نفس القرار، وشعورهما بنفس المشاعر، وذكرهما-قبيل الموت-لنفس الأسم، قد يوحى بدور خبيث قاتل لفاضل وهو مخفى عن العيون يدس لهما السم تدريجيا وهو يعاود اللعبة الدنيئة، لكن الأمر ليس واضحا وما كان ينبغى أن يغمــض هكذا دون مبرر.
ويمضى فاضل يترحم على نفسه كأنه مات، بل لقد اعتبر نفسه ميتا مادام لم يعد هو ظاهرا ظاهـره، فلم يبق له إلا أن يواصل لعبته الدامية الوحشية، فلا يخلو الأمر من تحريض سخربوط لقتل المجنون والشيخ البلخي، فهما الوحيدان القادران على حدس السر واختراق الحاجز، ومن يعرف أكثر هو العدو الأكبر، وحين يبلغ الطبيب المهينى كبير الشرطة أن قمر العطار وقوت القلوب ماتتا مسمومتين بعد أن نطقتا اسم فاضل صنعان بتقزز ورعب من يذكر مغتصب دخيل، يقوم كبير الشرطة بالقبض عليه فيهرب بالطاقية ليصبح فى عداد الموتى فعلا، إذ يستحيل عليه أن يظهـر خوفا من الإعدام.
وهنا نتذكر طريقة إختفاء جمصة البلطى ليتناسخ فى عبد الله الحمال بالمقارنة باختفاء فاضل ليستمر فى ظلام الدم والدناءة، ولا يجد فاضل ما يكسر به وحدته الجديدة إلا المضى فى سبيل المسخرة مخمورا باليأس والجنون، ولا يدفع ثمن عبثه وجرائمه إلا صفوة زملاء الجهاد والثورة، حيث يقول المفتى: ”ولا أتهم الا الشيعة والخوارج” (ص224)، ويخطر على باله - تكفيرا- أن يهرب أصدقاءه القدامى فى غفلة من صاحب الطاقية، فيظهر له سخربوط مذكرا بالشرط، ولاينفع خداعه بادعاء أن تهريب أعداء الدين ليس من أحوال الضمير، فهى حيلة لا تجوز، وبعد تهديد ونجاة كالهلاك، يضطر صنعان للإفاقة النهائية فيلقى بالطاقية بعيدا ليمضى إلى مصيره بإباء واستعلاء، ويلقى ربه لا يرجو إلا العدل.
حكاية سريعة النقلات حافلة بالجرائم والصراع الداخلي، وورودها بعد أن هدأت حدة القتل والعذاب يمثل صدمة جديدة للقاريء، وتشويهها لفاضل صنعان بالكشف عن داخله هكذا.. يمثل صدمة أخرى فيما يمثله، ومحفوظ يكاد بذلك يضرب فكرة التسامى الفرويدية حيث الحضارة والفضيلة-عند فرويد، هى تسامى بالغرائز، فإذا كان هذا التسامى يخفى وراءه كل هذا القتل والجنس والدناءة، فهو موقف مهزوز يكتفى بصورة خارجية تحمل مقومات الزيف مهما بدت براقة، والبديل عن التسامى الذى لم يشر إليه محفوظ هو سمو تكاملى، يستوعب القتل لا يخفيه ولا يكبته، والفرق بين السمو، والتسامى هو هذا الخيط الرفيع بين التمثل الواعى والكبت التلقائي، ولكن هذا موضوع آخر.
وعلى أى حال فالكاتب يعلن بهذه الحكاية أنه لا يكفى للفرد منا أن يحسن وجهه الظاهر (الفاضل-الثائر) وأن يفرح بكبت ما دون ذلك، حتى إذا ما سنحت الفرصة، فى الظلام، انطلق داخله المكبوت فى صورة… الإغراء محطما قمقمه عن شهواته المكبوته([19]) (ص226).
وقد استبعدت- بعد أن خطر ببالي- أن يكون محفوظ قد قصد عامدا أن يشوه بذلك صورة بعض المتشنجين من أشباه الثوار، ردا شخصيا على بعض الهجوم عليه، فقد رجع فاضل إلى أصله النقى بمحض إرادته لينال جزاءه بنبل يجعلنا نثق فى محاكمته العادلة بعد الموت رغم كل الضحايا.
خلاصة القول إن حكاية طاقية الاخفاء قد أرجعتنا إلى قضيتنا الأولي، وهى تـُـظهر القتل هنا دما خالصا، وحلا فرديا عابثا بشعا، وأن سبيل فاضل صنعان الأول حين كان مع الناس وبالناس ملتزما فاضلا كان هو السبيل الأسلم، ولو على حساب داخله الفج، حقيقة أن ثـَـمَّ تكاملا من نوع آخر مأمول وممكن، إلا أن الفضيلة الظاهرة خير من الفطرة العشواء الضاربة فى الظلمة بلا رادع أو قانون، والضمير ضرورى حتى ولو كان يمثل مرحلة ضبط مؤقتة يحل محلها باضطراد النمو الخيّر التلقائي، وهكذا يلقى الكاتب فى وجهنا تحديا جديدا، أصعب وأخطر.
11- معروف الاسكافي
القدرة الخارقة، والبطولة بالصدفة
مرة أخرى - رائعة- يؤلف الكاتب بين الحلم والواقع بصورة جديدة تعلن أن المهم فى الحلم أن يصدقه صاحبه ويصدقه الناس فتقع المعجزة، حتى وإن لم يكن إلا طيفا يظهر لحظة ويختفي، وهو بذلك يتفوق على الليالى القديمة فيما يتعلق بخاتم سليمان، وكما تقدم خطوة بطاقية الاخفاء، يقدم لنا أثر الخاتم، دون الخاتم، فنعيش أثر اليقين بقوة الحلم دون أن يكون الحلم مسئولا مباشرا طول الوقت عن نتائجه، أى انه يعلمنا أن الأحلام انما تتحقق بتصديقها لابفاعليتها الذاتية، وقارئ هذه الحكاية لابد وأنه قد انخلع قلبه-معي-وهو يعلم أن الحلم (المعجزة) لم يظهر إلا مرة واحدة وبـمحض الصدفة، وأن معروف عاش آثارهُ الطيبة عليه وعلى صحبه من الفقراء والصعاليك نتيجة هذه الصدفة السعيدة، وما ترتب عليها من وعود ومخاوف، أقول انخلعت قلوبنا حين دخل امتحانا جديدا نعرف مسبقا نتيجة فشله، وأمام من؟ السلطان شخصيا!، ولكن الحلم يتحقق-دون توقع منا أو منه-مرة أخرى (وأخيرة فى الأغلب) ربما ليقول لنا من جديد: أن الحلم الذى مر بتأثير المنزول، قد تكرر بتأثير الإرادة الفردية/الكونية (إذا التحمتا) ”ربى لتكن مشيئتك… لا تدع كل شيء يتلاشى كحلم” (ص237).
ولكن محفوظ يعلمنا منذ البداية أن مصدر هذه المعجزة هو القوى الخفية السرية غير المضمونة، وأن من يتخطى الواقع والظاهر هو عُرْضَة لأحد السبيلين حتما، ليكن حلما، ولتكن إرادة الخير، ولكنها أيضا - ما تجاوزت الواقع – عرضة للإستغلال فى الاتجاه الآخر، وهكذا يتجسد التحدى حين يطلب من معروف-من قبل القوى الخفية (فى الداخل ) أن يستعمل سلطته (المزعومة) فى قتل المجنون والشيخ البلخى (ص240) (ممثلى الرؤية والحقيقة) نفس الطلب من صاحب الطاقية (ص219)، الفرق بين التجربتين واضح، فالطاقية استعملت طول الوقت بشرط قاس فجَّر المكبوت الشهوانى القاتل العابث، أما حلم الخاتم فلم يستعمل إلا مرتين ولن يجر عائده إلا لخير الفقراء دون سلطة أو استغلال، ولا يحق هنا تفضيل لمعروف الاسكافى عن فاضل صنعان، فالفرصة لم تتح لمعروف أصلا، والاختبار كان فى أضيق الحدود، وشرط ازاحة الضمير لم يرد، والمقابلة الأقرب لمعروف هى مع حكاية ابراهيم السقا وكنزه وجزيرته المسرحية (السلطان: ص202)، ووجه الشبه بينهما واضح من حيث السن والطيبة والفقر.. وربــما سطحية الحكمة. وقد ظهر القتل فى حكاية معروف عابرا حين بدا فى شكل مجرد تحريض لقتل قوى الخير والحقيقة (المجنون والبلخى)، وبالرغم من أن جزاء الامتناع عن هذا القتل كان مبالغا فيه، لدرجة غير مقبولة، حيث قلد معروف ولاية الحى من قبل السلطان (ربما تذكر بغير وعى حكايته مع إبراهيم السقا) فاننا لا نستطيع أن نتبين مدى فضل معروف الإسكافى فى هذا الامتناع عن القتل، أهى مجرد صدفة ؟ أم هو السن؟ أم هو العجز؟، أم أنه امتناع الجهاد والوعى؟، والأرجح أنه ليس الأخير على كل حال، مما يذكرنا أن مجرد عدم القتل ليس بالضرورة فضيلة، كما يحذرنا من أن يكون نجيب محفوظ قد أْنَهِك فعلا، فأخذ يبتعد عن الواقعية الجديدة التى التزم بها فى البداية، ليحقق العدل بطريق الصدفة الخطرة.
12- السندباد
نهاية فاترة
يتم خيال محفوظ (لا حلمه) ختام هذه الحكايات بطريقة مصنوعة، فيعين معروف (الحاكم الجديد) نور الدين كاتما للسر، ويعين المجنون كبيرا للشرطة (ويسميه عبدالله العاقل-بلا مبرر لكل هذه المباشرة)، ثم يحكى السندباد أكثر الحكايات مباشرة فيرسم أسطح نهاية متوقعة لهذا العمل العظيم، وحكايات السندباد فى هذه الحكاية إما معادة أو متوقعة، وهى دائما أحادية الجانب، تبدأ بالحكمة ثم تسرد الأقصوصة دون داع للإثنين معا، مثل الانسان قد ينخدع بالوهم فيظنه حقيقة، ”وأنه لا نجاة لنا إلا اذا أقمنا فوق أرض صلبة” (ص247)، أو ”أن النوم لا يجوز اذا وجبت اليقظة أو حتى أنه لا يأس مع الحياة” (ص248) وهكذا حتى يقول فى تسطيح أكبر “أن الإبقاء على التقاليد البالية سخف ومهلكة”، هكذا يظهر وكأن الكاتب يرتد عن العمق الذى قلقل به وجودنا حين يقول “إن الحرية حياة الروح وإن الجنة نفسها لا تغنى الانسان شيئا اذا خسر حريته“ (ص251) يقول هذا ويتبعه بأقصوصة خاوية لا تتناسب اطلاقا مع هول بداياته وتطور حدسه المبدع، كما اكتمل فى الثلث الأول ثم فى طاقية الاخفاء حيث علّمنا كم هى صعوبة الاختيارات وتداخلها، واستحالة ترجيح الخير المطلق، وسد مسارب الانحراف… الخ.
ولكن بارقة أمل تفتح من جديد، إذ يصر السندباد على العودة إلى الترحال بالرغم من موفور الحكمة والمال عنده، فنطمئن إلى أنها ليست النهاية على كل حال.
13- البكاؤون
خاتمة بعد النهاية: مزيدة وملفقة
يبدو أن نجيب محفوظ كان مصرا - بوعى أو بغير وعى- على أن يخفف من جرعة الفزع التى جرَّعنا إياها فى بداية حكاياته، فعاد يضيف خاتمة بعد النهاية، رسم فيها حلم الجنة الحسى الساكن، دون صراع أو اعتراض “افعل ما بدالك” (ص216)، وبدلا من أن يجعل الحلم هو الواقع الآخر كما علمنا طوال الليالي، وبدلا من أن يمزج بينه وبين الواقع الأول فى تداخل مناسب كما عودنا، جعله بديلا منفصلا تماما، أوقف فيه الزمن فصار ممتدا بلا حدود، ولم ينتبه شهريار إلى أنه الخلود الخامد، أو لعله رفض ذلك، فتصور حاجته لاستمرارٍ ما، بدءًا بالاستمرار البيولوجى فى ولده: متى يكون لنا ولد (ص263)، ولكنه-مثلما فعل السندباد- اندفع إلى مواصلة رحلة البحث عن ما وراء الباب المحظور فتحه، وعلى خلاف ما ينتظر من سندباد أن يحصل على مزيد من الماس، وجد شهريار نفسه فى صحراء الندم واليأس، يشارك البكائين حسرتهم على ضياع الخيال المنشق (إذن: لم يكن حلما واقعا آخر بل كان خيالا منفصلا مصنوعا!!).
وتنتهى الليالى بنصيحة عبدالله العاقل له أن يأخذ مكانه القديم (ربما مجنونا نادما) تحت النخلة قريبا من اللسان الأخضر (ص268) ربما ليكون شهريار البري.. ينثر الحكمة العشوائية، ويرى ما لا يراه الآخرون، ويؤكد عبدالله العاقل فى النهاية، أن ”الطريق بلا نهاية، وأنه لا وصول اليه ولا مهرب عنه ولابد منه” (ص268).
وهكذا ينقذنا – الكاتب- رغم فرط المباشرة والأسلوب التقريرى من الاستسلام لنهايته المصنوعة.. ما دام يعلن أن محطة الوصول لم تحن بعد.
وبعد
فمن حق القاريء أن يتساءل عن مكان هذه النهاية من موضوعنا الذى اخترناه عنوانا لهذه القراءة ”القتل بين مقامى العبادة والدم”، وليس عندى جواب جاهز، الا أننى تصورت-غير مقتنع تماما- أنه من الجائز أن نجيب محفوظ قد خاف-مثلنا-من البعد الذى اندفع إليه فى البداية يكشف فيه عن داخلنا وداخله، وأنه فى الثلث الأخير من العمل- فيما عدا طاقية الاخفاء-وحتى النهاية قد عاد يخفف عنا (وعنه) من جرعة الرؤية، فتوارى القتل، وتوارى الدم، ولم يبق من وجه العبادة إلا الأمل المنشق، والجنة المسحورة، والندم (الكاثوليكى) على فقدها، وكأنه انتهى بنقض ما بدأ به بشكل أو باخر، قلت: لست مقتنعا بهذا تماما ولكنه ما خطر ببالى حتى هذه اللحظة.
ولا يصح أن أخفى أنى كدت أنكر ما ذهبت إليه مندفعا فى بداية الأمر لأثبت من خلاله الفــرض الذى تقدمه هذه القراءة.. وذلك حين فوجئت بهذه النهاية التقريرية الساكنة، فقلت لنفسي: لعل التناقض النوعى بين النهاية والبداية يرجع إلى إندفاعك فى رؤية ما لم يقصد الكاتب إليه أصلا، وفى نفس الوقت فإننى لم أستطع التراجع، إذ من حقى أن أرى حتى ما لم يره الكاتب أو لم يقصد إليه واعيا، ومن حقى أن أرى اندفاعات ابداعه ثم تردد تراجعه، ومن حقى أن أذهب أبعد منه إن استطعت، وأن أقف دون رؤيته إن عجزت، نعم من حقى كل هذا، أخطأت أم أصبت، وإلا: فلماذا القراءة ؟ ولماذا النقد؟
*****
إلا أنه علينا مهما غاص الإبداع أو اجتهدت القراءة أن نتذكر مع نجيب محفوظ أن ”الوجود أغمض ما فى الوجود” (ص6)، و”أن الإنسان أعظم مما نتصــور” (ص55)
[1] – صدر هذا النقد فى عمل لى فى “قراءات فى نجيب محفوظ” الطبعة الأولى (1990) الهيئة العامة للكتاب، والطبعة الثانية (2005) والطبعة الثالثة (2017) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[2]– أميز بين الانطباع Impression أو المنطبع Imprint حيث أعنى بالأول: الميل الفكرى العام تجاه موقف أو موضوع، فى حين أعنى بالثاني: Imprint المعلومة الـمُـدْخلة بَصْمًا فى أوقات التعلم المأزقى الكياني، التى يتميز بها الطفل والمبدع على حد سواء، لكنها تظل الوظيفة الأهم لنوع من التلقى القادر على تغيير التركيب تمهيدا لإعادة التشكيل.
[3] – يحيى الرخاوى” رأيت فيما يرى النائم” مجلة الانسان والتطور الفصلية عدد أكتوبر (1983) المجلد الرابع -العدد الرابع (ص104-137)
[4] – تسميته بالضمير هو أقرب تسمية شائعة، لكنها غير دقيقة بالمرة، فهو كيان أعقد، وأكثر تلقائية، وأقرب الى صدق الغرائز من الضمير بالمعنى الأخلاقى التأنيبى المعيق.
[5]– أقصد بالجنون هنا تحديدا: تنشيط الداخل البدائى ليعمل مستقلا وعلى حساب الخارج الواقعي.
[6] – Psychic determinism (deterministic causality) أنظر أيضا بالمقارنة: بين استمرار فتحى غانم فى تأكيد هذا النوع من الحتمية السببية فى حين تطور نجيب محفوظ إلى الحتمية الغائية teleological causality، وذلك فى قراءة نقدية للكاتب لرواية “الأفيال” لـ (فتحى غانم) “الحلم .. القبر.. الرحم” مجلة الانسان والتطور الفصلية عدد يوليو (1983) ( ص108-136)
– ثم ظهرت في مجموعة “قراءة فى مستويات وجدل الوعى البشرى .. من خلال النقد الأدبى” (2019) دراسة “الحلم .. القبر.. الرحم في “الأفيال” لـ (فتحى غانم) (ص 81) - منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[7] – يحيى الرخاوى: “قراءة فى مستويات وجدل الوعى البشرى .. من خلال النقد الأدبى” (2019) دراسة “الحلم .. القبر.. الرحم في “الأفيال” لـ (فتحى غانم) (ص 81) - منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[8] – لا تنس أن قمقام هو صنعان الجمالى .
[9] – يتضح ذلك بوضوح فيما بعد، ولكن بالنسبة لجريمة أخري-(ص56) ماذا دفعك إلى ارتكاب جريمتك الشنعاء (قتل خليل الهمذانى الحاكم) فيجيب بوضوح “أن أحقق ارادة الله”.. وسنرجع الى ذلك.
[10] – لولا أن الرواية قد سجلت أنها تمت فى 27/11/ 1979 لكان الارتباط بدراما المنصة وثيقا ومباشرا-مع بعض التحفظ فى التفاصيل-ولكن هذه الإرهاصات بقتل الحاكم، والتأكيد على جانب العبادة فى هذا القتل، مع رفضه باعتباره حلا فرديا.. الخ، كل ذلك هو من تفصيل يعد من قبيل الرؤية الأبعد لحدس الفنان قبل الحدث؟
[11] – يتأكد هذا المعنى فى بداية الحكاية التالية بعد أن تناسخ البلطى فى صورة عبد الله الحمال، إذ يخاطب نفسه القديمة (رأسه المعلقة) قائلا لتبق رمزا على موت الشرير الذى عبث بروحه (ص62).
[12]– كان ظهور سحلول طوال الرواية ثانويا وعابرا، رغم أنه كان يمكن أن يمثل تحديا موقظا فى مقابل لعبة القتل الخطر، ولكنه بالصورة التى ظهر بها خالطا بين مأساة الموت، وتجارة العاديات.. لم يبد بالعمق الكافي.
[13] – وهما شقيقتا الحاكم يوسف الطاهر، والحاكم يعلم بسلوكهما، وقد أعانتاه ماديا قبل ولايته، فتستر عليهما بعدها.
[14] – كذلك لم أفهم الدافع الخاص الذى دفع جلنار أصلا لاختيار عجر رفيقا جنسيا، وهو الثقيل العديم الميزات، ولا يكفى أن نتصور أنها - بذلك- كانت تدبر لجريمة القتل، وكذلك لم يبد أنها هى التى لفظته بعد الجريمة، لكنه عجزه الذى أبعده، وأخيرا فهى الوحيدة التى نسى الكاتب أن يـعدمها قصاصا، وكأن الافتعال الذى أحس به-مثلنا -قد أضجره، فأنساه القاعدة التى اتبعها طول الحكايات… من يدرى ؟
[15] – لم أتطرق لموقع الجنون وأشكاله تفصيلا فى هذة القراءة، وقد أعود إليه فى دراسة مقارنة مع أعمال أخرى لمحفوظ.
[16]– جاء هذا الرد على لسان سحلول، ورفضا لدور سحلول أصلا – دوره كما جاء فى هذا العمل- تصورت أن الأولى أن يـطلق مثل هذا الرد عبدالله المجنون شخصيا.
[17] – التى أخذت تتزايد بدءا من هذا الجزء.
[18] – أعنى بالقناع هنا ما يشير اليه يونج على أنه Persona ولا أعنى به ما قد توحى به الكلمة من خداع أو تظاهر.
[19] – قارن تحطيم هذا القمقم كبت الجنس والعبث والعدوان، بتحطيم قمقم جمصة البلطى لينطلق منه سنجام يدعوه لقتل الظلم، ومن قبله تحطيم كبت والده صنعان لينطلق منه الداخل بتناقضاته وتراوح خبطاته.
*****************
المحتوى
|
العنوان |
الصفحة |
|
الأهـداء |
3 |
|
المقدمة |
5 |
|
الباب الأول غريزة الجنس: من التكاثر إلى التواصل |
7 |
|
الفصل الأول: أصول ومنهج التعرف على ماهية الجنس |
9 |
|
الفصل الثانى: الجنس “فى ذاته” لغة كاملة |
23 |
|
الفصل الثالث: الجنس والجسد |
35 |
|
الفصل الرابع: الجنس وتحرير المرأة |
41 |
|
الفصل الخامس: الانحراف الجنسى |
51 |
|
الملحق (1) (عبر النقد الأدبى) تنويعات فى لغة الجنس ودلالاته: فى رواية “بيع نفس بشرية” الجنس الفيْض – الجنس الصفقة – الجنس اليأس |
65 |
|
الباب الثانى غريزة العدوان: من التفكيك إلى الإبداع |
87 |
|
العدوان وحركية الإبداع |
89 |
|
الملحق (2) (عبر النقد الأدبى) رواية “ليالى ألف ليلة” لــ “نجيب محفوظ” القتل بين مقامـَـىْ العبادة والدم |
123 |
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى

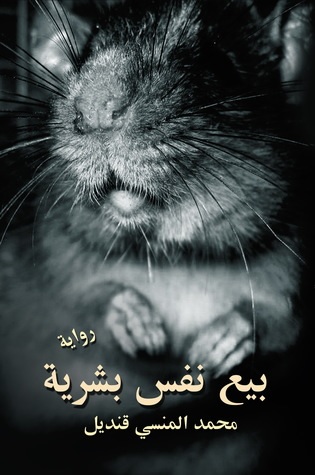


صباح الخير يا مولانا :
المقتطف :…… كذلك لم أفهم الدافع الخاص الذى دفع جلنار أصلا لاختيار عجر رفيقا جنسيا، وهو الثقيل العديم الميزات، ولا يكفى أن نتصور أنها - بذلك- كانت تدبر لجريمة القتل، وكذلك لم يبد أنها هى التى لفظته بعد الجريمة، لكنه عجزه الذى أبعده، وأخيرا فهى الوحيدة التى نسى الكاتب أن يـعدمها قصاصا، وكأن الافتعال الذى أحس به-مثلنا -قد أضجره، فأنساه القاعدة التى اتبعها طول الحكايات… من يدرى…
التعليق : شعرت بالفخر أن كانت لدى هذه التساؤلات ، كلما قرأت هذه الرواية ، التى أعيد قراءتها كل عامين أو ثلاثة ،لكننى وجدت ثمة إجابة فى إحدى القراءات ،فقد قلت لنفسى حينها لعل وجود جلنار نفسه فى الروايه كان موجها لكشف عجر بنهمه وشبقه وطمعه،وجبنه، لم يكن ليحظى بها إلا هكذا !كأنها كانت له مثل ماكان قمقام لصنعان الجمالى، و وسنجام لجمصة البلطى، وأيضا سخربوط وزرمباحه ،للآخرين، كأنها كانت أحد عفاريت الداخل التى انطلقت لتكشف الخارج ،ولكن على نحو مختلف …..
لكن الآن أثير لدى تساؤل جديد : ألا نرى أن هذا ما يحدث فى الحياة نفسها ؟! ألا تكشف لنا عن جانب من دور أحدهم فى حياة إلآخر ،دون أن نعرف باقى الحكاية لكليهما ، ربما ؟!سبحانه خالق الخلق وحده يعلم السر وأخفى . …
صباح الخير يا مولانا :
لا أظن أننى وجدت هذا الكتاب هنا الآن مصادقة، المهم انى فرحت به جدا ، وظللت أتصفحه و أقفز بين عناوينه ،أكاد ألتهمها، سأدخره لأقصى معه سهرتى ،وفرحت جدا لوعدك بتناول الغريزة الثالثة ،والذى أنتظره بفارغ الصبر،مبروك علينا يا مولانا .
المقتطف :
……ومن هنا كنت كلما حَضَرت محاضرة “علمية” فى هذا المنتدى أتساءل:
1- هل هناك فرق يميز هذا اللقاء عن لقاءات “علمية” أخرى.
2- هل استطاع اللقاء (أوالمحاضرة) أن يوصل المعلومة بطريقة مختلفة بحيث تكون “فعلا “/”وعيا”، يمتزج بالوعى العام ويغير السلوك، وليست مجرد إضافة معقلنة تُحفظ وتـُـنسى أو لا تُـنسي.
3- هل كان المخاطـَـب فى المقام الأول هو:الوعى ليتشكل، أم العقل ليتمنطق؟ (باعتبار أن الثقافة العلمية تخاطب الوعى من خلال العقل ولا تكتفى باستعمال الوعى خلفية يقظة لتشحذ به العقل الطاغى سيد المواقف برغم قصوره)
4- وعن ما تبقى بعد هذا اللقاء -إن تبقى شىء-: هل هو تبقى فى وعى الحضور أم فى ذاكرتهم؟ وما الفرق؟
5- وهل سينتقل ما تبقى – تلقائيا ما أمكن- إلى أصحاب المصلحة ؟عامة الناس؟……
التعليق : أخذت هذا المقتطف لأعلق عليه بحديث دار بينى وبين محمد ابنى ،الذى يحرص على حضور فاعليات حضرتك ،كلما سنحت له الفرصة ،وقد دار بيننا الحوار التالى ، عقب حضوره لإحداها (معلقا على تساؤلات الحضور لحضرتك ) :
_تعرفى ايه الفرق بين د.يحيى لما بيتكلم ، وبينكم كلكم ؟!
_فرق السما م العمى طبعا !
_كلكم لما بتتكلموا بتكونوا مهتمين بالكلام اللى عاوزين توصلوه ،هو بيكون مهتم بإيه اللى بيوصل
_!!!!!!!!!!!!!
هذا المقتطف ذكرني بذلك الحوار ،فقلت فى نفسى :
_الواد كان عنده حق