نشرة “الإنسان والتطور”
الأثنين: 30-4-2018
السنة الحادية عشرة
العدد: 3894
من كتاب “هل العلاج النفسى “مـَكـْلـَمـَة” (1)
(فقه العلاقات البشرية) (2)
(عبر ديوان “أغوار النفس”)
الجزء الثانى:
اللوحة السادسة: “قبر رخـام”
مقدمة
لا أعتقد أن رسالة هذه النشرة يمكن أن تصل إلى “من يهمه الأمر”، إلا بعد قراءة نشرة أمس، وعلى ذلك أنصح كل من لم يقرأ نشرة أمس أن يبدأ بقراءتها أولاً إن أراد أن يتابع ما أريد توصيله.
بل إننى أوصى بمن قرأ نشرة أمس أن يعيد قراءتها ثم يواصل نشرة اليوم .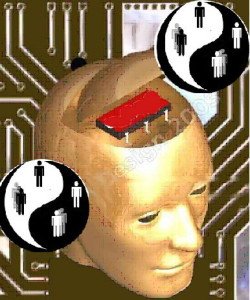
لقد فعلت ذلك شخصياً، واختلف الأمر معى.
عذراً
وشكراً .
…..
…..
استهلال “من الكتاب مباشرة” (2)
إشكالة سياسية أيديولوجية علاجية:
ما تثيره هذه اللوحة يبدو قضية سياسية لسنا فى موقع مناقشتها، ولكن وإن كانت القصيدة تبدو سياسية فى المقام الأول، خاصة بعد تحديثها، إلا أن ما يهمنا هنا هو ذلك الإنسان المريض الذى جاء يعانى وقد سبق أن تورط فى تقديس هذه المبادئ التى بدأت وكأنها تحارب كل “تقديس”، ثم نكتشف أن هذه المبادئ قد استعملها صاحبنا (مثل كثيرين من أصحابها) كدفاعات صلبة راح يتمسك بها، حين قامت بحمايته شخصيا بنجاح، كآلية عامـِيـَةْ أساسا، أكثر منها كموقف أو كمذهب عام قابل للاختبار سعيا إلى إقامة العدل وتحريك التطور على أرض الواقع لكل الناس؟ هذا الشخص كان – غالبا – يستعمل النظرية (الأيديولوجيا) تماما كما يستعمل شخص منغلق متدين يستعمل الدين ليس لتسهيل توصيله إلى الإيمان كدحا إلى وجه الحق، وإنما يستعمله ليستقر فى موقعه بعيدا عن حركية نموه (التى هى موازية – غالبا – لما أسماه كارل يونج: تجربة الرب)، هنا يصبح الدين آلية دفاعية تماما مثلما تصبح الأيديولوجية الاشتراكية آلية دفاعية، وطالما نجحت هذه الآلية هنا أو هناك من قبل أن يمرض صاحبها، أو دون أن يمرض أصلا فليس للطب النفسى ولا العلاج النفسى حق حتى فى مجرد نقدها، إنما ينشأ الإشكال حين يأتى صاحب هذه الآلية (فى الدين الجامد أو الأيديولوجى المقدس)، ويعانى نفسيا، فيجد الطبيب نفسه مضطرا إلى التلميح أن هذه الآلية التى قامت بالواجب فيما قبل المرض، أصبحت معرضة للفحص والنقد وإعادة النظر، مثل أية آلية أخرى.
هنا يقفز عامل آخر، وهو ما ألمحنا إليه فى مواقع أخرى كثيرة، هذا العامل هو: ماذا عن أيديولوجية المعالج نفسه، وكيف يمكن أن تكون عاملا فاعلا بعلمه أو بغير علمه فى مسيرة العلاج، وهل يمكن أن يزعم المعالج أنه محايد فى حين أن داخل داخله قد يحكم على أيديولوجية مريضه هذه بالزيف أو بالفشل أو بالعبث أو بالاغتراب أو بغير ذلك؟
فى البلاد المتقدمة يُتَجَنَّبُ هذا الحرج حين يوصى أن يمتنع الطبيب – بالحرج أو بالعرف أو بالعادة – أن يسأل مريضه عن دينه أو عن توجهه السياسى، وكأن مجرد تجهيل هذه المنطقة عند المريض، مع تصور الطبيب أنه أخفاهما أيضا بالنسبة لنفسه (إيش أدراه؟) يمكن أن يصبح العلاج أكثر موضوعية، طبعا هذا كلام سطحى، ناقشته مكررا كلما تعرضت إلى موضوع استحالة الحياد المطلق فى العلاج النفسى.
إذن ما العمل؟
ليس عندى اهتمام مباشر بالعمل السياسى، وإن كنت – مثل أى شخص يعيش فى مجتمع تنظمه سلطة ما – وبالتالى فأنا حيوان سياسى رغم أنفى، تقفز لى هذه القضية بشكل شخصى حين اضطر، ولو بينى وبين نفسى أن أتساءل عن موقعى الشخصى من هذا المذهب السياسى أو ذاك، وأيضا عن موقفى من هذا النوع من التدين أو ذاك، وهى قضية تحتد حين أواجـَهُ بمريض صاحب مذهب واضح محدد، أو صاحب أسلوب فى التدين راسخ جامد، ثم يأتى يسألنى النصح، فيقفز لى – غالبا – أنه لو كان على صواب فى مذهبه هذا أو فى طريقة تدينه وعلى اتساق معه، لما مـِـرَضَ، ولما جاء يستشيرنى وأسأل نفسى بشكل مباشر أو غير مباشر: أين يقع مذهبه مما حدث له؟
لا يجوز أن يجرى الأمر كذلك، وفى هذه الحالة (حين أضبط نفسى متلبسا بهذا الخطأ)، أتصور أننى كان يمكن أن أعفى نفسى من هذا الحرج بأن أّدعى الحياد، لكننى عادة لا أستطيع، فقد أمارس هذا الزعم ظاهرا وأنا غير متأكد من باطـِنى! فأتقدم خطوة لأعامل هذا الموقف الأيديولوجى الجامد أو طريقة التدين المستقرة بلا حراك، أعامل هذا أو ذاك باعتباره ميكانزما معرضا للاهتزاز مثل أى ميكانزم، وهكذا تنتقل القضية من منافشة المحتوى (مضمون الأيديولوجى، أو مضمون طريقة التدين) إلى البدء بالعمل على إنجاح صاحب أى منهما كما كان ناجحا فى الحفاظ على تماسكه متوازنا غير مريض، فإذا فشلنا، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر، لإطلاق مسيرة النمو، وهو نفس ما نلجأ إليه فى التعامل مع أى ميكانزم.
هناك بـُـعـْـدٌ آخر ينبغى وضعه فى الاعتبار بشأن المريض، قبل وبعد تعلقه بمنظومته الدفاعية: أيديولوجيةً أو دينا، ذلك أن بعض المرضى الذين يحضرون للعلاج يعلنون أن ما ألمّ بهم من مرض أو إعاقة إنما يرجع إلى تدهور قيم المجتمع عامة، والظلم السائد فيه، والاغتراب الغالب عليه، وكذا وكيت، وكأن الحل ليس فى أن يشفوا هم، حتى يستطيعوا أن يواصلوا تغيير ما يعترضون عليه بالثورة أو الإبداع أو الإصلاح أو أى دور يرتضونه، بل إن بعضهم يلح على الطبيب أن يفهم أنه لن ينصلح حال مرضه، ولن يشفى إلا إذا انصلح حال المجتمع، وكأنه بذلك يبلغ الطبيب ضمنا أن مهمته – حتى يشفيه – هى أن يُصلح حال المجتمع، ويقيم العدل، وربما يوزع الأرزاق، طبعا المريض لا يقول هذا صراحة، ولكنه يحيل أية معاناة إلى مثل هذه الأسباب الخارجة عنه، ويلقيها فى وجه الطبيب، وينتظر.
فى كثير من هذه الحالات لاحظتُ كيف تحل المناداة بالمبادئ المثالية، سماوية كانت أم إنسانية، محل الحياة الواقعية اليومية، وتبدو المبادىء التقدمية أو الاشتراكية أو اليسارية أكثر إغراء للشباب من غيرها (أو هكذا كانت تبدوا أيام كتابة النسخة الأولى للقصيدة)، فكنت كثيرا ما أتبين أن المناداة بهذه المبادئ بكل هذا الحماس، وبكل هذا الكلام، حتى فى الموقف العلاجى، هو نوع من إعلان ضمنى بعدم الالتزام بالمشاركة فى تحقيقها، وبرغم ذلك، فقد لاحظت من أصحاب هذه المبادئ أنهم أحيانا يحضرون وعندهم تصور عن أيديولوجية أو دين المعالج (من مقال قرأوه ، أو حديث سمعوه أو شاهدوه، أو خبر تناقلوه… إلخ)، وحين يكتشف الواحد منهم أن المعالج ليس كما تصور (ليس اشتراكيا، ليس مستشيخا، ليس مثاليا… إلخ) تهتز ثقته، وقد يتراجع، أو قد يواصل متحديا المعالج أحيانا، آمِرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر فى أحيان أخرى، وقد تنقلب المسألة العلاجية إلى مناقشات سياسية أو اقتصادية أو فقهية ، لو لم يأخذ الطبيب حذره، وتضيع معالم المهمة العلاجية المهنية، وتبهت محكات قياس التقدم فى العلاج.
وفى العلاج الجمعى
لاحظت فى العلاج الجمعى أن أكثر أفراد العلاج اغترابا عن التفاعل النشط فى “هنا والآن” هم الجاهزون بهذه الأفيشات البراقة، وحين كنت أصر أن أجذب بعضهم إلى اللحظة الراهنة، كان الواحد منهم يكاد يطلق عدوانه بلا هوادة احتجاجا على “رجعيتى”، وقد يشك فى محاولة غسيلى لمخه لأخلع عنه أيديولوجيته.. إالخ” وبالتالى قد يتردد فى وضع الثقة، أو حتى فى استمرار العلاج احتجاجا على بعدى عن التعاليم المقدسة (أيديولوجيا أو دينيا) التى يؤمن هو بها.
وكما يستغرق الشخص الرأسمالى فى جمع المال، ويكتمل اغترابه حين ينسى أن هذا المال ليس إلا وسيلة لتحقيق فرص أوسع لحركية نموه، وإطلاق حيويته، وتأمين وجوده، ومن ثم اكتساب حرية داخلية تعقبها فاعلية الخلق والعطاء، كذلك فإن مثل هذا الشخص يستغرق فى تكريس الأفكار والمبادئ التى تدعم تسلسل المنطق التكاثرى لديه، وتدعم الدفاع النظرى عن أيديولوجيته، فيكتمل اغترابه بالابتعاد المنظم عن ذاته وعن أرض الواقع الفردى، وعن مواجهة مشاكل الوجود الجماعى الحقيقية فى نطاقها الحى، كل هذا قد يكون مقبولا ومفيدا فى مجال آخر غير مجال العلاج، لكن متى ما احتاج الأمر إلى طلب المشورة والمساعدة المهنية، بما فى ذلك من إقرار ضمنىّ باهتزاز هذه الحيلة الأيديولوجية الدفاعية، فإن الحسابات تختلف، والمنهج يختلف، والمحكات تختلف.
حاولت أن أسائل نفسى عن هذه السكينة الظاهرية التى يتحلى بها بعض أصحاب هذه الآراء ووجدتها أحيانا أقرب إلى اللامبالاة نتيجة لـ”تصور” حل كل شيء بمجرد الحديث عنه من منطلق منظومتهم الفكرية وذلك بإعلان أن “كذا هو الحل” (سواء كان كلمة الإسلام – أو الديمقراطية – أو الاشتراكية أو الثورة – أو التنوير.. إلخ)، ليكن، ولكن الأمور لابد أن تختلف حين تظهر أعراض المرض حيث أن المرض قد يكون إعلانا لاهتزاز هذه الأيديولوجيا داخليا، ومن ثَمَّ فهو مطلب ضمنى أن تبدأ المراجعة مع ظهور المعاناة أو أثناء العلاج.
وما يكاد التغيير يعرض نفسه من خلال إحياء حركية الاختبار اليومى عبر المواجهة العلاجية حتى تبدأ وظيفة هذه الأفكار تتعرى، ويلوح أمل فى العوده إلى إطلاق حركية النمو ولو لفرد واحد، الذى هو بمثابة لبنة هامة فى مسيرة النمو الجماعى، ومن ثم العدل، والعمل، والحرية الحقيقية والإبداع… ولكن..!!
وبعـد
القصيدة لا تتناول هنا تفاصيل هذا الموقف العلاجى بشكل مباشر، أو حتى غير مباشر، بل الأرجح أن هذا الموقف قد أثار فى شخصى تحديات تلزمنى أن أعلن رأيى الذى يبدو نقدا سياسيا بشكل أو بآخر، حتى تناولت القصيدة بعض سلبيات تاريخ الثورة (تقريبا)، وشعارات الاشتراكية بدون اشتراكية، والكبت السياسى، والقهر السلطوى، وغسيل المخ، والافتقار إلى الأمان وغير ذلك، لهذا فإن بقية القصيدة لا تحتاج إلى تناول تفصيلىّ، لما يتعلق بآليات العلاج النفسى أو نقده، لهذا فضلت أن أكتفى بتحديد هذه المعالم العامة، واضـِعـًا فى حسابى أن هذا النقد قد يصل إلى أصحاب هذه المبادىء القوية الثابتة بما يسمح لهم أن يصنفونى كما يشاؤون، وهذا وارد ولابد أن أتحمل مسئوليته مادام واقعا.
ثم اختم اليوم بإعادة مقطع ساخر واحد احتراما لكسل الأصدقاء المشروع (غالبا) كعينة ربما تغريه، بعد التخلص من الكسل، بالرجوع لنشرة أمس.
……………..
(5)
“فى الواقعْْ: إن الواقعْْْ، واقعْْ جداً،”
والبنى آدم يادوبْ: مـادّةْْ ْوْتَاِريخْْ،
والتاريخ عَرْكَةْ اللِّى فاز فيها بيْركَبْ
يطلع المـنْـبَـرْ ويخطُبْ:
إلعيال الشغالين هُمَّا اللِّى فيُهمْ،
باسُمُهمْْ نـِـْلَعْن أبو اللِّى خلّفوهـُمْ
”باسْمُهُمْْ كل الحاجات تِبْقى أليسْطَا
والنـِّسـَا تلبس باطِيسْـطَا
والرجال يتحجّـُبوا، عامِلْ وأُسْطَىَ”.
(6)
يعنى كل الناس، عُمُومْ الشعب يَعْنِى :
لمْْ لابد إنه بيتغذّى لِحَدّ ما بَطْنُه تِشْبَـْع.
وامّا يِشْبَعْ يِبْقى لازِمْ إنُّه يسْمَعْ.
وان لَقَى سمْعُه ياعينىِ مِشْ تمامْْ، يِبْقَى يـِرْكـَعْ.
بَسّ يلزَقْ ودْنه عَالأْرضِ كـِيـوَيِّسْ،
وانْ سِمْعِ حاجَةْ تِزَيَّقْ، تبقى جَزْمة حَضْرِةْ الأخ اللِّى
عـيّنْ نَفُسُهْ رَيّسْ،
لاجْلِ ما يْعَوَّضْ لنَاِ حرمَانْ زمَانْ.
إمّالِ ايِهْ ؟!!
واللِّى يشبْع مِنكُو أكل وشُـوفْ،ركوعْ، سمَعَانْ كلامْ،
يِقَدْر يـِنَامْ:
مُطْمَئِنْ،
أو ساعات يقدر يِفِـنْ.
واللى ما يسمعشى يبقى مُخّهُ فوِّتْ،
أو غرابْ على عِشُّه زَنْ.
……….
[1] – يحيى الرخاوى: كتاب (“هل العلاج النفسى “مـَكـْلـَمـَة” سبعة لوحات) (الطبعة الأولى 2018) والكتاب متاح فى مكتبة الأنجلو المصرية وفى منفذ مستشفى دار المقطم للصحة النفسية شارع 10، وفى مركز الرخاوى: 24 شارع 18 من شارع 9 مدينة المقطم.
[2] – كتاب (“هل العلاج النفسى “مـَكـْلـَمـَة” سبعة لوحات) صفحة (121) (الطبعة الأولى 2018)
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى

