مقدمة فى:
العلاج الجمعى
من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق
أ.د. يحيى الرخاوى
2019
الإهداء إلى أبنائى وبناتى وقد تعلمتُ من مثابرتهم، ثم من اشرافى عليهم: أ.د. عماد حمدى غز أ.د. عزة البكرى أ.د. نهى صبرى (المرحومة) د. نجاة النحراوى
الإهداء
الإهداء
مقدمة
مقدمة
مقدمة:
اكتشفت مؤخرا وأنا أقوم بجمع ما تيسر من أعمالى للصدور فى طبعات ورقية أن كثيرا من أطروحاتى الباكرة سواء التى صدرت فى كتب مستقلة أو مقالات متفرقة قد بلغ عمر بعضها أكثر من أربعين سنة، كما أننى لاحظت أن خبرتى الممتدة فى واقع الممارسة طوال ما يزيد عن ستين عاما، قد سمحت لى بدرجة من النقد الذاتى والإضافة والتعديل، برغم بقاء جوهر المسألة راسخا، وهكذا وجدت أنه قد آن الأوان لإعادة النظر وإعادة المحاولة، والتحديث ، والتوضيح والاستشهاد وغير ذلك مما أتاحه الله لى.
ثم إنى قد قمت خلال ذلك بنشر كثير من هذه الأطروحات والأعمال فى النشرات اليومية، فى موقعى (النشرة اليومية “الإنسان والتطور”)([1])، ومن ذلك بعض أجزاء هذا الكتاب وتلقيت تعليقات عن بعضها فى بريد الجمعة، بما أتاح لى أن يتواصل الحوار حول ما ينشر تباعاً متى كان ذلك ممكنا، مما سمح لى بالتعديل مع ظهور هذه الطبعة الورقية.
المفروض أن هذا العمل هو بمثابة تحديث مطول لكتيّب “مقدمة فى العلاج الجمعى”([2])، وهو الكتيب الذى كان قد كتب أساسا كمقدمة لبحث الماجستير الذى قام به الإبن أ.د. عماد حمدى غز سنة 1975 ([3])، ثم أصبح كتيبا مستقلا بعد الاستجابة لاقتراح أ.د. رفعت محفوظ ([4])،، وبرغم أنه ظهر كتيبا محدود الغرض (مقدمة رسالة للماجستير) إلا أنه كان دائما فى محور اهتمامى الأساسى من الناحية العملية فالتنظيرية طوال هذه العقود، كما بلغتنى من كل من قرأه أهمية ما وصله منه على صغره وحدود ظروف نشره السابق.
أثناء مراجعتى له الآن وجدت أن ثلثه الأخير لا يرتبط بالعلاج الجمعى مباشرة بل بالخطوط العريضة لنظريتى الباكرة فى التركيب البشرى التطورى)[5]( ومن ثم العلاج، كما أن أوسطه متعلق بشكل مباشر بالمجموعة العلاجية التى أجرى عليها هذا البحث القديم للحصول على درجة الماجستير، فلم يبق من الكتيب ذى القطع الصغير إلا بعض ملامح تاريخية ومعالم عامة موجزة للخطوط العريضة للمنهج والممارسة.
إن المسألة إذن قد لا تكون تحديث كتيب كتب لغرض خاص فى وقت باكر، خاصة بعد أن صدرت سلسلة كتبى “فقه العلاقات البشرية” لوحات تشكيليلة من العلاج النفسى والحياة([6])، وكان أغلبه من واقع ممارسة خبراتية جماعية لما يسمى مجموعة المواجهة Encounter group التى سجلت خبرتى معها من واقع عملى خبراتى، سجلتها أولا شعرا بالعامية المصرية ثم شرحا في الأعمال السالفة الذكر.
هذا الكتاب الحالى ليس طبعة ثانية للكتيب الأول الذى أعتبره مجرد نقطة انطلاق لتسجيل بعض ما وصلنى من تقنيات، وشواهد عملية لطبيعى وصعوبات البحث فى هذا المجال.
هذا، ويبدو أننى قد بدأت جمع أعمالى لنشرها ورقيا ومن أهمها خبرتى في العلاج الجمعى بعد أن وصلنى منه ما أنار لى طريقى إلى عدد من المنظومات والحقائق وأنا أكتب فى “الإدراك”([7]) بالذات، مثلا عن الوعى الجمعى، والوعى المطلق إلى الوعى الغيب إلى معرفة الله.
كررت مرارا ومن البداية أن الممارسة كانت مصدرى الأساسى، وكانت أهم مجالات الممارسة هو العلاج الجمعى بوجه خاص، مع هذه العينات من المرضى والمتدربين طوال نيف وأربعين سنة فى قصر العينى ممثلة للطبقة الوسطى والأدنى من الشعب المصرى، فإذا كان ذلك الكتيب المقدمة قد ظهر من واقع خبرة مجموعة علاجية واحدة لعام وبعض عام، فماذا يمكن أن تكون الحال الآن (49 سنة X 52 أسبوعX متوسط عشرة مرضى ومتدربين اثنين على الأقل؟ يطرح منها الأجازات الرسمية فقط)!! بالإضافة إلى ما تيسر من ممارسات فى عيادتى الخاصة، ومستشفى “علاج الوسط” (المقطم) الذى أتولى مسئولية التدريب والتخطيط فيه؟!!!؟ هذا علما بأنه قد تم تسجيل معظم جلسات العلاج بالموقع الأساسى والمصدر الأهم لهذه الخبرة، وهو قسم الطب النفسى بكلية الطب قصر العينى، وذلك بإذن صريح موثق من المشاركين، وذلك بالجهود الذاتية البدائية بالصوت والصورة طوال العشرين سنة الأخيرة تقريبا، ولكنه تسجيل تنقصه الحرفية والإتقان، والفضل فيه من حيث المبدأ، يرجع إلى الابن د. أسامة رفعت، ولا أعرف كيف يمكن الاستفادة العلمية والتدريبية من هذه التسجيلات لتوصيل بقية الرسالة، ولعل الابن د. أسامة وزملاءه يتولون هذه المهمة فيما بعد، والله المستعان!
ثم أخيرا وليس آخراً تصادف أن أنشأت ابنتى أ.د. منى يحيى الرخاوى هى وزميلاتها وزملائها أد. نهى صبرى، د. مها وصفى، ود. دلال عامر، د. أحمد ضبيع… بدعم ورعاية أ.د. رفعت محفوظ & أ.د. عماد حمدى، وكل المجتهدين والمجتهدات من المشاركين والمشاركات، أنشأوا “الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية” التى ولدت نشيطة فتيّه وممتدة ومستمرة ومتواصلة مع مثيلاتها فى العالم، حتى اختيرت أ.د. منى عضو مجلس إدراة فى الجمعية العالمية للعلاج الجمعى سنة 2012 وحتى الآن، وقد طلب منى معظم أعضاء هذه الجمعية وعلى رأسهم أ.د. نهى صبرى، وأ.د. منى يحيى، أن أكتب خبرتى فى هذا العلاج من واقع ثقافتنا تحديدا، فلعل هذا العمل الحالى يكون بداية لما يحقق بعض ما يرجون.
مقدمة الكتيب الأصل سنة (1976): بقلم د. رفعت محفوظ محمود:
كتب الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى هذه المقدمة لغرض محدد، وهو تقديم بحث قام بالإشراف عليه وأعده أحد تلاميذه، وهو الدكتور عماد حمدى غز، وذلك عن “العلاج الجمعى: دراسة دينامية لاتجاه مصرى”، ثم عرضها علينا – تلاميذه – الواحد تلو الآخر كما يفعل فى أغلب ما يكتب قبل أن يدفع به إلى النشر، وإذا بنا نفاجأ بأن هذه الأفكار-التى كثيراً ما طلبنا منه نشرها – أمامنا مكدسة وراء بعضها فى تسلسل قائم بذاته يكاد يستقل حتى لينفصل عن البحث المراد تقديمه، وأصبحنا، وأصبحت أنا بوجه خاص فى حيرة، وعرضت عليه رأيى ألا تكون هذه المقدمة لبحث خاص، وأن يزيدها وينقحها ويكتب لنا وللناس كتابا عن العلاج النفسى الجمعى يضع فيه ولو الخطوط العريضة لخبرته وعلمه كما يعدنا دائما، ووافق من حيث المبدأ، ووعد خيراً، ولعلمنا المسبق بانشغاله، وطبعه، لم نأمن لهذا الوعد فأردنا منه التزاما، فاعتذر مرحليا، وحاولنا اختبار الموقف عمليا بأن طلبنا منه أن يكتب تقديما موجزا لبحث الزميل الدكتور عماد غز، ففعل ذلك … وأشار أن ينشر هذا التقديم هكذا، ولا مانع من أن يعاد نشره ضمن كتاب أكبر يصدر لاحقا…
وراجعت نفسى ووعوده السابقة وأيقنت أن الوعد غير الموقوت قد لا يعنى شيئا حسب سابق خبرتى معه..، وقلت لعل أفضل ما يمكن هو أن نقدم هذه المقدمة على مستوى آخر لأعداد أكبر مستقلة فى ذاتها .. وليكتب هو ما يريد فيما بعد، وأملنا أن تحقق هذه الخطوة مطلبين …
الأول: إحراجه حتى لا يتراجع
الثانى: توصيل بعض ما يمكن توصيله فى حينه إلى الناس دون انتظار.
ولم يخف علينا ما فى ذلك من مخاطرة إذ قد يحس القارئ أن الخاص (وهو تقديم بحث بذاته) أصبح عاما دون مراعاة للفرق بينهما، إلا أننا أدركنا بعد المراجعة المتأنية أن هذا لن يضير العمل شيئاً، وأن كل إشارة خاصة يمكن أن تـُـفهم دون الرجوع إلى البحث مباشرة، وكذلك فإنها قد تصلح لأى بحث من هذا القبيل دون الارتباط بهذا البحث بوجه خاص.
قد يكون فى هذه المحاولة بهذه الطريقة مالم يألفه القارئ، ولكن من ذا يستطيع أن يجزم أن المألوف هو الأفضل؟.
د. رفعت محفوظ محمود
وبعد
انتهى هذا الكتاب الحالى إلى أن يكون هو الأول من سلسلة كتب “عن العلاج الجمعى”، وآمل أن يلى كل ذلك عدد مناسب فى نفس الموضوع ربما أمكن الإحاطة ببعض هذه الخبرة الممتدة، علماً بأن الجزء الثانى من ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط” بعنوان “مدرسة العراة”([8])، وكذلك سلسلة “فقه العلاقات البشرية” بأجزائها الأربعة([9])، مستوحاة من خبرة العلاج الجمعى أساسا.
المقطم فى: 2 / 2 / 2020
[1]– www.rakhawy.net
[2] – يحيى الرخاوى: “مقدمة فى العلاج الجمعى” (عن البحث فى النفس والحياة) نشر فى 1978.
[3] – هو حاليا أستاذ متفرغ بقسم الطب النفسى كلية الطب قصر العينى، بعد أن أحيل إلى المعاش رئيسا للقسم لمدة ستة سنوات أرسى فيها دعائم القسم الجديد شكلا وموضوعا جزاه، الله عنا خيرا، ثم عين رئيسا لجامعة “دراية” بالمنيا.
[4] – هو حاليا أستاذ متفرغ بقسم الأمراض العصبية والنفسية كلية الطب جامعة المنيا، وهو بالمعاش أيضا بعد أن أنشأ القسم، كما أسس مدرسة “المنيا” للعلاج الجمعى ونحج فى قبول تحدى إشاعة أن مصر العليا لا تصلح لمثل ذلك، ثم أصبح الداعم الرئيسى للجمعية المصرية للعلاجات الجماعية.
[5] -النظرية التطورية الإيقاعحيوية Evolutionary Biorhythmic Theory
[6] – يحيى الرخاوى،”سلسلة فقه العلاقات البشرية”، الكتاب الأول: “العلاج النفسى (مقدمة) بين الشائع والإعلام والعلم والناس”، الكتاب الثانى: “هل العلاج النفسى “مَكْـلـَمَة”؟ (سبع لوحات)”، الكتاب الثالث: “قراءة فى عيون الناس (خمس عشرة لوحة)”، الكتاب الرابع: “قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى (2018)
[7] – يحيى الرخاوى: الأساس فى الطب النفسى ملف “الإدراك” نشـرات الإنسان والتطور اليومية:
(من 10/1/2012 إلى 10/3/2013) www.rakhawy.net
[8] – يحيى الرخاوى: رواية “مدرسة العراة” الجزء الثانى من ثلاثية “المشى على الصراط” الرواية الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1980 (الطبعة الأولى 1978، الطبعة الثانية 2008، الطبعة الثالثة 2018).
[9] – أنظر هامش رقم (6)
الفصل الأول: معالم أساسية وتاريخ
الفصل الأول: معالم أساسية وتاريخ
الفصل الأول: معالم أساسية، وتاريخ
أولاً: إختيار البحث
إن الطب النفسى الوصفى لم يزدهر إلا من خلال بعدين أساسيين:
أولا: تنمية الحدس الإكلينيكى، وثانيا: الوصف التسجيلى الأمين
… وبالتالى ينبغى أن يكون البحث العلمى فى فرعنا هذا ملتزماً أساساً بهذين البعدين، لا حكراً على تعداد الأرقام أو وفرة الأعداد (وإن كان لا غنى له عنهما).. وإنما يتحقق هذا الالتزام بالعمل على إعداد باحث أمين .. وتحديد فرض عامل .. وتسجيل ملاحظة يقظة. ثم بعد ذلك يأتى التفسير وإعادة التفسير وإعادة تفسير التفسير.. الخ، فمرحلة التفسير مفتوحة دائماً وإلى أبعد مدى.
وبديهى أن هذا الاتجاه الإكلينيكى الذى أحاول أن أؤكده بإلحاح، يكاد يصل إلى حد الإملال، ليس بديلا عن الأبحاث السلوكية المفصلة .. ولكنه الأصل دائما.
هذا البحث هو من نوع تسجيل الملاحظات أساساً ثم تفسيرها، وهو يعلن ضمناً أن إلزام إعادة التجربة مرفوض فى مجالنا هذا لأنه مستحيل، وأن العينة الضابطة مرفوضة أيضاً لأنها تكاد تكون خدعة، فالإنسان كائن فريد ليس كمثله آخر، وهو كائن متغير بالضرورة، متطور (أو متدهور بطبيعته)، هادفٌ واعٍ..، وقد أكدت هذه المقولات التى تعطى لعملنا وضعاً فريداً ضرورة البحث عن منهج للبحث العلمى خاص به، وقد تصاعد رفض فكرة “إعادة التجربة” و”العينة الضابطة” حتى أنى علمت مؤخراً أن آباء التداوى بالعقاقير النفسية فى معمل السيكوفارما كولوجى فى باريس (تحت رئاسة الأستاذ الدكتور “دينيكير” .. ومن قبله “ديلاى” مكتشفى عقار اللارجا كتيل) قد أعلنوا رفض إلحاح شركات الأدوية على الالتزام بهذه البدعة السخفية وهى بدعة “العينة الضابطة”..، فإذا كان ذلك فى مجال تقييم آثار العقاقير الفارماكولوجية، فهو أهم وأصدق فى مجال ملاحظة السلوك الإنسانى وتحديد قواه وتفسير جوانبه فى واقع الممارسة الإكلينيكية.. ومن ضمنها العلاج النفسى عامة، والعلاج الجمعى بشكل خاص.
ولكن هذا البحث أيضا يحاول – كما أعلن من ضمن أهدافه – تقييم طريقة ما فى العلاج النفسى، ويبدو أنه اثار بطريقة غير مباشرة: أننا ونحن فى سبيلنا إلى البحث والتحرى والتقدير لابد وأن نعرف “ماذا” نقيس، قبل أن نتناقش فى “كم” نقيس، فكثير من الأبحاث والآراء والنقد والتقييم يدور حول كمّ شئ لم تتحدد معامله تماما ولا نهائيا، فهى دراسات تجرى عادة لتجميع تلك الأبحاث المقارنة لتفضيل نوع معين من العلاج على نوع آخر(!!) إن أى ممارس للعلاج النفسى بأى درجة من الصدق أو العمق، يعرف ماذا تعنى كلمة “تقييم” لما يفعل، فإذا كان مصدر التقييم هو المريض: فدفاعاته قد تكون هى الحكم الأول وربما الأخير، ففى الوقت الذى قد يعتبر المريض نفسه قد “شفى والحمد لله” قد يضع المعالج يده على قلبه إذ هو يعرف تماماً أن المريض قد يكون بهذا هارباً إلى “مظهر الصحة” خوفاً من مخاطر التغيير، فهذا المريض الذى سنأخذ إجابته لصالح العلاج قد نجد طبيبه أحيانا – إن كان يقظا – يتحسب لاحتمال نكسة صريحة (بعودة الأعراض) أو نكسة خفية (بانحدار مستوى تكيفه ونبضه العاطفى وإبداعه واختراقه للحياة).
أنتهـِى إلى القول أننا إذا قلنا أن هذا النوع من العلاج أفضل من ذاك النوع دون أن نحدد بالقوة المكبرة معنى “أفضل“، وما هو الهدف من المسيرة العلاجية (ومن الحياة) نكون قد وقعنا فى مزلق استعمال أساليب علمية (بل شبه علمية) لتبرير جمود لاحضارى دون وعى أو مسئولية، ولعل كل من يقيـّـم طريقة للعلاج من هذا النوع بهذا الأسلوب يندرج إما تحت لافتة “المريدين” أو لافتة “الخائفين” (راجع الحماس للتحليل النفسى من المريدين، والهجوم عليه من الخائفين)، ومن هنا بدأ اعتراضى الأول على القائم بهذا البحث حين عرض علىّ فكرة البحث وخاصة أنه كان بشأن اختياره كجزء لازم للتقدم للحصول على درجة الماجستير … ومعنى ذلك أنه سيـُـقدم إلى جهة رسمية، للحصول على إجازة رسمية، فى وقت محدد…
وقد حاولت – لذلك – أن أثنى الباحث عن عزمه مراراً – رغم رغبتى الحقيقية فى أن يصرّ على المغامرة – إلا أنه وحده دون جميع المجتمعين أصر على خوض التجربة، وكانت ذريعته حينئذاك “.. لابد أن أكون واضحاً مع نفسى، ومحدداً فى اختيارى، ومنذ البداية ..، وما دمت قد اخترت هذا المجال مهنة وطريق معرفة .. فليكن بحثى فى مجالى دون تلكؤ…” ولا أنكر أنى قد تخوفـت من هذه اللهجة الواضحة المتحمسة، ولكن ما أثنانى عن الحيلولة الفعلية دون قيامه بالبحث هو ما تذكرته من حماسى فى أول شبابى العلمى تحت إشراف أستاذى الدكتور عبد العزيز عسكر حين كان أول بحث قمت به هو “تبريد مرضى الفصام” حوالى عشر درجات مئوية بما يحمل ذلك من مخاطر عضوية جسيمة، ومرت التجربة بسلامة وفائدة وإنارة، وها هو تلميذ لى يكرر هذا الحماس بما يحمل من مخاطر المواجهة العنيفة.. ليس فى داخل المرضى فحسب، بل فى داخل المعالج والباحث نفسه، إذ أن الجرعة البصيرية اللازمة لإجراء مثل هذا البحث بأمانة كانت فى تقديرى أكبر من احتمال شاب فى مستهل حياته، لكل هذا تماديت فى محاولة إثنائه عن عزمه كما تمادى زملاؤه فى نفس الاتجاه.. إلا أنه مضى فى إصراره، وحين يصر شاب على أمر قابل للاختبار فإنى لابد أن أرضخ، ذلك لأن إصراره يزيد مسئوليته عن نتائج محاولته، ثم إنه يتيح لى – ولنا – من خلال ذلك فرصة التجربة رغم المحاذير المبدئية الموضوعية، .. إلا أن رضوخى كان مهزوزاً، فقد عدت فترددت مرة أخرى حين أمعنت النظر فى تفاصيل البحث الذى سيقوم به، حيث أنى “شخصياً” من ضمن مادة بحثه، فأنا المعالج الذى يجرى عليه البحث مثله مثل المرضى وهو المعالج المساعد، وفى نفس الوقت أنا المشرف على نفس البحث .. والأدهى من ذلك فأنا أستاذ الطالب، ليس فقط فى مجال البحث بل وفى غير ذلك من المجالات، فضلا عن بعد رابع أهم وأخطر وهو العلاقة الوجدانية التى تربطنى بالباحث وتربطه بى .. سلبا وإيجاباً، بوعى أو بغير ذلك، فكيف بالله أتصور لبحث أقوم فيه بكل هذه الأدوار مجتمعة أن يقترب بدرجة كافية من الموضوعية..؟!
وقد عرضت مخاوفى – ثانية بعد بداية البحث – على الباحث وزملائه، وأصر الباحث أن يكمل الطريق الذى اختاره ليعلن للناس، وأهل العلم، ومحبى المعرفة ما يرى ويتصور أنه لازم أن يقال : إذْ يوصّـل لهم رؤيته بكل مالها وما عليها، وتمادى فى ذلك متهماً إياى أنى لو استمررت على هذا التردد فقد تبدأ مثل هذه التجربة العلاجية معى، وتموت معى .. إما بموتى أو بيأسى وعجزى، وكنت أحس من خلال مناقشاتنا أنهم يرون – كما أرى – فيما يجرى شيئاً جديداً، وأنى أحمل أمانة ينبغى أن تؤدَّى إلى أهلها –الناس والعلم– باللغة المشتركة … وبإعلان الجارى بالقدر الموضوعى الممكن، .. وليس بالاستسهال الهروبى الجزئى، ولا أنكر أن كل هذا قد أدخل الطمأنينة إلى قلبى .. ليس بالنسبة لهذه التجربة فحسب، بل بالنسبة لبقية أفكارى التى اختلطت بلحمى ودمى ولم يُؤذن لها فى الخروج إلى الكافة بعد …، وإنما أختصُّ بها مـَـنْ حولى فى مجالات التدريب والإشراف والدراسات العليا والبحث فحسب، وتذكرت أمثلة فى التاريخ – تاريخ علمنا – مثل هارى ستاك سوليفان، وأدولف ماير … إذ لم يكتـُبُ أىٌّ منهما أفكاره مباشرة فى الأغلب، وإنما نقل تلاميذ كل منهما أغلب نظرياته وفكره.. وقلت لنفسى فى خبث من يبالغ فى قدر نفسه: لعل فكرك الذى هو زاوية رؤيتك للحقيقة لن يموت بموتك .. أو حتى عجزك .. أو يأسك.
هكذا، أصر الباحث على القيام بالبحث الذى اختاره، وقاومته بالقدر الذى استطعت به أن ألجم موافقتى الداخلية، وانتصر هو و”داخلى” على مخاوفى وحساباتى .. وبدأ البحث .. لأعتبره – كما سأخلـُص فى النهاية – أنه ليس تقييما موضوعياً لطريقة علاج بذاتها (الأمر الذى أوضحت استحالته لأى طريقة .. كما سأزيد ذلك تفصيلاً)، وإنما هو وصف لما يجرى فى محاولة علاجية جديدة .. ليشمل هذا الوصف ما يجرى خارجنا، وما يجرى داخل وعى الباحثين فى نفس الوقت، بدرجة مختلطة إذ لا يمكن فصلهما عن بعضهما .. (وسوف أرجع إلى هذه النقطة بالتفصيل حين أتناول طريقة البحث).
وقد تصورت – وأمِلت – أن يكون لهذا البحث بالإضافة إلى ما أعلن من أهداف محددة – فوائد علمية أخرى منها على حد تقديرى:
1- أننا قد نتشجع ونتغلب على مرحلة أخرى من الشعور بالنقص لنثبت لأنفسنا أولا، وللعالم من حولنا، ثم ربما للعالم أجمع، أننا لسنا اقل من غيرنا، وأن الفكر المصرى والطب النفسى المصرى لهما أصالتهما ومكانهما فى مسيرة العلم والمعرفة، ثم ها نحن كمصريين ندلى بما عندنا فى العلاج النفسى فى أحدث صوره المعاصره – “العلاج الجمعى” – دون تردد.
2- أن يثق شباب الباحثين عندنا فى أن البحث العلمى بمعناه الأخلاقى والإبداعى معاً، ممكن ومتاح، وأن حكمة البحث العلمى ليست حكراً على الفكر المغترب، أو على الدفاع ضد إثارة الشكوك حول الباحث كأداة بحث، وأن نضرب لهم مثلاً حياً يشير إلى أن الأداة البشرية – على قصورها– قادرة على البحث والملاحظة والاستدلال وعلى الإسهام فى توضيح جانب من جوانب الحقيقة.
3- أن نحدد – بحثاً وتدويناً – بعض معالم ذواتنا بعيوبها ومزاياها، بحيث نستطيع أن نتبادلها – محددة – مع الآخرين، فى كل مجالات العلم فى الداخل والخارج، فيتعرفوا علينا من خلالها – لا من خلال تصوراتهم -، وينقدونا من واقعها فنتحول ونتطور ونسابق من خلال الاحتكاك والمناقشة، وبالتالى نكون قد تخطينا مرحلة النقل والتقليد إلى مرحلة الاحتكاك والحوار.
ثانياً: تاريخ التجربة
أما بالنسبة لموضوع البحث وهو “العلاج الجمعى: دراسة اتجاه مصرى” فإن له قصة طويلة معى لا أعتقد أن هذا مجال ذكرها تفصيلاً – وقد أرجع إليها حين أكتب بنفسى – إذا قدر لى – عن العلاج الجمعى من واقع خبرتى([1]) ووجهة نظرى، ولكنى هنا لابد أن أسرد تاريخاً قصيراً ألمَح إليه الباحث فى بضع سطور حين عرج على العلاج الجمعى فى مصر.
ولعل فى هذا التاريخ الموجز ما يفسر أن هذا الاتجاه “مصرى”، كما أنه قد يوضح للقارئ كيفية ارتباط علمنا هذا بوجه خاص بذواتنا وتجربتنا وثقافتنا الشخصية.
ويمكن أن أرجع هذه الطريقة العلاجية قيد البحث إلى ثلاث مصادر أساسية:
1- خبرة “شخصية” موازية.
2- خبرة مهنية طويلة فى العلاج النفسى عامةً.
3- بعض القراءات فى الموضوع.
4- أرضية ثقافية خاصة بمجتمعنا بالذات.
لمحة من الخبرة الشخصية:
بدأت التجربة بداية شخصية تماماً حين أردت مع صديق عزيز علىّ جداً أن نرتقى بلقاءاتنا الخاصة من مرحلة “الاتئناس وقتل الوقت” (أو ما يسميه إريك بيرن “لعبة الثرثرة”) إلى مرحلة المساعدة الجادة لبعضنا البعض..، وكانت لدينا الشجاعة حينذاك أن نلتقط الخيط من بعض معاناتنا .. ومشاركة زوجاتنا..، وبديهى أنه فى مثل هذا الموقف تبدا المجموعة المسماة مجموعة المواجهة Encountor group “المجموعة بلا قائد” Leaderless Group، وكان ذلك فى عام 1971، وتصادف أن ذلك كل قد حدث عقب خبرة الحدْس العلمى الذى أشرت إليه فى كتابى “حيرة طبيب نفسى”، والذى فزعت فيه إلى صديق وزميل (ولم أجده، ثم إلى زوجتى كما ورد فى كتابى حيرة طبيب نفسى([2])، بما صاحب ذلك من لهفة ملحة إلى أن أجد من يقبلنى ويصبر على الفكرة الجديدة قبل أن يسارع بالحكم عليها أو علىّ!!
التعليق: (فبراير 2013)
توقفت فجأة، وحاولت أن أتذكر تلك الفكرة الباكرة وكيف ولدت، وهل يا ترى لها علاقة بالعلاج الجمعى، أو على الأقل بهذه الفقرة التى أسميتها “الخبرة الشخصية”، فلم أستطع أن أحدد أية فكرة كانت بالضبط، فقلت أرجع إلى كتابى التى ذكرت فيه “حيرة طبيب نفسى”، فوجدتها تشغل الفصل الأخير على قصره، وتصورت أن من حق القارئ وحقى أن أعرض هذه العينة الباكرة التى يرجع تاريخها إلى أكثر من أربعين سنة، مع أن علاقتها بالعلاج الجمعى تبدو ضعيفة، لكننى حين أعدت قراءتها ، وراجعت ما وصلنى من هذا العلاج، وجدت ارتباطا وثيقا، خاصة وأنها ظهرت سنة 1971، وهى نفس السنة التى بدأت أمارس فيها العلاج الجمعى بانتظام أسبوعى حتى هذه اللحظة، قررت الآن برغم مقاومة شديدة خوفا من الاستطرادات التى تنحرف بالمسار أن اثبتها كما جاءت فى هذا الكتاب بالنص دون تغيير حرف واحد، خاصة وأنها تحوى جانبا مهما من علاقتى بالزميل الصديق الكريم أ.د. محمد شعلان، وهو أحد أهم افراد المجموعة التى أشرت إليها حالا، وسأرجع إليها فى حينها.
ثم قد أعتذر على حشر هذا الاستطراد إن لزم الاعتذار.
وها هى ذى :
…..
فى يوم الإثنين الثانى عشر من أبريل الماضى (1971)، وكنت جالسا مع مريض صديق بعيادتى الخاصة، أستمع إليه ولا أستمع إليه، وجدت أن الأمور المتناقضة جميعا قد ارتبطت ببعضها البعض فجأة، وأن كل الأضداد (أو معظمها) استدارت من موقف المواجهة إلى موقف التماسك والتآلف، وارتبط الانسان الفرد بالإنسان النوع، واستقر الأنا الهارب والأنا الناكص والأنا المنقسم (التعابير من الفكر التحليلى الجديد: العلاقة بالموضوع) فى قاع خلايا المخ، وصعد فرويد إلى أعلى طبقات النفس وأكثزها سطحية، وكأن كل شئ أشرق فجأة… وتفاهمت الكيمياء مع الكهرباء مع التحليل النفسى مع التطور. وتعجبت من كل هذا.. فرحت به، وخفت منه فى نفس الوقت، واتصلت تليفونيا بزميل صديق، فلم أجده..، وانطلقت أشرح أفكارى للصديق المريض أمامي- بلغة قريبة منه ومن مشكلته- وكان للجديد وقع عنيف علىّ… ولكن الصديق المريض قال لى: “ما أنا عارف”، وعجبت، وتذكرت حقيقة قديمة وهى أن الأصدقاء المرضى يعرفون النفس أدق وأصدق من كل النظريات، وذهبت آخر النهار لزميلى الصديق الطبيب المختص ومعى زوجتى… ولم أجده لا هو، ولا زوجته الصديقة المتخصصة فى علم النفس، ولم أستطع الصمت، وأخرجت ورقا من مكتبه وانطلقت طوال أكثر من ساعة أشرح لزوجتى الفكرة وأرسمها على الورق وأربط الأفكار ببعضها البعض.. ولا أعرف إن كانت قد أدركتْ التفاصيل أم لا.. ولكنها كانت تتابع أفكارى غالبا بقدر من الحب يشجعنى أن أقول مالا يعنيها دون حرج..، وحين حضر زميلى وزوجته تواعدنا أن أشرح له الفكرة فيما بعد..، وخلال أيام كنت أعيد القصة عليهما مع زوجتى من أولها لآخرها… وسألتهم هل هناك جديد؟ فقالوا: ”يبدو ذلك…”
وفى ليلة تالية حلمت أنى أكتب خطابا لصديقى “بيير برينتـّى” فى باريس الذى قال تعليقه عن الشئ الـ “ما” الذى ينبغى أن أهب حياتى له، واستيقظت فى جوف الليل وأخذت أكتب له وأكتب حتى أكملت أكثر من عشر صفحات، وأرسلتها فورا دون أن أحتفظ بنسخة، ولم يرد (ولا أدرى حتى الآن إن كان خطابى قد وصل، وخجل أن يسفه آرائى فى الرد، أم أن رجال البريد أحسوا بثقل وزنه فتخففوا من جهد توصيله).
واستمررت بعد ذلك أمارس المهنة، ولكنى وجدت أن الأسماء القديمة تعوق فهمى أكثر وأكثر، وأن الفكرة الجديدة تلح علىّ فى أن أبحث عن أسماء جديدة، وفعلت…، ووجدت أن هذه الفكرة أكثر تقبلا وفهما من التعقيدات الشديدة والألغاز التى كنا نحاول أن نفهم بها الانسان المريض، ووجدت أنه حتى العلاج أخذ طابعا آخر ومراحل أخرى، أصبح أوضح وأبسط وأسرع وأكثر ترابطا.
وطبعا شككت فى كل ذلك، ولم يشكّ فيه مرضاى ولا زملائى (الصغارمنهم بوجه خاص) وقلت أبدا: هذه صحوة من صحوات الحيرة أردت بها أن أهدئ من حيرتى فترة ما، وأن هذه الفكرة موجودة من قديم وقد انجلت فجأة… هذه هى كل الحكاية… لابد أنى قرأتها يوما.. أو أنى سأقرؤها يوما…
وذهبت أبحث عنها فى كل ما تصل إليه عينى مما قرأت، وذهبت أناقشها مع كل من أثق فى سعة إطلاعهم، ووجدت جزئياتها موجودة فعلا، ولكنها ليست موجودة إطلاقا ككل متكامل…، قال بها “فرويد” عندما تحدث عن غريزة الموت والحياة، (وليس قبل ذلك!) وقال بها يونج وهو يغوص فى اللاشعور الجمعى، وفى حديثه عن تاريخ الانسان النوع وضرورة تحقيق ذاته، وعن “تجربة الرب” وقال بها “إريك اريكسون” وهو يضع الانسان فى تطوره الاجتماعى وكأنه عدة أناس بعضهم فوق بعض، وقال بها ساندور رادو، وإريك فروم، وكارين هورنى وفيربرن وجنترب وهنرى إى وزرادشت ونيتشه وبرجسون وبرناردشو وكل الناس.
ولم يقلها أحد.
وكنت حين أقرأ بالانجليزية ونادرا بالفرنسية ولا أجد هذه الفكرة، أقول لنفسى لابد أنها كتبت بالألمانى، فهناك الأصالة والتطور وأنا لاأعرف الألمانية، إذن فلا جديد، ولكنه بالرغم منى، بدا لى كل شئ جديدا، وبعد شهور طويلة حين استقرت الأشياء وأخذت الأسماء الجديدة مواضعها التقريبية، كتبت إلى زميلى وصديقى الدكتور محمد شعلان فى الولايات المتحدة الأمريكية خطابا سيئا للغاية حاولت أن أقدم له الفكرة ببعض التفاصيل، وبعد أن شرحت فيه وجهة نظرى فى أن انتشار فرويد لم يكن لأصالته، وإنما لحاجة الناس إلى تبرير توقفهم التطوري- أو تدهورهم- خلال القرن التاسع عشر ([3]) قلت له:
”يا محمد: إما أن نساهم إراديا فى التطور أو نموت، والمسألة تحتاج إلى حوار متصل، ولكنها لاتحتاج- فى نظري- إلى تحليل منظم، المسألة تحتاج إلى حب جارف، وصدق، وتقشف نفسى، وتصوف، وإيمان بالأصل، وبالاستمرار، ويقين بالغد، وبكل ماهو أصيل… وأين هذا كله؟ هو موجود عبر التاريخ، وهو الذى يجعلنا نفخر بأن ننتمى إلى هذا الجنس من المخلوقات…. ليس هناك جديد بمعنى الجديد، وإنما الجديد هو فى إعادة تنظيم القديم، أنا لاأشك أن هناك حوالى ألف أو قل مائة- فى مجال الطب النفسى فقط- يفكرون فيما أفكر فيه الآن، أنا لاأشك أنى إن لم أكتب مايدور فى وجداني- الشئ الذى يلح على فيه البعض الآن- لاأشك أن غيرى سيكتبه، وربما أفضل، وحين أرسلت إليك مقالتى عن الصحة النفسية قدمت لها أقترح أن تعتبرها نوعا من الضلال المنظم Systematized delusion، فإذا كان الضلال ماهو إلا دفاع ضد الجنون المطبق، فقد أطبق، إلا إذا أردت أن تعتبر أن هذا الجنون فى خدمة الذات والتطور.. إذن فهو الخلق..
هل آن الأوان أن أحدثك عن هذا الذى كان؟. فليكن..
الآن: ماهو موقفنا من المرض النفسى وتقسيماته وعلاجه؟
راجع التقسيم الدولى والأمريكى وغيرهما وتعجب للمرحلة المتواضعة التى تجمـَّـدنا عندها…، ثم راجع محاولة فهم المخ بالتفاعلات الكيميائية وفقط، وستجد تقلصات العلماء فى المعامل تشبه تشنجات فئران التجارب، وهم يحاولون تعميم ما على الفأر على الإنسان…، ثم راجع الموقف الأبله فى تفسير الصدمات الكهربائية بالرغم من اعترافى بأنها…. ذات مفعول رائع إذا أحسنـّـا استخدامها، ثم راجع النظريات السيكوباثولوجية وعدم ارتباطها ببعضها البعض من ناحية وبالوضع العضوى للمخ من ناحية أخرى، ثم راجع أقصى اليمين من المدعين – مثلا- أن الأمراض النفسية ما هى إلا نوع من الصرع…. وهم لايفهمون الصرع ذاته.
ثم راجع الصراع الخائب بين التحليليين والسلوكين، ثم راجع علاقة الأمراض ببعضها البعض: الصرع بالشيزوفرينيا والأخير بجنون والهوس والاكتئاب، ثم راجع التاريخ…. أعنى تاريخ الحياة وتناسبها: لا مع المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية…. ولكن مع الموقف البارنوى والموقف الاكتئابى… “الخ”
ومضيت فى خطابى ألح فى حاجتنا إلى جديد يربط كل ذلك ببعضه البعض:
..وأن الفارماكولوجيا (علم العقاقير الطبية) النفسية من ناحية، وتداخل الأمراض الذهانية فى بعضها البعض من ناحية أخرى يمكن أن يعمـّـق الفهم ويحل الإشكال… ، ثم عرضت فكرتى عن أن مخ الإنسان ليس مخا واحدا بل عدة أمخاخ، وأنى أعنى بالمخ ”تركيبا متكاملا” وليس منطقة بذاتها، وأن كل تركيب متكامل له نقطة انبعاث تنظم عمله، وأنه فى الأحوال العادية لا يقود إلا مخ واحد وتكون بقية الامخاخ كامنة أو مساعدة ، وأن هذا المخ الواحد هو الذى يسيطر بالتنظيم على كل أجزاء الجهاز العصبى في وقت السلامة، وفى الأحوال المرضية (أمراض الكينونة) يعمل أكثر من مخ معا كيفما اتفق، وأحيانا يعمل المخ القديم متفوقا، وينتصر على المخ الحديث فى الصراع بينهما، وأن العقاقير تعمل بشكل تطورى مرتب على بعض الأمخاخ دون الأخرى، وبذلك يمكن تهدئة المخ القديم اختياريا دون المساس بدرجة كبيرة بالمخ الحديث، وأن الصدمة الكهربائية إنما تمسح النشاط الكهربائى لكل الأمخاخ ثم تعطى الفرصة للمخ الأقوى أن يلتقط عصا المايسترو ليوجه الفرقة كلها، وأن هذا يفسر اختلاف الاستجابة للعلاج الكهربائى بعد تحضير كيميائى وتهيئة نفسية مناسبة، ترجح كفة المخ الذى نسلمه القيادة، وأن العلاج النفسى هو الحب الإنسانى الذى يجذب طاقة المريض إلى الخارج إلى الناس ويغرى المخ الحديث بأن يلتقط عصا المايسترو ولا يخاف من الوحدة أو القهر، وأنه بذلك يتوافق العلاج الكيميائى مع العلاج النفسى مع العلاج الكهربائى، وقسمت له الأمخاخ وسميتها، وكان بديهيا وأنا أعرض كل هذه الأفكار فى خطاب من بضعة صفحات أن أزيد الأمر تعقيدا وليس توضيحا كما قد يجد القارئ نفسه فى متاهة وهو يتابع الفقرة السابقة مما يحتاج إلى اعتذار جديد- وكان بديهيا ألا أتوقع ردا إيجابيا… وهذا ماحدث- ولكنى على كل حال ختمت الخطاب قائلا:
”والآن: هل نعلن الثورة؟ هل نرفض الأسماء؟ هل آن لنا أن نصمم على التطور بإرادتنا وعلى رفض المقدسات الخادعة، هل نأخذ من كل مخ أصالته وجوهره ونحاول أن نوفق بينها لنحوِّل الناس المنشقين على أنفسهم إلى إنسان واحد متوافق مع تاريخه المجيد فى الصراع للبقاء فالتطور.
هل تحضر؟ هل تكتب؟ هل نتفاهم؟ هل نستطيع الصمود حتى نموت لا تسرقنا أيامنا ولا أطماعنا قبل أن يفتت عقولنا الكولسترول المترسب داخل شراييننا؟
هل نستمر؟ هل نيأس مثل الأنواع المنقرضة من الأحياء؟ هل أنت معى؟
ولك منى الحب والسلام… يحيى
وكما قلت: لم يكن الرد إيجابيا حيث أرسل شعلان لى خطابا قال فيه:
”هل تغضب من حرارة الشمس إذا حرقت جلدك…. أو من بلاهة الحمار إذا لم يفهم قولك؟ فلا تغضب منى إذا كانت استجابتى لكتابك الأخير قد تجمدت طيلة هذا الوقت. فقد كان كتابك (أو خطابك) محاولة لترجمة إحساس أثق فى صدقه…. أما ترجمة الإحساس إلى لغة العقل والتصنيف والتنظيم فقد نزلت على عينى غشاوة فلم أستطع أن أفهم ماذا تريد أن تقول … ربما لمجرد أننى فى حالة ثورة على العقل والمنطق….”
ثم قال:
“… ولأنى أعتقد أن مثل هذه المحاولات ضرورية من أجل نقل الخبرة من مجال الإحساس المبهم الغامض إلى مجال المفاهيم الموضوعية، ولتمكين نقل العلم من جيل إلى جيل ومن مكان إلى مكان، ومحاولتك هى إحدى هذه المحاولات، ولكن مثلها مثل غيرها من المحاولات تجد نفسك تقول ماقاله الغير ولكن تصر على تغيير لفظ أو مفهوم، بينما الأساس واحد وينشأ حوار ومناقشة وخلاف وبيزنطية.
ثم يقول: “أريد أن أصل إلى أنى شبعت نظريات وتنظيرا وتنظيما وتصنيفا، وإذا كان لى أن أتعلم فبالخبرة” “إن مجال العلم ملئ بالمقالات، إنها أصبحت تمثل أزمة مثل أزمة المواصلات وأزمة تلوث الهواء وأزمة التخلص من الفضلات، والمقالات العلمية أصبحت قيمتها مقاربة لقيمة الورق والحبر الذى ينفق عليها… أنت تتفق معى فى هذا، وسوف تقول أن ماحاولتَ أن تعبر عنه ليس مقالة أخرى وليس نظرية، ولكنه توضيح وتنسيق لما هو معلوم، وربط أجزاء العلم المتفرقة وتوحيدها حتى فى اللفظ وتصر على استخدام كلمة “مخ” وكلما تستخدمها يثار لعابى لأنه كان فيما مضى سندوتشى المفضل عند “على كيفك” فى الإسكندرية “ولا بـّاس” فى القاهرة.
ثم يقول:
“أعود وأقول معك لابد من تنظير وتنسيق وتوفيق… ولكن أليس العلم مليئا بالنظريات… وكلها نظريات لاتفعل شيئا ولا تنجد الطبيب فى لقائه مع مريضه فلماذا نضيف واحدة أخرى؟”، “لقد كنت فيما مضى متحمسا لساندور رادو ثم وجدت نفسى أتحدث بلغة لايفهمها إلا تلاميذ ساندور رادو وعددهم محدود…. – ولكنى فضلت أن أعود إلى لغة التحليل النفسى لأنها لغة منتشرة ويفهمها الكثيرون ممن أحترمهم وأستطيع التفاهم معهم”
ثم ينهى خطابه بعد اعتراضات أخرى كثيرة قائلا:
قبل أن أنام أقول: نعم لابد أن أكتب وأن تكتب ولابد أن نتحدث بل نتعارك أحيانا ولابد أن نتفاعل وجها لوجه، ولابد أن نجابه مشكلة حية نتحدث عنها قبل أن نغرق فى النظريات ولابد أن تكون بوجدانك فى كتاباتك وألا تعتذر….. وأقول أنى معك ولست معك… وليكن هذا “علم وصول” لحديث لابد أن يستمر ………………….. “محمد”
وسكت،
هكذا أرسلت إلى بييبر فى باريس… ولم يرد، كما أرسلت إلى محمد فى أمريكا… ورد على بهذا الدش البارد، أو أقول “الفاتر” لما فيه من حب وصدق..
…
وسكت طويلا حتى جاء العيد فأرسلت له خطابا حارا كان فيه:
”عزيزى محمد: كل سنة وأنت طيب، وأنت حر، وأنت خالق، وأنت نفسك، وأنت مستيقظ، وأنت محبوب، وأنت تحب، وأنت تغنى وتنطلق، وأنت قوى، وأنت مسئول، وأنت شريف، وأنت إنسان، وأنت تتطور، وأنت حى….
وصلنى خطابك “ضد الأمخاخ” ورفضت أغلب ماجاء فيه وقد جمعتَ فيه من التناقضات ما أغرانى بالرد عليه، ثم أغرانى بالرد عليك، ثم أغرانى بالحديث عنك.
وفيه قلت:
”لقد رفضتَ اللغة ثم تمسكت بلغة الأغلب: المحللين
وهاجمتَ الأبحاث… ثم استشهدت بنتائجها !
ورفضتَ التشخيص… ثم تمسكت برموز النظريات السائدة !
ورفضتَ المخ… خوفا من أن تسجن فى خلاياه !
وحاولت أن تتحرر، وخيل إليك أنك نجحت… ولكن الحرية صعبة صعبة، فأنت تتردد وتحاول أن تميل تحت مظلة تحتمى بها، والمظلة ليست قفصا مثل قفصك القديم، ولكنها وقاية مما يأتى من السماء، من المجهول… ولكن إلى متى تظل رافعها فوق رأسك؟ ثم كيف تستعمل يديك؟ وكيف تنطلق؟ لتنطلق !
نعم…
لابد من آخرين، ولكن ليس دائما أصحاب لغة لفظية وإنما أصحاب مشاعر وقلوب (قلوب مخية أيضا)، وفيما أعلم فلم ينجح إنسان وحده”
ثم قلت له:
”قيود الأرض غائرة فى جوفها وهى تجذبك إليها، وأنت تحن، وتخاف، وقيود التحليل النفسى تأمن فى رحابها… ولكنها تتسلل إلى فكرك فى براءة ظاهرية، وتوهمك أنها مفاتيح تفتح الأقفال، وأنت فى سكرة الأمان، وأنت تحمل كومة المفاتيح، تنسى أن المفاتيح تقفل الأقفال أيضا ولا تفتحها فقط، وأنت تعلم أنى كنت حريصا على رجوعك، ومازلت، ولكن حرصى اليوم لسبب آخر غير زمان، لأنى زمان كنت حريصا على قسم الأمراض النفسية وعلى مصر، وعلى صديق شريف، أما الآن فأنا حريص، على إنسان، فلربما كان وجودك معنا خطوة على الطريق التطورى لنا جميعا.
وأنت تسأل: هل الجلسات الصباحية التى أشرت إليها من معلم لتلاميذ أم من ند لند؟ وأنا أجد عندى الشجاعة الآن لأقول: إن رؤيتى الآن تجعل الصدق أساس التفاهم وليس كم المعلومات، وتجعل الحرية الذاتية هى الوسيلة الأولى لتقييم الرأى وليست الحجج والبراهين، ومن ثم فإنى لا أجد الصدق والحرية إلا فى الشباب (مهما كانت أعمار شهادة الميلاد) وإنى بعد تجربتى الأخيرة لست مستعدا بحال أن أضيع عمرى فى مناقشات بيزنطية تستعرض فيها العضلات، أو يحمى بها المناقش نفسه من أصالته، أو يحصل بها المناقش على شبق فكرى زائف، وإنما أنا مستعد أن أبذل عمرى مع إنسان حر صادق تثيرنى اعتراضاته فأجد بها ذاتى وأنير بها فكرى، ويثيره هجومى فيستيقظ ويرفض، ويتعرى بلا خجل… والإنسان الذى حل مشكلته بين الكتب والأبحاث، الذى يعشق حروف المطبعة أكثر من نبض الإنسان يصعب علىّ أن أثير فيه تساؤلات الوجود والكون والخلق، وربما كانت مثل هذه الفروق هى التى تميز الانجليز عن الفرنسيين، وهى التى تميز العلم الهندسى عن الفلسفة الصوفية، والأرقام عن الموسيقى… الخ، وأنا احترم الزميل العالم الحافظ المنظم، كما أحترم الأسمنت المصنوع منه برج الجزيرة، وأحبه كما أحب عمارة بلمونت، وأقدر كفاحه كما أقدر مهندس السد العالى… وفقط- من أجل ذلك فأنا أحتاج من أستطيع أن أتكلم معه دون أن أنطق، وقد وجدت منهم الكثير هنا بين الشباب خاصة، لأنه كما يقول العرب “من طلب شيئا وجده”.
ثم قلت أخيرا:
لست أدرى كيف بدأت الخطاب وكيف أنهيه يا محمد، كل ما أدريه أنى أحمل فى نفسى هذه الأيام ومنذ إبريل الماضى طاقة هائلة من الحب تكاد تغمر العالم كله، طاقة تكاد تصنع الحياة، طاقة تتحدى الجنون، وتشرق كالشمس بين جنبى وتضئ وتدفئ وأحس أننا لو كنا جماعة لعملنا شيئا.. ربما.. بل حتما..
وأخيرا لك ماتشعر به من خلال الكلمات”
وبعد
لن أعتذر لهذا الاستطراد الآن، فقد وصلنى منه شخصيا تاريخا كنت قد نسيته تقريبا،
وأنا أعتبره علامة على محتوى هذا العمل بشكل أو بآخر!
[1] – ولعل الأوان قد آن حالا بهذه المحاولة الحالية الممتدة فى سلسلة آملُ أن تكتمل.
[2]-: يحيى الرخاوى “حيرة طبيب نفسى” (كتبت 1970) دار الغد للثقافة والنشر. الطبعة الأولى 1972، “مستويات الصحة النفسية، من مأزق الحيرة إلى ولادة الفكرة” الطبعة الأولى 2017 منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.
[3] – مع قهر العصر الفكتورى
الفصل الثانى الخبرات التمهيدية والإعداد
الفصل الثانى الخبرات التمهيدية والإعداد
الفصل الثانى: الخبرات التمهيدية والإعداد
استهلال:
أذكر أن هذه المجموعة الصغيرة، مجموعة المواجهة التدريبية، قد أدت هذا الدور بنجاح شريف، وطمأنتنى – ولو بطريق غير مباشر – أنى لست وحدى، وأن حدسى هذا([1]) ليس بعيداً عن الواقع تماماً، وتطور الموقف بعد ذلك تطوراً مهما وخطيراً فى نفس الوقت.. وقابلنا من المضاعفات إذ نواجه داخلنا ما قابلنا، حتى انتبهنا بأمانة منذ ذلك الحين إلى أن جرعة الرؤية دائماً، ومهما كانت نوعية المغامر، هى أكبر من احتمال الواقع المرحلى..، وتحملنا المصاعب فى صبر وشجاعة وتصميم، ونبع دور القائد تلقائيا من مواقع تفاعلات المجموعة، فكنُت أنا هذا القائد.. فزادت الأمور تعقيداً.. ثم مرت الخبرة بسلام نسبى رغم كل شىء وتوقفت المحاولة عندما حققت ما حققت من أغراضها دون مضاعفات جسيمة.
وهنا أقف وقفة واضحة مع القارئ ومع نفسى لأكرر أنى لن أعرج إلى هذه التجارب الخاصة فى هذا العمل وما يليه بالتفصيل .. لأنها لا تخصنى وحدى، وأفرادها لهم عندى مكانة الاحترام والحب والامتنان بحيث لا أسمح لنفسى بأن أتعرض بالحكم على أى منهم لأى سبب كان، أما بالنسبة لشخصى فالأمر له وجهان:
الأول: أنه لا يمكن أن أتكلم عن شخصى دون أن أتكلم عن هؤلاء الأصدقاء والأحباب، لأنى لم أمر بالتجربة وحيداً فى الصحراء، أو فى حجرة مغلقة.
والثانى: أن مارأيته فى نفسى ولنفسى أكبر من استيعاب أى قارئ أحاول أن أحقق معه لغة مشتركة، الأمر الذى جعلنى أشك فى أى سيرة ذاتية ([2])، إذا أنها لا يمكن أن تعرض حتى الجزء المتاح لصاحبها .. وقد فهمت من خلال ذلك معنى أن “علوم المكاشفة” لم يصرح لهم (بعض الصوفية مثل إمامنا الغزالى) بالحديث عنها، فواقع الأمر من خلال خبرتى هذه (وهى ليست صوفية أصلاً حتى لا تختلط الأمور .. ولكنها علاجية عملية مباشرة) أن المكاشفة – كما عرفتها – لا تعنى الكشف الصوفى فحسب، ولكنها قد تعنى اكتشاف النفس ايضا .. وقبلاً، ولعلهما واحد فى النهاية، فمن عرف نفسه فقد عرف الله، وهى خبرة لم يصرح لهم بالحديث عنها … لأنها لا يمكن الحديث عنها من خلال لغة مشتركة، وبالتالى فبدون هذه اللغة المشتركة .. فلا قيمة للحديث ولا للكتابة… ولا للوصف، ويراودنى احتجاج داخلى بأنى لو “ذهبت” قبل أن أحكيها فإنى خائن لأمانة أثقل .. هى أمانة ما أتيح لى من فرصة المعرفة الأعمق..، لأن الحقيقة ليست ملكا لرائيها، إلا إن كان منعزلا غير مسئول .
(10/2/2013)
*..ثم يبدو أنه قد حان الوقت والتاريخ لتسجيل بعض هذه الخبرة بشكل مواز لا يقترب من أى فرد من أفرادها بشكل مباشر، وإنما قد يكفى شرح العلاقات البشرية والسيكوباثولوجى فى الحياة اليومية من واقع الممارسة الحقيقية والموازية والخبراتية جميعا، وقد ظهر ذلك منى بشكل إبداعى أولا شعرا بالعامية: “ديوان أغور النفس”، ثم فى صورته العلمية ثانيا فى “فقه العلاقات البشرية” “دراسة فى علم السيكوباثولوجى(2)” أى الكتاب الثانى، وهو الذى نشر مسلسلا فى نشرات متلاحقة من نشرة الإنسان والتطور اليومية فى موقعى: (من نشرة 10/6/2009 إلى نشرة 15/9/2010) فى (628 صفحة) ثم ظهرت أخيرا فى نسخة ورقية متاحة([3]).
كما أن الجزء الثانى من ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط”، باسم “مدرسة العراة”، كان من وحى هذه التجربة أيضا.
بصراحة أنا أعتبر أن هذه الأعمال (فقه العلاقات البشرية/أغوار النفس/مدرسة العراة) هو جزء لا يتجزأ مما أريد توصيله عن العلاج الجمعى، لكن بما أن هذه المجموعة لم تكن مجموعة مرضية أصلا، وكذلك نظرا للتحفظات السابق ذكرها، فإن كل ما استطعت أن أصرح به، بشكل غير مباشر، كان عن شخصى([4]).
ثم نعود إلى متن الكتيب الحالى:
…. أرجع بعد هذا الاستطراد إلى تطور نشأة هذا النوع من العلاج من خلال التجربة الشخصية: حين حضر الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد شعلان – محمّلا بكل العلم والخبرة والأمانة، والتجارب التى حاول خوضها، عاد والشوق إلى البحث فى داخله ليس أقل من البحث فى خارجه، وقد عاد بناء على رغبته وإلحاحى معاً، وبدأت تجاربه فى عناده الهادئ فى ممارسة العلاج الجمعى فى القصر العينى .. وقوبل بالمقاومة المتوقعة، وحضرت معه بضعة مرات .. وقارنت بين ما يفعله وما مررت به من خبرة شخصية، والتقت احتياجاتنا ببعضنا البعض، ثم اتّسعت الدائرة لتشمل شركاء التجربة الأولى، ولتمتد إلى بعض الأصدقاء من الناشئين فى مهنتنا وغيرهم، لتتكون “مجموعة خاصة” تماماً، نمشى من خلالها على الصراط، نقع مراراً ونقوم أحياناً .. نخوض النار ونلمح الجنة .. وتنتهى هذه التجربة بكل ما لها وما عليها لتختفى فى دائرة المحظور الذى أشرت إليه فى الفقرة السابقة .. وللأسباب التى عددتها…، وأكتفى بهذا القدر من التلميح عن التجارب الشخصية.
هنا يجب أن أقف وقفة واضحة حتى لا أدع لخيال القارئ أن يتصور ما ليس بحقيقة، فأقول إن كل ما أشرت إليه من مضاعفات وآلام وخبرات وأحداث – من وجهة نظرى على الأقل – ليس فيه سر يشين، ولا هو بعيد عن التجارب العلمية الصادقة فى أى موقع علمى فى العالم المعاصر، ولولا احترامى للمشتركين فيها، واعترافى بالجميل والامتنان لهم، وبالتالى ضرورة استئذانهم، لكان فى وصف هذه التجارب شرف أى شرف لكل من ساهم فيها مهما انتهى إليه اختياره.
ثم أعود لاؤكد هذه الحقيقة وهى أنه: “لولا هاتين التجربتين الشخصيتين المتلاحقتين اللتين خضتهما بكل ما حملت من رغبة فى المعرفة، وإصرار على المخاطرة واحتياج شخصى لما أمكن أن تكون ثمة “طريقة جديدة” فى العلاج الجمعى، ولما أمكن أن يتم هذا البحث فى “اتجاه مصرى” .. إلخ…، وهكذا أخلص من هذه النقطة إلى القول بأن: الخبرة الشخصية والتكوين الشخصى والمخاطرة الشخصية لهم أبلغ الأثر فى انتقاء نوع العلاج الذى يمارسه أى معالج دون سواه، وفى تحديد هدفه ووسيلته جميعاً.
ثانيا: الخبرة الطويلة فى العلاج النفسى الفردى
أما البعد الثانى الذى ينبغى أن أشير إليه فى وصف نشأة هذا العلاج قيد البحث فهو ما سبقه من ممارسات علاجية عموما، فقد ظللت منذ اختيارى هذه المهنة أقرنها مباشرة بالعلاج النفسى، لأنه بدون العلاج النفسى لا ينبغى أن نتكلم عن الطب النفسى، والعلاج النفسى (الذى هو تغير المريض إلى أحسن من خلال علاقة هادفة بينه وبين المعالج) هو فى عمقه صراع (حوار) بيولوجى بين نشاط مخ (أمخاخ) إنسان ذى خبرة ونشاط مخ (أمخاخ) إنسان فى محنة ([5]) وبالتالى فإن كل ما يتعلق بنشاط المخ من كيمياء وكهرباء وبيئة محيطة هو داخل ضمن العلاج النفسى،..، أقول إذن: إنه بدون هذا المفهوم الأشمل للعلاج النفسى، كان لزاماً علىّ أن أبحث عن مهنة أخرى، أو على الأقل أن أدرج نشاطى المهنى تحت لافتة أخرى، وقد مارست العلاج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما (منذ 1958 وحتى 1976)، وكنت أتبع فيه كل ما علمته وقرأته وسمعت عنه .. بالإضافة إلى التجربة والخطأ، وما علمنى إياه المرضى أساتذتى العظام، وكنت – بداهة – أشعر بالنقص وأتصور أنه كان لزاماً على ّ أن أتبع طريق التلمذة والتحليل التدريبى فى الخارج .. الأمر الذى لم يتح لى فعلا وواقعاً، وكنت أُرجع فشلى مع بعض الحالات أحياناً إلى نقص خبرتى التى تعيننى عليها قراءاتى الخفيفة ومثابرتى الطويلة (التى وصلت إلى سبع ساعات متصلة يومياً فى هذا النوع من العلاج خاصة) ….، إلا أنى كنت أصبّر نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه المحاولة ابتداء من واقع نفسه وتجاربه دون تدريب سابق، وأنه أمامى ميزة إضافية وهى أن التجارب الأخرى مكتوبة فى متناول يدى، وقد أفادنى هذا الشعور بالنقص – بقدر ما عوقنى – فكان دائما يمنع غرورى، ويحد من غلوائى، ويهدئ خطواتى..، وحين كان يعود من الخارج أى من زملائى ممن أتيحت له فرصة التدريب فى الخارج وأحاوره، أو حين كنت أناقش أستاذى الدكتور عبد العزيز عسكر (وهو قد تدرب ايضا فى الخارج) كنت ازداد ثقة بما أفعل، وحين سافرت فى مهمتى العلمية إلى باريس وشاهدت بعض جلسات العلاج النفسى (مع أنها كانت أساسا للأطفال) عبر الدوائر التليفزيونية (الأستاذ ليبوفيسى، وديادكين) تيقنت أنى على الطريق السليم، وأن الوعى والمثابرة والمسئولية والتعلم من الخبرة السابقة هى الأسس الضرورية فى العلاج النفسى الفردى – فى بيئتنا هذه – بما لها من معالم خاصة أورد أهمها:
أولا: أنى جربت كل الطرق المعروفة تقريباً من أول الاستلقاء على الحشية والتداعى الحر إلى المواجهة وجهاً لوجه والعلاج التفسيرى المباشر والمنطقى.
ثانيا: أنى مارست هذا العلاج مع كل أنواع الحالات من أول الهستيريا التحولية التى ينتهى الإيحاء فيها فى جلسة أو اثنتين ليبدأ بعد ذلك علاج أعمق، أو لا يبدأ..، إلى العلاج المكثف للفصام الذى استمرت إحدى حالاته معى ثلاثة عشر سنة تماما، كنت أرى صاحبها فيها كل يوم تقريباً .. وأغوص معه إلى أعمق طبقات الوجود.
ثالثا: أن طول ممارستى لهذا العلاج مع ندرة سفرى وندرة انقطاعى عن العمل، أتاح لى فرصة التتبع الطويل للحالات المستمرة فيه، وكذا للحالات التى انقطعت عنه.
وقد خلصتُ من تجربتى الطويلة هذه إلى أن هذا العلاج الفردى هادف وضرورى لتكوين المعالج النفسى، وأنه ربما يكون لا غنى عنه للمعالج أكثر من المريض (وربما أكثر منه)، بل – وقد قررت ذلك بعد أن مارست العلاج الجمعى – أنه مرحلة لازمة لكل معالج قبل أن ينتقل للعلاج الجمعى ، ناهيك عن التفرغ له، كما خرجت أيضا من الخبرة الطويلة مع الذهانيين عامة والفصاميين خاصة، والصديق الفصامى (صاحبى فى الثلاثة عشر سنة السالفة الذكر) بوجه أشد خصوصية،.. خرجت من كل هذا بمعرفة عن أعماق النفس الإنسانية فى أزمة وجودها، بما هيأ لى فيما بعد أن أمارس العلاج الجمعى فى سهولة أكبر وتقييم أعمق من خلال معرفتى أغوار النفس حتى سر الجنون.
ولكنى لم أكن قادراً على تقييم حقيقة نتائج العلاج الفردى، وخاصة تلك التى استمرت عدة سنوات، فقد تصورت حينذاك أنى توصلت مع المريض – منهم – إلى درجات رائعة من الوعى والصحة والتوازن، ولكنى تعلمت – فيما بعد – من خلال هؤلاء الأفراد الذين انتقلوا معى من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى أن كثيرا منهم كانوا فى خدعة لفظية اغترابية سطحية فى كثير من الأحيان، وقد قام العلاج الجمعى فى هذا بعمل بوتقة الاختبار الموضوعة على النار والتى تضع فيها المعدن المراد تقييمه فإما يزداد صلابة لأصالته أو أن يتفحم ويتناثر، وللأسف فإن عددا ممن “أتم” علاجه الفردى لم يحتمل اختبار المواجهة فى العلاج الجمعى، حتى عدلت عن قياسهم بمقياس مدى استيعابهم للنقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى إلا إذا دعت الضرورة، والحق أقول أن هذه الخبرة كانت صدمة لى، تكاد تصرخ فى وجهى:” إذن .. ماذا كنت تعمل طوال هذه السنوات؟”([6])، وامتد اختبار البوتقة (العلاج الجمعى) ليكشف حقيقة توازن من حضر علاجاً فردياً حتى عند غيرى من الزملاء لمدد طويلة، بل إنى لا أذيع سراً إذا قلت أن بعض الزملاء من المعالجين الفرديين الذين صاحبونا بعض الوقت متدربين: لم يتحمل رؤية ما يجرى فى العلاج الجمعى فضلا عن المشاركة فيه، وكان كل هذا الانزعاج والهرب دليلا على الطبيعة المختلفة للعلاج الجمعى وعلى درجة عمقه معاً، بل إن الانزعاج والهرب كانا أكبر فى أولئك المرضى الذين كانت لهم خبرة سابقة فى العلاج الفردى عنه فى أولئك الذين يدخلون إلى العلاج الجمعى مباشرة، وكأن العلاج الفردى – بشكل أو بآخر – قد يبعد الفرد عن نفسه أكثر مما تفعل الحياة العادية .. ولكنى لم أتمادَ فى هذا التصور، لأن الحالات التى دخلت اختبار البوتقة قليلة، ومشكوك فى صلابتها ابتداء، ولم يدفعنى كل هذا إلى أن أفقد الثقة تماماً بالعلاج الفردى لصالح العلاجى الجمعى، بل تيقنت أنهما علاجان مختلفان.. وأنه لكل دوره، وقد خطر ببالى أن هذه المدة التى قضيتها فى العلاج الفردى قبل أن أواجه حقيقته وحقيقتى وهى حوالى الخمسة عشر عاماً، هى قربية من المدة التى سمحت لأى جديد بالظهور فى مجالنا هذا وخاصة من بدأ حياته بممارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين([7]).
خلاصة القول: أن هذه الفترة التى قضيتها أمارس العلاج الفردى كانت ثروة حقيقية أدت ثلاث وظائف على الأقل.
الأولى: معرفتى أكثر بالنفس الإنسانية فى أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خلال علاج الفصاميين.
الثانية: إيمانى بضرورة وجدوى هذا العلاج الفردى كمرحلة وكبديل يحتاجه الكثيرون (بعكس بيرلز الذى اعتبره غير ذى موضوع حتى شبـَّـهَ التداعى الحر بالتناثر الفصامى)
والثالثة: عجزى عن الاستمرار فيه – شخصياً – وتطورى من خلاله إلى هذا العلاج الجمعى موضوع البحث (بالرغم من استمرارى فى الاشراف على من يمارسونه من المتدربين والمتدربات الأصغر).
أما بداية ممارستى المهنية للعلاج الجمعى فقد واكبت تجاربى الشخصية سالفة الذكر كما واكبت بعض بقايا حالات العلاج الفردى وكانت التجارب الأولى للعلاج الجمعى ثلاثة:
الأولى: بالمشاركة فى (وأحيانا قيادة) جلسات جماعية فى مستشفى دار المقطم للصحة النفسية حيث يحضر عدد يتراوح بين 15، 20 فرداً، مع خمسة إلى ثمانية من هيئة العلاج والمتدربين، وهو يجرى يومياً، وكنت أحضره مرة أسبوعياً، وكان النقاش عقب كل جلسة مثرياً ومفسراً ونافعاً لى وللمتدربين معاً، ولكنه كان ذا طبيعة موقوتة بفترة تواجد المريض فى المستشفى، وبالرغم من ذلك فإن نتائجه كانت مشجعة وأحياناً رائعة.
الثانية: بعض المحاولات السابقة لهذه المحاولة قيد البحث، فى عيادتى الخاصة والتى كانت أساساً ليست إلا تجميعاً لأفراد كانوا يحضرون معى العلاج الفردى مع بعض المتدربين، والتى أشرت إلى أن أغلبهم لم يتموا جرعة العمق التى يحملها العلاج الجمعى بالمقارنة بالعلاج الفردى.
الثالثة: محاولة أصيلة لبعض المتطوعين (ليسو مرضى .. أو لم يعلنوا مرضهم) من طلبة كلية طب قصر العينى، وأغلبهم ذوو ميول يسارية أو ثورية أو شبه ثورية، وكانت هذه الخبرة علنية، يأتى ليشاهدها من يشاء من الطلبة والأطباء حيث تجرى فى مدرج مفتوح بالعيادة الخارجية للقصر العينى، وقد افادتنى هذه المحاولة تماما، إذ كانت تحمل من التحدى والعمق ما كان يحرجنى ويضطرنى إلى اكتشاف طبقات أعمق فى نفسى، أكثر من العلاقة مع المرضى الذين “يدفعون” فى عيادة خاصة، .. وقد استمرت هذه المحاولة ما يقارب العام الدراسى تعلمت فيها عن نفسى وعن الهرب فى المبادىء الثورية (أو شبه الثورية) ما كان يصعب علىّ أن أتعلمه من غيرها.
أما المصدر الذى اكتملت به هذه الطريقة، فهو بعض القراءات القليلة حول الموضوع وعن تعدد الذوات، وأهمها كتاب لإريك بيرن،([8]) وبعض مقالات عن علاج الجشتالت جمعها “كاجان”([9])، والحق أقول أن دور الممارسة كان له نصيب الأسد فى نشأة هذه الطريقة قيد البحث، وحتى اكتشافى لمبدأ “الهنا والآن” وصلنى من الممارسة قبل أن أقرأه وذلك من خلال مصادفة فى العلاج الفردى…، حين أراد أحد المرضى أن يهدينى رمزاً من الرخام على أحد وجهيه اسمى (كما هى العادة) ثم طلب منى أن أقترح عليه الحكمة التى يكتبها على الوجه الآخر كما اعتاد المترددون علىّ فى مثل هذه المناسبات (مثل “الصبر” أو “الحلم سيد الأخلاق” .. الخ) فقلت له ما رأيك أن تكتب الحكمة التى انتهينا إليها معاً بعد طول صحبتنا؟ وإذا به يبادر أن يهدينى اللوحة التالية:
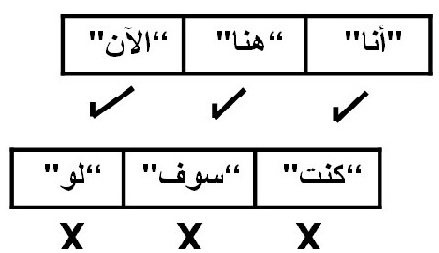 وبقيت هذه الرخامة منذ ذلك الحين على مكتبى حتى الآن، حتى أن صديقا لى حين عاد من الخارج ووجدها على مكتبى سألنى “هل أنت جشتالتى”؟ وقلت له بقليل من الحرج “ماذا تعنى؟”، وشرح لى فى إيجاز مازح كيف أن هناك مدرسة تسمى العلاج الجشتالتى تركز على الـ “هنا .. والآن” والـ “أنا.. أنت” مثلما تشير اللوحة .. الخ، وقد أوردت هذه الحادثة لأؤكد على دور الممارسة، ولأعيد إعلان طريقتى الخاصة فى اكتساب المعرفة، وهى نفس الطريقة التى أشرت لها فى “حيرة طبيب نفسى” حيث اعتبرت نفسى بالنسبة لما أقرأ ممن يعانون من ظاهرة القراءة السابقة Dega Lu إن صح التعبير، لأنى – فى فرعى هذا – أقرأ غالباً ما عرفته فعلا من خلال الممارسة..، الأمر الذى يمكن أن أعده تقصيراً فى بعض الأحيان.
وبقيت هذه الرخامة منذ ذلك الحين على مكتبى حتى الآن، حتى أن صديقا لى حين عاد من الخارج ووجدها على مكتبى سألنى “هل أنت جشتالتى”؟ وقلت له بقليل من الحرج “ماذا تعنى؟”، وشرح لى فى إيجاز مازح كيف أن هناك مدرسة تسمى العلاج الجشتالتى تركز على الـ “هنا .. والآن” والـ “أنا.. أنت” مثلما تشير اللوحة .. الخ، وقد أوردت هذه الحادثة لأؤكد على دور الممارسة، ولأعيد إعلان طريقتى الخاصة فى اكتساب المعرفة، وهى نفس الطريقة التى أشرت لها فى “حيرة طبيب نفسى” حيث اعتبرت نفسى بالنسبة لما أقرأ ممن يعانون من ظاهرة القراءة السابقة Dega Lu إن صح التعبير، لأنى – فى فرعى هذا – أقرأ غالباً ما عرفته فعلا من خلال الممارسة..، الأمر الذى يمكن أن أعده تقصيراً فى بعض الأحيان.
ولكنى أوردت هذا التسلسل، لأشرح كيف سمح لنا هذا التركيز على هذه الطريقة أن نشعر بالمشاركة والتماثل مع الطبيعة البشرية، ومحاولات رأب صدعها، وتعديل مسارها مهما اختلفت الثقافات.
[1] – أنظر الفصل الأول (ص9)
[2] – علما بأنى ضمنت ما أتصور أنه خبرتى الذاتية – وليس بالضرورة سيرتى- فى معظم محاولاتى عرض تجاربى بكل لون وقلم من أول أدب الرحلات (الترحال الأول: “الناس والطريق)، (الترحال الثانى: “الموت والحنين)، (الترحال الثالث: “ذكر ما لا ينقال) (وغير ذلك فى سلسلة “فقة العلاقات البشرية ) انظر هامش رقم (6).
[3]– وقد ظهرت هذه التجربة مستقلة شعرا مع الشرح اللازم فى طبعة ورقية مؤخرا: فى “فقه العلاقات البشرية”(4) “قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، سنة 2018.
[4]– يحيى الرخاوى (رواية المشى على الصراط): الجزء الثانى، “مدرسة العراة”، الطبعة الأولى 1978، الطبعة الثانية 2008، الطبعة الثالثة 2019 منشورات جمعية الطب النفسى التطورى
[5] – تعجبت وأنا أقرأ (أنقل) هذه العبارة التى كتبتها سنة 1976 ولم أكن أعرف شيئا عن العلم المعرفى العصبى، وتفسيراته للعلاج النفسى، ثم جاءنى مؤخرا كتاب مرجعى مهم تأليف: Louis Cozolino
“The Neuroscience of Psychotherapy” Building and Rebuilding the Human Brain.(2002)
وفيه أغلب ما كنت أعنيه بهذه العبارة وأمارسه، وحين نسخت نسخة من هذا الكتاب الجديد وأعطيتها لزميلى وإبنى أ.د. رفعت محفوظ ، قال لى : اليس هذا هو ما كنت تعلمنا إياه منذ سنة 1974 ، ثم أضاف: إننى أكرر ذلك لكل من أدرس لهم أو أدربهم فى المنيا (2019) وغيرها، فحمدت الله.
[6] – أنظر الفصلين الرابع عشر والخامس عشر.
[7] – راجع توقيت ظهور النظريات الجديدة لكل من كارين هورنى، وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم .وأغلبها ظهر بعد حوالى 18 عاماً من بداية تدريبهم وعلاجهم التحليلى، وحتى بيرلز – مؤسس مدرسة العلاج الجشتالتى – أمضى نفس المدة تقريبا فى هذا السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، وكأن هذه السنين الطويلة ضرورة كحد ادنى يسمح بالتطور من واقع الممارسة، وليس التغيير لمجرد الرغبة فى اختصار الطريق.
[8] – Eric Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy in 1961”
[9] – جيروم كاجان (Jerome Kagan) هو عالم نفس أمريكي، وُلد فى عام 1929 فى نيوجيرسي، ونشأ فى راهواي، نيوجيرسي. تقاعد كاجان مؤخرًا بعد عمله كأستاذ فى جامعة هارفارد ببرنامج التنمية. وهو يعد أحد الرواد الرئيسيين فى علم النفس التنموي. وقد عمل بشكلٍ واسع على مسألة الحالة المزاجية، وقدم فهمًا عميقًا للانفعال، تم إدراج كاجان فى المركز الثانى والعشرين كأبرز علماء النفس فى القرن العشرين
الفصل الثالث والأصل فى الوحدات أن تجمعا
الفصل الثالث والأصل فى الوحدات أن تجمعا
الفصل الثالث: … والأصل فى الوحْداتِ أن تُجَمَّعا
وقع فى يدى مؤخراً كتاب كنت قد بدأت فى قراءته منذ بضع سنوات عن “التاريخ الطبيعى للذكاء” (بعنوان أصلى يقول: ما بعد المعلومات)
“Beyond Information” The Natural History of Intelligence
وإذا بى أكتشف أننى خططت فى بعض صفحاته ما كنت أحتاجه الآن لدعم ما أقدمه فى سياق مفهوم الوعى الجمعى والإدراك، والتطور، ومن ثم العلاج الجمعى والإيمان والثورة جميعا، وخاصة من مدخل مرتبط بثقافتنا الخاصة، الكتاب من تأليف: توم ستونير Tom Stonier والحمد لله أنه مترجم بدقة فائقة بواسطة صديق رائع([1])
ما همنى تقديمه فيما يتعلق بالعلاج الجمعى هو اتساع تعريف الذكاء ليشمل الحيوان والنبات بل والجماد فلا يقتصر على الإنسان، وقد ربطت ذلك بما وصلنى من خبرتى فى العلاج الجمعى التى أكدت لى أن الأصل فى الحياة كلها من أول تركيب الذرة حتى غاية مطلق الكون إلى وجه الله هو ما يقابل ما يسميه ستونير “التطور الدينامى لما هو المادة/الطاقة/المعلومات” ([2]).
انتبهت وأنا أتابع الاحدث فالأحدث فيما كتب فى العلاج الجمعى مع ربطه بخبرتى التى انبثقت منها هذه الكتابات المتناغمة مع ثقافتنا أساسا إلى احتمال أن تكون هذه التجمعات الإنسانية الإيجابية، وإن تولّدت من ممارسة مهنية محدودة: أن تكون ضمن الإفاقة التى أحلم بها لتكوين الوعى العالمى الجديد فى مواجهة الاغتراب الكمى المتمادى (النظام “العولمى” “الأمريكى” “الإسرائيلى” “الصينى” الجديد)، وفيما يلى بعض خطوط مبدئية عن هذا المنطلق الخاص:
أولاً: اتساع مدى تعريف الذكاء: استعمل الكاتب كلمة الذكاء استعمالا خاصا مفيدا جدا، وإن كان مثيرا للجدل، وقد أرجعنى هذا الاستعمال إلى كتاب “دانيال دينيت” “أنواع العقول”([3]) الذى أكرر الإشارة إليه كثيرا، وكيف أنه استعمل كلمة “العقل” ليفيد بها: منظومة البرامج البيولوجية التى تحافظ على بقاء أى نوع من الأحياء من الفيروس حتى الإنسان، وهو ما يقابل ما استعمله أنا مرة باسم تشكيلات “برامج البقاء”، وأخرى باسم “مستويات الوعى”، يقول ستونير فى كتابه هذا ما يلى:
“تنزع القواميس إلى تعريف الذكاء بأنه “المقدرة على الفهم، والقدرة على الاستيعاب وإدراك مغزى الأفعال أو أحد التواصلات”
وندرِّس نحن لطلبة الطب:
“أن الذكاء هو القدرة على استيعاب العلاقات الأساسية”
فنلاحظ أن هذا أو ذاك لا يصف إلا نوعا واحدا من العمليات العقلية المعرفية الهادفة، وأن كثيرا من العمليات التى نقوم بها، بل وتقوم بها الأحياء الأدنى، قد توصف بالذكاء دون أن تتوفر لها تحديدا هذه المواصفات السالفة الذكر، وينتهى مؤلف الكتاب إلى تعريف خاص يتفق مع تخصصه فى المعلوماتية والتطور معا فيقول:
“إن الذكاء يعتبر خاصة لنظم المعلومات، وبما أن المعلومات هى خاصة فيزيقية أساسية …، فعلى ذلك يكون الذكاء نتاجا لتطور نظم المعلومات”،
وبالتالى فإن الذكاء لا يمكن التأكد من أمره إلا بملاحظة “ديناميات النظام أو سلوكه.
ثم يقول: “..عندما تكون البيئة متغيرة يحتاج الأمر إلى الذكاء للإبقاء على سلامة النظام استجابة للمؤثرات، والاستجابة الذكية قد ينتج عنها أحد الحالات التالية:
(1) أن يعزز النظام قدرته على البقاء.
(2) أن يعزز النظام قدرته على التكاثر.
(3) إذا كان النظام موجها بالأهداف فإنه يعزز من إنجاز الهدف،
وهكذا يتسع مفهوم الذكاء ليشمل كل نظام معلوماتى متسق هادف.
على هذا الأساس سمحت لنفسى أن أربط برامج البقاء بهذا التعريف الأوسع للذكاء.
كما انتبهت إلى الإشارة إلى ذكاء النبات بوجه خاص، وقد توقفت طويلا بألم مناسب، واحترام واجب، عند تعبير “ذكاء النبات”، ذلك أنه عندنا – فى الطب النفسى– حين يتدهور المريض الذهانى (الفصامى السلبى خاصة) تدهورا شديـدا، نقول – للأسف – إنه وصل إلى “حالة نباتية”، وكنت أجد صعوبة فى شرح هذا المصطلح لتلاميذى، وأحيانا اخجل حين أصف إنسانا أنه اصبح كالنبات، وكنت أيضا أقع فى حيرة مترددة تشعرنى أننى على خطأ، حين اشرح لهم، ولنفسى، أن الذى يحافظ على الحياة، على استمرار الحياة، أعنى الحياة الجسدية والنفسية معا، هو وجود “معنى” أو “غاية” ما، لا تبدو سهلة التحديد عادة فى الأسوياء، فما بالك فى عمق الوجود الفصامى المزمن، وكان عندى صديق جميل ظل صديقى عشرات السنين حتى أصبحنا هو وأنا كهلين، رحمه الله، كان قد انسحب من كل شىء – قبل أن يستأذن– حتى من الكلام، وفشلت معه كل محاولات العلاج، وظل صامتا لسنوات طويلة قبل أن يرحل إلى خالقه، وكنت أسأل عنه كل فترة، ويخبروننى أنه ما زال كما هو، وأقابله فأجده فعلا كما هو: يذهب للمطعم فى المواعيد، ويجلس تحت شجرته المفضلة، وينظر إلى من حوله بين الحين والحين نظرات ذكية (هكذا نصفها جميعا)، ويعتنى بدرجة متوسطة بنظافته الشخصية، وينام ليلا، وكنت أصفه لطلبتى بأنه اصبح فى هذه الحالة التى نسميها “نباتية”، وحين يسألونى عن ماذا يعنى التعبير، أشير إلى احتمال أنه أصبح مثل الشجرة التى يحبها ويجلس فى ظلها معظم الوقت، وكنت أذهب أحيانا أتأمل هذه الشجرة، سواء كان جالسا تحتها أم لا، وأسأل نفسى: هل هذه الشجرة لها هدف فى الحياة حتى تبقى حية، وأرد على نفسى أن: نعم، لها، و..و لَهُ. وأتوقف عند ذلك ولا أحاول أن أتمادى فى الإجابة، وإن كان يخطر لى أن يكون هدفها أن تظلل صديقها هذا، حتى أننى خفت أن تذبل وتموت بعد رحيل صديقى هذا وقد تجاوز السبعين.
ثانياً: ذكاء “الجماد”: سمح اتساع مفهوم الذكاء السالف الذكر أن تمتد صفة الذكاء إلى ذكاء الجماد، وكان ابسط توضيح لذلك هو ما جاء فى الكتاب ليثبت ذكاء بللورات السكر، حيث ورد بالنص:
“فالجماد فى صورة بلورة السكر مثلاً يبدى أيضا قدرة على معالجة المعلومات، فعندما توضع بلورة السكر فى محلول فوق مشبع، فإنها تمد المحلول بالمعلومات التى تؤدى لبدء تفاعل يؤدى إلى تنامى البلورة فيما يُعرف عامياً بالسكر البنات.
والمعلومات هكذا صفة فيزيقية أساسية فى كل النظم الكونية، والذكاء ليس إلا نتيجة لتطور نظم المعلومات هذه، ويمتد الذكاء – بهذا المفهوم الموسع– يمتد فى طيف متصل من الظواهر تبدأ من أدنى الدرجات بظواهر ما يشبه الذكاء البدائى فى الجماد، ثم ما هو أرقى من ذلك فى النبات، فالحيوانات البدائية، ثم الحيوانات الراقية، لنصل إلى أرقى الدرجات فى ذكاء البشر كأفراد وكمجتمعات.
ثالثاً: علاقة هذه النزعة الطبيعية للتجمع المنظم بالعلاج الجمعى: بلغنى من واقع الممارسة أن ما يجرى فى العلاج الجمعى (وفى أى تجمع إيجابى بشرى بقائى، إيمانى أو حضارى إبداعى)، هو الأصل وهو الأقرب إلى الطبيعة الأصلية لنظام الكون كما خلقه الله.
رابعاً: إن التجمعات حتى فى نظام هادف ليست إيجابية على طول الخط، وإلا لما انقرض هذا العدد الهائل من الأحياء 999 من كل ألف، وهم يتجمعون ربما بغباء يفسر انقراضهم.
خامساً: إنه بقدر ما يحتاج التجمع الإيجابى البشرى إلى تفاعل مستويات متعددة من الوعى معا – فى العلاج الجمعى كمثال – يقتصر التجمع السلبى على المستوى السطحى الظاهر أو المستوى البدائى الخائف، كما يحدث فى مظاهرات الفوضى والتخريب.
سادساً: إن اللعب فى الوعى بالتحريك المغرض (غسيل المخ) فى تجمّعٍ ما على مستوى واحد من الوعى أسهل وأسرع كثيرا فى تحقيق التهييج والإثارة والفوضى، فى حين يستعصى مثل هذا الأمر إذا كان التجمع يجرى على مستويات متعددة من مستويات الوعى، يتخلق منها الوعى الجمعى، هنا يصعب إعادة توجيه أو إجهاض أو إحباط مثل هذا التجمع الإيجابى الهادف إلى تحقيق أهداف الطبيعة الأصلية.
سابعاً: إن التجمع بتنشيط مستويات الوعى المتعددة يتم على مستوى حركية المعلومات: بالمعنى الأشمل للمعلومات، أكثر مما يتحقق على مستوى الاقتناع بالمعنى الظاهر، ويمكن الإقرار أن تجمع المعلومات هو أصلب وأبقى، أما تجمع الأفكار والأيديولوجيات فهو أضعف وأهوى.
ثامناً: فى حين ينجح أو يفشل الذكاء الجماعى، فيما هو دون الإنسان حسب صراعات البقاء غير المدركة على مستوى الدراية أى التى تقتصر على البرمجة الوراثية، والاستيعاب التلقائى لبرامج التطور البقائية، فإنه يضاف إليه فى حالة الإنسان فى التجمعات الإيجابية – والعلاج الجمعى – كمثال: “تبادل حركية الإدراك” و”المواجدة” (التقمص العاطفى Empathy).
تاسعاً: إن ما يسمى “الذكاء الجماعى” غير ما يسمى “الذكاء الاجتماعى” فالأول مرتبط بالتطور والبقاء وتخليق الوعى الجمعى إيجابيا، وأيضا هو فى ناحية مرتبط بغريزة القطيع سواء لحفظ الحياة والنوع أو نحو الهلاك الجماعى فى الظروف السلبية، أما الثانى – الذكاء الاجتماعى – فهو مرتبط بالسلوك التكيفى الظاهر بين البشر، وهو أقرب إلى ما يسمى حديثا “ذكاء العاطفة أو الذكاء الوجدانى Emotional Intelligence وفى العلاج الجمعى يتخلق ويتنامى الذكاء الجمعى الإيجابى وهو أهم وأكثر فاعلية حتى من الذكاء الاجتماعى الذى قد يمارس أكثر فى نوع من العلاج السلوكى المعرفى، الذى يوصف أحيانا كنوع من العلاج الجمعى (برغم تحفظى).
عاشراً: يتخلق الذكاء الجماعى الإيجابى (الوعى الجمعى) بالتواصل البينشخصى والجماعى بدرجات متناهية الصغر لكنها قادرة على التراكم فالتوليف فالتخلق والإبداع فى كيان ضامّ فاعل، كما أن التغيرات الحادثة قد تتم أيضا فى وحدات زمنية متناهية الصغر لا يمكن رصدها عادة فى حينها.
شحذ تخليق الوعى الجماعى
رجعت من جديد إلى ذكاء الجماد، مع التوسع طبعا فى مفهوم طيف الذكاء، وكيف أن التنسيق الذرى للمادة يمكن أن يكون نوعا من الذكاء، وأنه إذا اختل، ترتـَّبَ عنه ما نعرف من آثار هائلة مدمرة وغير ذلك مما نسمع عن تفتيت الذرة، الأمر الذى قد يكون تدخلا فى ذكائها الذى يحفظ عليها تماسكها.
ما فائدة كل هذا فى موقفى من الذكاء الجمعى الذى أفضل أن أسميه “شحذ تخليق الوعى الجماعى”، والذى أرى أنه الأصل فى الحياة والعلاقات كما أشرت سابقا، حين أشرت أيضا إلى كيف انه يختلف عن الذكاء الاجتماعى، وقبل ذلك نبهت إلى اختلافه عما يسمى عقل الجماعة المرتبط بغريزة القطيع.
أعتبرت كل هذا تمهيدا للنقلة التى ألمحت إليها أيضا بالنسبة لمسألتين جوهريتين سواء بالنسبة لممارستنا العلاج الجمعى فى ثقافتنا الخاصة، أو بالنسبة للنقلة من الوعى البين شخصى، إلى الوعى الجماعى، إلى الوعى الطبيعى، إلى الوعى الكونى، إلى وجه الله.
انطلاقا مما أشرت إليه سابقا من أن الأصل فى الوجود (وليس فقط فى الحياة) هو “التجمع فى نظام”، يسمح أو لا يسمح بالتفكك إلى وحداته، بنظام أيضا، ونادرا بغير نظام، لاحظت أثناء ممارستى العلاج الجمعى، ذلك تماما دون أن أنظّر له مسبقا، أو حتى أقرأ عنه، ورحت أتابع في خبرتى تكوين المجموعات العلاجية الواحدة تلو الأخرى، ثم انفضاضها، وطفقت ألاحظ أن ثـَمَّ رباطا غير مرئى يربط بيننا يحفظ علينا تماسك المجموعة من جهة، وقد يكون هو ما يستحق أن يسمى “العامل العلاجى” من جهة أخرى، ثم ربطت ذلك – كما ألمحت مرارا- بتخليق الوعى الجماعى المرتبط بشكل أو بآخر بالوعى الكونى ربما مرورا بالوعى الجماعى خارج المجموعة، وربما الوعى الاجتماعى بشكل مختلف ودرجات متباينة.
رحت بعد ذلك ألاحظ ما يتردد فى ثقافتنا عن أن “الله هو الشافى” بالمعنى الإيجابى البسيط، وما أعرفه وما يصلنى من فعل الدعاء، وما أومن به وأمارسه من معنى الحديث الشريف “اجتمعا عليه وافترقا عليه” فقدّرت أن هذا التجمع النظامى هو أعمق من، وأسبق عن، ما نعرفه عن ما هو حياة، وأيدنى فى ذلك ما ورد فى الكتاب الذى أناقش بعض ما جاء فيه عن “التاريخ الطبيعى للذكاء” فى حدود ما ورد فيه من تحديث، بل تثوير لمفهوم الذكاء، واسترشدت ببعض العلاقات الطبيعية فى المادة مثل الرابطة التساهمية، ووصلنى شىء أشبه بتجمعنا فى دائرة بالذات فى العلاج الجمعى، الأمر الذى لاحظته فى كل الصور التى حصلت عليها مما تحت يدى من مراجع.
ثم إننى من خلال رحلتى فى ملف الإدراك([4]) وأيضا من خلال ألعاب عدم الفهم([5]) وغير ذلك تبين لى كيف أن هذه الحلقة الجماعية فى العلاج الجمعى تقوم بتنشيط مستويات الوعى المتعددة – كما ذكرنا- عند سائر أفراد المجموعة بدرجات متفاوتة تسهم كل بالقدر المتاح فى تكوين الوعى الجماعى الذى هو أكثر نشاطا وحركية نحو مستويات وعى تدركها ثقافتنا بلغة الدين الشعبى، والإيمان الفطرى بشكل أوضح وأرسخ من الدين المؤسسى، والإرشاد الدينى اللفظى وقهر العلم السلطوى.
من هنا خطر لى معنى جديد لتسبيح الجماد لله سبحانه وتعالى([6])، والسماء والأرض، وما بينهما، والطير، وكل شىء، الأمر الذى لو استقبلناه – دون الحديث عن سَبْق أو إعجاز أو تفسير علمىّ للنص الإلهى!، استقبلناه باعتباره من أساسيات ذكاء المادة، وارتباطها بكل دورات وتشكيلات ونغمات تشكيلات ما حولها، تصعيدا إلى ما هو أعلى فأعلى حتى ما لا نعرف (الغيب)، إذن لأمكن أن تسعفنا فروض عاملة قد تفسر “العامل العلاجى” فى العلاج الجمعى، بما يتفق مع ثقافتنا من جهة وبما يتواصل مع دوائر التوازن الجمعى من أول ذرات المادة حتى مطلق الغيب من جهة أخرى مرورا بكل الأحياء فجماعات البشر.
رجعت إلى جارودى وانبهاره بدور “الجامع” فى الإسلام، وتصورت أنه التقط معنى الحث على صلاة الجماعة ، وفى المسجد بوجه خاص، كما حسبت أن هذا الانتظام المتواكب مع الإيقاع الحيوى الطبيعى، جنبا إلى جنب مع التلاقى البشرى الخلاق (دون وعظ لفظى مبالغ فيه أو ترهيب أو ترغيب) مع التأكيد على معنى أن يتوجه كل أصحاب دين بذاته إلى نفس البؤرة من كل أنحاء المعمورة فى نفس التوقيت النسبى، تصورت أن كل ذلك يتسق مع هذه الحقائق التى وصلتنى من العلاج الجمعى دون تأكيد أو حماس أو مغالاة أو تعسف، لكننى لم أجد أن جارودى كان عنده فرصة لمثل هذا الربط، برغم كل تقديره لدور “المسجد” على أكثر من مستوى، ومثله فى أى دين لم يتشوه.
ملحوظة:
سبق أن ذكرت أنه بالرغم من وضوح الأسس الإدراكية لهذه الفروض التصاعدية هكذا، فإننى أتجنب فى جلسات العلاج الجمعى، إلا نادرا، استعمال اللغة الدينة، اللهم إلا لفظ الجلالة أحيانا، وكثيرا ما أنبه أننى لا أعنى به ما يتبادر للذهن مما اعتدنا عليه، وإنما أربطه بحضوره فى الوعى “هنا والآن”، قبل وبعد كل مكان، ولا أستبعد أننى أنجح أحيانا، لا أعلم إلى أى مدى.
[1] – Tom Stonier: “Beyond Information: The Natural History of Intelligence”, Publication: Springer Science & Business Media 1992 .
تأليف: توم ستونير “التاريخ الطبيعى للذكاء: ما بعد المعلومات” ترجمة د. مصطفى فهمى إبراهيم، وصدر فى سلسلة المشروع القومى للترجمة، سنة 2001
[2] – Dynamic evolution of the / energy /power/ information
[3]– دانييل دينيت: الكتاب المترجم باسم “تطور العقول” صادر عن “المكتبة الأكاديمية” القاهرة 2003
Daniel C. Dennet 1996: Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness
[4] – يحيى الرخاوى: “ملف الإدراك” نشرات “الإنسان والتطور” (من 10/1/2012 إلى 10/3/2013) بموقع المؤلف: www.rakhawy.net
[5] – مثلا لعبة “دانا لما ما بافهمشى يمكن”، وكذلك من خلال لعبة “أنا خايف أقول كلام من غير كلام لحسن” ثم الكتاب الثالث فى سلسلة العلاج الجمعى: “حركية الإدراك وجدل مستويات الوعى” تحت الطبع.
[6] – انظر الفصل الثالث عشر
الفصل الرابع البحث العلمى فى العلاج الجمعى
الفصل الرابع البحث العلمى فى العلاج الجمعى
الفصل الرابع: البحث العلمى فى العلاج الجمعى
نرجع إلى البحث المحدد قيد الشرح:
حين تخطينا المرحلة الأولى (أنظر الفصل الأول) – وهى اختيار الموضوع بعد مقاومتى (مشرفاً) وإصرار الباحث – واجهنا مباشرة، وبداهة، ضرورة تحديد الطريقة العملية التى سنقوم فيها بإجراء البحث، وأجد من المفيد هنا أن أذكر مراحل التفكير التى مررنا بها: حتى أعرض للقارئ – وخاصة الباحث المبتدئ – كيف تتسلسل الأمور فى صعوبة مرهقة قبل أن يستقر الباحث على وسيلته المفضلة، أيضا حتى أفتح الأبواب لطـُرِق بديلة للطريقة التى اتبعناها، لنواصل البحث بها .. أو ليقوم غيرنا بتطويرها لسد النقص الذى سيظهر فى طريقتنا الحالية، وقد بدأ تفكيرنا بالطريقة التقليدية لتقييم ما يجرى فى هذا النوع من العلاج بالاعتماد على رأى المرضى والمترددين فى التقييم وتحديد طبيعة العلاج وتفسير كيفية التغير من خلاله وأعددنا لذلك استباراً “محدد الأسئلة، حر الإجابة“، بحيث يسمح للمجيب أن تكون إجابته فى كلمة واحدة، أو سطر أو بضعة سطور، أو عدة صفحات على نفس السؤال، وقدرنا أن يكون البحث مقارنا! بين مجموعة ممن استمروا فى العلاج ومجموعة أخرى ممن انقطعوا عنه .. وقد ملأ فعلا هذه الكراسات عدد يزيد عن عشرين فرداً، وكانت إجاباتهم ثرية وعميقة وشديدة الإثارة والفائدة .. إلا أن الحصول على من انقطعوا عن العلاج كان صعبا .. وحثهم على الإجابة بنفس الحماس كان مشكلا، وكدنا نقع – من خلال الحرص – فى شرك مقارنة ما لا يُقارن ..، ولما كان البحث بطبيعته محدد المدة (للحصول على التقدم لنيل الماجستير فى تاريخ محدد) فقد دفعنا هذا إلى خوض التجربة فى الحال بقرار عرض ما يجرى فى عدة جلسات علاجية متلاحقة، ومحاولة تفسير العملية العلاجية ذاتها، وبدأنا فى اول الأمر نعتمد على الباحث نفسه، وإلى درجة أقل على زملاء له يحضرون المجموعة، وتعرّض الجميع إلى هجوم المجموعة المباشر، وشاركهم فى تلقى هذا الهجوم المعالج الأول نفسه (شخصِى)، ورحّب الجميع بهذه المعارضة التى وصلت لدرجة الرفض لكن دون توقف، وأحيانا لدرجة العدوان لكن دون تجاوز، حتى استقر الأمر من خلال الحوار الخلاق، وتعود أفراد المجموعة على طبيعة العمل الجارى ورضوا باستمرار البحث كجزء من مسيرة المجموعة باعتباره مكملا لطبيعة أهداف المجموعة فى نوعية التواجد الإيجابى فى الحياة، وهذا فى ذاته هو أول إعلان لطبيعة نوعية العامل المشترك بين أفرادها، ولا أستبق الأحداث حين أقول إنه أثبت نوعا من “ارتباطا النفع العام بالنفع الخاص ارتباطا عضويا ومباشراً”، ولكن دون أى افتعال أو أدنى درجة من إعاقة الهدف العلاجى أساساً.
وبدأ التسجيل، واعتمدنا بادئ ذى بدء على الذاكرة لمشاهدين معنا، ولكن هذه الطريقة لم تعطنا سوى صفحات معدودة وإن كانت تحوى التفاعلات الهامة، والانتقالات ذات الدلالة، والاستجابات المميزة، إلا أننا أحسسنا أن الحصيلة ليست كافية. فانتقلنا إلى مرحلة التسجيل الصوتى، الذى أعطانا مادة أثرى وأدق، أتاحت لنا أن ننتقى منه عينات للحوار بنص ألفاظه، ثم لجأنا فى الجلسة الأخيرة – الثالثة عشر – إلى محاولة من نوع خاص وهى أن يقوم الباحث بتفريغ الجلسة كلها، ثم يعطيها للمعالج الأول، ويطلب منه تعليقا مكتوبا على أحداثها أولا بأول، فإذا بالتفريغ يقع فى عشرات الصفحات، وإذا بالتعليق يصل إلى ما يقرب من ذلك، وكان على الباحث بعد ذلك أن يناقش الاثنين معا “التفريغ والتفسير” ثم يحاول أن يربطهما بالمدارس المعاصرة، وقد فعل هذا على قدر جهده، وإذا بنا أمام بحث كامل قائم بذاته، مادته جلسة علاجية واحدة!!!
وقد أوردت هذه التفاصيل لأوضح نقطة أخرى، وهى تدرج مستويات البحث من جهة، وصعوبة ادعاء الالتزام الموضوعى من جهة أخرى، وملاحظتى على أنه سواء كان التسجيل من الذاكرة، أم عينات من التسجيل الصوتى، أم التسجيل الصوتى الكامل، فإنى لاحظت أن اتجاه الباحث ومناقشاته وتساؤلاته وتعليقاته كانت متقاربة، وكأن العامل المشترك الفعلى هو الباحث نفسه وفروضه العاملة!! مما يؤكد ما ذهبت إليه أول الأمر من أن أداة البحث هى الباحث نفسه([1]) فى مثل هذه الأبحاث أغلب الأحيان.
وعلى من يتصور أن التسجيل بالذاكرة” هو طريقة ناقصة أن يتذكر أن الممارسة الإكلينيكية كلها تعتمد على التسجيل بالذاكرة أساسا، وأن هذا التسجيل التلقائى هو الذى ينمى الحدْس الإكلينيكى للممارس باستمرار، سواء وصل هذا التسجيل إلى شعوره أو ظل يساهم فى تكوينه المهنى لا شعوريا، فإذا أردنا ان نضع مثل هذا البحث الذى بين أيدينا فى مكانه الطبيعى فهو إضافة منظمة إلى الممارسة الاكلينيكية الجارية فعلا تلقائيا .. بما يحدد بعض معالمها، ويؤكد أو ينفى بعض تصوراتنا لها، وبالتالى فإن مناقشة معلومة واحدة من جلسة واحدة قد تؤدى هذا الغرض وتعود بالفائدة على المهتمين بالأمر من المشتغلين بالعلاج النفسى، كما أن محاولة القراءة الفاحصة لكل كلمة قيلت، فضلا عن كل همسة، وكل لفتة، وكل صمت، قد تفيد جميعها فى نفس الاتجاه ولنفس الهدف..
هكذا تبين لنا أن وظيفة البحث العلمى فى هذا المجال هى “أمانة التسجيل بقدر الإمكان” من موقف شخصى، لأن غير ذلك مستحيل كما سيرد، ثم التفسير بقدر المتاح من ترابط المعلومات، وبالتالى إتاحة الفرصة – من خلال هذا وذاك – للممارس لتعميق رؤيته وإعادة النظر فيما يأخذ وما يذر، أما البعد الثالث الذى أشار إليه الباحث وهو التفهم الدينامى للاضطرابات والأمراض النفسية (من قبل ومن بعد: ديناميات الشخصية) فهو يبدأ ايضا بالتسجيل فالتفسير فالتنظير، وقد أتاح لنا هذا البحث فرصة إضافة رؤية مناسبة لهذا الجانب على أية حال.
ولنا هنا وقفة لازمة لتوضيح هذه الصعوبة المشتركة فى مثل هذا النوع من الدراسات والأبحاث، فعلى كثرة ما كتب عن العلاج النفسى، فإن تسجيل ما يدور فعلا بكل التفاصيل لم يرد بدرجة كافية (ونستطيع أن نقول ذلك، حتى بالنسبة للكتب التى كتبت عن حالة واحدة: Case Book))، ومع ذلك فإن ما كتب عن العلاج النفسى يصل إلى آلاف المجلدات دون حرج فى أن التسجيل التفصيلى غير وارد، اكتفاءً بتسجيل “عينات دالة”، ولو كان هذا التسجيل الجزئى (العيناتى) مرفوض، لتعرض النشر فى العلاج النفسى لمحنة شديدة تهدد بتوقف صدور أية كتابة عنه .. ذلك لأن أمام هذه الأمانى التسجيلية صعوبات واستحالات عديدة نورد بعضها هنا كأمثلة:
1- الاستحالة العملية: إن تسجيل حالة واحدة فى علاج تحليلى نفسى طويل قد يحتاج إلى عشرات المجلدات، لأن تفريغ ساعة واحدة من التداعى الحر، قد يلزمه أكثر من عشرين صفحة، فإذا كان متوسط الجلسات فى العام ما بين مائة جلسة وثلاثمائة، وكانت مدة العلاج من سنتين إلى خمسة فللقارئ أن يتصور حجم “المادة الخام” التى سيبدأ منها تقييمه وتفسيره وتنظيره.. ذلك التقييم الذى يبلغ بدروه حجما مماثلا على الأقل إن أراد الباحث الإتقان!!
2- الاستحالة التسجيلية الفنية: حيث إن ما يمكن تسجيله عادة هو التسجيل الصوتى، وفى أحوال نادرة: التسجيل الصورى الصوتى معا، وهذا وذاك يحتاجان إلى “تكنيك” فنى خاص أقل ما فيه أن يتمكن من جمع وجهَىْ المعالج والمريض معاً فى آن واحد (ثم تكثيف عدد أكبر من المرضى).. وهذا يستدعى أن يتم العلاج فى “استديو” كامل المعدات، قد يخرج بالعلاج كله عن تلقائيته الضرورية لفاعليته!!
ثم تأتى بعد ذلك الصعوبة فى إعادة العرض بالتفصيل للوصول إلى ما يسمى الحكم الموضوعى(!!) ثم استعادة العرض.. فإذا انتهينا إلى أخذ عينات من التسجيل رجعنا إلى التساؤل “أى عينة” أُخذت، وأى عينة تُركت؟ ولماذا؟… ومن أنت الذى أخذتَ ما أخذت، وكيف سمحت لنفسك بترك ما تركت، وأصبحت المسائل اتهام و”دفاع” وشكوك تفسير.. لتتوقف مسيرة العالـِم الباحث عن الحقيقة إنْ عاجلا وإنْ آجلا.
3- الاستحالة المهنية: ذلك أن التسجيل التفصيلى لا يمكن أن يتم دون أن يؤثر على طبيعة العلاج وتطور المريض والمعالج معاً، بما يشوه ما يجرى حقيقة وفعلا، إذْ قد يعوق التلقائية والسلاسة اللازمتين لنقل “عينة” أمينة مما يجرى ناهيك عن نقل “كل” ما يجرى.
4- الاعتبارات الأخلاقية: ومهما قيل فى درجة السماح الذى سيسمح بها المريض والمعالج معاً – من أجل خاطر عيون البحث العلمى – فإن مادة البحث لابد وأن تتأثر إذ أنها تتناول أعمق درجات الوجود البشرى، حتى نصطدم بما لا نعرف، فإذا تصورنا أن مريضاً ما قد سمح لنا بالإطلاع على كل هذا المحتوى، فلابد من إعادة النظر فى طبيعته وتكوينه اللذان سمحا له بهذا السماح، وهى خبرة ملتبسة بين الدافع إسهاماً إيجابياً للعلم، أو استعراضاً سلبياً للظهور، بحيث يصعب تعميم النتائج المستقاة من مثل هذه العينة، أما النوع الأغلب الذى لن يسمح لنا بالوصول إلى هذا العمق وتسجيله، فهو يعلن بذلك ضمنا أن بحثنا ناقص فعلا.
5- الاعتبارات الذاتية عند المعالج: إذا أردنا أن يكون التسجيل شاهد صدق على ما يجرى فلابد أن يجرى التسجيل للمريض والمعالج معاً، ثم للظاهر والباطن معاً، وكما أن الباطن عند المريض بعيد المنال إلا من خلال المادة المتاحة أثناء العلاج، فإن الباطن عند المعالج صعب المنال ولكنه ضرورى لمعرفة التفاعلات الاستجابية لما يجرى أولا بأول، وهذا أمر يعرى المعالج – إن صدق – لدرجة قد لا يسمح بها كل معالج، (حتى فى دور الباحث) ولا يستطيعها آخرون، وقد لا يدركها الباقون.
نخلص من كل ذلك: إلى أن ما نقرأه فى مئات المراجع التى بين أيدينا عن العلاج النفسى وأنواعه، هو أقرب إلى وجهة نظر شخصية، ذات بعد موضوعى بقدر موضوعية صاحبها، وذات فائدة عملية بقدر إمكانية تطبيقها، وهى تعتمد على عينات منتقاه، تؤكد أو تنفى وجهة النظر هذه أو تلك.
وما دمنا أمام ظاهرة إنسانية علمية مهنية بهذه الدرجة من الصعوبة، وفى نفس الوقت هى تتناول أخطر وأعمق معالم وجودنا، فنحن لا نملك أن نتخلى عن مسئوليتنا فنحجم عن الخوض فيها لمجرد أن الحواجز دون الوصول إلى حقيقتها كثيرة وشائكة، ولكن علينا فى نفس الوقت ألا نبالغ فى تصور موضوعية عملنا لأننا فى النهاية أمام عينة محددة قابلة للتعميم بقدر نسبى دائماً.
وإنى لأكاد ألمح على وجه بعض السلوكيين والطرائقيين شماته وفرحة بإعلانى هذا النقص البادى فى هذه الطريقة البحثية، وكأن الجزء الظاهرى المحدود الذى نحصل عليه بوسائلهم هو البديل الأمثل لهذا العجز الذى أعلنه الآن بشجاعة، وهنا أقول: لا .. وألف مرة لا .. لأن الصعوبة ليس بديلها الاستسهال، ولأن الحقيقة ليست هى “ما يمكن الحصول عليه” ولكنها ماهيتها. سواء أدركناها أم ظللنا نسعى دائما لإدراكها، وأنا لا أقول هنا بتواجد مزدوج للأشياء مثل “كانت” حين تحدث عن الظاهر (الفنومين) والجوهر (النومين) وزعم أن الأخير غير قابل للتعرف عليه فوقع فى قبضة هيجل! حين واجهنا بتساؤله: إذا كان هذا “النومين” بعيداً عن إمكان معرفتنا، فلماذا الحديث عنه أصلا وكيف يمكن افتراضه؟ لا .. أنا لا أقول أن هناك حقيقة بعيدة عن المعرفة، بل العكس ربما يكون الصحيح هو أن هناك معرفة بعيدة عن ما نتصور أنه الحقيقة، ولكنى أعلن من خلال تحديد الصعوبات وتقدير العجز ما يلى:
أولا: إن السلوك الانسانى شديد التعقيد
ثانيا: إن الوسائل المتاحة لتسجيله لا تتعدى الظاهر، وحتى الاستنباط لا يتعدى القدر المتاح للشعور.
ثالثا: إن هذا التعقيد وهذه الصعوبة لا ترفع عنا مسئولية – وضرورة – البحث فيه، ومحاولة سبر أغواره.
رابعا: إن قصور وسيلةٍ ما لا يمنعنا من أخذ معطياتها بالقدر الممكن، وأن أهمية معطيات وسيلة البحث لاتقاس بالسهولة التى نحصل بها على المعلومات، ولكن بالمعاناة الموضوعية التى نبذلها فى محاوله البحث، والتى تظهر وتقاس بمدى معاناتنا، ومدى قبول قصورنا، ومدى احترامنا لنقص وسائلنا، وإدراكنا صعوبة غايتنا.
فإذا كانت هذه المواجهة المؤلمة قد أعلنت أن مجال العلاج النفسى (أو ما يمكن أن يسمى: تجربة التغيير البشرى) هو مجال صعب، وأن كل ما نعرفه عنه مما هو قابل للنشر (أو محتمل النشر) هو مجرد “عينات” و”وجهات نظر”، كان هذا أدعى إلى أن ندلى بدلونا فى عرض العينة التى نرى عرضها، وفى إبداء وجهة النظر التى نرتئيها .. دون شعور بالنقص من جهة، ودون مغالاة فى إدعاء الموضوعية من جهة أخرى.
من هنا لابد أن اعترف بشجاعة الإبن الباحث لإصراره على خوض غمار هذه التجربة الحية الخلاقة .. ليعرض عينة من “تجربة التغير البشرى” الذى يجرى فى مجال العلاج الجمعى من وجهة نظره أساسا، مستعينا بوجهة نظر المعالج أحيانا، وهو المشرف على الرسالة فى نفس الوقت، بلا ادعاء لموضوعية غير متاحة لأى باحث فى مجالنا هذا، مهما حاول أن يخفف من أثر مسئولية وجوده الذاتى – وليكن تطوره بعد ذلك– من خلال القدر الذى سوف يتاح له من احتكاك وجدل وقبول ورفض للآراء الأخرى (الذاتية ايضا بدرجات متفاوتة).
مادة البحث
مادة هذا البحث – وربما كل بحث يجرى فى مجال العلاج النفسى – مكونة من ثلاثة عناصر اساسية:
1- المرضى والمترددون.
2- المعالج (والمعالجون المساعدون إن وجدوا).
3- الباحث نفسه.
ولنتحدث عن كل جانب من مادة هذا البحث على حدة:
أولا: المرضى والمترددون:
بادئ ذى بدء، لابد لنا من وقفة عند تعبير “المرضى”، ففى الوقت الذى أجرى فيه البحث على هذه المجموعة كان عمرها قد بلغ ما يزيد عن عام ونصف لأغلب أفراداها، وكانت معظم الأعراض عند أغلبهم قد زال … بحيث ينبغى مراجعة تسميتهم “مرضى”، وقد أشار الباحث إلى أن التشخيصات كانت قد تغيرت فعلا من خلال العملية العلاجية، وأكاد أسمع رداً جاهزاً يقول أنهم ما داموا لا يزالون يترددون على العلاج فهم مرضى، ولن أتطرق هنا إلى مناقشة هذا الادعاء، ولكنى أحيل القارئ إلى نظريتى عن “مستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردى”([2]) وأقول إن مجرد التردد للعلاج لا يعنى المرض بل قد يعنى رؤية أعمق، أو أملا أشمل، أو إصراراً أقوى على الحياة الأفضل على طريق التطور، ولهذا استعملت لفظ المترددين بجوار المرضى وبينهما حرف عطف لأحدد أن المتردد ليس مريضا بالضرورة، وبالتالى أفتح بابا للتبادل بين صفتى المرضى والمترددين لأؤكد أنه طريق ذهاب وإياب، وفى هذه المجموعة بوجه خاص ذكر الباحث أن حضور بعض أفرادها كان بهدف التدريب، ولكن باقترابهم من “المأزق الوجودى العلاجى أو النمائى” ظهرت الأعراض لدرجة أنهم أعلنوا بأنفسهم رغبتهم فى الانتقال إلى صفة المرضى حتى يمارسوا حقهم الطبيعى بكل أبعاده، وكأن المرض أصبح حقاً اختياريا مرحلياً فى الطريق إلى التغيير الواعى.
ثم أنتقل بعد ذلك إلى التعريف بأفراد المجموعة، فبالإضافة إلى ما ذكر الباحث عنهم من معلومات – بعد أن استبدل أسماءهم – فهم بالنسبة لى من أقرب من عرفت، من حيث فضلهم على فكرى، وعلى وجودى، وعلى علمى أيضا، فهؤلاء الناس بكل سلبياتهم وإيجابياتهم وعدوانهم وظلمهم ومحاولاتهم وشقائهم وألمهم وهروبهم .. بشر بحق، وإذا كانت تعريفات الإنسان قد تنوعت بشكل مربك بادئين من أنه حيوان ضاحك إلى أنه حيوان ناطق أو مفكر إلى آخره، فإنى هنا أحب أن أعلن أن هؤلاء الناس قد علّمونى أن الإنسان “… هو الكائن دائم المحاولة الواعية إلى الرقى “معا”، برغم وعيه الآنى بضرورة الاستقرار المرحلى”.
ولكنى أقر هنا أن من حق هؤلاء المرضى أن يتصفوا بما هو يخصهم أكثر، بالإضافة إلى ما أورد الباحث من مواصفات وتشخيصات.
1- هم جميعاً – تقريبا- فى عناد عنيد ضد استسهال حل بذاته سواء كان هذا الحل حياة عادية هامدة، أم مرض مزمن جاثم، أم موقف انسحابى متفرج.
2- وهم جميعا – تقريبا- قد قبلوا أن يستمروا فى الحضور، وبالتالى فى ممارسة المحاولة الموجـَّـهة فى أن يقبلوا هذا العناد لمواصلة محاولة التغيير بكل ما يحمل من مخاطر وآلام.
3- وهم – جميعا تقريبا- وربما يرجع ذلك جزئياً إلى تأثير العلاج، قد واصلوا احتكاكهم بالواقع والتكلم باللغة السائدة، رغم مواصلتهم تعرية أنفسهم والتفاهم – مؤقتا – بلغة خاصة أثناء العلاج فى نفس الوقت.
4- وهم جميعا – تقريبا- قد قبلوا التعرى أولا أمام بعضهم البعض وأمام المعالج، وثانيا أمام الباحث، قبلوه فى شجاعة وصراحة، وتفسيرى أنهم وصلوا إلى درجة من الصدق مع أنفسهم، ولأنفسهم لم يعد عندهم معها ما يخشونه من رأى آخر، أو فرجة آخر، أو تسجيل آخر، فضلا عن إدراكهم لاتصال نفعهم الشخصى بالنفع العام كما ذكرت.
لكل هذا فإنى أعلن شعورى أنهم هم الذين قاموا بهذا البحث أساسا وفعلا، لأنهم واصلوا البحث الصادق فى داخلهم وخارجهم، ثم ساهموا بالموافقة على تسجيل ذلك وتوصيله دون تصنع أو افتعال، ففضلهم على الباحث وعلىّ وعلى العلم وللحقيقة فضل مباشر ليس له جزاء إلا أن تنجح محاولتهم لهم، وهذا ما يضاعف ديْنى – وربما دين الباحث إذْ يدرك حقيقة عطائهم – إليهم وإلى من هم مثلهم، فأنا لا أعنى بوصفى لهم أشخاصهم، بقدر ما أعنى كل من “هم كذلك” سواء كانوا هؤلاء الناس أم أى ناس.
ولنا هنا وقفة، فهناك من سيقول: إذن هؤلاء نوع خاص من الناس، وبالتالى فهذا العلاج لا يصلح إلا لأمثالهم.
والرد المباشر: ولم لا؟ .. والرد التالى: نحن لا نستطيع أن نجزم إن كانوا قد قدموا للعلاج بهذه النوعية أم أن العلاج قد أسهم فى كشف غطائهم فظهرت هذه الإمكانيات الإيجابية العنيدة؟ والرد الأخير: إن أحدا لم يدّع أن هذا العلاج هو العلاج الأوحد، بل بالعكس إنى أقر وأعلن أن لكل نوع من العلاج نوع من المتعالجين.
ثانياً: المعالج
ثم ننتقل إلى مادة البحث الثانية وهى “المعالج” نفسه: وأول ما نبحث هنا هو ما أشار إليه الباحث من أن هناك وجه شبه بين المعالج وبين هؤلاء المرضى، وأنه مجرد فرد فى المجموعة مع تميز خاص من حيث فعالية دوره، ودرجة مسئوليته فى التغيير، واتجاهه ووضعه المهنى الذى يأخذ به أتعابه، وإنى إذْ أقره على ذلك .. أقره أيضا على ما أشار من خلاف .. أضيف إلى هذا وذاك أنى كنت شبه متعاقد معهم عقداً لم يعلن أبداً، وهو الاستجابة من جانبهم لدعوة من جانبى تكاد تقول: “… إنى مثلكم .. ولكنى مصر على الاستمرار بلغة الواقع دون التنازل عن اى جوهر رأيته فى نفسى، فهل نحاول – يا جماعة – أن نمارس حياتنا سوياً إلى غاية عمق وجودنا بكل أبعادها المترامية، لنرى الحكاية ..، بل وقد نساهم فى توجيه المسار من خلال نجاح موقفنا العنيد .. كعينة قادرة على التطور بوعى وألم ودون تناثر أو صراخ”؟ وقد سمعت استجاباتهم واحداً واحدا بالموافقة “من خلال فعل الحضور والاستمرار فيه”، وعزوت هذه الموافقة – النسبية طبعا– إلى ضغط داخلى مباشر أعلن بظهور الأعراض، وإغراء خارجى مباشر هو محاولة المعالج الذاتية المهنية المستمرة.
ومهما يكن من أمر اضطرارهم لخوض هذه التجربة بسبب أعراضهم، ومهما يكن من أمر وضعى بالنسبة لهم كطبيب وظيفته الأساسية هى تخفيف الألم وإزالة الأعراض، فإن هذه وتلك كانتا الاتفاق الظاهرى فحسب، أما العقد غير المعلن – حسب تصورى – فكان يتعلق بخوض هذه التجربة الكيانية، ومن هنا جاء شعورى بالعرفان تجاههم، وإنى إذ أعترف بهذا البعد الذى لم ترد مناقشته فى البحث بطريق مباشر (وإن كان الباحث قد أشار أنه بتطور المجموعة لم يعد المعالج إلا عضواً فيها) أقول إنى إذْ اعترف بهذا البعد أقرر من وجهة نظرى أنه موجود عند كل معالج رضى أم لم يرض، وعى به أم لم يع، فالعقد فى العلاج النفسى بوجه عام والعلاج الجمعى بوجه خاص هو دائما أبداً عقدان:
العقد الأول: عقد ما بين طبيب (أو معالج) – طرف أول – ومريض – طرف ثان – الأول يرتزق ويمتهن مهنة إنسانية (بالمرّة)، والثانى يشكو من أعراض مرضية أدت إلى أن يذهب إلى الأول ويريد أن يتخفف منها.
أما العقد الثانى: فهو العقد الأعمق غير المعلن بين إنسان وإنسان: الطرف الأول (المعالج) يعيش مرحلة وجود ناجحة نسبيا وبالتالى فله تصور لأبعادها، وسلوكه إنما يمثلها ويبررها حتى ولو ضعفت درجة وعيه بها، والطرف الثانى (المريض) يبحث عن مثل هذا التصور، فينتقى من المعالجين من هو أقرب إلى تصوره ليحققا معاً مرحلة إيجابية مشتركة – وليست متماثلة بالضرورة – بصورة ما.
هذا، ولا يوجد حد فاصل بين العقد الأول والعقد الثانى، لأن العقد الأول هو الديباجة التمهيدية للعقد الثانى، ولأن العقد الثانى هو الوسيلة الفعلية لتحقيق أهداف العقد الأول (زوال الأعراض .. والاسترزاق).
ولابد أن أعترف أنى سمعت مثل هذا التفسير – فى سياق آخر– لطبيعة العلاقة بين المريض والطبيب فى موقف العلاج النفسى أول ما سمعته من أستاذنا المرحوم الدكتور يوسف حلمى جنينة أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب قصر العينى، حيث كان يقول – ناقدا أو ساخرا- ما معناه “إن الطبيب (المعالج) النفسى ينتقى من مرضاه من يماثلونه، ليرى نفسه فيهم بالساعات الطوال ويبرر وجوده من خلالهم”، وقد رفضت هذا القول الذى قيل هجوماً على العلاج النفسى سنين طويلة، ولكنى فى النهاية وصلت إلى نفس النتيجة مع تحوير بسيط فى العبارة الأخيرة إذ لابد أن تتعدل – فى بعض الأحيان – مـِـنْ “.. ويبرر وجوده من خلالهم” إلى “…. ليبحثوا سويا عن معنى وجودهم، وعن الطريق إلى إمكان تغييره إن لزم الأمر” وقد قلت “فى بعض الأحيان” لأنى مازلت أتصور أن كثيرا من العلاجات يصدق عليه كلام أستاذنا الدكتور جنينة، وآمل – متحيزاً – أن هذا النوع قيد البحث يصدق عليه التحوير الذى اقترحتـُه.
وأختم هذه النقطة التى ينبغى أن تتضح عند كل ممارس للعلاج النفسى، وكل باحث فيه بأنه “إذا كان الأمر كذلك، وهو عندى كذلك، فإن درجة الوعى التى يتم فيها هذان الاتفاقان ضرورة لازمة لتأمين المسار، والتقليل من المضاعفات، وتأكيد الاختيار”.
فإذا كانت هذه هى العلاقة بين مادتى البحث الأساسيتين (المرضى والمعالج) فإن موقف الباحث يزداد صعوبة فوق الصعوبات القائمة فعلا، لأن المعالج هنا هو المشرف على الباحث ايضا، وهو أستاذ له، ثم هناك علاقتهما العاطفية التى جعلت الباحث يشكره فى مقدمة بحثه باعتباره والده الروحى (!)، ولنا أن نتصور كيف يقوم باحث بعمل بحث مادته (أو ضمن مادته)، والده الروحى … ليبحث عن ضعفه واحتياجه وخطئه والتوائه..الخ.، وقد ناقشت هذه النقطة سابقا فى عجالة ولكنى أعود إليها هنا بتفصيل لازم:
فقد كنا أمام ثلاث اختيارات: إما أن يقوم بالبحث أحد تلاميذ صاحب المدرسة الناشئة الداعية لفكرة “الطب النفسى التطورى” والمسهمة فى تطبيق هذه الدعوة فى المجالات المتعلقة بهذا الفرع ومن بينها مجال العلاج النفسى الجمعى، وإما أن يقوم بهذا البحث أحد المنشقين عنها لأن عنده فرصة أعمق ومشاركة أطول لمعرفة عيوبها ونقائصها، وبالتالى فإن موقف المعارضة منها هو موقف يقظ يتيح له أن يحدد ما عليها أكثر مما يحدد ما لها، وأخيراً فالاحتمال الثالث أن يقوم بالبحث باحث “آخر” ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مما يمكن أن يطلق عليه – افتراضاً – باحث موضوعى.
أما الافتراض الأول: وهو الذى تم فعلا – فهو يضعنا فى موضع خاص إذ هو أقرب إلى “عرض” ما يجرى من وجهة نظر مشتركة تقريباً (مشتركة بين الباحث والمعالج)، وإلا ما انضووا سويا تحت لواء هذه المدرسة وهذا العلاج، وبهذا الإعلان يصبح العرض أميناً لو أسميناه “صورة من الداخل/الخارج، وبالعكس!.
أما الاحتمال الثانى: فسوف يمنحنا صورة دفاعية كذلك، فهو لا شك خليط بين موضوعية محتملة – حسب درجة تطور الباحث نفسه وأمانته مع وجوده – وبين تحيز مضاد أكيد – هو فى الأغلب مبرر انشقاقه عن المدرسة.
أما الاحتمال الثالث: فخبرتى ومشاهدتى واطلاعى على الأبحاث التى يزعم أصحابها الموضوعية، ثم طبيعة مثل هذا العلاج ومحتواه، كل ذلك يجعلنى أجزم أن مثل هذا الباحث المحايد ابتداء سرعان ما سيندرج خلال دفاعاته الخاصة تحت أحد الاحتمالين السابقين بدرجة أو أخرى، لأنه فى مواجهة هذا النوع من التفاعل لابد وأن يدافع أى باحث مغامر عن نوع وجوده ابتداءًا، وإذا كنا قد أشرنا إلى أن الباحث قد هرب من هذا المأزق – مؤقتاً – بأن أعلن أنه إنما يبحث فى آليات “العمليات” الجارية لا ” تقييم النتائج”، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن ننفى أنه فى نهاية الأمر، لابد وأن يرتبط شرح هذه العمليات بتقييم النتائج، أو بتعبير آخر إن أبحاث النتائج ما هى إلا نتائج “العمليات الجارية” وليست شيئاً آخر.
ونخلص من هذه المواجهة الضرورية إلى إعلان واقع هذا البحث وهو أننا أمام “عرض وجهة نظر باحث تلميذ فى ما يفعله معالج هو أستاذ له .. لا أكثر ولا أقل”، وهذا الإعلان إنما يعيد وضع الأمر فى نصابه ولا ينقص حق التلميذ الباحث فى أن يقول رأيه فى حدود المستطاع..
أما موقفى الآن كمقدم لهذا البحث فهو أن أضيف للباحث وجهة نظرى فى كونى مادة البحث:
أولا: أنه لابد من اعتبار المعالج ضمن مادة البحث مثل كثير ممن كتب عن أنواع العلاج النفسى، فشخصية الباحث كمادة بحث هى التى تفسر لنا نوع اختياره لمرضاه([3])، ولسنهم، وجنسهم (واختيارهم له كذلك) ثم محتوى العلاج ثم هدفه، وبدرجة هائلة: نتائجه، بل وفى عمق العلاقة: فلسفته فى الحياة ومحتوى نظريته، ولنراجع سوياً فى هدوء – ولو مصطنع – نوع حالات الهستريا والحواز التى عالجها فرويد، ولنراجع اختيار يونج لمرضاه ممن هم فى وسط العمر، ثم ويلهلم رايخ وزبائنه ومن بينهم فردريك بيرلز مؤسس مدرسة الجشتالت .. واختيار أدلر لتوجيه بعض نشاطه للأطفال، ثم نعيد النظر فى شخصية كل معالج لنرى كيف تحدد شخصيته اختياره وفكره النظرى ونتائجه جميعا.
ولست هنا بصدد تحديد وجهة نظرى من هذه المقولة الخطيرة تفصيلا: من أنا؟ ولماذا؟ ولكنى أوافق على انى “شخصياً” .. و”تماما” ينطبق علىّ ما زعمته فى الفقرة السابقة ..، ولكنى أحذر من التمادى فى هذه “الشخصنة” للنظريات العلمية وإلا وقعنا فيما وقع فيه أستاذنا المرحوم الدكتور صبرى جرجس حين عزى كل فكر فرويد إلى ميوله الصهيوينة الخفية…
ثانيا: إن العلاج النفسى إنما يحدث تغييراً فى المريض من خلال التفاعل بين اثنين، لأننا لا يمكن أن نتكلم عن تفاعل يقوم به متفاعل واحد وإلا كان فعلا لا تفاعلا، والمعالج هو الطرف الثانى فى التفاعل ولابد أن نعترف أنه معرض لتغير هو ذاته بل ربما هو ملتزم بالتغيـّر إن كان التفاعل صادقاً فعلا، وفى رأيى أن كل العلاجات التى تدعى أن المعالج “محايد” أو غير متداخل فى التفاعل، إنما تعلن ضمناً أن تدخله أخفى وأخطر، لأن موقف الحياد مستحيل، فإذا كان ممكناً فهو يعلن بشكل ما توقف النمو من الجانبين، لأنه يعنى أن المعالج ثابت مدافع عن ميكانزماته بانسحابه تحت عنوان عدم التداخل، وبالتالى فإن المريض أو المرضى قد يتبعون نفس الأسلوب تحت أى تبرير ظاهر أو خفى، وقد تبينت من الممارسة أنه توجد مثل هذه المجموعات – التى تجتمع تحت عنوان العلاج الجمعى ايضاً – تؤكد بطريقة ما – أن هذا ” اللاتغير” هو هو التغير المنشود، وبالتالى فهى تؤدى وظيفة نافعة إذ تزيح عن كاهل المترددين الزعم بضرورة التغير وحتمية الصيرورة ..
ولكن لابد من الاعتراف أن إعلان المعالج لنوعية تحيزه، وطبيعة إلتزامه وحقيقة مخاوفه وأبعاد احتياجه..هو السبيل إلى الاقلال من “الاتفاقيات الخفية” بين المعالج والمتردد، وإتاحة الفرصة للتقليل من مخاطر التأثير الذى يختبئ وراء تصوره أو ادعائه الحياد، وكأنى أعلن هنا ضمنا أنه لا حياد فى العلاج النفسى – وأذكر القارئ بلمحة عن العلاج النفسى “المتمركز حول الزبون”([4]) Client Centered Psychotherapy والذى ابتدعه روجرز، والذى سمى أيضا العلاج غير الموجه Nondirective Psychotherapy قد أعلن روجرز شخصياً – مؤخراً – أنه لا يعرف من أطلق عليه لفظ “غير موجه” هذا واعتذر لفريك فى مقابلة خاصة (فى كتاب عن مقابلات فريك مع الإنسانيين فى علم النفس “مازلو وميرفى وروجرز”) أنه لو كان هو الذى أطلق عليه هذا الاسم فهو آسف، وأنه تراجع لأنه لا يوجد علاج غير موجه .. وإلا لما كان ثم علاج..
فالموقف إذن كالتالى: إما موقف من المعالج معلن وقابل للتغيير والتفاعل والمواجهة، وإما موقف سرى شديد التأثير والمناورة بعيد عن متناول النقاش والجدل الحيوى، وأخطر المواقف السرية ما كان سريا على صاحبه ذاته .. ونقابل تأثير هذه السرية الخفية أكثر ما نقابلها عند أشد المعالجين حماساً للحياد..
فإذا انتقلنا إلى المعالج كمادة لهذا البحث فإننا نقابل تعليق الباحث فى أكثر من موقع بأن المعالج كان يكشف نفسه، ويعلن احتياجه، ويدافع عن حقه فى الضعف .. الخ وقد اعتبر الباحث هذا دليلا على تطور المجموعة من جهة ودليلا كذلك على نمو المعالج من جهة أخرى، ولكن علىّ أن أثير من جانبى هنا عدة نقاط إضافية:
1- إن إعلان المعالج لموقفه لا يعنى بالضرورة أن هذا هو موقفه، بل قد يعنى محاولة علاجية تحددها مسئوليته، والتزامه فى وقت محدد تجاه فرد محدد فى مرحلة بذاتها من تطوره، على انى أتصور أن هذا التكنيك العلاجى لم يكن ليخفى على عديد من أفراد المجموعة، وأعتقد شخصيا أن مرحلة هذه المجموعة قد تخطت مثل هذا الموقف الحِرَفى الصرف.
2- إن إعلان المعالج لموقف ما بأنه موقفه شخصيا، قد يخفى عن المعالج نفسه أن هذا ليس موقفه.
3- إن إعلان المعالج لموقف ما قد يكون مناورة من نوع التمويه ذى الدرجتين Double Bluffing، فقد يعلن المعالج أنه يتدخل فى حرية الآخرين، وأنه من واقع مسئوليته ملزم بإعلان أنه يعالجهم لسد احتياجه أساسا، فيبدو بذلك وكأنه أمين وموضوعى. ولكن هذا الإعلان فى ذاته – بما يحمل من مظاهر الأمانة والموضوعية – قد يثير فى الأعضاء احتمال أن هذا ليس صحيحاً وأنهم أحرار حقيقة فى اختيار طريقهم دون تأثير غير مباشر من المعالج، وأن المعالج بإعلانه هذا قد كشف ورقه، والباقى مسئولية المترددين، وقد تحمل هذه الاستجابة فى ذاتها خدعة أعمق لأنها قد تغرى المترددين والمرضى بإلقاء أسلحة حذرهم فى حين أن الأمر يسير فى نفس الاتجاه الذى حذّر منه، أو بألفاظ أخرى ” إن كشف ورق المعالج إذ يؤكد تدخله قد يسهل تدخله لأنه لا يثير الحذر الواجب ضد ذلك”.
ولم يكن الباحث – على قدر تصورى– فى موقف يسمح له بأن يصل إلى الشك فى نوايا المعالج لهذه الدرجة، ربما لتعداد العلاقات المتشابكة بينهما، لذلك وضعت هذا الأمر بوضوح هكذا من بداية البحث، وحتى لا يكون الحماس الخادع هو نهاية تصور الحقيقة..، فإذا كان لى أن أعترف فأنا لا أعرف عن نفسى أكثر مما ذكره الباحث وإن كنت لا أستبعد هذه الدرجات الأخرى من التمويه، وهو أمر بعيد عن إدراكى حاليا أتركه لاختبار الزمن.. أو لباحث أكثر تشككا وربما أشجع.. وربما أكثر دفاعا وتخوفا.. الخ ولكنى أخشى فى نفس الوقت أننا لو فتحنا باب التشكيك إلى التمويه المزدوج ثم الثلاثى ثم الرباعى.. أن نصل فى النهاية إلى موقف “الشك المطلق” وليس فقط “الشك المنهجى،([5]) وكأن الحقيقة الوحيدة فى كل هذه القضية هى أن الباحث يشك، أما نتاج ما يشك فيه وحقيقته الموضوعية فهى ليست فى متناوله شخصياً (ولا فى متناول أحد بالتالى).
إلى هذا الحد يصل التسلسل الطبيعى إلى الاعتراف بالعجز النسبى أو المطلق عن الموضوعية .. ولكن دون التسليم اليائس بعدم إمكان تحديد حقيقة ما يجرى خارج عقولنا، لأن كل ذلك سيتوقف فى النهاية على من هو “الباحث” الذى يشك، الأمر الذى دعانى إلى أن أضعه هو ذاته كمادة للبحث (وهى الفقرة التالية مباشرة).
ثالثاً: الباحث
تعودنا فى التفكير العلمى السائد فى مجال علمنا هذا ألا ندرج الباحث تحت موضوع “مادة البحث” إلا إذا استخدمنا مقولة الاستبصار Introspectionكوسيلة للبحث حيث يكون فيها الملاحـِـظ هو نفسه الظاهرة تحت الملاحظة ولكنى هنا أدرج الباحث تحت مادة البحث من باب آخر وهو أن الباحث فى موقفنا هذا يصدر فى النهاية أحكاما نابعة من إدراكه لمجريات الظواهر، سواء كانت أحكاماً بالنسبة للعينة التى انتقاها ليقدم من خلالها وجهة نظره ويدعمها، أم طريقة سلسلته للأمور، أم تقييمه لما يجرى أم تفسيره لكل ذلك، فهذه الخطوات كلها تشمل أحكاما .. فهى ليست إطلاقا مجرد تسجيل ملاحظات والربط بينها، وهو بمجرد أن يصدر هذا الحكم للمتلقى (القارئ أو الطالب أو الباحث الزميل أو المقيّم للبحث) فإنه يصبح بذلك مادة فى بحثه ونتيجة فى نفس الوقت .. ومن حق كل هؤلاء أن يقيّموه هو ذاته من خلال ما يقدمه .. وكأنى بهذا أضيف صعوبة جديدة فى موقفنا البحثى هذا وهى ان البحث برمته منذ انتقاء الموضوع إلى انتقاء الطريقة إلى انتقاء عينة المعلومات إلى طريقة عرض النتائج إلى تفسيرها … كل ذلك هو فى مقام مادة البحث التى ينبغى وضعها فى الاعتبار ونحن نتناول البحث .. وإلا فنحن معرضون لخداع مضلل … وما دام الباحث أصبح “أداة البحث” و “مادته” معاً فإن تناول هذا “المتغير” بدقة وتمحيص: بما له من صفات الأمانة العلمية وسعة الأفق، وما عليه من دفاعات ومخاوف داخلية، يعطى للبحث مكانه الدقيق فى الكشف عن جوانب ما يبحث، إذ لا يمكن أن نكون موضوعيين بحال إذا أهملنا موقف الباحث من الحياة، ومدى رؤيته، وطبيعة علاقته بالوجود وبذاته .. بما فى ذلك فلسفته وموقفه من الدين والسياسة والزوجة والأولاد (كما أشرنا) .. لأن كل ذلك يحدِّد بطريقة أو بأخرى اتجاهاته من البحث من هذا النوع، وقد تكون النتيجة الهامة التى يخرج منها قارئ لمثل هذا البحث أن هذا الباحث عاجز عن الرؤية الشاملة، أو أنه ظالم خائف، أو أنه عادل شجاع إلى آخر هذه الاحتمالات المتنوعة….
وهذا يرجعنا أيضا إلى ضرورة إعداد باحثين لهم كفاءة خاصة، وصفات خاصة، وإلا فنحن أمام باحثين من “المريدين” أو باحثين من “المدافعين الخائفين” لا أكثر ولا أقل..
وكل هذه الاعتبارات تنبهنا ثانية إلى أنه ما دام الباحث “إنسانا” فى مجال “علم انسانى” فلا سبيل إلا بالمغامرة، ولا أمان إلا بالحذر، وحتى إذا تصورنا أننا أمام عقل إلكترونى محكم .. وأننا سوف نترك له الحكم النهائى بحساباته الآلية .. فإننا سنواجه بالتساؤل العملى: “من الذى سيغذى هذا العقل بالمعلومات؟ أليس إنسانا له موقفه ومميزاته ..” أيضا؟
****
وبتنوع مادة البحث من المرضى والمترددين إلى المعالج إلى الباحث ذاته نجد أنفسنا مرة أخرى – ليست أخيرة– فى موقف يكثف مرحلة صعبة مرّ بها التفكير العلمى ردحا من الزمن، وأعتقد أنه لم يتحمل غموضها وتشابكها، فإذا به ينتهى فى كثير من الأفكار المعروضة كبدائل عن هذه الصعوبة إلى حلول ملتبسة أو جزئية، لا أجد مناصا من التلميح إليها:
1- فقد لجأ فريق إلى الاكتفاء بقياس “جزئيات السلوك” ونسوا أثناء ذلك أن انتقاء قياس هذا الجزء من السلوك دون ذاك، وانتقاء هذه الأداة للقياس دون تلك، إلى آخر عمليات الانتقاء والتخطيط، هى جميعاً من ضمن موقف ذاتى قد يكون هروبا من مواجهة مشاكل كلية أعمق مثل التى طرحناها سابقا، وقد وضعنا هذا الاتجاه فى مأزق تشويه الانسان بتجزيئه دون غائية او عمق شامل، وإن كنت لا أنكر أن إتقان معرفة الجزء هو سبيل لازم لتجميع معالم الكل فى أحيان كثيرة.
2- أما الفريق الآخر فقد لجأ إلى رفض البحث العلمى – فى مجال الإنسانيات – بصورته هذه تاركا الأمر إلى الإنطباع والتأمل الشخصى من خلال التجربة التلقائية وإصدار الأحكام على مسئولية مصدرها، حتى كادت المسألة أن تصبح – فى تقدير هذا الفريق – أقرب إلى التفكير الفلسفى من موقع التأمل بعد الاستيعاب، وقد هوجم هذا الفريق واتهم أنه يرجع بالعلم إلى ما اسموه “البحث على مقعد وثير”، أى بعيداً عن الممارسة العملية والتجارب وإعادتها إلى آخر هذه القصة..، وفى رأيى أن هذا الفريق قد أضاف إلى علمنا قدراً من التنوير لا يقل عن الفريق الأول .. بل لعله يزيد، وأن اتهامه “بالبحث على مقعد وثير” هو اتهام من لم يعرف معاناة التفكير الخلاق وهو يبحث عن جديد… لا يلتزم فيه إلا بصدق ذاتى يحاول أن يقربه من الصدق الموضوعى، فالمقعد فى رايى ليس وثيراً أبدا، بل هى معاناة متصلة، يرجع الحكم فيها إلى ضمير يقظ قادر على رفض كل مسلمة مسبقة .. على مسئوليته (دون أن يجن).
3- أما الفريق الأخير فقد اكتفى “بالخبرة الفنية” ورفض البحث فى الجزئيات بزعم أنه تشويه للحقائق الكلية، ثم خاف من إصدار الأحكام الانطباعية، حتى أصبحت المسألة – فى تقدير هذا الفريق – نوعا من سر المهنة، ينتقل من معلم إلى صبى بالمحاكاة فالتقمص فالتعاطف فالتفجر من الداخل، وسار التعليم فى هذ السبيل هو شبيه بكل الوسائل المعروفة فى أى حرفة من الحرف .. وكانت الدلائل تشير إلى ان الأمور تسير فى اتجاه سليم نافع .. هو استمرار نجاح الحرفة فى أداء المطلوب منها، ورغم أن هذا هو الطريق العملى السائد عند أغلب الممارسين – خاصة فيما يخص خبرتنا وظروفنا – حيث تعتبر كل مقابلة للمريض نوع من البحث العلمى، وكل نتيجة للعلاج تقييم لهذا البحث، وكل خبرة من أستاذ لطالب هى إعطاء سر المهنة، إلا أن هذا السبيل يضعنا فى مأزق حقيقى لأنه يبتعد بنا عن معنى العلم التقليدى، مما قد يعرض المهنة إلى النفى بعيدا عن ما هو “علم مؤسسى” اللهم إلا إذا وجد هذا الفريق وسيلة أو وسائل ينقل بها الخبرة “العلمية” إلى دوائر أوسع فأوسع، حتى لا تصبح حكراً على فئة محدودة معرضه للانقراض تحت مسمى سر المهنة، وهذا مطلب صعب فى كل فن وحرفة إبداعية.
وبعـد
هكذا نجد أنفسنا فى هذا البحث وقد التزمنا بشق طريقنا الصعب “بما يمكن” دون استسهال يلبس ثوب الموضوعية، أو تنظير هو أقرب إلى التفلسف (لا الفلسفة) أو صمت يلبس ثوب الحرفية ويكتم سر المهنة.
ولعل تقييمى الأول لما منحنا هذا البحث هو الطمأنينة إلى أنه بإمكاننا أن نخترق كل هذه الصعوبات برغم شدتها، إذ أن تسجيل الملاحظات بهذه الدقة والشجاعة – مهما كانت انتقائية – ثم عرض الآراء صريحة دون شعور بالنقص أو اختباء وراء الأرقام، ثم الحماس الظاهر لهذه الآراء دون تردد .. ثم التفسير ووجهة النظر الشخصية فى جلاء محدد.. كل ذلك هى خطوات لازمة على مسيرة البحث العلمى، وهى خليقة أن تثير حواراً، على الجميع أن يواجهوه بشجاعة، ثم يأتى الزمن يحكم بين الجميع على مراحل متتالية، إذ يصدر حكمه على المدى القصير بمقياس انتشار الفكر وفائدته العاجلة، ثم على المدى الأبعد بمقياس استمرار الفكر وتحديه، ثم على المدى المطلق بمقياس الإسهام فى مسيرة التطور للنوع كله.
وحكم الزمن هو الفيصل النهائى فى كل مبحث يتجرأ ليعلن أنه رأى زاوية من زوايا الحقيقة.
وأعتذر فى النهاية إذْ أطلت حتى انتهيت إلى هذه النهاية المزعجة والمسئولة فى نفس الوقت، ذلك لأنى من أشد الناس إشفاقا على إضاعة وقت الباحثين – وخاصة الشباب منهم – فى توهم موضوعية لا وجود لها إلا بقدر الاعتراف بعجز الباحث ومحاولته هو نفسه التطور للاقتراب من الموضوعية فى كل مناحى حياته، وكذلك فإنى من أشد الناس حرصاً على تذكير كافة الباحثين فى مجالنا هذا بضرورة التسجيل وإبداء الرأى دون مخاوف أو تردد أو تلكؤ، ثم يتواصل الحوار والتصحيح وتتمادى المراجعات بغير نهاية.
[1] – يحيى الرخاوى: “الباحث أداة البحث، وحقله فى دراسة الطفولة والجنون” عدد أكتوبر 1980 “مجلة الإنسان والتطور الفصلية”.
[2] – انظر هامش (10)
[3] – انظر هامش (6)
[4] – مدرسة العلاج المتمركز حول العميل أو مدرسة العلاج المتمركز حول الشخص بالإنجليزية : Person-centered therapy هى العمل الرئيسى الذى نشره كارل روجرز عام 1951. وتُعد من أوضح الأمثلة على المدارس الإنسانية فى العلاج النفسي. صنفها النقاد كونها ممارسة لعلاقة إنسانية عميقة من الفهم والقبول حيث يقوم المعالج بإظهار الانفتاح والتعاطف والتقدير الإيجابى غير المشروط، مع أهمية إبرازه الاستماع العميق المتمعن للعميل والمحاولة الأمينة للدخول إلى عالمه الخاص لمساعدته على التعبير عن ذاته وتطويرها.
تُؤكد هذه المدرسة على أن العميل هو مركز العملية المشورية وليس المعالج، حيث أنها تؤمن أن كل إنسان لديه القدرة الكامنة على التعامل مع مشكلاته واستخراج الموارد الكامنة فى نفسه لإزالة الأسباب المعوقة لنموه الشخصي. كما تُوكد أيضًا على أولوية الفرد فى مقابل الجمود والعقائدية الموجودة سواء فى الدين أو فى المدارس النفسية الجامدة مثل التحليل النفسى الكلاسيكي.
كارل روجرز (8 يناير 1902 – 4 فبراير 1987) عالم نفس أمريكى هام، قام مع أبراهام ماسلو بتأسيس التوجه الإنسانى فى علم النفس السريري. ساهم أيضا بتأسيس العلاج النفسى غير الموجّه الذى سماها العلاج المتمركز حول العميل ليؤكد أن نظريته يمكن تطبيقها فى كل التفاعلات بين الأشخاص وليس فقط على التفاعل بين المعالِج والزبون.
اعتقد روجرز أن الدافع الأساسى لأفعال البشر هو الرغبة فى التحقق الذاتى وأن المشاكل النفسية تأتى من عدم التلاؤم بين “الذات” و”الذات المثالية” و”الذات العملية”. بحسب روجرز فإن الفجوة بين المسموح به وبين الإحساس الذاتى قد يؤدى إلى الكبت. قام روجرز بالتشديد على مساوئ الكبت مثله مثل سيجموند فرويد ولكنه اختلف عن فرويد بقوله أن الكبت ليس أمراً محتما. ويختلف روجرز عن فرويد أيضا بنظرته المتفائلة للطبيعة الإنسانية.
[5] – يقول ديكارت: “يجب النظر إلى كل ما يمكن أن يوضع موضع الشك على أنه زائف” ولا يقصد ديكارت بذلك الحكم بزيف كل شيء، أو بزيف كل ما يوضع محل الشك، بل يقصد أنه لن يقبل بأى شيء على أنه حقيقى ما لم يُخضع لامتحان الشك، الذى يستطيع به الوصول إلى شيء يقينى عن طريق برهان عقلي.
الفصل الخامس جدل العقول وحركية تخليق الوعى
الفصل الخامس جدل العقول وحركية تخليق الوعى
الفصل الخامس: جدل العقول وحركية تخليق الوعى الجمعى
العلاج الجمعى لا علاقة له بالعقل الجماعى
النقلة من الاكتفاء الذاتى والترابطات الثنائية إلى الانتماء إلى “الوعى الجمعى” نقلة من أدق وأهم ما يُوَاجَه به الوعى البشرى على مسار تطوره حتى الآن، ويبدو أن العلاج الجمعى، ومثله، يمكن أن يكون السبيل لتصحيح كثير من مفاهيم ما يسمى علم النفس الاجتماعى، أو حتى علم النفس الجمعى، ذلك أننى حين رحت أبحث عن ما يسمى “ذات الجماعة ” Group Ego، فوجئت بأن ما يذكر فى هذا الصدد أغلبه دراسات ومواصفات عن ما يمكن أن يسمى سيكولوجية العامة، أو سيكولوجية التجمعات أو سيكولوجية القطيع، وأخص بالذكر كتاب سيجموند فرويد عن علم النفس الاجتماعى وتحليل “الذات”([1]) مع إشارات قوية لماك دوجال، المهم فى كل هذا أن هذا التوجه كان مهما بالنسبة لى حيث وصلنى منه غير ما نمارسه نحن فى العلاج الجمعى تماما، ذلك أنه وصلنى أن التركيز فى مثل هذه التخصصات كان على وصف ما يحدث من إلغاء التميّز الفردى (أو العقل الفردى، أو الذكاء الفردى، أو التفرد الذاتى) لحساب تحريك جموعى انفعالى نكوصى ضعيف الكف قصير النظر.
حين رحت أتأمل هذه الصورة مع تقارب الاسم Group mind انتبهت إلى الفرق الشاسع حتى العكس تقريبا بين ما نطلق عليه الوعى الجمعى Collective Consciousness، وهو الأسم الذى شبهته (قبل أن اطلع على هذه الاستعمالات الباكرة) بـ “ذات الجماعة”، وإذا بالمسألة غير ذلك، ومن هنا وجدت لزاما على أن أبين ما وصلنى من طبيعة هذا الاختلاف بشكل مبدئى وأساسى وجوهرى:
هذا وقد اختلفت مع “يالوم”([2]) فى اعتبار “التقليد” (الأسلوب المحاكاتى ص 109) من العوامل العلاجية إلا بدرجة طفيفة مؤقتة وعابرة، كنت متوجسا من تصور أن هذا التقليد قد يُفهم على أنه إسهام فى تخليق الوعى الجماعى الذى أشرت إليه: فرفضت التسليم غير المشروط لهذا “الاسلوب المحاكاتى” كعامل إيجابى منبها أن هذا التقليد الذى وصلنى كان أقرب إلى غريزة القطيع([3])، وهو ما لا يساهم فى تكوين الوعى الجماعى إيجابيا.
كما رجح لدى أن هذه الظاهرة التى وصفها “ليبون”([4]) هى ظاهرة نكوصية انفعلاية (وليست حتى وجدانية) بدائية، وبالرغم من أنها توصف بوصف جماعى، وأحيانا بالعقل الجمعى بالذات، فإنها أبعد ما تكون عن موضوعية الواقع وعن النضج وعن التخطيط الهادف جميعا، وإن كانت لها وظيفة مرحلية فى السياسة وما إليها أحيانا، وفى مراحل معينة مما يسمى الثورة، وأيضا بالرغم من أنها تنتمى فى تفسيرها إلى فكر التطور، إلا أنها بالمواصفات السابقة هى أبعد ما تكون عن ما يجرى فى العلاج الجمعى، بل لعل العكس هو الصحيح، مما نشرح بعضه على الوجه التالى:
(1) نحن نتعامل فى هذا العلاج مع عدد من العقول (مستويات وعى) لكل فرد، معا باحترام شديد، وتبادل محسوب، فى حين أن عقل الجماعة فى القطيع هو عقل واحد انفعالى بدائى غالبا
(2) حركية التعامل فى العلاج الجمعى هى فى جدل هذه العقول معا على مستويات مختلفة ليست قاصرة حتى على التحليل التركيبى لإريك بيرن([5])، وإنما هى تشمل أى مستوى متاح نعرف له تسمية أو لا نعرف، فهى حركية إبداعية تلقائية تحسب بنتائجها التراكمية.
(3) تفسير ما يجرى بلغة حركية الوعى على المستويات المتنوعة والمتصاعدة والمتداخلة هو من أصعب ما يكون، كما أن تحديد أبعاد مفهوم الوعى نفسه ما زال من اصعب ما يكون أيضا
(4) إحياء ديالكتيك التطور، الذى وصفناه كآلية أساسية فى العلاج الجمعى، لا يعنى العودة إلى مرحلة سابقة للتطور مثل ما وصلنى من فرويد و”ليبون”، وإنما العكس: أعنى أنه دفع مستويات الوعى المتبادلة “إيقاعا”، أو المتراوحة “ذهابا وجيئة”، إلى المواجهة اشتمالا فجدلا، ليتخلق منها المستوى الأرقى ما أمكن ذلك، فى حين أن التناقضات التى وصفت فى “العقل الجمعى” هى بمثابة تجاور الأضداد بلا حركية وبلا إبداع خلاّق.
(5) التعامل مع الزمن فى العلاج الجمعى شديد الحيوية بالغ الحساسية، انطلاقا من التركيز فى “هنا والآن”، بما يستتبع ذلك من استيعاب التغيرات الشديدة الضآلة لكنها فى نفس الوقت البالغة الدلالة نوعيا، وكل هذا لا يرصد أولا بأول بقدر ما يتراكم ويـُستنتج من النتائج.
(6) فى العلاج الجمعى تتأكد فردية كل فرد كلما انتمى أكثر إلى الوعى الجماعى المتكون فيما بين أفراد الجماعة، بما يحقق مقولة وينيكوت “أن تكون وحيدا مع To be alone with”([6])، وهو ما أشار إليه “يالوم” كأحد العوامل العلاجية، وهو ما يتفق مع خبرتنا، فى حين أنه فى حالة العقل الجماعى تذوب شخصية الفرد فى الجماعة ويصبح رقما مكررا لا أكثر، كأنه صدى يتردد فى فراغ.
(7) فى العلاج الجمعى يتواصل نشاط حركية “برنامج الدخول والخروج“، من الذات إلى الوعى الجمعى، وبالعكس، وفى كل “رحلة دخول وخروج” تختلف نقط البداية والنهاية حتى لا تكون حركة فى المحل، أما فى العقل الجمعى فتنطلق الحركة مثل إعصار لا يعرف أحد مصدره فى كثير من الأحيان، وتختفى معالم محتواه ولا يتراجع، وأحيانا ما تكون الحركة فى “المحل”.
(8) فى العلاج الجمعى يتواصل أيضا تنشيط وتوجيه “الإيقاع الحيوى”، فيتراوح نبضه بين استيعاب ما يجرى، وبين بسط ما يتشكل: دون إعمال فكر ظاهر، أو مراجعة معقلنة، ثم ينشط من جديد، وهكذا، وعلى القائد أن يراعى هذا التناوب ما أمكن ذلك دون التزام بتوقيت معين أو توزيع الوقت بشكل ملزم، فالنبض الذى يجرى يختلف طول دوراته من شخص إلى آخر، ومن مرحلة إلى مرحلة طول الوقت، أما فى العقل الجمعى فتتقلص الحركة فى اتجاه الانقباض الدافع معظم الوقت ثم تتمادى بالقصور الذاتى فلا وقت للاستيعاب أو للملء، فلا سبيل للقياس بالإيقاع الحيوى؟
(9) فى العلاج الجمعى ينشط الجدل الحيوى لاستيعاب ما يبدو متناقضا، من خلال آليات كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال العكس، والجمل الناقصة، والألعاب، والمينى دراما وحين يحضر قصدا الشىء ونقيضه يتراجع التناقض ليس بحدوث حل وسط تلفيقى أو حتى توفيقى، وإنما بتوجه سهم المتناقضين جدليا إلى هدف ثالث مشترك من خلال فاعليتهما معا من أكثر من وجه على أكثر من مستوى.
(10) فى العلاج الجمعى ينسلخ أى شخص لأى فترة بعيدا عن الوعى الجمعى فى عملية مراجعة، أو مقاومة، أو حتى استراحة، ويعود حين يستطيع أو يقرر أو ينكشه القائد أو أحد الزملاء، أو لا يعود، ولا يعتبر ذلك خيانة أو خيبة أو تقاعسا، فى حين أنه فى العقل الجمعى يكاد يعتبر من يفعل ذلك ناشزا، أو عدوا، أو جسما غريبا مـُقحما، المهم أنه يُلفظ بطريقة ما من الجماعة سرا أو علانية، وقد يهلك نتيجة لإنفصاله.
وبعد
أتوقف الآن لأتساءل: بالله عليكم ما ذا يصل من كل ما سبق لواحد لم يرى كل هذا رأى العين أثناء الممارسة، متدربا، أو حاضرا فى الدائرة الأوسع متعلما؟ هل من المعقول أن متخصصا عاما يقرأ هذه النقاط العشرة، بهذا الإيجاز، مهما كانت تصف الأمر الواقع، يصله منها ما يعاونه على القيام بهذا النوع من العلاج؟
الإجابة عندى جاهزة وحاسمة وهى غالبا النفى المبدئى، ثم الأمل المؤجـَّل.
طيب هل يحتاج من يمارس هذا العلاج أو يتدرب عليه إلى مثل هذا التنظير، وكيف يستفيد منه؟
الإجابة عندى أن الإفادة ممكنة، بالمعنى العام أعنى أن تكون دعما لما قد يمارسه، وليست إرشادا مباشرا لما عليه أن يمارسه.
احترت بعد ذلك كيف أقدم عينات تبين بعض ما أشارت إليه هذه النقاط العشر كأمثلة؟ إن تقديم ما جرى فى جلسة ما، كما فعل يالوم فى كتابه السالف الذكر وغيره، هو أمر وارد وغالبا مفيد، فقط لمن يمارس العلاج ويستطيع أن يُعمل خياله ويتصور ما لم نذكره، وحتى تقديم بعض المقاطع من الفيديو لا يمكن أن يوصل الرسالة التى احتوتها هذه النقاط ومثلها وغيرها.
ولكن: ربما أكتفى بعينات محدودة، حتى أجمع وأرتب ما يفيد فى أحد إصدارات هذه السلسلة لاحقا! فى كتاب يعرض الألعاب والمينى دراما.
[1] – Sigmund Freud: Group Psychology and the Analysis of the Ego 1922
والذى ذكر كثيرا عملا باكرا لجوستاف ليبون
– Gustave Le Bon and the Group Mind tradition first published in 1895. Moscovici (1981)
[2] – The Yalom Reader “Selections from the work therapist and storyteller” Edited by: Irvin D. Yalom Copyright: 1998
[3] – أنظر الفصل الثالث “والأصل فى الوحدات أن تجمعا”
[4] – Gustave Le Bon and the Group Mind tradition first published in 1895. Moscovici (1981)
[5] – Eric Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy in 1961
[6] – هذا مصطلح رائع استعرته من المحلل النفسى “دونالد وينيكوت” Winnicott
الفصل السادس من العزلة وتشكيلات الارتباط
الفصل السادس من العزلة وتشكيلات الارتباط
الفصل السادس: من العزلة وتشكيلات الارتباط الثنائى إلى تخليق الوعى الجمعى
الاختلاف الجوهرى الذى وجدته بين خبرتنا وخبرة “يالوم” هو أن منطلقه كان أقرب إلى التصحيح والتوفيق والدعم، أما ما وصلنى من خبرتنا فيمكن أن أزعم أن المنطلق كان أقرب إلى التعتعة فالتحريك فالإبداع فتخليق الوعى الجمعى القادر على إحياء جدل نمو التطور على مستوى الوحدات البشرية والوحدات الاجتماعية الصغيرة، وبرغم اتفاقنا وإياه على غموض العامل العلاجى وأيضا على إمبريقية الخبرة وضرورة قياسها بالنتائج العملية على أرض الواقع، بغض النظر عن الخلفية النظرية أو حتى حقيقة ما يحدث، إلا أنه يبدو أن علينا أن نواصل توضيح الخلفية النظرية المحتملة تأكيدا على اختلاف الثقافة من جهة، واحتراما لاختلاف نوعية التشخيصات من جهة أخرى وخصوصا اشتمال المجموعات لدينا على نسبة مناسبة من الذهانيين.
حين عرّفت هذا العلاج على انه “إحياء ديالكتيك النمو” فى بدايات هذه الممارسة لم تكن الصورة بهذا الوضوح بالنسبة لموقع هذا العلاج فى تحريك طور “البسط والتشكيل” فى نبض الإيقاعحيوى، وخاصة فيما يتعلق بالنقلة من العزلة أو الارتباط الثنائى إلى الانتماء للوعى الجمعى، إلا أن هذه المسألة أخذت تتضح لى مع استمرار الكتابة والمتابعة حتى فضلت أن أخصص لها هذا الفصل.
المرض النفسى (بعد استبعاد المرضى العضوى التشريحى مؤقتا) هو مرض العلاقات البشرية كما تتجلى فى مظاهر اضطرابات تشكيلات الوعى (فالسلوك) وكذلك صعوبات التواصل (فالمعاناة أو الإيذاء أو كليهما مع درجات من الإعاقة). نوبات النمو بالنسبة لنظرية التطور التى أنتمى إليها هى استعادة لمراحل نمو الحياة بشكل إيقاعى منتظم لا يتوقف، وفى نفس الوقت لا يوجد تماثل مطلق مهما ضؤل الفرق بين نبضة وأخرى، يحدث ذلك من أصغر نبضة ولادة الفكرة (ميكروجينى Microgeny) حتى أزمة النمو (الإريكسونيةEric Erickson مثلا) مرورا بنبضات النوم/الحلم (نوم “رمك” واللا “رمك” REM & NREM) وسوف نقدم التصورات والمشاهدات على عدة محاور أهمها:
الأول: ربط الارتباط الثنائى بين الأحياء، بتجليات أنواع الارتباط الثنائى بين البشر آخذين المؤسسة الزواجية كنموذج.
الثانى: فروض النقلة من العزلة أو الارتباط الثنائى، الإيجابى والسلبى، إلى تشكيل الوعى الجمعى كمرحلة أرقى وأنضج تطورا، دون التخلى عن الارتباط الثنائى.
الثالث: حركية برنامج الدخول والخروج فى تطبيقاته وأثرها على استمرارية الانتقال من الثنائى إلى الجمعى وبالعكس بإيقاع مضطرد، لا يتوقف ولا يكتفى بأحدهما بديلا عن الآخر.
الرابع: فروض العلاقة التى تبين دوام نبض حركية هذا الوعى الجمعى المتشكل نحو الوعى الجماعى الأوسع إلى الوعى الكونى المطلق.
وبعد:
1- انطلاقا من التذكرة بأن الإنسان يحمل فى تركيبه الحيوى البيولوجى أغلب أنواع الأحياء، ومن ثم أغلب تنويعات العلاقات، فالأرجح أن تكون معظم هذه البرامج العلاقاتية الثنائية جاهزة فى تركيبه. ومن ثم فإن نجاح أو فشل مثل هذه العلاقات الشديدة الصعوبة قد يتوقف على تنـَاسـُبِ تنشيط حركية النمو بصفة عامة، مع المرحلة أكثر مما يتوقف على انتقاء وتفضيل نوع بذاته غير حاضر بالضرورة فى وقتٍ بذاته وغير مضمون استمراره.
2- إن حركية النمو ذهابا وجيئه، نكوصا وتطورا، اقترابا وابتعادا، دخولا وخروجا هى التى تسمح لكل هذه التنويعات أن تدخل التجربة وتخرج منها بشكل مرن واعد، مرورا بالآلام المصاحبة، وتعرضا للمضاعفات المحتملة.
3- إن الذى يسمح بالحفاظ على الأمل فى هذه العلاقات الثنائية الصعبة والضرورية فى آن، دون أن يعاق أو يضار أحد الطرفين أو كليهما بشكل دائم أو متزايد، هو دعم حركية النمو هذه لأطول وقت، ونحن نضع فى الاعتبار حتمية الإيقاع الحيوى وقوانينه التى تساعد على ذلك، ليأخذ كل طور حقه – إذْ تتبادل الممارسة المستوْعِبةْ مع البسط الإبداعى– بمعنى أن المسيرة تحتاج إلى وقت للامتلاء بالخبرات الإيجابية وغير ذلك، حتى تمتلىء – بالقدر المناسب للمرحلة، ثم يطلق النبض الحيوى طور البسط Unfolding phase الذى تصاحبه عادة أزمة نمو، لو أحسنّا معايشتها، فإنها تعيد تشكيل العلاقة على مستوى أعلى كما ذكرنا..، وهكذا.
على هذا الأساس يمكن أن نضع فروضا لحركية العلاج الجمعى ومساره انطلاقا من هذه الأسس العامة ولكن دون محاولة التدقيق فى فصل أطوار النبض عن بعضها البعض ولا التركيز على تفاصيل حركية كل فرد فى المجموعة على حدة، تماما مثلما لا تستطيع رصد النبضات المتناهية الصغر (الميكروجينى) على مسار النمو الطبيعى للطفل فالراشد حتى نهاية العمر، وربما مثلما لا نستطيع أن نرصد حركية بلورات السكر في تشكيل السكر النبات: فى التجربة السالفة الذكر.
البداية:
رحت أنتبه إلى فحص ومراجعة ظاهرة هذا التعالق الثنائىSymbiosis بدافع البحث عن أبعاد مضاعفة معطلة نسبيا فى العلاج الجمعى، حين كنا نرصد ما يسمى “الثنائية Pairing (كما وصفها Bion) حين يرتبط أحد أفراد المجموعة ارتباطا خاصا جدا بآخر أو أخرى، وذلك أثناء العلاج، إما لأنه يشبهه، أو لأن دفاعات أحدهما تدعم دفاعات الآخر وبالعكس، كنا نسمى ذلك من باب الفكاهة (العلاجية) أو التعرية للإفاقة “سَنْبَطَهْ” من Symbiosis، (وذلك بعد أن نـَـحـَـتـْـنـَـا فعلا جديدا فى اللغة العربية هو فعل: سـَنـْبـَط، يـُسـَنـْبـِط)، وننظر إليها نظرة ذات دلالة، وتتعامل المجموعة – تحت قيادة المعالج (أو أكثر) – مع هذه الظاهرة وهى تهدف إلى التخفيف من حدة هذا الترابط السلبى عادة، حتى يعود انفتاح هذين العضوين على المجموعة، بما يدعم مسيرة نموهما وتقدم المجموعة الذى هو هدف العلاج أساسا، ليعود على أفرادها جميعا بحفز مسيرة التطور.
ثم إنى اضطررت أن أرجع إلى أصل كلمة Symbiosis أثناء كتابة أطروحتى عن تحرير المرأة وتطور الإنسان سنة 1975([1]) بحثا عن تنويعات “العيش معا“ً عند مخّتلف الأحياء، فلم أتمكن – فى الوقت المتاح – من أن أحصد التباديل والتوافيق بسهولة من المراجع الأوسع، فلجأت إلى القاموس الطبى دورلاند ([2])، وإذا بى أعثر على خمس تصنيفات متنوعة، بلغتْ من الوضوح والتمايز أن أوحت لى أن أحاول أن أنظر فى العلاقات البشرية الثنائية، خصوصا بين الرجل والمرأة، من خلال هذا المنظور.
بصفة أساسية، وبإيجاز أرجو ألا يكون مخلاً، وجدت أن تقسيم التنويعات يعتمد على مدى الضرر أو الفائدة، أو عدم التأثر، مما يعود على كل طرف من الطرفين نتيجة لهذا “التعايش معا”.
وقد وجدت أن عرض هذه التنويعات فى جدول موجز يمكن أن يكون أكثر فائدة وأوضح للمقارنة على الوجه التالى:
تعقيب محدود وتنبيهات هامة:
خطر لى فى البداية أن أتوقف عند عرض هذا الجدول هكذا، لأدع خيال القارئ يتصرف رفضا وقبولا، وإعادة تشكيل كما يشاء، ثم تداركت الأمر لأضيف ما يلى:
أولا:
المقصود بتعبير “يستفيد”، أو “يتضرر“، ليس أساسا الفائدة الظاهرة أو النفع القريب، ولكن المقصود من الفائدة هو أن تكون هذه العلاقة الثنائية هى أيضا لصالح حياة، بقاء، او دفع مسيرة نمو الفرد فى ذاته لذاته، وفى الأحوال الأحسن لا تقتصر الفائدة فقط على الإسهام فى أن يتحقق الفرد بذاته لذاته من خلال هذه العلاقة، ولكن أيضا هو ينطلق منها على امتداد مسيرة نموه، لتطوير ذاته إلى ما تعدُ به، ثم تمتد لمن حوله إلى ما يعد به نوعه من “برامج تطوره”.
أما الضرر فهو عكس ذلك تماما، أى أن تكون العلاقة على حساب اضطراد الحياة ودعم البقاء، مرورا بإعاقة تحقيق الذات مرحليا، ثم تمتد الإعاقة إلى مسيرة النمو سواء كان ذلك لحساب الآخر: ليس بالضرورة من منطلق النمو (مثل الارتباط الطفيلى) أو على حساب الاثنين (مثل الارتباط التحطيمى).
ثانياً:
لا يمكن وضع حد فاصل بين أنواع هذه الترابطات وبعضها البعض، ففى حين تتصف أحياء بذاتها بنوع خاص من الترابط، فإن الإنسان الذى يحمل تاريخ كل الأنواع، وتتكرر دورات نموه (تطوره) خلال عمره كله، وهو يمر بكل تنويعات نبضاتها، هو كائن جدير وجاهز أن ينتقل من نوع من الترابط إلى آخر، تبعا لحيوية تجربته، وتفتح مسار نموه، أعنى نموهما، كل على حدة، و”معا”
فقد يبدأ الارتباط طفيلا، أو حتى تهلكة (أموت فيك وتموت فياّ) حتى إذا استنفد أغراضه يفيق أحد الطرفين أو كلاهما فيصبح تعايشيا أو حتى تكافليا.
والعكس صحيح، فقد يبدأ تكافليا لنفع الاثنين كل على مساره، ثم يُنهك أو يُستهلك، او ينتهى عمره الافتراضى نتيجة سوء تعهده، فينقلب طفيليًّا: حين تنسحب المرأة – مثلا – من المجتمع الأوسع، من العمل، من الناس، تلقائيا أو بفعل فاعل، فتتنازل عن استقلالها، أو حين يُنهك الرجل أو يكسر لسبب ما، فيتراجعً عن مسيرته لتتبناه المرأة: معتمِدًا تماما فيصبح طفيليًّا عليها، وهكذا …إلخ
ثالثاً:
إن الانتقال من نوع إلى آخر لا يسير فى خطى تصعيدية أو تراجعية خطية، وإنما هو يتذبذب تطوراً أو نكوصا حسب المراحل، وحسب تأثير عامل الزمن سلبا وإيجابا، وحسب الوسط المحيط، وحسب الظروف الضاغطة وبقدر الفرص المتاحة وتنوعها.
رابعاً:
إن فرص التحول من نوع من الترابط إلى آخر تظل متاحة باستمرار، وفى نفس الوقت هى تتأثر ببرامج التطور الملائمة، وبثقافة المجتمع المحيط وأيديولوجياته وقيوده، ومساحة الحرية، والسماح بالتغير وفرص الإبداع (إبداع الذات خاصة).
خامساً:
إن علامات فشل نوع من هذه الترابطات تُعلَنُ بأشكال مختلفة، ليست قاصرة على إعلان الاختلافات الزوجية (أو الثنائية) بالطريقة المباشرة، فقد تظهر فى شكل عَرَض نفسى أو مرض نفسى، أو جسدى، أو ربما يعلن الفشل من خلال تغيّر مُنذر فى أى من مجالات التواصل بينهما (التواصل الجسدى أو الفكرى أو الوجدانى أو كل ذلك … إلخ) كما قد يتجلى أو يتفاقم الخلاف مع ظهور سلوك مُبَاعِد فى ذاته، أو تداخل بديل يحرك مستوى آخر من التواصل لأحد الطرفين يبعده عن شريكه بشكل مباشر أو غير مباشر.
سادساً:
إن ظهور أى من إنذارات أو أعراض فشل أى نوع من هذه الأنواع يعتبر فرصة “مفترقية” (على مفترق الطرق) لإعادة النظر، ومن ثم إمكانية التقدم نحو نوع أكثر إيجابية وأطول عمرا، أو قد يحدث أنه بإعلان الفشل تماما ربما تظهر لأى طرف من الاثنين أو لكليهما فرص أخرى بشكل أو بآخر، فيبدأ مسيرة أنجح.
سابعاً:
إن المطلوب ليس هو الإصرار على أن تكون البداية جيدة (تكافلية مثلا) من أول الطريق، لأن ذلك أمر دونه توافر مقومات التكافل الحقيقية لضمان ممارسة بنّاءه على أرض الواقع، وإنما نلفت النظر إلى أهمية الحركة والمرونة إلى ما هو أبقى مهما كانت البداية.
ثامناً:
إن أية بداية – مع ضمان حركية التطور من حيث المبدأ – بأى نوع من الترابط قد تتيح فرصة لتطوير العلاقة (بعد، ومن خلال، أزمات نمو العلاقة، ونمو الطرفين أيضا) إلى نوع أفضل وأفضل نحو التكامل…
تاسعاً:
إن احترام مسيرة الواقع من خلال الممارسة المفتوحة لكل الاحتمالات هو الذى يسمح لدورات النمو والتصحيح بإعطاء أكبر فرصة لحركية النمو بالمراجعة والتصحيح الفعلى.
عاشراً:
إن هذه كلها فروض قابلة للمناقشة والاختبار.
وبعـد
أولا: على الرغم من أن بداية تحديث هذا الفرض الذى ظهر باكرا مرتبطا بأطروحة أسبق عن “تحرير المرأة وتطور الإنسان” قد فرض نفسه من واقع ممارسة العلاج الجمعى، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى تطورات هذه العلاقات المحتملة من خلال العلاج الجمعى بالذات وهذا ما قد يظهر مع عرض حالات، أو إذا ظهر سياق مناسب لكل نوع أو لأى نقله.
ثانيا: كثيرا ما تكون البداية فى العلاج الجمعى ليست من صعوبات أو مضاعفات العلاقة الثنائية، وإنما من الانغلاق الأساسى على الذات فى الحوصلة الشيزيدية، (الشكل) وفى هذه الحال قد تتنقل المسيرة عبر أى من الصعوبات الثنائية أو تتجاوزها مباشرة إلى الإسهام فى تكوين الوعى الجمعى بأقل حاجة إلى الوقوف طويلا فى المرحلة الثنائية، حسب تطور كل حالة، وتطور المجموعة.
من التعدد إلى التكامل “معا”: مفتوح النهاية
انتهينا إلى أن الفكرة المركزية فى ممارستنا للعلاج الجمعى تنبع من فروض تعدد كيانات الوجود البشرى فى الفرد الواحد، وذلك فى طريقها المفتوح النهاية إلى الواحدية، وأن هذا يتحقق أكثر، وينشط علاجيا من خلال تقنيات تتناول هذه المسألة بحرفية لعدد من المرضى (أو البشر عموما) بحيث يتخلق من معيتهم معا وعيا جماعيا يحتوى التعدد نحو كلٍّ يتوحد، وفى نفس الوقت تنشط مسيرة النمو للأفراد فى محيط هذا الوعى الجمعى.
وفيما يلى نقدم جذور انتمائنا للفكرة منذ ظهرت:
الوحدة والتعدد فى الكيان البشرى(1) ([1])
دراسة الإنسان شديدة الصعوبة، شديدة الخطر، فهى شديدة الصعوبة منهجا، شديدة الخطر جوهرا وعواقبا، وحين أقول “دراسة الإنسان” فأنا إنما أعنى دراسته (1) كيانا، (2) وجوهرا، (3) وتركيبا، (4) وسلوكا، (5) وغاية، (6) وجزءا من كل إكبر.
إن إشاعة دراسة الإنسان كانت -ومازالت- تخضع لعوامل عديدة تكاد تبعدنا عن حقيقتها، وفيما يلى نعرض بعض القصور المرتبطة بهذه المحاولات:
1- الإنسان هو الشىء “الممكن دراسته“ أعنى أن الظاهرة الإنسانية قد تختزل الى ما يقع فى قدرة أدوات الدراسة ومدى المنهج المستعمل، فاذا قصر المنهج عن رؤية بُعْدٍ ما فى الوجود البشرى فالحل هو إهمال هذا البعد واعتباره غير موجود أصلا ضمن الظاهره الانسانية، وهذا موقف متواضع عاجز، ورغم أنه عملى ومنطقى، إلا أن الحماس ضاعف من عملية الإنكار هذه حتى أصبح الإنسان مجموعة ظواهر قابلة للقياس والفحص حتى ولو لم يكن كذلك فقط، أو لم يكن كذلك أصلا.
2- ثم تأتى فى الطرف الآخر دراسة الانسان من منطلق محتوياته: الانسان هو مجموع ما يحوى من مخزون وطاقة يحددان سلوكه ومعالمه جميعا، وتخضع دراسة هذا الذى يحتويه هذا الوعاء لاستنتاجات منطقية وعينات محتملة من هذا المحتوى وتفسيرات رمزية تترجم هذا المحتوى إلى تصور ممكن.
ويتساوى هذان الإتجاهان فى أنهما يجعلان الإنسان مجموعة أجزاء، سواء كانت نتاج جزئيات السلوك، أم تراكمات المحتوى فهل هو كذلك؟
3- ثم يقفز مفهوم كلى لاحت معالم واحديته منذ الخمسينات، يتناول الإنسان باعتباره “كيانا كليا واعيا وإراديا” وقد سمى أغلب المتدرجين فى هذا الإتجاه باسم شامل غير واضح المعالم وهو “ الاتجاه الإنساني“، واستعملوا لغة عامة أقرب الى لغة الشعر متصورين أنهم بذلك قد تخطوا التجزيء والتفتيت، إلا أنهم فى حماسهم نحو الكلية ضد الجزئية قد تخطوا أصلا إحتمال التعدد، وأصبح الانسان لديهم وحدة نامية بشكل متصل، وهم لم يبسطوا الأمر لدرجة التسطيح الذى قد يبدو من ظاهر تقديمى، فالانسان عندهم كيان مركب شديد التعقيد والتكثيف، لكن تركيز هذا الاتجاه على كلية ووحدة الإنسان يتخطى بشكل ما احتمال تعدد تركيبه ووجوده جميعا.
فالاتجاهات الثلاثة قد سلمت بشكل أو بآخر باعتبار الانسان”وحدة” – من البداية للنهاية – بشكل أو بآخر، وهذا أمر بديهى بل وضرورى لأنه تترتب عليه أمور عملية ووظيفية لا تحتمل غير ذلك، فأى فرد كائنا ما كان وبغض النظر عن “ما هو”، هو يقوم من نومه ويغسل وجهه ويذهب الى عمله ويحيى الناس ويكسب قوت يومه … الى آخره، وعامة النـاس لا تقبل فى أى شخـص كائنا من كـان هـو، (أو ” مـا هو”) أن يكون غير ذلك، ولا تستطيع أن تعامله إلا بصفته الواحدية المفردة واذا ما كان الأمر غير ذلك، فإن الدهشة تبدأ، والأحكام تصدر، فاذا كان”هو” أحيانا “هو”، وأحيانا ”ليس هو” وإنما هو آخر، (وفى الحالين فهو واحد مفرد) قيل أنه متقلب أو غريب الأطوار أو ذو وجهيـن، وقد يتحذلق البعض فيصفونه بالازدواج، فإذا زادت الحذلقة وُصف بالانفصام وهلم جرا، وهذه الأوصاف تختلط فى أذهان العامة وعلى ألسنتهم، كما أنها تعنى التعدد (أو الازدواج) فى أزمان مختلفة وليس فى نفس الوقت عادة.
فاذا كان الأمر كذلك عند العامة، فهل يكون هو كذلك عند العلماء؟ حتى هذه المرحلة من التقديم يبدو أنه يمكن أن يكون كذلك أيضا عند بعض العلماء، إلا أن المتأمل للغة المستعملة فى بعض النظريات النفسية سوف يكتشف أن الإشارة ظهرت من قديم تشير إلى احتمال التعدد فى الكيان البشرى الفرد فى آن واحد، رغم ظاهر الوحدة والتفرد:
(أ) ويمكن أن نبدأ بالإشارة الى حدس يونج الأعمق لما هو كيان داخلى سواء فى إشارته الى “القناع” (السلوك الخارجي) فى مقابل ” الظل” ( الكيان الداخلى) أو إشارته إلى ” الأنيما” فى مقابل ” الأنيمس” (بمعنى وجود الكيان الأنثوى داخل الإنسان الذكر والكيان الذكرى داخل الإنسان الأنثي)، ثم وهو يشير الى النماذج المتوارثة عبر الأجيال، بل عبر الأحياء ” الأركيتايب” Archetypes، كل ذلك إنما يدل على تركيبات تنظيمية متكاملة تمثل كيانات لا أجزاء.
(ب) ثم يأتى بعد ذلك بعض الفكر التحليلى الأحدث ليكلمنا عن “الأنا الناكص” و”الأنا المضاد للذة”) المضاد لليبيدو egoAintilibidinal )، و”الأنا اللذى الليبيدى”ego Libidinal وكيف أن هذه الكيانات التى هى فى الداخل لها شخصيتها وصفتها وطلباتها و “حضورها” ومظاهرها الصريحة فى الحلم والجنون، ومظاهرها الخفية الرمزية فى العصاب وبعض السواء، وكل ذلك بلغة مدرسة “العلاقة بالموضوع” Object Relation Theory ، ثم يأتى بعد ذلك ذكر المواضيع الداخلية Internal Object لا لتشير الى محتويات الوعاء الإنسانى كجزئيات متجمعة أو ذكريات قابلة للاسترجاع، وإنما لتشير إلى الحياة الداخلية الحاوية للموجودات الكيانية التنظيمية، ورغم تسمية هذه المدرسة لهذه المحتويات بالمواضيع الداخلية إلا أن المتعمق فى المعنى المراد والوظيفة لكل منها سوف يجد أنها إنما تعنى شخوصا بأكملها فى داخلنا، لا مجرد مواضيع، إذن فكيفية تواجد هذه الشخوص فى الداخل لا ينبغى أن تؤخذ بمعنى “الوعاء والمحتوي” لأن الوعاء – فى حالة الإنسان- هو هو المحتوى كما سنرى”.
(جـ) وفى ضربة حدس([2]) (وهى فى نفس الوقت ضربة حظ، ومأزق وعى) يرى إريك بيرن – صاحب مدرسة التحليل التفاعلاتى – الإنسان أمامه متعددا بشكل واضح ومميز، ويعيد – بتواضع شديد – رسم خريطه الكيان البشرى فى صورة “تثليثية” محددة (الأنا الوالدى والأنا اليافع- الناضج- والأنا الطفلي)، كيانات وتنظيمات (لا مجرد أجزاء ودوافع وطاقه محكومة وقوى) تتبادل وتتعاون وتتنافر وتتصارع وتتعدد وتنمو (فى بعضها مع بعض) إلى كيانات أكبر فأكبر وهكذا، وينشىء “بيرن” نظرية تركيبية متكاملة تبدأ بالتحليل التركيبى Structural Analysis وتمتد إلى التحليل التفاعلاتى Transactional Analysis الذى يعنى ببساطة: أنه ما دام التركيب البشرى متعدد الشخوص، فإن التفاعل بين شخص وآخر ليس تفاعلا بين شخص واحد وآخر واحد، بل انه يجرى على مستويات متعددة فى نفس اللحظة وتشير هذه المستويات الى علاقات متبادلة ومتداخلة بين هذه الزحمة من الكيانات بعضها مع بعض، وهذا ما يحدث كل يوم وكل لحظة فى الاحوال العادية فى نفس اللحظة وإن كان لا يظهر على السطح إلا مستوى ظاهر واحد فقط (للناظر غير المدقق طبعا).
وتنتشر هذه النظرية، ويشاع استعمالها، ثم يساء استعمالها لأنها تؤخذ من مدخل التبسيط والإختزال، أكثر مما تؤخذ من مدخل التركيب المتداخل والمسار النموى المعقد.
ولا تكتفى هذه النظرية بالحديث عن هذا “التثليث” للكيان البشرى بل تتحدث- دون وضوح كاف -عما أسمته “وحدات الأنا” Ego Units التى يتركب منها الكيان البشرى، والناظر المتفحص الى ما يعنيه هذا التعبير يكتشف ان هذه الوحدات ليست إلا كيانات (شخوصا) متكاملة متراكمة يتكون منها وبها الوجود البشرى المفرد.
(د) ثم تأتى ممارستنا الإكلينيكية الخاصة تطبيقا منهجيا: وهى أقرب إلى المنهج الفينومينولوجى لهذا المنطلق، فأواجه “الزحمة” المتناهية داخل التركيب البشرى فى الجنون والحلم والشعر خاصة ([3])، وكل التجارب القريبة والموازية لهذه الخبرات الإنسانيه المركبه، وتؤكد لى مشاهداتى ومعايشتى طبيعة هذا التعدد والتكاثف، وأتبين أن التعلم بالبصم (الطبع) Learning by Imprinting ليس سوى انطباع كيانات خارجية على الجوهر الانسانى المتلقى النامى، لتُسْتَوعب وتُمثل Assimilated فيما بعد، أو تظل قلقة جاهزة للتعتعة فى الحلم والشعر والجنون وما إليها.
مخاطر ومفاجآت للشخص العادى:
ولهذا المدخل أهمية خاصة بالنسبة للشخص العادى، كما له مخاطر لا تخفى:
إن تغير النظرة إلى الإنسان كوحدة إستاتيكية (أو حتى ديناميكية) إلى إعتباره “مجمع شخوص” يمثل موجزا للتاريخ ومحتوى العالم فى آن واحد، خليق بأن يقلب كثيرا من الموازين السائدة حاليا عن مفهوم الإنسان ومفهوم الحضارة ومفهوم النمو الفردى ومفهوم التطور البشرى جميعا، بما فى ذلك من مخاطر ومفاجآت وفيما يلى بعض الأمثلة:
(أ) ماذا يكون موقف الشخص العادى أمام نفسه ؟ صورته لذاته؟ فخره بها؟ تحديده لها ؟ لأنه إذا كان “هو” ليس “هو” بل “هم” أو “نحن ” فكيف يتحدد أو يتميز؟ وبأى واحد من “هؤلاء يفخر؟”
(ب) ماذا يكون الموقف من قرارات الشخص لنفسه، وإختياره لفعله؟ من الذى اختار؟ ومن المسئول؟ (وقد يمتد هذا البعد إمتدادا خطرا -ولو من الناحية النظرية- ليشمل المسؤولية الجنائية…..، تصور!!)
(ج) كيف نعامل بعضنا بعضا، وكيف نتفق ونتحاب ونحن قد أصبحنا ” حفلة” موجودات ولسنا إرادة أفراد؟
ويمكن أن نستطرد فى هذه التساؤلات الى مدى بعيد، حتى نستشعر الخطر الأكبر الذى أدى بعضه الى سوء إستعمال نظرية التحليل التفاعلاتى حتى أصبح المخطىء- كمثال من الحياة العادية – يقول “لعن الله طفلى” (Dam my Child) يعنى بذلك أن المسئول عن الخطأ أو التقصير هو ذلك الكيان الطفلى الداخلى يقول ذلك بدلا من أن يتألم من المسئولية هو ككل ، ويتعلم من الخطأ….وقس على ذلك.
والآن …
إذا كان القبول بهذا التعدد هو فتح لباب سلبيات لا نعرف الى أين ستؤدى بنا، أفلا يكون ذلك مبرراً لأن ننكره إبتداء؟ وهنا يبدأ الخطر على العلم والمعرفة، حين يصبح الاعتراف بالحقيقة الفعلية أو المحتملة جدا معتمدا على آثارها وليس على حقيقتها الذاتية، فاذا صح أن الكيان البشرى الفرد هو بالضروة عدة شخوص بعضها فى بعض، وصح أن هذا المفهوم هو مفهوم خطر – من حيث المبدأ - على حدود الذات وعلى استمرار النمو وتحديد المسئولية فلابد أن حلقة مفقودة تكمن بين هذا الذى صح، وذاك الذى صح بما أن الكائن البشرى قد أثبت بالتاريخ ثبات خطاه نحو التقدم، واستمرار بقائه برغم قوى الانقراض المحيطة والملاحقة وهنا يبدا البحث الجاد بكل ما يصحبه من معاناة عن تلك الحلقة المفقودة.
فما الحل إذا؟
الحل الأسهل هو أن نسارع فننكر هذا التعدد ونقصره على درجته القصوى من التناثر فى الجنون وخاصة “جنون الفصام” تحت عناوين نفـْسمراضية مثل “فقد أبعاد الذات، Loss of Ego Bounderies وتعدد الكيانات، وتساوى التكافؤ” وأمثال هذه المصطلحات التى تشير إلى أن التعدد ما هو إلا مرض بالضرورة؟
ولكن ماذا عن الحلم ؟ هذه الشخوص التى تظهر فى الحلم أليست كيانات متعتعة من الوحدة ظاهرة التماسك فى اليقظة؟ أليست هى جزء من تكويننا الداخلى حيث المحتوى هو الوعاء ذاته كما ذكرنا؟
قد يأتى الرد أنها ليست سوى ذكريات مسجلة قد يسمح لها بالإستعادة بشكل خاص فى غياب وعى اليقظة أثناء النوم، لكن الدراسات العميقة والمتأنية تكشف أن:
“الحلم فعلٌ كيانى” نوابى تنظيمّى مستقل وليس تكرارا ذهنيا مسطحا، وأنه إعادة خلاّقة وليس استعادة متناثرة فقط، وأن وظيفته تشكيليه “تمثيلية” Assimilative وليست مجرد وظيفة تفريغية ترويحية!
فأين نخفى كل هذه المعطيات هربا من مواجهة حقيقة تعددنا؟
ثم يأتى الشعر ليعرى كيان الشاعر (الانسان) الذى يصب وجوده فى ألفاظ لها كيانها الجديد ووظائفها الجديدة. اذ ترتسم الصور الجديدة فى تشكيل الإيقاع الجديد، يعلن الشاعر هذا التعدد مباشرة ويحاول بكل وسيلة فنيه أن يؤلف بين تراكيبه وشخوصه، فتنطلق من تحت عباءته الكيانات قادمة من كهوف التاريخ، وتناقضات الحاضر، متجهة إلى صنع الولاف الأعلى فى توليد الآلهه فى طريقها الى الاله الواحد الأحد، وليس هذا مجال أمثلة أو تفاصيل، إلا أنى أعلن فى هذا الإستطراد أن هذا هو المدخل الأصعب لاستيعاب الشعر واستقبال رسائله المكثفة، ولكن الذى يهمنا هنا هو دلالة هذا التعدد والتناقض والتكثيف والقدرة على التحول (مثلا) “… التى تجعل من حضور مهيار ذاته عند أدونيس نفيا واثباتا، خلقا وتدميرا فى نفس الوقت”([4]) وهذا التعدد الذى يشمل الذوات والطبيعة وما بعدها فى حركة ذاتية نحو إعادة التنظيم وتنظيم اللقاءات فى الكيان المتخلق الجديد… يجدها كل قارئ يقظ شجاع فى كل شعر حقيقى ([5]).
هنا يجدر بنا أن نتوقف لنحل هذا التناقض الظاهر:
1- الانسان متعدد فى كيان ظاهرى واحد.
2- التعدد خطر وقد يفتح أبواب السلبية والتناثر ما لم يواصل التقدم.
3- فالإنسان مستمر، حالة كونه يتقدم مضطرد النمو.
4- الإنسان يتطور ويرتقى ويبقى من خلال كل ذلك معا.
5- الإنسان تتجمع وحداته حول تخليق واحدية لا تكتمل ولا تهمد.
6- الإنسان يعاود هذه الدورات باستمرار.
الخلاصة
الإنسان جـّماع حركة غائية إلى توحد واعد مفتوح النهاية إليه!
فهل يواكب العلاج النفسى، والعلاج الجمعى خاصة هذا الاحتمال ويدعمه؟
هذا ما سوف نتدارسه فيما يلى!.
[1]– يحيى الرخاوى: “تحرير المرأة وتطور الإنسان”، العدد الثانى والثالث- المجلة الاجتماعية القومية. المجلد الثانى عشر سبتمبر 1975
[2]– Dorland’s Medical Dictionary (24th Edition) W.B’ Saunders Co. Philadelphia and London، .1967.
[1] – يحيى الرخاوى، مجلة الإنسان والتطورالفصلية – عدد أكتوبر 1981. www.rakahwy.net
[2] – بدأت هذه الرؤية، ثم هذه النظرية لما بدأ أريك بيرن يعتقد فى حدسه الإكلينيكى وقدرته على الوصول إلى مهنة الجندى القادم للكشف (وكان بيرن أيامها يخدم فى الجيش) دون أن يسأله عليها، وثبت لديه أن هذه القدرة أعلى من مجرد الصدفة، حيث صدق حدسه فى تحديد مهنة نسبة المترددين على العيادة دون سؤالهم أعلى بكثير من زميله الطبيب المجند الذى كان يحاوره ويقوم مستقلا بنفس التجربة، وخلص من ذلك إلى أن المسألة تحتاج إلى لحظة استعداد خاص من شخص بذاته وأنه يمكن تنميتها، ثم تسلسلت الرؤى وتعاقب التنظير حتى اكتملت نظريته.
[3]– كما فى فنون أخرى لا مجال للتطرق، وكذا فى التصوف، الذى لم أذكره الآن لأنه خبرة معقدة تجمع هذه الأطراف جميعا، وهى غير قابلة للدراسة العادية بشكل مباشر بحيث لا يفيد الإستشهاد بها هنا.
[4] – أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقى ( جابر عصفور) مجلة فصول ( يوليو 1981) السنة الأولى المجلد الأول – العدد الرابع.
[5]– ومثال عابر - خشية الإستطراد- يقول: ” فينيق مت، فينيق ولتبدأ بك الحرائق، لتبدا الشقائق” أو “مزدوج أنا، مثلث”… (نفس الشاعر فى نفس المقال)
الفصل السابع الوعى الجماعى من أصل الحياة
الفصل السابع الوعى الجماعى من أصل الحياة
الفصل السابع: الوعى الجماعى من أصل الحياة إلى غيب المُطلق
يمكن الآن أن أعرض لبعض الفروض الفرعية أو المكملة لعلاقة الوعى الجماعى بالخلود فى الحياة العادية والمرض النفسى والعلاج (الجمعى خاصة).
أولاً: إن البدء من تاريخ الحياة، يذكرنا باستعمال مصطلح “الوعى” من منطلق “أنواع العقول” كما استعمله دانيال دينيت، فقد كان عنوان الكتاب الرئيسى هو “أنواع العقول”، ثم وضع للكتاب عنوانا فرعيا هو “الطريق إلى فهم الوعى” Towards Understanding of Consciousness ، وهذا العنوان الذكى المتواضع يدعونا إلى سلوك هذا الطريق لفهم ماهية الوعى من خلال تشكيلات وترتيبات العقول التى أشار إليها دينيت باعتبارها مستويات الوعى الهيراركية، وذلك لفهم حركية النمو والمعرفة والتواصل.
ثانياً: إن امتداد الوعى من اللاحياة إلى الحياة يتضمن الدعوة لقبول فكرة كيف أن للجماد وعيا، وأيضا لاحترام محاولات البحث عن ما هو وعى فى الروبوتات الحديثة.
ثالثاً: إن قوانين البقاء، خاصة قبل مرحلة الإنسان، هى قوانين بعيدة عن متناول الوعى بها فى ظاهر العقل والسلوك لسائر الأحياء، لكنها أثبتت أنها برامج فاعلة وناجحة لمن تبقى من أحياء امتدت إلى الإنسان.
رابعاً: إن اكتساب الإنسان القدرة على “الوعى بالوعى” لا يعنى أنه استطاع أن يحيط بتفاصيل دور وفاعلية الوعى البشرى وعلاقته بالنشاطات المعرفية الأخرى، فمازال الوعى أقرب إلى الإدراك الشمولى منه إلى التفكير أو الإدراك الحسى أو التعقيل المنطقى.
خامساً: إن هذا التجذير لنشأة الوعى الأشمل فى أصول تطور الحياة والأحياء إنما يسمح بامتداد الفرض إلى تصور امتداد الوعى طولا مستقبليا فى النوع البشرى، وهو احتمال قائم وبقائى ومفيد (ما لم تحول دون ذلك عوائق ومضاعفات مصنوعة بغباء تطورى أو بطفرات سلبية).
سادساً: يصبح النزوع إلى الانتقال من الوعى الفردى إلى وعى المجموعة Group consciousness إلى الوعى الجماعى Collective Consciousness هو صفة بشرية خاصة متعلقة بما اكتسبه الإنسان من القدرة على الإسهام فى مسيرة تطوره سلبا وإيجابا، بدرجة ما من الإرادة يصبح هذا النزوع طبيعة بشرية ممكن رعايتها أو تصحيحها اذا انحرفت.
سابعاً: بالانتقال من هذا البعد العرضى إلى الامتداد الطبيعى فى النوع البشرى نجد أنفسنا أمام إشكالة الإدراك الظاهر لحتمية “الموت” ومن ثم “الوعى الساعى للنزوع إلى الخلود”.
ثامناً: إن حدوث الموت كنهاية حتمية للوجود الفردى أصاب الإنسان برعب كيانى ليس فقط على نهاية حياته فردا وإنما أيضا – فى عمقٍ خفىّ- على احتمال انقراض نوعه.
تاسعاً: راح الإنسان من واقع صراعه ضد هذا الفناء الفردى يبحث عن حل يحول دون أن يكون الفناء الفردى مرادفا لـ…، أو دليلا على حتمية الفناء الجماعى، أو فناء النوع.
عاشراً: جاءت معظم الديانات بمحاولة حل هذا الإشكال بفضل الله بعرض الحياة الأخرة الأبقى بشكل دائم.
حادى عشر: حين فصَلت التفسيرات اللفظية والسطحية الدنيا عن الآخرة، وفصل الاغتراب والذاتوية المنغلقة الفرد عن جماعته، بدأ الفرد فى مواجهة الصراع ضد الموت، والسعى للخلود الفردى، أو على أحسن تقدير الخلود فى الأجيال التالية فى الأجيال التالية فى الأسرة.
ثانى عشر: ظهرت أشكال المبالغة الاغترابية لهذا النزوع للخلود فى الحياة العادية فى تشكيلات الجمع للجمع، وتراكم الامتلاك، وتضخم القوة الذاتية بمضاعفاتها السلطوية والرأسمالية والاستغلالية والاحتلالية والاستهلاكية، والشرك بالله بالعبودية للمال والأولاد كمثال محدد واضح.
ثالث عشر: ظهرت أشكال النزوع للخلود فى المرض النفسى فى صورة الضلالات العدمية (فمن يُعْدِمُ الحياة ينفى نهايتها المفروضة) وضلالات المهدى المنتظر وضلالات القوة المحركة للعالم المتحكمة فى الزمن، وضلالات السيطرة على العالم ..الخ.
رابع عشر: على مستوى الحياة العادية السليمة بدا أن الحل الممكن – بطريق غير مباشر – قد لاح: بالوقاية بالنظم العادلة والإنسانية وكدح الإيمان وفرص الإبداع والتواصل، وعلى مستوى التطبيب والعلاج بدا أن الدفع بالوعى الفردى إلى حركية الجماعة بتخليق الوعى الجماعى الإبداعى الضام الممتد هو الطريق الصحيح لاستعادة صحة المسار وتحقيق هدف برامج البقاء.
خامس عشر: كما أن الوعى الفردى أدرك كيف يتهدده الفناء بالموت إن لم ينضم إلى الوعى الجماعى فى حركيته النامية، فإن الوعى الجماعى قد يتهدد بنفس التهديد إن لم يلتحم بالوعى الكونى إلى الوعى المطلق إلى وجه الله فى الغيب بلا حدود ولا نهاية وهذا محور فى ما وصلنى من ثقافتنا الشعبية أكثر من وصاية السلطات التقليدية التفسيرية.
سادس عشر: معظم العلاجات الصحيحة تتحرك فى هذا الاتجاه ولكن بأبجدية مختلفة وفروض مغايرة، وسماح ضمنى بجدل مستويات الوعى الإنسانى مع بعضها البعض دون وصاية تنظيرية اختزالية محددة.
سابع عشر: هذه الفروض تتجلى فاعليتها أكثر فأكثر بأسماء مختلفة بشكل مباشر فى علاج الوسط والعلاج الجمعى، وإلى درجة أقل فى العلاج المعرفى.
ثامن عشر: إن العلاجات الأخرى لها مكانها فى عمليات تنظيم مستويات الوعى بالتبادل، أو بالتعاون أو بالجدل، أو بالتثبيط الانتقائى المتقطع، حسب مسار إعادة التشكيل([1]) بشكل يسهل كسر شرنقة الوعى الفردى نحو المشاركة فى تشكيل الوعى الجماعى إلى التناغم مع الوعى الكونى إلى وجه الله.
تاسع عشر: إن الفروض والأطروحات الجديدة المتضمنة فى “ظاهرة” إن المخ يعيد بناء نفسه “هى أقرب الفروض احتراما لتلقائية النزوع البيولوجى التلقائى إلى التنظيم الممتد من أصل الحياة إلى غيب المطلق (الخلود).
عشرون: إن ارتباط هذه الفروض بالنظرية الإيقاعية التطورية من جهة، وبالإيمان التواصلى الضام الكادح إلى وحدة التوجه من جهة، يَعِدُ بآمال أكبر من الاقتصار على مستوى التطبيب النفسى والعلاج النفسى، وهو من ضمن الأرضية التى تخلقت فيها فروضى!.
الملحق: “الحوار”
د. طلعت مطر
وهل الأنبياء قد تفردوا بوعى آخر أو وعى أعمق؟ ولا أقصد بالانبياء هنا أنبياء الدين فقط.
د. يحيى:
فى رأيى أن هذا هو فعلا ما يميز الأنبياء خاصة (عليهم الصلاة والسلام)، والمبدعين عامة، “وكل من له نبى يصلىّ عليه كما يقول حادي الموال المصرى فى الموالد” وقد قلت فى كتابى “حكمة المجانين” “لسنا فى حاجة إلى دين جديد لكننا فى حاجة إلى ملايين الأنبياء” ولهذا تفصيل آخر متى أتيحت الفرصة
د. طلعت مطر
هل تعتقد إن كل العلاجات النفسية تفسح الطريق الى وعى جمعى فكدح الى الله أم أن بعضها قد يعطل هذا الوعى تماما ولو مرحليا كما تفعل العلاجات الكيميائية؟
وأكرر شكرى وإعجابى بهذا الطرح .
د. يحيى:
كل العلاجات التكاملية الهادفة تسمح بتكون وعى جماعى وبالذات العلاج الجمعى وعلاج الوسط وربما كثير من العلاج المعرفى.
أما العلاجات الكيميائية فهى ليست ضد تكوين الوعى الجماعى بهذه البساطة التى يغرينا بها التفكير الاستقطابى، صحيح أن استعمالها وحدها، وباختزال تثبيطى، ولمدة طويلة جدا، قد يهمّد النبض الحيوى والجدل معا، إلا أن استعمالها انتقائيا بجرعات متغيرة حسب فروض حركية تبادل وتنافس وتكافل نشاطات مستويات معينة من الوعى (المخ/الأمخاخ) ومن ثـَمَّ انتقاء العقار الذى يثبط هذا المستوى دون ذاك: حتى يحقق التوازن الضرورى للسماح بتحفيز الجدل المتعدد القنوات بين مستويات الوعى المختلفة المشاركة فى تخليق الوعى البينشخصى والوعى الجمعى، كل هذا معا هو الذى يعطى للعلاجات الكيميائية وللأدوية النيورلبتات العظيمة دوراً رائعا وأهمية فائقة للمشاركة فى إعادة تشكيل الوعى البينشخصى والوعى الجماعى معا، وخاصة حين تشمل المجموعة العلاجية أو علاج الوسط ذهانيين، وهذا ما نمارسه طول الوقت فعلا، ولولا العقاقير وخاصة النيورولبتات الجسيمة لما استطعنا أن نشركهم فى هذه العلاجات بهذه الشجاعة.
د. طلعت مطر
وأخيرا: قال السيد المسيح “إن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا”
د. يحيى:
شكراً
وإليك هذا الحوار عن مقتطف من “موقف الاختيار”، وهو مع مولانا النفرى وفيها رائحة ذلك([2]).
مقتطف من نشرة “وعى الشوق”:
وقال مولانا النفرى أنه وقال لى:
“قد جعلت لك فى السد أبواباً بعدد ما خلقت، وغرست على كل باب شجرة وعين ماء باردة وأظمأتك، وعزتى لئن خرجت لا رددتك إلى منزل أهلى ولا سقيتك من الماء”
فقلت لمولانا:
أى سد هذا يا مولانا وبه كل هذه الأبواب بعدد كل المخلوقات وليس فقط بعدد كل البشر؟ ماذا يتبقى من السد سدا إن كانت به كل تلك الأبواب، والأجمل والأرحب والأغرب والأطرب أن على كل باب: شجرة وعين ماء باردة، فيحضرنى قيظ لطيف محيط يجعل شربة الماء الباردة تساوى كل إغراء ممكن، ولم يكتف يا مولانا بظمأ ظمآن فى هذا القيظ الذى حضرنى، فزادنى ظمأ، فلم يعد بد من أن ينظر الظمأن من أى باب: فيرى الشجرة الظليلة وعين الماء الباردة فيزداد ظمأً، فيهمّ بالخروج، لكن يأتينا النهى بوضوح أنه خروج بلا نتيجة لأنه لن يحقق غرضه ليرتوى من عين الماء الباردة تحت ظل الشجرة، كما أنه سوف يدفع ثمن الخروج – إذا خرج – مقابلا جسيما: طردا دائما وعطشا متزايدا
…..
…..
وصلتنى يا مولاى الرسالة وأرجو أن تكون أقرب إلى ما أوصَلَهُ لك، وإليك اجتهادى:
إن المهم فى السعى إليه هو هذا “الشوق” الحقيقى “المتجدد”، مع اليقين الحقيقى الماثل باحتمال تحقيق هدف المسعى، وتظل هذه الحالة الدافعة الواعدة هى أصل تجديد الشوق وحفز السعى.
……………..
…………….
كل هذا يا مولانا يؤكد لى جوهرية وأولوية أن الشوق مع اليقين هو البداية والنهاية على مسار الكدح والصلاة والدعاء.
لا الظمأ ينطفئ يأسا
ولا الخروج ممنوع قهرا
ولا العودة متاحة إذا زاد الظمأ فكسر الظمآن التردد وخرج
ولا الارتواء وارد حتى لو خرج الظمآن ما دام الشرط بهذا الوضوح
فتتحقق العلاقة بين “وعى الكادح” و”وعى المطلق” فى محيط “وعى الطبيعة” بالحفاظ على “وعى الشوق” على طول المدى.
كل هذا ياطلعت ومولانا النفرى لم يكن نبيا، ولم يدّع النبوة !!!
د. محمد جمال
إيه وعى الروبوت ده!!
د. يحيى:
أولاً: برجاء الرجوع إلى ردى على الابن د. طلعت مطر حالا .
ثانياً: هذا موضوع صعب ورائع وأنا لست مؤهلا للرد عليه، وأذكرك كما ذكرت للابن طلعت حالا أننا لا نعرف الكفاية عن “الوعى البشرى” فما بالك “بوعى الروبوت”، وقد سمعت عنه من الصديق أ.د.نبيل على رائد المعلوماتية فى الشرق العربى ولم استزد منه ما يكفى.
د. محمد جمال
انا كنت متوقع ان الوعي ده يخص كل ما هو فيه روح، او يمكن اقصد ما خلق الله مش اللي من صنع البشر، وان ما ليس به روح هو ربما يكون مكمل للوعى الخاص بالكائنات التى لها روح!! ده غير انى أول مرة أخد بالى فعلا أن ممكن يكون وجود الاديان السماوية ووصفها للحياة الاخرى، محاولة ربانيه لتسكين خوف الإنسان من الموت واشباع رغبته فى الخلود!!
د. يحيى:
برجاء قراءة ما سبق، وفيه فرض محدود عن موقع الخلود فى الآخرة قبولا ومحاولة فهم.
وعموما أنا لا أتكلم عن الروح مستقلة، وقد كررت ذلك مرارا احتراما لتحذير ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم “وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي”.
ثم إن عنوان هذا العمل كله يبدأ بـ “ذكاء الجماد” ثم سوف نعود إلى بعض ذلك فى فصول تسبيج الجبال وما شابه (أنظر الفصل الثالث عشر)
د. رجائى الجميل
المقتطف: رأيت الوعى الجماعى كيانا مستقلا، مرنا مساميا مرحبا؟؟؟
التعليق: هل الوعى الجماعى يظهر جليا فى ازمات النمو او المرض فقط ام هو محرك فاعل داخلنا طول الوقت ونحن الآن فى أزمة تخلى عن هذا الوعى الجماعى فعلا.
د. يحيى:
فى حدود خبرتى، خاصة فى الآونة الأخيرة، ومن خلال خبرة العلاج الجمعى بوجه خاص أفضل أن أراه كيانا قائما خارجنا/داخلنا “معا”، حتى لا نكتفى بتصورات إسقاطية أو خيالية، هذا إن لم يكن خارجنا منفصلا عن داخلنا أصلا بالاغتراب الجاثم، الوعى الجمعى أساسا هو كيان دائم التكوّن وسط وحول كل جماعة لها شكل ونظام وبرامج واستمرار، وهو يكاد يكون مستقلا ومساميا، فضلا عن مرونته وحركيته الإيقاعية، أما أننا فى أزمة تخلى عن هذا الوعى فهذا وارد، لكنه ليس تخليا بمعنى التنازل، ربما يكون بمعنى العجز والاغتراب أكثر، فإن تمادى فهو من منذرات الانقراض.
هذا علما بأننى سوف أخصص الكتاب الثالث من هذه السلسة لتناول دور الوعى والادراك في كدح المعرفة هذا، وسوف يكون عنوانه غاليا: “حركية الادراك وجدل مستويات الوعى”
****
وأختم بإشارات محدودة للتذكرة حتى لو كانت قد سبقت:
أولا: إن الأصل فى الوجود (وليس فقط فى الحياة) هو “التجمع فى نظام”: يسمح بالحركة فى نظام: يسمح لوحداته بالابتعاد فالتآلف باستمرار.
ثانيا: يوجد رباط غير مرئى يربط – ابتداءً- بين الأحياء وبعضها، وبين أفراد وجماعات كل نوع من الأحياء، إذن: هو يربط فيما بيننا نحن البشر،، فيحفظ علينا تماسك المجموعة من جهة، فى حركيتها النامية الضامة المتناغمة طول الوقت إذا ما أحسنا احترام قوانين وجودنا معا.
ثالثا: إن تنمية وتخليق الوعى الجماعى مرتبط بشكل أو بآخر بالوعى الاجتماعى لكنه ليس مرادفا له، ومن ثم بالوعى الثقافى إلى الوعى مع الطبيعة إلى الوعى الكونى إلى الوعى المطلق (إلى الغيب – إلى وجه الله).
رابعاً: إن هذه الحلقة الجماعية، وهى وحدة العلاج الجمعى، تقوم بتنشيط مستويات الوعى المتعددة – كما ذكرنا– عند سائر أفراد المجموعة بدرجات متفاوتة، إذ يسهم كلٌّ بالقدر المتاح فى تكوين الوعى الجماعى الذى هو أكثر نشاطا وحركية لتشكيل مستويات وعى متصاعدة: تدركها ثقافتنا بلغة الدين الشعبى، والإيمان الفطرى بشكل أوضح وأرسخ من الدين المؤسسى، والإرشاد الدينى اللفظى والترجمات المتاحة من العلم السلطوى.
خامسا: إنه لا يمكن الإلمام بهذه الحقائق من مدخل التفكير المسمى “حل المشاكل” الأقرب إلى المنطق الأرسطى المرتبط بالنصف الطاغى من المخ أساسا وإنما من مدخل الإدراك المشتمل لكل العقول (مستويات الوعى) المتبادلة والمتجادلة دوما بالمعنى الأشمل والمتجاوز للحواس المعروفة، والتفكير الخطى الحلمشاكلى
سادسا: إن صعوبة الاستيعاب وغموض الشرح لا يبرران إغفال موضوع كهذا، موضوع أعتبره من أساسيات معرفة النفس البشرية وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين البشر على كل المستويات.
وهذا بعض ما أتاحته لنا خبرتنا فى العلاج الجمعى.
[1] – مما سيرد تفصيله لاحقا عند الحديث عن تناغم فاعلية العلاجات المختلفة بما فى ذلك العقاقير على مسار العلاج
[2] – يحيى الرخاوى، “الإنسان والتطور” حوار مع مولانا النفّرى (52) من “موقف الاختيار”، “وعى الشوْق” (2-11-2013) www.rakhawy.net
الفصل الثامن التقنيات الأساسية فى العلاج الجمعى
الفصل الثامن التقنيات الأساسية فى العلاج الجمعى
الفصل الثامن: التقنيات الأساسية فى العلاج الجمعى
إذا كانت هذه هى التشكيلات المتاحة عبر تاريخ الحياة، وهى إما العزلة والاستكفاء الذاتى حتى فى البقاء والتكاثر بالانقسام ويكفى التلاؤم مع المحيط، وإما بتخليق تشكيلات ثنائية سلبية وإيجابية، وهى تكتسب الاعتراف بالبقاء تبعا لظروف تدعمها لفترة بذاتها يبدو أن لها عمر افتراضى فكيف تستمر الحياة ضد عنف وإغارة قوى الإنقراض؟ (وبالذات بالنسبة للنوع البشرى؟).
وماذا يجرى فى ممارسة العلاج الجمعى كمثال؟
أولا: يبدأ كل مشارك من “حيث هو”، وهذا يشمل المرضى والمتدربين (المعالجين المشاركين) والقائد، ويعرف كل واحد نفسه بالاسم وأهم شكوى واحدة والعمل أحيانا أو كما يشاء.
ثانياً: لا يطلب من أى مشارك إلا اتباع القواعد وأسس الاتفاق من حيث:
(1) الإلتزام بموعد ومكان والحضور،
و(2) السماح بحضور الدائرة الأكبر (فى حالة الاضطرار التدريبى أو العلمى إلى ذلك)، ثم
(3) الإلتزام بقواعد التفاعل التى تهيئ لتصعيد تدريجى حسب توجيهات القائد ومشاركة المعالجين.
ثالثاً: تصل إلى القائد (والمشاركين) مباشرة، (ومن خلال المعلومات المتاحة من أوراق المشاهدة بعيدا عن الجلسات) ما يمكن معه التعرف على درجة ونوع الترابط البادئ به كل مشارك، وذلك دون تحديد التفاصيل حتى فى وعى المعالج مباشرة، ويلاحظ احتمال وجود طيف من الاختلافات على كل مستوى، سواء فى تاريخ الشخص أو أثناء حضوره المجموعة، كما أننا لاحظنا أنه ليس من الضرورة – أن تكون وظيفة المجموعة هى استعادة فتصحيح الأخطاء والعلاقات المعيقة الموجودة مسقباً، وإن كان من غير الممكن إغفال تأثير العلاقات السابقة دون التركيز عليها كمنطلق.
رابعاً: تبدأ النقلة النوعية تدريجيا – دون إعلان – بالتعرف بين أفراد المجموعة ان العلاقات المتاحة هى علاقات آنية (الآن) مكانية (هنا) بين وعى شخصى (أنا) ووعى أى شخص آخر فى المجموعة (أنت)، وتبدو هذه النقلة صعبة لأنها تنفى تصورات مسبقة عن أن العلاج هو أساسا بالكلام ولو فى صورة حوار ومناقشات وإثبات وإقناع، وهنا أفضل أن أحدد طبيعة الاختلاف من خلال نفى المتوقع بشكل غير مباشر، ويشمل هذا النفى أنها:
1- ليست حوارا بين عقلين ظاهرين.
2 – ولا هى مناقشة بين رأيين أو معتقدين.
3 – ولا هى مناظرة بين وجهات نظر.
4- ولا هى قواعد عامة إرشادية أو تطبيقية (الناس/الواحد/ماهو أصل الحكاية/ما هو الأصول إنه…….. الخ).
5 – ولا هى حديث عن من هو “ليس هنا” (ضمير الغائب) إلا بمقدار ما هو مقدمه لإحضاره فى “وعى الآن”.
6- ولا هى صفقة دفاعات (ميكانزمات) تبريرية (عادة) متبادلة، إلا كمقدمة لمواجهتها.
7 – ولا هى نصائح (فوقية من قائد فرقة لأعضائها أو فى أى عضو لآخر).
8 – ولا هى حِكَمٌ وأمثال (حتى لو كانت مناسبة) إلا انطلاقا منها إلى ما هو “هنا والآن”.
9 – ولا هى تصحيح مباشر عام لأخطاء معرفية عن النفس، فى الصحة والمرض، (ولا عموما).
10 – ولا هى مناقشات: “إثبت لى” و”أثبت لك”.
11 – ولا هى تفريغ للتفريج “أطلّع اللى جوايا”.
12 – ولا هى وعود مؤجلة.
13 – ولا هى تعبير مباشر عن ارتباطات عاطفية بذاتها.
14 – ولا هى تصفيق لعواطف لا تـُختبر
15 – ولا هى حديث عن آمال مثالية مؤجلة.
16 – ولا هى توجيه للصحّ والخطأ حسب الأصول المرعية.
17 – ولا هى تزجية وقت.
18 – ولا هى مقياس لألمعية ذكاء قادر على حل الألغاز.
19 – ولا هى تصفيق لقائد.
20 – ولا هى تقييم للمشاركين وترتيبهم تنازليا أو تصاعديا.
أكتفى بهذه العينات مؤقتا، وإن كنت أعترف:
أولا: أنها ليست كل ما نحاول تجنبه.
وثانياً: أنها لم تخطر على بالى بهذه الصورة ولا بهذا الترتيب طوال ممارستى خلال أكثر من أربعين عاما، إلا حالا لزوم الكتابة، لكنها غالبا كانت سارية طول الوقت.
هوامش حول الأسلوب:
- لا يتم النهى عن كل هذه النواهى ومثلها بشكل قهرى فوقى وإنما يُكتَفَى بالتذكرة بالقواعد بطريقة متدرجة متصاعدة باستمرار.
- يتم التنبيه فى البداية فالتذكرة تكرارا من جانب قائد المجموعة بجرعة واضحة، ثم يتدرج الأمر رويدا رويدا فيشارك المتدرب، أو المعالج المشارك فى ذلك، ثم يساهم أفراد من المجموعة فى التذكرة بهذه النواهى بدرجات مختلفة، مع ملاحظة أن من ينهى عن بعض ذلك لا يكون هو بالضرورة ملتزما شخصيا بشكل أكبر من الشخص الذى ينهاه، فلا يمكن نفى أن ذلك يشكل أحيانا نوعاً من التذكرة الشخصية أو الإسقاط.
- مع نمو المجموعة تتراجع درجة الحاجة إلى التنبيه رويدا رويدا، بما يشير إلى اكتساب الأغلبية قدرا من المهارات اللازمة لمواجهة الوعى الآنى لبعضهم البعض مباشرة حسب متطلبات العلاج.
- تساهم عملية مواصلة النهى، وتصعيده أحيانا فى الانتقاء الطبيعى لمن سوف يستمر فى الجماعة متحملا هذه الطرق الجديدة فى التواصل.
- يحدث فى مناسبات ليست نادرة أن ينبه المرضى – القائد- أو المعالجين المشاركين (أو المتدربين) إلى ضرورة الالتزام بالقواعد إذا ما حاد أحدهم عنها، وخاصة إذا تكرر ذلك من معالج بذاته فضلا عن احتمال تنبيه القائد نفسه إذا لم يلتزم بالقواعد.
- يساهم الإلتزام بالشكل فى تحقيق المراد من المحتوى، فمثلا يساهم تثبيت نفس المكان ونفس الموعد (بالدقيقة) فى تشكيل “المحيط” داخل كل فرد وداخل الجماعة، ومن ثم إرساء القواعد الأساسية اللازمة للمواجهة والحركية فالتغيير.
خامساً: تتطور العلاقة فى المجموعة كيفما اتفق، ولا يقاس النجاح بسرعة اكتساب المهارات الجديدة، وإنما بتفعيلها تدريجيا لتحقيق النقلة النوعية فى التفاعل، وهذا يرتبط بدرجة أو بأخرى بمهارة القائد (ومساعديه)، ويبدو أن المسيرة تتحرك على الوجه التالى:
- تنمو العلاقة بشكل غامض متزايد، وربما خفى، مع المجموعة ككل بدرجات متفاوته، وحسب التشخيص، وصلابة الدفاعات والسن وكثير من المتغيرات الفاعلة التى يصـْـعـُـب تحديدها مستقلة.
- مع مرور الوقت تنتقل العلاقة الاعتمادية أكثر فأكثر من القائد إلى المجموعة عادة دون الإقلال من دور القائد.
- تبدو العلاقة فى البداية ثنائية بين كل فرد وبين القائد بشكل أساسى .
- سرعان ما تبدأ سلسلة من التربيطات العشوائية الثنائية فأكثر بين أفراد المجموعة وبعضهم البعض والمعالجين معهم.
- لا تنفى العلاقة الثنائية مع القائد التى لا تخلو من درجة من الاعتمادية أو التعلق، أو التعلق المتبادل([1]) لا تنفى هذه العلاقة تعدد العلاقات الثنائية بين أفراد المجموعة.
سادساً: مع مرور الوقت يتبين أن معظم المرضى يحضرون “للمجموعة” وليس للقائد، ولا لشخص بذاته، وتزيد جرعة الانتماء للمجموعة تدريجيا لتفوق درجة العلاقة بين الأفراد، اللهم إلا إذا كان أحد أفرادها يمر بمأزق نمو معين، أو حدث له موقف خاص استدعى انتباها خاصا لفترة محدودة عادة.
سابعاً: يتأكد ذلك باختبار غياب القائد مصادفة (باعتذار مسبق أو آنىّ نادرا) حيث يفاجأ الجميع غالبا بطلاقة وتلقائية غير متوقعة فى غياب القائد.
ثامناً: فيما عدا العلاقة التحطيمية Synnecrosis لاحظنا حركية الانتقالات بين العلاقات الثنائية بدرجات متفاوتة لكنها كانت تضم – بالإضافة – عاملا مشتركا جديدا، وسواء كانت علاقة ثنائية تكافليةMutualism ام تعايشية Commensalism أم تساغبية Amensalismأم حتى طفيلةParasitism فإن هذه العلاقات تستمر فى التبادل والتغير مضافا إليها هذا الجزء المشترك الغامض الحافز للتوجه فى نفس الوقت نحو “كيان يتخلق يلتف حوله الجميع دون تحديد”، وحتى العلاقة التحطيمية إن وجدت، فإنها تتراجع تدريجا وقد تتبدل ولو بصعوبة ثم تشارك إلى نفس التوجه الجماعى الضامّ.
تاسعا: إذا تعمقت علاقة ثنائية خاصة أو حلت علاقة ثنائية جديدة محل أخرى لدرجة استبعاد القاسم المشترك الجامع للجميع (ولذلك مظاهر سوف نعود إليها فى عرض لنص الجلسات) فإن ذلك يعد من المضاعفات الأساسية، وهو ما يسميه “بيون” كما ذكرنا الازدواجية Pairing ، فإن ذلك يقبل ايضا كمرحلة، وتتعاون المجموعة على مساعدة هذا “الزوج المستقل” نسبيا على العودة إليها تدريجيا وتنجح عادة أو تفشل مؤقتا، وقد يعطل التمادى فى مثل هذا التزاوج الانتظام فى المجموعة، ولا يكمل الاثنان ولا يكون هذا ضدهما ولا ضد المجموعة عادة، فالمجموعة لا تمثل قيمة منافسة بديلة عن المجتمع الأوسع، وإنما فرصة أرحب وحركية أنشط.
عاشراً: لا نسمح أو نشجع أية علاقات ثنائية خارج وقت المجموعة، ولا خارج مكانها، ما أمكن ذلك، اللهم إلا اتصالات هاتفية محدودة وشفافة عادة، وإن كان لا يمكن ضمان حدود ذلك بشكل محكم منضبط بشكل دائم أو مطلق.
حادى عشر: لا توجد وصية محددة لشكل العلاقات أو امتدادها بعد انتهاء المجموعة، لا نَهْى ولا تشجيع، علما بأنه خلال عشرات السنين لم تحدث مضاعفات يمكن أن نعتبرها سلبية تماما.
ثانى عشر: تتواصل حركة وعى المشارك ما بين العلاقة بالذات فالعلاقة الثنائية (داخل وخارج المجموعة) إلى العلاقة بالوعى الجمعى وهى تتبع غالبا برنامج “الدخول والخروج” المتواكب والمتكامل مع “نبض الايقاع الحيوى”، إلا أن هذا لا يرفض من حيث المبدأ، وربما يتيح قدرا من الحركية ذهابا وجيئة، ملأً وبسطاً، بما يؤكد طبيعة النمو الإيقاعى النابض معظم الوقت.
ثالث عشر: ما يتبقى من المجموعة بعد انتهائها ليس “ذكريات” بقدر ما هو حضور تشكيلات الوعى الجديدة واستمرار حركيتها مع ما طبع من وعى أفراد المجموعة حتى بعد افتراقهم.
رابع عشر: يظل الوعى الجمعى ماثلا فى الوعى الشخصى لكثير من أفراد المجموعة، دون دراية بذلك، بما يسهم فى تحريك وتطوير ونماء العلاقات التالية لخبرة هذا العلاج بعد انتهائه.
خامس عشر: من منطلق ثقافتنا المعتادة قد يرتبط تخليق الوعى الجمعى للمجموعة” بحضور الله معنا بطريقة تلقائية موضوعية حاضرة فى “هنا والآن” ليس لها علاقة بدين معين أو مذهب معين أو حلال أو حرام أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، وقد كان الحرج ينتابنى باستمرار- كما ذكرت- كلما اضطررت لذلك وعرجت إلى هذه المنطقة ولو مصادفة، أو ضمنا حيث كنت أخشى دائما الترجمة الفورية إلى مفاهيم سلطوية تقليدية جامدة ومغتربة عن “هنا والآن”.
استشهادات داعمة:
كنت أحسب أن ما وصَلَنا من العلاج الجمعى خلال أكثر من “أربعين عاما” هو فى أحسن الأحوال قاصر على ثقافتنا أكثر من غيرنا وذلك من خلال ممارسات وانطباعات وفروض إكلينيكية خالصة، وإذا بفيض ما وصلنى حديثا من إنجازات علمية من مختلف المصادر يطمئنى أن طالبى المعرفة والعلماء فى كل مكان أمين يعملون فى نفس الاتجاه حتى وصلوا إلى فروض ومعلومات شديدة الارتباط بما عايشناه ونعايشه فى خبرتنا بما يدعمها عبر قنوات علمية ومعرفية أخرى بلغات أخرى.
أهم النقاط التى تصدَّرت الاحدث فالاحدث هو التأكيد على فاعلية ونشاطات وتعدد قنوات التواصل بين البشر، واستدامة نبض المخ البشرى باستمرار لإعادة التشكيل، وأهمية وحدات الزمن المتناهية الصغر فى احتواء التفاعل بين الناس وبعضهم البعض، وسوف أحاول الآن الاستشهاد بمقتطفات من الأحدث فالأحدث مما وصلنى فى هذا الشأن.
الفكرة الأساسية قبل كل ذلك وحول كل ذلك: هى أن المخ البشرى عضو عظيم التعقيد بالغ القدرة فائق الكفاءة دائم النشاط فى عمليات إعادة تنظيم نفسه باستمرار فى الصحة والمرض، هذا المدخل برغم أنه يبدو عضويا عصبونيا مشتبكيا بيولوجيا إلا أنه هو الذى تتناوله الأبحاث الأحدث فالأحدث، ومن خلاله نتعامل مع المخ البشرى الآن كمنظم عملاق للمعلومات والطاقة،Processors of Energy and Information الأمر الذى يظهر فى تجليات السلوك البشرى المختلفة.
المقتطفات:
نبدأ بهذه الجملة من الفصل الأول من الكتاب المعنون بعنوان:
البيولوجية النيورونية البينشخصية فى العلاج الجمعى والعمليات الجماعية([2])
الفصل اسمه “التكامل بين النيوروبيولوجية البينشخصية وبين العلاج الجمعى”
وفيما يلى بعض المنطلقات الأساسية الأحدث
(1):
“…إن علاقاتنا البادئة تشكل التركيب الجوهرى لأمخاخنا ونشاطها فى بحر من الالتقاءات البينشخصية التى تواصل تعديل تربيطات مخنا باستمرار، إن هذه الخبرات تخلّق توقعات لكيفية علاقاتنا مع بعضنا البعض، وهى تنتظم ممتدة فى ما هو “ذاكرة طويلة المدى” Long term memory، مؤثرة باستمرار فى كل مناحى حياتنا، فهى ترشدنا فى انتقاء شريك حياتنا، وطريقة أبوتنا وأمومتنا، ومستويات مرونتنا وآمالنا، وقدرتنا على ابتداع معنى لحياتنا وغير ذلك من قدرات معيشية وبينشخصية”.
(2):
“…إن العلاج الجمعى بوجه خاص أكثر من أى علاج نفسى يعطى الفرصة لتلامس عوالمنا الداخلية، وأن يدعم بعضنا البعض، وكل ذلك داخل الوسط المتماسك الذى يهيئه المعالج ابتداءً، ثم كل أفراد المجموعة معا فيما بعد”.
(3):
“…إن نهرا جاريا من التواصل يجرى دائما تحت مستوى الوعى الظاهر، إن تغيرات تشكيلات التكامل تؤثر فى التغيرات النوعية الميكروثوانية التى تتجلى من خلال “النظرات” و”نغمة الصوت”، و”رنين الكلام” و”وضع الجسد”، و”الحركة” جنبا إلى جنب مع الرسائل الصوتية والبصرية التى تنشأ من النشاط الضمنى للنصف الكروى الأيمن”.
(4):
“…إذا استوعب المعالج فى العلاج الجمعى – بداخله- “هذه” المفاهيم فإنه لا يتعامل فقط مع معلومات النصف الكروى الأيسر (الطاغى)، وإنما أيضا يتعايش بإحساس النصف الأيمن، ثم إن أفراد المجموعة يستطيعون بدورهم التجاوب مع بعضهم البعض بنفس الطريقة”.
التعقيب استلهاما من الفقرة الأخيرة:
إن هذا المدخل يضعنا فى إشكالة تبدو بلا حل من حيث البحث العلمى بالطرق التقليدية، وحين لاحظت كل ذلك بشكل كلىّ مرة، ثم فى حضور فروض تقفز لى أثناء الممارسة: لم أتحمس (أو لم أستطع، أو لم أجرؤ) أن أصيغها بهذا الحسم الذى ظهر مؤخرا فى كتب أحدث ومنها هذا الكتاب الحالى الذى اقتطفت منه بعض المنطلقات الأساسية، لكننى حين رجعت إلى الألعاب النفسية التى مارسناها وجدت أنها كلها تقريبا تكشف بشكل أو بآخر معظم هذه الاحتمالات الأخيرة،
وسوف أخصص فصلا أو أكثر – ربما كتابا بأكمله – لأقدم ألعابا([3]) أثبتت بعض جوانب هذه المشاهدات والآراء والملاحظات السابق اقتطافها، وأكتفى هنا بمثالين:
اللعبة الأولى: “يا خبر دانا لما ما بفهمشى يمكن …”
لم يكن مقصودا تماما إثبات فرض يقول: “إن الكلام المنطوق السائد المفهوم ليس هو الوسيلة الوحيدة للتواصل، وربما ليس الوسيلة الأمثل”
واللعبة الثانية هى: “أنا أخاف أقول كلام من غير كلام لحسن ….”([4])
وبرغم ما فى إيراد هذه العينات من تكرار فإنه يبدو أنه لا مفر من ذلك لأن هذا كتاب وذاك كتاب آخر، والهدف مختلف فى الحالتين.
الخطوط العامة لطبيعة ومسار العلاج النفسى (والجمعى خاصة):
لما كان الباحث قد حمّلنى مسئولية هذه الطريقة التى قام بالبحث فيها، فإنى انتهز الفرصة فى هذا التقديم المطول لأحدد معالمها فى خطوط عريضة، تتفق مع ما جاء فى البحث حينا، وتختلف معه حينا آخر .. فأقول:
1- إن العلاج النفسى هو جوهر الطب النفسى، وهو المميز الحقيقى لهذه المهنة، وهو الممارسة التى جوهرها تلك العلاقة بين إنسان ذى خبرة وإنسان فى محنة، بهدف تغيير سلوك أو تعديل تشكيل مضطرب، أو معطل، أو طفيلى أو مغترب (بغض النظر عن المسمى التشخيصى فى كثير من معظم الأحوال)
2- إن العلاج الجمعى بصفة عامة هو صورة نشطة ومتطورة من العلاج النفسى (بالتوصيف السابق).
3- إن مجرد تغيير السلوك (خاصة فى شكل أعراض)، أثناء العلاج النفسى أو بدونه، من خلال علاقة إنسان بإنسان ليس إيجابيا بصفة مطلقة، لأن اختفاء سلوك ما، مهما كان مزعجا، قد يتم على حساب نمو الشخصية أو على حساب التفاعل الوجدانى الأعمق أو على حساب “شخص آخر” (فى تفاعل وجدانى عميق مع صاحب الأعراض)، وعلى ذلك يكون اختفاء الأعراض ليس هدفا نهائيا فى كل الأحوال بل هو علامة على الطريق ننطلق منها إلى النمو الممكن.
4- إن الطريقة التى تختفى بها الأعراض، والهدف من اختفائها، ومسيرة الفرد بعد اختفائها هى التى تحدد نوع هذا العلاج وموقعه بين العلاجات الأخرى.
5- لكل معالج أن يختار الطريقة التى تشحذ رؤيته، أو تعميه عن موقفه، هذا حق إنسانى صرف ليس لأحد أن يحرمه منه إلا بقدر حظه من ضريبة التنوير العام التى تتناسب مع مرحلة نمو مجتمعه عامة، لأنه من البديهى أن كل فرد – وكل معالج بالتالى – فى لحظة ما من مسار تطوره لا يستطيع غير ذلك، وبالتالى فإنه يحدد –شعوريا ولا شعوريا- طريقة العلاج والهدف منه على قدر الجرعة التى يتصور أنه يتحملها، وإلا فمن ذا ينقذه إذا تعرض لجرعة فوق طاقته وهو متحمل مسئولية علاج آخرين؟.
وبعـد
كأنى بكل هذا أقرر أن العلاج النفسى عامة، والعلاج الجمعى خاصة تختلف طرقه بعدد اختلاف الأفراد الذين يمارسونه، وأن انتقال معالج ما من مرحلة إلى مرحلة: مثلا من العلاج الفردى إلى الجمعى: (مثل روجرز الذى أعلن أنه لم يعد يستطيع أن يمارس العلاج الفردى ثانية، وقد أصبحتُ أنا كذلك – تقريبا- منذ عامين([5])، ثم بيرلز الذى أعلن أنه حتى العلاج الجمعى كاد يصبح بعيدا عن متناوله … الخ) أو حتى التغيير الفرعى فى نفس نوع العلاج : مثل الانتقال من علاج “الفرد فى المجموعة” إلى نوع “علاج المجموعة ككل” أو العكس ..، كل ذلك إنما يدل على تطور المعالج ذاته، أو تراجعه، حسب مرحلة نموه أو درجة خوفه.
من خلال كل ذلك نستطيع أن نخلص إلى نتيجة بسيطة ومنبهة للغاية، وهى: “أن كل أنواع العلاج القائمة بعيوبها ومزاياها مطلوبة لأن المرضى يختلفون، وبالتالى ينبغى أن يكون هناك من يقابل احتياجاتهم من المعالجين المختلفين بنفس قدر اختلافهم”، والتلاقى بين هذا الطبيب (أو المعالج) وبين ذلك المريض واستمرارهما معا هو تحديد ضمنى لمرحلة تطورهما، وتلاقى مجموعة بالتالى واستمرارها مع معالج بذاته هو تحديد أيضا لمرحلة هذه المجموعة ([6]).
وهكذا أستطيع أن أقرر معالم هذا العلاج بالنسبة لى ومن خبرتى كالتالى:
1- إن هذا العلاج يتفق مع احتياجاتى فى هذه المرحلة من الرؤية والتطور، فأنا لم أعد أستطيع أن أمارس العلاج الفردى بنفس الكفاءة إذا أردت الحفاظ على أمانتى مع نفسى.
2- إنه – فيما عدا فترات محدودة للضرورة القصوى- يكون الحضور باختيار كامل للمريض، يتجدد كل مرة، وبالتالى بمسئولية كاملة.
3- إن الأسلوب الجارى فى هذا العلاج هو أسلوب تلقائى خبراتى، به عدد محدود من القواعد أهمها التركيز شبه المطلق على الـ“هنا والآن”، فضلا عن القواعد التنظيمية العادية بالنسبة لمواعيد الحضور ومدة الجلسة وما إلى ذلك.
4- إن هذا العلاج له توجه نمائى يقول: “إن الإنسان عامة قادر على ان يستمر فى النمو، وهو يواصل التنازل عن الاحتياج إلى اللجوء المتزايد للحيل الدفاعية، وأن هذا وحده هو السبيل لإطلاق قدرات إبداعه وإعطاء حياته معنى ولمسيرته هدفاً”.
5- إن ظهور الأعراض يعتبر فى كثير من الأحيان من الآثار الجانبية (الإيجابية) لمواصلة هذه المحاولات المستمرة للتغير على مسار النمو فى ظروف ليست كاملة الملاءمة.
6- إن طلب زوال الأعراض يتضمن إعلان طلب العون من آخر، (يعرف الحكاية أو يحاول أن يعرفها باستمرار)، سواء تم العون فرديا، أو فى حالتنا هذه، مع آخرين يحاولون نفس المحاولة (العلاج الجمعى وعلاج الوسط)، باعتبارهم شركاء على نفس الطريق.
7- إنه إذا حققت هذه المشاركة هدفها الأصلى –تخفيف الألم وكسر الوحدة – دون التوقف عند مرحلة الاعتماد على هذه المجموعة بوجه خاص دون غيرها، فإن الفرد قادر بعدها على الاستمرار بعد اكتساب ميزتين هما نتيجتان طبيعيتان لكل ذلك.
(أ) الاعتماد على المصادر الذاتية معظم الوقت: إذ يصبح احتياجه للآخرين موقوت، ومرتبط بمواقف معينة، ويصبح قادراً على أن يمارسه دون ارتباط معوِّق، لأنه فى رحلته منه وإليهم، وبالعكس، يبدأ من قاعدة ذاتية ثابتة، ويعود إليها دون تخلخل عنيف فى رحلات الذهاب والعودة.
(ب) التقبل النشط: وأعنى به القدرة على ممارسة الحياة مع كل الناس دون استثناء بالقدر الذى يضطر إليه فى سلوكه اليومى المختار([7])، وهذا التقبل نشط وخال من مزاعم الحرية الشخصية المبالغ فى قيمتها واليقين من تحقيقهما.
8- إنه انطلاقا من هاتين الركيزتين: (الاعتماد على المصادر الذاتية والتقبل النشط)، تتواصل مسيرة النمو للفرد فيستغنى الفرد باضطراد عن احتياجه للدفاعات المشوهة.
مراحل تطور العلاقة العلاجية
1- تظهر الأعراض عادة حين تعاق مسيرة النمو، أو تجهض، أو تنحرف، وبالتالى فإن العلاج هو إطلاق التسلسل الطبيعى وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة نشاط هذه العملية لاستكمال المسيرة..
2- قد تختفى الأعراض بعد فترة من بداية العلاج، واختفاؤها قد يكون نتيجة لعودة الدفاعات السابقة للعمل، أو نتيجة لاكتساب دفاعات جديدة أهمها:
العقلنة Intellectualisation والتقديس Idealisation للمعالج، فالمريض من خلال حركة المجموعة النشطة وتأثير المعالج سرعان ما يفهم طبيعة الأعراض .. ولكنه مجرد فهم عقلانى عادة، ثم هو قد يتحمس للحلول التى يستوحيها من موقف المعالج وإيحاءاته، وهو قد يبالغ فى تعظيم صفات هذا المعالج وقدراته، وبتزايد الفهم العقلى دون عمق الاستيعاب الوجدانى، وبتزايد تصوير المعالج بالقائد أو الساحر، أو صاحب الطريقة .. قد تتلاشى الأعراض فى هذه المرحلة، إلا أن هذا ليس هو غاية المراد!!
3- تستمر هذه الفترة لمدة تطول أو تقصر حسب كل حالة، وتتوقف هذه المدة على تكوين الشخصية، ونوع التشخيص، وموقف علاقات المريض بالآخرين بكل الدوائر بدءًا بدائرة الجماعة.
4- قد ينقطع المريض عن العلاج فى هذه المرحلة، ويعتبر نفسه قد شفى بالمقاييس العادية.
5- يمكن للمريض أن يتوقف عند أية مرحلة يستطيع التوقف فيها دون إبداء أسباب.
6- إذا استمر المريض فى الحضور بالرغم من اختفاء الأعراض فإن الاحتمال الأول هو أن تكون الحيل الدفاعية وخاصة هذين الدفاعين (العقلنة والتقديس) لم يعودا يشبعانه، مع تزايد ضغط المجموعة لكشف هذه الحيل، فإذا اضيف إلى هذا وذاك موقف المعالج الرافض لاستمرار هذا النوع من التحسن (ويتوقف ذلك على حساباته وتوقيته ومسئوليته وخبرته ودرجة نضجه)، فإن المريض لابد سيواجَه بمرحلة جديدة من العلاج نشطة ومتحدية.
7- هذه النقلة قد تتسم عادة بشكل من الهجوم على المعالج، ويظهر هذا الهجوم فى أشكال مختلفة ظهرت أغلبها فيما عرضه الباحث، كما يلى:
(أ) الهجوم اللفظى المباشر بالسباب أو الاحتجاج أو مقاطعة الحوار.
(ب) اتهام المعالج بأنه “صاحب طريقة” أو “ديكتاتور” أو “مجنون” أو مثالى”…الخ.
(جـ) الهجوم بمخالفة القواعد واختراق الممنوع بشكل متكرر
(د) الهجوم بالتشويش وبإعاقة المجموعة، أو الاحتكار، أو التسخيف.
8- قد يتخذ المريض هذا الهجوم مبرراً لانقاطاعه، ولكنه انقطاع من نوع آخر غير ما ذكر سابقا، فالأول انقطاع “الهارب المستكفى” أما هنا فهو انقطاع ” المحتج الغاضب“، وفى خبرتى فإن هذا الانقطاع الأخير يكون أفضل أحيانا، حيث يكون المريض فيه أقل عرضه لعودة الأعراض بنفس سرعة عودتها فى الحال الأولى، حتى وهو يدمغ المجموعة والمعالج ويصفها بأنها مؤذية أو ضارة إلخ.
9- قد يتخذ العدوان على المجموعة ظهور أعراض تكون قد اختفت، أو ظهور مضاعفات جانبية، وقد ينتهى هذا العدوان الصامت، أو العدوان السلبى، باحتمال انسحاب العضو من المجموعة أيضا، على أن استمرار جدوى هذا النوع من الانسحاب (المنسحب الرافض) ومدى فاعليته فى اختفاء الأعراض، وفى استيعاب الخبرات التى استفادها المريض من المجموعة فيما بعد، هو أقل مما ذكرنا بالنسبة للمحتج الغاضب، ويكون هذا الانسحاب أكثر تهديداً للمجموعة وإعلاناً للرفض حين يكون حضور هذا الفرد مرتبط بحضور فرد آخر (مثل انسحاب الزوجة رغم استمرار حضور زوجها) ويشمل هذا الانسحاب بالإضافة إلى الدفاع الذاتى رغبة فى توقف المجموعة ككل وإفشالها (أنا ذاهب .. أرونى شطارتكم وأنتم تكملون!).
10- قد يستمر أحد هؤلاء تحت ضغط المجموعة، أو الشريك، أو التهديد بظهور الأعراض، أو الرغبة الظاهرية فى استكمال “الفرجة”، ولكنه يحاول أن يفرض شروطه ويحوّل مجرى المجموعة إلى مجموعة اعتمادية، أو مجموعة لتمضية الوقت، أو لزعم التميز عن المجتمع الخارجى، فإذا ووجه برفض شروطه أو عدم جدواها: عاد للانسحاب بنفس الأسلوب القديم، أو حاول إفشال المجموعة والتشكيك فيها بكل وسيلة (وقد أورد الباحث أمثلة لهذا الموقف أيضا والذى يمكن أن يلخص فى أنه موقف: “فيها – بشروطى- أو أخفيها” .
11- إذا تخطى المريض هذه المراحل واستمر مع ذلك فى حضور المجموعة، فإنه يكون قد اقترب من احتمال تغير نوعى فى وجوده: وهذا يعنى أن مواجهة جديدة أعمق قد فرضت عليه إذْ لم يعد الاعتماد مقبولا ولا العدوان مبرّرا (وكأن مرحلة الاعتماد تقابل الموقف الشيزيدى([8]) فى النمو، ومرحلة العدوان تقابل الموقف البارنوى([9]). وهو الآن على أبواب الموقف الاكتئابى([10])، وفى هذه المرحلة يجد المريض نفسه فى مفترق طرق ثلاث:
الأول: أن تعود الأعراض القديمة، ولكنها عادة تعود بشكل محور وبحدّة أقل.
الثانى: أن تظهر أعراض جديدة بديلة عن الأعراض القديمة، ولكن من واقع ميكانزمات أخرى، بما فى ذلك الجسدنة.
الثالث: أن يواجه المريض انهيار دفاعاته القديمة والجديدة معاً، وبالتالى يواجه اضطراره لمواجهة الواقع بحجمه – بدرجة أو باخرى – وهنا يقترب أكثر فأكثر من أبواب الاكتئاب الحقيقى الذى أصبحت أعتبره الاكتئاب الإيجابى الذى يعلن بداية علاقة حقيقية بالعالم الموضوعى الذى يتمثل “هنا والآن” فى أعضاء المجموعة بعيويهم وميزاتهم، إذ يكتشف المريض أنه لم يعد يصلح أن يعتمد عليهم أو يعتدى عليهم، وهذا الاحتمال الثالث هو-غالبا- ما يقابل الموقف الاكتئابى فى نمو الطفل (عند ميلانى كلاين وجانترب) وكذلك هو ما يقابل “المأزق” Impass (عند بيرلز).
وإن كنت لم أعد أفضل إطلاق لفظ الاكتئاب على المشاعر المصاحبة لهذه المواجهة وأفضل عليها لفظ “الألم” (كما وصفه أحد المرضى فى إحدى الجلسات) ، وهذا الألم عادة ما يتميز عن ما يسمى الاكتئاب بما يلى:
(أ) إنه يحدث فى وساد من الدراية والاختيار بوعى يقظ.
(ب) عادة لا يصاحبه “شعور بالذنب”
(جـ) يكون الفرد فيه قد تخطى مرحلة الثنائية الوجدانية Ambivalence إلى محاولة الاقتراب من مرحلة تحمل التناقض Tolerance of Ambiguity.
10- قد يدرك المريض ما ينتظره من مواجهة حقيقية للواقع بحجمه وقد يخاف من هذه الخطوة بشكل متزايد، وقد يهيئ للتراجع عنها أساسا بأحد طريقين:
(أ) أن يتحمل الألم وحده تماما، فيلغى وجود المجموعة، وهذه الخطوة تضاعف من الألم بدرجة قد تبرر التراجع عنه بالعودة إلى بعض دفاعاته التى قد يكون قد استغنى عنها، أو إلى طور سابق (مثل طور الكر فرّ أو حتى الانسحاب).
(ب) أن يكثف جرعة الألم بأن يبالغ فى ضرورة تحمل مسئولية من حوله كدليل على ارتباطه بالواقع وعلى اشتراكه فى المسيرة، ولكن هذه المبادرة غير المحسوبة قد تضاعف أيضا من هذا الألم حتى تبرر فى النهاية انسحابه بعيداً عن تحمله.
11- إذا احتمل المريض هذا الألم الحى، مستغلا وجوده فى المجموعة لتخفيف حدته، ومعايشة مسئوليته فإن وظيفة المجموعة فى هذه المرحلة تكون فى أشد حالات فعاليتها وهى تعنى أساساً:
“إن هذا الألم ضريبة الحياة، وأننا نعانيه “معاً” – لا بالنيابة أحدنا عن الآخر – وبالتالى فإن جرعته يمكن أن تكون محتملة: هيا نواصل”.
إذا حدثت هذه الخطوة فإن المريض ينتقل إلى مرحلة المأزق ومنها إلى مرحلة “الولاف” الإرادى اليقظ، أو مرحلة الديالكتيك الحى، أى الجدل التطورى
12- هذه الخطوة الأخيرة هى التى تحدد هدف العلاج كله وهو “إحياء ديالكتيك النمو بطريقة عملية ومباشرة وواعية نسبيا إلى حد ما” وهى نهاية وبداية معاً حسب قانون الجدل الحيوى المستمر، فهى نهاية لكل ما سبقها من خطوات، وبداية أيضا، ولكنها متى استقرت فإنها تحتاج إلى فترة كمون وممارسة متأنية تنبعث بعدها مسيرة جديدة ([11]) ..، وكل ما ينبغى أن أشير إليه هنا قبل شرح هذا المفهوم تفصيلاً فى موقعه هو أن ” تحقيق الموالفة الأعلى” يختلف فى كثير من أبعاده عن الشائع عن العلاج النفسى فأقرر مؤقتا فى إيجاز:
(أ) إن هذا العلاج لا يسعى إلى “كبت” الجزء الآخر من النفس، كما هو الحال فى العلاجات التى تعمل على تقوية ضبط النفس والتعويض الشعورى.
(ب) إن هذا العلاج لا يهدف إلى تسوية تسكينية كحل وسط – إلا كمرحلة مؤقتة– ذلك الحل المعيق الذى يتم عادة باتفاق سرى بين أجزاء النفس، (مستوياتها) إذ يلبس كل جزء (مستوى) صفة الجزء الآخر ليقدم للوجود ما يسمى “خداع التحسن” (إن صح التعبير) وقد يكون هو المقابل لما أسماه إريك بيرن “التلوث” أو لعله المقابل أحيانا أيضا للتشخيص المعروف فى التصنيف الشائع تحت عنوان “اضطرابات الشخصية”، وكل ذلك هو بمثابة إعلان عن توقف النمو بشكل أو بآخر.
(جـ) يهدف هذا العلاج حفز السعى نحو تحقيق “الموالفة الأعلى” بين قوى النفس المتعددة المتواجهة المتناقضة ويتم ذلك من خلال تحديد هذه القوى، ثم فصلها عن بعضها، ثم إعادة المواجهة، ثم إفشال استقلال أى منها، ثم دفعها إلى التلاحم الجدلى لتشكيل النقلة التالية على مسيرة النمو
(وكل هذا سوف نعود إليه بالتفصيل).
خلاصة القول: بعد تحديد معالم هذا العلاج وهدفه وخطواته:
1- إنه علاج عملىّ، له هدف بعيد غير معلن وهو حفز استمرار مسيرة النمو، ولكنه يقبل كل الأهداف الوسطى التى تفرض عليه ويعتبر نتائجها المستقرة مرحلياً (وليس نهائيا) من إيجابياته.
2- إنه من الناحية التطبيقية لا يهمه التنظير أو المواصفات الطوبائية الهروبية بقدر ما يهمه وضوح المقاييس التى يقيس بها خطوات مسيرته، وأهم هذه المقاييس:
(أ) اختفاء الأعراض المعيقة ولو مرحلياً
(ب) إرساء علاقة تسمح بالرجوع لاستكمال المسيرة إذا عادت الأعراض.
(جـ) إدراك طبيعة الاختيار، ومن ثم المسئولية فى حالتى الصحة والمرض.
(د) التكلم باللغة السائدة .. والارتباط بالواقع بما فيه بعد “الزمن”،. وتحمل مشقة التكيف، مع استمرار النمو.
[1] – فضلنا استعمال كلمة تعلق بديلا عن كلمة “طرح” Tranference لتوضيح وجهة نظرنا أن المسألة ليست مجرد طرح يستعيد علاقات والدية (أو غير والدية) قديمة، وإنما هى ممارسة علاقات جديدة متحركة.
[2] – The Interpersonal Neurobiology of Group Psychotherapy and Group Process, Susan P. Gantt, Bonnie Badenoch, Karnac Books, Jan 1, 2013
[3] – هذا فضلا عن ما سوف أنشره من عدة كتب عن “الألعاب العلاجية” و”المينى دراما” فى خبرتنا فى العلاج الجمعى!
[4] – وقد سبق تناولهما بالتفصيل فى “الإنسان والتطور” الإدراك بتاريخ ( 21-8-2012)، ( 22-8-2012)، (28-8-2012) . بموقع المؤلف www.rakhawy.net
[5] – سنة 1972
[6] – ويمكن تعميم ذلك على المجتمع الأوسع بصورة مجملة بالنسبة للقائد والشعب : “كيفما تكونوا يولىّ عليكم!”.
[7] – لاحظ التناقض الظاهرى بين الاضطرار والاختيار ..
[8] – Schizoid Position
[9] – Paranoid Position
[10] – Depressive Position
[11] – أنظر فيما بعد علاقة هذا العلاج بحركية الديالكتيك
الفصل التاسع علاقة هذا العلاج بأنواع العلاج الجمعى
الفصل التاسع علاقة هذا العلاج بأنواع العلاج الجمعى
الفصل التاسع: علاقة هذا العلاج بأنواع العلاج الجمعى الأخرى
كما ذكرنا من البداية، يكاد العلاج الجمعى الحديث يكون تنظيما مهنيا لممارسة حياتية اجتماعية جارية منذ وُجد الإنسان فى مجتمع إنسانى، وأيضا منذ اكتشف الإنسان – ليس قريبا جدا من بؤرة وعيه- أنه لكى يكون إنسانا فلا بد أن تكون حالة كونه فى مواجهة وتفاعل مع كائن مثله من نفس النوع. فإذا رجعنا لنبدأ من بلد مثل مصر فعلينا أن نبدأ من هذه الحقيقة الأقدم ونحن نتحسس طريقنا للإسهام فى طريقة علاجية أحدث، جنبا إلى جنب مع الانتقاء الوارد، أو اللقاء الجائز مع ممارسات غيرنا فى نفس المجال.
الأصل غائر فى ثقافتنا
يمكن إرجاع أصل العلاج الجمعى فى مصر إلى كلمتين شائعتين هما: “الناس لبعضها”، فإذا تقدمنا خطوة وجدنا أننا نتبادل التأكيد على ” أن الجنة نفسها لا تكون كذلك إلا بالناس “دى جنة من غير ناس ما تنداس” فإذا أكملناها بما يتميز به دور قائد المجموعة عادة فى ثقافتنا دون تعميم، صحّ ما تكتمل به معالم ما نمارسه من أنه ” إللى مالوش كبير يشتري له كبير”.
إن البحث فى تنويعات العلاج الجمعى هو أمر لاحق لمبدأ واحد متفق عليه، وممارَس فعلا، بل ولعل الهدف واحد، والفلسفة واحدة، لكن الاختلاف وارد فى الطريقة والتفاصيل، وهذا الاختلاف لا يرتبط فقط بالمدرسة التى ينتمى إليها المعالج وإنما هو يرتبط أيضا، وربما قبلا، بالمعالج نفسه، فالاختلاف وارد حتى لو كانت المجموعة العلاجية والمعالج ينتمون إلى نفس المدرسة، ذلك لأن الفرق بين أية مجموعة وأخرى هو حتمى ومهم، اللهم إلا فى القواعد المنظـِّمة العامة.
لم أشغل نفسى كثيرا بالنظر فيما إذا كان ما نمارسه يمكن أن يصنف تحت ما يسمى “الفرد فى المجموعة”، أم “المجموعة ككل“، إذ بدا لى منذ البداية أن أعلن من خلال خبرتى أن مثل هذا الفصل هو شبه مستحيل فى ثقافتنا، اللهم إلا لفترات محدودة حسب مسار المجموعة واحتياجات بعض الأفراد فى ظروف خاصة، مثل المرور بمأزق النمو، أو أزمة نقلة التغيير، (+ إعادة الولادة) أو محنة احتمال الانتحار (قبيل الولادة النفسية).
كذلك فإن تصنيف نوع العلاج الجمعى باعتباره تحليليا([1]) أم تدعيميا هو أمر تقريبى تماما، فلا أظن أن هناك علاجا نفسيا كائنا ما كان يمكن أن يستغنى –مثلا- عن قراءة “الميكانزمات” الجارية فى الأفراد والجماعة أولا بأول وهو يدير علاجا يتعامل مع الإمراضية النفسية ويهدف إلى دفع عجلة النمو، بل إن قراءة الاشخاص والمجموعة من خلال هذه الحيل النفسية ليست قاصرة على مدرسة التحليل النفسى، ولا حتى على ممارسة ما هو علاج نفسى عموما، فهذه عملية أقدم من كل هذا، فهى جزء لا يتجزأ من طبيعة الوجود البشرى عبرالتاريخ، فى السياسة والدين والأسواق والحب والحرب…، وغير ذلك([2]) ، ومع ذلك فلا مفر من أن نبدأ بهذا النوع من العلاج المسمى :
أولا: العلاج ذو التوجه التحليلى النفسى
Psychoanalytically Oriented Group Therapy
هو العلاج الجمعى الأكثر شيوعا فى الولايات المتحدة الأمريكية([3])، وهو العلاج ذو التوجه التحليلي، وهو لا يعنى أن نوعا من التحليل النفسى الفردى يمكن أن يجرى فى المجموعة، لكن يبدو أن كثيرا من توجهات التحليل النفسى الفردى، وأيضا لغته، قد حورت نفسها حتى لا تتعارض مع أساسيات أنواع العلاجات النفسية الجارية.
فيما يسمى بالعلاج التحليلى توجد درجة أكبر من التعامل بالألفاظ (الكلام)، ومساحة أوسع من التنفيث، وصدر أرحب للتحرك إلى ذكريات الماضى دون تهيير مبدأ “هنا والآن” أكثر من اللازم، إذ يظل أغلب هذا النوع حريصا على مبدأ “هنا والآن”، ولكن لا مانع من جرعة من التجاوز بين الحين والحين للفرد أو للجماعة للتحرك بعيدا عن “هنا- و-الآن” إلى “كان- و”هناك”.
ويتفق كثيرون على أن الفرق بين التحليل النفسى الفردى، وممارسة مبادئه فى الجماعة هو أنه فى الحالة الأخيرة يمكن دعم ما سمى بإعادة البناء Reconstruction
وثمَّ توجه تحليلى أيضا يعتبر الانتماء إلى المجموعة بمثابة تكوين “عائلة جديدة” لها معظم مواصفات العائلة، وبالتالى تمر بنفس مراحل نموها.
وقد تبنى بعض هؤلاء المعالجين التحليليين المبادئ الأساسية لمدرسة “العلاقة بالموضوع” (المدرسة التحليلية الإنجليزية) من حيث مواقع النمو المتلاحقة التى يمر بها الطفل ابتداء، أى من الموقف الشيزيدى، إلى الموقف البارنوى ، إلى الموقف الاكتئابى، وقد اعتبر بعضهم أن المجموعة تعطى فرصة لأفرادها للنكوص إلى هذه المواقع، وأن المعالج هو بديل ثدى الأم.
وفى ممارستنا نحترم أغلب ذلك من حيث المبدأ، مع التحوير والتطوير اللازمين من واقع الممارسة والتنظير، ومن أهم ذلك:
أولا: فى ممارساتنا تكون قراءة الميكانزمات واردة فى وعى المعالج والمجموعة، لكن دون إعلان التفسير بشكل مباشر، ودون الجزم بسلامة التفسير الذى قد يخطر على المعالج حتى دون أن يقفز إلى بؤرة وعيه، إذ يعتبر أى تفسير محتمل، وهو غير معلن عادة، ليس إلا فرضا عاملا ينتظر الاختبار غالبا، فهو قابل للتعديل والمراجعة والإبدال والتطوير باستمرار.
ثانيا : نحن نتبنى باحترام شديد فروض “إعادة الولادة” جنبا إلى جنب مع متابعة مواقع النمو التى ذكرناها حالا بدءا من ميلانى كلاين ومدرسة العلاقة بالموضوع، لكن ذلك لا يقتصر على تفسير هذه المراحل بتطور علاقة الطفل مع أمه أساسا، وإنما يتوازى مع تبنى الأفكار الأساسية لنظرية الاستعادة Recapitulation Theory بلغة إرنست هيكل فى تضفر مع النظرية التطورية الإيقاعية التى ننتمى إليها، Evolutionary Rhythmic Theory والتى جعلت الاستعادة بنفس الترتيب، ولكن مرتبطا بمراحل التطور الأصلى التى هى أساس النمو واستعادة انطلاقة النمو والإبداع بإيقاع حتمى منتظم، بحيث يمكن الحديث عن مواكبة هذه الأطوار ودعمها، أكثر من التوقف عندها وتفسيرها.
وفى هذا الصدد ينبغى توضيح نقطة أخرى وهى أننا لا نتكلم بلغة النكوص إلى ثدى الأم كما ذهب بعض المحللين، بقدر ما اكتشفنا أننا نمارس حضور تكوين “الوعى الجمعى” الجامع Collective Consciousness الذى اعتبرناه بمثابة الرحِم الأكبر، وأحيانا الرحم الأصل، وليس أن المعالج هو بديل ثدى الأم! ومن ثم احترام ومتابعة فترة الحمل حتى إعادة الولادة فما بعدها بمواكبة المرور بمراحل المواقف السالفة الذكر، وقد لاحظنا فى هذا الصدد كلا مما يلى:
1) إن البدء من الموقف الشيزيدى يكون جاهزا فى أغلب الأحيان، ولكن بصور متنوعة، وبرغم الاسم، فإن هذه المرحلة تكاد لا يكون لها علاقة بالفصام كمرض محدد المعالم (برغم اشتقاق الاسم من الشيزوفرينيا)، وإنما هى تعنى مرحة “اللاموضوع” عموما، ليس بمعنى النفى الفعلى المطلق للآخر، وإنما بمعنى أن حضور “الآخر” فى هذا الموقف يكون كموضوع ذاتىّ Self-Object، بشكل مطلق تقريبا، وهذا ما قد يتصف به كثير من أنواع اضطراب الشخصية، وقد لا حظنا أن الموقف الشيزيدى الخفى يتجلى بشكل بالغ الذاتوية فى الشخصية النرجسية Narrisstic Personality بشكل خاص، ومن العجيب أن ذلك يكون أكثر وضوحا وتفعيلا أكثر من حضوره فى الشخصية الشيزيدية Schizoid Personality بشكلها الوصفى سلوكيا، لكن نفس الموقف يتجلى جدا بشكله الصريح فى الفصام البسيط، وعموما فى الفصام السلبى، وفى اضطراب الشخصية الذى قد يحدث بعد نقلة زملية Syndrome shift من فصام نشط إلى هذا النوع من الشخصية المتبلدة أو القاسية أو المنحرفة تماما، ولا بد من الاعتراف بأن تحريك المريض من قوقعته الشيزيدية، أو رفع غطاء التبلد وإنكار الآخر من فوق مشاعره يعتبر من أصعب مراحل تطور الفرد فى المجموعة، إلا أننا لاحظنا أن الوجود فى المجموعة، مع أفراد يحاولون، وكل فى موقع مختلف عن الآخر عادة، يساعد فى عملية تعتعة هذا الجمود وكشف هذا الغطاء بقدر أقل من المضاعفات([4]).
2) أما الموقف البارنوى فيظهر بشكل أوضح أثناء تطور العلاقة بين أفراد المجموعة، وهو يتصف بأسياسيات الكر والفر، ولكن ليس بالمعنى الذى ذكره “بيون” فى افتراضاته الأساسية، وإنما بمعنى التنشيط المحسوب للموقف البارنوى، حين يبدو “الموضوع” (الآخر) مهِّددا أكثر منه واعدا (الموقف الاكتئابى)، ويجرى تفعيل هذا الموقف التوجسى المتحفز للهرب أو للانقضاض أساسا بشكل مباشر مع المعالج شخصيا، ويكون التعبير عنه بأشكال مختلفة، ويقوم المعالج فى بعض الأحيان باستثارة هذا الموقف عمدا، أملا فى استيعابه فى مسيرة النمو، يتجلى ذلك خاصة فى بعض الألعاب العلاجية، وأحيانا فى المينى دراما (التى تحل غالبا فى خبرتنا محل السيكودراما التقليدية)، وسوف نعرض لذلك – مثلا– فى الألعاب التى تعرضت للكشف عن “الحق فى الخوف“، (الفرّ) وعن جذور الحـِقـْـد “الطبيعية” (بما يشير إلى الكرّ) وغير ذلك، (أنظر بعد)([5])، على أن الفر (الهروب) لا يتمادى عادة إلى ترك المجموعة تماما بقدر ما يظهر فى شكل الحذر من الاقتراب أكثر([6])، وقد لاحظنا أن حركية هذا الموقف تتدعم باللجوء إلى برنامج الدخول والخروج In-and-Out-program، فتظل المسافة بين الشخص وبين المجموعة، وأيضا بين الفرد وبين الآخر تتحرك فى تناقص متذبذب، حتى يجرؤ أن يتحمل حقيقة وجود الآخر فى وعيه بما يحمل من إيجابيات، فتتاح الفرصة للانتقال إلى الموقف الاكتئابى وهو ما سيأتى ذكره بعد.
3) نحن نعتبر الموقف الاكتئابى بصورته الناضجة النشطة خاصا بالإنسان بشكل متميز، وظهوره أثناء العلاج يتدرج باضطراد عادة على قدر احتمال تبعته، كما أن ظهوره يعلن أن المريض أثناء العلاج بدأ يتحسس طريقه إلى “موضوع حقيقى“، ولا يكون هذا الموضوع هو بالضرورة قائد المجموعة، ولا حتى أحد أفراد المجموعة تحديدا، فربما يكون البدء فى التعرف على “الموضوع” كموضوع حقيقى مع الكيان المشترك المتكون الذى أشرنا إليه حالا مما أسماه بعض التحليليين “ذات المجموعة” Group Ego، لكن هذه البداية ليست كافية لتحريك الموقف الاكتئابى، لأن قاعدة “هنا-والآن” تشترط فى نفس الوقت أن تكون العلاقة بالموضوع أقرب إلى “أنت” وليس “أنتم”، ومن أهم مظاهر هذا الموقف هو حضور الآخر بكلــِّيته فى وعى الشخص، ومن ثمَّ حضور ثنائية الوجدان Ambivalence فى خلفية ملامح الاكتئاب الذى لا يعلن عن نفسه فى شكل الحزن أو الانقباض أو الانهباط، بقدر ما يتجلى فى شكل “ألم المأزق” و”صعوبة تحمل التناقض”، هذا التناقض إنما يعلن الموقف الاكتئابى من حيث أن الشخص يبدأ يعترف بأهمية وإيجابية حضور الآخر كموضوع حقيقى فى مواجهة وعيه وليس مُسقطا من داخله، لكنه فى نفس الوقت يصله تهديد ضمنى أن هذا الآخر الذى تبين أنه مصدر لعلاقة حقيقية (حب حقيقى –رؤية حقيقية- قبول حقيقى) هو هو مصدر التهديد بالترك ([7]) ، ومن ثمَّ التهديد بالهلاك من مصدر الحب ذاته.
4) ثـَمَّ فرق آخر فى مواكبتنا لاستيعاب الموقف الاكتئابى غير ما ذهبت إليه ميلانى كلاين، فهى تعتبر أن هذا الموقف الذى لا يحتمل، خليق بأن يترتب عليه محاولة التخلص من التهديد، وذلك بقتل الأم فى الخيال، ومن ثم الشعور بالذنب، فضلا عن حرمانه من الموضوع الواعد حرمانا بلا رجعة، ويكون الشعور بالذنب لقتل المحب المحبوب فالتكفير هو المفسر لهذا الموقف الاكتئابى، لكن فى خبرتنا – كما سبق أن ألمحنا- كان ظهور هذا الموقف فى العلاج الجمعى فى رحاب الرحم المحيط هو الذى يستوعب ثنائية الوجدان حتى تنقلب إلى “تحمل الغموض” بـ “إدراك الموضوع بكليته دون تجزيئه أو اختزاله، فالاكتئاب هنا إيجابى يعلن ألم المحاولة، وليس تكفيريا نتيجة للشعور بالذنب لقتل الأم (مصدر الحب: الحياة).
ثانيا: العلاج الجشتالتى: (1 من 2):
اعتبر الباحث ([8]) – بحق– أن مدرسة الجشتالت منطلقة من الفلسفة الوجودية أساسا من حيث التركيز على “كلية وجود الشخص” وليس الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض، وقد تركز الاهتمام فى هذه المدرسة على أن النظرة الكلية للإنسان يمكن أن تستعيد له حقه فى، وقدرته على: التكامل واضطراد النمو، وبالتالى يستطيع أن يحتوى ويتجاوز ذلك الاستقطاب الذى غلب على الإنسان المعاصر([9]) فى صور: “العقل مقابل الجسد” و”التفكير مقابل الوجدان”، و”تحقيق الذات الفعلية مقابل تحقيق صورة الذات”، واعتبر “بيرلز” أن الإنسان يلعب أدوارا شكلية تبعده أكثر فأكثر عن نفسه وعن الآخرين وتـُـعـَـمـِّـق تجزئته على حساب كليته، وبالتالى فإن هدف هذه المدرسة هو أن يتعرف الشخص على كلية ذاته ويقبلها ويتحمل مسؤولية وجوده، فإن فعل فإن اضطراد النمو يصبح نتيجة طبيعية تلقائية.
وفيما يلى بعض القواعد العامة التى تميز هذه المدرسة ونوعية تطبيقها فى العلاج الحالى.
أولاً: شحذ الادراك بالحواس وتجاوزها:
يستعمل المعالج الجشتالتى عينيه وأذنيه جسدا ووعياً، وربما كلـّه فى متابعة وإدراك التعبير غير اللفظى أكثر من محتوى كلام المريض، يقول بيرلز: “إن المعالج الجيد لا ينصت إلى محتوى رطان المريض بل إلى صوته، إلى موسيقى كلامه، وهو يواصل ملاحظة تردده، كما أن هذا المعالج لا يستعمل “التفسير” أو يرحب بالتعليل وقد عبر عن ذلك صراحة بقوله “إن: “لـِمـَاذَا“… و”لِأَنّ“: كلمات “قذرة” “سيئة السمعة” فى العلاج الجشتالتى “بل إنه أوصى: “أن تزيح عقلك جانبا وتستعمل حواسك”.
وفى خبرتنا كان لكل ذلك موقعه وفائدته وتطبيقاته التفصيلية التى سوف يأتى ذكر بعضها فى عرض الأمثلة، وقد لاحظنا فى هذا الصدد أن كل هذا يؤكد على دور “الإدراك” بمعناه الأوسع وخاصة فيما يتعلق بالادراك المتجاوز للحواسExtrasensory Perception ، حيث قد يصل الأمر إلى أن يُطلب من بعض المشاركين أن يلاحظ (أو يترجم) ما تقوله عينا زميله أو ما يبدو على وجهه فى لحظة معينة، كذلك كان من فضل حدة ملاحظة المعالج (ثم بقية أعضاء المجموعة) أن أصبح من السهل أن نلتقط هزة ساق أو شكل جلسة، ونركز عليها ونبدأ منها التفاعل أو قد توحى “بلعبة ما”، أو “مينى دراما” (انظر بعد) وقد تطور الأمر إلى ابتداع لعبة تكشف احتمال التواصل بدون كلام أو بجوار الكلام مثل لعبة “أنا لو حاقول كلام من غير كلام يمكن….” وسوف نناقشها مستقلة([10]).
ثانياً المأزق:
يمثل المأزق موقفا جوهريا فى العلاج الجمعى الجشتالتى، والمعالج إذْ يلاحظ ما يحاول المريض تجنب الخوض فيه، يحاول من خلال “الإحباط الماهر المقصود” أن يحول دون أن يتمادى المريض فى هروبه، وإذا بالمريض فى مأزق تخلى الدعم السابق، وفى نفس الوقت لا يكون قد اكتسب القدرة على اكتساب أدوات استقلاله بنفسه فينشأ “المأزق”، وحين يقدم المريض على خوض المأزق ويفعلها، ويتحمل نتائج ما اسماه بيرلز “المشى فى النار” Passing into fire وأسميناه نحن “المشى على الصراط”([11]) ويتحملها فإن قدراته قد تنطلق بما يعلن احتمال التغير النوعى مع عبور المأزق الذى يعتبر من أهم معالم النقلات فى العلاج الجشتالتى.
وفى خبرتنا: بدا أن المأزق مهما كان طفيفا فهو ضرورى للحكم على نقلة النمو وما إذا كانت نوعية بلا رجعة، أو سطحية شكلية، وكثيرا ما تظهر أعراض جديدة فى بداية المأزق وقمته وخاصة الألم النفسى (يسمى الاكتئاب أحيانا ونتجنب تسميته بذلك لتجنب الخلط) أو تغير الذات Depersonalization أو أى تغير نوعى فى الإدراك، أو اختلاف نوع الأحلام أو حتى ظهور الأفكار الانتحارية، ونادرا فرط التوجس.
ثالثاُ: الكرسى الساخن: (التأكيد على الفرد فى المجموعة).
الكرسى الساخن يعنى التركيز على فرد بذاته فى المجموعة تأكيداً لغلبة فكرة “الفرد فى المجموعة” على فكرة المجموعة ككل فى هذه الجزئية من تقنيات الممارسة الجشتاليتة.
وفى خبرتنا اكتشفنا أننا نرجح – دون قصد – مبدأ الفرد فى المجموعة لأنه يستحيل ألا توجد المجموعة فى خلفية التفاعل طول الوقت مهما تركز العمل على أفراد.
ولا يتم اختيار الشخص الذى يحتل الكرسى الساخن لأسباب معينة، حتى لو بدا أنه يمر بأزمة خاصة تحتاج عناية خاصة، لكن هذا الاختيار يعتمد على مسار المجموعة ومهارة المعالجين وهو ليس بالضرورة مرتبط بمدة معينة ولكنه يفرض نفسه حين يكون فرد بالذات فى حالة أزمة خاصة تستدعى تركيزا معينا للشخص فى الكرسى الساخن. وتختلف مدة ومرّات شغل شخص ما لمأزق الكرسى الساخن أيضا حسب مهارة المعالج ومسئوليته ليس فقط عن الشخص فى المأزق وإنما عن بقية أفراد المجموعة وبالنسبة أيضا لوقت المجموعة، وكثيرا ما سأل المشاهدون([12]) (غير المتدربين داخل المجموعة) عن أحقية فرد واحد يأخذ وقتا قد يزيد عن نصف وقت المجموعة فى جلسة واحده، ولا يكون الرد – فى المناقشة بعد انصراف المرضى – بتعداد أسباب ذلك، ولكن بالتأكيد على أن المسألة ليست تقسيم الوقت بالتساوى، وإنما هى تتوقف على مدى المسئولية عن متابعة آنية لانتباه الأغلب وجرجرتهم بين الحين والحين إلى المشاركة أو التفاعل بشكل أو بآخر فى التعليق ثم العودة إلى الكرسى الساخن أو شغله بشخص آخر أو الانتقال إلى آلية أخرى من آليات العلاج، ثم التذكرة أنه مهما بلغ الوقت الذى يبذل مع فرد واحد فإن مشاركة الباقين – دون تدخل مباشر تجرى بدرجة مناسبة فى أغلب الأحيان وهكذا.
ولا يتزامن “المأزق” مع شغل الكرسى الساخن بشكل مباشر وإن ارتبطا أحيانا بدرجة ما، بمعنى أنه أحيانا يكون شغل الكرسى الساخن متواكبا مع ما اسماه بيرلز الإحباط الماهر Skilful Frustration لكن هذا ليس قاعدة ولا هو مطلوب دائما، وأحيانا ما يكون الكرسى الساخن مطلبا صريحا أو خفيا من أحد أفراد المجموعة (ليس بالألفاظ الحرفية!!)، وهذا ليس دليلا دائما على حاجته إليه، فقد يكون نوعا من “غيرة الاخوة” Sibling rivalry أو لجذب الانتباه ومن ثم الاستجابة، وقد يتكرر شغل الكرسى الساخن بشخص واحد فقط عدة جلسات متتالية، لكن ينبغى ألا يتمادى الأمر وخاصة مع تنبيه أفراد المجموعة أو ملاحظة المعالج المساعد احتمال طرح أو طرح مقابل transference & Counter & Transference ويتم تناول ذلك بأقل قدر من الاتهام وأكبر قدر من المسئولية المشتركة.
ولا ينتظر من التعامل على الكرسى الساخن ما ينتظر من المشى على الصراط (المأزق) حيث أن الأول، وحتى بحسب الاسم ، هو نوع من تسخين التفاعل وتعميق التفاعل، أما الأخير فهو أزمة نمو ممتدة إذا أحسن الإعداد لها وتم اجتيازها يحدث بعدها عادة نقلة نوعية إيجابية على مسار النمو.
رابعاً: “هنا والآن”:
يؤكد بيرلز على أهمية التركيز تماما على هذه القاعدة كأساس جوهرى للعلاج الجمعى خاصة، وهو يقرر أنه لايوجد شىء يعمق المسؤولية مثل هذه القاعدة حتى اعتبر كما أسلفنا أن كلمتى “لماذا” “ولأن” كلمتان مرفوضتان (أو بتعبيره كما ذكرنا: قذرتان، سيئتا السمعة Dirty words of bad reputation) وفى خبرتنا (وأيضا بمراجعة معظم أنواع العلاج الجمعى) وجدناه على صواب نسبى حتى لو بدا فى الأمر بعض المبالغة.
وقد بدا لنا أن الالتزام بهذه القاعدة أصعب فى ثقافتنا ربما لأنه يعلن كيف تغلب فى حوارنا آليات “وضع اللوم” Putting The Blame والتبرير Rationalization والأرجح أن وسائل الإعلام العامة وكثيرا من الدراما والمسلسلات قد دعمت هذا الموقف الشائع بشكل أو بآخر حتى كاد يترادف عند الكثيرين مع “العلاج النفسى أو التحليل النفسى”.
ويحذق أفراد المجموعة عادة، استعمال هذه القاعدة برغم صعوبتها فى البداية، لكن تظل متماوجة بسبب إصرار المعالج المطلق على الإلتزام بهذه القاعدة (هنا والآن) .
خامساً: “أنا” “أنت”:
تكاد لا تنفصل هذه القاعدة عن القاعدة السابقة، “هنا والآن” وهما يـُذكران معا بصفة شبه دائمة “أنا – أنت” & “هنا والآن” (أنا وانت هنا ودلوقتى)، ويتم ذلك بالتنبيه على توجيه الخطاب (والتفاعل) إلى شخص مفرد باستمرار فى “هنا والآن” ومن ثم ينمى المسؤولية اللحظية فالممتدة.
وفى خبرتنا: ساعدتنا فى ذلك قواعد فرعية مارسناها جعلت الأمر أكثر صعوبة لكن أكثر تحديدا وإلزاما ومن ذلك -كما ذكرنا-:
أ) منع – ما أمكن ذلك – استعمال ألفاظ النكرة أو التعميم “الواحد” “الناس” “الشخص”.
ب) يطلب من المتكلم أن يذكر اسم المخاطَبْ تحديدا فى بدء المواجهة “يا فلان…” وأحيانا يُرَد إلى ذلك إذا حاد عن القاعدة.
ج) الإقلال حتى المنع أحيانا من المخاطبة بطرح الأسئلة المتلاحقة أو النصائح الفوقية، فيقال للمتكلم أن يواصل حواره: “من غير سؤال ولا نصيحة”، أى يجرى الحوار دون أسئلة ما أمكن ذلك ودون نصائح.
د) الانتباه إلى الحد من استعمال ضمير الغائب ( هو – هى – هم) ما أمكن ذلك.
ملحوظة: يتكرر السؤال فى آخر خمس دقائق عن مدى ضرورة الإلتزام بهذه القواعد فى الحياة العادية، والإجابة تكون برفض التوصية بمثل هذا الإلتزام إلا إذا جاء عفوا.
سادساً: قلب السؤال إلى إثبات:
وذلك بأن يطلب من السائل (سواء وجه سؤاله للمعالج أو لغيره) أن يحاول أن يجيب هو نفسه على السؤال الذى طرحه، أو أن يقوله بصيغة الإثبات “شيل علامة الاستفهام”.
وفى خبرتنا: اكتشفنا هذه الحقيقة الكامنة وهى أن أى سؤال يحمل معه احتمالات إجابات مهمة، يمكن التعامل معها الأرجح فالأرجح، بما ينمى استقلالية السائل، ويعمق الحوار.
سابعاً: الاختيار بعد تحديد الشكل من الأرضية:
لم أتبين باكرا علاقة العلاج الجشتالتى بعلم نفس الجشتالت، وبالتالى لم أعرف إلا بعد فترة ما علاقة هذا العلاج بتحديد الشكل من الأرضية، ثم توصلت من خلال معظم آليات العلاج من أول تحديد “المواجهة” فى أنا/أنت & “هنا/الآن” حتى الألعاب بكل التفاصيل التى سنذكرها لاحقا أن متصل الدراية Awareness Continuum قد يتداخل فيه الشكل مع الأرضية بحيث يصعب حسم الاختيار بينهما فى لحظة معينة أيها الشكل وأيها الأرضية.
المثل البسيط الذى ضربه لى أحد الزملاء ولم أقرأه هو لطالب يذاكر دروسه ولا يستطيع أن يركز لأن مثانته ملآنه، ويتأخر كسلا أوعنادا فى إفراغها فتصعب المسألة أكثر، وحين يحسم الأمر بأن يترك الدرس (الشكل) ويفرغ مثانته (الأرضية) التى كادت تصبح شكلا يحتل بؤرة انتباهه فقراره، تتحدد الخطوط بين الشكل والأرضية ويعود ليختار الاستذكار “شكلا” أكثر تحديدا ووضوحا.
فى العلاج، مع لعب هذا الدور ثم ذاك بين اختيارين، أو مع تقنيه العكس: أن يلعب عكس ما يعتقد أو يقول، ثم يرى أى الدورين أقرب إليه، فإنه بذلك يحدد الشكل من الأرضية، وقد يحسم حالة التردد والغموض والبلبلة ويقرر ما يشاء، وهكذا.
العلاج الجشتالتى (2من2) “الألعاب النفسية”
تمثل الألعاب النفسية أداة أساسية فى العلاج الجمعى الذى نمارسه منذ أربعين عاما، ومما لا شك فيه أن البداية كانت من مدرسة الجشتالت، وأنا لم أتعرف منها إلا على بعض ألعاب أساسية وجدتها أكثر تلاؤما مع، وإفادة لثقافتنا الخاصة، كما أننى لم أصنفها كلها تحت ما يسمى الألعاب حيث أنى فضلت أن أدرج لعبة “الحوار” Dialogue بين مكونات الشخصية مع ما أسميته “المينى دراما”، حيث يلتقط المعالج (أو غيره) أى انشقاق أو انفصال فى تركيب الشخصية ويرتب حوارا بين الأجزاء المنشقة فتكون دراما وليست بالضرورة لعبة كما طبقناها نحن.
وفيما يلى مجرد عينات من ثلاث لعبات أخرى بحسب بيرلز:
(1) لعبة “الإعكاس” (العكس): وفيها يطلب من الشخص أن يقول أو يمارس عكس ما يعلن تماما، وهذا وذاك سنرجع إليه أيضا -هنا أو فيما بعد- مع ما اسميناه “المينى دراما” كما ذكرنا.
(2) لعبة “المسؤولية”: وفيها يقول المشارك “أى كلام” سواء فيه “أنا” أو “أنت” أو حتى أية جملة عامة أو جملة بلا قصد محدد، ثم يعقبها مباشرة بـ “وأنا مسؤول عن كده” ويوجه كلامه مثل كل لعبة إلى شخص بذاته، مثلا:
يا فلان: أنا مش فاهم حاجة ……. وانا مسؤول عن كده
أو يا فلان: أنت بعيد عنى قوى ……. وانا مسؤول عن كده
أو يا فلانة: الدنيا اسودت قوى وما مفيش فايدة ……. وأنا مسؤول عن كده
وقد وجدنا أنه مهما كان ما يقال فِإن هذه اللعبة تحرك مسئولية وحضور المشارك بشكل مباشر بغض النظر عن محتوى ما قيل، حتى لو بدا أبعد ما يكون عن مسئوليته أو عن الإسهام فى حدوثه أو عن قدرته على تغييره، وهو ما يحقق ويعمق وظيفة “هنا والآن” من ناحية، كما أنه يمكن أن يعادل – بدرجة ما – ذلك الميل المتزايد فى ثقافتنا من حيث إلقاء اللوم على الآخر، والتبرير، الذى عادة ما يكون باللجوء إلى أسباب فى الماضى.
(3) لعبة “أنا عندى سر”: ونحن لم نكتف بأن تكون هذه اللعبة كشفاً للإسقاط كما قال بيرلز لكننا طورناها بأشكال مختلفة، فكنا نطلب من المشارك أن يكمل الجملة بأية طريقة من الطرق التالية (وغيرها) مثلا:
“أنا عندى سر لو عرفته حاتقول علىّ …….. (أكمل).
ثم:
“أنا عندى سر لا يمكن أقوله لحد لحسن …….. (أكمل).
وأيضا:
“أنا عندى سر لو قلته يمكن …….. (أكمل).
(وسوف نرجع إلى كل ذلك فى سلسلة الكتب التالية عن الألعاب فى العلاج الجمعى).
وبعـد
نورد فيما يلى بعض الملاحظات من خبرتنا حول “الألعاب” وتطورها بصفة عامة فى العلاج الجمعى وغيره مما سنعود إليه فى الكتاب الخاص بذلك.
أولاً: بدأت ممارسة الألعاب كجزء أساسى فى هذا العلاج منذ بداية العلاج الجمعى سنة 1971 وحتى الآن.
ثانياً: قمت بتجربة لممارسة ألعاب موازية فى برنامج “سر اللعبة” فى قناة النيل الثقافية لمدة سنة وشهرين (مرة أسبوعيا) مع متطوعين أسوياء لكشف وفحص بعض الظواهر والقيم فى الثقافية المصرية، وبالذات تعدد الذوات فى التركيب البشرى وساعدنى فى ذلك فهم طبيعة هذه الألعاب وتوظيفها فى العلاج أيضا.
ثالثا: قمت بمحاولة مماثلة محدودة فى برنامج “أقلب الصفحة” قناة MBC مع بعض المشاهير والفنانين والإعلاميين.
رابعاً: أجرينا محاولات تجريبية مع أسوياء من حضور ندوات جمعية الطب النفسى التطورى والعمل الجماعى فى الندوات الشهرية فى دار المقطم للصحة النفسية.
خامساً: بدأت تجربة لممارسة الألعاب كتابةً وعن بعد من خلال “موقعى” الخاص، وبرغم أن ذلك كان أبعد ما يكون عن الممارسة فى العلاج الجمعى إلا أن الاستجابات والحوارات كانت مفيدة ولها دلادلتها قد نعود إليها فى تناولنا الأوسع للألعاب.
سادساً: جرت محاولات محدودة مع العامة فى برنامج “مع الرخاوى” فى قناة أنا (لمدة 5 شهور) ([13]):
نبذة عن دور وتطور الألعاب فى العلاج الجمعى خاصة: (التفاصيل فى الكتب اللاحقة)
1) كانت البداية ونحن منبهرين بمدرسة التحليل التفاعلاتى Transactional Analysis فكانت معظم الألعاب أقرب إلى لعبة الحوار التى أشار إليها بيرلز، وهى التى نقلنـاها فيما بعـد إلى “المينى دراما”، وقد كانت الانشقاقات المتاحة غالبا بين الذات الطفلية والذات الوالدية.
2) لم نستعمل من ألعاب العلاج الجشتالتى المسجلة التى وصلت إلينا إلا لعبتىْ:
(1) “أنا عندى سر….”، “و(2) أنا مسؤول عن كده”
3) فى السنوات الأولى بالغنا فى استعمال الألعاب خاصة كلما وجدنا صعوبة ولو نسبية فى تحريك المجموعة، فكانت وسيلة مهمة تساعد فى فك العرقلة.
4) تبينا بعد ذلك أن فرط اللجوء إلى لعبة ما لفك العرقلة فيه بعض الاستسهال ومن ثم اقتصرنا على تشجيع استعمالها فى الشهرين أو الثلاثة الأولى (من عمر المجموعة: 12 شهرا) ثم أوصينا بالإقلال منها تدريجيا حتى أمكن أن نستغنى عنها تقريبا فى النصف الأوسط من عمر المجموعة بعد أن يكون معظم أفراد المجموعة قد وصلهم الجزء الآخر من وجودهم ووجود الآخرين وبدأوا يتواصلون بكل مستويات تركيبهم أو أغلبها دون الحاجة إلى ألعاب.
5) اختلفت الألعاب التى مورست اختلافا شديدا حتى أننا لم نلتزم بنص معين مهما كان ناجحا فى مجموعات سابقة.
6) كانت الألعاب الأهم هى التى نطلب فيها أن يكمل المشارك جملة ناقصة وهو يُعتبر بذلك مؤلفا مشاركا فى “نص” المينى دراما .
7) الذى يقترح مضمون اللعبة يكون قائد المجموعة أو أحد المتدربين أو المعالجين المشاركين أو المرضى بمعنى أنه يسمح لأى مشارك أن يقترح لعبة ما، ويترك تقدير السماح بممارستها إلى المعالج الرئيسى أساسا أو المعالجين المساعدين أو المتدربين، فلا يوجد إلزام بلعبها.
8) اختلف ترتيب إدارة اللعبة اختلافا شديدا حسب الحاجة إليها والوقت المتاح وحماس المشاركين، ويتنوع الترتيب غالبا كما يلى:
أ) قد يلعب فردٌ واحد لعبة واحدة أثناء التفاعل مع المعالج أو مع زميل، ويكون ذلك أيضا أقرب إلى المينى دراما.
ب) يمكن أن يوجه المشارك كلام اللعبة لأى شخص فى المجموعة باسمه عادة بما فى ذلك المعالجين، ويكون الدور التالى على هذا الشخص المخاطب ليلعب بدوره، وهكذا.
ج) يمكن أن يترك الاختيار للذى لعب اللعبة ليحدد الذى يلعب بعده ونقول له ساعتها “تدى الكورة لمين”. (أى: من تختار ليلعب بعدك).
د) يمكن أن تكون اللعبة ذات دلالة وأهمية خاصة فيطلب من المشارك أن يلعبها مع كل أفراد المجموعة مع التوصية بإلزام نسبى ألا يكرر إكمال النص، أى أن تكون التكملة مختلفة مع كل فرد.
هـ) عادة ما يلعب المعالج الرئيسى أخر واحد فى الترتيب، إذا كانت اللعبة ملزمة للجميع، وقد توصلنا إلى ذلك خشية أن يتصور بعض أفراد المجموعة أن استجابته هى الاستجابة النموذجية المطلوبة التى تساعد فى العلاج فيحذون حذوه، ويقلدونه ويفقدون فرصة التلقائية.
سابعا: قد نعود إلى انتقاء ألعاب مكملة أكثر كشفاً وأعمق غورا قبيل انتهاء المجموعة فى الشهرين الأخيرين عادة.
ثالثا: العلاج بالتحليل التفاعلاتى([14])
الواقع أننى بدأت هذه الخبرة فى العلاج الجمعى متأثرا بهذه المدرسة ، من الناحية النظرية على الأقل، بشكل مباشر، ولم أكن قد قرأت عن إسهاماتها فى العلاج الجمعى([15]) بوجه خاص، وإنما كنت مشدودا بشكل أكثر لنشأة هذه المدرسة من الحدس المباشر لصاحبها، ومن بساطة واستقامة لغتها، ثم من إمكانية تطبيق بُعدها التركيبى: التحليل التركيبى Structural Analysis بشكل مباشر دون الحاجة إلى كل ما يحتاجه التحليل النفسى التقليدى، وقد بلغ من فرط مباشرتها وبساطتها أن أسىء فهمها كما أسىء استعمالها فى العلاج وغير العلاج.
فكرة تعدد الذوات فكرة مباشرة وذكية ، يؤيدها التطور والتاريخ والتطبيق جميعا، ومن فرط حماسى للفكرة ، كان من السهل عمل انشقاقات بين ذوات الفرد فى كثير من المواقف فى خبرتنا الباكرة فى العلاج الجمعى منذ أوائل السبعينيات، إلا أن حماس الشباب الذين اشتركوا فى تجربة المتطوعين حول هذا التاريخ وكانوا طلبة من كلية الطب جعلت هذا الانشقاق أغلب ما يكون بين الذات الطفلية فى مواجهة الذات الوالدية، وكنا نفرح حين تنتصر الأخيرة على الأولى (الذات الطفل على الذات الوالد) فى كثير مما يجرى فى السيكودراما، أو المينى دراما التى تجرى وإلى درجة أقل فى الألعاب. انتقل هذا التحيز وهذا الحماس إلى خبرتنا فى علاج المرضى بشكل واضح، وإن كان أقل تصفيقا وأقل دعما للذات الطفل.
مع تعميق الخبرة فى مجال العلاج الجمعى تحديدا والنظر فى نتائجها بدءا من مجموعة الطلبة التجريبية، امتدادا إلى المرضى، ومع مرور الزمن والتتبع لكثير من الحالات التى شاركتنا هذه المحاولات البادئة، اكتشفت أن تجارب الانشقاق واللعب والدراما على أساس هذا التقسيم الثلاثى كانت لا تنتهى بولاف جديد كما نرجو، كما أننا لم نكن ندعو – الذات اليافع (Adult Ego State)، إلى المشاركة للتصالح والتوفيق ثم التناسب والإبدال، أو للولاف والنمو معا، ومن ثم كانت النتائج تسير فى اتجاه نوع خاص من التلوث التلفيقى الذى وصفناه وليس الذى وصفه إريك بيرن أو بيرلز، وكان الناتج نوعا من “اضطراب الشخصية” بها معالم كثيرة من النكوص والبعد النسبى عن الواقع، كل هذا جعلنا نتراجع ونقلل من هذا الاندفاع فى نفس الاتجاه، الذى كان يمثل درجة من “التلوث” بين الذوات (كحل وسط ساكن) وليس التكامل النامى المرجو.
ثم إنه بتقدم الألعاب والمنيدراما تبينا كيف أن تعدد الذوات لا يقتصر على هذا الثالوث، بل يمتد إلى ما يقابل ما اسماه إريك بيرن “وحدات الذات” Ego Units ، ومع تقدمنا أكثر فى التعرف على ماهية تعدد مستويات الوعى (بما يقابل أحيانا تعدد العقول بلغة دانيال دنيت) ([16]) استطعنا أن نوسع قاعدة الانشقاق إلى ما تجاوز هذا التثليث التفاعلاتى، حتى وصلنا الآن (2018) إلى ندرة السماح بالأنا الطفلية أو الوالدية بالمثول فى المينى دراما إلا لضرورة ترتبط بإمكانية احتواء أى منهما فى الكل النامى بدءًا من الآن.
لغة ومبادىء مدرسة التحليل التفاعلاتى:
بصفة عامة فإن لغة هذه المدرسة يمكن إيراد رؤوس مواضيعها كالتالى:
1) التفاعلاتية Transactions ، وهو ما اشرنا إليه حالا من أن الحوار بين اثنين هو فى واقع الحال حوار بين ستة (على الأقل)، ويمكن تحليل ذلك فى أى مقطع تفاعل
2) اللعبة The Game(الدور) وتشير إلى سلسلة من النقلات بين حالات الذات تفاعلاتيا، لكن ليكون دورا قابلا للتحليل فإن الذات الظاهرة (على السطح) عادة ما تخفى الذاتين الأخريتين
3) النص Script وهو يشير إلى برنامج مزروع منذ الطفولة على مستوى الوعى غالبا يرسم خطة لحياة الفرد بشكل أو بآخر، ويقول بيرن أن هذا البرنامج هو الذى يحدد معظم أنواع تفاعل الفرد طوال عمره، ويوجز تصنيفات البرامج الأساسية باسم “مواقع” على الوجه التالى:
1- أنا على صواب، وأنت كذلك ( الموضع الصحّى)
I am O.K. you are O.K. (Healthy position).
2-أنا على صواب وأنت على خطأ (الموضع البارنوى)
I am O.K. you are not O.K. (Paranoid position).
3-أنا على خطأ وأنت على صواب (الموضع الاكتئابى)
I am not O.K. you are O.K. (Depressive position).
4- أنا على خطأ وأنت على خطأ (الموضع الشيزيدى).
I am not O.K. you are not O.K. (Schizoid position).
ويمر العلاج التفاعلاتى عموما بخطوات متتالية فى العلاج النفسى كالتالى :
1) التحليل التركيبى Structural Analysis: وهو بمثابة تخطيط فرض إمراضى من واقع التشريح التركيبى لحالات الذات وعلاقتها ببعضها البعض بما يسمح بالتحليل التفاعلاتى .
2) التحليل التفاعلاتى Transactional Analysis: ويعنى به بيرن تفعيل هذه العملية بفض التلوث، وتحديد الحدود بين الذوات، ومنع توْه الطفل (الذات الطفلية) وحل الصراع بين الطفل والوالد وترجيح قيادة الذات اليافع معظم الوقت ، وبعد هذه المرحلة يمكن أن يتواصل التحليل النفسى أو التحليل التفاعلاتى (حسب بيرن!!)
3) تحليل “الدور” (اللعبة Game) وهى خطوة تكميلية يقوم بها المعالج أو المريض، بل كلاهما بعد التفاهم على اللغة، بعد القبول المبدئى بفروض التحليل التركيبى.
4) تحليل النص Scrip : عادة لا يظهر النص بوضوح إلا فى مرحلة متأخرة من العلاج (بعد عدة جلسات من العلاج الجمعى مثلا) ، وعموما فإنه يمكن تحقيق تفوق الذات اليافع قبل أو حتى بدون تحليل النص
وخلال كل ذلك يستعمل المعالج كلا من:
- الأسئلة
- والمواجهة
- والشرح
- والتوضيح
- والتأكيد
والهدف عموما من هذا العلاج هكذا هو الوصول إلى مرحلة: “التفاعل بلا حاجة إلى لعب الأدوار Game Free Existence”، فإن كان ذلك مستحيلا، وهو كذلك فى كثير من الأحيان، فيمكن الرضا بمرحلة يمكن للشخص فيها أن يحذق اختيار “الدور” الذى يلعبه ويحسن أداءه.
التعقيب:
بعد ممارستنا المحدودة لبعض هذه القواعد ، وبصفة عامة كانت لنا مواقف نقدية بلغت حد الرفض إزاء هذا الأسلوب العلاجى وبعض التنظير لهذه المدرسة، نورد أهمها كما يلى :
1) أسمى إريك بيرن، ولو عفوا، أن هذا العلاج هو “العلاج بالكلام” Treatment by Talk وفى خبرتنا لم يكن الأمر كذلك تماما، فالكلام يكاد يفقد أولويته فى التفاعل فى العلاج الجمعى، برغم أنه الوسيلة الأوضح والأسهل، فنحن فى العلاج الجمعى نعتبر الكلام “وسيلة للشغل” ونبدأ الجلسة كما أشرنا سابقا بالتساؤل: “مين اللى عايز يشتغل” وليس “مين اللى عايز يتكلم”، ثم نحاول فى معظم المواجهات والتفاعلات أن ننبه إلى التعبير بأكثر من قنوات للتواصل، بدءا بالوجه والجسد، وليس انتهاء بالإشارة البديلة التى نعتبرها نوعا من الكلام.
2) نحن لا نعتبر أن التحليل التركيبى خطوة نحو العلاج التحليلى النفسي ، بل لعله يوجد تعارض جذرى بين الطريقتين من عمق معين، ثم إن العلاج الجمعى (كما نمارسه) هو أقرب إلى تفعيل الكلام لا تفسيره ولا تأويله.
3) نحن نستعمل التحليل التركيبى كقاعدة تقريبا، بعد توسيع مفهوم تعدد الذوات معتمدين على تحديد الذوات بما يقابل الأمخاخ تطوريا، فعندنا المخ الشيزيدى المتفرد (الذات الشيزيدية) والمخ البارانوى (الذات الهروبية العدوانية = الكر/الفر)، والمخ الاكتئابى (العلاقة البشرية الصعبة الضرورية بالموضوع) ثم الذات العادية (أو العصابية أو فرط العادية بدرجات متفاوتة من استعمال ميكانزمات التكيف حتى الامتثال)، وكل ذلك يمكن رسمه بقطاع مستعرض فى الشخصية، سواء قبل العلاج النفسى أو بدونه، ويفيدنا كل ذلك ليس فقط فى العلاج النفسى، أو العلاج الجمعى، وإنما فى رسم الإمراضية لأى مريض من البداية، وهى الخطوة التى نعتبرها أهم من لافتة التشخيص فى التخطيط العلاجى – حتى بالعقاقير- والمتابعة.
4) نحن نحترم فكرة ما هو برنامج ممتد موجه “نص” script (خطة حياة) لكن نختلف مع هذه المدرسة فى كل التفاصيل كما يلى:
* نولى اهتماما بالغا بالبرامج الوراثية، ليس بمعنى وراثة مرض بذاته، وإنما بالبحث عن أى نص (برنامج بيولوجى يمكن أن يورث مثل: القابلية المفرطة للإيقاعية النوابية، أو مثل الاستهداف للتفكك، أو مثل الميول التوجسية.. أو مثل وراثة فرط الطاقة إلخ)، ويمتد احترامنا لهذه البرامج إلى النظر فى أثر التنشئة الباكرة فيها حتى تكوين الشخصية فى كل مرحلة من مراحل النمو، ويتغير النص تلقائيا فى النمو السليم مع كل مرحلة نمو ونضع ذلك فى الاعتبار باستمرار.
* لا نعتبر أن “النص” تكوّن شعوريا أثناء الطفولة كما تصور إريك بيرن، وأنه تركيب مزروع وبيولوجى وغائر لكننا نتعامل معه باعتباره جاهزا للتغير من الطفولة وحتى نهاية العمر مع نبضات الإيقاعحيوى والنمو، وجزء كبير منه لاشعورى ويعتبر من سمات الشخصية السوية أو غير السوية، وله علاقة مباشرة وغير مباشرة بما يسمى “الأسطورة الذاتية”
* لا يقتصر النص – إذن – على هذه الأوضاع الأربعة التى وضعها إريك بيرن، وقد وجدنا أنها مرتبطة بثقافته الغربية بشكل ما، حتى أننا قمنا بتعديلها من واقع خبرتنا بما يجرى فى ثقافتنا، مع أننا لا نلجأ إلى استعمالها، لا فى التوصيف الإمراضى التركيبى (التحليل التركيبى)، ولا فى العلاج النفسى الفردى أو الجمعى، ومع ذلك نورد التحويرات المقترحة التى قد تتفق أكثر مع ثقافتنا وخبرتنا أو ما نأمله فى ثقافتنا بشكل أو بآخر.
نحن نعتبر النص Script برنامجا بيولوجيا يشمل تشكيلات نيورونية، وداخل خلوية مزروعة فينا من قبل أن نولد، وهى برامج بيولوجية قابلة للتطوير كما أنها قابلة للتشويه، وهى نشطة على مستوى اللاوعى غالبا، لكنها تتجلى فى السلوك وفى نوع الشخصية أساسا، ثم تظهر فى المرض بتحوير شديد حسب مسار المرض ونوع العلاج، وفيما يلى ما نقترحه من تعديل فى تصنيف البرامج الأساسية:
* أنا على صواب وعلى خطأ، وأنت على صواب وعلى خطأ (الموقف الصحّى)
* أنا على صواب وأنت على خطأ (الموقف البارنوى)
* أنا على خطأ وأنت كذلك لكنى أحتاجك فنحن على صواب أيضاً (الموقف الاكتئابى)
* أنا على خطأ وأنت كذلك، ولا يحتاج أى منا للآخر (الموقف الشيزيدى).
وبالرغم من ذلك فنحن لا نستعمل هذه النصوص أصلا، مكتفين بالتعامل مع حالات الذات باعتبارها أمخاخا بيولوجية، وحسب علاقتها بالموضوع (تطوريا وحسب مدرسة العلاقة بالموضوع) كما ذكرنا، ويتم التركيز على المواجهة فالجدل فالولاف الأعلى فى رحم المجموعة.
خلاصة القول
إننا نمارس العلاج الجمعى من منطلق ثقافتنا، ويغلب عليه مبادىء علاج الجشتالت دون الالتزام بالمبدأ الوجودى، مع استلهام تقنياته غالبا
إننا نأخذ من علاج التحليل التفاعلاتى فكرة التعدد فقط، دون بقية التقنيات والتفاصيل غالبا
إننا نتبنى الفكر التطورى الممتد ونفسر من خلاله مراحل وأطوار النمو المستعادة، ومن ثم الإمراضية ، ومنها نخطط للعلاج النفسى وغير النفسى، الجمعى وغير الجمعى.
[1] – يقصد بالتحليلى هنا : التحليل النفسى، الفرويدى غالبا، وليس دائما، فمن أعظم ما نستلهمه فى خبرتنا هو استلهام مواقع النمو المتتالية للمدرسة الإنجليزية فى التحليل النفسى، (ميلانى كلاين- فبربيرن- جنترب) مع تضفرها بالمدرسة التطورية الإيقاعية.
[2] – يحيى الرخاوى: “حياتنا .. والطب النفسى” الفصل الرابع: “الحيل النفسية فى الأمثال العامية”، سنة 1972
[3] – تاريخ كتابة هذا الفصل سنة 1976
[4]– من أول هذه المرحلة وطوال عرضنا للاختلافات نذكّر القارئ، خاصة الذى يمارس العلاج الجمعى أن ما يميز ما نقدم هنا الآن هو وجود الذهانيين جنبا إلى جنب مع سائر التشخيصات فى نفس المجموعة، وأيضا مواكبة استعمال العلاجات العضوية، وخاصة النيورولبتات بالطريقة التى أوضحناها فى الفصل السابق، وخاصة طريقة الزجزجة Zigzag وهذا اللاتجانس هو من أهم محركات المجموعة تحت أمان استخدام النيورولبتات فى الوقت المناسب بالقدر المناسب.
[5] – غالبا سوف تعرض ألعاب كثيره شرح هذا الموقف فى كتاب أو أكثر بعد هذه السلسلة يعرض مختلف الألعاب الكاشفة لهذه المواقف.
[6] – لا تقتربوا أكثر إذ أنى ألبس جلدى بالمقلوب،
حتى يدمى من لمس الآخر، فيخاف ويرت، إذْ يصبغ كفيه نزفٌ حى
(ثم)…….
فبقدر شعورى بحنانك: سوف يكون دفاعى عن حقى فى الغوص إلى جوف الكهف
وبقدر شعورى بحنانك، سوف يكون هجومى لأشوه كل الحب وكل الصدق
– أنظر: يحيى الرخاوى “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” ص 302
[7] – أضغطـْ تحلبْ أتركْ تننضبْ
أضغطـْ تحلبْ أتركْ تننضبْ
لكن هل تنضب يوما دوما؟؟!!
فكرهت الحب (أنظر كتاب “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” ص 843)
[8] – مازلنا نشير إلى البحث الذى كان الكتيب الأول الذى نحدثه مقدمة لبحثه.
[9] – مرة أخرى لن أستدرج إلى أى تاريخ سردى أو تأصيل نظرى فى أى من المدارس التى سأشير إليها لأن الغرض هو تقديم خبرتنا فيما يتقاطع مع بعض أفكار هذه المدارس لا أكثر.
[10] – هنا أو فى كتاب مستقل للألعاب العلاجية.
[11] – هذا هو اسم ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط” الذى خصص الجزء الثانى منها باسم “مدرسة العراة”، لعرض خبرة روائية للعلاج الجمعى مستلهمه من خبرة واقعية معظم الوقت، والمفهوم الشائع للمشى على الصراط فى الفكر الدينى الشعبى هو أنه فى الطريق إلى الجنة لى الإنسان القيام بعبور برزخ فوق نار مشتعلة (نار جهنم) مشيا على سلك رفيع جدا من الصلب…الخ.
[12]– إشارة إلى الدائرة الأكبر، دائرة المشاهدة، صامتين للمتدربين والمهيئيين لممارسة هذا العلاج أو مثله لاحقا، ويتم هذا بإذن المرضى فى المجموعة وبعد موافقتهم، وهذه الدائرة الأكبر تناقش ما نشار بعد اتفقها ووقت المجموعة وانصراف كل المرضى .
[13] – وقد تم تسجيل الكثير من هذه الخبرات صوتا وصورة، ونأمل أن يكون بعضها متاح فى الوقت المناسب بعضها حاليا متاحة بموقعى الخاص.
[14] – Transactional Analysis
[15] – وإن كنت قد اكتشفت الآن أنه يوجد كتاب لرائدها إريك بيرن عن مبادئ العلاج الجمعى Principles of Group Treatment 1966 وهو صادر بعد كتابه التحليل التفاعلاتى والعلاج النفسى Transactional Analysis and Psychotherapy 1961 ، أتعشم أن أحصل عليه وأقرأه قبل إصدار الطبعة التالية من هذا العمل.
[16] – انظر هامش (23)
الفصل العاشر علاقة هذا العلاج بالعلاجات الاخرى
الفصل العاشر علاقة هذا العلاج بالعلاجات الاخرى
الفصل العاشر: علاقة هذا العلاج بالعلاجات غير النفسية (العضوية) الأخرى
أولاً : العلاجات (الفارماكولوجية) بالعقاقير
يتميز ما يجرى فى خبرتنا – وفى هذا البحث أيضا- بأن تصنيفات المشاركين فى هذا العلاج غير متجانسة، وبالتالى هى تشمل أغلب أنواع الاضطرابات، بل إنه يكاد يغلب فيها عدد الذهانيين واضطرابات الشخصية على غير ذلك من تشخيصات، ويبدو أن البحث الحالى كان يمثل تحديدا هذا الترجيح، فقد كانت أغلب الحالات من نوع الاضطرابات الجسيمة، وكان حوالى نصف المرضى يتعاطون عقاقير فى نفس الوقت، ولكن هذا البحث لم يقدم لنا إشارات واضحة عن دور هذه العقاقير والعلاجات “مع” العلاج الجارى أو “بديلا عنه” أو “معوقاً” له، ولا أستبعد نقداً من بعض العتاة يقول: “من أدرانا أن هذا التغير الذى تزعمون ليس نتيجة للعقاقير التى يتناولها هؤلاء المرضى، فهو ليس نتيجة للعلاج الجمعى بالذات؟” إلا أن الباحث كان حذراً منذ البداية، فأعلن أنه يبحث فى طبيعة وأبعاد العملية العلاجية، وليس فى نتائجها تحديدا، ولا هو وضع فرضا عن علاقة النتائج بمتغير علاجىّ بذاته، وربما ترك بحث هذا الأمر لمرحلة تالية.
وأبدأ بأن أوضح بعض الخطوط العريضة بهذا الشأن:
1- مجموعة هذا البحث تعانى من اضطرابات شديدة بصفة عامة: 6 فصاميين، 7 اضطراب شخصية شديد مما يعتبر مكافئا غائيا للفصام من منظور تطورى خاص.
2- كثيرون من مجموعة البحث لم يستجيبوا “لكل” العلاجات السابقة وحدها بما فيها العقاقير الكيميائية والجلسات الكهربائية، ليس بمعنى أن حالتهم متدهورة أو مستعصية، ولكن بمعنى أنهم مروا بعلاجات كيميائية وفيزيقية مختلفة لم تحقق لهم الشفاء، ثم التحقوا بهذا العلاج.
3- أثنان من المجموعة دخلا المستشفى فترة من الوقت أثناء العلاج، الأول: لبضعة أسابيع، والثانى: مازال بها (وقت إجراء البحث، وكان يحضر خصيصا من المستشفى ليحضر جلسات العلاج في عيادتى الخاصة).
الأساس التطورى البيولوجى لاستعمال العقاقير عموما، وفى العلاج الجمعى.
كانت فكرة التغيير الفعلى لتركيب الدماغ واصلة إلىّ من الممارسة منذ البداية، وذلك من خلال العلاج عامة بما فى ذلك العلاج النفسى، والعلاج الجمعى خاصة، على أن ذلك كان – ومازال– مرتبطا بانتمائى للفكر البيولوجى التطورى بالمعنى الاوسع، هذا المدخل هو الذى هدانى إلى فروض فاعلية العلاج (نقد النص البشرى) من حيث أنه يؤكد إعادة تشكيل بناء المخ من خلال العلاقة العلاجية، وهو الذى تطور مؤخرا مع نمو العلم المعرفى العصبى([1])، وتبنـِّى مفهوم المطاوعة النيورونية([2])، فتحققت بعض فروضى الباكرة تدريجيا: وبناء على ذلك فإن ما يميز الطريقة المتبعة فى هذا العلاج طول الوقت هو التزاوج المرن بين التداوى بالعقاقير وخاصة النيورلبتات الجسيمة Major Neuroleptics والتى يمكن ترتيبها بحسب فاعليتها الانتقائية المتصاعدة هيراركيا تبعا لتأثيرها على مستويات المخ من منظور تطورى أساسا، بما يسمح بالتحرك مع جرعات الأدوية ونوعها، حسب تطور الحالة، ومتابعة فروض التغير في تشكيلات الأمخاخ وعلاقتها ببعضها البعض ويجرى تحديد ذلك بمشاركة المرضى أحيانا. (انظر بعد).
إن النظرية التى تنتمى إليها هذه المعالجة هى تطورية فى المقام الأول، وهى تتكامل مع مراحل النمو إذ هى موازية لنظرية “العلاقة بالموضوع” Object Relation Theories، وقد ظل هذا المفهوم التطورى بالإضافة إلى ما قمت بتطويره لنظرية الاستعادة (Recapitulation Theory) هو الذى يسمح لنا بالتعامل مع العقاقير انتقائيا حسب تطور العلاقة العلاجية من خلال ملاحظات حركية استعادة، وإعادة، النمو ومواصفات نشاط المواقع النمائية (التطورية) المختلفة([3]) وليس مجرد ظهور أو اختفاء الأعراض.
وفيما يلى الخطوط العريضة لكيفية استعمال العقاقير عموما، ومع العلاج الجمعى حسب هذه الفروض التطورية:
(1) نحن نستعمل عددا قليلا من العقاقير المهدئات العظيمة (النيورولينات الأقدم عادة التى أمكن التعرف على فاعليتها الانتقائية على أى مستوى تطورى (أى الأمخاخ الأقدم فالاحدث…) ومضادات الاكتئاب التقليدية (ثلاثية الدوائر عادة) وهى التى نستعملها انتقائيا أيضا من خلال الخبرة الطويلة معها إذ أنها هى الأخرى الأقدم فى خبرتنا. (أنظر بعد).
(2) لا يرتبط ذلك تحديدا بالتشخيص التقليدى للمرض ولا بالموقع الكيميائى المشتبكى لفاعلية العقار، وإنما يتوقف على التخطيط الإمراضى (سيكوباثولوجيا) لكل مريض، حيث يوضع من خلاله فرض يصف ما يجرى من نشاط كل مخ من الأمخاخ المتراتبة تطوريا وهيراركيا ونمائيا وتحديد أى مخ ناشزٍ أو مغيرٍ من واقع الأعراض وتغيرها، والعلاقة بالمعالج واختلاف المسافة، وتلقائية المشاركة فى التأهيل والعلاقة بالواقع، ومن خلال ذلك يمكن رصد صراعات الأمخاخ مع بعضها، وتحديد غلبة أيها – فى هذا الاضطراب بالذات فى هذا المريض بالذات فى هذا الوقت بالذات.
(3) تُرسم الخطة العلاجية على أساس الحدّ من النشاط العشوائى للمستويات الأقدم التى تنشطت على حساب المستوى الأحدث الذى كان قائد فريق الأمخاخ (نقطة انبعاث النبض المخىPace Maker ) فى حالة اليقظة والسلامة، والمخ الأحدث هو المخ الذى يحتفظ بعلاقاته بالواقع فعلا يوميا، ويحافظ على علاقته بالآخرين (الموضوع) مسايرة مقبولة، وتبادلا متحـَمـِّلاً، وذلك بصفة غالبه ودورية وإيقاعية وقائدة، وليس بصفة جاثمة مستبعدة لغير طول الوقت.
(4) تُعطى العقاقير على هذا الأساس باعتبار أن المخ الأقدم الذى يحضر عادة فى شكل عدوان، أو بدائية، أو نكوص اعتمادى وانسحاب من الواقع: يحتاج لنوع من العقاقير الأقوى فاعلية جدا للتثبيط، ويبدو أن اروع ما يميز هذه العقاقير منذ اكتشف عقار الكلوربرمازين هو هذه “الانتقائية”، وأن أقوى هذه العقاقير بالتالى هو أقدرها على التحكم فى فرط نشاط المخ الأقدم وهو حتى الآن([4]): عقار الهالوبيريدول. (ثم العقاقير الأحدث زيبركسا، أولابكس، القادرة على تثبيط النشاط الناشز لأكثر من مستوى بدائى واحد).
(5) يتم ترتيب العقاقير هذا الترتيب الهيراركى على مر السنيين، من واقع الممارسة الاكلينيكة، والمتابعة السيكوباثولوجية (النفسمراضية) حتى يصبح استعمال عقار حديث يحتاج لفروض تشكيلية لتحديد فاعليته الانتقالية أكثر مما يحتاج لتبريرات معملية بيوكيميائية.
وهنا أقر واعترف بصعوبة إقدامى على استعمل أى عقار جديد إلا بعد أن أجد له مكانه على سلم هذه الهيراركية بتجربته لمدة طويلة تصل أحيانا لسنوات.
(6) يُفضل استعمال الأسلوب المتقطع فى إعطاء هذه العقاقير Zigzag اعتمادا على أن المقصود ليس هو التثبيط القاهر حتى التهميد النهائى، وإنما هو الضبط والربط حتى إمكان ترويض نشاط وطاقة الأقدم للتكامل والتبادل مع فاعلية الأحدث.
(7) يتواصل تغيير جرعة العقار مع التمادى فى مسيرة التأهيل (بما فى ذلك العلاج الجمعى أو العلاج عموما) بمعنى أنه تنقص العقاقير تدريجيا – دون إلغائها- مع ظهور علامات استعادة المخ الأحدث نشاطه، وبالتالى احتمال استعادة قيادته لبقية الأمخاخ أثناء الصحو.
(8) قد يلزم الأمر مع تغيير الجرعة تغيير العقار من الأقوى جدا، إلى الأقوى فقط إذا ظهرت علامات ضبط كافية لنشاط المخ العشوائى الأكثر قِدَما لصالح الأحدث فالأحدث، وهكذا.
(9) يُعتير ظهور الاكتئاب “الأصيل” (الألم العلاقاتى) أثناء هذه العملية دليلا على الانتقال من غلبة المخ البدائى إلى المخ الإنسانى حيث يعتبر تنشيط هذا الاكتئاب الإنسانى دليلا على صعوبة محاولة عمل علاقة مع آخر، وفى نفس الوقت فإن هذا المخ يمارس درجة من ثنائية الوجدان من جهة، وألم التواصل من جهة أخرى، وبعض نقلات المزاج من جهة ثالثة، ويعتبر كل ذلك دليلا على التقدم نحو استعادة إيقاع مسيرة النمو الأسلم، وفى هذه الحالة قد يستعان ببعض مضادات الاكتئاب التقليدية بجرعة متوسطة للحفاظ على اضطراد مسيرة النمو، حيث أن جرعة مناسبة من الألم (الذى هو عمق هذا الاكتئاب) يعتبر علامة إيجابية لمحاولة عمل علاقة حقيقية مع الأخرين، بدءًا بمرضى المجموعة.
(10) مع ضمان إطلاق الطاقة التى كان يستولى عليها المخ الأقدم لتكون تحت تصرف المخ الأحدث لإرساء علاقة بالواقع (العمل أساسا) وبالموضوع ( تنشيط العلاقاتية) نقوم بإنقاص جرعات العقاقير بتناسب عكسى مضطرد، أى: كلما أمكن تشغيل الطاقة الحيوية (النفسية) فى التواصل، وشحن الواقع، أمكن إنقاص جرعات العقاقير.
(11) يعتبر العلاج الجمعى بالذات بمثابة خبرة أزمة نمو([5]) علاجية ممتدة، يعود فيها المريض إلى رحم الجماعة حيث يمارس خبرة استعادة الثقة الأساسية،([6]) ثم ينتقل إلى مواقف النمو المتتالية بشكل معلن أو خفى، مرورا بمرحلة “الكر والفر” (المخ البارنوى) ثم مرحلة المخ الاكتئابى العلاقاتى المتميز بظهور “ألم العلاقة” وذلك جنبا إلى جنب مع استعادة تنظيم الطاقة الحيوية وشحن الواقع والموضوع بها تدريجيا،
وهكذا يمكن اعتبار العلاج الجمعى من منطلق التطور والنمو بمثابة تخليق أزمة نمو علاجية منضبطة لاستعادة بسط نبضة نمو سليمة لتصحيح مسار التطور الفردى، بالعودة إلى الإيقاع الحيوى التكيفى النمائى المستمر.
وبعد
خطوات التطبيق:
بناء على هذه الفروض جميعا يتدرج التعامل مع العقاقير فى هذا العلاج على الوجه التالى:
1- يسمح لكل مريض من أول جلسة دون استثناء أن يتناول العقاقير التى كان يتناولها قبل بداية هذا العلاج دون زيادة أو نقصان أو تغيير، على أن يعاد النظر فى الجرعة بعد ذلك أولا بأول اعتبارا من الجلسة التالية وعلى مدار السنة حسب المتغيرات التى ألمحنا إلى بعضهما وقد نفصلها أكثر فيما بعد.
2- لا يهمنا فى البداية عادة إن كانت النتائج الإيجابية قد حدثت نتيجة لهذه العقاقير أو للعلاج الجمعى، فالذى يحدد ذلك هو “نوع النتائج” و”استمرار فاعلية النتيجة”، وليس مجرد النظرة المسطحة للنتائج، واختفاء الأعراض ومجالات المقارنة الإكلينيكية العامة مفتوحة: فعندنا – وعند غيرنا – من يأخذ هذه العقاقير دون هذا العلاج، ونحن نتتبع يومياً طبيعة نتائجهم” ومداها، ونوعها، بخبرتنا الإكلينيكية، دون خدعة ومزاعم الضبط الأعمى والمقارنات السطحية.
3- نتفاهم مع المريض عادة ومنذ البداية عن فكرتنا عن طريقة عمل هذه العقاقير بما فى ذلك التفسير التركيبى التطورى البيولوجى دون استعمال مصطلحات علمية غريبة، لكن بالإشارة إلى عملها الانتقائى على مستويات المخ المتصاعده، وتـُفـَهـَّم أغلب المرضى ما نريد توصيله عادة وتدريجيا، كما يستطيع بعض المرضى أن يقوموا بربط التغيرات الذاتية الخاصة والسلوكية الجارية فى المجموعة وخارجها بجرعة العقاقير المناسبة ونوعها، ويناقشَ ذلك مع المعالج فى كثير من الأحيان.
4- بعد أن تصل هذه الرسائل بوضوح كاف، لا نعود للحديث النظرى عن طريقة عمل العقاقير من جانبنا وإنما نستجيب للتساؤلات حولها، علما بأن كل جلسة تنتهى (فجأة) بإعلان أنه: “آخر خمس دقائق للأسئلة والأدوية“، فإذا سأل أحدهم عن جرعته أو بعض الأعراض الجانبية تمت الإجابة وعمل اللازم.
5- يتعلم المريض حاجته للعقاقير وتناسبها مع طبيعة تفاعله بعد بضعة أسابيع من البداية، وعادة ما يصله أننا قد نستغنى عنها نهائيا إن آجلا أو عاجلا.
6- لاحظنا أن أغلب المرضى – حتى الفصاميين المزمنين – يمكنهم أن يستغنوا عن العقاقير تلقائياً مع تقدم العلاج وتطور مراحله.. دون أن يخل هذا بوظائفهم الفسيولوجية (النوم مثلا) أو النفسية (العلاقاتية مثلا)، وقد يرجع البعض إليها تلقائياً لأيام أو أسابيع وبجرعة أقل، ثم يوقفها ثانية، وقد يخطرنا بذلك أو لا يخطرنا، ولكننا نتتبع آثار كل هذا طول الوقت أولا بأول.
7- تعلمنا من هذه الطريقة التلقائية أنه إذا سمح للنشاط القديم والأعمق للمخ بالتعبير بلغة الواقع، وقوبل بالتقبل من حيث المبدأ دون تشتيت أو انحراف، وبدأت محاولات استيعاب هذا النشاط دوريا مع الإيقاع الجارى، فإن المريض لا يحتاج للعقار الذى يخمده بنفس الجرعة، والعكس صحيح، وهذا التناوب مباشر ويومى ولا يحتاج لما يسمى فترة الكمون حتى يظهر مفعول العقاقير كما تزعم معظم الأبحاث.
8- لا نلجأ أبداً إلى (بل وننهى عن) تعاطى المنومات والمهدئات الخفيفة التى تعمل تسكينا على المستويات الأعلى من المخ.
9- فى بعض الأحيان يقل تعاطى المخدرات والكحول تلقائياً لمن كانوا يتعاطونها، إذ يبدو أن الحاجة إليها هى الأخرى تقل حتى أن المريض قد ينقطع عنها تماماً مع ازدياد التفاعلات واكتشاف الداخل والاعتراف به وتقبله، وللعلم، فلم يكن فى هذه المجموعة ولا مريض واحد يمكن أن يطلق عليه صفة “مدمن”، وعموما فإن الاستغناء عن تعاطى أى عقاقير مساعدة غير الموصوفة فى المجموعة هو من أول خطوات التعاقد الذى يشمل تنظيم التداخل الكيميائى جنبا إلى جنب مع الجارى فى تشكيل الوعى.
10- مع استمرار المناقشات حول العقاقير (تحديدا فى الخمس دقائق الأخيرة المخصصة للأسئلة والأدوية)، يتم التواصل ونحن نحتكم إلى أبسط المحكات التى نحكم بها على الحاجة إلى العقاقير (وهى نفس المقاييس التى توصل إليها المرضى تلقائياً) وهى:
(أ) النوم (7 – 9 ساعات يومياً)، مع متابعة نوع النوم وتوقيته ليلا، وجدواه عن بعد، دون الدخول فى تفاصل الأحلام عادة، مع تجنب النوم نهارا أكثر من نصف ساعة “استثناءً”.
(ب) الانتظام فى العمل اليومى العادى.
(جـ) التواصل المتكافىء مع المحيطين بأية درجة من تبادل التحمل والقدرة على الاستمرار.
فاذا استمر “التمام” على هذه المحكات من جانبنا وجانب المرضى، تـُرِك الأمر لمقياس التناسب العكسى. بين نوع خاص من التفاعل فى المجموعة والجرعة، كما يلى:
11- لاحظنا أن مفعول العقاقير يتغير مع جلسات العلاج ومثال ذلك أن المريض الذى كان لا ينام إلا بجرعة 300 ملجرام لارجا كتيل أو ميليريل قد يكفيه بعد تفاعل ناجح مائة ملجرام أو أقل، ثم إنه مع التقدم فى العلاج قد لا يحتاج إلى هذه العقاقير أصلا، وهذا فى ذاته يؤخذ مؤشرا على نجاح إعادة التنظيم لمستويات الأمخاخ وتناوبها وتكافلها، ومع ذلك فلابد من الحذر من التوقف عن تعاطى العقاقير قبل الآوان، (المحكوم بمحكات استيعاب الطاقة فى العمل والعلاقات، وإيقاعية دورات النوم ونجاحها فى إستعادة الترتيب الطبيعى).
12- لاحظنا أيضاً أن نوع التفاعل فى المجموعة يساهم فى تحديد جرعة العقار، فالتفاعل الكامل المستوعب يتيح تناسقا داخلياً بين مستويات المخ، فلا يدع مجالا لعمل هذه المستويات مستقلا متنافراً فلا يحتاج المريض إلى جرعاته السابقة لتهدئته، وعلى النقيض من ذلك فإن التفاعل المبتور أو الناقص أو السطحى المزيف قد يحتاج لزيادة الجرعة لأن مثل هذه التفاعلات تضغط أكثر على النشاط الداخلى مما يثيره حتى يحتاج معه إلى تهدئة مناسبة، ولكن لفترة محدودة فى العادة.
13- أثناء إجراء هذا البحث بعد عدة أشهر، كان جميع المرضى قد توقفوا تماماً عن تعاطى العقاقير، تلقائياً وبالموافقة الضمنية من المعالج.
14- لم نلجأ فى هذه المجموعة عامة – وأثناء إجراء هذا البحث خاصة، إلى جلسات تنظيم إيقاع الدماغRhythm Restoring Therapy, RRT (الجلسات الكهربائية)، رغم ثقتنا فى هذا العلاج وإيماننا بسلامته وفاعليته وضرورته فى حينه ولغرض محدود ولفترة محدودة، إذا استُعمل من منطلق الإيقاع الحيوى، لاستعادة التشكيل المنتظم([7]) ولكن فى هذه المجموعة، وبعد أن استتبت العلاقة العلاجية فضلنا معايشة الأعراض التى تظهر أولا بأول حتى ولو كانت ضلالات أو هلاوس فقد كنا نفضل أن نستوعبها فى المجموعة، باعتبار أنها نابعة من الجزء المتمم لوجود المريض، وأن هذا العلاج هو مواجهة هذا الجزء واستيعابه وليس تهميده وإخفائه.
ملاحظات ختامية أخرى
بعد هذه الملاحظات الإكلينيكية العامة وانطلاقا من التنظير الموجز السابق حضرتنى هذه الملاحظات التالية وفضلت اثباتها:
1- إن مفعول العقاقير خاصة – والعلاجات العضوية عامة – هو عامل مساعد غالبا وضرورى أحياناً.. مع العلاج الجمعى وخاصة للذهانيين.
2- إن الحاجة إلى العقاقير تمثل مرحلة محدودة فى بداية العلاج ثم تتضاءل الحاجة إليها مع تقدم العلاج.
3- إن العقاقير لا تستعمل كمسكن بديل، ولكنها تستعمل كمنظـِّم لنشاط جزء معين ومستوى معين من مستويات المخ فى وقت يحتاج فيه هذا النشاط إلى التنظيم، حتى يأتى الوقت الذى يمكن استيعاب هذا النشاط الذى استقل استيعابه متناوبا ثم متكاملا فى الكل المفيد.
4- إن هذه العقاقير وخاصة المهدئات العظيمة لا تحتاج لفترة كمون طويلة Latent Period كما أنها ليست ضرورية دائما لمدى طويل كما يوهمنا أصحاب شركات الأدوية، وكما جاء فى كثير من الأبحاث التقليدية.
5- إن مفعول جرعة العقار يتناسب مع درجة النشاط للمخ (المستوى) الذى يعمل عليه العقار انتقائيا، وبالتالى فالجرعة ترتبط مباشرة بتناسب، وتبادل، وتكافل عمل ونشاط، مستويات مخية معينة أو على العكس بتنافر وتنافس وتصارع هذه المستويات كل ذلك مُقاسٌ بالمتابعة الإكلينيكية خاصة فى المجالات “العلاقاتية” مع تتبع إيقاع النوم ونوعية النشاط.
6- إن التوازن الذى يصل إليه المريض بعد فترة من المحاولة والخطأ، وبعد توضيح الأمر له ابتداء، له ميزان دقيق يمكن الاعتماد عليه فى هذا النوع من العلاج، وبالتالى فإن رأى المريض – بعد استتباب العلاقة مع المعالج أو المجموعة – يؤخذ فى الاعتبار بجدية كاملة.
7- إن مهمة الطبيب تشمل شرح وجهة نظره فى توقيت وجرعة العقار حتى ولو لم تمثل الحقيقة النهائية، والمريض – فى هذا العلاج – يساهم فى الحوار حول ضبط الجرعة من خلال ذلك، وهذا يؤكد اختياره الذى يشمل بذلك التدخل الكيميائى.
8- إن المستوى التطورى الذى يثبطه كل عقار (تلو الآخر) وكذلك المستوى التطورى الذى قد يطلق نشاطه كل عقار تلو الآخر، هو من أهم وأخطر المعلومات التى ينبغى أن يلم بها المعالج فى كل لحظة …، ولو على مستوى الفروض العاملة.
وبعد
مع أن كل هذه المسائل والممارسات مازالت فى منطقة الفروض وبالذات من حيث “طريقة الفاعلية Mode of Action”، وهى فروض مبنية على احتمالات كيميائية ملتبسة لكن متناسبة مع الترتيب الهيراركى للأمخاخ، كما أن الفروض التى ننتمى إليها هى التى ترتبط بمفهوم النمو الذى تدور حوله حركية العلاج الجمعى فى إعادة تشكيل المخ، قد أثبتت صحتها جزئيا من واقع النتائج التى تضع فى الاعتبار حركية التشكيلات الجارية فى النفسمراضية التركيبية أثناء العلاج، ومتابعة تغيرها من واقع السلوك وحوارات الوعى الجارى على كل المستويات.
[1] – انظر هامش (16)
[2] – Norman Doidge, M.D. The Brain that Changes It self 2007 Penguin Books.
[3] – كلمة موقع Position تستعملها نظرية العلاقة بالموضوع بمعنى مرحلة من مراحل النمو، وبالرغم من أنها تستعمل كلمات مستقاة من المرض والإمراضية وهى الموقع الشيزيدى، والموقع البارانوى والموقع الاكتئابى Schicoid Position, Paranoid P., Depressive P. إلا أن ذلك لا يعنى أنها تصف مراحل مرضية وإنما هى مراحل نمو تبدأ من الولادة، وما أضفته إليها من خلال “النظرية التطورية الإيقاعية” Evolutionary Rhythmic Theory هو أن هذا التلاحق ليس قاصرا على مرحلة الطفولة، أو على تطور علاقة الطفل بأمه، فهو يتكرر بنفس الترتيب فى كل أزمة نمو، وأيضا فى أزمات الإبداع، وبشكل مرضى (فاشل) فى أزمات المرض، وأنها أطوار تستعاد وتنشط أكثر فى حالة المرض وليست مواقع (يرجع إليها نكوصا) فالحركية الإيقاعية هى دائمة الحدوث! إما للنمو والتطور وإما للنكسة فى الأمراض الدورية الصريحة وما يوازيها، فهى أطوار استعادة باستمرار مع كل نبض حيوى، وليست مواقع جاذبة بالنكوص.
[4] – سنة 1978، ولكن تم استحداث عقاقير!
[5] – Growth Crisis
[6] – Basic Trust
[7]– معنى ذلك أننا قد نلجأ إلى الصدمات (واحدة أو أثنتين فى العادة) إذا لم تكن علاقة المريض قد استتبت بالمجموعة، أو كان بعيداً عن علاج الوسط الحامى، وكان التفاعل الذى انبعث نشطاً أعنف من قدرته فى بداية المواجهة، ويمكن الرجوع إلى استعمال هذا العلاج باعتباره “إعادة تشغيل” للمخ فى ظروف ملائمة تسمح للمخ أن يصحح نفسه، تماما مثل الصدمة الكهربية للقلب أثناء جراحة القلب المفتوح أو مثل:
إعادة تشغيل حاسوب Re-start جيد ليعيد تصحيح نفسه مما أصابه من خلل مؤقت.
أنظر يحيى الرخاوى: مقال “صدمة بالكهرباء..أم ضبط للإيقاع؟” عدد أبريل 1982 – مجلة الإنسان والتطور الفصلية – www.rakhawy.net
الفصل الحادى عشر العوامل العلاجية ورأى يالوم
الفصل الحادى عشر العوامل العلاجية ورأى يالوم
الفصل الحادى عشر: العوامل العلاجية والفروق الثقافية ورأى “يالوم”
“تكاثرت الظباء على خراشٍ، فما يدرى خراش ما يصيد” (وخراش صياد غزلان)، سوف أبدأ اليوم بما نهانى ابنى محمد عن أن أعرج إليه، لكننى قلت أحاول اليوم مع شيخ العلاج الجمعى عمنا “يالوم”، وهو يعرض أول فصل فى كتابه “المختار”([1]) بعنوان جميل يقول بالانجليزية: The Therapeutic Factors What is that heals: والذى قمت بترجمته كما وصل لى العوامل العلاجية: ما هذا الذى يُشْفى؟
وهو يبدأ بمقدمة شديدة الأمانة وصلنى منها أنه يعترف فيها:
- أن العامل الشافى هو أبعد ما يكون عن التحديد،
- وأنه يكاد يستحيل فصل عامل واحد عن بقية العوامل،
- وأن أية محاولة لتحديد عامل بذاته هى محاولة تقريبية، وناقصة غالبا،
لكنه يمضى بعد ذلك فى تحديد متواضع لبعض تلك العوامل، وأعترف أننى استلهمت من العناوين أكثر مما حاولت مناقشة تفاصيل المتن كما أورده، وكأنه يكتب لى شخصيا، وكأنه يسألنى وهل عندكم مثل هذا، فأجيبه من واقع خبرتنا وثقافتنا بما يلى هكذا:
وسوف أبدأ برصد ثبت بقائمة كل ما أورد من عوامل دون إلتزام بمناقشتها جميعاً بنفس الدرجة:
يبدو أنه علىّ أن أحدد نوع العلاج الجمعى الذى أقدمه هنا حتى لا تبدو الفروق التى تظهر من خلال المقارنة مجرد فروق ثقافية، ذلك أننى لاحظت إشارة “يالوم” المتكررة إلى أنواع من العلاج الجمعى مختلفة عن هذا النوع المحدد الذى أمارسه وأصفه، هنا مع عرض الفروق التى تبدو بمثابة اعتراضات وقد لا تكون كذلك، فهو يتكلم عن مجموعات متنوعة من أول مجموعات الإدمان وحتى مجموعات المنحرفين، وعن مجموعات القسم الداخلى، وعن مجموعات اضطرابات الشخصية وعن مجموعات المواجهة، صحيح أنه يركز الكلام على خبرته الشاملة فى أساسيات العلاج الجمعى لكنه يشير بالتزام إلى هذه التنويعات الهامة فى كثير من الأحيان.
ما أعرضه -كما أشرت- هنا هو خلاصة خبرتى شخصياً فى قصر العينى بوجه خاص مع مجموعة من المرضى عبر نصف قرن 1971، 2020 بالإضافة إلى ممارسات مفتوحة فى مستشفى دار المقطم بالصحة النفسية، وممارسات محدودة فى عيادتى الخاصة، فضلا عن رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرفت عليها، والتى أشرت إليها سابقا فأتاحت لى فرصا للدراسة الأعمق، وأنا أحاول توصيل بعض ذلك كما بينت سابقاً.
لكننى وجدت الآن أنه علىّ قبل أن استطرد أن أعيد تحديد أهم ما يمكن أن يفسر الفروق بين خبرتى هذه، وما يقدمه “يالوم” بطريقة مدرسية شبه تقليدية من واقع الخبرة أيضا، ولو فيها بعض الإعادة كما يلى:
أولا: أكرر أن أغلب مرضانا فى هذه المجموعات يعالجون بالمجان (حتى دون دعم شركات تأمين) فى مستشفى حكومى جامعى وأغلبهم من الطبقة الوسطى الدنيا فأدنى.
ثانيا: إن المرضى فى تجربتنا غير متجانسين فى التشخيص (وفى غير ذلك).
ثالثا: إن عدم التجانس يمتد إلى المستوى التعليمى ففيهم الأمى حتى الجامعى وما بينهما.
رابعاً: إن عدم التجانس هذا يمتد أيضا إلى سنوات العمر وإن كنا لاحظنا أننا نعمل أكثر مع منتصف العمر غالبا (20-60).
خامسا: إن المجموعة قد تشمل أحيانا – ولو فى بعض مراحلها- ذهانين فى حالة نشاط، أو إفاقة نسبية، أو بقايا أعراض، كما تشمل غير ذلك من تشخيصات، لذلك فإننا نستعمل العقاقير بطريقة تناقصية مناسبة مساعدة معظم الوقت (الفصل السابق).
وعلى ذلك فإن كثيرا من الملاحظات التى تظهر اختلافات مهمة مع ما أورده “يالوم” قد ترجع إلى هذه الفروق، وليس فقط لاختلاف الثقافات أو لقصور هنا أو هناك.
ثم نبدأ فى مناقشة ما أورده “يالوم” تحت العوامل العلاجية.
(1) زرع الأمل Instillation of Hope
يبدو أن يالوم يعتبر مجرد حضور هذا العلاج دليلا على أن المريض يأمل منه شيئا طيبا، يصله عادة من مريض سابق أو من قراءة عابرة، أو من خبرة شخصية جعلته يبحث عن، أو يأمل فى: “شىء آخر”، و”يالوم” يقرّ أنه يقوم بدور مبدئى فى الحفاظ على هذا الأمل بشكل أو بآخر، وخاصة فى الفترة الأولى…الخ.
الحال عندنا يبدو مثل ذلك من حيث المبدأ، وأنا – مثله – سوف أتكلم أساسا عن المجموعات التى مارست معها هذا العلاج فى قصر العينى بوجه خاص، كما ذكرت سابقا.
فى حين أنه يشير أو حتى يوصى بنوع التحضير لدخول المجموعة، بما يشمل التلويح بالأمل، أو التأكيد عليه من معالج أصغر أو متدربٍ آمِل، أقول فى حين أنه يعطى اهتماما خاصا لمثل هذا التحضير فإننا لا نفعل ذلك تقريبا، فنكتفى بالتوصية بكتابة “ورقة مشاهده” Sheet كاملة لمن نعرض عليه الدخول إلى هذا العلاج، وفيها نجمع المعلومات التقليدية الكافية اللازم رصدها فى أية ورقة مشاهدة عن أى مريض لأى علاج آخر، وعلى الرغم من أن هذا الشرط لا يستوفى دائما بشكل كاف، فإن الافتقار إلى اكتماله لم يعوق مسيرة أى فرد فى المجموعة بشكل خاص، وكان هذا دليلا ضمنيا على كيف يتركز هذا العلاج أساسا فى “هنا والآن” وما يتولّد حالا لينمو!! ومع ذلك فإنى كنت آسف دائما لعدم استكماله، وإن كانت الفرصة كانت تتاح لاستيفاء ما نحتاج إليه من بيانات أثناء مسيرة العلاج خلال سنة كاملة ([2]).
بمجرد أن تبدأ المجموعة لا يجرى الحديث عن “الأمل” فيما يسمى الشفاء بأى قدر من المباشرة أو التشجيع الحماسى، بل إن الرد على من يسأل عن نسبة الأمل فى الشفاء، أو احتمال عودة المرض إذا تم الشفاء، يؤجَّل إلى آخر خمس دقائق([3]) “المخصصة للأسئلة والأدوية”، وحتى فى هذه الخمس دقائق لا يُجاب على مثل هذه الأسئلة بشكل مباشر، وكثيرا ما تكون الإجابات مفتوحة مثل:
– إحنا وشطارتنا.
– آدى احنا حانشوف.
– ربنا يسهل.
– طبعا فيه أمل، بس ده مش وعد، دا حسب نتيجة إللى بنعمله سوّا.
– الأمل موجود مادام ربنا موجود (ليس بالمعنى التقليدى أو الاغترابى).
– ده مش العلاج الوحيد على كل حال، وانت حر (خاصة ونحن نعمل فى مؤسسة علاجيه تعليمية بها كل أنواع العلاج دون استثناء).
– أديك حاتشوف بنفسك.
– واحدة واحدة على قد ما نشوف، وأدى احنا بنكمّـل.
ولا أعرف تحديدا ما فائدة ذلك، لكننى لاحظت أن هذه الإجابات ومثلها ترسل رسالة للمرضى أن ما يفعله معنا، وما نفعله “معا“: هو الذى يجيب على مثل هذا السؤال وليس التلويح بالأمل بالألفاظ، ثم إننا لا نقيس الأمل بإقراره من جانب المريض أو بتأكيده من جانب المعالج (أو المعالجين) وإنما بالانتظام فى الحضور، والالتزام بالقواعد، ومدى التحمل، ونوع قفزات أو لمحات التغيير.
ويختلف تناول موضوع الأمل “كعامل فاعل فى العلاج” باختلاف نوع المجموعة طبعا، فمجموعات الإدمان، أو مجموعات اضطرابات الشخصية، غير المجموعات غير المتجانسة من المرضى التى هى مجال ممارستى واختيارى الأول، وهى التى سوف يقتصر حديثى عنها كما أشرت سابقا، وهى مجموعات تمثل شريحة اجتماعية متوسطة أو متوسطة دنيا أو دون المتوسطة تعالج بالمجان([4]).
ومع تقدم عمر المجموعة، فإنها لا تعود إلى هذا السؤال عن الأمل المتوقع عادة، وقد لاحظنا أن المرضى يعزفون عن طرح هذا السؤال تلقائيا، وأن المعالج يصبح أقل استعدادا للتطرق إلى الإجابة عليه، ويرجع ذلك عادة إلى أن أغلب أفراد المجموعة يكونون قد تلقوا إجابات عملية ضمنية كافية من واقع مسيرة العلاج، كما أنهم يكونون قد ألفوا بشكل واضح التعامل من خلال مبدأ “هنا والآن“، وهذا المبدأ يستبعد الحديث عن الأمل بشكل مباشر تلقائيا، لأن الأمل – مهما لاح- هو أمر يتعلق بالمستقبل الذى لا يحضر “هنا والآن” بشكل مباشر محدد.
وقد نعود إلى الحديث عن الأمل بالنسبة لأفراد معينين فى أوقات بذاتها أورد بعضها فيما يلى:
(أ) حين يبدو وكأن حالة المريض تسوء (ظاهريا على الأقل)، فتظهر أعراض جديدة ضد الشائع عن العلاج النفسى عموما، ويتردد مباشرة، أو ضمناً، أن المفروض فى العلاج أنه “يريّح العيان”، أقول إنه من الطبيعى أنه حين يجد المريض نفسه يتألم أكثر، وهو يتحرك أصعب، فإن السؤال عن الأمل يكون طبيعيا، والرد ينبغى أن يكون موضوعيا مُطَمْئِنًا نسبيا.
(ب) فى أوقات “المرور فى المأزق” (المشى على الصراط) ([5]) “المرور فى النار” Passing into Fire، وهى أوقات سنرجع إليها فى حينها بالتفصيل يحتاج المريض فى هذه الأوقات أن يطمئن إلى أنه يمشى فى الطريق الصحيح حتى يتحمل آلام المأزق ولا يتعجّل فى الحكم على الموقف بالسلبية أو يسارع بالهرب إلى مايشبه الصحة Flight into health ، فيرتد إلى ما قبل المأزق.
(جـ) فى أوقات التحسن المرحلى سواء بعد المأزق، أو بدونه، فإن المريض قد يفرح بهذه النقلة النوعية وبالتالى يقفز إليه السؤال، هل هناك أمل فى أن يستمر فى نوعية هذه النقلة الجديدة أم أنها خدعة مؤقتة، ويتوجه الحوار أيضا فى اتجاه تدعيم الاستمرار والسعى إلى الأحسن (بعد استبعاد آلية (ميكانزم) الهرب فى الصحة Flight into health.
وفى جميع هذه الأحوال يلتزم المعالج بنفس الالتزامات السابق التوصية بها، ولا يجيب عن التساؤلات بشكل مباشر، بل إنه يكون قد حصل على نتائج ودلائل عملية من واقع الممارسة الجارية سواء عن المريض المتسائل أو مع غيره، أو فى المجموعة ككل، تجيب نيابة عنه بشكل عملى، “وهنا والآن”.
ثم إن هذا التحريك للتساؤل عن الأمل، والحاجة إلى تدعيمه – كعامل علاجى كما يرى “يالوم” – قد يقفز فى مستوى ما من الوعى عند أى فرد من أفراد المجموعة حتى لو لم يمر بهذه الاحتمالات أو مثلها، لأنه يتصور نفسه فى موقع زميله المريض الذى زادت آلامه، أو ظهرت أعراض جديدة عليه أو وهو يمر بمأزق علاجىّ صعب، وبالتالى قد يقفز داخله متسائلا وماذا لو جاء علىّ الدور؟ إلى أى مدى سوف احتمل مثل ذلك إن لم يصلنى أمل فى نتيجة مؤكدة تبرر كل هذا أو تخففه:
كل هذا عن الأمل وكيفية تناول إثارته فى المجموعة، وكل تحفظاتنا هذه هى نتيجة التخوف من التأكيد على الأمل “عاملا علاجيا” ضروريا (بنص تعبير يالوم) حتى لا يصبح عاملا معطـِّلا إذا أبـْعـَـدَنـَا عن “هنا والآن” حتى لو كان الحوار يجرى بلغة مثالية أو قيمية مثل أن يتكلم البعض ولو بدون قصد ظاهر عن قيم مثل “النمو” و”التطور” و”الحرية” و”الإيثار” ومثل هذا الكلام الذى يبعدنا عادة – ككلام وليس كموقف – عن “هنا الآن” وقد يوقعنا فى أوهام مثالية تجعل الإحباط أقرب والبعد عن الواقع أكثر احتمالا.
فى خبرتنا كم لاحظت أن الحديث عن الأمل يمكن تناوله بشكل غير مباشر باختباره فى “هنا والآن” وذلك مقارنة بإدراك (وليس بفهم أو اقتناع) ما يحدث مثلا فى الأجزاء شديدة القصر من الموقف أثناء المسيرة .
ثم إن “يالوم” لم يذكر بشكل محدد التفرقة الواجبة بين “الأمل الجاهز” أو “الأمل المنطقى المعقلن” أو “الأمل المصنوع” من خلال الممارسة والتفاعل و”الأمل الواقعى” و”الأمل القاصر على الفرد” و”الأمل الممتد للجماعة” و”الأمل الممتد خارج الجماعة” (ناهيك عن الأمل الممتد إلى كل الناس ومابعد الناس) مع أن كل ذلك بدا لى كأنواع وتجليات فى تبادل ومراحل تساهم فى تحديد موقع ومرحلة الأفراد (أيضا موقع المجموعة وقد أعود إليها) وهى أنواع وتجليات تساعد فى معايشة معنى الأمل واقعا فى التكوين وليس أمنية فى الانتظار.
(2) الشمولية Universality
يبدأ “يالوم” هنا بالتذكرة بأن كل مريض (كل شخص) عنده فكرة فى عمقٍ ما من تركيبه بأنه ليس كمثله أحد فيما يعانيه، وأن حالته فريدة فى نوعها، ويقول “يالوم” أن هذه الفكرة تهتز بمجرد مشاركة المريض مع مجموعة من المرضى، إذ يكتشف أنه مثله مثل كثيرين، ولو اختلفت التفاصيل، وأيضا يتبين أن هناك من يراه (أو يرى حالته) مثلما يرى هو حالتهم، ويعتبر “يالوم” أن هذا فى حد ذاته باعث لنوع من التهدئه أو الطمأنة، حين يكتشف المريض وجه الشبه فى بعض المناطق، واحتمال الألفه فى بعض التفاعلات، وأن أفراد الجماعة يركبون نفس الزورق على حد تعبيرهwe are in the same boat ، وأن البؤس يحب الونس، Misery loves company، بل إنه يقول إن وجه الشبه يمتد بحيث يكتشف المشارك أن مساحة التشابة بين كل الناس أوسع بكثير مما كان يتصور.
أورد “يالوم” تجربة أجراها حين وزع ورقة على أعضاء مجموعةٍ ما، وطلب أن يكتب كل منهم – دون ذكر اسمه- عن ما هو العامل “السرى” الأهم الذى يصعب عليه إعلانه ويرى أنه يعرقل ولو نسبيا المشاركة فى المجموعة، واكتشف أن هناك وجه شبه بين كثير من الاستجابات، وقد وجد عاملين على قائمة الاستجابات هما “الشعور بعدم الكفاءة“، و”صعوبة عمل العلاقة اغترابا“، بمعنى أنه بالرغم من ظاهر التواصل فإنه يصل للكثيرين أن أحدا لا يهتم بالآخر فى واقع الأمر. ثم أشار إلى بعض الصعوبات الخاصة التى تحول دون تنشيط عامل الشمولية (فالتماثل)، ومنها الفروق الثقافية الفرعية (ولم يذكر اختلاف الدين) وإن كان قد ذكر بعض الانحرافات الجنسية.
فى خبرتنا الخاصة لم يكن الأمر كذلك تماما وفيما يلى بعض الملاحظات:
أولا: نحن لا نشجع، ولا حتى فى البداية، فرط الحديث عن كشف ما بالداخل!!، وكلما ذكر أحدهم أنه هنا “عشان أطلّع اللى جوايا” تكون إجابتنا غالبا، لا ليس تماما الآن هكذا، دع ما بالداخل بالداخل حالياً، وسوف يصبح حاضرا “هنا والآن” فى الوقت المناسب. (وسنأتى إلى هذه النقطة عند الحديث عن العامل العلاجى المسمى “التفريغ” غالبا) وعادة ما يقاوم المرضى بشدة هذا النوع من المنع، فنؤكد أن هذا مـُـتـَـضـَـمـَّـن فى الاتفاق العلاجى الأساسى الذى يشترط اتباع قواعد المجموعة وخاصة مبدأ “أنا أنت” “هنا والآن”، وأننا حين نمارس حضورنا الجاهز “هنا والآن” (كما يظهر خارجنا) فإنه سيجرجر ما بداخلنا وينشطه فى حدود ما يمكن تغييره غالبا، وبالتالى لا تأتى فرص المشاركة لتحقيق مبدأ الشمولية كما ذكره “يالوم” إلا من خلال ما يجرى “هنا والآن”، بين من هو “أنا أنت” ليس للتماثل، وإنما لحوار الوعى البينشخصى (ثم الوعى الجمعى).
من هنا نحن نحاول الإقلال حتى النهْى عن استعمال ألفاظ التعميم مثل “الناس” “أصلنا.. كـُـُلنا” “الواحد”…الخ.
ثانياً: كثير من المشاركين، وخاصة فى الجلسات الأولى يمدح فكرة العلاج مستعملاً المثل القائل: “من شاف بلاوى الناس هانت عليه بلوته”، وأنا شخصياً أفزع من هذا الموقف الذى يمثله هذا المثل حتى أكاد أنهر قائله، إلا أن نكون فى بداية البداية، فأتراجع، وأكتفى بالرفض مذكرا المستشهد بهذا المثل أنه مثل يتسم برائحة الشفقة بل لعل فيه قدر من الشماته: اللاشعورية على الأقل، وأنبهه أن ما تقدمه المجموعة هو أنه: “من شاف بلاوى الناس زادت عليه بلوته”، بمعنى: أنه إذا تخلى الشخص عن موقف الحكم الفوقى والشفقة الجاهزة، فإنه سيحمل هم بلوته شخصيا، جنبا إلى جنب مع بلوة غيره، فيزيد الحمل، ليخف عنهما معا بالمشاركة بطريقة أخرى نتعلمها معا فى المجموعة، وقد يجرنا هذا إلى التفرقة بين “زعلان عليه” (يا عينى! يا حرام!) وزعلان “معاه” مشاركا شاعراً بمشاعره (المواجدةEmpathy)، والأهم: شاعرا بمشاعر نفسه القريبة من مشاعر المتألم، وقد يسأل أحدهم أحياناً هذا المشارك: انت حزين معاه يعنى شايف حزنه، ولا سمحت لحزنك انت إنه يقرّب، فقرّبت منه”، وكثيرا ما تأتى الإجابة ولو فى فترة متأخرة من نمو المجموعة، بأن حزن زميله شجعه أن يسمح لحزنه أن يقترب من نفسه، فيتقاربا. هذا المعنى يختلف فى عمق المستوى عن المعنى الذى أورده “يالوم” تحت عنوان “الشمولية”، من حيث أن هذا النوع من الشمولية الأعمق ينقلنا إلى عمق التشابه بيننا وبين بعضنا ليس فقط فيما نكتمه من أسرار، أو ما نعانى منه من شعور بعدم الكفاءة، وإنما هو يرجعنا إلى درجة من الوعى بالطبيعة المشتركة للبشر كافة، وخاصة الحقوق المنسية أو المنكرة مثل حق الحزن، أو حق الغضب، أو حتى حق الحقد، ونحن نتعامل مع هذه الطبيعة البشرية بالاعتراف والرؤية والقبول ابتداءً، ثم نرى ماذا يمكن أن نتصرف فيما نسميه “خـِلقةْ ربنا”، ونعنى بذلك أصل الطبيعة البشرية عادة دون أى معنى دينى ضيق.
وأيضا عن “الشمولية” نحن عادة نتخطى – دون نسيان- مستوى تشابه مشكلات، أو مشاعر، أو تشابه داخل المرضى بعضهم ببعض إلى التشابه بين المرضى والأسوياء بما فى ذلك المعالجين بدءًا بالمدَرِّب (المعالج الرئيسى) إلى المتدربيين (فالمعالجين المشاركين) وكثيرا ما ينبه المعالج الرئيسى المعالج المساعد إلى الالتفات إلى التفرقة بين مشاعر المشاركة (المواجدة Empathy) ومشاعر الاعتمادية، ولهذا جذوره فى ثقافتنا الشعبية، يقول الموال المصرى:
صاحبت صـاحب وقلت فْ يوم يشيل حـِمْــلي
جــاب حـِمـْلـــه التقيـــل وحطــُّـه على حـِمْــلي
لفـِّـيت جميع البلاد على صاحب يشيل حـِمْــلي
وتـْعبــت وشْـــــــقيت، لــكن بـــدون فـــــايدة
واللى اشتكيلـُهْ يقولـِّى: وَنـَا مين يشيل حـِملي
هذا موقف أصدق من المثل: من شاف بلاوى الناس، هانت عليه بلوته، بل هو أيضا أقرب إلى المثل المقترح!! “من شاف بلاوى الناس زادت عليه بلوته”
وهو لا يقرّ حقيقة بل هو يتضمن نهيا أخلاقيا عن المشاركة السطحية لاستغراق كل واحد فى ذاته.
مشاعر الشفقة Sympathy لاتخلو – ولو فى السر- من الفوقية والحُكمية أيضا”، وفى حدود الاتفاق المبدئى فى التدريب وحق المتدرب أن يعتذر فى البداية وللفترة التى يراها تناسبه متى شاء إذا رأى أن جرعة التفاعل أكبر من احتماله، لكنه لا يسمح للقائد بهذا الاستثناء، وما يسرى على أى مريض مشارك يسرى عليه، ([6])، وليس من حقه أن يعتذر عن المشاركة.
إن الكشف عن وجه الشبه بين السليم والمريض، وبين المعالج والمتعالج، سواء فى تفاعل مشترك أو فى لعبة يمارسها الجميع واحدة واحدة، يفيد كثيرا فى تأكيد مبدأ الشمولية، ليس فقط شمولية المعاناة والأعراض وإنما شمولية الطبيعة البشرية والآلام العامة والفرحة الأساسية (دون أسباب) والمعالج يستجيب لتداخلات المرضى أو ملاحظات المساعدين (أو المتدربيين) ومثل ذلك يسرى على المتدرب بعد انتهاء مرحلة الأمان (حق استعمال النور الأحمر= حق الاعتذار عن المشاركة الآن:) التى يحددها المتدرب بنفسه دون شروط ودون ضغط من المدرب (المعالج الرئيسى).
رابعا: لم تتح لى (لنا) الفرصة لمشاركة من يمثل ثقافة فرعيه دينية من الأقليه المسيحية اللهم إلا مع عدد محدود من المتدربين والمتدربات، فكانت الفرصة ضيقة لتجاوز الحواجز الفاصلة (خاصة اللاشعورية) فى مثل هذه الأحوال، وكثيرا ما وصلنا، حتى من خلال التمثيل أو الإشارات غير المباشرة إلى نوع من قبول الشمولية المرتبطة بحضور الله معنا دون تمييز (ليس من منطلق ما يسمى الروحانية، ولا الزعم السطحى “بقبول الآخر”) وكان هذا الحضور يتجسد بحيث يجمعنا شموليا بغض النظر عن الفروق الثقافية الدينية الأساسية والفرعية .
إلا أن الفرصة أتيحت أكثر ونحن نمارس اختراق الفروق الثقافية الفرعية المرتبطة بنوع ودرجة التدين الفرعى الذى يظهر إما فى شكل الملبس (النقاب) أو المظهر (اللحية)، ويشترط على المنتقبه أن تظهر وجهها أثناء الجلسه فحسب وإذا رفضت نعتذر عن السماح لها بالمشاركة فى المجموعة أصلا، ونفسر لها ذلك بأننا نتواصل عبر قنوات متعددة، من أهمها تعبيرات الوجه، لكن من حق المنتقبة أن ترتدى النقاب قبل بداية الجلسة وبعد نهايتها مباشرة.
خامساً: أفادت الشمولية -من حيث المبدأ- أيضا فى التقريب بين أفراد المجموعة فيما يتعلق بالأعراض أو بالحقوق والمشاعر وقد امتد ذلك إلى توحيد العلاقة بالعامل المشترك الأعظم الذى اسميته “الوعى الجمعى للمجموعة” الممتد تلقائيا إلى الوعى الجماعى للمجتمع (ثم للكون إلى وجه الله كما اعتدنا أن نستعمل مثل هذا التعبير بين الحين والحين كما ذكرنا وسنذكر) فَتتُجَاوز بذلك الفروق الفردية فى درجة الالتزام الدينى وحتى الفروق بين الأديان، دون الاختباء وراء زعم التسامح السلوكى الظاهر الذى لا يمس جوهر التمييز الخفى.
سادساً: لاحظنا ايضا من البداية أن الفروق الطبقية (غير موجودة بأية درجة واضحة فى هذه المجموعات، حيث العلاج بالمجان كما ذكرنا، فالطبقات الفرعية متقاربه، والفروق الثقافية والتعليمية محودة نسبياً.
سابعاً: ساعد كثيرا فى كسر الحواجز، والتأكيد على فكرة الشموليه وفائدتها إلزام المعالج الرئيسى (المدرب) بأن تسرى عليه كل قواعد المجموعة بما فى ذلك كما ذكرنا – عدم قبول اعتذاره عن المشاركة مثله مثل أى مريض متى طلب منه ذلك (ليس من حقه استعمال النور الأحمر مثل المتدرب)، وقد ساعدت الألعاب بالذات فى تسهيل إظهار هذه الشمولية وكذلك الطبيعة المشتركه وخاصة الألعاب التى فيها إحراج وكشف عن الطبيعة البشرية بشكل محرج وأحيانا بالغ الإحراج، لكن القائد أو المدرب يلعب أخر فرد خشيه أن يظن بعض أفراد المجموعة أن استجابته هى الاستجابه النموذجية أو المطلوبة: فيقلدها.
ثامناً: امتد تأثير عامل “الشمولية” إلى دائرة الحضور للمشاهدة – وليس للفرجة- والمشاركة فى المناقشة بعد الجلسة، وهى دائرة أغنتنا عن فكرة الجلوس فى حجرة مشاهدة مستقلة لا تسمح بالرؤية إلا من جانب واحد – برغم أنها موجودة وجاهزة – لكننا رفضنا فكرة المشاهدة فى السرّ، وأكدنا – بعد أخذ موافقة المرضى من البداية- أن فرص المشاهدة المتبادلة علانية قائمة، علما بأن الدائرة الكبيرة تضم من عشرة إلى أكثر من ثلاثين مشاهدا متعلما مناقشا بعد الجلسة، فى حين أن دائرة العلاج الجمعى تضم من 8 إلى 12 مشاركا ما بين معالج ومريض (كما ذكرنا سالفا)، ولا يسمح للدائرة الأكبر بالمشاركة ولا بحرف واحد أثناء التسعين الدقيقة المخصصة للجلسة العلاجية، لكن يسمح لمن شاء منهم بالمشاركة فى المناقشة مع المعالجين بقيادة المعالج الأكبر (المدرب) وذلك بعد انصراف جميع المرضى، وتستمر المناقشة لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا.
وقد لاحظت أن دائرة المشاهدين تحترم الجارى فى صمت مطلق حسب التعليمات، لكن الحضور فى هذه الدائرة للمشاهدة تشارك فى المناقشة كما ذكرنا بعد انتهاء الجلسة، وقد أقر كثير منهم بكسر الحاجز وممارسة المشاركة الصامته من بعيد مع ما يجرى فى المجموعة، وبتقمص بعض المتفاعلين من المرضى خاصة بوعى أو بنصف وعى، بما يدعم رأى “يالوم” فى فاعلية المشاركة، حتى يكاد يقترب الحضور فى الدائرتين من المشاركة فى تشكيل الوعى الجمعى الذى يتكون من تفاعلات دائرة المجموعة، والذى يبدو أنه يمتد إلى دائرة المشاهدة، وأثناء المناقشة بعد انتهاء وقت المجموعة، يجيب المعالج الرئيسى أساسا على أسئلة المشاهدين ([7])، وأيضا يتبادل فيها المناقشون الآراء مع بعضهم البعض لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين دقيقة عادة.
وبعد
الشمولية خاصة بالمعنى الذى أورده “يالوم”، ظاهرة تحدث تلقائيا، وهى تعتبر من أساسيات حركية العلاج الجمعى، تماما مثل زرع “الأمل”، أما أنها عامل علاجى فهذا ما يحتاج وقفة متأنية ونظرة أعمق، فمن وجهة نظرنا هى تبدو كنتيجة للمسار الصحيح للعلاج، لكن علينا أن نتذكر أن الشمولية الإيجابية لا تحل محل التفرد أبدا، ففى الوقت الذى يحتاج المريض مثله مثل أى شخص أن يشعر أنه “مثله مثل غيره” هو يحتاج جدا أن يعرف أنه “ليس كمثله أحد تماما”، تمييزا وليس بالضرورة تفوقا، ولا معاناة.
(3) نقل المعلومات Imparting Information (مازلنا مع يالوم)
لا أعرف كيف وضع “يالوم” هذا العامل فى هذا الترتيب المتقدم وإن كنت غير متأكد إن كان الترتيب يعنى عنده الأهمية النسبية أم لا، وإذا كنت قد اختلفت معه – مع الاعتراف بفضله – فيما يتعلق بعامل “زرع الأمل” وإلى درجة أقل حول عامل “الشمولية”، وهما العامل الأول والثانى بدرجة ما فإن الاختلاف يشتد إزاء هذا العامل الثالث بوجه خاص.
ابتداء لا شك أن أى علاج نفسى من أى نوع كان، فرديا أو سلوكيا أو معرفيا أو جماعيا أو غيره هو نوع من التعليم، ويدرج “يالوم” هنا ما يشبه التعليم النفسى Psycho education حيث تصل إلى المشاركين بطريق مباشر أو غير مباشر معلومات موضوعية عن الصحة النفسية وبعض الديناميات التى تفسر بعض السلوكيات، وربما الأعراض، وكذلك تصلهم بعض التعلميات والتوجيهات من المعالج أساسا، وهو يقر أن معظم المرضى يعقبون بعد تفاعلاتهم فى خبرة العلاج الجمعى أنهم أصبحوا أكثر فهما للوظائف النفسية، أو لمعنى الأعراض وبعض ديناميات التواصل وآليات العلاج، وهو يقر أن معظم مثل هذه المعلومات تصل بطريق غير مباشر وإن كان قد أشار إلى أن بعض أنواع العلاج الجمعى قد خصصت جزءًا (أو مرحلة) من العلاج للتثقيف النفسى المباشر، وقد أعطى أمثلة خاصة عن جماعات العلاج الذاتى Self Group كما أن البعض الآخر استعمل بعض وسائل العلاج المعرفى لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الذات أو عن العالم، أو استعمل بعض وسائل العلاج السلوكى وتدريبات الاسترخاء وما شابه، على أن الكلمة التى استعملها بالانجليزية وهى Imparting information لا تعنى بالضرورة “تعليم أو تلقين”، وإنما تعنى “نقل المعلومات، وهى تعبير أكثر سلاسة ودعوة للمشاركة.
وهو عموما يرى أن تفسير الظاهر هو خطوة نحو التحكم فى الأداء، وقد نبه إلى أن أسلوب النصح، وكثرة الينبغينّات (ينبغى أن..)، واللوم المرشد أحيانا: كل ذلك قد يشير إلى أن المجموعة ما زالت فى البداية، وكلما امتد عمرها قلّ مثل ذلك، كما يقول إن المهم فى النصيحة هو أن تخدم “طريقة تناول أمر ما” وليس “محتواها”، وهذا جيد، وهو ينبه أيضا إلى أن المريض طالب النصح ليس بالضرورة يطلبه لينفذه، بل إنه أحيانا قد يطلب ذلك ليثبت عدم جدواه، وكأنه يمارس لعبة “نعم…ولكن”([8])، وعلى الناحية الأخرى نبه “يالوم” على أن هناك من هو جاهز بالنصائح للآخرين معظم الوقت، وأخيرا أشار أيضا إلى من يرفض قبول النصح من حيث المبدأ طول الوقت.
وأخيرا أشار إلى نوعيات من العلاج الجمعى الإرشادى أساساً الملئ بهذا العامل الارشادى بشكل أمر مباشرة مثل اجتماعات القاعات بالمستشفى الداخلى وبعض برامج التأهيل الدينامية والشخصية.
من واقع خبرتنا بالنسبة لنقل المعلومات المناسبة:
أولاً: على الرغم من أن المستوى الثقافى التعليمى لكل هذه المجموعات التى نتكلم عنها فى تجربتنا هو مستوى شديد التواضع بما فى ذلك الثقافة النفسية والتحليلية، إلا أننا اعتبرنا ذلك مزية أكثر منها أمرا معطلا، لأننا لم نكن نحتاج إلى تصحيح أو تعليم لمحو ما لا يتفق مع مسيرتنا وخاصة مسألة “فك العقد”، و”تحليل الرموز” والكلام عن الأسباب والعقد بما يصل أحيانا إلى مستوى التبرير.
ثانياً: أعفانا التركيز الشديد على “هنا والآن” من الثقة فى جدوى النصائح عموما لأن أغلب النصائح غير قابلة للتطبيق – أو حتى للاختبار – فى “هنا والآن”.
ثالثاً: أدخلنا شرطا نسبيا لكنه أصبح لحوحا بالممارسة، مع أنه صعّب علينا التفاعل بشكل أو بآخر، وهو أن ننبه المتفاعلين “فى هنا والآن” أن يجرى الحوار “من غير سؤال ولا نصيحة“ وكانت الصعوبة فوق الوصف حتى على المعالجين أنفسهم إذ كيف يجرى تفاعل أو حوار هكذا، وقد لاحظنا أنه حتى لو نجح المريض أن يتجنب النصائح أو يخفف منها، فإنه لا يستطيع عادة أن يتجنب السؤال، فنخفف من الشرط ونعتبر السؤال “فتح كلام” على شرط ألا يتمادى صاحبه فيصبح بمثابة التحقيق.
رابعاً: لا نذكر عادة أية تسمية للتشخيص أو حتى للأعراض ولو على المستوى الوصفى إلا بمقدار ما نحتاجه لتفعيل بعض آثارها فى التفاعل هنا والآن، وهذا نادر، وعادة معطل.
خامساً: لا يتطرق التفاعل أو الحوارإلى العلّية (الأسباب) إلا نادرا، فإذا حدث فإنه لا يتاح له إلا وقت قصير جدا، وربما يسمح ذلك باستعمال هذه الذكريات العلّيه فى الدراما القصيرة (المينى دراما) أو استلهام لعبة مناسبة منه.
سادساً: لا يقدم المعالج تفسيرا إمراضيا (سيكوباثولوجيا) بأية صورة مباشرة أثناء الجلسة، وإن كان بعض المرضى وأحيانا المتدربين يعرج أحيانا إلى التساؤل حول معنى هذا الموقف أو ذاك، لكننى اعتدت أن أتجنب المناقشة أو حتى الموافقة، وأنتقل بسرعة إلى: “إذن ماذا؟” حتى لو صح هذا الفرض السيكوباثولوجى أو ذاك، ولم ألاحظ أية مقاومة شديدة اللهم إلا من بعض الأفراد الجاهزين من قبل الإلتحاق بالمجموعة، بمفاهيم التحليل النفسى بما يشمل، فك العقد و”التنفيث” و”اطلـّـع اللى جوايا”، الامر الذى سرعان ما نتجاوزه بالنقلة إلى “إذن ماذا”؟ كما ذكرنا
لكن فى المناقشة بعد انتهاء الجلسة مع الدائرة الكبيرة كانت تطرح احتمالات تفسيرات إمراضية (سيكوباثولوجية) وليست بالضرورة عـِلّية (سببية) بالنسبة لما جرى فى هذه الجلسة بوجه خاص وإلى درجة أقل بالنسبة لمريض بذاته أو حدث بذاته يمر به فرد من المجموعة (المأزق مثلا) أو المجموعة ككل (مثلا: غلبة المقاومة أو الصمت) وكان يتم شرح وجهة نظر قائد المجموعة المدرب فى حدود التعليم أثناء المناقشة بعد الجلسة على شرط ربط التفسير بالتدريب ما أمكن ذلك.
سابعا: لابد هنا من توضيح تعدد الأهداف فى هذه المجموعة بوجه خاص: فأنا أعلن من البداية للمرضى والمتدربين والمشاهدين (الدائرة الأكبر) أننى أخدم ثلاثة أهداف فى نفس الوقت وأننى أحاول أن أوفق بين متطلباتهم بما يخدم الغرض من هذه الممارسة الخاصة.
الهدف الأول: هو علاج المرضى
الهدف الثانى: هو الكشف بما يشبه البحث العلمى دون إعاقة لسير العلاج لما هو نفسامراضية (سيكوباثولوجيا) بشكل انتقائى حسب ما يتاح على مدار مدة المجموعة.
الهدف الثالث: تدريب المساعدين الأصغر على ممارسة فنيات هذا العلاج.
وعادة لا يوجد تعارض ولا حتى تنافس بين هذه الأهداف الثلاثة – اللهم إلا داخل نفسى: مَنْ إدرانى – لكن يبدو أن التزامى بهذا الترتيب هو الذى جعل طرح إعطاء معلومات نفسية أو دينامية أو سيكلوباثولوجية بصفة عامة لا يفسد مسار العلاج أو التدريب.
ثامنا: لاحظنا أن بعض المرضى لمن أتيحت له فرصة قراءة متوسطة، أو خبرة علاج نفسى سابقة فرديا أو جمعيا، قد ينبرى بإعطاء تفسيرات إمراضية نفسية (سيكوباثولوجية تحليلنفسية)([9]) وعادة ما يبدو ذلك غريبا حتى أنه يـُـرفض من المرضى قبل المعالجين، ليس بالضرورة لأنه يعطى تفسيرا خاطئا، وإنما لأن المعالجين يعزفون عن ذلك، ولأسباب علاجية تصل إلى المرضى بشكل واضح، وقد يتمادى مثل هذا الشخص حتى يستحق الوصف الذى صكّـه بعض المعالجين “يلعب طب نفسى” Playing Psychiatry.
تاسعا: أورد “يالوم” ضمن المعلومات التى قد يوصلها إلى المرضى بإرشادات محددة، وهذه لا نعتبرها “معلومات” ولكن نعتبرها “تعليمات”، وهى عادة ما تكون ضمن شروط التعاقد منذا البداية مما لا يحتاج الأمر معه إلى التكرار، وأهم مثال لذلك أن يكون لكل مشترك فى المجموعة عملا ملزما([10])، فإن لم يكن الأمر كذلك فى البداية، يذكـّر به بين الحين والحين وربما – فى بعض الحالات – يصبح إلزاما كشرط لاستمراره فى مواصلة العلاج، وتعتبر الدراسة المنتظمة عملا، كذلك العمل كربة منزل، ولا يشترط عمل بذاته، أو فى تخصص معين ولكننا نعرّف العمل بأنه: (1) “ساعة” عدد محدد من الساعات يا حبذا فى نفس التوقيت اليومى، و(2)”رئيس” و(3)”عائد”، و(4)”ناتج”، و(5)”مجتمع”، فنحن لا نوصى (وأحيانا لا نقبل) أن يقتصر العمل على الترجمة مثلا فى المنزل أو القيام بحسابات معينة يقدمها الشخص لشركته أو رئيسه وهو جالس فى منزله طول الوقت، فمثل هذا العمل ليس فيه زملاء يمثلون مجتمع العمل! وكل هذا ليس معلومات وإنما “تعليمات” وإن كان “يالوم” قد أشار إليها – دون ذكر العمل بالذات، كذلك يعتبر من أهم المعلومات والتعليمات ما يتعلق بالعقاقير خاصة وأن أكثر من نصف المجموعة عادة من الذهانيين (حاليين أو سابقيين) يتعاطون مضادات للذهان أثناء العلاج، لكننا لا نتحدث فى جرعة العقاقير التى عادة ما تتناقص مع تقدم العلاج، إلا فى آخر خمس دقائق فى كل جلسة أى من الدقيقة 86 إلى الدقيقة 90 وهى الدقائق المخصصة “للأسئلة والأدوية”، وفى هذه الخمس دقائق قد يسأل المريض عن الأعراض الجانبية لعقار يتعاطاه، أو عن مشاعر أو أحاسيس ظهرت أو اختفت بعد تعاطى عقار معين أو أى سؤال بعيد عن “هنا والآن”!
وبعد
فبالنسبة لموقع ما ذكره “يالوم” من أن هذه المعلومات الجاهزة للتعلـّـم هى “عامل علاجى” ضمن ما عـَّدَد من عوامل علاجية أخرى، فنحن لا نستطيع ضمها هكذا ببساطة فى موضع متقدم من العوامل العلاجية، بل وغالبا نعتبرها ناتجا جانبيا غير مباشر لمواصلة العلاج، مع التركيز على التخفيف من المباشرة التفسيرية والتعليمية والنصائحية لصالح النقلة المعرفية والموضوعية بالانتقال:
(1) من: الماضى إلى الحاضر،
(2) من: “لماذا” إلى “إذن ماذا”،
(3) من: المعلومة إلى تفعيلها وجدواها،
(4) من: الإرشاد إلى قياس عائده أولا بأول ما أمكن ذلك.
(4) الإيثـار (الغيرية) Altruism “يالوم”
تعجبتُ من طريقة حديث “يالوم” عن الإيثار كعامل علاجى، وقد كان عجبى ليس نتيجة لرفضى أن يكون كذلك، ولكن لكيفية تقديم “يالوم” هذه القيمة العلاجية بشكل أقرب إلى المباشرة، وصلتنى وكأنها قيمة “أخلاقية” “إيجابية” “مفيدة”، ثم عذرته فما الكتابة كالممارسة، وهأنذا أعانى من نفس الموقف الذى لا أعرف له حلا، وفى محاولة اختراق مقاومتى وقصورى أقول:
أشار “يالوم” – بتعميم لم أفهمه- أن المرضى النفسيين يشعرون بشعور عميق بأنه ليس لديهم ما يعطونه للغير، ثم راح يعدد كيف أن ممارسة العطاء من خلال التفاعل فى هذا العلاج تفيد مثل هذا الشخص، فيستفيد وهو يستشعر قدرته وفاعليته، ومن ثم يتغلب على شعوره الظاهر أو الخفى بالعجز أو القصور أو الدونية.
تعجبت إذ أفرد “يالوم” ذراع العطاء مستقلا عن ذراع الاخذ، كما أنه ركّز على أن ذلك ينمى القدرة ويحفز المبادأة، كما افتقدت توظيف حركية الأخذ والعطاء فى تنشيط وتوثيق وتحريك العلاقات البشرية (وإن كان قد أفرد للعلاقات البينشخصية فقرة مستقلة كعامل علاجى فيما بعد).
فى خبرتنا لا نفرح كثيرا وربما ولا قليلا، بشكل خاص لممارسة “الإيثار” بالذات كعامل مستقل، بل إن كلمات مثل “العطاء” و”الإيثار” أو “التضحية” ليست من الكلمات المرحب بها فى التفاعل أثناء الجلسات، وكان هذا التحفظ يزداد أكثر حين نرصد شعور المعطى بالعطاء بمعنى “الإيثار” بالذات، وهو اللفظ الذى استعمله “يالوم” والذى يعنى تحديداً: “تفضيل الآخر على الذات”!!، وقبل أن نعرض الملاحظات والفروق بالنسبة لموقفنا من هذا العامل، أشعر أنه لا بد من الإشارة أولا إلى اعتبارات أساسية هى التى قد تكون مسئولة عن توجيه المسار، وتحديد نوعيات التفاعل غالبا، ليس فقط بالنسبة لموقفنا من الإيثار، وإنما بالنسبة لمجمل فاعلية هذا العلاج وطبيعته (لهذا قد يتكرر ذكرها، فعذرا)
بعدان أساسيان يحضران فى خلفية هذه المنطقة بوجه عام، لا مفر من الاعتراف بهما ابتداء وباستمرار لعل فى ذلك ما يوضح الاختلافات، ويبين طبيعة المسار الخاص بنا فى هذه الخبرة المحددة.
أولاً: إن الممارسة التلقائية للعلاج الجمعى هى تنشيط ودفع لجدل النمو، وقد بينا ما نعنى بذلك من قبل، وهذا يتضمن تنشيط برامج تطورية عريقة كادت تتراجع أمام أفكار وممارسات أحدث فأحدث غلبت فيها تخطيطات العقل الأحدث دون سائر العقول، هذه البداية تضعنا مباشرة أمام منظور تطورى عملىّ نعايشه “معا” رأى العين (دون أن نسميه أو نناقشه غالبا)، وباعتبار ما أعرفه عن انتمائى لهذا الفكر دون ربط مباشر بنظريتى التى تحمل اسم التطور، فإننى أقوم بقراءة مرضاى وخاصة الذهانيين منهم، وكذلك قراءة تطورهم (أو تدهورهم) عموما وأثناء هذا العلاج خاصة، من خلال البرامج الأساسية للتطور، بمعنى ارتباط حركتنا معا مباشرة بحركية النمو وحتمية اضطراده فى نبضات (الإيقاع الحيوى) وبالتالى يكون دورنا فى العلاج النفسى (والحياة) مرتبط بمواكبة واستيعاب وفهم ودفع هذه الحركية فى اتجاهها، وهذا يجعل كل العوامل (العلاجية) تنبع من، بل وتقاس بمدى اتساقها مع طبيعة التطور وبرامجه، الأمر الذى يظهر فى النتائج بصفة عامة، ويتجلى فى صعوبات ومراحل العملية النمائية باستمرار، وعلى هذا فحين نقرأ ما طرحه “يالوم” بشأن الإيثار، فإننا نفعل ذلك بنفس المنظار تقريبا، أعنى نجد أنفسنا تلقائيا، نبدأ من برامج ومسار تضعنا فى بؤرة البحث عن معوقات وآفاق التطور، ثم نضيف ما تيسر من خبرتنا فى محاولة تصحيح توجـُّهـِهِ، وتدعيم فاعليته…بما يرتبط بشكل ما بثقافتنا، ولا أخجل أن أقول بمدى تخلفنا (الذى قد يثبت أنه مزية لو أحسنا الانطلاق منه).
ثانياً: البعد الآخر الذى يتداخل بشكل مباشر وعميق وأساسى مع بعد التطور هو علاقة هذا التطور بخالق الحياة، دون أى تنظير ميتافيزيقى أو لاهوتى أو أيديولوجى، فقط باعتبار مدى ارتباط هذا البعد بالمنظور التطورى النمائى السالف الذكر، وهذا مرتبط بشكل ما بالمستوى الذى وصل إليه تطور الوعى عند الإنسان، ثم الوعى بالوعى، وهو أمر يضع الإنسان فى وضع خاص وهو يتجذر بأصوله فى أصل الحياة من قبل نشأتها امتدادا إلى مطلق الكون دون معرفته، وهى وصلة مرتبطة بشكل أو بآخر بثقافتنا، وبالإدراك عموما، وهى متضمنة فى حدس الأطفال، وإيمان كبار السن (العجائز)، ونبض الإيمان.
وقد وجدت أن الممارسة مع هذه المجموعات فى قصر العينى بتعليمها المتواضع، ومستواها الاجتماعى الرقيق، وحدسها الفائق، وتنوع أمراضها، تقربنى إلى هذين البعدين دون حاجة إلى ذكرهما أو تذكرهما أصلا، لكن من واقع الممارسة أجدنى أعيشهما طول الوقت ويصلان إلى المجموعة والمتدربين دون أى إحالة محددة لأى منهما بالألفاظ، اللهم إلا بعض التلميح الاضطرارى أحيانا لحضوره معنا وحضورنا، حوله به، بشكل حذر عابر، وبالألفاظ البسيطة العادية التى يستعملها العامة (والخاصة بدرجة أقل).
من البديهى أننى سوف أرجع إلى هذين البعدين كثيرا فى مواقع أخرى وإن كنت آمل أن أوصل للقارئ ضرورة الانتباه إلى أن هذا المنطلق هو منطلق “عملى” “إمبريقى” “إيمانى” “آنى” “ثقافىّ”، وليس أكاديميا ممنهجا، ولا هو دينىّ سلطوىّ أصلا، وطبعا ولا هو ميتافيزيقى!!
مزيد عن الإيثار:
فإذا عدنا إلى تناول هذا العامل – الإيثار – مقارنة بما جاء فى رأى “يالوم” فإننى سوف أطرح الملاحظات العملية المتعلقة بممارستنا انطلاقا من هذين العاملين بشكل أو بآخر، إذ لا سبيل إلى عرض الفروق الثقافية بغير ذلك:
أولا: نحن نتناول الإيثار انطلاقا من النظر فى تنوع العلاقات الثنائية تطوريا، ثم كيفية تخليق الوعى الجمعى مع تطوير هذه العلاقات، وبالتالى يتهمش البعد الأخلاقى المثالى لحساب المنطلق التطورى العملى، فينقلب ما أسماه “يالوم” الإيثار إلى نوع من حب النفس (وليس) الأنانية، وهو حب فيه قبول للذات أرقى وأكثر واقعية، وذلك من خلال حركية العلاج التى تقابل النقلة التطورية من التركيز على حفظ الفرد بمكاسبه الخاصة أو تفرده إلى الوعى بجوهرية الحفاظ على الفرد منطلقا ضروريا لصالح الجماعة وبالعكس، مستوحين كل ذلك من تاريخ التطور بمعنى: أن حفظ الفرد دون جماعته هو إذعان للانقراض بشكل ما، هذا ما نتعلمه من تاريخ التطور عامة، فما بالك فيمن يتصور أنه يتربع على قمة هرم التطور ويسمى “الإنسان” (مرة أخرى، نحن لا نناقش ذلك مباشرة أثناء العلاج طبعا).
من أبسط الإضافات والتعديلات العلمية التى طرأت على علم التطور اهتزاز الفكرة التى سادت ردحا من الزمن حتى استقرت كأنها بديهية، وهى التى تقول “أن البقاء للاقوى” لم يعد هذا المبدأ صحيحا دون تحفظ، وإنما ثبت، ثم تأكد أن البقاء “للأقدر تكافلا”، مع أفراد نوعه أولا، ثم امتدادا إلى مجموعات الأنواع التى تشاركه فى التواجد معا فى الطبيعة المحيطة به، من هنا يصبح ما يسمى الإيثار برنامجا بقائيا نافعا للفرد والنوع والحياة على حد سواء، ولا يحتاج لأى إعلاء لقيمته الأخلاقية والمثالية ولو نسبيا بدرجة أو درجات.
ثانيا: من هذا المنطلق يتحول العطاء، حتى الذى يبدو تفضيلا للآخر على النفس (الإيثار) إلى مجرد ممارسة برنامج أذكى للحفاظ على الفرد فالجماعة فالنوع، ويكاد تختفى فكرة المفاضلة بين “أنا أم أنت”، إلى: “أنا فأنت <==> وبالعكس” لصالحنا معا، ونحن نمارس ذلك حتى فيما يتعلق بما يسمى “الحب” إذ أن أحدا لا يستطيع أن يحب آخر إلا إذا أحب نفسه، فحب الآخر مرورا بحب النفس يدعم العاطفة ويدعمها، وحب النفس الإيجابى هذا غير الأنانية، بل هو قد يكون عكسها.
ثالثا: لاحظنا أن ما يسمى الإيثار، حتى بمعناه الشائع، هو نتيجة لتقدم نمو المجموعة أكثر منه عاملا علاجيا فى ذاته، وحين تظهر فوائده على المُعطـِى من خلال التفاعل والممارسة، فإن حلقة علاجية تتكون فيصبح عاملا إيجابيا نمائيا بعد أن ينتقل من المستوى الأخلاقى المثالى تقريبا إلى المستوى النفعى البقائى للمجموع بدءًا بنفسه ، فبالذى أخذ منه، فالأخرين.
رابعا: لا نستعمل ألفاظ العطاء إلا نادرا، إذ بمجرد أن نستعمل هذا اللفظ ومرادفاته، تقفز النصائح بسهولة مسطحة، وقد أشرنا من قبل إلى تلك القاعدة الإضافية فى التفاعل حين نذكّر أن يجرى الحوار أو التفاعل “من غير سؤال ولا نصيحة” (ما أمكن ذلك) وإنما يتجلى العطاء (شاملا الإيثار) فى سلوكيات وتفاعلات لا تسمى عطاء عادة، ومن ذلك عطاء الوقت، وعطاء الفرصة، وعطاء الرؤية، وعطاء الإنصات، وعطاء الاحترام، وعطاء التذكر، وكل هذا يصل تدريجيا إلينا حتى نتعود على اعتباره من أولويات أنواع العطاء وأهمها، وهذا طبعا يختلف عن التعاطف الظاهر أو التطمين المباشر، ورويدا رويدا يختلف مفهوم العطاء (والإيثار) اختلافا أكيدا مقارنة بالشائع فى الحياة العادية وأيضا فى المنظومات الأخلاقية والدينية التقليدية.
خامسا: مع تكون الوعى الجمعى لاحظنا أن من يعطى لا يعطى فردا بذاته بقدر ما هو يدعم الوعى الجمعى بطريق غير مباشر، وحين تنتقل العلاقات البينشخصية من مستوى العلاقات الثنائية إلى الانتماء إلى قاسم مشترك واحد، يشارك فى تخليقه كل أفراد المجموعة، وهو ما أسميناه بالوعى الجمعى Collective Consciousness، تصبح للمجموعة ذات مستقلة ضامّة حاوية فى نفس الوقت.
سادساً: يصعب عادة حسابات العطاء “بمن” الذى كسب مِنْ مَنْ على حساب “من”، مادامت العملية ذهابا وجيئه طول الوقت، وأيضا لغموض مقاييس المكسب والخسارة وصعوبة قياسها بل واحتمال دلالة سلبية مجرد القياس والمقارنة.
سابعاً: كانت ممارسة تفاعلات وخبرات العطاء تجرى جنبا إلى جنب مع تفاعلات وخبرات محاولات التغلب على صعوبة الأخذ، وقد لاحظنا أن صعوبة “الأخذ” لا تعنى رفض الأخد بقدر ما تعنى تفضيل الأخذ خطفا أو سرا، وقد لاحظنا أن كسر صعوبة “الأخد” مرتبط بشكل غير مباشر بتنمية القدرة على العطاء، أى أن من ينجح فى أن يقبل أن يأخد ما يأتيه من آخر وهو يتجاوز الحذر والتردد فى عملية الأخذ، هو الذى يصبح أجهز وأسهل عطاء أسهل وأصدق.
ثامناً: كانت المشاركة الوجدانية بمعنى المواجدة Empathy من أهم ما تعلمنا منه خبرة خاصة كشفت عن نوع من العطاء شديد التميز فى الإنسان خاصة، إذ يتبين فيه المشارك الفرق بين أن “يتألم على” وبين “يتألم مع“، وحتى وهو “يتألم مع” فإننا لاحظنا أنه ينتقل من مشاركة الآخر ألمه إلى تحريك ألمه الشخصى فى نفس الوقت، فيكون أقرب وأصدق، ويتم تبادل الأخذ والعطاء من نوع آخر أرقى وأبقى.
تاسعاً: كان حضور الوعى الجمعى عاملا وصيًّا مشتركا مساعدا فى التغلب على صعوبات كل من الأخذ والعطاء، وخاصة إذا ارتبط بثقافة التواصل الإيمانى دون وصاية اغترابية فوقية، فمن حيث المبدأ فإن صعوبات العلاقات الثنائية كانت دائما توضع موضع الاختبار ولا تحل غالبا إلا بتدخل عامل مشترك هو الانتماء معا إلى الوعى الجمعى فما بعده: الذى يتصاعد إلى غايته بما تتيحه له ثقافتنا الخاصة.
وبعـد
أما كون الإيثار بالذات هو عامل علاجى فلابد أن نستنتج من كل ما سبق أنه ليس كذلك بالمعنى الحرفى للإيثار، ولكنه من بعد تطورى كما أوضحنا يصبح تنشيطا لبرنامج تطورى أرقى مازال يمارس بكفاءة عند كثير من الأحياء، ربما أكثر كفاءة مما يبدو على معظم ممارسات الإنسان المعاصر، وبالتالى: فالأرجح لدينا أن العامل العلاجى فى هذه المنطقة يتحقق بتقدم أفراد المجموعة نحو الوعى الجمعى (ذات المجموعة) الذى يصبح ممثلا لكل فرد من المجموعة فى نفس الوقت، وليس بالضرورة نتيجة لتعلم كل منهم كيف “يؤثر” الآخر على نفسه، وإنما هو يصبح أكثر موضوعية وأقرب إلى ممارسة هذا النوع من الأنانية/الغيرية/التطورية التى هى بمثابة تنمية الوعى بأنه: لا جدوى ولا معنى ولا أبقى! من أن أحصل وحدى على حقى، أو حقوقى بما فى ذلك الإنصات والرؤية والاعتراف، ما لم يحصل غيرى وبإسهام منى، على نفس الحق، وأنه لن يتحقق هذا إلا إذا مارسنا معا كجماعة مثل ذلك، وحين تصبح المجموعة نموذجا مصغرا لمحاولة تصحيح مسار العلاقات البشرية، لترتقى فتكون أقرب إلى علاقات الأحياء الأدنى التى نجحت معنا فى مقاومة الانقراض!!!، بمعنى أنه بالرغم من نمو الوعى واللغة عند الإنسان إلا أن تخلف نمو الذكاء التطورى، السالف الوصف، قد وضعه فى مأزق تطورى بعض مظاهره هو المرض النفسى.
مناقشة ما تبقى من العوامل العلاجية فى رأى “يالوم”
ننطلق الآن من تشكيلات “العلاقات الثنائية” تطوريا ،حتى نصل إلى ما يقابل تخليق الوعى الجمعى، دون استكمال مناقشة عوامل “يالوم” العلاجية تفصيلا فى مثل هذا العلاج، فلقد وجدت أنه تناول فيما تبقى من عوامل، ستة من ثمانية عوامل مرتبطة بنفس الفكرة الأساسية، ففيما عدا “التفريغ”Catharsis والعوامل الوجودية Existential factors كانت العوامل الست تدور حول نفس فكرة تخليق كيان جمعى يضم المشاركين فى وحدةٍ ما، لعلها تقابل – وإن كانت لا ترادف بالضرورة – ما أسميناه الوعى الجمعى، وهذه العوامل الست كما أوردها “يالوم” هى:
5- الاستعادة التصحيحية لجماعة الأسرة الأولية:
The Corrective Recapitulation of the Primary Family Group
6- تنمية الأسلوب الاجتماعى : Developing of Social Technique
7- السلوك المُحاكاتى: Imitating Behavior
8 & 9- (أنظر بعد)
10- التعليم البينشخصى – Interpersonal Learning
11- تماسك المجموعة: Group Cohesiveness
12- المجموعة ممثله لكون اجتماعى مصغر
The Group as Social Microcosm
وبالنظر فى كل هذه العوامل مجتمعة نظرة أولية يمكن أن نتبين كيف أنها تتداخل وتتكامل لتكون هذا الذى اسميناه “الوعى الجمعى” Collective Consciousness أو “ذات المجموعة” Group Ego، ومع أننى كنت أميل إلى جمع كل هذه العوامل معا لأنطلق مباشرة إلى تناول هذا الوعى الكيان الغامض القادر الذى يتكون من خلال هذا التنظيم الجماعى، والتفاعل البينشخصى، إلا أننى تراجعت بناء على آراء أصدقاء مشاركين، لأقول كلمة قصيرة عن كل عامل منفردا، مع أنه لا ينفرد أبدا:
* فبالنسبة “للاستعادة التصحيحية لجماعة الأسرة الأولية” نجد أن “يالوم” يربط بين ظروف معظم المرضى الصعبة التى عاشوها مع أسرهم الأولى، وهو يقول إنه من السهل ملاحظة أنه مع بداية اللقاءات الأولى يشعر معظم المرضى أنهم يكّونون أسرة جديدة بشكل أو بآخر، ويمثل المعالج الأول أحد الوالدين كما يمثل مساعده مثله أو غيره، ويمثل الأفراد الأخوة والأخوات تقريبا، وهو يصف التنافس بين الأخوة، والاعتمادية على القائد، والغيرة، ومحاولات جذب الانتباه إلى آخر ما نعرف عن العلاقات فى أية أسرة، وهو يقول إن المسألة ليست استعادة للاستعادة والتنفيث بل هى استعادة وتصحيح للعلاقات بشكل ما، وكأن إعادة معايشة هذه العلاقات هى بمثابة مواصلة استكمال ما لم ينته فى الأسرة الأولى من إرساء قواعد للعلاقات البشرية النمائية المضطردة.
وفى خبرتنا: وجدنا أن تشبيه المجموعة بالأسرة هو تشبيه جيد، وأيضا أن يمثل أفرادها أدوار الأسرة الأولى هو أمر وارد، لكنه ليس مرادفا لما لاحظناه من تطور مختلف لتخليق ما أسميناه “الوعى الجمعى”.
فالمسألة ليست استعادة خبرات الاسرة الأولى لتصحيحها أو إكمال مسيرتها، وإنما هى أقرب إلى نقلة نوعية نحو الإسهام فى تأليف وحدة وعى مختلفة، تتميز عن الوعى الجمعى للأسرة النووية، أو حتى الأسرة الممتدة، وإن كانت أقرب إلى هذا النوع الأخير دون تماثل.
ويبدو أن عدم التجانس فى مجموعات خبرتنا، وهو الذى يسمح بمشاركة عدد من المرضى الذهانيين، جعل علاقة خبرتنا الجماعية بنموذج الأسرة الأولى أضعف وأبعد فكان الأقرب تشبيها لممارستنا هو أنها تشبه نوعا من التجمع الحيوى البقائى فى ظروف أكثر تلاؤما بشكل أو بآخر.
ثم إنه بالنسبة لورود خبرات الأسرة الأولى لتصحيحها حتى فى السيكودرما، لاحظنا أنه قد غلبت طروحات مشاكل الأسرة الحالية أكثر من الأسرة الأولية، فمثلا: تواترت بالنسبة للسيدات فرصة الحديث عن الظلم الواقع عليهن حاليا، وعن فرص الحرية والحركة التى تتيحها لهن الأسرة الأولى، مقارنة بالفرصة المتاحة فى المجموعة، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى تجاوز نموذج الأسرة الأولى بشكل أو بآخر
* وبالنسبة لتنمية الأسلوب الاجتماعى فقد ذكر يالوم ما يشير إلى ما فهمت منه أنه أقرب ما يكون إلى بعض أساليب العلاج السلوكى المعرفى لتنمية مهارات التواصل مثلا، وهو أمر يكاد لا يحدث فى خبرتنا بشكل مباشر على الأقل، ونحن نعزو ذلك إلى اختلاف نوعية المرضى والظروف المتاحة، حيث يذكر يالوم فى هذا الصدد كيف يختلف تأثير هذا العامل حسب نوعية المجموعة وهدفها، فالحاجة إلى تنمية المهارات داخل المستشفى أو داخل الوسط العلاجى،غيرها على مستوى جماعات العيادة الخارجية، وهكذا، ثم إنه يضرب – كمثال- كيف أن الشخصيات الانطوائية والشيزيدية مثلا تتدرب من خلال هذا العلاج على كل من المواجهة والتعبير عن الذات.
وفى خبرتنا لم، ولا، نركز على تعديل أو تطوير سمات بذاتها لأفراد بعينهم، وإنما يتم استيعاب الطرق الجديدة للتعامل مع الجماعة من خلال المبادئ الأساسية للمجموعة بدءًا من التركيز على هنا والآن مرورا بالالتزام بسريان نفس القواعد على الجميع دون تمييز، بما فى ذلك المعالج الأساسى والمساعدين الذين أضاؤوا النور الأخضر، (ليسرى عليهم ما يسرى على قائد المجموعة وعلى المرضى)، وقد وجدنا أن فى ذلك ما يساعد المرضى على الشعور بالاحترام والمساواة، بما يسهل عليهم التدريب على المشاركة والتلقائية.
* أما بالنسبة للسلوك المحاكاتى وهو من أهم أساليب التربية التقليدية بوعى أو بغير وعى، فإن يالوم احترمه كما ينبغى كعامل علاجى فاعل، لكنه لم يبين تطوره من التقليد الحرفى لدرجة إلغاء الذات، إلى التقمص المحدود، إلى التقمص الجزئى من هنا وهناك إلى التأليف بين أجزاء المحاكاة فى كلٍّ جديد، ونحن نعترف أن كل هذا يحدث بدرجات متنوعة، تكاد تكون غير منظورة وبالتالى لا تصل إلى درجة أن تسمى محاكاة أصلا.
وفى خبرتنا لاحظنا أنه إذا وصلت درجة المحاكاة إلى ما يـُلاحظ صراحة أنها كذلك، فإن رفضا واضحا يقابلها من معظم أفراد المجموعة وليس من القائد فحسب، وإذا كانت المحاكاة للقائد فقط فإن المسألة قد تصل إلى ما يسمى “يلعب طبيبا”Playing Psychiatry ، ولا يكون الرفض منعا قطعا، وإن كان قد يحمل أحيانا جرعة من السخرية الخفيفة.
بصفة عامة، اعتبرنا أن التعلم والتقمص إذا وصل إلى درجة المحاكاة فإنه يعد عاملا سلبيا وليس علاجيا ما لم يتم تجاوزه على مسار المجموعة، وللتقليل من هذه السلبية كنا نوصى مثلا فى ممارسة الألعاب “ألا يكرر المشارك” نفس الاستجابة مع كل الأفراد، -كما ذكرنا- حتى تختلف استجابته مع كل واحد عن غيره ما أمكن ذلك، كذلك كانت القاعدة فى الألعاب هو أن يلعب القائد آخر فرد حتى لا يتأثر المرضى بأدائه ويتصورون أنه الأداء الأنسب فيقلدونه.
عموماً فإن هذا العامل إذا ظهر صريحا فهو أقرب إلى السلبية وعلينا تجاوزه.
* وبالنسبة لعامل التعلم البينشخصى Interpersonal Learning فقد وجدت يالوم يقدمه أقرب إلى نقل المعلومات Imparting Information (العامل الثانى)، وإن كان قد أضاف نقلات نوعية هامة يتعلمها المرضى من بعضهم البعض، غالبا دون أن يقصدوا.
ومع ذلك فأين التعلم فى ذلك؟ ألا ترون معى ورطة شق الشعرة (أو قسم ما لا ينقسم) التى تورط فيها “يالوم”، وقد وجدت أن فصل هذا العامل مستقلا عن حركية تكوين الوعى الجمعى وتكوين الأسرة الجديدة نوعيا (وليس تصحيح القديم بالضرورة) وبزوع ما اسمينا “ذات الجماعة” هو فصل تعسفى لجأ إليه “يالوم” ربما من باب محاولة عرض نفس الأمر من زوايا مختلفة، وبالرغم من تركيزى على الاختلافات الثقافيه إلا أننى شعرت فى هذه الفقرة برغم عنوانها أنها “تعليم” شعرت بوجه الشبه حتى مع أمثالنا العامية وهو يقول: “الناس لبعضها”.
* ثم ينتقل يالوم إلى عامل “تماسك المجموعة” Group Cohesiveness ويربطه بشكل ما بشخصية المعالج وأيضا بما يصله بطريق مباشر أو غير مباشر من تطور المجموعة وتفاعلها، وتداخلها، وما يطرأ على أفرادها من نقلات مع تقدم سير المجموعة، ويعتبر “يالوم” هذا العامل أقوى من كل العوامل، إذْ يشمل هذا التماسك العلاقة بين الجميع: المعالج والمساعدين وأفراد المجموعا معا، وتختلف المجموعات عن بعضها البعض فى مدى تماسكها حسب درجة ما بلغت من “النحنوية” (مِنْ نَحْنٌ)
وهى ترجمه طريفة مقابل نفس النحت الذى نحته يالوم قائلا “إن هؤلاء الذين لديهم حس الصلابة وال……… weness” هم الأكثر تصديا للدفاع عن قيم المجموعة فى مواجهات التهديد الداخلى والخارجى.
وهو يزعم أن التماسكCohesiveness مثله مثل العزّه dignity نعرفهما لكن لا أحد يستطيع أن يصف أيا منهما.
وهو يعتبر أن تماسك المجموعة هو نتاج تفاعل العوامل الضامة الأخرى مجتمعه، وأنه العامل الذى يجعل المنتمى للمجموعة يشعر بانجذاب طبيعى إليها، وأن ثم دفء يحيطه من خلال انتمائه لها، وأن ناسا تقدره وتحترمه، وأنه بدوره يقدر هذه الجماعة ككل كما يقدر أفرادها، ويقاس تماسك المجموعة بدرجة انتماء أفرادها إليها، ودعمه إياها، أكثر مما يقاس بدعمها له، وقد يحتوى البعض المجموعة داخله طول الوقت حتى يقول أحدهم: وكأن المجموعة تقف على كتفه حتى يسأل نفسه “يا ترى ماذا يقولون فى هذا التصرف أو ذاك”.
لا ينسى “يالوم” أن يقر أن ثمة أفرادا قد يظلون على مسافة من المجموعة، مع اعترافهم بأن: المجموعة “تسير فى الاتجاه المناسب” لكننى “لست جزءًا منها“.
ويقر “يالوم” مرة أخرى بمحورية هذا العامل إذ يقول إن هذا العامل هو مهم ليس فقط فى ذاته ولكن لأنه ضرورى لفاعلية كل العوامل الأخرى.
وفى خبرتنا يصدق كل ذلك مع الحذر من أمرين:
الأول: استبدال العلاقة بالمجموعة بضرورة الحاجة إلى الانتماء إلى الجماعات العادية خارجها.
الثانى: الشعور بالتفوق عن العاديين لمن لم يأخذوا هذه الفرصة، الأمر الذى قد يستتبعه نوع من موقف “الكر الفر” (ربما مثل الذى أشار إليه بيون Bion).
وأخيرا نصل إلى عامل: المجموعة ممثله لكون اجتماعى مصغر
The Group as Social Microcosm
حين قرأت عنوان هذا العامل فرحت باستعمال كلمة “كون”، وتصورت أن “يالوم” أخيرا قد وصله ما وصلنا من فكرة هذا الوعى الجمعى وتصنيفه بمثابة “جسد جامع واعد” وأفراد المجموعة هم أعضاؤه، وأن هذا المجتمع الصغير هو ما يعنيه “يالوم” بـ Microcosm ، إلا أننى حين قرأت ما أدرجه تحت هذا العنوان الجميل احترمته مثلما احترمت كل اجتهاده لكننى وجدت أنه أبعد ما يكون عن ما أوحى لى به العنوان.
من وجهة نظر “يالوم” فإن هذا العلاج يجعل للانتماء إلى هذه الجماعة دلالة خاصة هامة جدا، ليس فقط أثناء العلاج، وإنما هى تمتد إلى تعامله مع مجتمعات أكبر فأكبر حتى يصبح سلوك من يجتاز خبرة هذا العلاج بنجاح مختلفا فى دوائر أوسع وأوسع، وقد نبه إلى أن هذا الاتساع قد تسميه كل مدرسة نفسية بأبجديتها الخاصة، وهو يتوقف جزئيا على شخصية المعالج أيضا، لكنه فى نهاية النهاية لا يرتبط بتنظير بذاته، ولا بشخص بذاته، فهو نقله نوعيه لها إيجابياتها بغض النظر عن الصفات أو الأسماء التى تلصق بها.
الاختلاف الأساسى معنا، ما دمنا قبلنا استعمال لغات مختلفة لنفس الظاهرة، هو أننا فى ثقافتنا، وفى خبرتنا هذه نسمح لأنفسنا أن نربط هذا الكون الاجتماعى المصغر، بالوعى الجمعى، فالوعى الجماعى المتصاعد، فالوعى الكونى إلى ما لا نعرف، وهذا ما أشرت إليه سابقا واعدا بعودة تفصيلية إذا لزم الأمر، وسوف يلزم غالبا.
وبعد
لم يبق من العوامل العلاجية التى قدمها “يالوم” إلا عاملان هما اللذان استبعدت ضمهها إلى المجموعة، لضعف علاقتهما بتخليق الوعى الجمعى الذى تصورنا أنه محور هذه العوامل الست السابقة، وهذان العاملان هما “التفريغ” (8) و“العوامل الوجودية”(9).
أما عن التفريغ Catharsis كعامل علاجى فقد أشرنا سابقا إلى أننا لا نلجأ له إلا نادرا، بل إننا نحول دونه فى كثير من الأحيان، وهذا ما سبق أن أوضحناه ونحن نشير إلى رفض الفكرة الشائعة القائلة :أطلّع اللى جوابا” كما سبق أن أشرنا أن السماح بمثل ذلك يبعدنا عادة عن “هنا والآن” اللهم إلا إذا كان مقدمة للعبة أو سيكودراما.
أما عن العوامل الوجودية Existential Factors فقد أكد “يالوم” على ثلاث عوامل:
الأول: حتمية مواجهة الوحدة وقبولها من حيث المبدأ،
والثانى: حتمية مواجهة الحياة والموت ومن ثم موضوعية تمضية العمر بأمانة مع الاستغناء عن التفاهات،
والثالث: حتمية تحمل مسئولية الطريقة التى نحيا بها بغض النظر عن مدى الإرشاد والدعم الذى نلقاه من الآخرين.
وقد أشار “يالوم” أن هذه القضايا الوجودية تصبغ مسيرة المجموعة بقدر ما يعيشها قائدها ويمارسها بتلقائية وصدق بغض النظر عن النظرية التى يتبعها أو المدرسة التى ينتمى إليها.
وفى خبرتنا نرى أن الأمور قد تكون كذلك من حيث المبدأ ولكن الاختلاف فى أن هذه القضايا لا تسمى عندنا قضايا وجودية أصلاً، وهى لا تطرح بشكل مباشر على المجموعة بدرجات متفاوتة.
فقضية “قبول الوحدة” تصل إلى أغلب أفراد المجموعة، ولكن بشكل لا يصل إلى قول وينيكوت “أن تكون وحيدا مع To be alone with لكننا لا حظنا أن فرط الجوع إلى الآخر، وإلى الدعم الخارجى عموما يتناقص مع نمو المجموعة، ونحن نواجه اختبار واقعية وموضوعية هذا الاحتمال قرب نهاية العام المتفق عليه كعمر المجموعة عادة، ولا يبدو على المشارك عادة أنه منزعج من النهاية لأنه سـَـيـُـترك وحيدا إذ يبدو أن المجموعة تصبح أنيسا فى الوعى – دون إعلان ذلك – حتى بعد الانقطاع عنها، وقد أشرنا إلى وجود الوعى المطلق الذى يجمعنا فى موقع العلاج، وأنه هو هو معنا فى منازلنا بعد نهاية عام العلاج، وأن هذا وعى يمتد التعاقد معه بغير نهاية.
أما قضية “حتمية الموت” نهاية للحياة فإن هذه الحقيقة المطلقة ترتبط عادة بالبعد الدينى التقليدى لدينا، خاصة فى مستوى المرضى الاجتماعى والثقافى للذين نتحدث عنهم ونحن نقدم خبرتنا هذه. ويختلف نوع هذا الارتباط وشدته باختلاف الأفراد وعلاقتهم بتقديس تفسيرات التراث التى تصلهم من متوسطى الثقافة الدينية، أو من خلال قنوات عامة أو خاصة، أو من خلال ما تيسر من الترهيب والترغيب …الخ.
العامل الثالث وهو المسؤولية المطلقة تقريبا هو العامل الوحيد الذى نؤكد عليه فى ممارستنا، فثمة لعبة سبق أن أشرنا إليها (ص ؟؟)، تؤكد ذلك حين يطلب من كل مشارك أن ينهى كل فعل أو قول أو شعور بتعقيب يقول: “وأنا مسئول عن كده” ، ثم إن العلاج عموما الذى نمارسه فى كل أنواع العلاجات وخاصة علاج الوسط يسمى علاج المواجهة المواكبة المسئولية م.م.م. وهو قريب من العلاج المعرفى المسمى بعلاج القبول والإلتزام Acceptance Commitment Therapy إلا أن هذه العوامل جميعا لا تطرح فى المجموعة باعتبارها مواقف فكرية أو مذهبية أو وجودية كما أسماها “يالوم”، ولكنها ترد كيفما اتفق حسب مناسبة التفاعل ومقتضى الحال، وسوف نرجع إليه ونحن نتناول عرض بعض الألعاب العلاجية فى عمل لاحق فى هذه السلسلة.
[1] – The Yalom Reader “Selections from the work therapist and storyteller” Edited by: Irvin D. Yalom Copyright: 1998
[2]-، هذا الاستيفاء لا يتم خلال الجلسة طبعا، وهذا كله استثناء تصحيحىّ لا ينبغى اللجوء إليه ما أمكن ذلك.
[3]-(من التسعين دقيقة)، فكل جلسة مدتها 85 دقيقة+ هذه الخمس دقائق للأسئلة والأدوية!! = 90 دقيقة.
[4]– ومن البديهى أن “العلاج الخاص بمقابل” يعتبر عاملا مهما فى قياس الأمل، فلا أحد يدفع عادة إلا لأنه يأمل فى نتيجة إيجابية حسب تصوره.
[5]– هذه هى ترجمة مصطلح بيرلز Passirg into fire وهم الاسم الذى أطلقته على ثلاثيتى الروائية باسم “المشى على الصراط” وخصصت فيها الجزء الثانى باسم “مدرسة العراة” لوصف خبرة العلاج الجمعى على لسان حضورها دون أية وصاية علمية مباشرة.
[6] ] – فى صورة شعرية بالعامية نقدت الطبيب النفسى عموما، وفى هذا العلاج خصوصا حين يطلب من المريض أن يحيى مشاعره ليشارك “ويقول لى حـِـسّ” وأحيانا يقول له المبتدىء، “حس زى ما أنا باحس” فجاءت الصورة الشعرية فى منتهى القسوة على لسان المريض وهو يقول:
ويقلب سيخى، ويقول لى حِسّ،
بالنار من تحتك،
كما إنى باحسّ
بحلاوة ريحتك.!!!
[7] – الذى يستعد بعضهم لتدريب منظم لاحق
[8] – هى لعبة وصفها إريك بيرن وتعنى الموافقة على أمر ما بـ “نعم” مع ضمان وضع شرط ينفيه أو يمحوه مباشرة بـ “لكن” مثلا: “نعم أنا خطأت فى كذا ولكن عندى أسبابى وأنا مقتنع بها.
[9] – خطر لى الآن من كثرة إضافة سيكوباثولوجية بعد ذكر إمراضية بين قوسين أن أنحت كلمة جديدة وجدت كتابتها صعبة لكن نطقها سهل بالعربية وهى “نفْسِمراضية” مقابل Psychopathological. ما رأيكم
[10]– خاصة ونحن ليس لدينا “تأمين بطالة”، وربما هذا أفضل لحالات العلاج الجمعى خاصة.
الفصل الثانى عشر علاقة هذا العلاج الجمعى بالفلسفة،
الفصل الثانى عشر علاقة هذا العلاج الجمعى بالفلسفة،
الفصل الثانى عشر: علاقة هذا العلاج الجمعى بالفلسفة، و(الديالكتيك)
مقدمة:
عبر أكثر من أربعين عاما من ممارستى العلاج الجمعى فى قصر العينى ساعدنى المستوى التعليمى والثقافى لكل هذه المجموعات أن أتأكد من أن الفلسفة ليست كما يتصور المثقفون والأكاديميون، بل هى معايشة كل إنسان من حيث هو إنسان لما هو وعى ووعى بالوعى، فهى ليست نشاطا عقليا كما شاع عن العقل، وقد ساعدتنى الألعاب النفسية بوجه خاص على كشف حركية ديالكتيك النمو من خلال التوليف الحيوى الماثل أمامى فى ممارستى محرّكا ومشاركا، كما اتضح لى أكثر فأكثر أن مفهوم “فعل الفلسفة” يتجلى من خلال التركيز على قاعدة “هنا والآن”.
…. عرفت الفلسفة من ممارسة مهنتى ووصلت إٍلى بعض مسائلها مواجهةً، ومحاولة حلٍّ من خلال تحدِّى مرضاى وهم يقذفون فى وجهى بمشاكل الوجود والصيرورة وأنا لا أجرؤ أن أسمى هذا أو ذاك بالعرَض الشائع “أفكار شبه فلسفية” Pseudo-philosophical thoughts وهو ما يسارع صغار المتدربين والزملاء إلى لصقه على المريض بمجرد ألا يفهم ما يقوله المريض، (وكذا، ربما زملائى كبار التقليديون)، وأسال الزميل الأصغر عادة: وهل انت تعرف الفلسفة حتى تعرف ما يشبهها؟!!
إشكالة تعريف الفلسفة:
– هل هى الحكمة؟ أم حب الحكمة؟
– وهل هى دراسة المعارف؟ أم أصل المعارف؟
– وهل هى علم الوجود؟ أم علم الموجودات أم ليست علماً أصلا؟
– وهل هى دراسة منظومات القيم؟ أم دراسة النسق الفكرى المتكامل؟ أم هى النشاط العقلى ذاته؟
– وهل هى معرفة الواقع؟ أم ما هو ليس واقع لكنه واقع؟
الفلسفة غير التفلسف، وعالم الفلسفة، غير دارس الفلسفة، غير الفيلسوف، كما أن كل ما يمكن أن نتعلمه ونعلمة هو علم الفلسفة، وأحيانا التفلسف وليست الفلسفة، وبالتالى فالذى قد يصعب علينا هو التفلسف أما الذى تخيفنا معايشته فهو الفلسفة.
إن قول أحد الوضعين المنطقيين مؤخراً “.. إن الجمع بين العلم والفلسفة أصبح ضرورة لا غنى عنها، وأن الفصل الذى تم بينهما فى غضون القرن التاسع عشر كان له أسوأ النتائج على العلم والفلسفة على السواء” هو قول يصدق أكثر جدا على علمنا هذا. (الطب النفسى إذا سُمِّى “علما” تجاوزاً)، وهو يصدق أكثر على هذه الخبرة التى تسمى العلاج الجمعى .
من خلال هذه الممارسة اكتشفت أن الفلسفة هى ممارسة أساساً، ثم يأتى التنظير بعد ذلك (أو لا يأتى)، تماما كما ذكرت بالنسبة للمنهج الذى أرى أنه الأقرب إلى ما نمارسه، وبغير احتمال شجاعة هذه الممارسة فإننا إنما نقوم بعملية عكسية غالبا: هى وأد كل محاولة تجديد مقتحم، لا تنطبق عليه شروط البضاعة المعروضة فى السوق.
إن الفلسفة برغم ما شاع بين الناس وكيف أنها تبدو من أكثر المجالات حاجة إلى التخصص والموسوعية، إلا أن من المعروف أن أسئلة الأطفال هى هى أسئلة الفلاسفة، دع جانبا الإجابات الآن، ولكل واحد منا موقف فلسفى تحت جلده وهو لا يدرى غالبا.
يوجد بين الأطباء النفسيين ظاهرة تسمى “رهاب الفلسفة”، إذْ قد تعتريهم أعراض حساسية أو أتونوميه بمجرد سماع الكلمة مع أنه توجد شعبة فى الجمعية البريطانية الملكية للطب النفسى اسمها “الفلسفة -علم النفس- الطب النفسى“ P.P.P Psychiatry – Psychology Philosophy & وقد كنت عضوا فيها إلا أننى لم أشترك فى أى نشاط لأسباب خاصة، حتى استغنوا عنى غالبا.
اجتهاد:
يا ترى هل أستطيع أن أضع معالم لما أعنيه – هنا على الأقل – بهذا اللفظ “الفلسفة”، دون طمع أن يصل إلى مستوى “التعريف” فأقول:
“الفلسفة هى المحاولة المستمرة المتجددة ، للحياة المغامرة فى اتجاه معين، فى لحظة ما … مع قبول مبدأ التغيـّر دائما مع استمرار المحاولة..والتعلم والنقد لإعادة التشكيل، وقد يصحب ذلك درجة من التنظير المعرفى أو لا يصحبها، لكن هذه المحاولة تتصف تقريبا دائما بالعمل الدائب فى منطقة حركية المتناقضات فى تنشيط جدلى واعد بولاف متصاعد، أى نمو مضطرد”
ثم إنى حين أعدت النظر فى هذا التوصيف الشامل خجلت لأننى وجدت أننى لا اصف الفلسفة، بل الحياة النابضة للإنسان النامى حالة كونه متناه يسعى إلى اللا متناه، مستعملا فى ذلك مكاسبه التطورية والبيولوجية، وخاصة الرمز والتجريد والإبداع، فى رحلة وجودية صيرورية معرفية مغامرة.
ما هذا ؟ هل أنا أشرح نفسى أم أزيد ألامور تعقيدا؟ وما علاقة ذلك بالطب النفسى، وما علاقته بالبيولوجى؟ وما علاقته بالعلاج الجمعى؟
الفلسفة ليست نقيض البيولوجى
أعيش على أمل أن يتفلسف الأطباء وهم يخطون خطواتهم المتواضعة فى الحياة اليومية العملية وهم يمارسون مهنتهم بمعارفهم العضوية الثرية من كيمياء وطبيعة وفسيولوجى . .، فيتعرفون على علم الحياة Bio- Logy فى عمق وحدته الأولية، كما آمل فى نفس الوقت أن يخوض الفلاسفة دنيا البيولوجى فى غير تردد، وقد فعلها منهم الكتيرون وأثروا معارفنا الطبيعية والرياضية بلا حدود، هل فى هذا الأمل بعض ما كان يعنيه أبو الأطباء “أبو قراط” حين قال: “إن ما يصلح للطب يصلح للفسلفة، وما يصلح للفسلفة يصلح للطبيب، والطبيب الفيلسوف هو فى منزلة الآلهة”؟
- أغلب الفلاسفة عبر القرون كانوا يحلمون بمعمل للأفكار: يختبرون فيه أفكارهم ويتحققون منها ثم يُوَلِّدون غيرها ما أمكن، كما أن بعضهم قد زاد طموحه حتى تصوّر أن هذا المعمل هو الحياة العامة – والسياسية بالذات، مثل حلم أفلاطون بالملك الفيلسوف (ومحاولاته الفاشلة!!) وكذلك محاولات الماركسيين بعد ذلك … وأعتقد أن هذ الحلم ظل أيضا يراود الفلاسفة من بيكون إلى الوضعين المنطقيين، إلى غيرهم، ولعل فى هذا وحده دليل على إلحاح هذا الخيال، فهل يا ترى ما زال هذا الحلم قابلا للتطبيق، وكيف؟
يبدوا أن الفلسفة باعتبارها ممارسة نوعية لحياة بشرية نشطة ورائدة، إنما تتجلى فى رحلات أفراد ومجموعات صغيرة ، برغم أنها تغرى بأنها أسلوب قابل للتعميم من خلال مناهج وبرامج جماعية مختلفة، لكن التاريخ والواقع يحذران من هذا التعميم، كذلك فإن محاولات التطبيق فالإحباط ينبهان أن ثمَّ خطأ فى هذا الحلم الضاغط، فتظل الفلسفة هى البرنامج الحيوى الأقرب لكشف الطبيعة البشرية فى حدود الأفراد والمجموعات الصغيرة، مع إتاحة الفرصة لاستلهام معطياتها ببرامج أخرى لأغراض أخرى، ومن بين هذه المجالات المحدودة، اكتشف أن العلاج الجمعى – كما نمارسه – يمكن أن يكون إحداها.
العلاج الجمعى والفلسفة
فى السنوات الأولى لممارستى هذا العلاج الجمعى فى “قصر العينى” خيل إِلىّ أحيانا أنى فى معمل لاختبار الأفكار كما كان بعضهم يصور الفلسفة، ثم تطور تصورى إلى أنه ليس معملاً لاختبار الأفكار فحسب بل إنه مصنع أيضا لتوليد أفكار جديدة، ثم إنه أيضا مجال عملى لاختبار فاعلية هذه الأفكار فى التغيير، لكننى مؤخرا وبعد دخولى إلى مرحلة التعرف على محيط الإدراك، وقنوات المعرفة الأخرى، تجاوزت التركيز على ما هو “أفكار” إلى النظر فى حركية الوعى، ومعرفية الإدراك، وتجليات الإبداع فى واقع الممارسة أساسا، ولم تغب عنى معالم “فعل الفلسفة” فى كل ذلك أبدا.
العلاج الجمعى ليس حقل تجارب لأفكار أو مسيرة مجموعة من البشر
القضية التى أتناولها من خلال ممارساتى هذا العلاج هى قضية كيانية تتعلق بالوجود وجوهره، حتى أننى اتجهت فى مرحلة من تفكيرى (حيرة طبيب نفسى) إلى تصنيف الأمراض النفسية إلى أمراض كيانية (وهى مركز اهتمامى) وأمراض تكيفيه (وهى على هامش انتباهى…)، والعلاقة بين النوعين وثيقة مما لا مجال لتفصيله هنا حالا.
قضية الوجود قبل الماهية تعتبر تأكيداً للاختيار، وأن الانسان صانع نفسه، ولكنى قد أشرت سابقا إلى أنى أضع الماهية الكامنة بدءًا من الإرث الجينى، والتاريخ الحيوى، أساساً لما يحدث فيما بعد، وكأن الوجود يحور الماهية بشكل محدود حسب فرص تفاعله فى المكان والزمان معاً، ولكنه لا يصنع الماهية ابتداء، ومن هنا جاء تركيزى على أن قضية الوجود البشرى ليست هى “تكون أو لا تكون” To be or not to be ولكنها مسار الصيرورة “تكون أو تصير” To be or to become، علما بأن الصيرورة لا تحل محل ضرورة تحقيق الوجود أولا، ولكنها تنطلق منه.
ثم ماذا بعد:
ثـَمَّ تساؤلات لا بد أن تطرح الآن قبل الدخول فى صلب التخصص.
أين العلاج النفسى الجمعى من كل هذا؟.
ألا يشوه هذا التنظير مسيرة العلاج النفسى ويخرجه عن هدفه، أو يفرض عليه ما ليس له؟
وللرد على ذلك أجتهد فأقول:
1- إٍن هذه المشاكل الكيانية والصيرورية موجوده عند الشخص العادى، وهى ليست مشكلة خاصة بالمختصين فى الفلسفة، إنها طبيعة النمو، وحركية الوعى البشرى لا أكثر ولا أقل.
2- إن المرض النفسى هو المظهر الطبنفسى لإعلان الفشل (المؤقت أو المضطرد) فى هذه المواجهة العنيفة غير المحسوبة، مع هذه المشاكل الحية التى يعيشها الإنسان بغض النظر عن مدى وعيه بها، أو قدرته على تسميتها، أو نجاحه فى التعبير عنها.
3- إنه بحسب درجة الوعى ونوع اللغة المستعملة تكون الممارسة التى هى هى الفلسفة دون أن تسمى كذلك (وهذا أفضل).
4- إن وعى المعالج الجزئى والمتجدد بهذا الموقف دون حاجة إلى كلام، هو السبيل لإثارة وعى مقابل من جهة المرضى مما يساعد فى تحديد موقف مسئول تجاه ما فرضته الاستعدادت البيولوجية الأساسية لتتحرّك فى المجال المتاح، فى حدود فرص التفاعل مع المحيط بما يشمل الآخرين. (والمجال المتاح هنا هو “المجموعة العلاجية”).
5- لاحظنا أيضا أن مسيرة العلاج النابعة من المشاكل المطروحة وكذلك قواعد العلاج التى مارسناها، وحورناها، وابتدعنا غيرها، تتصل اتصالا مباشراً بمشاكل الفلسفة الحية، التى إذا كنا قد نجحنا فى الهرب منها فيما يسمى العلم، فإِن المرضى جاؤوا يذكّرونا بها من واقع مآسى وجودهم، ومدى تعرّيهم، وليس أمامنا إلا أن نواجه مسؤوليتنا تجاهها (دون تسميتها فلسفة، ربما هذا أفضل).
6- إن الأعراض التى هى الدافع الأول لحضور المريض للاستشارة، تزول، ليس بالضرورة بالتركيز على إزالتها، وإنما كنتيجة “لاضطراد النمو” من واقع “تنشيط جدله” الذى هو “فعل الفلسفة” أو من واقع تراجع المحاولة.
7- ليس مطلوبا من أى معالج (فى العلاج الجمعى خاصة) أن يتبع فلسفة بذاتها كما زعم “بيرلز” أنه يتبع الفلسفة الوجودية فى علاجه الجشتالتى الجمعى، مما لا يطابق الواقع تماما كما أشرنا سابقا، ولكن الذى يحدث هو أن المعالج يكتشف تلقائيا بعد تدريب وإشراف ووقت كاف، أنه يمارس فلسفته الخاصة دون تسميتها، وأنه مسؤول عن ذلك، وعن تغييرها كلما سنحت الفرصة من واقع تفاعله مع المرضى ونفسه ونتائجه، ثم يكتشف أن حركية النمو ونوعية النتائج هى التى تحدد المسار وليس محتويات المعتقد الذى يتصور أنه يعتقده.
بعض أوجه الشبه
مناهج الفلسفة ، خاصة فى الممارسات الأصلية والحوارات الشارحة، هى آليات لها أسماء وتوصيف لا تقل قواعدها إلزاما عن آليات ومناهج العلاج الجمعى، وفيما يلى مجرد إشارات إلى بعض ما يمكن أن تلتقى فيه هذه بتلك:
(1) يلاحظ المتتبع لكثير من الحوارات والتفاعل فى العلاج الجمعى ما يشبه مبدأ “التوليد” الذى اتبعه سقراط للوصول إلى الحقائق، وقد ظهرهذا جلياً فى رفض الإجابة على الأسئلة أحياناً، وقلبها جملا إخبارية أحياناً أخرى، وأيضا فى طرح أسئلة مقابلة بديلا عن الإجابة الجاهزة.
(2) يهدف العلاج عادة إِلى تأكيد افتراض أن لكل مشكلة جانبين يكادان يتساويان فى القوة فنتذكر فى هذا الصدد محاورة بارمنيدس حيث يقول أفلاطون “إن لكل مشكلة جانبين ويمكن الدفاع عن أيهما بمثل القوة التى ندافع بها عن الآخر”.
(3) يظهر مبدأ رفض الثرثرة والجدل العقلى (الدردشة) الذى ننبه إليه فى كل جلسة علاج جمعى تقريباً، وهو ما يقابل النقد الموجع للسفسطائيين عندما ذهب فكرهم إلى درجة أن أصبحت غاية التفكير هى الانتصارعلى الآخر وليس الوصول للحقيقة
(4) يتكرر فى العلاج الجمعى الهجوم على الموقف الحُكمى لأحد الأفراد على فرد آخر أو على الآخرين عموما، وفى ذلك ما يلامس مع الفارق الموقف الشاكّ لـ”بيرون” حين يؤكد أنه: لا مجال للحكم على شئ من حيث المبدأ؟
(5) لعل فى التأكيد على الحرية والاختيار والمسئولية ما يؤكد المبدأ الأساسى فى الفلسفة الوجودية وهو أن الوجود يخلق نفسه باستمرار، وأن الانسان هو حريته.
(6) إن محاولة الانتقال من الحب الفردى والعلاقة التكافلية المعطِّلة إِلى التأكيد على تنمية “القدرة على الحب” لكل من يستحقه (أو من لا يستحقه أحيانا) ما قد يشير إٍلى موقف أفلاطون من الحب، ذلك الموقف الذى أسئ فهمه أشد الإساءة. بزعم أنه “حب عذرى” أو “حب مثالى”..الخ .
(7) نلاحظ أنه باتباع مبدأ “أنا – أنت”، تسعى المجموعة فى إصرار إلى كسر التحوصل حول الذات بما يؤيد أن الوجود الفردى لابد له أن يتناسق مع الوجود العام، الأمر الذى ناقشه هيدجر تحت مفهوم “التواصل” و”ياسبرز” تحت مفهوم “الأنت”.
(8) إن فى التأكيد على ضرورة خوض تجربة – “هنا والآن”– حية كأساس للشفاء، أى الأساس للنمو والتغير، ما قد يلامس – من عمق معين– رأى جابرييل مارسيل فى ضرورة العودة إلى تلك “الخبرة الأولى”..
(9) تتكرر فى الجلسات محاولات الدعوة إلى التقاط الفرصة لبداية جديدة من تجربة حية، بما يشبه الرأى الوجودى فى مغامرة إظهار الضعف والاعتماد ، وربما يقابل ذلك هشاشة النفس عند ياسبرر أو تجربة سقوط الدفاعات القديمة قبل ظهور البديل أى الاقتراب من المأزق الذى ربما يقابل الغثيان عند سارتر.؟
(10) ربما يكون فى السماح المحسوب بالنكوص المحدود، فى دراما، أو لعبة، (وخاصة ما أشرنا إليه من حماسنا للذات الطفلية عند إريك بيرن فى بداية خبرتنا) ما يذكرنا بشكل ما باتجاه المدرسة الأبيقورية فى تقديس مبدأ اللذة.؟
(11) ثم إننا يمكن أن نستشعر ظهور مبدأ البراجماتية فى كثير من الأحيان، وذلك بالإصرار على إرجاع كل مسار العلاج إلى الواقع العملى، ومثال ذلك حين تُرفض البصيرة العقلانية، ويصر المعالج والمجموعة على الوصول إلى البصيرة الحقيقية التى تستقر فى القلب ويصدقها العمل…، وفى كل ذلك ما يؤكد المبدأ البراجماتى من أن الفكر غائىّ بطبيعته، وأن المعرفة لا ينبغى أن تكون إلا أداة فى خدمة العمل.؟
(12) وقد لاحظنا أنه فى محاولة تصعيد الإدراك لدى أفراد المجموعة من استقبال الآخرين والأشياء باعتبارهم “موضوعات ذاتية” إلى استقبالهم باعتبارهم “كيانات موضوعية”، ما يلقى بنا مباشرة فى خضم نظرية المعرفة Epistemology بأمواجها المتلاطمة بين المثالية والواقعية. إن تطور الإدراك من الذاتية إلى الموضوعية لا يتم فقط بالطريقة التى اقترحها “كانْت” فى مثاليته النقدية (التى لم أفهمها إِلا من خلال نظرية تنظيم “اعتمال” المعلومات) ولكنها أقرب ما تكون – أيضاً – إلى تصاعد مراتب الوعى عند هيجل فى ممارسة تجريبية عملية.. حية “هنا والآن”.
علاقة هذا العلاج الجمعى بالديالكتيك
الحديث عن الديالكتيك، هو أصعب مراحل تقديم الخلفية النظرية لهذا العلاج ، وفيما يلى بعض ما يوضح موقفى إزاء هذه القضية:
أولاً: منذ وصفت هذا العلاج بأنه “تنشيط ديالكتيك النمو” وهذا مثبت بوضوح فى الكتيب المقدمة (1978) ([1]) ، لم أعد إليه لمزيد من الإيضاح وحتى الآن.
ثانياً: إن قراءة هيجل أو الاستشهاد به أو فهمه، كل ذلك يمثل لى مهمة صعبة، لا أزعم أننى فى مستوى تناولها بالقدر الكافى.
ثالثاً: إن الحديث عن الديالكتيك، أو الكتابة فيه، هو ضد الديالكتيك نفسه، هذه ليست مقولتى، ولا أذكر أين قرأتها لكنها أفادتنى كثيرا، وهى مقولة صحيحة، بالغة الدلالة.
رابعاً: جرى استعمال لفظ الديالكتيك فى علاجات نفسية، مفيدة وهامة، لكننى وجدتها أبعد ما تكون عن ما وصلنى من هذا اللفظ، ومن استعماله لشرح طبيعة العلاج الجمعى الذى نمارسه، ومن ذلك العلاج السلوكى الديالكتيكى Dialectic Behaviour Therapy، وقد ابتدعته مارشا لينهان Marsha M.Linehan 1999،([2]) وهو علاج ليس له علاقة بالعلاج الجمعى بالذات، كما أن آلياته وأساليبه مليئه بالمناقشات والتوجيهات والتدريبات السلوكية الظاهرة، يهدف كثير منها إلى تعديل الأفكار السلبية والسيطرة على موجات الانفعال الانفجارية، كما أنه يمثل إحدى تجليات العلاج المعرفى المتتالية مثله مثل علاج القبول والالتزام Acceptance Commitment Therapy أو علاج “شحن الذهن”Mindfullness الذى يساعد المريض على احتواء فرط الانفعال …الخ، وما لكل ذلك من آليات لا تستعمل عادة فى العلاج الذى نمارسه، بل إن بعضها نتجنب استعماله بشكل محدد، لكثرة ما فيه من التوجيهات المباشرة والتدريبات.
خامساً: لم أجد كلمة بالعربية – للأسف- تفيد ما وصلنى من الكلمة بالانجليزية Dialectic، بل إن الكلمات الجاهزة للترجمة مثل جدل وجدال تفيد أنواعا من الحوار (الفكرى واللفظى والتجريدى) تبعدنا عن حقيقة حركية الديالكتيك كما وصلتنى وكما أود أن أنجح فى تقديم بعض أبعادها.
سادساً: إن انتمائى الأساسى الجوهرى لنظريات التطور جعلنى أفهم كيف أتعامل مع ظاهرة الديالكتيك بشكل عام على أنها أساس فى حركية “الطفرة” التى تتخلق منها الأنواع من خلال الجدل الحيوى بينها، وأنا اعتبر هذا فرض يحتاج إلى فحص من علماء التطور أساسا أكثر من علماء النفس أو الطب النفسى.
سابعاً: إننى مثل كثير من الفروض التى وصلت إليها من خلال غوصى فى فعل الإدراك ودوره فى الحفاظ على الحياة عبر التاريخ (قبل وبعد التفكير واللغة) قد اكتشفت أن غموض طبيعة الادراك المتجاوز للحواس إنما يرتبط بشكل ما بغموض طبيعة الديالكتيك وصعوبة تناولها.
ثامناً: بفضل التركيز المتناهى فى “هنا والآن” فى هذا العلاج الجمعى الذى نمارسه وصلتنى من نشاط مجموعات بشرية لا تتناقش ولا تتحاور ولا تتصارع مع بعضها البعض، وإنما تتفاعل وتتواجه و”تتادَلَكْ”([3]) أسبوعا بعد أسبوع (بل ثانية بعد ثانية، بل فى أجزاء الثوانى) وصلتنى طبيعة حركية التواصل البشرى على مسار النمو الإنسانى بشكل لا يفسره غالبا إلا الملامح الأعمق لهذه العملية المسماة الديالكتيك.
تاسعاً: قدرت أن تقديم الديالكتيك قد يتضح ولو نسبيا إذا أكدنا ابتداء على ما هو ليس هو كالتالى:
(1) هو ليس الجدل حواراً عقلياً كما يتصور البعض.
(2) وهو ليس محددا بصراع بين ضدين بمعنى “الصراع” Conflict ، ومن ثم تحقيق درجة مناسبة للتكيف فى محاولة حل هذا الصراع.
(3) كما أنه ليس حلا توافقياً وسطاً بين قطبين على أقصى محور ممتد، أى أنه ليس “حَلْوَسَطَاَ” Compromise تسكينا.
(4) ولا هو احتواء أحد المتصارعين للآخر.
(5) وليس الديالكتيك مبرراً للحفاظ على سلبيات الحياة بجوار أو حتى بداخل ايجابيتها (ولعل هذا الفهم الخاطىء هو ما استثار كيركجارد ضد هيجل وضد اجتماع الأضداد بالذات حتى الرفض).
(6) ولا هو عملية تبادلية تسمح باتفاق دورى يتم من خلاله تبادل الأدوار وتناوبها بين المتناقضين بشكل منتظم، لأن هذا ينتمى إلى “الإيقاع الحيوى” وهو أحد آليات التطور، وأساس استمرارية الحياة، وله علاقة بحركية الديالكتيك، لكنه ليس هو.
(7) وأخيراً: فالديالكتيك ليس تجريدا منفصلا عن عيانية نشاط المخ، ولا عن الأساس البيولوجى للنمو والحياة.
تعريف النفس من هذا المنطلق (البيولوجى/الديالكتيكى)
ماهية النفس:
ألفنا أن نتحدث عن النفس: بمعنى نشاط المخ، أو بمعنى رمزى تجريدى فتنفصل عن المخ والجسد بلا تحديد، أو بمعنى دينامى على أساس أنها محصلة قوى متصارعة مع بعضها، ولكننا لم نتعود أن نتحدث عنها بمعنى الناتج النامى المتجدد النابض الممتد لحركية النمو الديالكتيكى للجهاز العصبى كله فى احتكاكه المستمر بالبيئة (وخاصة بالآخر الإنسانى).
ماهية الديالكتيك:
“إن الديالكتيك هو حركة المواجهة المتلاحمة الحية الصادقة بين الأضداد.. التى إذا استمرت فى حيوية لوقت كاف .. دون أن تقضى على الكائن الحى (أو على الشعب أو على الفكرة) فإنها قادرة على تفعيل هذه الأضداد فى كلٍّ جديد مختلف نوعيا، وأقدر كميا من مجموع أجزائه، وبالتالى فهذا الكل الجديد هو ذو نوعية جديدة وله قوانين جديدة ….”
فالديالكتيك الحى ليس فيه غالب ومغلوب، بل ولا سلب وإيجاب، بل ولا حسن وسئ، وإنما أدنيان إلى أرقى، ولا شك أن هذه الفكرة قد خطرت كأمل عند المفكرين الإنسانيين فى علم النفس بل وكمرحلة طبيعية فى نمو الشخصية، ويظهر هذا واضحاً فى تفكير ماسلو، وحديثة عن مرحلة اختفاء الاستقطاب بين المنطق والنزوة، بين الوسيلة والغاية، بين الأنانية والأثرة.. الخ وهو فى حديثه عن حل هذا الاستقطاب Resolution يتحدث عن الولاف Synthesis ويتكلم عن الاتحاد التعاونى Synergic Union ولكن الذى أعنيه هنا ليس تكرار ألفاظ هذا الأمل ولكن محاولة تفسير حقيقة طبيعة خوض التفاعل الديالكتيكى (لا مجرد الاتحاد أو التعاون)، ثم الإشارة إلى أن الطريقة محددة المعالم والبيئة (المحيط) واضحة القوانين هى المناخ الذى يتيح لهذا الديالكتيك الحيوى أن يستمر تصاعداً.
ماهية الأعراض:
من هذا المنطلق تصبح الأعراض هى مضاعفات الحركة التطورية الديالكتيكية إذا ما فرضت على الكيان البشرى قبل أن يستوعب المرحلة السابقة وقد استكملت مقومات نمائها واستعدادها، لتخليق الولاف التالى:
ماهية العلاج النفسى:
وبالتالى: يكون العلاج النفسى من هذا المنطلق هو مساعدة هذه الحركة التطورية على مواصلة هذه المرحلة إلى الولاف الأعلى …..، أو على التراجع عن هذه المحاولة حتى تستعد وتستكمل مقومات الحركة الناجحة فى المحاولة (النبضة) القادمة.
خطوات ومثابرة:
إن العلاج النمائى عموما وخاصة العلاج الجمعى – يخطط لما أسميناه تنشيط حركية الحياة بإحياء ديالكتيك النمو ويشمل ذلك خطوات متكاملة متعاقبة متداخلة معا، تتم ممارستها من خلال فنية تحريك الوعى، أفرادا وجماعة، وجماعات، وقياس كل ذلك بالنتائج الظاهرة ما أمكن ذلك، وأيضا بالمتابعة لرصد نتائج الفروض المشيرة إلى حتمية التغيرات المتناهية الصغر القابلة للتكثيف وإعادة التشكيل، ومن ذلك:
(1) تعتعة الجمود الساكن لتخثرات متفرقة، أو لكتلة الشخصية المتوقفة أو المتكلسة أو الدائرة فى المحل، وذلك من خلال التحريك الفنى العلاجى بكل آليات هذا العلاج بدءًا بالتركيز فى “هنا والآن” وبالسيكودراما، وأداء العكس، والألعاب النفسية بأنواعها وبكل ما ذكرنا وسوف نذكر من تقنيات.
(2) إعادة مواجهة هذه القوى مع بعضها البعض لا لإحياء الصراع فى ذاته، وإنما لإعادة تقييم التناقض، والاعتراف بوجود أطرافه، ومن ثم التنشيط فالتحريك، فالدياكتيك، فالنمو.
(3) الحفاظ على استمرار هذه المواجهة وتصعيدها بالدرجة التى تسمح بها دعامة المجموعة والمعالج.
(4) تجنب القصد فى ترجيح أى منظومة (بيولوجية كيانية) بذاتها، مهما شاع أنها الأقدر تكيفا والأكفأ قيادة (اللهم إلا مرحليا: انظر بعد) بمعنى أن المطلوب ليس هو – مثلا- مجرد ترجيح الأنا Ego الفرويدى، أو “الفتى” ADULT التفاعلاتى، أو التلقائية الجشتالتية.
(5) مواكبة مراحل النمو المتصاعدة، حيث كل وحدة أكبر من سابقتها – ولكنها وسط على الطريق – والوحدة تتم: بنجاح التوليف لتشكيل وحدات أكبر، وأيضا: باحتواء مؤقت للجزء المتبقى من الضد الذى لم يتم تمثّله لحين تحريك جديد فى نبضة نمو جديدة طبيعية، ومن خلال التنشيط العلاجى.
(6) مع استقرار الوحدة الأكبر التى تسمى الولاف الأعلى Higher Synthesis لفترة تؤكد فيها نوعيتها فإنه يتم السماح بتحريك جديد يسمح بظهور الجزء المحتوى داخلها ليلتحم بالتناقض خارجها وتبدأ مواجهة جديدة … وهكذا ..
(7) باستمرار هذه العملية وتكرارها يقل هذا الجزء المُحتوى بعد كل نجاح أعلى حتى يبدو وكأنه يمكن أن يتلاشى (ولو نظرياُ) وهنا يكاد يصبح الوجود مطلقاً والتكامل خالداً وهذا غير وارد عمليا طالما يظل الانسان كائنا بشريا، ولكنه قد يتجلى للحظات مؤقتة فى الابداع والتصوف ومثل ذلك من خبرات …
(8) بما أن هذا الهدف الأبعد هو هدف نظرى بالضرورة فالحركة تظل مستمرة (إيقاعيا) نحو التكامل إلى أبعد مما نستطيع أن ندركه فى حياة الإنسان الفرد المحدودة حتى الآن.
وبعد
هكذا نستطيع أن نراجع طبيعة هذا العلاج قيد البحث من خلال هذا المنظور بأن نعيد تأكيدنا أنه ليس كبتاً، ولا قمعاً وتحكما ولا تصالحاً وتبادلا بين أجزاء أو كيانات النفس، وإنما هو تنشيط حركية تهدف إلى تهيئة الظروف المساعدة لإنجاح هذه الخطوات التطورية بعد أن هددها الفشل فى صورة المرض وأعراضه .. وذلك للوصول إلى الولاف التالى وهكذا.
ملحوظة:
فى حالة مجموعات المواجهة تجرى نفس هذه الخطوات دون الحاجة إلى التعامل مع أعراض وأمراض، وإنما نتيجة لحركية مستويات المشاركة فى الوعى لخطوات النمو استجابة لتفعيل الرغبة التلقائية فى إحياء الحركة وكسر الجمود ضد الابداع، ولهذا حديث آخر.
[1] – يحيى الرخاوى، “مقدمة فى العلاج الجمعى”، دار الغد للثقافة والنشر. 1978
[2] – Janowsky, David S. (1999). Psychotherapy indications and outcomes. Washington, DC: American Psychiatric Press. p. 100. ISBN 0-88048-761-5.
- M. & Dimeff, L. (2001). Dialectical Behavior Therapy in a nutshell, The California Psychologist, 34, 10-13.
[3] – أول مرة استعمل فعل تدالّكَ من ديالكتيك، وأعتقد أنه قد آن الأوان لنحته ربما نخرج من هذا المأزق.
تدالك، يتدالك، أى عايش وشكل الديالكتيك ومارسه فهو متدالك والاسم ديالكتيك!!.
الفصل الثالث عشر علاقة العلاج الجمعى بالدين
الفصل الثالث عشر علاقة العلاج الجمعى بالدين
الفصل الثالث عشر: علاقة العلاج الجمعى بالدين والإيمان (كثقافة)
ثقافتنا المصرية، وإلى درجة لا أعرف مداها: العربية، شديدة الارتباط بما جاء فى هذا العنوان، وقد كان العنوان الأصلى فى أصول الكتاب الأول هو: “علاقة هذا العلاج بالسياسة والدين”، إلا أننى قررت فى هذه الطبعة، وقد ألمحت فى ذلك الكتيب إلى مسألة الدين فى ثقافتنا من أبعاد أربعة هى:
(1) التصوف ومسيرة النمو الفردى،
(2) والتصوف الجماعاتى (الطُّرُق)
(3) والدين التواصل (المعاملة) ثم
(4) الفرق بين التدين والإيمان،
إلا أننى انتبهت الآن إلى أن كل هذا وغيره يندرج تحت ما يمكن أن نتعرف عليه كثقافة شعبية تدينية إيمانية لها حضورها الفاعل طول الوقت فى وعى المشاركين معالجين ومرضى، وخلال الأربعين سنة بين ظهور المقدمة (أصل الكتاب الأول) ومحاولة إكمال هذا العمل شغلتنى العلاقة بين الثقافة وشمول الإدراك ودوائر الوعى المتكاثفة والممتدة، ومن هنا جاء تغير العنوان مع أقل القليل من تعديل المحتوى.
أشرت فى مقدمة هذا العمل أننى تعرفت على ثقافة ناسى من خلال هذا العلاج أكثر مما تعرفت عليها عضوا فى لجان المجلس الأعلى للثقافة، أو من قراءاتى أو خبراتى الشخصية الطويلة، ثم إن الشريحة الاجتماعية التى اشتغلت معها هذا العلاج طوال هذه العقود الأربعة كانت أغلبها من الطبقة الوسطى (الشريحة المتوسطة والأدنى منها) وما تحتها حيث يمارَسَ هذا العلاج فى قسم الطب النفسى قصر العينى بالمجان، وقد وصلنى عن ثقافتنا من هذه الشريحة بالذات عن هذا البُعْد بوجه خاص ما هو هام، ودال:
لاحظت فى بلدنا هذا أثناء ذلك، وغير ذلك، أن ممارسة العلاج عامة، والعلاج النفسى خاصة والعلاج الجمعى بدرجة أكثر تخصيصا مرتبطة أشد الارتباط بهذا البعد الإيمانى الذى لا يتجلى فقط فى المعتقد أو العبادات، وأنه من أهم ما يمكن اعتباره “عاملاً علاجيا”، إن لم يكن الأهم، ظاهرا وباطنا، بغض النظر عن الالتزام بالتفاصيل!.
عبر نصف قرن، تكونت لدىّ فروض من واقع هذه الممارسة بوجه خاص، وأيضا من واقع تعرية وعيى فى مواجهة وعى مرضاى عموما، وبوجه خاص المرضى الذهانيين فى طور النشاط، تكونت فروضى متلاحقة، حتى بدت متكاملة، عن مستويات الوعى من ناحية، ومسيرة النمو الفردى فيما بينها إلى ما هو الوعى مفتوح النهاية من ناحية أخرى، وعلاقة هذا وذاك بالبيولوجى والإيمان، هذا بالعرض، أما بالطول فقد وصلتنى أكثر وضوحا وتكاملا جوهرية موقع “الإيقاع الحيوى” عبر تاريخ التطور توازيا مع مسيرة “النمو العلاجى” (تلخيصاً، وإعادة، واستعادة: رحلات النمو والتطور) كل ذلك وأنا أشارك وأتابع وأساهم فى تكوين ما أسميته “الوعى الجمعى”من خلال نشاط هذا العلاج: المجموعة تلو الأخرى، من هذا المنطلق تعرفت أكثر على الفرق بين “مسيرة الإيمان” وبين “معتقد التدين”، ركزت أكثر على الأولى (مسيرة الإيمان) باعتبار أنها أقرب إلى التعامل مع “الإدراك” ومع “النمو المتواصل عبر الإيقاع الحيوى” عبر (برنامج /برامج) الدخول والخروج.
كل هذا يحتاج إلى عودة منهجية تفصيلية مستقلة لا مجال للاستطراد إليها الآن، لكن كان من اللازم أن أشير إلى هذا البعد من حيث أنه يميز ثقافتنا بوجه خاص، وهى حاضرة طول الوقت فى ممارسة هذا العلاج الجمعى هكذا، وذلك حتى أعود إليه فى عمل مستقل متى سنحت الفرصة.
الخطوط العريضة – المتعلقة- أثناء ممارسة هذا العلاج:
أولا: إن الغالبية العظمى من مرضانا يتعاطون العلاج، بكل أشكاله، فى مجال الطب النفسى وغير النفسى (بما فى ذلك الجراحة!!) فى عمق معين من وجودهم بيقين مختلف الدرجات: أن “الله هو الشافى” بغض النظر عن نوع دينهم أو نوع مرضهم كما ذكرت.
ثانياً: إن هذا الاعتقاد ليس له علاقة مباشرة، فى أغلب الأحوال، بالعلاج الدينى (بالقرآن مثلا أو الرقى الشرعية أو المباركة الكنسية). بل إنه يمثل خلفية ثقافية فى كل الممارسة الطبية المهنية فى بلدنا بشكل عام، حتى لو لم نتحدث عنه أو نذكره صراحة.
ثالثاً: إن هذا الاعتقاد ليس معتقدا فكريا نظريا، ولكنه يقبع فى مستوى وعى غائر أشمل وأعم يمثل ما هو ثقافة عميقة “وشاملة” فى نسيج الوعى العام بشكل أو بآخر.
رابعاً: إن هذه الأرضية الثقافية ليس لها بالضرورة علاقة مباشرة، أو تناسب طردى، مع أداء العبادات اليومية، ولا مع الإلتزام بزى معين (مثلا: الحجاب أو النقاب للإناث) أو بمظهر معين (مثلا: إطلاق اللحى للرجال).
خامساً: بالرغم من ذلك، فإن استعمال الأبجدية الدينية، واللغة الدينية عامة أثناء العلاج، يظل طول الوقت محدودا، اللهم إلا إذا تطرق إليه أحد أفراد المجموعة كما فى ذلك المعالج عفوا، حتى أننا كنا سرعان ما نتحول عنه بحسم واحترام .
سادساً: إن السماح بالاختلاف شكلا وموضوعا كان ظاهرا وغالبا، وبرغم قلة عدد المشاركين المسيحيين إلا أن الاختلاف فى درجة الإلتزام الدينى التقليدى لم يكن مطروحا للمناقشة ولا كان غيابه حائلا دون عمق التواصل طول الوقت.
سابعاً: حين كنت أضطر إلى استعمال اللغة الدينية من أبسط صور حضورها مثل “ربنا موجود” إلى أعمق احتمالات تجلياتها، مثل مخاطبة ربنا “هنا والآن” بضمير المخاطبْ: مثلا أثناء لعبة من الألعاب” كنت أسارع بالتنبيه إلى أننى أشير إلى ربنا الحاضر معنا فى جلسة العلاج، فى حجرة العلاج، وليس إلى أى افتراض مغترب أو تجريدى أو ميتافيزيقى، ولم يعترض أحد من المتشددين حتى من دائرة المشاهدين أثناء المناقشات بعد الجلسة طوال هذه السنوات، ولم يبعدنا أى من ذلك عن “هنا والآن”، ولا عن المرضى أو المعالجين، بل ربما كان العكس هو الذى يحدث أحيانا حين تنجح المجموعة فى استحضار هذا الوعى الجمعى التصعيدى “إليه” بهذا الأسلوب المباشر.
ثامناً: تطور بى الأمر فى الأربع سنوات الأخيرة-تقريبا- إلى التعامل المباشر مع تجسيد حركية الوعى المتكونة فيما بيننا، فى وسطنا عادة، وهى التى عادة ما تتجدد رَأْىَ العـَيـْن فتقوم بدور أكبر فى توثيق التواصل بين أفراد المجموعة، حتى أننا كنا نستعمل أحيانا تعبير “اجتمعوا عليه وافترقوا عليه”، ونستلهم منه كيف أننا نلتقى حول “ما هو مشترك”، وحين نفترق إلى الأسبوع التالى، نفترق على “ما هو مشترك” أيضا تحت مظلة واسعة تصل إلى بيوتنا حيث نقيم، وحيث ربنا أيضا، وهى ممتدة تشمل الجميع دون ترتيب محدد، وذلك دون إحالة دينية تفسيرية مباشرة.
تاسعاً: كانت الحاجة إلى هذا التجمع الضام حول التخليق التنشيط المركزى للوعى الجمعى، تظهر أكثر فى مواقف عدم الأمان، فيتم استحضار هذا الوعى الجمعى مع احتمال تصعيده إلى ما بعده حاضرا، دون ألفاظ دينية عادة، ولكنا كنا نتبادل بعض الإشارات المحدودة إلى احتمال ارتباط ذلك بالوعى الفوقى فالأوسع فالممتد إلى غايته..، دون ذكر حدوده ولا إحالته للدين أو الإيمان بشكل مباشر.. الخ.
عاشراً: تأكد الشعور بهذا الرابط المشترك الأعظم (الوعى الجمعى) تدريجيا مع ممارسة التدرج فى توثيق تلك الوصلة التى تضمن فاعلية التواصل مع وعى أبقى وأوسع إحاطة وأكثر شمولا: يضم كل أفراد المجموعة غالبا، وهذا التواصل “بالعرض”، والمحتمل تصعيده “طولا” و”اتساعا” كان يبدو الأقرب إلى هذا البعد الإيمانى الحاضر تحت سطح الوعى الظاهر للمجموعة الممثلة لثقافتنا الشعبية خاصة الخاصة وقد تغلغل فيها أن الله هو الشافى.
حادى عشر: بدا أن مقياس حضور الآخر فى الوعى يتوقف بدرجة جوهرية على مدى حضور المشارك فى تخليق حضور هذا الرابط المشترك الأعظم والانتماء إليه من واقع ثقافتنا التى تربطه إلى ما هو “الله” بشكل أو بآخر، دون تسميته كذلك بالضرورة.
ثانى عشر: لم ينفصل ذلك عن إبداعية الوعى الثقافى الشعبى المرتبط بالدين الشعبى، مثل “أن الناس لبعضها و”إن الجنة من غير ناس ما تنداس“…إلخ
ثالث عشر: لاحظنا أنه كلما زاد الانتماء إلى هذا الوعى الجمعى (فى المجموعة) تراجع الاحتياج اللحوح إلى المبالغة فى التمسك بالعلاقات المعـِّـطلة مثل (الثنائية Pairing أو الطرح Transference)
رابع عشر: بدا أن الأمر لا يتعلق بدرجة التزام المعالج الدينية شخصيا بقدر ما يتعلق بموقفه من الممارسة الجماعية وحضور هذا البعد الثقافى فى طبقات وعيه المختلفة.
خامس عشر: ندر حتى كاد لا يظهر أبدا أى استشهاد بنصوص دينية محددة مثل الاستشهاد بآية قرآنية بذاتها أو حديث نبوى أو مقولة مقدسة، سواء من المعالج أو من المشاركين، بل إن مثل هذه الاستشهادات إذا ما ظهرت مصادفة كانت تـحَـجـَّم فورا، وأحيانا يـُـرفض التمادى فيها أو العودة إليها ما أمكن ذلك.
سادس عشر: وصلتنى شخصيا علاقة وثيقة بين حركية النمو التى أشرنا إليها بوضوح فى تناولنا لحركية تكون الديالكتيك المتصاعدة، وبين التواصل الحركى والإيقاعى مع هذا الوعى الجمعى فى حركته التصعيدية إلى وعى أشمل فأشمل دون استعمال اللغة الدينية مباشرة.
سابع عشر: توصلت إلى فروض لا أريد أن أتطرق إليها هنا الآن خشية سوء الفهم نتيجة الاختزال، لكننى أشرت إليها فى تناولى لحركية “الديالكتيك” من حيث أن حركية التصعيد بالولاف الأكبر فالأكبر نحو الواحدية من خلال ديالكتيك التعددية فالتشكيل يكاد يكون موازيا للنمو الارتقائى المسمى عند بعض الصوفية “الكدح” للوصول إلى ما يشبه الوجود شبه الآلهى، وقد حذرنا من استعمال مثل هذه اللغة كما فعل أبراهام ماسلو، حتى لا نُستدرج إلى ما شطح إليه بعض المتصوفة حتى كُفِّروا.
ثامن عشر: بدا أن برنامج الدخول والخروج In – and – Out Program سواء فى العلاقات الثنائية عبر هذا الوصل الثقافى (الإيمانى) أو فى علاقات الذهاب والإياب “مـِـنْ “و”إلى” الوعى الجمعى الذى يتكون وسط المجموعة وبها بالتدريج إلى الوعى الكونى وبالعكس، بدا أنه الأكثر تناسبا مع ما تتجلى به الطبيعة البشرية فى ثقافتنا فى مسارها المنتظم بين الوعى الشخصى والوعى الجمعى فالوعى الكونى بما قد تسهله العبادات الراتبة المتناغمة غالبا مع الإيقاع الحيوى الشخصى والإيقاع الحيوى الكونى بشكل أو بآخر.
تاسع عشر: كنا – ومازلنا – نتجنب فى المناقشات بعد كل جلسة علاجية، وهى مناقشات منتظمة تعليمية تدريبية، كنا نتجنب الحديث عن الحلال والحرام، وأيضا نتجنب محاولة الخوض فى أية تفسيرات دينية تقليدية أو إدعاء تفسير الجارى بنصوص دينية بذاتها دون رفض احتمال الربط التلقائى فى التلقى بين الوعى الجمعى والتصعيد الواقعى المحتمل “هنا والآن” ولكن دون مناقشته أو تفسيره أو الاحتجاج به.
عشرون: لم يحدث أى تعارض بين بعض اللغة الدينية المستعملة أحيانا (اضطرارا) وبين بعض مفاهيم التطور التى أنتمى إليها والتى كانت يمكن أن تعرض فى المناقشات بعد كل جلسة، وليس أثناء الجلسة نفسها من المشاركين فيها.
وبعد
أعتقد أن هذه الممارسة وتطورها بهذه الصورة لها علاقة بفروضى المتعددة حول هذه المسألة مثل فروضى عن “الأسس البيولوجية للإيمان”([1]) “والغريزة التوازنية الممتدة”([2]) “والموت كنقلة من الوعى الشخصى، إلى الوعى الكونى“([3]) أو باعتباره “أزمة نمو” وأيضا عن كثير مما ورد فى “ملف الإدراك”([4]) مما قد أعود إليه مستقبلا، (وآمل أن يصدر فى الكتاب الرابع من هذه السلسلة عن العلاج الجمعى).
فروض المعنى الإيقاعىحيوى للتسبيح
بدءا بالجماد إلى مطلق الغيب
أرجع اليوم مضطرا إلى محاولة أن أطرح بعض ما خطر لى من فروض، ما زالت تحتاج إلى دعم من ممارسين، أكثر من القراء والمفسرين والمنظرين، وأكرر مرة أخرى أننى ضد هذا الاتجاه المنادى بالتفسير العلمى للقرآن، مرة أخرى: فقرآنى الكريم من عند ربى لا يحتاج دعما من خارجه، خاصة مما يسمى العلم المؤسسى الذى اصبحت له آلهة غير إلهى الذى أكرم خلقه بهذا الكتاب الكريم وكل ما أنزل قبله وبعده، ومن فرط اعتراضى على هذا الاتجاه، تجسدت مقاومتى اليوم وهى تدعونى أن أتجنب مناقشة هذا الموضوع كلية حتى لا يساء فهمى، إلا أننى شعرت وكأنى أتخلى عن توصيل رسالة وصلتنى من واقع ما أتاحه لى ربى من فرص أثناء الممارسة، وأيضا أثناء محاولة الكتابة لسبر الطبيعة البشرية بما هو أقرب إلى ثقافتنا الخاصة.
الفروض
أولاً: لا بديل عن البدء من اللغة العربية بكل حضورها الحضارى العبقرى، وللأسف فإن المعاجم على روعتها وموسوعيتها – فى حدود ما وصل إلىّ – لم تستطع أن تستوعب كيف تخلقت ألفاظها وتراكيبها، وبالذات فيما يخص الإحاطة الأعمق بالظواهر المشتملة الحركية المتغيرة، سبق أن أشرت إلى ذلك وأنا أتناول لفظ “وجدان”([5])، وأصله “وجد” وأيضا فيما عرضت من أصول “الحزن”([6]) مشتقا من لغتى وتشكيلاتها، ثم فى تناولى ملف “الإدراك” Idrak وإحاطته واتساعه، وأخيرا فى لمحة موجزة عن “الإيمان” Iman، ثم ها نحن نواجه لفظا جديدا يمتد بأبعاده ليشمل الوعى المتخلق، والإيقاع المتناغم وهو “التسبيح” وقد عجزت عن تعريبه بحروف لاتينية!!!
الصعوبة تنشأ عندى فورا حين تبادر المعاجم بشرح لفظ آخر على أنه المترادف له، وقد علمنى أبى أنه لا توجد مترادفات متطابقة فى اللغات القوية، لأنه لو قام لفظ بوظيفته لما احتاج أن يتخلق منه أو بجواره مترادفًا له هو فى غنى عنه.
ثم انتقل مرغما إلى مادة “سَبّح”، فأفاجأ ابتداءً بأنه: “سبَّح = صلَّى”، لجأ إلى الصلاة” فأتوقف، وأتحرج وأقبل بشروط، ثم أواصل لأجد أن “سبح: قال سبحان الله” فأجدنى أمام باب مفتوح نسبيا أفضل من أن يغلق بالمترادفات والاختزال، ثم أفرح حين تفتح المعاجم ضلفة أخرى فتتناول مادة “سَبـَـح” (بفتح السين والباء دون تشديد) لتقربنى من الحركة والماء والعوم، ويفتح ذلك بابا أوسع، خذ عندك: (سبَح: نام وسكن)، و(سبحت النجوم: سارت فى الفلك “السابحات سبحا، ثم سبح فى الخيال”، فأجد كل هذا هو بعض ما وصلنى من اللفظ الذى أنا بسبيل التعرف عليه، وأرضى فى هذه المرحلة أن أكتفى بذلك.
فإذا انتقلنا إلى سبحان الله وجدت ما يشبه الإجماع على أن المعنى المراد هو “تنزيه لله”، وحين كنت أصغر مما أنا الآن كنت أتساءل: من أنا حتى أنزّه ربى العلى القدير، ولكن حين ألممت أكثر بأن التنزيه هو عادة عمّاّ يصفون، أحببت ربى أكثر، واستغفرته أكثر وأكثر، لكننى لم أقبل أن أقصر تسبيحه تعالى على هذا التنزيه، كما أنى تعجبت من كثير من التفاسير التى تقلب “سبح لله” إلى “سبح الله” وتصر على أن اللام زائدة!! بأى حق؟ يتخلصون منها باعتبارها زائدة؟! فيقفز لى ما أشرت فى حوار لى مع مولانا النفرى إلى فعل حروف الجرّ على اختلافها ([7]) بوعيى فى علاقتى بالله سبحانه.
ثانياً: ثم رجعت أستعين بفرضين شغلانى طوال العقود الماضية وكتبت عنهما بدرجات مختلفة:
الفرض الأول: هو ما يتعلق بالإيقاع الحيوى من أول التفاعل الكيميائى ومسار التيار العصبى فى الأعصاب إلى إيقاع الكون كله مرورا بالإيقاع الحيوى البشرى فى دورات النمو والنوم والأحلام، ثم الإبداع إلى ما بعده.
أما الفرض الثانى: فهو أن الإلحاد استحالة بيولوجية، من حيث تقديرى أن الخلية لا تستطيع أن تلحد، لأن وجودها الحى مرتبط بانتظام مكوناتها وتناسقها مع المكونات الأوسع فالأوسع إلى الوعى الكونى إلى ما بعده، وأن كل من يمكن أن ينكر هذا الاتصال وهذا الوجود فى البشر وهم الذين الذين يعتقدون أنهم ملحدون إنما يتحدثون باسم قشرة مخية تعمل ببرامج محدودة على الجانب الطاغى من النصف الكروى للمخ، وليس بكلية حضور خلايا أمخاخهم مجتمعة إليه.
انطلاقا من هذين الفرضين الأقدم قدرت أن هذه العلاقة التى تحفظ الحياة من خلال اتصالها بالنظام الكونى: فالله: هى مانعة للإلحاد البيولوجى أصلا، وبالنسبة للتسبيح فقد تصورت أن تناسق هذا النظام الأصغر فما بعده إلى غايته هو ما يقابل التسبيح الذى تقوم به هذه النظم، وحين احتج بعض من ناقشونى فى هذا الفرض الأخير بأنه يجعل الإيمان عملية تلقائية (أتوماتيكية) لا فضل للمؤمن فيها كنت – وما زلت – أبين أن الإنسان باكتسابه الوعى وحمل الأمانة أصبح مسئولا عن دعم هذه النعمة البدئية التلقائية والحفاظ عليها أو عن إنكارها ومحاربتها والاستسلام إلى نشوزها، ومن ثَمَّ تحمل مسئولية ناتج ما فعل بها.
ثالثاً: الفرض التالى الذى دعمنى جاءنى حين انتقل بى النظر إلى تناسق الذرات غير الحية حيث فوجئت مؤخرا – كما عرضت سابقا – فى الكتاب الذى أشرت فى الفصل السابق “عن التاريخ الطبيعى للذكاء” بمعلومات عن ذكاء النبات، ثم عن ذكاء الجماد الذى يحافظ على تجمعات جزئياته إلى بعضها البعض، كما أشرت إليه سابقا، وهنا قفزت إلى الآيات الكريمة التى تشير إلى تسبيح الجبال وغيرها فقدرت أن تسبيح المادة هذا هو الذى يحافظ على خصائصها وتماسكها لبقائها ونفعها وصلاحها.
رابعاً: على مدى أكثر من أربعة عقود وصلنى أثناء العلاج الجمعى احترام مطلق للتواصل بين البشر فى أجزاء من الثوانى، وبدرجات متناهية الصغر وعلى مستويات متعددة التصعيد، وهى تتفاعل جدلا حتى يتخلق من لقاءاتنا المنتظمة كيانا متجددا (وليس جديدا) وهو ما أسميته “الوعى الجمعى” والذى ميزته تحديدا عن كل من عقل الجماعة([8]) وعن الذكاء الاجتماعى([9]) ، فوجدت أن ما يجرى قبل وبعد وبجوار الكلام والتفكير هو الأهم، وأننا فعلا نخلـّـق ثم نجتمع حول “وعى جماعى” أرقى وأعمق وأشمل من الوعى الفردى، بل أننى انتهيت إلى أن هذا الوعى البشرى الجماعى هو الذى يعطى للبشر المعاصرين صفة البشرية فى صورتها الأحدث، وأن ما يجرى عكس ذلك إنما يهدد بتفريغ الإنسان من إنسانيته أى من فاعلية الوعى الجماعى البشرى وأسبقيته، فيمهد لانقراضه وهو يستبعد فرصته فى التسبيح بالمعنى المذكور حالا.
خامساً: من كل ذلك وصلت إلى “فرض التسبيح” الذى يقول:
* “إن التسبيح كما يصل إلينا هو حركية الوعى بتناسقية هارمونية متصاعدة تصل الوحدات (والأفراد) ببعضهم البعض ليتفاعلوا فى دوائر أوسع فأوسع إلى دوائر الوعى المطلق إلى وجه الله”.
* إن التسبيح هو برنامج معلوماتى يمكن أن يرجع إلى أصل الحياة، وبلغة الإيمان: إلى خالقها، وأنه يتصف بقدرته على تماسك الوحدات المكِّونة للوحدة لحفظ الاستمرار والتناسق والتفاعل مع وحدات أخرى فى امتداد نابض أبدا، مع درجات مختلفة من الوعى حسب موقع وطبيعة الكائنات: حية وغير حية.
سادساً: إن الصحة النفسية خاصة من منطلق النمو والتطور إنما ترتبط بمدى النجاح فى تدعيم هذا البرنامج على درجات وعى متنوعة، وبأسماء مختلفة غالبا بحيث تتحقق فاعلية التنسيق بكل البرامج التنشيطية الجدلية والإيقاعية دائمة القبض والبسط إلى غايتها.
وبعد:
رأيت إثبات آيات التسبيح دون شرح أو قراءة أو تفسير، أمـِـلاً أن يقرأها من يشاء فى إطار التقسيم الذى تراءى لى حسب الفروض السالفة الذكر، ثم قد نعود إليها لاحقا أولا نحتاج لأن نعود!!.
أولاً: التسبيح الذى يتجاوز الإنسان
- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً(الإسراء 44)
- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ … (الرعد 13)
- يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (الحشر 24)
- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (الجمعة1)
- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (التغابن 1)
- وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (الأنبياء 79)
- فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ( فصلت 38)
- سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الحديد 1)
- سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(الحشر 1)
- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (الإسراء 44) أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (النور 41)
ثانياً: التسبيح والهارمونى والإيقاع الحيوى
- فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً (مريم 11)
- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (الأحزاب 42)
- يسبح له بالغدو والآصال (النور 36)
- وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (الفتح 9)
- وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (الطور 49)
- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (طه 130)
- وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (طه 130)
- وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (غافر 55)
- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق 31)
- وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (ق 40)
- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (الأنبياء 20)
- وَمِنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (الإنسان 26)
- وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (آل عمران 41)
- فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ(الصافات 144)
- فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ(الأنبياء87).
****
تضعنا فروض التسبيح فى إشكالية منهجية ضخمة، لا تقتصر على غموض وتشعب تعريفات اللغة المستعملة وإنما تمتد إلى ضرورة تحمل البحث فيما نحتاجه أشد الاحتياج، وفى نفس الوقت لا نستطيع إثباته بالمنطق العادى العادى، برغم بداهة حتمية حضوره، وضخامة آثار ذلك.
هذا الفرض يستعمل لغة قديمة/جديدة حين يتكلم عن تناسقية هارمونية الحياة المتصاعدة، بل حين يتكلم عن الوعى أصلا، ثم يمده عرضا إلى “دوائر الوعى” الممتدة المتضاعفة بلا نهاية، ويغوص به طولا “فى امتداد نابض متجدد”، بما فى ذلك الإشارة الضمنية إلى أن “المادة” قد يكون لها ما يسمى الوعى، مع التذكرة بالمباحث الأحدث جدا التى تتكلم مؤخرا عن “وعىٍ للحاسوب”، ووعى الجماد ووعى النبات، كما أشرنا سابقاً.
تطورات الفكرة ودعائمها
هذا الفرض لم ينبع من فراغ فبمجرد أن تكلم “توم ستونير” صاحب كتاب (التاريخ الطبيعى للذكاء) عن ذكاء الجماد حتى وجدت أنه من الأفضل أن أبدأ بالعام ثم الخاص.
أولاً: إن التسبيح لا يحتاج إلى ذكاء إلا بالمعنى الذى ورد فى التاريخ الطبيعى للذكاء.
وثانياً: إن هذا ليس تفسيرا علميا للقرآن كما اتفقنا.
وبعـد
إن ما وصلنى مما يجرى فى العلاج عامة، والعلاج الجمعى بوجه خاص، وبالذات فيما يتعلق بثقافتنا الإيمانية والشعبية المتميزتين، هو مرتبط تماما بما اسميته تخليق الوعى العام، وعلاقة ذلك بالتواصل المتناغم مع مستويات الوعى المتعددة والمتصاعدة، سواء مستويات الوعى البين-شخصى الثنائى، أو مستويات الوعى البين جماعى المتعدد، أقول إن هذا الذى وصلنى كان هو مصدر الهامى بالمعنى المتعدد للتسبيح من كل هذه المصادر بكل هذه المستويات التى لا يجمعها إلا توحّد بؤرة التوحيد، واتفاق “التوجه” بكل لغة من كل حدب وصوب.
على أنه من الضرورى التأكيد على أن نفس العملية تجرى فى ثقافات أخرى بنفس الآلية لنفس الهدف فى العلاج الجمعى وغير العلاج الجمعى، ولابد أنها تسمى تسميات مختلفة، وعلينا أن نحترمها ونحن نتمسك بثقافتنا، وننطلق من خبرتنا، ونتكلم بلغتنا، نلتقى حتما متى صدق العزم.
ولا أستبعد بُعد الرقص الإيقاعى، والذِّكر الشعبى.
[1]– يحيى الرخاوى، مجلة سطور، الأسس البيولوجية للدين والايمان، عدد يوليو 2004
[2]– يحيى الرخاوى، حركية الوجود وتجليات الإبداع، المجلس الأعلى للثقافة، 2007
[3]– يحيى الرخاوى، “الإنسان والتطور”، الموت: ذلك الوعى الآخر، بتاريخ 5-1-2008
[4]– يحيى الرخاوى، “الإنسان والتطور” ملف الإدراك من (10-1-2012 إلى 10-3-2013)
[5] – سبق لى محاولة مراجعة ونقد ثلاثين تعريف (بالإنجليزية) لما هو انفعال، أو عاطفة مبينا قصورها جميعا عن الوفاء بتحديد الظاهرة المعنية، وحين لجأت إلى استعمال لفظ “وجدان” تبين لى أنه لفظ أكثر احتواء، وأدق نبضا من أغلب الألفاظ المقابلة فى لغات أخرى، حتى أننى اقترحت نقله كما هو إلى اللغات الأخرى متى ما نجحنا فى استلهام ما يمكن أن يحدد الظاهرة التى يحتويها، أو يشير إليها، انطلاقا من موقعه فى لغتنا نحن، وحينذاك (كما اقترحت) سوف يكتب معربا عن الإنجليزية هكذ “وِجْدَان” Wijdan “دون ترجمة” (مجلة الإنسان والتطور الفصلية– السنة الخامسة – ابريل 1983 ص 108 – 150)
[6] – يحيى الرخاوى “الإنسان والتطور اليومية” “عن الوجدان، والحزن” بتاريخ 18-11-2007
www.rakahwy.net
[7] – يحيى الرخاوى، “الإنسان والتطور” حوار مع مولانا النفرى”: 9-11-2013 “حروف الجر، وحركية الكدح” www.rakhawy.net
[8] – يحيى الرخاوى “الإنسان والتطور”، ماذا يحدث بالضبط مما هو ضد “جماعة القطيع”؟ 2-6-2013
[9] – انظر الفصل الثالث “والأصل فى الوحْداتِ أن تُجَمَّعا” ص 37
الفصل الرابع عشر العلاقة بين العلاج الفرد والجمعى
الفصل الرابع عشر العلاقة بين العلاج الفرد والجمعى
الفصل الرابع عشر: العلاقة بين العلاج الفردى والعلاج الجمعى
هذه خبرة سلبية تعتبر نادرة، لكنها واقعية وهامة إذ تعرّى الفرق بأسلوب ساخر بحذر من الاسراع بتصور وجه شبه أكثر مما يحتمله الواقع، وفيما يلى الخطوط العريضة لهذه النقلة بالنسبة لى ص 24، وما بعدها (الفصل الثانى) ثم أضيف الآن:
1) بالنسبة لخبرتى الشخصية التى مهدت لممارستى العلاج الجمعى، ذكرت فى الفصل الثانى مراحل ذلك، وضرورته، وأنصح بالرجوع إليها.
2) لا ننصح عادة بأن يمر المريض بمرحلة العلاج الفردى قبل العلاج الجمعى، ولا يشترط ذلك.
3) لا نرفض أن يلتحق مريض مرّ بمرحلة العلاج الفردى بالعلاج الجمعى، سواء يكون قد حقق من خلاله ما أراد هو أو معالجه، أو كانت النقلة نتيجة لنوع من الإحباط قل أم كثر.
4) تعتبر النقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى أزمة نمو بشكل أو بآخر، لأن ما اعتاده المتعالج فرديا من السرية، وطلاقة البوْح، وخصوصية العلاقة، هو على النقيض مما يحدث فى العلاج الجمعى غالبا، ويمكن تشبيه هذه النقلة بالنقلة من العلاقة الثنائية التى يعيشها الرضيع منذ الولادة مع أمه، إلى العلاقة الأخوية والأسرية التى يمارسها تدريجيا بعد ذلك، لكن النقلة فى العلاج من العلاقة الثنائية إلى العلاقة الجمعية تكون أكثر تأزيما وصدْما.
5) ليس بالضرورة أن يكون المعالج الفردى السابق هو أحد المعالجين فى المجموعة التى التحق بها المريض المنتقِل، بل إن الغالب ألا يكون هو هو، وإن جاز غير ذلك.
6) يحتاج الأمر إلى التدرج مع المريض المنتقل من الكلام إلى الفعل، ومن الحكى إلى المواجهة، ومن الماضى إلى الحاضر، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول مما يحتاجه المريض الذى دخل إلى العلاج الجمعى مباشرة.
7) أحيانا قد يحتاج بعض المرضى أثناء العلاج الجمعى، إلى جلسات فردية تدعيمية محددة، خاصة فى فترات المرور بمأزق حاد، أو ظهور أعراض جديدة، أو ظروف جديدة تحتاج إلى دعم خاص، ولكن يراعى ألا تطول مدة هذا الاستثناء.
8) ينصح عادة أن يكون المعالج الفردى في هذه الحالات هو أحد المعالجين فى المجموعة.
9) يكون اللجوء إلى الدعم بالعلاج الفردى فى حالات الاضطرار إلى ذلك مثل المرور بمأزق بالغ الشدة بسبب جرعة التغير “المشى على الصراط”، Passing into fire ولا يكون بديلا عن العلاج الجمعى وتحدد له مدة محددة يتفق عليها حسب حدة المأزق أو الظروف الطارئة.
10) إذا تعذر أن يقوم بالعلاج الفردى أحد المعالجين فى المجموعة، فلا بد من تعاون شبه إشرافى (إشراف القرين) بين المعالج الفردى والمعالج الجمعى للفترة المحددة لمثل هذا الاستثناء.
11) لاحظنا أنه فى حالات تزامن العلاج الفردى مع العلاج الجمعى لمدة طويلة، يمكن أن تجهَض النقلات التى تتم فى العلاج الجمعى، ما لم يكن المعالج الفردى متابعا لمراحل نمو المجموعة، وهذا الفرد في المجموعة بشكل خاص، ذلك لأنه قد يتمادى التحاور فى العلاج الفردى كلاما وتفسيرا إلى درجة العقلنة، والبعد عن الـ”هنا والآن”، وهو ما قد يفسد ما تم إنجازه فى العلاج الجمعى .
12) تعتبر المتابعة الفردية المتباعِدة نوعا من العلاج الفردى قصير الزمن، وتسرى عليها ما يسرى من ملاحظات سالفة الذكر فيما يتعلق بالعلاج الفردى عموما.
13) إذا لزم الأمر، يستعان فى كل الحالات وحسب كل حالة، تشخيصا، ومأزقا ومرحلة علاج (نمو) : بالعقاقير المناسبة، بحسب ما ذكر فى الفصل الخاص بعلاقة العقاقير بالعلاج الجمعى، حيث تسرى المبادئ العامة على العلاج الفردى، (وأيضا على العلاج عامة).
14) لا توجد قاعدة تقول : إن العلاج الجمعى أفضل من العلاج الفردى، أو العكس، فكل حالة مرهونة بكل ظروفها فى أوقات مختلفة.
15) التنقل المتكرر فيما بين العلاج الجمعى والعلاج الفردى غير مفيد، بل هو ضار، ولا يعتبر ضمن إيجابيات ما يسمى “برنامج الدخول والخروج”In-and- out- program
16) ليس مهما أى أنواع العلاج الفردى تسرى عليه كل هذه القواعد، لكن الملاحظ أن هذه المدرسة تعد العلاج السلوكى والمعرفى، خاصة المتضمـَّن مع التأهيل أو العلاج الفردى، متمما للعلاج الجمعى، فأحيانا يشترط فى العلاج الجمعى، منذ البداية، أو فى مرحلة باكرة ، أن يمارس المريض عمله العادى تحت كل الظروف، وأحيانا يتخلل أيام الاسبوع تردد محدود على مستشفى نهارى مع تواصل منتظم بين المنظومتين، وهكذا
17) العلاج الفردي الذى يكاد يكون مناقضا للعلاج الجمعى الذى نمارسه هو التحليل النفسى التقليدى، وهذا ليس مرادفا للعلاج الجمعى من منظور التحليل النفسى.
18) الذى يساعد فى النقلة الضرورية من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى هو الالتزام المتدرج حتى الإلزام شبه الدائم بمبدأ “هنا والآن”
19) نحن نبدأ اللقاء في العلاج الجمعى بسؤال يطرح على الجميع يقول “مين اللى عايز يشتغل”، ونصر على استعمال كلمة “يشتغل، حتى نفرّق بينها وبين “مين اللى عايز يتكلم”، ويكاد هذا يعلن ومن البداية أهم الفروق بين العلاجين
20) يحدث الطرح Transference فى العلاج الجمعى مثلما يحدث فى العلاج الفردى، خاصة إذا كان قائد المجموعة من النوع جاهز الحضور المتداخل معظم الوقت، ولكن الطرح وارد فى العلاج الجمعى مع غير القائد، فيما يسمى “الثنائية” Pairing ، ويـُحَل الطرح داخل المجموعة باحتوائه والتفاعل من خلاله بآليات العلاج الجمعى العادية، ويكون حله أسهل فى العادة، ما لم تحدث مضاعفات خارج المجموعة.
21) بعد انتهاء مدة المجموعة بانقضاء الزمن المتفق عليه (فى خبرتنا اثنا عشر شهرا) لا يوصى عادة لأى فرد بذاته، باستكمال علاجه إذا لزم الأمر بشكل محدد، علاجا فرديا، أو فى مجموعة جديدة، أو بامتدادا التأهيل ..إذا لزم الأمر بشكل ليس له بديل، وذلك خوفا من إهدار ما تم إنجازه فى العلاج الجمعى.
وبعد
هذه النقلة من العلاج الفردى عايشتها عاجزا مع أحد مرضاى من طلبة الطب حتى تخرج طبيبا، وهو متمسك بسلبياتها بشكل أثارنى حتى صورتها شعرا به قسوة وتعرية لإبن عزيز كان موقفه وهو ينتقل متحمسا من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى، مثيرا للنقد حتى قفز منى هذا الشعر بكل هذه القسوة الساخرة.
الفصل الخامس عشر نقلة من العلاج الفردى للجمعى
الفصل الخامس عشر نقلة من العلاج الفردى للجمعى
الفصل الخامس عشر: نقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى (خبرة سلبية لحالة واحدة)
الحالة:
تكاد تكون هذه الحالة تطبيقا مباشرا، يكاد يعرض مقارنة حادة بين العلاج النفسى الفردى التسكينى بالكلام، وبين العلاج الجمعى المواجهى النمائى، Confrontation Growth-Oriented Group Therapy
هذه الحالة بوجه خاص، كانت لها تاريخ طويل معى فى العلاج النفسى الفردى، أنجزتْ من خلاله درجة معقولة من التكيف، والتسكين حتى تخرّج صاحبها من كلية قمة (الطب)، واختفت الأعراض البادئة. ثم إنه قرر بوضوح أن يواصل فى العلاج الجمعى، باعتبار أنه مرحلة لاحقة تفيده فى استكمال النمو، حسب ما سمع، خاصة وأنه – بتخرجه – لم يعد فى حاجة إلى جرعة زائدة من آليات الدفاع العامِية، وقد كان صادق النية فى أن يحاول وأن يكمل.
الذى حدث هو العكس تماما، فقد عرّت تجربة العلاج الجمعى المواجِهِى الجرعة المفرطة من الاعتمادية التى ربما اعتادها صاحبنا أثناء العلاج الفردى، وقبله، لكنه اصر على مواصلة المحاولة معنا فى العلاج الجمعى، وكلما تقدم فيها، تأكد لى تماديه فى موقف “المتفرج” دون مشاركة، وازدادت ميكانزمات العقلنة والاعتمادية، حتى صار واضحا للجميع أنه لا ينوى أن يتقدم، إن لم يتراجع.
كان صاحبنا شاطراً تماما فى وصف ما به، بل وما بغيره، كما كان حاذقا فى الإعجاب بما يجرى حوله من محاولات وتجارب، ومفاجآت مخاطر، لكنه كان دا ئما يحمى نفسه بمزيد من الطلبات من موقف سلبى اعتمادى متلق، بلا محاولة جادة من جانبه لأى حركة نحو التغير الكيفى الحقيقى.
كان صاحبنا مثابرا منتظما فى حضور اللقاءات كلها تقريبا، دون أى تغيير من جانبه، وحين تكررت المواجهة، وتعرى موقفه أكثر فأكثر، بدأ العدوان الاحتجاجى يحل محل المقاومة الاعتمادية، ليختم تجربته بالاحتجاج على قائد المجموعة، معالجه القديم، وكان احتجاجه موضوعيا منبِّها، مؤكدا ما ذهبنا إليه فى العلاج النفسى بأنواعه، من ضرورة ضبط جرعة الرؤية الجديدة، لتتناسب مع فرص احتوائها ، وظروف واقعها، على مسار النمو،
اسمحو لى أن أختم هذا العمل بطرح هذه الحالة كنموذج، وسوف أبدأ بإثبات المتن الشعرى (بالعامية) ثم ألحقه بالشرح أولاً بأول.
(1)([1])
والعيون التـَّانـْيـَه دى بتقول كلامْ،
زى تخاريف الصيامْْ؛
الصيام عن نبضِة الأَلـَم اللى تِـبْنى،
الصياْم عن أىَّ شئ فيه المُـغـامْـرَهْْ،
الصيام عن إن لازم كل بـنِـى آدم لازمْ يـِفَتّح،
مش يتنَّـح
الصيام عن أى حاجة فيها إنى: عايز أكونْْ:
زىّ خلقةْْ ربنا”
مسألة أن أكون “زى خلقة ربنا” تكررت كثيرا فى هذا العمل، وأنا – بصراحة – لا أجد لها بديلا ، حتى كلمة “الفطرة” أجدها بديلا أكثر غموضا فعلا من: “زى خلقة ربنا”
يتحفظ العلماء عادة على هذه اللغة، وربما عندهم حق، فما أن تنطق بهذا التعبير “زى خلقة ربنا” أو “كما خلقنا الله” حتى ينبرى أهل السلطة الدينية ليستولوا على كل ما بعد ذلك لصالح تعميق سلطتهم، وليس لصالح إطلاق المسيرة البشرية لتكمل مشوارها “إليه”، وأيضا ينبرى العلماء المنهجيون يتهمونك بالقفز وراء الحقائق العلمية المحددة إلى ما يسمونه الميتافيزيقا، الذى أقصده، وغالبا يقصده الناس البسطاء، بهذا التعبير، هو أن يكون الإنسان إنسانا، كائنا متميزا، يحمل تاريخ تطوره كله، لا يلغى أوله لصالح آخره، ولا يطلق لأوله العنان على حساب مكاسب تطوره، هذا ليس حلا توفيقيا وسطا، لكنه تاريخ الحياة وتاريخ الإنسان، هو الحركة الدائبة، المتناوبة، لتحقق الجدل فى دوراتها المتعاقبة، هذا تحديدا ما أتصور أن الحق تعالى من خلال التطور قد هيأه لهذا الكائن البشرى الفائق الرقى، الظالم نفسه برقيه المنقوص.
حين يقول المتن إن صاحبنا قد أغلق وعيه فَصَام عن أى احتمال أن يكون كذلك، فإن المقصود، (وهو الذى حدث فى هذه الخبرة) أنه راح يقاوم كل محاولة تفاعل يمكن أن تهز ما استقر عليه من دفاعات مجمّدة، وبالذات تلك الدفاعات التى يبدو أنها قويت أثناء العلاج الفردى، حتى انتهت الخبرة (القصيدة) بأن يضع اللوم على قائد المجموعة (هو هو معالجه السابق) وهو لا يتحرك من موقعه، خوفا من: “نبضِة الأَلـَم اللى تِـبْنى“، من “أىَّ شئ فيه المُـغـامْـرَهْْ”، من الرؤية الجديدة: “إنّ لازم كل بـنِـى آدم يـِفَتّح، مش يتنَّـح”.
… حين يرفض لسان حال هذا الصديق أن يكون “زى خلقة ربنا”، فإن هذا يعنى أنه متمسك بميكانزماته التى اكتسبها لتحميه من التهديد بشطح غير محسوب على مسار النمو، هذا ليس عيبا ولا نقصا فى مرحلة معينة، خاصة إذا كان قد تدعم بخبرة العلاج الفردى أما أن يكون هذا هو نهاية المطاف، فهو الامر الذى نتوقف عنده، ونتعلم من مثل هذه الحالة أن المسألة ليست كذلك.
بعد هذه الخبرة صرت حين أتيقن من مثل هذه الحالات أن موقفها صلب وحاسم، أتراجع عن الحماس للنصح بالعلاج الجمعى خاصة، وأحيانا، ولو أنها نادرة، أنصح مثل هذا الشخص بالتوقف فعلا عن المشاركة فى علاجات تعرضه لما ليس فى حسبانه، نعم، أن يتوقف عن التردد على هذا النوع من العلاج النفسى، لكن الذى يحدث عادة هو أن يصر مريضٌ ماَ على أن يخوض التجربة، وله كل الحق، وفى هذه الحالة أستسلمُ للانتقاء الطبيعى، فكم من مريض تصورت أنه لن يتحمل أن يكمل معنا المسيرة، وإذا به يفعلها ونصف، وكم من آخر بدا متحمسا جاهزا للتغير، لكن ما إن تبدأ الخبرة حتى يتراجع بسرعة إلى دفاعاته المتينة تماما، حتى ينقطع عن العلاج المهدد بخلخلتها.
أهم صفة تصف هذه الوقفة للحالة المعروضة فى هذا الفصل هى الاستسهال وتجنب الألم وتصور العلاج تصورا سحريا يحل المشاكل بدون ألم (بالبنج الدفاعاتى)،
ورغم انبهار صاحبنا الكلامى بما يجرى، وإعلانه البدئى أنه يريد أن يكمل المسيرة، إلا أنه، ومن البداية، راح يحدد طريقه الذى يؤدى به إلى عكس ما يعلن دون أن يدرى. هذه الصورة الاعتمادية المرفوضة من حيث المبدأ لها ماوراءها من مبررات، أهمها، وفى هذه القصيدة بالذات: تجنب الألم مهما ضؤلت درجته، …. إن الذى مر بجرعة مفرطة من الألم (يحدث ذلك عادة فى بداية أزمات التطور الحادة أو بداية الخبرة المرضية) ثم لم يجد أحدا بجواره، ولم يجد دفعا بداخله لتحمله أو تجاوزه، ثم لملم نفسه بدفاعات أيا كانت، إن من مر بمثل هذه الخبرة يأبى – عادة – أن يعود إليها تحت أى إغراء، ولو رأى أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة دفع الخطى على مسار النمو. لكن العجيب فى مثل هذه الأحوال أنه لا يستسلم لدفاعاته – مثل أغلب العاديين – بل يظل يتصور أن فى الإمكان أن يحقق أمنيته نظريا، بجرعات جاهزة من الهدهدة والتفريغ والحمل (أن يحمله آخر) والاعتمادية. ويظل الموقف هكذا طول الوقت، كما تبين القصيدة: لا هو يكف عن إعلان المحاولة دون محاولة، ولا هو يحاول فعلا، ولو بأى درجة كانت، صاحبنا كان يبدو، دون بقية المجموعة، مرتاحا، حالما، مستقرا، لكنه دائم الإعلان عن نيته فى المشاركة، ولكن بشروطه.
(2)
العيون دى صرّحت إن صاحبنا
عمره ما حايعلن يسيبنا
بس شرطه يْـتّنه نايمْ فى العسل، عمال بيحلَم،
بَسْ عامل نفسه بيحاول، ويتكلمْ، ويحكُـمْ،
شرطِ إنه لمْ يخطّـى أو يِسلّـمْ
مشْ على بالُه اللى جارِى،
”كل همّه، يستخبَّى أو يدارى”.
وان وَصلُّه، غَصْب عَنُّهْ
يترمى سْطيحَهْ ويُطْلُبْ حتّه مـِنُّـهْ:
شرط إنه يجيله فى البزازة دافْيَةْ، جَنْب فُمُّهْ.
أعتقد أن هذا الجزء من المتن، هو المقابل الشعرى المباشر لما سبق شرحه حالا قبل عرض النص كاملا، إن الذى كان يميز هذا الموقف بوجه خاص هو إلحاح صاحب هذه العيون لإعلان “نيَّتِه” فى المشاركة، وفى نفس الوقت طلبه المباشر أن يعطيه أحدهم ما يتصور أنه حقه دون سعى من جانبه إليه.([2])
هذه الرؤية المعقلنة هى مكافئة تماما للعمى الكامل، “مش على باله اللى جارى”، لأنها رؤية مع وقف التفيذ إلا بهذه الشروط التى هى ضد كل قواعد ما يسمى “مسيرة النمو”.
مرة أخرى: إن مما يستدعى العجب هو تساؤل يقول: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يصر صاحب كل هذه الدفاعات القوية، على استمرار المحاولة بهذا الإلحاح والانتظام فى طَرْق الأبواب؟ بالرغم مما يصله من صعوبات، وما يرى من مشقة وألم لازمين للخوض فى التجربة؟
إن التفسير الأقرب هو نجاح آلية (ميكانزم) العقلنة بشكل فائق بما يجعله يواصل الرصد لما يجرى من على مسافة آمنة، بحيث يصبح العقل النشط المتفرج مصدًّا قويا طول الوقت، ضد التغير، ويصبح صاحبه غير مهدد فعلا بالتغير الفعلى، فهو لذلك يواصل المطالبة بالتغيير ألفاظا منطوقة لا أكثر.
لكن هل هذا هو كل ما فى الامر؟ فى هذا الشأن نتذكر أن:
أولاً: المسألة لا تقتصر على هذه القناة للتوصيل بالكلمات والرموز المعقلنة، فالجسم يتلقى، والوجدان يتلقى، والوعى – بمستوياته – يتلقى، ومن هنا تأتى أهمية البيت فى المتن الشعرى: “وان وصل له غصب عنه”، نعم الذى يحدث أن الرسائل التى تصل لمثل صاحبنا هذا، تصله من وراء ظهره، تصله فعلا غصبا عنه، وهو لا يرفضها بل يمحوها فورا بعكس ما نتصوره، يمحوها بأن يتقبلها ويطلبها من الوضع مستلقيا رضيعا، “وان وصل له غصب عنه، يرتمى سطيحة ويطلب حتة منه”!!!
ثانيا: فى هذه المرحلة يستغنى صاحبنا عن فعل التغيير بمتابعة كل ما يجرى، وبالتالى يتجنب مواجهة داخله وكأن أفراد المجموعة تحقق بالنيابة عنه أمانيه وتحل صراعاته أما هو فيتصور أنه “عرف” الحكاية فلا توجد مشاكل ولا خطوات بعد ذلك.
ثالثا: فى نفس الوقت يجد صاحبنا نفسه فى موقف المقاومة العنيفة بإعلان “عدم الفهم” متى ما اقتربت الرؤية الذاتية منه، أو تهدَّدَ بضرورة التفاعل.
رابعا: هذا لا ينفى أبدا أنه ربما يصله ما يغيرّ تركيبه ولو من خلف ظهره.. أو من خلال ما يسمى الانتباه السلبى، فلا خبرة بهذا الجدية يمكن أن تـُهْدر بلا جدوى تماما حتى ولو توقف وصولها عند مرحلة التنظير والعقلنة.
خامسا: وبسبب هذه الزحمة من المتناقضات: (مثل الحضور مع المقاومة، والفرجة برغم الاستيعاب السرى) يستمر هذا الموقف ربما إلى أجل غير مسمى. (كما حدث فى هذه الحالة) وينبغى على المعالج أن ينتبه إلى ذلك كله وأن يتعامل معه على هذا الأساس فى حينه، رحت أوصل قراءة موقفه من عيونه وكله أكثر من كلماته:
(3)
كان صاحبنا حلو خالص فى الكلام
كان بيتفرج، وهوه بعيد تمام،
كل ما ندّيلُه حتـّه، يترسم ويقول كمان.
عايز أخطى، بس شرطى، فى الأمان
كان مركـِّـز عاللى كان واخد عليه
لما كان بيحكَّى للى شافُهْ “بيهْ”:
كلٌّه “مين”، و”زمان” و”ليه”!!
شيخ طريقة أو حكيم ما اعرفشى إيه،
……….
……….
بس دِى ياناسْ لقاهـَا حكاية تانية ـ
يعنى شغل “هنا” و “حالا” كل ثانية
كل ما واحد يهمّ
نـِفـْسـُه يعنى يهم زيّه، بس لأْ، من غير ألمْ !!
يقلب الخبرة مشاهدة كإنه فيلمْ:
………..
قالُّهْ سمَّعْنَا كمان حبّةْ نغَمْ:
كِيدِ العدَا،
يا سلامْ!! هوا جوّاك كلّ دا!؟
أنا نِفْسِى ابقَى كده!!
بس حبُّونِى كمانْ.
حُط حتَّهْ عالميزان.
أصلِى متعَّود زمانْ:
إنى انام شبعان كلامْ.
تأكيد جديد لنفس الموقف، بتشكيلات متنوعة لموقف المتفرج، الذى انفصل عن المشاركة حتى بدا مستلذا بألم الذى يحاول، “بس سمعنا كمان حبة نغم”.
ليس هذا فقط، بل إنه يبدى إعجابه بالمؤدِّى، “يا سلام!! هوه جواك كل ده!!”، وأمنيته (الكلامية) أن يتقمصه “أنا نفسى ابقى كده”
هذا الموقف يعتبر أكثر سلبية بكثير من موقف الشخص الذى رضى بالعادية، أو بفرط العادية كنهاية للمطاف، فصاحبنا هنا لا يرفض المحاولة كما قلنا، لكنه حتى وهو يعلن أنه يتمنى أن يمر بمثل ما يمر به هذا المتقلب على جمر الحقيقة، يلحق نفسه بما يكشف أن هذا التمنى نفسه هو الذى يخدعه ويحول بينه وبين المحاولة الحقيقية، فهو يلحق أمنيته فورا بأن يمد يده “متسولا”: بس حبُّونِى كمانْ. “حُط حتُّهْ عالميزان”
وهو يعزو ذلك إلى خبرته السابقة فى العلاج الفردى الكلامى التسكينى التأويلى،
“أصلِى متعَّود زمانْ: إنى انام شبعان كلامْ.
الذى حدث ان المجموعة وقائدها انتبهوا إلى كل هذه السلبيات التى جعلت وجود صاحبنا مثيرا للدهشة من ناحية – لماذا يستمر؟- ومانعا للمشاركة الزائفة السطحية التى كان يمثلها أصدق تمثيل حتى أن الباقين لم يكتفوا برفضه، بل خافوا ورفضوا أن يسلكوا سبيله.
المقطع التالى يمكن أن نقرأه على لسان حال المجموعة، أو على لسان حال قائدها وهى تبدأ بتنبيه صاحبنا أن يكف عن التسول ويشرع فى المبادأة، إن كان صادقا فى أنه “أنا نِفسى ابقى كده”.
ويتكرر الموقف وكأنه سوف يهم أن يفعلها، لكن سلوكه، وإعلانه، وإصراره على التمسك بموقع المتلقى طول الوقت، يكشف نفسه بسرعة هائلة:
قام صاحبنا بانْ كإنه مشْ مِمَانـِعْ،
بس قاعد ينتظر “بِنجِ اللذاذة”،
كـلّه دايب فى الإزازة”
هذه الفقرة بالذات، وتعبير بنج اللذاذة، كله دايب فى الإزازة، هى من أصرح الفقرات نهيا عن المفهوم الشائع: ان العلاج النفسى هو ترييح وتسكين وتفريغ، معظم المرضى، وأهلهم أكثر منهم لا يطلبون من الاستشارة النفسية، أو العلاج النفسى وبالذات فى البداية إلا “أن يرتاحوا”، وقد ناقشنا ذلك فى هذا العمل وغيره مرارا، ونكرر هنا أن هذا حقهم، ولكن ليس على حساب رحلة نموهم. كل هذا لا يعنى أن يمتنع المعالج أن يعطى جرعة “الترييح ” الضرورى بين الحين والحين، وخاصة فى البداية، ولو على سبيل الرشوة حتى تستمر مسيرة العلاج إلى أن يعاد التعاقد لدفع عجلة النمو.
وإذا كان “الترييح” وارد كهدف فى العلاج الفردى، فإنه ليس كذلك فى العلاج الجمعى إلا كنتيجة مختلفة نوعيا عن معنى التسكين.
راح صاحبنا معرّى جوعه، نطّ كل اللى مْدَارِيهْ
عرضحال كاتب جميع ما نـِفـْسُه فيه:
“.. بعد موفور السلامْ،
نِفْسِى حبِّةْ حُبْ .. أو حتِّةْ حقيقهْ،
نفسى أفْهَمْ فى اللى جارى ولو دقيقهْ،
نفسى أعرف فى اللى بتقولوا عليهْ،
نفسى اشوف دا إسمه إيه”
موقف صريح آخر لإعلان التسول، لكن التسول هنا يتجاوز تسول الحب، فهو يتسول أيضا المعرفة، فهو يدرك – من بعد أعمق – أن كل رؤيته لحقيقة الجارى، ولألم الذى يحاول أن يخوض التجربة، ليست إلا رؤية زائفة، بل إنها يمكن أن توصف بأنها حتى: “ضد الرؤية”، وقد عرى المتن الشعرى ما بداخل صاحبنا حين يقرن تسوله للحب، بتسوله للحقيقة، ويلحق ذلك مباشرة بإعلان جهله بما يجرى حوله برغم كل مزاعمه أنه يراه ويعرفه، وبالتالى يطلب منه، ويحاول أن يكونه، بل إنه يعترف أن كل الأسماء التى أطلقها على هذه الخبرة أو الخبرات، غير كافية للإحاطة بها:
“نفسى أعرف فى اللى بتقولوا عليه، نفسى أشوف دا إسمه إيه”.
فى خبرتى كنت أترك مثل هذا الشخص وكأنى أهمله، لعله يستثار من بعيد لبعيد، وبعد فتره تطول أو تقصر حسب حساباتى أحاول بداية الحوار معه، ومن ثم الأمل فى التفاعل، ولكنه فى العادة يعود يكرر الكلمات الجارية فى المجموعة .. دون إحاطة كافية بمضمونها، أو تحمل مسئوليتها، أو حتى محاولة احترام حفزها.
الذى حدث – كما قلنا سابقا- أن المعالج وهو هو الذى كان معه فى العلاج الفردى ظهر وهو يحاول أن يظهر له الفرق بين خبرة العلاج الفردى، وخبرة العلاج الجمعى.
الفقرة التالية من المتن تظهر محاولات هذا المعالج استدراج صاحبنا إلى كشف مدى ما يريد من هذه الاعتمادية، التى حلّت محل المواكبة التى لوّح المعلم بها:
“المعلم قال له: ماشى ياللاّ بينا “
ولكن بلا جدوى أيضا:
(6)
…………
- يالله بينا!!! يالله بينا؟ على فين؟
دانا مستنى سعادتكْْ.
روح وهاتْْ لى زى عادتكْْ.
أى حاجة فيها لذّة،
الكلام الحلو، والمنزول، ومزّة.
أنا أحكى، وانت تتصرف براحتكْْ.
أنا تعجبنى صراحتك
يبدو فى هذه الصورة من جديد الأثر السلبى للإصرار على مفهوم أن العلاج النفسى عند مثل هذا الشخص ليس إلا تفريغ بالكلام.
كثير من المرضى يتصورون أن دورهم ينتهى عند الحكى، والباقى على المعالج
“آنا أحكى، وانت تتصرف براحتك”
وإعجاب صاحبنا بصراحة المعالج قد يكون إشارة إلى استقباله هو وليس إلى دور المعالج الحقيقى، فأى معالج مهما بلغ تعاطفه مع مريضه، وتأثره بفكرة الترييح والتسكين والتفريغ، لا يمكن أن يقبل أن يطول هذا الوضع، وإلا انتهى إلى السلبية، صراحة المعالج حتى فى رفض القيام بهذا الدور، قد يقلبها مثل هذا المريض إلى تصفيق للمعالج دون أن يصله رفض المعالج لكل هذه الاعتمادية.
وهنا أحب أن أشير إلى أن التحسن الظاهرى الذى قد يتوهم المريض والمعالج معا أنه تم فى العلاج الفردى.. قد تتبين طبيعته الهروبية والدفاعية إذا ما أتيحت الفرصة لاختباره فى بوتقة العلاج الجمعى بما يحمله من مواجهة وتفاعل ومقارنة واختيار، خاصة حين يتصاعد موقف المعالج حتى يرفض مثل هذا المريض، وكأنه يعاقبه “يزعل منه” يهمله، يكشفه، يواجهه، يهدده بقطع العلاج، لكن صاحبنا يكاد يكون على يقين من حقه فى ألا يتغير مهما تغيّر نوع العلاج.
نقرأ المتن:
……………
لسَّه عندى كلام كتير أنا نفسى اقولهْْ،
عايِز اوْصف فى مشاعرى وإٍحساساتى،
واقعد اوصفها سنين،
مش حا بَطّلْ، خايف ابطّلْ،
لو أبطّل وصف فى الإحساسْ حَاحِسّ،
وانا مِش قد الكلام دهْ.
يلاحظ هنا أن الخطاب هو بلغة الجزء الأعمق من النفس. كما هو الحال فى كشف داخل هذا الشخص دون مواجهة .. لأن كل هذه الدفاعات تحدث – طبعا – بعيدا عن وعى المريض الظاهر، أمّا الطبيب “أو المعالج” فإنه يلتقطها من خلال تقمصه بالجزء الأعمق لمريضه، ثم قد يتبينها المريض فيما بعد، أو لا يتبينها.
عندما أشرح هذه الفقرة التى تقول:
“لو أبطل وصف فى الإحساس حا حس”
لا يصدقنى أغلب تلاميذى أو زملائى الأصغر، ناهيك عن مرضاى.
المعتقد العام هو فى الاتجاه العكسى (كما أشرنا سابقا غالبا)، معظم الناس يعتقدون أن وصف الإحساس هو سبيل إلى تعميق الإحساس، النص هنا ينبه إلى أنه فى كثير من الأحيان، ولا مجال للتعميم ، يكون وصف الإحساس بالالفاظ هو بديل عن معايشة هذا الإحساس، وفيما يلى مشهدين يؤكدان ذلك، الأرجح أننى اشرت إليهما سالفا أيضا وهما
أولا: فترات الصمت التى تحدث مصادفة فى العلاج الجمعى، فتتفجر خلالها أحاسيس مختلفة، لمن يحمى نفسه بسبات خفيف أو عميق، أو على الأقل بسرحان ممتد، قد تكسره زيادة فترة الصمت أكثر وأكثر، فى هذه الحالات التى عايشتها فى العلاج الجمعى عددا متوسطا من المرات، كانت المشاعر الحقيقية تظهر خلال الصمت أعمق، وأصدق من تلك التى يسارع بوصفها الصامت بالألفاظ أولا بأول.
ثانيا: حين أعرض على مريض فى لقاء إكلينكيى – تعليمى فى الغالب – أن يسمح لحزنه أن يظهر دون (أ) أن يعزوه إلى سبب، حالى أو سابق، وأيضا (ب) دون أن يعبر عنه بالألفاظ، (أحيانا أستعمل تعبير: يمارس حقهُ فى “الألم”)، وإذا بنوع آخر من الأحاسيس يطل من العينين والوجه والجسد دون ألفاظ مؤكدا الفكرة التى جاءت فى المتن هنا: أنه
“لو أبطل وصف فى الإحساس حاحس”،
داخل “صاحبنا” هنا، يعلنها هكذا: أنه يحكى ويصف حتى لا يسمح لمشاعر أصدق أن تطل منه رغما عنه.
ينبغى أن ننبه هنا إلى أن وصف الإحساس ليس منهيا عنه على طول الخط، فالقدرة على ترجمة الأحاسيس إلى ألفاظ هى أداة للفنانين والشعراء خاصة، وإن كانت قد مرت علىّ فترة شعرت فيها أن الشعر بالذات قد يكون ضد الثورة، اللهم إلا شعر التحريض، وهو ليس شعرا جيدا دائما، أو على الأقل ليس من أفضل الشعر، وإذا كنا نشجع الطفل فى نموه العادى أن يتعلم الرموز (الكلام) فى طريقه إلى التفوق الإنسانى، فإن الرموز اللفظية التى تصف الانفعال بوجه خاص هى من أعجز الرموز وأكثرها غموضا وتداخلا. إن النمو عند الأطفال وغيرهم لا يعنى أن يحل الرمز محل الخبرة.
فى هذه الصورة التى أقدمها هنا يخرج اللفظ عن هذه الوظيفة – كما ذكرنا – ويصبح بديلا عن الخبرة .. يصبح اغترابا عن الوجود.
حين يتأكد هذا الموقف هكذا، من داخل داخل المريض، يصبح الاستمرار بنفس شروط التعاقد البدئى مضيعة للوقت فى أغلب الأحوال، وهنا يحق للمعالج أن يفرض توقف العلاج (كأنه الطرد)، وأنبه هنا أن من قواعد العلاج الجمعى الذى نمارسه أنه يحق لأى فرد، معالج أو مريض، أن يعلن رغبته فى طرد أى فرد آخر(معالج أو مريض)، على شرط أن للمطرود أن يستمر غصبا عن الطارد، وكثيرا ما يحدث ذلك أثناء العلاج، لكن لم يحدث أبدا أن طَرَدَ مريض معالجا، وإن كان هذا وارد من حيث المبدا، وحين يستعمل المطرود حقه فى الاستمرار غصبا عن طارده وخاصة المعالج، ونطلب من المريض أن يفرض حضوره رغما عن طارده (المعالج)، بالألفاظ تارة، وبالبقاء دون تنفيذ الطرد تارة أخرى، يحدث عادة فى هذا الموقف نوع من “إعادة التعاقد“، وهذا يوثق العلاقة الجديدة برغم ما يبدو فى ظاهر الأمر من شكل القسوة.
المقطع التالى فى المتن يعلن مثل هذا الموقف من المعالج ببساطة “شوف لك حد غيرى”، ولعل هذا يبين أيضا أن هذا الإجراء ليس حرمانا من العلاج، وإنما هو اقتراح بعلاج آخر، قد يكون المريض فيه أقل مقاومة، وأكثر استفادة حسب شروطه.
المقطع التالى يعرض أيضا مقارنة ساخرة بين العلاج التسكينى بالعقاقير المهدئة أو القامعة (مع أنها هى هى التى تستعمل منظّمة، ومنسِّقة مع اختلاف الطريقة والجرعة والتوقيت بحسب مسيرة العلاج التكاملى)، وهو – المقطع- يشير أيضا إلى وسائل هروبية أخرى، من أول الهجرة الهروبية إلى التوقف عن مسيرة النمو تماما مما نسميه أحيانا – برغم قسوة الاسم – الموت النفسى ، وهو يقابل الاغتراب المزمن، أو ما يسمى “فرط العادية الروتينية المعادة”، وهو ما يدل عليه تعبير “إنه مش لازم نعيش”،
بديهى أن هذه الجملة ليست دعوة للانتحار بقدر ما هى حفز إلى الحياة مرة أخرى “كما خلقنا الله”.
(7)
المعلم قالُّه: شوفْ لَكْ حد غيرى،
جَنْبِنَا دكّانة تانيةْ،
فيها “بيتزا” مِالّلى هيَّهْْ،
أو “لازانْيَا”.
………..
……….
فيها توليفةْ حبوب من شغل برّة.
تمنع التكْشيرهْ، والتفكيرْ، وْتمِلاكْ بالمسرّة.
فيها حقنةْ تخلِّى بَالَكْ مِستريـَّـحْ.
تِنتشِى وْتفـضَلْ مِتَنَّحْ.
فيها سرّّ ما يِتْنِسِيشْ.
إنـه “مِشَ لازِمْ نعيش”!!
المتن التالى يظهر لنا كيف استجاب صاحبنا لهذا الطرد الصريح بأن أعلن مقاومته للتغيير رغما عنه، وهذا لا يتعارض مع إصراره البدئى على التغيير مثل الآخرين “أنا نِفْسى ابقى كده”، لكن حين وصل الأمر إلى التهديد بـ… “إنهاء التعاقد” هكذا، استثار هذا الموقف مقاومة صاحبنا فراح يكشف عن أسبابه للمقاومة.
هذا النوع من العلاج بالمواجهة والتعرية، إن لم تضبط جرعته، ويمتد زمنه إلى درجة كافية، ومهما كانت حسن نية من يشترك فيه، وموافقته على شروطه، وأيضا مهما سمى أنه علاج من منظور النمو والتطور ومثل هذا الكلام، فإن فيه خطورة أن يطغى عليه فكر مثالى، تحت تأثير معالج له حضور قوى، أو منظومة مثالية ذاتية طاغية ظاهرة أو خفية، وبالتالى، فإن المريض الذى يلتقط أيا من هذا مهما كان حماسه، يخشى على هويته، على منظومته الخاصة من الاهتزاز، سواء كانت منظومة دينية، أو أيديولوجية سياسية، أو ذاتية ظاهرة أو خفية، يخشى عليها لدرجة أن أية دعوة للمخاطرة بالتغيير تترجم لديه بانها إغارة من منظومة المعالج الأقوى، أو من منظومة المجموعة ككل، وهنا تقفز المقاومة (المشروعة بصراحة)، ولا تهدأ إلا حين يكتشف المشارك أن له حق الاحتفاظ “بنفسه وهُويته كما هى”، وأن المطلوب هو السماح بإضافة جدلية من خلال الاختلاف الموضوعى المقاس بمقاييس النمو والتكيف والإنجاز معا.
الاحتجاج هنا والمقاومة يعلنهما “داخل” صاحبنا، وليس ظاهره، كما أشرنا سالفا، وحين ترفض علاقة الاعتمادية العلاجية بهذا الوضوح، سواء بسبب لا جدواها، أو بسبب تناقضها مع قيم هذا النوع من العلاج وأهدافه، تتجلى فى داخل المريض بدائل استسهالية ليس فيها مخاطر الرؤية، ولا أشواك العلاقة الموضوعية، ومن أهمها الاعتماد على المواد (حتى الإدمان الطبى أو غير الطبى)، هذه البدائل الهروبية لا ينبغى الحكم عليها بأحكام أخلاقية أو دينية ابتداء، وإنما بمدى سلبيتها أو إيجابيتها على مسيرة النمو، فقد يكون فى مثل هذا الاستسهال تنازل عن الهوية الحقيقية بقبول الضياع وسط كتلة الناس الممتزجة.
يعود صاحبنا الذى نحترم استمراره هكذا، ينتبه إلى أن هذا الوعى الناقد الذى كشف له شخصيا فشل مهاربه، هو ناتج من خبرته فى هذا النوع من العلاج، وبالتالى جعله كمن رقص على السلم، فلا هو أعمى تماما يمشى حاله مثل غيره، ولا هو يواصل رحلة النمو ويدفع ثمنها ، حتى الحل الهروبى اللّذى، يبدو أنه أفشله قبل أن يبدا، لم يأت الإفشال من نصائح المعالج، ولا من القياس على خبرة الذين يحاولون جادين فى المجموعة، لكنه جاء من واقع رؤيته الأمينة، برغم أنها لم تنفعه حافزا لاستمرار تجربة نموه، فهى رؤية صادقة وكاملة، برغم أنها عاجزة ، وذلك لأنها معقلنة تماما.
يبدو أن الوعى المعقلن، حتى من داخل الداخل يمثل ناقدا قويا، لكنه ليس كافيا – عادة – للتغلب على مثل هذه المقاومة القوية.
وها هو صاحبنا يعلن أسفه أنه لم يستطع أن يتخلص مما وصله من رؤية، وفى نفس الوقت لم يستطع أن يكمل، فيروح يضع اللوم كل اللوم على من عرّضه لهذه الجرعة المفرطة، دون أن يتأكد من قدرته على تحملها،
هذا هو ما نعنيه بضرورة “ضبط الجرعة”، ليس فقط جرعة العقاقير وتناسبها مع مسيرة النمو، وإنما أساسا جرعة الرؤية، وتناسبها مع الألم، والحركة.
نسمع عتاب صاحبنا الهجومى على المعالج، الذى اضطره بعد كل هذه المقاومة أن يتخطى الحواجز فيرى ما كان محتجزا وراء ميكانزماته لكنه توقف ولم يكمل!!
…………
(9)
كله منَّكْ يا مِعلمْ:
ليه تفتَّح عينىٍ وِتْوَرينى نَفْسى؟
ليه تلوَّح باللى عمره ما كانْ فِى نِفْسِى؟
واحده واحده، كُنت هَدِّى،
قبل ما تْحَنِّسْنِى ،يعنى، بالحاجاتْ دِى.
ليه تخلِّى الأعمى يتلخبط ويرقص عالسلالم ؟
كنت سيبْنِى فى الطَّرَاوةْ، يعنى صاحى زى نايمْ.
داهية تلعنْ يوم مَا شُفتَكْ.
يوم ما فكرت استريحْ جُوّا خيمتكْ.
يوم ما جيتـْلَكْ تانى بعد ما كنت سبتكْْ.
يا معلّم: إما إنك تقبل الركاب جميعاً
اللى واقف، واللى قاعدْْ، واللى مِتشعبط كمان،
أو تحط اليافطةْْ تعلن فين خطوطْْ حَدّ الأمانْ.
كل واحد شاف كده غير اللى شايفُهْ،
يبقى يعرف إنه يمكن لسّه مِشْ قَدّ اللى عِرْفُهْ.
نختم هذا الشرح بشىء من الإعادة ونحن نتساءل:
إلى أى مدى يحق للمعالج أن يغير من توع وجود المريض، وقيمه؟
إن احتجاج صاحبنا الأخير هذا هو إعلان من جانبه – رغم سلبيته – محذر رائع، مطالب بضبط الجرعة.
الاختلاف حول هذه القضية شديد، وأغلب الآراء ترجح صراحة أنه ليس من حق المعالج أن يتدخل بأية صورة فى نوعية وجود آخر، أو منظومة قيمه، وبرغم أننى مع هذا الرأى ابتداء إلا أننى أعيد صياغة التحذير هكذا:
.. “ليس من حق المعالج من حيث المبدأ – أن يتدخل فى نوعية وجود آخر أو منظومات قيم من يعالجه، بشكل مباشر، ولكن أيضا ليس مطلوبا منه أن يخفى عن مريضه نوع وجوده هو (وجود المعالج)، خاصة مع المريض الذهانى، فالأرجح أن هذا الأخير سوف يلتقط منه ما يشاء دون إذنه، وعلى ذلك:
فكلما كان التدخل واعيا كان آمن وأكثر انضباطا،
وأضيف:
إن الحديث عن المعالج والعلاج يختص بدائرة محدودة فى المجتمع، وأن الذى قد يسمح للمعالج بهذا التدخل الواعى المسئول هو عاملين أساسين:
أولا: وجود أعراض ضاق بها المريض وبالتالى فهو ساع إلى التغيير ابتداء،
ثانيا: حضور المريض باختياره النسبى للعلاج، ثم تأكيد حضوره هذا بانتظامه فى الحضور برغم كل شىء.
إذا ما توفر أحد هذين الشرطين فهو اعتراف ضمنى بأن المريض يوافق على تغيير ما، والمعالج عادة – كما تبينت أثناء خبرتى- يعرض تغييرين:
أحدهما تغيير ثورى نحو النمو والتطور.. (وعليه أن يكون ناجحا شخصيا فى ممارسة هذا السبيل ولو جزئيا، وإلا فالخدعة أخطر من كل تصور).. فهو يقف مع هذا التغيير ويساهم بالمشاركة فى استمراره، وهو يشير ضمنا، من واقع ممارسته إلى نتائجه،
أما التغيير الآخر الذى يعرضه المعالج – بطريق غير مباشر فهو عرض تعديل ما استجد من أحوال مرضية (أعراض وإعاقة) بالرجوع إلى نوع الوجود القديم شريطة اختفاء الأعراض والاستمرار فى الاداء على أرض الواقع
على المعالج أن يترك المريض يلجأ إلى هذا التغيير الأخير بنفسه – وربما ضد محاولات دفعه لمواصلة النمو – حتى يتحمل مسئولية نتائجه
أما الذى ينبغى أن يرفضه المعالج فهو الحل الوسط المائع المتذبذب فى صورة استمرار الأعراض أو استمرار الاعتمادية أو استمرار الخداع “بالرقص على السلم” بين الاختيارات المطروحة.
خاتمة ووعد:
انتهى الكتاب الأول من هذه السلسلة بعد أن حذفت ما يساوى نصف ما نشر على الأقل، ونواصل نشر الأجزاء التالية لعلها تكون أكثر وضوحاً وفائدة.
[1] – سبق ظهور هذا النص مع الشرح فى سلسلة فقه العلاقات البشرية، الكتاب الثالث “قراءة فى عيون الناس” اللوحة الثامنة، “نايم فى العسل”، (ص 130)، لكننى وجدت التكرار مفيد فى هذا السياق فعذراً للتكرار.
[2] – يمكن مراجعة المقطع الذى نشرناه من جلسة العلاج الجمعى: “عايزة حُبَ” “الإنسان والتطور” بتاريخ: (12-11-2009 “الحق فى الحب بين الأخذ والتسول”) دعما لشرح مثل هذا المتن. www.rakhawy.net
الفهرس
الفهرس
|
الموضوع |
| – الإهــداء |
| – مقدمة |
| الفصل الأول:
معالم أساسية، وتاريخ |
| الفصل الثانى:
الخبرات التمهيدية والإعداد |
| الفصل الثالث:
والأصل فى الوحْداتِ أن تُجَمَّعا |
| الفصل الرابع:
البحث العلمى فى العلاج الجمعى |
| الفصل الخامس:
جدل العقول وحركية تخليق الوعى الجمعى |
| الفصل السادس:
من العزلة وتشكيلات الارتباط الثنائى إلى تخليق الوعى الجمعى |
| الفصل السابع:
الوعى الجماعى من أصل الحياة إلى غيب المُطلق |
| الفصل الثامن:
التقنيات الأساسية فى العلاج الجمعى |
| الفصل التاسع:
علاقة هذا العلاج بأنواع العلاج الجمعى الأخرى |
| الفصل العاشر:
علاقة هذا العلاج بالعلاجات غير النفسية (العضوية) الأخرى |
| الفصل الحادى عشر:
العوامل العلاجية والفروق الثقافية ورأى “يالوم” |
| الفصل الثانى عشر:
علاقة هذا العلاج الجمعى بالفلسفة، و(بالديالكتيك) |
| الفصل الثالث عشر:
علاقة العلاج الجمعى بالدين والإيمان (كثقافة) |
| الفصل الرابع عشر:
العلاقة بين العلاج الفردى والعلاج الجمعى |
| الفصل الخامس عشر:
نقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى (خبرة سلبية لحالة واحدة) |
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى





جميل