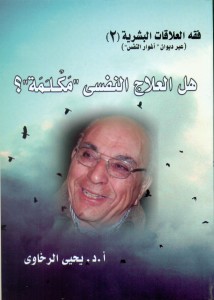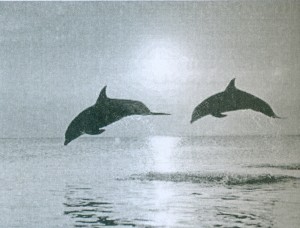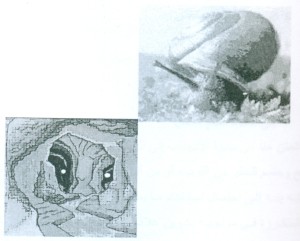فقه العلاقات البشرية (2)
(عبر ديوان “أغوار النفس”)
هل العلاج النفسى “مَكْـلـَمَة”؟
(سبع لوحات)
أ.د. يحيى الرخاوى
الإهــداء
هو هو إهداء الديوان “أغوار النفس”:
ياتَرَى الِكْلَمَهْ حا تقدر تـْفشـِى سرىَّ؟
يا ترى مين فيكـُو يِسْتَحْمل مَرَارْتىِ؟
يا ترى مين فيكـُو حاَيْسَاعِى شَقَاىَ؟
أَهدِى مينْ؟ أَهدى إِيهْ؟
هوَّا عُـمـْر المُرّ يِتْهادَى يا عالَم؟
قلت انطّ فْ وسط خلق الله جميعاً..
همُّه دول حِمْل الكَلاَمْ المُرّ والدَّم اللِّى يِغْليى.
هـُـمَّـا دول حِمْل الحقيقةْْ.
قلت أهْدِيهاَ لْبلدنا،
للِّى غنّى .. والَّلى صَحَّاهْ الغُنَى.
يَا مَاقُلْتُوا يَا أَهْل مصر يا فنـَّانين،
يا غلابَهْ، يا حضارَهْ، يا تاريخ.
يا ما قُلْتُوا، ويَا مَا عِدْتُوا.
صَحِّيتُونى.
]واللى بَنَتْ مَصـْـر كاتْْْ فى الأصل: غِنَّيَوهْ[.
الهديّه للى غنّى، قال: “بَهِيّهْ لىِ يَاسينْ”،
واللِّى صَحَّى لَيْلَى والمجنوُنْْ يِـغَـنُّوا لمْصَرْ تانى.
واللِّى علـِّـمْـنى حلاوة الـمُرْ .. من جُوّا النَقَايَهْ،
واللِّى.. واللِّى.. واللِّى.. واللِّى.. والجَمِيعْ.
يا ترى تقبل يا شَاِعر مَصْر يا صاحب الرِّبابَةْ؟
يا تَـرَى يا اهْل الحَضَارَهْ والكَلاَمْ الحِلْو واللِّحْنِ الأدَانْ.
تقَبلُوا منِّى الهدِيَّهْ؟
أصِلى غَاوِى،
بس يا خسارَهْ مانِيشْ لا بِسْ طاقِيَّه،
قلت انقَّـْـط بالَكَلامْ.
مقدمة:
هذا هو الكتاب الثانى انطلاقا من ديوان “أغوار النفس” (بالعامية المصرية)، وقد كان الكتاب الأول: “مقدمة فى نقد العلاج النفسى بين الشائع والإعلام والعلم والناس” تمهيداً عاماً لهذه الكتب الثلاثة التالية، المنبعثة من نفس الديوان.
فى هذا الكتاب الثانى نعرض سبع لوحات شعرية على “لسان حال” أصحابها أو تقمصا لتصوراتى عنهم كما صاغها الشعر، وليس كما هم، وكنت أحسب أنها لوحات نقد العلاج النفسى إلا أننى تبينت أن جرعة النفسمراضية التركيبية بها أكبر وأهم، الأمر الذى دفعنى لنشرها مسلسلة فى النشرة اليومية “الإنسان والتطور” باسم “فقه العلاقات البشرية” وهو الاسم الذى ارتضيته للأعمال الأربعة الحالية.
هذا، وقد نشرت لوحات هذا الجزء فى الديوان تحت عنوان “جنازات“، لكننى عدلت عن ذلك وفضلت أن تنشر كل الصور الشعرية باسم واحد وهو “لوحات“.
وكما ذكرت فى المقدمة العامة فى الكتاب الأول فإنه سوف يتبع هذا الكتاب الحالى الكتاب الثالث بعنوان: “قراءة فى عيون الناس” ويشمل خمس عشرة لوحة.
ثم الكتاب الرابع بعنوان “تجليات يحيى الرخاوى: بين السيرة والمسار” وهو ما شرحتُ ما يميزه فى المقدمة العامة، ثم سيأتى ذكر مصادره وطبيعته فى مقدمته حين يظهر.
الفصل الأول:
عن نمو الكلام وعلاقته بالمعنى واللغة
الكلام هو من أحدث الأدوات التى تساعد البشر على التواصل فيما بينهم لكنه ليس بالضرورة الأداة الأقدر، وما يهمنا هنا هو تحديد متى ينفصل الكلام عن تاريخ تطوره، ومتى ينفصل عن المعنى، وعن الغاية، وعن سائر وظائفه، بل وعن اللغة، ومتى يؤدى عكس وظيفته([1])؟
1- ينشأ الكلام عند الطفل حين يرتبط الصوت عادة بما تشير إليه الكلمة، حتى أنه كثيرا ما يستعمل الطفل نفس الكلمة، لتعنى معانى كثيرة، وكل الفـْرق يكون فى التنغيم وما يصاحبه من إشارات نتيجة لحضور الموضوع (الشىء) عادة أمام حواسه، أو نتيجة لاختلاف السياق أو الموقف الذى يوجه فيه نفس الكلمة المنطوقة إلى المعنى المختلف. المثال الذى أحب أن أستشهد به كان طفلا عزيزا بمثابة حفيدى – أصبح الآن جراحا استشاريا كبيرا فى إنجلترا – نـَطـَقَ كلمة “كـَرَة” مبكرا، ولم تكن بهذا الوضوح بل أظن أنها كانت “كوووية”، وبدأ يطلق نفس اللفظ على عدد هائل من الأشياء، بل والأشخاص، مع تغير التنغيم والإيقاع المصاحب أحيانا بالإشارة إلى ما يريد، فهذا “كـُويـَهْ”، وذاك “كـُووُوويـَااااهْ”، وتلك “كـُوّة”، وهذه “كره” (بعد أن استطاع نطق الراء إلا قليلا)، هذه المرحلة هى نوع من الربط بين الصوت والإشارة والموضوع، فهى مرحلة التجربة والخطأ، حتى تتميز الأشياء فيما بعد مع اكتساب أبجدية دلالية أكثر فأكثر Denotation.
2- يستقل اللفظ عن ما يشير إليه “حالا”، ويصبح هو ذاته كيانا قائما بذاته، يحتوى (يتضمن) المعنى المراد، سواء حضر الشىء المراد أمامه (أمام حواسه) أم حضر فى ذاكرته أم فى وعيه، هنا يتضمن اللفظ محتواه بما يعنيه، وهذه هى مرحلة التضمين Connotation.
3- قد يستقل اللفظ تماما عن موضوعه بشكل مباشر ليصبح موضوعا فى ذاته، وهذا لا يعنى أنه ينفصل عن المعنى أو عن الغاية التى نشأ ليؤديها، وإنما يعنى أن اللفظ يكتسب قدرة ذاتية، يستعملها فى وظيفته للاقتصاد، والتوافيق والتباديل، مما يتيح له كرمز له مضمونه أن يقوم بتشكيل المفهوم تلو المفهوم، فى تصعيد متكامل Verbalization.
فإذا رجعنا الآن إلى ذلك الطفل بعد أن أصبح جرّاحا “استشاريا بريطانيا” عظيما، ذلك الطفل الذى كان يستعمل لفظ الكرة لكل شىء تقريبا، وطلبنا منه تعريف لفظ الكرة، فقد يرجع إلى القاموس، وسوف يجد أن الكرة: “هى كل جسم مستدير، ومنه الكرة الأرضية، والكرة أداة مستديرة من الجلد ونحوه يلعب بها..(الوسيط) إلخ”، وهكذا أصبح للفظ مضمون متعارف عليه بالتحديد لإفادة الحضور العيانى لشىء بذاته حتى لو لم يوجد هذا الشىء حالاً.
فإذا انتقلنا إلى المجاز وقلنا بالعامية “الكورة اجوان” (حتى لو ترجمناها إلى الفصحى “الكرة ليست إلا أهدافا”)، فإننا لا نعنى هذا الجسم المستدير… إلخ، كما ورد فى المعجم، وإنما نحن نتكلم عن مفهوم أكثر تعقيدا يشير إلى أنه “من لم يحرز أهدافا فى ملعب الكرة، فكأنه لم ينجح مهما بلغت مهارته، “حتى لو تكلمنا عن “اتحاد الكرة”، فإننا نعنى معنى غير التضمين المغلق، وغير المفهوم المجازى الذى أشرنا إليه حالا، فبمجرد أن يصبح لفظ الكرة “مضافا إليه”، يختلف معناه، وهكذا.
اغتراب الكلام:
مع تطور القدرة الكلامية، لابد أن تخف جرعة التركيز على أن يحمل كل لفظ كل المعنى المتضمن فيه، ذلك المعنى الذى نشأ اللفظ لاحتوائه، وهذا جيد اقتصاديا للتخفيف من عبء حضور كل المعنى فى كل اللفظ ليحتل بؤرة الوعى باستمرار، إذ أن هذا الحضور الكلى المستحيل لابد وأن يبطىء من سرعة الإفادة والتواصل حتى ربما تتعطل، ومن مثل هذا فنحن فى حاجة مناسبة لقدر من التخفيف يحول دون تضمين كل لفظ كل معناه، وهكذا يصبح هذا التخفيف حيلة دفاعية تساعدنا على تجنب المواجهة المعطـِّـلة بالسرعة البطيئة، وأيضا يساعدنا على التخلى المشروع عن مسئولية تفعيل ما تضمنه كل كلمة من معنى قد يتطلب فعلا وموقفا وقرارا حالا… إلخ.
مثل أية آلية دفاعية، إذا ما زادت وظيفتها الدفاعية عن حاجتنا إليها تنحرف بمسار النمو أو توقفه تماما، دعونا نتناول الآن ما يحدث للكلام إذا انحرف بالنمو عن مساره إلى ما هو زائف مغترب، إن ما يحدث حين ينفصل الكلام أكثر فأكثر فأكثر عن مضمونه وحفزه هو: أن يستقل عن معناه بدرجات متزايدة حتى يفقد أصول وظائفه، فبدلا من أن يصبح تبادله سعيا إلى الفهم والتفاهم، يصبح تبادله أقرب إلى الدفاعات ضد الفهم، متجاوزا المعنى المشترك المراد، فلا يعود يؤدى وظيفته المعرفية، بل يصبح عبئا على اللغة الكائن الحى، ومن ثم على الوجود البشرى المتكامل، وينقلب عائقا للنمو، ومضيعة للوقت، ومظهرا للاغتراب. الأرجح أن هذا هو ما يسمى بالعامية الساخرة: أحيانا “طق حنك” أو “أى كلام” أو “كلام فى الهجايص”.
وقد عبرت اللغة الشبابية عن هذا الاغتراب بقاموس كامل لمن شاء أن يرجع إليه، حتى أننى فسرت ظهور هذه اللغة الشبابية بأنها احتجاج ضمنى على ما آل إليه حال الكلام اغترابا، واعتبرت أن هذه اللغة الجديدة المرفوضة من المؤسسات والسلطة على حد سواء، هى نوع من تنشيط حركية اللغة، مثلما يقوم الشعر بتجديد اللغة، حين يعيد تشكيل الصورة بنفس الأبجدية اللفظية ليبدع لحنا مختلفا فى تشكيل جديد، وتفصيل ذلك فى مبحثى “حركية اللغة بين الشعر والشارع”([2]).
من خلال هذا الاغتراب المتمادى تتحول الكلمات إلى أصوات، مهما كانت هى نفس الكلمات ذات التاريخ والمعنى كما قد تتحول الجمل إلى مقاطع مفككة بلا تشكيل ضام أو هادف، ويتحول هدف الكلام إلى “تزجية للوقت”، كوسيلة دفاعية ضد الوعى الأعمق بالمعنى، فالإلزام بالفعل، ويتحول التواصل المحتمل بالكلام الحى، إلى صفقات تسكينية قصيرة العمر.
يصدق كل ذلك فى الحياة العامة مثلما يصدق فى بعض ما يسمى العلاج النفسى الذى وصف فى كثير من الأحوال بأنه: “العلاج بالكلام”.
وبعد
كما بينت فى الكتاب الأول سوف أبدأ غالبا بإثبات المتن الشعرى متكاملا قبل المضى فى الانطلاق منه أو شرحه، فقرة فقرة، لعل فى ذلك اعتذاراً مناسبا لما ألحقه به الشرح!.
- 1 –
مرّّ الهَوَا صفَّرْ، سِمْعِنَا الّصُوتْ كإن النَّعْش بِيْطلّع كَلاَمْ:
”لأْْ..، لسّهْ..، إسْكُتْ،.. لَمْ حَصَلْ.،
سيِمَا ..، ياتَاكْسِى، .. لسَّه كامْ ؟” أىّ كلام.
ألفاظْْْ زينَهْ، مَسْكيَنهْْ،
بِتـْزَقْزَقْ، وتـْصَوْصَوْ،
.. وِخَلاَصْ!!
اللفظ ماتْ مِنْ ركنِتُهْ.
من لعبة العسكرْ وطول تخبــيــَّته،
ظرف رصاصْ فاضِى مصدِّى فْ علبتـُـه.
لما القلم سنه اتقصفْ؛ عملــته تلبيسهْ تــمــكـِّـن ماسْكتهْ،
واهِى شخبطهْ.
– 2 –
 واحدْ نايم مـِتْـصَلـْطَحْ، وعْنيه تتفرجْ:
واحدْ نايم مـِتْـصَلـْطَحْ، وعْنيه تتفرجْ:
على رسم السقفِِ
وْعَلَى أفكارُو اللى بتلفْْ، تْلِفْ، تْلِفْ،
وكلامْْ فى كلامْْ .. هاتَكْ يا كَلاْم.. يا حرامْْْ!!!!
والتانىِ قاعِدْلِى وَرَاه، على كرسِى مـدَهَّبْ.
قلبه الأبيض طيّبْ. وسَماعُهْ لَمْ يِـِتْـعيــِّبْ،
عمال بيفسَّرْ أحْلاَمْ
وصاحبْنا يرصّ فْ أوهامْ،
وعُقـدْ، ومركَّب، و”المكتوب”
و: قدَرْ، وحكاوِى، وْصَفّ ذْنوب.
وأخينـَا شَفَايفُهْ قِفْل رْصاص،
وِوْدانُهْ يا خويا شريطْ حسَّاسْ.
يِسَمعْ حكاياتْ .. حكاياتْْ،
وتمرّ ساعاتْ وساعاتْْ،
(ما أَظنّشْْ أَيوبْْ ماتْ).
”إٍشى عدّى البحر ولا اتْبَلـِّـش”؟؟
”قالـِّـك: إٍلعجل فْ بطن امه”!!…!!
أرْزَاقْ ..!!
وخلايق لابْسَه الوِشّ زْوَاقْ.
-3-
اللفظ قام من رَقْدِتُـه.
ربك كريم يِنْفُخْ فى صُورْتُه ومَعْنِتُه.
يرجعْ يغنى الطِّير عَلَى فْروعِ الشَّجَرْ.
ويقول”ياربّ”،
وتجيله ردَ الدعْوَهْ مِنْ قَلْبُه الرِّطِبّ.
-4-
ألفاظ بتهِزّ الكُونْ،
وبتضربْْ فى المَلْيَانْ،
وتغــَّير طَعْمِ الضِّحْكَةْ،
وتشع النُّورْ مِا الضَّلمَهْ،
وبتفضَحْ كِدْب السَّاكِتْ،
وبْتِفْقِسْ كل جَبَانْ.
***
انطلاقا من المتن:
من الواضح أن هذه البداية تشير إلى أمرين مما سبق شرحهما حالا فى البداية، فمن ناحية تعلن أن الاغتراب فى الكلام المنفصل لم يعد إلا أصواتا، وأن الجسد البشرى الأداة: أصبح نعشا، وأن الوجود الإنسانى المغترب أصبح موتا، فراحت الأصوات تخرج كأنها الكلام، وراح الكلام يخرج ليس إلا أصواتا رطانا (وربما هذه الأصوات شبه الجنائزية هى التى أوحت بتسمية القصائد: الجنازات([3])).
مرّّ الهَوَا صفَّرْ، سِمْعِنَا الّصُوْت كإن النَّعْش بِيْطلّع كَلاَمْ:
”لأْْ..، لسّهْ..، إسْكُتْ،.. لَمْ حَصَلْ.
سيِمَا ..، ياتَاكْسِى، .. لسَّه كام ؟” أىّ كلام.
ألفاظْْ زينَهْ، مَسْكيَنهْْ،
بتزقْزَقْ، وتْصَوْصَوْ،
.. وِخَلاَصْ!!
ثم يتواصل المتن فى محاولة تفسير لماذا حدث ذلك قائلا:
اللفظ ماتْ مِنْ ركنِتُهْ.
من لعبة العسكر وطول تخبــيـّته،
ظرف رصاص فاضى مِصـَدِّى فْ علبتــه.
لما القلم سِنّه اتقصف؛ عملــتُه تلبيسه تــمــكّن ماسِكتهُ،
واهى شخبطه.
انطلاقا من المتن:
الكلام عضو حى من أعضاء الوجود الحيوى البشرى كما أشرنا، ومثلما يضمُرُ أى عضو نتيجة “عدم الاستعمال” المناسب، مثلما ضمرت فقرات ذيلنا وعضلاته لما توقّف أجدادنا عن التعلق بها فى الشجر، فإن أى عضو لا يُستعمل يضمر حتى يختفى أو يكاد، كذلك الكلام إن لم يـُـستعمل فى وظيفته الأصلية، غالبا نتيجة للقهر والقمع، يضمر أو يصبح غير ما هو، لأنه يخدم غير ما نشأ من أجله.
حين يحال بين الإنسان وبين توظيف كلامه فى التعبير عن ذاته، وتوصيل فكره، والإسهام فى دعم إرادته، لاتخاذ قراره، وتشكيل إبداعه، ثم يطول هذا القهر والقمع، فإن كل ما يصدر من أصوات تشبه الكلام لا تكون كلاما نافعا، ويبقى الكلام الأصل كامنا بداخلنا دون تنشيط أو تدعيم، لأنه لم يعد له فائدة فى تحقيق الوجود أو دفع المسيرة على طريق النمو، هكذا يموت اللفظ فى ظلام القهر، يموت بالمنع، ثم يموت بالاستغناء:
“اللفظ مات من ركنته، من لعبة العسكر وطول تخبيته“.
هكذا يصبح الرمز رمزا ليس إلى ما يشير إليه، وإنما إلى نفسه، وتتكاثف الرموز وتتكاثر وتـُزاحم بعضها بعضا، حتى تصبح عبئا على الوجود، مما يهييء للمرض النفسى والاغتراب العقلى هربا من الاغتراب النمطى المفرغ من الوجود الحى، وبالتالى يصبح الوجود البشرى هيكلا خاويا (نعشا) تتردد فيه أصوات لا تؤدى وظيفتها سواء فى إثراء الوجود، أو فى التواصل بين البشر، أو فى تشكيل الإبداع تصعيدا أو تجديدا.
المتأمل فى الألفاظ اليومية المتبادلة بين الناس قد ينزعج من عدم ترابطها الأعمق، أو من خلوها من المعنى الأصلى لها، أو من خروجها من معناها الأصلى إلى معنى آخر قد يكون نقيض الأول، خذ مثلا من يستعمل ألفاظ: السلام (السلام عليكم)، والخير (صباح الخير) وهو لا يعنى بهما شيئا، لا من السلام ولا من الخير.
هكذا تختفى المعانى التى كانت تحتويها الألفاظ، فيصبح اللفظ غطاء لإناء بلا محتوى، وبلا نبض يحافظ على جدته وحيويته.
“ظرف رصاص فاضى مِصـَدِّى فْ علبته”.
ومع ذلك، فلا يوجد بديل، هو هو نفس اللفظ، إذا امتلأ: هو الوسيلة الوحيدة – تقريبا – التى يمكن أن أكتب بها هذا الكلام، هو هو الأبجدية التى استعملها لأصفه هو نفسه بأنه:
“ظرف رصاص فاضى مصدى فْ علبته”.
ليكن…، لكن مازال اللفظ موجودا مهما أفرغ أو صـَدَأَ ومازلنا فى أمس الحاجة إليه، وعلينا أن نواصل بما تبقى منه، لعل وعسى..!
أليس هو (اللفظ، بجواره لفظ، ثم لفظ مضاف إليه لفظ …إلخ) الذى يمكننى الآن من مخاطبتك عزيزى القارئ، أليس هو الذى يعرِّى ما جرى له، أى ما جرى لى، أى ما جرى لك؟ أليس هو الذى جعل الشباب يرفضون ما آل إليه حال الكلام فاللغة، فاخترعوا لغتهم (اللغة الشبابية) بنفس الحروف، ولكن بتجديد مغامر، جعل كل السلطات تخاف منهم، وتدمغهم وترفضهم، وهم لم يفعلوا شيئا إلا إعلان أن كلامنا الجارى غالبا قد أصبح: “ظرف رصاص فاضى مصدى ف علبته”.
أقتطف من ديوانى “سر اللعبة” نفس النقد للاغتراب الكلامى الذى بدا لى أنه كان بالفصحى أسهل وصولا، أو على الأقل أخف لسعا من نار العامّية الملتهبة، مع أنه تكلم أيضا عن “الأحياء الموتى” قلت هناك:
…والأحياء الموتى فى صخبٍ دائمْ
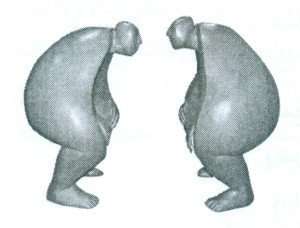 ويخيل للواحد منهم أن الآخر يسمعُهُ
ويخيل للواحد منهم أن الآخر يسمعُهُ
والأخر لا تشغله إلا نفسهْ
أو موضوعٌ آخرْ
لكن الرد الجاهز، دوما جاهز:
– ما حال الدنيا؟
= الدفع تأخر
– هل نمتَ الليلةْ؟
= الأسهم زادتْ
– كم سعر الذهب اليوم؟
= المأتم بعد العصر؟!
“والكل يدِافعُ عن شىء لا يعرفـُهُ
بحماسٍ لا يهدأ أبدا،
التحليل النفسى (وما إليه!):
ثم ينتقل المتن الحالى إلى نقد العلاج النفسى الكلامى.
وبعد ذلك نرى كيف تدب الحياة فى الكلمات.
– 2 –
واحدْ نايم مـِتْـصَلـْطَحْ، وعْنيه تتفرجْ:
على رسم السقفِِ وْعَلَى أفكارُو اللى بتلفْْ، تْلِفْ،. تْلِفْ،
وكلامْْ فى كلامْْ .. هاتَكْ يا كَلاْم.
يا حرامْْ!!
والتانىِ قاعِدْلِى وَرَاه، على كرسى مـدَهَّبْ.
قلبه الأبيض طيّب. وسَماعُهْ لَمْ يِتْـعيــِّبْ،
عمال بيفسَّرْ أحْلاَمْ
وصاحبنا يرص فْ أوهام،
وعُقـدْ، ومركَّب، و”المكتوب”
و”قدَرْ”، وحكاوِى، وْصَفّ ذْنوب.
وأخينا شَفَايفُهْ قِفْل رْصاص،
وِوْدانُهْ يا خويا شريطْ حسَّاسْ.
يِسَمعْ حكاياتْ .. حكاياتْْ،
وتمرّ ساعاتْ وساعاتْْ،
(ما أَظنّشْْ أَيوبْْ ماتْ).
”إٍشى عدّى البحر ولا اتْبَلِّش”؟؟
”قالَّك: إٍلعجل فْ بطن امه”!!
أرْزَاقْ ..!
وخلايق لابْسَه الوِشّ زْوَاقْ.
هل مات التحليل النفسى: فعلاً؟
أثناء تجوالى باحثا عثرت على حوار هام مع الاستاذ الدكتور جوناثان إنجل([4]) Jonathan Engel، وهو حاصل على دكتوراه فى تاريخ العلوم والطب من جامعة ييل Yale، وكان قد كتب كتابا مؤخرا 2008 عن العلاج النفسى الأمريكى بعنوان: American Psychotherapy: The Rise of Psychotherapy in the U.S.A.
أجرى الحوار جابرييل بيركنر Gabrielle Birkner، ونشر فى 18 فبراير سنة 2009، وقد رأيت أنْ أقتطف من هذا الحوار ما يبين كيف أن نقد التحليل النفسى قائم ومستمر وكثير منه موضوعى حتى عهد قريب جدا.
قبل أن أقتطف بعض فقرات الحوار، أريد أن أعترف أننى حين قرأت تعبير “العلاج الأمريكى”، ونهوض العلاج النفسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت أتصور أنه سوف يتكلم أكثر عن الثقافة الأمريكية المعاصرة، وعن تميزها بما أتاح ظهور علاج نفسى باسمها، لكننى لم أجد أيا من ذلك فى كل فهرس المحتويات، ولا فيما استطعت الحصول عليه من موجزات ومقتطفات (لم أحصل على الكتاب الأصلى كله بعد) – نبهنى ذلك أن ما يقوم به هذا العمل الحالى هنا ومثله من محاولات “تحديد علاج نفسى مصرى“، ثم “علاج نفسى عربى”، هو أمر مشروع، بل أمر مطلوب منا ولنا، ربما أكثر بكثير مما هو كذلك عند الأمريكيين.
سأل المحاوِر “برنكنر” الدكتور “جوناثان إنجل” عن كيف حصل على الدكتوراه فى فيينا، وحين كتب كتابا عن العلاج النفسى كتبه فى أمريكا عن أمريكا، وأعتقد أن مثل هذا السؤال وجوابه قد يهدى بعضنا إلى ما ينبغى فعله، فهو ينطبق أكثر فأكثر على كثير منا، المهم، سوف أقتطف من هذا الحوار ما قد يكفى لبيان هذا الرأى([5]).
وفيما يلى مقتطفات من الحوار، أرى أنها قد تكفى شرحا لما أريد.
المحاور بيركنر: لقد ركزت فى كتابك السابق على السياسة الصحية عامة مثل الإيدز وغيره، فما الذى دعاك لتناول موضوع العلاج النفسى مؤخرا؟
جوناثان إنجل: لقد كانت أطروحتى أثناء دراستى الطب فى فيينا منذ نحو 25 عاما عن حركة التحليل النفسى، وعلاقتها بالمجتمع اليهودى، فى فيينا.
بيركنر: كيف أن أطروحة عن التحليل النفسى فى فينا تتطور إلى كتاب عن العلاج النفسى فى أمريكا؟
إنجل: لقد لاحظت أننا نفتقر إلى كتاب يشرح لنا كيف أنه لا أحد الآن – تقريبا – من الأمريكيين يذهب للتحليل النفسى كما كان فى الماضى، بل دعنى أقول إن أحدا من الذين يذهبون لاستشارة الطبيب النفسى لا يفعل ذلك وهو يهدف إلى أن يعالج علاجا نفسيا على وجه التحديد، لا شك أن مفهوم العلاج النفسى مازال شائعا عند العامة، لكنه لم يعد من مهام الطبيب النفسى بالذات، أما ما يمارَس تحت اسم العلاج النفسى فهو ليس نابعا من، ولا محرَّكا بـ، ما هو “تحليل نفسى” بالذات.
بيركنر: هل ثـَمَّ مكان للتحليل النفسى حاليا فى مجال الطب النفسى؟
جوناثان إنجل: دعنى أقول لك شيئا هاما، إنك تسمع مثلا من يقول: “أنا أمارس من منطلق التحليل النفسى …….” “لكننى أفعل ذلك جنبا إلى جنب مع بعض مضادات الاكتئاب”، وهكذا، هذا كل ما هنالك…..
بيركنر: أرى أن أغلب الأطباء النفسيين هذه الأيام قد نـَحـُّوا جانبا فكرة التحليل النفسى، فهل فعلوا نفس الشىء مع ما يسمى العلاج النفسى؟
جوناثان إنجل: معظم الأطباء النفسيين يميلون إلى ممارسة نوع من العلاج النفسى، وكثير منهم تدرب على ذلك لفترة ما، لكنهم يكسبون أكثر حين يتعاملون بالعقاقير بلا شك.
بيركنر: ما هى المواصفات التى تجعل من المعالج معالجا كفءا
جوناثان إنجل: الذكاء والمواجدة (Empathy) ([6]) فى إطار من الالتزام المهنى المنضبط، أنت تستطيع أن تجد كل ذلك وأنت تشرب قدحا من الجعة مع صديق، لكن أن تتواجد هذه الصفات الثلاثة هكذا بالتزام مسئول، فهذا أمر آخر.
بيركنر: لو أن التحليل النفسى كان بكل هذه اللافاعلية، فما الذى جعله يستمر كل هذه المدة؟ لماذا لم يختف تماما؟
جوناثان إنجل: كانت “التذكرة الفرويدية” هى أول التذاكر الواعدة بعرض جيد، بديلا عن ما كان ساريا فى الثلاثينيات، مثلا لو أنك سألت أحد الممارسين عن ما كان يمكن تقديمه للمرضى النفسيين آنذاك، لأجابك أنه كان قليلا جدا، فظهر التحليل النفسى فى هذه الآونة، فبدا وكأنه الدواء لكل الأمراض، صحيح أنه سار ببطء شديد، لكن بدا شيئا أفضل من لاشى.
بيركنر: لكن بعد ذلك ظهرت علاجات كثيرة، أسرع وأفضل نتائجا، فلماذا استمر التحليل النفسى بعدها، ومعها، بكل هذا التأثير؟
جوناثان إنجل: …. ليس هكذا تماما…. ثم إنه مع تزايد التنظيم، وبالنظر إلى الاعتبارات الاقتصادية، والنتائج المتواضعة التى أنجزها هذا النوع من العلاج، فإن هذ التأثير سوف ينحسر أكثر فأكثر باضطراد.
بيركنر: هل تعتقد أن ثـَمَّ أملا فى أن يستعيد التحليل النفسى منزلته فى وقت ما؟
جوناثان إنجل: لا ..، لقد مات.
مع أن هذا المقتطف لم يضف لى جديدا سواء إلى ما جاء فى المتن، أو فى الشرح القديم، أو حتى فيما أنوى تقديمه، إلا أننى اقتطفت منه هذا المقتطف الطويل نسبيا، لأبين من خلاله ما يلى:
-
إن النقد والمراجعة ليس قاصرا على أمثالنا ممن لم يمارسوا – غالبا – التحليل النفسى بالكثافة التى مورس بها فى بلد مثل أمريكا لعشرات السنين.
-
إذا كان هذا العالم الأستاذ فى تاريخ الطب عامة، يرى أن ثم علاجا يمكن أن يسمى العلاج الأمريكى، فأولى بنا أن نفكر فى ثقافتنا الشديدة الاختلاف عن ما يجرى هناك، وعن ما جرى تاريخا، أن نفكر فى تميزنا سلبا وإيجابا عن غيرنا وبالذات فيما يخص العلاج النفسى.
-
إن استمرار شيوع مفاهيم التحليل النفسى عند العامة على مستوى العالم، بما فى ذلك بلادنا، له أسباب ثقافية (إيجابية وسلبية)، لا تتعلق غالبا بفكرة الطب ولا بفكرة العلاج بوجه خاص.
-
إن المتن الشعرى الحالى الذى كتبته سنة 1974 بالعامية المصرية، قد تناول هذه القضية بإحاطة شاملة، وكان له نفس التوجه تقريبا، ولعل رد دكتور إنجل أن التحليل النفسى “مات” ولا سبيل إلى إحيائه يرتبط بشكل ما بما ننقده من أن ظاهرة التحليل النفسى الكلامى تحمل مخاطر اللاحراك، سواء بفرط الاجتهاد والتفسير اللفظى، أم بسوء استعماله لعقلنة حركية الوجود وتوقيفها فى المحل، وهو ما نعنيه بالموت هنا (ولعل هذا يشفع لى فى استعمال لفظ “جنازات” فى الطبعة المحدودة السابقة).
ملاحظات لاحقة محدودة
(1) كثيرا ما يأتى المرضى عندنا يطلبون تحليلا نفسيا بالذات، وليس علاجا نفسيا، أو حتى علاجا يريحهم فقط، وفى هذه الحالة قد أقول لهم مباشرة: “أنا أعالج أساسا، وليست وظيفتى الأولى هى أن أحلل أو أريّح”.
(2) إنه لا يوجد عندنا حاليا بعد رحيل المرحوم مصطفى زيور – إلا نادرا جدا – من يمارس التحليل النفسى بالمعنى الوارد لا فى الحوار مع مؤلف الكتاب الأمريكى ولا فى المتن الشعرى.
(3) إن الصبر وحسن الاستماع الذى يتحلى بهما المحلل النفسى هما العوامل الفاعلة المسئولة عن التحسن أو الشفاء،
“قلبه الأبيض طيب، وسماعُه لم يـِتْعّيِّب”.
وليس بالضرورة، ولا فى المقام الأول: محتوى ما يقال، وليس أيضا ذكاء التفسير، ولا سلامة تأويله
(4) إن تعبير “فك العقد” هو تعبير شائع عندنا برغم أنه لا يستعمل عند الأجانب بهذا الاختزال، وهذا ما قصدت به الاستشهاد بهذا المقطع الساخر من فزورة مشهورة تقول:
“إشِى عدّى البحر ولا اتبلّش“
وجوابها الأشهر:
“قال لك العجل فى بطن أمه“
وهو ما يشير إلى احتمالات التسطيح أثناء التقعر فى التفسير الأبعد، مع أن الأسهل حاضر، لأن أى شخص يركب مركبا صغير، (أو حتى يسير على كوبرى) ينطبق عليه أنه “عدّى البحر ولا اتبلّش” فلماذا تقتصر الإجابة على هذا الرد الصعب. خطر لى أن هذا قد يقابل تعسف تفسيرات التحليل التقليدي لأمور ربما هى ظاهرة للعيان أقرب وأيسر([7]).
(5) إن وظيفة “الفضفضة” و”التنفيث”، و”طلـّع اللى جوّاك، أو طلـّع اللى فى قلبك” تغلب على فكر أغلب من يسعى إلى العلاج النفسى أو التحليل النفسى، مع أن هذا “التطليع”، ليس إلا جزءٌ يسير من العملية العلاجية، فى البداية فحسب.
(6) إن الإعلام السطحى (انظر: “نفسنة الحياة المعاصرة”)([8]) والدراما التافهة يساهمان فى تشكيل وعى العامة عن موضوع العلاج النفسى والتحليل النفسى، وهما مسئولان عن تثبيته عند مرحلة تاريخية انتهت (مع إسهام بعض النفسيين بشكل أو بآخر فى ذلك).
(7) إن الغالب عند العامة وهم يحاولون الاستعانة بالعلاج النفسى أو التحليل النفسى هو البحث فى الأسباب (الحتمية السببية)، وقد يصلح ذلك مدخلا إلى العلاج، لكنه يستخدم فى كثير من الأحيان فى التبرير أو التفسير وليس كخطوة نحو العلاج النمائى وبسط الوقفة Unblocking & Unfolding.
(8) لم أعرف مـَنْ كنت أعنى بتعبير “وخلايق لابسه الوش زواق”، ربما كنت أشير إلى الإعلام والدراما، لكننى أبدا لم أكن أقصد الزملاء المحللين الذين احترمهم.
إحياء المعنى ليملأ الكلام!!
-3-
اللفظ قام من رَقْدِتُـه.
ربك كريم يِنْفُخْ فى صُورْتُه ومَعْنِتُه.
يرجع يغنى الطِّير عَلَى فْروعِ الشَّجَرْ.
ويقول”يارب”،
وتجيله ردَ الدعْوَهْ مِنْ قَلْبُه الرِّطِبّ.
فى بداية شرح هذه المقدمة بينا كيف يموت الكلام حين ينفصل عن معناه المفيد والدافع والمسئول، لكننا نبهنا أيضا كيف أن هذا الانفصال هو حركىّ مرن، إذا وُظـِّفَ إيجابيا ليكون مفصلا مرنا، يسمح للألفاظ أن تتشابك مع بعضها بسهولة نسبية لتكوين المفاهيم والجمل المفيدة (وهذا هو الشعر).
أشرت بعد ذلك إلى كيف أن لغة الشارع، وبالذات اللغة الشبابية، (وأضيف هنا إليها اللغة المسماة: لغة “البيئة”) هى – بشكل ما – تجديد للغة ولو بدا استسهالاً عشوائيا، من حيث أن ظهور هذه اللغة هكذا هو نوع من الاحتجاج على موت اللغة التى كانت ثرية حين كانت تحتوى معانيها، ثم ماتت داخل الألفاظ المغتربة نتيجة للقهر والإفراغ، ثم ألمحت كيف أن الشعر هو القادر على إحياء الألفاظ وهى رميم، بإعادة تشكيلها نغما وصورة.
حين يقول المتن هنا: “اللفظ قام من رقدته”، إنما يذكرنا مرة أخرى بأنه مهما ماتت الألفاظ اغترابا فإنها هى هى الأبجدية التى يمكن أن تتشكل بها اللغة من جديد: شعرا وحفزا وثورة، ربما التعبير الأدق هو “الكمون” انتظارا لبعثٍ ما.
فى خبرة العلاج الجمعى، حين أواجِهُ بعض المرضى لأطلب منهم ومنى، ملتزمين بقاعدة: “هنا والآن”، أن ينطق أى منا كلمة واحدة أو اثنين بمعناهما الحقيقى مثل “أنا أقدر” أو “من حقى أن..” تقابلنى مقاومة شديدة لا أتوقعها ولايتصورها أحد، مع أن الكلمات تكون شديدة التداول، شديدة البساطة، فنستنتج أنه يبدو أن التركيز فى أن يُحضر الشخص (المريض) فى “هنا والآن” المعنى الذى يحتويه التعبير المطلوب، هو السبب فى هذه الصعوبة.
فى الألعاب النفسية أيضا فى العلاج الجمعى خاصة، نلاحظ أنه بمجرد أن تضيف صفة “بحقيقى“، أو “بحق وحقيق” ويكمل المشارك بسرعة وتمثيل ما يكتشف به كيف أنه لم يكن يستعمل نفس الألفاظ بهذا المعنى الذى دبّ فيها لمجرد استحضارها “هنا والآن” بمصاحباتها التمثيلية، وفى هذا السياق حتى تدب الحياة فى نفس الألفاظ، فتجرجر ما تيسر لها أن تجرجر من مضمون حتى لو لم نتعرف عليه من قبل، وهكذا.
فى موقف محدد أذكره كمثال، كان شديد الصدق والعنف والدلالة، كانت إحداهن تستنقذ فى مأزق علاجى بالله، وهى تصيح بشكل روتينى فاتر، قائلة: “يارب” وإذا بمساعدى ينبهها (وهو شاب يحاول جاهدا أن يعيش ويستمر محتفظا بالمعنى) أنها لا تعنى ما تقول، وأنها لو كانت تعنيه لأحست بذبذبات اللفظ تخرج من تحت إظفر إصبع قدمها، لاحظت كيف ساعد حماس مساعدى الشاب وتلقائيته فى أن يستعيد هذا اللفظ “يارب” وهو الذى نقوله فى اليوم عشرات المرات دون أن ينبض بحقه، كيف يستعيد نبضه حين يلتحم بالجسد، فينبض بمحتواه الصعب.
أعتقد أن مثل هذا الإحياء له مظاهر كثيرة فى كثير من نشاطات الحياة التى تحاول فى هذا الاتجاه، مثل الذكر عند بعض الصوفية بترديد اسم معين، ومثل أداء بعض المغنين لنفس اللفظ وهم ممتلئون به، فيصل إلى المتلقى بما يحمله، مِنْ أم كلثوم إلى مايكل جاكسون، لا أحسب أن عبقرية غناء أم كلثوم تكمن فى جمال صوتها فحسب، بل هى – كما وصلتنى بعد رحيلها بالذات – ترتبط بقدرتها الفائقة على أن تعطى لكل لفظ فرصة أن تنبض به حياة جديدة، ثم إنى أدركت مؤخرا سر شعبية مايكل جاكسون، حين شاهدته بعد وفاته([9])، جاكسون لم يتوقف عند ملء اللفظ بمعناه، بل تمادى إلى تحقيق عبقرية تمازُج اللفظ مع النغم مع الحركة لجسد “يقول“، فتكتمل الرسالة وتحرك ما يقابلها فى المتلقى فيتصاعد الأداء ويخترق محرّكا الوعى الفردى والجمعى بما هو.
القرآن الكريم بدون تفسير:
أحيانا يكون تفسير اللفظ الخاص فى سياق خاص مفسداً لعملية الإحياء والتحريك هذه، أدركت ذلك حين كان بعض مرضاى يلجؤون إلى ما يسمى “العلاج بالقرآن”، إذ غالبا ما يقوم المعالج – هو وليس المريض – بقراءة بعض آيات القرآن الكريم معتقدا أن هذه الآية أو تلك تعالج هذا المرض أو العرض بالذات، وهكذا، فكنت لا أشجب الفكرة تماما، بل أحدد شروطى الخاصة لاحتمال فاعليتها، فألفاظ القرآن الكريم وصفت بأنها يمكن أن تجعل الجبل خاشعا من خشية الله، فهى – غالبا حتى تؤدى هذا الدور– لا تحتاج تفسيرا بشريا، وصيَّا عليها، بقدر ما تتطلب أن تـَرِد فى سياق، وجرعة، وحالة من التهيؤ تسمح بأن تحرك وعى المتلقى بما هى، وليس بما تعنيه فى المعاجم، أو بما يقوله المفسرون عنها، وقد أذكـّر مريضى بآيات خشوع الجبل([10])، ثم أوصيه إن أراد الاستعانة بالقرآن الكريم أن يقرأ بنفسه جزءا محددا (ربع حزب مثلا، كل تانى يوم مثلا) بالترتيب دون انتقاء ودون فهم ودون تفسير، وأنا لا أقصد بذلك مفعولا سحريا خاصا، لكننى أحاول أن أحوّل ممارسته الاغترابية المفرطة المستسلمة التابعة عن طريق “وسيط”، إلى فرصة احتمال تواصل مباشر بين نغمته الخاصة، ونغمة “المابعد” (الغيب) من خلال هذا الوسيط القادر، أعنى الألفاظ المقدسة، بفضل احتمال التحام نبضها بالوعى الكونى:
“ربك كريم ينفخ فى صورته ومعنته”
تتلاحم أنغام مستويات الوعى مع بعضها بكل هذا الثراء النابض فى سياقها الخاص، دون لفظنتها الاغترابية ([11]).
ربما هذا التوجه، الذى لم أتبينه إلا مؤخرا، كان وراء ما جاء بالمتن منذ أكثر من ثلاثين عاماً مشيرا إلى أن ما تحيى الألفاظ لتنبض بمعانيها من جديد هى تلك الصحوة/البعث، التى تسمح بالتناغم بين الوعى الذاتى والوعى الكونى إلى وجه المطلق، توجـٌّـها إلى وجه الحق تعالى (وليسمه من يشاء ما يشاء)، فتصبح الألفاظ التى كانت قد تحولت بالقهر والإهمال إلى: “ظرف رصاص فاضى مصدِّى ف علبته”، تصبح ملتحمة بكل من معناها، فى تشكيلها الجديد:
“ربك كريم ينفخ فى صورته ومعنته”.
التشكيل الأشمل للوعى الخاص والعام:
التأكيد هنا على أن هذا الإحياء ليس عملية عقلنة منفصلة بقدر ما هو أمل فى تشكيل تناغمى بين الوعى الذاتى والوعى المطلق أو الوعى الكونى من خلال ألفاظ استعادت حيويتها، هو ما يلحق ذلك من إشارة إلى وسيط آخر، وهو التناغم مع الطبيعة
“يـِرْجـَعْ يغنـِّى الطير على فـْروع الشجرْ”.
حين يترسخ الاغتراب حتى تموت الألفاظ أو تكمن هامدة، ينفصل الإنسان عن الطبيعة، وحين يعزف اللحن النابض من جديد، يعود الإدراك إلى تلقى الأصوات لغة قادرة جديدة، قلنا من قبل إن الكلام حين يموت، يصبح مجرد أصوات بلا معنى،
“مر الهوا صفر كإن النعش بيطلع كلام”
فيتم الاغتراب، وتتوقف حركية النمو، هنا انعكست الصورة فأصبحت الأصوات (أصوات الطير) غناء له معنى يروح يندمج فى اللحن الأكبر فالأكبر أيضا، فيتم التواصل بين الوعى الذاتى، ووعى الطبيعة إلى الوعى الكونى، فهو اللحن البعث الجديد
“ويقول يارب”
الرد يأتى من داخلنا دليلا على عمق التكامل مشيرا إلى بؤرة الوجود المتناغم
“وتجيلـُه رد الدعوة من قلبه الرِّطب”.
وكأن الردّ يأتى ممن هو أقرب من حبل الوريد، ممتدا إلى كرسيه الذى وسع السموات والأرض سواء بسواء، ولعل هذا ما أعنيه عادة، بتناغم الوعى الذاتى مع الوعى الكونى، هكذا تعود الألفاظ بكل عنفوانها وقدرتها لتقوم بدورها فى التناغم والثورة، والتغيير، لتنطلق مسيرة النمو.
بعض آليات إحياء الألفاظ فى العلاج الجمعى:
فى العلاج النفسى الجمعى، وهو الموضوع الأساسى فى الكتاب الثالث فى هذا العمل، نتدرج فى إحياء الكلام بشكل غير مقصود مباشرة، لكن هذا هو ما يتم من خلال آليات محددة لا نقصد بها فكرة “إحياء الألفاظ” تحديدا، وإنما يكون ذلك بعض نتائجها الهامة.
ويمكن عرض بعض هذه الآليات فى خطوطها العريضة على الوجه التالى:
-
التركيز شبه المطلق على أن يكون التفاعل فى “هنا والآن”، وهو الأمر الذى يستتبعه الابتعاد عن التعميم والتبرير، والإقلال من التفسير والتأويل، وفى هذا يمارس المعالج نهيا متصاعدا عن استعمال تعبيرات تبدا بألفاظ مثل “الواحد”….، “الناس”….، “الإنسان” ..إلخ.
-
التنبيه إلى أن النصائح المباشرة، إلا ما يمكن تطبيقه واختباره فى “هنا والآن”، هى أيضا مهرب من احتواء اللفظ لمعناه لصعوبة اختبار تنفيذ فاعليته حالا.
-
تحديد أسلوب التخاطب بـ “أنا – أنت”، يتبعه تلقائيا تحمل مسئولية الخطاب والتلقى، فلا تستعمل صفات أو ضمائر الجمع مثل “كلكم، كلنا”، وأيضا لا يستعمل ضمير الغائب (هو، هى، هم) ما أمكن، وقد لاحظنا كيف أن ذلك يستتبعه تضييق مساحة الفائض اللفظى بشكل يحيى نبض الألفاظ.
-
الألعاب العلاجية تتطلب كلا من التمثيل بكل معنى الكلمة، حتى أننى اسميتها المينى دراما minidrama كما تسمح بتأليف بقية النص المحذوف (إبداعا مباشرا) مع ممارسة مبدأ “أنا – أنت” “هنا والآن” فى نفس الوقت، وبالتالى تتيح الفرصة لتكامل وسائل التعبير (الفقرة التالية بند 5)
-
استعمال وسائل أخرى للتواصل غير اللفظى (ليس اللغة الإشارية، التى هى نوع آخر من الرموز) بما فى ذلك لغة الجسد، ولغة العيون (انظر الكتاب الثالث([12])) وتعبيرات الوجه …إلخ، سواء فى الألعاب أو غير الألعاب، وهذا لا يدل على احتمال الاستغناء عن الألفاظ ، بل قد يكتشف المريض من خلاله إلى أى مدى كان مبتعدا بألفاظه عن ذاته، أو جسده، أو بقية وجوده، وقد يتم ذلك فى نوع من التمثيليات النفسية (السيكودراما): الصامتة، أو الناطقة.
-
استعمال الاحتمال العكسى للألفاظ والجمل، بتدريب وتمثيل أيضا، وهو وسيلة يتحدد بها كل من الأصل وعكسه، مثلا يقول المريض “أنا مش قادر أعبر”، فتطلب منه أن يقول (ويمثل) “أنا قادر أعبر” – تمثيلا – ثم بالتبادل، فنحول بذلك دون تداخل الشكل مع الأرضية (بالتعبير الجشتالتى)، فيمارس المريض والمعالج نوعا من التحديد الذى يسمح للّفظ أن يستعيد مضمونه الدال.
-
الإقلال من استعمال ألفاظ التقريب ما أمكن ذلك (مثل “تقريبا” “نص نص” “مش قوى” “يعنى”..إلخ).
-
الإقلال من استعمال تعبيرات التأجيل مثل: أصلى ناوى “إن شاء الله” (بالمعنى الهروبى)، “حاحاول”، ..إلخ.
-
تجنب استعمال الحِكَمْ والأمثال ما أمكن ذلك؛ منعا للاستدراج إلى التعميم والإفراط فى التجريد، وأيضا تجنب استعمال ألفاظ التعميم أو الإحالة مثل “الناس” “الواحد” ما هو كلهم”.
10- التعامل مع الأسئلة باعتبارها مشروع إجابات: يُطلب أحيانا من المريض أن يقلب سؤاله إلى جملة إخبارية برفع علامة الاستفهام، أو يطلب منه أن يجيب هو أولا على سؤاله إجابة محتملة، أو أن يقول مايتصور ان المسئول (معالج أو زميل مريض) سوف يجيبه به
إمراضية الإفراط في تحميل اللفظ معناه:
برغم الحرص الشديد على أن يحتوى اللفظ معناه، لعلنا نتذكر كيف أشرنا إلى أن ذلك هو عبء شديد إذا ما بولغ فيه، وقد لاحظت فى بعض حالات الفصام، خاصة فى نوع الفصام المبتدئ، وأيضا فى بعض حالات الاكتئاب أن المريض يشعر فجأة أنه ينبغى عليه أن يعيش كل لفظ ينطقه بحقه تماما، أى أن يكون اللفظ هو معناه بالضبط وكما ينبغى، فإذا تصورنا أن الجمل تتكون من وحدات متتالية مثل السلسلة المترابطة، فإن الأسهل أن تكون حلقات السلسلة مرنة وخفيفة حتى يتم الترابط والتسلسل بما يحقق تماسكها فوظيفتها الأشمل فالأشمل، فإذا تصورنا أن المبالغة المرضية فى أن تكون كل وحدة (حلقة) مليئة ثقيلة بما تحتويه من مضمون، فإن التسلسل قد ينقطع، وقد فسرت بذلك بعض ما ينتهى إليه المريض مما نسميه “فقد الترابط” Incoherence، الذى هو بهذا التفسير ليس نتيجة أن الألفاظ صارت بلا معنى، ولكنه نتيجة أن الألفاظ لفظا لفظا قد امتلأت بمضامينها مستقلة، فازداد ثقلها لدرجة عجزت معها أن تترابط مع ما قبلها وما بعدها.
الألفاظ الثورة:
حين تـُبعث الألفاظ من جديد، وتنبض بمضمونها، وتحفز إلى غايتها، تصبح ثورة فى ذاتها، ولعل هذا بعض ما كان يعنيه أدونيس وهو يميز بين “شعر الثورة” (الشعر التحريضى)، وبين الشعر الثورة، الذى هو تشكيل مغيّر يُحيى اللغة ويجددها.
والمتن التالى (نهاية المقدمة) يشير إلى توظيف اللفظ للنقد والتحريض، أكثر من تحضيره فى تشكيل جديد (الشعر شعر):
ألفاظ بتهِزّ الكُونْ،
وبتضربْْ فى المَلْيَانْ،
وتغّير طَعْمِ الضِّحْكَةْ،
وتشع النُّورْ مِا الضَّلمَهْ،
وبتفضَحْ كِدْب السَّاكِتْ،
وبْتِفْقِسْ كل جَبَانْ.
استشهادان ختاميان:
الألفاظ التى تحتوى معناها، فيكون لها كل هذا النبض، وكل هذا الإحياء، ليست هى الألفاظ الجميلة، أو الرنانة أو الجذلة، بل هى “أى لفظ كان”، حالة كونه ينبض بمعناه سلسا منسابا.
وفيما يلى مقتطفان يثبتان ذلك بشكل أو بآخر:
الأول: من أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ (1994)، وقيامى بنقدها (يحيى الرخاوى سنة 2006).
والثانى: من قصيدة باكرة لى فى ديوان “البيت الزجاجى والثعبان” (1983) استلهمتها من السعى بين الصفا والمروة، ذات عمرة. (قبل أصداء محفوظ بعشر سنوات).
المقتطف الأول:
الصدى رقم 78 من أصداء السيرة، (محفوظ سنة 1994)
78 – البلاغة
قال الأستاذ “البلاغة سحر” فآمنا على قوله ورحنا نستبق فى ضرب الأمثال. ثم سرح بى الخيال إلى ماض بعيد يهيم فى السذاجة. تذكرت كلمات بسيطة لا وزن لها فى ذاتها مثل: أنت،.. فيم تفكر؟… طيب،. يا لك من ماكر!… ولكن لسحرها الغريب الغامض جن أناس،.. وثمل آخرون بسعادة لا توصف،..
النقد: ([13])
على صغر هذه الفقرة، فإنها تطرحنا أمام قضية نقدية لأعمال محفوظ، أنا لست متأكدا من أنها نالت حقها من الدراسة، وهى قضية اللغة، وإن كنت قد قرأت أكثر عن علاقة يحيى حقى باللغة مبدعا، وإلى درجة أقل ناقدا، فهنا ينبهنا محفوظ إلى نوع من البلاغة تستأهل الوقوف عندها، وأنها ليست أبدا، ولا أصلا ذلك البريق الذى ينبعث من ظاهر الألفاظ أو زينة الأسلوب، وليست هى أيضا: الحـِكـَم الرصينة المختصرة التى تنطلق من مثل أو بيت شعر، بل إن الحديث بالأمثال والاستشهاد بالشعر قد يصبح ضد البلاغة بالمعنى الذى تتناوله هذه الفقرة، وربما بالمعنى الذى قال فيه صلاح عبد الصبور “يأتى من بعدى من يعطى الألفاظ معانيها” “يأتى من بعدى من لا يتحدث بالأمثال”([14])، أما البلاغة التى يقدمها لنا هنا محفوظ فهى أن يحمل اللفظ – أى لفظ – معناه تماما، فيصبح سحرا قادرا أن يثمل به الناس فى سعادة لا توصف، وأن يجن آخرون. أية ألفاظ هذه التى تـسكر وتـجن؟ ألفاظ غاية فى السذاجة، هى فى ذاتها كأصوات – أبعد ما تكون عن البلاغة مثل “أنت” هكذا فقط: “أنت”، أو “فيم تفكر”؟ نعم “فيم تفكر” أو “طيب” أكرر: “طيب” ثم “يالك من ماكر”،…… أعنى “يالك من ماكر”.
هل أدعوك – عزيزى القاريء – أن تتوقف عند هذه الألفاظ فتكررها أنت للمرة الثالثة بصوت مرتفع، ثم تترك كل لفظ (أو تعبير) منها يرن فى وعيك شخصيا دون محاولة أن تكمل، ودون محاولة أن تتذكر حوله أو به أو منه شيئا، إذا فعلت ذلك “هكذا”، فسوف تعرف علاقة محفوظ باللغة، فى هذا النصّ، وربما تتصالح عليها، وربما، يصلك كيف يمكن أن تدب الحياة فى الألفاظ فى العلاج الجمعى ونحن نركز على أنا أنت: “هنا والآن” تصورت أننا نكرر ألفاظ محفوظ هذه فى جلسة من العلاج الجمعى وجدتها تجذبنى إلى هنا والآن” بكل ما تعنيه ونمارسه فى هذا العلاج.
المقتطف الثانى:
من قصيدة “أنهار المسعى السبعة”
ديوانى: “البيت الزجاجى والثعبان” (سنة 1983)([15])
………………….
وتقول الناس الأنهار
للناس التيار:
…………….
…………….
قال النهر السادس:
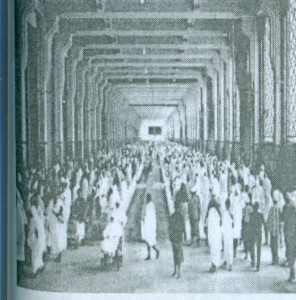 لو أن السعى تناغـَمَ بعد السـَّعـْىِ إلى السـَّعـْىِ
لو أن السعى تناغـَمَ بعد السـَّعـْىِ إلى السـَّعـْىِ
لرجعـْنـَا أطهرَ من طفلٍ لم يولدْ بعدْ
لا نتكاثر بالعُـدّةِ والعدّ
ولعادَ المـعــْـنى
يملأ وجه الكلمهْ
يهتز الكون:
لو يعنى القائل “أهلاً”
أنْ: “أهلاَ“
ولأنى كاتب هذا النص، فاسمحوا لى ألا أعلـّق.
الفصل الثانى:
(اللوحات: من 1 – 7)
اللوحة الأولى:([16])
من ْشطّى لـْـشَـطِّى
العلاج النفسى هو مسيرة “معا” نحو مواصلة الحياة بما خلقتْ به لما خلقتْ له، وهو يتواصل بمشاركة خبرة سابق وتعثر لاحق!
يحدث ذلك عادة بعد وقفة، أو قفلة، أو عرقلة، حين يحول أى من ذلك دون استمرار مسيرة النمو الفردى، (فهو المرض).
إن أى “تغيير” حقيقى، هو مخاطرة من حيث المبدأ، ربما لهذا فإن التغيير يحدث عادة دون وعى كامل، بل هو عادة لا يحتاج إلى قرارٍ واعٍ أصلا، التغيير المستمر هو نتاج طبيعى لحياة صحيحة طبيعية، والعلاج النفسى يهيئ الفرص لتحقيق هذا بإزالة العرقلة أو تصحيح الإنحراف عن المسار النمائى الطبيعى.
ولكن هل توجد مواصفات محددة للتغيير الذى نعنيه فى العلاج وغير العلاج؟ وما هى المقاييس التى نقيس بها ما نسميه: “حياة طبيعية”؟
لا شىء يستحق أن يوصف بصفة أنه “حياة” لو كان غير عرضة للتغيير، من البديهى أن نفترض أن التغيير لا بد أن يتم إلى أحسن، أما ما هو الأحسن وما هو الأسوأ فهذا أمر نختلف حوله للأسف بما لا يقاس.
فى الأحوال التى نسميها “عادية” لا يحتاج الأمر للحديث عن التغيير باعتبار أنه يجرى ولو من وراء ظهورنا، أما فى حالات المرض، فالدعوة للتغيير تفرض نفسها من خلال ما يسمى “العلاج”، وذلك بهدف تحويل مسار التغيير السلبى الذى كان نتاجه المرض، إلى تغيير إيجابى.
فى جميع الأحوال، ومهما صنفنا التغيير إلى سلبى أو إيجابى، وكذلك مهما بدت حتميته أو أُعـْلـِنت ضرورته من خلال ظهور الأعراض وتجسيد الإعاقة، فإنه يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر حتى لو سمى علاجا، لعل ما وراء هذا ما تعنيه حكمة شعبية بالغة الدلالة تقول محذرة: “اللى تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش“، ليكن، لكن المرض هنا قد أعلن فى نهاية المطاف أن الذى تعرفه فى هذا الظرف بالذات هو ليس “الأحسن”، وهكذا نجد أنفسنا فى الموقف العلاجى وقد خرجت المسألة عن مجرد “عـَرْض” اختيارى (Option) للتغيير إلى أنه ضرورة يفرضها المرض بشكل أو بآخر (ولو من حيث المبدأ).
نحن لا نقصد بالتغيير من خلال العلاج مجرد اختفاء الأعراض الظاهرة على السطح، الأعراض تختفى أحيانا لتحل محلها حالة من اللاأعراض التى قد تكافئ أحيانا حالة من اللاحياة إذا ما توقفت الحركة لحساب مجرد اختفاء الأعراض الإيجابية الظاهرة.
قد تختفى الأعراض كحيلة دفاعية ضد احتمال التغيير الذى تدعونا إليه خبرة المرض، ذلك أن المرض بقدر ما هو سلبى، قد يكون فرصة لإعادة النظر، ومن ثم التغيير، فهو دعوة ضمنية للتغيير، ومن هنا يبدأ التهديد.
ونظرا لأن أى تغيير هو مغامرة تحفها المخاطر، فقد يكون الحل عند المريض أن “يرجع فى كلامه” ويتنازل عن الحل المرضى، وبالتالى يتجنب مخاطرة التغيير، بمعنى أن الأعراض قد تختفى تحت تهديد التغيير.
نحن لا نرفض ذلك فقد يكون مفيدا مرحليا، لكننا ننبه فقط إلى أن مجرد اختفاء الأعراض فى حد ذاته ليس دليلا على التـَّغـَيـُّر، بل إنه قد يكون تراجعا عن المحاولة (وهذا نوع – على أية حال – من العلاج لاينبغى رفضه لأنه الغالب).
وكما اتفقنا نبدا بالمتن مكتملا كما ظهر فعلا فى الطبعة الأخيرة فى ديوان “أغوار النفس”([17]) ثم تبدأ التداعيات.
(1)
 الشط التانى الـْمِشْ بايِــــنْ:
الشط التانى الـْمِشْ بايِــــنْ:
كل مااقَرّب لُهْ، يتــَّاخِـرْ.
وِمراكبْ، وقلوعْ، وسفايــنْ،
والبحر الهــِوّ مالوش آخــــرْ.
(2)
لأ مِشْ لاعِبْ.
حاستنى لمّا اعرف نفسى، من جـوّه.
على شرط ما شوفشِى اللـِّى جــوَّهْ.
واذَا شفته لقيتـُـه مشْ هـُوٍّه،
لازِمْ يفضَلْ زىْ ما هُوَّهْ.
(3)
أنــا ماشى ”سريع” حوالين نفسى،
وباصبّح زىْ ما بامَسِّى،
وانْ كان لازم إنـّى أَعدّى:
رَاحَ اعدّى مِنْ شَطىِّ لـْـشَطِّىْ،
هوَّا دَا شَرْطى.
(4)
ولحدّ ما يـِهـْدَى الموج،
واشترى عوّامة واربطها على سارى الخوف،
ياللا نقول “ليهْْ”؟ و”ازاىْ؟”
”كان إمتَى”؟ “يا سَلاْمْ”! “يِـبـْـقَى انَا مَظْلومْ”.
شكر الله سعيك!!
****
انطلاقا من المتن:
(1)
الشط التانى الـْمِشْ بايِــــنْ:
كل مااقَرّب لُهْ، يتّاخِـرْ.
وِمراكبْ، وقلوع، وسفايــنْ،
والبحر الهــِوْ مالوش آخــــرْ.
الشائع أن رحلة العلاج تبدأ بطلب مباشر أو غير مباشر من المريض أن “يرجع كما كان” (عايز أرجع زى ما كنت قبل ما اعيا)، وهو مطلب مشروع بداهة، لكن العلاج النمائى Growth Oriented Therapy ينبه بطريق مباشر أو غير مباشر أن هذا المطلب، مع أنه منطقى وطيب ومعقول، إلا انه ليس هو غاية المراد، لأن حالة الـ “ما كان عليه”، الذى يريد المريض أن يرجع إليها، هى هى التى أدت إلى المرض، ومن ثـَمَّ نوصل للمريض أنْ هيـَّا نهمّ معا لنطلب، أو نأمل، أو نعمل على: أن “نرجع” (يرجع المريض معنا) أفضل مما كان، عادة يوافق المريض آمِلا، ويتمنى الطبيب([18]) مجتهدا، (لكن: ما كل ما يتمنى المرء يدركه!!).
الإشكال فى هذه الدعوة (العزومة) إلى أن نـَخـْرُجُ أحسن مما كنا فيه هو أن أى تغيير هو نقلة إلى مجهولٍ ما، الصورة هنا تبدوا وكأن المريض واقف على شاطئ هش، ينذر بالانهيار، أو انهار بعضه فعلا، وبالتالى فهو يهمّ أن يعبره إلى الشاطئ الآخر (التغيير)، لكن هذا الشاطئ الآخر، برغم التأكيد أنه موجود، إلا أنه غير ظاهر.
“الشط التانى المش باين“،
ليس هذا فحسب، بل إنه شاطئ يبتعد كلما اتجهنا نحوه، وكأنه سراب بشكل أو بآخر.
“كل مااقَرّب لُهْ، يتّاخِـرْ“،.
حتى نشك أنه موجود أصلا:
“والبحر الهـِوّ ما لوش آخر”،
هذا فضلا عما يكتنف رحلة العبور من أهوال الزحام وأخطار التصادم “ومراكب، وقلوع، وسفاين“.
إن ما يحدث فى العلاج النفسى غالبا أنه كلما لاحت معالم تغيير ما، تـَمَّ نفىُ الاحتمال تلقائيا، أو تم التراجع عنه بالمحو، بمعنى أن المريض، من فرط تردده ورعبه من التغيير، وبرغم رغبته فيه فى نفس الوقت ولو من حيث المبدأ، يبادر بأن يمحوه أولا بأول.
إذن ليس الشاطئ هو الذى يتباعد باستمرار، ولكن المريض يكتشف أن المراد بعيد، وصعب المنال، وغير مضمون “كل ما اقربْ لهْ يتّأخر“، فيتخذ قرارا داخليا أنه لا داعى (الطيب أحسن!!)، ويتراجع (داخل داخله، حتى لو بدا متعاونا ظاهريا)، وتظهر تبريرات التأجيل بما يشاع عن العلاج والتفسير والتأويل فى الجزء التالى من المتن:
(2)
لأ مِشْ لاعِبْ.
حاستنى لمّا اعرف نفسى، من جـوّه.
على شرط ما شوفشِى اللـِّى جــوَّهْ.
واذَا شفته لقيتـُـه مشْ هـُوٍّه،
لازِمْ يفضَلْ زىْ ما هُوَّهْ.
برغم أن التغيير هو محور العلاج كما أشرنا، إلا أن مقاومته أيضا هى قضية التحدى التى لا ينجح العلاج إلا بحمل مسئولية التصدى لها، إعلان المريض هنا (من مستوى أعمق، بعيدا عن ظاهر الوعى عادة) أنه لن يغامر بالتغيير الحقيقى “لأ مش لاعب“، هو التفاعل المبدئى الذى يجب أن ننتظره منه كاستجابة عميقة تعلن مخاوفه من مغامرة التغيير، وعلينا أن نتساءل: فلماذا حضر إذن للعلاج؟ علما بأن ظاهـِرَهُ قد يعلن فى نفس الوقت أنه جاهزٌ للتغيير وراغبٌ فيه.
لا أحد يحضر للعلاج ليتغير بالمعنى الحرفى للكلمة، برغم أن هناك الكثير من المرضى يطلبون ذلك من أول مقابلة، لكن هؤلاء بالذات غالبا هم الذين لا يتغيرون، التغيير ليس مطلبا “من الوضع جالسا”، كأنك تطلب “واحد شاى!!”، لا يوجد شىء اسمه “عايز واحد تغيير وصلّحه”، كما لا يوجد تغيير سهل مثل تغيير لون الشعر مثلا.
فى جميع الأحوال علينا أن نتوقع، ونحترم هذا الموقف الرافض للتغيير، الخائف منه، هذا حق المريض وطبيعة الأشياء، بمجرد أن يدرك المريض، ولو من بعيد، أن المسألة جِد خالص تحتاج إلى جهد حقيقى، لا يتوقف عند مجرد التفريغ أو الترييح، تبدأ المقاومة.
هذا الموقف المقاوِم هو موقف أصدق من زعم طلب التغيير دون دفع ثمنه، وهنا يقفز إلى السطح سؤال بديهى، إذا كان الرفض هو الموقف الأصدق، فلماذا حضر المريض أصلا، وماذا يمكن عمله إزاء ذلك؟
كثيرا ما يحدد المريض أنه حضر لأنه يريد “أن يعرف نفسه“، ويتصور أن الطبيب قادر على أن يعرّفه نفسه، وكأن مهمة الطبيب هى أن يقرأ الطالع أو يحكى ما يقوله له “الوَدَع” الطبـِّى (مثل ضاربة الودّع).
وفى أحيان أخرى يتصور المريض ابتداءً أو يطلب من الطبيب صراحة أن يساعده على أن “يعرف نفسه”، وبالتالى: إنْ كان لا بد من التغيير فيكون بعد أن “يعرف نفسه”، وكأنه يقول إنه يريد أن يقبل ما يقبل، وأن يغير ما يغير، بناء على هذه المعرفة، فربما لا يحتاج الأمر إلى تغيير أصلا بناء على زعم أنه “عرف نفسه، فوجدها تمام التمام!!
التحليل النفسى، أو الإشاعات التى دارت حوله، هو مسئول نسبيا عن هذه الوقفة، صحيح أن العلاج يسمح بشحذ البصيرة، ومن ثم معرفة النفس، وأنه كلما كان النور كافيا، كانت المسيرة أكثر أمانا، وأن المعرفة هى الخطوة الأولى نحو اتخاذ القرار، لكن المسألة تتوقف على طبيعة المعرفة، وليست على مجرد المعرفة؛ فقد تكون المعرفة المعقلنة هى البداية والنهاية، وهذا تعطيل واضح، وقد تكون تعطيلا دائما لمسيرة العلاج. بل إن المعرفة، حتى من خلال التحليل النفسى قد تدور بعيدا عما ينبغى أن نعرفه، فكثير من تحليلات المحللين النفسيين تدور فى المساحة التى يسمحون بها لأنفسهم – من خلال إطارهم النظرى – أن يبحثوا فيه، أما باقى الأهوال البعيدة عن تنظيرهم، وأحيانا البعيدة عن تحملهم، فهى تزداد إظلاما وبُعدا، (يصدق هذا أيضا على كل مـُـنـْـتـَـمٍ لنظرية نفسية أخرى ثابته محكمة([19])، مهما كانت الأقرب إلى الحقيقة والصواب).
يأتى النص هنا وينبه أن المريض والطبيب معه يتوقفان عند حدود المنطقة المتاحة، حتى لو كان الزعم المبدئى هو كشف ما بالداخل (من جوه).
انفصل يونج عن فرويد، ونبهنا إلى أن فرويد يلعب فى ملعب تدريبى صغير، هو ما أسماه اللاشعور الشخصى، أما الملعب الأكبر، او الأهم، فهو الملعب الأصلى الذى أسماه يونج “اللاشعور الجمعى”، وفى رأيى أن غضب فرويد من يونج، (وحسده له، ربما) وتأثره من تركه، لم يكن فقط لأنه المسيحى بين مريديه الأوائل، وإنما لأنه تجاوز المنطقة التى توقف عندها فرويد.
النص هنا ينبه إلى أنه من الجائز أن نجد، أو على الأقل أن نفترض، أن ثمة طبقات تكمن وراء ما نكتشف باستمرار، وبهذا ينقلب العلاج النفسى إلى مسيرة من الكشف والإبداع تتواصل مع التقدم باضطراد وهى تنتقل من معرفة محتوى الداخل، وربما فك رموزه، إلى معرفة “الطريق (المنهج) إلى المعرفة” بشكل ليس له نهاية([20])، معرفة المنهج بالتدريب العملى، أهم من تقليب المحتوى، إذن فطلب المريض أن ينتظرحتى يعرف نفسه من الداخل، هو طلب لن يتحقق أبدا، لأنه لن يعرفها كما هى أبدا، والمتن ينبهنا هنا إلى أن أغوار المريض تحذر أن تكشف عن نفسها، لأن صاحبها نفسه لا يريد ذلك “على شرط ما شوفشى اللى جوه“.
ثم إنه حتى لو رضينا بالتوقف عند معرفة الممكن أو المسموح برؤيته، فإن هناك آلية دفاعية (ميكانزما) جاهزة لتثبيت التوقف والاكتفاء بالمعرفة دون الفعل، أى دون تغير حقيقى، المتن ينبهنا هنا إلى أن المريض لو اكتشف من خلال هذه المغامرة المعرفية (المـُـعـَـقلنة) أن هذا الذى رآه هو فعلا ليس كما توقع، أو كما يرجو، “واذا شفته لقيته مش هوّه”، فإن تفاعله الأعمق، يمكن أن يكون عكس الظاهر، بمعنى أنه بدلا من أن تؤدى هذه المعرفة إلى التغيير كما بدأ التعاقد، فإنها قد تكون بديلة عن التغيير و”يستمر الحال على ما هو عليه، وعلى الأعراض أن تلجأ إلى الاختباء!!”([21]).
وحتى لو لم تختف الأعراض، فيمكن أن يكون الحل هو أن يعتادها المريض!!([22])
يستمر المتن يكمل نفس التأكيد على أن مجرد الكلام قد يكون وسيلة لتنمية بصيرة معقلنة، ليست أكثر من استبصار ذاتى مع وقف التغيير([23])، مما قد يكون هو السبب فى إعاقة النضج.
(3)
أنــا ماشى ”سريع” حوالين نفسى،
وباصبّح زىْ ما بامَسِّى،
وان كان لازم إنى أَعدّى:
رَاحَ اعدّى مِنْ شَطّىْ لـشَطِّىْ،
هوَّا دَا شَرْطى.
من أشهر الإشاعات التى روج لها بعض ما شاع عن التحليل النفسى، وعموما، هى مقولة أنه: “إذا عـُرف السبب بطل العجب”، وبالقياس يمكن تصور لسان حال البعض “إذا فـُـسـِّـرَ العرض بطـُلَ المرض”، وهذا وذاك هو ما نحاول ضحده، حتى إذا انتقلت “المعرفة” إلى “رؤية” ومواجهة و”انتقلت” الرؤية إلى “كشف” وتعرية أعماق الأعماق، فإنها وحدها لاتكفى للنمو النفسى (التطورالذاتى) إذا غلبت عليها المعرفة المعقلنة أكثر من التبصر الوجدانى.
ولكن بما أن الحياة هى الحركة، التى لا يمكن إيقافها طالما نحن نتمتع بما يسمى حياة، فإن التوقف عادة لا يكون توقفا بمعنى الوقوف فى الموقع أو اللاحراك، وإنما بمعنى الحركة فى المحل، “محلك سر“، بل أحيانا ما تكون ثمة حركة نتاجها سلبى، كما سبق أن ذكرنا فى “المقدمة” (سـِرْ بضهرك).
ثمة حركة قد تتم بحماس شديد، لكنها تحمل مقومات إلغاء ناتجها بنفس الحماس، ذلك لأنه قد يثبت أنه حماس مشروط بوقف التنفيذ، المريض هنا، وأحيانا المحلل أو الطبيب قد يعلن القبول – بل وضرورة القبول – بفكرة التغيير، وهو لا يألو جهدا ظاهرا فى السير فى هذا الاتجاه، لكن يبدو أن المريض عادة ما يفعل ذلك بناء على ضمان سرى أنه فى النهاية يملك آلية محو كل ما تغير أولا بأول، ليبدأ من جديد نفس المحاولة وإن تغيرت تفاصيلها، وهو ينتهى إلى نفس النقطة دائما، وهكذا، وقد يُسمى هذا أحيانا “تكرار النص” Repetition of Script .
إن نظرية الاستعادة Recapitulation Theory [24] وهى عندى أساس التطور برغم النقد الشديد الذى لقيته وتلقاه مؤخراً، تقول بتكرار النص (الأنتوجينا تعيد نص الفيلوجينيا..إلخ)، لكن التكرار فى نظرية الاستعادة لا ينتهى إلى نفس النهاية بعد كل دورة، وإلا توقف التطور من بدايته، إن الاستعادة، غير الإعادة، لأنها تنتهى إلى إضافةٍ مَا إلى ما كان عند البدء، أى أنها تنتهى فى كل دورة فى نقطة غير نقطة البدء– إضافة حقيقية مهما كانت ضئيلة – ، أو هى تنتهى بتغير نوعى – مهما كان ضئيلا – لكنه تغير، أما إذا انتهت إلى حيث بدأت (موقعا وكماًّ)، وبنفس المواصفات التى بدأت بها (كـَيـْفاً)، فإنها تكون معطلة للنمو (العلاج)، بل وتكون خدعة مغتربة.
هذا هو الشرط الذى يعلنه المتن هنا، وهو ينطلق من داخل داخل المريض وليس من ظاهر حماسه.
“وان كان لازم إنى أعدّى،
راح اعدى من شطـِّى لشطـِّى،
هوّا ده شرطى”.
طبعا مثل هذا الشرط لا يُعـْلن صراحة، وبالذات لا يعلنه المريض لنفسه، فهو لا يصل إلى وعيه، ولكن على الطبيب أو المحلل أن ينتبه إلى احتمال أن يكون اطمئنان المريض إلى أنه “مهما تحرك، لن يتغير”، هو الذى يدفعه لتجاوب كاذب مع المعالج، لأنه ضامن – فى النهاية – أنه فى موقعه لا يتزحزح، مهما نشط.
كل هذا يكاد يشير إلى عكس ما يبدو أن المريض قد جاء من أجله، وكأن هدف المريض الأعمق والحال كذلك: هو ألا يشفى، فكيف ذلك وهو الذى سعى للعلاج؟ وطلب العون؟ ودفع الثمن (“مادة” أو “وشما” أو غير ذلك)؟
هذا كله محتمل أن يكون جانبا من الموقف أو الحقيقة، لكنه ليس كل الحقيقة، هو فقط ينبه إلى أنه ينبغى علينا ألا نـُـستدرج إلى التسليم لتغير ظاهرىّ مؤقت نرضى به فى حين أنه ليس تغيرا أصلا، وأيضا هو ينبه من جانب آخر أن نفهم كيف أن الشفاء هو مطلب رائع ظاهر، ولكن وراءه فى العمق قراراً أسبق هو ما نسميه “اختيار الحل المرضى” وهو اختيار على مستوى آخر من مستويات الوعى، وبالتالى فهو (المريض) فى هذا المستوى الأول غير مستعد أن يتنازل عن اختياره الحل المرضى بسهولة، فهو يقاوم كل الضمانات التى تغريه بالتغيير باعتبارها غير مضمونة، ومن ثم التمسك باللاتغيير هكذا.
مهمة المعالج هى استيعاب كل ذلك (مع المريض)، واختراقه، فتجاوزه.
“التغيير الكاذب” وارد أيضا، وكثير، ونعنى به أن نوع الوجود لايختلف، وحركية النمو لا تنطلق، ولكن يتغير الشكل من الظاهر فحسب، ومثال ذلك:
-
أن يحل عـَرَضٌ (أخفى) محل عرض (أكثر إزعاجا)، مثل: أن تحل اللامبالاة الخفيـَّة محل الانفعال الطفلى الفج.
-
أو تحل بصيرة مزيفة مرضية (ياه، لقد اكتشفت أننى فعلا متحوصل حول ذاتى) محل إنكار ما هو كذلك (بالعكس: أنا أحب كل الناس)، ثم لا حراك فى الحالين.
كل هذا مجرد إحلال وإبدال وليس تغييرا
كثير من المرضى حين يمرون بهذا المأزق يصطنعون (لأنفسهم وللمعالج وللآخرين) موقفا كأنه التغيير ذاته، ولكنه فى الحقيقة خدعة تكشفها ضعف المعاناة، وانتفاء الألم الصحى المصاحب للنقلات الحادة أو الخوف الذى يصاحب البصيرة الفاعلة الموضوعية، وقد يعلن ذلك بألفاظ رنانة، وفرحة تسكينية، وكأنّ ثـَمَّ تغيير قد تم بفضل العلاج وحسن النية، لكن اختبار نوعية التحول تثبت أنه تغيير اللون الظاهرى كما ذكرنا، أو هو إعادة نفس النص للوصول إلى نقطة نهاية، هى هى نقطة البداية، فهى الدائرة المغلقة برغم كل صخب الحركة الخادعة.
مرة أخرى:
“راحَ اعدّى من شطـِّى لـْشطى، هـَوا دا شرطى“.
يا ترى لماذا كل هذه المقاومة؟
كل هذه الشروط، والمهارب والمناورات إنما تنبع من الخوف الهائل من النقلة النوعية التى هى علامة التطور الحقيقية، النقلة فى العلاج النفسى – وأثناء النمو– ليست بالضرورة قفزة فى الخلاء دون تدريب أو إعداد، لكن طالما أنها نقلة نوعية بالضرورة، فثم خوف يحيط بها، وثمة جسارة تحتاجها، مهما بلغ الإعداد والاستعداد.
والخوف له مصادر متعددة برغم تفسير مصادره وتجلياته عبر مسيرة النمو منذ البداية إلى النهاية، وفيما يلى بعض ملامح ومراحل ذلك:
-
ثمَّ خوف بدئىّ يقال إنه موجود من صدمة الميلاد، منذ الخروج من الرحم إلى الناس.
-
ثمَّ خوف من العودة إلى الرحم : فلا ناس، ولا حياة. (الطور الشيزيدى).
-
ثمَّ خوف من العلاقة بالآخر (الموضوع) باعتباره مصدر الخطر لأنه مصدر الاختلاف ومن ثَمَّ “الكر والفر” (الطور البارنوى).
-
ثم خوف من التعلق جنبا إلى جنب مع: الخوف من الترك.
-
وحين نكبر أكبر، تتربص بنا مخاوف من مقدسات نعلن أننا نسعى إليها حثيثا ونحن نخاف منها جدا دون وعى ظاهر غالبا.
-
ثمَّ خوف من النمو والبصيرة الأعمق التى تضطرنا أن ندرك مدى مسئوليتنا عن كل ما يصيبنا (ولعله هو ما يقابل حمل الأمانة التى حملها الإنسان دون السماوات والأرض والجبال)
-
ثمَّ خوف من الإيمان (أن نذوب فى الكون دون رجعة).
العلاج النفسى النمائى يضع ذلك كله فى الاعتبار، لا ينكره، ولا يخضع لشروطه أو مبالغاته، وهذا يحتاج من المعالج أن يمارس هو نفسه مواجهة مخاوفه الحقيقية ربما مواكبا لمخاوف مريضه ليتجاوزاها معا إن كان صادقا فى محاولة مواصلة نموه.
العلاج النفسى التسكينى أحيانا يكون دوره هو أن يبرر هذا الخوف، ويعترف به ويفسره، فيصبح ملطـفا لحدته، ومسكنا لإرعابه.
(4)
ولـْحـَدّّّ ما يهدَى الموج،
واشترى عوّامة واربطها على سارى الخوف،
ياللا نقول “ليهْْ”؟
و”ازاىْ؟”
”كان إمتَى”؟
“يا سَلاْمْ”!
“يْبقَى انَا مَظْلومْ”.!!!!
شكر الله سعيك!!
قد يكون من باب احترام الواقع الموضوعى، وضبط الجرعة أن نرضى مرحليا بالعلاج التسكينى، فنسمح للعلاج النفسى – ولو مؤقتا– أن يقوم بدور المرفأ الذى يلجأ إليه الخائف حتى يهدأ موج التهديد بالغرق فى محيط المجهول، بل قد نرضى أن نوظفه بوعى ليحقق ذلك،
“واشترى عوامة واربطها على سارى الخوف“
إذن فهو التأجيل!
ليكن.
ولكن…: إلى متى؟
هذا هو فن التطبيب والعلاج.
الحاصل فى أغلب الأحوال (والحالات) أن يتوقف العلاج عند هذه المرحلة، ليصبح التأجيل المتكرر هو نهاية المطاف، يتم ذلك حين يستدرجنا الكلام إلى الفرحة بالتفسير والتبرير، والرضا بالشفقة (دون التعاطف والمواجدة) وبالدعم الظاهرى، حتى يختفى الخوف، أو يقل، لكن فى نفس الوقت يتم تزييف الحركة أو تنغلق الدائرة.
وسط هذا الإعصار من التهديد بالتغيير، بما يشمل من تضخيم خفى أو ظاهر فى مخاطر المغامرة به، تمر جلسات العلاج تلو الجلسات فى البحث عن الأسباب وكيفية حدوث ما حدث، خاصة فى فترة الطفولة!!!! مع ما تيسر من علامات التعجب ومظاهر المشاركة.
وقد يتوقف العلاج عند هذه المرحلة، فيستمر تأجيل التغيير إلى أجل غير مسمى. ليصبح هذا الأجل غاية الممكن الآن، مرة أخرى: حركة نشطة، لكن “فى المحل”.
لا بد أن نعترف، أن هذه المرحلة (التى لم تعد مرحلة فى هذه الحالة، بل نهاية للمطاف كما ذكرنا)، هى الغالبة فى كثير مما يسمى العلاج النفسى، بل والتحليل النفسى، لكن علينا أن نعترف أنه علاج نفسى حقيقى ومفيد أحيانا، لكنه ليس ما نريد تقديمه هنا، ولا هو ما نأمل فيه لكل الحالات فى كل الظروف، إذ قد يترتب على التوقف عند هذه المرحلة كنهاية للمطاف ألا يخرج المريض إلا بمبرر لمرضه، حتى لو سمى تفسيرا أو تأويلا “يبقى انا مظلوم، شكر الله سعيك“.
هذا موقف تبريرى قح، قد يقوم به العلاج النفسى تحت أوهام الشائع عن التحليل النفسى، يدعم هذا الموقف التبريرى كهدف خفى للسعى للعلاج النفسى غلبة التركيز على “الأسباب“، بما يرتبط جزئيا بما يسمى الحتمية السببية ([25]): أى معرفة سبب حدوث المرض، دون الحتمية الغائية([26]) أى معرفة هدف ظهور المرضى ومعناه ولغته، وهذا عكس الغالب فى العلاج النفسى الجمعى مثلا حيث التركيز يكاد يكون مطلقا فى “هنا والآن”، وهو لا يقبل “لماذا؟” إلا عبورا لينتقل إلى “إذن ماذا؟” بدءًا من الآن.
هذه النقطة بالذات لها أهمية خاصة فى ثقافتنا الخاصة، حيث يغلب عندنا لوم الآخرين بديلا عن النقد الذاتى، وكذلك نحن نميل إلى تبرير الذى جرى بديلا عن الانطلاق منه.
إن الانطلاق من أن المرض – حتى الجنون – هو اختيار كأنه الحل على مستوى ما من الوعى، هو الذى يسمح لنا بالحوار على هذا المستوى الأعمق لإثبات أنه “ليس حلا” أصلا، ومن ثم فإنّ تقديم بديل آخر وهو مسار “اختيار الصحة” والنمو من خلال العلاج هو وظيفة العلاج الأساسية.
صحيح أن على الطبيب أن يتلمس لمريضه العذر، لكن ليس لكى يتوقف عنده، وإنما لكى ينطلق منه فى ظروف أفضل: هى إتاحة فرصة العلاج الحقيقى، بمعنى أنه إذا كان المرض قد حدث (حين اختارته أعماق المريض حلا) فى ظروف قاهرة وضاغطة فإن وظيفة العلاج هى أن يعرض اختيارا بديلا بعد استنهاض إيجابيات المريض، ولا مانع من التماس العذر للمريض بعض الوقت، لكن أن يكون هذا هو نهاية المطاف فهى الوقفة حتى الركود الساكن، وعلينا ألا نسمح بها إلا مضطرين.
وأخيراً: نحن نعرف هذا التعبير الذى نقوله للمعزين شكرا لهم على مواساتهم لنا فى المآتم، وكأن من يتوقف تماما، حتى لو يتوهم السير هو يسير فى المحل، قد يكون الموت مهما تمتع بمظاهر الحياة، فهو يستأهل ختام المتن هكذا فى سرادق لا يتردد فيه إلا تبادل العزاء كما تنتهى القصيدة: “شكر الله سعيك”.
اللوحة الثانية:
(2) الركن بتاعى مِتْـحضّر
أول بيت فى هذه القصيدة، يقول:
الركن بتاعِى مـتحضّر!!!
دع مؤقتا ما سوف يلى بعد ذلك الآن من مظاهر وتجليات وإيجابيات وسلبيات الانسحاب من أى علاقة، ولو حتى العلاقة العلاجية، والذى يبدأ بـ :
“حارجـَعْله واسيبْكم، ساعتنْ أحسّبْكم“.
وتعالوا نقرأ هذه الظاهرة الأساسية فى حركية الوجود.
مركزية الحنين إلى الركن فى حركية نبض الحياة الطبيعية
هل هناك أى منا ليس عنده هذا الحنين إلى العودة إلى هذا الركن الغائر فى تركيبه البشرى العادى؟ وهو هو الذى يـُسقطه أحيانا إلى خارجه فى صورة السعى إلى اللجوء:
-
إلى موقع سرى خاص
-
إلى دفء غامض خاص
-
إلى سكون واعـِد خاص
-
إلى وحدة مختارة خاصة
-
إلى صمت مُفْعمٍ خاص
يحكى المتن هنا عن سلبية الانجذاب إلى الركن الخاص بدرجة لحوح، وهذا مرتبط بنزوح واضح وحاسم للحذر من القرب، أو من أى علاقة بالآخر، خوفا، وعزلة، أو حتى مرضا، ثم إنه ينبه إلى احتمال استخدام ما يسمى العلاج النفسى لمواجهة هذه الآلية الانسحابية المتكررة فى مواجهة تكوين علاقة إنسانية حقيقية، بما فى ذلك العلاقة العلاجية.
استلهمتُ من كل هذا دعوة للنظر لاعتبار هذا النزوع طبيعة بشرية كجزء من برنامج الدخول والخروج، بمعنى: إن من حق أى منا أن يحترم نزوعه أحيانا إلى العودة إلى ركنه الخاص، بعض الوقت، أننى أفترض أن هذا السماح إنما يعطى العلاقة حيوية حركية تحافظ عليها ولا تلغيها.
هذه الظاهرة أنا عايشتها، وأعايشها شخصيا بشكل لحوح، وأذكر أننى تناولتها فى كثير من أعمالى، خاصة الشعرية، و عبر ما تيسر من حكى عن السيرة الذاتية (فى ترحالاتى الثلاثة)([27])، ولم أكن أتصور أنها جوهرية إلى هذه الدرجة، لا فى وجودى، ولا بصفة عامة.
أقر وأعترف أننى كنت، وما زلت، أشعر بحنين ملح طول الوقت تقريبا إلى العودة (وليس بالضرورة إلى الانسحاب) إلى ركنٍ ما:
مكان صغير بعيد فى حضن الطبيعة
أعلى الجبل
على شاطئٍ خالٍ
فى عشة منفردة بين الحقول
فى حجرة مستقلة (بها حمام خاص جدا) فى بيتى (ما أمكن ذلك)
هذا بالنسبة لحنينى الشخصى إلى ركن الخارج،
أما ركن الداخل فهو “حكاية” أخرى!.
هل ما بالداخل هو ركن واحد غائر بعيد يمكن أن تنتهى إليه كل الأركان؟ أم أنه أركان متعددة، متتالية أو متكاملة، مثل الاستراحات على الطريق السريع؟
حين أشعر بهذا الحنين لا يحضرنى بالاسم الذى أطلقتـُه عليه حالا “الحق فى الانسحاب”، فهو ليس انسحابا، ليس ابتعادا، ليس دفعا للآخر احتماء منه، هو شىء أشبه: بالاستئذان الحاسم، مع وعد ضمنى بعودة محتملة (أشعر أنه لو كانت الطمأنينة مطلقة أن العودة مضمونة 100% إذن لانتقص ذلك من حق الرجوع إلى الركن، فعلا كلمة الاستئذان أفضل كثيرا، رجوع مؤقت، مع تلويح وأمل فى عودة أكثر صدقا وجاهزية.
الأرجح أنها ظاهرة طبيعية، مزروعة فى تركيبنا الحيوى منذ تعرفنا على حقيقه ما يسمى “الإيقاع الحيوى”، برنامج الحياة الأول، وقانون دوراتها من أول الكمون الدورى (الشتوى) عند بعض الأحياء حتى دورات النوم والصحو وكذا دورات الحلم واللاحلم إلى آخر ما يـُـبـَـيـِّـنُ الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى.
ليس مهما الآن أن نعرف أن الإيقاع الحيوى عامة، والإيقاع الحيوى البشرى، قد نشأ ليتناغم مع طبيعة هى فى جوهرها مبنية على إيقاعية الكون الحيوية، أم أنه طبيعة بيولوجية بـَدْئية فى التركيب الحيوى الأساسى، ثم راحت تتناغم مع الإيقاع الحيوى المحيط فى الطبيعة والكون، هذه قضية لم تحسم، لكن نتيجتها واحدة، وهى أننا نعيش فى إيقاع، وبإيقاع حيوى مستمر طول الوقت.
هذا النزوع إلى الداخل، إلى الكهف، إلى الغار، إلى النوم، إلى البيات الشتوى… هذا الحنين إلى الرجوع، هو الضلع الضرورى الراجع لاستمرارية حركية الإيقاع الحيوى، وبالذات فى نبضه مع برنامج “الذهاب والعودة”: In-and-Out Program.
يبدو أن الحق فى الانسحاب إلى ركنٍ ما، قبوٍ ما، كهفٍ ما، (وما يعادل أى من ذلك) هو حق أساسى، وهو إذا مورس بسلاسة مثل كل الحقوق، فإنه يعفينا من أحد سبيلين:
الأول: الاضطرار إلى انسحاب جبان ومتكرر إلى غير رجعة تعميقا وتثبيتا للموقف الشيزيدى Schizoid Position حيث “لا موضوع”، (وهو الذى جاء فى القصيدة الحالية، والذى سوف نعود إليه لاحقا).
والثانى: الاضطرار إلى الاستمرار اضطرادا بالقصور الذاتى القهرى، مع التنبيه (تنبيه الواحد لنفسه، أو عدم سماح الآخرين له) بعدم الحنين (!!!) إلى، أو طلب الحق فى، أو الاعتراف بـ: حق للرجوع، ولو المؤقت بما يترتب عليه من إعاقة فى محصلة النمو فى نهاية النهاية، دورات النوم والصحو طول العمر، بل تمثل بشكل ما دُراعـَىْ الدخول والخروج بشكل أو بآخر.
لابد أن أعترف أننى حين عدت إلى جاستن باشلار([28]) شاعرا وناقدا أساسا قبل أن يكون فيلسوفا، سمعته يوبخنى توبيخا قاسيا، ومباشرا، على حكاية “شرح على المتن” هذه، لم يكن غاضبا مثل غضب المرحوم إبراهيم عبد الحليم منى حين نظر فى الشرح المبدئى لديوان أغوار النفس – أصل هذا العمل الآن– ، ولا مستبعدا هذا الاحتمال دهشةً مثلما نبهنى المرحوم صلاح عبد الصبور بعد مناقشته ديوان سر اللعبة فى البرنانج الثانى، باشلار نهرنى معقبا ناقدا، وقد حذفت مقتطفاتى، منه وعنه (ومن غيره)، لأنها طويلة جداً حرصا على عدم الخروج عن السياق)، وأكتفى بخلاصة تقول:
-
الحنين إلى الرجوع إلى الركن الخاص فيه شىء من النكوص المشروع.
-
الرغبة فى النكوص وممارسته دوريا هما من ضمن آليات الإيقاع الحيوى
-
النوم هو من أعظم آليات النكوص المشروع.
-
فى المدرسة التحليلية الإنجليزية (ميلانى كلاين – فيربرن – جانتريب) اعتراف بالأنا الناكص دائم الجذب إلى وراء.
-
نداء الرحم هو وارد فى آليات النمو والعلاقات التى كررنا الإشارة إليها، وبالذات: تحت اسم برنامج الدخول والخروج In- and- out program .
-
من أهم “وظائف الذات Ego Functions ” وظيفة أسماها “بللاك([29]) Bellack ”النكوص فى خدمة الأنا أو النكوص للتكيف الأعلى” Adaptive Regression in the Service of the Ego (ARISE)
كل هذه الاتجاهات تفسر ذلك النزوع الطبيعى للاحتماء بمرفأ خاص، من أول كوخ صغير أعلى جبل منعزل، إلى إغفاءة محدودة تحت غطاء دافئ حالك، بمعنى أن يكون لكل فرد “مرفأ” خاص (نفسى أساسا) يركن إليه بين الحين والحين ليعاود منه الرحلة من جديد.
خبرات شخصية: الركن داخلى أم خارجى؟
لا ينفصل حنينى إلى ركنى الخاص الداخلى عن انجذابى إلى ركنى الخاص خارجى فى الطبيعة بوجه خاص. وإليكم عينة واحدة من المقتطفات التى حذفتها:
“…..ليكن ريف فرنسا فى الشمال هو رحلتى إلى داخلى أكمل بها شرنقتى لعلى أخرُجُ فراشة حقيقية قادرة على البيض من جديد.” [30]
وبعد
أوقفت نفسى عن التمادى، وسوف أكتفى بعرض ما خلصت إليه من تلك المقتطفات التى حذفتها فى المراجعة الأخيرة:
أولا: التعرف على حجم خبرتى الشخصية عن هذا الحنين إلى الركن الخاص كما ظهرت فى جزء واحد من عمل واحد، ساعدنى على احترام هذا النزوع فى كل الناس، وخاصة المرضى.
ثانياً: أننى كتبت كل ذلك باكرا دون أية رؤية للتنظير فى تشريح النفس وتركيب البشر.
ثالثا: أننى اكتشفت كيف كنت أنتقل من ركنى الداخلى إلى ركنى الخارجى باستمرار حتى أننى أحيانا كنت أعجز عن التمييز المحدد الواعى بينهما.
رابعا: أن الركن ليس “مكانا” بقدر ما هو “حيز محدود من الأمان” سواء كان مكانا أو زمانا.
خامسا: أن الركن يمكن أن يتواجد وسط حشد من الناس.
سادسا: أن رحلات الداخل هى التى تعطى معنى وطعما واحتمال إبداع لرحلات الخارج، فى عملية الإبداع خاصة.
سابعا: أننى وضعت احتمالا ضعيفا جعلنى أصر على أن أفحص الأمر فى خبراتى المهنية والحياتية، خشية أن تكون المسألة برمتها أمرا شخصيا تورطت فى تعميمه على سائر البشر.
الوجه السلبى للحنين إلى الركن ملاذًا دائما ساكنا:
لا نبضا إيقاعيا مبدعا:
المتن هنا يعرض الجانب الآخر من هذه الظاهرة، الجانب المرضى المعوِّق للنمو، الجاهز للانسحاب طول الوقت بمجرد التهديد بتكوين علاقة حقيقية مع آخر، سواء كان هذا الآخر حبيبا أو صديقا أو زوجا أو معالجا، وهذا ما يقوله لسان حال هذه الحالة .
الموقف فى العلاج النفسى:
العلاج النفسى إنما يهدف أساسا إلى تجاوز هذه العودة الجبانة بلا رجعة حقيقية، والتى وصفها المتن هنا (وفى كل هذا العمل) بـ “الموت”؟ ولكنه يسمح بالحركة ذهابا وجيئة ضمن حركية الإيقاعحيوى.
العودة بلا رجعة هى موت نفسى مهما ظل النَّـفـَـسُ داخلا خارجا، فهو لا يعنى الموت الذى هو إعادة بعث أو أزمة نمو ، ولا الموت باختفاء الجسد الذى تبين لى مؤخرا أنه أرقى بكثير من الموت النفسى([31]): الموت النفسى هو الجمود العدم الذى نعنيه هنا.
قلنا وزدنا وأعدنا إن الحياة حركة نمائية دائبة، وإن العلاج النفسى ليس إلا تحريك للحياة فى اتجاهها، وإننا لا نكون بشرا إلا إذا مارسنا الوعى بأننا كذلك مع من هو غيرنا من البشر الذى هو أيضا كذلك، وإننا إنما نمارس حياتنا هكذا “معا”.
لكى نكون كذلك، نكرر، ولن نمل: أن الكائن البشرى قد صار مُحـْرجا فى أنه يعى أنه حى، وأنه ناطق، وأنه قادر من خلال اللغة وغيرها على التواصل مع آخر يحمل نفس الصفات، وأن هذا هو من أهم السبل للنمو المضطرد فى نبض حيوى حتى نهاية الفرد لتستمر الحلقات فى أجيال أخرى، فإذا حال حائل دون استمرار هذه المسيرة، فهو المرض.
المرض النفسى من هذا المنطلق وقفة مؤقتة (أو دائمة)، وهو أيضا حركة إلى الوراء، وهو تفكيك دون إعادة تشكيل ناجح، مع احتمالات اندمالات تهمد الحركة باضطراد، وأيضا مع احتمالات خدعة التظاهر بالحركة الزائفة فى المحل، وهذا ما نسميه أيضا فى هذا العمل بالذات فى أكثر من موقع، نسميه “الموت النفسى”.
العلاج النفسى هو محاولة لتفادى هذا المصير، بتعديل هذا المسار السلبى، العلاج إذن هو:
-
تحريك الوقفة،
-
وفك العرقلة،
-
وتشكيل التفكيك،
-
وتحويل المسار إلى وجهته الطبيعية ودوراته الحيوية من جديد.
الشائع – كما ذكرنا – هو أن العلاج “ترييح” و”تسكين”، ليكن الترييح خطوة على طريق العلاج أحيانا، لكنها ليست العلاج كل العلاج، العلاج هو استعادة حركية الحياة بكل ما تحمل من راحة وألم ومخاطرة وتواصل وافتراق وعودة.
العملية العلاجية لا تسير هكذا ببساطة، بل إن ألعابها والتواءاتها وخداعاتها هى بلا حصر، مهما بلغت النوايا الحسنة، ومهما بدا نشاط الحركة، فقد تكون الحركة فى المحل (كما فى نـَصّ اللوحة الأولى من هذا الفصل “من شطى لشطى“)، وقد تمتد أكثر قليلا لكنها لا تتخطى مرحلة إعادة النص (سكريبت)، وهو ما يشير إلى أن خطوات معينة تعاد باستمرار لتنتهى إلى نفس النقطة، فينغلق النمو، بمعنى أنه لا يحدث أى تغيير مهما ضؤُلَ، بسبب الانتهاء بعد كل دورة إلى نفس النقطة.
هذا الخداع وذلك التلاعب لا يقتصر على الكيان الفردى، بل قد يتورط فيهما نوع “من الأحياء” بأكمله، فيتوقف تطوره أو ينقرض.
ولكن دعونا نعود فنعرض المتن الشعرى كله على بعضه بعد هذه المقدمة التى تبدو أنها كادت تأخذ حقه.
(1)
الركن بتاعِى مـتـحـضّـر،
حارْجَـعْـلُهْ واسيبكمْ،
ساعْتِنْْ احسّ بْـكُمْ.
حافضلْ كِــدَهُـهْ
طالعْْ
نازلْ،
زىْ اليـُويـُو،
كِــدَهُـهْ.
(2)
أصل انا خايفْ.
أنا خايف موتْ، أنا ميّـتْ خايف.
لكن قولــِّـى:
هوّا الميت بيخاف؟
طبعا بيخاف،
بيخاف يصحى.
(3)
ياللاّبـْـنـا نلعب يا جماعة لعبة “هيلا هُـبُ”.
نقعد مع بعض.
قال إيه، ونحسّ،
وكلام للصبح،
ونقول بنحب.
فيها لاخْـِفيها، أنا فين بيها،
ما هى مش موجودهْ من أصلـُه.
قدِّم رجلِ تْـغـُـوص التانية،
دانا كل ما زاد النـــــاس،
باغطسْ وِبْدونْ إحساسْ.
(4)
ومادام الركن متحضر هنا تحت الأرض:
راح انط لفوقْ،
وأعدّى الطوقْ،
وارْضِى القرداتِى.
يِسْتَرْزَقْ.
الفرق بين ما عرضنا من قبل فى “الحنين إلى الركن الخاص”، وبين هذا التراجع المرضى هنا إلى ركن قبرٍ يمثل ما هو ضد الحياة خوفا من التواصل، هو الفرق بين الصحة والمرض، وعلى قدر ما يطمئن هذا الشخص إلى أنه قادر على التراجع تماما، تكون حركته – الظاهرة – نحو الآخر. الشرط هنا يُعلـَن من البداية هكذا:
الركن بتاعِى مـتـحـضّـر،
حارْجَـعْـلُهْ واسيبكمْ، ساعْتـِنْْ احسّ بْـكُمْ،
حافضلْ كِــدَهُـهْ، طالعْ ..، نازلْ، زىْ اليـُويـُو، كِــدَهُـهْْْ.
هذا الموقف لا يُعلن بداهة هكذا فى العلاج النفسى، وإنما يستنتجه المعالج حين يلاحظ أن مريضه جاهز لأن ينسحب بمجرد أن يتهدد بالوعى بأن ثمة علاقة تنمو بينه وبين الطبيب.
النص (السكريبت) يحدث هكذا عادة:
يتقدم المريض نحو الشفاء (ظاهريا) فيبدى تفهما، ويحاول تواصلا، ويقترب من الواقع، ومن الآخر، ولا يعلن شروطه السلبية هذه صراحة، ولا لنفسه، حتى لو كانت جاهزة من البداية بداخله، وهو عادة لا يعرفها، بل هو ينكرها إذا ووجه بها، ويتساءل أيضا، ومعه حق “إذن لماذا حضر للعلاج؟” ثم إنه عادة يبدو وكأنه يستجيب بشكل نشط للعلاج، لكن عند “مأزق” النقلة النوعية، سرعان ما يرجع إلى موقفه الأول بكل عنفوان مقاومته، إن تصريح داخله هكذا: إنه لا يفعل شيئا إلا أنه “يطلع وينزل مثل اليويو“، هو الضمان الذى يشجعه على استمرار المحاولة مطمئنا أنه لن يتغير.
وهكذا ينقلب العلاج إلى ما يشبه تزجية الوقت، ما لم ينتبه المعالج ويحاول كسر هذه الحلقة.
دور المعالج:
المتن هنا ليست وظيفته أن يبين كيف يمكن كسر هذه الحلقة بقدر ما هو مـَعْـِنـٌّى بتجسيد صلابة ونوع المقاومة من هذا النوع، يمكن للمعالج أن يدرك أن التقدم خادع، وأن عملية العلاج تتحرك دون تقدم مثل لعبة اليويو (طالع نازل) فهى لا تنتهى أبدا، إذ يلاحظ رجوع المريض إلى نفس المستوى الوجودى/السلوكى السابق تحت أى تهديد بالاقتراب أو بالتواصل، فإذا تكرر ذلك مرارا فإن المسألة لا تصبح علاجا تطوريا نهائياً بقدر ما تصبح تأجيلا وتسكينا (وهذا طيب إذا اضطررنا له أحيانا: شريطة أن نعرف ذلك، وقد نقبله).
المعالج اليقظ، خصوصا من ينتمى إلى العلاج من منظور النمو، يعرف هذه الخبرة: خبرة التحسن الخادع برغم ظاهر تحسنه، تحسن كأنه الواجهة التى أعيد دهانها دون تغيير حقيقى والطبيب قد يلاحظ تكرار ذلك باستمرار.
هذه المقاومة هى من أعنف أنواع المقاومة التى تبديها الشخصيات الشيزيدية بوجه خاص، وأيضا الوسواسية بدرجة قهرية، إذ أنها شخصيات سريعة الاستبصار المعقلن والفعلى، تلتقط بسرعة ما يهدف إليه المعالج، وتستجيب بحماس واضح على مستوى الأمل والرؤية والكلام والعقلنة، ولكنها تفعل ذلك لأنها واثقة من امتلاك آلية الانسحاب فور الطلب، وحين نستمع إلى داخل داخلها نجد المبرر جاهزا، والمناورة معدّة (كما رأينا فى الحالة الأولى: من شطـِّى لشْطى).
لا يوجد مجال للاتهام هنا، كما يفعل بعض المعالجين (إنت للى مش عايز تعمل علاقة أهه = ها أنت لا تريد عمل علاقة مع آخر)، ذلك أن المريض (أو الشخص) المقاِوم لهذه الدرجة عنده مبرراته، ربما ترجع لتركيب غائر فى صورة برنامج جاهز وُلـِد به، (الاستعداد الوراثى) وربما لخبرات سابقة رسّخت الخوف من الاقتراب الحقيقى والتواصل، وربما لهذا وذاك معاً، ومن ثم فإن أية نقلة نوعية فى اتجاه تواصل حقيقى مع الآخر، حتى مع المعالج أثناء العلاج، هى نقلة مرعبة، بلا ضمان، وها هو المتن يعلن لنا ما يقوله “داخل” هذا الشخص فى هذه الحالة فى الفقرة التالية:
أصل انا خايفْ، أنا خايف موتْ، أنا ميّـتْ خايف.
لكن قولـِّـى: هـُوَّا الميت بيخاف؟
طبعا بيخاف، بيخاف يصحى.
نكمل استلهام المتن ونحن نتدارس: أى موت هذا الذى نخاف أن نصحو منه، ذكرت أن هذه الاستجابة الجبانة المتكررة بلا حركية حقيقية ضمن برنامج الذهاب والعودة، هى “الموت – مع لبس قناع الحياة”!! وهو موت نفسى سلبى، وهو عكس الموت إلى إعادة بعث، كما أنه ليس الموت باختفاء الجسد، الذى تبين لى مؤخرا – كما ذكرت([32])– أنه أرقى بكثير من الموت النفسى الجمود العدم الذى نعنيه هنا.
الموت النفسى ألعن من الموت الذى نعرفه، ثم إن تعبير “أنا خايف موت” هنا، وعموما، هو تعبير قد يشير إلى تجسيد حيلة دفاعية نتيجة الرعب الذى تواجهه بعض الحيوانات الأدنى باللجوء إلى التجمد الساكن بجوار الأحجار أو الأشجار، حتى يحسبها المهاجـِم جمادا، وتصبح الحركة فى هذه الحال مساوية للالتهام من المُغـِير الأخطر.
أما تعبير “ميت خايف” فهو تعبير غير مألوف، لكن الشطر التالى مباشرة يبين هذا النوع الأعمق من الخوف، ذلك أن الذى تصلب خوفا، ليحافظ على نفسه بهذا الجمود الدفاعى، لا يختفى خوفه إذْ تجمد، بل إنه يزيده ليحافظ على جموده هذا الذى يحميه. إنه يخاف خوفين: يخاف الخوف البدئى من المهاجم الذى تجمد حتى يتقيه، ثم إنه يخاف أن يتحرك من موقعه الثابت حتى لا ينقض المهاجم عليه بمجرد أن يتحرك فيتجسد فى عين المهاجم كائنا حيا يصلح للافتراس.
الصحو الذى يخافه هذا الميت هو أن يستيقظ من موته الدفاعى هذا، فيتحرك، فيهلك.
امتدت آلية الدفاع هذه فى البشر حتى أصبح الجمود والإنكار والمحو هى الميكانزمات المكافئة للموت، وأصبح الخوف من الآخر وارد من حيث إن “الآخر” هو تهديد لكينونتى، لماهيتى، لحريتى، هذا موقف نمر به جميعا فى السنين الأولى بدءا من الشهور الأولى ونحن نتحسس طريقنا إلى التواصل، وقد يفلح أغلبنا (المفروض يعنى) أن يتجاوزه إلى تحمل الآخر وهو يحفر سبيله إليه، ولكن إذا زاد الخوف من الاقتراب، وكان ميكانزم الانسحاب إلى الركن بهذه الجاهزية فإن المسألة تتجاوز مجرد الخوف والحذر إلى الانسحاب إلى الكهف بهذا الجمود هكذا (الموت النفسى)، وتصبح العودة إلى التواصل خطرا مضاعفا، لأنها تمر من جديد بنفس الموقف (البارانوى) الذى ألجأ الشخص إلى الهرب فى الجمود الكهف.
هذا النزوع إلى العودة إلى الركن القبر، ثم الخوف من الصحو، هما من أهم ميكانزمات عرقلة النمو، لكن المسألة هنا لا تتوقف عند هذا الحل، بل إن الشيزيدى يتحايل لتغطية انسحابه ليس فقط عن الآخر، وإنما على نفسه أيضا، بحركة نشطة، يتوقف مدى نشاطها على مدى ضمان جاهزية الانسحاب إلى الكهف الجمود، مع ضمان إجهاض فاعلية حركية الذهاب <==> العودة.
هذه الجاهزية للانسحاب الإجهاضى هى استعداد داخلى قوى، ونزوع واثق من القدرة على إلغاء التواصل بالآخر فى أى لحظة. قد يتم هذا الإلغاء بأن تنسحب العواطف من السطح، أو تشل فاعليتها تماما، وهو ما يمكن أن نسميه “غطاء اللامبالاة”، هذا الغطاء هو بمثابة تصنيع جدار عازل، جاهز لتغليف النفس الحقيقية، كغطاء يقوم بدور الواقى ضد أى اقتراب أو اختراق من آخر، إنها آلية سحب المشاعر للداخل حتى لا نخاطر بالمشاركة التى تلوح باحتمال التواصل.
اللامبالاة حتى التبلد التى نصف بها عادة كثيرا من حالات الفصام السالبة ليست سوى هذا الغطاء السميك الذى تـَكـوَّن ليخفى الرعب الساحق عن صاحبه من جهة، ثم ليحميه من أى احتمال للتواصل من جهة أخرى.
فى بداية الفصام الحاد يتجسد هذا الرعب أعراضا غامرة من الفزع والهلع، وتكون استجابة المريض فى مواجهة أى مؤثر يصله من خارجه رعباً هائلا، يبدو المريض وكأنه يتلقى المؤثرات الحسية لأول مرة، لا ليتعرف عليها ويستوعبها مثل الطفل حديث الولادة، وإنما ليخاف منها وينسحب بعيدا عنها إلى ركنه ، وهو يختبئ تحت غطاء لا مبالاته.
فى العلاج النفسى المكثف لحالات الفصام نحتال لكى نخترق دفاعات هذا الموت الظاهر الذى يخفى وراءه كل هذا الرعب، وكثيرا أثناء محاولة الاقتراب غير المحسوب جيداً نفاجأ بتفجير قدر هائل من المقاومة ومزيد من الإنكار فالبلادة، فإذا تواصلت المحاولة، من معالج مبتدئ متحمس وكسر حاجز اللامبالاة عشوائيا فإنه قد يواجه بشكل مفاجئ بتفجير درجة غامرة من الهلع المريع، والتوجس المـُـتـَـلـَـفـِّـتْ، وقد يعقب ذلك مباشرة هياج مفاجئ حتى التحطيم، وهذه هى حركة الذراع الأخرى لإلغاء “الآخر” الذى يمثل كل هذا الخطر بمجرد وجوده أو اقترابه، الجمود والهجوم هنا هما وجهان لعملة واحدة.
تطبيقا لهذا التأويل يمكن أن نرى بعض حالات العدوان التى قد يقدم عليها الذهانى، وكيف يتواتر القتل مثلا أكثر بالنسبة للأقرب فالأقرب، لأن التهديد هنا يأتى من الأقرب لأنه هو الذى يهدد أسرع بعمل علاقة، قد يترتب عليها تحريك الحياة فى ميت أَمِنَ بموته: لموته، فهو الرعب حتى الهجوم وربما القتل.
من هنا يمكن الانتباه كيف أنه علينا أن نتأنى طويلا قبل أن نحكم على مريض أنه “متبلد الشعور”، الشعور لا يتبلد، والعواطف لا تنعدم، وإنما هى تختبئ حماية وانسحابا،
هذا الفرض جدير بأن يجعل الطبيب يتعامل مع المريض محترِما حتى تبلده، لأنه – بحسب هذا الفرض – يكمن وراء هذا التبلد الظاهر عواطف ووجدانات زاخرة بكل الصدق والألم، والرعب، وهى تظل موجودة نابضة فى الداخل برغم كمونها، حتى لو لم يصلنا منها إلا ذبذبة بعيدة بعيدة تحت غطاء من اللامبالاة والتبلد.
فى بؤرة هذه العواطف الهاربة يكمن الخوف، وبالذات الخوف من الحركة، الخوف من اليقظة، الخوف من البعث، الخوف من احتمال العودة إلى الحياة المليئة بالآخرين الخطرين!
إن أخشى ما يخشاه مثل هذا المريض (أو الشخص) هو أن يتعرض لخبرة إحياء مشاعره، دون إعداد أو استعداد كافيين ومن ثم احتمال استقبال أو إرسال بعضها، بما يترتب على ذلك من التهديد بعمل علاقة حقيقية بأى شخص حقيقى.
توصيات وتطبيقات عملية:
إذا ما تبنى الطبيب النفسى هذا الفرض، واستوعب هذه الاحتمالات، فإن ذلك قد يكون خليقا أن يجعله:
-
يحترم اللامبالاة، بل وحتى يمكنه أن يحترم ما يسمى بالموت النفسى، فلا يتعامل مع هذا أو ذاك باعتبار أن أيا منهما هو مجرد مظهر سلبى لاختفاء المشاعر والبلادة.
-
يبذل جهدا آخرا من نوع آخر، للنظر فيما وراء هذا الجدار الواقى للمريض ضد التواصل الخطر (من وجهة نظر المريض).
-
يتأنى فى محاولة اختراق هذا الجدار إلا بعد أن يلتف حوله لعله يوصل للمريض أية درجة من الأمان قبل محاولة كسره.
-
لا يُحبـَط إن هو فشل فى كل ذلك، باعتبار أن المريض إنما يستعمل حقه (المرحلى) فى استعمال ما تيسر من دفاعات، بما فى ذلك الموت: اللامبالاة.
امتداد الخوف من التواصل الثنائى إلى العلاج الجمعى:
العلاج الجمعى (المفروض يعنى) هو أقدر على اختراق صعوبات التواصل هذه أكثر من العلاج المقتصر على الطبيب والمريض فقط، (العلاج الفردى)، ذلك لأنه من المفروض أنه حين يكون الاقتراب متعددا، والائتناس واردا من أكثر من مصدر (آخر)، يقل الخوف حيث يمكن اختبار نتائج الاقتراب بقدر ما تكون الثقة متاحة والبديل وارد لكن الشيزيدى، أو داخله على الأقل، تزداد مخاوفه كلما ازدادت مصادر واحتمالات تكوين العلاقة، هذا الداخل يتعامل هنا فى المتن مع محاولات التقارب حتى فى العلاج الجمعى بسخرية لاذعة، وهو يعلن أشكالا من المقاومة والشكوك بشكل آخر، من نوع آخر، حيث يصف محاولات الاقتراب والحوار بأنها أشبه باللعب لتزجية الوقت أو تبادل الخداع، فهى أعجز من أن تقدم عرضا كافيا يسمح بأية درجة من الأمان.
ياللاّبـْـنـا نلعب يا جماعة لعبة “هيلا هُـبُ”.
نقعد مع بعض.. قال إيه، ونحسّ، ..
وكلام للصبح،.. ونقول بنحب.
من أكثر ما يقع فيه المعالج النفسى الجمعى (المبتدئ عادة) هو أن يلجأ إلى استسهال استعمال تلك الألفاظ العاطفية الشائعة، برغم بريق مضمونها، مثل “الإحساس” أو “الحب” أو “التعاطف”، فى أحيان كثيرة قد يصيح المعالج فى مريض ما: “يا أخى ما تحس بزمايلك” مثلا، أو قد يتبادل أفراد المجموعة كلمات مثل: ” أنا احبك فعلا”، أو “أنا شاعر بيك جدا”([33])، وكلام من هذا. كل ذلك مقبول بحذر، لأنه هو ما اعتدنا عليه، ثم إنه لا توجد ألفاظ أخرى بديلة جاهزة، لكن الصورة التى أوردها المتن هنا تنبهنا إلى ضرورة أن يكون وراء كل هذه الألفاظ ما يجعلها قادرة على تسهيل فعل التواصل، أو الحفز للسير على أرض الواقع، وإلا فالمسألة تصبح – كما تعلمنا من المريض منذ قليل – أشبه بتزجية الوقت.
أيضا تذكرنا هذه الفقرة بما جاء فى المقدمة من التنبيه إلى أن العلاج النفسى ليس مرادفا لما هو: “علاج بالكلام”، فالكلام بزعم الانضمام للجماعة يمكن أن يبدو جاهزا وأن يستمر “للصبح”،(حسب المتن هنا) لكن دون أن يخطو المريض للمشاركة بوعى يسمح بالحركة النمائية.
إذن ماذا؟
فيها لاخفيها، أنا مين بيها
ما هى مش موجودة من أصله
قدِّم رجلِ تْـغـُـوص التانية،
دانا كل ما زاد النـــــاس،
باغطسْ وِبْدونْ إحساسْ
بالرغم من كل ذلك، وبالرغم من يقظة داخل هذا المتردد الجاهز للانسحاب هكذا، فإنه قد لا يمانع – ساخرا داخله– من المشاركة، بل إنه قد يشارك متحمسا سواء للكلام، أو للانضمام لمجموعة تعانى مثله، لكنه يكثف رؤيته الساخرة من البداية حتى تفل كل حماس، وتجهض كل احتمال لأى تواصل، فهو يعلن بذلك أنها مشاركة مستحيلة حيث أنه غير حاضر فيها أصلا. برغم ما يبُذل من جهد من معظم الأطراف، لكن – من وجهة نظر هذا الشيزيدى الساخر – يظْل كل واحد فى خندقه بعيدين عن بعضهم البعض.
ثم إن افتقاد المريض للثقة الأساسية تجعله دائم التساؤل عن موقعه فى المجموع أو حتى بالمجموع “أنا مين بيها”، برغم احتمال حماسه البدْئـِى “فيها لاخفيها”.
ننبه هنا إلى أنه بالرغم من كون العلاج الجمعى يعطى فرصا أكبر لتنمية التواصل بين عدد أكبر من البشر، إلا أن المسألة لا تحقق أهدافها بمجرد النقلة من علاقة ثنائية، إلى علاقة متعددة – أفراد المجموعة بما فى ذلك المعالجون – لأنه أحيانا ما تكون كثرة العدد بمثابة فرصة للهرب فى محيط مائع غير محدد، ضد قواعد ممارسات العلاج الجمعى التى تؤكد على قاعدة: “أنا ó أنت”، بقدر ما تؤكد على “هنا والآن”:
“دانا كل ما زاد الناس، باغطس وبدون إحساس”([34]).
ينتهى النص مثلما بدأ وهو يعلن أن ما يحول دون أى حركة نمو من خلال تواصل البشر مع بعضهم هو هذا القرار المسبق بالانسحاب السلبى المشروط والعودة لنفس الموقع الذى بدأ منه لا أكثر، وكلما كان هذا القرار عميقا وراسخا، فإن المريض (أو الشخص) قد يسمح لنفسه بأى اقتراب أو تفاعل شكلى، لأنه مطمئن إلى الفشل المريح فى النهاية، بزعم طاعته لتعلميات العلاج، وأحيانا لأوامر وتوصيات المعالج.
كثيرا ما يبدو المريض مشاركا متحمسا كنوع من إرضاء المعالج لا أكثر، إما اعترافا بجميل ما، وإما رشوة لضمان استمرار المسافة كما هى، وإما للفـَـلّ من حماس التدخل للتغيير، وهذا هو ما اختتمت به هذه الصورة من المتن:
وما دام الركن متحضر هنا تحت الأرض:
راح انطّ لفوقْ،
وأعدّى الطوقْ،
وارْضِى القرداتِى.
يِسْتَرْزَقْ.
وبرغم الرفض العميق لأى احتمال تواصل، علاجى حقيقى، فإن العلاج قد يستمر لمدة التعاقد (أحيانا أكثر من سنة)، وقد ينخدع الطبيب بذلك وخاصة إذا كان متحمسا مثاليا آمِلا، وكأن المريض بإرضائه ظاهريا، يعفى نفسه من مخاطر التغيير.
وبعد
أرجو أن يكون قد بلغنا من هذه الصور مدى ضرورة الإنصات إلى داخل مرضانا بشكل واع، دون اتهام أو تسرع، حتى لا تخدعنا حيل الطاعة المؤقتة، والامتثال المناوِر، أو حتى اختفاء الأعراض، ثم إن المثابرة على كشف الداخل هكذا لا تعنى التمادى فى اتهام المريض بإصراره على موقفه، وإنما هى تـَحـْفـِزُ إلى مزيد من احترام قراره المبدئى (رغم فشله) وبالتالى المثابرة فى عرض بديل حقيقى يحمل أمانًا وَمِعيَّه لا تضطر المريض إلى هذا الإصرار على الانسحاب والتوقف والمناورة هكذا.
اللوحة الثالثة:
(3) رِيـْحــِة بنى آدمْ
مقدمة:
بالنسبة للمؤسسات التعليمية، الجامعية خاصة، تـُقـَدَّم الخدمات بالمجان غالبا، لكن ثمَّ مقابل ضمنى، لا يعلـَن بشكل مباشر، وهو أن تتاح الفرصة للدارسين من الطلبة والأطباء أن يتعلموا من الشرح الإكلينيكى المباشر لحالة المريض علانية وجماعة، وفى حضور المريض، هذا أمر مشروع من حيث المبدأ، وهو مـُتـَضـَمـّن عرفا وواقعا فى العـِقد المعلن باسم المستشفى “التعليمى”، أو “الجامعى” (فاسمْ وصِفـَة المستشفى ليس سرا)، لكن هذا لا ينفى أن يكون فى هذا الإجراء التعليمى ما يُؤلم ويُحرج، وعلينا أن نتناوله بمنتهى المسئولية والرقة والأمانة والموضوعية والاحترام، ويصبح الأمر أصعب وأدق إذا تعرض المريض لإجراء ما يسمى “البحث العلمى”، ومهما حصلنا على موافقة المريض صراحة، فإن علينا أن نعلم أنها فى كثير من الأحيان تكون موافقة المضطر.
لكى يقوم الأستاذ (أو المدرب أو الباحث) بمهمته هذه بمسئولية، واحترام، أقدم بعض اللزوميات كما يلى:
أولا: توصيات وشروط عامة:
-
على المسئول أن يقوم على قدر ما يَقْدِرُ بتقمص المريض فى هذا الموقف – وذلك بأى درجة من الصدق بشكل مباشر أو غير مباشر – فيتصور نفسه هو، أو أحد أعزائه (ابنه، زوجته، ابنته… إلخ) وهو فى موقع المريض، ويسأل نفسه: هل يقبل هذا الموقف أو يرفضه؟
-
فإذا قبله طواعية، أو اضطرارا (حسب شطارة اطلاعه على داخله)، فعليه أن يكتشف أن من حقه – وهو فى موقف المريض – أن يحكم على الطبيب، وعلى ما يفعله، وكذلك على الحضور للتعلم أو التدريب، سواء حدث ذلك شعوريا أو لا شعوريا، ومتن هذه اللوحة التشكيلية هو من وجهة نظر وبلسان “داخل، مريضٍ شجاعٍ قوىِّ ساخر يحكم على فاحـِصـِهِ .
-
ينبغى أن يكون المريض على علم تام بأن هذا الاحتمال وارد، (عرض حالته على متدربين أو دارسين) وأنه متضمَّن جزئيا فى التعاقد المبدئى، مادام هذا المستشفى جامعى أو تعليمى أو ضمن شروط التعاقد لصالح جموع المرضى فى النهاية، وبديهى أنه يستحسن ألا يكون ذلك شرطا أساسيا لقبول المريض للعلاج، ولكنه بند إضافى مهم فى الاتفاق على أية حال، وهو بشكل غير مباشر – كما ذكرنا – يكاد يكون الثمن الذى يدفعه المريض مقابل علاجه مجانا، أو الإشراف على علاجه من أطباء أكبر، وليس “شرطا لعلاجه” طبعا (المقابل غير شرط الإذعان بداهة)
-
ينبغى أن يتم إعداد المريض لذلك قبل المقابلة الإكلينيكة التدريبية بشكل واضح محدد وتفصيلى ما أمكن ذلك، فيعرف مسبقا من سيقابل، مثلا: اسم المدرب الأكبر، وصفة من سوف يكون حاضرا، وموعد المقابلة، ولمدة كم من الوقت… إلخ.
-
ينبغى أن يكون الهدف من المقابلة معلنا، وعادة ما نشرح للمريض – أيا كان تشخيصه أو خطورة حالته – أن الهدف هو تدريبى فى المقام الأول (التعليم)، وأن هذا لا يعنى أن ذلك سوف يتم على حسابه، بل هو فى نهاية النهاية قد يفيد فى كشف تفاصيل تسهم فى تحسين فرص شفائه وأن حالته قد تتضح معالمها أكثر من خلال هذا اللقاء بشكل أعمق، وأكثر تفصيلا ومشاركة، وأنه من المتوقع أن يؤدى ذلك – غالبا – إلى تخطيط علاجى أفضل.
-
ينبغى أن يُخطر المريض أن النتيجة الإيجابية التى يمكن أن يخرج بها هو والمشاركون فى هذا الاجتماع التدريبى لن تقتصر على حالته، يتم ذلك باتفاق صريح وليس ضمنيا، وباحترام حقيقى وليس مفتعلا، فنحن نقول له بالنص فى بداية المقابلة: “فى الأغلب: اللى حانوصل له مع بعض: حاينفعك إنت واللى زيك”. ويستحسن أن تكون هذه النقطة واضحة بدرجة توصِّل له فضله فى المشاركة فى نفع الأطباء المتدربين، فيتحسنون، فيقدمون خدمات أفضل فأتقن له ولسائر المرضى ممن هم مثله، وبهذا يصل للمريض – ما أمكن ذلك – أنه مشارِكُ فى الفضل فى احتمال نفع المرضى الذين قد يستفيدون من الإنارة العلمية التى وصلت إلينا من فحص حالته بهذا العمق، وعادة ما نشكر المريض بصدق – صراحة وعلانية – على فضله وتفضله بهذا وذاك.
-
ينبغى أن يـُـبلغ المريض بوضوح أن من حقه ألا يرد على أى سؤال أو استفسار يرى أنه لا يريد أن يعرضه علانية أمام “جماعة لا يعرفهم”.
-
ينبغى أن يتم الشرح والمناقشات أثناء حضور المريض باللغة التى يفهمها، (اللغة العربية، ويا حبذا باللهجة المحلية)، وأن يوضح له، خاصة إذا طلب، أى مصطلح علمى مستعمل أثناء المناقشات
-
ينبغى أن يُستأذن المريض فى تسجيل حالته بالصوت أو بالصورة إذا كان ذلك ضمن البرنامج التدريبى لأسباب تعليمية لاحقة، أو لبحث علمى، ويُخطر المريض بذلك بشكل مباشر، وتوضع الكاميرات فى موضع ظاهر حتى يتذكر المريض طول الوقت أن هذا جارٍ، وله الحق أن يعترض فى أى وقت ويوقف التسجيل، علما بأنه يُخطر أن هذا التسجيل لن يستعمل لأى هدف إعلامى عام، وإنما هدفه محدد بأغراض العلم والتعليم بشكل استبعادى لأى غرض آخر.
-
لا ينبغى إخفاء المشاهدين (غير المشاركين) من خارج التدريب، كما فى حالة جلسات العلاج الجمعى، وقد بينا ذلك صراحة فى النشرات التى عرضت لبعض الألعاب العلاجية التى جرت فى العلاج الجمعى، كما فسرنا فائدة حضور الدائرة الأوسع للتدريب، والإعداد للتدريب، تلك الدائرة من المشاهدين التى تتحلق حول دائرة المجموعة العلاجية وتكون ظاهرة لكل الحاضرين، وتشارك فى المناقشة بعد انتهاء الجلسة.
بصراحة أنا فضلت خلال ما يقرب من نصف قرن أن يكون مثل هذا الحضور للمشاهدين (مشروع متدربين) علانية هكذا (عينى عينك)، حتى نطمئن إلى موافقة المريض طول الوقت، ذلك لأن البديل هو أن تنقل الجلسة بدائرة تليفزيونية مغلقة للمشاهدين، (وقد حضرت بعض ذلك فى باريس مع البروفيسور ديادكين، والبروفيسور ليبوفسكى) وكانت الشاشات العارضة توضع فى مكان آخر بعيدا عن المرضى (الأطفال) وأهاليهم، ويجلس المشاهدون المتدربون خلف زجاج لا يسمح بالرؤية إلا من ناحية واحدة one way screen وقد وجدت أن هذا وذاك فيه خدعة جزئية للمريض حتى لو أخذنا موافقته المبدئية، وحين قررت أن أوسع دائرة التدريب فضلت أن نقوم برفع كل هذه الحواجز والاستئذان من المرضى بشكل مباشر أبسط وأصدق، فى حضور الدائرة الأكبر من المشاهدين ويجرى ذلك بالتزام مطلق منذ 1971 وحتى الآن (2017). ثم إننى أقوم فى بداية الجلسة الأولى بتعريف المرضى من البداية بمغزى حضور هؤلاء فى الدائرة الأوسع دون مشاركة، وبما يمثلونه لنا، وما نمثله لهم، وكأن من حقنا أن نتفرج عليهم، ما دمنا قد سمحنا لهم أن يتفرجوا علينا، وكثيرا ما أفاد ذلك – ضمنيا- فى مقارنة المجتمع الخارجى (العادى) بمجتمع المجموعة العلاجية، ربما تأكيدا للموقف النقدى عموما، وأيضا لآلية امتدادات الوعى الجماعى إلى دوائره الأوسع باستمرار، يجرى ذلك دون السماح لأى من المشاهدين بأى نوع من المداخلات أثناء العلاج، لكن من حقهم أن يشاركوا فى المناقشة بعد نهاية كل جلسة.
وبعد
لا تمنع كل هذه التحفظات من أن يشعر بعض المرضى بالحرج، حتى ولو وافقوا احتراما وتعاونا، الأمر الذى تتيحه أعراف ثقافتنا الطيبة غالبا، هذا الحرج لا يُعلن من قبل المريض باستمرار، وعلى الطبيب أن يتقمص مريضه مجددا، ليشجعه على إعلان حرجه، أو سحب موافقته، أو على الأقل ليشعره أنه ممتن لموافقته، وأنه مدين له بشكل أو بآخر مقابل هذه الموافقة (مدين له بالعلاج أساسا، وبما يخرج به من هذا اللقاء لصالحه، ولصالح من هو فى مثل حالته)،
أغلب مرضانا والحمد لله يتفهمون كل ذلك بدرجة مطمئنة.
ثانيا: بالنسبة للتعلم واكتساب الخبرة (وبالذات للأصغر وهو يكبر)
هناك بعدٌ آخر أقل وضوحا من بعد “التعليم”، وهو بعد “التعلــُّـم”، فالطبيب، خاصة فى بداية ممارسته للمهنة، يتعلم من مرضاه، بشكل مباشر، وغير مباشر، يتعلم من نجاحه، كما يتعلم من فشله، وهذه العملية تجرى بشكل تلقائى طول الوقت وحتى نهاية العمر، ومع ذلك فإن مجرد شعور المريض أن طبيبه يتعلم من خلال علاقته العلاجية به، يمكن أن يمثل قلقا موضوعيا ما، وهذا أمر لا يمكن تجنبه لأنه يستحيل أن تنضج خبرة الأصغر، أو حتى أن ينضج الأصغر نفسه ليصبح أقدر فأقدر، إلا من خلال الممارسة.
هذا أمر لا يحله، أو قل: لا يخفف من مضاعفاته، إلا مستويات الإشراف المتعددة([35])، بما فى ذلك ما أسميناه “إشراف المريض” و”إشراف النتائج“، ولذلك يستحسن أن يطمئن المريض ولو بشكل غير مباشر على أن ثم إشرافا جاريا طول الوقت، حين يرى المريض الجارى ببصيرته فيعقب على أداء الطبيب بشكل موضوعى يفيدهما معا، فيتقبل الطبيب ذلك، وأيضا – أحيانا – حين يتجاوز نمو المريض مرحلة نمو الطبيب فيكتشف الطبيب ذلك بأمانة ، فيضطرد نموه، أضف إلى ذلك “إشراف النتائج“، وبالذات إذا كان الحكم على النتائج ليس بمجرد اختفاء الأعراض.
يمكن للقارىء أن يجد مستويات الاشراف فى موقع آخر، لكننى سوف أكتفى بأن أقتطف نص ما جاء فى “إشراف المريض” و”إشراف النتائج” دون مستويات وأنواع الاشراف الأخرى: كالتالى:
إشراف المريض Patient’s Supervision :
أفضـِّـل أن أبدأ بالإشارة إلى حادثتين مرتا بى مع مريضين استفدت منهما بشكل جعلنى أكرر تذكرهما، فذكرهما، كلما أتيحت الفرصة لذلك:
الحادثة الأولى: هى ما قاله لى مريض أثناء محاولاتى دفعه على مسار خطوات نموه بما فى ذلك من مآزق وصعوبات تبدو أحيانا شبه مستحيلة، قال لى هذا المريض: “هو انت عايزنا نحقق حتى لنفسنا اللى انت ما قدرتش تحققه بنفسك؟ (أو لنفسك – لا أذكر، وربما قالها مرة لنفسك ومرة بنفسك)”
الحادثة الثانية: حين قال لى مريض آخر: أننى لستُ الشخص المناسب لعلاجه، لأن رؤيتى – الناتجة من طول ممارستى، كما قال – قد جعلت مساحة وعيى تتسع حتى تحتوى مساحة وعيه كله (وعى المريض) فهو “على حد قوله” لا يملك إزاء ذلك أن يتحرك معى إلا داخل دائرة وعيى التى تحيط بوعيه تماما، وهذا يعوق حركية علاجه وبالتالى يعوق نموه، وطلب منى هذا المريض أن أحوله لطبيب أصغر تسمح دائرة وعيه – باعتبار أنها متوسطة مناسبة – أن تتداخل دون احتواء: مع دائرة وعى المريض، فتتحرك الدائرتان تقاربا وابتعادا بما يفيد “الاثنين”.
الإشراف الآخر الذى يتم من جانب المريض، وإن لم يكن يصلح معه استعمال كلمة إشراف هكذا مباشرة: حين يتجاوز نمو المريض درجة نمو الطبيب، ومع افتراض أمانة الطبيب مع نفسه ودرجة مرونته واستعداده للتعلم بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن مثل هذا المريض الذى تجاوز مرحلة نمو طبيبه، يتيح فرصة للطبيب أن يلحق به (بشكل غير مباشر طبعا)، وقد يتجاوزه الطبيب بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل والتجاوز مع مريض ثالث وهكذا. قلت إن هذا ليس إشرافا مباشرا، لكنه إشراف ضمنى بشكل أو بآخر.
إشراف النتائج Results Supervision
يتم هذا النوع من الإشراف من خلال كل أنواع الإشراف الأخرى بشكل أو بآخر، ذلك أن نتيجة العلاج، المقيـَّمة نوعيا بمحكات موضوعية، ليست مجرد اختفاء الأعراض، سواء كانت هذه النتائج هى نتائج تحقيق الأهداف المتوسطة السلوكية الواقعية المتفق عليها عادة أولا بأول، أو كانت النتائج القصوى غير محددة المعالم تماما، والتى ترتبط أساسا بإطلاق حركية النمو، واستعادة تنشيط الحياة بطزاجة واقية.
ثالثا: بالنسبة للبحث العلمى
من حيث المبدأ، وفى كل التخصصات، تعتبر إشكالة إجراء الأبحاث العلمية على المرضى فى أى تخصص إشكالة شديدة التعقيد، إذْ لا ينبغى تحت أى ظرف أن يكون الإنسان سليما أو مريضا مجالا للتجريب أصلا، لكن أغلب ما يطلق عليه صفة البحث العلمى هو تجريب أساسا، فما العمل؟
فى بعض مجالات البحث توجد قواعد تبدو منضبطة ومحكمة للتجريب مثلا: بالنسبة للعقاقير الجديدة عامة يبدأ التجريب بعيدا عن الأحياء in vitro ثم بالتجريب على الحيوانات، ثم بالتجريب فى متطوعين يعرفون كل الشروط، وكل المخاطر وكل الفوائد المحتملة، وبرغم أن هذا وارد ضمنا فى تجريب العقاقير الجديدة فى الأمراض النفسية أيضا، إلا أن مجال الطب النفسى هو من أكثر المجالات التى جرى فيها التشويه، والتزييف، وغسيل المخ، والدعاية الكاذبة، والرشاوى الظاهرة والخفية، برغم كل المزاعم ضد كل هذا.
لن أتناول هذه القضية هنا بالتفصيل فقد عرجت إليها مرارا وتكراراً فى مواقع أخرى، لكننى سوف أشير إلى ما يخص البحث العلمى فى حالة العلاج النفسى مؤجلا الآن الحديث عن البحث العلمى والعقاقير فى مجال الأمراض النفسية خاصة.
بعض ما يتميز به (أو ينبغى أن يتميز به) البحث فى العلاج النفسى:
أولاً: معظم الابحاث التى تجرى فى مجال العلاج النفسى هى أبحاث “وصفية خبراتية” لا تجريبية مفتعلة.
ثانياً: أهم ما يشترط فى هذه الأبحاث هو أمانة التسجيل مع العناية بكل التفاصيل (بالشروط السالف ذكرها)
ثالثاً: يبدأ البحث العلمى هنا، مثل أى بحث آخر بفرض علمى قابل للإثبات أو النقض، لكن كثيرا ما ينبع الفرض أثناء المقابلة وبالذات أثناء التشكيل الوصفى المبدئى للتركيبة النفسمراضية للحالة([36])
رابعاً: يتم اختبار مبدئى لهذا الفرض الأساسى بالتفسير المناسب الذى يتفق أو يختلف مع الفرض، ولا يتغير أسلوب العلاج للوفاء بمتطلبات الفرض طبعا.
خامساً: يتم تعديل الفرض بالمناقشات المستمرة ونتائج التطبيق الآنى والتتابعى، وكذلك من خلال ربط المعلومات من المصادر المختلفة وبالأدوات المختلفة (المقابلة الإكلينيكية – القياسات النفسية – المعلومات المضافة من مصادر مختلفة.. إلخ).
سادساً: عادة ما يولـّد هذا الفرض الأساسى فروضا فرعية أو يحل محله فرض بديل.
سابعاً: يتم تحقيق هذا الفرض بالمتابعة المسجلة أيضا ويتم تحويره أو إبداله أو التفريع منه أولا بأول.
من كل ذلك يمكن أن نلاحظ أن كل هذه الإجراءات البحثية تجرى فى إطار حركية العلاقة من مستويات الوعى البينشخصية والجمعية دون إحكام انضباط المؤثرات بشكل يفسد كل خطوات العلاج، والمفروض أنها لا تؤثر أدنى تأثير على مسار المرض، أو فرص العلاج، إذ إنها لا تشمل إدخال عامل مفتعل على المريض تحاول أن نرى أثره، فالمقابلة هى المقابلة، والشروط هى الشروط، والوصف لا يخرج عن تسجيل الجارى، أما تحليل المحتوى والتفسير والتأويل والمناقشة العلمية فتأتى لاحقا.
وبرغم أن هذه الأبحاث الوصفية التتبعية تبدو من أسلم وأشرف أنواع الأبحاث فى كل فروع الطب حيث يتم فيها البحث العلمى دون أى تدخل مفتعل، إلا أن علينا أن نخطر المريض بوضوح أن هذا وارد، دون أى مساس بسرية حالته من أول تجنب ذكر اسمه حتى وظيفته حتى محل إقامته.
أما الأبحاث التى يدخل فيها تقييم فاعلية العقاقير مع التذكرة بأن أغلب حالات العلاج النفسى الفردى والجمعى لدينا، تتعاطى العقاقير، بجرعات متفاوتة، وبطريقة متغيرة حسب تطور الحالة، وتتزايد أهمية ذلك خاصة فى حالات الذهان، أقول: أما تعميم وشروط إدخال هذه الجزئية (العقاقير) فى الأبحاث فى العلاج النفسى مهما كانت وصفية: فيسرى عليها أغلب ما يسرى على الأبحاث العلمية بشأن العقاقير فى أى مجال، مع التحفظ على المبالغة فى التركيز على عينات المقارنة لأن ذلك يمثل صعوبة متزايدة فى حالة الأمراض النفسية إذْ لا توجد حالة مثل أخرى مهما تساوت بعض المواصفات، وهى مسألة تحتاج إلى شرح تفصيلى بعد ما لحقها من تشويه وسوء استعمال بسبب التدخلات التجارية والاستهلاكية شبه العلمية لمؤسسات الأدوية العملاقة.
****
المتن: (على لسان حال المريض كالعادة).
(1)
طَـيـّبْ طَـيـّب، واحدةْ واحدةّ.
أنا حاقـْلـَع اهُـــهْ:
أدى صورْتى يا سيدِى،…. شَـرْمـــطْــْها،
وادى قصـّـة حبْ،
وادى عقدة نقص، وكسرة قلب.
أهو كلّه كلامْ
(2)
أنا قالع مَلــْط،
لكنـّى مش عريان.
هوّا انا مهبول؟
أدّيك نفسى لحمهْ طريهْ ؟
طب ليه؟([37])
الناس الشــُّرَفا فى الغابهْ أنبلْ منكمْ.
ياكـْلـُوها علناً بشجاعهْ من غير تبرير.
ولا ييجى واحدْ منهم بيهْْ،
يسأل بالعلم المتمكِّنْ: بـِتْـحِـس بإيه”؟
ويقلـِّــب سيخِى،
ويقولـِّى حـِسْ، بالنار من تحتـكْ.
كما إنى باحِـسّْ، بحلاوة ريحتـَكْ.
……
الحالة دى صعبهْ ومهمّـهْ،
تنفعْ للدرس.
انطلاقا من المتن:
هذا هو المريض يعلن ساخرا فى احتجاج قاسٍ
طَـيـّبْ…! طَـيـّبْ !، واحدهْ واحدةّ.
أنا حاقـْلـَع اهُـــهْ:
أدى صورتى يا سيدى: شَـرْمـــطْــْها،
وادى قصـّـة حبْ،
وادى عقدة نقص، وكسرة قلب.
أهو كلّه كلامْ
مستويات الوعى بين التفريغ والتعليل:
قلنا من البداية أن العلاج النفسى ليس هو العلاج بالكلام، وإن كان الكلام من أهم وسائله، فى هذه اللوحة سنتناول تقييم مستوى ومحتوى الكلام، وخاصة ما شاع عن العلاج النفسى، وبالذات عن التحليل النفسى بوجه خاص، وهى تتعلق باختزال العلاج النفسى إلى:
(1) الترييح
(2) التفريغ
(3) التركيز على البحث عن السبب وخصوصا فى التاريخ السابق وخاصة الطفولة، باعتبار أنه “إذا عرف السبب زال العجب”
وقد تناولنا هذه النقاط الثلاثة بالنقد التفصيلى فى مواقع أخرى حتى وصل النقد إلى تعديل المقوله السابقة وأنه “إذا عرف السبب زاد العجب”.
المتن هنا هو على لسان داخل مريض تصورتُ أنه قد بلغت بصيرته الناقدة عمقا قاسيا وهو يعلنها من خلال صرخته المحتجة التى تنبهنا إلى:
-
إن هناك احتمالا أن كل (أو أغلب) ما يحكيه المريض ليس إلا القشرة الظاهرة لما يعيشه أو يعانيه أو يتذكره،
-
بمعنى: هذا المريض (الذى يأتى المتن على لسانه) وهو المريض الساخر الكاشف المخترق – مثل كثير من المرضى – قد يحجب، بإرادة ما، ليست بالضرورة واعية، الحقيقة داخل داخله،
-
وأنه يعلن بذلك، مـِنْ مستوى ما من وجوده، أنه لا يستأمِن طبييه عليها، (هذا إذا وصل هو إلى معرفتها أصلا).
معنى ذلك أن الكلام الظاهر قد يكون أبعد ما يكون:
-
عن الكلام الكامن،
-
ثم عن التركيب الغائر،
-
ثم عن الحقيقة.
وسواء كان المريض يعرف أنه لا يكشف عن “كل طبقات ذاته”، أولا يعرف، فإنه فى كثير من الأحيان، يكون كل (أو أغلب) ما يحكيه ليس إلا
-
تصوره عن أسباب مرضه،
-
أو العوامل الظاهرة التى أدت لظهوره،
-
أو التى هيأت لظهوره.
****
ثم نعود نكرر فقرات المتن لننطلق منها واحدة واحدة:
طَـيـّبْ…! طَـيـّبْ !، واحدهْ واحدةّ.
أنا حاقـْلـَع اهُـــهْ:
أدى صورتى يا سيدى: شَـرْمـــطْــْها،
وادى قصـّـة حبْ،
وادى عقدة نقص، وكسرة قلب.
أهو كلّه كلامْ
****
على الطبيب إذن ألا يُسـْتدرج للاستسلام لهذه القشرة الكلامية، ناهيك عن الفرحة بها، فالتوقف عندها، لأنها قد تكون فى كثير من الأحيان تبريرية أكثر منها تعليلية.
كثيرا ما يثبت أنه مثلا: ليس المهم فى المقام الأول أن المريض حُرِمَ من الحنان أو أُنكر الاعتراف به منذ طفولته، بقدر ما هو مهم النظر فى التركيب الذى آلت إليه مجموع ذواته ومستويات وعيه، وهو ما يمثله هذا الكيان الإنسانى الفرد الماثل “الآن” للعلاج.
إن التركيب (المرضى) الحالى هو الذى يحتاج إلى إعادة تشكيل، فضلا عن أنه المتاح لذلك، أما سبب المرض، (خصوصا أن أغلب الأسباب قد حدثت فى الماضى اللهم إلا الاضطرابات التفاعلية والموقفية الصرف)، فهو جزء من الماضى غالبا، وبما أننا لا نستطيع تعديل الماضى، وكل ما نملك إزاءه هو تذكـّره أو تذكـّر بعضه، أو حتى تذكّر ما أخفاه عنا دونه (أخفى الماضى بظاهر ما يقال كما يشير النص)، ثم ماذا ترتب على هذا الماضى مما هو ماثل أمامنا الآن.
أدِى صورْتى يا سيدى،….، شَـرْ مـــطْــْها،
وادى قصـّـة حبْ، وعقدة نقص، وكسرة قلب.
لابد إذن من تحجيم هذه الشائعة البالغة الشهرة، الجسيمة الخطأ فالإضرار، تلك الشائعة التى تقول: إن العلاج هو “كلام وتفريغ”.
واضح من سخرية بصيرة لسان حال المريض هنا أن تركيز الطبيب (المعالج) على محتوى الكلام الذى يقوله المريض، وظاهر ما يحكى، إنما يبُعد الطبيب عن صلب القضية، المريض هنا يقولها تنبيها ساخرا: “أهو كله كلام!!”
ثم إن داخل المريض يـُلحق ذلك فورا بإيجاز رأيه، وإعلان أن مثل هذا الطبيب الذى استـُدرِجَ إلى هذه المنطقة التبريرية التفسيرية التعليلة، هو أبعد ما يكون عن حقيقة أعماق مريضه وطبيعة تشكيله.
أنا قالع مَلــْط،
لكنى مش عريان.
هوّا انا مهبول؟
أدّيك نفسى لحمة طرية؟
على إيه؟
لو أننا تعمقنا الموقف كما تدعونا بصيرة لسان حال هذا المريض الساخرة هكذا، إذن لرأينا أن كثيرا من التفاصيل السطحية التى قد تملأ جلسات التحليل النفسى ليست إلا مظاهر جزئية لمشكلة الوجود الأعمق، فقد تكون غطاءً للوحدة القاسية البشعة التى اكتشفها المريض بلا حل، وعلى لسان هذا الجزء تصبح صورة المريض التى فى متناول العلاج ليست هى حقيقته وإنما غطاؤه.
المريض هنا هو الذى يتفرج بعمق حدْسه – من داخل داخله – على المعالج وهو يحاول أن يفسر ويؤوّل الجارى.
إذا اكتفى الطبيب بهذا المستوى الكلامى السطحى فإنه لا يستطيع أن يمارس التشكيل النقدى العلاجى الذى يمكنه من أن يصيغ “الفرض” الأصلح للعلاج.
هذا الموقف الساخر يعرفه بعض الذهانيين خاصة سواء المرضى منهم أم ذوى الرؤية الذهانية بعد أو قبيل المرض، وهم أحيانا يمارسونه بوعى جزئى على الأقل، ومن موقف السخرية هذا قد تطفو قصص الشعور بالذنب، وعقد النقص والفشل فى الحب، دون أن يكون أى من ذلك هو بؤرة الخلل أو جوهر الاضطراب…. إلخ.
المتن ينبهنا إلى أن كثيرا من هذه الحكاوى قد لا تكون إلا مجرد تفريغ كلامى، قد يخفف الضغط عن الجزء الأعلى من الشخصية ولكنه لا يغوص إلى جوهر مشكلة وجود المريض.
تحذير من التعميم:
لا يمكن تعميم مغزى هذا الموقف هكذا بلا تمييز، إذ عادة ما ينشأ هذا الموقف ويحتد حين يشك المريض فى قدرة المعالج على استيعابه، أو فى جدية المعالج فى مواكبته، أو حين يستشعر المريض انفصال المعالج على مسافة منه، إلى موقف أشبه بالفرجة، أو حتى الشفقة، دون مشاركة فعلية أو مواجدة.
أحيانا فى موقف التعليم، يكون سؤال الطبيب الكبير (الأستاذ مثلا) للمريض “بتحس بإيه”، هو بغرض الشرح فى موقف التدريب، حتى يعلّم المتدرب كيف يسمّى مثل هذه المشاعر باسم عرض معين، أو لكى يصل فى النهاية إلى اسم مرض بذاته، فيكتمل الدرس، قد يلتقط المريض هذا الموقف بحدسه، أو بذكائه، أو بكليهما فيصبح الموقف أكثر إيلاماً له، وينطلق حكمه على ما يجرى أكثر سخرية وقسوة كما سيأتى فى المتن حالا:
-
ثم إنه كثيرا ما يصعب على المريض أن يصف ما يشعر به (يحس بيه)
-
أو قد يكون ما يعيشه ويعايشه من مشاعر ووجدان أكثر إيلاما وعمقا من أن تـُعلن أصلا.
-
وأحيانا يكون المريض أكثر استهانة بجدوى أن يقول لمعالج يشك فى قدراته حقيقة ما يحس به.
تبينت أبعاد هذا الموقف وكيف يصل إلى المرضى من خلال حماس زملائى المبتدئين المتدربين معى أثناء العلاج الجمعى خاصة – وقد ألمحتُ لذلك من قبل– وأورد بعض مثل ذلك فيما يلى:
يدعو أحد المتدربين المريض فى موقف معين أن “يحس بمشاعر معينة” (الخوف مثلا) بدلا من أن يحكى عنها، أو أن “يشعر بالتعاطف” مع زميل آخر يكون قد تعرى أو تألم أو أعلن ضعفه أو احتياجه فى بعض مقاطع التفاعل فى المجموعة، كنت ساعتها انظر للزميل المتدرب وهو يصر على أن المريض إن لم يكشف عن مشاعره لحظتها بدرجة مناسبة، أو إن لم يشارك زميله بالعمق الكافى، فهو“لا يحس“، لدرجة اتهامه أحيانا بالبلادة، كنت أنظر إلى زميلى المتدرب بما معناه “وأنت؟ هل لاحظت تعاطفك؟ مع من؟ وإلى أى درجة؟ وكيف يمكنك أن تظهره؟”، وقد يتمادى المتدرب (أو المعالج الكلامى!) فى تحفيز المريض “أن يحس” بالجارى، أو بما به، ضاربا بنفسه – دون بصيرة كافية – القدوة، فقد يقول للمريض بشكل مباشر أو غير مباشر: “حس زى ما انا باحس“.
وهنا يحضرنى مثل مصرى عامى مهم يقول على لسان من يُجلد عددا معينا من الجلدات “اللى بينجلد غير اللى بيعـّدّ“، ومثل آخر أقل انطباقا لكنه أكثر شيوعا يقول “إللى إيده فى المية غير اللى إيده فى النار“، وأغنية أقل فأقل دلالة وهى التى تقول “عوّام ياللى على شط الهوا عوّام“.
كل ذلك يشير إلى إحاطة الوعى الشعبى بحقيقة أن النصح، والحفز، والتوجيه لمن لا يعيش التجربة بحقيقة أبعادها، أى لمن يرصدها من على مسافة، هو بلا جدوى من ناحية، وأيضا هو يـُشعر المريض ببعد المعالج عنه من ناحية أخرى.
أحيانا يطلب المتدرب من المريض أن يوقظ إحساسه ليخترق اللامبالاة التى تورط فيها هربا من آلامه، والمتدرب لا يدرى حجم عبء ما يطلبه من المريض ولا خطورته، فكأنه يطلب تفجير ذرة كامنة – باستعمال الكلام!! – وقد أحيطت هذه الذرة البشرية بجدار اللامبالاة الواقى، هذا ليس اتهاما للمعالج الأصغر بل هو تنبيه ضمنى إلى بعض مسار التدريب، وهو تنبيه مهم حتى لا يتصور المعالج المبتدئ، والمعالج عموما، أنه هو صاحب الإحساس الحى النقى، وأن المريض هو وحده فاقد الإحساس وأن عليه (على المريض) أن يتشبه به وبتفاعله حتى يكون سويا حاضرا!!
فشتان بين إحساس إنسان اختبأت مشاعره رعبا، وبين إحساس شاب فى أول طريقه لاكتساب الخبرة والتعلم وهو يكتشف طبقات مشاعره مع اكتشاف طبقات وعيه تدريجيا دون تهديد بالتفسخ أو المواجهة.
المتن هنا ينبهنا إلى أن مثل هذا المريض، خاصة إذا كان ذهانىّ فى مرحلة تعرية تحتد فيها بصيرته، يعلـِّمنا ساخرا أن المريض لن يكشف داخل داخله إلا لمن يثق فيه بالقدر الذى يسمح له بمثل هذا الكشف، أو أقل، هذا للطبيب وحده وهو منفرد به، فما بالك فى العلاج الجمعى.
وإن كان الأمر قد يصبح أكثر سلاسة حين يشترك الجميع – بما فى ذلك المعالج – فى محاولة هذا الكشف وخاصة أثناء الألعاب العلاجية كما سيأتى ذكره.
الخلاصة:
كل هذا يشير فى نهاية النهاية، وبرغم قسوة سخرية المتن إلى:
-
أن الثقة بين مثل هذا المريض وبين الطبيب أو المعالج، هى المعبر الأول والضرورى الذى يسمح بالتواصل فالكشف.
-
وأن وراء كل ظاهر ما هو أهم وأعمق
-
وأن علينا ألا نقيس مشاعر مرضانا بمشاعرنا، أو بتصورنا عن مشاعرنا
(2)
أنا قالع مَلــْط،
لكنى مش عريان.
هوّا انا مهبول؟
أدّيك نفسى لحمة طرية؟
على إيه؟ !!!
الناس الشرفا فى الغابة أنبل منكم.
ياكـْلـُوها علناً بشجاعة من غير تبرير.
ولا ييجى واحد منهم بيه:
يسأل بالعلم المتمكِّن: بـِتْـحِـس بإيه”؟
ويقلّـــب سيخى،
ويقولْْْ لِى حِــسْ:
بالنار من تحتكْ.
كما إنى باحِـسْ:
بحلاوة ريحتـكْ.
(الحالة دى صعبة ومهمّة،
تنفع للدرس).
تعبير “الحالة دى تنفع للدرس” هو تعبير مؤلم متواتر فى المؤسسات التعليمية، وبرغم أنه حقيقة مقبولة ومشروعة، إلا أن الأستاذ أو المدرب أحيانا يعلنه أمام المريض صراحة بنفس الألفاظ، إن وصول ذلك للمريض بهذه الصورة الفجة، ولو بطريق غير مباشر، هو الذى مـَثـَّلـَهُ المتن وقد صاح فينا هذا المريض الساخر:
أن آلامه ليس كمثلها ألم، وأنه كمن ينشوى بنارها، ونحن الذين ندرس أو ندرّس، لا تصلنا إلا كمن يشم العابر رائحة الشواء تتصاعد مما تقلبه النار!!
أظن أنه لو صار هذا البيت المرعب بين الناس مثلا عاميا جديدا لانتبهنا أكثر، وراعينا أكثر
مرة أخرى:
ويقلِّب سـِيخى،
ويقولـَّى حـِسّ: بالنار من تحتـْكْ،
كما إنى باحس بحلاوة ريحتك“
(فصارت مثلاً!! إن شاء الله)
اللوحة الرابعة:
(4) الموت السرّى المِـتـْدحِـلب
نقرأ المتن كله أولا:
(1)
لا يــاعْم.!! كده أحسن.…،
……
أصل الموت علناً بيخُضْ.
ولا حدْ يقول، ولاحد يْرَدْ.
ولا فيه مزّيكا،
ولا جنس يا ويكا،
ولا فيه كْلْ واشكُرْ بالفستقْ،
ولا كفتهْ وكبدة وحتةْْ كيف،
ولا فيه تصنيف.
(2)
خلّينا كده نلعب فى السر،
قال إيه عايشين.
وأقول: “أنا رأيى ياجماعة”.
وكإنِّى عندى رأى صحيحْ.
وراح اعمل زى ما اكون باخْـتارْ.
أو أرفعْ حاجبى وانا مِحتارْ.
كده،.. شبـــَـه الجـــدْ.
(3)
يا أخينا:
لما انت عرفت انى ميّت، بتقرّب ليه؟
ماتكونشـِى عايز تتفرّج؟
على إيه؟
عايـــز تعرف ازاى المّيت بيحسّ.
إزاى بيطلّع حس.
ولاّّ حاتاخد تفاصيل النَـعـْى؟
تكتب إعلان وبخط اسود وببنط عريض:
”إن المرحوم كان واحد بيه،
ولاخدْشـِى نصيبُه فى الدنيا ويا عينى عليه.
والمعزَى من ستهْ لتسعهْ،
بــمَعادْ سابق.”
(4)
بس ما تـِنْـساش:
ضرب المّيت أكبر حُـــرمـَه.
إزرعْ صبّار جنب التربهْ،
والشيخ “عارفْ” يقرا سورة ”الإنسان”.
أولا: الاغتراب فى لذة ظاهرة أحد مظاهر الموت النفسى:
المواجهة أثناء العلاج النفسى بأن الوجود المغترب (مرضاً أو فرطَ عادية) هو موت نفسى بشكل أو بآخر، تعتبر أحيانا من الصدمات العلاجية المفيدة إذا ما ضبطت الجرعة، أما إذا زادت جرعة التعرية أو اختيار التوقيت المناسب، فالنتائج قد تكون مضاعفات معيقة أهمها خطر الرؤية المعجزة نتيجة للألم المفرط.
الحياة التراكمية الاغترابية (العادية) تواصل مسيرتها بسلسلة من الرشاوى التسكينية والنكوصية، وبالتالى يتمادى الخمود حتى الموت (توقف النمو) تحت غطاء من اللذائذ المؤقتة المنفصلة عن بعضها، وعن عائدها.
عنوان هذه القصيدة “الموت السرى المتدحلب“، يشير إلى أن هذا الموت لا يسمى موتا عادة، حيث أنه يتسحب تحت عناوين شديدة الرشاقة بالغة الإغواء، مثل اللهو التفريغى الصاخب، أو الجنس اللذى يمارس لذاته “ولا فيه مزّيكا – أو جنس يا ويكا“.
بل إن لذة الأكل أو تعاطى المسكرات، قد تنضم بشكل أو بآخر إلى هذه النشاطات المغتربة حين تصبح ِأهدافا فى ذاتها .
“كـُلْ واشكر” شامى بالفستق،
أو كفتة وكبده وحته كيف“.
كل ذلك قد يندرج تحت بند الرفاهية واللذة والمتعة والترييح، ليكن، ولنعترف أنه لا يوجد ما يدعو فى الحياة العادية أن نرفض بعض ذلك أو أن ننكر حقنا فيه “قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَاللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ”، لكنه حق مشروط بالتفرقة بين الغاية والوسيلة، بين حق المتعة تصعيدا إلى متعة أرقى فأرقى، وبين المتعة اللذيه الاختزالية المكررة كنهاية للمطاف.
هذا العمى الجيد فى الحياة العادية يصبح معطلا فى العلاج النفسى، لأن كثيرا من الأمراض النفسية إنما ظهرت لتعلن، أو على الأقل تعرّى، التوقف عند هذه المرحلة اللذية التراكمية المغتربة، الاعتراف للمريض بأنه على حق فى رفضه هذا، برغم فشله فى إعطاء البديل، قد يجعل بصيرته تحتد أكثر فأكثر فيتمادى المعالج فى إعلان أن كل هذه المظاهر هى نوع من الموت الذى علينا – بالعلاج – أن نتحفز لرفضه، لكن ليس بالمرض ولكن بفرصة العلاج.
وهنا يعلن المتن تلك المقارنة بين الموت سـِرَّا، بالإستغراق فى لذة مخدرة مغتربة، وبين الموت المتسحبِّ على مسار المرض السلبى، وبين التسليم لموت اغترابى تحت أسماء تدليل خبيثة.
لا يــاعْم.!! كده أحسن…،
…………
أصل الموت علناً بيخُضْ.
ولا حدْ يقول، ولاحد يردْْ.
ولا فيه مزّيكا،
ولا جنس يا ويكا،
ولا فيه كل واشكر بالفستقْ،
ولا كفتة وكبدة وحتةْْ كيف،
ولا فيه تصنيف.
ثانيا: تشكيلات أخرى للاغتراب
يعرّى لسان حال داخل المريض فى “المتن” بعد ذلك تشكيلات أخرى لتجليات الاغتراب، ففى الفقرة التالية ينبه بسخرية أيضا إلى لعبة الاغتراب فى الكلام وفى المناقشات وفى تبادل الآراء بلا آراء (طقّ حـَنـَكْ)، وفى مظاهر الاختيار بلا حرية حقيقية لا تتجلى إلا فى وجود بدائل للقرارات المطلوب الاختيار فيما بينها، وقدرة على التمييز، ثم على الحسم، ثم على اختبار نتيجة الاختيار، ثم على تحمل مسئولية هذه النتيجة واحتمال إعادة الاختيار.. إلخ، بدون كل ذلك يصبح الاختيار مظهراً خادعا يـُضم إلى تشكيلات الاغتراب (موتا سريا متدْحـِلبـَاَ) حتى لو سمّى حرية.
خلّينا كده نلعب فى السر،
قال إيه عايشين.
وأقول: “أنا رأيى ياجماعة”.
وكإنى عندى رأى صحيح.
وراح اعمل زى ما اكون باخْـتارْ.
أو أرفع حاجبى وانا مِحتارْ.
كده،.. شبـــَـه الجـــدْ.
ثالثا: التجاوب الظاهرى وخطورة الإيلام دون فِعْل
على الطبيب المعالج ألا ينخدع فى التعبيرات الظاهرة مهما كانت واضحة أو فى الاختيارات الكلامية ما دامت لم تـُخـْتـَبـَر، ثم متى ظهرت الأمور هكذا فى سياق العلاج النفسى أصبحت مهمة الطبيب (المعالج) أن يواصل التحرك بعد التعرية آملا فى عرض بدائل علاجية نمائية، وهنا يتجلى مأزق اختيارى جديد:
إذا توقف العلاج عند مرحلة تعرية هذه التشكيلات العادية (الرائعة) باعتبار أنها ليست إلا اغترابا مكافئا لموت تخديرىّ (فرط الدفاعات المسكـِّنه)، وأن المرض لم يظهر إلا لأن داخل المريض رفضها قبل أن يقوم العلاج بتعريتها، أو بإكمال تعريتها حدّ الألم، إذا توقف العلاج عند هذه المرحلة دون مشاركة حقيقية من المعالج تصبح المسألة أقرب إلى الفرجة والتجريح، أكثر منها مواكبة ومواجدة علاجية.
وقد يلتقط المريض ذلك منبـِّها (كما جاء فى المتن) باحتجاج ساخر – من داخله – إلى سلبية إعلان هذه الرؤية بمجرد تسميتها وكأن فى ذلك إعلان لرفض الاغتراب، دون طرح بديل، من هنا تأتى صرخة لسان حال المريض ورفضه، ومن ثم السخرية من هذا الموقف العلاجى المجهض المتوقف عند الكشف، والوصف، والتغيير وربما التبرير.
هذا التحذير الساخر هو تعرية أخرى للعلاقة العلاجية الرسمية “من سته لتسعة، بميعاد سابق” حين يُفرغ العلاج من المواجدة والمواكبة، لحساب تسمية المرضى بأسماء تشخيصية أو إعلان الوفاة والتحسر على ما آلت إليه حركته من سكون هامد (حتى بوصف النفسمراضية للسيكوباثولوجى)، تصبح المسألة كأنها عرْض لمشاهدة درامية تستحق الفرجة،
يواصل لسان حال المريض مواجهة داخل الطبيب (المعالج) قائلا:
يا أخينا:
لما انت عرفت انى ميّت، بتقرّب ليه؟
ماتكونشـِى عايز تتفرّج؟
على إيه؟
عايـــز تعرف ازاى المّيت بيحسّ.
إزاى بيطلّع حـِسّ.
ولاّّ حاتاخد تفاصيل النَـعـْى؟
تكتب إعلان وبخط اسود وببنط عريض:
”إن المرحوم كان واحد بيه،
ولاخدْشـِى نصيبُه فى الدنيا ويا عينى عليه.
والمعزى من ستة لتسعة،
بــ “معاد سابق.”
رابعا: إما الألم فالنمو – وإما الموت – بالإنسحاب التسليمى المحتج:
أحيانا يصل يأس المريض من المعالج إلى الإقرار باستحالة تحريك الجمود المتحوصل داخل سياج من الدفاعات الاغترابية، وهنا يصبح التمادى فى تعتعة حركية النمو نوعا من مضاعفة الألم بلا أمل، ومن ثَمَّ يقفز المتن ناهيا عن مثل هذا العبث بمعنى:
إما محاولة متواصلة جادة تحت كل الظروف باعتبار أن هذا الألم المترتب على السخرية هو ثمن مشروع وهو إشارة خضراء – رغم المعاناة- داعية للتحريك بقدر بذل الجهد ومواصلة الصحبة.
وإما تسليم طيب بحق المريض فى اختيار الدفاعات التى تناسبه، حتى لو كان المرض هو الذى بدأ بتعريتها، وليس من حق المعالج فى هذه الحال أن يسمى هذه الدفاعات موتا مادام لم يواصل مع المريض ليحققا البديل.
وبألفاظ أخرى:
إما التسليم بحق الاغتراب (السائد فى الحياة العادية)،
وإما مواصلة مسيرة النمو العلاجى بلا توقف أبدا.
هذا وإلا: فالمسألة (العلاج) تصبح بلا طائل إلا الإيلام والتنظير والمعرفة المـُعـَقـْلنة حتى لو تخفـّى تحت مظلة الشفقة واحترام الواقع.
بس ما تـِنْـساش:
ضرب المّيت أكبر حُـــرمه.
إزرع صبّار جنب التربهْ،
والشيخ “عارف” يقرا سورة ”الإنسان”([38])
وقد يلتقط لسان حال المريض التراجع، فهو هنا ينهى عن مواصلة المحاولة ما دام المعالج ليس على قدرها، فما الداعى للتوقف عند محطة الألم، وهذا لسان حال من يعلن ذلك.
اللوحة الخامسة:
(5) لله يـاسْيادى……!!!!
أحيانا يبلغ من سوء فهم، أو سوء استخدام العلاج النفسى أن يصبح مجرد مجال لاستدرار العطف والشفقة واستجداء التقبل بلا شروط، هذا الموقف ينبغى التنبيه على مدى سلبيته، خاصة فى ثقافتنا نحن التى تدعم الاعتمادية بشكل أو بآخر، سواء الاعتمادية على رئيس أو كبير أو سلطة، أو الاعتمادية على رمز أو مقام أو فكرة، صحيح أننا نؤكد أيضا رفضنا للمبالغة فى التأكيد على الاستقلال الباكر والبالغ والممتد، وهو ما تتصف به ثقافات أخرى ومجتمعات أخرى، لكن لا يصح أن يصل السماح بالاعتمادية إلى هذه الصورة الواردة بالمتن.
فى مجال العلاج النفسى يعتبر تمادى هذا الموقف الاعتمادى مسئولية كل من المعالج والمريض على حد سواء، بل إنه مسئولية المعالج أكثر. هذه الاعتمادية قد تتمادى أكثر فأكثر لتصبح بمثابة النكوص، فالسكون، ومن ثمَّ: الموت النفسى الذى أشبعناه شرحا وتفصيلا فى الحالات السابقة، النكوص هنا طفلىّ يتأرجح ملتذا، وإن كان المتن قد عرّاه ليعلن أن الأرجوحة قد صارت نعشا.
ولكن دعونا أولا نقرأ المتن مجتمعا:
(1)
لله ياسيادى..،
عَـيـّل غلبانْ…،
مسكينْ تعبانْ.
يستاهل العطفِ والشفقهْ، وشويـّةْْ حبْْ.
(2)
نفسى اتمرجح، وارجع تانى أرضعْ مالْبِـزْ،
واتلـــذّ.
عاْيز ابقى معاكمْ، شايـْلِنـِّى شيلْ،
حتى على خشبة نعْشْ.
هيلاَ بيلا، يا حَلـُـلّى.
(3)
خلّينا مع بعض: نتونّسْ،
وندَرْدِشْ.
بس ما نـِمـْشيش قدّام.
وحانمشى ليه؟
ما تبص يا بيه:
دا الكلب بيجرى ورا ديله، نهاره وْليـــلُـــهْ،
وانا ديلى لافِــفْ جوّايـــــــا،
ولا حدّ منكم ويــّـاىَ.
(4)
مش نـِعْـقل ونبطـّل نحــلـمْ.
واذا كنتـُو مُصرّين قالْ يعنى،
هاتوا حتــَّة.
خايف اقـَـرَّب، ولاَّ أجرّب
خليها مَـسـْتورهْ أنا فْْْ عرضـَكْ.
ثـُـم انطلاقا من المتن:
(1)
لله ياسيادى..،
عَـيـّل غلبانْ…،
مسكين تعبان.
يستاهل العطفِ والشفقهْ، وشويةْْ حبْْ.
(2)
نفسى اتمرجح، وارجع تانى أرضع مِـالْبِـزّ،
واتلذْْ.
عاْيز ابقى معاكمْ، شايـْلِنّى شيلْ،
حتى على خشبة نعْشْ.
هيلا بيلا، يا حَلـُـلّى.
العلاج الجمعى المَكْلَمةْ الدافئة “معاً”:
إذا كان النكوص المتأرجح حتى الموت وارد فى العلاج الفردى حيث الطبيب يمثل رمزاً كبيرا خليقا بأن يُعتمد عليه إلى كل مدى، فهل هو أيضا كذلك فى العلاج الجمعى؟ بصراحة: نعم، لكن إلى درجة أقل، صعب أن يتعمق هذا النوع من الاعتماد فى “مجموعة من المرضى والمعالجين، تنبض بحركية النمو
(3)
خلّينا مع بعض: نتونّسْ،
ونـْـدَرْدشْ.
بس ما نـِمـْشيش قدّام.
وحانمشى ليه؟
ما تبص يا بيه:
دا الكلب بيجرى ورا ديله، نهاره وْليـــلُـــهْ،
وانا ديلى لافِــفْ جوّايـــــــا،
ولا حدّ منكم ويــّـاىَ.
لكن هناك نوع من (أو احتمال لـ..) سوء استعمال العلاج الجمعى فى هذا الاتجاه إذا طالت مدته، وكذلك إذا غلب الحكى فيه على فعل التفاعل، وخاصة إذا انفصلت المجموعة باعتماد أفرادها على بعضهم البعض أكثر فأكثر دون سائر المجتمع، أقول هناك احتمال أن تدور المجموعة بكاملها فى دائرة مفرغة (مثل تلك التى ذكرناها فى الحالات السابقة)، فيتوقف النمو “بس ما نمشيش قدام“، ويتواصل اللّف فى المحل،
التشبيه هذه المرة بالكلب الذى يحاول أن يمسك ذيلة فيلف حول نفسه بلا توقف أو نهاية.
“دا الكلب بيجرى ورا ديله، نهاره وليلهْ” فما بالك إذا كان هذا اللّف هو داخلىّ وخفىّ فى بؤرة وحدة جافة وعزلة مغلقة برغم التواجد الجسدى فى المجموعة “وانا ديلى لافف جوايا، ولا حدّ منكم ويايا”
(4)
مش نـِعْـقل ونبطـّل نحلم.
واذا كنتو مُصرّين قالْ يعنى،
هاتوا حتة.
خايف اقـَـرَّب،
ولا أجرّب
خليها مَـسـْتورة أنا فْْ عرضـَك
الخوف من التمادى فى “حلم العلاج” التطورى
من مضاعفات العلاج الجمعى (خاصة النوع الذى نمارسه هنا) أن تنفصل المجموعة ولو مؤقتا عن الواقع، حتى تبدو المسألة أقرب إلى الحلم، وأن الفرض القائل بأن ظهور الأعراض هو إعلان ضمنى لاحتمال تحريك مسيرة النمو (فالتطور) هو أيضا فرض أقرب إلى الحلم.
“وان كنتو مصرين قال يعنى، هاتوا حته”،
يتم إعلان هذا الموقف بأمانة فعلية، وليس بالكلام – عادة – من لسان حال بعض المشاركين صراحة، وذلك فى صورة الإصرار على الحفاظ على مسافة بعيدا عن الآخر، والتمسك بحق الدفاعات العامية .
(4)
مش نـِعْـقل ونبطـّل نحــلـمْ.
واذا كنتـُو مُصرّين قالْ يعنى،
هاتوا حتــَّة.
…….
خايف اقـَـرَّب،
ولاَّ أجرّب
خليها مَـسـْتورهْ أنا فْْْ عرضـَكْ.
وهكذا ينتهى المتن بهذا التنبيه الساخر، الذى يعلن صاحبه اعتمادية من نوع آخر، كأنه يقول: “اعملوها انتم واحتفظوا لى بنصيبى([39]).
وبعد
هذه مضاعفة من مضاعفة العلاج الجمعى ينبغى تجنبها، سواء بالنسبة للمجموعة ككل، أو بالنسبة لبعض أفرادها إذا أمكن رصدها والتفاعل معها بالأسلوب المناسب، في الوقت المناسب، أولا بأول، وباستمرار.
اللوحة السادسة:
(6) قبر رخـام
لهذه القصيدة حكاية، فقد صدرت فى الطبعة الأولى للديوان باسم “شَبَه الإنسان” (فى 166 كلمة)، ثم جرى تحديث محدود بعد ذلك، لم ينشر (غالبا)، ثم أجريتُ عليها تحديثا آخر وأنا أعدها لأضمها إلى هذا العمل الذى لا يريد أن يستقر على منهج، فإذا بها تصل إلى أربعة أضعاف حجمها (735 كلمة).
المقدمة وباعث القصيدة:
من أصعب ما يواجه الطبيب النفسى أن يعالج “أصحاب المبادئ الثابتة”، ليس مهما أن تكون المبادئ سليمة، أو صحيحة، أو أصح، ولكن الصعوبة تأتى من أنها ثابتة، والمتابع لحوارى مع الله([40]) استلهاما من مواقف ومخاطبات مولانا النفرى([41]) وهو يعلمنا خطورة العلم المستقر، وأيضا خطورة الجهل المستقر، لابد أن يصله مدى خطورة هذا الاستقرار الجاثم على حركية نمونا، وبالتالى على توجهنا إلى الله تعالى، الجاثم بالعلم أو بالجهل فما بالك بالفكر المستقر، والنظرية المستقرة التى هى مرادفة للأيديولوجيا.
حين كتبت هذه القصيدة فى صورتها الأولى سنة 1974 ، لم تكن نتائج تفكك الاتحاد السوفيتى قد ظهرت تماما بعد، ولم يكن فوكوياما قد أعلن – بخيبة مؤقتة – موت التاريخ، كان ما يشغلنى آنذاك هو “موت الإنسان” من حيث إنه حركة ووعى وتاريخ، وكان ما بلغنى من الممارسة الخاطئة للفكر الاشتراكى (وليس من حركية هذا الفكر البسيطة والبديهية والواقعية والممكنة) أن التاريخ توقف عندما فعله من قلبوا جوهر هذا الفكر الحركى إلى أيديولوجية جامدة، مع أن المفروض أن الفكرة فى عمق أصالتها، هى ضد فكرة الأيديولوجيا أصلا، شعرت أن حركية الفكر خمدت عند من زعم امتلاك حق احتكار تطبيق العدل، فما بالك عن من تبعهم – خاصة منا – مقلدين بغباء أو بادعاء ممن لم يستوعبوها أصلا، ولم يعرفوا عنها إلا ما شاع عنها، أو ما بلغهم من ظاهر تطبيقها وسفه منفذيها.
ثم نبدأ بالقصيدة (المتن) وهى تبدو أنها لا تحتاج إلى المزيد:
(1)
كـَـفَـر البقر بالْـحَجـَـر
من غير سلامْ،
وكإن مولانا ما كانشـِى يومْْ إِمامْْ.
شِـدّوا الستايرْ، كعب دايرْْ،
وْخيوطْها من ليف الضلامْ،
والنــصْبة كانت مش كما الواجب،
ولا قدّ المقام،
(2)
كان بِوِدّى إِنى ما أَجرّحشى حدْ.
كان بودّى ما شوْفشى إن الحارة سدْ.
كان بودّى أَصَدّق انّ العْدلْ ُُمُمكنْْ.
قَاُلوا: “جرّب”، قُلت:”يمكنْ”.
(3)
شاف صاحبنا شوفْ يورّيه إيه رسالته”
ربّنا نوّر بصيرْتُـهْ، قام مِرَاجِعْ كـُل سيرته،
إتـْوجَعْ، لكنُّـهْ كمِّل، يحكى كلّ اللى حصل:
(4)
التعلب، فات فاتْ،
وفْ راســُهْ، أيْـدُولُوجِـيَّـاتْ.
والثورة: شوية كلمَاتْ،
وانا وانتَ: لابْسين شعارات،
بنغـَنـِّى، ونقول حكاياتْ:
(5)
”فى الواقعْْ: إن الواقعْْْ، واقعْْ جداً،”
والبنى آدم يادوبْ: مـادّةْْ ْوْتَاِريخْْ،
والتاريخ عَرْكَةْ اللِّى فاز فيها بيْركَبْ
يطلع المـنْـبَـرْ ويخطُبْ:
إلعيال الشغالين هُمَّا اللِّى فيُهمْ،
باسُمُهمْْ نـِـْلَعْن أبو اللِّى خلّفوهـُمْ
”باسْمُهُمْْ كل الحاجات تِبْقى أليسْطَا
والنـِّسـَا تلبس باطِيسْـطَا
والرجال يتحجّـُبوا، عامِلْ وأُسْطَىَ”.
(6)
يعنى كل الناس، عُمُومْ الشعب يَعْنِى :
لمْْ لابد إنه بيتغذّى لِحَدّ ما بَطْنُه تِشْبَـْع.
وامّا يِشْبَعْ يِبْقى لازِمْ إنُّه يسْمَعْ.
وان لَقَى سمْعُه ياعينىِ مِشْ تمامْْ، يِبْقَى يِرْكَعْْْْْْْْْْ.
بَسّ يلزَقْ ودْنه عَالأْرضِ كـِيـوَيِّسْ،
وانْ سِمْعِ حاجَةْ تِزَيَّقْ، تبقى جَزْمة حَضْرِةْ الأخ اللِّى
عـيّنْ نَفُسُهْ رَيّسْ،
لاجْلِ ما يْعَوَّضْ لنَاِ حرمَانْ زمَانْ.
إمّالِ ايِهْ ؟!!
واللِّى يشبْع مِنكُو أكل وشُـوفْ،ركوعْ، سمَعَانْ كلامْ،
يِقَدْر يـِنَامْ:
مُطْمَئِنْ،
أو ساعات يقدر يِفِـنْ.
واللى ما يسمعشى يبقى مُخّهُ فوِّتْ،
أو غرابْ على عِشُّه زَنْ.
(7)
والحاجات دى حلوه خالصْ
بس إوعـَكْ تِسْتَـمَنّـى إنك تقيسْهـَا،
أَصْلَهَا خْصُوصِى، ومحـْطوطَةْ فى كيسْها.
وانت بس تنـفــِّذ الحتّة اللِّى بَـظـِّـتْ (يعنى بانتْ).
إنت حُـرّ فْْ كل حاجة، إلآ إنك تبقى حر.
(لأْْ، دى مش زَلِّـــةْ قَلْم، ولا هِيّةْ هفوةْ،
مش ضرورى تـِتـْفَهمْ، لكن مفيَدةْ،
زى تفكيكةْ ”داريدا”([42])).
يعنى كل الناس يا حبة عينى ممكن تبقى حُرَّةْ.
حرة كما وُلدوا وأكْتَرْ،
يعنى بـَـلـْـبـُـوصْ حر خالص، بس ما ينطقشى كلمة،
….. يِتخدش بيها حياءْ حامى البلاد من كل غُمّـةْ،
ما هـُو مَـوْلانَا رأى الرأى اللىِّ ينفعْ،
الحكومة تقول، يقومْ الكلّ يسمعْ.
واللى عايز أمر تانى، ينتبه للأوّلانى .
مش حا تفرقْ.
قول يا باسطْْ.
والوثائق فى المعانى، والمعانى فى المباني.
(برضه تفكيكة داريدا، ….تبقى هاصِـط ْ).
(8)
الدنيا دى طول عمرها تدّى اللى يـَغـْلـِبْ:
سيفْ ومطوةْ
واللى مغلوب يـنـضرب فوق القفا فى كل خطوةْ
أصل باينْ إن “داروين” كان ناويلْهَا:
إن أصحاب العروشْ، ويَّا أصحاب الفضيلةْ،
يعملولنا جنس تانى. جنس أحْسَنْ.
إسمُهُُ: “إنسانٌٌٌ مُحَسَّنْ،
واللى يفضل منّا إحنا؟
مش مهمْ.
إحنا برضه لسّة من جنس البشرْ،…إلقديمْْ.
يعنى “حيوانٌ بـِيِنْـطَـقْْ”،
مش كفاية؟!!!
ليه بقى عايز يقلِّبْ، ولاّ يفهمْ؟
هوّا إيهْ؟ هىَّ سايبةْ؟
يعنى إيه الكل يفهم ؟!!
مشْ ضرورِى،
يِكفـِى إنه يقرا “ميثاق” السعادَْهْ،
واللى صعـْب عليه حايلقى شَرْحُهُُ فِى خُطَبِ القيادةْ.
واللى لسّة برضه مش فاهمْ يـُحاكـَـــمْ .
وانْ ثَبَتْْ إنه برئْ. يتــْـَرَزْع نوطِ “العَبَطْ”
وانْ ثَبتْْ إنه بِيِفْهَمْ، يبقى من أَهْل اللَّبَطْ.
“يعنى إيـــه؟”
زى واحد ناسى ساعتُه.
يعنىِ نِـفسُهْ فِـى حاجاتٍ، مِشْ بِتَاْعتُه.
“زى إيه؟”
(9)
زى واحد جه فى مخه-لا مؤاخدة -يعيش كويّـــــسْْ.
”برضه عيب”
هوّا يعنى ناقْصُهْْ حَاجَةْ؟
قال يا أُمّى، والنبى تدعى لنا إحنـَا والرئيسْ،
ربنا يبارك فى مجهودنا يكتّــر فى الفلوسْ.
بس لو نعرف معاهم قدّ إيه،
واحنا لينا كامْ فى إيهْ!
(10)
”آدى أَخْرِةْْ فَهْـمَـك اللِّى مالُوشْْ مُنَاسْبَةْْ.
طبْ خُــدوهْْ، وضّــبوهْ،
واحكُموا بالعدْل يعنى: إعْدلوهْ
تـُهمتـُهْ ترويج “شفافـيِّه” مُعاصْرةْ
هذا ملعوبُ الخَواجةْ،
وان رمِينَا الكومِى بدْرى، تبقَى بَصرةْ.
“الكلاْم دا مِشْ بتاعْنَا،
دَشْ ماْ لهُوْش أى معنى”
تُهمتُهْ التانية “البجاحة”
واحنا فى عِـزّ الصراحةْ،
واللى عايز غير ما يُنشـرْ،
هوّه حرّّ انه “يفكـَّـرْ”،
فى اللى عايزُهْْ
أو يشوفُهْ جوّا حـِلمـهْ،
وان حكاهْْْ يحكيه لأمُّــهْْ،
وانْ أخد بالُـه وقاُلْه مُـوَطِّى حِسُّهْ،
مستحيل حدّ يِمسُّهْ
(11)
قالـــَّها يا مّهْ أنا شفت الليلادِى:
“إنى ماشى فى المعادِى.
شفت نفسى باخترعْ نظريَّةْ موضَـهْ،
زى ساكنْ فى المقابرْ يبنى قصر ألف أُودهْْ:
“والعواطف أصبحت مـِلْك الحكومَهْ،
والحكومة حلوهْ خالص.
عبّـت الحب الأمومى، والحنانْ،
جوّا أكياس المطالْبةَ بالسَّلاَمْ،
والطوابير اللى كانت طولـْهـَا كيلو،
اختفت ما عادتشى نافعة.
”أصلنا شطـَّـبـْنا بيع وبلاش مِلاَوْعة “
واللِّى طَالُهْ من رضا الريّس نصيبْْ:
فازْ، وقّــلعْ.
واللى لسّه ما جاشِـى دوره: بات مولـَّع.
قام سعادة البيه قايـلْ لُـهْ: “تعالى بكُرَه”
[درس مشْ عايز مِذاكرهْ”]
وْرُحت صاحِى.
(12)
قالُوا إنْ أكْرَمْتُوا ميِّـــتكُو ادْفِنُوه.
دا القبر رخامْ،
والنقش عليه آخر موضَةْ، خلاّله مقامْ،
واللى دَفَنُوهْ، سَوَا من مُـدَّة، نِسْـيُوا المرحومْ كان مين.
أَتِاريهْْ كان شَبَه الإنْسَانْ.
إشكالة سياسية أيديولوجية علاجية:
ما تثيره هذه اللوحة يبدو قضية سياسية لسنا فى موقع مناقشتها، ولكن وإن كانت القصيدة تبدو سياسية فى المقام الأول، خاصة بعد تحديثها، إلا أن ما يهمنا هنا هو ذلك الإنسان المريض الذى جاء يعانى وقد سبق أن تورط فى تقديس هذه المبادئ التى بدأت وكأنها تحارب كل “تقديس”، ثم نكتشف أن هذه المبادئ قد استعملها صاحبنا (مثل كثيرين من أصحابها) كدفاعات صلبة راح يتمسك بها، حين قامت بحمايته شخصيا بنجاح، كآلية عامـِيـَةْ أساسا، أكثر منها كموقف أو كمذهب عام قابل للاختبار سعيا إلى إقامة العدل وتحريك التطور على أرض الواقع لكل الناس؟ هذا الشخص كان – غالبا – يستعمل النظرية (الأيديولوجيا) تماما كما يستعمل شخص منغلق متدين يستعمل الدين ليس لتسهيل توصيله إلى الإيمان كدحا إلى وجه الحق، وإنما يستعمله ليستقر فى موقعه بعيدا عن حركية نموه (التى هى موازية – غالبا – لما أسماه كارل يونج: تجربة الرب)، هنا يصبح الدين آلية دفاعية تماما مثلما تصبح الأيديولوجية الاشتراكية آلية دفاعية، وطالما نجحت هذه الآلية هنا أو هناك من قبل أن يمرض صاحبها، أو دون أن يمرض أصلا فليس للطب النفسى ولا العلاج النفسى حق حتى فى مجرد نقدها، إنما ينشأ الإشكال حين يأتى صاحب هذه الآلية (فى الدين الجامد أو الأيديولوجى المقدس)، ويعانى نفسيا، فيجد الطبيب نفسه مضطرا إلى التلميح أن هذه الآلية التى قامت بالواجب فيما قبل المرض، أصبحت معرضة للفحص والنقد وإعادة النظر، مثل أية آلية أخرى.
هنا يقفز عامل آخر، وهو ما ألمحنا إليه فى مواقع أخرى كثيرة، هذا العامل هو: ماذا عن أيديولوجية المعالج نفسه، وكيف يمكن أن تكون عاملا فاعلا بعلمه أو بغير علمه فى مسيرة العلاج، وهل يمكن أن يزعم المعالج أنه محايد فى حين أن داخل داخله قد يحكم على أيديولوجية مريضه هذه بالزيف أو بالفشل أو بالعبث أو بالاغتراب أو بغير ذلك؟
فى البلاد المتقدمة يُتَجَنَّبُ هذا الحرج حين يوصى أن يمتنع الطبيب – بالحرج أو بالعرف أو بالعادة – أن يسأل مريضه عن دينه أو عن توجهه السياسى، وكأن مجرد تجهيل هذه المنطقة عند المريض، مع تصور الطبيب أنه أخفاهما أيضا بالنسبة لنفسه (إيش أدراه؟) يمكن أن يصبح العلاج أكثر موضوعية، طبعا هذا كلام سطحى، ناقشته مكررا كلما تعرضت إلى موضوع استحالة الحياد المطلق فى العلاج النفسى.
إذن ما العمل؟
ليس عندى اهتمام مباشر بالعمل السياسى، وإن كنت – مثل أى شخص يعيش فى مجتمع تنظمه سلطة ما – وبالتالى فأنا حيوان سياسى رغم أنفى، تقفز لى هذه القضية بشكل شخصى حين اضطر، ولو بينى وبين نفسى أن أتساءل عن موقعى الشخصى من هذا المذهب السياسى أو ذاك، وأيضا عن موقفى من هذا النوع من التدين أو ذاك، وهى قضية تحتد حين أواجـَهُ بمريض صاحب مذهب واضح محدد، أو صاحب أسلوب فى التدين راسخ جامد، ثم يأتى يسألنى النصح، فيقفز لى – غالبا – أنه لو كان على صواب فى مذهبه هذا أو فى طريقة تدينه وعلى اتساق معه، لما مـِـرَضَ، ولما جاء يستشيرنى وأسأل نفسى بشكل مباشر أو غير مباشر: أين يقع مذهبه مما حدث له؟
لا يجوز أن يجرى الأمر كذلك، وفى هذه الحالة (حين أضبط نفسى متلبسا بهذا الخطأ)، أتصور أننى كان يمكن أن أعفى نفسى من هذا الحرج بأن أّدعى الحياد، لكننى عادة لا أستطيع، فقد أمارس هذا الزعم ظاهرا وأنا غير متأكد من باطـِنى! فأتقدم خطوة لأعامل هذا الموقف الأيديولوجى الجامد أو طريقة التدين المستقرة بلا حراك، أعامل هذا أو ذاك باعتباره ميكانزما معرضا للاهتزاز مثل أى ميكانزم، وهكذا تنتقل القضية من منافشة المحتوى (مضمون الأيديولوجى، أو مضمون طريقة التدين) إلى البدء بالعمل على إنجاح صاحب أى منهما كما كان ناجحا فى الحفاظ على تماسكه متوازنا غير مريض، فإذا فشلنا، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر، لإطلاق مسيرة النمو، وهو نفس ما نلجأ إليه فى التعامل مع أى ميكانزم.
هناك بـُـعـْـدٌ آخر ينبغى وضعه فى الاعتبار بشأن المريض، قبل وبعد تعلقه بمنظومته الدفاعية: أيديولوجيةً أو دينا، ذلك أن بعض المرضى الذين يحضرون للعلاج يعلنون أن ما ألمّ بهم من مرض أو إعاقة إنما يرجع إلى تدهور قيم المجتمع عامة، والظلم السائد فيه، والاغتراب الغالب عليه، وكذا وكيت، وكأن الحل ليس فى أن يشفوا هم، حتى يستطيعوا أن يواصلوا تغيير ما يعترضون عليه بالثورة أو الإبداع أو الإصلاح أو أى دور يرتضونه، بل إن بعضهم يلح على الطبيب أن يفهم أنه لن ينصلح حال مرضه، ولن يشفى إلا إذا انصلح حال المجتمع، وكأنه بذلك يبلغ الطبيب ضمنا أن مهمته – حتى يشفيه – هى أن يُصلح حال المجتمع، ويقيم العدل، وربما يوزع الأرزاق، طبعا المريض لا يقول هذا صراحة، ولكنه يحيل أية معاناة إلى مثل هذه الأسباب الخارجة عنه، ويلقيها فى وجه الطبيب، وينتظر.
فى كثير من هذه الحالات لاحظتُ كيف تحل المناداة بالمبادئ المثالية، سماوية كانت أم إنسانية، محل الحياة الواقعية اليومية، وتبدو المبادىء التقدمية أو الاشتراكية أو اليسارية أكثر إغراء للشباب من غيرها (أو هكذا كانت تبدوا أيام كتابة النسخة الأولى للقصيدة)، فكنت كثيرا ما أتبين أن المناداة بهذه المبادئ بكل هذا الحماس، وبكل هذا الكلام، حتى فى الموقف العلاجى، هو نوع من إعلان ضمنى بعدم الالتزام بالمشاركة فى تحقيقها، وبرغم ذلك، فقد لاحظت من أصحاب هذه المبادئ أنهم أحيانا يحضرون وعندهم تصور عن أيديولوجية أو دين المعالج (من مقال قرأوه ، أو حديث سمعوه أو شاهدوه، أو خبر تناقلوه… إلخ)، وحين يكتشف الواحد منهم أن المعالج ليس كما تصور (ليس اشتراكيا، ليس مستشيخا، ليس مثاليا… إلخ) تهتز ثقته، وقد يتراجع، أو قد يواصل متحديا المعالج أحيانا، آمِرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر فى أحيان أخرى، وقد تنقلب المسألة العلاجية إلى مناقشات سياسية أو اقتصادية أو فقهية ، لو لم يأخذ الطبيب حذره، وتضيع معالم المهمة العلاجية المهنية، وتبهت محكات قياس التقدم فى العلاج.
وفى العلاج الجمعى
لاحظت فى العلاج الجمعى أن أكثر أفراد العلاج اغترابا عن التفاعل النشط فى “هنا والآن” هم الجاهزون بهذه الأفيشات البراقة، وحين كنت أصر أن أجذب بعضهم إلى اللحظة الراهنة، كان الواحد منهم يكاد يطلق عدوانه بلا هوادة احتجاجا على “رجعيتى”، وقد يشك فى محاولة غسيلى لمخه لأخلع عنه أيديولوجيته.. إالخ” وبالتالى قد يتردد فى وضع الثقة، أو حتى فى استمرار العلاج احتجاجا على بعدى عن التعاليم المقدسة (أيديولوجيا أو دينيا) التى يؤمن هو بها.
وكما يستغرق الشخص الرأسمالى فى جمع المال، ويكتمل اغترابه حين ينسى أن هذا المال ليس إلا وسيلة لتحقيق فرص أوسع لحركية نموه، وإطلاق حيويته، وتأمين وجوده، ومن ثم اكتساب حرية داخلية تعقبها فاعلية الخلق والعطاء، كذلك فإن مثل هذا الشخص يستغرق فى تكريس الأفكار والمبادئ التى تدعم تسلسل المنطق التكاثرى لديه، وتدعم الدفاع النظرى عن أيديولوجيته، فيكتمل اغترابه بالابتعاد المنظم عن ذاته وعن أرض الواقع الفردى، وعن مواجهة مشاكل الوجود الجماعى الحقيقية فى نطاقها الحى، كل هذا قد يكون مقبولا ومفيدا فى مجال آخر غير مجال العلاج، لكن متى ما احتاج الأمر إلى طلب المشورة والمساعدة المهنية، بما فى ذلك من إقرار ضمنىّ باهتزاز هذه الحيلة الأيديولوجية الدفاعية، فإن الحسابات تختلف، والمنهج يختلف، والمحكات تختلف.
حاولت أن أسائل نفسى عن هذه السكينة الظاهرية التى يتحلى بها بعض أصحاب هذه الآراء ووجدتها أحيانا أقرب إلى اللامبالاة نتيجة لـ”تصور” حل كل شيء بمجرد الحديث عنه من منطلق منظومتهم الفكرية وذلك بإعلان أن “كذا هو الحل” (سواء كان كلمة الإسلام – أو الديمقراطية – أو الاشتراكية أو الثورة – أو التنوير.. إلخ)، ليكن، ولكن الأمور لابد أن تختلف حين تظهر أعراض المرض حيث أن المرض قد يكون إعلانا لاهتزاز هذه الأيديولوجيا داخليا، ومن ثَمَّ فهو مطلب ضمنى أن تبدأ المراجعة مع ظهور المعاناة أو أثناء العلاج.
وما يكاد التغيير يعرض نفسه من خلال إحياء حركية الاختبار اليومى عبر المواجهة العلاجية حتى تبدأ وظيفة هذه الأفكار تتعرى، ويلوح أمل فى العوده إلى إطلاق حركية النمو ولو لفرد واحد، الذى هو بمثابة لبنة هامة فى مسيرة النمو الجماعى، ومن ثم العدل، والعمل، والحرية الحقيقية والإبداع… ولكن..!!
وبعـد
القصيدة لا تتناول هنا تفاصيل هذا الموقف العلاجى بشكل مباشر، أو حتى غير مباشر، بل الأرجح أن هذا الموقف قد أثار فى شخصى تحديات تلزمنى أن أعلن رأيى الذى يبدو نقدا سياسيا بشكل أو بآخر، حتى تناولت القصيدة بعض سلبيات تاريخ الثورة (تقريبا)، وشعارات الاشتراكية بدون اشتراكية، والكبت السياسى، والقهر السلطوى، وغسيل المخ، والافتقار إلى الأمان وغير ذلك، لهذا فإن بقية القصيدة لا تحتاج إلى تناول تفصيلىّ، لما يتعلق بآليات العلاج النفسى أو نقده، لهذا فضلت أن أكتفى بتحديد هذه المعالم العامة، واضـِعـًا فى حسابى أن هذا النقد قد يصل إلى أصحاب هذه المبادىء القوية الثابتة بما يسمح لهم أن يصنفونى كما يشاؤون، وهذا وارد ولابد أن أتحمل مسئوليته مادام واقعا.
اللوحة السابعة:
(7) حمام الزاجل
لا توجد كلمة شائعة الاستعمال، سهلة التناول، مقدسة أحيانا، وملتبسة كثيرا، مثل كلمة “الحب”، نحن نتداول هذه الكلمة بإفراط شديد طول العمر، طول الوقت، ربما يسمعها الرضيع قبل أن يسمع “بابا” و”ماما”، ثم خذ عندك: بمجرد أن يكبر وينتبه إلى ما يقال حتى يواجَه بسيل من العبارات كلها تحمل كلمة الحب بشكل أو بآخر، فهى إما تعبير عن الحب، أو دعوة للحب، أوسؤال عن الحب (بتحب ماما أكتر ولا بابا؟ باحبهم الاتنين!!)، ثم خذ عندك ادعاء حب المدرسة، ثم حب الصديق والصديقة، ثم الحب الذى هو حب، والحب الذى كنظام الحب، ثم يتدخل الجذب الجنسى فى الموضوع، فيصبح الحب غراما وهياما، مع الإضافات المناسبة من الخيال والرومانسية والأحلام، وهات يا حب، ثم خذ أيضا حب الوطن (فرض عليّا)، وحب النادى الأهلى، وحب النبى وأهل بيته، ومحبة السيدة العذراء، وحب النفس، ولا مؤاخذة “الأنانية” (وهى غير حب النفس)، وحب الناس، والحب فى الله، والموت حبا، فى المحبوب أو بسبب المحبوب، أو مع المحبوب (بالمرة).
طيب بالله عليكم كيف نتناول هذه الكلمة، هذا المفهوم، هذه القضية، وهى هكذا، كيف نتناولها فى سياق العلاج النفسى؟
حين وصلت إلىَّ هذه القصيدة، هذه الحالة، وجدت أنها تمثل نموذجا له أهميته الخاصة لما تتناوله من مقارنة بين نوعين على الأقل من أنواع الحب، رحت أقلب فيما سبق وفيما لحق من قصائد هذا الديوان، فوجدت أن معظم القصائد، إن لم يكن كلها إنما تتناول قضية الحب أيضا بشكل أو بآخر، فهى تتناول قضية العلاقة البشرية عامة، حتى أننى – كما ذكرت – أطلقت على نشر هذا الشرح مسلسلا فى نشرات الإنسان والتطور (أصل هذا الكتاب) عنوانا شاملا هو “فقه العلاقات البشرية” ثم احتفظت بها عنوانا لهذه السلسلة بأجزائها المتتالية.
القصيدة الحالية تعرّى الحب الثنائى، وبالذات فى علاقة المؤسسة الزواجية باعتبارها المثال الشائع الأعم لما هو “عقد جامع مانع”، يشترط امتلاكا “جامعا” للطرفين، وأحياناً لطرف واحد، و”مانعا” لأى آخر عادة، وهذا الشرط الأخير “المانع” يعنى ضمنا الحدّ من اختبار القدرة على الحب التى هى أصل الحب طبعا، وهل يستطيع أحد أن يمارس أى حياة جملة وتفصيلا: إلا من خلال قدرته على ذلك؟!!
ثم نبدأ كالعادة بالمتن:
(1)
عايزين إيه منـِّى؟
أنا مالِى؟
أنا عايزهْْْ أعيشْ،
زىّ الباقْيِـيِـن،
يبقَى لى عشّ صغيّر، وعْيالْْ.
ولـَفَندى بتاعِى (أيوه بتاعى ملكى)،
يرجعلِـى تملّى.. زىّ حمام الزاجل.ْ
يحضنّى أنا وعيالِى،
يطوينٍى تحت جناحُهْ،
وراح اربُطْ رجلُهْ بـْـفتــلَةْ لـَيْـــطير.
(2)
أنا مالى بْكلّ الناسْ؟
ما تحبّــــوهُـمْ
هوّا انا قلتلكُو انَا باكْرَهْ حَدّ؟
حـِبُّوهم بكلامْكُمْ يعنى،
مش حا يخسّــرْ.
ما انا بَرْضُهْ باحِبّ انِّى اتكلِّم،
لكنّى مِشْ قــدّ كَلاَمِى
دا كَلام كِدَا بسْ
ولا عايزهْ أصلّحْ حَدْْ،
ولاّّ واخْدةْْ كَـلاْمْكم جَدّ،
ولاّّ نـِفسِى أعدّل فى الكونْ،
ولا شَايْلَه هَمِّّ المطحـُون،
ولا قادره أصاحب المجنونْ
ولاّ نَاوية أبطَّل لــتّ ورَصْ.
واهُو كُلُه كَلاَمْ.
(3)
أنـــا عايزة حد يعوزْنِى،
وأعوزْ عَوَزَانُهْ،
إشمـِعـْنى حسـَن ونعيمَا؟ْ
إشمعنى بتوع السِّيمَا؟
أنا مشْْ قدّ الحب التانِى
وانْ كان لازم نتــــــّـــطـــّور؟….. ….. نتطوّرْْ،!!
ما يـْضــــــُرّشْْ.
بس ارجع تانى لْعشّى،
ولـَفـَنـْدى بتاعى، أيوه بتاعى مـِلـْكـِى :
يطوينى تحت جناحهْ،
وانا ماسكه الخيط بالجامدْ،
تعبانة وبرضه باعـَانـِدْ
ما هو لو سبته حـَيـْطير
وانا مش قد التغيير
والآن:
ما العمل؟
ما هو الأفضل؟
أن نسميه حبا، ويذهب المتلقى إلى ما يذهب إليه بمجرد أن يسمع كلمة “حب”؟ أم نسميه العلاقات البشرية فنمسخه ونحن نهرب من مسئولية التحديد والتفنيد، ونتكلم عنه وكأننا نتكلم عن معادلة رياضية فاترة؟
هل أجمع من الديوان القصائد التى تناولت تشكيلات الحب بشكل مباشر، ثم أخرج منها بمنظومة نتعلم منها ما هو الحب وكيف يتجلى فى مختلف صوره، فلا ألزم نفسى بقصيدة بذاتها تقدم الموضوع مخنوقا منفصلا، أم أتناول الموضوع من خلال كل قصيدة بحسب ترتيبها، ثم نجمع الخلاصة لاحقا؟
قصيدتان قفزتا إلىّ وأنا أواجه هذا المأزق، قصيدة “الترعة سابت فى الغيطان“، وقصيدة “دراكيولا“([43]).
الأولى: “الترعة سابت فى الغيطان” تعرى نوعا من الحب فيه سهولة وعطاء ودماثة وصدق وإخلاص، بلا شروط ولا معاناة ولا مقابل (يعنى) ولا.. ولا.. وبالتالى بلا “آخـَر”، بلا موضوع حقيقى متميز (انظر بعد)!!
والثانية: “دراكيولا” تجلى فيه ما سـُمـِّىَ حبا بشكل التهامى احتوائى قاتل، كأنه موت يقتات بموت، ويغذيه، “بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا” (انظر بعد).
المهم، هذه القصيدة الحالية تتيح لنا – على لسان صاحبتها – النظر فى ثلاثة مستويات من الحب:
الأول: الحب الامتلاكى (ويشمل الخصوصية والأمان والاطمئنان السرى الاعتمادى).
الثانى: الحب الجوع الاحتياج، فاحتياج الاحتياج (ويشمل شرب الماء المالح، والاستعمال المتبادل أحيانا).
والثالث: الإشارة إلى صعوبة النقلة إلى الحب: “القدرة على الحب” الممتد إلى الدوائر الأوسع. (ويشمل الاستعداد للحب والقدرة على توليده وتوجيهه وتحويله وتحمل مسئوليته وطول النفس الملازم له).
هذه القصيدة تتناول النوع الأول، وبعض الثانى، كما تحذر من احتمال مثالية أو عقلنة النوع الثالث.
(المتن):
عايزين إيه منـِّى؟
أنا مالِى؟
أنا عايزهْْ أعيشْ،
زىّ الباقْيِيِن،
يبقَى لى عشْ صغيّر، وعْيالْْ.
ولـَفَندى بتاعِى (أيوه بتاعى مِلكى)،
يرجـَعـْلِـى تملّى.. زىّ حمام الزاجل.ْ
يحضنّى أنا وعيالِى،
يطوينٍى تحت جناحُهْ،
وراح اربُطْ رجلُهْ بـْـفتــلَةْ
تعبـِّرُ هذه الفقرة عن أكثر أنواع الحب شيوعا “زى الباقيين“، وهو الذى يتصف بما يلى (وغير ما يلى):
1- الخصوصية “يبقى لى عش صغير“
2- والملكية: لفندى بتاعى (أيوه بتاعى ملكى)
3- وتصور الأمان: يرجع لى تملى، يطوينى تحت جناحه
4- والأسرة الصغيرة (غالبا فى المؤسسة الزواجية) يحضنّى أنا وعيالى
5- وضمانات ضد اللاأمان: وراح اربط رجله بفتلة،…….
هذا النوع من الحب الثنائى الخصوصى الامتلاكى يظل فاعلا مفيدا طالما سكنت حركة طـَـرَفـَـيـَهْ، وهو يغذى نوعا من العلاقة التكميلية (التكافلية) وهى ما تسمى أحيانا “علاقة القفل بالمفتاح” ([44])، ويظل الطرفان يتبادلان – من خلال هذه العلاقة – الأمان، والتأمين، فى مقابل (وعلى شرط) “أن يستمر الحال على ما هو عليه”، لأطول مدة ممكنة.
فى حالات كثيرة، مع استمرار نمو كل من الطرفين، كل بطريقته وحسب ظروفه، تهتز هذه العلاقة لأنها تكاد تحول دون نمو طرف واحد أو كلا طرفيها، فتظهر الأعراض، إما عند أحد الطرفين، وإما فيما يسمى “مرض العلاقة ذاتها” أى أن كلا من الطرفين بعيدا عن الآخر لا يعانى من أعراض بذاتها، وإنما إذا ما تفاعل الطرفان معا، تظهر الصعوبة فى العلاقة، وربما التهديد، وربما الفشل الذى يعلن مباشره أو عن طريق ظهور الأعراض.
حين يعلن هذا المأزق فى العلاج النفسى، يحتاج الأمر إلى وقفة فاحصة ناقدة، تغرى الطبيب، أو تضطره، فى كثير من الأحيان، أن يتقدم نحو ما يسمى “إعادة التعاقد” بمعنى أن يعتبر أن العقد الثنائى السابق قد استنفد أغراضه فى ظروفه التى كانت حتى الآن، وأن الأمر يحتاج إعادة التعاقد على مستوى آخر حسب مرحلة مسيرة النضج، ويمكن إيجاز بعض ذلك كما يلى:
يسمح الطبيب أن تتخلخل العلاقة، ولو مرحليا، لإعطاء الفرصة للانتقال إلى مستوى آخر من الحب، وهو مستوى “القدرة على الحب”: حب الآخرين أيضا، وليس فقط الحب الاستبعادى إلا لواحد، لا يعود هذا المحبوب محبوبا بديلا عن كل الناس، بل يصبح ممثلا لكل الناس، وهو ما عبرتُ عنه ذات مرة ، بأن المرأة – مثلا – تحب زوجها بالأصالة عن نفسه والنيابة عن حب كل الرجال، بل كل الناس (وقس على ذلك). هنا تصبح المسألة أقل احتكارا وأكثر حركية وحرية، إذْ تنتقل حركية “التواجد الاستبعادى” “معا”:
من: “أنا أحبك دون غيرك” (انت وبس اللى حبيبى)”، إلى:
“أنا أستطيع أن أحب الجدير بحبى (كل الناس حلوين، فى عنيىّ حلوين)“، لكننى أمارس الحب معك لأنك أقرب وأطيب، وتقوم لى بنفس ما أقوم به لك، أو على الأقل أنا أتوقع منك ذلك، وأعمل على تحقيق ذلك، وأنت كذلك، تقوم به بدورك معى.
(وكلام من هذا، وهو الذى تعرّض للتعرية من خلال هذه القصيدة!) .
هذا النوع الأخير “القدرة على الحب مع الالتزام بتخصيص يتطلبه الواقع“، – مهما زعم المحبون أنه مقبول من حيث المبدأ – هو مرفوض من داخلهم، إلا نادرا، إذ يبدو الأمر لكل المحبين والخائفين والمحتاجين والجائعين أنه مبنى على أمل بعيد، ومنطق خائب فاتر مرفوض غالبا فى داخلنا مهما بدا علينا الحماس نحوه، وعلينا أن نعترف بأن النقلة من تخصيص الحب وتركيزه على فرد واحد طول الوقت، إلى القدرة على الحب، تبدو أكبر من قدرات أغلب الناس، ثم إنها قد تختلط بنقلة إلى الخلف نكوصا بما يسمح بالتعدد دون التزام ودون عدل.
نشأت المؤسسة الزواجية (وهى الممثلة الأكثر شيوعا للحب الثنائى، فالأسرى)، كحركة تطورية لتنظيم الجنس، وتربية الأولاد، وتكوين المجتمع الأحدث، وقد أدت وما زالت تؤدى، وظيفة اجتماعية، وعلاقاتية، شديدة الأهمية، كما لم يوجد بديل لها أثبت قدرته على الاستمرار والنجاح بشكل يبرر تجاوزها أو إزاحتها أو الاستغناء عنها حتى الآن، من هنا نفهم مشروعية منطق هذه الحالة فى هذه القصيدة وهى تصر على حقها فى الحفاظ على الاستمرار فى هذه المؤسسة، الأكثر أمانا، حتى لو لم تكن الأكثر إبداعا، أو الأكثر امتدادا فى الآخرين، حتى لو كانت مبنية على مبدأ الاحتياج المتبادل بعد التعديل!! بمعنى أن يحتاج طرف طرفا آخر، فيسعد هذا الطرف بهذا الاحتياج الذى أشعره بأن له وجودا ما، فيحتاج هذا الاحتياج أكثر مما يحتاج صاحبه الذى احتاجه، وهذا ما يعبر عنه المتن بشكل مباشر فى النص السابق الاستشهاد به:
“أنا نِفـْسِى حد يعوزنى، وأعوز عوزانه“
الاحتياج غير مرفوض فى ذاته، ولكن أن يظل هو الذى يحافظ طول الوقت على العلاقة، فهذا ما ننبه إلى عدم كفايته، فهو أعجز من ذلك عادة.
الطبيب النفسى المعالج لا يملك – ولا هو من طبيعة عمله – أن يتصدى ليرفض ابتداء هذا النوع البسيط الشائع من الحب، فبرغم أنه ليس غاية المراد، إلا أنه يعلن بوضوح أن هذه هى المرحلة التى يعيشها أغلب الناس حاليا، تلك المرحلة التى تعلن نقص الإنسان حين يلح عليه احتياجه فيتبادله مع آخر فى حدود المسموح به، ولكن يبدو أن لهذا النوع عمره الافتراضى المتوسط أو القصير، خاصة إذا اضطرد نمو أحد الطرفين دون -أو أسرع من- الآخر، فتتخلخل العلاقة، وتظهر الأعراض على أحد أو كلا الطرفين، فيجد الطبيب نفسه فى مأزق جديد من حيث أن عليه أن يصحح وضعا انكسر فعلا، وهو ينتبه إلى أنه بين أمرين (كالعادة):
-
إما أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه دون إعادة تشكيل فيصبح أكثر عرضة للكسر من جديد، أو أكثر دفاعية وجمودا.
-
وإما أن يعرض، من خلال العلاج عامة، والعلاج الجمعى خاصة، (أو تنظيم الخبرة الحياتية خارج سياق العلاج) يعرض تجاوز هذه المرحلة من الحب الثنائى السكونى المستقل إلى القدرة على الحب مع التنظيم الضرورى.
إن دفع الشخص أو المريض فى اتجاه هذا النموذج الأكثر نضجا يهدد الشريك (الأكثر اعتمادية بالذات، وقد يهدد الشريكين) بالتخلى عن نوع من العلاقة، كان يقوم بوظيفته بكفاءة ما، وبضمان معقول مضمون، برغم فشله الأخير، ومن هنا تبدأ المقاومة لأى احتمال آخر، حتى لو لاح أنه نموذج للحب أكثر نضجا وأطول عمرا، لكن “إيش ضمّنى”، هذا ما تقوله القصيدة،
المقاومة هنا تبدأ بإعلان التمسك بالقيم السائدة عند كل الناس:
أنا عايزة أعيش
“زىّ الباقْيِـيِـن “
حتى ولو فشلت هذه القيم برغم أنها السائدة عند أغلب الناس، وأنها قد أعلن فشلها بظهور الأعراض عند هذين الشريكين بوجه خاص، فإن الدفاعات – فى البداية على الأقل – لا تطلب إلا الرجوع “كما كنت”، “مثل الباقيين”!!
الإشكال أن هذه النقلة، من الحب الخصوصى المنغلق “عليهما”، إلى القدرة على الحب فى سياق جماعة (علاجية أو غير علاجية)، قد تـُـعلن من بعض أفراد المجموعة بشكل متواتر، وأيضا فى العلاج الفردى، وهى قد تعلن من أحد الشريكين (مع احتمال أن يكون هو الأقل نضجا)، وعادة ما تصدر مزاعم النضج المعلنة هذه من أبعد أفراد المجموعة عن النضج، فيزعمون أنهم “فاهمون” و”قادرون” وكلام من هذا، وقد يصل الأمر ببعضهم أن يزعموا أنهم فعلوها بالفعل، وينتظرون، أو يطلبون، من شريكهم أن يلحقهم. الإشكال يصبح أكثر وأصعب حين يكون المعالج نفسه هو هذا الشخص الدفاعى المعقلِن، بمعنى أن تكون درجة نضجه أقل بقليل أو كثير من هذه النقلة، وربما من مرحلة نضج بعض مرضاه، وهنا تصبح المقاومة التى ترد على “لسان حال” راوية هذه القصيدة فى محلها، ونستطيع أن نفهم سخريتها اللاذعة، مِنْ مَن يزعم تجاوز مأزق النقلة إلى موقف أقرب إلى مثالية “لم تـُـخــْـتـَـبر”،
يقول النص فى ذلك:
(2)
أنا مالى بْكلّ الناسْ؟ ما تحبّوهمْ .. هوّا انا قلتلكُو انَا باكْرَه حَدّ؟
حـِبُّوهم بكلامْكُمْ يعنى، مش حا يخسّــرْ.
ما انا بَرْضُهْ باحِبّ انِّى اتكلِّم،
لكنّى مِشْ قد كَلاَمِى.. دا كَلام كِدَه بسْ
ولا عايزهْ أصلّحْ حَدْْ،
ولاّّ واخْدهْْ كَـلاْمْكم جَدّ،
ولاّّ نفسى أعدّل فى الكونْ،
ولا شَايْلَه هَمِّ المطحون،
ولا قادرة أصاحب المجنون
ولاّ نَاوية أبطَّل بَصْ ورَصْ.
واهُو كُلُه كَلاَمْ.
ادعاء – أو تصور – النمو يتواصل بمجرد إطلاق الكلمات الرنانة التى تعلنه أو تصفه هو ادعاء شائع فى كثير من الممارسات الناقصة فى العلاج النفسى عامة، والعلاج الجمعى بوجه خاص، وأيضا فى الحياة العامة، وتنبيه الحالة هنا فى القصيدة، للمعالج، وللمشاركين فى نفس الوقت، هو تنبيه مشروع ومهم، ويشير إلى بصيرة جيدة مهما كان تبرير التوقف، وهو تحذير من أن تصبح المسألة “مـَـكـْـلـَـمة” مثالية لم تُختبر، مكلمة تتمادى على حساب هدم مؤسسات فى مأزق حقيقى، مثل المؤسسة الزواجية التى لم يجد لها الإنسان بديلا أفضل حتى تاريخه.
تعلن هذه الحالة أيضا أسلوبا آخر للمقاومة، وهو الاستمرار الصورى مع الحذر المتمادى،
“ما انا بَرْضُهْ باحِبّ انِّى اتكلِّم،
لكنّى مِشْ قد كَلاَمِى،
دا كَلام كِدَه بسْ“
لا يحتاج الأمر إلى التذكرة بأن هناك أكثر من صوت تتكلم به هذه الإنسانة، أو أن هذه القصيدة إنما تترجم لسان حالها داخلها وليس خطابها الظاهر فحسب مثل كل – أو معظم – قصائد الديوان.
كانت صاحبتنا هنا شديدة الحماس للكلام عن الناس والمطلق والحرية، وحين دخلت الاختبار الحقيقى هربت بكل ما عندها من قوة، وكان لسان حالها يردد هذا المنطق أن الكلام يمكن أن نساير به الشائع، بما فى ذلك أن نزعم اهتمامنا بالكل وحبنا لهم على حد سواء، وأننا تخلينا، أو قادرون على التخلى عن الامتلاك والخصوصية… إلخ ولا يهم بعد ذلك أن نحقق شيئا من هذا أبدا.
(3)
أنـــا عايزة حد يعوزْنِى، وأعوز عَوَزَانُهْ،
إشمـِعـْنى حسن ونعيما؟ْ إشمعنى بتوع السِّيما؟
أنا مشْْ قدّ الحب التانِى ..
وانْ كان لازم نتطوْر؟!! نتطوّرْ…!،
ما يـْضـُرّشْْ.
بس ارجع تانى لْعشّى،
ولَفَندى بتاعى،
يطوينى تحت جناحهْ،
وانا ماسكه الخيط بالجامدْ،
تعبانة وبرضه باعـَانـِدْ
ما هو لو سبته حـَيـْطير
وانا مش قد التغيير
لهجة السخرية هنا، برغم قسوتها تقوم بوظيفة التعرية المأمول الاستفادة منها بأكبر قدر من المسئولية، هذا المقطع “أنا عيزة حد يعوزنى، وأعوز عوزانه” وهو الذى استشهدنا به فى البداية، هو مفتاح سر الأمر الواقع، وهو برغم واقعيته ليس مقبولا ولا ناجحا على المدى الطويل، خاصة فى الحالات التى واجهت الصعوبة بأمانة حتى الألم أو الشقاء أو الفشل أو المرض، ومع ذلك، ونظرا لصعوبة النقلة، يمكن قبول الدفاعات – التى تتعرى بهذه السخرية هنا – كمرحلة على الأقل.
إن القدرة على حب الجميع (الصنف كله) هى أمر صعب فعلاً، وهو الذى تسخر منه صاحبة هذه القصيدة بصدق صادق، فهو أمر واقعى – حتى لو كان نادرا – ومهما بلغت السخرية أو التعرية، فإنها لا تكفى لكنها تفتح الباب أمام تنمية القدرة على الحب الشامل (مركزا فى أفراد من لحم ودم) ثم فى ممارسة هذا الحب الشامل مع من تتعامل معهم فى الحياة اليومية (ممثـِّـلـِـين لسائر البشر)، وهو نقيض التقديس والذوبان والاعتمادية الرضيعية، وأيضا نقيض التسيب والتعدد بلا رابط أو رادع، الأمر الذى يحتاج إلى درجة من المسئولية والرفض الواعى، بقدر ما يتجلى فيه ما ينبغى من الود والتراحم والشوفان، هذا النوع الذى يطرح على المريض (وعلى الطبيب) هو حب أيضا، بل لعله الحب القادر على الاستمرار باستمرار المحاولة والالتزام، وهو مرحلة فعلا صعبة إلى أبعد الحدود لكنها تستأهل.
من أصدق خبراتى فى العلاج النفسى أن يعلن أحدهم انسحابه من هذه المحاولة (مواصلة النضج)، لأنها أكبر منه (مثل صديقتنا هنا). ولكن هذا لا يبرر التنازل عن الأمل فيه، والسعى لتحقيق ولو درجة منه، فأكبر فأكبر طول الوقت، إن مجرد السعى إلى إمكانية تحقيقه، ولو على المدى الطويل هو حركية علاقاتية وعلاجية واردة، مع احترام الوقت اللازم حتى تكون المسألة جدا.
لا مفر من أن نشير إلى بعض المحكات التى تبين أن هذا الصعب هو شىء عادى برغم ندرته، واحتمال تشوهه، وما دمنا مضطرين إلى المضى قدما فى طرق بابه، فعلينا أن نتعلم كيف نقيس مصداقيته أولا بأول، مثل أن يقاس:
-
بالقدرة على الابتعاد الاختيارى عن نفس الشريك للاقتراب منه عل مستوى أنضج باستمرار “برنامج الدخول والخروج” ([45]).
-
ثم بالتغير النوعى لطبيعة العلاقة ومسارها وإيقاعها.
-
ثم باختبار القدرة على معايشة توجه المشاعر نحو “موضوع” (آخر) مع اختلاف ظروف التنفيذ الواقعى.
-
ثم بمدى تواجد الآخرين المحيطين المحبين حول أصحاب هذه العلاقة الثنائية، بما يمارسونه شخصيا فى مجالاتهم وعلاقاتهم الموازية، وأيضا بمباركتهم وتكافلهم واحترامهم المتبادل…. إلخ.
فى العلاج النفسى (الجمعى خاصة)، وفى الروايات وفى الأفلام، وفى النظريات الباهرة، يكثر الحديث عن التطور – كما أفعل الآن حالا وكثيرا – وقد لا ينتبه المحاورون أن وفرة الحديث عن التطور هو ضد التطور (مثلما أن الحديث عن الجدل، هو ضد الجدل)، السخرية فى المتن من هذه العقلنة هنا شديدة الدلالة.
“وانْ كان لازم نتطور؟! نتطور!، ….. ما يضرش!!!”
هذا النوع من السخرية ليس مرفوضا على طول الخط، وقد واجهتُ فى خبرتى مثل ذلك وأقسى من مـَـرْضـَـى ينبهون بعض زملائهم الذين يتحدثون عن التطور وكأنه فنجان شاى، أو نزهة ترفيهية، دون حركة أو ألم، وأحيانا ما ينبهون المعالج، أو ينبههم المعالج إلى ما فى هذا الموقف من “طق حنك”!!! كما أشرتُ من قبل أنه قد قال أحدهم ذات مرة ما يوازى سخرية هذه الحالة، حين راح ينبه زميله ساخرا أن المسألة – كما ذكرنا – ليست بمثابة: “ادينى واحد تطوّر وصلّـحه..”.
حين تتعمق مرحلة النمو فى العلاج الجمعى وتلوح صعوبة التطور وما يصاحبه من مخاطر مرعبة، أتذكر فأعلن لنفسى إعادة اكتشاف أنه “لن يتطور إنسان باختياره”، وإنما بإلزام داخلى، نتيجة حركة مضطردة، و ورطة موضوعية تجعل الرجوع إلى الحالة السابقة مستحيلا.
اعتدت فى مثل هذه المآزق أن أوجه المريض – ونفسى – بأن عليه أن يراجع نفسه ولا يسير فى الزحمة والسلام، يحدث هذا التوجيه غالبا بطريق ضمنىّ غير مباشر، وهو يعرض بشكل خفى.
-
إما أن يتحمل المريض آلام رحلة العلاج بما فى ذلك ثم مصاعب النمو، وإما أن يخبئ الأعراض بمعرفته: بالتسكين أو بالتنازل عن أية آمال إنسانية أنضج أو باليأس، فتختفى الأعراض دفاعيا، ولا مانع من هذا الاحتمال ما دام هذا هو المتاح مرحليا!!!
-
وإما أن يضطر لمحاولة طرق باب الطريق الآخر، الأندر، والأكثر نضجا لأن المسألة ليست عرْضا (أو عزومة)، بما أن الفشل قد أعلن بالمرض، أو المعاناة، أو الشقاء، فهو إعلان لانتهاء العمر الافتراضى لمرحلة لم تعد تصلح، ولنوع من التواصل فشل برغم نجاحه النسبى لفترة ما، ثم يمكن أن ينتقل بكل جدية ومعاناة إلى تنمية القدرة على الحب الحقيقية، ليست على حساب الصدق، والعدل، والأسرة، وإنما باتساع دائرة التعاقد على مستوى أرقى فأرقى ، فتمثل الأسرة لبنة فى مجتمع نابض، وليست مهربا بعيدا عنه.
****
المحتوى
صفحة |
العنوان |
3 |
– الأهداء |
5 |
– مقدمة |
7 |
الفصل الأول:عن نمو الكلام وعلاقته بالمعنى واللغة |
33 |
الفصل الثانى:اللوحات (1 – 7) |
35 |
اللوحة الأولى:من ْشطّى لْشطِّى |
51 |
اللوحة الثانية:الركن بتاعى مِتْـحضّر |
73 |
اللوحة التالتة:رِيـْحــِة بنى آدمْ |
93 |
اللوحة الرابعة:الموت السرّى المِـتـْدحِـلب |
103 |
اللوحة الخامسة:لله يـاسْيادى……!!!! |
111 |
اللوحة السادسة:قبر رخام |
127 |
اللوحة السابعـة:حمام الزاجل |
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى