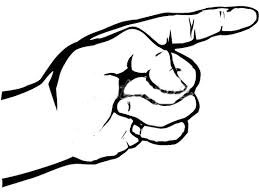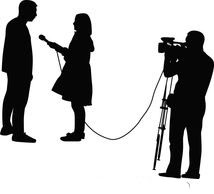فقه العلاقات البشرية (1)
(عبر ديوان “أغوار النفس”)
العلاج النفسى (مقدمة)
بين الشائع والإعلام والعلم والناس
أ.د. يحيى الرخاوى
إهـداء هذه الطبعة (2018)
إلى “هذه المجموعة الطيبة الرائعة من البشر “المصريين”
الذين ألهمونى بصدق ما “هُم”، وما هو نحن، فكان هذا العمل “ديوان أغوار النفس” بالعامية المصرية،
مع أنه لا يصوّرهم “هم” بصفة شخصية!!! جزاهم الله خيرا.
إهداء الطبعة الأولى لديوان “أغوار النفس”(1977)
إلى الأصدقاء الذين تركونى: أمانة، أو مسئولية، أو خوفاً.
وإلى هؤلاء الذين لم يعرفونى: دفاعاً، أو إهمالا، أو رفضا.
أهدى هذا العمل عرفانا بجميلهم،
وتأكيدا لمسئولية اختيارى ما هو “أنا”
مقدمة الطبعة الأولى لديوان: “أغوار النفس” (1977)
–1–
كتبتُ “هذا العمل” فى السنوات الأخيرة على فترات متقطعة، وقد حبسته فى محفوظاتى، مثلما أحبس كثيراً مما أكتب لأسباب مختلفة، من ذلك: الخوف من الخلط بين أدوارى فى رحلتى فى هذه الحياة، فأنا طبيب أمارس المهنة، وأنا أستاذ بالجامعة، وأنا صاحب قلم بعض الوقت.. إلخ، ولعل هذا بعض ما أشرت إليه فى بعض الحواشى فى كتابى “سر اللعبة”، (دراسة فى علم السيكوباثولوجى)، من أنى لا أجرؤ أن أعرض نفسى على الناس “حاليا” لأنى مازلت أرتدى قميص الطبيب وأتصدى لعلاجهم، وهم يحتاجون أن يرونى كذلك.
ومنها أن جرعة رؤيتى لنفسى (من خلال معاناتى التى أثارها فىّ أصدقائى المرضى) بدت لى أكبر من أن تقال، حتى أنه ساورنى الشك فى كل السير الذاتية التى لايمكن أن تعرض إلا الجزء “المتاح” من صاحبها، أو حتى الجزء المدرك له من ذاته على أحسن تقدير، أما إذا زادت الرؤية فلا سبيل فى مرحلة تطور الإنسان الحالية إلى عرضها “هكذا” – ولعل هذا ما حدا بالمتصوفة إلى الكف عن الحديث فى علوم المكاشفة – ولا يملك صاحب هذه الرؤية، إذن، إلا أن يحتال ليعرض نفسه بالأسلوب السائد بلغة الفن، وربما الفلسفة أو العلم، فالفن الروائى مثلا – فى جزء منه على الأقل – يساعد صاحبه أن يتحدث عن بعض ما يرى داخله على ألسنة شخوص أعماله، (وهذا هو بعض ما حاولته فى رواية طويلة هى: “المشى على الصراط” صدر منها الجزء الأول والثانى باسم “الواقعة” ثم “مدرسة العراة”([1]).
العمل الحالى يكاد يكون أيضا من هذا القبيل: تجربة شخصية عنيفة، جرت أكثر فى مجال شخصىّ، واختلطت بممارستى لمهنتى، وقد هزتنى كثيرا وخطيرا، وصلنى من خلالها ما لم أكن أحلم أن أراه أبدا، وعلمتنى فى مهنتى وعن نفسى ما صار هاديا لى، ومثبتا لخطواتى، وقد بلغ انفعالى بها، ومعايشتى لها، أننى حين أردت أن أسجلها خرجتْ “بالعامية المصرية” مرتدية ثوبا منظوما فضفاضا معا، فزاد حرجى وتضاعف ترددى.
ثم حدث فى فبراير الماضى حين كنت أشارك فى ندوة فى البرنامج الثانى فى الإذاعة المصرية عن كتاب الشهر مع الأستاذ الدكتورة سهير القلماوى ومؤلفة الكتاب الأستاذ الدكتورة نبيلة محمود وكان عنوانه “القصص الشعبى بين الرومانسية والواقعية”، أن طرحتُ تساؤلا على مؤلفة الكتاب عن: “ما هو البديل الحالى للقصص الشعبى بعد تناقص كمـِّهِ وتشويه كـَيـْفـِهِ”؟ وكدنا نتفق أن الإذاعة والتليفزيون ليسا بديلا حقيقيا – بوضعهما الراهن – فالقصص الشعبى والملاحم الشعبية كان لها – وما زال بدرجة ما – وظيفة سبر أغوار النفس، بالإشارة إلى الجزء المغمور منها بشكل فنى (قد يقال عنه خرافى أو أسطورى أحيانا). هذه وظيفة تكتمل بها رؤيتنا للجانب الآخر من وجودنا، وقد كان هذا الفن الشعبى يقوم بهذا الدور تلقائيا وبنجاح نسبى، تساءلت: هل ما زال الأمر كذلك، وهل من بديل؟ أين هو هذا الفن – الآن – الذى يمكن أن يصل إلى عمق ما كان يصل إليه ذلك الفن الشعبى التلقائى؟ أحسست – وقتها – أن حساسيتنا المعاصرة ضد الخرافة، نتيجة لغرور العقل الواعى ومنطقه القاصر والمتعب، قد ينتج عنها تشويه للوجود البشرى وإعاقة لنموه الحقيقى بشقيه الواعى واللاواعى، فالنمو الإنسانى لا يتم إلا إذا شمل جانـِـبـَىْ الوجود، وقـَرَّب بينهما سعيا إلى أن يندمجا فى كلٍّ واحد موضوعى متكامل، إن أى تقدم يــتصور أنه إذا ملك ناصية العلم التقليدى وحده، فقد ملك سبيل التقدم المعاصر هو تصور خاطئ، بل هو تصور خرافى مهما سـُمـِّىَ علما.
أحسست أن للشعر العامى بوجه خاص دوره فى هذه النقلة الحضارية – إذا أردنا أن نبحث عن بديل حقيقى، لينتشر بين الناس ويغطى هذه الفجوة التى تركها انحسار القصص الشعبى واختفاء “الحدوتة” من بيوتنا ومجالس سمرنا.
رجعت أقلب فى أوراقى “هذه” التى سبق أن كتبتها من سنوات، وتصورت أنها قد تؤدى دورا فى رؤية النفس الإنسانية، وأنها – رغم صعوبة بعض أجزائها – ليست أصعب من بعض الفن الشعبى الذى أدى وظيفته بشكل ما. رحت أراجع بعض ما كتبت من أكثر من عشر سنوات عن أرجوزة “واحد اتنين سرجى مرجى” ثم عن “الحيل النفسية فى الأمثال العامية”، ونشر فى مجلة الصحة النفسية، ثم فى كتابى “حياتنا والطب النفسى”([2]): فوجدت أن علاقتى بهذا الفن الشعبى – تفسيرا حينذاك – ليست جديدة، ثم تذكرت تفسيرا آخر قدمته للأغنية الشعبية “يا طالع الشجرة”، نشر فى ملحقٍ مَا لمجلة الهلال([3])، جعلت أسترجع كل ذلك وأنا أقرأ أوراقى هذه، فوجدت أن هذا الذى بين يدى يستحق أن ينشر بالمعنى الذى خطر لى أثناء هذا النقاش الإذاعى.
الحكى الشعبى يُحدث تأثيره حتى ولو لم يكن مفهومٌ ظاهره.
لم يثننى تخوفٌ قديم على اسمى العلمى، فقد تصادف كل هذا بـُـعـَـيـْـدَ حصولى على درجة الأستاذية فى فرع تخصصى، وكان هذا الحدث هو علامة أنى أستطيع أن أبدأ بداية كنت أنتظرها من زمن لأتواصل مع الناس مباشرة دون قيود الخوف على الوظيفة أو من الوظيفة. قررت أن أنتصر على ترددى وأتحمل ما يكون.
–2–
فى هذا العمل حاولت أن أقدم رؤيتى للوجه الآخر للعلاج النفسى، ومن خلال ذلك رحت أخترق حواجز النفس الإنسانية لأعرضها كما عرفتها داخلى وخارجى، بنبض الإنسان المصرى فى الشارع.
بداية: أؤكد أنها خبرة شخصية، وأنها إنما تصف “الوجه الآخر” للعلاج النفسى فحسب، أعنى سلبياته وبعض صعوباته ومضاعفاته، أما وظيفة العلاج النفسى الإيجابية وفوائده ودوره البناء، فهذا شأن آخر، كـُتبت فيه الكتب، وساهمت أنا كذلك فى تناوله.
إن دور الطب النفسى فـى المجتمع المعاصر لم يتحدد بصورة كافية، والصراع بين مدارسه ليس صراعا نظريا بحتا، بل هو اختلاف له دلالتة، اختلاف خليق بأن يجعل الإنسان العادى يقف مرتين قبل أن يأخذ معطياته المتواضعة مسلمات “بلا نقاش”.
–3–
العلاج النفسى يشمل عدة أنواع، من أهمها ما يسمى أحيانا العلاج بـ “الكلام” حتى أن بعض الباحثين أسمى هذه الطريقة “الشفاء عن طريق الكلام”، حيث يتصور – أو يصوّر- هؤلاء أن الكلام وخاصة التفريغ هو العامل العلاجى فى العملية العلاجية خاصة ما يسمى منها: ”التحليل النفسى” الذى روّج بعض المتحمسين له جدا لآليات الاسترسال، والتداعى، والتبرير، والمريض يستلقى على حشية لمدة معينة… إلخ.
إن الكلام هو ما يميز الإنسان – (أو هو من أهم ما يميز الإنسان)، لكن حين يحل ”الكلام” محل الحياة، أو حين يصبح العلاج بالكلام هو المبرر الخفى للتوقف عن التطور الإنسانى والنمو النفسى، فهذا يحتاج لموقف نقدى يقِظ.
مسوّدة مقدمة الطبعة الحالية
(كتبت سنة 2009)
بعد نحو ثلاثين عاما (1979 – 2009) اقتنعت أن تجربة شرح متن ديوانى الأول بالفصحى “سر اللعبة” قد نجحت إذْ خرجت منها منظومة علمية متكاملة، جارى تحديثها، هى كتابى المرجع “دراسة فى علم السيكوباثولوجى”. وحين قررت إعادة طبع ديوانى “أغوار النفس” بالعامية المصرية كتبت فى مقدمته “إنها خطوة لعلها تحفزنى لكتابة ما ينبغى أن أكتبه”.
لا أتردد أن أكرر أننى أسارع فى نشر هذه الأعمال فى هذه الفترة من حياتى باندفاع لاهث خوفا من أن يحل الأجل، وألقى ربى وأنا كاتم شهادتى عن أصحابها، أنا أملك – ساعتها– دفاعا قويا وهو أنه هو الذى اختارنى قبل أن أتم مهمتى، لكن ماذا أقول إذا عرج الحساب إلى مسؤوليتى عن ترتيب أولوياتى؟ أعتقد أننى سوف أُسأل عن الوقت الذى أضعتـُه فى كتابة الشعر وأنا لست بشاعر، وفى الكتابة للصحف وأنا لست سياسيا فاعلا، أو كاتب مقال أساسا، أفعل هذا أو ذاك على حساب الكتابة فيما أعتقد أنه خبرة خاصة لم تتح لشاعر أوسياسى، أو لكاتب مقال أو حتى لطبيب نفسى تقليدى.
عذرى كان، ومازال، هو أن كل ما كتبت، شعرا أو مقالا أو قصا، كان يدور حول محور واحد، هو البحث فى ماهية النفس البشرية “ربى كما خلقتنى”([4])، وهو هو الذى يستدرجنى إلى هذه المخاطرة وهى المخاطرة التى تشرح الشعر، فتمسخه، لحساب أساس جوهرى من أسس ممارسة التعرف على النفس بحثا وعلاجا، إنها رؤية غامرة، حركت ما يكمـُـنُ فىّ، فتناولتُ الأداة التى تصادف أنها وقعت فى يدي، أُبـْلِغُ من خلالها ما تيسر لى من هذه الرؤية.
مقدمة جامعة (2018)
صدر هذا العمل بأجزائه المتالية مسلسلا فى النشرة اليومية “الإنسان والتطور” التى كنت – ومازلت – أصدرها فى موقعى www.rakhawy.net تحت عنوان “فقه العلاقات البشرية”، وذلك فى المدة من 9/6/2009 إلى 15/9/2010 وكان بمثابة “شرح على المتن” أسوة بما فعلت مع ديوانى الأول بالفـُصـْحى “سر اللعبة” لكننى عدلت عن أن يكون شرحا واكتفيت بأن يكون انطلاقا من الأصل الشعرى أو تداعيات عليه.
حين قررت أن أصدر هذه الطبعة الورقية قررت أن أقسم العمل إلى عدّة كتب حتى أخفف الجرعة على القارئ من ناحية، وربما أستطيع أن أوضح بعض ما غـُمض بإيقاع أهدأ من ناحية أخرى.
– الكتاب الأول (الحالى): “العلاج النفسى (مقدمة): بين الشائع والإعلام والعلم والناس” يحتوى شرح مقدمة الديوان المذكور، وتعرية ما وصل إليه تسطيح أو سوء فهم أو سوء تطبيق ما هو تحت مسمى “العلاج النفسى” وهى مقدمة قاسية بقدر ما وصلنى عما آلت إليه هذه الممارسة سواء ممن تصدى لها اجتهادا عشوائيا أو ممن أساء فهمها أو تطبيقها.
فى آخر لحظة اكتشفتُ أن لى قصيدة بالفصحى فى نقد العلاج عامة، والعلاج النفسى خاصة أنهيت بها ملحق ديوانى “سـر اللعبة”، ثم عـدلت عن إعـادة نشرهـا – فى الطبعة الأخيرة – مع نفس الديوان حيث وجدت أن مكانها الأنسب هو فى هذا الجزء الأول المخصص لنقد العلاج عامة ، وهى بعنوان “حب للبيع“، وبرغم أنها بالفصحى رأيت أن أضيفها إلى كتاب النقد هذا كما ألحق بها شرحها كما ظهر فى كتابى “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” وقد حضرتنى بعض التعديلات والتحديث على الفقرة الأخيرة من المتن وبالتالى على الشرح وذلك دون سائر القصيدة.
أما الكتاب الثانى فهو: “هل العلاج النفسى مـَكـْلـَمـَة؟”، وقد تناولت فيه نقد ما شاع عن العلاج النفسى وأنه العلاج بالكلام متجاوزا العلاقات الأعمق والأوثق بين مستويات الوعى، وخاصة فى العلاج الجمعى وعلاج الوسط، وقد ركزت فى هذا الكتاب على الكلام على الجانب السلبى للاقتصار على الكلام وسيلة أولى أو وحيدة فى العلاج حتى يكاد يصبح تسكينا أقرب إلى الموت النفسى، مما دفعنى إلى أن اسمـّى القصائد “جنازات” ثم نجحتُ الآن مضطرا (رفقا بمشاعر القارئ) أن أتراجع عن ذلك واكتفى باسم “لوحات”، ولم يتغير النص والتداعيات تاركا الاسم والصفة لما يصل للقارىء مشاركاً!!.
الكتاب الثالث: هو “قراءة فى عيون الناس” وهى قراءة استلهمتها من الخمس عشرة زوجا من العيون البشرية الأمينة ليس بصفة شخصية مباشرة، وهى تكشف جرعة ِأعمق من النفسمراضية التركيبية Structural Psychopathology بمعنى أنها تقرأ التركيبية البشرية التى لها علاقة بلغة المرض، وكيف أن النظر فى ما يقوله المرض أساسا، (وليس فقط المريض)، والتعلم معه لغة أكثر أمانا وأقدر حفزا يحقق له – ولنا – ما أراد أن يقوله وعجز عن قوله إلا بلغة المرض، هذه النفسمراضية التركيبية فى هذا الكتاب لا تكشف فقط عن ما آل إليه تنظيم (سوء تنظيم) المخ (الأمخاخ) ولكنها أيضا تعرّى أبعاد ما آلت إليه تباديل وتوافيق وصعوبات وصفقات وآليات “العلاقات البشرية” فى الصحة والمرض معا، وهو الذى اسميته مستلهما تراثنا “فقه العلاقات البشرية” وهو ما يمكن أن يقابل علم النفسمراضية (السيكوباثولوجى) فى الصحة والمرض.
وأخيرا: الكتاب الرابع، بعنوان: “تجليات “يحيى الرخاوى” بين السيرة والمسار”، وقد تضمن اللوحة السادسة عشر من ديوان “أغوار النفس” بعد أن أجلتها من الكتاب الثالث لأبدأ بها هذا الكتاب الأخير فهى قراءة فى عيونى شخصيا، علما بأننى أحترم فرضا يقول إن كل هذه اللوحات فى كل هذه الكتب ليست إلا نتاج الجدل الدائر على مستوى الوعى البينشخصى والجمعى مع مرضاى وتلاميذى وأصدقائى، فتكون أقرب إلى المعايشة الخبراتية منها إلى وصف حالات خارجى، الأمر الذى يمكن أن يسرى على الأجزاء الأربعة، فجعلت عنوان الجزء الرابع: “تجليات يحيى الرخاوى بين السيرة والمسار”.
إهـداء([5]) ( ديوان “سر اللعبة”)
ياتَرَى الِكْلَمَهْ حا تقدر تـفـْـشـِى سرىَّ؟
يا ترى مين فيكـُو يِسْتَحْمل مَرَارْتىِ؟
يا ترى مين فيكـُو حاَيْسَاعِى شَقَاىَ؟
أَهدِى مينْ؟ أَهدى إِيهْ؟
هوَّا عُـمـْر المُرّ يِتْهادَى يا عالَم؟
قلت انطـّ فْ وسط خلق الله جميعاً..
همُّا دول حِمْل الكَلاَمْ المُرّ والدَّم اللِّى يِغْلي.
هـُـمَّـا دول حِمْل الحقيقةْْ.
قلت أهْدِيهاَ لْبلدنا،
للِّى غنّى .. والَّلى صَحَّاهْ الغُنَى.
يَا مَاقُلْتُوا يَا أَهْل مصر يا فنـَّانين،
يا غلابَهْ، يا حضارَهْ، يا تاريخ.
يا ما قُلْتُوا، ويَا مَا عِدْتُوا،…صَحِّيتُونى:
]واللى بَنَتْ مَصـْـر كاتْْْ فى الأصل: غِنَّيَوهْ[.
الهديّه للى غنّى، قال: “بَهِيّهْ لىِ يَاسينْ”،
واللِّى صَحَّى لَيْلَى والمجنوُنْْ يِـغَـنُّوا لمْصَرْ تانى.
واللِّى علـِّـمْـنى حلاوة الـمُرّ .. من جُوّا النَقَايَهْ،
واللِّى.. واللِّى.. واللِّى.. واللِّى.. والجَمِيعْ.
يا ترى تقبل يا شَاِعر مَصْر يا صاحب الرِّبابَةْ؟
يا تَـرَى يا اهْل الحَضَارَهْ والكَلاَمْ الحِلْو واللِّحْنِ الأدَانْ.
تقَبلُوا منِّى الهدِيَّهْ؟
أصِلى غَاوِى،
بس يا خسارَهْ مانِيشْ لا بِسْ طاقِيَّه،
قلت انقَّـْـط بالَكَلامْ.
الفصل الأول
المتن الشعرى
(مجتمـِعاً: ابتداءً)
إعادة ترتيب
اعتدت أن أنهى ما عنَّ لى من تداعيات وشروح بالنص الشعرى كاملا، إلا اننى عدلت هنا عن ذلك وفضـَّـلت أن أبدأ بإثبات المتن، لعلى أثير فى القارئ (غير المختصّ خاصة) حب الاستطلاع لمتابعة التداعيات والتوضيح – إن أراد – ثم لعل ذلك يخفف من وصاية الشرح الذى يكاد يشوِّهـُه ويفقده شاعريته، لهذا أفردت للمتن مجتمـِعـًا فصلا مستقلا هو الفصل الأول، لإعطائه أولويته وأهميته مستقلا بعيدا عن التداعيات والشرح.
******
أولاً: المتن
-1-
كل القلم ما اتقصف يطلعْ لُـه سن جديدْ،
”وايش تعمل الكـلْمـَةْ يَابَـا، والقدَرْ مواعيد”؟
خلق القلم مِالعَدَمْ أو راقْ، وِ.. مَــلاَهَا،
وانْ كان عاجبْنٍى وَجَبْ،
ولاّ أتنّـى بعيدْ.
-2-
بصرَاحَـةْ انا خفْتْ.
خـُفتْ منهمْ، خفتْ ”منى”، …. خفت منّــا.
خفتِ مالطوبِ، والطماطم، والملاَمْْ والتريقهْ،
خفت مالبيض الممشِّــشْْ، والنكتْ، والبحلقهْ.
-3-
قلت انـَا مِشْ قدّ قـَلـَـمِى.
قلت انا يكفينىِ أَلـَمـِى.
قلت أنا ما لى، أنا اسـْترزَقْ واعيشْ،
والهربْْ فى الأسْـَتـذَةْ زيّـُــهْ مافــيشْْ،
والمراكزْ، والجوايزْ، والـَّذى ما بـْيـنِـْتـهيشْ
قلت اخبِّى نفسى جُـوَّا كامْ كتابْ.
قلت أشـْغـِـلْ روحى بالقولْ والحسابْْْ.
والمقابلاتْ، والمجالسْ
والجماعةْ مخلَّصـِينـْلـَكْ كل حاجـَةْْ، أَيْـوَهْ خـَالـِصْْ.
بس بـَرْضـَك وانت “جالسْ”.
-4-
قلت أرسمْ نفسـِى واتْـدَكْـتَـرْ وارُصّ.
قلت أتـفـرَّجْ وِ أَتـْفلسـِـفْ وابــُـصّ.
بس يا عالمْْ دا دمْ ولحم حىْ.
أستخبَّى مــنــُّـه فينْ؟
-5-
المريض ورّانى نفسي
المريض خلاّنى أتـْلـَمـْلمْ وافَـكـَّـرْ.
المريض عـَدِّلـِّى مـُخـِّى،
نضَّفُهْ من كل واغشْ، كانوا فارضينُهْ عليهْ.
من ملاعيب اللى بايعْ ذمته بـْمعَـَرفـِشى إيـِهْ.
من شوية آلاتـِـيـَّة، والعَـشـَا الـْ “أوبـنْ بـُوِفـِيهْ”.
-6-
ييجى صاحْبَك “مَـلْط” إلا مالْـحـقيقهْ،ّ
ييجى يزْقُـلـْها فى وشِّى وتـَنُّـه ماشي.
الأصول إنى أعالجـه، واكفى ماجور عالخــبـر”.
”بكره يعقل! بالدواءِ الـمـُعتبرْ”.
بس والله يا عالَــمْ لـَـمْ قِــدِرْتْ.
لَـمْ قِدِرت اعمَى بْـنَوَاضْرى،
حتى لو كان العمى دا”رَأْسـمـَاَلكْ”،
أو كما سـَمـُّـوهْ حديثا “مَـشـِّـى حـَاَلكْ”،
يعنى “طـَنّشْ، إنتَ مالـَك”.ْ
-7-
قلت: إعْقَل يا ابْن نـَفـْسِي.
قلت: حاسِبْ ما الـْفـَضـَايحْ والجُرَسْ.
قلت إدّيها عمَى حيسِى، وزوّد فى الحَرَسْ.
نطّّ غَـصـْبـِن عنـِّى، ورّانى إنّـى هوّه.
بس جـــُوّهْ ! ! !
قلت أَخطف نظره عالماشى واغَمَّضْ مِن جديد،
هّيه نظره -واللىّ خَلَقَكْ- لم تَنِيـتْها
-8-
بصيت لقيت الزفــَّـة بتلف الضريح لمْ بطّلت،
وتقول مـَدَدْ!!…،
بـَسّّ الـَعـِـماَمةْ اتـْغـَيـَّرتْ:
والحاجات، هى الحاجات الـمِشْ حاجَاتْ.
-9-
الطبيب أصبح مهندسْ للعـُقـَولِ الـَبايْـظَهْ
(يعنِى .. !!)،
واللى برضه اتْصلـَّـحـِتْ.
(الطبيب دا هوّ انا، مش حد غيرى)
اللَّهْْْ عليهْ، والسِّتْ بـِتـْمسِّى عليهْ!
والشاشةْ، والواقعْ، خـُلاصـْةِ القـَوْلِِ، مخْـتَـصَرِ الـَكـَلامْْ:
آخـِرْ تمامْْ، فـِى حَـلّ مُعـضـِلـَةِ الأنَــــامْ:
”لّما كنا نـَحـْنُ فى عصر الـَقـَلقْْ،
”نستعيذُُ بربّنا مما خلقْ”،
يبقى لازْمَـنْ كلنا نعمل حسابنا،
وِنـَـدَعِ القلقْ،
يعنى نخمد من سـُكات وانْ كان عاجبنا،
عـَـلـَـشان نعيش
ماهو كله ماشى فى الـْمــَـافـِشْ
ثم إن الحزن برضه ما لوش لزومْ،..طـَـنـــِّـشْ: تعومْ،
ثم إوعـَى انــَّك تنام من غير لحاف
أحسن تخاف
حيث النصيحة “لا تـَخـَــفْ”
فيها السعاده والبلاده، والحياه سكـَّر زياده
ثـُمَّ إنّّ اُلأُم لازِمْْ إِنـّها تراعى عـِيـَالـْهـَا
بعد ما انــْـفــُـك العقد إللى ف خيالها
يعنى تعمل زى ما بـِـنـْـقـُـولــِّها
مش كما طبيعتها أو من قلبها
فلقد ثبتْْ: إن الـعُـَقدْْ “وِحـْشـَةْ قوى”!!.
هـَذَا الذى قد أَظـْهـُرُه الـْبـَحـِثِ الـفُلاَنـِى،
”لمّا عدّ التانى ساب الأوَّلانى”.
ثم أوْصَى: “أنْْ يكون الكــلْْ عالْ.
إذْ لابـُدْ انّ الـُكوَيـِّسْ:
هـُوَّا أحـْسـَنْ مـِالَّذِى مـُا هـُوشْ كُوَيـِّسْ.
إمـَّاِل ايـِهْ؟”
[هذا برنامج “عفاف هانم”،
بـتسأل حضرة الدكتور فلان ]
-10-
وساعات أشوفنى مـِطـيّباتى مُـعْـتَبـرْْ،
آه يا حلاوتـُهْ وهـُوَّا بِيـْلبِّـسْ خـُدُوُدهْْ الإبْـتسَامةْ،
أو لمّا بِيْـشَـَخـْبـَطْْ ويكتبْلَكْ حـُبـُوبْ “منعْْ السآمـة”،
أو لما يِوْصف حقنة المُـحـَاياة تقوم تمسح مشاعرك
“بالسلامة”.
-11-
وساعات أشوفنِى كمَا “الأغا”
بيضحّـك المَـلـِكهْ، ويُستعمَـلْ من الظاهرْْ، وبَــسْ.
-12-
وساعات جنابهْ يلف أحكامو فْ زواق،
مش أى “حاجةْ”.
يِـفـْـتى كما قاضى الزمان وكأنه جاب المستخبى:
إنّ لازم تبقى بارد : ذوق وخفــَّه:
أحسن ما تبقى صريح يقولوا جتـْله هفــّة،
”كُـنْ منافقْ”، يعنى “جامِلْ”، “مَشِّى حالَك”.
تبقى ماشى فى السليم، مهما جرالكْ.
والعواطف تـِتـْشـَحـَنْ جوّا العيونْْ زى البضاعـَهْ.
(كل ساعةْ نُصّ ساعةْ).
”يعنى إيه ؟!؟”
“.. مشْ مُـهِـمْ”.
-13-
والجنازه زفّهْ تـُرقـُصْ عالسـَّرَايـِرْ –
فى البيوت اللى حوالِـيـهـَـا الستاير.
واللى خايفْ من خيالُهْ،
اللى خايفْ مـاِلـْعـَسـَاكـِرْ.. والرقيب،
واللى بيوزَّعْ تذاكر يا نصيبْْ،
واللى بيفَرَّق دوا “ضـِدَّ الذنوبْ”،
واللى ماشـى يـشـقّ فى بطانةِ الجيوبْ.
والعرايضْ، والجرايدْ،
واللىَّ بيرصُّوا الكلامْ؛
”قفْ مـَكـَاَنكْ، أو تــأخـَّرْْ لـْلأِمـَامْ”!
بخَّرُوا سـِيـْدنـَا الإِمـَامْ”
”سرْ، بضـَهـْرَكْ…”
والـَعـَرقْ؟: إلكُـوزْ بـِكـَامْ؟..”
-14-
أَمَّا صورهْْ مـُرْعـِبـَهْ يا خـَلـْق هـُوهْ.. إلحـَقـُونـِى.
قـُلـْت غـَلـْطـَانْ والـنـَّبـِى يا نـَاسْ سـِيـُبونـِى.
قلت اغـَمَّض تـَانـِى حـَبـَّهْ صـْغـَيـَّرِينْ،.. لمْ قِدِرت.
طبْْ حا فتّح ليه يا عـَالـَمْ؟ هـِيَّا فُرْجـَةْ؟!
بصّ لىِ “صاحـْبـَك” ولعـِّبْـلىِ حواجـْبـُهْ،
قال: وقِعْت.
والقلم كـَمّل كإِنى لمْْ وِقفت:
-15 –
بقى دى حياتنا يا ناسْ، وِآخْرِةْ صبرنا؟
الحياهْْْ؟ نـُقـْعد نـِـحَـكِّـى لبعضـِنـَا؟
الحياهْْ؟ نُقْعد نـِحـِسّ، نـْـبـُصْ، يـِتـْهـَيـَّأ لـِنـَا؟
طب واحنا فين ”دلوقتى” حالاً “أو هنا”؟
دى المركب الماشـْيـَهْ بِلاَ دَفّهْ ولا مـِقـْلاعْ حَاتُشْرُدْ مِنـّنَا،
واوْعَى الشـُّقـُوقُ تـِوْسـَعْ يا نايم فى الـَعـَسلْ،
لا المَّيهْ تِعْــلَى، تزيدْْ، تزيدْ،
.. مّيةْ عطَنْ، تـِكْسِى الجلودْ بالدَّهْنَنَه،
وتفوح ريحتـْها تِعْمِى كلِّ اللـى يحاولْْ يـِتلـِفـِتْ ناحيةْ: ..”لمـِاَذاَ”،
أو “لمعنى” يكون ما جـَاشِى فى”الكـِتـَابْ”،
أو لـِلـِّى “جـُوَّه”،…أو نـَواحـِى “ربنا”!
(الرحمهْ يارب العباد: إغفرْ لنِا).
-16-
واللعب دايرْْ ليلْْ نهارْ لمْ يـِنـْقطعْ،
والسيركْ صـَاحْــبُه واقفْلِى بْيِلفّ العـَصـَا
ويقول بعزّ مـَا فـِيهْْ: أهو دا اللى ممكن، واللِّى عاجبهْ!
-17-
أنا مش عاجبْـنى هِـهْ، ولازْمَـنْ يِتْحَكَى،
كل اللى جارى.. لاجْل ما الناس تنتبه قبل الطوفان،
للناسْ..، لكل الناسْ حا قول:
رد الجميل للطير بـِيـْنزِفْْ مِِ الأَلـَمْ قـُدَّام عـُيـُونى.
قالوا “مريض” لكنه أستاذ الأساتذة كلهم.
علّمنى أشـُوفْ، علّمنى أَصـْحـَى.
علـّمنى ضـَرب النار، بكلمةْْ صدق طالعهْْ مولـَّعـَةْ.
تحرق عبيد الضَّلمة والتفويت وشـُغـْل الهـَمـْبـَكـَةْ،
وتْنوَّر السكة لإخوانِ الشـَّقـَا،
للى يـقايسْ، للى يـِحـسْ، يـِبـُصْ، يـِتـْجـَرَّأْ، يـُشـُوفْ، : للناسْ .. لكلِّ الناسْ حاقـُولْْ؛
-18-
دا حق كلِّ النَّاسْْ يا نَاسْ.
حق اللِّى ورَّانى حقيقتى،
حتى لوكاتْ مش حقيقتى،
[الحقيقة انك تـِدَوَّرْ عالحقيقة.]
دا دين ولازم يندفع،
دا دين عليَّا للى قالهالى وما اقدرشِى يـكمـِّل،
لكنه علـِّمنى، ووصانى أوفـِّى الدين لأصحابه الغلابهْ،
وازاى أنا يا خلق هوه حاحْكـِى وانا غرقان لشوشتي؟
أهو دالـِّـلى كان،
حتى ولو ما كاشفشـى منى إلا خيبتى.
ما قدرتش اسكت،
دا السكات يبقى خيانة للى كان.
هو انا ناقص رجل، ولا ماليش لسان ؟
-19-
أنا رايح اقول كلِّ اللى عارفُهْ حتى لو جانِى الفِقِى مــدِّدْنِى
فى الفَلَكَهْ وقطَّعْ جِتــِّــتِى:
إنْ كنت عايْز تلِعَبِ “العَشَرة” وتْبقَى الطَّيبَةْ؛
نكشف وَرَقنَا قبلِِ مَا الوَادْ يِتْحَرَقْ،
واللَّى يِبَصَّر “بالبِنَيَّة” يِبْقَى ذَنبِ التَّانىِ عَلَى جَنْبُهْ،
مَالوشْ يزْعلْ بَقَى، مَا كَانْ يشْوفْ!
ما الِّلعْبِ عالمْكشْوُفْ…، أَهُهْ
-20-
لأَّهْ، مانيِش ساكتْ ودِيِنى وْمذهبى،
حتَّى ولو كان اللِّى “مَاتْ” هواّ اللِّى “عاش”، فى عـُرْفـُكم
لأَّهْ، مانيِشْ مَيِّت حَاعيش:
وســــــَّـــع بقى..!!
-21-
القلم صحصح وِنَطّ الحْرف منُّه لْوَحدُه بِيخزّق عِينَىَّ،
وابْتْدا قَلمِى يِجَرّحنى أنا.
قالِّى بالذمَّةْْ:
لو كنت صحيح بنى آدمْْ،.. بـِـتـْحِسْ،
والناس قدّامك فى ألـَمُهمْ، وفْ فَرَحْتِهُمْ،
وفْ كسْرتهم، وفْ ميلة البخْتٌ،
مشْ ترسـِمـْهُم للناسْ؟
الناس التانيهْْ؟
إٍللى مِشْ قادْرَهْ تقولْ: “آه”، عَنْدِ الدَّكْتورْ.
أصل “الآه” المودَهْ غاليهْ،
لازمْ بالحَجْزْ،
لازمْ بالدورْ.
مش يمكن ناسْنا الَغْلبَانَهْ إِللى لِسَّه “ما صَابْـهَاشِ” الدورْ.
ينتبهوا قبل الدُّحْدِيرَةْ – قبل ما يغرقُوا فى الطينْ.
ولاّ السَّبُّوبه حَاتتعْطَّلْ لَو ذِعْت السِّر؟
ولاّ انْتَ جَبَان؟
-22-
بصراحة انا خـُفـْت.
خفت من القلم الطايح فى الكلّ كـِلـِيلـَهْ
حيقولُوا إٍيه الزُّمَلاَ المِسْتَنِّيَهْ الغلْطَهْ؟
حيقولوا إيه العُلَماَ المُكْـــنْ
(بِسْكون عَالْكَافْ .. إِوعَكْ تغْلَطْ)
على عالِم، أو مُتَعَالم: بيقولْ كَماَ راجِل الشَّارع
-23-
القلم اتهز فْ إيدى،
طــلــَّـعْ لى لسانُهْ،
ما يقولوا!!:
حد يقدر يحرم الطير من غُـنَـاه؟!
من وليف العش، من حضن الحياةْْ؟!
تطلع الكلمهْ كما ربِّى خلقْها،
تطلع الكلمةْْ بْعَـبلْها،
تِبْقَى هىَّ الِكْلمة أَصْل الكُونْ تِصَحِّى المِيِّتِيْن.
والخايفْ يبقى يوسَّعْْ،
أَحْسن يطَّرْطـَش،
أو تيجى فْ عينه شرارة،
أو لا سـَمـَحَ الـلّه
يِكْتِشِفِ انُّه بِيْحِسْ.
الفصل الثانى
صعوبة الكتابة فى “العلاج النفسى” ومضاعفاتها
انطلاقا من المتن([6])
بالله عليكم هل يحتاج هذا المتن كما ورد فى الفصل الأول: إلى شرح؟ هل يصِحّ أن يضاف إليه ما يشوِّهه؟ علما بأنه صدر مستقلا فى الديوان طبعا، وعلى من يكتفى به أن يكتفى، على شرط أن يقرأه بموسيقاه التى تنبعث منه، أما أولئك الذين لم يعتادوا الاستمتاع بجمال شعر العامية الفصحى، فسوف أضيف ما تيسر فى هذا الكتاب المقدمة بما يسهل المتابعة لسلسلة الكتب التى ذُكِرتْ فى المقدمة الشاملة.
المتن واحدة واحدة!!:
كلّ القلـْم ما اْتقصـَفْ يطلعْ له سنّ جديدْ
وايش تعمل الكلمة يابَا والقدرْ مواعيدْ
خلق القلم ما العدم أوراق، وِمَــــلاها
وان كانْ عاجِبْـنى وَجَبْ، ولاّ أتنّـى بعيدْ
الكتابة فى العلاج النفسى تكاد تكون مستحيلة، بل إنها تكاد تكون ضد العلاج النفسي، تماما مثل الكتابة فى الجدل وعن الجدل التى هى بالضرورة ضد الجدل.
العلاج النفسى عملية حيوية مَعيشة لايمكن للكلمات أن تستوعبها، ومن أغلط الغلط أن يتعلم أحدهم العلاج النفسى من قراءة الكتب عنه، مهما بلغت دقة هذه الكتب وإحاطتها. إن قراءة ألف كتاب فى العلاج النفسى لا تساوى الجلوس مسئولا أمام مريض أمى يحضر مرة أسبوعيا لمدة ساعة خلال سنة أو أقل أو أكثر وهو يتحسن (أو يتذبذب فى طريقه إلى التحسن، أو يتدهور رغم الجهد والصبر).
إن “قصف القلم” المشار إليه هنا هو إعلان عن بعض حلقات جهادى فى محاولة “الكتابة فى العلاج النفسي” أو “عن العلاج النفسى”، ولعل هذا هو بعض ما أخر صدور هذا العمل.
تبينت لى صعوبة المسألة من قديم عندما كان يطلب منى زملائى الأساتذة فى كلية الطب، قصر العينى، أن أضع سؤالا تحريريا فى العلاج النفسى (على أساس أنهم يعتبرون أنه من أهم ما يتصورون أنه تخصصى الدقيق) كنت أشكر، وأبتسم، وأعتذر، وأرفض ما أمكن الرفض. تصور معى – مثلا – سؤالا يقول: “قل ما تعرفه عن العلاج النفسى بالإيحاء”، فيأتى الجواب متضمِّنا أنواع الأمراض التى تستجيب للإيحاء، والشخصيات الأكثر قابلية له، وطرقه المباشرة وغير المباشرة، ونتائجه المحدودة، يجيب عن ذلك طالب شاطر حافظ إجابة لا تخر الماء (ما تخرش المية)، فيضطر الممتحـِن المصحـِّح أن يعطيه عشرة على عشرة!! (وربما نجمة)، قارن ذلك بمباشرة أسبوعيه للإشراف على طبيب صغير متدرب، يجرى تتبع خطوات نمو خبرته، ونموه، وهو يحكى مع زملاء له فى جلسات الإشراف المنتظمة، يحكى ما يرى أنه يحتاج إلى إشراف، أو حوار، من خبير أكبر، أو زملاء أقدم، يحكى أيضا عن ماذا حدث له أثناء جلوسه مع المريض قبل ومع وبعد الجلسة، وهو يحتار، وهو يحاول، ثم ماذا حدث للمريض أثناء العلاج ونتيجة له، خطوة خطوة، ومأزقا فاجتيازا، أو مأزقا فوقفة، ثم يسأل ويتساءل ويناقش الإجابة عن كل ذلك، هذا هو بعض ما عرضناه مرارا وتكرارا فى باب “التدريب عن بعد”، فى نشرات “الإنسان والتطور” اليومية.([7]) وهو هو ما يجرى فى واقع الحال فى قسم الطب النفسى كلية الطب قصر العينى منذ أكثر من أربعين سنة مرة أسبوعيا وفى مستشفى دار المقطم للصحة النفسية ضمن علاج الوسط طول الوقت والمفروض فى أى مركز يمارس ما يسمى العلاج النفسى([8]).
إذن: فماذا يفيد أن أكتب عن أصول أو قواعد أو معنى أو هدف ما يسمى “العلاج النفسى”؟ وكيف أضمن أن يسير ما يصل من ذلك جنبا إلى جنب مع التدريب والإشراف طول الوقت؟
ومع ذلك فهذه محاولة اجتهاد أرجو منها الخير الممكن.
هذه هى بعض معالم مأزقى المتجدد: كلما هممت بأن اكتب فى العلاج النفسى ينقصف قلمى فعلا، فأتوقف، وأتردد، وأتراجع، لكننى لم أكف أبدا عن الإعداد لهذا الاحتمال (الكتابة عن العلاج النفسى)، وأنا أكاد أكون على يقين معظم الوقت من أننى أعـِدُ بما قد “لن يكون أبدا”.
ومن بين ما جمعتُ تمهيدا لهذا الاحتمال ما يلى:
1- تسجيل صوتي، ثم تفريغ التسجيل كتابة، لما تيسر من مناقشات مع الأطباء الأصغر الذين يمارسون العلاج النفسى تحت إشرافى، وهو ما ظهر بعضه فى النشرة اليومية فى باب التدريب عن بعد.
2- تسجيل المناقشات بعد كل جلسة ”علاج نفسى جمعى” أقوم فيها بمسئولية العلاج فى مستشفى قصر العينى، جنبا إلى جنب مع مهمة تدريب الأصغر. وقد نشرت بعض معالم نظام التدريب فى بعض النشرات بموقعى، وتشمل هذه المناقشات أسئلة وتعليقات المشاركين داخل المجموعة العلاجية، بالإضافة إلى أسئلة وتعليقات المشاهدين الحاضرين([9]) فى الحلقة الخارجية المحيطة بأعضاء جلسة العلاج الجمعى. وكان الواجب الذى يقوم به المتدرب فى قصر العينى هو أن يقوم بتفريغ تسجيلات هذه المناقشات البعدية – بعد كل جلسة – أولا بأول، وظل هذا يحدث، ولمدة سنوات، ثم توقف التسجيل بعد ذلك بعد أن تراكم دون تحرير أولا بأول، ثم حين سألت عنه مؤخرا، اكتشفت أنه فـُـقـِـدَ أغلبه، ولم أجزع كما ينبغى، فقد تأكدت أن ما تبقى منه عندى الآن يكفى وزيادة (يكفى ماذا؟ يكفى من؟) وعموما فإن ما نشر مؤخرا فى “باب التدريب عن بعد”([10]) فى نشرات “الإنسان والتطور” اليومية به عينات مهمة، وإن كانت محدودة، لبعض ما تم فى السنوات الأخيرة فى مستشفى دار المقطم أساسا، وأيضا فى قسم الطب النفسى قصر العينى.
3- تسجيل مواز للمناقشات بعد الجلسات الجماعية فى مستشفى دار المقطم للصحة النفسية ثم تفريغ التسجيل مباشرة، استمر ذلك لمدة تزيد عن عشر سنوات وقد اختفى أغلبه أيضا، لكننى أعتقد أن ما تبقى يكفى، وزيادة (يكفى ماذا؟ يكفى من؟)
4- تم تسجيل أغلب جلسات العلاج الجمعى فى قصر العينى، وذلك لعدد من المجموعات العلاجية المتلاحقة، بالصوت والصورة وهى جلسات العلاج والتدريب التى تجرى فى قصر العينى أسبوعيا منذ سنة 1971 (وحتى الآن 2017) (بعد إذن صريح من كل المشاركين مرضى وأطباء) بالإضافة إلى تسجيل المناقشات اللاحقة التى أشرنا إليها حالا([11]).
5- من خلال الإشراف على رسائل للماجستير (اثنتان) والدكتوراه (أربعة)، تم تسجيل صوتى لأغلب جلسات العلاج الجمعى موضوع الرسالة، لتكون مادة للاستشهاد ودراسة المحتوي. (على سبيل المثال لا الحصر: رسالتى أ.د. عماد حمدى غز فى الماجستير والدكتوراه – رئيس قسم الطب النفسى بطب القاهرة سابقا – ورسالة الدكتوراه أ.د. عزة البكرى رئيس القسم حاليا، ورسالة أ. د. نهى صبرى، ورسالة الدكتوراه فى الفلسفة – فرع علم نفس – المرحومة د. نجاة النحراوى).
هذا، وتبلغ كل هذه التسجيلات مئات الأشرطة حتى الآن، لم يفرغ أغلب ما تبقى منها بنظام يسمح باستعمالها فى مثل هذا الكتاب، أو أى كتاب، وقد وجدت أن الاعتماد عليها الآن وأنا أكتب هذا العمل، أو مجرد تصوُّر إمكان نشرها بعد رحيلى هو أمر يتراوح بين الاستحالة، وترجيح الاختزال والتسطيح بكل المخاطر المترتبة على ذلك، خصوصا إذا قام بالتفريغ والتبويب من لم يعاشر التجربة شخصيا.
وهكذا: تزاحمتْ وتكاثفتْ وتداخلتْ وتراكمتْ كل هذه المادة، وبدلا من أن تكون حافزا للكتابة أصبحت عائقا لمجرد البداية فى كتابة خبرتنا فى موضوع العلاج النفسى.
أمام هذا الكم الهائل من المادة الخام قُـصِف قلمى المرة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى.. فعلا، فأعاود المحاولة وأنا أشعر أنه لا مفر من مواجهة الالتزام بالكتابة مهما كانت الصعوبات أو المضاعفات، وهكذا ظل الواجب ضاغطا، والكتابة لحوح ملوِّحة طول الوقت، مرة أخرى:
“كل القلم ما اتقصف يطلع له سن جديد”
تأكد لى من خلال هذا التحدى المتجدد: إلحاح “الكتابة” فى العلاج النفسى، حتى وضعت لنفسى (وربما لغيرى إن شاء) بعض الشروط والتحفظات التى أنصح بالالتزام بها لمن شاء أن يخوض هذه المخاطرة، ومن ذلك:
أولاً: ألا تكون الكلمة المكتوبة هى الأصل: ذلك أننى – كما ذكرت – ما زلت أنصح المتدربين معى على العلاج النفسى ألا يقرؤوا أصلا فى موضوع العلاج النفسى خلال السنة الأولى من الممارسة على الأقل، ولكن هذا لا يمنع من القراءة فى نظريات علم النفس ومدارسه، وبالذات فى “علم النفسمراضية: السيكوباثولوجي”، وبالتالى لا تكون الكتابة (فالقراءة) هى المرجع الأول أو الأوحد لمعرفة ماهية “فن العلاج”. فالمرجع الأول هو المريض ومسار العلاج، أما المرجع الأصل فهو الإشراف من أستاذ (معلم مدرب) بشكل منتظم. ثم الإشراف من الأقران Peer Supervision، ثم الإشراف الذاتى، فضلا عن الإشراف غير المباشر من المرضى. ([12])
ثانياً: أن تتناسب جرعة القراءة مع حجم الممارسة تناسبا ترجح فيه كفة الممارسة على كفة القراءة طول الوقت (كلما زاد عدد المرضى، زاد احتمال الاستفادة من القراءة لاحقا)، فقد لاحظت أنه كلما زادت جرعة القراءة عن فعل الممارسة تعرض الممارس إلى ما يسمى العـَقـْلـَنـَةْ. ذلك لأن فن العلاج هذا إنما يمارَس “بكلية وجود المعالج نفسه“، وليس بتنفيذ أوامر العقل الحاسب المنطقى فحسب.
حدود ومعالم:
من كل هذا يمكن أن نستنتج ابتداء حدود ومعالم هذا النقد فى هذه الأعمال، وهو ما يمثله بعض هذا العمل، حتى لا نتوقع منه غير ما يعد به، وأيضا حتى لا نسىء فهم أو تطبيق بعض ما يصلنا منه.
هذا العمل – بكل أجزائه إذن – لا يعدو أن يكون:
1- إطارا عاما لا يغنى عن الممارسة، ولا يحل محلها، وإن كنا نأمل أن يؤنـِس من يمارس العلاج النفسى ويضيف إليه.
2- خبرة محلية لا تنفصل عن أحدث ما توصل إليه العلم والفن الطبى عبر العالم، لكنها فى النهاية تنطبق أكثر على المجتمع العربى خاصة وعلى المجتمع المصرى بشكل أكثر تخصيصا.
3- كتابا حواريا أكثر منه تعليمات تلقينية أى أن المعلومات التى يطرحها جديرة بأن تثير ما يقابلها ويعدلها لا أن تمثل للقارئ توليفة جاهزة للتطبيق الحرفي.
4- تطبيقا تنظيريا للفكر الذى ينتمى إليه المؤلف ([13])، الذى يمكن أن نوجز بعض معالمه فيما يلى:
-
النمو عملية مستمرة من الولادة حتى الموت (وبعده) ([14]).
-
النمو يتم فى دورات، تتصل هذه الدورات بالدورات البيولوجية الحيوية (الإيقاعحيوى) وخصوصا دورات اليقظة والنوم، ودورات النوم الحالم متناوبا مع النوم غير الحالم.
-
النمو يتضمن فرص ومسيرة التغير الكيفى بعد أزمات طفرية.
-
الإنسان مكون من شخوص (ذوات) متعددة تعمل كذات واحدة فى لحظة بذاتها أثناء اليقظة، وتتبادل لتتكامل من خلال كل من الإيقاع الحيوى، والتناسب الأدائى، بما يحقق عملية جدلية لا نهاية لها.
-
المرض النفسى هو خلل فى الطبيعة البشرية ومسارها بأى من:
(أ) الانحراف أو
(ب) التوقف أو
(جـ) النكوص أو
(د) التشوّه (بالتكلس أو التفسخ أو الاندمال)،
وهو عادة خليط من كل ذلك: بما يعيق عملية النمو المشار إليها سالفا وهو يظهر فى شكل نشاز يتجلى فى ظهور الأعراض من جهة، وفى عجز الأداء الحياتى واضطراب العلاقات البشرية (البينشخصية) من جهة أخرى.
-
علاج المرض النفسى هو استعادة نشاط مسيرة النمو بانتظام واتساق، أى استعاده سلامة استيعاب توظيف النبض الحيوى الذى يؤدى إلى تكامل مستويات الدماغ (منظومات الذات – مستويات الوعي.. إلخ) فى كلٍّ حركىٍّ متسق، مما ينتج عنه اختفاء أعراض النشاز، ونتائجه المعيقة.
إعادة تنبيه
إذا كان الأمر محفوف بكل هذه المحاذير فمن حقـنا بعد كل ذلك أن نعيد التساؤل عن جدوى الكتابة فى مثل هذه المواضيع للقارئ العادى غير المتخصص، بل وعلينا أيضا أن ندرس ما هو الضرر الممكن إلحاقه بالشخص العادى أيضا إذا ما أساء فهم المكتوب أو أساء تطبيقه؟ هذا تساؤل موضوعى وأخلاقى، حتى كدت أرجح أن ضرر الكتابة فالقراءة قد يكون أكثر من الفائدة ما لم يـُـبذل الجهد الكافى فى احترام المكتوب والتعمق فيه، بل إنه يراودنى الشك أيضا فى نوعية استقبال المتخصص ومدى رحابة صدره وقدرته على المراجعة معنا.
بعد فترة من الحيرة استقر رأيى على مخاطبة الشخص العادى والمريض والمتخصص معا دون حرج، وأبين تبرير ما انتهيتُ إليه فيما يلى:
أولا: إن من حق مريضنا وأهلنا، وعامة الناس عندنا (نحن جميعا مشروع مرضي) أن يعرفوا وجهة نظر تــمارس فى بيئتهم، من واقع ثقافتهم بدلا من ترديد مقولات أجنبية وأفكار وتجارب مستوردة معظم الوقت، هذا علما بأن الخبرات الخاصة تتضفر لتصب فى المعرفة العامة ما أتيحت الفرصة لذلك.
ثانيا: أنه مادام هناك ما هو فى متناول الناس تحت اسم “العلاج النفسي”، أو اسماء قريبة من ذلك، فينبغى أن تتاح لهم معلومات “أخري”، من واقع التجارب الفعـلية، حتى تتعدد المصادر أمامهم، وبالتالى يمكن أن ترجح اللغة الأصح والأنفع.
ثالثا: إن الأفلام والمسلسلات تتناول موضوع العلاج النفسى بشكل متواتر، وهى تقدم من خلال ذلك أسطح وأغلط ما يمكن تقديمه فى هذا الصدد (مثل التركيز على فك العقد، والغوص فى الماضى بحثا عن الأسباب حتى التبرير،. وتشويه صورة المريض العقلي، وتتـفيه [من التفاهة] صورة الطبيب النفسي) كل ذلك لا يصح السكوت عليه ولا يكفى التوقف عند شجبه أو مطالبة السلطات بمنعه، وإنما ينبغى أن يقابله ويوازيه فكر آخر يقدم المعلومات الصحيحة البديلة للشخص العادى.
رابعا: أثناء الممارسة لاحظت أن المرضى يفهمون النظريات التى أنتمى إليها، أو الفروض والتفسيرات التى أضعها بتلقائية ومباشرة ووضوح، أكثر من ذويهم، وأحيانا يلتقطون عمق مغزاها أكثر من الزملاء الأطباء التقليديين. (يحدث ذلك بوجه خاص بالنسبة لما يتعلق بالمرض النفسى والعقلى كلغة واختيار له غاية، وأيضا بالنسبة لما يتعلق بتعدد الذوات فى الكيان البشرى).
خامسا: التسجيلات التى تحت يدى تؤكد أن هذا التلقى المتميز عند المرضى لا يشترط أو يتطلب أيـًّا مما يلى:
(أ) درجة عالية من الذكاء،
ولا: (ب) قدرا من القراءة السابقة الكافية فى العلوم والنظريات النفسية،
ولا: (جـ) معالجا متميزا له قدرات خاصة أو نظرية محكمة، اللهم إلا طول خبرته ودوام تعلـُّـمه.
سادساً: إن هؤلاء المرضى (الذهانيين خاصة = المرضى العقليين) يستجيبون لمجرد الإشارة ولو من بعيد، ولو بلغة غامضة، لمفهوم “الغائية” فى المرض النفسى: ذلك المفهوم الذى يركز على معنى المرض، ومعنى الأعراض وما تريد تحقيقه، مثل الاحتجاج على ما هو اغتراب “عادى”، دون المساس بجوهر ما هى الصحة، برغم أنهم لا يعترفون بسهولة بدورهم فى اختيار “الخلل المرضى”.
سابعاً: كثيرٌ من هؤلاء المرضى يتقبلون (ويمارسون أثناء بعض أنواع العلاج. انظر بعد) حركية وإيقاعية “تعدد الذوات”، حتى تظهر استجابتهم بشكل ملفت حين يكملون بشكل عفوى رائع تعرية النفسمراضية بمجرد أن يبدأ المعالج فى الإشارة إليه.
ثامناً: إن استجابة هؤلاء المرضى هى فى الأغلب- أكثر جاهزية من استجابة الشخص العادى الذى يحتمى عادة وراء دفاعات تمنع هذه الرؤية الأعمق.
مخاطر ومضاعفات محتملة
أما عن المخاطر والأضرار التى يمكن أن تترتب على حضور هذه المعلومات فى متناول الشخص العادى (جدا)، والمريض أيضا، فهى حقيقية، ولا يخفف من أثارها إلا أنها أقل من الفوائد السابق ذكرها،
ومن بعض هذه المخاطر المحتملة ما يلى:
(أ) أن تزيد جرعة العقلنة (الفهم المجرّد) فتحول دون المعايشة الحقيقية، التى هى محور العلاج، حتى تحل محله، بمعنى أن تصبح المعلومات المقدمة هى السبيل إلى فهم عقلانى دون فعل أو تغيير فى الذات سلوكا وتركيبا.
(ب) أن تتاح الفرصة لممارسة ما يسمى “هواية التطبيب النفسي” على حساب المرضى والأصحاء على حد سواء.
(جـ) أن يتلقى هذا العمل قارئ متعجل مع ما يترتب على ذلك من درجات مختلفة من التعميم والتبسيط، مما قد يؤدى إلى غير ما قـُـصد منه، وأحيانا عكس ما قصد منه.
(د) أن يفهم البعض غائية المرض النفسى والعقلى (اختيار المريض لمرضه، بما فى ذلك اختيار الجنون) على أنه نوع من الادعاء أو حتى نوع من المبالغة والاستسهال (الدلع)، فيتصور أننا نتهم المريض إذْ نحمّله مسئولية اختيار مرضه، فى حين أن هذا التوجه إلى اعتبار المرض اختيارا يحمل دعوى ضمنية أنه مَنِ اختار المرض، يستطيع أن يختار العدول عنه والعودة إلى الصحة عن طريق العلاج المشارك.
كل هذا الذى ذكرته فى الصفحات السابقة هو الذى جعل القلم يتوقف (ينقصف) المرة تلو المرة، وهو الذى جعله يعاود المحاوله (يطلع له سن جديد). والتحذير(فى البيت الثاني) من عدم جدوى الكلمات فى مواجهة مسيرة الأحداث التى تبدو حتميه (والقدر مواعيد) هو تحذير نسبي، لأنه ليست كل الكلمات لها نفس الفاعلية، أو اللافاعلية، والكلمة الكاشفة المخترقه هى نفسها جزء من القدر وخاصة حين تلتحم بتوقيتها ودلالته.
عن القدر والمصادفة
كلمة القدر هنا (وربما فيما بعد) لها تفسير فى هذا السياق العلمى ليس له علاقة بنفس الكلمة “القدر” حين تستعمل فى سياق دينى (مثلا) – فمن ناحية يمكن أن نتصور أن حتمية فرويد (الحتمية السببية = لكل حدث تفسيره وأسبابه فيما سبق من أحداث) هى نوع من القدر بشكل أو بآخر، وبالتالى فإن هذه الحتمية لا تغيـّـرها الكلمات، وإنما يغيرها إعادة تنظيم مقومات الحتمية التى جمّدت التركيب البشرى بهذه الصورة، وهذا ما يزعمه التحليل النفسى، غير أن التحليل النفسى قد أشيع عنه أنه “علاج بالكلام” وهو ليس كذلك فى عمق أفكاره، فهو قد يستعمل الكلام بشكل غير نمطى ليحقق هدف التغيير الحقيقي. وعلينا أن نقرّ أن الكلام ومحتواه هو ضرورة من أهم الوسائل للتواصل والتفريغ والإبلاغ ومن ثم إمكانية التفكيك لإعادة التشكيل، أما أن يكون العلاج بالكلام هو الغاية والوسيلة بهدف خفض التوتر أساسا، فهذا ما لا نتفق معه، (وسوف يأتى نقد ذلك بالتفصيل فى الكتاب الثانى([15])).
أما المعنى الأخر المحتمل للقـَدَر (هنا) فهو ما قد يشير إلى التركيب الجينى المبرمج فى الدنا DNA ([16]) داخل الخلية (التناسلية بالذات). هذا التركيب الخلوى لا يحمل فقط السمات الوراثية سليمة كانت أم مرضية، وإنما هو يحمل برامج مسار النمو حتى نهايته بما فى ذلك مدى العمر Life Span لكل نوع من الأحياء. هذا القدر البيولوجى (الدنا) ليس حتما مطلقا غير قابل للتغيير وإلا لما تطورت الأنواع، ولا ظهر الابداع، إن وصف القدر بأنه “مواعيد” قد يشير إلى ما يحمل الدنا من توقيت مناوِب للبسط والاستيعاب عبر دورات الإيقاعحيوى المستمر، كذلك العمر الافتراضى للبرامج النوعية ([17]).
فهكذا ظهر هذا الكتاب رغما عنى، من هذا المنطلق انتصر (وينتصر) حتم الكتابة على الاكتفاء بالممارسة والنقل المباشر من فرد إلى فرد، وهو الأمر الذى يتعرض للتشويه وسوء الفهم والاستعمال من خلال الانحرافات المحتملة.
خلق القلم مِالعَدَمْ أو راقْ، وِ.. مَــلاَهَا،
وانْ كان عاجبْنٍى وَجَبْ، ولاّ أتنّـى بعيدْ.
هأنذا أقر وأعترف انه مهما بلغت عندى المقاومة والتحفظ ضد تسجيل الخبرة، فإن إلحاح إبلاغها إلى أصحابها رغم احتمال سوء استعمالها أو تشويهها لا يتوقف، وربما كان هذا هو ما خرج شعرا يعلن تخليق الأوراق من العدم الذى حاولت أن أهرب فيه، وهكذا يبدو أن كل محاولاتى فى القص والشعر والنقد أحيانا: لم تكن إلا تخليقا لأدوات (أوراق) لأملأها بما يمكن أن يوصل رؤيتى بشكل أو بآخر.
لو أننى استسلمت لهواجس نفسى وكتبت مثل المتهم الذى يحاول أن يدافع عن نفسه بالاستشهاد بالقرائن (المراجع، والأرقام والإحصاء) قبل أن يقول كلمته إذن لما خططت حرفا واحدا فى العلاج النفسى خاصة.
كذلك لو أننى عملت حساب النقد (القاسى المتعسف أو حتى الموضوعى ظاهريا) ليحاسبنى على خبرتى بما أورده من مراجع، وعلى الشعر بمعيار الشعر (فقط) وعلى النقد بمعيار النقد التقليدى أو حتى بمقاييس ما سمى مؤخرا “علم النقد” (فقط). إذن لما كتبت حرفا أيضا.
أعتقد أن هذا هو السبب الذى جعلنى لا أحرص على التأجيل حتى أتقن الأداة “جدا”، وهو الذى جعلنى أرضى بتواضع عطائها وهى تبزغ (إن كان عاجبنى وجبْ)، فإذا لم أفعل: فإنها (الأداة) تنطلق منى ضاربة عرض الحائط باعتراضاتى وتحفظى وخوفى من النقد وعمل حساب الزملاء وأهل كل صنعة من الخواجات خاصة، وكأن أدواتى تعمل بالتسيير الذاتى وتدفعنى بعيدا عن الحيلولة دون التسجيل (ولاّ أتنى بعيد).
وبعد
كل هذا التحدّى والانطلاق المقتحـِـم لم يقلل من خوفى،
وهذا التردد والحساب، هو ما عبرت عنه فى الفصل التالى.
الفصل الثالث
الخوف من النقد المُعـِـيق، واختراقه
تنبيه:
أنبه مرة أخرى أن هذه المقدمة هى مقدمة لسلسلة الكتب جميعها!! وليست لهذا الكتاب الأول وحده !
–2–
بصرَاحَـةْ انا خفْتْ.
خفتْ منهمْ، خفتْ ”منى”، …. خفت منّــا.
خفتِ مالطوبِ، والطماطم، والملاَمْْ والتريقهْ،
خفت مالبيض الممشِّــشْْ، والنكتْ، والبحلقهْ.
انطلاقا من المتن:
عرّى لى هذا النص أن الخوف من البوْح (كما يقول الصوفية) هو خوف أساسىّ يكمن فى داخلنا، وليس فقط خوفا من الاختلاف مع من هم (أو ما هو) فى خارجنا، البوح هنا ليس بوحا فقط بما يصلنى من داخلى بحسب حدة ومرحلة البصيرة “خفت منى”، بل هو بوح أيضا بما يصلنى من مرضاى، فيحرك ما تيسَّر فىّ وفيهم، يـُظهر المتن هنا أن للخوف مصادر متنوعة، متضفّرة معا:
“خفت منهم”
هذا هو أخف أنواع الخوف، وهو خوف مشروع، ومفيد أيضا، هو نوع من عمل حساب للنقد حتى لو كان نقدا قاسيا حتى احتمال الإعاقة، لو أننا تركنا الحبل على الغارب، ولم نعمل حساب رأى الآخرين، إذن لبلغ الشطح مبلغا لا يمكن التنبؤ بمداه، لأن الإلغاء الكلى لاحتمال الحوار الناقد مع آخر، أيا كان هذا الآخر، قد يسمح لأىّ من كان أن يطلق لفروضه أو نظرياته العنان بشكل يعرضها للتناثر والتجاوز بلا حدود، صحيح أن المبالغة فى عمل حساب الآخرين قد تجهض إبداعا أصيلا نادرا، لكن تظل الحسبة محفوفة بالمخاطر، والمسألة فى نهاية النهاية متروكة لحسابات صاحب الفكرة وعليه أن يعمل حساب الدور الإيجابى لهذا الخوف من النقد من الآخرين، وذلك مهما بلغت أصالة الفكرة، أو عمق الرؤية.
“خفت منى”
لا يقتصر الخوف على عمل حساب الآخر الناقد الخارجى أخطأ أم أصاب، ولكن ثَمَّ خوف أهم من الناقد الداخلى النشط، هذا الناقد الداخلى ليس ببساطة: مرادفا للضمير، لكنه ناقد حقيقى يقوم بدور جيد مثله مثل الناقد الخارجى، وأكثر، هذا الخوف الثانى هو “منى” أساسا، ثم يجتمع هذا الخوف منى، مع الخوف منهم حالة كونهم بداخلى وخارجى معا، فيصبح “الخوف منا”:
“خفت منا”
الآخرون هم أيضا بداخلنا، أو لعلهم أساسا بداخلنا، وهم أحيانا يكونون بداخلنا أكثر مما هم بخارجنا، وهذا أيضا مكسب مهم، وفى نفس الوقت هو إعاقة محتملة، وعلى من يغامر أن يغامر دون أن ينسى.
يـُـعتبر المتن “هكذا” بمثابة لوحة متحركة تُظهر مدى الشجب، والرفض، والسخرية المحتملة، وهو ما يتجاوز ما أسميته نقدا حالا. إن النقد مهما أخطأ هو نشاط بنـَّاء فى نهاية النهاية، أما السخرية والوشم والنفى والترصد، فكل هذا ليس إلا إعاقة خالصة.
خفت مالطوبْ والطماطمْ والكلامْ والتريقةْ
خفت مالبِيض الممششْ، والنكتْ والبحلقةْ
موضوع الإعاقة من خلال تأثير نظرات التركيز (البحلقة) بالعامية = التحديق (بالفصحى) هو موضوع أكثر حساسية من مجرد النقد أو السخرية المعلنه، هذه الظاهرة – تركيز نظرات الآخرين حتى الإعاقة – رُصدت بعناية شديدة باعتبارها متعلقة ببعض فروض وحقائق علم الباراسيكولوجى([18])، وأيضا لها علاقة بالعين الشريرة (الحسد)، وربما هى هى التى حين تتجسد مرضيا تصل إلى ما يسمى “ضلالات الإشارة” Delusion of Reference حتى “ضلالات الاضطهاد” Delusion of persecution.
وكأنى هنا أتقمص المجتمع المسمى بالمجتمع العلمى السلطوى خاصة، وهو مجتمع ناقد محافظ بالضرورة، وعنده بعض الحق، بل كثير من الحق، خاصة حين كان مجتمعا علميا نقيا، بعيدا عن ألعاب سوق الدواء، هذه التعرية كان لها تفاصيل فى وعيى، فرصدت هذا الحوار الداخلى ساخرا حتى الرفض، لكننى فضلت أن أثبته!!
قلت أنا ما لى، أنا اسـْترزَقْ واعيشْ،
 والهربُ فى الأسْـَتـذَةْ زيّـُــهْ مافــيشْْ،
والهربُ فى الأسْـَتـذَةْ زيّـُــهْ مافــيشْْ،
والمراكزْ، والجوايزْ، واللـَّذى ما بـْيـنِـْتـهيشْ
قلت اخبِّى نفسى جُـوَّا كامْ كتابْ.
قلت أشـْغـِـلْ روحى بالقولْ والحسابْْ.
والمقابلاتْ، والمجالسْ
والجماعةْ مخلَّصـِينـْلـَكْ كل حاجـَةْْ، أَيْـوَهْ خـَالـِصْْ.
بس بـَرْضـَك وانت “جالسْ”.
شعرت فجأة، وأنا أتعسف لأكتب شرح هذه الفقرة، أن ثمة فقرات، خصوصا فى المقدمة، ينبغى أن تـُتـْرَك متنا دون أن نقترب منها شرحا أصلا، تترك بما هى، كما هى، فهى أكثر وضوحا، ومباشرة من أن تشرح، أكتفى هنا بالإشارة إلى ما يسمى “علم نفس المقعد الوثير” Arm Chair Psychology، ويـُقصد به عادة: التنظير من الوضع متأملا، بأقل قدر من الخبرة المعيشة، ومن التجربة القابلة للاختبار، هذا التعبير، الذى أضفت إليه من عندى وصف “الوثير”، هو ما انتهت به هذه الفقرة “بس برضك وانت جالس“.
أما موقفى من الجوائز، مع كل احترامى لها دون سعى مباشر، فهو معروف ومنشور فى أماكن أخرى (“جوائز وجوائز” مثلا).([19])
تقديس الكلمة المطبوعة
بقيت كلمة هامة، ليست شرحا بالضرورة، لكنها بمثابة هامش دال، فقد نبهت مرارا إلى خطورة تقديسنا للكلمة المطبوعة، حيث ما زال العامة، وكثير من الخاصة، يعتبرون الكلمة المطبوعة مصدرا مـُسـَلـَّما به، لكثير من المعلومات التى قد تضيف إلى المعرفة بقدر ما يحتمل أن تشوهها أو تختزلها.
بالنسبة للعلماء – وهم فئة من الخاصة – المسألة أصبحت أكثر إشكالية، أما بالنسبة للممارسين لمهن عملية تستعمل العلم والمعلومات فالأمور تصبح أخطر وأعقد، نحن نعيش وسط فيضان من الكتب والمجلات العلمية وشبه العلمية وغير العلمية، يكاد يصل إلى حد الطوفان، وبقدر ما يمكن أن يثرينا هذا الطوفان إذ يروى ظمأنا للمعرفة، يمكن أن يغرقنا حين يلهينا عن الخبرة المعيشة، والطبيعة المخترِقة.
الحد الفاصل بين الثقافة بالمعنى الحضارى التطورى المغامر المجدد، وبين الثقافة بالمعنى الاغترابى المضلل الهارب، هو حد دقيق قد لا يـُرى بأعلى درجة من البصيرة والنقد. فى تقديرى أن كثيرا من العلم المنشور (أو ما يسمى كذلك)، وبالذات: الذى له علاقة بحركية القوى المالية التحتية، تمويلا أم نشرا أم تسويقا، أصبح بعضه، إن لم يكن أكثره، خطرا على المعرفة، خصوصا إذا استعملـَـتـْـه السلطات المعلنة أو الخفية لتسويق وتبرير حياة مغتربة تخدم الأغراض التحتية (المالية السلطوية عادة) أكثر مما تخدم المعرفة البقائية التى تصب فى صالح تطور البشر. يمتد خطر تقديس – أو على أحسن الفروض وصاية – الكلمة المطبوعة (علمية وغير علمية للخاصة والعامة) إلى مجالات كثيرة كثيرة، علينا أن نحذر أن نستسلم لها دون وعى مسئول، يمتد تقديس الكلمة المكتوبة إلى قصر ما يسمى مواثيق حقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الطفل أيضا، وكل الحقوق الحقيقية والصورية والمزعومة، قصْر هذه القيم جميعا على ما هو مكتوب فى تلك المواثيق، بل إن ألفاظ القانون نفسه فى بعض الأحيان تكون عائقا ضد تطبيق العدالة الأعمق. هذا مأزق لا مخرج منه فى الحياة المعاصرة إلا بتطور جذرى حقيقى قد يصل إلى درجة “الطفرة” وإلى أن يتحقق ذلك فلا مفر من الالتجاء إلى حلول مرحلية أو فردية محفوفة بالمخاطر.
نتيجة لذلك كاد الكثير من الممارسة الطبية النفسية بالذات يصبح ممارسة مكتبية تطبيقية أكثر منها ممارسة فنية عملية (إمبريقية).
المعلومات الحاسمة التى تخرج بواسطة شركات الدواء شرحا لأسباب هذا المرض أو ذاك، بهذا التغير الكيميائى المحدد أو ذاك، كسبب مباشر وحاسم، هى المقصودة غالبا بتعبير([20])
“الجماعةْ مخلَّصـِينـْلـَكْ كل حاجَةْْ. أَيْـوَهْ خَالـِصْْ،
بس بـَرْضَك وانت “جالسْ”.
 قلت أرسمْ نفسـِى واتْـدَكْـتَـرْ وارُصّ.
قلت أرسمْ نفسـِى واتْـدَكْـتَـرْ وارُصّ.
قلت أتـفـرَّجْ وِ أَتـْفلسـِـفْ وابــُصْْ.
بس يا عالمْْ دا دمْ ولحم حىْ،
حاستخبّى منه فين؟؟!!
هذه مرحلة نظرية لم أستطع أن أركن إليها أبدا، وإن كنت لا أعفى نفسى من أنها لاحت وتلوح لى بين الحين والحين: التمادى فى التخصص، والتباهى بالوظيفة العليا، والتوقف عند أعلى الشهادات مما يمكن أن يكون مهربا من نوع آخر، لكنه أبدأ لم يقنعنى.
هذا عن الفـُرْجة مهربا، أما عن التفلسف فقد ساهم الإعلام وجاهزية الزملاء (وأنا منهم أحيانا!!) إلى تصوير الطبيب النفسى المسئول، عارفا فاهما لآليات الحياة وخباياها، وبالتالى قادرا على إصدار الحكم والأحكام، والتفسيرات والتأويلات، بما يختلط عند العامة بما يسمى “فلسفة” بشكل أو بآخر، هذا ما أعنيه بالتفلسف وهو غير “فعل الفلسفة”، وهو الأقرب إلى ممارسة الطب النفسى.
فعل الفلسفة هو معايشة الأسئلة التى توصف بأنها هى هى التى تدور حول الحياة والموت، والوعى، والكون، والعدم، والوجود، مثلا: يحضر المريض لنا فنتقمصه لنجد أنفسنا ننتقل:
بين المهدى المنتظر … وساندريلا.
بين النورْس المحلـِّق … والطير الملقى فى الطين بلا أجنحة.
بين الطفل المسخ …. والنبى.
وكل ذلك تعرية صارخة فريدة متنوعة طول الوقت، وهو ما اسميته فعل الفلسفة نفيا لما هو تفلسف.
من هنا تتاح الفرصة لتعلّم من نوع آخر من خلال حدة البصيرة وتحمل المسئولية معا، هذا بعض ما أعنيه دائما حين أصرح المرة تلو الأخرى أن المرضى هم أساتذتى الأوائل بعد أن عرفت كيف أسمح لنفسى بمحاولة فك شفرة مرضهم، ليصححونى، ونكمل معا (ما أمكن ذلك). وهذا هو ما جاء فى الفصل التالى.
الفصل الرابع
المريض ورّانى نفسى

مقدمة:
ما زلنا فى الفصل المقدمة الجامعة، وهذا الفصل يركز على كيف أن مصدرى الأساسى هو الخبرة من واقع معايشتى لمرضاى، واحترامى للغة المرَض، ومحاولة مواكبتى لهم لنواصل.
 المريض ورّانى نفسى
المريض ورّانى نفسى
المريض خلاّنى أتـْلـَمـْلمْ وافَـكـَّـرْ.
المريض عـَدِّلـِّى مـُخـِّى،
نضَّفُهْ من كل واغشْ، كانوا فارضينُهْ عليهْ.
من ملاعيب اللى بايع ذمته بـْمعَـَرفـِشى إيـِهْ.
من شوية آلاتـِـيـَّة، والعَـشـَا الـْ “أوبـنْ بـُوِفـِيهْ”.
لا يقتصر ما تعلمته من مرضاى على معرفتى بأمراضهم، أو نـَفـْسِمـْرَاضيتهم ([21]) Psychopathology، أو طرق علاجهم، بل امتد إلى شحذ بصيرتى لأتعرف بشكل مباشر على نفسى بالقدر الذى وصلنى ([22]) (مما لا أعرف مداه حتى الآن)،
مهنتنا مهنة صعبة لمن يريد أن يواصل المعرفة ذهابا وجيئة:
بين “ما هو” و:……”من هو”،
بين “لماذا” و:……”إذن ماذا”،
بين “الأصل الغامض” و:…….”المدى المفتوح”.
حين يكتشف الممارس المغامر بالمعرفة أن رؤية المريض وصدق حدسه (رغم وقفته المهزومة مرحليا) هى إثراء لوجوده شخصيا كطبيب وكإنسان، وفى نفس الوقت هى تحد لقدرته على أن يرى نفسه، يصبح مأزقه أصعب فأصعب، لكن فـُرَصـَهُ تصبح أكثر ثراء للنمو والتغير إن هو قـَبـِلَ المخاطرة.
مسألة “العشا الأوبن بوفييه“، هى إشارة إلى احتفاليات وطقوس المؤتمرات العلمية الحديثة، وهى قضية تحتاج وقفة: فمازلت أتعجب لماذا تُلقَى أحدث الأبحاث العلمية، فى الفنادق بالغة الفخامة باهظة التكاليف، أليس المكان الأنسب للعلم هو دور العلم، والتعليم، والبحث العلمى؟ إن التحجج بسعة المدرجات أو وفرتها هو حجة مردودة، فالأصل أن الفنادق للفندقة، بما فيها من صالات الاحتفالات، ومطاعم ومقاهى وأركان أخرى، والأصل فى دور العلم والتعليم هو أن نلتقى فى مدرج، أو معمل، أو قاعة محاضرات، هل العلم الذى يلقى فى “موفمبيك” شرم الشيخ له مصداقية أكثر، وفائدة أعم للمرضى، عن العلم الذى يلقى فى جامعة القاهرة أو كلية طب قصر العينى أو مركز الطب النفسى فى عين شمس؟ يتصور كثير من الزملاء أن المسألة لا تفرق (ما تفرقشى)، وهذا تصور ساذج، فشركات الدواء التى تموِّل هذه المؤتمرات بمئات الآلاف من الدولارات وأكثر، تعرف كيف تنفق نقودها، ولماذا، وبالتالى تعرف كيف تستردها، وكيف تستعملها، ليس هذا هو موضوعنا وإن كنا سنرجع إليه كثيرا (غالبا)، لكن الإشارة هنا كانت لمجرد ورود ذكر “العشاء حول مائدة مفتوحة لتنوع اختيار المشويات ! السلاطات والحلوى”، مع ما تيسر من المعادلات والمعلومات ونتائج الأبحاث!!!
إن الإنصات للمريض لترجمة أعراضه إلى لغة ناقدة، كاشفة، ثائرة، مـُجـْهـَضة أحيانا، هو مفتاح علاجه، وفى نفس الوقت قد يكون المريض وهو يضىء هذا النور الأحمر بمثابة ما أسماه لى يوسف إدريس ذات مرة: “ناضورجى الخطر القادم على المجتمع ككل”، فهو فى ذلك مثله مثل المبدع، مع احتمالات الفشل والنجاح.
مواجهة “الحقيقة” على أرض الواقع
 بس والله يا عالَــمْ لمْ قِــدِرت.
بس والله يا عالَــمْ لمْ قِــدِرت.
لَـمْ قِدِرت آعمَى بْـنَوَاضْرى،
حتى لو كان العمى دا”رَأْسـمـَاَلكْ”،
أو كما سـَمـُوهْ حديثا “مَـشـِّـى حـَاَلكْ”،
يعنى “طـَنّشْ، إنتَ مالـَك”.ْ
لاحظتُ أننى استعمل كلمة “الحقيقة“ أكثر من اللازم، وهى كلمة نجدها أكثر تواترا فى قاموس الفلاسفة عنها عند العلماء أو الفنانين، وإذا كانت قضية الفيلسوف من بعض نواحيها هى البحث عن الحقيقة، فإن أزمة المجنون هى مواجهة الحقيقة فجأة دون استعداد أو إعداد، ويبدو أن ورطة الطبيب النفسى هى فى اضطراره إلى أن يكون شاهدا على هذا المأزق رضى أم لم يرْضَ، ولو أمعنا النظر فى مدارس الطب النفسى لوجدناها تختلف بشدة فى تقييم هذه الخبرة الإنسانية: “مواجهة الحقيقة الداخلية والمطلقة عارية عادة، ومـُشـَوَّهة أحيانا،ً ومـُحـَرَّفَـَة كثيرا” كما يلقيها فى وجوههم المرضى الذين يحكون عنها!!.
1- فريق يدمغها بالأسماء والأوصاف المرضية السلبية معلنا بذلك أنه ينبغى ألا نستسلم لـ (أو حتى نصدق) رؤية المجنون، بما أنها رؤية شاذة، أو على الأقل لا تستحق، مادام لم يستعد لها بكامل مسئوليته، ولم يـُـقـْـدِم عليها بعمق وعيه، إذن فالهزيمة التى اجتاحته من هذه الخبرة هى هزيمة لا أكثر، وبالتالى فهى تضعه حيث وضع نفسه “مريضا شاذا فحسب”، هذا الفريق يعلق فى رقبة المجنون لافتة تحمل اسم ظاهرة مرضية عضوية أو سلوكية ظاهرية (التشخيص)، ويكتفى بذلك.
2- وفريق على أقصى الطرف الآخر يعلى من شأنها، ويصفها بألفاظ الاحتجاج والحرية والثورة، ويعزو الهزيمة التى مُنى بها المريض، إذا رآها هزيمة، إلى قسوة المجتمع وغبائة، ويفترض أن هذا الموقف رغم سلبيته هو أفضل من “الانضباط الأعمى”، ومن النجاح الأجوف المغترب (على حدّ رأيه)، هذا الفريق يتصور أن هذا التقبل فى ذاته خليق بأن يجعلها خطوة للأمام، وليست ضربة قاضية تنهى الجولات قبل بدايتها، هذا الفريق له رؤية فنية توصف عادة بأنها “رؤية حرة”، ويندرج تحت هذه الرؤية ما يسمى الحركة المناهضة للطب النفسى Antipsychiatry. ولكن هذا لا يتعدى الموقف الفنى الناقص، المثير برغم نقصه، فهو لا يصل إلى الموقف العلمى البناء، ولا إلى الموقف الثائر الملتزم، إن مآل هذه الرؤية إذا تمادت هو التسيب السلبى، ومزيد من إجهاض أية احتمالات إيجابية، ومن ثـَمَّ التدهور المرضى أكثر.
3- وفريق ثالث يرى هذه المواجهة فى حجمها القاسى والمؤلم، وموقفها الناقد اللاذع ولكنه لا يعلى من شأنها بقدر ما يتخذ موقفا مسئولا إزاءها، فهو معها من حيث المبدأ، شريطة أن يتحمل صاحبها مسئوليتها ”معنا”، فوظيفة الطبيب هنا هى أن يقلب الهزيمة نصرا، (لا أن يوقف إطلاق نيران الحقيقة فحسب) وهو فى هذه الرحلة لابد أن يرى المريض من زاويتيين:
مرة من خلال فهم واستيعاب ما جرى من حيث أنه رفض العمى والرتابة،
ثم يراه مرة ثانية: من موقف الحزم حتى اللوم بهدف تحجيم الشطح المحتمل، حيث الرضوخ للحلّ المرضى إنما يعلن العجز عن تحمل حدّة البصيرة ونبض الحس الأعمق،
وعلى الطبيب أن يحاول من خلال هذا وذاك أن ينتصر بهما معا بمشاركة المريض ليتكاملا فى ولاف أرقى! بمعنى أن يبين للمريض دوره فى اختيار المرض فى نفس اللحظة التى يبادر فيها بمشاركته لإعادة اختيار الصحة.
إعادة من المتن:
-6-
ييجى صاحْبَك “مَـلْط” إلا مالْـحـقيقهْ،ّ
ييجى يزقُـلُها فى وشى وتـنه ماشي.
الأصول إنى أعالجـه، واكفى ماجور عالخــبـر”.
”بكره يعقل! بالدواءٍِ الـمـُعتبرْ”.
بس والله يا عالَــمْ لمْ قِــدِرت.
لَـمْ قِدِرت آعمَى بْـنَوَاضْرى،
حتى لو كان العمى دا”رَأْسـمـَاَلكْ”،
أو كما سـَمـُوهْ حديثا “مَـشـِّـى حـَاَلكْ”،
يعنى “طـَنّشْ، إنتَ مالـَك”.ْ
الخاطر الذى يتبادر إلى ذهن أى طبيب، وهو موقف إيجابى طبيعى هو أن يبادر بعلاج المريض، خاصة إذا كان المرض جسيما، وهو ما يسمى عادة بالجنون (المرض العقلى)، ولا لوم عليه فى ذلك إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة، حيث إن وضع مسافة مهنية باردة بين الطبيب والمريض تحتاج إلى نوع من الميكانزمات العامِيَة التى تشيِّئ([23]) هذا المريض بشكل أو بآخر.
هذه إشارة قاسية إلى النموذج الطبى القمعى الذى يرى المرض حريقا لابد من الإسراع فى إطفائه بالعقاقير حتى لو لم يتبق بعد ذلك إلا الرماد، وهو يسلك لتحقيق ذلك سبيل المبالغة فى استعمال العقاقير، واعتبار المرض النفسى مجرد تغير كيميائى فى وظيفة المخ، وهو نموذج يحجب الرؤية عن الطبيب النفسي، وبالتالى هو يحرمه من التعرض لتعميق الوعى ومواجهة حقيقة وجوده ذاته كما ذكرت، أما “الذى منه” فهو إشارة إلى سوء استعمال بقية الأساليب الكيميائية الصرفة، مع أن هذه الأساليب لها فاعليتها وروعتها ووظيفتها إذا كانت جزءا من كل متكامل على مسيرة التطبيب النفسى، أما إذا كانت بديلا عن العلاقة الإنسانية أو كانت مجرد خفضٍ للطاقة وتهدئة للثورة فإنها قد تعمل فى عكس الاتجاه الخلاق.
-7-
قلت: إعْقَل يا ابْن نـَفـْسِي.
قلت: حاسِبْ ما الـْفـَضـَايحْ والجُرَسْ.
قلت إدّيها عمَى حيسِى، وزوّد فى الحَرَسْ.
نطّّ غَـصـْبـِن عنـِّى، ورّانى إنّـى هوّه.
بس جـــُوّهْ ! ! !
قلت أَخطف نظره عالماشى واغَمَّضْ مِن جديد،
هّيه نظره – واللىّ خَلَقَكْ- لم تَنِيـتْها
انطلاقا من المتن:
مع اضطراد نمو الطبيب، قد يتجرأ فيسمح بما يسمى “إعادة الولادة”، ليصبح “ابن نفسه” بعد أن كان ابن أبيه وأمه، وهو يعلم – عادة – أنه إذا فشلت “إعادة الولادة” فهى احتمال تجربة الجنون ذاتها، أمّا إذا نجحت فهى تجربة أزمات التطور وكذلك إرهاصات الخلق والإبداع. أن يصبح الفرد والد نفسه، احتمال فيه من الروعة بقدر ما فيه من المسئولية، والخطاب هنا “يابـْن نفسى” يشير إلى أن من تعرض لمصاحبة المجنون فى رحلته المرعبة هذه، فهو لابد والدٌ لنفسه من جديد، وعليه أن يتحمل مشاق الرحلة، وأن يقلبها إبداعا حقيقيا متى امتلك الأداة، فهى فرصة، وهى مصيبة فى نفس الوقت إذا لم تتم بأمان.
الاشتغال بالطب النفسى إشكالة شديدة التعقيد، إنها مهنة تستدرجك – إن كنت صادقا- إلى عالمك الداخلى، بقدر ما تغوص فى عالم المريض (المجنون خاصة)، إنك لا تستطيع أن ترى المجنون منفصلا عنك إن صدقتَ فى محاولة قراءته ثم نقده لإعادة تشكيله، وتشكيلك معه كما أشرنا من قبل، هى ليست مهارة تُستعمل من الظاهر، إنك متى تغامر بتقمص المريض فإنك تكتشف أنها ليست مجرد عملية لـِـبـْـسِ قميصه (تقمّصه)، بل إنه يحرك فيك الجزء المقابل لما تعرى فيه عشوائيا، برغم احتمال غائيةٍ لها دلالاتها فى بداية رحلة الجنون.
كيف يحدث ذلك؟
“نطّ غَـصـْبـِن عنـِّى، ورّانى إنّـى هوّه.…، بس جـــُوّهْ!!!”
إذن هذه المسألة لا تحدث اختيارا محسوبا مسبقا، وإنما هى نتاج صدق المواكبة، وأمانة المعايشة.
أنت تعرف مريضك، إذْ تتعرف عليه من خلالك، وهو أيضا يعرفك من خلاله، كل ما فى الأمر أن ما يمكن أن نسميه جنونا لا يكون كذلك طالما أنه كامن فى داخلنا (بس جوه)، لكنه هو هو موجود فينا كلنا، التركيب الأساسى لى ولمريضى واحد، ولا تُكسر المسافة بينك وبين المريض بشكل موضوعى مفيد إلا من خلال الإقرار بذلك منذ البداية بكل ما يحمل من مفاجآت ومخاطر.
المريض ليس مختلفا عنا، وما يسمى جنونا هو ذلك التركيب الذى يبدو عشوائيا فى بعض مراحل حركيته، نحن نستنتجه عادة ولا نعرف جوهره تفصيلا إلا من خلال ناتجه الظاهر على السطح. كل ما هو تحت السطح نحن نضع له الفروض للتعرف عليه، هذه الفروض قد تصح وقد لا تصح، وكل فرض أو نظرية قد يفيد فى التعرف على بعض الظاهرة لا أكثر.
عن الحلم والجنون
المدخل الأصلح لتأكيد وجه الشبه بين الطبيب والمريض هو ظاهرة الحلم، (وليس فقط محتواه أو تفسيره)، حركية الحلم من واقع نشاطه، ومن دوره فى ترتيب، (و”لاترتيب”: فوضى) المعلومات فيه، الحلم هو الجنون دون هزيمة، بل فى الأحوال العادية، هو الجنون الناجح، فى موقعه المناسب فى دورة الإيقاعحيوى، أو لعله الإبداع الخفى، نحن لا نعرف ما يجرى أثناء الحلم الحقيقى، (على الأقل عشرون دقيقة كل تسعين دقيقة، بمجموع نحو ساعتين كل ليلة)، كل ما كان يهمنا فى مسألة الحلم حتى وقت قريب هو “محتوى الحلم” الذى يُعـْلـَنُ فيما أسميه “الحلم المـَـحـْـكـِـى” والذى افترضت أنه لا يتشكل إلا فى الثوانى (أو أقل) ما بين النوم واليقظة قرب الاستيقاظ، هذا المحتوى هو الذى ظل يشد انتباهنا، وتدور حوله أبحاثنا، وتحاول تفسيره تأويلاتنا، بعيدا عن ظاهرة الحلم ذاتها (انظر: الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع)([24])، لأن تشكيلة وحركية ظاهرة الحلم هى هى تشكيلة وحركية ظاهرة الجنون مع اختلاف حالة الوعى، وطبيعة المآل.
بمجرد أن نستيقظ، يعود كل شىء كما كان إلا قليلا، ونروح نمضى ساعات يقظتنا وسلوكنا العادى ليس عليه شائبة، لأن جنوننا يكون أثناء يقظتنا كامن ساكن، وهو ينتظر أن تأتى ساعات النوم ليتحرك فى نشاط الحلم بحساب وإيقاع راتب، مرة أخرى: لنستيقظ من جديد “كما كنت” إلا قليلا، وهكذا.
فى مواجهة المجنون
حين نلتقى بشخص مجنون فى واقع الحياة، يتحرك جنوننا الكامن داخلنا، فنخاف من هذا التحرك، ويختلف تفاعلنا باختلاف موقفنا وما هو نحن، ومن ذلك:
-
بعضنا يرعب من مجرد احتمال وجود وجه شبه معه، ولو فى المستقبل البعيد.
-
بعضنا يخاف ويسرع بالهرب الفعلى (بتجنب مواصلة رؤيته).
-
بعضنا يزداد عمى وبعدا ويفترض – شعوريا أو لا شعوريا – استحالة إصابته بمثل ذلك.
-
بعضنا يـُمـَنـْظـِر ويفتى ويصنّف وينصح ويشخـِّص (من الأطباء عادة).
-
بعضنا (من الأطباء أيضا) يسارع إلى الالتجاء إلى العلاج السلطوى الذى قد يطفئ حركية جنون المريض، بدلا من أن يستوعب طاقتها، وفى نفس الوقت هو يزيد من إحكام قهر حركية جنونه الكامن شخصيا.
-
بعضنا يمارس الوشم والتشويه، ثم الابتعاد، فالنفور.
-
بعضنا يمصمص شفاهه ويركب هودج الشفقة، وهو ينظر إلى الموقف متعاطفا من أعلى.
-
بعضننا يصفق له ويمدحه وهو فـِرَحَ (ربما لأنه جـُـنَّ بالنيابة عنه).
-
بعضننا ينكر الخبرة برمتها (ولا من شاف ولا من درى).
حقيقة وتدرّج موقف الطبيب بالممارسة:
الطبيب الذى لا يغامر بالتعرف على مريضه من خلال جنونه الكامن شخصيا([25])، يحتاج مزيدا من الدفاعات خشية أن يرى هذا الاحتمال، أن يرى نفسه بروعة أعماقها وإرعاب تعريها، وتساعده فى دعم دفاعاته شركات الدواء، والعلم السطحى المـُسـُخـَّر لمصالح هذه الشركات، والاغتراب المعقلن، كلها جاهزة لتخدم دفاعاته ضد أن يرى وجه الشبه أصلا، وهى مؤسسات تتضخم، لتكدس الأموال، وتهدد تطور الإنسان، فيجد الطبيب نفسه – بدون وعى غالبا – أداة طيّعة للقيام بدور لم يقصده غالبا، وقد يسمى علما فى كثير من الأحيان.
لكن هناك احتمال أن يكون الطبيب قد قطع شوطا على طريق نموه الشخصى، فتنشط هذه الدفاعات بدرجة واعية نسبيا، فلا تعود دفاعات تماما، بل تتراجع ولو جزئيا إلى “بصيرة واعية” تحل محل تلك الدفاعات العامِيَة، هذه البصيرة هى التى تساعد أن تزيح الدفاعات جانبا، لنرى ما يراه المريض، ليس فقط فيه، وإنما أيضا فينا.
هذا ما يصوره المتن حين يصف دفاعات التعمية (عمَى حيسِى) وعموم الدفاعات (الحرَسْ)، حين تتحول الدفاعات اللاشعورية إلى آليات وعى مخترقة مؤلمة، تحتد بصيرة الطبيب، وتتواصل الخطوات نحو الرؤية، بشكل مقتحم من الداخل، وحينئذ لا يملك الطبيب الأمين (أو أى مغامـِرٌ نحو المعرفة) لها صدا.
إذن فإن البصيرة الفاعلة (وهى غير المعرفة المعقلنة، ولعلها عكسها) هى – غالبا – عملية مقصودة هادفة تتقرر من الداخل بوعى آخر، بعد أن تفشل الدفاعات الواعية جزئيا (حين لم تعد دفاعات صرفا)، من أن تحقق الإظلام الانتقائى التلقائى عادة، لحمايتنا من فرط الرؤية، لعل هذا هو المقصود بـ:
“قلت إدّيها عمَى حيسِى، وزوّد فى الحَرَسْ”.
فإذا تواصلت خطوات نمو الطبيب بجدية – من واقع الممارسة عادة، وياحبذا تحت إشراف متعدد المستويات – فسوف تتراجع هذه الميكانزمات، فلا يعود العمى مطلوبا ولا مفيدا، بل هى البصيرة المؤلمة الداعمة فى آن، الأمر الذى يترتب عليه أن نرى أنفسنا مثلنا مثل المريض، مع الاختلاف الجوهرى فى طريقة تعاملنا مع هذا التركيب، ومن ثـَمَّ مآله:
المعالج ينمو من خلال ذلك (المفروض يعنى)، والمريض يشفى، أو يتدهور، بحسب عوامل كثيرة. لكن تظل الرؤية والمشاركة والألم والوعى الأشمل هى بدايات محتملة قائمة عند المريض مثلما عند الطبيب فى المراحل المختلفة، ثم تتفرق الطرق ويختلف المآل، أو تتواكب المسيرة ويعاد التشكيل لكليهما.
كل هذه النقلات ليس لها توقيت معين أثناء رحلات نمو الطبيب، ففى أى لحظة، تغوص بصيرة الطبيب إلى حقيقة الجارى، فإن صدقت الرؤية، فلا رجعة كاملة فيما رأى، تماما مثلما ترى منظرا بعينيك مفتحتين، فإذا لم تتحمله، أو أردت محوه من وعيك الحسى لسبب أو لآخر، بأن تغمض عينيك عنه، فإنك تظل تراه، تعرفه، وتعترف بوجوده، مع أنك مغمض العينين.
مع تواصل أمانة المحاولة، تكفى لحظة تنوير تكاد تشبه لحظات الإلهام فى الإبداع، ويمكن أن تكون هذه اللحظة مشروطة – شعورياً أو لاشعورياً – بالتراجع عنها، لكن هذا الشرط، لو واصل الطبيب أمانته، وجهاده، لا يتحقق كاملا أبدا، فيواصل الطبيب، الكشف والتعرى، فالألم البـَنـَّاء والنمو.
قلت أَخطـَف نظره عالمَاشى واغَمَّضْ مِن جديد،
هيّه نظره – واللىّ خَلَقَكْ – لم تَنِيتْها
الرؤية التى تترتب على هذه المغامرة تشمل أكبر مما قصدتْ إليه من عمق التعرف على المريض وأحواله، وحين تحتد بصيرة الطبيب فإنه لايمكن توظيفها انتقائيا للمريض دونه إذا صدقت الممارسة، ذلك أنها عادة ما تمتد إلى مناطق وآفاق تتجاوزه هو ومريضه على حد سواء: حتى يجد نفسه مضطرا إلى ممارسة كلٍّ من:
-
تعرية الاغتراب،
-
وتحطيم الأصنام،
-
ومغامرة الكشف،
-
وحيرة المعرفة،
-
ومخاطرة إعادة التشكيل (الإبداع)…
(كل هذه مجرد أمثلة)
فماذا يقول المتن؟
بصيت لقيت الزفّه بتلف الضريح لم بطّلت، وتقول مـَدَدْ!!
بـَسّ الـَعـِـماَمةْ اتـْغـَيـَّرتْ:
والحاجات، هى الحاجات الـمِشْ حاجَاتْ.
تقديس القديم والتوقف عنده يصبح بشعا من خلال هذه الرؤية الجديدة، سواء كانت رؤية المجنون أم الفنان أم الثائر أم الطبيب الجاد المشارك، و”القديم” هنا لا يقتصر على تجمد السلف بقدر ما يصور الجمود الفكرى بصفة عامة.
كثير من المباديء الحديثة (بما فى ذلك مناهج العلم المؤسسى) قد أصبحت أديانا مغلقة، أو أصناما ثابتة، برغم تغيير الاسم والشكل
“بس العمامة اتغيرت“.
الأصنام الجديدة، والمناهج المغلقة، لها نفس قدسية القديم المـُـعـَـطــِّـل.
المشكلة هنا ليست مجرد مشكلة السلف والخلف، ولا القديم والجديد، ولكنها مشكلة الجمود ضد الحركة، علما بأننى احترم القديم بجدية كاملة، ولكن دون قبول وصايته، فهو الأب الشرعى للجديد، لكنه ليس بديلا عنه، لا جديد ذا أصالة يولد سفاحا، ولكن الاحترام والاستيعاب والجدل شىء، والتقديس والجمود والتكرار شىء آخر.
وهكذا تتمادى هذه الخبرة المغامرة حتى تصل إلى احتمال إعادة النظر فى كل شىء على أنه “هو هو”، إلا أنه أصبح “ليس هو“.
دعونا نكرر بعض المتن للضرورة:
-9-
الطبيب أصبح مهندسْ للعـُقـَولِ الـَبايْـظَهْ
(يعنى .. !!)،
واللى برضه اتْصلـَّـحـِتْ.
(الطبيب دا هوّ انا، مش حد غيرى)
اللَّهْْْ عليهْ، والسِّتْ بـِتـْمسِّى عليهْ!
والشاشةْ، والواقعْ، خـُلاصـْةِ القـَوْلِِ، مخْـتَـصَرِ الـَكـَلامْْ:
آخـِرْ تمامْْ، فـِى حَـلّ مُعـضـِلـَةِ الأنَــــامْ:
”لّما كنا نـَحـْنُ فى عصر الـَقـَلقْْ،
”نستعيذُُ بربّنا مما خلقْ”،
يبقى لازْمَـنْ كلنا نعمل حسابنا،
وِنـَـدَعِ القلقْ،
يعنى نخمد من سـُكات وانْ كان عاجبنا
علشان نعيش
ماهو كله ماشى فى الـْمــَـافـِشْ
ثم إن الحزن برضه ما لوش لزوم
طنـــِّـشْ: تعوم،
ثم إوعى انك تنام من غير لحاف
أحسن تخاف
حيث النصيحة “لا تـَـخـَــفْ”
فيها السعادة والبلادة، والحياة سكر زيادة
ثـُمَّ إنّّ اُلأُم لازِمْْ إِنـّها تراعى عـِيـَالـْهـَا
بعد ما انــْـفــُـك العقد إللى ف خيالها
يعنى تعمل زى ما بنقولــّها
مش كما طبيعتها أو من قلبها
فلقد ثبتْْ: إن الـعُـَقدْْ “وِحـْشـَةْ قوى”!!.
هـَذَا الذى قد أَظـْهـُرُه الـْبـَحـِثِ الـفُلاَنـِى،
“لمّا عدّ التانى ساب الأوَّلانى”.
ثم أوْصَى: “أنْْ يكون الكــلْْ عالْ.
إذْ لابـُدْ انّ الـُكوَيـِّسْ:
هـُوَّا أحـْسـَنْ مـِالَّذِى مـُا هـُوشْ كُوَيـِّسْ.
إمـَّاِل ايـِهْ؟”
[هذا برنامج “عفاف هانم”،
بـتسأل حضرة الدكتور ”فلان” ]
أرجو اعتبار أن مثل ذلك، وايضا ما سوف يرد فى الفقرات التالية، هو نوع من النقد الذاتى أكثر منه نقدا لأى من الزملاء. هذا تقديم واجب، فكل الأدوار التى انتقدت فيها الطبيب النفسى هى أدوار تصورتُ أننى قمت بها شخصيا فى مرحلة من مراحل ممارستى لمهنتى، مع أننى أحمد الله أن ذلك كان نادرا فى الواقع، لكن منعا للحرج أرجو اعتباره بمثابة نقد ذاتى أساسا، لا أعنى به المهنة ذاتها ولا أى من الزملاء، فالقضية فى تصورى ليست قضية تجريح لبعض الاتجاهات، ولكنها خبرة شخصية أساسا، فإذا استيقظ ما يقابلها فى نفوس بعضهم، فهذه مسئوليتهم، والذى يحكم فى ذلك أولا وأخيرا هو الوعى والمسؤولية، ومادامت مسيرة التطور الفردى ليست قانونا واحدا ملزما لكل الناس، فليتوقف من يشاء حيثما شاء، ويظل الفرد هو المسئول أولا وقبل كل أحد عن اختياره.
ربما الذى شحذ بصيرتى فأفادنى عبر تجربتى الطويلة هو أننى مارست أغلب أنواع الطب النفسى المتاح عبر أربعين عاما (ستين عاما الآن 2018) بحماس وإيمان فى كل مرحلة، فأصابنى من كل ذلك ما أصابنى، ومن ذلك تلك المرحلة القصيرة التى تعاملت فيها مع المخ البشرى كأنه آلة مصقولة متقنة، وهى الصورة التى أتصور أنها الغالبة فى كثير من ممارسات هذه المهنة حين يصفها المتن بفقرة تقول:
 “الطبيب أصبح مهندس للعقول البايظة“
“الطبيب أصبح مهندس للعقول البايظة“
هذا ما يحدث إذا ما تعامل الطبيب مع العقل البشرى كنموذج هندسى ميـْكنى، لا أكثر، ولقد تراجعت عن نقد أنه نموذج حاسوبى (كما جاء فى هوامش الطبعة الأولى) بعد أن تعرفت على الحاسوب الأحدث أكثر فأكثر، فالتعامل مع الإنسان (والمخ البشرى) كآلة ميكانيكية كمية، غير التعامل معه كحاسوب حديث، ناهيك عن كونه كيانا بشريا أكثر تعقيدا، وأرسخ تاريخا ([26])
أما أن الطبيب بدأ مؤخرا يلعب دورا غير التطبيب، ليصبح مهندسا للعقول السليمة (واللى برضه اتصلحت) فهى إشارة إلى دور الطبيب النفسى فى المجتمع الأوسع مفتيا إعلاميا متداخلا أكثر من اللازم فيما لا يقع تحت مظلة تخصصه.
الفقرة التالية كلها تنتقد الدور الإعلامى للطبيب النفسى، والشائع أننى من أكثر من يمارس هذا الدور، وبرغم تحفظى على هذا الشائع إلا أننى أرى أن ذلك أفضل من أن يظن الناس أننى أهاجم غيرى.
أول ما انتبهت إلى هذا الدور الخاص للطبيب النفسى كان فى الستينات، وكان أحد الزملاء راجعا من الخارج، وله كاريزما خاصة، وذكى، وعالم، وحاضر، وجاهز، وكان هناك برنامج اسمه “نجمك المفضل” على ما أذكر، تقدمه ليلى رستم (أو ربما أمانى ناشد، لست متأكدا)، وكنت أتصور من اسم البرنامج أن النجم لا بد أن يكون نجما سينمائيا على الأقل، وإذا بى أفاجا بهذا الزميل الفاضل، يقول كلاما مهما فى كل شىء، كان حاضرا وطيبا ومفيدا وملما بدوره إلماما كافيا، ولم أجد فى نفسى اعتراضا جاهزا، أو غيرة خفية، فى أن يقوم زميل طبيب نفسى لامع بهذا الدور المفيد، وحين جاءت دعوة لى للإسهام فى مثل هذا الدور الإعلامى، لم أجد فى نفسى مميزات زميلى هذا، فناقشت الإعلامى الطيب الذى عرض علىّ فكرة التوعية الوقائية للمشاهدين، المرحوم فؤاد شاكر (الذى تخصص بعد ذلك فى الإعلام الدينى)، عرضت عليه ألا يقتصر البرنامج على الصحة النفسية، وأن الأفضل أن نقدم معلومات علمية أساسية مفيدة يتعرف الشخص العادى من خلالها على “ما ومن هو الإنسان”، لعلنا نعرّف الناس ماهية التركيب البشرى المجهولة لدى أغلبهم، فاقتنع وجعل اسم البرنامج “الإنسان ذلك المجهول” (نفس الاسم الذى استعمله الفيلسوف الأمريكى ألكسيس كارليل)، وفعلا قدمنا سلسلة من الحلقات، تحت هذا العنوان “الإنسان ذلك المجهول”، تناولنا فيها جوانب ثقافية علمية طبية عامة وخاصة مثل: العلاقة بين الوراثة والتنشئة، و”حكمة الجسد” فى علم الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء)، إلى أن وصلنا إلى العلاقات البشرية (اختصاص الطب النفسى) بشكل أو بآخر.
منذ هذا التاريخ فى أوائل الستينات، وحتى حين قبلت أن أقدم البرنامج الأحدث “مع الرخاوى”، فى قناة جديدة اسمها “أنا“، (من تاريخ 5-6-2007 إلى 17-11-2007) وهو برنامج يهدف إلى نقد القيم السائدة، وإعادة التعرف عليها، وأنا أحاول ألا أعتذر عن أداء دورى الإعلامى هذا، وفى نفس الوقت ألا أنساق لما أنتقده الآن.
ما بين هذين التاريخين وبعدها لم أرفض أن أشارك فى برنامج إذاعى أو تليفزيونى إلا نادرا، وأحيانا وصل بى رفضى لما أنتقد الآن أن انسحبت من برنامج كان يذاع على الهواء، أذكر أن البرنامج كان اسمه “ماسبيرو”، ولعل اسم المقدمة الفاضلة كان “شافكى”، وكانت الحلقة على الهواء عن “أعداء النجاح” حدث فيها – رغما عن المقدمة ربما بسبب طيبتها – ما لم أتمكن من مواصلة البرنامح للإسهام فى تصحيح ما قاله أحد الضيوف “الناجحين” افتخارا بإنجازات سيئة وصفها بأنها علمية!! ولما افتقدت فرصة التصحيح وهو ما تصورت أنه لا يجوز أن يصل إلى الناس فى وجودى هكذا، حيث إن بقائى كان يعنى أننى مشترك بشكل غير مباشر فيما يقال، ويضر (من وجهة نظرى)، احتججت فى نفسى وقررت الانسحاب، وزعمت أننى قد أصابنى طارئ صحى أثناء التسجيل، وانسحبت فعلا – على الهواء – أمام كل المشاهدين، وانتهت المهمة وأنا فى حيرة: إذن لماذا أقبل الإسهام فى هذه التغطية الإعلامية هكذا “عمال على بطال”؟!!
فيما عدا مثل هذه الحادثة النادرة، لا أذكر أننى اعتذرت بلا عذر حقيقى، كنت أذكر قول أفلاطون فى مقدمة الجمهورية، (من الذاكرة) أن عقاب من يتخلى عن مسؤولية الريادة أو القيادة أو التوجيه العام، هو أن يتولى الأمر من هو أقل فائدة وربما أضر أثراً ليس معنى هذا أن زملائى أقل قدرة على الترشيد والتثقيف والتوعية، لكن هذا كان هو التبرير الذى أقنع به نفسى معظم الوقت.
كل هذه المقدمة وجدتها ضرورية قبل أن أعود إلى المتن والشرح؛ لأن المتن فيه سخرية لاذعة – مرة أخرى – أرجو ألا تصيب إلا شخصي.
نفسنة ([27]) الحياة المعاصرة
بصراحة، كلمة “نفسنة” ليست الترجمة الدقيقة لأصل الكلمة التى وصلتنى بالإنجليزية وهى Psychiatrization، وأنا استعلمها هنا لأنبه كيف أن الإعلام عندنا، قد بالغ فى حشر آراء الطب النفسى (وعلم النفس) فى كل أمور الحياة تقريبا، من أول السياسة، حتى الجريمة، مرورا بالتربية، والرياضة، والأسعار، والموضة، والدين، والعنف، واختيار الوزراء، ولون حجرات النوم، ومائدة الطعام، والاستخارة، وسخرية عادل إمام مقارنة بخفة دم إسماعيل يس، وسيكولوجية ركاب مترو الأنفاق… إلخ.
احتاج الأمر منى الآن وأنا أشرح هذا المتن أن أتوقف فى محاولة أن أصنف ما أتجنب أن أقوله وما قد يقوله بعض زملائى بحسن النية فى مثل هذه اللقاءات فوجدت أن أغلبها يمكن أن تندرج تحت ما يلى:
1) بديهيات لا تحتاج إلى رأى أصلا، (وليس بالضرورة رأى علم النفس أو الطب النفسى) مثل أن “الجريمة لا تفيد”، أو أنه “على الأب أن يكون قدوة لأولاده جدا جدا”!!
2) تحصيل حاصل قد يأخذ صفة نفسية، لكنه لا يضيف، مثل أن الطالب الذى ينتبه إلى الدرس جيدا، يحتاج مجهودا أقل لمذاكرته (أى والله)!
3) شجب أخلاقى للشر بأشكاله، مثل أن الغش لا يصح، وعيب!،، لأن من يغش إنما يغش نفسه، وهذا ليس من الصحة النفسية فى شىء!!!!!
4) نصائح عادية مسطحة يقولها أى واحد فى أى مناسبة (دون حاجة إلى أن يكون مختصا فى النفس، ولا فى غير النفس)، مثل: إنه على الزوجين أن يجتهدا فى حل مشاكلهما معا بالسلامة.
5) نصيحة نفسية معادة (حتى لو كانت روجعت وثبت عدم جدواها) مثل النصيحة الأشهر “دع القلق وابدأ الحياة” (انظر نقدها فى المتن السابق ص66 ).
6) فتاوى سياسية بلغة نفسية، مثلا: تبرر السلام مع إسرائيل، أو تشجبه (كله ينفع).
7) وضع لا فتة تشخيصية على شخص نشرت حكايته فى الإعلام، دون لقاء هذا الشخص أو فحصه، ودون استيفاء المعلومات اللازمة، ودون التأكد من مصداقية المحرر الذى نشر الخبر، ودون عمل حساب تأثير هذه اللافتة النفسية عليه أو على ذويه، أو على من هو مثله.
8) الحكم على مسئولية متهم ارتكب جريمة غريبة، أو نادرة، أو مستهجنة جدا، لم يبت فيها قضائيا بعد، دون فحصه مباشرة، أو ملاحظته، أو الاطلاع على ملفه.
9) ترديد توصيات نابعة من ثقافة غير ثقافتنا، فى سياق لا يناسبها، مثل الكلام عن الحرية وحقوق الطفل، بنفس الألفاظ والتوصيات التى تتردد فى ثقافات أخرى، ولصق الصفات النفسية، وعبارات المديح بهذه التوصيات لمجرد أنها مستوردة.
10) التوصية الأكيدة بضرورة الذهاب إلى الطبيب النفسى للاستشارة (والعلاج) “عمّال على بطّال”، فى أمور الحياة العادية التى غالبا لا تحتاج لمثل ذلك.
11) تشريح شخصية بعض الفناين أو الفنانات بما يحب أن يسميه الإعلاميون “تحليل نفسي”، دون لقائهم، وبأقل قدر من المعلومات، وغالبا دون إذن منهم.
12) لصق اسم مرض خاص (أو صفة مرض عام، مثل الجنون) ببعض رؤساء الدول الذين يمارسون سوء استخدام السلطة فى الحرب أو السلم، وكأننا لا نعرف أننا بذلك نلتمس لهم العذر (مـَرْضـَى بقى!!) ليواصلوا قتل واستغلال الأبرياء والضحايا.
……….. وغير ذلك كثير مما هو مثل ذلك.!!
هوامش محدودة:
بعد كل هذه المقدمة الطويلة، وجدت أن المتن أوضح من أن أضيف إليه شرحا آخر، اللهم إلا ما تصورت أنه يحتاج إلى التذكرة من جديد، مثل ما يلى:
1- تجنب الإلحاح فى ترديد أنه “دع القلق وابدأ الحياة”،
ثم إنك – بعد ذلك: لمْ لا بدْ انك تسيب هذا “القلق”، علشان “تعيش”
دون اتهام الكتاب الأصلى لديل كارنيجى بالمسئولية الكاملة عن سلبية تـَلـَقـِّى هذا المفهوم، الذى هو من أشهر ما يجرى بين الناس على أنه غاية المراد لتحقيق ما هو صحة نفسية، وقد كررت طويلا أن البديل الحقيقى هو “عش القلق، واقتحم الحياة”.
2- إشاعة أن ثم شىء اسمه “الاكتئاب القومي”، وأن الحزن مرفوض من أساسه، فهى إشاعة تروّج مفاهيم سطحية، مسخت عاطفة شديدة العمق والدلالة مثل الحزن.([28]). ثم أنها تشوه الوعى القومى بشكل أو بآخر.
3- الترويج السطحى ضد الخوف المشروع، كثيرا ما يتكرر فى الإعلام، الأمر الذى انتقدته حتى فى أرجوزة للأطفال عن الخوف، لا أكتفى إزاءها بالإشارة إلى موقعها فى الموقع برابط، وإنما أقتطف منها ما يلى:
 قالوا يعنى، بحسن نيةْ: “لا تخف”
قالوا يعنى، بحسن نيةْ: “لا تخف”
دا مافيش خطرْ
طب لماذا؟
هوا يعنى انا مش بشر؟
إنما احنا نقولَّك: “خافْ وخوِّف” !
فيها إيه؟
لو ماخفتش مش حاتعمل أى حاجهَ،
فيها تجديد أو مغامرة
لو ما خفتش مش حاتاخد يعنى بالكْ،
حتى لوْ عاملين مؤامرة
لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للبر دُكْهَهْ
خايف انْ تْبِلّ شعركْ
لو ما خفتش يبقى بتزِّيف مشاعرك
بس برضه خللى بالك
إوعى خوفكْ
يلغى شوفكْ
………………
إوعى خوفك يسحبك عنا بعيدْ، جوّا نفسك
إوعى خوفك يلغى رقة نبض حسك
4- استشهاد الإعلام، وبعض النفسيين، بما ينشر هنا وهناك من أرقام ونسب مئوية لكثير من الأبحاث (بعضها أو كثير منها مستورد)، الأمر الذى يتكرر بشكل متواتر، وكثيرا ما ينساق الطبيب النفسى إلى تفسير هذه الأرقام وكأنها حقائق مسلمة، دون (أو قبل) مناقشة مدى مصداقيتها، أو نوع العينة التى أجريت عليها وهل هى ممثِّلة لما تشير إليه أم لا؟ … إلخ … إلخ.
(هـَذَا الذى قد أَظـْهـُرُه الـْبـَحـِثِ الـفُلاَنـِى،
لمّا عد التانى ساب الأولاني،
ثم أوصى: “أنْْ يكون الكــلْْ عالْ…الخ).
*****
استمرار وصف أدوار يلعبها الطبيب النفسى
-10-
وساعات أشوفه مـِطـيّباتى مُـعْـتَبـرْْ،
آه يا حلاوتـُهْ وهـُوَّا بِيـْلبِّـسْ خـُدُوُدهْْ الإبْـتسَامةْ،
أو لمّا بِيْـشَـَخـْبـَطْْ ويكتبْلَكْ حـُبـُوبْ “منعْْ السآمـة”،
أو لما يْوصف حقنة المُـحـَاياة تقوم تمسح مشاعرك “بالسلامة”.
-11-
وساعات أشوفنِى كما “الأغا”
بيضحّـك المَـلِكة، ويُستعمَـلْْ من الظاهرْْ، وبَــسْ.
انطلاقا من المتن:
من أقبح الأدوار التى قد يضطر اليها الطبيب النفسى – أو قد يتمتع بها إن شاء – هو ما تصورت نفسى فيه أحيانا بالنسبة للمرفـَّهات من بنات الذوات (القدامى، والمحدثات معا) حين يحضرن للفرجة علىّ، أو للدردشة، أو ‘للوِنْسَه’، أو لقضاء وقت مع نجم “تلفزيونى” – مقابل مبلغ الكشف – أو لمعاينة اسم معين وجها لوجه، ربما للتأكد من خفة دمه، أو للكشف عن ما وراء تجهم وجهه، وكنت عادة اضطر من منطق العقل والذوق والمجاملة والتكيف وآداب المهنة أن أجارى مثل هذه النوازع، فطالب الاستشارة الأولى له هذا الحق مهما كان الدافع إلى الاستشارة، فأجدنى فى حيرة وأنا أحاول أن أحدد دورى أكثر فأكثر قبل أن أستثار. لكن، والحمد لله، تكون مثل هذه الزيارة هى الأولى والأخيرة، فنادرا ما أضطر للصبر على زائرة أو زائر من هذا النوع أكثر من مرة واحدة، وهو كذلك، نادرا ما يصبر علىّ، وقد استنتجت من هذه الخبرات أن ما يحدث هو أن مثل هذه العلاقة العلاجية – إن كان لها أن تسمى كذلك أصلا– تنتهى بمجرد نهاية استكشاف الاستطلاع أو الفرجة، أنا ليس من حقى أن أشجب من يستطيع من الزملاء أن يقدم خدمات لهذا النوع من طالبات وطالبى الحاجة ما داموا قد سألوه المشورة، ولكننى كنت أعجز عادة أن أواصل.
حاولت عدة مرات، وقد أكرر هذه التيمة كثيرا، أن أبين الفرق بين العلاج وبين “الترييح”، كما يشاع عن الطبيب النفسى أن: “الطبيب لازم يريّـح المريض”، الطبيب يعالج، ومن ضمن علامات نجاح العلاج أحيانا أن مريضه يرتاح، لكن لا ينبغى أن يكون الهدف تماما ودائما هو “إرضاء الزبون”، فالزبون هنا بوجه خاص ليس “دائما على حق”، وقد يصل الأمر إلى استعمال الطبيب من جانب المريض تبريرا لسلوك سلبى باعتبار أن المريض ليس مسئولا جدا عما يفعل، طالما هو مريض ولا مؤاخذة.
يندرج تحت فكرة “الترييح” ما جاء فى المتن: إعطاء حبوب منع السآمة، (لمضادات الاكتئاب مثلا). حين صار الحزن مرفوضا من أساسه بفضل الإعلام الطبى المسطح – تحت تأثير شركات الدواء – وبالتالى أصبح التخلص منه بأسرع ما يمكن هو هدف العلاج فى كثير من الأحيان، لن أكرر الحديث عن إيجابيات الشعور الجاد بالألم النفسى، لكن السائد فى معظم الممارسات هو الإسراع بالتخلص من الحزن ما أمكن ذلك. النتيجة ليست فى اتجاه أن تحل الفرحة الحقيقية محل هذا الحزن المـُـزاح، ولكن أن يحل نوع من الطمأنينة التى كثيرا ما تكون ماسخة ولا تتناسب مع الجارى، حتى تصل إلى درجة من اللامبالاة، وربما هذا ما يعنيه المتن: “تمسح مشاعرك بالسلامة”
أعرف الردود على كل ذلك، وأحترمها، وأرفضها من واقع الممارسة.
مرة أخرى.
عودة إلى الفتاوى النفسية:
-12-
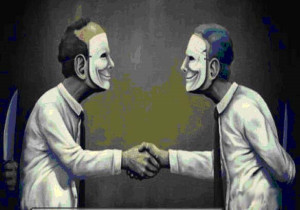 وساعات جنابه يلف أحكامه ف زواق، مش أى “حاجةْ”.
وساعات جنابه يلف أحكامه ف زواق، مش أى “حاجةْ”.
يفتى كما قاضى الزمان وكأنه جاب المستخبى، يقولك انك :
”لا تخَفْ”!ْ! و”دع القلق”، “بـطـّلْ سماجة”،
”كُـنْ منافقْ”، يعنى “جامِلْ”، “مَشِّى حالَك”.
تبقى ماشى فى السليم، مهما جرالكْ.
والعواطف تـِتـْشـَحـَنْ جوّا العيونْْ زى البضاعـَهْ.
(كل ساعةْ نُصّ ساعةْ).
”يعنى إيه ؟!؟”
”.. مشْ مُـهِـمْ”.
لا يحتاج هذا الجزء- أيضا- من المتن إلى مزيد من الشرح أكثر مما جاء سابقا فى فقرة “نفسنة الحياة المعاصرة“، فقط ننبه هنا على الفرق الحساس بين ما يسمى “ضرورة التكيف” مع المحيطين والواقع بما يتجلى فى مظاهر المجاملة المباعِدة ما بين الناس خوفا على مشاعر بعضهم مما يندرج تحت عناوين مثل الذوق، والرقة، والسلوك المتحضر وكلام من هذا. الحد الفاصل بين التعامل الحضارى، وبين النفاق الدمث، لا يمكن تمييزه بسهولة، وأيضا الحد الفاصل بين الوقاحة والاقتراب المغامر للمصارحة هو أيضا لا يمكن تمييزه. هذا بالنسبة لما يجرى فى الحياة العامة، فكيف يكون الحال فى مجال ممارسة الطب النفسى والعلاج النفسى؟
لا بد أن توضع الاختلافات الثقافية هنا فى الاعتبار بشكل متزايد، ويمكننى بهذا الصدد أن أصف عشرات المستويات بالطول والعرض، التى تختلف فيها المسافة، واللهجة، وعلو الصوت، وحسم وضع شروط العلاج، واللوم على عدم الامتثال للتعليمات بما فى ذلك تعاطى العقاقير، كل ذلك يختلف بين ثقافة وثقافة، وصولا إلى الثقافات الفرعية، كما يختلف بين مريض ومريض.
فى ثقافتنا بصفة عامة، الطبيب والد، والوالد مسئول، وهو فى مرحلة باكرة يحمى ويحيط، بقدر ما عليه أن يقتحم لينقذ، وأغلب مرضانا يعطوننا فرصة حقيقية وعميقة لكل ذلك ثم تضطرد مسيرة النمو.
المبالغة فى الالتزام بقواعد السلوك المهنى الشائعة، أو المستوردة، قد تكون سلبية تحت عنوان الموقف المحايد، أو الحرية المسطحة.
ثم ينتقل المتن إلى موقف نقدى “عام”
-13-
والجنازه زفّهْْ تـُرقـُصْ عالسـَّرَايـِرْ –
فى البيوت اللى حوالِـيـهـَـا الستاير.
واللى خايفْ من خيالُهْ،
واللى خايفْ مـاِلـْعـَسـَاكـِرْ.. والرقيب،
واللى بيوزَّعْ تذاكر يا نصيبْْ،
واللى بيفَرَّق دوا “ضـِدَّ الذنوبْ”،
واللى ماشـى يـشـق فى بطانة الجيوب.
والعرايضْ، والجرايدْ،
 واللىَّ بيرصُّوا الكلامْ؛
واللىَّ بيرصُّوا الكلامْ؛
“قفْ مـَكـَاَنكْ، أو تــأخـَّرْْ لـْلأِمـَامْ”!
بخَّرُوا سـِيـْدنـَا الإِمـَامْ”
“سرْ، بضـَهـْرَكْ…”
والـَعـَرقْ؟: إلكُـوزْ بـِكـَامْ؟..”
لا أجد مبررا لشرح نصوص هذا المتن التى لا تحتاج إلى شرح أصلا، خاصة حين تبتعد عن سياق التطبيب والمعالجة، فهذه الفقرة – مثلا – تكاد تكون نقدا اجتماعيا وسياسيا صريحا ومباشرا أكثر منها عرضا لما هو خاص بالمرض النفسى والعلاج النفسى.
تكفى هنا الإشارة إلى أن المرض النفسى، الذى هو بالتعريف الأصلى نوع من الاغتراب عن الواقع، هو فى ذاته، خاصة فى بدايته، إعلان لرفض هذا الاغتراب المتمادى فى الحياة المعاصرة المكررة النمطية الباردة، حين يشتد الاغتراب فى الحياة العادية النمطية، وتهمد الحركة إلا المـُـعـَـاد منها، تصبح الحياة هى والموت سواء، ولا يبقى منها إلا حركة معادة، قد تبدو نكوصية رافضة، وكأن هذا الرقص هو استعمال جسد زائط، دون حيويته وتلقائيته، المريض لا ينخدع بهذا الرقص نكوصا، وحين أتقمصه، أفهم رؤيته لهذه الأجسام الزائطة، جثثا تتنطط وراء ستار رؤية غائمة، (والجنازة زفة ترقص عالسراير).
فما هى حكاية “الستاير”؟
من بين أهم ما يكسره المريض العقلى بالذات (المجنون بثورته برغم أنها مـُـجهضة!!) هو ذلك الساتر الكثيف الذى يغطى داخلنا عن بعضنا، نتيجة لخوفنا من حقيقة داخلنا، (اللى خايف من خياله – البيوت اللى حواليها الستاير) وأيضا الخوف من القهر المحتمل من خارجنا، (واللى خايف مالعساكر والرقيب).
ألعاب وجوائز الحظ فى المجتمعات الكسولة والاعتمادية تقوم أيضا بدور سلبى متزايد (واللى بيوزَّعْ تذاكر يانصيبْْ)، حتى يصبح الاعتماد على الحظ من علامات الاغتراب بشكل أو بآخر، حين تفرط السلطات والمجتمع فى التأثيم والمبالغة فى التركيز على عقاب الذنوب من أول عذاب القبر إلى ما لا يمكن تصوره، تنشأ آلية تكفيرية، استغفارية، اعترافية، قد تقوم بدور التخفيف قليلا أو كثيرا، لكنه دور تسكينى فى النهاية، ويعتبر التنفيث والتفريغ والاعتراف للطبيب النفسى من بين هذه الآليات “واللى بيوزع دوا ضد الذنوب”، إلا أنه ليس هو دوره الأساسى، أحيانا يكون مجرد الذهاب إلى الطبيب، و”الاعتراف له بما جرى، ناهيك عن ما يجرى” هو نوع من التماس عذر مقبول (– مريض بقى!!– ) للتمادى فى نفس الممارسة المتجاوزة التى اعترف بها للطبيب، وكأنه بذلك: “عمل اللى عليه” هكذا يجد الطبيب نفسه يُستعمل لتبرير السلبيات شعوريا أو لا شعوريا، ومن ثم التمادى فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما الذين “يرصـُّون الكلام” فلا مبرر للإطالة فى الحديث عن الدور السلبى للخطب، والبيانات، والشعارات، والإعلام، إذا ابتعد كل ذلك عن الفعل المـُـثـْمـِر على أرض الواقع، واستعمل للتأجيل أو التبرير أو التفريغ، كل هذا أصبح من أقبح تجليات الاغتراب فى المجتمع المعاصر، وهو ما يكشف عنه لسان حال المريض هنا، وعلى الطبيب ألا يكتفى بأن يشجبه من حيث المبدأ، بل أن يشترك مع المريض فى رفضه، بطريقة أخرى، (غير الصياح) السياسى، وغير المرض، طريقة لا تسمح للمريض بالتمادى فى أية هزيمة فردية (المرض)، ودون خروج عن الدور الأساسى لممارسة المهنة إلى دور السياسى أو المصلح الاجتماعى أو الواعظ.
أما ما يجرى من ادعاء التقدم بالألفاظ والتقليد الأعمى دون تقدم حقيقى، “محلك سر”، فهو التأخر بعينه، وهو إشارة إلى حالة كوننا نتبع كل متسلط طاعة وتقديسا:
”قفْ مـَكـَاَنكْ، أو تــأخـَّرْْ لـْلأِمـَامْ”!
بخَّرُوا سـِيـْدنـَا الإِمـَامْ”،
“سرْ بضـَهـْرَكْ…”
ثم تـُخـْتـَم هذه الفقرة بالتنبيه إلى قضية بديهية تفضح الاستغلال المباشر للجهد البشرى لصالح الإثراء والتسلط، وأعتقد أن هذا النص القائل:
“والعرق الكوز بكام؟”
وهو غنى عن الشرح كما يبدو.
مرة أخرى: الطبيب النفسى ليس سياسيا، ولا مصلحا اجتماعيا أو داعية دينيا منوطا به إقامة العدل، ورفع الظلم، لكن المريض لا يدعه فى حاله، فهو ثائر (برغم فشله وخيبته) يحتج على ما ينبغى الاحتجاج عليه، وهو يلقى فى وجه الطبيب بقضايا حقيقية تستحق الاحتجاج، بل الثورة، لكنه – المريض – لا يتحمل مسئولية هذه الثورة، ومهما رأى الطبيب فشل مريضه فى إكمال ثورته، فإن هذا لا يعفيه من تحمل مسؤولية ما وصله حتى لو كان مريضه لا يتحملها، من هنا يصبح تبنى قضايا المريض، أو القضايا العامة التى أثارها المريض، هو ضمن امتحانات أمانة الطبيب فى اختبار مشاركته الإيجابية، ليس فقط فى مساعدة مريضه أن يشفى، وإنما فى القيام عنه، وربما معه لاحقا، بمواجهة السلبيات العامة (مع الخاصة) بشكل أو بآخر بحسب الفرص المتاحة.
تبدأ المواجهة بالرؤية، ثم مِنْ كُلٍّ بحسب ما يقدر على التغيير، احترام مبررات احتجاج المريض النفسى على كل هذا الظلم والاغتراب تجرجر الطبيب إلى أدوار خارج نطاق مهنته بدرجة أو بأخرى، وهو ليس مـُطـَالب بالقيام بدور عملى فى رفع الظلم العام أو إحقاق العدل أو ما شابه، لكنه ليس من حقه أن يختبئ تماما داخل حدود مهنته، لا فرط الحماس دون أدوات الثورة الحقيقية مطلوب أو مفيد، ولا الانسحاب المهنى التخصصى مقبول على طول الخط، لو حدث هذا الاحتمال الأخير، وتخلى الطبيب عن مشاعره التلقائية الطبيعية البسيطة سوف يجد نفسه فى مأزق شخصى إن كان على نفسه بصيرا، ذلك أنه إذا تمادى فى فصل مهنته عن الهمّ العام، والمسئولية، فسوف يصبح عرضه للاستغلال من جانب نظريات وتشكيلات ومؤسسات سلطوية تجارية قهرية شركاتية دوائية!! كلها فى خدمة ما هرب منه المريض، ثم راح يستنقذ منه بمرضه ثم بطبيبه بشكل أو بآخر.
حين يمارس الطبيب دوره بهذه الأمانة والمسئولية، سوف يجد نفسه فى مأزق يتجدد مع كل مريض تقريبا، وكأن المريض إذ يلقى بهذه القضايا – الحقيقية – فى وجه الطبيب، يكلفه ضمنا بأن يكمل طبيبه المشوار الذى عجز هو أن يكمله!!! أو أن يشتركا فى ذلك بطريق غير مباشر.
وبعد
أَمَّا صورهْْ مـُرْعـِبـَهْ يا خـَلـْق هـُوهْ.. إلحـَقـُونـِى.
قـُلـْت غـَلـْطـَانْ والـنـَّبـِى يا نـَاسْ سـِيـُبونـِى.
قلت اغـَمَّض تـَانـِى حـَبـَّهْ صـْغـَيـَّرِينْ،
.. لمْ قِدِرت.
طبْْ حا فتّح ليه يا عـَالـَمْ؟ هيـَّا فُرْجـَةْ !!!
بصّ لىِ “صاحـْبـَك” ولعَّبْلىِ حواجـْبـُهْ،
قال: وقِعْت.
والقلم كـَمّل كإِنى لم وِقفت:
عودة إلى بداية هذا العمل كله
نذكر كيف أعلنت منذ البداية أن حاجتى – القهرية تقريبا – لنقل ما وصلنى ويصلنى من المريض إلى عامة الناس، هى التى تجعل من البوح والكتابة إلزاما عبـّرت عنه باستقلال قلمى عنى، ومواصلة انطلاقه ضد كل المحاولات التى أحاول بها أن أثنيه عن ذلك.
بدأ المتن كما نذكر بهذه الصورة:
“كل القلم ما اتقصف يطلع له سن جديد”،
هكذا نقرأ بداية المتن والقلم يتحدى، ويحدد الرؤية التى لا تريد أن تختفى، ليبلغها إلى أصحابها.
سبق أن أشرنا إلى استحالة محو الرؤية التى رآها المريض فرآها الطبيب من خلاله، والتى تعود هنا لتعلن بشكل آخر:
“قلت اغمض تانى حبة صغيرين،
لمْ قدرت”
شرحت سابقا كيف أن الصورة التى تصل للعينين لا تختفى بمجرد إغلاق الجفنين، وها نحن نجد تجليا ثانيا يؤكد هذا التفسير.
“القلم” هنا لا يمثل مجرد التعبير والتنفيث والإبلاغ، وإنما هو الإعلان الظاهر عن وعى داخلىّ، يحول دون الطبيب والاختباء فى مهنته، هذا الوعى هو الذى يشير إليه المتن بـ”صاحبك”:
“بصّ لى صاحبك ولعب لى حواجبه، قال وقعت“.
وهكذا تصبح هذه الرؤية المشتركة هى قضية الطبيب حتى ولو لم يتحمل مسؤوليتها مثيرها الأول (المريض)، فيكفيه أنه حرّك أمام وعى الطبييب واقعا ماثلا يحتاج موقفا إزاءه، واقعا لا ينقصه إلا حفز التغيير أو حتى البدء به، أما أضعف التثوير فهو إعلانه هكذا.
وربما هذا ما يقوم به هذا القلم الذى عجزت عن كبح جماحه، فماذا وصف القلم بعد أن اقتحم الحواجز الواحد تلو الآخر، وأزاحنى المرة تلو المرة؟
العلاج النفسى مدرسة (سياسية) أيضاَ!!
-15-
بقى دى حياتنا يا ناسْ، وِآخْرِةْ صبرنا؟
الحياهْْ؟ نـُقـْعد نـِـحَـكِّـى لبعضـِنـَا؟
الحياهْْ؟ نُقْعد نـِحـِسْ، نـِبـُصْ، يـِتـْهـَيـَّأ لـِنـَا؟
طب واحنا فين ”دلوقتى” حالاً “أو هنا”؟
دى المركب الماشـْيـَهْ بِلاَ دَفّهْ ولا مـِقـْلاعْ حَاتُشْرُدْ مِنـّنَا،
واوْعَى الشـُّقـُوقُ تـِوْسـَعْ يا نايم فى الـَعـَسلْ،
لا المَّيهْ تِعْــلَى، تزيدْْ، تزيدْ،
تداخل الخاص والعام وملامسة السياسة:
من هنا حتى آخر هذا الجزء الأول تتجلى الوصلة بين ما يمكن أن يسمى “ممارسة العلاج النفسى” والمسئولية السياسية على المواطن العادى، وقارىء النص فى هذا الجزء الأخير يمكن أن يـَـقـْـرَأ نقدا للعلاج النفسى عامة، كما يمكن أن يقرأه نقدا للذين يمارسون النضال السياسى من على الكراسى الوتيرة فى مقاهى تجمعاتهم أو حتى لجان لقاءاتهم، وأيضا يمكن أن يقرأه باعتباره موقفا سياسيا عاما.
إذا كنا قد نبهنا إلى ضرورة حُسن الاستماع إلى معنى ومغزى وهدف ما يقوله المريض النفسى باعتباره احتجاجا على الاغتراب السائد، وعلى تفريغ الكلام من محتواه، وعلى الحياة الفاترة القاهرة لأى إبداع أو تجديد، سواء فى محيطه وفى امتداده إلى الدوائر الأوسع، وبالرغم من ذلك فقد بينا كيف أن المريض فاشل فى إكمال آثار هذه الرؤية فانقلبت ثورته إلى الصياح (بالأعراض) أو الانسحاب (بالانزواء) أو التفسخ (بالجنون)، إذا كان كل ذلك كذلك فعلينا أن نبادر بالتعلم من بداياته دون نهاية محاولته، بمعنى أن علينا أن نتعلم منه ليس فقط ماهية الحياة وأصولها الفطرية السليمة وكيف تفشل، ولكن أيضا نتعلم سلبيات المجتمع الذى اضطره إلى هذا الاختيار الفاشل فى النهاية، ثم نواجهه معا.
النص هنا يعلن بوضوح ومن البداية أنه “لا” .. “لا” .. وهو يشجب المكلمة السياسية (حتى لو أخذت شكل العلاج) بضربة واحدة كما يشجب موقف المثقفين والتحليليين النفسيين معاً.
وأخيراً هو يصرخ ويحدد اقتراب الخطر .
بقى دى حياتنا يا ناسْ، وِآخْرِةْ صبرنا؟
الحياهْْْ؟ نـُقـْعد نـِـحَـكِّـى لبعضـِنـَا؟
البيت الأول ينبه إلى أنه للصبر حدود!!
أما البيت الثانى فهو يحذر من المـَـكـْـلـَـمات السياسية والعلاجية بشكل عام كما تجرى فى المناظرات اللفظية سواء فى النشاط السياسى مع وقف التنفيذ، أو فى مـَكـْلـَمـَات ثلل المثقفين جلوسا، وأقرب تسمية لهذا الاغتراب الناقد الذى يحل محل الاغتراب السائد هو المصطلح “مـُكـْلـَمـَة” ولا أذكر من الذى ابتدعه، ولعله صلاح جاهين.
أما فى العلاج النفسى فالكتاب الثانى بأكمله هو مخصص لنقد العلاج الكلامى إذا انقلب إلى “مـُكـَلـَمـَة”
ثم يقفز المتن إلى العلاج الجمعى وما يوازيه (بسرعة خاطفة) حين يتساؤل مستنكراً:
الحياةْْ؟ نُقْعد نـِحـِسْ، نـِبـُصْ، يـِتـْهـَيـَّأ لـِنـَا ؟ !!
من المضاعفات التى نحذر منها فيما يتعلق بالعلاج الجمعى هو أن ينقلب الأمر إلى التأكيد على تبادل المشاعر والأحاسيس للتقارب لتنمية الوعى الجمعى، لكن الذى يحدث فى بعض الأحيان أو الكثير من الأحيان، هو أن المسألة تتوقف عند هذه المرحلة حتى لو جرى التأكيد على الالتزام بقاعدة أنا <==> أنت، “هنا والآن”، والالتزام بهذه القواعد فى العلاج الجمعى ليست نهاية المطاف، ولكنها تنشيط لمستويات الوعى، للانطلاق من الرؤية إلى إبداع الذات باتخاذ قرار التغيير (ليس بالضرورة على مستوى عقلى شعورى معلن)، فإن لم يتحقق ذلك فإن مجرد تعميق الاحساس بما فى ذلك الاحساس الصادق والموقف النقدى المتميز، قد يرتقى بموقع الجماعة النمائى لكن بدلا من أن يصب فى المجتمع الأوسع فإنه قد يفصل المجموعة عن المجتمع وكأنها مجموعة متميزة أرقى إحساسا وأعمق وعيا، فإذا توقف الحال عند هذه المرحلة فهى مضاعفة سلبية وليست خطوة نمائية، أو إبداعية، وها هو المتن يرفضها متسائلا بسخرية:
الحياهْْ؟ نُقْعد نـِحـِسْ، نـِبـُصْ، يـِتـْهـَيـَّأ لـِنـَا؟ !!
طب واحنا فين ”دلوقتى” حالاً “أو هنا”؟ !!
إذن: فإن مجرد تعميق الاحساس وشحذ البصيرة لا قيمة لهما إلا إذا كانا دافعا إلى الوعى باللحظة الراهنة وما ينبغى أن ينطلق منها، وهنا تلوح الحاجة إلى أن ينقلب الإحساس تخطيطا وتنظيميا (أيضا على أى مستوى من الوعى) له قائد وغاية ومسار (عادة بالتبادل بين مستويات الدماغ والوجود).
واوْعَى الشـُّقـُوقُ تـِوْسـَعْ يا نايم فى الـَعـَسلْ،
لا المَّيهْ تِعْــلَى، تزيدْْ، تزيدْ،
.. مّيةْ عطَنْ، تـِكْسِى الجلودْ بالدَّهْنَنَه،
وتفوح ريحتـْها تِعْمِى كلِّ اللـى يحاولْْ يـِتلـِفـِتْ ناحيةْ “لمـِاَذاَ”،
أو “لمعنى” يكون ما جـَاشِى فى”الكـِتـَابْ”،
أو لـِلـِّى “جـُوَّه”،
أو نـَواحـِى “ربنا” !
(الرحمهْ يارب العباد: إغفرْ لنِا).
ثم يتواصل الإنذار بتصور ما يمكن أن يؤول إليه الفرد، (والمجتمع) من تشقق فى بنيانه، وتبلد فى أحاسيسه وعمى فى بصيرته، لست متأكدا أيهما أكثر اغترابا ونكوصا، الشقوق التى تعلن تصدع المجتمع وانفصال الناس عن بعضهم البعض أم العمى الذى يمنع الرؤية ويبلد المشاعر ويشل حركية الإبداع، المتن هنا لا يحذر من غرق المركب التى تشققت بقدر ما ينبه إلى لزوجه المشاعر التى تخثرت، والنتيجة هى قهر الأفكار، ورفض التساؤل ووأد الإبداع وتجميد البحث.
تِعْمِى كلِّ اللـى يحاولْْ يـِتلـِفـِتْ
ناحيةْ “لمـِاَذاَ”،
أو “لمعنى” يكون ما جـَاشِى فى”الكـِتـَابْ”،
أو لـِلـِّى “جـُوَّه”،
أو نـَواحـِى “ربنا”!
-16-
واللعب دايرْْ ليلْْ نهارْ لمْ يـِنـْقطعْ،
والسيركْ صـَاحْــبُه واقفْلِى بْيِلفّ العـَصـَا
ويقول بعزّ مـَا فـِيهْْ: أهو دا اللى ممكن، واللِّى عاجبهْ!
كل ذلك، والقائمون على إدارة المجتمع برغم كل اغترابه وعطشه وعماه، يواصلان تعميق القهر بمزيد من السيطرة “واللى عاجبه”
-17-
أنا مش عاجبْـنى هِـهْْ، ولازْمَـنْ يِتْحَكَى،
كل اللى جارى.. لاجْل ما الناس تنتبه قبل الطوفان،
للناس..، لكل الناس حا قول.
رد الجميل للطير بـِيـْنزِفْْ مِِ الأَلـَمْ قـُدَّام عـُيـُونى.
قالوا “مريض” لكنه أستاذ الأساتذة كلهم:
علّمنى أشـُوفْْ. علّمنى أَصـْحـَى.
علـّمنى ضـَربْ النار، بكلمةْْ صدق طالعهْْ مولـَّعـَةْ.
تحرق عبيد الضَّلمة والتفويت وشـُغـْل الهـَمـْبـَكـَةْ،
وتْنوَّر السكة لإخوانِ الشـَّقـَا،
للى يـقايسْ، للى يـِحـسْ، يـِبـُصْ، يـِتـْجـَرَّأْ، يـُشـُوفْ،
للناسْ .. لكلِّ الناسْ حاقـُولْْ؛
هكذا يبدأ التعاطف مع المريض بصفته “الناضورجى” (على أعلى سارى السفينة) الذى رأى خطر القرصان يقترب من بعيد، فبدأ الصياح المنذِر، لكنه لم يكمله، ففشل ونكص وعجز، لكن ذلك لا يمنع أن نتعلم منه ونحن نأخذ بيده، وإذا لم يستفد هو فى الوقت المناسب بالقدر المناسب، فليكن ما تعلمناه منه – برغم فشله – هو مدرسة بأكملها .
-
نتعلم منه أن نرفض الاستسلام للجارى .. “أنا مش عاجبنى”
-
وإذا لم نتمكن من تصحيح مساره لاصراره على التمادى فى نفس اتجاه حله الفاشل فلا ينبغى أن ننسى آلامه الدفينة سواء التى دفعته إلى هذا الاحتجاج الصارخ أو التى ترتبت على فشله فى إكمال مشروع ثورته، فهو مـَهـْمـَا بدا ظاهره:
“ بـِيـْنزِفْْ مِِ الأَلـَمْ قـُدَّام عـُيـُونى“
وهنا يقفز تنبيه لازم وهو ألا نخذع فى ظاهر تبلد المريض أو وهج قفشاته، وأن ننتبه إلى رفض حاسم ومطلق لمقولة: إن “المجانين فى نعيم”.
سواء نجحنا فى الأخذ بيده أو فشلنا فقد بلغتنا الرسالة، ولها أصحابها، وعلينا أن نوصلها – ما أتيحت الفرصة – لموقعها المناسب لكل الآخرين بما فى ذلك، أو خاصة أولئك، الذين فى مفترق الطرق بين المرض والثورة والإبداع، ولم ينزلقوا إلى الحل المرضى بعد.
“للى يـقايسْ، للى يـِحـسْ، يـِبـُصْ، يـِتـْجـَرَّأْ، يـُشـُوفْ،
للناسْ .. لكلِّ الناسْ حاقـُولْْ”
-18-
دا حق كلِّ النَّاسْْ يا نَاسْ.
حق اللِّى ورَّانى حقيقتى،
حتى لوكات مش حقيقتى،
[الحقيقة انك تدور عالحقيقة.]
دا دين ولازم يندفع،
دا دين عليـَّا للى قالهالى وما اقدرشى يــِـكـَـمـِّل،
لكنه علـِّمـْنـَى، ووصانى أَوَفـِّى الدين لأصحابه الغلابة،
وازاى أنا يا خلق هوه حاحكى وانا غارق لشوشتي؟
أهو داللى كان، حتى ولو ما كاشفشـى منى إلا خيبتي.
ما قدرتش اسكت، دا السكات يبقى خيانة للى كان.
هو انا ناقص رجل، ولا ماليش لسان؟
كثيرا ما تحضرنى الشجاعة لأعلن فشلى مع أحد المرضى برغم تمام رؤيتى لأبعاد تركيبه الشائك المـُـعـَـجـِّز، وألمه الدفين الصامت، وعجزه واصراره على التمادى فى كل ذلك برغم كل إمكانات العلاج وصدق المحاولة ، لكن يتمادى فشلنا معا حين تجتمع السلبيات عليه ومن حوله حتى تشملنى، وربما تلوح لى أن استسلم ، وبرغم أننى عادة لا أكف عن مواصلة المحاولة ما أتيحت لى الفرصة إلا أن هذا لا يمنع من مواجهة عجزى، دون الرضوخ ليأس أو تراجع، هذا ما يشير إليه هذا النص حين أشعر أن ما تعلمته من احترام موقف المريض – برغم فشله – وبرغم فشلى أيضا فى الوصول معه إلى ما كنت أتمناه هو رسالة فى عنقى تظل معلقة فى رقبتى لأصحابها “كل الناس”، وربما هذا هو السبب المباشر لمواصلة نشر خبرتى بكل الوسائل المتاحة حاليا بعد طول الممارسة لما يقرب من ستين عاماً، إن توصيل هذه الرؤية التى وصلتنى من مرضاى لسائر الناس جدير بأن يكون بمثابة اعتذار لهم عن عجزى (ولو المؤقت ولو النسبى) لمساعدة بعضهم، وأنا مدين لهم بما وصلنى، فإن لم استطيع أن أرد الدين لصاحبه فعلىّ أن أرده لمن يحتاج إليه فيستفيد منه قبل فوات الآوان بدأً بنفسى، ثم “كل الناس يا ناس”.
-19-
أنا رايح اقول كلِّ اللى عارفُهْ حتى لو جانِى الفِقِى مــدِّدْنِى
فى الفَلَكَهْ وقطَّعْ جِتــِّــتِى:
إنْ كنت عايْز تلِعَبِ “العَشَرة” وتْبقَى الطَّيبَةْ؛
نكشف وَرَقنَا قبلِِ مَا الوَادْ يِتْحَرَقْ،
واللَّى يِبَصَّر “بالبِنَيَّة” يِبْقَى ذَنبِ التَّانىِ عَلَى جَنْبُهْ،
مَالوشْ يزْعلْ بَقَى. مَا كَانْ يشْوفْ!
ما الِّلعْبِ عالمْكشْوُفْ…، أَهُهْ.
يمكن الرجوع إلى المحاذير التى تصدرت مقدمة هذا العمل، خاصة الخوف من النقد، والتردد فى توجيه الخطاب إلى العامة ، مع من شاء من المختصين ، هذه المحاذير تراودنى تكراراً بين الحين والحين فأقاومها، وأواصل كشف ما أتصور أنه الحقيقة، وكأنى بذلك ألاعبهم وأنا أكشف أوراقى دون خوف من معرفة داخلى، كل هذا وأنا أستمد الدفع مما وصلنى من مرضاى، ومن فشلى، وهكذا أقبل التحدّى، ومهما طال الفشل، ومهما صُـنـِّـفـْـتُ بعيدا عن ما يسمى “الطب النفسى السائد غالبا”Main Stream Psychiatry وبرغم تحذيرى من المبالغة فى نقد ذلك حتى لا يصل إلى سلبيات ما يسمى “ضد النفسى” التى أرفضها على طول الخط، أقول برغم كل ذلك أواصل وأواصل، وبل أحاول كشف الحقائق ولو قسرا حتى لمن يرفض أن تصله الرسالة، وعليه أن يدفع الثمن ظاهرا أو خفيا على إسهامه فى دعم الغـُـربة والاغتراب وجمود الابداع، إذا أصر على موقفه.
-20-
لأَّهْ، مانيِش ساكتْ ودِيِنى وْمذهبى،
حتَّى ولو كان اللِّى “مَاتْ” هواّ اللِّى “عاش”، فى عرُفكم
لأَّهْ، مانيِشْ مَيِّت حَاعيش
وسـَّع بقى..!!
التعامل مع معنى الموت والحياة، من منطلق التطور والإبداع يختلف عن التعامل مع هذين المفهومين من منطلق الدين أو الخلود أو الطموح، إن أهم وأبسط قرار على كل إنسان أن يتخذه هو أن “يعيش”، وكل ما عدَا ذلك يأتى لاحقا، إن الالحاح أنه من الأفضل لكى نواصل العيش هو أن نتماثل مع المجموع طول الوقت بالطول والعرض، يكاد يكون العامل الأهم الكامن تحت الحركية المضادة له سواء بالمرض أو بالثورة أو بالإبداع وهذا هو ما صدَّرت به أول ديوان لى منذ خمسين عاما وهو أساس فكرى النفسمراضى قبل الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى، وهو ديوان “سر اللعبة”.
وهذا هو تصدير هذا الديوان بالفصحى:
مُذْ كنتُ وكان الناسْ …،
وأنا أحتالُ لكى أمضِىَ مثل الناسْ،
كان لزاماً أنْ أتشكـَّـلْ
أن أصبحَ رقماً ماَ،
ورقة شجر صفراءْ،
لا تصلحُ إلا لتساهم فى أن تلِقـُىَ ظلاّّ أغبرْ،
فى إهمالٍ فوق أديم الأرض
والورقة لا تتفتح مثل الزهرة،
تنمو بقَدَرْ،
لا تـُـثمرْ،
فقضاها أن تذبلْ،
تسقُطْ،
تتحلّلْ،
تذروها الريحُ بـِلاَ ذِكـْرى
كان علىّ أن أضغط روحى حتى ينتظمَ الصفْ،
فالصف المعوج خطيئة،
حتى لو كانت قبلتنا هى جبلُ الذهِب الأصفرْ،
أو صنم اللفظ الأجوفْ،
أو وهْج الكرسىِّ الأفخم،
كان على أن أخـْـمـِـدَ روحى تحت تراب “الأمر الواقع”
أن أتعلم نفس الكلماتْ…. وبنفس المعنى،
أو حتى من غير معانْ
ثم نعود إلى ديوان “أغوار النفس” بالعامية الجميلة وإلى القلم يؤكد قيادته:
-21-
القلم صحصح وِنَطّ الحْرف منُّه لْوَحدُه بِيخزّق عِينَىَّ،
وابْتْدا قَلمِى يِجَرّحنى أنا.
قالِّى بالذمَّةْْ:
لو كنت صحيح بنى آدمْْ،.. بـِـتـْحِسْ،
والناس قدّامك فى ألـَمُهمْ، وفْ فَرَحْتِهُمْ،
وفْ كسْرتهم، وفْ ميلة البخْتٌ،
مشْ ترسـِمـْهُم للناسْ؟ الناس التانيهْْ؟
إٍللى مِشْ قادْرَهْ تقولْ: “آه”، عَنْدِ الدَّكْتورْ.
أصل “الآه” المودَهْ غاليهْ،
لازمْ بالحَجْزْ،
لازمْ بالدورْ.
مش يمكن ناسْنا الَغْلبَانَهْ إِللى لِسَّه
“ما صَابْـهَاشِ” الدورْ؛
ينتبهوا قبل الدُّحْدِيرَةْ – قبل ما يغرقُوا فى الطينْ؟!
ولاّ السَّبُّوبه حَاتتعْطَّلْ لَو ذِعْت السِّر؟
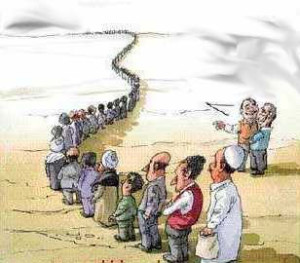 ولاّ انْتَ جَبَان؟
ولاّ انْتَ جَبَان؟
هانحن مرة أخرى نرجع إلى بداية البداية:
كل القلم ما اتقصف يطلعْ لُـه سن جديدْ،
المقطع هنا يؤكد من جديد استقلالية قلمى، الأمر الذى تكرر فى المقدمة وفى مواقع أخرى فى هذا الكتاب، وبالأخص فى هذا المقطع، بل وقد ورد أيضا فى شعرى بالفصحى، كما بيــَّنت فى قصيدة “ياليت شعرى لست شاعرا” فى آخر مقطع يقول:
أمضى أغافلُ المعاجِمَ الجحافلْْ،
بين المَخاضِ والنحيبْ.
أطرحُنى:
بين الضياع وَالرُّؤى.
بين النبىَّ والعدَمْ.
أخلّـِّق الحياة أبتعث.
أقولُنى جديدا،
فتولًدُ القصيدةْ.
إذن فالهدف من كل ذلك هو توصيل الرسالة لمن يهمه الأمر قبل هجوم حدة المرض، أو بتحديد أدق قبيل ذلك، فى مرحلة ما اسميته “مفترق الطرق” حيث آمل بإصرار أن تفيد هذه المعلومات البسيطة المزعجة فى أن تسهم فى المساعدة على اختيار الطرق النمائية (الابداع والنمو) بديلا عن التطور فى طريق المرض السلبى.
إعادة:
-22-
بصراحة انا خـُفـْت.
خفت من القلم الطايح فى الكلّ كـِلـِيلـَهْ
حيقولُوا إٍيه الزُّمَلاَ المِسْتَنِّيَهْ الغلْطَهْ؟
حيقولوا إيه العُلَماَ المُكْـــنْ
(بِسْكون عَالْكَافْ .. إِوعَكْ تغْلَطْ)
على عالِم، أو مُتَعَالم: بيقولْ كَماَ راجِل الشَّارع،
“ولاّ انْتَ جَبَان”!
-23-
القلم اتهز فْ إيدى،
طــلــَّـعْ لى لسانُهْ،
ما يقولوا!!:
حد يقدر يحرم الطير من غُـنَـاه؟!
من وليف العش، من حضن الحياةْْ؟!
تطلع الكلمهْ كما ربِّى خلقْها،
وهكذا واصل القلم استقلاله فخرج هذا العمل، وعلى المتلقى أن يتحمل بدوره مسئولية التلقى.
تطلع الكلمةْْ بْعَـبلْها،
تِبْقَى هىَّ الِكْلمة أَصْل الكُونْ تِصَحِّى المِيِّتِيْن.
والخايفْ يبقى يوسَّعْْ،
أَحْسن يطَّرْطـَش،
أو تيجى فْ عينه شرارة،
أو لا سـَمـَحََ الـلّه
يِكْتِشِفِ انُّه بِيْحِسْ.
الفصل الخامس
حب للبيع!
مقدمة:
ظهرت هذه القصيدة بهذا الاسم منذ نصف قرن تقريبا، وكتبت عليها “شرح على المتن” فى كتابى الأم “دراسة فى علم السيكوباثولوجى”، سنة 1979، بعد ظهورها بسنوات، وسوف أنشرها بنصها هى والشرح بأقل قدر من الإضافة، اللهم إلا فى الفقرة الأخيرة كما نوّهت فى المقدمة، ربما يفيد ذلك فى تسجيل مرحلة باكرة من موقفى من العلاقات العلاجية المفروضة والمتنوعة.
ولعلها كانت حوارا مع عنوان كتاب “صداقة للبيع” الذى كتبه([29]) وليام شوفيلد1964 عن العلاج النفسى.
****
أولا: القصيدة (الحوار)
– بضعة قطراتٍ من فضلكْ
= لم يبق إلا المتبقى
- جوعانٌُ .
محرومُ من نبض الكلمةْْ
= ما بَقِىَ لدَىَّ بلا معنى . .
مخزونٌ من أمس الأولْ
- آخـُذهُُُ أتدبـَّرُ حالى
قد يعنى شيئاًً بخيالى
= الحجزُ مقدّمْ
 – لكنى جائع
– لكنى جائع
= تجد قلوبا طازجة توزن بالجملة
فى “درب سعادة”
- قلبى لا ينبض
= عندى أحدث بدعة
تأخذها قبل الفجر وبعد آذان العصر
وتنام . . . .،
لا تصحو أبدا
- كم سعر الحبّ اليوم ؟
= حسْب التسعيرهْ، الطلبات كثيرهْ،
وأنا مرهق
- لكنى أدفع أكثْرْ
= نتدبرْ
-1-
= من أنت؟
- أنا رقمٌٌُ ما،
= طلباتـُك؟
- قفصٌ من ذهبٍ . . . . ذو قفل محكم
من صـُلـْب تراب السلفِ الأكرم
= فلتـُـحـْـكـِـمْ إغلاق نوافـِـذ َ عقلك
وليصمتْ قلبك أو يخفتْ . .،
تمضى تتسحب لا تندمْ،
- يا ليت! لكنى أمضى أتلَّفتْ
= إياكْ، …
 قد تنظر فجأة فى نفسك
قد تنظر فجأة فى نفسك
قد تعرف أكثر عن كونك
تتحطم،
- ساعدْنىِ باللـَّهـْوِ الأخفى
= أَغلقْ عَـينيكََ ولا تفهمْ.
-2-
= وجنابُكْ؟
- لا أعلم
- طلباتُك ؟
- ” أتناولْ” .. أسْـتَـسـِلْم،
أتَـعـَبـَّدُ فى ما هو كائِنْ
وأبرر واقع أمرى
أتـَكَـلـَّمْ . . أتـَكَـلـَّمْ . . أتـَكَـلـَّمْ
= تذكرتك؟
- فى أعلى المسرح
= قاعتنا ملأى بالأنعام
- أجلْسْنى فى أى مكان
فى الكرسى الزائد خلف الناس
بجوار التَّيس الأبكمْ
= البطلُ تغيبََ
– . . . . . . لا تحزنْ
ألعـُب دورَهْ ،
وأكرر ما أسمع من خلف الكُوّةْ،
لا تخشى شيئا . . . لا أحَدَ سيفهمْ
 = لا ترفع صوتك وتكتمْ
= لا ترفع صوتك وتكتمْ
- سمعا .. تـَمْ.. تـَمْ.. تـَمْ.. تـَمْ.. تـَمْ.. تـَمْ
= سلـِّم تغنمْ
- اخترتُ الأسلمْ
= الصفُّ تنظـَّمْ
- ما أحلى السَّـيـْرُ وقوفا .. تـَرَرَمْ ..تررم
رمْ .. رمْ.. رمْ.. رمْ.
-3-
= الثالث يتقدم
-.. سمعا يا أفندمْ
– طلباتك أنت الآخر؟
- أبحثُ، أتألم
- لا ترفع صوتك يسمعك الأبله والأبكم
- أتعلــّــمْْ
= لا تتعجل ، وأنا أيضا أتعلم
- .. تصدُقنى أم تسخر منى؟!!
= لا تتعجل ولسوف ترى
- .. دعنا نمضى لن أخسر شيئا
= لا أملك إلا صحبتك “معا”
- غـَـلـَـبـَـنـِـىَ اليأسُ دهوَرا
= لكنك جئت
- ضاعت منى الألفاظ
= نـَـجـْمـَـعُ أحرفها تتكلمْ
- فاح العفن من الرمز الميت
= بالحب يعود النبض إليه
- الناس جهنم
= الناس الأجبن،
– هل يوجد ناسٌ غير الناسْ
= الناس الناس وقود الكدح “إليه”
- وأنا ..؟؟!! وأنا ..؟؟!!
= أنت الناس، وبالناس…، فلا تندمْ
- من لى باليأس الخـِـدْر الأعظم
= لا مهرب بعد الآن
- العودُ على بدءٍٍٍ أكرمْ
انطلاقا من المتن([30]):
العلاج النفسى ممارسة مهنية، لها ما لها وعليها ما عليها، وتتوقف أساسا (بعد المرض والمريض) على المعالج والمجتمع معا، وبالتالى فمفعوله يمكن أن يكون:
-
تجميدا (مؤقتا أو دائما) لمسيرة النمو،
-
أو تبريرا لاغلاق دائرة الحركة تحت وهم الفهم والتفسير،
-
أو إطلاقا لمسارها وتنظيما لخطى النضج والإبداع.
”والعلاج النفسي” فى صورته الحديثة يختلط اختلاطا شديدا عند العامة بما هو “التحليل النفسي” وهو ليس كذلك تماما، وعلى أى حال فهو علاقة بين إنسان وإنسان، بين إنسان ذى خبرة مع إنسان فى محنة، يقوم الأول بالوقوف بجوار الثانى حتى تستقيم خطاه ويكمل هو مسيرته كما يستطيع ويرى.
بيع العواطف:
إذا ما طغى الموقف المهنى التقليدى الجاف على الموقف الإنسانى فى مجال العلاج النفسى، أصبحت المهنة على قدرٍ من التسطيح بحيث لا يفيد منها إلا قلة من الناس، تلك القلة التى تفضل التسكين حتى التوقف، أكثر مما تغامر بالعون لمواصلة السير..
– بضعة قطراتٍ من فضلكْ
= لم يبق إلا المتبقـِّى
فإذا كانت العواطف تباع وتشترى، فهى لابد إلى نفاد، وإذا رضى العصابى “بما يتبقي” لخلل رؤيته وضمور بصيرته، فإن الذهانى عادة ما يقف موقفه المتعالى الرافض –العاجز فى نفس الوقت – لهذه العواطف المطروحة للبيع، رغم إعلانه عن ذلك بأعراض الهزيمة لا أكثر ولا أقل، والذى يطلبه الذهانى على وجه التحديد هو ما افتقده فى الحياة العادية، فهو قد افتقد “المعنى”([31]) وافتقد الرسالة وافتقد العائد([32]) فواجـَـهَ فقر التغذية وسوء التغذية البيولوجية،([33]) لذلك فالمريض يذهب للعلاج النفسى أساسا بحثا عن هذا المعنى([34]) والطبيب (والمعالج) قد يبلغ درجة من الصدق مع نفسه إذ يدرك أنه أحيانا لا يملك هذه البضاعة بشكل، محدد جاهز للبيع.
العلاج.. والجوع للمعنى:
– جوعانٌ..
محرومٌ من نبض الكلمهْ
= ما بـَقـِىَ لدىّ بـِلا معنىّ.
مخزونٌ من أمس الأول
ومع ذلك، فإن حاجة المريض المـُلـِحـَّة، رغم يقينه الداخلى بأن ضالته المنشودة غير موجودة حيث ذهب يطلبها، قد تضطره إلى القبول بأخذ ما هو موجود، حتى ولو بدا بلا نفع، متصورا أن استقباله له سوف يحوِّر من طبيعة ما أخذ وبذلك يفى باحتياجه، وهذا ممكن علاجيا وعلميا، ذلك لأن التواصل بين البشر إنما يتم على أكثر من مستوى، فحتى لو أن الطبيب صدق فى قوله أنه ليس عنده ما يفيد حالا، فإن المريض قد يستفيد ربما أساسا من هذا الصدق ذاته، وربما من المحاورات المحاذية للألفاظ التى يسمح بها المجال والوقت الممنوح فى ممارسة العلاج النفسى.
– آخذه أتـَدَبـَّرُ حالى
قد يعنى شيئا بخيالى
تشوية العلاقة العلاجية الإنسانية:
على أنه قد نشأت بعض الممارسات التى فرضتها ظروف أتمنى أن تكون مؤقتة، جعلت هذه العلاقة المهنية تعانى من بعض المضاعفات ومن ذلك: مظاهر تأجيل الاستشارة والمعونة، وكأن الألم والجوع إلى المعنى يمكن أن يؤجل([35])، إن التأجيل قد يصلح لممارسة أخرى غير مرتبطة بالضرورة النابعة من “الجوع إلى المعني”، ورغم دلالة هذه العادة السلبية -طوابير الانتظار- إلا أنها قد تفيد بطريق غير مباشر، لأنها قد تـُرجع المريض إلى نفسه، وقد يجد المعنى الذى يبحث عنه – فى داخله- وذلك “أثناء انتظاره”، وبالتالى يموت الوهم الذى يصوِّر له أن السعادة يمكن أن تـُشترى من عند طبيب أو معالج.، فتنقلب المسألة من بيع الصداقة إلى بيع العواطف، وهذا ما يكشفه المتن ساخراً:
= الحجزُ مقدَّم
- لكنى جائع
= تجد قلوبـًا طازَجة توزنُ بالجملهْ
فى “دربِ سعادهْ
الإسراع بالتسكين الكيميائى:
لما عجز العلاج النفسى عن الوفاء بالتزاماته وخاصة بالنسبة للأعداد المتزايدة من البشر المحتاجين إليه، كان لزاما أن تظهر وسيلة أسرع وأسهل، وقد غمرت السوق (ونفوس البشر) موجة من الكيميائيات الحديثة تكاد تختلط بماء الشرب بعد المبالغة فى استعمالها، وهنا الخطر الأكبر الذى لن أوضحه تفصيلا([36])، وإن كان لابد من الإشارة إلى بضعة تحذيرات مبدئية تتعلق به:
1- إن استعمال العقاقير بطريقة انتقائية متغيـِّرة هو إجراء لا غنـَى عنه فى معظم الحالات، بل إنه يسهم فى إعاده تشكيل الدماغ (نقد النص البشرى).
2 – إن التسكين الكيميائى المبكر قد يؤدى إلى إجهاض نبضة نمو قبل اكتمالها.
3 – إن موقف الطبيب ودرجة خوفه من تقليب داخله هو، قد يتحكم فى الإسراع بالجرعة، أو فى مضاعفتها.
4 – إن الفروض المبنية عليها المبالغة فى فائدة الاقتصار على استعمال هذه العقاقير هى فروض تحتاج إلى مراجعة مسئولة.
5 – إن تناقص أعداد أعراض الأمراض النفسية الدورية (النوابية)، ونقص مظاهر دورات([37]) الحياة النامية لحساب تزايد الأعراض السلبية المزمنة قد يرجع بدرجة أو بأخرى إلى هذا الإفراط، وما وراءه من أيديولوجية الخوف من التغيّر على الجانبين.
– قلبى لا ينبض
= عندى أحدث بدعة
تأخذها قبل الفجر وبعد أذان العصر،
وتنام، …لا تصحو أبدا !
أما قضية العلاج النفسى بمقابل، فهى قضية عملية وهامة، ومبدأ المقابل قد يدل على الاختيار، وعلى جدية العلاقة وحدودها المهنية، ولكن التمادى فى تشويه العلاقة الإنسانية بمزايدات قد تخرج عن ما يسمح به الهدف العلاجى لا شك يعود بأسوإ الأثر على هذه الممارسة.
– كم سعر الحب اليوم
= حسب التسعيرة، الطلبات كثيرة
وأنا مرهق
- لكنى أدفع أكثر
= نتدبَّـر
أنواع العلاج([38])
العلاج بالتعمية:
قد يأتى المريض ابتداء ، وهدفه الخفىّ هو أن يُجهـِضَ أى احتمال لأن “يختلف” أو “يتغير” من خلال العلاج، على عكس ظاهر طلبه وسؤاله العوْن:
= من أنت
– أنا رقمٌ ما
= طلباتـُك؟
- قفصٌ من ذهبٍ ذو قفلٍ محكمْ
مـِنْ صلبِ ترابِ السلفِ الأكرمْ
مثل هذا المريض يطلب باستمرار أن يعود “كما كان” أو أن يصبح “مثله مثلهم“، وليس للطبيب أن يفرض عليه ابتداءً أى احتمال آخر، اللهم إلا إذا لم تستجب أعراضه للعلاج التقليدى، أو إذا عاودته الأعراض فى نكسة سريعة، إلا أن هذا الطلب العادى والمتوقع من جانب المريض قد لا يكون إلا اختبارا للطبيب من ناحية، وللمريض من ناحية أخرى، إذن فللطبيب حساباته الأعمق، وله موقفه الشخصى كذلك، والخوف كل الخوف أن تكون مبالغة الطبيب فى التوقف عند هذا الطلب من المريض نابعة من خوف الطبيب نفسه أكثر منها نابعة من رغبة المريض الحقيقية، وهكذا نرى أن الاسراع فى الاستجابة لمثل هذا الطلب هى من قبيل الإسهام فى الجمود والتدهور، لدرجة أنى أحيانا كنت أفكر فى أهمية “عدم توفر الخدمة الطبية النفسية” وليس فى توفرها لدرجة الرفاهية الحاملة لخطر الإجهاض أولا بأول، إجهاض أى مشروع نمو. واستجابة الطبيب للتوقف عند مرحلة التسكين قد تحمل حفزا خفيا لينتقل المريض إلى طلب التغيّر الحقيقى أو قد تكون موافقة الطبيب استسهالية لهما معا .
= فلتـُحـْكـِم إغلاق نوافذ عقلك
وليصمـُت قلبـُك أو يخفتْ..
تمضـِى تتسحـَّبُ : تسـْـلـَـمْ
إلا أن عدم الاستجابة لهذه النصيحة المدعمة عادة بالمُجـْـهـِـضـَـات الكيميائية قد تعنى أن طلب المريض الرجوع إلى حظيرة المجموع يسير فى ناحية، وأن رغبته الداخلية فى التغيير تسير فى ناحية أخرى، فها هو يكاد لا يقبل هذه الصفعة:
”- ياليت!!، لكنى أمضى أتلفـــَّـت”
والطبيب – الخائف عادة – قد يسارع بمساعدة مثل هذاالمريض فى ألا يتلفت وألا يبصر أعمق ما بنفسه ولا ما حوله، وحجته السليمة فى ذلك هو الخوف من احتمال تفسخه وتناثره الذى لا يمكن حساب نتاجه ما لم نهيـِّئ له:
-
الجرعة المناسبة المتكاملة من كل وسائل العلاج،
-
وخطة التأهيل طويلة المدى،
-
والمجتمع الخارجى الانتقالى المحيط الملائم، الأمر الذى يتخطى عادة قدرات الطب النفسى التقليدى فى معظم الأحوال، وبالتالى فالأغلب، والأرجح هو أن تتواصل عملية الإجهاض مع سبق الاصرار.
= إياكْ!
قد تنظـر فجأة فى نفسك
قد تعرف أكثر عن كونك: … تتحطـَّـمْ
- ساعدنى باللهو الأخفى
= أغلق عـَـيـْـنـَـيـْـكَ ولا تفهمْ
طبعا هذا الحوار لا يجرى بالألفاظ، ولابد أن نعترف أن الممارسة الطبية النفسية حاليا، يغلب على أكثرها هذا النوع التسكينى من التطبيب، وأنا لست ضده على طول الخط، قد يكون خطوة بادئة، وأحيانا ضرورية فى بعض الحالات، لكنه لا ينبغى أن يكون خطوة نهائية تغرى بالاستسلام له، والتوقف عنده .
على أن تجاوُز هذه المرحلة يحتاج إلى إعداد طبيب نفسى (معالج) من نوع خاص، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير المجتمع الأوسع بصفة أشمل، وبالوسائل التى لابد أن تتجاوز المحاولات المتعلقة فى حدود المهنة.
العلاج بالكلام:
يبدو هذا التعبير ملتصقا بالتحليل النفسى بوجه خاص لما يشتهر عنه من استلقاء على أريكه، ثم التداعى الحر (الكلام المنطلـق) والتفسير الكلامى وهكذا، وأكاد أجزم من واقع خبرتى ومما شاهدت من نتاج خبرة غيرى فى الممارسة الأكلينيكية أن هذا العلاج قد ينجح – مثل سابقة – فى إزالة الأعراض، ولكنه غالبا يحولها من أعراض عصابية (أو ذهانية) محدده إلى نمط فى التفكير العقلانى يصل بالشخصية إلى درجة من الهدوء والرضا، الأمر الذى قد يتعارض مع دوام نبض النمو.
إن مثل هذا العلاج بهذه النهاية، هو مطلب كثير من المرضى باعتباره علاجا رشيقا ترييحيا، وأن نتائجه أمنة بدرجة ما، وهو يسمح للمريض بإتقان تدريبات ذهنية يحذقها ليحصل من خلالها على درجة من الوجاهة العقلية، يستطيع بها أن يبرر الواقع ويفسر الحال بالتبرير والكلام والرضا الظاهرى:
-2-
= وجنابك
- لا أعلم
= طلباتك؟
- أتناول.. استسلم
أتعبـَّـد فيما هو كائن
وأبرِّر واقع أمري
أتكلم أتكلم أتكلم..!
لا يختلف هذا العلاج عن سابقة من حيث إجهاضه لنبضةِ النمو، وإن كان يستغرق وقتا وجهدا أطول وأصعب، وإذا كان احتمال عودة الأعراض فى الحالة الأولى هو نذير بأن التسكين لم ينفع، فإن الأعراض فى هذا العلاج لا تعود كما هى بل تتغلغل وتتحور حتى تختفى ظاهريا ولكنها تلوِّث تركيب الشخصية وتوقف النمو بشكل يشمل معظم جوانب الشخصية لدرجة أن تصل إلى ما يسمّى اضطراب الشخصية.
والمريض فى هذا العلاج قد يكتسب بصيرة عقلانية عالية تجعله متفرجا من بعيد يحسن إصدار الأحكام، وتوصيف الرؤية، ولكنه لا يتحمل مسئولية هذا وذاك بأى درجة، وكأن موقفه يشبه أيضا موقف المتفرج الذى يرضى بإصدار الأحكام دون محاولة التغيـّر.
= تذكرتك؟
- فى أعلى المسرح
هذه إشارة إلى أن موقف الفـُـرْجة يتأكد كلما زادت المسافة بين الطبيب والمريض، الأول يصدر أحكاما وتشخيصات، والثانى ينتظر تعليمات غالبا لا تفيده.
= قاعتنا ملأى بالأنعام
- أجلـِسْنِـى فى أىِّ مكانْ
فى الكرسِى الزائدِ خلفَ النـَّاسْ
بجوار التيـْس الأبكم
(مرّة أخرى، هذا حوار الوعى الأعمق وليس حوارا لفظيا معلنا طبعا) ونوع وجود مثل هذا الشخص، كما يؤكده هو ذاته، هو وجود غير مشارِك (الكرسى الزائد)، فهو وجود خامد بصورة أو بأخرى، لأنه يكاد يستسلم لمأساة اختفاء “المعنى”، والرضا بمستوى سطحى من التواصل، ومواصلة حياة أشبه بالصـَّـدَى أو المحاكاة، كأنها الحياة.
= البطل تغيبْ
- .. لا تحزن، ألعبُ دورَهْ،
وأكرِّرُ ما أسمعُ من خلفِ الكــُـوَّة،
لا تخشَ شيئـًا، لا أحد سيفهمْ”
هذا اعتراف من داخل “داخل” المريض بقراره التوقف عند هذه المحطة مادام هذا هو الممكن، فهو يعلن أنه لكى “يـُـشفى” ما عليه إلا أن يكرر ما يقال، ووعيه بهذا التكرار لا يضيره مادام قد نجح فى عقلنته، وكأنه يذهب للعلاج لتأكيد هذه العقلنة والحصول على التبرير والموافقة على موقفه المتفرج الدائر حول نفسه، وكأن هذه الصفقة العلاجية تسمح له باستمرار ما أسميتـُـهُ “رفاهية اليأس”.
= لا ترفعْ صوتك وتكتـَّـمْ
- سمْعـًا تمْ تمْ.. تمْ تمْ، تمْ ..
= سـَـلـِّم تغـنم
- اخترتُ الأسـلـَمْ
= الصفٌّ تنظـَّـِمْ
- ما أحلى السيرُ وقوفا
.. ترَرَمْ … ترَرَمْ … تمْ تمْ.
هكذا نجد أن كثيراً من هذا العلاج التفسيرى أو التبريرى – رغم فائدته التنظمية والتسكينية، يحتاج إلى مراجعة بالمقاييس النمائية، وإلى إعادة النظر فى أحقيته لكل هذا الوقت والجهد الذى يبذل فى إجرائه.
العلاج.. بالمواكبة:
كنت قبل ذلك أسميه علاج النمو، أو العلاج التطورى، إلا أنى فى هذا الموقف، وارتباطا بنبض المتن، فضلت هذا الإبدال المفيد ولو مؤقتا، فالعلاج هنا لا يهدف إلى التسكين الكيميائى أو الإيحائى، ولا إلى التبرير الكلامى، ولكنه يقوم بدوره بالمشاركة([39]) فى مسيرة النمو، وهنا يقفز لنا تأكيد مبدئى يقول: أنه لا يقوم بهذا العلاج المستمر معالج مبتعد… بل معالج متمرس مسئول يحفز خطى الحياة، فالموقف هنا يستحيل أن يكون هو هو الموقف المعروف عن المعالج والمتعالج، بل هو موقف شخصين يسيران معا فى نفس الاتجاه، لنفس الهدف، ولكن أحدهما يعرف الطريق أكثر، ويتقن إيقاع الخطى أكثر، وتـَحـَمـُّل العثرات أكثر، ويستطيع من خلال ذلك أن يتقن الصحبة لاستمرار المسير، وليس مجرد النصيحة بالتراجع أو الموافقة على التوقف([40]) وكثيرا ما يكون موقف المريض الإيجابى، برغم مرضه، هو العامل المشجع للطبيب أن ينتقل إلى هذا المستوى من العلاج:
-3-
= الثالث يتقدم
-.. سمعا يا أفندمْ
– طلباتك أنت الآخر؟
- أبحثُ، أتألم
- لا ترفع صوتك يسمعك الأبله والأبكم
- أتعلــّــمْْ
= لا تتعجل ، وأنا أيضا أتعلم
- .. تصدُقنى أم تسخر منى ؟!!
= لا تتعجلْ، ولسوف ترى
المواجهة هنا فى هذ العلاج هى الأساس والموقف مختلف تماما عن ما سبق، وهى نادرة لكننى أوردتها لأعرض نموذجا آخر آمل أن نجد له مساحة أرحب، فالمريض عادة لا يأتى للبحث أو يشكو من الالم (بعد أن حلت أسماء الأعراض محل هذه المشاعر الأصيلة) لكن هذا وارد برغم ندرته كما ذكرنا، كذلك يبدو أن هذا المريض قد شحذ حدْسه حتى لربط خبرة المرض بفرصة التعلمْ.
ربما هذا هو ما أتاح للطبيب هنا أن يطمئن فيصارحه بأنه أيضا “يتعلم بصدق مشاركته” و“عمق مـَعـِيـَّتـِهِ له“، ويبدو أنه اطمأن إلى قدرة هذا المريض على استنتاج موقفه المختلف هذا من واقع الممارسة، والطبيب الذى يعيش مسئولية نموه هو ذاته: لاشك ينتظر مثل هذا المريض ويفرح به، ولكنه لا يتمادى فى ذلك ولا يتصنعه، فهو المسئول الأول وقبل كل أحد، لكن لابد من اعترافه – على الأقل أمام نفسه – بائتناسه هو ذاته بصحبته، وفى خبرتى وجدت أن هذا النوع من الحوار المفتوح يصل أسرع وأصدق من مجرد الحديث التشجيعى ظاهرا عن مثل هذه الخبرات، مثل :”ضرورة التغـيـُّر” وفوائد ”التجديد!”.. وما إلى ذلك…، فالمسألة ليست فى إعلان هذا الموقف أو فى حسن النية، وإنما هى فى الممارسة ودفع عجلة النمو.
- .. دعنا نمضى لن أخسر شيئا
= لا أملك إلا صحبتك “معا”
– غلبنِىَ اليأسُ دهورَا
= لكنــَّـكَ جئت
حين يحضر مريض بهذا الحدْس المخـْتـَرِق، لطبيب بهذه الرؤية الثاقبة تختلف المسألة تماما، وتصبح المواجهة المواكبة المسئولية (م.م.م) هى السبيل الأمثل للعلاج، لكن هذا لا ينبغى أن يكون سبيلا إلى طمس حدود الأدوار، فما زال المريض يشكو، والطبيب يحاور المريض وها هو المريض يعلن من جديد:
- ضاعت منــِّى الألفاظْ
= نجمع أحرفها تــتـكلـَّمْ
- فاحَ العفنُ من الرمز الميــِّت
= بالحب يعود النبض إليهْ
هكذا يقوم الطبيب (المعالج) بدور قائد السرية الذى يعرف الطريق كما قلنا، وهو يتكلم من موقع المجرِّب العالم الإنسان معا، وهو إذ يعيد التأليف بين الأجزاء يشمل ذلك التأليف بين أجزاء الشخصية المتفسخة أو التى على وشك التفسخ وكثيرا، ما يلجأ الطبيب فى مثل هذه الأحوال إلى جرعات كيميائية مساعدة ولكنها موقوته ومرحلية ومتغيرة دائما: تناغما مع مراحل العملية العلاجية النمائية لإعادة تشكيل النص البشرى “ربى كما خلقتنى”.
أما الحديث عن الحب الناضج الآخر الذى يمكن أن يتصف به هذا العلاج نقيضا لما يشاع بين العامة عادة، فإنه يرجعنا إلى المعنى الأصلى لهذا اللفظ (الحب) الذى قدمناه طوال هذه الدراسة، بما يشمل:
-
الشوفان الكلى،
-
وقبول التناقض،
-
واحتمال الغموض،
-
والاستمرار “معا”،
والمُعالج بهذا وحده يستطيع أن يقوم بدور المترجم للألفاظ العاجزة، ودور لمّ شمل الحروف (والكيانات)([41]) المتصادمة المتزاحمة، فعلاج إحياء المعنى (علاج اللوجوس) مثلا: لا يعتمد على التفسير اللفظى، بقدر ما يعتمد على توفير المَعـْـبـَـر (أو القناة) والشاشة القادرة على التقاط متناثـَر الكلام لتجميعه فى جملة مفيدة غير منطوقة أو منطوقة.
الحب بهذه الصورة المخترقة، قد يبدو أكثر من احتمال المريض الشاكّ المتوجـِّسِ الوحيد، إلا أنه فى العلاج يمكن تخطى هذه المخاوف مع الاعتراف بها وبدورها وفهم معناها.
- الناس جهنم
= الناس الأجبن،
التعبير المشهور فى بداية الفكر الوجودى المسطح كان يعتبر أن الآخر هو الجحيم، وقد أخذت هذه المرحلة حقها حتى فشلت أو كادت، لكن لم يحلّ محلها بالقدر الكافي مفهوم أعمق، وأرحب وأشمل.
وهكذا يتمادى المعالج فى المشاركة والإيضاح الأعمق والأرسخ، ولا شك أن فى ذلك ما يهدد بفتح باب الاعتمادية، مما قد يغرى المريض بالتراجع، إلا أن هذه خطوة على الطريق وهى من صلب وظيفة العلاج، وهنا نرى عظـَم ألم المحاولة، من خلال إعلان الرغبة فى التراجع عن اختيار الحل المرضى: مطمئنا إلى أمانة الرفيق ورفضه المسبق:
– هل يوجد ناس غير الناس
= الناس الناس وقود الكدح “إليه”
والذى يقدمه حديثا (ليس حديثا جدا) مفهوم العلاج الجمعى هو أن الإنسان لا يكون كائنا بشريا إلا وهو فى علاقة مع الآخر، بمعنى الناس، وهذا ما وردَ ، وسيردُ كثيرا طوال هذا العمل بأجزائه كلها (الأربعة حتى الآن!).
والمقطع هنا يميز “الناس معا” عن العلاقات الصفقاتية المحدودة: بمعنى الامتلاك الاحتكار، والاستحواذ.
وحين يتيقن مثل هذا المريض أن المسيرة حتمية طولا، مطمئنا إلى رفيق الطريق الفاهم المشارك، يدرك أيضا أنها حتمية عرضا… بما يتطلبه ذلك من التزام مباشر بالناس، وهنا قد يستشعر عظم المسئولية التواصلية مع كدح الألم وروعته معا: ولكن هذه المسئولية والتواصل مع الناس هى هى مصدر الصحة وسر السعادة، وهذا ما يعرفه المريض ولكنه جاء لمـَّـا شعر أنه لا يقدر عليه – الآن – وحده، فيقوم الطبيب بدوره المشارك:
– وأنا ..؟؟!! وأنا ..؟؟!!
= أنت الناس، وبالناس…، فلا تندم
- سُحـْقاً لليأس الخـِـدْر الأعظم
وتتفق هذه اللحظة مع لحظة المواجهة فى رحلة التكامل والتى بعدها تستحيل العودة ويستحيل التناثر فى نفس الوقت.
= لا مهرب بعد الآن
- العودُ على بدءٍٍٍٍ أكرمْ
والعود على بدء يشير ثانية، ودائما إلى معنى “دورات الحياة” المتعاقبة نموا وهى ليست عودة بمعنى التكرار، لكنها إن صدقت، فهى إعادة ولادة، التى هى جوهر الإيقاعحيوى وبالتالى أساس الطبنفسى الإيقاعحويى التطورى “علاج المواجهة – المواكبة- المسئولية ” أساسا.
وبعد
إذا وصل المريض إلى هذه الدرجة من الرؤية يصبح اليأس مخجلا ومرفوضا، والتراجع مستحيلا أو قريبا من ذلك.
ولعل استعارتنا هذا الفصل من ديوان “سر اللعبة” ثم من المرجع الأم “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” قد أوضحـَت أكثر الموقف من “نقد العلاج النفسى”، كما كشفت لنا ملامح من العلاج الجمعى الذى هو مصدر هذه المحاولة برمتها، وبها إشارة أيضا إلى جذور الفكر النمائى التطورى، وكيف بدأ يشغلنى منذ عشرات السنين حتى كاد يكتمل فى هذه المنظومة المسماة الآن “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى”.
*****
المحتوى
صفحة |
العنوان |
3 |
– إهـداء هذه الطبعة (2018) |
5 |
- إهداء الطبعة الأولى لديوان “أغوار النفس” |
7 |
– مقدمة الطبعة الأولى للمتن ديوان أغوار النفس (الديوان: 1977) |
11 |
– مسودة مقدمة الطبعة الحالية (كتبت سنة 2009) |
13 |
– مقدمة جامعة (2018) |
15 |
– الإهـداء |
17 |
الفصل الأول:المتن الشعرى (مجتمـِعاً: ابتداءً) |
31 |
الفصل الثانى:صعوبة الكتابة فى “العلاج النفسى” ومضاعفاتها |
45 |
الفصل الثالث:الخوف من النقد المعيق، واختراقه |
53 |
الفصل الرابع:“المريض ورّانى نفسى” |
95 |
الفصل الخامس:حب للبيع! |
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى