نشرة “الإنسان والتطور”
السبت: 7-10-2023
السنة السابعة عشر
العدد: 5880
مقتطفات من: “فقه العلاقات البشرية”(4) [1]
عبر ديوان “أغوار النفس”
الكتاب الرابع:
“قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج”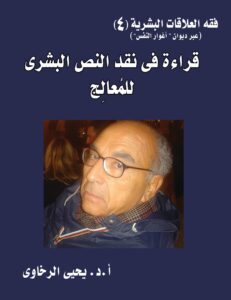
مقدمة:
فى هذه المرحلة، وأنا أقوم بتجميع ما أمكن مما سطرت هنا وهناك شاكراً ربى، حامداً التكنولوجيا الحاسوبية التى استطاعت أن تحتفظ لى بالكثير مما خطر لى، ورأيته، وعرفته، وافترضته، أكتشفُ باضطراد جرعة معايشتى لما هو نص “يحيى الرخاوى”. لا أرفض هذا الاكتشاف ولا أخجل منه، ورويدا رويدا بدأت أدرك أن هذا هو منهجى مهما كان الوصف والتصنيف .
حين خطر لي أن العلاج التكاملى، وخاصة العلاج النفسى، وبالذات العلاج الجمعى، أن كل ذلك ليس إلا “نقدٌ للنص البشرى” رحت أؤكد أن هذا لا يعنى إعادة تشكيل النص (نص المريض) دون احتمال (بل ضرورة) إعادة تشكيل نص المعالج.
النقد هو إبداع ثان، ويبدأ بقراءة النص ، ثم احتوائه، ثم إعادة تشكيله بما يضيف إلى إبداعيته وليس فقط بما يُحِسْن وصفه ، وبغير ذلك لا يكون النقد نقدا، ثم إننى نبهت مرارا أن مجرد الاكتفاء بتصوّر إعادة تشكيل النص البشرى للمريض، دون النص البشرى للمعالج، هو نوع من تجاوز حدود الإبداع الحقيقى على مسار الطرفين، كما أنه استهانة بالمريض وكأنه مادة أو موضوع للتشكيل دون مشاركة متبادلة، إن من حق المريض أن يقرأ نص المعالج تماما كما يقرأ المعالج نصه، ولا ينجح النقد بناء غائيا إبداعيا إلا أذا سرى على الجانبين تلقائيا.
أثناء إعدادى لمواصلة استلهام ما بقى من قصائد فى هذا الأصل “ديوان أغوار النفس”، اكتشفت أن أغلب ما تبقى هو جرعة كبيرة من السيرة الذاتية متفاعلة مع المسار المهنى طول الوقت تقريبا، فعرفت أنها أقرب إلى قراءة نص المعالج بغير قصد مباشر، خاصة وأنه ظهر فى شكل إبداعى لم يخطر ببالى مسبقا، فكان أقرب إلى الكشف والتعرى حالة كونهما فى جدل طول الوقت مع الممارسة العملية واحتمال مسار النمو.
هذا، وقد سبق أن بينت موقفى الحذر مما يسمى السيرة الذاتية، ليس باعتبار أنها بعيدة بالضرورة عن الموضوعية، وإنما احتراما للتركيب البشرى الأعجز عن الإلمام بعمق طبقات وجوده، وهمس ثوانى تقلــّبه ، وبالذات احتراما لقصور ما يسمى “الذاكرة” التى أعيد النظر فيها وفى طبيعتها، وفى قدرتها، وفى موقعها من الوجود عامة والوجود البشرى خاصة.
لقد فوجئت وأنا أتابع نفسى متنقلا بين كل النشاطات التى سجلها قلمى أحيانا بالرغم منى([2]) فوجئت بغلبة ما يمكن أن يسمى ،أو يشير إلى ما هو سيرة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا أريد أن أشغل القارىء بعرض بعض ذلك، فاكتفى فى هذه المقدمة بأن أبرر فصلى بعض قصائدى، فى ديوانى: (بالعامية) “أغوار النفس” عن بقية قراءة العيون البشرية التى قرأتها بالتتالى فى الجزء الثالث من سلسلة “فقه العلاقات البشرية” على الوجه التالي:
حين وصلت إلى قصيدة “المعلم” وأنا أعرف أنها كانت محاولة قراءة مباشرة فى مستويات وعيى شخصيا عبر عيونى، رحت أقرأ هذا النص وكأنه ليس أنا، فوجدت أننى أتعرّف علىّ أكثر فأكثر بالرغم منى، ووجدت أن هذه القصيدة، بالإضافة إلى قصيدتـَىْ “جمل المحامل”،و “الخلاص”، مرتبطة أشد الارتباط بنوع ممارستى مهنتى الذى أفرز كل هذه الأعمال، وبالذات هذا العمل تحديدا.
طبعا لن أعرج بأى تفصيل إلى ما تم نشره فى أعمال أخرى مثل أدب الرحلات الذى ظهر فى ثلاثة أجزاء، وتم فيه تجوال متعدد المستويات فى وعى الداخل كما فى رحلات الخارج وخاصة: الترحال الثالث بعنوان: “ذكر ما لا ينقال”([3])
********
الفصل الأول: اللوحة السادسة عشر:
قراءة فى عيون:
المِعــلـِّم (1)
(1)
طـَبْ والمعلمْ….؟
له عيونْ كما العيونْ؟
بتقول كلام هوَّا الكلامْ؟
ولاَّ كلامْ غير الكلامْ؟
أذكـِّر القاريء هنا ببعض ما هدفت إليه من هذا العمل مما ذكرته فى المقدمة لهذه المجموعة حيث قلت: إنها – أيضا – تجربة شخصية عنيفة، علمتنى فى مهنتى وعن نفسى ما صار هاديا لى، ومحذِّرا أيضا، ومحيِّرا أحيانا كثيرة.
فى العلاج الجمعى، يسرى على المعالج الأساسى ما يسرى على أى مريض، ويعامل على نفس المستوى، فمثلا: إذا طـُـرحت لعبة من ألعاب العلاج النفسى، وطـَـلـَـب المعالج من مريض أو أكثر أن يلعبها، فإن من حق نفس المريض أو أى مريض آخر أن يطلب من المعالج أن يلعبها هو أيضا، وقد اعتدت أن ألعب آخر واحد فى المجموعة، حتى لا تؤثر استجاباتى على بعض المرضى إذ قد يتصورون أن هذا الذى قمت به أنا هو المطلوب. المعالج المبتدئ تحت التمرين، يُعفى من معاملة المثل حتى لا يخطو فى رؤيته لنفسه، أو حركة نموه، أكثر مما يستطيع، ويظل هذا الإعفاء ممتدا حتى يطمئن هذا المتدرب أنه آن الأوان أن يسمح بمعاملته بنفس القواعد التى تسرى على المدرّب، فيعلن أنه تنازل عن حق الإعفاء، ويسمى ذلك أنه “أضاء النور الأخضر”، فيخطو خطوة هامة في التدريب بمغامرة الكشف، وذلك مقارنة بحقه قبل ذلك فى إضاءة “النور الأحمر” للاعتذار عن المشاركة.
على نفس القياس، أجلت القراءة فى عيونى شخصيا حتى نهاية محاولة التعرف على تشكيلات الوعى البشرى من خلال عيون الآخرين، وهو ما تضمنَّه الكتاب الثالث بوجه خاص “قراءة فى عيون الناس([4])
لاخيار للطبيب النفسى وهو يعود إلى نفسه تلقائيا و كثيرا، وتكرارا، سواء بالمواجدة empathy أو التقمص Identification سواء من خلال المشاركة فى الوعى البينشخصى، أو الجمعى، أو غير ذلك كل ذلك بالخبرة، وليس بالاستبطان المعلقنِ([5]) وهو يراجع تلقائيا كل ما وصل إليه، بعد أن يصل إليه، هذا الاضطرار لا يقسم الشخص إلى ملاحـِظ وملاحَظْ فتتعطل حركية الوعى وتلقائية التفاعل، وإنما هو جدل نشط تلقائيا يحدث بين مستويات الوعى المتبادلة فى كل الأحياء، حتى الانسان بداهة، إن هذه المشاركة على كل المستويات هى مصدر المعالج الأساسى فيما يتلقاه من مريضه، وهو منفتح لكل ما يأتيه ظاهرا وباطنا كمدخل لاحترام مريضه، ومن ثـَـمَّ نفسه، والاحترام هو عاطفة أساسية أعتبرها أرقى درجات الحب، كما أشرتُ مرارا، وكما أجلت الحديث عن ذلك بالتفصيل مرارا أيضا.
الشجاعة مطلوبة أكثر كثيرا حين يقارن الطبيب (أو المعالج) نفسه بمريضه، فيصله أن الفرق ليس فى التركيب البشرى الأساسى، ولكن فى ترتيب هذا التركيب وفاعليته ونتائجه، مرحلة بمرحلة، ولابد أن يدرب الطبيب نفسه على ممارسة درجة من العدل والصبر، وأن يتعود الألم المشارِك، وغير المشارك، وقد يصل الأمر – إن استطاع – أن يتصور معاملة المثل، على الأقل فيما يتعلق بالتخطيط، والتوجيه، والأمانى، والوجدان، يمتد ذلك إلى أقرب الأقربين، بمعنى أن يرضى على مريضه ما يرضاه على نفسه وعلى أولاده وزوجه، وأن يرجو للمريض ما يرجوه لنفسه ولأولاده، وزوجه، مع كل التقدير والانتباه للفروق الواقعية، يواصل ذلك وهو يدرك باستمرار وتجدد: أن الاختلافات – إن وجدت، وهى موجودة حتماً – هى فروق تنظيمية خارجية وواقعية، أما موقفه المعرفى ومسئوليته العلاجية فهما متضـَمنان فى العلاج=الممارسة النقدية (نقد النص البشرى).
تـَدَرُّجُ وعى الطبيب فى عملية نمو مضطرد أمرٌ وارد، بل حتمى، مع طول ممارسته، وهو الدليل على تواصل تطوره، وشحذ خبرته، ولكن الشك فى مصداقية البصيرة، مهما احتدّت، واجب عليه طول الوقت، ومن ثم فالمراجعة والنقد الذاتى ومن الآخرين بما فيهم المرضى (مستويات الاشراف) هى الضمان الأول فى استمرار التبصر ونمو الوعى. طريق النمو ليس له نهاية، وكل ذلك مفروض أن يصب فى صالح مرضاه، خاصة من خلال ما أسميناه “إِشراف المريض” و”إشراف النتائج” و”الإشراف الذاتى”، مع سائر صنوف الاشراف الأخرى. ([6])
فى هذه اللوحة (القصيدة) من قراءة العيون أصف – فى محاولة صدق – حيرتى مع نفسى: بما أِملْتُ، وآمل، به أن يدعم مسيرتي: ماذا أنا؟ ومن أنا؟ وهى بعض سطور من بعض أوراق ما سمح به الوعى أن يـُسطر، أما بقية الأوراق فقد أوهب الشجاعة لنشرها يوما – أو أموت بها آسـِفـًا – وكما أشرت فى المقدمة فقد سبق أن نشرت بعض ذلك لاحقا فى عمل أدبى جمع بين أدب الرحلات والسيرة الذاتية وهو ترحالاتى الثلاثة([7])، وأيضا سجلته فى بعض شعرى الذى لم ينشر أغلبه وإن كان جارى نشره بعد هذه اللملمة فى أضفتها إلى النص الأصلى هذا العمل الحالى الذى يقتصر على الثلاث قصائد المتبقية من ديوانى “أغوار النفس” بالإضافة إلى المقدمة / الخاتمة.
أعتقد أن هذه القصيدة التى تأخرت حتى النهاية تقريبا وهى بعنوان: “المعلم”: هى محاولة متواضعة تواضع العاجز دون ادعاء، وهى فى نفس الوقت دليل إصرارٍ مثابرٍ على مواصلة السعى دون استرخاء إلا ليعاود السعى، أعتقد – أو لعلى آمل – أن تقوم هذه الأوراق بتقديم فرصة ائتناس “عن بعد” لمن يحاول معنا.
يبدأ التشكيل بالتساؤل:
طـَـبْ والمـِـعـَـلمّ؟
له عيون كما العيون؟
بتقول كلام هوّه الكلام ولا كلام غير الكلام؟
هذا التساؤل وصلنى متكررا من “لسان حال” المجموعة ككل، وأيضا من أغلب أعضائها فـُرادًى، تساؤل يقول:
يا ترى هل كلام هذا “المـِعـَلـِّمْ”([8])، يحمل المعنى والفعل والمسئولية بالقدر الذى ينبغى أن يحملها؟ أم أنه كلام للاستعمال الظاهرى؟ يصلح للمرضى (والآخرين) ولا يسرى عليه شخصيا ولا يصلح له؟
هل هو يبيع النصح والفتاوى والتفسير والتأويل لغيره مرضى وغير مرضى؟ من واقع علمه وتحصيله، أم أنه يغامر فتفتح منه مستويات وعيه فيجرى تواصل متعدد القنوات طول الوقت.
تقمصتُ الصورة التى وصلت إلى بعض (أو كل) الأصدقاء فى هذه الخبرة خوفا، وتـحـُّفزاً، ورفـْضاً، ونقدا، فراح لسان حال أغلبهم يقول (وخاصة في بداية الخبرة):
(2)
شيخ الطريقة قاعدْ لىِ كما قاضى الزمانْ.
بيقسِّم الأرزاقْ ويمنح صكّ غفران الذنوبْ،
وكإن مشكلة الوجـودْ،
ما لهاش وجود،
إلا حـَـدَاهْ.
عامل سبيل إسمه “الحياه”:
”قال ده يعيش،
ودى تموتْ،
ودا مالوش الاّ كِدَه”.
قاعد يصنَّفْ فى البشر حسب المزاج:
“لازم تـعــدِّى عالصراط”
واللى بيشبه حضرتـُهْ: يديه قيراط:
فى جـَنـِّتـُهْ،
واللى يخالفَ هوّا حـُـرّ.
يكتب على قبره ماشاء:
مـَـيـِّـتْ صحيح، …لكنه حر فْ تـُـرْبـِتـُه.
وان قلنا ليه ياعمنا؟
بيقول كما قاضى الزمان:
ماقـْدِرْشِى يمشى عالصراط، ويكون “كـمـثـلى”.
ونقولـُّه: مثلك يعنى إيه؟
يتخضّ ويبان فى عيـنيه،
ســــؤالات كثير:
بتقول عـيـنيه:
فى هذه التجربة الخاصة جدا، كنت غالبا الأكثر خبرة مهنية، وهذا لا يعنى أننى كنت الأنضج أو الأعرف، ومع ذلك بدا لأغلب المشاركين أننى شيخ طريقة خاصة، بمعنى العارف بالمطلوب والطريق، والتوجه، وبالتالى هو الذى يملك أدوات قياس الخطى، وحسن الأداء… إلخ، وكل هذا غير صحيح، إلا أننى لا أنكر أنه كان هو ما وصل إلى أغلب المشاركين خاصة فى البداية، فلعل ما وصلهم هو الصحيح، فإن كان الأمر كذلك، فهذا هو الخطأ الذى يمكن أن يقع فيه أى قائد مجموعة، سواء عيّن نفسه قائدا لها (وهذا نادرا ما يحدث فى مثل هذه الخبرات)، أو فـُرِضَت عليه صورة القائد من خلال رؤية الآخرين له.
وبرغم هذا التحذير المبدئى، فلا مفر من الاعتراف بأن من يمارس الطب النفسى بالعمق الكافى، سوف يجد نفسه “يعرف أكثر فأكثر” بشكل مضطرد، رضى أم لم يرضَ، ومعرفته هذه عادة لا تتوقف عند حدود مهنته، بل إنها معرفة عادة ما تمتد – مختارا أو مضطرا – إلى تساؤلات كلية، وفروض محتملة، تتعلق بالوجود الإنسانى عامة، وليس بطبيعة المرض والمريض فقط، فهو يواجه المشكلة الأزلية وهى “ماهية الإنسان”، و”غائية الحياة“، فعمله لا يقف به عند الاكتفاء برؤية جانب من جوانب الانسان مثل فكره أو سلوكه او اسم مرضه أو تقييم معاناته، وإنما هو يضطره بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مواجهة تساؤلات موضوعية حول وجوده هو، ومعنى استمراره هو..، إلى الوجود عامة… إلخ إلخ، هذه الأسئلة قد يلقيها المريض فى وجهه مباشرة من خلال أعراضه أو بصيرته، وقد تتحرك فى الطبيب تلقائيا نتيجة لصدقة مع نفسه وتصديقه أزمة مريضه، هذا أثناء الممارسة، فما بالك إذا مر بتجربة مغامـِـرة عنيفة، مثل التى أنتجت هذا العمل كله([9])، الذى يـُختتم بهذه الرؤية الذاتية الصعبة، التى قد تـَصدق أو لا تـَصدق؟
لا يواجه مثل هذه المشكلة إلا من عانى هذا الحدس العلمى الفنى الوجودى العميق حتى اضطر اضطرارا إلى مواجهة مشكلة الوجود البشرى، ليس نظريا فى مطلق غايته، ولكن واقعا خلال مسيرة حياته اليومية، وما أبعد القطبين! إنه يحمل هذه الرؤية قولا ثقيلا، لايستطيع أن يتخلص منها بعد أن أشرقت فى عقله ووجدانه معا، وهو أيضا لا يستطيع أن يـُغفلها وينحـِّـيها جانبا لأنه يراها كل يوم عدة مرات فى مرضاه، وطول الوقت فى نفسه، وهو لا يستطيع أن ينظـِّرها فى فكرٍ بحت، لأنه:
ليس فيلسوفا يبحث وراء ماهية المفاهيم فى ذاتها،
وهو ليس فنانا يحورها ويعلنها بتشكيلاته المميزة ليوقظ بها الناس يوما ما،
وهو ليس نبيا يحاول أن يحققها على أرض الواقع فعلا يوميا منتشرا مضيئا ثائرا مستندا إلى المطلق وما بعد الحياة الدنيا،
وهو ليس متصوفا بحيث يستطيع أن يضبط جرعة ما يبوح به وما لا يبوح به للعامة خاصة.
وهو ليس عالما بالمعنى الذى انتهى إليه أغلب العلم المؤسساتى الذى أصبح أقرب إلى كنيسة المعلومات المحكمة المنزلة المنضبطة بالمناهج الثابتة. والأموال المتراكمة.
إذا كان هو ليس أيا من كل ذلك، فمن هو وكيف هو؟
أظن أن هذا العمل – مرة أخرى: الأقرب إلى السيرة الذاتية عبر المسار المهنى– هو محاولة لعرض بعض الإجابات الناقصة، التى تتعلق بفرد واحد، مرّ بما أتيح له، ووضع إجابات هى بمثابة فروض عاملة لا أكثر ولا أقل.
نبدأ بالصورة التى وردت فى هذا الجزء من المتن، وهى الصورة التى ربما وصلت إلى مستوى ما من وعى من خاضوا التجربة معه، ورفضوه، وأحبوه، وحذروا منه، وتساءلوا عنه، فألقى سلاحه وتقمصهم وهم يتساءلون عن ماهيته، وقد بدا لهم أنه يدعوهم ليكونوا نسخة منه (وهذا غير صحيح على طول الخط كما سوف يتضح الآن، وفى هذا العمل برمته).
ولكن دعونى أضيف الفقرة التالية حتى يتأملها القارئ قبل أن نعود إلى شرح الفقرتين معا:
ذلك أنه يبدو أن صاحبنا قد قـَـبـِـل التحدى، دون أن يقرّ أنه فعلا يريد أن يكونوا “مثله”، فكل بقية هذا التشكيل تقول أنه حين قبل التحدى “مثلك يعنى إيه؟”، اكتشف فى دهشة أنه لا يعرف الإجابة، فقفز إليه نفس تساؤلهم، وراح يبحث معهم: صحيح: “مثلى” يعنى إيه؟ وبرغم أنه لم يقر أنه يريدهم أن يكونوا مثله، إلا أن للسؤال مشروعيته فى ذاته، فإن صح أنه يعرض على الآخرين نوعا من الوجود يليق بالبشر، فهل يا ترى حقق هو هذا النوع؟ فإذا به يكتشف أنه يسعى، ما زال يسعى، وسوف يظل يسعى غالبا، وفى سعيه هذا يرى صورته من أكثر من زاوية، فى أكثر من تجلِّ كما بدت فى هذا التشكيل.
مازلت أتقمص رأيهم (رأى أغلبهم) فى الصورة التى تلقوها عن نوع حضور هذا القائد (المِعلـِّم) وكأنه يفرض ذاتية وجوده على غيره بشكل حـَرْفى، وكأنه يريد من الآخرين أن يكونوا نسخة منه، هذا التلقى (من المريض أو الأبناء أو أى واحد) وارد فى العلاج النفسى وفى الحياة عامة، وأحيانا يكون حقيقة عند بعض المعالجين الذين لا ينتبهون إلى نوع وجودهم الذى يستمدونه من سلطتهم على مرضاهم.
المِعلِّم يبدو بذلك أنه مثل شيخ الطريقة (الصوفية) له مريدون، ومنهج (طريقة)، و”رؤية” (فروض!)، المهم هنا، هو أن استقبال مرضاه (وأحيانا المحيطين به أيضا)، يصوِّر لهم أنه يصنفهم على مزاجه
“قاعد يصنف فى البشر حسب المزاج”
والتصنيف هنا ليس بوضع لافتة تشخيصية (اكتئاب، فصام… إلخ)، لكنه تصنيف أقسى وأكثر دَمْغاً، هذا ما يصل للخائفين من طغيان شخصيته، وهو تصور إصدار أحكام على المشاركين في التجربة، أحكاما تشمل تحديد جرعة الحيوية (الحياة) التى يتصف بها الشخص (أو المريض)، فكثيراً ما يصف الطبيب النفسى (أو المعالج) مريضه بأنه ميت..
بصراحة دعونى أعترف أننى بعد حيرة طويلة انتبهت إلى أننى لا أنتمى إلى أيديولوجيا معينة، أو حتى إلى أية منظومة ثـَـبـَّـتـَـتْـهـَـا وصاية أوصياء عليها مهما كان تقديسها، بقدر ما أنتمى إلى ما يمكن أن أسميه “حركية الحياة“، وليس عندى توصيف أكثر من أنها “استمرارية الحفاظ على الوجود البشرى نابضا فى دورات استيعاب فإبداع، لا يتوقفان (حتى بعد الموت)([10])، يبدو أن هذا اليقين يصل إلى المحيطين بى باعتباره يقينا ثابتا، مع أنه ليس أكثر من “نظام” أو “برنامج له قواعده”، التى لا أعرف إلا أقلها.
يبدو أنه ترتب على انتمائى لما أسميته “حياة” كقيمة فى ذاتها: أن الآخرين تلقوه باعتباره “أيديولوجية ما” حتى لو كان اسمها “الحياة”،
عامل سبيل اسمه “الحياة”
وبالتالى يمكن تصور هذا التلقى من الآخرين مع احترام أسبابه، بأنه ينتهى إلى: “أن من يتبع هذا الطريق: (ولا أظن أنه وصلهم باكرا أنه: “النبض المستمر” والتغير الوارد دائما، والبسط (الإبداع) المتناوب)، فهو يتبع طريقة هذا “المِعلمْ” “شيخ الطريقة”، لكن استقبالهم هنا وأنا أتقمصهم أكد لى أن هذه “الطريقة” التى صورونى شيخها، قد وصلتهم باعتبارها أيديولوجية أقيس بها درجة “حركية الحياة” عندهم، وبهذا تصبح المسألة أقسى، وأخنقُ إحكاماً، من أية أيديولوجية أخرى، لأنها تصل إلى الآخرين، وكأنها “براءات وجود صادرة من “فوق“ بدرجة كذا!.
وها هو لسان حالهم يصف تصنيف المـِـعـَـلـِّـم لهم – من وجهة نظرهم – بخطوط كاريكاتيرية هكذا:
هذا يصلح لأنه ينتسب إلى “الطريقة” (الحياةْ).
“قال ده يعيش”!
وهذه لا تصلح أصلا للانتماء إلى هذه “الحياة”.
“ودى تموت”
وذاك يكفيه هذا القدر من جرعة الحياة.
“ودا مالوش إلا كده”
هكذا كان تصورهم – غالبا – عن أحكامى على الخائفين من هذه الحركية، أو هذا البرنامج، باعتباره أيديولوجية مفروضه، وكأن عليهم أن يتبعوها ليحظوا بنيشان الشهادة أنهم “أحياء”، وهنا يقفز سؤال على لسانهم: إذا كان هذا هو المطلوب يا عمنا فكيف يمكن تحقيقه؟
وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه طبعا بالألفاظ، ولا حتى بالممارسة، بشكل مباشر: ويتكرر السؤال، فيأتى جوابٌ ضمنى: أنه إن لم توجد تفاصيل مسبقة لمعالم المذهب، فثم طريق إليه، وهوما يقابل “المشى على الصراط“.
مفهوم “المشى على الصراط” له معى قصة طويلة فى مسار فكرى ووجودى، وقد أسميت ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط” بأجزائها الثلاثة (الواقعة – مدرسة العراة – ملحمة الرحيل والعود)([11]) بناء على هذا المفهوم، أنا أفهم المشى على الصراط باعتباره جزءًا من البرنامج الذى أسميته “حركية الحياة”، وهو يتضمن: “عملية الانتقال” من حالة “وجود مستقر” (ساكن غالبا) إلى حالة “وجود واعٍد آخر” (غير معروفة معالمه عادة)، أعتقد أن هذا هو قريب مما يسميه فردريك بيرلز “المشى فى النار”([12]) Passing into Fire، خاصة فى العلاج الجمعى حيث يتواصل الإفشال التدريجى للآليات الدفاعية المستعملة والمثبـِّـتة لحالة الوجود المستقرة، فتهتز الميكانزمات وتتخلخل لدرجة ما، ويُستدرج مُستعملها بعد هز آلياتها إلى “نور البصيرة”، فلا تعود ميكانزماته قادرة على مواصلة عملية التثبيت والتسكين التلقائية، فيتحرك المريض (أو أى شخص ينمو) مرغما نسبيا من خلال اختيار عميق إلى احتمال آخر، ويدخل فى مرحلة صعبة عادة بعد أن فقد القديم فاعليته وتماسكه دون، أو قبل، ظهور ملامح الجديد، برغم يقينٍ مـَـا بأن هذا الطريق (الصراط) هو الذى يؤدى إلى “احتمال ما يرجـُو مما لا يُعـْلم”، فهو ليس صراطا يؤدى إما إلى الجنة “يدّيه قيراط فى جنته” وإما إلى النار، ولكنه صراط بين “القديم الساكن” و”الجديد المحتمل” “غيْر معروف المعالم”.
الاتهام المـُـوَجـَّـه للمعلم هنا هو أنه يخدع الناس – خاصة مـَـنْ حوله– بوعود غامضة، لكنه يخفى فى سريرته مواصفات محددة للحياة التى يعتبرها الجنة (ربما اليوتوبيا)، وهكذا يبدو لهم أن دخول جنته الخاصة (الخصوصى) هذه لا يرتبط بكدح السائر على الصراط، بقدر ما يرتبط برضا المعلم حامل قلم الأحكام والتصنيف!
قاعد يـِصنـَّف فى البشر حَسَبِ المزاج،
إذن فهو متهم بأنه يخلخل القديم، ولا يعد بجديد محدد، ويمنح مقابل رضاه حجرات أو قصور (أو أفدنة أو قراريط) فى جنته الخاصة، فهى – من واقع تخوفهم – ليست دعوة للتكامل والتطور، وإنما هى دعوة للتبعية والتقليد بأن يكونوا نسخة منها.
واللى بيشبه حضرتـُهْ، يديه قيراط فى جـَنـِّتـُهْ
كل هذا وصلنى ضمن وجهة نظرهم التى تقمصـْـتـُـهـَا، وقد تصوروا، أو قرروا، أو اكتشفوا، أن كل ذلك: كان يجرى تحت زعم “حرية مشبوهة”.
فى هذه المواقف العلاجية (وغير العلاجية) يتم استعمال كلمة “الحرية” بإفراط شديد وخداع حقيقى، لا أتردد فى أن أشبهه باستعمال أمريكا للفظ الديمقراطية التى تسوّقها لنا باستمرار لتحقيق الفوضى (وهم يوهمونا أنها خلاّقة)، حتى نخضع للتبعية والاستسلام، وهم يصورون لنا أن ذلك قد تم باختيارنا (حريتنا).
المتن هنا يحاول أن يعرى صورة “المعلم” كما وصلتهم وهو يدعى أنه يسمح لأى واحد أن يخالف تعليماته، السماح بالاختلاف، مثل مزاعم “قبول الآخر” من على السطح، يبدو كأنه: منتهى الحرية، لكنه سماح فوقىّ مشروط – كما يرونه:
واللى يخالف “هوه حر”!!
وعليه أن يدفع ثمن استعماله حريته حكما نهائيا بالنفى الإعدامى.
مَيـِّت صحيحْ،!!
لكنه حرّ فْ تربته!
أية حرية تلك التى تفترض واحدية الاختيار قبل السماح المزعوم بالاختلاف؟
أية حرية تلك التى تنتهى بالحكم بسحب صفة الحياة منك بمجرد أن تخرج عن الخط المرسوم: الصراط المحدد!!؟
هكذا يتم الإعدام “رميا بالأحكام الفوقية” بعد الطرد من الجنة.
كما يمكن أن يتم النفى القاتل بالسقوط من على شعرة الصراط: وأنت تترجح عليها مرعوبا.
كثير من المرضى الذين يدخلون هذا المأزق يلح لسان حالهم فى طرح أسئلة مشروعه معلنة وخفية، عادة تقول:
مادام القديم قد اهتز أو تخلخل وتحطم هكذا حتى لم يعد من الممكن الرجوع إليه، فلم يعد أمامنا إلا المضى قدما إلى المجهول، لكن يظل من حقنا ان نسأل “إلى أين؟” “ثم ماذا؟”،
وهم لا يجدون إجابة – من المعلّم (المعالج!) بالذات – إلا “أنت حر“،
كيف “هو حر” وهو لم يعد يستطيع إلا المضى قدما على شعرة الصراط؟
هذه الصورة التى تبدو ديكتاتورية إلى هذه الدرجة ليست حقيقة العلاج، ولا هى كانت حقيقة ما جرى فى التجربة الخاصة التى أتحدث عنها، (من وجهة نظرى)، إلا أن تعريتها هكذا ربما تكون ضمانا لتجنب حدوثها عشوائيا فى العلاج أو غير العلاج إلا اضطرارا.
مساحة الحركة، والحضور الاختيارى، والاستمرار الاختيارى المتجدد لفترة من الزمن تسمح بمواصلة السير على الصراط إلى الوجود الجديد الذى يصبح قديما ليهتز فيما بعد، فى أزمة نمو لاحقة، فيدخل إلى صراطٍ تال وهكذا: هذا هو قانون حركية الحياة.
“المشى على الصراط” لا يوصل صاحبه إلى غاية محددة، لكنه يؤكد له سلامة توجهه كدْحاً.
إن أسهل سبل الهرب من مواجهة مواصلة السعى اختيارا، هو أن يتصور المريض (أو أى شخص) أن المطلوب هو أن يكون صورة طبق الأصل من المعالج – المعلم – (القدوة)، وهذا يبدو في البداية أنه هو الضمان إذا واصل المشى على الصراط، ومادام قد أصبح نسخة من “المعلم”، فهو سوف يحصل على قيراط من الجنة الموعودة
لكن كيف يكون مثله والمعلم نفسه لا تتبين له معالم محددة ومعلنة؟ فيتواصل التساؤل:
“ونقول له: مثلك يعنى ايه”؟
يسكت.. يتوه
يسرح.. يقف!
وعـْـنيهْ تقول.. كلام كتير:
وهكذا لا يجد الخائفون جوابا جاهزاً لأن المعلم شخصيا لا يعرف الجواب،
فيبدأ هو شخصيا البحث عن جواب وفى عينيه “كلام كثير” وتنتقل السيرة إلى مواجهة الذات في صورة أسئلة متلاحقة وفروض متولدّة، واحتمالات متعددة:
………………………….
…………………………
ونواصل الأسبوع القادم لاستكمال قراءة اللوحة السادسة عشر “المعلم”
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] – يحيى الرخاوى: (2018) سلسلة “فقه العلاقات البشرية” (4) (عبر ديوان: “أغوار النفس”) “قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج“، الناشر: جمعية الطب النفسى التطورى – القاهرة.
[2] – ربما هذا هو ما عبّرت عنه قائلا: ”كل القلم ما اتقصف يطلعْ لُـه سن جديدْ،”…الخ. (مقدمة ديوانى “أغوار النفس” بالعامية) الطبعة الثالثة 2017 منشوارت جمعية الطب النفسى التطورى.
[3] – يحيى الرخاوى (2000) الترحال الثالث: “ذكر ما لا ينقال” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى ، القاهرة.
[4] – يحيى الرخاوى (2018) فقه العلاقات البشرية (3) “قراءة فى عيون الناس” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، القاهرة.
[5] – Intellectulized Introspection
[6] – يمكن الرجوع إلى “مستويات الاشراف” نشرة الإنسان والتطور اليومية: (19-3-2013)، (24-3-2013) www.rakhawy.net،
[7] – يحيى الرخاوى: الترحال الأول: “الناس والطريق” – الترحال الثانى:” الموت والحنين” – الترحال الثالث: “ذكر ما لا ينقال” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى سنة 2000.موجود بالموقع وفى طبعة ورقية بمكتبة الأنجلو المصرية ومستشفى دار المقطم للصحة النفسية.
[8] – أفضل استعمال كلمة المِعلِّم (بكسر الميم) إشارة إلى فكرة الصبى والمعلم في أي صنعة، وكثيرا ما أفخر حتى مع مرضاتى أنى “صنايعى” أكثر من اعتزازى بأنى طبيب، وأكثر طبعا من أننى “دُكـْتـُرْ”
[9] – يحيى الرخاوى: (2017) ديوان “أغوار النفس”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، القاهرة.
[10] – نشرة الإنسان والتطور اليومية: بتاريخ 5-1-2008 “الموت أزمة نمو” www.rakhawy.net
[11] – يحيى الرخاوى: (2008) ثلاثية المشى على الصراط، الجزء الأول: “الواقعة”، الناشر “ميريت”، الجزء الثانى (2008): “مدرسة العراة”، الناشر: الحضارة للنشر، الجزء الثالث (2017): “ملحمة الرحيل والعود”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، القاهرة.
[12] – فريدريك بيرلز Frederick Perls (8 يوليو 1893 – 14 مارس 1970(، هو ألماني. يعتبر صاحب نظرية الإرشاد والعلاج النفسي الجشطالتي (Gestalt therapy).
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى


