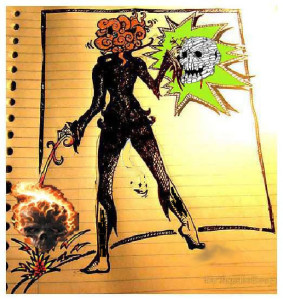نشرة “الإنسان والتطور”
4-7-2011
السنة الرابعة
العدد: 1403
كتاب جديد (قديم)
عندما يتعرى الإنسان (6 من 12)
“دروس للناس: فى الطب النفسى”
أبلة الناظرة
قال الحكيم:
– دخلت علىّ وقد انطفأ لون بشرتها الأسمر، فظهرت تجاعيد وجهها كالحة صدئة ولكن عيونها لا تزال تلمع ببريق حاد، قالت عيناها ”لولا الشديد القوى” وقال صمتى: “ماذا”؟ وقالت نظراتها: ”ما رأيتك عمرى” وقلت وهى تنظر إلى الكرسى مترددة تود لو انصرفت قبل أن تجلس:
- تفضلى استريحى.
قالت:
- أين هى ؟
قلت:
- ماذا؟
قالت:
- الراحة
قلت:
- فى داخلك
- داخلى أنا؟ إن داخلى هو الجحيم ذاته، نار موقدة تطلع على الأفئدة، ويشتد لهيبها فى الليل..الليل وحش كاسر.. وأنا فريسة فزعة.. أخاف أن أنام.
- إذن هو ذاك
- لست أدرى ما “هو”، وما “ذاك”، ولكن هذا ما أتى بى إليك، النوم وجهنم التى فى داخلى، وقد رأيت الخطر من أول وهلة، لم يكن أرقا كالأرق، ولكنه الخوف، ليس هناك ما يؤرقنى، كل شىء يتم كما أريد. كل شىء بنظام. حتى الجولة الأخيرة. حاولت أن أتخطاها، حوّلت الهزيمة إلى مزيد من التحدى والقوة وكدت أنساها، أو قل خططت أن أتعداها لأنساها، ثم إن هذا الذى كان، حدث فجأة وبلا مقدمات، فحين وضعت رأسى فى تلك الليلة.. هى ليلة غير الليالى. كيف حدث هذا فجأة دون مقدمات؟ حين وضعت رأسى تلك الليلة على الوسادة دق ناقوس فى جانب رأسى.. كأن بناء قد انهار، كأنى مت فجأة، هل تتصور أن الشعور بالموت يصاحبه شعور باليقظة الحادة، هل تتصور أنى إذْ أنتبه كل هذا الانتباه أشعر فى ذات الوقت بكل الضياع، هل هذا ما يصدق عليه ”أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا” ولكن كيف ينتبه الموتى الأحياء؟ كيف يموت جزء منك لتستيقظ فجأة. فى تلك الليلة انهار كل شىء.. تقوّض البناء الشامخ على رأسى فأفقت، مت فصحوت، والغريب فى كل هذا أن ذلك يحدث فجأة، وحين شعرت أن كل شىء قد انتهى للحظة، استيقظتْ فىّ أشياء أخرى، كنت فى سبات عميق لا أظن أحدا يستطيع أن يفهم إلا إن عاش التجربة ذاتها، إن تجارب الإنسان الممزق لها اسم رشيق لديكم، لابد أن ينقلب الإنسان بين يديكم إلى صفحة من كتاب… إلى عنوان.. إلى لفظ جامد بارد لا حياة فيه، التجارب لا توصف بالألفاظ سوف تجمع الأعراض وتضربها وتطرحها وتقسمها وتخرج منها باسم رقيق أو صفيق، وتناقشها مع زملاء لك، كل ذلك وأنت لا تعرف عنى شيئاً، بالله عليك كيف تجرؤ أن تحول الناس إلى ألفاظ؟
- ليت هذه غاية مهمتى.. ولكن لا بد من الألفاظ أو أى شىء كالألفاظ، لا بد من لغة حتى نتفاهم… أية لغة.
- ولكن الألفاظ انهارت مع الصرح المتداعى… ذهبت مع الأنقاض كنت قبلا ”أقول”.. وكان لقولى صليل ورنين.. كان لا يُرد لى قول، كانت تعليماتى فى المدرسة مقدسة.. كل لفظ لابد أن ينفذ حرفياً.. حرفياً، حتى الحروف كان لها معان حتى الصمت كان له معنى؛ وحين انهارت الأشياء كلها وذهب النوم. جعلت أتساءل عن معنى كل هذا، ولكن مالى أتحدث إليك وكأنك تسمع وتفهم؟ إذْ كيف تفهم مالا أستطيع أنا التعبير عنه؟
- أحاول
- يكفينى أن تحاول، فلابد أن أجد من يحاول بعد أن توقفت محاولتى أنا، وعدت أشك فى كل شئ
- كيف؟
- إنِ اهتزت معانى الألفاظ فلابد أن تراجع ما كان حتى تعيد بناء المعانى من جديد.
- إذن… ماذا؟
- كان كل شىء مرسوم.. له هدف وتخطيط ونظام، كنت أقول “لا” يعنى “لا”، كانت الـ ”لا” حرف نفى، وكان الجميع يعرفون ذلك وكان على طرف لسانى دائما: “أنا قلت لا يعنى لا”، وكان الجميع يعرفون ذلك، وبالتالى كانوا يعرفون أنى حين أقول نعم فهى الـ”نعم”، ولو انطبقت السماء على الأرض فلن تتغير ”اللا” إلى “نعم” ولا العكس، ما أغرب هذه الأيام.
حين كانت الأشياء عادية تماماً، كان لكل شىء معالم محدودة فى دنيا غير محددة المعالم.. كانت كل ألفاظى جملا مفيدة.. والآن.. تغير كل شىء وتداخل الكلام فى بعضه البعض… بغير سبب… أى والله بغير سبب.
لقد تخرج من تحت يدى أجيال أعتز بهم فى كل مكان.. كنت أدير مصنعا للنجاح، وكانت القوالب محكمة.. والطالبات نسخاً مكررة مطبوعة باسمى… أعنى باسم مدرستى، ليس أجمل من أن ترى نتاج عملك أمامك تفخر به، ولكن الآن، لماذا أرى بناتى مثل العرائس الحلاوة التى تعرض بمناسبة مولد النبى، كيف يطيق الإنسان أن يفخر بعرائس بعرائس مذاقها شديد الحلاوة ولكن ليس فيها حياة؟! هل ذقت طعم حلوى تلك العرائس، أنا لا أطيقها، فكيف أفخر بها، ولكنها متقنة الصنع مزركشة المظهر، ألا يكفى هذا؟ كان يكفى زمان، أما الآن فلم يعد يكفى.. بل لم يعد شىء البتة يكفى.
- يكفى ماذا؟ كيف؟
- حين أحكى لك عن كل ذلك النجاح أسمع فى جانب عقلى همسا يقول “طز” أنا آسفة للتعبير، ولكنك طبيب لا بد أن أصارحك بكل شىء..، وأحيانا حين أكون متحمسة غاية الحماس فى ذكر مباهج عملى يخرج لى هذا الجانب من عقلى لسانه، هل يمكن أن أعيش بعد ذلك.. بل أنه لا معنى للنوم ولا للأكل ولا للشراب إذا فقد النجاح قيمته بهذه السخرية اللاذعة ولكن ما معنى النجاح يا دكتور؟
- أن يحقق الإنسان هدفه
- إذا كان كذلك فقد حققت هدفى، فلماذا يسخر منى عقلى، أعنى ذلك الجانب من عقلى؟ أنا من عادتى ألا ألتفت إلى الهمس أبدا.. كانت المدرسات يهمسن، والدادات يهمسن وأنا لست هناك، ماذا يصنع الهمس، أليس الهمس كلام ضعيف؟ أنا لا أحب الضعف، فلماذا حين أسمع الهمس الآن أضطرب منه، ومن أين يأتى الهمس.. منى أنا..”أنا” أسخر من “أنا”، كان هدفى أن أصنع تلميذات متفوقات، مؤدبات، منظمات، يحفظن آرائى ويرددنها.. لأن آرائى هى الصواب، وقد كان، أليس هذا هو عين النجاح؟ أليس هذا هو تحقيق الهدف؟
قلت:
- ولكن هل كان هذا هو الهدف؟
قالت:
- يظهر أنك خبيث خبث ذلك الجانب من عقلى الذى يردد همس السخرية، نعم كان هذا هو الهدف، وهل يمكن أن يكون لناظرة ثانوى هدف آخر.
- مجرد سؤال عابر
- لا.. بل هذا هو السؤال الذى جئتك من أجله… “ما هو الهدف؟”
- النجاح.. مثلا
- إذن ماهو النجاح؟
- تحقيق الهدف
- اسمع يا دكتور أنا لم أجيء إلى هنا لألعب معك لعبة القط والفأر، ولست فى حصة منطق، ولست أريد أن أضيع وقتك ووقتى، وقتى؟ ولكن ما معنى الوقت.. هل هناك زمن.. حين انهار كل شىء توقف الزمن.. بل تراجع إلى فترة سحيقة ليست لها بداية، بل إنى شعرت أنه تراجع إلى ما قبل وجودى، بل إنه كاد يتراجع إلى ما قبل وجود الأشياء كلها. ما أقسى كل هذا، ولكن هل أنت متأكد أن هذا المرض فى حدود اختصاصك؟ هل أنت متأكد أن هذا مرض أصلا؟
- أنا متأكد أنى أستطيع مساعدتك، لو أردتِ.
- وهل يمكن ألا أريد؟ إذن لماذا جئت إليك؟
- للمجيء هنا أسباب عدة.. ولا أستطيع أن أرجح إحداها حتى تتضح الأمور.
- وهل تتضح الأمور؟ وكيف تتضح وهى غامضة علىّ أنا شخصا؟ إنه الغروب أو هو ما بعد الغروب وما قبل الليل؟ هل تعرف هذا الوقت الكئيب؟ إن الظلام الدامس شئ محدد المعالم مثل النهار المشرق، ولكن ذلك الضباب الهلامى لا تكاد تمسك منه شيئا حتى ينسحب منك، ويصبح الوضوح والتحديد فى عداد المستحيل.
- ولهذا جئت إلى هنا.
- هل أنت صانع المستحيل؟
- بل الإنسان فى داخلك هو الذى يصنع كل جديد
- إن هذا هو المستحيل ذاته، أن تجد إنساناً فى داخلى، أنا فى داخلى شىء فى زنزانة من جليد، ولا بد حتى يخرج ذلك الشىء إنسانا من جديد أن ينصهر الجليد، ولابد لكى ينصهر أن تضطرم فىّ النار، ثم لا أدرى ربما احترق أنا شخصياً قبل أن ينصهر الجليد حتى إذا خرج ذلك الانسان الداخلى من زنزانته لم يجد إلا الرماد، أو قل لى بربك كيف نصل إلى ذلك الانسان الخائف المتجمد دون أن أحترق.. ولكن لماذا حدث كل ذلك وقد كنت أشد الناس نجاحاً.
- رجعنا إلى النجاح؟
- نجحت، نجحت، نجحت، حتى أصبح النجاح بغير معنى، فانقلب كل نجاحى فشلا، لماذا يفعل الانسان بنفسه كل هذا؟
- لأن الانسان أحيانا تسرقه أهداف غيره وهو يحسبها أهدافه، وحين يفاجأ بالحقيقة يختل توازنه.
- ولكنها كانت أهدافى أنا، واختيارى أنا، لم يكن فى حياتى أحد إلا أنا وواجبى وقوتى وقدرتى أنا، ولكن كيف حدث كل ذلك؟
- كيف؟
- كان كل شىء على ما يرام، كنت قوية تماما، ولكنى كنت وحدى، كان الناس دائما يقتربون منى إلى قدر محدود ولكنى لا أسمح لهم بأن يقتربوا أكثر، لماذا؟.. لقد كنت أعرف كل شئ، وأسير فى كل طريق، ولكنى أخشى اقترابهم منى، آراؤهم لم تكن تعنينى فى شىء، لأن آرائى دائما هى الأصوب، لأن كفاحى هو الأكثر أصالة، لأنى صاحبة رسالة وهم أصحاب مهايا، موظفون ينتظرون العلاوات، وقد عشت وسط كل هؤلاء على بعد منهم، حتى بناتى كنت أخشى أن يقتربوا منى أكثر، كانوا أقرب إلىّ فى كشوف المدرسة أكثر من الواقع الحى، كنت أدير مصنع التفوق بمهارة لا مثيل لها، وكان يصنع عرائس حسنة المنظر، وقد قلت لك: أنا أحب أن أشاهد عرائس المولد ولا آكلها، وفى الفترة الأخيرة كنت أحاول أن أتذكر بناتى فيردن إلى خاطرى على بعد منى لا يقتربن ولا أقترب، كنت على قمة هرم من العمل والنظام وأنت لا تستطيع أن ترى إلا موقع قدمك وأنت على القمة، فى حين أنك ترى الهرم كله وأنت على السفح، وتمنيت أن أصنع شيئا هرما أكثر إشراقاً وأدوم خلودا، ولكنى حين وصلت إلى القمة نسيت أشياء كثيرة وكان كل همى ألا أنزلق. هل يفيدك أن تسمع هذا.. أعنى هل يمكن أن يفيدنى؟
- بلا شك
- بل كلى شك.. ومع ذلك فهى قصة ليس فيها جديد، فتاة فى كلية تربية، بنت من ثمان بنات لأب متوسط فى كل شىء.. فى الطول والعرض والذكاء والطموح.. وكل شىء، ما أبغض أن يكون الإنسان متوسطا فهو يكاد يكون بلا معنى، ووسط هؤلاء البنات الثمان تفتحت نفسى أتساءل كما يتساءل الشباب، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الفقر؟ لماذا الألم؟ لماذا الضياع؟ لماذا الحياة؟ ومثل كل الشباب وجدت إجابات غير مقنعة، وهروب مقنع، وأحسست بالرغبة فى أن أصنع شيئا لنا نحن البنات ولماذا البنات؟ لأنهن أصل الحياة، وصعدت السلم… وفرحت بمهنة التدريس، وكنت ناجحة متحمسة أريد أن أصنع شيئا ما، وفى المدرسة عشت أتألم من منظر الناظرة، امرأة بيضاء مترهلة، ذات عيون صفراء..أى والله صفراء… لا تهتم إلا بالهدايا، وهى تفضل الحلوى كل أنواع الحلوى، وتقرب إليها تلك الحاشية التى تجيد ”التكبيس” لزوم آلام المفاصل، أما فى العمل فكان كل همها أن تسدد الخانات وترضى الرياسات وتزين السلالم بزهريات الورد فى انتظار مدير المنطقة أو نائبه، أو قريب الوزير أو حاجبه، وثرت مع مجموعة من المدرسات ثورة هائلة، وتخلصنا منها، وأصبحت أنا الناظرة، أنا ”أبلة الناظرة”، إلى هنا وكل شئ طيب، ثم تسلسلت الأحداث بعد ذلك وتغير كل شىء، أم أنا التى تغيرت؟ لست أدرى؟، وما السبب فى كل ذلك؟ الآراء التى كانت تستهزيء بها الزميلات أصبحت تنزيلا لا يأتيه الباطل وأصبح كل ما أقوله صوابا، ورفضت ذلك فى أول الأمر، ولكن خيل إلى أنى كنت فعلا على صواب، وابتدأ الجميع يصدقون على كلامى… وانزعجت ثم استأنست… ثم ارتحت
“أنا” أحب الحق
“أنا” أعرف ما هو الحق
“أنا” أقول الحق
“أنا” الحق
وهم يوافقونى على ذلك، ومن يخالف فقد خالف الحق.. وكان أول المخالفين زميلاتى اللاتى ثرت معهن، ولا بد أن واحدة منا هى المحقة والجميع يؤكدون أنى أنا المحقة؛ فلأتخلص من الزميلات المشاغبات حتى لا يعقن المسيرة.. وقد كان، ولم يبق حولى إلا من يصدقنى، وهكذا نوفر الوقت ونتفرغ للبناء، وحين كان يظهر بين المدرسات من له رأى، أى رأى، كانت المقربات يخفننى منها، كن يقلن ما دمت أنا على صواب فما الداعى لصواب آخر، وكن يقلن أنه إذا زاد الاختلاف فإنى معرضه للتخلى عن النظارة مثلما فعلت بالبيضاء المترهلة، وكنت أخاف على رسالتى ألا تتحقق.
أنا لا تهمنى النظارة ولكن يهمنى المبدأ؛ وقد هممت مراراً أن أتركها ولكنى خفت على تحقيق رسالتى من بعدى، كان الخوف يرعبنى.. الخوف على رسالتى ومبادئى، وعلى نفسى، لأنى أنا التى أمثل الرسالة والمبادىء، فكنت أعمل المستحيل حتى أنقل صاحب الرأى إلى مدرسة أخرى، ويا حبذا خارج المنطقة ولم يبق من حولى إلا من يؤيدونى.
ومجلس الآباء، حتى مجلس الآباء كان يوافقنى على آرائى، وهو مجلس منتخب بلا أية شبهة فهو يحوى مختلف النزعات والحرف والثقافات، وأعضاؤه ليسوا موظفين لدى، حتى أشك فى نفاقهم، إذن فأنا على حق دائما على حق، وبالإجماع.. دائما بالإجماع.. ولكن هل يمكن أن يتشابه الناس إلى هذه الدرجة؟ درجة الإجماع فى كل شى… كل شىء وكنت أتمنى فى قرارة نفسى أن يعارضنى أحد.
ولكن إذا ما عارضنى أحد كنت أحس أنه يريد أن يقضى علىّ، أن يزيحنى من مكانى، وسرعان ما أتخلص منه، ولم لا؟ فأنا أعرف كل شىء، كانت خطبة الصباح تردد آرائى الغالية، وصحيفة الحائط تزينها معتقداتى الصائبة، وأصبح كل شىء هو أنا، وأنا هى كل شىء، وظل الناس على بعد منى لا يدخلون حياتى أبداً… ولم أشعر حينذاك بقسوة الوحدة وأنا وسط الناس، إن ألعن الأشياء أن تكون وحيداً بين الناس لأنهم لم يعودوا إلا نسخا مكررة منك، أين التفاعل أو التضارب الذى يصنع الحياة.. وحين جاءت تلك الاخصائية الاجتماعية ابتدأت أحس بالخطر المهدد وعشت أياما وشهورا أحاولى أن أصوغها فى قالب آرائى فلم أستطع، واهتززت أمام نفسى، ولكنى مضيت فى طريقى، إذ كيف تأتى تلك الفتاة المتخرجة أول أمس، والتى لا تدرى من أمور المدرسة كثيرا أو قليلا تحاول أن تصنع شيئا غير ما أرى، صحيح أنى أحب الاعتراض ولكن فى حدود اختيار أحد آرائى، لا معنى أن يأتوا بأراء جديدة إذ ليس هناك جديد مادمت أنا أعرف كل شىء، صحيح أنى فى أول الأمر تململت من الاجماع، ولكن الآن وبعد أن تعودته أجد أن هذا هو أقرب الطرق إلى العمل المنتج، ماذا تعرف هى فى شئون مدرستى؟ أية خبرة لها حتى “تقول” أصلا؟ إن كل ما عليها هو أن توزع الصدقات وتعفى الفقراء من المصروفات وأنا لا أعترض، أما أن تتحدث عن العواطف والإنسانيات فإن هذا يعنى أنى بلا عواطف ولا أفهم فى المشاعر الانسانية…. لا… سوف أقضى عليها سوف أسحقها، خاصة بعد أن فوجئت بها وهى تحرض أولياء الأمور ليرشحوا أنفسهم فى مجلس الآباء ليصنعوا شيئاً جديداً، أى شىء يمكن أن يكون جديداً عن آرائى، وهل هناك جديد بعد كل ما حققت؟
قلت:
- ولماذا نسميه تحريضاً… ألم يكن مجرد اقتراح.
قالت:
- ولكنى تعودت أن أقترح أنا، وأن أنتخب أنا، أعنى أباشر الانتخاب، وأن أسيّر الأمور كما هى فى صالح المدرسة فأى اقتراح بعد ذلك، أو غير ذلك، هو تحريض صريح.
- وماذا يخيفك ما دام الرأى الصواب هو الذى سينتصر فى الأغلب.
- لقد كنت تعودت الإجماع، وحين تتعود شيئاً يختل اتزانك إذا تغير، وظيفة الانتخاب ومجلس الآباء هى أن تصاغ آرائى صياغة مقبولة، ذلك المستشار والد البنت هناء، كان بارعا فى هذا الشأن، وهو يـُنتخب دائما فى مجلس الآباء لذلك فالآراء التى تخرج منه، تخرج فى شكل مقنع. ليس هنااك سوى صواب واحد ! نعم ولكنى أحب النظام، والنظام يقول أنه لابد للمدرسة من مجلس إدارة، وأنه لا بد من مجلس آباء كذلك، ولا بد من ترشيح، ولا بد من انتخاب، وما دمت أحب النظام، وما دام النظام لا يضر ولا يتعارض مع آرائى، فلتكن مجالس للآباء وللإدارة وقد كان كل شىء يسير كما أريد، حتى جاءت هذه الاخصائية اللعينة، لست متأكدة إن كان لها أغراض خاصة أم لا، أصبحت لا أعلم… ،لا يبدو عليها كذلك، فهى متواضعة ترفض أية ترقية وتفضل دورها كإخصائية، وقد رفضت التفتيش والترقى وتقول أن عملها مع البنات أقرب إلى الانسانية وأكثر فاعلية وأوسع مجالا للخدمة، هى إنسانة طيبة ولكنها شاذة وطويلة اللسان، هل تتصور أنها أقرب إلى البنات منى أنا التى أصنعهن على عينى أنا التى أصوغ العرائس، وهى تقول أنها تحاول أن تدب فيهن الحياة، فهى تتعهد عواطفهن وتسمع لهن وتحس بأحاسيسهن، وأنا أبتعد وأبتعد، ويلفح خلاياى هواء بارد، ويزيد شعورى بالوحدة وأمج النفاق رويدا رويدا… ربما كانت هذه بداية القصة.
وسكتت فجأة.
وطال السكوت
فقلت:
- ثم ماذا؟
قالت:
أنا لا أفهم لماذا انهار كل شىء منذ تلك الليلة المشئومة، لم يحدث أى شىء فى حياتى، حتى تلك الاخصائية كانت ترعبنى من الداخل أما فى ظاهر الأمر فكل الأمور تسير على هواى أقول “لا” يعنى “لا” أقول” نعم” يعنى “نعم” أليس هذا هو المهم؟
- ما رأيك أنت؟
- نعم إن النجاح والقوة والتفوق هى كل شىء.
- هى أهداف عظيمة.. ولكن ماذا حدث؟
- أنا لا أعرف ماذا حدث، لهذا جئت إليك، قل لى أنت ماذا حدث؟ الوحدة.. والمسافة بينك وبين الآخرين، والعيون من حولى لها لغة أقسى من كل تصور.. لست أدرى كيف وصل الأمر إلى كل ذلك، أول ما داخلنى هو الخوف. كنت قد تعودت السيطرة وتعودت أذنى “آمين” وإذا بهذه النغمة النشاز تظهر فى الأفق شائهة كريهة، وابتدأت أخاف.
- ولكن لماذا؟
- لا أعرف، ولكن الانسان إذا عاش وحده فإنه يخاف أى احتمال آخر، خصوصاً إذا تعود الحل الواضح الصريح.
- ولكن ربما كان الحل الواضح الصريح خطأ… وربما كان الاحتمال الآخر أفضل.
- أنت تتحدث مثل الأخصائية، لأنه إذا كان فى الأمر”ربما” تداخلت الأمور وضاعت الحقيقة وضعت أنا أيضا
- ولكن الوصول إلى الحقيقة، لا يأتى إلا إذا كان فى الأمر ”ربما”
- كان ذلك أيام زمان أيام كنت فى ثورة شبابى…
– كنت فى سن الأخصائية؟ ولكن الأخصائية شىء آخر، أنا ثرت على البيضاء المترهلة، أما هى فلماذا تثور وليس فى الامكان أبدع مما كان.
- ولكن الدنيا تتطور.
- أنا التى أطورها… وأنا أعرف صالح بناتى.
- فلماذا الخوف؟
- أنا جئت هنا أسألك لماذا الخوف.
- من الوحدة والاحتمال الآخر.
- ولكن الجميع يحيطون بى.
- على مسافة.
- ولكنهم كثيرون.
- نسخ مكررة.
- وماذا فى ذلك؟
- إذا كان كل من حولك مثلك فلا يصبح حولك أحد… فهى الوحدة الباردة. بلا آخرين.. وسط الآخرين.
- وهل لابد من الاعتراض والنقاش والجدل حتى أشعر بالآخرين؟
- لابد من الاختلاف حتى نحس بغيرنا وبالتالى نحس بأنفسنا.
- وماذا أستفيد من الخلاف غير الصداع… والخوف.؟
- بل تشعرين بذاتك.
- ولكنى أفنى فى بناتى ومدرستي
- فلا يبقى منك شىء.
- ماذا تعنى؟
- إذا فنيت فى أى شىء مهماكانت قيمته، فأين أنت؟
- نعم أين “أنا”؟
- لقد كان لك جهازا خارجيا من النجاح والتفوق يخفى وراءه ذاتك الحقيقية، وحين تكرر النجاح دون أن تجدى ما تريدين انهار كل شىء.
- وكيف انهار؟
- أسمع منك.
- أنا لا أذكر شيئاً.
- إطلاقا؟
- أبدا.
- والاخصائية؟
- لا… الاخصائية أرعبتنى فقط ولكنها لم تكن سبباً فى هذا الانهيار وقد نقلتها من المدرسة فى نهاية المطاف.
- إذن ماذا؟
- ربما مدرسة الراهبات
- ماذا تعنين؟
- … كأس كرة السلة التى ضاعت، ولكن هذا شىء بسيط سوف نسترده فى العام القادم.
- أكيد؟
-… هل تشك فى ذلك؟
- ماذا حدث؟
- هى مدرسة الألعاب الرياضية التى يسمونها “الضابطة” خدعتنى.
- هذا نتيجة الاقتصار على الرأى الواحد
- قالت إن الفريق مستعد وسيأخذ كأس المنطقة
- ثم ماذا؟
- تحديت وراهنت وفاخرت أمام الجميع.
- ثم ماذا؟
- ثم انهزمنا ستة صفر
- أى فريق يمكن أن ينهزم
- ولكن هذه الهزيمة أثارت الشك فى كل شىء وكل أحد… ونظرت حولى فلم أجد إلا أبواق النفاق، ومع ذلك فأنا أحب سماع النفاق.
- إذن لا ذنب للمدرسة أو الضابطة.
- بل هى كاذبة مغرورة حمقاء، وقد خدعتنى.
– خافت منك.
- وهل أنا أخيف؟
– ماذا ترين؟
- هم الجبناء.
- ولكنك تخافين الشجاعة.. فتحاربين الاخصائية
- هم الذين عودونى على ذلك
- وأنت التى أردت ذلك
- ولكنى سوف أنتصر فى العام القادم… إذا كان هناك عام قادم
- كل شىء جائز
- ولكن لماذا انهار كل شىء.. فى داخلي؟
- لأنك اكتشفت الخداع.. والوحدة.
- ولكن هل تعلم إلى من لجأت حين لم أجد أحداً حولى؟
- إلى الأخصائية.
- نعم، كيف عرفت؟ أليس هذا هو الذل بعينه؟
- بل هى الإفاقة بعد سبات عميق.
- ليتنى أنام.. أّذهب فى سبات لا أفيق منه.
- ليتك تستطيعين.
- ولكنى شعرت بالمهانة حين جئت إليك
- أية مهانة أن تستشيرى آخر.
- ولكن أنا؟ هى؟ لماذا؟
- لأنه لابد من آخر حتى تشعرين بذاتك
- كل هذا وأنا لا أشعر بذاتى؟!
- لقد نسيت الآخرين.
- من أجلهم.
- لا ينسى الإنسان أحداً ثم يقول أنه يعمل من أجله، فالنسيان حكم بالإعدام.
- ولكنى أعدمت نفسى أولا فيهم
- إذا عاش الإنسان فى وحدة باردة هكذا من كثرة النفاق وتكرار الإجماع أعدم ذاته … وهو يعدم الآخرين.
- …. كنت واثقة من نفسى إلى أبعد مدى
- كان غروراً وليس ثقة
- وكل هذه القوة؟!
- كانت سيطرة وليست قوة
- وكل هذا الحب؟
- كان احتواء وليس حباً
- وثورتى… ورفضى للقديم؟
- هذا زمن مضى .
- والآن؟
- لم يبق إلا ما يشبه النجاح، والنفاق
- أين عواطفى وحبى للناس؟
- لا يوجد حب فى الهواء الطلق، وحين أصبح الناس نسخا مكررة، اختفى البشر، وانسحبت العواطف
- كل من حولى هؤلاء ليسوا بشراً؟
- البشر لا يوجدون فى كشوف الفصول أو فى جداول الحصص، ولكنهم يوجدون على أرض الواقع فى عمليات الأخذ والعطاء
- لقد كانوا حولى، كانوا معى.
- كانوا يحيطون بك، وليسوا معك
- كانوا معى فى الفصل وفى حفلات السمر، كنت هناك، وكانوا حوالىّ
- وسمعتِ قصائد المديح.
- لأعمال حققتُها فعلا.
- لكن أين الآراء الأخرى، والخطوة التالية، والاختلاف، والتجديد، والاستمرار والتطور.
- تريد أن تشككنى فى كل ذلك؟
- بل أنت التى جئت تشكين فى كل ذلك
- أنا لم أشك بعد.
- أن داخلك مازال قويا نقيا… وهو الذى فجر الكيان المتهاوي
- ولكن أين هو… ذلك القوى النقى؟
- وراء جدران الخوف البارد
- لماذا هو قوى وخائف؟
- أنت التى خفت منه، وخفت عليه من الناس، وهم خدعوك بالموافقة والنفاق، هم الذين ساعدوك على إنكار وجوده ولم يبق إلا نقاء قادر على تضحية فردية اشبه بالعمل الفدائى غير المضمون.
- وما العمل الآن؟
- بالثقة والحب يرجع كل شئ.
- أين؟ ما زال الجميع ينافقونى ويوافقونى.
- نبدأ من هنا، لنصل إلى من هم خارج الدائرة التى تحيط بك
- هنا أين، تقصد معك؟ أنا لست مريضة، كلما هممت أن أصدقك، ازداد حذرا منك.
– هذا أمر طبيعى، لكن لا بد من المخاطرة، لا يوجد حل آخر.
- أريد أن أنام.
- نعلن الهدنة المؤقتة وتنامين بالكيمياء ثم تعيدين النظر فى كل شىء.
- ولا أصبح بنفس القوة؟ العقاقير سوف تهد قوتى
- لتقومى منها وبها أقوى وأصلب وأقرب
- على شرط أن تظل آرائى هى الصائبة؟
- أو تتعلمين كيف يصبح الصواب أقرب إلى رأيك.
- لم أعتد ذلك، وهل يجعلنى كل ذلك أنام؟
- بل يجعلك تستيقظين.. فقد كنت نائمة حتى الآن.
- كل هذا الزمان؟
- إلا فترة ثورة الشباب
- أين راحت؟
- ضحكوا عليك بمظاهر القوة، وألحان النفاق
- قتلونى بجبنهم.
- ولكن الاخصائية تحبك
- الأخصائية؟
- تحب داخلك الضائع المنكمش وليس مظهرك الخادع.
- وما هو الضمان؟
- الضمان الوحيد هو أنه لا يوجد بديل
****
قال الفتى للحكيم:
– ما أروع كل هذا، وأصعبه
قال الحكيم:
– فعلا، كل رائع صعب
قال الفتى:
– هكذا تخدع مظاهر القوة والنفاق الناس، فما هو السبيل إلى توقى ذلك، لعل فى الأساليب العلمية الدواء الشافى المعافى.
قال الحكيم:
– أنت تريد أن تخوض فى أصعب المناطق حرجاً، فالعلم له وجوه كثيرة والعيب فى ذاته المقدسة يعرضنا للخطر والهجوم.
قال الفتى:
– ولكنى أسأل ولا أعيب، فهل فى العلم أيضا خداع؟
قال الحكيم:
– نعم…وللأسف، فهل تسامحنى إذا أنا اعتذرت عن دخول محرابه؟.
قال الفتى:
– ولكنا هنا نناقش الأشياء عارية فلا تبخل علىّ ولا تخونك الشجاعة.
قال الحكيم:
– إذن فاسمع منى يابنى حكاية “العلامة”.
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى