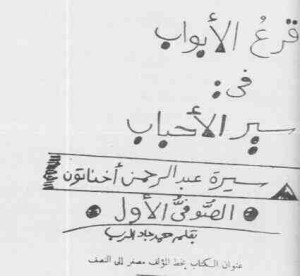نشرة “الإنسان والتطور”
7-12-2010
السنة الرابعة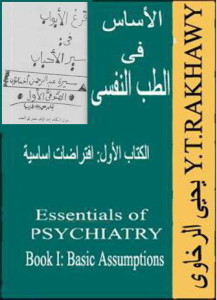
العدد: 1194
الفصل الأول:
ماهية الصحة النفسية (10)
حالات وأحوال:
حالة “اللاجنون الحركى” (1)
يبدو أن هذه المراجعة الناقدة قد أوصلتنا إلى منطقة ذات أهمية خاصة، ليس فقط فى تحديد الحد الفاصل بين الجنون والتحريك (حالة الجنون)، وبين العادية وفرط العادية وبين كل ذلك والإبداع، وإنما أوجدتنا فى بؤرة حركية النمو والتطور، وقد تأكد ذلك عرض نفس الإشكال فى الندوة الشهرية لدار المقطم للصحة النفسية (جمعية الطب النفسى التطورى)، يوم الجمعة الماضى (الموافق 3 ديسمبر 2010).
مرة أخرى أنبه إلى أن غير المختص قد التقط الرسالة المعنية ولو بصفة إجمالية أكثر من المختص، ربما يرجع ذلك إلى أننا حين نتحدث عن الجنون ثم نشرح الفرق بينه وبين “حالة الجنون”، إنما نستعمل ألفاظا شائعة ودالة ولو بدرجة من الغموض، أما حين نتحدث عن “الذهان”، أو “الفصام” مثلا فإننا نبتعد عن القضية المطروحة، رضينا أم لم نرض.
وقد ابتدعت فى هذه النشرة اسما جديدا يمكن أن يضاف إلى اسم “حالة الجنون” وهو “حالة اللاجنون” وكأن نفى الجنون لا يلغيه، وفى نفس الوقت لا يدفع بنا بعيدا عن التشكيل واحتمال الابداع.
عوْد على بدْء
هذه النشرة تصدر باسم “الإنسان والتطور” وهو نفس اسم المجلة “الأم” التى صدرت لمدة عشرين سنة (تقريبا) وكانت تتحرك فى نفس المنطقة وتعطى أولوية وفرصة المشاركة لغير المختص والمريض وأهله أساسا، فى كل من الكتابة والتلقى معاً، رجعت إلى أول عدد (بالصدفة تقريبا) وقد صدر فى أول يناير بتاريخ 1980، وإذا به يتناول هذا الموضوع تحديدا فى صورة حوار هام مع صديق كان يتحرك فى هذه المنطقة الحرجة بشجاعة وحرية وصدق لا مثيل لهما ألا وهو “المرحوم محمد جاد الرب“، وقد سمح رحمه الله آنذاك أن ننشر خواطره وإبداعه وطلاقته وأن نحاوره علانية على صفحات المجلة بشكل كان مفاجأة بقدر ما كان ترشيدا أو تنويرا.
خطر لى أننا الآن، وقد مضت ثلاثون عاما (تتم بعد 25 يوما) قد يكون من المفيد أن نعرض بعض هذا الحوار لنشرح نفس القضية من واقع الحال، فتكون هذه النشرة اليوم وغدا (وقد تمتد إلى الأسبوع القادم) مثالا عمليا لما يقع ما بين ما أسميناه “حالات وأحوال” وما بين “الافتراضات الأساسية” موضوع هذا الكتاب، وبهذا نكون قد بدأنا ما أملنا فيه من تطعيم التنظير ببعض حالات الواقع من جوهر ثقافتنا.
هذه خبرة من إنسان صادق، يعيش بحركية نشطة، خبرة تنذر بخطورة التمادى نحو المرض، لكن يتخلق منها مشروع تشكيل إبداعى، لم يكتمل، لكنه يستحق كل احترام ومناقشة.
تعريف مبدئى:
تركنا هذا الصديق – المرحوم محمد جاد الرب- منذ خمس سنوات وكتبت فيه رثاء متواضعا نشر فى صحيفة (مجلة) القاهرة، أورد بعضه تعريفا به وترحما عليه كما يلى.
……..
…. علاقتى بجاد الرب علاقة بدأت “على مية بيضا” دون أى انتماء “بلدياتى” إلى بركة السبع منوفية، (فهى ليست مركزى إلا على كبَر) حتى الانتماء إلى مصر لم يكن هو الذى يربطنا بعضنا إلى بعض، كان جاد الرب عاشقا لمصر (“بريستد”) حتى الوله المجنون، وكنت – ومازلت – عاشقا لمصر الدنيا (لا أم الدنيا) أعشق مصر مثل أى امرأة بالأصالة عنها والنيابة عن كل من هو وما هو مثلها كل العالم.
…. جاد الرب كان دائما أبدا يبدأ من “مصر بريستد- مركز بركة السبع”، يلف بها العالم ليعود إليها وقد احتوت العالم، هكذا بالعافية، ما دامت هى “فجر الضمير” وأصل الحضارة، وما دام ضمير العالم مات، أو كاد، ومادامت حضاراته قد تشرذمت وهى مدعوة للصراع بين بعضها حتى هلاكها جميعا، فعلى مصر بقيادة عبد الرحمن أخناتون الشهير بمحمد جاد الرب أن يتحمل مسئولية إحياء ضمير العالم لإنقاذ حضاراته وهى على وشك الانتحار، لغياب النبى المصرى الجديد.
بدأ الحوار بيننا مع صدور العدد الأول يناير 1980من مجلة الإنسان والتطور بصرخته التى لم يكف عن إطلاقها حتى استطاع الفشل الكلوى أن يحول بينه وبين الكلام، لكنه لم يرحمه من الصراخ من الألم الذى أظن أنه سيواصله حتى وهو يرد على الملائكة فى حساب القبر، وليس عذاب القبر، فالأرجح أن رحمة ربنا سبحانه سوف تقدر أنه نال حصته من العذاب قبل القبر بما يكفى لغفران ذنوب “بركة السبع” بكل من يحيط بها حتى نهاية العالم.
أبدأ المقتطف بأول ما نشرنا له، ونحن نفتتح أول عدد فى يناير 1980 بعنوان:
“الحكمة الملقاة علي قارعة الحياة: من أفواههم .. وبأقلامهم”
كانت دعوة إلى مشاركة حكماء الشوارع (قياسا على ما يسمى أطفال الشوارع)، كان العنوان الفرعى هو:
“قرع الأبواب في سير الأحباب،
سيرة عبدالرحمن أخناتون *الصوفي الأول*.
كان تعليقنا آنذاك يكاد يليق بأن يكون رثاءه لجاد الرب الآن، قلنا:
“….بادئ ذي بدء لابد أن نشكر هذا الصديق كما لابد أن نعتذر له، نشكره أن صب عصارة ألمه في هذه الكلمات المتحدية الصريحة، وأنه رضي أن ننشرها كما هي، وأنه قَبِلَ أن نعقب عليها دون الرجوع إليه ….
أنا لا أعرف هذا الإنسان المكافح العنيد معرفة شخصية، وحين رأيته بالصدفة حين حضر إلىّ يناقشنى مرحبا بشأن مقال نشرته في إحدي الصحف اليومية …، وطلبت منه بعد دقائق من اللقاء ألا يرى أحدنا الآخر ثانية أبدا …. ، وكان حرصي علي تجنب هذا اللقاء ألا تختلط صورتيه على، صورته علي الورق الذى أرسله لى قبل اللقاء مليئا بتلك الألفاظ المشرقة الحمراء والزرقاء والسوداء، الدقيقة الجميلة أحيانا، والمنبعجة الثائرة.. أحيانا (حسب الحالة)، مع صورته في الواقع بإهماله لذاته ومظهره وشأن بيته..، كان هذا الموقف فيما بيننا من البداية لا يقترب بأية درجة من الموقف العلاجي، ولكن من قال أننا في موقف علاجي؟ ومن قال أننا أمام مريض أصلا؟ إن حكمة وصدق وألم وصراخ ‘محمد جاد الرب’ هي نبض الإنسان العادي الذي لم يستطع أن يكون نجما فيختبئ وراء جعجعة صيته،
ولم يستطع أن يكون رقما، فـُينْسي وسط زحام القطيع،
ولم يستطع أن يكون مجنونا فيرتاح وراء الأسوار،
ولم يستطع أن يكون سياسيا فيذوب في الشعارات والصفقات،
ولم يستطع أن يكون متصوفا منسحبا فيسكت مشرقا متبتلا،
ولم يستطع أن يدعي الدروشة ويحذق الاحتيال أو يلبس مزيكا،
ولم يستطع أخيرا أن يسكت أو أن ييأس
وكل هذا هو المهم الرائع في هذا الانسان العنيد.
ثم ختمت رثائى بعد أن اقتطفت جزءًا من أخر حوار بيننا (من عدد الإنسان والتطور أكتوبر سنة 1998) قائلا:
مع السلامة يا جاد، عملت ما عليك وتركتنا نتفرج على من يتفرج.
لكن ولا يهمك ربنا يخليك، ويخلى أخناتون حبيبك، وكل من يتعرض له، ولك السلام.
بلِّغ تحياتى لكل من يسأل عنا.
يحيى
وها هو يحضر ثانية يعيد نشر كتابه – الطبعة الثانية!!- وهو الكتاب الذى ظهر فى العدد الأول مجلة “الإنسان والتطور”، ومازلنا نعيده ونستذكره، والتكرار يعلم الشطار
وبعد
أرجو مخلصا من أبنائى وبناتى الذين يتابعون النشرة حاليا، وخاصة الذين لم يتجاوز عمرهم هذه السن (30سنة) أو لعله تجاوزها قليلا جدا، أن يعرفوا كيف بدأنا، وأننا مازلنا نحاول فى نفس المنطقة بنفس الاصرار فيصبروا علينا وعلى أنفسهم بلا شروط.
* * * *
مجلة “الإنسان والتطور”
عدد يناير 1980
الحكمة الملقاة على قارعة الحياة
من أفواههم .. وبأقلامهم
تأليف: محمد جاد الرب
حــوار: يحيى الرخاوى
المقدمة:
تعمدنا أن يكون لهذا الباب ثقله فى هذه المجلة، فهو مشاركة فى تحرير هذه المجلة.. ممن يسمون مرضى ، ونحن نرجو من خلاله أن نقوم بدور الموصل الجيد بين المريض والمجتمع، وهو توصيل يتم فى عكس الاتحاه الذى يتم فى التطبيب وعلاج المرضي، وبألفاظ أخرى نقول: إنه إذا كان دور الطبيب النفسى داخل العيادة هو أن ينقل إلى المريض متطلبات المجتمع ويترجم له لغته حتى يعود يستطيع أن يتحدث اللغة السائدة، فإن وظيفة الطبيب النفسى خارج العيادة، إذا ما امتد دوره إلى الإسهام فى تطوير المجتمع، هو أن يوصل لغة المريض إلى عامة الناس مبشرا ونذيرا.
لغة المرضى التى تسمى “الحكمة” أحيانا هى لغة شديدة الصدق شديدة الإثارة شديدة التحدي، وقد حاولت أن أنقلها فى أعمال فنية قبل ذلك، مما أسميته بالفن العلمي، فقلت فى مقدمة كتابى “عندما يتعرى الإنسان”:
“وقد حاولت يأن إبحث عن حكمة اليوم فى حديثى مع أصدقائى المرضى ووجدتها فى كل من بلا استثناء، وحين كنت أعجز أن أرها كنت أعلم أنى لم أفهم لدرجة كافية، أو أنه – صديقى المريض – لم يعان لدرجة كافيه،
وقد وصل التزامى بهذه المهمة الترجمية مرحلة كادت توقف ممارستى لمهنتى أصلا حيث كتبت فى مقدمة كتابى الأخير “حكمة المجانين:
“وأعود إلى مأزقى الأول: إن أردت الصدق مع نفسى فعلى أن أختار: إما أن أترك هذه المهنة فورا .. أو، أو أن أغامر فأتحمل مسئولية المواجهة، ومواجهة المسئولية ، لكنى كنت دائم الحذر من الإعلاء من شأن هذه الحكمة (حكمة المجنون) لدرجة تنسينا هزيمة المجنون واستسهاله.
”فالجنون خبرة شديدة الخطورة، وبالتالى فرؤية المجنون هى على ما تحمل من صدق وإثارة وتحدى ليست شرف الوجود ولا هى نهاية المطاف، حيث أنها- وإن أعلنت جزءا من الحقيقة .. فإن ذلك صادر من مَثَلٍ سئ لوجود مبتذل، وفشل صريح ،وتشوية لكل شئ حتى لهذا الجزء من الحقيقة الذى أعلنوه، رغم صدقه فى ذاته.
إن إنكار تجربة الجنون تماما ولفظها ووصمها بالسلبية والتخريف والعبثية والهزيمة (رغم صدق كل ذلك)، وحتى وضع لافته أكاديمية عليها تحمل اسما لاتينيا رشيقا (هو التشخيص) كل ذلك لايلغى أنها جزء من حقيقة وجودنا.
كما أن الإعلاء من شأنها والانبهار أمامها .. والدفاع عنها كما هى (كما تفعل الحركة المناهضة للطب النفسي) هو عبث فنى “لم ينجح فى إقناعى بفاعليته وإيجابيتة.، وقديما قالوا ”خذو الحكمة من أفواه المجانين”وقد وقفت أمام هذا القول طويلا، واستلهمته وأنا اكتب تجربتى الأولى .. وقد عدت أتأمل هذا القول “خذو الحكمة من أفواه المجانين “وتعجبت لدقته وحكمته أيضا:
فهو قول لم يشر إلى أن المجنون حكيم أبدا.
وهو لم يعل من قدر الجنون ذاته ، وإنما حملنا مسئولية عدم الاستهانة بما يقول المجنون، فكأنه يدمغ الجنون فى نفس الوقت الذى يحرص فيه على الاستفادة من “المعني”الذى يكمن وراءه.
وإذا كان المجنون يقول أحيانا كلاما هو الصدق ذاته، إلا أنه لا يتحمل مسئولية صدقه هذا ..ولا هو يلتزم بتحقيقه، كما إذا كان المجنون يعلن بتناثره وتلقاءيته الرعناء فشل الحياة العادية أوعجز التقتويم الشائع الخادع، فهو لايعطى بديلا، ولا مثلا يحتذى ، بل بالعكس إنه يشوه الصدق ويخاف من الحقيقة.
خلاصة القول أن المجنون لوحة فنية حية تتحدانا وهى تحرّك فينا مقابلها، لكنها لا ينبغى أن تغرى أبداً بنسخها كما هى.
* * *
الحكمة التى نبدأ بها هنا هى “مشروع كتاب”خطه صديق اسمه محمد جاد الرب، تعرفت به عن طريق رسائل غامضة مكتوبة بخط فحل (تبدو صورته بعد التصغير إلى النصف).
* * * *
قرع الأبواب فى: سير الأحباب
سيرة عبدالرحمن أخناتون
*الصوفى الأول*
بقلم محمد جاد الرب
بادى ذى بدء لابد أن نشكر هذا الصديق كما لابد أن نعتذر له، نشكره أن صب عصارة ألمه فى هذه الكلمات المتحدية الصريحة، وأنه رضى أن ننشرها كما هى، وأنه قبل أن نعقب عليها دون الرجوع إليه، وأنه قبل أن نسميه مريضا نفسيآ أو مجنونا والعياذ بالله.. ولنا أن نقر بشكل ما أن رضاه ذلك ليس إلا حبا منه للحقيقة، وحرصا منه على الإسهام فى المسيرة.
أنا لا أعرف هذا الإنسان المكافح العنيد معرفة شخصية، وحين رأيته بالصدفة بشأن مقال نشرته فى إحدى الصحف اليومية عن مذبحة ( جيم جونز) كان لقاء للنقاش العقلى وليس للكشف أو الاستشارة أو التشخيص، ورفضت دعواته المتكررة عن طريق رسائله ورسله معا، كما رفضت الاشتراك معه فى النوادى والأحزاب والمؤسسات التى ينشئها فى القرى وعبر الترانستور، أعنى فى خياله المتعلق بهذا وذاك، إذ هى لا تخرج إلى التنفيذ أبدا (تقريبا)، ولكن من قال أننا أمام مريض ؟
لكننا اتفقنا بناء على طلبه أن أعامله كمريض أو كمجنون، هكذا اتفقنا هو وأنا على الورق، ولعل هذا فى ذاته يثبت كم هو أبعد ما يكون عن ذلك، ولكن هذا هو المدخل الذى ارتضيناه معا .. وفى هذا يقول الأخ جاد الرب استجابة للفكرة بل وفرحا بها: يقول ردا على استئذانه فى أن أتحدث عنه كمريض نفسي:
بسم الله الرحيم الرحمن القديم الاحسان
أخى العزيز
أرجو أن تعلم صادق ارتياحى لهذا الأسلوب .. “مريض نفسى”، هذا هو وضعى الفعلى وبالصدفة البحته فإن رسالتك قد وصلتنى وأنا أحاول إعداد موضوع لمجلة الإذاعة يستوعب رؤيتى بالتحديد القاطع لمجتمع الديانتين حيث ترانى وقد وصلت إلى نهاية المقدمة أقدم نفسى كمريض لديكم.
أخي: يجب أن أصرخ فيك سائلا إياك:
كيف نعالج مشكلة الفقر الروحى المصرى !
( وسنعود إلى هذا النص ثانية فيم بعد)
…..
هكذا نرى كيف يقر صديقنا بتواضع متألم أنه مرتاح لاعتباره مريضا نفسيا، ويقدم نفسه بهذه الصفة.
ولكن هل يعنى ذلك أن نقبل نحن إقراره بالمرض كنوع من الاستسهال والتخلى ؟؟
هذه قضية أخرى ليست محل نقاش هنا الآن، لكنى ألقيها أمام وعى وضمير كل قارئ فى كل مراحل تقديم هذا الكتاب (إن كان ثمة كتاب) !!
ولعل من يعرف الصديق الانسان محمد جاد الرب شخصيا يجده مختلفا أشد الاختلاف عن هذا الشخص الذى أصفه وأحاوره واستيقظ على يده وأتحداه وأقبله وأرفضه، إلا أن هذا لا يغير من الموقف شيئا، وسواء كان محمد جاد الرب مجنونا أم رائدا مهزوما أم إنسانا عاديا يدفع ثمن رؤيته عصيرا يقطر ألما داميا فإن المهم أنه أتاح لنا هذه الرحلة مع الحكمة الملقاة على قارعة الحياة.
****
وإلى النص:-
عنوان الكتاب (مرة أخرى)
قرع الأبواب فى سير الأحباب
سيرة عبد الرحمن اخناتون. الصوفى الاول
تأليف: محمد جاد الرب حوار: يحيى الرخاوى
مثل كل فقرات الكتاب، كان عنوانه أكثر من عنوان ولكنى تمسكت بهذا العنوان الأول، وقد تصورت أن ‘قرع الأبواب” قد تعنى عدة أمور يستحسن الوقوف عندها:
1- فهى تبدو مشتقة أصلا من آية عيسى عليه السلام ‘اقرعو يفتح لكم – عيسي’، وهى الكلمة التى صدر بها الكتاب .
2- وهى الإشارة إلى الالحاح المستمر رغبة فى التواصل الحق، ذلك الالحاح الذى يكمن وراء الوجود البشرى ويظهر عاريا فى تجربة الجنون وهذا الالحاح ذو شقين: إلحاح يلهث للتواصل مع البشر ليروا ما هو بالداخل حتى أعمق جذوره غير مكتفين بالسطح أو باللفظ المنمق، وهو الإلحاح الذى يظهر تناقضا عجيبا فى وجود المجنون، إذ يظهر كيف أنه دائم الطرق دائم الاستغاثة وفى نفس الوقت هو شديد الخوف والاصرار على الهرب والصمت الحذر إن تجربة المجنون إذ تعلن هذا الطرق الملح على آذان وقلوب وعقول الاخوة فى البشرية، تعلن يأسا مسبقا من فتح الابواب ولكنها لا تتوقف عن الطرق أبدا وهنا التناقض المرهق حتى النزيف فالإنهاك فالتناثر.
ولعل تعرى المجنون وعشوائيته هو إعلان آخر لرغبته فى أن يرى أعماقه إخوانه البشر، ولعل هذا هو الترجمة المرضية لما أسميته فى مكان آخر ‘الحاجة إلى الشوفان (*)‘، وبالرغم من هذه المحاولة الغبية فإن أحدا لا يرى أعماقه.. فتستمر الاستغاثة ‘يستمر الطرق”مع الاستمرار اليأس المسبق.
على أن هناك تفسيرا آخر لاستمرار الطرق العنيد إذ لابد أن تستشعر أن الانسان (الآخر) وهو المطروق ليس هو الهدف فى ذاته، ولكنه الباب الذى يطرق سبيلا إلى ما بعده، وما بعده هو الذات الكبرى المشتركة أو الكون الأعظم أو الله، ويمكن أن نرى من خلال هذا التناقض العنيد، وذاك الاصرار المستحيل ما يذكرنا بالموقف الدون كيشوتى بالغ التعقيد.
أما إذا أدمجنا بقية العنوان ‘سير الأحباب” فإن لنا أن نراجع أنفسنا لأن القرع هنا قد يعنى التذكير المكرر – مثل شاعر الربابة – بالسيرة العطرة لمواكب البشرية المضيئة عبر التاريخ، وهذه المواكب التى يجمعها شبق تصوفى إلى الحقيقة، والسعى إلى وجه الله من أكبر الدعائم التى يركن إليها الانسان فى أزمة تمزقه، وهذا المعنى يبرر أن السيد المؤلف قد ألحق بهذا العنوان العام عنوانا محددا هو أنه يتحدث عن ‘سيرة عبد الرحمن أخناتون”باعتباره الصوفى الأول.
والتأليف المكون منه الاسم الجديد تأليف هنا له دلالته الجميلة فنيا، وجنونيا، فما أجمل أن يشعر المصرى منا أن جده “أخناتون” كان اسمه ”عبد الرحمن” وكأنه بذلك يتجسد لحما ودما مثل ‘أى عبد الرحمن”نلقاه فى حياتنا اليومية فلا يعود أسطورة تاريخية خفية.
وما أجمل أن يرتبط التصوف بديانة قبل الديانات السماوية المعروفة، إعلانا من المؤلف بعمق حدسه ورؤيته لحاجة الانسان الملحة لعبادة الرحمن فى رحلته التطورية المستمرة.
وهكذا يفاجئنا الصديق جاد الرب بعنوان لكتابة بكاد يدلنا – ومباشرة – على محتواه.
كلمة الكتاب
لم يذكر السيد المؤلف صراحة أن ما اقتطفه هنا هو الكلمة التى يريد أن يصدر بها الكتاب، ولكنى استنتجها تلقائيا حين وجدتها فى ورقة منفصله، وأنها ليست من كلامه هو، ولكنها مقتطف من أقوال أحبابه: عيسى ويوحنا المعمدان، وألبرت شفيتسر، (عن عبد الرحمن بدوي)، وقد قدمت هذه الكلمة مصورة (مصغرة إلى النصف) كعينة من الخط الذى كتبت به أغلب صفحات الكتاب ولن أناقش محتوى هذه الكلمات لأنها ليست كلماته ولكنى سأناقش هنا ظاهرة الإفراط فى اقتطاف الحكم والأقوال أو ما يسمى بالكلمات المضيئة فى محاولة إعادة قراءتها بنبض جديد فى مثل هذه التجارب الكيمانية.
فالمجنون والمبدع على حد سواء يستطيعان أن يقرآن فى هذه الكلمات المضيئة مالا يستطيعه الشخص العادي.
اقرعوا يُفتح لكم – عيسى

الآن قد وضعت الفأس على أصل
الشجر فكل شجرة لامم تصنع ثمرا
جيدا تقطع وتلقى فى النار ..
يوحنا المعمدان
يجب على الإنسانية أن تجدد نفسها
بمزاج عقلى جديد إذا كانت لا تريد
لنفسها الدمار – البرت شفييتسر
دكتور عبد الرحمن بدوى
بل إن قراءة هذه الكلمات قد تصبح عملا إبداعيا فى ذاته.
والذى يأخذ مقتطفات الصديق جاد الرب مأخذا سطحيا فيعتبرها مجرد متناثرات بلا رابط، سوف يفقد الطريق للتعرف عليه لا محالة، فى حين أن الذى يحاول أن يعيد قراءتها معه، فيشعر به وهو يكبر الخط، وهو يفسح المسافات، وهو يعيد على الحروف.. إن من يفعل ذلك معه لابد سيصادق الكلمات ويصادقه بشكل جديد لأنهما سيشعران معا بالشئ المشترك، والأمانة الواعية فى الرسالة المرهقة التى تحملها الكلمات إليهما (إليهم) وهذا هو الفضل الأول لاختراع الكتابة رغم عجزها الملح عن أداء هذه الرسالة على الوجه الأكمل لكل قارئ.
ولكن ماذا يفعل الصديق جاد الرب أمام هذه اللوحة الجميلة، إنه – كما يبدو فيما بعد – يكتفى بالنبض المشترك والوقوف أمام ضياء الكلمات انبهارا، بل لعل شبق النبض بالكلمات يسكب قوة الدفعة إلى القرار، ماذا لو أحسن قراءة يوحنا المعمدان وهو يعلنها فى بساطة .. ‘”فكل شجرة لا تصنع تمرا جيدا تقطع وتلقى فى النار” لاشك أنه سيهب ليصنع (يطرح) ثمرا، أو هو سيمسك ذيله فى أسنانه ويجرى هربا من مسئولية هذه الكلمات كما كنا نجرى هربا من كمسارى قطار الدلتا حتى لا “يطوقنا” حين يضبطنا بلا تذاكر (بين هورين وزفتا، أو بين هورين وبركة السبع)، أم لعله فى تقديمه هذه اللوحات المتتابعة بلا ترابط يثير فينا رغبة البحث ‘عن المزاج العقلى الجديد”الذى نادى به شفايتزر .. لعل .. !!
المهم أن ظاهرة الوقوف عند الكلمات المضيئة، وتكرارها بلا مسئولية، يثير قضية إفراغها من فاعليتها بابتذال التكرار، حتى لتصبح مثل شعارات الساسة المحترفين، أو لافتات الصالونات الثقافية المغتربة، فهى ظاهرة لا تحمل القدر من الايجابية الذى تلوح به لأول وهلة، وقد شرح ‘بيون” Bion أن من علامات تفكك المجموعة العلاجية فى العلاج الجمعي، الاكثار من الاستشهاد بالحكم والأيات المأثورة، مما يصرف النشاط الجمعى عن العمل النموى إلى التباهى اللفظي.
* * * *
وإلى الغد نكمل التعرف على المنطقة التى حيرتنا تنظير، لعلها تتجلَّى عرضاً واقعاً ثريا، من خلال حوارنا مع الصديق المرحوم “جاد الرب”.
* – (دراسة فى علم السيكوباثولوجى – دار الغد للثقافة والنشر، (1979)
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى