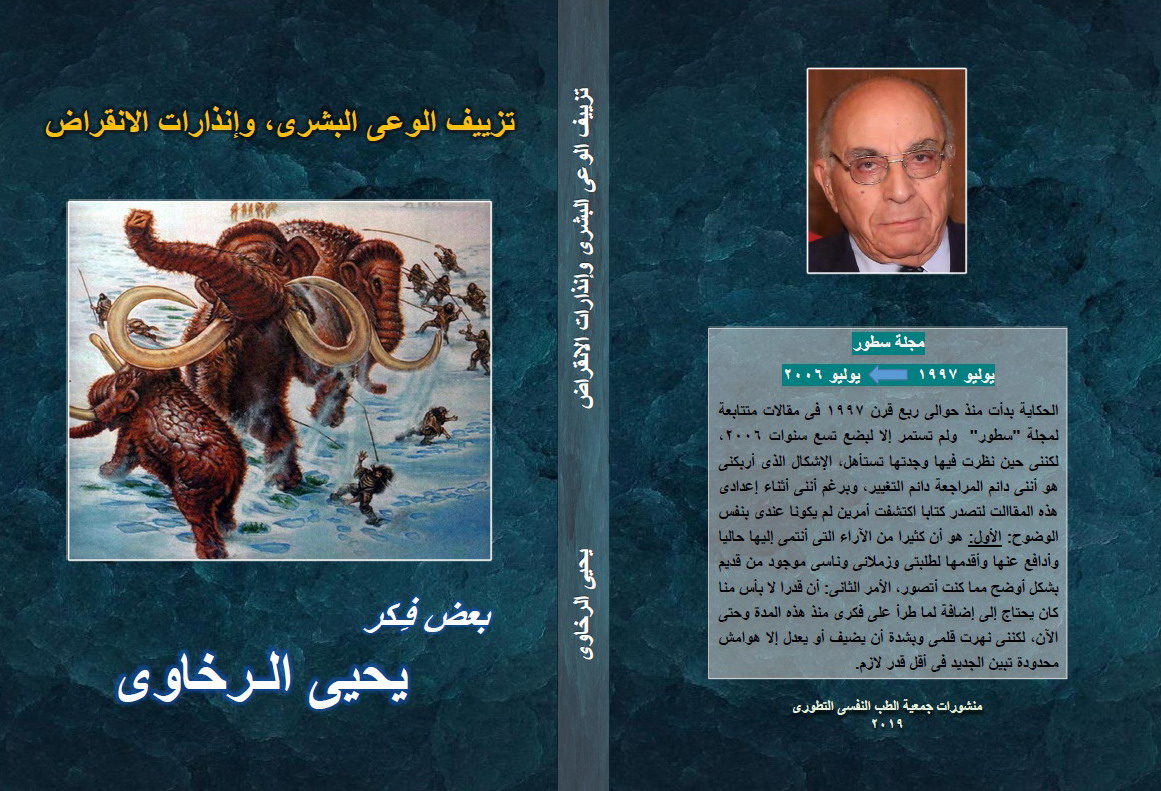يحيى الرخاوى
(مجلة سطور)
(من يوليو 1997 إلى يوليو 2006 )
2019
الإهـــداء
إلى أ.د. رفعت محفوظ
&
أ.د. عماد حمدى غز
أثناء محاولتى جمع ما بدر عنى دون ترتيب استجابة لما كان يطلب منى بصفتى مواطنا مشاركا يعتقد الطالب أن عنده ما يستحق أن يصل إلى ناسه، تفضلت د/ فاطمة نصر رئيس تحرير مجلة سطور بهذا التكريم الطيب وأتاحت لى أن أواصل الكتابة غير المنتطمة فى مجلتها البليغة والحرة “سطور” ولم أتخيل أن تتجمع يوما كتاباتى معا فيما يستحق النشر مكتملا، لكن أبنائى فى سكرتاريتى قاموا بتلقائية طيبة بهذا الجمع وأحضروا هذه المجموعة من المقالات التى وجدت بها ما يستحق أن يظهر مجتمعا. الإشكال الذى أربكنى هو أننى دائم المراجعة دائم التغيير، وبرغم ذلك، فقد اكتشفت أننى أثناء إعدادى هذه المقالات لتصدر كتابا أمرين لم يكونا عندى بنفس الوضوح: الأول: هو أن كثيرا من الآراء التى أنتمى إليها حاليا وأدافع عنها وأقدمها لطلبتى وزملائى وناسى موجود من قديم بشكل أوضح مما كنت أتصور، الأمر الثانى: أن قدرا لا بأس منها أصبح يحتاج إلى إضافة لما طرأ على فكرى منذ هذه المدة وحتى الآن، لكننى نهرت قلمى وبشدة أن يضيف أو يعدل إلا هوامش محدودة تبين الجديد فى أقل قدر لازم، مع أن ما جرى فى هذه السنوات (ما يقرب من عشرون عاما) أكد مخاوفى على هذا الكائن الرائع من الانقراض وهو التوجه الغالب فى معظم ما جاء فى هذا العمل. وبرغم من أننى مازلت أتمسك بمعظم ما جاء فى كل المقالات بلا استثناء وأن التغيرات التى طرأت على فكرى وموقفى ليست قليلة إلا أننى فضلت أن تخرج هذه المجموعة دون أى تعديل أو تطور باعتبار أنها تسجيل تاريخى لمرحلة فكر مواطن مصرى مجتهد، وأن من علامات إشارات الإنذار أنها تضئ وتنطفئ بانتظام وباستمرار لعلها تنبه الغافل أو هى ربما توقظ النائم. يحيى الرخاوى 30/9/2019
مقدمة
مقدمة
منطلق شخصى: ينشأ المصطلح من معايشة مشتركة ومتفاهمة لواقع الحال فى تمايزه وتباينه، ثم يستقر ويتحدد، ثم يتعمق، ويتأكد، ثم يتوقف ويتجمد، فيحول دون نمو أو مراجعة ما احتواه من مفهوم أو مفاهيم، لفترة تطول أو تقصر حسب قدرتنا على تحمل العودة إلى اقتحامه وإعادة النظر فيما وصل إليه. يسرى هذا على مصطلح “الطبقة الوسطى”، فى نشأته، وفيما آل إليه، فللطبقة الوسطى ما يميزها، ويحدد معالمها، ويبين أخلاقها، ويكتب سيرتها، وهأنذا ما زلت أشعر أننى أكتب هذه السطور من داخل طبقتى الوسطى، وأننى أتوجه بها إلى قارئ من الطبقة الوسطى، فإلى أى مدى إذن يصح كل هذا (أو بعضه)؟ وماذا يعنى الزعم باختفائها (باختفائنا: قارئى وأنا)؟ تتعرض الطبقة الوسطى – مرحليا- للإنكار، أو التمييع، أو للتجاوز على أحسن الفروض، وذلك تحت زعم اتساعها حتى تسمح باحتواء ما فوقها وما تحتها([2]) أو بتصور تزايد الاستقطاب الطبقى باضطراد زيادة الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء، ولن ينفعنا أن ننقذها من الضياع أن نقسمها أيضا إلى شرائح أكثر عددا([3]) ولعل فى هاتين الحجتين (أو المظهرين) المتطرفتين فى التناقض ما يسمح لنا بإعادة النظر فى المسألة، دون ضرورة الاستسلام لضياع هوية هذه الطبقة، وفى نفس الوقت، دون الاستسلام لجمود المصطلح ودلالاته فى مواجهة حركية الظاهرة. فإذا كانت معايير المنظور التاريخى الذى يسجل حضور هذه الطبقة وتجلياتها، ومعايير المنظور الاقتصادى الذى يؤكدها، ومعايير المنظور الاجتماعى الذى يعلنها ويحددها، أقول إن كانت كل هذه المعايير تخضع الآن لحراك يهددها جوهريا، بل ويتنبأ بزوال مصداقيتها، فإن المنطلق الذى أنطلق منه هنا والآن، يدعونى إلى قراءة معطيات معيار آخر، مصدر آخر قد يكون أصدق تعرفا على هوية هذه الطبقة، مصدر قد يحيل دلالات هذا المفهوم إلى ما يتخطى معاييره التاريخية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى ما يجعل هذه الهوية أبقى من المعايير التى قيست بها فى مرحلة بذاتها، أعنى بكل هذا ما سجله الأدب الروائى خاصة (والقصصى عامة) لماهية ومسار وحضور هذه الطبقة، وإذا أردنا مثالا صارخا وشهيرا جدا، فإن نجيب محفوظ (شخصيا)، وأعماله (عامة) هى خير شاهد على زعمى هذا، أعنى زعمى بأن أدبنا المعاصر هو مصدر هام للتعرف على هذه الطبقة جملة وتفصيلا، ولعله مصدر أهم وأكثر ثراء مما بين أيدينا، من معلومات كثيرة يقال لها “علمية”، وهى تمتلئ بأرقام الإحصاء وجداول المقارنة. ليس معنى التحفظ السابق أننى أزعم أن الطبقة الوسطى- مفهوما وواقعا- باقية كما هى، أو أنها ينبغى أن تبقى كما نتصورها وننتمى إليها، بل إننى أدعو إلى مراجعة جادة لجذور ما تعنيه وما تشير إليه فكرة الوسط، وفكرة الطبقة فى ضوء المتغيرات الأحدث. فـ “الوسط” يشير- عند الغالبية- إلى موقع بين طرفين، وعند فئة غير قليلة إنما يعنى تسوية ما بين نقيضين، تسوية تعادلية، هامدة فى العادة، مع أن للوسط – حتى معجميا- مدلولات أو معان أخرى أرقى وأشمل مثل: العدل والخير، كما أن مدلول “الطبقة” قد يتوقف عند المستوى الاجتماعى والاقتصادى، ثم يعد كل ما عدا ذلك نتاجا ثانويا لهذا المستوى بالذات. من الواضح أن تناول المصطلح بهذا الشكل إنما ينطوى على جمود يصعب أن يناسب أى ظاهرة حقيقية، فما بالنا بظاهرة حركية فى زمن سريع كما هو الحال فيما يتعلق بـ”الطبقة الوسطى” فى “زمننا هذا”؟ من الطبيعى إذن أن يؤدى مثل هذا الفهم للطبقة الوسطى إلى مزاعم باختفائها ولكن هل يعنى هذا أن نتخلى عن المفهوم؟؟ جدير بنا أن نراجع هذا وذاك إن احترام حركية الظواهر الإنسانية يدعونا إلى النظر فيما هو “وسط” بوصفه “مرحلة” متقدمة نسبيا على مسار حركة متصلة. وأن ننظر فيما هو “طبقة” بالبحث عن عوامل مشتركة قبل، وبعد، ومع، العامل الاقتصادى، تفيد فى تمييز نوع وجود مجموعة من الناس فى الحياة فى وقت بذاته، كما تشير إلى موقعهم على المسار، وتوجههم إلى المصير. من هذه المراجعة اهتديت إلى احتمال (فرض) بديل يقول: “إن الإنسان المعاصر لا ينتمى إلى طبقة دون أخرى، وإنما هو يقع فى مرحلة قبل أخرى، وبعد أخرى، وموقعه هذا قابل (بل وملزم فى الظروف المناسبة) بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة على مسار نمائه (تطوره) الفردى. وهذا المنظور، ينقلنا من الحديث عن الطبقات الاجتماعية المحددة، إلى الحديث عن المراحل التطورية المفتوحة، وقد جاءت هذه النقلة نتيجة لتسارع خطى كل من الحراك الاجتماعى والحراك التطورى من ناحية، وأيضا نتيجة لتزايد شفافية المعلومات، وفرص الإحاطة المعرفية وتعميق الوعى الكيانى من جهة أخرى. وإليكم بعض تفصيل ذلك: أولا: مقدمات (1) نحن نلاحظ سرعة وطبيعة وتوجه حركة الناس على مدرج السلم الاجتماعى، وعلينا أن نلاحظ إلى جانب ذلك -من أجل استيعاب أصدق- تسارع الحركة على مدرج آخر هو مدرج التطور الفردى والنوعى من أدنى إلى أعلى أو بالعكس. (2) إننا نحتاج إذن إلى أن نرى الناس من مناظير أخرى حتى لو بدا أنهم قد تجمعوا معا فى “طبقة” أو فئة متجانسة، بمعنى أن وعينا بالمتغيرات الأحدث، وتأملنا فى واقع الحال، إنما يدعونا إلى توسيع أدوات تمييز الناس بعضهم عن بعض باستعمال مقاييس أكثر إحاطة وأرقى تصنيفا. (3) إن من أهم ما يمكن أن يؤدى إليه توسيع أدواتنا هو أن نعيد النظر فى طبيعة العلاقة بين موقع الفرد (الطبقى) وبين حركة تطوره الشخصى، بمعنى عمق الوعى، والقدرة على المراجعة والمغامرة، وتجديد الذات، وتحمل الغموض، ووفرة التساؤل الخلاق، فى مقابل الرضا بالوجود الساكن، وتكرار الآمن، وطاعة الشائع … إلخ. (4) إننا بتطبيق المناظير الأوسع فى المواقع المختلفة،لابد أن نكتشف وجه شبه بين المتحرك هنا والمتحرك هناك، دون حتمية التقيد بطبقته الاجتماعية، بنفس الدرجة التى نكتشف بها وجه الشبه بين الساكن هنا والساكن هناك، مرة أخرى دون التقيد بالطبقة الاجتماعية/الاقتصادية. ثانيا: التوالى (1) إن تقسيم الناس إلى طبقات يعلو بعضها بعضا حسب موقعهم الاقتصادى والاجتماعى، ثم استنتاج مواقفهم وصفاتهم المميزة بناء على ذلك أساسا أو تماما، قد أصبح أسلوبا اختزاليا يحمل خطأ تنظيريا تترتب عليه أخطاء تطبيقية خطيرة. (2) ينبهنا الحراك الاجتماعى المتسارع مؤخرا، والذى يعنى الانتقال من طبقة إلى طبقة بسرعة نسبية، إلى أن الانتماء إلى طبقة بذاتها ليس نهاية المطاف، بل لعله بدايته (على مستوى مسار نماء الفرد ذاته)، وبألفاظ أخرى، فإن طبقتى (الاجتماعية) قد يحددها فى البداية موقع ولادتى، ولكنه لم يعد يفرضها طول تاريخ حياتى. (3) إن تسارع “الحراك الاجتماعى” يواكبه أو يستقل عنه ويسابقه، نوع آخر من “الحراك”، وسوف أسميه “الحراك التطوري” على مسار كل فرد أيا كانت طبقته. فإذا كان الحراك الاجتماعى قد تسارع -فى مصر مثلا- نتيجة لتغيرات اقتصادية، وسياسية، ونفسية، أدت إليها مغامرات الهجرة الارتزاقية، واهتزازات القيم الاقتصادية، فإن الحراك التطورى المواكب يحدث نتيجة لتزايد شفافية المعلومات، واتساع مجال الفرص المعروضة لإعادة تشكيل الوعى، وسهولة الانتقال بين الثقافات الأصلية والفرعية المختلفة. ثالثا: النتائج لو صح هذا الفرض، فإنه قد يفسر بعض الملاحظات التى انتبه إليها كثير من الملاحظين مؤخرا، كما أنه قد يصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة والشائعة على الوجه التالى: (1) إن الزعم باختفاء الطبقة الوسطى هو دليل على اهتزاز المقاييس التى كنا نحدد بها ما هو أعلى وما هو أدنى وما هو أوسط، وليس إشارة إلى اتساعها حتى شمولها كل الناس، ولا إلى تضاؤلها أمام تزايد الاستقطاب الاقتصادى. (2) قد يرجع بعض ما أصاب الاتحاد السوفيتى – مثلا- إلى خطأ التوقف عند مفهوم غلبة طبقة بذاتها، بدلا من العمل على تسهيل توفير الفرص العادلة للحراك بنوعيه (الاجتماعى والتطورى). (3) إن المبالغة فى التمسك بصورة الديمقراطية الغربية الحالية (وخاصة فى شكل الديمقراطية بالإنابة)، إنما يوهم بمساواة فى القدرة على التمييز، وعلى تحمل المسئولية، ولكنه يتضمن – فى نفس الوقت- رغبة خبيثة فى إخفاء العوامل الفاعلة جدا فى التمييز بين الناس، رغبة فى تقسيمهم - سرا غالبا – إلى طبقات متجمدة لها حدود خرسانية مغلقة. (4) إن الاعتراف بفكرة “الصفوة”، بدلا من ممارستها فى السر، قد يكون ممكنا حين تصبح كلمة الصفوة مميزة لـ “مرحلة بذاتها”، وليس لـطبقة أو فئة أو جنس أو عنصر، وبالتالى تصبح هذه المرحلة مفتوحة طول الوقت لمن يدفع ثمنها، ويقدر عليها، كما أنها تميز من ينجح فى أن ينتمى إليها، وليس من يجد نفسه فيها. هنا تصبح “الطبقة الوسطي” سمة لمرحلة تطور مفتوحة، لا مجرد مواصفات سطحية ساكنة. (5) إن المراحل المتتالية على سلم التطور الفردى، ليست فقط متصلة بعضها ببعض، وإنما هى متناسقة مع بعضها البعض، سواء تحت قيادة موحدة للمستوى السائد فى فترة معينة، أو بتنظيم التبادل بين المستويات، حسب الموقف المناسب فى اللحظة المناسبة . بمعنى أنه لا توجد مرحلة أعلى مطلقة تحل محل مرحلة أدنى استنفدت أغراضها، وبالتالى لا يكون المستوى الأعلى أعلى إلا إذا احتوى ما قبله وتكامل به، وأحسب -أو أفترض أن هذا يمكن أن يسرى على الرؤية المقترحة فى هذا المقال للتنظيم البشرى المتكامل . هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل خاص: ذلك أنه على مسار أى تطور حقيقى، لا يختفى الأقدم بظهور الأحدث والأرقى، وإنما يحتوى الأعلى الأدنى دون محو أو إنكار، ولا يتم هذا الاحتواء مرة واحدة ، وإنما تظل حركة الذهاب والعودة فيما بينهما طول الوقت، وتواصـل هذه الحركة الجدلية النشطة بين مستوى ومستوى يضيف إلى كل منهما ما يدعم المسيرة باستمرار، وهكذا تظل كل المراحل (المستويات) متسقة داخل الكل الأحدث بقيادة الأرقى معظم الوقت، كما يظل للمستوى الأدنى الحق فى القيادة بعض الوقت حسب الإيقاع الحيوى أو الاجتماعى أو كليهما. ولتوضيح ذلك أكثر: نأخذ مثلا من تطور المخ (الدماغ)، وقد يصلح هذا القياس بالذات إذا تبنينا الفرض القائل أن المخ البشرى الحالى هو أصدق تسجيل لتاريخ تطوره البيولوجى. فالمخ البشرى حاليا مرتب ترتيبا طبقيا بشكل أو بآخر: فثمَّ مخ أحدث هو القشرة، ومخ أقدم، هو جذع المخ (شاملا ما يسمى المخ الأوسط)، وثمة مخ بينى (الداينكفالون) وهو ما بين القشرة وجذع المخ، (يتكون من مهاد ومهيد ونوايا قاعدية..إلخ،) وكل من هذه المستويات مشتمل بشكل تلقائى - فى حالة الصحو خاصة- فى كل متناسق تحت قيادة المخ الأحدث عادة، إلا أن ثم تبادلا فى القيادة بين المستويات المختلفة يحدث أثناء النوم والحلم، كما أن ثمة تكاملا فائقا بين المستويات أيضا يحدث أثناء الإبداع. من كل هذا يمكن القول إن مستويات (طبقات) المخ ليست منفصلة حسما بقدر ما هى متواصلة تاريخا، ومتكاملة حاضرا، صحيح أن المخ البينى (الداينكفالون) لا يمكن أن يرتقى بنفسه إلى المخ القشرى، لكنه إذ يتكامل، ويتبادل معه يصبح أساسا لا يمكن الاستغناء عنه فى تحقيق تكامل المخ البشرى([4]) ولايصح القياس - طبعا- على إطلاقه، وإنما نكتفى بالإشارة إلى أنه حتى مع تمييز المرحلة الأرقى المفتوحة لكل البشر، بما هو “صفوة،’ فإن ذلك لا يلغى، ولا يقلل دور من هم دون الصفوة، بل إنه يؤكد ضرورة وجود كل المراحل (الطبقات) كل الوقت ، شريطة أن تكون المواصلات بينها مفتوحة، وقواعد الانتقال معلنة ، وإمكانيات الانتقال متاحة. رابعا: الخلاصة (1) إن الذين رصدوا ولاحظوا اختفاء الطبقة الوسطى محقين تماما، ليس لأنها اختفت فعلا، أو لأنها تكاثرت وتعددت مستوياتها، ولكن لأن المقاييس التى كنا نحددها بها لم تعد صالحة للعصر، وبالتالى فإذا نحن أصررنا على استعمالها فإننا سوف نصطنع طبقات لا وجود لها، تسجنها تصوراتنا لا أكثر. (2) إن المرحلة الوسطى (وليست بالضرورة الطبقة الوسطى)، على مسار أى تطور، ستظل من أهم المراحل وأخطرها، باعتبارها المرحلة الواعدة بالحركة الأرقى، ومن ثم لا ينبغى تجميد حركتها عند مواصفات معينة بقدر ما ينبغى إتاحة الفرصة لانطلاقها لإكمال مسارها. (3) إن الذى سوف يؤكد حركية الإنسان دون سجنه فى طبقة بذاتها أمران (أ) الإبداع المحرِّك و(ب) وفرة وتكافؤ الفرص. (4) إنه يمكن تطبيق هذا المقياس الجديد على أى فئة تتصور أنها متجانسة ماديا، أو ذهنيا، أو عرقيا، أو سياسيا، فى كل جماعة فرعية: توجد صفوة متحركة، ومجموعة جامدة متجمدة ، وما بين هذه وتلك توجد طبقات وطبقات من فئات المثقفين، والتشكيليين، والساسة، والأثرياء، والفقراء، والعلماء، ورجال الجامعة، والبحث العلمى، والسود والبيض وأهل هذا الدين أو ذاك. وبعــد فإن المسألة -هكذا- تحتاج أكثر من أى وقت مضى، إلى ثورة فى التنشئة والنظم الاجتماعية والسياسية تتواكب مع ما فرضه علينا تسارع كل من “الحراك الاجتماعى” و”الحراك التطورى” نتيجة لهذه الهجمة الرائعة التى أحاطت بنا عشوائيا من خلال شفافية المعلومات و سهولة التواصل والإسراع بالتصنيف الحكمى الفوقى عادة. [1] – مجلة سطور: (عدد أغسطس – 1998) العنوان الأصلى لهذا المقال كان “ماذا بعد الزعم باختفاء الطبقة الوسطى؟” لكننى فضلت الآن العنوان الحالى. [2] – حسين أمين ”ماذا حدث للمصريين فى نصف قرن؟ تطور المجتمع المصرى فى نصف قرن 1945-1995″ العدد 565 – يناير 1998 – كتاب الهلال [3] – رمزى زكى: ”وداعا للطبقة الوسطى” – دار المستقبل – 1997 [4] – دانيال دينيت “أنواع العقول” الكتاب المترجم صادر عن “المكتبة الأكاديمية” القاهرة 2003 Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness Daniel C. Dennet 1996 حين طلب منى أن أكتب عن الموقف من التراث باعتبار أنه يمكن أن يكون هربا فيه أو هربا إليه ترددت كثيرا أن أوافق على ذلك، أو أن أرفض ذلك، لأننى توقفت - بداية – عند محاولة تحديد “ما هو تراث” قبل أن أحاول النظر فى موقفنا منه،هربا أو غير ذلك. وقد بدأت حيرتى بهجوم أسئلة دالة تقول: هل التراث هو مجرد ماض نحكيه ونتناقله ثم ننتقى منه؟ أم رواية نجترها أو نتناساها حسب مقتضى الحال؟ أم تاريخ نقرؤه بفخر أو خجل حسب مقدار الصدق والكذب والحياء والمسئولية؟ المعجم (الوسيط) يقول: التُّرَاثُ: الإِراثُ وهو ما ورث فما هذا الذى ورث، وهل ما ورث هذا هو حاضر(بيولوجى) قائم فى تركيبنا (الآن)، أو هو وعى ماثل أو متاح فى وجودنا الحالى، أو هو معلومات مودعة على أرفف المكتبات وفى بطون الوثائق وعلى الحواسب وديسكاتها؟ وما علاقة التراث بالتاريخ الخاص لأمة من الأمم، وهل الأوْلى، والأكثر واقعية ومواجهة ومسئولية، والأقرب إلى الطبيعة النمائية، هو أن نتعامل مع التراث باعتباره تاريخا يزار، أو ملجأ نهرب إليه، أو إنجازا ماضيا نتفحص ما تبقى من قدراته؟ أم أنه حاضر نجادله وننطلق منه وبه ومعه؟ لم أستطع، كذلك لم أجرؤ، أن أحاول الرد على كل هذه الأسئلة فى البداية، لكننى اكتفيت بأن أرفض ابتداء: (1) أن أنساق وراء التقليد الشائع الذى يتعامل مع التراث باعتباره ماضيا يحكى، أو مهربا يغرى. (2) أن أقصِر التراث على ما هو مسجل تاريخا (صدقا أو غير ذلك علما بأنى أعامل حتى ما يصدق من التاريخ باعتباره إشاعة راجحة لوجهة نظر محدودة، مهما بلغت دقة تسجيلها وسلامة منهجها). وبدلا من هذا وذاك، قلت أحاول أن أتعامل مع التراث الماثل أمامى “هنا”، ذلك أنه لاح لى بديل يقول: إن التراث هو حاضر فاعل يتجاوز ما أثبت رموزا فى وثائق يقال لها التاريخ. وثائق لا يمكن إغفالها، كما لا يمكن الاكتفاء بها، وهذا الحاضر الفاعل يشمل بعدين أساسيين هما: 1- التراث كحاضر بيولوجى، مسجل فى خلايانا الحية الآن، ورثناه حيا عن حى، قبل أن نرثه أبا عن جد. 2- التراث كوعى شعبى مرصود فى عادات، وتقاليد، وأغان، ورقصات، وأمثلة وأساطير ممتدة. وسوف يكون تركيزى فى هذا المقال على البعد الأول دون الثانى. وفى ذلك أقول: إن الفرض الذى أطرحه هنا لفهم التراث وتحمل مسئوليته يزعم أن الإنسان، فردا، أو جنسا، أو جماعة، أو نوعا إنما هو تاريخه الماثل الآن، بمعنى أن التاريخ الصادق الوحيد هو ما بقى حتى الآن مسجلا فى خلايانا: بيولوجيا: فاعلا وكامنا وجاهزا للتنشيط والجدل. فإن صح ذلك (أنظر بعد) فإن الوسيلة الوحيدة لمعايشة التراث هى مواجهته “هنا والآن”، لا استدعاؤه، أو قراءته، وإنما تعريته، ومخاطبته، والجدل معه وبه. وقبل أن أستطرد فى طرح بعض أبعاد هذا الفرض، أود أن أشير إلى قليل من أُسِسِه: من المعلومات، والنظريات، والحقائق، والفروض السابقة على الوجه التالى: أولا: مازالت نظريات التطور (داروين خاصة) محل جدل طويل، بعضه عقيم، لا بسبب استحالة إثباتها طولا-كما يزعمون، ولكن بسبب تراجع تحمل مسئوليتها عرضا، ومستقبلا ثانيا: تراوحت الآراء حول وراثة العادات المكتسبة، من أول “لامارك” الذى قال بها حتى الدارونيين المحدثين المؤيدين بعلماء الوراثة الأقدم الذين أنكروها، مارين بداروين شخصيا الذى علق الأمر دون حسم. لكن البندول قد انتقل مؤخرا إلى الاعتراف المبدئى، دون تفصيل دقيق، أو يقين حاسم، بصحة وراثة بعض آثار أنواع معينة مطبوعة من التعلم (ليست بالضرورة “عادات”) ثالثا: يؤكد ذلك: الدرسات الباكرة حول ظاهرة البصم Imprinting، وهى ظاهرة تشير إلى نوع كامن من التعلم لا يتبع مبدأ المثير والاستجابة، بل مبدأ المطلق و البسط Releaser-unfolfing، حيث لا يحتاج السلوك المطبوع إلا أن يطلق فينبسط متكاملا، وهذا ما سمى بالتعلم بالبصم، وهو يؤكد انتقال هذا التعلم جاهزا إلى أجيال تالية، ويتميز هذا النوع من التعلم عن النوع الأكثر شيوعا وهو التعلم الشرطى بمميزات لا مجال لتفصيلها حالا. رابعا: واكب ذلك إضافات دالة نتيجة للتقدم الرائع فى تقنيات دراسة النشاط النوعى والكمى والموضعى لبعض أجزاء ومستويات الدماغ، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى “المطاوعة النيورونية ” Neural plasticity وقد أظهرت هذه الدراسات كيف يمكن أن يتكيف، ويتغير، تنظيم تركيب المخ، نتيجة لخبرات يعايشها صاحبها فى البيئة المحيطة([2])، وخاصة تلك الخبرات الجذرية المغيـّرة للسلوك الأعمق، أو المرتبطة بالبقاء والتطور. خامسا: تدعمت هذه الدراسات الجينية والتعّـلـِمية بالدراسات الخاصة بالذاكرة،([3]) وخاصة فيما يتعلق بدور حامض “الدنا” (ديسوكسى ريبونيوكليك) DNA ودوره المحورى فى كل من الوراثة والتعلم وأصل الحياة. سادسا: أحيت هذه الدراسات ما كان قد أهمل من نظريات نفسية، وهى الدراسات التى ترى الإنسان فى بعده الطولى، تركيبا هيراركيا متكاملا، يحتوى الأحدث منه الأقدم ليتكامل معه لا ليمحوه، ولا ليحل – تماما- محله، (وهذه الاتجاهات قد تكاملت مؤخرا فى بعض النظريات النفسية ذات النظرة الغائية مثل نظريات علم النفس الإنسانى عموما و “ماسلو” خصوصا، على أننا قد يمكن أن نتعرف على بعض جوانب هذا الاتجاه فى نظريات أخرى أقدم وأعمق، مثل منظور النماذج البدائية عند كارل يونج وكيفية استيعابها فى عملية النمو التكاملى التفردIndviduation سابعا: ظهرت نظريات أحدث تجمع بين التنظيم الهيراركى للمخ تاريخا وحاضرا، وبين تعدد الذوات (الذات الطفلية Child Ego State، وما يقابلها من تنظيم بدائى يقال له الذات الأقدم Arche psyche، والذات الوالدية Parent Ego State، وما يقابلها من تنظيم قديم جاهز للبرمجة من سلطة خارجية، يقال له الذات الخارجيةExtero psyche، ثم الذات اليافعة Adult Ego State، وما يقابلها من تنظيم الذات الأحدث Neo psyche وهذه التعريفات، والتنظيمات هى من لغة ومصطلحات نظرية التحليل التفاعلاتى Transactional analysis - إريك بيرن- الذى يبدأ بالتحليل التركيبى Structural analysis وكلها تنظيمات نيوروبيولوجية فينومينولوجيه، وليست مفاهيم رمزية تجريدية ) من خلال هذه المعطيات الأقدم والأحدث انتهيت إلى تدعيم الفرض الحالى قائلا: إن التراث الحقيقى للإنسان: نوعا، وجماعة، وفردا، هو مسجل بكل الدقة والتفاصيل، فى الحامض النووى عامة، وفى التنظيمات البيولوجية الخلوية، والمنظوماتية للدماغ البشرى ثانية، وإن هذا التراث هو حاضر حالا، وإن كان غير مستقل أبدا فى حالات الصحو والسلامة. وهكذا وجدتنى أتعامل مع التراث وجها لوجه، ماثلا “هنا والآن”، وقلت أبدأ بالنظر فى التركيب الفردى، لأطرح تنويعات وتباديل، واحتمالات تعامل الإنسان مع تاريخه القائم فعلا فى تركيبه الآنى، ثم أحاول، ولو بقياس تعسفى، أن أوازى بين هذا الذى نظمته النيوروالبيولجيا، وبين ما يمكن أن نقوم به فى مواجهة وحمل مسئولية تراث الجماعة الخاصة، فالعامة، فالإنسان. تجليات التراث الدماغى: لا يوجد مدخل لمعرفة علاقة الأقدم بالأحدث فى تنظيمات المخ البشرى، (مع احتمال وجود ما يقابلها داخل الخلايا من جهة، وفى الكون عامة من جهة أخرى) أفضل من النظر فى التناوب الذى ينظمه الإيقاع الحيوى فى الأحوال العادية للإنسان الفرد، حيث يجرى بشكل نابض منتظم تبادل بين نشاط مستويات المخ، أثناء النوم واليقظة، ثم أثناء النوم: بين النوم الحالم والنوم غير الحالم..إلخ، (هذا إلى جانب الجدل الولافى على مسار النمو الطولى، مما سنؤجل الحديث عنه الآن). الحلم من هذا المنطلق، هو طور أو مرحلة محدودة، ومنظمة، ودورية للتراث البيولوجى الكامن فى المخ، وهذه المرحلة ليست لمجرد الراحة، أو التبادل التفريغى، وإنما يترتب -عادة – على نشاط هذه المرحلة نوع من التكامل مع بعض ذخائر التراث البيولوجى، حيث يحدث مع كل حلم - تذكرناه أو لم نتذكره- نوع من الإحكام Consolidation والتنغيم Modulation لمنظومات المعلومات الأحدث مع الأقدم، وباستمرار. ثم إن الإبداع من هذا المنطلق أيضا، هو العملية التى تتم فيها مثل هذه الزيارة إلى التراث البيولوجى، بما تعد من الإحكام والتنغيم، ثم يتمادى الأمر بدرجة من الوعى والإرادة لإعادة التنظيم والتوليف حتى يتولد الأصيل الجديد المتجدد. إذن: فالتراث المسجل بيولوجيا موجود طول الوقت، ومتاح فى الأحوال العادية للنائم خاصة أثناء نشاط الحلم فى سياق حالة “وعى آخر”. كما أنه متاح للمبدع فى حالة وعى فائق (وعى: هو جـماع ولافى من وعى اليقظة العادى، والوعى الأقدم) وعلى ذلك نخلص إلى القول بأن: علاقة الحاضر بالماضى على المستوى البيولوجى هى علاقة حاضر متاح، بحاضر كامن، وليست علاقة القديم بالحديث بالمعنى الزمنى الطولى. هذا فى حالة السواء العادى. أما فى حالات الإبداع فإن المخ القديم يصبح دافعا وموردا رائعا لطاقة ومواد متنوعة وخام، بحيث يستطيع المخ الأحدث أن يعيد صياغتها جنبا إلى جنب مع ما يحصله من معلومات أحدث، وما يمارسه من واقع آنى، فهى علاقة جدلية خلاقة بين التراث الكامن، والحاضر القادر أحوال التراث فى تنويعات المرض: أما فى الأحوال المرضية فإن علاقة مستويات المخ ببعضها تتنوع مُعَوقّة أومُشِلَّة أو مفسخة: (1) ففى الجنون التفسخى (الفصام غالبا): بدلا من أن تظل أقدم مستويات الوجود والمخ، متداخلة ومتبادلة مع بقية التنظيمات والمستويات، فإنها تستقل، وتقود إذ تسحب الوجود إلى مرحلة بدائية نكوصية، تاركة وراءها، آثار التفسخ والعجز اللذان يصيبان المستويات الأحدث نتيجة الإزاحة، والإشلال، والإفقار. (2) وفى أغلب حالات اضطرابات الشخصية: يطغى المخ الأحدث – ملوَّثا – حتى يستبعد أى تعاون أو تبادل دورى مع المستويات الأقدم وهو ما أصبح يسمى حديثا “فرط العادية” Hyper-normality (3) وفى بعض حالات اضطرابات الشخصية الأخرى يبدو الأمر وكأن اتفاقا – بل تلفيقا تصالحيا – قد حسم الخلاف بين المستويات وبعضها، فيقوم المخ الأحدث السائد بخدمة أهداف المخ الأقدم دون أن يظهر الأخير فجَّا بعدوانيته، وبدائيته، وذاتيته، ونرجسيته وجذبه الانسحابى وهكذا يحقق كل أغراضه البدائية من خلال المظاهر شبه العادية، وشبه الحديثة حيث يقوم بتنفيذها – نيابة عنه- المخ الأحدث نتيجة هذا الاتفاق (السرى) عادة. القياس المحتمل: فإذا استلهمنا هذا النموذج البيولوجى – المرضى – فإننا نستطيع أن نعيد تصنيف علاقتنا بالتراث عامة على الوجه التالى: الاحتمال الأول: (النكوص= التدهور): وفيه يقود التراث مهما كان قديما وجامدا، طبيعة ومسيرة الوجود الآنى، فيقودنا إلى التكرار، والنمطية، والحلقات المغلقة، والوجود المثقوب والجمود. وهذا نوع من التدهور العام الذى يقابل، فى حالة الفرد، الجنون السلبى الذى يتمثل فى غلبة المخ الأقدم، ثم التدهور العاجز وهو ما يقابل فى واقعنا: الحركات الأصولية أو السلفية الداعية إلى العودة إلى القديم حرفيا، وتزويقه وتبريره إن أمكن، وكذلك الفخر بمنجزاته والمبالغة فى إنكار سلبياته. الاحتمال الثانى: (القشرية = التسطيح): وهو الاتجاه إلى المبالغة فى إلغاء القديم تماما، وإنكار تأثيره، حيث يتم الاكتفاء باللغة الأحدث، والإنجازات الأحدث،، فنمضى مثل أشباه القردة المبرمجة، إلى لا شىء، رغم ظاهر ما يسمى المعاصرة أو التنوير وما إلى ذلك، وهذا هو ما يقابل ما أسميناه – فى حالة الفرد- فرط العادية Hyper normality (وهو نوع من اضطراب الشخصية) وأيضا هو ما يقابل الحركات شبه العلمية المتعصبة للمناهج الحديثة المختزَلة والمختزِلة. الاحتمال الثالث: (التلفيق = التلوث): وهو يعنى هذه المحاولات الخائبة التى تضع الحديث فى خدمة القديم (التراث) لتبرر العودة إليه، فتشوه الاثنين معا، رغم الاحتفاظ بظاهر شعارات لغة الأحدث. وقد يتمادى هذا الاتجاه إلى تفسير القديم (التراث) بأبجدية الحديث، بل قد يتمادى الأمر إلى محاولة إثبات وتأكيد سبق القديم (التراث) لما جاء به الحديث (بما فى ذلك العلم الحديث!). وهو ما يقابل – فى حالة الفرد- نوعا آخر من اضطرابات الشخصية. وأيضا هو ما يقابل ما يحدث فى مجتمعاتنا بإفراط متزايد تحت عناوين مثل التفسير العلمى (العلم الحديث) للتراث (بما فى ذلك القرآن) وما إلى ذلك. الاحتمال الرابع: (الانشقاق: لفض الاشتباك) وهنا يتم فض الاشتباك لتحقيق توازن شكلى بحيث لا يلتقى التراث مع الحاضر إلا بمعاهدة صلح مشبوهة، فيقال إن التراث (بما فى ذلك تراث الأديان والايمان والحدس..إلخ)، هو نشاط وجدانى، فى حين أن معطيات العصر ومناهجه هى نشاط فكرى، وأن الانسان المعاصر يحتاج إلى هذا وذاك معا، وهذا احتمال تلفيقى تصالحى خطير، لم أذكر ما يقابله فى حالة الفرد، حيث يحتاج إلى تفصيل خاص، إذ أنه يقع بين السواء والمرض لأنه يتم بانشقاق شبه تصالحى: يوقف النمو، لكنه لا يحدث مرضا صريحا عادة اللهم إلا بعض الصعاب السطحى المؤقت. ويقابل ذلك تلك المحاولات التوفيقية (التلفيقية أحيانا) التى تحاول أن تحترم التراث، لكنها لا تقتحمه، وهى قد تفسره لكنها لا تستلهمه، وهى تستحضره لكنها لا تحييه، وأشير باحترام واعتذار لبعض محاولات زكى نجيب محمود مثلا فى هذا الصدد. الخلاصة واقتراحات المواجهة: نخلص من كل ذلك إلى عدة استتاجات أساسية، نأمل أن تهدينا إلى اقتراحات عملية: أولا: إن التراث الحى موجود “هنا والآن” بداخلنا قبل وبعد رصده فى كتب التاريخ أو روايات الأقدمين (هذا فضلا عن حضوره السابق الإشارة إليه فى صورة تقاليد، أو أمثال، أو أساطير أو أغان وممارسات شعبية مما قد نعود إليه فى حديث آخر). ثانيا: إن هذا التراث الماثل فينا الآن، هو كامن عادة، إذ لا يمكن أن يسود أو يستقل إلا فى حالات النكوص والتدهور، وكمونه هذا لا يعنى خموله أو ثانويته، بل هو ينبه إلى ضرورة التبادل معه، والجدل من خلال تنشيطه (أنظر بعد). ثالثا: إن الجدل بين هذا التراث البيولوجى الماثل فينا-“الآن”- بكمونه الجاهز للتنشيط، وبين المعطيات الأحدث، بالأدوات العصرية الأقدر، والمعلومات المتدفقة المتجددة أبدا، هو الإبداع الحقيقى الذى يمكن أن يميز ثقافة ما من ثقافات البشر المعاصرة، ثقافة لها هويتها المتميزة نوعيا، والقادرة على الإسهام التضفرى مع ثقافات أخرى مواكبة، تتجادل مع تراثها الخاص والعام طول الوقت. رابعا: إنه بغير التربية التى تسمح للتراث البيولوجى (الذى هو حاضر كامن متبادل مجادل معا) أن يسهم فى تشكيل الوعى الفردى والجمعى لا يمكن أن يتكامل الإنسان فردا أو جماعة وسيظل: إما هيكلا هشا بلا جذور، أو أثرا كالحا بلا حياة. خامسا: إنه ينبغى أن نحسن التفرقة بين ميوعة التلفيقية الشائعة بين القديم والمعاصر، والتى تركز على الترجمة الخائبة والمتعسفة إلى لغة أحدث، أو على التسوية الهامدة التى تقتطف من القديم جزءا لتلصقه إلى جزء أحدث، أو تصيغ نفس القديم بأبجدية أكثر معاصرة، نفرق بين ذلك وبين ما ندعو إليه ونأمل فيه من جدل مبدع مع ما يمكن تنشيطه من التراث البيولوجى الحاضر والجاهز دوما. سادسا: إنه من خلال هذا الفرض يتبين لنا أن التراث ( البيولوجى خاصة) ليس قديما أصلا، بل هو حاضر شديد الثراء، وافر العطاء، لا يظهر فى إيجابيته إلا من خلال ناتج جدله مع الواقع الآنى الحى. سابعا: إن ما يسمى “التراث” (تقليديا: كما هو شائع فى أغلب الأحوال) وهو المسجل رموزا فى كتاب، أو معلومات فى تاريخ، أو منهج فى نظرية، لا ينبغى أن تقتصر معرفتنا به لتفيد الإلمام بتاريخنا الخاص، كما لا ينبغى أن نستعمله مهربا نلجأ إليه ندارى به عجزنا الحالى. ثامنا: إن هذا التراث المكتوب، فى صورة مراجع، أو تاريخ، هو ضرورى ومهم أيضا، لأنه القادر على إثارة ما يقابله فى تركيبنا الآنى، فالواجب أن نعايشه ونحن نقرأه، لا أن نكتفى بحفظه، أو تسميعه، أو الفرجة عليه، أو الاستشهاد به أو حتى الفخر به. وبألفاظ أخرى: إنه يعتبر المـُـطـْـق Releaser المناسب، لتراثنا البيولوجى المطبوع فينا، إذا أخدنا نظرية التعلم بالبصم قياسا لما نريد إيضاحه. وبعـد فإذا كان التراث حاضرا لا يمكن قراءته إلا من خلال جدل مبدع مع حاضر آخر أقدر وأرحب، فإن من يصوره لنفسه ولنا مهربا آمنا، أو بديلا جاهزا إنما يلغى كلا من حاضره المعاصر، وتراثه الكامن معا. [1] – مجلة سطور: (عدد أكتوبر – 1998) The Brain That Changes Itself” Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain science” Edited by: Norman Doidge , M.D. Copyright: 2007 [3] – أضيفت كذلك أبعاد للذاكرة وكيف أنها تتواجد فى المخ وخارجه معا، ويمكنك الرجوع إلى محاضرة روبرت شيلدريك : “العقل الممتد” The Extended Mind على موقع اليوتيوب. من نافلة القول أن نقول إنه لايوجد شئ إسمه الحقيقة، وإنكار وجود الحقيقة – بالمفهوم الذى يلوح به بعض غلاة العلماء، أو بعض متعصبى الأديان والأيديولوجيات- ليس موقفا عدميا أو مثاليا، وهو لا يعنى ما قال به بيراندللوا (ومثله كثيرون) فى مسرحيته الجميلة “لكل حقيقـته”، ولكنه إلزام متجدد بدوام السعى إلى تخليق الحقيقة المتحركة القابلة للتعديل والتشكيل باستمرار الحياة، واستمرار المحاولة. فالأمر الآن يمكن أن يوجز فى فرض يقول: “الحقيقة هى موضوعية وسلامة وصحة منهج السعى إليها” وحين نذكر كلمة المنهج، يقفز إلينا فى مجال العلم- متصدرا- المنهج التجريبى بما يعنى من حتم الإعادة والمقارنة، وهو منهج أحسن ما يقال فيه هو: أنه قد يظهر بعض سطح الحقيقة دون سائرها، فإذا حل هذا الظاهر الجزء محل الكل فإنه يبعدنا عن الحقيقة لا يقربنا منها، أما فى مجال السياسة فإن الحقائق تختفى وراء مناهج حسنة السمعة ضعيفة المصداقية، مثل منهج الديقراطية، والتاريخية، والمفاوضاتية، وحتى منهج الحرب (وهى إحدى لغات السياسة) كلها مناهج تجعل من الأقوى، ومن الغالبية (بغض النظر عن نوعيتها) هى الوصى الشرعى الذى له الحق فى الإفتاء بما هو حق أو حقيقة. وحين يحتار الإنسان بين هذه المناهج الناقصة، أو الزائفة، تقفز إليه مناهج بديلة تترجح بين أقصى الزيف، مثل ألعاب الحدس البدائى، والشطح الجماعى، والوهم المتناثر البراق، وبين أقصى الوثقانية الكلية الواعدة بالمعرفة الكلية المباشرة برغم غموضها وخصوصيتها والتى تتمثل فى الإلهام الإيمانى والسعى الصوفى الجاد المثابر. وحتى لا نـتمادى فى تنظيرات مجردة دعونا نطرح بعض التساؤلات والأمثلة لأشباه الحقيقة. أولا: هل حقيقة أن الصحيح نفسيا هو الشخص الذى يشبه سلوكه أغلب الناس، ويستطيع أن يتشكل كما يريدون، وأن من حاد عن السواء الإحصائى لعامة الناس، يمكن أن يوصم بوصمة المرض؟ ثانيا: هل حقيقة أن من يـُجـْـمع عليه أغلبية المشاركين (فى الانتخابات العامة، أو مجلس الشعب، أو مجالس الكليات أو مجالس تحرير الصحف أو أى مجالس من أى نوع) هوالأقـرب للحقيقة، أم أنه الأقرب إلى احتياجات هؤلاء الناس فى هذه اللحظة الزمنية، حتى لو كانت هذه الاحتياجات هى الانتحار نفسه (تصور لو أجريت عندنا آنتخابات حرة فعلا ورشح المتدينون- الخصوصيون جدا- أنفسهم نيابة عن الله([2]) سبحانه وتعالى، فأى حقيقة يمكن أن يمثلوها مع كل هذه الديمقراطية). ثالثا: هل ما تنتهى إليه النتائج العلمية جدا،هو الحقيقة، أم أنه مرحلة إلى الحقيقة ما دام العلم – بالتعريف – هو مفتوح النهاية أبدا وقابل للتفنيد (بل للتكذيب) والمراجعة دائما. نقول، بعد أن نتوقع إجابات مناسبة لهذه الأسئلة أوالأمثلة، إننا لا نملك إلا السعى، ثم السعى، ثم السعى إلى الحقيقة، لا أكثر. فالساكن الثابت لا يصل، من موقعه إلى أى حقيقة كافية. فهل يصل من يتحرك – جدا- إلى الحقيقة بالضرورة؟ الإجابة مازالت تحتمل النفى، فثمة حركة تبدو شديدة النشاط، شديدة الحماس، شديدة الحرارة، ولكن بتتبع خطواتها بأمانة كافية، وبتقييم موضوعى لنتائجها المرة تلو المرة، قد نكتشف أنها حركة “فى المحل” أيضا، وأنها ليست إلا إعادة لنص فاشل، سبق أن تكرر واعدا المرة تلو الأخرى، يحدث هذا فى أبسط مظاهر السلوك، مثل تكرار تجارب الحب أو الزواج الذى يتم فيها انتقاء الحبيب الجديد (أو الشريك الجديد) بنفس مواصفات القديم (مع تغير الإسم والعنوان وظاهر الصفات) ثم يتسلسل النص العاطفى حتى يتم الفراق أو الطلاق المرة تلو المرة بنفس الطريقة، ونفس الخطوات، ونفس النهاية، ثم، من جديد، وهكذا، يتكرر مثل ذلك مع المدمن الراجع، كما يمكن أن تكتشفه فيما شئت من التجارب البشرية فى مجالات الثراء الاستهلاكى التفاخرى، أو مجالات التعصب الأيديولوجى أو الدينى أو الوطنى، أو حتى بعض مجالات البحث العلمى الكمى، ولا يخفى أن مثل هذا “النص المكرر” لا يمثل الحقيقة بل يؤكد القصور عن الاستفادة من الوعى بالخطوات إليها، والعجز عن التعلم من نتائج الفشل عن تحقيق خيالاتنا عنها. حتى العلاقة بالآخر كموضوع حقيقى (من حيث أنه - الآخر- وليس مجرد مسقطا لاحتياجاتنا) مثل هذه العلاقة لا توجد إلا من خلال “برنامج الذهاب والعودة” منه وإليه، ذلك البرنامج الذى يسمح لنا بإعادة الرؤية، وهو البرنامج الذى - إن صح- يسمح لنا أن نـتخلق فى حضور آخر يتخلق بنا ومعنا طول الوقت . الحركة نحو الحقيقة، التى أزعم أنها هى هى الحقيقة، لا بد أن تكون لها مواصفات موضوعية محددة ، تجعلها فعلا إبداعا متجددا يخلق حقائقه المرحلية باستمرار، ومن هذه المواصفات. أولا: ألا تبدأ الحركة من فراغ، إذ لا بد أن تكون بدايتها محتوية تاريخها. ثانيا: أن تقبل الحركة – رغم جدتها- أى قدر من الاختيار للتحقق والنقد والنضج مع احتمال مغامرة تغير نوعى ولو كان شديد الضآلة لا يمكن رصده ابتداء). ثالثا: أن تقيس نجاحها وفشلها بنوعية التعلم بما فى ذلك مراجعة المنهج، بدءا بمنهجها ذاته. رابعا: أن تقبل التبادل الإيقاعى مع السكون الإيجابى، بمعنى ألا تكون حركة طول الوقت، وأعنى بالسكون الإيجابى ذلك النوع من التلقى المستوعب لمزيد من المعلومات التى تصبح ذخيرة الطور الأتى من حركة متجددة . خلاصة القول: إن الإنسان الساعى إلى الحقيقة هو إنسان قادر على ممارسة الإيقاع الإبداعى بين السكون المسـتوعب، والحركة المهددة بالتحول، وهو الإنسان المغامر طول الوقت وهو يكابد أشرف ما تتميز به محنة الوعى والحرية من حتم التغيير إلى ما لا يعرف، باستعمال كل ما يعرف والتفتح لكل ما لا يعرف. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد ديسمبر – 1998) [2] – وهذا هو ما حدث لاحقا فعلا بعد أحداث 25 يناير ولمدة عام واحد. (من 24 يونيو 2012، حتى 3 يوليو 2013). لعل أهم ما يهم الناس هذه الأيام هو محاولة حل هذا الأشكال الماثل فى المواجهة الحادة بين ما يمثلة تعميق النظر فى الحاضر الجاثم، ومحاولة التخطيط للمستقبل، فالحاضر يبدو وكأنه أتاح لنا من الأدوات (التقنيات القادره على مضاعفة سرعة الرصد، والتواصل، والشفافية) ما يسمح لنا بأن تنصور قدرتنا على صناعة مستقبلنا كما ينبغى أو كما نشاء، أو هكذا يلوحون لنا بما يعد به النظام العالمى المزعوم (الجديد)، ليس على مستوى المسار السياسى فحسب، وإنما على مستوى مسارات المعرفة والتقدم، وصياغة، وإعادة صياغة الحياة. فإلى أى مدى يصح كل ذلك. وهل هذا الحلم القديم الجديد (امتلاك الأدوات التى تمكننا من امتلاك ناصية التخطيط للمستقبل حقيقة وفعلا) قد تحقق فعلا أو هل هو على وشك التحقيق؟ وهل يؤدى بنا الانبهار بهذا الإنجاز – الذى ليس لنا فضل مباشر فيه – إلى الوقوف مشدوهين أمام رواده، سواء كان اسمهم قادة النظام العالمى الجديد، أم كانوا من صفوة العلماء والإعلاميين من أهل التواصل والشفافية والتقنية الأحدث، نقف مشدوهين تابعين نردد مع الحسن بن هانئ كيف أنهم قد “.. دان الزمان لهم، فما يصيبهموا إلا بما شاءوا”؟ وهل هذا الزمان الذى دان لهم هو زمانننا أيضاُ؟ أم أنهم احتكروا إنجازاته ورفاهيته كما دارت كئوس خمر أبى نواس على “فتية” بعينهم دون سواهم (دارَت عَلى فِتيَةٍ دانَ الزَمانُ لَهُم. فَما يُصيبُهُمُ إِلّا بِما شاؤوا) وهل حقيقى أن هذه الأدوات – هكذا – يمكن أن تتيح لنا أن نكف عن الحلم العادى لأن قدراتها فاقت خيالات وشطحات الأحلام نفسها؟ وأين يقع الحلم – حلمى وحلمك كل ليلة ونحن نيام – من كل هذا؟ هل احتوته وصاية هذا النظام الجديد، وهل لاحقته وتلاحقه تلك الأدوات الرائعة القادرة؟ أم أنه هو (الحلم – حق الحلم) هو الذى بقى لنا فى منطقة أمان نسبى من هذه الإغارة؟ وهل هذه الإضافة – إضافة من الحلم: المعرفة الأخرى – لازمة أم هى تزيّد عابث يمكن الاستغناء عنه؟ الإجابة عندى جاهزة وحاسمة ومحدودة، على الرغم من أنها لا تعدو أن تكون فرضا جديداَ، يكمل أو يطوّر فرضا سبق أن طرحته حول هذه المسألة. الإجابة (فرض هذه الأطروحة) تقول: نعم، له دور: للحلم دور آخر، دور باقٍ، وسيبقى، ويزيد، إن كان للإنسان أن يواصل مسيرة تطوره المبدع الممتد. فالحلم إبداع الشخص العادى، وهو قادر على إثراء حياته بعيداَ عن وصاية غرور اليقظة طول الوقت” فكيف يكون ذلك كذلك؟ لابد من عودة سريعة (موجزة قدر الإمكان) إلى الفرض القديم، ذلك الفرض الذى قدمه كاتب هذه السطور من قبل، ومقدمات هذا الفرض القديم تقول: يتناول المخ معلومات (محتواه تركيبه/ ذواته… إلخ) أثناء اليقظة بشكل انتقائى لما هو واقع فى بؤرة وعيه الظاهرى ومرتبط بقصدية سلوكه الآنى، لكن المعلومات (بالمعنى الأشمل) تصل إلينا قبل وبعد ومع هذا التحديد الانتقائى، ويقوم الحلم بوظيفة أن يعيد التنظيم، ويحكم التناغم، ويعزز التعلـّم، وقد كان لاكتشاف ظهور النشاط الحالم بإيقاع حتمى منظم (20 دقيقة كل 90 دقيقة أثناء النوم) أثر هائل فى فهم ظاهرة الحلم ووظائفها، قبل وبعد ظهور محتوى الحلم ومحاولات فك وتفسير رموزه. من أهم ما قدمه هذا الكشف الأحدث هو التأكيد على أن الحلم يحدث حتما، سواء تذكرناه وحكيناه، أم لا، وأن الحلم ليس حارسا للنوم كما قال فرويد، بل لعل النوم هو خادم الحلم، أى أننا لا نحلم لنحافظ على استمرار نومنا، وإنما قد يكون الأصح أننا ننام لكى تتاح لنا فرصة أن نحلم، فالحلم ليس مجرد تنفيذ أو تفريغ، بل هو “يحاول بانتظام أن يعيد التنظيم، ويحكم التناغم، ويعزز التعلم”. هذا الفرض إنما يضع ظاهرة الحلم المسجلة فسيولوجيا (برسام المخ الكهربائى) فى مرتبة أهم وأكثر دلالة من ظاهرة محتوياته التى شغلت التحليل النفسى والوعى الشعبى قرونا، فحديث العلم الآن يرتبط بنشاط الحلم وأثره، أكثر من ارتباطه بمحتوى الحلم وتفسيره، هذا النشاط الحالم يقوم بتحريك الكيانات الداخلية، أى أنه يقوم بقلقلة المعلومات التى لم تـُـتـَمثل تماما أثناء اليقظة لترتيبها، أى أنه يباشر تفكيك البنية القائمة بهدف تحقيق درجة أكبر من التوازن والتكامل والتماثل والاستيعاب، ويتكرر هذا النشاط إيقاعياً، فى محاولة دائبة لاستكمال مهمة التوازن والنمو البيولوجى (التى لا تستكمل أبداً مادامت الحياة تنمو باستمرار). ولو أيقظنا النائم فى أثناء هذا التنشيط الإيقاعى، فإنه سيواجه – “وهو يستيقظ” – نتاج هذا الكم الهائل من تحريك مفردات المخ وكياناته ومحتواه وتراكيبه، ثم إنه سوف يتعامل مع هذا الكم المتحرك بقدرة تنظيمية خاصة بنوع وعيه حالة كونه يستيقظ فإذا حاول أن يحكى بعد استيقاظه – فى دقائق أو أقل ما حدث، ربما فى جزء من ثانية، فهو لا شك سوف يؤلف ما يمكن أن ينقله إلى شخص آخر بالحكى، أو ما قد يسجله لنفسة أو يحادث به نفسه، وبديهى أن هذا الذى حدث ولو فى جزء من ثانية لابد أن يحكى بطريقة غير حقيقته، طريقة أكثر تكثيفا من سلسلة التفكير والتألف فى أثناء اليقظة، بما تحمل، وتدوير للزمن، أو عكسة، أو تقطيعة، من هذا المنطلق يتطور هذا الفرض الأساسى موضاعنا لهذه الأطروحة وهو يقول: “إن عملية التنشيط، فالقلقلة والتفكيك، بما يترتب عليها مؤقتا من ترابط عشوائى، وعكس للزمن وتدويره.. إلخ – هذه العملية الناتجة عن النشاط الإيقاعى المسجل برسام المخ، ليست هى الحلم كما نسمع عنه، وإنما هى المورد لمادة الحلم ومفرداته. أما الحلم المحكى فنفترض أنه يـُـحكى فى أثناء عملية إبداعية هائلة السرعة، تتم فى بعض الثانية، أو فى بضع ثوان، فى حالة من الوعى لاهى وعى الحالم، ولا هى وعى اليقظة، ووظيفة محاولة “التذكر” فـ “الحكى” هى ناتج التقاط المتاح من معلومات هذا التحريك الفائق السرعة، ثم بسطه بما تيسر من إعادة تنظيم (إبداع) على مساحة من الزمن والوعى تصلح للحكى أو التسجيل”. يمكننا، إذن، صياغة عملية الحلم فى مراحل ثلاث أساسية، تبدأ من: الحلم بالقوة (كما يحضر فسيولوجيا أساسا). ثم الحلم بالفعل حين تصبح مادة المعلومات المتحركة فى متناول الحالم، ثم الحلم بالحكى، وهى المرحلة النهائية التى تصلنا إذا ما تمكن الحالم من أن يرصدها أو يتصور أنه يرصدها، ثم يحكيها، عادة بعد أن يضيف إليها أو ينتقص منها ما شاء كما يشاء مستوى وعيه بين اليقظة والنوم. فللحلم المحكى وعى خاص يتوسط وعى النوم، ووعى النشاط الحالم، ووعى اليقظة معا. وبقدر ما تكون المادة المتاحة من وعى الحلم عارية وحاضرة فى الحلم المحكى، يكون التكثيف والتداخل والتدوير والأصالة، فيبدو الحلم أكثر غموضاً وإن كان أكثر ثراء وأقدر تحريكا. وعلى العكس، بقدر ما يتدخل وعى اليقظة فى حبك مادة الحلم وروايتها يكون الرمز والتنظيم والتفصيل والسلسلة حتى يمكن أن ينتهى الأمر إلى تزييف كامل للمادة الخام المتعتعة أثناء النشاط الحالم الأصلى. وعلى هذا الأساسى فإن الحلم، بكل درجاته هو إضافة إلى مساحة الوجود، وليس مجرد حكى أو رصد لما هو موجود. وأيضاً لزيادة الأيضاح، فإن نشاط الحلم بغض النظر عن ما يُحكى ليس مجرد تفريغ دوافعى، أو انفعال موجـّـه، أو تداع سلبى أو تعبير عن رغبة لم تتحقق فى اليقظة ولكنه إعادة وتنظيم وترتيب وتوجه (أى عملية إبداع بشكل أو بآخر). من خلالِ هذا الفرض نرى – كذلك – أن الحلم ليس نشاطاً بدائياً، فعملياته الأولية (فرويد) ليست أولية جداً (بدائية – طفلية – عشوائية) بل إنى رصدت كيف أن الحلم كثيرا ما يستعمل “العمليات الثالثوية” التى وصفها “سيلفانو اريتى” فى الإبداع، حيث تؤلف هذه العمليات الثالثوية بين العمليات الأولية والثانوية فى ولاف إبداعى أعلى. وقد أعلن مثل ذلك “دوستويفسكى “([2]) نصاً: “…. تتميز الأحلام ببروز قوى، وشدة خارقة، وتتميز كذلك بتشابه كبير مع الواقع، قد يكون مجموع اللوحة عجيباً شاذاً، ولكن الإطار، ومجمل تسلسل التصور يكونان فى الوقت نفسه، على درجة عالية من المعقولية، ويشتملان على تفاصيل مرهفة جداً، تفاصيل غير متوقعة، تبلغ من حسن المساهمة فى كمال المجموعة أن الحالم لا يستطيع أن يبتكرها فى حالة اليقظة، ولو كان فنانا كبيرا، مثل “بوشكين”، أو “تورجنيف”. إذن، فالحلم ليس خلطا عشوائيا، وإنما هو إبداع له ظروفه الخاصة، وسرعته الهائلة، كما أن احتمالات تشويهه وتسطيحه متعددة. ويجرنا هذا إلى الحديث عن “لغة الحلم” التى اختلف حولها المفسرون والحالمونه جميعاً، ولكنهم اتفقوا بشكل أو بآخر، على أن ثمة لغة (متذكرين طوال الوقت أن اللغة غير الكلام، فاللغة بنية، والكلام بعض مظاهرها)، وقد كاد الاتفاق ينعقد على أن لغة الحلم هى لغة مصورة، لها نحوها وبلاغتها الخاصة، وأنه يمكن حل شفرتها من حيث المبدأ بجهد ما. وهنا لابد أن تثار قضية خطيرة تماماً، وهى قضية إنكار حق “الصورة” فى المثول “هكذا” من حيث هى كيان دال قائم بذاته، قادر على التشكيل الحر حتى لو لم يفد ما اعتدنا أن نفهمه من اللغة الرمز واللغة الكلمات، فالحلم يتكلم بالصورة مباشرة، وهو بذلك لا يقلب التفكير إلى صور بقدر ما يستعمل الصور الحاضرة فى وعيه الخاص للتعبير، وعلينا – ما أمكن ذلك – أن نتلقى الحلم بلغته الخاصة، بدلا من أن نسارع فنترجمه إلى لغتنا السائدة فى اليقظة، ومن هذا المنطلق يمكن أن يتمدد وجودنا وتتعدد مستويات لغاتنا القادرة على التأليف المتصاعد بدلا من أن تظل لغة واحدة وصية طول الوقت على ما سواها (مرة أخرى: هذا من حيث المبدأ على الأقل). وهكذا نحرر لغة الحلم من وصاية لغة اليقظة كما حررنا غايته من مجرد كونها إكمالاً لرغيات وغايات المستوى السائد فى اليقظة، فالحلم – كما ذكرنا حالا – لا يحدث “خصيصاً” لتحقيق رغبة، أو لتفريغ طاقة” فهو ظاهرة إيقاعية دورية حتمية ينبغى أن نحترم حدوثها لمجرد أنها صفة حيوية للكائن البشرى مثلما وظيفة اليقظة، ولا يوجد مبرر إذن أن نسارع بإسقاط تصوراتنا (وآمالنا) عليها حتى تـُـختزل إلى وجود باهت على هامش اليقظة. وقد أثبتت تجارب الحرمان من الأحلام، أن الأحلام تؤدى وظائف صمام الأمن، والتفريغ، وإعادة تنغيم (هارمونية) المعلومات، كذلك يقوم الحلم بتعزيز التعلم بطريقته الخاصة، بمعنى تعزيز المادة المكتسبة لتُمثل فى طريقها إلى أن تصبح تحويرا فى التركيب. كل ذلك يحدث حتى لو لم يعرف الحالم أنه حلم أصلا وللحلم علاقة وثيقة بالجنون (الجنون بمعنى التناثر، والاغتراب، واللغة الخاصة، وضرب الزمن) فهو يتفق مع الجنون فى تجازوه وتكثيفه وتفكيكه وغلبة لغة الصورة وفجاجته كذلك، إلا أنه فى الجنون يحدث تنشيط الداخل هذا فى أثناء اليقظة وليس بالتبادل معها، فتقتحم مادة الداخل المنشطة فى وعيها الخاص، تقتحم وعى اليقظة اقتحاما غير متوازن ولا متبادل، فيحدث التشوش والخلط. وأهم ما يعنينا هنا هو أن وجه الشبه بين الحلم والجنون يزداد كلما اقتربنا من بداية العمليتين: بداية الحلم، وبداية الجنون، أو بتعبير أدق، كلما اقتربنا من عمق المستوى الأول لنشاط كل منهما، أما الإبداع، فهو يشترك معهما فى البداية أيضاً (المستوى الأولى: التفكيك)، ولكنه يختلف مساره، ونتاجه، مع اختلافات نوع الوعى وتكامل مستوياته، واتساع المسئولية، واتجاه الغائية، وفعل الإرادة، وأخيراً الطبيعة الولافية للناتج وآثاره. فإذا صحّ هذا الفرض الأساسى، وهو يزداد تحققا من خلال الممارسة الإكلينيكية والنقد الأدبى منذ نشر سنة 1985،([3]) فإن المطروح – هذه الأيام – على الوعى البشرى من إغارة أدوات الوعى الغالب المحكمة يصبح خطراَ على الجنس البشرى إن هو اقتصر على أن يتمادى بلغة مستوى اليقظة دون سواها، أو بأدواتها (أدوات اليقظة دون سواها). لابد أن نضع فى الاعتبار تلك الثورة الإبداعية فى مجال الأدب خاصة والفن عامة (ربما اندرج تحت مسميات متنوعة مثل الحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية… إلخ) هذه الثورة الإبداعية على الرغم من شطحاتها وغموضها كانت صرخة مناسبة تحاول أن تذكرنا بالجانب الآخر (الأعمق) من وجودنا البشرى، وكأنها محاولة أن تعطى شرعية ما، لمستويات وجودنا الأخرى، وكأنها التقطت خطورة الاستسلام لأحادية القطب فى الكيان البشرى قبل إنذارات خطورة الاستسلام للنظام العالمى أحادى القطب على مستوى السياسة والاقتصاد. ومع صعوبة الأمر وتحديات اللغة وخطورة الخلط بين إتاحة الفرصة لمستويات الوجود الأخرى للإسهام فى تنمية المعرفة تكاملها ومن ثم: الإبداع فالنمو، فإن الأمر يستاهل أن نقف وقفة قد يكون فيها إنقاذ للبشرية من التسطح فالانقراض. ولاشك أن المراجعات والحوار الجارى فى مجال الإبداع الفنى والأدبى فى هذه المنطقة، يواكبه حوار مواز جار فى مجال فلسفة العلوم ومراجعة المنهج، وما يتفتق عنه من تسخير التقنيات الأحدث لعلوم أقرب إلى كسر الاستقطاب أحادى البعد، وتجاوز السببية الحتمية، وذلك مثل علم الشواش والتركيبية Chasos & Compleyity Sciences والعلوم الكموية Quantum sciences، كل ذلك يعلن أن الإنسان فى كل مكان، ومجال، منتبه بشكل أو بآخر إلى ما “ليس كذلك” ما ليس قوة عمياء ساحقة لاغية لما لا يقع فى نطاقها أو يتكلم بلغتها، وما ليس حسابات سوق فوقية، وما ليس رفاهية محدودة المساحة. نعم، إن الإنسان يقاوم بكل لغة فى كل مجال: وهو يواجه مخاطر كل ما هو “كذلك” بالسعى المستمر لاستلهام كل ما “ليس كذلك” بالسعى الدؤوب فيما وراء السطح الطافى. وهنا لابد من وقفة تحذير من أن يُختزل هذا المدخل الذى يحاول توظيف (وعى) الحلم فى المعرفة، ومن ثم فى الإبداع، ومن ثم فى صياغة المستقبل، أن يختزل كل ذلك إلى التفسير خاصة بلغة التحليل النفسى التى أدت – بكل إخلاص وعمق للأسف إلى التأكيد المستمر على ترجمة لغة هذا العملاق الغائر إلى السطح الرمزى ترجمتها إلى لغة اليقظة بدلا من تعميق استقلاليتها ثم البحث عن توليف محتمل واعد. خلاصة القول فى هذه العجالة تؤكد: إن الحلم – بكل وعوده وغموضه – هو حق الإنسان المعاصر الذى لا يكتمل إلا به. وإن إنسانا لا يحلم، ولا يستلهم أحلامه (درى بها أم لم يدْر) لابد أن يقع فريسة وصاية خارجه، وأيضاً وصاية من خارجه. وإذا كانت التجارب الفسيولوجية الأكيدة قد أثبتت بما ليس فيه مجال للشك أن الجنون والتناثر هما النتاج المباشر للحرمان من الحلم، فإن حرمان الإنسان المعاصر من حق الحلم وحق إسهام حلمه – المتجاوز للتقنيات الوصية – فى صياغة مستقبلة، لابد أن تؤدى إلى نفس المآل على مستوى الجنس البشرى، وكأنه حرمان من حرية أعمق وأهم. وفى يقينى أن أخطر المضاعفات التى لحقت بالجنس البشرى مثل انهيار الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية لم تكن فى اختفاء توازن القوى، ولا فى إعطاء الشرعية لاحتكار نظام اقتصادى واحد مشكوك فى علاقته بإنسانية الإنسان، وإنما كانت فى حرمان الناس من حلم العدل والحرية، فمهما كان الحال داخل تلك المعسكرات المنهارة من حرمان حقيقى من عمق العدل والحرية، فإنها كانت تمثل بشكل ما – حلم مـِـنْ هو خارجها، وهذا وحده كان كافيا للحفاظ على الأمل فى تطور أرقى ووجود أعمق. وأحسب أن تاريخ ظهور اليوتوبيات الواحدة تلو الأخرى منذ جمهورية أفلاطون ويوتوبيا إسبرطة حتى الاتحاد السوفيتى وإعلانات الجماهيرية الليبية ليس إلا تأكيد لحق الإنسان فى الحلم وحاجته إليه. وأخيرا فإننى سوف أختم هذا الحديث الموجز بالتنبيه على أننى تجنبت عمدا أن أعرج إلى ما يسمى “أحلام اليقظة”، لأننى كنت أعنى غير ما شاع عند الناس مرتبطا بهذا المصطلح (أحلام اليقظة)، فالحلم الذى أدافع عن حق الإنسان فى الاحتفاظ به، واستلهامه، والتكامل من خلاله هو الحلم الإبداع، الحلم الوعى الآخر، والحلم الحرية البديلة، أما أحلام اليقظة، فهى نشاط اليقظة المسلسل بالرموز والمفاهيم الخاصة بوعى اليقظة حتى لو أدرج معها ما يسمى الخيال العلمى. إن المسألة جد لا هزل، وحق الإنسان فى استثمار مستويات وعيه الأخرى ليس قاصرا على مجال الإبداع الحديث والقديم على حد سواء… حيث يمثل الحلم إبداع الشخص العادى، وحيث يظل نشاط الحلم جزءاً لا يتجزأ من وجوده البشرى المتكامل، وأكاد أختم هذا المقال بصرخة فرحة تقول: افعلوا بنا ماشئتم، بكل ما تتصورون: لكنكم لن تستطيعوا – بغير استسلامنا – أن تغيروا على حقنا فى الحلم بكل ما تعنية الكلمة من معان. أما ماذا علينا بعد الوعى بروعة وضرورة ممارسة هذا الحق – حق الحلم – وهو مازال فاعلا فى المناطق الآمنة من النوم، بعيداً عن الإغارة الملاحقة لأدوات اليقظة، فهو أمر يعتمد على كل الجهود المبذولة فى كل المجالات للحفاظ على إنجازات الكائن البشرى متكاملة متبادلة متجادلة، وهذا هو التحدى الملقى على كل فرد بشرى معاصر. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد أبريل – 1999) [2] – فيودور دوستويفسكى، الجريمة والعقاب 1 ـ المجلد8، “الجريمة والعقاب” هى الرواية الثانية التى كتبها دوستويفسكى فى آن واحد مع رواية المقامر، عام 1866. [3] – يحيى الرخاوى: “الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع ” مجلة فصول – المجلد الخامس-العدد الثانى- 1985. هل التغير فعل إرادى مطلوب دائما أو غالبا؟ أم أنه إعلان لما تم تراكـمـه فاعلا: فى لحظة نقلة نوعية؟ وهل التعتيم تضليل مقصود عادة؟ أم أنه قد يكون ضرورة دفاعية تمهيدا لتغيير أقدر فى وقت أنسب؟ وهل يستطيع الإنسان أن يعيش وينمو ويتطور دون أن يترجـَّـحُ ما بين التغيير والتعتيم بشكل يكاد يكون متناوبا ومنتظما ومضطردا؟ وهل يمكن أن تثار نفس الأسئلة على المدى الأشمل (تطور النوع فتطور الإنسان)، وأيضا تطور المجتمعات ودورات الحضارات؟ ثم ما هى علاقة التغيير والتعتيم الفردى بالمسار الجماعى (والاجتماعي) طولا وعرضا؟ هذا ما عنّ لى ـ من تساؤلات ـ وأنا أحاول الاستجابة للمشاركة فى هذه القضية المثارة، وللإجابة على بعض هذه الأسئلة لابد من فتح ملفات فروض التطور، والتعلم، والنمو الفردى، وأزمات المرض، وأزمات الثورة، ودورات الإبداع، وتماوج استعمال الحيل النفسية (الميكانزمات)، ودورات الإيقاع الحيوى، حيث يتداخل كل ذلك بقدر ما فى إضاءة زوايا هذه القضية بشكل أو بآخر. فالنمو الفردى ـ مثلا ـ يتم فى دورات، فهو لا يضطرد بشكل كمى خطى أصلا، وكل دورة تعيد سابقتها وتضيف إليها بعد فترة استيعاب لمنجزات الدورة السابقة، فتتواصل المسيرة ما بين مظاهر أزمات التغيير، واستثمار كمون التعتيم. وبلغة التحليل النفسى، فإن كل الحيل النفسية اللازمة للتكيف هى نوع من التعتيم الضرورى للتكيف وخفض التوتر، أما التغيير فهو أقل تناولا فى مفاهيم التحليل النفسى، اللهم إلا فى ثنايا عملية التحليل نفسها. وهذا التناوب أيضا أصبح يرصد فى أنواع التعلـم المختلفة وتبادلها، وفى دورات المناخ الفصلية وغير الفصلية، مما لا مجال لتفصيله هنا الآن. نخلص من كل ذلك إلى أنه لا يوجد تغيير بدون تعتيم يسبقه ، كما لا يوجد تعتيم إيجابىّ إلا تمهيدا لتغيير ما، وأن هذا هو ما يحدث فى “الأحوال الطبيعية” وفى هذه العجالة تستحيل الإحاطة بكل ما تطور من مفاهيم تكاد تقلب منظومة القيم التى شاعت حول اللفظين أو على الأقل تعيد ترتيبها أو تعيد صياغتها، كذلك فثمة إعادة نظر فى “إيقاع الحركة” و”طبيعة العلاقات”. لكل ذلك سوف يكون الطرح فى هذه المرحلة بمثابة خطوط عريضة لفروض بديلة، لعلها تثير حفزا للمراجعة المتأنية، حتى لو اهتزت منظومات قديمة. التغيير كشف عما تم أثناء التعتيم: إن مدخل فهم هذا التناوب الجارى على كل المستويات هو من خلال ما يسمى بالإيقاع الحيوى، ولكى نواكب دورات الطبيعة بفهم أعمق: ينبغى أن نعيد النظر ـ أساسا ـ فى مضمون “مفهوم “ما هو تغيير وما هو تعتيم، وما علاقتة كلٍّ بهذا الإيقاع فالشائع أن التغيير هو فعل إرادى أقرب إلى ما يشبه الثورة أو التجديد، وأن التعتيم هو نوع من التمويه والمناورة وأيضا يغلب على الظن - العام- أن التغيير هو ما نلاحظه أو نرصده فى وقت إعلانه، وأن التعتيم هو عملية سلبية تفتقر إلى فرص تجميع وحدات الوجود (والمعرفة) بعيدا عن الوعى قليلا أو كثيرا، وكل ذلك يشير إلى مفاهيم تحتاج إلى مراجعة والفروض البديلة التى تصاغ من مدخل الإيقاع الحيوى تقول: (1) إن التغيير الظاهرى ما هو إلا “كشف” لما تم قبله، بقدر ما هو إبداع ضام لوحدات تجمعت، هى التى سمحت بنقلة وُلافية نوعية. (2) وعلى ذلك فلكى يـَظهر (يعلن) التغيير فى الوقت المناسب، لابد وأن تسبقه عمليات شحن كافية، لا تجرى عادة إلا تحت مظلة درجة خافتة من الوعى (يمكن أن تعتبر تغييبا)، جنبا إلى جنب مع فرص تنظيم استيعاب مناسب لما يتم تجميعه، حتى إذا حان وقت إعلان النقلة من الكم إلى الكيف كانت الأبجدية المتراكمة جاهزة ومناسبة لصياغة الجملة الجديدة. الإيقاع الحيوى وحتمية التناوب: إن هذا الذى يحدث لا يتم من خلال المفهوم الأحادى البعد، الكمى التقدير، الخطى المسار، الاستقطابى التناقض، لكنه يتناوب مع/فى الزمن الذى يتشكل أبدا على إيقاع النبض الحيوى، وبعض مظاهر ذلك: (1) إن الظاهرة البشرية على كل مستوياتها (مثلها مثل أغلب الظواهر الطبيعية والكونية) هى ظاهرة إيقاعية فى جوهرها (والإيقاع هنا يعنى: الدورية والإعادة والإطلاق والتصعيد معا). (2) إن الطبيعة الإيقاعية للوجود البشرى راسخة وأساسية، سواء كان ذلك بطبيعتها أم أنها نتيجة تكيف الكيان الحيوى (البشرى ضمنا) على مدى القرون مع إيقاعية الكون أساسا (دورات الأفلاك التى أقرب مظاهرها: دوران الأرض، وتناوب الليل والنهار). (3) إن أظهر إيقاعات الطبيعة البشرية هو تناوب النوم واليقظة، ثم تناوب النوم الحالم والنوم الساكن، وفى الفسيولوجيا عامة تناوب أطوار دورة النبضة القلبية. (4) وعلى مستوى النمو الفردى فإن كثيرا من المدارس النفسية تتناول مسار النمو باعتباره، يتم فى دورات إيقاعية (إريك إريكسون – أوتو رانك – النظرية الإيقاعية التطورية:الرخاوي). وفى حالة النمو، ونشاط المخ، والتطور عامة، فإن الدورات ليست مغلقة تعيد نفسها حرفيا (مثل دورات القلب)، وإنما يتم التوليف النسبى فى كل دورة باستيعاب سابقتها، بحيث تنتهى كل دورة إلى مستوى من الوجود مختلف عن، و أعلى من، ومتقدم عن: سابـِـقـِـهِ. ولكى يتحقق ذلك بكفاءة مناسبة، فإن ما يتم من خلال فعلنة المعلومات Information Processing على المدى الطويل أثناء الكمون ظاهرا إنما يمثل ملء المخ بمفردات صالحة للتفاعل الولافى الخلاق، حتى إذاما حان دورالبسط للتغيير، سواء كان ذلك فى دورة نمو أو فى خبرة إبداع أو فى إنجاز ثورة، وجد المخ ما يخلق به المستوى الجديد، وهو ما يعلن معه ما يبدو باعتباره “تغييرا”. التغيير السلبى والتعتيم الهروبى: كل ما سبق هو الأرضية التى يمكن أن نفهم من خلالها كيف أن التغيير والتعتيم هما طورا الحركة المتبادلان فى دورات النمو والتطور عامة، وبالتالى كيف أن لهما دور إيجابى لا يمكن الاستغناء عنه، وهذا صحيح، لكن كلا من التغيير والتعتيم يمكن أن يكون سلبيا، وهذا ما يحدث فى ظروف النمو العسرة وفى الأمراض النفسية، كما ترجح كفة هذه السلبية بشكل أو بآخر فى المجتمعات المتخلفة، والمشوشة، والتابعة، والمطحونة. فكيف ذلك؟ يكون التغيير سلبيا حين يتم: (ا) تعسفا، أو (ب) متلاحقا، أو (جـ) مـفتعلا، أو (ء) تفكيكا إلى أدنى هذه هى المحكات التى يمكن أن نفرق بها بين: ما هو “مرض عقلى وما هو إبداع”، بين ما هو “ثورة وما هو انقلاب”، وأيضا بين “النبى والمتنبي”، وأخيرا بين “الحداثة وأدعياء الحداثة”. كذلك يكون التعتيم سلبيا حين يتم: (ا) بغرض الإخفاء لا التخفيف من حدة الوعى (ب) وحين يكون مدبرا من خارج لحساب الخارج، لا لإتاحة فرصة تنظيم الداخل. (جـ) وحين يمتد حتى يستديم، فيحول دون نقلة التغيير أصلا. (ء) وحين يسمى بعكسه، فالشفافية المعاصرة المنتقاة المزيفة هى تعتيم انتقائى بشكل أو بآخر. قيم جديدة، ولغة جديدة: إن المعروض من خلال إعادة النظر فى هذين البعدين ـ هكذا ـ هو أن نركز على النظر الأعمق فى نوع التغير، وليس فى مبدأ التغيير. وأيضا فى وظيفة التعتيم وليس فى المسارعة إلى شجب التعتيم. فالذى حدث مؤخرا فى صدمة الحاضر (وليس صدمة المستقبل بعد) أن كثيرا من المعلومات تكاثرت، والوصاية زادت، والحركة تداخلت، ومن ثم فلابد لنا من أن نضمن ألفاظنا القديمة مضامين جديدة، فتصبح كلمة “الثورة “- مثلا – ليست بمعنى النقلة الجماعية الإيجابية النوعية المركزة، وإنما تتحور لتعنى مدى نشاط حركية الوعى النشط المثابر الملتحم بوعى الجماعة فالكون، فيكتسب الموقف الثورى حيوية دائمة، ولا يقتصر على نقلة مفاجئة. ويجرنا هذا إلى احتمال وارد، وهو أن نكف عن استعمال الألفاظ القديمة ـ حتى لفظ الثورة ـ ما دامت لم تعد تحتوى معناها المألوف، وأن نبحث عن أبجدية أخرى ومناهج أخرى تسمح لنا أن نستوعب إحاطتنا بطبيعة حركة التطور، كما تصلنا أحدث فأحدث، ذلك أن إعادة النظر التى أدعو إليها قد تجعلنا لا نعود نصفق للتغيير لمجرد التغيير، أو نشجب التعتيم خوفا من الغموض والخداع للتسكين. إن النظر الموضوعى المواكب للغة العصر يقتضى الإلمام بالمحكات التى تميز الإيجابى عن السلبى، كما يلزم باتباع المنهج الذى يرجح الإيجابى على السلبى، فى كل من التغيير والتعتيم. إن الإنسان وقد امتلك إرادة أن يحسن الإنصات لإيقاع مسيرة الحياة بلغة موضوعية أفضل، قد أصبح عليه أن يواكب الطبيعة التطورية بترجيح إيجابية كل دور، فلا يعود يفرح بالتشنج سعيا للتغير، كما أنه لا يستطيع أن يبرر لنفسه أن يستسلم لليأس حين يضطر إلى التعتيم. لم يعد مناسبا-مثلا- أن نصفق كثيرا للموقف الذى صوّره لصلاح عبد الصبور وهو يعايرنا وينبهنا على لسان سعيد فى “ليلى والمجنون” أنه “..لن ينجيكم أن تندمجوا أو تندغموا حتى تتكون من أجسادكم المرتعدة كومة قاذورات” ثم يصيح بنا أن الحل هو أن ننفجر أو نموت، “فانفجروا أو موتوا، إنفجروا أو موتوا” لم يعد مناسبا أن نصفق لهذا الموقف الأشبه بخطب عبد الناصر أو كاسترو، هذا إذا كنا قد نضجنا حتى استطعنا أن نفهم كيف أن الانفجار والموت مترادفان بشكل أو بآخر. وأحسب كذلك أن هذه الرؤية المطروحة يمكن أن تنبهنا إلى تفسير انتقائى لبيتى شعر الشابى الشهيرين “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر” فالإرادة هنا هى إرادة الحياة لا إرادة التغيير، والاستجابة هنا توحى بامتلاك ناصية القدر وليس بافتعال قوانين خارجه، أما البيت الثانى، فإن بؤرة الانتباه-بالفهم الجديد-لابد وأن تنتقل من شطره الثانى “ولا بد للقيد أن ينكسر” إلى شطره الأول “ولا بد لليل أن ينجلى” لأن ذلك يبدو – من هذا المنطلق الجديد- أقرب إلى ما ذهبنا إليه هنا من أن التغيير يتم بمواكبة الإيقاع الحيوى، وليس بمجرد الفعل الإرادى الظاهر المحدود، كما نلمح فى الشطر الثانى. إعادة صياغة: من كل ما سبق يمكن إعادة صياغة الخطوط الأساسية للقضية كالتالى: 1- إن إرادة التغيير هى العمل على الحصول على مقوماته، للامتلاء بأبجديته، واستيعاب وحدات العمل الصالح لإتمامه. 2- إن فعل التغيير جار طول الوقت، سواء منه ما يجرى تحت ستار ما يسمى التعتيم، أو ما يرتبط بما نعيه إراديا بشكل مباشر نطلق عليه دون غيره لفظ “التغيير”. 3- إن التعتيم المناسب طور لازم فى حركية الإيقاع الحيوى (المتناوب أبدا). 4- إن ثمة أوقات وظروف ومراحل يصبح فيها التغيير الإرادى الحاسم والحاد بلا بديل، ولكنه لا ينجح أو يستمر إلا إذا كان قد أُعـِد له بما ينبغى، وهذه الأوقات والفرص لم تعد بنفس الإلحاح كما كانت فى الماضى، كما لم يعد لها نفس البريق السابق. 5- إن ثمة مناطق فى المعرفة والوعى بالوجود وبالكون تتطلب درجة ما من التعتيم المناسب، ومن أهمهما ما يتعلق بماهية الروح مثلا، وربما بمعالم الذات الإلهية، وهو تعتيم نوعى يسمح بإدراك من نوع آخر حتى يمكن أن يسمى “التعتيم المعرفى”. 6- إن أيا من التعتيم والتغيير قد يتم بفعل فاعل، لينحرف عن مساره الطبيعى: فمثلا قد يكون الحفز إلى التغيير من فعل المخابرات الأمريكية، كما قد يكون التمادى فى التعتيم هو بهدف محو الهوية القومية للشعوب التابعة. خلاصة القول: أولا: إن “التعتيم” الإيجابى هو “تغيير” مؤجل. ثانيا: إن ما يسمى التغيير هو “كشف” لنهاية مرحلة متصلة ، وهو يعلن الوعى بالنقلة الكيفية أكثر منه إعلان تفاصيل عملية منقطعة عما قبلها. ثالثا: إن الاستسلام للتعتيم والتأجيل إلى أجل غير محدد، هو مناورة خطرة ينبغى أن تكون موضع اختبار حذر، ومراجعة طول الوقت. رابعا: إن اليأس فى فترات الكمون (تعتيما) هو المسئول عن توقف الفعل التحضيرى، ومن ثم تراجع المسار أو التمهيد لتغيير سلبى عشوائى. خامسا: إن العامل الأساسى فى ترجيح احتمال التطور دون الانقراض هو: (1) مواصلة الإعداد. و(2) حسن التوقيت . بديلا عن: (1) فرط الحماس . و(2) إجهاض دورات النضج. وبعـد فمن حق قارىء هذه المـداخله أن يساوره الشك فى أن الأخذ بفروضها يمكن أن يهمد زخم الثورة فينا، وأن يسهل على أصحاب الغرض ممن يملكون مقاليد التوجيه والتشكيل بالوسائل الأحدث، يسهل “عليهم” تنويمنا وخداعنا إلى ما لا نهاية. ليكن، فإذا كان ولابد، فلتأت نهايتنا ـ فنهايتهم ـ ونحن على وعى بلغة العصر، أفضل من أن تأتى نتيجة لأوهام الفعل وتشنجات الاختلاف ظاهريا. إن الإنسان قد أثبت عبر تاريخه – حتى الآن – أنه قادر على استيعاب تحديات الانقراض، وأحسب أننا بتفهمنا لقوانين التطور وحسن مواكبتها، برفض اليأس، لا يكون أمامنا إلا استيعاب نبض الحياة: كل دور بلغتة. وهكذا لا نقع فى مصيدة تغيير زائف، ولا نستسلم ـ يأسا ـ لمناورات تعتيم دائم. **** [1] – مجلة سطور: (عدد يوليو – 1999) مقدمة: – 1 – لست متأكدا من أين نبدأ ونحن نحاول استعادة حضور أجسادنا فى بؤرة وجودنا الفاعل، ولا أجد فى نفسى رغبة، ولا قدرة، على استعراض ما آل إليه موقع الجسد فى وجودنا المعاصر، الأمر الذى تأكد وظهر وتناولته الأقلام والعقول بما يكفى، وعلى الرغم من ذلك فلا مفر من التذكرة – كمقدمة- بأمثلة دالة على ما آل إليه الحال فيما يتعلق بعلاقة الإنسان المعاصر بجسده كما يلى: أولا: إهمال الجسد، أو تهميشة، لحساب ما يسمى العقل. ثانيا: احتقار الجسد، أو ازدرائه، لحساب ما يسمى الروح. ثالثا: استعمال الجسد منفصلا: (أ) كأداة للذة (للشبع، والجنس خاصة) (ب) كأداة للزينة (فى التجمل والتلميع، والزينة... الخ) (جـ) كمجال للتسويق (للوفاء باستعمالات “أ” & “ب”) (د) كأداة فى سـعار التنافس (ألعاب القوى ومثلها) رابعا: اعتبار الجسد سلعة ينبغى الاهتمام بزيادة عمرها الافتراضى (بالعناية بالصحة، ومقاومة التلوث مثلا) بغض النظر عما تحتويه، هذه السلعة، أو تــُـحـَـسَّن من أجـلـه وبناء على ذلك، فقد تحولت الحياة إلى تجريد مـعقلن ملفظـن، حلَّ محل كلية الوجود، مع نـَـفـْى الجسد، الأمر الذى ترتب عليه كثير مما نعانى حالا، وربما مستقبلا. -2- قبل أن نحاول النظر فى إمكانية رجوع الجسد إلى موقعه المحورى فى الوجود، بجدر بنا أن نمر سريعا على بعض حقائق قديمة/حديثة، كمدخل للمسألة، إذ لا يكفى أن نعلن مع نيتشه موقع الجسد “فى بؤرة العالم”، ونحن لا نعرف كيف السبيل إلى ذلك، ولا ماذا بعد ذلك. العجيب أن من أهم العلوم التى ساهمت فى غربة الجسد وفصله عن الوجود علوما كانت منوطة أصلا بالتأكيد على دوره ومحوريته، وأعنى – فى حدود تخصصي- علم الطب (والطب النفسى ضمنا)، وعلم النفس (الحديث خاصة، أو المسمى كذلك)، فقد آل موقع الجسد من خلال تحيز هذين العلمين- بحثا وممارسة- إلى ما ذكرنا من غربة أو اختزال أو تهميش. ويبدو أن ذلك قد تم من خلال سبل مختلفة أدت إلى نفس النتيجة، ومن ذلك: (1) إهمال دراسة الوعى الإنسانى، إما بتجنب ذلك مباشرة، أو بالاقتصار على تحديد نشاط ما هو وعى فى حدود نشاط اليقظة والنوم أو بتحديد مناطق دماغية عصبية بذاتها، مكلفة بالحفاظ على تناوب الانتباه مع الغفلة، وقد ترتب على ذلك إهمال دراسة الجسد باعتباره “وعيا متعينا” (أنظر بعد). (2) التركيز على دراسة الجسد باعتباره أعضاء وأجهزة ووصلات يصدر عنها سلوك وحركات، وقد ظهر ذلك بشكل صارخ فى تجارب الحيوان بوجه خاص، ثم فى تعميم ذلك على الإنسان بشكل بدائى قاصر. (3) اختزال الجسد إلى وحداته الأولية، من كيمياء وخلايا ومشتبكات، تتأثر كميا، بزيادة هذه المادة، أو نقصان ذلك المركب، (الأمر الذى نشطت فى اتجاهه شركات الدواء بشكل مفرط، لأغراض تجارية بحتة). (4) فصل الدماغ (المخ) عن الجسد فصلا فوقيا، باعتبار أن الجسد هو تابع منفذ لنشاط المخ، وليس فاعلا مشاركا فى وظائف الوجود. (5) إهمال تعميق العلاقة المركبة بين الوحدة التى يتكون منها الجسد (والإنسان) أى الخلايا المبرمجة أنويتها تاريخا وحاضرا، وبين كـلية تجلى الجسد فى واحدية الوجود. وقد كانت نتيجة كل ذلك، وغيره، أن تراجع حضور الجسد عن بؤرة الاهتمام فيما يخص التنظير والممارسة والعلاج جميعا. -3- ثم نستعرض بعض أساسيات علاقة الجسد ببعض المحاور، مرة أخرى كأمثلة – فى حدود المساحة المتاحة - تمهيدا لتبرير الدعوة إلى استرجاع موقعه المحورى بما قد يهدى إلى معالم الطريق إلى ذلك. أولا: الجسد منظومة “وعى متعين”: تـُـركـِّـز بعض اتجاهات الدعوة إلى استرجاع دور الجسد حول فكرة “الوعى بالجسد”، كما تشير اتجاهات أخرى إلى دور الجسد باعتباره أحد مجالات “تجليات الوعى”. ونحن نرى أن كلا المنطقين ليسا كافيين لتحقيق هذه الغاية الصعبة، وخاصة النظر إلى ما آل إليه نفى الجسد وتغريبه، بل إن المغالاة فى دور “الوعى بالجسد”، أو فى التأكيد على “الجسد كمجال للوعي”، قد تؤدى فى النهاية إلى مزيد من الإنشقاق بشكل أو بآخر. أحسب أنه غنى عن البيان أن نتذكر أن كلمة الوعى لا تعنى اليقظة (فى مقابل النوم) كما أنها لا تعنى الوعى الإدراكى الـظاهر (الفرويدى مثلا فى مقابل اللاوعي)، وإنما هى تشير إلى منظومات مشتبكية الوجود الحيوى إذ يتجلى فى تركيبات محددة، جدلية أو تبادلية، أو كليهما، حسب الموقف والسياق الآنى، وعلى ذلك يكون الوعى بالجسد هو مجرد تذكرة جزئية بأهمية الجسد، وليس كافيا للإحاطة بما هو ذاته، ولا هو وسيلة لاسترجاع دوره، بل إن التدريبات الجشتالتية الخاصة بتنمية الوعى بالجسد، وبالحركة (والتى لها مكافئاتها فى بعض ممارسات التأمل، واليوجا، وبعض الديانات السماوية وغير السماوية)، لا تفى بغرضها إلا إذا كانت خطوة تعويضية مؤقتة تهدف إلى تكامل تلقائى بعيدا عن هذا التركيز الواعى، فالإفراط فى الوعى بالجسد مثله مثل الإفراط فى الوعى بعملية التفكير أو حتى بالعمليات الفسيولوجية التلقائية، كل ذلك هو نوع من الاستبطان المعطـِّـل، وهو يعمق الانشقاق ثمنا باهظا لعقلنة استكشاف موضوعاته، وقد يصل الأمر إلى تشويه سلاسة حركية الوجود. وعلى الجانب الآخر فإن اعتبار الجسد مجرد مجال لتجليات الوعى يتضمن – بشكل أو بآخر – استعمال الجسد كوعاء أو كأداة لغيره، وهو الأمر الذى نبهنا إلى مخاطره منذ البداية. خلاصة القول: إنه لا يمكن أن يعود الجسد إلى تكامله فى واحدية الوجود إلا باعتباره هو ذاته منظومة “وعى متعين” Concretized Consciousnessلها حضورها المستقل فى سياق بذاته، بقدر ما لها حركيتها الجدلية المستمرة مع سائر منظومات الوعى بالمضمون الأشمل السالف الذكر. ثانيا: المخ (الدماغ) يتجلى فى الجسد ولنأخذ مثالا واحدا لذلك، وهو تجليات الذاكرة فى الجسد. من قديم، وموضوع تحديد مركز للذاكرة فى خلايا المخ هو أمر مطروح للنقاش والمراجعة، ومنذ وضع لاشلى القانون المسمى “قانون الكتلة الفاعلة” (سنة 1937) والذاكرة ترفض أن يـحـدد لها مركز خاص، أو بتعبيرات أدق: مخزن خاص، فالذاكرة ليست – كما نبسـطها للمبتديء – مثل مخزن له سعة ومفتاح وأمين مخزن وأدوات تنظيم ومفاتيح استدعاء، لكنها حضور ممتد منظم متراكم متداخل متعدد فى “أغلب”، إن لم يكن فى “كل”، أجزاء المخ، صحيح أن هناك مراكز (مثل الجهاز الحوفى Limbie system) تعتبر أساسية لاستقبال وتسجيل وتمرير المعلومات إلى ما هو ذاكرة، إلا أنه متى تم ذلك فإنه لا يمكن تحديد منطقة بذاتها مختصة بذكريات بذاتها، أو بالذكريات عموما. وانطلاقا من هذه العمومية، وامتدادا من الذاكرة التحصيلية إلى الذاكرة الوراثية، تحتم فتح ملف الجسد كمشارك فاعل فى كل ما هو ذاكرة. فهل توجد أدلة على أن الجسد هو – أيضا عضو ذاكرة فى ذاته؟ إليكم بعض أمثلة من حالات من واقع الممارسة: أ- فى دراسة لحالة تعدد الشخصية، سجلت مريضة كان والدها يعذبها (ضرار الطفولة (Abuse بحرق أجزاء فى جسدها، فلوحظ أن هذه المريضة يظهر على جلدها مباشرة آثار نفس الحروق فى نفس المواضع السابقة بمجرد أن تتحول إلى الشخصية الطفلية المنشقة (أثناء العلاج أو أثناء النوبات). ب- فى حالة أخرى لرجل فى منتصف العمر كان يعانى من نوبات السير أثناء النوم (السرنمة) Somnanbulism بشكل يعرضه للخطر، مما اضطر الأهل إلى ربط يديه وقدميه فى بداية شدة الحالة، فكانت إذا جاءته النوبة قام محاولا فك قيده بالقوة حتى حدثت رضوض وسجحات فى رسـغيه وساقية، ثم لجأ الأهل بعد ذلك إلى احتياطات أخرى أغنتهم عن هذا التربيط حتى زالت كل آثاره، إلا أن المريض حين عاودته الحالة، راح يقاوم قيودا وهمية، ورباطا خانقا (غير موجود) فى كل بداية لنوبة “السرنمة”، وإذا بنفس الكدمات والسجحات تظهر فى نفس المواضع (بلا وجود لأية قيود أصلا). جـ- ولا تقتصر هذه الملاحظات على المرضى، بل إنها تمتد إلى حالات الأسوياء، مثلا: فى حالة المسيحيين الذين تظهر على أجسادهم فى مواقع صلب المسيح فى المناسبات الدينية نفس علامات الصلب من كدمات وسجحات. ولكن كل هذا لا يعنى الزعم بأن الجسد – مستقلا – يحتفظ بالذكريات، لكنه يشير إلى كيف تنطبع آثار ذكريات بذاتها فى خلاياه، وكيف يستعيدها ذكرى مجسدة بكل مظاهرها السابقة. الذاكرة الجينية: منذ اختلاف اللاماركيين مع الدارونيين المحدثين، والتساؤل يتردد حول علاقة “دنا”DNA خلايا المخ بدنا الخلايا التناسلية، وهذا التساؤل مرتبط أصلا بإشكالة الجدل حول وراثة العادات المكتسبة، الأمر الذى حسم مؤخرا لصالح هذا الاحتمال، ولكن لنبدأ من البداية. يبدأ الجسد – بل الوجود – كتنظيم مبرمج فى الجينيات التناسلية، وبالتالى فإن تشكيل الجسد بصفة عامة، مورفولوجيا، هو موجود فى الجين منذ البداية، وهذه الحقيقة القديمة جدا، الحديثة جدا، ينبغى أن تنبهنا إلى عدة أمور: أولاً: اتصال خلايا المخ بما ينطبع فيها من سلوك بالخلايا التناسلية اتصالا يصل إلى درجة قصوى تسمح بنقل كل هذه السمات. ثانيا: حسم مسألة انتقال نوع من السلوك المكتسب إلى الأجيال اللاحقة عن طريق تعديل هذا البرنامج. وما يهمنا فى هذه النقطة يحتاج إلى تفصيل طويل للتأكيد على أن أى تعديل غائر فى برمجة الجينيات، إنما يتردد فى جينات الجسد كله، وأهم ذلك فى جينات الخلايا التناسلية، دون استبعاد سائر الجسد. ويختلف هذا التأثير شدة وغورا وثباتا باختلاف دلالة السلوك التطورية، وتثبيتاته النفسية، ومدى تمثله وتحويره. والفرض الذى سنعود إليه من هذا المنطلق هو ترجيح احتمال العكس، أى أن ما يحدث فى الجسد ابتداء يمكن أن يتردد بدوره فى خلايا المخ بشكل أو بآخر. ثالثا: الجسد فى المخ: إذا كانت الذاكرة التى تتمركز فى المخ ابتداء تتجلى مظاهرها فى الجسد كما أسلفنا، فهل للجسد حضور فى المخ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من أن نعرج إلى ما يسمى صورة الجسد Body Image وأيضا مخطط الجسدBody Schema والأولى (الصورة)، تشير إلى تصور ظاهر أو كامن لما هو جسم الفرد، وهذا ليس له تحديد بيولوجى ثابت كما أن له ظروف فى تكوينه وتأثيره تختلف تماما عن ما يسمى “مخطط الجسم” الذى يتكون تلقائيا بعد الولادة مباشرة، ويمثل تكامل التفاعل بين جميع الشكليات الحسية المستـُـقـْـبـَـلة من العالم الخارجى عن طريق الحواس خاصة، خارجية وداخلية، وما يهمنا فيما يتعلق بموضوع هذا المقال هو أن هذا المخطط هو تنظيم نيورونى خلوى مشتبكى، وليس صورة ذهنية أو متخيلة بعيدة عن برمجة نيورونات بذاتها. وبالتركيز على دور مخطط الجسد أكثر من صورة الجسم، مع تصور احتمال تغيـره بتغير ما يحدث فى الجسم، يمكن أن نقترب من التوضيح الفرضى القائل: إن الأفكار والمعتقدات والسمات يمكن أن تتحرك، بل تتغير من خلال مشاركة الجسد الحيوية. وهذا هو المنطلق الذى سبق وتناوله كاتب هذا المقال فى اعتبار الجسد عضو من أعضاء التفكير والإبداع والإيمان جميعا([2]) خلاصة ونهاية مفتوحة ونكتفى بهذا القدر من الإشارات لإثبات أحقية الفروض التالية بالعناية، إذا كان لنا أن نستعيد موقع الجسد فى الإسهام فى واحدية الوجود البشرى وتكامله. أولا: إن الجسد هو وعى متعين وهو كيان متكامل مع كل أجزائه (بما فى ذلك الدماغ/المخ)، وفى نفس الوقت فإن له تجلياته التى تبدو وكأنها مستقلة (مثل النفس والروح)، الأمر الذى لا ينبغى أن نتمادى فى النظر فيه من منطلق استقطابى. ثانيا: إن الوعى بالجسد ليس هو السبيل إلى استعادة دوره، وإن كان الوعى بأهمية دوره هو السبيل لإطلاق قدراته كوعى متعين مساهم فى تكامل مستويات الوعى. ثالثا: إن فرط التجريد وفرط العقلنة (وهم بعض مظاهر ما يسمى بأزمة المثقفين) مسئولان عن اغتراب الجسد مهما أفاضا فى الحديث عنه. رابعا: إن اختفاء الجسد الفرد – بالموت أساسا – لا ينهى دور هذا الجسد فى انطباعاته الفيزيقية: فى أجساد الآخرين، وأنغام الكون، الأمر الذى قد يكون مدخلا لتفسير كثير من الظواهر الفيزيقية التى يحاولون بها إثبات بعض الملاحظات فى أنشطة بعض ملاحظات علم الباراسيكولوجى. خامسا: إن مراجع بأكملها كتبت فى التأكيد على دور الجسد فى التفكير والإبداع مثل كتاب”Philosophy in the Flesh” By George Lakoff سادسا: إن شهادة بعض المبدعين – بما فيهم إينشتاين – يؤكد على مشاركة الجسد فى التفكير الإبداعى فهو الذى يقول: “…إن الألفاظ كما تستعمل فى اللغة المكتوبة أو المنطوقة لاتقوم بأى دور فى ميكانزمات تفكيره، وإنما تبدأ عملياته المعرفية بصورة بصرية وعضلية، ثم تتدخل الكلمات بعد ذلك فى شكل سمعى”، ويضيف: “… إنه يستطيع أن يسترجع بإرادته هذه الصور وأن يؤلف بينها…” خاتمة: إن استعادة دور الجسد لا يتم بالتنظير حوله - مثل كتابة هذه المداخل – أو التركيز عليه، وإنما ينبغى النظر إلى تحديد إمكانية تغيير أسلوب الحياة، فى الحركة والحس والتواصل والجنس والعلاقة بالطبيعة، ليعود للجسد دوره المحورى فى تناسق الوجود البشرى مع بعضنا البعض، ومع امتداداته فى الطبيعة والكون. إن خطر انفصالنا عن أجسانا يتمادى بفرط جلوسنا إلى المكاتب، واستعمالنا الحروف بدل العضلات، ومؤخرا استعمالنا الجنس الالكترونى والهاتفى بدل حوار التحام ومواجهة الأجساد. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد سبتمبر – 1999) المقال يناقش موقع الجسد فى الوجود البشرى (المعاصر) وكيف أنه استبعد إلا كأداة للذة أو مجال للتسويق أو ديكور للزينة والمقال يقدم الجسد باعتباره “وعيا متعيناً” هو بؤرة الوجود بشكل أو بآخر، وبعد تعداد وسائل اهمال وتهميش واختزال الجسد فى معظم العلوم بما فى ذلك الطب النفسى، وعلم النفس، يشير المقال إلى الجسد إلى الذكرة وعلاقة الجسد بالعقل والمخ، وبالعكس، وأن محوريته فى الوجود يمكن أن تنفى اختفاءه بالموت مشيرا إلى فرض تحلل موجاته لتتطبع فى أجساد الأحياء بشكل ما. [2]– يحيى الرخاوى: “مراجعات فى لغات المعرفة: – المعرفة والجسد” سلسلة “اقرأ” العدد: 62 – دار المعارف (ص 104 – ص 126)، سنة 1997 . أصول المسألة: على مدى التاريخ الحيوى ظل الكائن الحى يندفع إلى الهرب فى مواجهة الخطر، وحين أصيب الانسان بمحنة الوعى من ناحية، وبالوجود المتعدد التركيب من ناحية أخرى، لم يعد الهرب مجرد سلوك دفاعى معلن، وإنما صار الوعى به، والاستعداد له، وتحسـب ظهوره من أهم ما يميز الوجدان البشرى، وهذا هو ما يسمى الخوف. وقد زاد الأمر تعقيدا كما يلى: أولا: أصبح مصدر الخطر غير قاصر على الخارج، بل امتد إلى داخل الذات. ثانيا: أصبح توقع الخطر يمثل نفس التهديد الذى يحدثه مثول الخطر فى اللحظة الراهنة. ثالثا: تعدى الوعى بالخطر، والوعى بضرورة الهرب، حجم الخطر الموضوعى، ليصل أحيانا إلى درجة معوقة، أو مؤلمة، أو مفسِّخة، بما لا يتناسب مع مصدر وحجم الخطر داخلا وخارجا. وهكذا يمكن تعريف الخوف بأنه: تفاعل وجدانى يعلن الوعى بالعجز، أو احتمال العجز، أو ترجيح العجز، فى مواجهة خطر ما. ويرجع ذلك عادة إلى إدراك ترجيح عدم التناسب بين القدرة (الحقيقية أو المتخلية) وبين متطلبات مواجهة الخطر أو التهديد به. كما يمكن أن يرجع ـ مؤخرا- إلى الوعى بعدم التناسب بين كم المعلومات الحاضرة أو المتاحة، وبين القدرة على الإحاطة بها والتمكن من استعمالها لدرء الخطر. ويختلف الخوف حسب ما يتعلق به: فثمَّ خوف “من”، وثمَّ خوف “علي”، وأيضا ثمَّ خوف “أن”: وأخيرا ثمَّ خوف فقط: تختلط فيه “مـن” “وعـلـي” و ”أن”، وغير ذلك. ولا يمكن فصل الخوف بذاته لذاته عن مشاعر أخرى متداخله ومتفاعله مثل مشاعر القلق (الذى هو نوع من الخوف الداخلى فى النهاية) أو الربكة أو الحيرة أو فرط الدهشة المزعجة أحيانا. وأيضا لا يمكن إنكار الخوف الكامن تحت ما ينفيه أو يخفيه مثل: ظاهر التبلد أو الإقدام المندفع فى نزوة غير محسوبة، حيث يبدو التصرف عكس الهرب، وبلا خوف ظاهر، مع أنه هو هو. لكل هنا الاتساع فسوف نقصر الحديث على “الوعى بالخطر غير المتناسب مع تقييم القدرة الذاتية”، (مرة أخرى: الحقيقية، أو المتخيلة). من هذا المنطلق يمكن القول إن الخوف هو حقيقة إنسانية لا مفر من الاعتراف بها، وهو مظهر من مظاهر روعة النقص البشرى فى مواجهة اتساع آفاق الغيب، وتعدد تشكيلات المجهول، فضلا عن ترامى وتزايد كم المعلومات باضطراد غير مسبوق. فهل يليق ـ والوضع كذلك ـ بالطب النفسى خاصة، وعلم النفس ضمنا ـ أن يروج للدعوة إلى تجنبه أبدا، وحتما، وفورا وبأقصى سرعة؟ وحتى لا نظلم الطب النفسى (وعلم النفس) فإن أيا منهما لم يعتبر الخوف مرضا إلا إذا أشقى صاحبه به، أو أعاقة عن أداء مهام حياته، هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع وكيف يتناول الأطباء والمعالجون، وكذلك وسائل الإعلام والدراما مسألة الخوف، فهذا أمر آخر. جذور وعمومية الخوف: لا أحد يمكن أن يزعم أن الحياة كانت سكونا فى يوم من الأيام، حتى ما قبل الحياة، كان فهو حركة دائبة بقوانين أخرى، ثم إن النقلة المفترضة من اللاحياة إلى الحياة بدءا من تحرك أصل بللورات “الدنا” DNA إلى ما يشبه الفيروس إنما ترجعنا إلى ربط الحركة بالحياة كأساس للتطور الحيوى، وحين تنامى التطور حتى ظهور الوعى البشرى أصبح مجرد الوعى بالحركة نحو المجهول (الخطوة التالية) هو المهدد الأعظم المصاحب للتقدم نموا أو إبداعا، ومن ثم ظهر الخوف فى صورته البشرية، دون أن يتخلى عن جذوره البيولوجية التاريخية، وحين يبلغ الخوف من الحركة أقصى مداه يصبح الدفاع الجاهز هو أن يتجمد الوجود الحيوى، وهذا ما كانت تلجأ إليه الفريسة أمام الحيوان المفترس فى الغابة، حيث يصبح التجمد والسكون وكذا تغير اللون لتتشابه الفريسة مع ما حولها يصبح هذا وذاك هما الوسيلة للحماية من المهاجم المفترس. وبتأمل هذا التجمد الساكن والتماثل مع الطبيعة المحيطة فى مواجهة الخطر ندرك أنه فى مثل هذه اللحظة تصبح مجرد الحركة هى الخطر الأكبر الذى يمكن أن يعرض الكائن للهلاك، وقد نجد مثل هذا التفاعل فى الإنسان فى أحوال الرعب المجمد (لدرجة التصلب الكاتاتونى فى الأحوال المرضية)، وقد وصل تقمصى لأحد أصدقائى المرضى فى هذا الموقف أن وصفت حالة الخوف الذى جمدتـه كما يلى: أخاف من أن تموج الأحشاء، من دورة الدماء، من نثرة الأجنة، أخاف همس الطير أخاف من نسائم الصباح من خيط فجر كاذبٍ، أو صادقِ من زحف ليل صامتٍ، أو صاخبِ ومن حفيف ثوبـى الخشن ويصل الخوف إلى مداه حين يتعمق إلى الخوف حتى من حركة ما قبل الحياة أخاف من تناثر الذرات فى مدارها أخاف من سكونها وحين يصل الخوف من الحركة إلى الخوف من السكون، يكون “الوعى بالسكون” قد وصل إلى اعتبار أنه حركة كامنة على وشك الانطلاق، فالوعى بتبادل الحركة والسكون يلغى الأمان الكاذب الذى يلوح به السكون. وبالنسبة للوعى البشرى لا يكون الخوف من مجرد إغارة “الآخر” المفترس مثلما هو الحال فى قانون الغابة، ولكن تتخذ الإغارة أشكالا متعددة، مثل الإهانة، والإغفال، والإنكار، والنفى، وكل ذلك يقابـل بالانسحاب المتجمد، ثم بالخوف من فك هذا التجمد خشية أن تعود الإهانة والإغفال، ويصبح التجمد كأنه موت اختيارى، يلغى المشاعر فى مواجهة الإهانة والإهمال. أخاف لاحراك، موت تمطى فى تجلط الدماء ، فى مأتم الإباء والشائع عن الخوف من الموت يقابله وهم أن الحل هو نفى الموت، بأحلام الخلود، وهذا الوهم ـ وهم الخلود ـ هو الذى ضربه نجيب محفوظ بلا هوادة فى ملحمة الحرافيش بوجه خاص، وحين يحتد الوعى البشرى فى مواجهة خطر الموت ينفى الحياة أصلا قبل أن ينفيها الموت، وحتى حين يحلم الإنسان بوهم الخلود فإنه يدرك فى مستوى أعمق من الوعى، أن الخلود سكون ممل، هو بالعدم أشبه. أخاف أن أموت إن حييت أخاف إن حييت لا أموت وهكذا يتساوى الخوف من الموت ومن الحياة ليصبح هو العدم الدفاعى، الذى يلغى الوعى بكليهما، ويتجلى العدم فى حياتنا المعاصرة فى كل مظاهر الاغتراب والوجود الزائف. رحلات الداخل والخارج، وإسقاط الخوف: ذكرنا فيما سبق أن ظهور الخوف ارتبط بظهور الوعى، فأصبح الكائن الحى الواعى يتحرك من النظر إلى الداخل المجهول المهدد، إلى النظر إلى الخارج المزدحم الملاحق، ومع أن الداخل يكون أخطر عادة باعتباره مجهولا من جهه، ودائم الحضور من جهة أخرى، إلا أن الكائن البشرى يفضل توجيه هذا الشعور (الخوف) إلى ما يظهر له فى الخارج بديلا عن مواجهة خطر الداخل، ويبدو ذلك فى مظاهر دفاعات “الإسقاط” و”الإبدال” و”الإزاحة” التى تصل فى حدتها المرضية إلى ما يسمى الـرهابPhobia الذى تتعدد أنواعه مثل رهاب الانفراد (المشى وحيدا) أو رهاب التشتت (الخوف من الأماكن غير المحدودة، مثل الميادين) أو رهاب الازدحام والخوف من الناس، أو رهاب الأماكن المغلقة، أو رهاب الأماكن المرتفعة، كل ذلك يعلن مظهرا من مظاهر إسقاط الخوف من الداخل وتحويله إلى الشعور بالخطر الخارجى الذى يعتبر قابلا للتعامل ولو بإعلان الخوف منه، وحتى لا أطيل فى هذا الاستطراد أكتفى بعرض تقمص آخر لبعض مرضاى تعبيرا عن هذا التنوع الدفاعى فى تشكيلات إسقاط الخوف إلى الخارج. فى الداخل كهف الظلمـة، والمجهول وتفتيت الذره والخارج خطر داهم، يبدو أن الرعب من الخارج أرحم، شيء ألمسه بيدى، يلهينى عن هول الحق العارى، عن رؤية ذاتى، أفليس الخارج أقرب، والخوف عليـه، أو منه، يبدو أعقل؟ أخشى أن أمشى وحدي حتى لا تخطف رأسى الحدأة. أما بين الناس: فالرعب الأكبر: أن تسحقنى أجسادهم المنبعجة، اللزجة والممتزجة. أخشى أن يـغـلـق خلفى الباب ، أو أن يفتح: فالباب المقفول هو القبر أو الرحم أو السجن والباب المفتوح يذيع السر، أخشى أن أنظر من حالق، أو أن يأكل جسمى المرض الأسود، أو أن أقضـىَ فجأة، أو أتناثر لكن الأمر لا ينتهى عند هذا الحد، فكل هذه الدفاعات (الميكانزمات) الإسقاطية هى حل جزئى فى مواجهة الخوف من الداخل الذى هو أكبر ما يتميز به الإنسان فى هذه القضية، فحين تعجز هذه الحيل (الدفاعات ـ الميكانزمات) أن تحافظ على التوازن (ولو كان توازنا مرضيا)، ينتقل الخوف إلى ما هو أرعب: إلى مواجهة الداخل عاريا بكل غموضة، وقوانينه الخاصة، وتهديداته، وهذا ما شرحه المقطع التالى امتدادا فى التقمص. لم يعد الرعب من الخارج يكفى أن ينسينى الداخل فاقتربت نفسى منها حتى كدت أراها: الظلمة والمجهول وتفتيت الذرة، والسرداب المسحور وما قبل الفكرة، والطفل المقسوم إلى نصفين ينتظر سليمان وعدله. ويصل الرعب من مواجهة الداخل واحتمال التناثر مبلغا يتجلى فى مظاهر تسليم وتفكيك “ذهانى” لا مجال لتفصيله حالاً. الخوف من الآخر، الخوف من الحب وفى حالة الكائن البشرى لا يقتصر مصدر الخطر على كيان مهاجم مفترس فحسب، وإنما يمتد إلى أشكال أعقد وأعمق سوف نكتفى بعرض ما يخص الكائن البشرى تحديداً، وأعنى: إشكالة الخوف من الآخر، والخوف من الحب، والخوف من الأخذ. فبقدر ما أصبح الوعى البشرى تحدّيـًا يعلن مواكبة المعرفة بالفعل، أصبحت العلاقة بالآخر تحدّيـًا فى حالة اختبار متصل، ولم يعد يكفى أن تقول إن الآخر هو الجحيم (من ناحية) أو أنه لاغنى عنه حتى الذوبان فيه (من ناحية أخري). ذلك أنه لمـا وصل وعى الانسان إلى أنه لا مفر من المخاطرة بالاعتراف بالخروج من الرحم، راح يحن إلى العودة إليه (إلى الرحم)، وفى نفس الوقت إلى الحرص على الحفاظ على نفسه خارجه، وذلك بإرساء علاقة موضوعية مع كيان بشرى “آخر” يعايش نفس التحدى، من هنا بدأت تجليات إشكالة الوعى بالآخر وما يصاحبها من إقدام وإحجام وخوف نوعى مختلف. وخطر “الآخر” يكمن فى الاستسلام لأمان غير مضمون من ناحية، وفى التهديد بالالتهام أو الاستعمال، ومن ثم المحو من ناحية أخرى، وعلى عكس ما يتصور الناس فإن إرساء علاقة بالآخر من موقع العطاء (والإيثار والمساعدة معا) لهو أخف وآمن من إرساء علاقة حقيقية تحتمل الأخذ والعطاء، فالخوف من الأخذ، أو بتعبير أدق الخوف من “الوعى بالأخذ” يمثل جانبا من أهم ما يحول دون جدل العلاقة بالآخر بشكل يسمح بتنامى مسيرة النمو، وسوف اكتفى هنا بالإشارة إلى الخوف من الاقتراب، ومن ثم من الوعى بالضعف أثناء فعل الأخذ، فى مقابل ذلك: الخوف من الابتعاد حتى لا نقع فى هوة الوحدة. ويتناسب الخوف من الاقتراب مع الخوف من التسليم بالأمان، وكلما زاد احتمال الطمأنينة إلى حق الاعتماد المصاحـب باحتمال التخلـى، تحفز الخوف دافعا للابتعاد والحذر، كما يبدو من هذا النص الآخر: يا من تغرينى بحنان صادق، فلتحذر: فبقدر شعورى بحنانك سوف يكون دفاعى عن حقى فى الغوص إلى جوف الكهف. وبقدر شعورى بحنانك، سوف يكون هجومى لأشوه كل الحب وكل الصدق. فلتحذر، إذ فى الداخل، وحش سلبى متحفز، فى صورة طفل جوعان. وفى نفس الوقت، فإن الوعى البشرى على يقين من أن دوام تجنب “خطر الآخر” (متضمنا خطر الحب)، لا يحل الإشكال، بل يكاد ينفى ما يتميز به الإنسان من كونه “كيان مع…”، بل إنه ينفى الحياة ذاتها. لكن ماذا يغرينى فى جوف الكهف؟ وصقيع الوحدة يعنى الموت؟ وهذا ما يشير إلى الخوف من الإنكار ـ والترك (التخلي) لو عـرّض الفرد نفسه لعمل علاقة بالآخر، فهى الوحدة. ومع كل هذا فالإنسان لا يقبل فى عمق إنسانيته بعدمية الوحدة وهو يساويها بالموت فلا يستسلم لها، بل تظل رحلة “الذهاب والعودة” بعيدا عن الآخر وإليه بلا توقف، فإذا ما رفض الوعى البشرى صقيع الوحدة ليتقدم نحو الآخر طلبا للدفء والمحبة، يقفز إليه خوف مضاد يحـذر من خطر الترك أو الإغفال. ألبس جلدى بالمقلوب فلينزف إذ تقتربوا، ولتنزعجوا، لأواصل هربى فى سرداب الظلمة، نحو القوقعة المسحورة…، لكن بالله عليكم: ماذا يغرينى فى جوف الكهف، وصقيع الوحدة يعنى الموت؟ لكن الموت الواحد:… أمر حتمى ومقدر، أما فى بستان الحب، فالخطر الأكبر أن تنسونى فى الظل، ألا يغمرنى دفء الشمس، أو يأكل برعم روحى دود الخوف. فتموت الوردة فى الكفن الأخضر، لم تتفتح، والشمس تعانق من حولى كل الأزهار، هذا موت أبشع، لا… لا تقتربوا أكثر، جلدى بالمقلوب، والقوقعة المسحورة تحمينى منكم. وهكذا تستمر رحلة الوعى البشرى من خوف إلى خوف: خوف من الوحدة، وخوف من الآخر، خوف من الابتعاد حتى لا يـنسى، وخوف من الاقتراب حتى لا يـلتهم، خوف من الأمان حتى لا يـخدع، وخوف من اللاأمان حتى لا يتجمد رعبا. إلا أن كل هذا ليس سلبيا بحال، بل إنه عمق الطبيعة البشرية التى لا يتم مسار النمو إلا من خلال الجدل معها واستمرار محاولة التوليف الأعلى من خلال كل ذلك. وتشمل هذه المسيرة تفاصيل أخرى حول الخوف من مصادر لا مجال لعرضها فى هذه العجالة مثل الخوف من الإيمان، والخوف من الحرية، فهذا كله يحتاج إلى عودة أشمل وتناول أرحب. تعقيب ودعوة لاقتحام الخوف إذا كان الخوف يمتد بجذوره إلى كل هذا العمق، وتظهر تجلياته بكل هذا التنوع، فعلينا أن نراجع أنفسنا أمام مزاعم معاصرة تبالغ فى تصوير أن الخوف يندرج غالبا تحت ما هو “اضطراب” أو “مرض”، تحت أى عنوان مثل “القلق” “والرهاب” “ونوبات الهلع”، وما إلى ذلك، ذلك أنه لا ينبغى علينا أن ننفى الخوف ابتداء خشية أن يتزايد حتى يصل إلى ما يسمى المرض النفسى، بل إن علينا أن نحترمه لنستوعبه بل نقتحمه لنكون به إلى ما هو طبيعتنا البشرية. وأعتقد أن هذا سوف ينبهنا إلى ضرورة مراجعة مقولات سائدة مثل: “دع القلق وابدأ الحياة”، ليحل محلها، مثلا: ” اقتحم القلق لتستمر فى الحياة” وبالقياس يمكن أن نضحك من كتاب عنوانه: “لا تخف”، لنؤلف بدلا منه كتابا بعنوان: “كيف نخاف”؟ وهكذا ولنتذكر أن الوعى الشعبى ظل ينبهنا إلى مثل ذلك فى قوله: مثلا أنه “من خاف سلم”، أو حتى: “قالوا نام لما ادبحك، قال دى حاجة تطير النوم من العين”. ملحق: (على لسان الاطفال داخلنا وخارجنا) بعد ثلاثين سنة كتبت فى هذا المعنى فى أراجيزى على لسان الأطفال: -1- قالوا يعنى، بحسن نيةْ: “لا تخف” دا مافيش خطرْ طب لماذا؟ هوا يعنى انا مش بشر؟ حِيثْ كده، احنَا نقولَّك: “خافْ وخوِّف”! فيها إيه؟ -2- لو ماخفتش مش حاتعمل أى حاجهَ، فيها تجديد أو مغامرة لو ما خفتش مش حاتاخد يعنى بالكْ، حتى لوْ عاملين مؤامرة لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للبر دُكْهَهْ خايف انْ تْبِلّ شعركْ لو ما خفتش يبقى بتزيـّف مشاعرك -3- بس برضه خللى بالك إوعى خوفكْ يلغى شوفكْ إوعى خوفك يسحبك عنا بعيدْ، جوّا نفسكْ إوعى خوفك يلغى رِقّةْ نبض حسَّكْ إوعى خوفك ان بكره شرّ حامِلْ يمنعك إنـَّـك تحاولْ [1] – مجلة سطور: (عدد نوفمبر – 1999) كان العنوان الذى نشر به هذا المقال فى مجلة سطور هو “روعة النقص البشرى” لكننى فضلت هذا العنوان كما ألحقت بالمقال أرجوزة من ديوانى للأطفال”أغانى مصرية عن الفطرة البشرية للأطفال والكبار” عن نفس الموضوع أصبح البحث عن الهوية القومية، ناهيك عن الهوية الفردية، فرض عين لا فرض كفاية، حدث ذلك بعد ما زحف الإعلام المحلى والعالمى على وعى البشر بشكل منذر، وهذا الزعم يتفق تماماً مع ما يسرى من تساؤلات تزداد إلحالحاً حول “من الذى أصبح يحكم العالم”؟ بعد أن تضاءل دور الحكومات فى تسيير عجلة الاقتصاد القومى، فالعالمى، ومن ثم التحكم فى مجريات السياسة، فالتربية، فالثقافة، فهوية المجتمع، فالأفراد. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نفتح هذا الملف أصلاً؟ لأن واجب البحث عن هوية أصبح فرض عين كما ذكرنا حالاً، نعم، على كل فرد أن يذود عن هويته حتى لو خالف العالم أجمع، إن الذى اعترض – رسمياً – على بداية الألفية الثالثة كان شخصا واحداً هو فيدل كاسترو، ولكن اعتراضه هذا ليس كافياً ليغفر لنا الانسياق وراء خطأ واضح كالشمس، لكن الذى يغفر لنا أن من حق الناس أن تفرح معاً، حتى دون مناسبة، نعم: فرحنا فرحة طفل لم يتعلم الكتابة، شدّنا منظر الأصفار الثلاثة بجوار بعضها، فرحنا نلعب بها، ونغنى لها وكأننا نتقاذف “بلْياً”، أو نرص كرات ملونة بجوار بعضها، فينحنى لها رقم اثنين بالعربية، أو يتلوى راقصاً بالإنجليزية، ولا اعتراض على ما اتفق عليه الناس حتى لو أعلنوا أنهم أجلوا الألفية الثالثة لتأتى حسب إعادة حساباتهم، وظروفهم المتغيـّرة ولكن الدرس يقول: إن اتفاق العالم كله على شكل ما، وهوية ما، ونظام سوق ما، واحتفال ما، لا يعنى أن أياً من هذا هو الصواب، ولا هو الأصوب ولا هو الحقيقة!!. نرجع لموضوع الهوية: فليس معنى أنه لا توجد ملامح محددة لهوية بديلة عن النموذج المعروض – بلا صاحب صريح – أن أساير الجارى وأتبع المتاح الشائع، حتى لو كان عالمياً، فهذه مسألة جد لا لهو فيها، وهى تشكيل ممتد وليس فرحة عابرة، ومن يتصور أن ” النموذج الأمريكى” هو هوية إنسان النظام العالمى الجديد: عليه أن يراجع نفسه لأن أمريكا ذاتها كانت ومازالت، تاريخاً، وواقعاً، تبحث عن هوية، إن الفرد الأمريكى ليس له بعد ما يميزه من سمات “جامعة مانعة”، بل لعل ما يميزه فعلاً هو أنه يتمتع بأكبر قدر “اللاهوية”. إن ما يشاع عما يسمى النظام العالمى الجديد إنما يشير إلى “الوسائل” وليس إلى ما تؤدى إليه هذه الوسائل من تحديد معالم بذاتها، إنه نظام يشير إلى الشكل لا يحدد المضمون: فالمفروض أن أهم وسائل هذا النظام هى: السوق الحرة، والديمقوقراطية، وحقوق الإنسان، وإمكانيات التوصيل والتواصل دون حواجز (مما يسمى أحياناً، ربما من باب المزاح!! الشفافية)، أما إلى ماذا يؤدى كل هذا، فلا أحد يستطيع الجزم، مثلاً: نحن نتكلم عن حقوق الإنسان دون أن ننتبه إلى حاجتنا إلى مزيد من التعرف على هذا الإنسان الذى نحاول أن نحق له حقوقه، لا أحد يستطيع أن يجزم فعلاً بمدى ما أحرزناه من تعرّف على طبيعتنا الحالية، والواعدة تطورياً، بل إن ما بدا لنا يوماً ما مزية بديهية تميز ماهية الإنسان وتحافظ على إنسانيته ونوعه، مثل دافعية ودلالات غريزة الجنس بين ذكر وأنثى، أصبح الآن محل شك، بل ومحل سخرية، فالشاذ الآن – فى المجتمعات التى ترفع رايات التقدم- هو من ينظر شذراً، أو حتى عجباً، إلى الشاذ جنسياً، وعلى من يتصور أن الإنسان لم يخلق “شاذ بطبعه”، أن يلم نفسه وإلا اعتبر وقحا وقاهراً ومتخلفاً، وراسباً فى مادة ما هو: “حرية شخصية”، وانتهى الأمر عندهم إلى أنه من حقوقك كإنسان الآن أن تكون شاذاً، وأن تعلن ذلك على الملأ، وأنا لا أريد بذلك أن أثير حفيظتنا الأخلاقية، أو ان أحرك رفضاً انفعالياً بإثارة مشاعر متخلفة تغلب على ثقاقتنا(!!) ولكنى أنبه فقط إلى أن كل شئ حتى الغرائز ومتطلبات حفظ النوع، أصبح مفتوحاً للمناقشة. ولنا أن نتساءل هنا: هل الهوية التى تتشكل فى تلك المجتمعات الحرة جداً، الجريئة فعلاً، الشديدة الحقوقية الإنسانية هى هى التى تتكون، أو ينبغى أن تتكون عند متخلفين أمثالنا؟ أم أن للمسألة بعداً سابقاً لذلك: يطرح تساؤلاً يقول: هل الهوية هى غاية محددة المعالم يمكن الوصول إليها أصلاً، أم أنها حالة مرحلية فى تشكـّـل مستمر؟ موقف بعض النظريات النفسية نبدأ من مدخل مدرسة علم النفس الإنسانى، التى ظلت تمارس كأحدث صيحة حتى الستينيات، وهى مدرسة إنسانية فعلاً تتجاوز مدرسة التحليل النفسى والمدرسة السلوكية، وهى تُعلى من قيم الإنسان مما يتفق مع الشائع فى المواثيق العالمية الإنشائية المعلنة (مثل حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق المريض النفسى، حقوق الشواذ .. إلخ)، ويؤكد هذا العلم بوجه خاص على أهمية “تحقيق الذات” Self actualization، وكأن الذات (الهوية) قيمة محددة تحتاج إلى جهد مرتب، ومسار معروف، فتتحقق، وكأن كل فرد يمكنه أن يحقق ذاته إذا ما وصل إلى هذه المحطة، محطة (غاية: تحقيق الذات). وقد عارضتْ هذا المفهوم مدارس نفسية لاحقة حيث راحت تؤكد على مفهوم امتداد الذات Self expansion لا مجرد تحقيق الذات، بمعنى أن الذات كيان متجدد أبداً، وأن أى تحقيق لها إنما يتضمن موقفاً استاتيكيا مقفول النهاية، فى حين أن الإنسان فى حالة تشكل مستمر، أكد هذا بوجه خاص “سيلفانو أريتى” (صاحب نظرية لم تأخذ حظها من الشيوع وهى: النظرية المعرفية الإرادية Cognitive Volitional Theory)، وأيضا أكده علم النفس التجاوزى (عبر الشخصية Trans personal) إذْ يقول بأن الهوية (الشخصية) هى مجرد مرحلة من مراحل النمو، وهى رحلة متوسطة وليست غاية فى ذاتها، ولا يكون الإنسان نامياً بحق إلا إذا تخطاها إلى ما أسماه “عبر الشخصية”، أو عبر الهوية Transpersonal، ومن هذا المنطلق يصبح تحقيق الذات (الهوية) مجرد هدف مرحلى هام لا أكثر، لذلك ينبغى تجاوزه، هنا نتساءل: تجاوزه إلى أين، لنكون ماذا؟ والرد البسيط يقول: لتكون لنا ذات (هوية) لها معالم مميزة لكل فرد بذاته فى ثقافة بذاتها تجمعه إلى غيره: ثقافة (وعى) جماعى بذاته، وهكذا: وهكذا تقفز إلينا حتمية النظر فى الفروق الثقافية (قبل أن تمحى نهائياً فى زحمة دلالات الاحتفالات بالألفية التى لم تبدأ بعد)، وسوف أكتفى باجتهادات تخص ما هو مصرى (عربى) كمثال: نبدأ بالقضية الأساسية التى ما لبثت تتردد منذ أن وضعها شكسبير على لسان “هاملت” منذ بضعة قرون “أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال”. وقد شاع هذا السؤال بشكل مسطح أدى إلى اختزال الوجود البشرى إلى تصورات سطحية وخاصة بعد سوء فهم بعض شعب الفلسفة الوجودية، وتمادى هذا الاختزال حتى بدا أن الرد على هذا التساؤل بالإيجاب “أن أكون” هو غاية المراد “لكل العباد!!”، وتأكد هذا بشكل خاص فى مواجهتنا لأزمة الهوية فى مرحلة المراهقة، حيث نكرر بلا كلل أن التأكيد على ما هو “أن أكون” هو التفسير الجاهز لشكل ومسار الاختلاف بين الأجيال، الذى يسمى أحياناً صراع الأجيال، وعادة ما نرجع به إلى الصراع بين الأب وابنه فيما يسمى “عقدة أويب” التى روج لها سيجموند فرويد (ربما لأسباب شخصية) والتى ضخمت من مسألة التنافس على الأم والخوف من الخصاء .. إلخ. لكن هذا المستوى من التساؤل (أكون أو لا أكون) هو المستوى الأدنى (أو قل المستوى البداية) لمسيرة الهوية، ذلك لأن المنظور النمائى المتواصل يقول: إن الإنسان إنما “يكون ليصير”، لا ليكون، فبمجرد تحقيق الكينونة الأولية “أكون”، ومع استمرار جدل النمو: يقفز تساؤل أرقى يقول “أكون أو اصير”، بل إننى أكتشفت (فى مداخلتى عن الإبداع والحرية) ان هذا المستوى هو أيضا مرحلى، وهو يختص بالهوية القومية والفردية، فانتبهت إلى أن مستوى “أكون أو أصير” ليس هو، بدوره، غاية المطاف، بل إنه يلحقه مستوى “أنقرض أو أَطْفٌر” (= نتطور أو تضفر) بما يؤثر فى الهوية الإنسانية من منظور تطورى ممتد. إذن فالمطروح ليكون الإنسان كياناً نامياً بحق هو أن يواصل مراحل التشكل نحو صيرورته المفتوحة النهاية، ما دام على قيد الحياة، بل وما أمتد فى نوعه بعد حياته فرداً. فهل يحق النموذج الغربى هذا الطموح البشرى الذى هو: المسار التطورى الطبيعى للإنسان؟ ينبنى المفهوم الغربى فى هذا الصدد على أساسين: الأول: الحرية الفردية مؤكدة الاستقلالية، والثانى: تآليه الإنسان باعتباره هو محور الوجود ومنتهاه، ولا يمانع النموذج الغربى أن يضع مع هذا وذاك، وبجوارهما، بعض الديكورات التدينية أو الممارسات الغيبية الشاذة. وفى المقابل فالإنسان المصرى (كمثال لا أكثر) يختلف فى كلتا المسألتين، فلا هو يتمتع بــ، أو حتى يقدس، الحرية الفردية، ولا وجوده يتوقف عند قمة هامته فرداً أو نوعاً، (ولا هو عاد يمتد إلى ما بعده كادحاً إليه كدحاً ليلاقيه)، ومع ذلك فهو مختلف مازال، ومن حقنا أن ننظر كيف ذلك. وسوف أقدم فى هذه المداخلة بُعداً واحداً لهذا التميز المحتمل. الهوية والحرية والاعتمادية يبدو لأول وهلة أن الحرية هى الأساس الضرورى عندهم لتحقيق الهوية، وأنها لا تتفق مع الاعتمادية، بمعنى أن الانسان الحر هو الإنسان المستقل فعلا جداً، وهذا جائز فى الثاقفة التى نبع منها هذا المفهوم، أما ما خبرناه من واقعنا نحن، وبالنسبة لى: من خلال معايشة مأزق المرض النفسى فى واقعنا الخاص، فهو أن ثمة اختلافات ثقافية جذرية تدعو لإعادة النظر فى هذه المسألة. قضية الحرية الغربية – كما ذكرنا – تتبلور معالمها من خلال مقولات ظاهرة ومتكررة مثل “أزمة الهوية فى المراهقة” وحفز الاستقلال المبكر فى أوائل منتصف العمر، بالاقتصار على العائلة النواة أو العائلة الصغيرة المغلقة الحدود، والتأكيد على تقدير الذات، والطلاق المتكرر، وحق الشذوذ واحترامه، وكلها قضايا ليست معيشة فى شرقنا الأدنى، أو الأقصى، بنفس الصورة. فالاعتمادية على الكبير فى ثقافتنا (قبل التشوية الذى لحق بها فى العقود الثلاثة الأخيرة تقريباً) هى حق معلن لا نتهرب ولا نخجل منه، ورعاية الكبير للصغير (الصغير حتى سن الخمسين وأكثر) هى ممارسة طبيعية سلسة، وهذا وذاك يرتبط بغلبة ما يسمى “الأسرة الممتدة” التى لا تقتصر على الوالدين والإخوة، بل تمتد إلى الأعمام والخالات والأجداد والجدات، وأحياناً إلى الجيران، كل ذلك يجعل الاعتمادية أمراً وارداً، بل مشروعا، بل محبباً فى أحيان كثيرة، وأن “اللى مالوش كبير يشتريله كبير” فهل يتعارض ذلك مع ممارسة الحرية، وتكوين الهوية؟. إن الصراع بين الأجيال كما صوره فرويد خاصة فى عقدة أوديب ليس حتماً لازما، ثم إن هذا الصراع لا ينتهى بانتصار الولد على الوالد، ولا بتقمص الولد لوالده، وإنما هو ينتهى (أو يحل) بتصالح بينهما، هذا ما قالت به مدرسة لاحقة هى مدرسة التحليل التفاعلاتى (إيريك بيرنTransactional Analysis ) التى اعتبرت أن تمثل الأب، ليصبح جزءاً لا يتجزاً مما أسمته (اليافع المتكاملIntegrated Adult ) هو فى النهاية الطيبة لمسار النمو، أى أن الفرد يصبح ناضجا حين يتصالح مع والده الخارجى والداخلى، لا حين ينتصر عليهما، أو ينفصل عنهما. جدل إسماعيل/إبراهيم ومن منطلق ثقافتنا نحن: أعرض ما أسميته جدل “إسماعيل – إبراهيم” (بديلاً عن عقدة أوديب، وأيضا عن تصالح تسوياتى مشبوه، وهو جدل يبدأ بفرض يقول: إن العلاقة بين البشر فى الثقافة المؤمنة (أو حتى المتدينة) ليست علاقة مواجهة ثنائية “أنا<==>أنت”، بل هى علاقة من خلال عامل مشترك أعظم، هو الوعى الكونى (الله) الذى يضمهما (تحابا فى الله، اجتمعا عليه، وافترقا عليه .. إلخ)، وبالتالى تصبح مسائل مثل: حتمية التنافس، والتهديد بالهجر فالضياع، وثنائية الوجدان Ambivalence تجاه الوالد (= كره وحب الوالد – الأب أو الأم أو كليهما– فى نفس الوقت) تصبح كل تلك المسائل أقل أهمية وحدّة: عما يصورها ويعيشها العالم الغربى، وتصبح ممارسة الحرية ليست مرتبطة بالثقة فى هذا القاسم المشترك الذى يستظل بظله كل من يمارس علاقة مع “آخر”، وبتعبير آخر نقول: إن الاعتمادية الطبيعية والمعلنة تحت مظلة أمان حرية التوحيد إن صح التعبير هى الأصل، وبالتالى فإنها تخلق حرية من نوع آخر، بعكس المتصور لأول وهلة من ضرورة التعارض بين الاعتمادية (على الكبير خاصة) من ناحية، وبين الحرية والاستقلال على الجانب الآخر. مثل هذه الاعتمادية توجد بوضوح أيضاً – أو أصلاً– فى ديانات وايديولوجيات الشرق الأقصى، وخاصة الكنفوشيوسية، ولقد لفت انتباهى إلى مثل ذلك ما جاء فى مقدمة كتاب عن “تشريح الاعتمادية Anatomy of Dependency” حين ذكر مؤلفه: تاكيو دوا Take Doi (1978) اليابابى أن فكرة الكتاب جاءته بعد أن تعجب من مضيفه الأمريكى وهو يدعوه فى بيته “أن يساعد نفسه Help yourself”، وكيف أنه وجد ذلك مناقضاً لثقافته تماماً، ثم جاءته فكرة تأليف ذلك الكتاب، أقول: إن هذه الاعتمادية على الكبير، سواء كان الله – سبحانه – عندنا، أم التقاليد والأعراف فى جنوب شرق آسيا، لا تتعارض مع نوع أعمق من الحرية، وهى من المقومات الأساسية لتكوين الهوية الفردية من خلال قيم ثقافة مغايرة لقيم ثقافة الغرب، وهذا أمر لا يميزنا بالضرورة، لكنه يعلن اختلافاً يجب وضعه فى الاعتبار حيث لا نملك ولا نعيش نحن هنا ذلك السياق المتكامل الذى يمارسون فيه قيمهم، ويحققون من خلاله هويتهم. ثم نعود بتفصيل أكثر إلى فرضية “جدل إسماعيل – إبراهيم” بديلا عن عقدة فرويد: أننا لو تعمقنا مغزى حكاية أضحية إسماعيل – إبراهيم، لوجدناها تمثل أقصى صور الطاعة حتى القبول بالذبح، إلا أن هذا التمادى فى الطاعة لم يكن إلا سعياً إلى ما يمكن أن يعتبر “إعادة الولادة” التى نستنتجها من معنى الفداء بالقربان الذى نزل له من السماء، فالاعتمادية فى هذا الرمز هى طاعة الصغير للكبير حتى قبول الموت ذبحاً، ولكن ليس باعتبار أن الكبير هو الأعرف والأقدر لمجرد أنه كبير، ولكن باعتباره الأقرب إلى الأكبر فالأكبر، فإسماعيل حين أطاع أباه إبراهيم لم يقل له “افعل ما ترى” أو ما تريد، وإلا فإن ذلك يصبح تشريعاً للاستسلام المهدد لتكوين الهوية أصلاً، وإنما قال له “أفعل ما تؤمر” وكأنه ما أطاعه إلا لأن إبراهيم بدروه إنما يطيع الحق الأكبر. فالإنسان فى مجتمع كهذا إنما يحصل على حريته حين يختار التبعية والاعتمادية حتى نهايتها، بوعى كامل وإعلان بسيط وشجاع، فينعتق بالتوحيد أساساً وبالطاعة المشروطة، فمن الواضح أن شرط الطاعة هنا فى جدل إسماعيل – إبراهيم هو أن يكون الكبير ليس هو الأكبر، وإنما هو عبد مثله لمشترك أعظم. أعرف جيداً ما يمكن أن يثار من اعتراضات وتحذيرات ورفض فى هذه المرحلة من تقديم هذا الفرض نتيجة لغلبة سوء استعمال فكرة الاحتماء بالمتشرك الأعظم، وخاصة إذا اختص الكبير باحتكار الحق فى تقديم تفسيرات متحيزة للنصوص المقدسة، إلا أن سوء الاستعمال وتدهور التدين لا ينبغى أن يكون حائلاً دون التفكير العلمى والحدْس الإيمانى، ولا دون البحث عن المميزات الثقافية الحقيقية لماهيتنا حتى لو كانت قد صارت إلى عكس ما نستلهمه من أصولها، (ثم إنى لا أتكلم لا فى التفسير التقليدى، ولا فى السياسة!!). ويمكن أن نتابع هذا الفرض القائل بإمكانية الحصول على “هوية متميزة” من خلال “اعتمادية مختارة” فى ظل “قاسم مشترك ضامن” بأن ننظر فى بعض التراث الأدبى الذى أعتبـُـره مصدراً أكثر مصداقية من كثير من الدراسات المنهجية، وهذه بعض الأمثلة: أولاً: صورة الأب فى إبداعات نجيب محفوظ: وأشهر أب عند محفوظ هو “السيد أحمد عبد الجواد” فى الثلاثية، فنلاحظ أن حضوره الأبوى العملاق لم يمنع أولاده الثلاثة أن يشبوا متميزين جميعاً، لكل منهم هويته الخاصة، التى هى ليست أباهم، ثم إننا لا نجد أياً منهم صورة للآخر، على الرغم من أن الأب واحد، والاعتمادية عليه: ظاهرة أو خفية هى فى أوج تجليها، ولا واحد منهم يشبه أباه (بما فى ذلك ياسين)، ولا واحد منهم لم يعتمد على أبيه صراحة وضمناً، ولا واحد منهم ارتضى أن يتوقف عند ماهية عادية رمادية، تعلن تسوية ماسخة تبهت معها هوية الأب والابن على حد سواء، بل إن كل أبناء “سى السيد” تميزوا، على اختلافهم فيما بينهم، تميزوا بما هو يميز كل واحد منهم عن الآخر، وعن أبيه، (ينطبق هذا أيضا على البنتين: عائشة وخديجة). ثم نتابع الأب الإله عند محفوظ سواء كان زعبلاوى([2])، أو الجبلاوى([3]) أو الرحيمى([4])، كل أب من هؤلاء: حضر أم غاب، كان يغرى ويعد بالكشف فى نفس الوقت، فالاعتمادية فى ثقافتنا هذه كما تبدت فى هذه الأمثلة ليست متعارضة لا مع الهوية، ولا هى معوقة لها. كما أنها ليست مانعة للإبداع الذاتى ومواصلة السعى لمزيد من الكشف والنمو، وحتى الصوفى الغامض الذى تكرر فى أدب محفوظ، كان يبدو بمثابة الوسيط بين الأب والإله وبين العبد الجائع إلى الاتباع، وكان يبدو دوره كأنه يفتح باب نوع جيد من التبعية، نوع رائق وإرادى وغير مشوه. ثانياً: إذا انتقلنا إلى ديستويفسكى واجهتنا صورة الأب المحيط بطريقة مختلفة تماماً، ومع ذلك فثم مكان للتعرف على نوع مقلوب من الاعتمادية فأغلب آباء وأجداد روايات ديستويفسكى فيهم قدر من الطفولة لا يخفى، بل إن أبناء وبنات روايات ديستويفسكى كانوا يقومون بدور الأب فى كثير من الأحيان، من أول “نيتوشكا نزفانونا” حتى الفارس الصغير، ثم الطفلة “نللى” فى “مذلون مهانون” وكذلك “أليوشا” فى “كارامازوف” ومع ذلك فإن الاعتمادية هنا – على الابن – كان لها نفس الدلالة التى شرحناها لوظيفة الاعتمادية على الأب، فكلتاهما تؤكدان الاعتمادية التى نريد هنا الاعتراف بإيجابيتها، حيث لا تتعارض مع الحرية التى نزعم أنها فى شرقنا إنما تنبع من قبول “الاعتمادية لتجاوزها” وليس من “أزمة الهوية” كما تظهر لديهم مقترنة بحتمية الصراع بين الطفل وأحد والديه أو كليهما، وكذا بالسعى الحثيث إلى التبكير فى الاستقلال عنهما. ثم إن لدينا أمثلة أخرى للاعتمادية، التى قد يمارسها المبدع (ليبدع)، وهو يعلنها، ويفخر بها، بغير أن تحول دون تميز هويته مبدعاً متفرداً، ونتذكر هنا دون تفصيل اعتمادية المتنبى على سيف الدولة التى لم تعق إبداعه، ولم ترهق حركية توجهه، كذلك اعتمادية محمد عبد الوهاب على أحمد شوقى مما يحتاج إلى عودة. وأخيراً فإن الاعتمادية المطلقة فى الإبداع الصوفى الحقيقى: إبداع الذات فى الكون (العبودية التوحيدية المولدة للحرية إن صح التعبير) يمكن أن تعتبر فصل الخطاب فى هذه المسألة. ونخلص من هذا كله إلى بعض الافتراضات الجديرة بالنظر كما يلى: إن إعلان الاعتمادية وقبولها حتى احتمال الموت (إسماعيل/إبراهيم) تحت مظلة التوحيد/التحريرى الحقيقى. خليق بان يفوت الفرص على غش الاعتمادية الخفية بكل صورها المحورة والعكسية والتعويضية والمزاحة، فحرية “إسماعيل” بإعادة الولادة تتم فى سياق إيمانية تحريرية تجعل القاسم المشترك الأعظم شريكاً فى كل علاقة. وبألفاظ أخرى: إن الشبع من الاعتمادية جهاراً نهاراً خليق بأن يفتح الباب للطرفين: الأكبر والأصغر أن ينتقلوا منها إلى ما بعدها، إذْ يمكن أن ينال كل منهما ما شاء لتحقيق “هويته” تحت مظلة مشتركة، بدلاً من التحايل لمحو الهوية الخاصة المتميزة بتسويق سريع لهويات زائفة وسطحية ( مثل الوجبات السريعة والتيك أواى!). كما أن مواجهة هذه الاعتمادية الصريحة، وإعلانها مرحلياً، ثم الجدل معها، كل ذلك خليق بأن يعفينا من اللجوء إلى ميكانزمات خفية مثل التقمص بالمعتدى، أو الخـُـلْـف([5]) التشنجى، ونحن نستعير معالم قشرة هوية ليست لنا ولسنا لها، لا هى نحن، ولا هى تقليد جيد لما هم. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد فبراير – 2000) كان العنوان الذى نشر به هذا المقال هو “أكون أو أصير” لكننى فضلت العنوان الحالى أثناء المراجعة! [2] – نجيب محفوظ “دنيا الله”، الطبعة الأولى 1962، دار الشروق، ودنيا الله مجموعة قصصية تضم ١٤ قصة وزعبلاوى هى قصة قصيرة يدور محورها حول راوى مريض يسعى للقيا الزعبلاى لمداواته، إن رمزية القصة هى رحلة البحث عن الله فى زمن الشك [3] – نجيب محفوظ “أولاد حارتنا”، الطبعة الأولى 1959، مكتبة مصر، يبدأ «محفوظ» الرواية بقصة شخص يدعى “الجبلاوى” فُهم حينها أنه يقصد به (الله)، ثم أنجب الجبلاوى أولادًا أكبرهم إدريس (إبليس) [4] – نجيب محفوظ “الطريق”، مكتبة مصر، 1964، “الحرية والكرامة والسلام” كلمات رددها نجيب محفوظ على لسان بطل الرواية «صابر» مظهرا علته فى البحث عن والده “سيد سيد الرحيمي” صاحب السلطة والمال الذى ماهو إلا حسنة من الحسنات، والذى سيجد فى كنفه الاحترام والكرامه، وسيحرره من ذل الحاجه الى اى مخلوق [5] – Negativism -1- وحدى تماما، مختبئ فى شقتى المتواضعة (نجمة ونصف، أو نجمتين بعد التعديل)، هناك فى أقصى الجنوب، (دهـَـبّ: جنوب سيناء) بين جيران طيبين، مساكن شعبية جميلة، ناسها ليس لهم علاقة بهذه الحكاية، وقد زاد من اطمئنانى إلى نجاح خطة هروبى أنه ليس عندى طبق (دش) فى هذا المكان البعيد الجميل، الشقة ـ شديدة الشعبية ـ تقع بين البحر والجبل، رأيتَ كيف؟!!! قلبت المطبخ والممر الذى أمامه إلى حجرة تطل على البحر، وجعلت المطبخ الناحية الأخرى، أما الصالة فهى تقبع فى حضن الجبل، أحس بالفرق بين ما أكتبه فى الصالة فى حضن الجبل، وبين ما أكتبه فى تلك الحجرة والبحر على مرمى البصر، لا أفضل هذا عن ذاك، لكن لكلٍّ روحه ورائحته، عبر النافذة، أرى الشجر يتمايل فى نشوة نشطة، لو رأيت نفس حركته هذه فى القاهرة لحسبتها العاصفة، ليس عندى طبق فضائى، ولو أننى كنت أنوى أن أفعلها هنا أيضا حتى أواصل مبادءاتى إلى العالم قبل أن يقتحمنى هو، زودوا “دهب” أخيرا بمحطة تقوية جعلت القناة الأولى والثانية متاحة لى ولجيرانى، بمجرد استعمال هوائى (إيريال) داخلى، سوف أحتفل وحدى برأس السنة، ما زلت أذكر ليلتها فى باريس، ياه !! كم هى الفرحة معدية شريطة ألا يفسدها السـُّـكـْــر البـَـيـِّـن، ليس عندى مانع أن أحتفل بطريقتى وحدى بالسنة الجديدة، لكن عندى ألف مانع ومانع أن أحتفل ببداية ألفية لم تبدأ بعد، سوف أحتفل وحدى وسط خواجات لا أعرفهم، ولا يعرفونى. هنا، – فى دهب – أشعر أنى أنزل ضيفا على ضيوف بلدى. -2- منذ ساعات، وأنا أتناول عشائى، (الذى هو السحور فى واقع الأمر) فى المطعم الصينى الجميل فى العسلة. جاءنى النادل وهمس فى أذنى، وادعى أنه متعجب كيف يحبنى الناس هكذا من بعيد دون معرفة، وأن دليله على ذلك أن أحد الخواجات الجالسين على المائدة المقابلة يعزمنى على شراب ما، صحيح أننى أبالغ فى ما أنفح هذا النادل بالذات من منح (بقشيش) زيادة عن الحساب، وكأنى أشترى صمته، أو أجهض تساؤلاته، أضمن بذلك أن يتركنى فى حالى، ألاحظ أنه يفهم جيدا ما أريد، يبدو دائما ممتنا مرحبا مجاملا، لكن ليس لدرجة أن يحبب الناس فىّ هكذا، أو أن يدعى ذلك، نظرت إلى المائدة المشار إليها فوجدت مجموعة من الأجانب الشباب الذين أدعو لهم عادة بالسعادة الحقيقية، مرة لأننى أتصور أنهم يحتاجون لدعوتى هذه، ومرة لأنه يخيل إلى أن نوع سعادتهم “ليست هى”، ومرة لأصالح من خلالهم كل ما هو خواجة، ومرة لاعتقادى أننى رجل طيب، و أن دعوتى مستجابة، لا أعرف كيف، فلا أستخسرها فيهم، لا أذكر من الذى قال من الخوجات القدامى: “كن أخى وإلا قتلتك”، أما نحن فكنا نغنى أطفالا “يا احنا ياهمه يا كوم الريش، همه يموتوا واحنا نعيش”، لم نكن نعنى الخوجات طبعا، كنا نعنى أى “هـُـمـَّــه”، لاحظ من فضلك الفروق الثقافية، لسنا قتلة بطبعنا، كل ما نقدر عليه من عدوان هو أمنية أن يتولى عنا سيدنا عزرائيل المهمة، أما هم، فـ”كن أخى وإلا قتلتك”، ياه!!، كلام فارغ هذا وذاك، لا هم قتلة، ولا نحن نتمنى لغيرنا الموت، التنوع البشرى الخلاق؟!! القبول بالآخر!! لا يا شيخ!!؟ والشيشان؟ أليسوا آخر؟ وأهل كوسوفو أليسوا “آخر”؟ والفلسطينى فى الداخل، والخارج أليس آخر؟ يا أخى: إلى أين أنت ذاهب؟! لا تذهب بعيدا هكذا إلى الناحية الأخرى، الروس والصرب والصهاينة حاجة ثانية، الدنيا فيها وفيها؟ والتاريخ مليء بالمآسى، ولا يبقى إلا الخير! لست متأكدا من ذلك، لكن لعله خيرا، هذه التكنولوجيا المتسارعة ترفع الحواجز بين الناس بسرعة أكبر من تنامى حقدهم وعماهم، هل يمكن أن تعمل شيئا أكبر يذيب التعصب ويرسى العدل؟ يزيل التعصب يمكن، لكن يرسى العدل !! كيف؟ هل يمكن أن “تخلق” لنا آخرين بطريقة أصدق؟ الآخر موجود ونصف، ألم يقرر العالم هذه الليلة أن يتجاوز تاريخه الدموى، وأن نلعب معا نحن الناس، كل الناس، هذه اللعبة على مستوى الدنيا بأسرها؟ لعبة بداية الألفية الثالثة، الألفية التى لم تبدأ بعد. بدأت أو إن شا الله ما بدأت، كله واحد، لماذا بدأناها قبل أن تبدأ؟ نحن أحرار، لماذا ننتظر حتى نبدأها فى وقتها؟ وهل يعرف أحد تحديدا وقت بداية أى شىء؟ الأمور دائما تبدأ قبل أن تبدأ، وحين ندرك أنها بدأت تكون قد طابت وطلبت الأكـّـالة. لم أصدق النادل واعتبرت كلامه من باب المجاملة، إلا أنه عاد فأصر على إبلاغ الرسالة، مشيرا بتأكيد حار إلى شاب “خواجة” يبدو ظريفا وطيبا. -3- كنت عندما أحضر إلى هنا أحاول أن أنصت إلى اللهجات من حولى لأتبين الجنسيات، توقفت عن ذلك بعد أن اعتبرت أنهم، أننا، كلنا أولاد حواء وآدم. فلماذا البحث؟ لا بد أن التراب الذى خلق منه سيدنا آدم كان من هذه الجبال النقية الفتية الجميلة من حولى. -4- أنظر إلى المائدة المشار إليها، فإذا بالشاب الذى على طرفها يومئ لى برأسه فعلا، يومئ وهو يرفع ما يشرب إلى أعلى، فأفعل مثله شاكرا، ثم أربت على صدرى بمعنى أننى لا أستطيع أن أقبل كرمه بما عرض من شراب، فيبتسم ويحنى رأسه ثانية فى دماثة دافئة، الله!!!!، هؤلاء الناس بهم دفء خاص بعكس ما أشيع ـ أنا ـ عنهم، قلت للنادل إننى لا أعرف هذه الوجوه، فهل يعرفهم هو، قال إن الشاب هو أحد مدربى الغطس هنا، ألمانى على الأرجح، وأن الجلـساء ضيوفه أو زبائنه، (لا فرق) وأنه لا بد قد لاحظ كيف أننى آتى أجلس وحدى الأسبوع تلو الأسبوع، وسألنى النادل إن كنت أعمل هنا، ولم أرد، فلم يلح، إذن فأنا آتى وحدى، تعجبت لذلك مع أنى آتى وحدى فعلا، ألست أنا الذى أعلنت منذ قليل أننى إنما هربت إلى هنا لأحتفل وحدى، كيف لم أنتبه إلى ذلك بنفس المعنى الذى لاحظه النادل؟ لماذا أتحدث عن وحدتى مع أننى لا أمارسها، أو لعلى لا أشعر أننى أمارسها، هل أنا وحدى فعلا؟ لا أظن، الأغلب أننى لست وحدى، كيف؟ لا بد أننى كثير، وابتسمت. نظرت إلى النادل وإلى المضيف (هكذا اعتبرت ـ كما أشرت ـ أنى ضيف هذا الخواجة) ودعوت ألا يكون أحدهما قد سمع ما لم أقله. -5- أعود إلى صديقى الحاسوب، كان ينتظرنى فى أدب وسماح لا تعرفهما الزوجات العصريات، اعترفت له أننى هارب وربما كاذب أدعى الوحدة، واكتشفت كيف أن لصديقى الحاسوب هذا، فضل، أو وزر، خفوت وعيى بوحدتى التى لاحظها كل من الخواجة والنادل، معا!!، كنت قد اقتنيت هذا النوع من الحاسوب حديثا، وهو نوع به بطاقة تلفاز تسمح بالاستقبال على شاشة صغيرة يمكن إزاحتها إلى زاوية هامشية على ناحية، وكنت قد اعتدت أن أشغل هذه الخلفية أثناء استغراقى فى عملى، وأن أعاود النظر للألوان الصامتة أحيانا، أو الإنصات للأصوات الهامسة أحيانا أخرى، أو إغفال هذا وذاك رغم بقاء أى منها فى الخلفية، ثم وأنا فى هذه الحال متصورا نجاح خطة الهرب المزعوم، وأنا أدعم إصرارى على مقاومة هذه الخدعة الجماعية المسماة الاحتفالية بالألفية، إذا بى أكتشف أن القناة الثانية، التى تصل إلى هذا المكان النائى من خلال محطة تقوية حديثة، تجرنى جرا إلى العالم كله، كل الناس اتفقوا أن يلعبوا معا هذه اللعبة الجماعية هذه الليلة. ليس أمامى خيار، ورائى ورائى، أضطر أن أتابع ما يجرى بجزء من وعيى، أجدنى أتسحب من ورائى لأنضم إلى هذه المليارات من البشر الذين يلعبون، هكذا أكتشف أننى غير رافض ولا حاجة، على الأقل لست رافضا كما كنت أتصور. -6- مباراة كأس العالم فى كرة القدم، كان ذلك منذ أكثر من عامين، لست متأكدا، قفزت فرحا بالهدف، ليس المهم من أصاب مرمى من، الهم أننى جالس أمام التلفاز أشارك ألف مليون بنى آدم نفس الشعور، فى نفس اللحظة هل هذا هو “الحج الالكتروني”؟([2]) -7- قبل الفجر، اعتدت آنذاك ـ منذ عشرين عاما ـ أن أقتطف بضع ساعات أكتب وأقرأ فيها قبل أن تلتقطنى عجلة الواجبات اليومية، أفتح المذياع الصغير، لم يكن إرسال البرنامج الموسيقى متصلا 24 ساعة كما هو اليوم، ألعب فى المفتاح على الموجة القصيرة، أى دندنة تكفى، تكسر صمت الـليل، مع أنى لا أشبع من مناجاته، ورائى ما ينبغى إنجازه قبل وبعد مناجاة الصمت. الموسيقى الخالصة تأتينى، وهى لا تحتاج إلى فك رموزها، الأغانى الغريبة ألفاظها لا تحتاج بدورها إلى فك شفرتها، أعتبرها ضمن الموسيقى التى لا أفهمها، الأخبار التى تأتينى برطان متدفق أتركها دقيقة، أو أكثر أو أقل، لا أغير المحطة، أنصت إلى جرس رطان فتحضرنى أسئلة كثيرة عن معتقدات أصحاب هذا الرطان وعن دينهم، وعن مآلهم، وعن رحمة ربنا بى وبهم، أطمئن إلى عدله طمأنينة لا قبلها ولا بعدها، من قال غير ذلك، الله يخيبهم، هذا المذياع الصغير “الترانسستور” يساعد الناس أن تتقرب إلى الله، يقربنا من بعضنا البعض، من ذا الذى يستطيع أن يقاوم؟ أهلا !!! “أكتب فرحا”: غصبا صدفة، لمست إصبعى المفتاح، فـَـسَـرَتْ كلماتٌ عجميةْ،… تنتزع السيف من الغمد، تلتهم ظلام الرؤية”. “أكتب أيضا” يجتمع السامرُ من أحباب الله، البيض السود السمر الحمر. البيذق والـفرز ورخ الشاه” أنهى ما كتبت بأنه: “يتراقص سهم الأفق يفتح وعيى المرتجف الأعشى، فيرينى العالم.،… مذياعا ملقى، فى حجم الكف، والناس الواحد: كلٌّ ليس له مِثْلٌ أصلا. أختم صلاتى قائلا: ”… يتصاعد كدح الناس إلى خالقهم جمعا فى معراج الرحمة”. -8- أسير فى هذه المظاهرة العالمية وأنا وحدى هكذا فى أقصى الجنوب، أنتقل غصبا عنى من جزر “الأوكلاند” شرقا حتى جزيرة “سماو” غربا، أنبهر من هذه الألعاب النارية فى سيدنى، و أرقص مع الراقصين فى هاواى. يا حلاوة!! لماذا اتفق العالم على الاحتفال معا هكذا بألفية لم تبدأ بعد؟ لا أقصد لماذا، بل كيف؟ كيف أقنع الناس بعضهم البعض أن يغيظوا التاريخ الحقيقى وهم يحتفلون بما اتفقوا عليه، وليس بما يفرضه عليهم هذا التاريخ الأعشى؟. أشعر فجأة أن من حق الناس عبر العالم أن تلعب معا متى شاءت كيف شاءت، أفرح أننى واحد من هؤلاد الناس. -9- هذه الأرقام الأربعة التى تبدأ من اليسار بواحد ثم تسعة تلح علىّ منذ تعلمت القراءة والكتابة 1911-1919 – 1933 - 1945- 1952- 1967- 1973 - 1999، لابد أن كل الناس مثلى، قد نمى إلى علمنا ـ جميعا ـ أن هذا الشكل اللحوح، سوف يتغير، وماذا فى ذلك؟ يتغير كما يشاء، أنا مالي؟ نحن مالنا، كيف سيكون منظر التاريخ وأنا أكتبه قبل بداية أى رسالة، كيف سأكتب الرقم الجديد؟ تحريرا فى كذا شهر كذا سنة 2000، يا صلاة النبى، سنة مثل كل السنين، لماذا تغمرنى هذه الدهشة البريئة وأنا أتصور منظر التاريخ الجديد؟ يبدو أن هذه التسعات اللحوح أخذت حقها وزيادة. من يدري؟ بـُـشرى!، تختفى التسعات، ويختفى معها كل ما نريده أن يختفى ليحل محله ما لا بد أن يحل محله. من يدرى؟ من فمك إلى باب السماء. ما دامت السنون تجرى وراء بعضها، حتى وصلنا إلى سنة 2000 هكذا فلا بد أن العالم يتغير، لابد أن شيئا ما سوف يتغير، ليست المسألة فيما هو ليزر أو غير ليزر، المسألة هى نحن، ما هذا الليزر؟ طز، لا أريد أن تمتد هذه “الطز” إلى فانتوثانية زويل، نحن ما صدقنا فرحنا به وبها. كم فانتو ثانية مرت بنا حتى وصلنا إلى هذه السنة ذات الدم الخفيف هكذا؟ ثلاثة أصفار وبجوارها اثنين، منظر طبعا. أقاوم أن يسحبونى أكثر من هذا، لابد أن آخذ حذرى، ليس كل سحب مثل الآخر، ربما يسحبونى لأشارك بالمرة فى النظام العالمى الجديد أو فى بورصة نيويورك بقروشى الخائفة قليلة الخبرة، من يدرى؟ حتى لو لم يكن ملعوبا أو مؤامرة، فقد ضحكنا عليهم، أنا والناس، كل الناس ضحكوا على كل الناس. فـرحـنا – نحن الناس – بهذا الرسم الجديد ورحنا نلعب. -10- “أخيـــــراً”. ألقى بإحدى البليات الثلاث فتقع داخل المثلث بالكاد، فالبلية الثانية، فالبلية الثالثة، أجمعهم وأرصهم، يتقدم الرقم اثنين فـاردًا جذعه مختالا، يميل برقة حانية، يبتسم، أطمئن إليه فأترك البلـى بجوار بعضها فى رعايته، لعله يحرسهم. الخواجات يلعبون بالأصفار الدوائر الكرات مثل رجل السيرك فى مولد السيد البدوى، رقمهم الاثنين بالإنجليزية يهتز على موسيقى الراى، ثم ينتظر رصتهم أمامه وهو لا يكف عن الرقص. فيم كان اعتراضى إذن على ما اتفق هؤلاء الناس عليه؟ آه! تذكرت، كنت معترضا أن يغالطونا وهم متجهمون يفرضون علينا حساباتهم لمجرد أنهم تورطوا فى فرحة طفلية مثلما أكتشف الآن. كل ما أطالب به الآن هو أن يعترفوا أنه ليس احتفالا بالألفية الثالثة، ليكن الحفل هو الحفل، لكن فلنسمه حفل وداع الألفية الثانية، وداعا يمكن أن يستغرق عاما بأكمله. لا يعنينى أن تبدأ ألفية ثالثة أو تنتهى ثانية، ما يغيظنى هو الاستعباط، يعايرونا كل رمضان وكل عيد ويقرصون أذننا أنه “عيب كذا”، وأننا لا بد أن نسمع كلام علم الفلك، يعنى كلامهم، فهم أصحاب توكيل شركات العلم الحديث، فلماذا لم يسمعوا هم الآن كلام علم حساب يحذقه طفل ذو سبعة أعوام. ما الفرق بين أن نحتفل اليوم بألفية لم تأت بعد أو أن نحتفل بها بعد عام أو خمسة، حتى لو أعلنوا أنهم أجلوا الألفية الثالثة لتأتى بعد الرابعة، مسموح. كل شيء مسموح ما دمنا نلعب جميعا معا، حلوة هذه، فقط علينا وعليهم، شروط أى لعب أن تسرى القواعد “علينا وعليهم” حتى لعبة الحرب، حتى الإجراءات الأمنية على الحدود، علينا وعليهم، أليس كذلك؟. أين الحكم؟ يطل علىّ فيدل كاسترو من الشاشة المظلمة، كنت قد أغلقت الحاسوب والتلفاز معه، تملأ لحيته واجهة النافذة، يمسك ورقة كبيرة يقرأ منها فرمانا سلطانيا، يختفى وجهه ليحل محله وجه فؤاد المهندس، كم هو ثقيل الظل فى الأفلام رائع الحضور فى المسرحيات، يعود وجه كاسترو وهو يصيح “والله ما انا لاعب”، فيصفق له مارادونا وينتقلان معا من شاشة الكمبيوتر إلى الشاشة الصغيرة فى الركن، يقفزان من النافذة دون أن تــفتح، لست متأكدا من الذى قفز أولا: فؤاد المهندس أم كاسترو، لم أكن أعلم أن فيدل خفيف الظل هكذا، فيجدان الظلام الدامس، يُـرعبان. افتح التلفاز فإذا مذيع صينى يشترط سرا أو علانية، كذا وكيت وأن الرئيس الصينى قد قرر بالنسبة لاحتفال الألفية، واتفاقية الجات معا، أنه “فيها لاخفيها”، وذلك بعد أن أملى شروطه، ولم ينتظر ليعرف إن كانوا قد قبلوها أم لا. خاف أن تنتهى اللعبة دون أن يحسبوا حسابه، سوف يشترك ويـطـنـبـل، ثم يأتى الحساب فيما بعد. ونحن؟ متى نقبض ثمن سماع الكلام؟ -11- سوق النخاسة لتسويق المحترفين، أجور المدربين بعشرات أو مئات الألوف، تتراءى لى حركات الشابات لاعبات القوى، وأرقام الفوز تـحـسـب بجزء من الثانية. لم ذاك يا بناتى الحلوات؟ تفوز الواحدة منكن بفارق يصل إلى جزء من عشرة من الثانية؟ هذا ليس لعبا، هذه صفقات (بيزنس). أى قسوة يسمونها تدريبا؟ وأى منافسة يسمونها لعبا؟! “إخص” اللعب خيال جامح، نشاط حر، فرحة فى ذاته وليس فى نتيجته، معية زائطة، إنزلى يا بنت أنت وهى حتى نرقص ونلعب معا دون شقاوه، نحتفل معا بأى كلام، المهم نحتفل بعيدا عن سوق النخاسة ومزادات أجزاء الثانية. تلك الهيجة البهيجة الراقصة المضيئة لا تعرف من الذى يديرها. هل يمكن أن نكون قد استطعنا أخيرا أن نلعب هذه الليلة معا، فعلا، نلعب بجد. هل يمكن أن يسمح السادة فى البيت الأبيض أو السراى الصفراء أن يلعب العالم دون إذنهم ودون عائد عليهم؟ طبعا لا، إذن فهو “بيليى”. بيلى من يا جدع أنت،؟ كل حاجة كلينتون، بيلي؟ بطل تفكير تآمري. يعنى تريدنى أن أصدق أن ناس العالم الطيبين ـ نحن ـ هم الذين قرروا الاحتفال بالتخلص من هذه التسعات اللحوح “قبل الهنا بسنة” أعنى: بيوم واحد. والله فكرة!! لماذا ننتظر يوما آخر؟ ثم من أدرانا أن الألفية الأولى قد بدأت فى ميعادها؟ إن كل ما هو تاريخ هو مجرد لعبة وثائق خائبة، تبرر عجز الإنسان أن يكون كذلك. -12- أين ذهب رفضى؟ كيف ذابت مقاومتي؟ أنا لا أستطيع أن أشارك فيما ليس لنا، فيما ليس نحن، لماذا نتركهم يقررون لنا متى بدأ التاريخ، ومتى ينتهي؟ فوكوياما يعلن عن نهاية التاريخ، وهاهم يذكرونا ببدايته التى قرروها بغير استئذان من أصحابها، نعم هم الذين فرضوا علينا ما يجرى هكذا، وليس نحن ناس العالم الذين قررنا أن نلعب سويا. -13- أدخل مترددا إلى حجرة حضرة الناظر لآخذ إذنا أن ألعب فى الخمس دقائق التى بين الحصص، التى بين العقدين، التى بين القرنين، التى بين الألفيتين، يصرفنى الناظر وهو يضحك دون سخرية، أسأل الفراش لماذا كان يضحك حضرة الناظر، فيخبرنى بإجابتين، الأولى: لأن اللعب لا يتطلب إذنا، والثانية: لأنه لا توجد فواصل بين أى وقت وأى وقت. نحن الذين ابتدعنا الفصل بين أى شيء و أى شيء، كله متصل بكله، ونحن الذين نوقف الحركة اصطناعا لنتأمل، ونأمل، لعل وعسى،من يدري؟ -14- أدركَ التلفاز الصغير القابع فى زاوية الحاسوب الصباح، فسكت عن الاحتفال المباح، فعاودتنى التساؤلات والمراجعة. يبدو أننى سـُرِقت مثل غيرى، والذى كان قد كان. أحسن. -15- الألفية الثالثة لم تبدأ بعد، والمسألة لا تحتاج إلى مناقشات وإثباتات، لكن للأمر دلالات مطـمــئنة، ذلك أننا أثبتنا نحن البشر (حلوة هذه) أننا حتى لو استدرجنا إلى ما لم نقرره، فإن اتفاق الناس أهم من حسبة الأوصياء. مرة أخرى، “علينا وعليهم”. -16- مدرسة رياض الأطفال بالمعادى، كى جى تو، زفتا، بركة السبع، “سلطانية مهلبية، بابا قال لى عدّ الميّه، عشرة عشرين تلاتين اربعين… سبعين تمانين تسعين ميه”، فسنة ألفين ليست هى، مرة أخرى: فلماذا يعايرونا فى مسألة تحديد رمضان والأعياد؟ لماذا نسوا أن اتفاق الناس وتوثيق العلاقة بالطبيعة أهم من أى علم للفلك أو الحساب أو المنطق؟ -17- يرفع لى أرسطو([3]) حاجبيه فأنهره وأعايره أن منطقه هذا هو الذى أخر مسيرتنا نحن البشر ألفيتين بالتمام، يـلـعــب لى حواجبه وهو يغمز بإحدى عينيه، فأضطر أن أخرج له لسانى، وأنا استغيث بصديقى فون دوماروس([4]) الذى لا يعرفه أحد، مع أن صديقنا المشترك سيلفانو أريتى([5]) هو الذى أبلغنى وجهة نظره، كان أريتى وقتها يدافع عن منطق المجانين الأعمق مستشهدا بفون دوماروس. -18- أقول لشيخ الأزهر التنويرى الطيب: إن الدين يا مولانا لن ينقص أو يزيد إذا نحن صمنا يوما زيادة أو يوما ناقصا، إن المهم هو احترام اتفاق الناس وتوثيق العلاقة بالطبيعة، علينا أن نحافظ على علاقتنا مباشرة بالله سبحانه، وبالطبيعة الأم، بلا وصاية آلات، أو حسابات، ثم ها هو العالم كله يتفق على “أنه: “هو ماله”؟ (يقصدون أرسطو، أو مرصد حلوان). يا عم أرسطو، يا سيدنا أرسطو، الله يخرب بيتك. يا فضيلة المفتى، يا مصطفى يا محمود، إن الناس يا مولانا إذا أجمعوا على خطأ فقد يكون أصوب من أى صواب. لم لا؟ -19- تنتهى الاحتفالات فى جزيرة “سماو” فيعاودنى التفكير التآمرى الذى هو ليس تآمريا: من يا ترى هذا الذى ضحك على العالم هكذا، لتحديد هذا الوقت بالذات؟ أقصد من ذا الذى قرر ميعاد اللعب، ومكان اللعب، وطريقة اللعب؟ ليس مهما أن نجد إجابة، وليس لائقا أن نتهم أمريكا مثلا ـ كما اعتدنا ـ بأنها وراء كل هذا الملعوب، المهم أن هذه الشائعة (أن الألفية الثالثة بدأت)، مهما كان مصدرها، قد سرت بسهولة خطرة بين بقاع العالم لمدة عام أو بعض عام (على الأقل)، حتى صدق الناس أنهم يمكن أن يكونوا “معا”. يا عم فهمى يا هويدى، يا دكتور عبد الوهاب يا مسيرى، هم يتحيزون لأفكارهم، وتواريخهم، وآثارهم، وأديانهم، ليكن. أليسوا أحق بنا منا، أكثر الله خيرهم أنهم سمحوا لنا أن نفرح معهم!!. -20- تقفز الست مونيكا من الشاشة وجسمها البض يملأ فراغ الحجرة كله، زاد وزنها سبعين كيلو جرام فظهرت معالم الزيادة داخل الملاءة اللف التى لا تعرف كيف تستعملها فتقع منها كل خطوتين وهى تتعثر، فلا أبتسم ولا أشمت، لكنى ألمح سهير البابلى وقد ضربت لخمة فى قسم اللبان([6]) حين لم تستطع أن تحكم الملاءة عليها فصاحت فيها: “روحى كتك نيله وأنا مش عارفه وشك من ظهرك” لم أعرف إن كانت تخاطب الملاءة أم تخاطب مونيكا التى رعبت منها رعبا ليس له مبرر، فراحت تتراقص رغم حجمها ولزوجتها. يا بنت يا سهير لم فعلتِ ما فعلت؟ أيرضيك أن تتركى لنا هذه الفيلة “مونيكا” تلعق بقايانا الهامدة، وهى إنسانة خاوية مثل طاحونة مهجورة؟ طيب الله يسامحك يا سهير يا بابلى. أنت السبب. فى ماذا؟ لا أعرف. -21- ماذا يا سهير لو أنهم استعملوا نفس الأداة لتسويق وترويج أفكارهم الأخرى، فراحت تسرى بين الناس، كل الناس، بهذه السرعة فصدقوها، فصدقناها بنصف وعى، أو حتى بدون وعى، حتى أصبحت أى فكرة يروجونها حقيقة أكبر من أى حقيقة موضوعية. تقولين أن هذا هو الحادث فعلا؟ لا يا شيخة؟ يرقص الناس ويغنون معا فى توقيت ليس هو، “قبل الهنا بسنه”، أعنى قبل الهنا وخلاص!! هذه المرة جاءت سليمة، ولعبناها خطأ معا، لكن ما العمل والسائق مجهول، والوقود غير كاف، والأفكار ليست واضحة ولاجيدة، وكيف نحول دون أن يسربوا لنا أفكارا أخرى تخرب بيوتنا وعقولنا معا؟ أنا مالى، ننقرض جـمـعا كما لعبنا جمـعا. حين تهاجمنى فكرة الانقراض هذه، أتصور أننى أمثل النوع البشرى كله، يا ذى الفضيحة، ألا أخجل؟ لكنها حقيقة، حين أتأمل الأفكار المتسربة عن الرفاهية، وعن الديقراطية، وعن ”سيدنا” “العلم المؤسسى”، وعن الشذوذ الجنسى. أتحسس رأسى، وأهرش فى أجزاء خاصة من جسمى، وأتجرع بعض ما تبقى فى إناء “المخلل” بعد أن اختفت محتوياته الصلبة، وأمنع نفسى عن التعليق. -22- أصرخ بالمخرج معتذرا أنْ سامحنى، وأنها آخر مرة، كومبارس كومبارس، لكننى مهم فى خلفية المشهد، أقسم له أننى لن أفعلها ثانية، يطيـّـب توفيق صالح خاطرى، ويطمئننى أننى لم أخطيء فى اللقطة ولا حاجة، لأنه ليس لى دور أصلا فى هذا الفيلم، يعدنى توفيق صالح أن يبحث لى عن دور مناسب فى الفيلم القادم، وأعلم أنه يكذب رحمة بى، أشعر أكثر يقينا باقتراب نهاية النوع البشرى كله، مع أننا نحن البشر كان دمنا خفيف ولا يصح أن ننقرض هكذا بخطأ ما فى حسبة البقاء. لو كان عند الديناصور وعىٌ مستقبلى، ربما كان مازال معنا حتى الآن، أخاف منه مثلما كنت أخاف طفلا أن يلتهمنى “وابور الزلط”. -23- مع تسحب هذه السيرة، سيرة الانقراض، ومع هذا الرعب، رعب الفناء بخطأ غبى، يتسرب منى السماح الذى عشته بالرغم منى وأنا أشارك فيما جرى هذه الليلة دون استئذان. تصورتـُـنا ـ فرحا ـ عبر العالم ونحن نخرج لساننا جماعة لأى رقم فيه رسم تسعة، ثم هأنذا أتراجع عن اعتبارها لعبة فرحت أبحث عن أصل وفصل فاعلها، هل هى فعلا ملعوب وليست لعبة، ملعوب بفعل فاعل، والفاعل قوى ومجهول؟ لابد أنه فاعل يملك السلاح، والمال، وكل وسائل الإعلام مما نعرف، وما لا نعرف. -24- أريد أن أذهب للخواجة الذى عزمنى على الشراب أمس فى المطعم الصينى وأقبل رأسه و أنا أقبل دعوته. -25- لو أن أمريكا وإنجلترا وفرنسا، اتفقوا منذ عام أو بعض عام أن يقدّموا هذه الاحتفالات سنة كاملة بادعاء أنهم يسايرون العلم والموضوعية، هل كان يجرؤ أى واحد غيرهم أن يعملها؟ هل كانت كوريا أو نيجيريا، أو حتى الهند الذرية تجرؤ أن تحتفل وقتما تشاء؟ تنضم مصر أم الدنيا إليهم، مصر جاهزة للانضمام طول الوقت “سنتنضـم”([7]) حالا، دقيقة واحدة، هل كان سيستجيب لنا أحد إذا قلنا أننا سنحتفل مبكرا عاما لمجرد أن سنة2000 دمها أخف، ومنظرها أجمل، وأننا زهقنا جدا من حكاية ألف وتسعمائة وكذا هذه، لو حدث ذلك لفتحوا علينا نار السخرية والاتهام بالجهل والتخلف، واتهمونا بقلة حقوق الإنسان، وقلة العلم، وقلة العولمة، والسفالة، لكنهم لا يستطيعون أن يتهمونا بقلة الذرية أو الضعف الجنسى. -26- أخرج لهم لسانى ولا أجرؤ على التصريح باتهامهم بالعجز الجنسى مع أنى أعرف الكثير، خل الطابق مستور. أقفل نافذة العالم التكنولوجية التى فـرضـت على، وأتاحت لى، فرحة المشاركة، وفكر التآمر معا. -27- أكتب مقالا للأهرام ([8]) أقول فيه أن المسألة كانت لعبة طريفة، وأننى كنت مخطئا، وأن من حق الناس فى كل مكان أن تفرح وقتما تريد، حتى لو لم تعرف من ذا الذى يحركها. فقط علينا أن نأخذ الحذر، و أن نتدبر الأمر، وأن نؤكد على هـويتنا المميزة، وكلام ماسخ من هذا، كلام أعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر. كلام مثل عدمه، لكننى أكتبه، وهات يا واحد اثنين ثلاثة، إبرة الخـياطة… -28- أتساءل عن عدد الذين سوف يقرأون هذا المقال، وعن جدواه، وعن لزومه، أتجنب التمادى فى التساؤل، كما أتجنب محاولة الإجابة. أخاف لو أننى صدقت فى الإجابة أن أمزق ما كتبت. هل أنا أضحك على نفسي؟ أبرر وجودى بمثل هذا الذى أكتبه. فى حماس طفلى لا يهمد، وكأن أحدا ـ يهمه الأمر جدا ـ ينتظره فعلا؟ تصعب علىّ نفسى، أكتشف أنه ليس لى فى الأمر شىء. أحسن. تصبحون على خير (ما أمكن ذلك). ****
[1] – مجلة سطور: (عدد مارس – 2000) كتبت هذا المقال احتجاجا بمناسبة الاحتفال العالمى “المزيف” بدخول العام الجديد: عام 2000 قبل توقيته بيوم واحد (هكذا بالعافية!!) [2] – كنت قد استلهمت هذا الحدث وكتبت مقالات فى الأهرام: 2-7-1999 بعنوان “البعد الإيمانى ومستقبل البشرية (مستقبلنا)” فإذا بالصديق (الحرفوش) توفيق صالح يعجب به ويدعونى للكتابة أوسع فى هذا الموضوع فكان دافعا لى أن أكتب الجزء الثالث من روايتى المشى على الصراط بعنوان “ملحمة الرحيل والعود” الطبعة الأولى 2007، الطبعة الثانية 2017 [3] – يراجع فكر أرسطو ومنطق أرسطو بصفة خاصة ومدى إعاقته للتفكير البشرى طوال ألفيتين. [4] – ظهر منطق “فون دوماروس” سنة 1947 ليتناقض مع منطق أرسطو ليثبت أن الشئ يكون نفس الشئ وضده فى آن …. إلخ. [5] – سيلفانو أريتى طبيب نفسى أمريكى مبدع، صاحب كتاب “تفسير الفصام” والمحرر الأول للكتاب الأمريكى للطب النفسى فى السبعينات والثمانينيات وهو الذى تبنى منطق فون دوماروس ووظفه فى فهم لغة الفصامى وغائيته ومن ثم فهم “إرادة المجنون واختياراته وموقفه” [6] – إشارة إلى مسرحية “ريا وسكينة”. [7] – إشارة إلى يونس شلبى فى مسرحية “مدرسة المشاغبين”. [8] – مقال الأهرام بتاريخ 18-1-2000 نشر بعنوان: “ماذا بعدما لعبنا معاً لعبة الألفية” بعد مناقشة فكرة موضوعه مع الصديق “توفيق صالح” أولا: اقترن لفظ التفكير – حديثا – بلفظ العقل، فى الوقت الذى أخذ فيه لفظ العقل قدرا من الاحترام والتقديس بما بستحق وما لا يستحق، وقد تم ذلك بتبرير مناسب، ألا وهو محاولة مواجهة الخرافة والتخلف، إلا أنه كان من بين النتائج التى ترتبت على هذا التقديس أن اختزلت أو استبعدت طرائف ومناهل المعرفة الأخرى (التى لا تتفق مع التعريف المحدود لما هو “عقل” أو ما هو “تفكير”). ثانيا: شاع بين علماء النفس تعريف للتفكير بأنه “حل المشاكل” Problem Solving، وعلى الرغم من أن حل المشاكل قد يمتد إلى أعماق أخرى تتجاوز ما يتواتر إلى الذهن لأول وهلة، إلا أن ذلك المعنى المباشر لما هو “حل للمشاكل”، ظل يعتبر مرجعا عند أغلب المشتغلين بعلم النفس، كلما ذكرت كلمة “التفكير”، حتى كاد يقتصر على ما يشبه ألغاز الشطرنج أو أحاجى الحاسوب. ثالثا: اقترنت كلمة التفكير بما يشبه المقابلة مع ما هو انفعالى أو عاطفى أو حتى وجدانى، فزاد هذا المنطق الاستقطابى (التفكير، ضد = فى مقابل، الانفعال) زاد من فصل التفكير عن كلية الوجود. رابعا: استقلت كلمة “التفكير” عن كل من “الوعى” و”الثقافة”، ولا أعنى بالاستقلال هنا: الانفصال، وإنما المقصود هو أن الكلمة أصبحت تصف ظاهرة أكثر تحديدا، وأكثر قابلية للدراسة التجزيئية المنظمة عن كل من كلمتى “الوعى” و”الثقافة” إلا أن هذا الاستقلال تمادى حتى أصبح تفضيلا وتفوقا. خامسا: ترادفت كلمة التفكير، فى كثير من الأحيان مع، ظاهرة العقلنة (أو الذهننة Intellectualization) والتى اختلطت بدورها بلفظ التفكير العقلى، فى حين أن العقلنة ليست إلا حيلة دفاعية تستعمل المنطق المعقلن كمهرب بعيدا عن التواجد البصيرى المشتمل. سادسا: تفاقم سوء فهم عبارة ديكارت “أنا أفكر فأنا موجود”، إلى اختزال الوجود إلى ما هو تفكير، إلى ما هو عقل كما شاع عنه، وتضمن ذلك استبعاد “ما ليس كذلك”. وقد انتبهت إلى هذه المغالطة يوما وأنا أحاور مريضا فصاميا (حتى أننى تقمصته احتراما فكتبت فى كتابى “حكمة المجانين (1972)، أنا أفكر فأنا غير موجود([2])، ثم أضفت من عندى: لا تفكر، ولكن: استعمل التفكير!!!) سابعا: استُعملت كلمة التفكير كمرادف لكلمة المعرفة Cognition، فاختزلت كلمة المعرفة إلى ما هو تفكير منطقى عقلانى خطى، مع أن المعرفة أشمل وأكمل. وبعد فإننى سوف أكتفى بهذا القدر من مظاهر إشكالة مفهوم: “ما هو تفكير”، وأستطيع أن أطمئن إلى كفايتها للتنبيه إلى ضرورة مراجعة الموقف برمته، ذلك أن المسألة ليست مجرد ترادف خاطئ، أو تدخل عفوى ملتبس، وإنما وراء هذا الخلط والتداخل احتمال خطإ منظم جسيم قد تترتب عليه تداعيات منذرة. ذلك أننا إذا أهملنا “ما ليس كذلك” (ما ليس تفكيرا كما نتصوره)، أو تصورنا أن “ما ليس كذلك” يقوم بوظائف أقل أهمية فى تشكيل وعينا وتوجيه مستقبلنا نكون قد وقعنا فى خطأ تطورى مهدد للنوع البشرى بأكمله. وأضرب لذلك مثالا شائعا : إن من بعض مظاهر هذا الاختزال أو الاستبعاد (بحسن نية، أو سوء حسابات) هو أن نقصر استعمال الدين والتدين – مثلا- باعتباره نوعا من النشاط الطيب الذى يمارس بعض الوقت (فى عطلة نهاية الأسبوع مثلا، أو قبل النوم وبعد الأكل!!) ليفيد فى جعل قلوبنا بيضاء !!! (نحب بعضنا البعض فى بله كاذب)، دون أن نستلهم من تاريخ النزوع الدينى والمعرفة الإيمانية معرفة تساهم فى الحفاظ على بقائنا، وتطوير وجودنا. ومثال آخر: حين نستعمل الإبداع الفنى ليدغدغ الجمال، ويريح البال، ويفرغ الطاقة (التطهير)، دون أن ندرك دوره المعرفى وخطورته فى تشكيل الوعى، ودفع عجلة التطور إلى الأرقى والأكمل وجودا وإحاطة. الفرض: الفرض الذى أطرحه فى هذه المداخلة يقول: إن ثم خطأ تطوريا يتعرض له الجنس البشرى نتيجة لترجيحه نشاط جزء من تركيبه على سائر الأنشطة الأخرى، ذلك أن هذا الترجيح يجعلنا نقوم بتنظيم حياتنا تبعا لما يصل إلينا من معلومات نتعرف عليها أساسا أو تماما من خلال عمل هذا النشاط المميز (المسمى التفكير)، على حساب استبعاد، أو التهوين من شأن، الجارى على مستويات أخرى من جدل حيوى مع الطبيعة الداخلية والخارجية من ناحية، ومع التاريخ والمستقبل من ناحية أخرى. وفيما يلى بعض هذه المنطلقات، بما تحمل من إنذارات، وما تحفز من مراجعات: أولا: من منظور تاريخى 1) من منطلق حسابات وتاريخ التطور: تاريخ الإنسان ليس تاريخ التفكير، وإنما هو “تاريخ التلاؤم مع المحيط” مستعملا كل إمكاناته البقائية والتطورية، بما فى ذلك – مؤخرا – “بيولوجية التفكير”، فإذا كان تقدير عمر الكون يتراوح من 9 إلى 20 بليون (ألف مليون سنة)، وعمر الأرض يقدر من 4 إلى 6 بليون سنة.، وعمر الحياة على الأرض من 1 إلى 2 بليون سنة، فإن عمر الإنسان يدور حول 600000 سنة فقط، وبالتالى فإن حسابات التطور التى تجرى بمقاييس عقل الإنسان وحده، وحاجاته، وتوجهاته، ثم تحاول التخطيط لمستقبله ولا تضع فى اعتبارها تاريخ الحياة قبله ومعه، هى حسابات تحتاج إلى وقفة فمواجهة. وبالنسبة لما هو إنسان فإنه يمكن إرجاع جذور السلوك التدينى إلى حوالى 100000 سنة وذلك قبل نشأة اللغة التى يقدر عمرها بحوالى 100000 سنة، فى حين لم يمض على أكثر الديانات المعاصرة انتشارا (أو أشهرها بالنسبة لنا) سوى ألفان، وألف ونصف من الأعوام بالنسبة لكل من الديانتين المسيحية والإسلام على التوالى، أما عن عمر العلوم الحديثة التى تحاول مؤخرا صياغة مستقبلنا وحدها (تعسفا) فهو لا يزيد عن قرن (إلى قرن ونصف) على أحدث الافتراضات، وقد تسارعت إنجازات ما يسمى العلم الحديث (وهو مرتبط ومقترن غالبا مع الشائع عن العقل والتفكير) فى الأربعة عقود الأخيرة بما لا يقارن بتاريخ إنجازات العلوم المعروفة طوال التاريخ. ب) مثال من تطبيق فكر صحيح (الفكر الماركسى) منذ أوائل هذا القرن (باعتبار سنة 2000 هى آخر سنة فيه) حتى قرب أواخره، جرت تجربة محددة لتطبيق إنجاز رائع للعقل البشرى فيما يتعلق بالتفسير المادى للتاريخ، وما يترتب على ذلك من احتمالات تطبيق العدل وإطلاق مسار تطور الإنسان، ولايستطيع حكم عدل أن ينكر، مهما بلغ، تحيزه، أن هذا التفكير هو صواب فى صواب بدرجة تقترب من الكمال، من أول تفكير ماركس الباكر حتى تفكير المجددين المحدثين من الشيوعيين المخلصين، وقد شمل هذا التفكير بعض المراجعات الحصيفة التى حذرت من، حتى ألغت، دور الدين، (مغفة ارتباط النزوع التدينى بالتاريخ الحيوى المرتبط بالحاجة إلى الأدمان)، كما استهان هذا الفكر بدور الحافز الشخصى للتملك (مغقلا ارتباط ذلك بالتاريخ الحيوى أيضا الناتج عن التهديد بالموت جوعا والمرتبط باللا أمان الأساسى فى الوجود) إلى آخر مثل ذلك. ثم إن هذا التفكير السليم جدا (والذى ما زال سليما) قد طبق بكل حماس، وقتل، وإخلاص فى واقع الإنسان لعدة عقود، فى أكثر من موقع جغرافى، وقد فشل للأسف فشلا خطيرا، وقيل فى تفسير ذلك كلام كثير كان من أهمه مراجعة الفرق بين النظرية والتطبيق، ومع كل هذا الفشل، لا يستطيع إنسان أن يدعى أنه تفكير خاطئ أو فاسد، فهو لم يرجح ظلم الإنسان لأخيه الانسان أو يجمـّل استعمال إنسان لإنسان آخر كأداه لرفاهيته، أو يبرر الاستهلاك للاستهلاك أو لمجرد التميز، أو يدعو إلى الاغتراب، أو يتجاهل الإبداع، لم بفعل أيا من هذا بل نادى بعكسه الجميل، ومع ذلك فقد فشل وسيفشل، كما سيفشل التفكير اللاحق الذى حل محله شامتا وهو يعلن ببلاهة صادقة: نهاية التاريخ، (فوكوياما)([3]) أو حتمية سيادة السوق، أو تمادى صراع الحضارات، نعم سوف يفشل حتما مادام لم يضع – هو الآخر – فى اعتباره تاريخ تطور الإنسان ووسائل تكيفه قبل، وبعد، ومع ما يسمى : “التفكير”. ثانيا: من منظور تفسير الدين بالعقل (بالتفكير) إن فشل التفكير الماركسى على أرض الواقع، والفشل المنتظر للتفكير العولمى التسويقى المنتظر هو دليل على أن إغفال التاريخ الحيوى، أو على أحسن الفروض التهوين من دوره، هو كارثة تطورية بكل معنى الكلمة، ولتوضيح بعض ذلك نضرب مثلا واضحا لإهمال تاريخ النزوع الدينى مثلا عبر 300 ألف سنة واختزاله لحساب التفكير المعقلن الحديث تحت ما يسمى تفسير الدين بالعلم (أو بالعقل). بلغ من سذاجة بعض المتدينين، وحرص البعض الاخر على دينهم فى لهفة دالة على شعور بالخجل أو النقص من كونهم متدينين، أن اندفعوا يبررون تدينهم بما يتصورونه عقلا أو تعقلا أو علما، وذلك بمحاولة تفسير الدين جملة وتفصيلا بما أسموه عقلا، وهو ما ظهر أنه مرادف عندهم لإعمال التفكير المنطقى أحادى البعد، أو تقديس العلم الشائع المتاح المحدود المنهج. فانتشر ما يسمى التفسير العقلى للدين، (والمتجسد مؤخرا فيما يسمى: التفسير العلمى للقرآن، كمثال) حدث ذلك بعد أن شاع أن ما لا يوافق العلم، مما نضطر للتمسك به، لا بد أن يحشر حشرا فيما هو أبجدية العلم “المتاح”، كما لابد أن يقرأ من خلال نص التفكير المعقلن. وقد ترتب على ذلك أن اختصر الدين إلى قشور العلم. هذا موقف لا يضيف شيئا إلى الدين حتى لو أعلن أسبقية الدين فى بعض الرؤى الحدسية، ولا يأخذ شيئا من الدين، لا من تاريخه ولا من خصوصيته، ولا من عطائه ووظائفه. ثالثا: من منطلق الدراسات اللغوية والنقدية إن المتابع للتطورات الأحدث فى علوم اللغة وعلوم النقد (الأدبى) لابد أن يطمئن إلى صحوة الوعى البشرى قليلا أو كثيرا، لما يتهدده من خلال تضييق مفهوم العقل واختزال مفهوم التفكير، وتكفى هنا الإشارة إلى الإضافات التى أضافتها دراسات سيميولوجيا اللغة، وكذلك الحركة التفكيكية فى النقد الأدبى، حتى نطمئن إلى يقظة الوعى البشرى إلى ما يحيط به من مخاطر الاختزال والاستسهال، إذا ما استسلم للحاضر الواضح تحت أى اسم براق، حتى لو كان هذا الاسم هو “العقل”، أو التفكير المعقلن. رابعا: من منظور المدارس النفسية حتى فرويد الذى أضاف برؤيته إلى فهم ما هو إنسان إضافة دالـّة من حيث تأكيده على تضاؤل دور العقل الواعى أمام سطوة اللاوعى، حتى فرويد انتهى إلى حتم وصاية الوعى المفكر (العمليات الثانوية Secondary Processes) على حركة اللاوعى الدوافعى (العمليات الأوليةPrimary Processes ) فكادت تتوارى عبقرية اكتشاف لغة الحلم التصويرية والكلية والتكثيفية فى محاولاته الحتمية لترجمة الحلم وتفسيره الرمزى التعسفى. وظل الأمر كذلك حسب قول فرويد “حيثما تكون الـ ” هى Id: يكون الـ “أنا” Ego، حتى نبه سيلفانو أريتى إلى أن التفكير الإبداعى إنما يتم بالتوليف بين هذه العمليات جميعا بما أسماه “الولاف السحرى”([4]) The majic synthesis” وهو ما يعادل ما أسماه “العمليات الثالثوية” Tertiary processes وبهذا أضاف أريتى نوعا من التفكير الذى ليس منطقيا أرسطيا من ناحية وليس عشوائيا خرافيا من ناحية أخرى، بل إبداعا متميزا. ثم تتعدد المدارس الموازية لتؤكد على تعدد الذوات (بوجه خاص مدرسة التحليل التفاعلاتى لرائدها إريك بيرن)([5]) كما تؤكد على حق كل “ذات” فى القيادة بالتبادل مع الذات اليافعة المبرمجة عقلانيا (=الذات “اليافع” الواقعى) فى هارمونية محسوبة واتساق مناسب، وبالتالى تفتح هذه المدرسة الباب لفهم مشروعية نسبية للتفكير الطفلى (عند الناضج) والتفكير الحكيم (عند الطفل) كأمثلة كما أن هذه المدرسة تشير إلى أن مسار النضج المستمر إنما يتوجه إلى “الولاف الأعلي” بين الذوات إلى ما أسماه الناضج المتكامل Integrated Adult، وقد اعترف إريك بيرن أن هذا المفهوم الأخير غامض بالنسبة له، ذلك ربما لأنه غاية أكثر منه واقع ماثل، ولأنه حالة من التكوين المستمر، أما نوع تفكير هذه الذات “الناضج فى تكامل” (كما عدلت اسمه) فهو أقرب إلى العمليات الثالثوية (الإبداعية) التى أشرنا إليها فى فكر سيلفانو أريتى. وأخيرا فإن المدرسة المسماة “علم النفس عبر الشخصية” تؤكد على نوع من التفكير التجاوزى، فى مرحلة تجاوز تحقيق الذات إلى ما هو عبرها نحو الامتداد فى الكون الأعظم، مما يفتح الآفاق لتفكير أعلى لا يخضع لمنظومة وصاية “التفكير العقلانى” بالمفهوم الغالب. خامسا: من منطلق بيولوجى تستعمل كلمة بيولوجى – فى الأغلب – استعمالا مختزلا باعتبار أنها مرتبطة أساسا بالكيمياء الحيوية والمحسوسات الفيزيقية المتعينة، إلى أن استعمالها الأصح والأشمل هو أنها تتعلق بما هو حيوى (تطورى تكاملي) ومن هذا المنطلق توجد مداخل كثيرة تطمئن القاريء إلى أن فريقا من العلماء والمبدعين والعارفين لم يستسلم للاخترال الشائع لما هو تفكير باعتباره المصدر الأساسى للمعرفة، فراح يفتح الباب لتأصيل فهم المسار الحيوى للحياة برمتها، وبالذات للنزوع الدينى/الإيمان. وأكتفى هنا بثلاث أمثلة ذات دلالة: أولا: الأسس التطورية النيورو- بيولوجية للتدين/الإيمان لم تنكر – حسما – نظرية التطور دور الدين فى الحفاظ على فكرة الانتقاء “الطبيعى، فالشاذع أن داروين وحده هو صاحب هذه النظرية([6])، والزعم الغالب هو أنه كان أكثر ميلا إلى انكار الدين ونفى الخالق بتأكيده على الطبيعة التكيفية الانتقائية لمسار الحياة، إلا أنه لم يكن وحده صاحب كشف نظرية التطور الانتقائية التكيفية، ففى نفس العام (1871) شاركه فى الكشف “ولاس” (المنسى والمهضوم حقه) الذى كان يرى أن ثمة إعدادا مسبقا مسلسلا للتكيف يجهز لصلاحية البقاء للحفاظ على الأنواع الأرقى، وبالتالى أن ثمة معد لذلك (الوعى المطلق: الله) وهذا قد يعنى أن الجهاز العصبى أو أى تنظيم حيوى فى الدماغ البشرى هو مهيأ من قديم لتلقى هذا الإعداد والتواصل مع هذه القوة/الوعى الأعلى، وعلى ذلك فإن هؤلاء المتبقين للبقاء – من وجهة نظر “ولاس”- مجهز عندهم الدنا DNA لإظهار السمات اللازمة لاستمرار التكيف والتطور فى بيئة وظروف جديدة ومتجددة تسمح بظهور أنواع متطورة أرقى فأرقى، وفى المقابل فإن الأنواع التى حرمت من هذه الاستعدادات لا تستطيع أن تكمل فى ظل نفس الظروف، وعلى ذلك فإنها تتوقف أو تنقرض، وعلى الرغم من أننى لست متحمسا لمثل هذه التأويلات تبريرا للدين أو دفاعا عن التطور، إلا أننى أوردت هذا الرأى الآخر لنظرية التطور لأظهر كيف أن العلماء لا يتوقفون عند تفسيرات منطقية متعجلة، وأن احترامهم لحدس الجموع من ناحية، وللتاريخ من ناحية أخرى يجعلهم يحاولون إضافة ما – إضافة تبدو متعسفة أحيانا ومنطقية أحيانا أخرى – وذلك فى محاولة المواءمة بين رؤى ومعلومات نظرياتهم الأولية وما يغلب عند الناس ويؤيده التاريخ. وقد حاول بعض العلماء ربط بعض ما لاحظوه من سلوك الحيوانات باعتباره الجذور الأولية للنزوع التدينى، فلاحظوا أن الأفيال والذئاب والشمبانزى تمارس نوعا من الطقوس المنتظمة بشكل جماعى أثناء العواصف والرعود، وهذا يكاد يشيه ما يقوم به بعض البدائيين فى مثل هذه الظروف، كما أن هذه الفيلة والذئاب والشمبانزى تدفن جثث موتاها، أو بقايا هياكلهم كما يفعل الإنسان. كذلك درس فريق ثالث سلوك بعض أنواع الإنسان الأول (البليوليثيك) الذى عاش فى أوربا والشرق الأوسط من ثلاثمائة ألف سنة قبل الميلاد، حيث ترك لنا ما يشير إلى أنهم كانوا يدفنون موتاهم فى وضع النوم مما يشير إلى احتمال إيمانهم بالحياة الآخرة، كما كانوا يضعون حولهم قرون الماعز فى شكل دائرة ومعها بعض جلود الحيوانات، وبعض الأدوات الحجرية والزهور. (مما امتد وتعمق فى طقوس الخلود عند قدماء المصريين)، وعلى ذلك فمن المحتمل أن هؤلاء البشر الأول (300.000 سنة ق.م.) كان عندهم عواطف ومشاعر قوية وشديدة تجاه ما هو روح مطلقة أعلى، وما هو الحياة بعد الموت، وما يصاحب ذلك من آمال ومخاوف تتعلق بهذه المعتقدات. على أن أحدا من العلماء لم يستطع أن يحدد اللحظة التى يمكن أن نتصور أن الإنسان أصبح فيها على وعى بوجود الله، (أو الروح الأعظم). ثانيا: محاولة تحديد المخ الحوفى Limbic Brain كمركز أساسى للخبرة الدينية لم يستبعد العلماء احتمال وجود شبكة نيورونية قادرة على استقبال الأنماط والأشكال الهندسية المرتبطة ارتباطا شديدا باللغة الدينية الكلية (والفنية لاحقا)، وهذه الشبكة لها محطات فى الفص الصدغى الأسفل، وفى اللوزة، وفى الحوفية، والمهيد – وحيث أن هذه النيورونات لها استجابات متعددة الأنماط فإنه يمكن أن يشمل ذلك بعض الوجدانات المتعلقة بالتدين، ومن الممكن أن تتمازج الأشكال الهندسية الرمزية مع الوجوه فيما يشبه الخبرة الصوفية العاطفية (التدينية) بشكل أو بآخر. على هذا الأساس، فقد حاولوا تفسير المستوى النيورونى لإدراك الملائكة والأرواح والأشباح بأنه يحدث من مدخلات من مختلف النيورونات فى مختلف أجهزة الدماغ كل منها يضيف بعض المميزات لما ينتج من إدراكات عاطفية (سمعية بصرية حدْسية إيمانية دينية). ويذكر كارل يونج ما يتعلق بهذا الاحتمال حين يقرر أنه بغض النظر عن الثقافة البيئة المحيطة، والزمن، فإن الهنود الأمريكيون الحمر والأفريقيين، والكرومانيين، والمصريين، والمسيحيين المحدثين، كل هؤلاء يرون الصليب بشكل متواتر راسخ فى خبرتهم الصوفية، ويعزون ذلك إلى خبرة كونية أو روحية فائقة الدلالة. وحديثا: فإن الأبحاث النيوروبيولوجية أثبتت أنه توجد نيورونات تطلق دفعاتها انتقائيا إلى أشكال بصرية هندسية تشبه الصليب أو المثلثات (الأهرامات) والوجوه، وهذه النيورونات تعرف باسم نيورونات الصليب، كما تسمى أيضا النيورونات الباحثة عن المعالم، حيث أنها يمكن أن تتعرف على الوجوه، والأشكال الهندسية وتستجيب بشكل دينى لذلك. وقد خلصت هذه الدراسات إلى احتمال أن يكون المخ الحوفى Limibic Brain هو الموقع المسئول عن الخبرات الدينية”، بالإضافة إلى مسئوليته عن بعض تلك الخبرات التى وصفها بعض من استعاد الحياة بعد أن عد ميتا بشكل أو بآخر، ومن هذه المحاولات والفروض والاجتهادات التأويلية يتنامى الحديث عن أمخاخ متعددة وليس مخا واحدا من بينها مخ القشرة الأحدث، والمخ الحوفى (الوجدانى الإيمانى التدينى) وغيرهما. ثالثا: تعدد الأمخاخ (الأدمغة) وتعدد التفكير إن التحدى الذى تواجهه هذه المداخلة لا يقتصر على رفض ترجيح أحد أشكال التفكير على ما عداها، أو ترجيح عمل مخ أحدث على مخ أقدم، وإنما هو ينبه أساسا إلى خطورة إنكار فاعلية دور المخ الأقدم فى كلية عمل الوعى البشرى الأحدث، وتأثير ذلك فى مسار تطوره، ذلك أن الأقدم لا يكون أقدم إلا إذا انفصل عن الأحدث واستقل وساد بصفة عشوائية (كما هو الحال فى الجنون) أما إذا كان المخ الأقدم كامنا فاعلا متبادلا متناغما مع الأحدث تطورا، فإنه لا يصبح الأقدم، وإنما يصبح المتضمن فى الأحدث الكلى، وليس الأحدث المغترب. ثم إن الخطأ الذى ترتب على الإعلاء من التفكير المعقلن لم يقتصر على استبعاد النشاط الأقدم بعد فصله تعسفيا ليصبح أقدم فعلا، بل إنه راح يستبعد نصف المخ الكروى الذى أسماه متنحيا مع أنه منظومة دماغية مواكبة فى مسار التطور لمنظومة النصف الكروى الذى سمى طاغيا (والذى أصبح مؤخرا النصف القاهر)، إن النصف (المخ/الدماغ) المتنحى يعتبر عضوا مستقلا بل إنه يعتبر كيانا متكاملا بشكل أو بآخر، وقد أدت الدراسات لكل نصف (مخ) على حدة، بالقدر الذى سمحت به الأدوات والفرص المتاحة، إلى التقرير أنه حتى ما يسمى بالمخ الأحدث المتمثل فى النصفين الكرويين (=القشرة)، ليس مخا واحدا، والأهم من ذلك أن كلا من النصفين (المخين) يفكر بطريقة مختلفة عن النصف (المخ) الآخر، يقول وكسلر (1980): إنه من المسائل التى شغلت فسيولوجيا الأعصاب طويلا: الأحقية النسبية لفحص نصفى الدماغ على مستويات متباينة. وقد قام بوجن قبل ذلك (1969) بفحص الفروق النوعية لعمل نصفى المخ سواء على المستوى التجريبى (فى الشمبانزى)، أو بالملاحظة الانتقائية فى الإنسان لبعض الحالات التى أصيب فيها أحد نصفى المخ دون الآخر، أو التى أجريت لها عمليات فصل النصفين الكرويين بشق الجسم المندمل (فى حالة الصرع) أو بإزالته فى بعض حالات الأورام. وقد انتهت معظم هذه الأبحاث والملاحظات إلى أن كلا من النصفين الكرويين له عمل مختلف نوعيا عن الآخر، كما ثبت أن تركيب كل من النصفين بالتشريح الدقيق بالفحص المجهرى الإلكترونى يشير إلى اختلاف تركيبى أيضا، وكذلك فإن المخ غير الطاغى (الأيمن فى الشخص الأيمن) متخصص أكثر فى النشاط البصرى، التصويرى المكانى وأيضا فى التفكير التربيطى، فى حين أن المخ الطاغى يختص بالتفكير التسلسلى والتجريدى وخاصة فى منطقة ”بروكا”، وأخيرا فإنه يبدو كذلك أن الاستجابة العاطفية فى كل مخ تختلف عن الآخر، وعلى ذلك فإن استعمال كلمة “طاغ” و”متنح” فى وصف كل من النصفين الكرويين هو استعمال قديم وخاطئ ويدل على طغيان غير مشروع وتحيز من جانب المنظرين إلى ما يعرفونه من تفكير عقلانى على حساب تهميش ما يعيشونه من تمازج خبراتى أشمل، ولهذا اقترحت أن يسمى النصف الطاغى بالمخ الترميزى أو المنطقى، فى حين يسمى النصف المتنحى بالمخ التركيبى أو التصويرى. تفاؤل حذر وخلاصة: على الرغم مما حفلت به هذه المداخلة من نقد وتحذيرات ومخاوف، فإن الوعى البشرى، بخبرته وحدسه وحساباته وإبداعاته ومعلوماته جميعا قد أدرك بشكل ما خطورة هذا الانحراف فى مسار الإنسان، وتصورى أن ما يجرى من استدراك وتعميق وتوسيع للمنهج وابتداع لغات أقدر على الإحاطة بالظاهرة البشرية فى كل مجال، هو مبشر بخير يمكن أن ينقذ الإنسان من التهديد القادم، اللهم إلا إذا بلغ عمى الساسة، والأصوليين من المتدينين والعلمانيين والتنويريين جميعا، مبلغا يحول دون أن تنقذ هذه الاستدراكات المعرفيه الرائعة الإنسان من الوصاية التعسفية التى تفرضها أخر عشرين قرن من الزمان على ستمائة ألف سنة من التاريخ، وقد يتمادى هذا العمى بخطأ تطورى عشوائى وارد، كما قد يأخذ دفعه وتبريره، بشكل خفى، من جشع الماليين الجدد الذين احتفظوا من التاريخ بعدم الأمان المتواصل الذى يبرر ما يجمعون، دون السعى إلى توفير الأمان ومقومات البقاء والتطور من واقع الامتداد فى الكون والتواصل مع البشر. خاتمة: بتفاؤل حذر: ثم أختم هذه المداخلة بعرض بعض ما يدعو إلى هذا التفاؤل الحذر وأخيرا وليس آخرا فقد يكون فى احترام تاريخ النزوع الدينى والنبض الإيمانى ودورهما الإيجابى فى مسيرة التطور البشرى ما يعفى العلماء المتدينين من اختزال ظاهر الدين إلى ما يعرفون، وأيضا ما ينقذ الدين من رجالاته الذين يصرون على تقزيمه فى ألفاظ معاجمهم، وأيضا على تبريره بظاهر عقولهم المتمحكة فى قشور العلم وظاهره، مع أن وظيفته التطورية، وحتى النفعية الحالية، تبدو أعرق وأقدر من كل هذه الوصايات اللاحقة. ****
[1] – مجلة سطور: (عدد أبريل – 2000) نقد لغلبة التفكير التجريدى البحثى (والتفكير المعقلن من منظور حسابات وتاريخ التطور، ثم تشويه الدين بتفسيره بهذا التفكير المحدود دون غيره من أدوات المعرفة، ثم من منظور الدراسات اللغوية، فالمدارس النفسية وأخيرا من منطلق بيولوجى لتفسير جذور التدين ويخلص المقال ليس إلى رفض التفكير المعقلن (والتجريدى) وإنما إلى ضرورة الانتباه إلى عدم الاقتصار عليه وعدم السماح له أن يصبح وصيا على غيره من أنواع التفكير الأخرى ومناهل المعرفة وأدوات الوعى، وقد يتم ذلك بالتبادل بعض الوقت ربما سعيا إلى تخليق جدلى محتمل قادم. [2] – يحيى الرخاوى: “حكمة المجانين”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، الطبعة الاولى 1972، الطبعة الثانية 2018 [3] – يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما، هو عالم وفيلسوف واقتصادى سياسى، مؤلف، وأستاذ جامعى أميركى. اشتهر بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير الصادر عام 1992، والذى جادل فيه بأن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة فى أنحاء العالم قد يشير إلى نقطة النهاية للتطور الإجتماعى والثقافى والسياسى للإنسان [4] – Silvano Arieti: (1976) Creativity The Magic Synthesis. Basic Books, Inc. Publishers، New York, p12.-13 [5] – التحليل التفاعلاتى والعلاج النفسى Transactional Analysis and Psychotherapy 1961 [6] – قمت لاحقا بمراجعة موقف داروين من هذه المسألة وكتبت نشرة بتاريخ 3-8-2014، بعنوان: “تشارلز داروين “جاب الديب: من بؤرة وعى إيمانه المعرفى” (وليس من “ديله”) الإنسان فى رحلته المحدودة كفرد، كما هو فى رحلته الممتدة كنوع، هو فى حركة دائمة، باعتبار أن السكون – طالما هو ليس أبديا وليس سلبيا – هو جزء من الحركة، هذه الحركة هى خارجية وداخلية معا، كما أنها مكانية وزمانية فى آن. الهجرة هى الذراع من الحركة الذى يدفع الإنسان أن يترك مكانه الأول (الأصلى/الساكن) إلى غيره (المختلف / الواعد). الذى شاع بيننا لاستعمال هذا اللفظ (هجرة) يجعل الهجرة حدثا استثنائيا، وقد يقصرها على ترك الوطن هربا من تخلف أو قهر، أو سعيا إلى رزق أوسع أو مجتمع أكثر انضباطا وإحكاما. يحدث هذا بصفة دائمة، أو مؤقتة، وهو يحدث نتيجة لطموح متنام، أو يأس جاثم. هذا المقال لا يقتصر على هذا النوع من الهجرة، وإن كان يبدأ به. كنت – وما زلت إلى درجة أقل- أحاور زملائى وأولادى وطلبتى وهم يعدون العدة للهجرة قائلا: إذا كانت بلدنا سيئة لا تناسب آمالك ولا تحقق طموحك، أو تستفيد من قدراتك التى لا تجد لها فرصة بيننا، وبذلك تقرر تركها وتركنا، فمن الذى سيصلح حالها؟ هل نستورد لها شبابا من الخارج (الآن: الصين أرخص!!) لهم قدرات فائقة وعقول مبدعة يصلحونها حتى ترضى أن تبقى بيننا؟ أما إن كانت بلدنا معقولة صالحة للاستعمال الآدمى!!! فلماذا تتركها؟ ولم أكن أقتنع بما أحاول أن أقنعهم به. المسألة هذه الأيام زادت ونـظمت بشكل يسمح للشك أن يتمادى حتى يصل الأمر إلى ما يمكن أن يسموه “تفكيرا تآمريا”، ليكن. المسألة أن نوعية موجات الهجرة الآن توحى بأن ثمّ إجراء يجرى لإعادة تشكيل العالم بحيث يعاد تمييزه طبقيا من جديد مع إعادة تعريف السادة والعبيد: الأقوى والأكثر ثراء وأوفر إنتاجا يتجمعون عبر العالم ليشكلوا صفوة ليس لها وطن، صفوة عابرة للأوطان، وعابرة للقارات، ومنفصلة عن الأرض، وعن الدول، أما بقية الناس فيعاد تنظيمهم ما بين العبيد الأحدث: للأعمال القذرة والاستهلاك، والعقول الأحذق: للاستعمال كأدوات بشرية لتحقيق المزيد من القوة والسيطرة. تقع ما بين هذا وذاك طبقات من المكتبيين والجنود والسماسرة والوسطاء. فى هذا النظام الجديد يتوجه الاستهجار (الدعوة إلى الهجرة فتفعيلها) من الشعوب والأوطان الفقيرة إلى هذين الفريقين: إما عقل يـُـستعمل بشرط ألا يستقل لنفسه أو ينفع ناسه دون أسياده، وإما جسد مطحون فى أدنى القاع يرضى أن يقوم عنهم بالأعمال القذرة التى يربأون أن يضيعوا وقتهم فيها، والتى لم ينجحوا أن يخترعوا آلات حاذقة بدرجة كافية لتقوم بها. الهجرة فى المحل أدْرَكَ كثير منا ما يراد بهم من هذا الاستهجار، فتحفظوا عليه، أو أغفلوه، أو عجزوا عنه، لكن ذلك لم يمنعهم من البحث – بوعى أو بغير وعى – عن بدائل مكافئة ، فلجأوا إلى بدائل تعويضية أو مكافئة، نجح هؤلاء أن يهاجروا وهم فى محلهم، وذلك باللجوء إلى عديد من البدائل أورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلى: أولا: ثمة هجرة تعليمية تجلت هذه الهجرة فى الإقبال على المدارس الأجنبية (التى يسمونها مدارس اللغات) سواء كانت برامجها “وطنية” (إسما) أو “عالمية”، هذه الموجة التى كادت تصبح قاعدة للقادرين ، تسحب الصغير من سن مبكرة إلى غير مكانه ، بعيدا عن أرضه، منفصلا عن ناسه، فيتشكل وعيه مخدوعا بالتلويح بالانتماء إلى هوية عالمية، لا يكتشف ميوعتها أو أنها بلا جذور إلا بعد فوات الأوان. ثانيا: ثمة هجرة جغرافية محدودة يبدو أن ما يسمى المنتجعات (والقرى) الجديدة قد استقلت بذاتها حتى صارت بمثابة أقطار ذات سيادة، بها من التقاليد والأعراف ما يجعل العائش فيها يكون جزءا من ثقافة فرعية لا تنتمى فى قليل أو كثير إلى ما يسمى الوطن. ثالثا: ثمة هجرة فئوية بعد اختفاء (أو خفوت) الوعى السياسى المشارك بالمعنى الحقيقى وليس بمجرد نشر كلمات لا تجد صداها إلى فى حبر الأوراق التى نشرت عليها، لجأ الناس إلى تكوين مجتمعات بديلة ،يتراوح حجمها من بضعة أفراد إلى تجمع مهنيين، إلى منتجعات شبه مغلقة، المفروض أن هذه التجمعات تتضفر لتصب بشكل هيراركى فى تجمعات أكبر فأكبر حتى تصنع الوحدة الضامة المتميزة التى اسمها “الوطن”، لكن الذى حدث أن هذه التجمعات أصبحت “بديلا” عن الوطن لا وحدات تسهم فى تشكيله، أصبحت ملاذا لهجرة محلية توهم أفرادها بالانتماء إلى الجزء دون أن ينتبهوا عادة إلى أنهم انفصلوا عن الأصل. هذا النوع من الهجرة يتضمن تشكيلات مختلفة، ليست متماثلة بالضرورة، إذ ليس من الضرورى أن يجمعهم فكر واحد، أو أيديولوجية واحدة، أو توجه واحد، الذى يجمعهم عادة إما مصالح متبادلة ظاهرة أو خفية، وإما ائتناس غامض يوهمهم بالانتماء إلى جماعة ما تمثل مهجرا بعيدا عن الإلتزام بالوطن الكل، وأحيانا عن “عامة الناس” يمكن أن تتضمن هذه التجمعات الصالونات الثقافية والتجمعات اللاحكومية حتى ثلل السلطة الظاهرة والخفية، التى ما زالت تتبادل الكراسى دون غيرها فى دائرتها الضيقة، مرورا بالنوادى والنقابات والتجمعات الأكاديمية المنتجة والصورية على حد سواء. رابعا: ثمة هجرة عقائدية/أيديولوجية الفرق بين اعتناق عقيدة ما، أو الانتماء إلى عقيدة ما، وبين الهجرة إلى فكر عقائدى هربا وأملا، هو أن الأخيرة تمثل حركة انسحابية أو شبه ثورية (أو ثورية) وهى تتصف بالنقلة المبتعدة عن الفكر السائد الفاسد (من وجهة نظر هذا الجذب العقائدى الواعد) كما يجذبها الأمل فى الاحتماء بهذا الفكر الملوِّح بحل “آخر” بشكل “آخر”، أشهر هذه الهجرات – بعد تراجع المد اليسارى – هو الهجرة إلى الأصولية الدينية، لعل جماعة التكفير والهجرة كانت أكثر صراحة فى التعبير عن هذا النوع من الهجرة البديلة. تأصيل حتمية الهجرة كل ما سبق هو تصنيف لما شاع عن الهجرة كما تعودنا استعمال اللفظ، لكن الأمر يحتاج إلى تأصيل أعمق ابتغاء فهم أعمق لحفز الهجرة وطبيعتها. إن صح ما ذكرناه ابتداء من أن الهجرة “هى الذراع من الحركة الذى يدفع الإنسان أن يترك مكانه الأول (الأصلى/الساكن) إلى غيره (المختلف/الواعد). فإن ذلك يفترض أن نبحث فى أن ثم دافعا أساسيا يكمن وراء هذه الحركية المهاجرة باعتبار أنها من طبيعة الوجود البشرى، وأن هذه الطبيعة يمكن أن تتجلى فى تشكيلات سلبية أو إيجابية بحسب قبولها، وظروف نمائها، واحتمال تشويهاتها وانحرافها، ثم فائدة عائدها على الفرد فالمجموع. علمنى مرضاى، كما تعلمت من رحلتى الداخلية، وترحالاتى الخارجية المفتوحة، أنه “لا هجرة إلا إلى عودة”، تتدعم هذه المقولة منذ ترك أبينا آدم (عليه السلام) الجنة مع الوعد بالعودة إليها له ولبنيه إن أتموا الدورات بكفاءة راضية مرضية، ثم تتدعم أيضا بأحداث تاريخية لا مجال لذكرها اللهم إلا إشارة محدودة إلى هجرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم العودة أخيرا إلى مكة. إن هذه الشرطية “لا هجرة إلا إلى عودة” لا تكتمل إلا بالتذكرة بأن شرط النمو أنه “لا عودة إلى نفس النقطة” ذاتها، إنها قاعدة لا تلغى الهجرة بل تسهلها وتؤمنها. العودة التى تجعل الهجرة بناءة باعتبارها ذراع الذهاب فى حركية النبض الحيوى لا تغلق الدائرة ما دامت تنتهى إلى نقطة أعلى وأرقى وأكثر انفتاحا، ومن ثم وعدا برحلة ذهاب جديدة (هجرة) لعودة مختلفة إلى نقطة مختلفة أعلى وأنضج وهكذا، هذه الفرضية تتجلى أيضا فى قول الصوفية الأشهر “كل من انفصل عن أصله يطلب أيام وصله”. برنامج الذهاب والعودة كل هذا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى “برنامج الذهاب والعودة” In and-our Program الذى يؤكد أن النمو لا يسير فى اضطراد خطى، وإنما هو يمضى فى تجوال ونبض دائمين، مع اختلاف طول ذراعى الذهاب والعودة مع كل دورة نمو. هذا الأساس “البيولوجى لـ “حتمية الهجرة” يتجلى فى حركية الوعى الساعى إلى الاستكشاف الذى يأخد شكل الهجرة من المحدود إلى المطلق، من الضرورة إلى الاختيار، من المعلوم إلى الغيب اليقين، من الذات إلى الله، وهو هو نفس الدافع وراء الإبداع الحقيقى الذى يظهر أحيانا فى شكل رمزى مباشر يؤكد هذه الفروض أكثر منه يستلهمها([2])، كما قد تلح هذه القضية عند مبدعين أكثر من غيرهم مثل نجيب محفوظ التى لا يكاد يخلو عمل له من الإشارة إليها، (وليس فقط فى “زعبلاوى، أو “الطريق” أو “ملحمة الحرافيش.” الهجرة وإعادة الولادة إن الجنين حين يخرج من رحم أمه، لا تنتهى علاقته إلا بالرحم الجسدى، ذلك أن رحلة النمو تظل مستمرة فى حركية منتظمة فيما أسميناه برنامج الذهاب والعودة فى تالف مع نبض الإيقاع الحيوى. إن النمو البشرى كله هو سلسلة متصلة من دورات جذب العودة إلى الرحم/الوعى ثم انطلاقة الهجرة إلى الواقع “الآخر”، إنها سلسلة متراوحة من الحمل المتجدد وإعادة الولادة. إن العودة إلى الرحم/الوعى/الأصل تكون إيجابية ونمائية إذا لم تكن عودة إلى نفس النقطة الصفرية، تماما مثلما أشرنا إلى شرط الإيجابية فى حديثنا عن جذب العودة فى قانون الهجرة. إنه بقدر نجاح الكائن البشرى أن ينهى كل رحلة من رحلات الوعى هذه إلى موقع أرقى وأثرى يتواصل النمو ويتأكد دور الهجرة كضرورة مرنة تسمح باستمرار النماء والتطور. هذا التأصيل البيولوجى والنمائى يجعلنا نعيد النظر فى مسألة الهجرة ليس كعامل استثنائى، يرفض أو يقبل، وإنما كطبيعة بشرية أساسية تتجلى إيجابيا أو سلبيا حسب توفير المناخ الملائم، فماذا آلت إليه هذه الطبيعة مؤخرا؟ وما هى فرصها؟ سوف أكتفى فى الفقرة التالية بالتنبيه إلى بعض الانحراف الذى تتعرض له فرص الهجرة الخارجية دون غيرها. تزييف الهجرة والتماثل المائع الذى حدث أن الإنسان المعاصر أصبح يستطيع أن يغادر موقعه أو موطنه وهو جالس فى مكتبه وراء حاسوبه، يستطيع أن يهاجر إلى واقع مصنوع: يلوّح بأنه يمكن أن يغنيه الترحال الحى فى الداخل عن الانتشال فى الخارج. إن هذه الوسائل الأحدث جعلت (شكل) الهجرة فى متناول كل فرد بقدر مناسب من الخيال وحذق متوسط للأداة، وفى هذا ما فيه من مخاطر التشويه والتحريف. فى نفس الوقت فإن تزايد تقارب النمط العالمى للوجود البشرى من حيث محاولة توحيد طرق التفكير وأشكال المناهج، حتى أدق تفاصيل النص الحياتى (السكريبت) يجعل أى انتقال من مكان إلى مكان ليس فيه من الاختلاف والوعد ما كان يلوح به فى ماضى الزمان. هل معنى ذلك أن الهجرة الطبيعية الحقيقية النابضة الممثلة لذراع الذهاب فى النبض الحيوى أصبحت هامشية يمكن الاستغناء عنها؟ ليس تماما، لكن علينا أن ندرك أننا إذا لم ننتبه إلى حتمية الهجرة كجزء لا يتجزأ من حركية النمو ونبض الوجود الحيوى، فإننا نكون عرضه لأن نتدخل بشكل يختزل البشر إلى ما ليسوا هم. خاتمة خاصة رأيت أن أختم مقالى هذا بإشارة شخصية إلى تطور موقفى من قضية الهجرة فى صورتها الشائعة. وأنا فى فرنسا 1967/1968، أخذت أتراسل مع زميل لى كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة أرسلت إليه معاتبا أقول: يا طير يا طاير فى السما..، رايح بلاد الغرب ليه؟ إوعك يكون زهقك عماك، عن مصرنا، عن عصرنا.، تفضل تلف تلف .. كما نورس حزين، حاتحط فين ..، والوجد بيشدك لفوق، الفوق فضا.، الفوق قضا. وعنيك تشعلق كل مادى وتنسى طين الأرض. مصر. كنت أيامها أتصور أن ترك مصر هو عدم اعتراف بجميلها، وأنها أولى بنا، وكذا وكيت كما بينت فى أول المقال، لكننى بعد فترة، لا أذكر مداها، تصورت أن “مصر” يمكن ألا تكون مجرد أرض، تصورت أن “مصر” التى أدعو للعودة إليها يمكن نخلقها كيف نشاء أنـّى نشاء دون الإلتزام بحدود حغرافية، باعتبار أنها وعى مشتمل يحيط بالوعى الخاص،. لا علاقة له بالجغرافيا، فاستدركت وأنا فى ترحال آخر، ما بين بلاد الله لخلق الله، وأيضا وأنا أنظر إلى الدنيا من خلال وعى مرضاى يطل من نافذة عيونهم، كتبت لنفس صديقى مراجِعا بعد سنوات: دانا لما بابص جوا عيون الناس، الناس من أيها جنس، بالاقيها ف كل بلاد الله لخلق الله، وف كل كلام ،.. وف كل سكات.. واذا شفت الألم، الحب، الرفض، الحزن الفرحه فى عيونهم: يبقى باشوف مصر.، وباشوفها أكتر لما بابص جواى.، وأخيرا قررت فى نفس القصيدة أن أضع تعريفا للمصرى كما يلى: ”كل واحد همه ناسه، كل واحد ربه واحد، كل واحد حـر بينا، يبقى مصرى” . تبقى مصر بتاعتى هى الدنيا ديـه كلها، هى وعـد الغيب، وكل الخـلـق، والحركـة اللى تـبـنى. ……. ثم تراجعت بعد ذلك كله إلى ما ورد فى هذا المقال. **** [1] – مجلة سطور: (عدد يوليو – 2002) وكان العنوان الأصلى “سادة وعبيد!” يضيف هذا المقال أنواعا من الهجرة غير الهجرة المعروفة إلى بلد أخرى لاكتساب جنسية أخرى (ومستقبل أخر) ومن ذلك الهجرة إلى تربية منفصلة، والهجرة إلى المجتمعات المغلقة والمنتجعات الجديدة والمدن الخاصة، والهجرة العقائدية (الأيديولوجية) والهجرة الفئوية. المقال لا يرفض الهجرة بل هو يغير أحد ضلعى برنامج الذهاب والعودة الضرورى لاستمرار حركية النمو، ثم هو ينبه على عدم استسهال الهجرة البديلة الزائفة بالسفر التواصلى عبر الانترنت وأنت تمارس “الهجرة فى المحل” (مثل المشى فى المحل) لأنها لا تحقق حركية الهجرة الخلاقة. وفى نهاية المقال مقتطف من قصيدة بالعامية فيها عشق شديد لمصر، تراجع عنه المؤلف ولم يتراجع فى هذا المقال. [2] – مثال: رواية باولو كويلهو- التى ترجمها بهاء طاهر بعنوان “ساحر الصحراء”، وما كان يجوز إلا الاحتفاظ باسمها “السيميائي”، وكذلك رحلة ابن فطومة لنجيب محفوظ، وغيرهما. – دورية نجيب محفوظ، “الأسطورة الذاتية: بين سعى كويلهو، وكدْح محفوظ” العدد الثانى: ديسمبر 2009 المجلس الأعلى للثقافة. ينبغى أن نعيد النظر فى حادث 11 سبتمبر دون دهشة، إنه النتاج الطبيعى لاختيارهم، كما أنه الرمز المنذر لما يمكن أن يلحقنا جميعا، نحن وهم، إذا استمر الحال على ما هو عليه. عادوا يتساءلون: “لماذا يكرهوننا”؟، وكأن السؤال لا يحمل جوابه دون حاجة إلى إجابة، منذ أن كتب وليم ليدرر كتابه سنة 1958 بعنوان “الأمريكى القبيح”([2]) حتى كتب حلمى شعراوى فى العدد الماضى من هذه المجلة (سطور 68) ما ذكرنا به، أو عرفنا به، ونفس السؤال يتردد وكأنه ليس ناقصا إلا أن يدرج فى حقوق الإنسان “الأمريكى”: أنه على سائر البشر أن يحبو الإنسان الأمريكى بوجه خاص، فإذا لم نحبه فنحن نتجاوز حقوق الإنسان عامة وليس الإنسان الأمريكى فحسب. لماذا يكرهوننا ؟.. من يكره من؟ أتصور أن مسألة حقوق الإنسان الآن تتطور بشكل يناسب لغة العصر “العالمى الجديد”، هى لم تعد حقوقا عامة، ولا واجبة طول الوقت، أصبحت حقوقا نوعية، جغرافية، دينية، مرحلية، تـُـفـَـصَّـل فى كل مناسبة حسب مصالح ومتطلبات الأقوى (الأرقى!) فالأضعف (الأدنى)، السمة الثانية الجديدة لحقوق الإنسان الخاصة هى ملاحق المذكرات التفسيرية لتنظيم احتمال تعارض حقوق الإنسان الأرقى مع الإنسان الأدنى، مثال ذلك أنه إذا تعارضت حقوق الإنسان الأعلى مع حقوق الإنسان الأدنى فإن الأولى تـَـجـُـبّ الثانية ”بالعافية”، بهذا الفرض فإنه إذا كان من حق الإنسان الأمريكى أن يــُـحـَـب من سائر البشر، ومن حق الإنسان الفلسطينى أن يكون له وطن، (بعد إثبات أنه إنسان دون اعتراض فى مجلس الأمن) فإن على الفلسطينى أن يحب الأمريكى أولا ثم ينتظر حقه فى الوطن حسب مزاج المحبوب ودرجة رضاه!!!. ما كل ما هو أمريكى: أمريكى أخشى أن يفهم القارئ أننى أتحدث عن كل أمريكا أو كل أمريكى. أمريكا بلد من بلاد الله لخلق الله، فيها ما يـُـحـَـب، ومن يُحِب، كانت أملا للعالم الحر كما كان الاتحاد السوفيتى أملا للعدل والفرص الكريمة، لكن ما كل ما يتمنى الناس يدركونه، “يأتى الدولار بما لا يشتهى البشر”، أمريكا التى أشير إليها هنا قد لا يكون موقعها فى القارة الأمريكية أصلا، أنا أصف أمريكا الحقيقية عبر العالم، أمريكا المعولمية هى التى عينت بوش فى منصبه الحالى وليس الشعب الأمريكى، عينته وهو أبعد ما يكون عما يؤهله لمنصب ساع عند مدير عام جمعية زراعة البطاطس المصرية، هذه الأمريكا الفوقية الخفية هى التى جعلت بوقها الدبليو هذا يدافع عن حق شارون فى قتل الناس فى بيوتهم وسياراتهم دون محاكمة دفاعا عن مستعمرين احتلوا أرض غيرهم لا لينصبوا فيها الثكنات حتى يجلوا، ولكن ليقيموا عليها مستعمرات دائمة طاردة لأهل الأرض الأصليين، هذه الأمريكا العابرة للأخلاق والمبادئ والحقوق والقانون والتاريخ والجغرافيا، هى التى تجعلنا نتمسك بحق كراهيتها بقدر ما تفترض لنفسها حق أن نحبها رغم كل ما تمثله وتفعله. إن من حق أى مخلوق بشرى أن يدافع عن كيانه، وأمله، ونبضه، وإبداعه، ونوعه، بأن يمارس كراهية هذه الأمريكا بكل ما يجده مناسبا من أدوات، ومشاريع، وتحالفات، وبدائل، من أول تعطيل مصالحها، حتى رمز إبادة ما تمثله، مرورا بمقاطعتها، واحتقارا لما تعرضه علينا لنستهلكه مما لا نحتاجه. حق الكراهية مع أن الكراهية هى حق من حقوق الإنسان المشروعة، رغم دماثه المثاليين، ومع أن هذا الحق هو عرض يمارس إذا ما احتاجه صاحبه، فإننى كثيرا ما أتصور أن حقنا فى كراهية هذه الأمريكا هو واجب كما أنه حق. أتساءل كيف يمكن ألا يكره إنسان طيب قوى متحضر هذه الأمريكا بما تفعل، وما تمثل، ومـَـنْ تظلم، ومـَـنْ تقتل. مـَـنْ أوْلى بممارسة حق الكره؟ السؤال الأجدر بالطرح - إذن- يمكن أن يكون “لماذا لا نكرههم؟” وليس “لماذا نكرههم؟” السؤال الآخر، وربما الأسبق الذى يحتاج بحثا أعمق، يقول: “لماذا يكرهوننا هم؟”، هذا إن كانوا يكرهوننا فعلا، ولا يكتفون باحتقارنا ومحاولة نفينا وإبادتنا. أريد أن أنبه ابتداء أننى أتحفظ على المثل القائل “إللى يحب ما يكرهشى” اللهم إلا إذا كان يعنى أن المحب يمكن أن يتغاضى عن بعض ما يكره فى محبوبه، ذلك لأن الأصل العلمى لهذه المسألة يقول بعكس المثل تماما. إن القدرة على الكراهية تعنى من ناحية رفض التبلد، كما أنها تعنى ضمنا القدرة على الحب، إن الذى يستطيع أن يكره، هو الذى يمكن أن نحترم حبه وهو يمارس كراهيته بمسئولية تسمح له أن يحتوى طاقتها فى حب أرقى، إن كثيرا من المقولات والمزاعم المطروحة على الساحة هذه الأيام تحت ما يسمى “ثقافة السلام” أو “قبول الآخر” أو حتى “حوار الأديان”، أو “حب الكل”، هى مقولات مثالية نظرية قد تكون طفلية إذا أحسنا الظن، وقد تكون مناورات ليس وراءها إلا خداع الأضعف، وخاصة إذا أكد عليها الأقوى، دون مسئولية حقيقية، ودون أن يـُـختبر، ودون معاملة المثل.. بعد التسليم بأن الكراهية حق من حقوق الإنسان، وهى من الحقوق السرية حتى الآن، لنا أن نتساءل: من الأولى بممارسة هذا الحق فى مساحة مشروعة باعتباره بداية اتخاذ موقف مناسب حفاظا على ذاته، ومن ثم على نوعه؟ الأضعف أم الأقوى؟ الأقوى يحتقر ولا يحتاج أن يكره إن القوى لا يكلف خاطره أن يكره، فهو قادر على الظلم، وعلى القهر، وعلى القتل، وعلى النفى، وعلى السحق، وعلى الترك، وعلى الإنكار، وعلى الاستغلال، وعلى الاحتقار. يفعل كل ذلك دون تردد سواء أعلنه وقام بتفعيله بالسلاح، والاحتلال، والسيطرة، والغطرسة، والظلم الرسمى، أو قام بتسريبه من خلال الإعلام الأخبث، أو عبر اتفاقات الإذعان، والمعونات المشروطة، والفوقية المحتـَـقـِرة، إن مثل هذا القوى الغبى لا يكلف خاطره أن يكره أصلا. أما الضعيف الذى لا يملك ما يرد به وجها لوجه، وبالقدر المناسب لما يفعله فيه القوى المتغطرس، فهو يمارس الكراهية باعتبار أنها هى ما يقدر عليه، أو لعلها بداية تحفزه إلى أن يقدر على شيء أكبر. إن كراهية الضعيف للقوى غير مضمونة العواقب دائما، برغم أنها حق، وأنها واجب. ذلك أنها أحيانا ما تزيد من يمارسها عجزا، وهى أحيانا ما تفجر صاحبها غيظا إذا لم يستطع أن يفجرها فى فعل قادر مناسب، وهى أحيانا تستغرق صاحبها حتى يتصور أنها الغاية لا الدافع فيكتفى بها ويكررها “فى المحل” ومع كل ذلك فهى تظل حقا من حقوق الإنسان الأضعف خاصة، إذا طلبنا من الضعيف المظلوم المقهور المهان ألا يكره، فإننا نطلب منه أن يتبلد، أو ندعوه إلى أن يستمرئ العبودية، لا أكثر ولا أقل. فلماذا يكرههم الناس؟ الرد على سؤال الأمريكيين لماذا يكرههم الناس، الضعفاء خاصة، لا يحتاج من خلال ما سبق إلى تفسير، أضف إلى ذلك أن هناك من الأقوياء الشرفاء فى أمريكا الجغرافيا وأمريكا الناس من يشاركنا فى كراهية هذه الأمريكا/السلطة/المال الأعمى. إن صح أنه من البديهى أن نكره - باعتبارنا الأضعف- هذه الأمريكا/السلطة، فكيف يمكن أن نفسر كراهيتهم لنا إذا حدثت ونحن الأضعف؟ قبل أن نحاول أن نجيب على هذا السؤال دعونا نطرح أسئلة سابقة تقول: هل هم يكرهوننا أم يخافون منا ؟ لماذا يخافون ونحن الأضعف والأتفه والأتبع فى رأيهم، وربما أنها الحقيقة؟ وإذا كانوا يكرهوننا فهل يرجع ذلك إلى أننا مسلمون؟ آم لأننا عرب؟ أم لأننا مختلفون؟ أم لأننا متخلفون؟ أم لأننا نمثل تهديدا باعتبار أننا نمثل بديلا لا يعرفونه (ولا نحن)؟ أم لأننا لم نستسلم لهم بعد جملة وتفصيلا؟ وهل صحيح أننا لم نستسلم؟ مع أن الرجل الأمريكى العادى يتحمل مسئولية انتخاب هؤلاء الذين يقودونه وهم يترجحون بين البلاهة والإجرام، إلا أنه لا يكرهنا بالضرورة، الأغلب أن هذا الأمريكى فى الأريزونا أو تكساس ليس عنده علم أصلا بوجودنا، أو موقعنا، أو ديننا، أو مطالبنا، أو حقنا ناهيك عن إيماننا أو طموحنا أو علاقتنا بحضارة أخرى محتملة. هذا الجهل المعروف الذى يوصف به موقف ومعلومات المواطن الأمريكى بالنسبة للعالم الخارجى (وأحيانا الداخلي) يجعلنا لا نوجه له هذا الحديث إلا بمقدار ما قد يؤثر فى ممارسته لانتخابات قادمة مشكوك فى مصداقيتها، إننى أتصور أن هذه المؤسسة الفوقية إنما تزرع فى ناسها “كراهية مصنوعة” لصالح استمرار وتدعيم هيمنتها على العالم. المشاعر الأقسى إذا لم تكن الكراهية هى الشعور المناسب من الأقوى للأضعف، فما هى حقيقة مشاعر هذا الأقوى تجاه المستضعف؟ أحسب أننا يمكن أن نرصد أنواعا مختلفة من المشاعر والمواقف لا أحسب أن الكراهية تقع على رأس قائمتها: أولا: الإهمال حتى الإلغاء: يمكن أن يعيش الأمريكى طول حياته لا يعرف مـَـنْ هم العرب أو ما هو الإسلام أو المسلمين إلا ما يشاهده مصادفة فى فيلم سينمائى تافه، أو مسلسل مسطح، فهو يهمل وجودنا حق الإلغاء أصلا اللهم إلا إذا حدثت فرقعة هنا أو مصيبة جسيمة هناك، أو كارثه ساحقة تعزى إلينا تعزى إلينا بالحق أو بالباطل: تجعل الالغاء مستحيلا. ثانيا: الاحتقار والتهوين: هذا الموقف لا يعلن عادة، لكنه يستنتج من النظرة الأعليى، والمعاملة بمكيالين، والاستهتار بالمشورة الحقيقية، وفرض الرأى صراحة أو من خلال المن بالمعونات المشروطة. ثالثا: الاستقطاب للانقضاض: هذا موقف يعنى أنهم يضعوننا فى وعيهم، وفى حساباتهم فى أقصى الجانب الآخر من وجودهم، يرسمون صورتنا بعكس ما يتصورونه أنهم هـُـمْ، هذا هو تفسير ما دعاهم إلى تجسيم هذا العدو المجهول الذى أسموه “الإسلام” وهم لا يعرفون عنه إلا الصورة التى ألمح إليها مفكر خائب مثل فوكوياما، أو رسمها منظـر أخيب مثل هنتجتون. إنهم حين يصورون المسلمين باعتبارهم منافسوا الجولة القادمة فى الصراع المحتمل لا يكلفون خاطرهم بالتعرف الموضوعى على واقع المسلم أو الإسلام الذى عليهم أن يستعدوا لمواجهته، إنهم يختزلوننا إلى ما يبرر خوفهم، ثم يسوقون تلك الصورة يستعملونها لإخافة ناسهم، ومن ثم حفز الجميع للقتال والصراع بهدف القضاء على أى اختلاف ومختلف. يظهر هذا الموقف بشكل مفضوح حين يكرر السيد دبليو بغطرسته الغبية أن “من ليس معنا فهو ضدنا:” أو حين يخفى هذه المقولة أحيانا تحت مقولات أو إشارات أكثر دلالة مثل “من لا يحارب الإرهاب معنا فهو يناصر الإرهاب ضدنا” أو ” من ليس مع السلام والحرية اللذان يتجسدان فينا فهو مع الإرهاب والتخلف اللذان هما أى شيء غير ما نعتقد، وهكذا”، كل هذا يؤدى فى النهاية إلى ما أسميته الاستقطاب للانقضاض. رابعا: الشفقة والتفويت: يبدو هذا الموقف فى ظاهره شبه إنسانى، مع أنه فى عمقه موقف سطحى لفظى. يمكن أن نتبينه فى المقدمة المائعة لبيان الستين من مثقفيهم السلطويين حين يقولون كلاما إنشائيا فى محاولة تبرئة أنفسهم من تهمة نفى الآخر والاستعلاء عليه. إن المتأمل فى هذه المقدمة الإنشائية لابد أن يكتشف أنهم لا يمتدحون هذا الآخر إلا بوصفه قد حقق وجوده بالمقاييس التى حددوها للحسن والقبيح، أو للخير والشر، إنهم يمدحون الآخر حفزا له أن يرتقى ليقيسوه بمقاييسهم. يقولون مثلا ما معناه: إن المسلمين هم بشر وقد يكونون قابلين للتحضر، بل إنهم حاولوا فى بعض فترات التاريخ أن يكونوا كذلك، بدليل أنهم فى تلك الفترات اتبعوا النهج والقيم التى ارتضيناها لأنفسنا (وللبشر) أخيرا، إنهم بذلك يعلنون ضمنا قائمة القيم الذى حددوها هم دون غيرهم ، بعد أن احتكروا تفسير مضامينها بأنفسهم دون سواهم. فهم الذين يضعون تعريفات خاصة لكل من “الحرية” و”العلم” و”المنهج” و”التنوير” ومؤخرا “الدين“، ثم إنهم يصدرون فرمانا بعد ذلك أنه على كل من يريد أن يحصل على رضاهم لينعم بحق التواجد معهم على هذه الأرض أن يكون مثلهم مع السماح بهامش من الاختلاف فى التفاصيل التى تصب فى النهاية فيما يريدون. خامسا: المواجهة فالإبادة: إذا لم تفلح كل هذه الأساليب فى تحقيق أمانهم الزائف، بنفى الآخر بدرجة تؤكد لهم احتكار الخير والحقيقة وأدوات السلطة، فإنهم لا يتوقفون عن التمادى فى الغطرسة والإهانة والاستعمال والاحتقار بشكل متصاعد التحدى حتى يفقد هذا الأضعف ضبط نفسه فيقدم – يأسا – على ما يبرر لهم إبادته فعلا. وهكذا يحدث الحادث الذى ينتظرونه، فهم الذين مهدوا لظهوره، فيفزعون، ويهجمون، ويسحقون. ويبيدون وهم يطلقون صيحات الاستغاثة، ثم نداءات الاستنكار ثم آهازيج النصر. فى محاولة التعرف على أبعاد التصورات: إن التعرف على ما يطـلق عليه مسمى الإسلام فى وقتنا هذا يحتاج لجهد هائل من المسلمين قبل أعدائهم. إن المطروح من أشكال وتجليات ما يسمى الإسلام هو أكثر من أى تصور، هذا على مستوى البلد الواحد (مصر مثلا)، فما بالك بما هو قائم على مستوى العالم. ننظر فى بعض تباديل وتوافيق ما يطلق عليه الإسلام، ربما أمكننا أن نتعرف على أى إسلام يفوّتون له، وأى إسلام يوافقون عليه، وأى إسلام يحاربونه، وأى إسلام يستعدون للقضاء عليه. إن المطروح عل الساحة الآن مما يطلق عليه “إسلام” هو مختلف ومتنوع باختلاف التاريخ والجغرافيا والثقافة والممارسة. وفيما يلى بعض عينات من ذلك . أولاً: الإسلام الرسمى السلطوى: وهو الذى تنتهى حدوده عند ألفاظ المعاجم، وفتاوى السلف، هذا النوع من الإسلام لا يخيفهم أصلا، بل لعلهم يساهمون فى زيادة حجمه على حساب تجليات الإسلام الأخرى. إنه خير ضمان لهم أنهم الأعلى، والأكثر حركة، والأولى بقيادة العالم. ثانيا: الإسلام الوطنى الشعبى: وهو الغالب فى الممارسة التى تلتحم بالأرض الموجود عليها، وبثقافة ناسها، فيتجادل مع هذا وذاك ومع التاريخ الخاص بهذه المجموعة من المسلمين، لتفرز لنا إسلاما له طابعه المحلى الخاص، وهو وإن لم يخرج -غالبا- عن القواعد الجوهرية لما هو إسلام تقليدى إلا أن هذا النوع بالذات يمكن أن يحتوى مواطنين يدينون بأديان أخرى ، لكنهم يمارسون الإسلام المعيش بالعادات والتقاليد ونوع العلاقات والمواقف بشكل لا يمكن تمييزه عمن يعتنقون الدين المسمى بالإسلام، وهذا أقرب ما يكون إلى حال مصر منذ بضعة عقود، وربما فلسطين الآن. يمكن أن نتصور أن هذا المزج بين الوطن والدين هو من أكبر ما يمثل تهديدا للمستعمرين الجدد نظرا لصعوبة احتواء من يمارسون هذا النوع من الإسلام، ومن هنا يتولد حذر خاص منهم وكراهية تجاههم تتناسب مع حجم مقاومة الإغارة المهيمنة. ثالثا: الإسلام السياسى: وهو غير ما أطلقنا عليه الإسلام السلطوى، إن ما يسمى الإسلام السياسى يكاد يصبح وسيلة لغيره لا غاية فى ذاته، أن أصحاب هذا النشاط يقومون باستعمال ظاهر الإسلام لأغراض سياسية تؤدى إلى تحريك المجاميع ليستعملوا هذا التحريك لتمكين مجموعة من البشر من السلطة، ثم بعد ذلك يحلها حلال، إن مدى انتماء هذه المجموعة من البشر إلى الإسلام لابد أن يتوقف على تصنيف تال يضعهم حيث يمكن أن تتفق سماتهم ومواقفهم مع أى مما سبق من أنواع وتباديل. إن الصراع مع هذا النوع من الإسلام هو صراع سياسى فى المقام الأول، وربما الأخير، وهو يتبع قوانين كل الصراعات السياسية بما فى ذلك الكر والفر، والمناورة والتكتيك، وما يصاحب كل هذا من كراهية وتوجس وتبادل صفقات ضرورية، واتفاقات مؤقتة، وتحديد أدوار بين الكاره والمكروه (تحت الترويض). رابعاً: الإسلام الاستقطابى الأعمى: هنا يتحقق الموقف الذى ينفى الآخر بقدر ما ينفيه الآخر، وأكثر، مهما ادعى غير ذلك، هذا هو ما يركز عليه خصوم الإسلام تبريرا لمصارعته ثم تشويهه أو تمييعه أو محوه، ومن أسف أن هذا النوع هو الأكثر شيوعا فيما يشار إليه بالحركات الإسلامية، وما إليها، قد يكون المبرر لانتشار هذا النوع هو أنه يقوم بوظيفة “دفاعية” حفاظا على هوية متميزة فى مقابل التحدى والاستقطاب على الجانب الآخر. مثلا: إن استقطاب اليهود وتفردهم بزعم أنهم هم الذين يمثلون الدين الصحيح دون سواهم، لا بد أن يقابل باستقطاب إسلامى مقابل يدعى نفس الدعوى ليحمى نفسه من الذوبان أو التبعية . على نفس القياس نجد أن إحياء الأصولية الإنجيلية فى أمريكا متضامنة مع الصهيونية والقوى المالية تضطر المخالفين (مسلمين أو غير مسلمين) إلى التجمع حول القطب المضاد زاعمين بدورهم التفرد بالحق وتمثيل الخير وهكذا. خامساً: الإسلام الإبداعى: (الصوفي/ الوجودى/ النقدى/ الاجتهادى/ المعايشى) هذه الصورة يندر الحديث عنها بقدر ما يصعب توصيفها، مع أنها هى الصورة الأقرب إلى أصل الإسلام وكل الأديان. ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع هو متجاوز للتفاصيل دون التخلى عن الأساسيات، وبالتالى فإن المؤسسات الجاهزة، والتفسيرات الجامدة تقف له بالمرصاد، إن هذا النوع هو أقرب ما يكون إلى “الاسلام التوحيد الحرية” إلا أن أصحاب هذا الموقف يحاربون ويرفضون من الإسلام السلطة، ومن الإسلام الرسمى، ومن الإسلام الوسيلة السياسية أكثر مما يرفضون من أعداء الإسلام. يترتب على ذلك أنهم يضطرون إلى أن ينتسبوا إلى ما يحقق رؤيتهم، ويطلق حريتهم حتى تحت اسم غير الإسلام. سادسا: الإسلام التوحيد الحرية: بلا سلطة دينية رسمية ولا وصاية سلفية جامدة، مع التأكيد على بساطة التعاليم ومباشرة العلاقة بالكون وخالقه، وهو متداخل مع النوع السابق إن عمق التوحيد فى هذا الإسلام الأصل هو الذى يولد حركية الحرية ويؤكد كرامة البشر ومساواتهم، هذا النوع من الإسلام، لا يمارس إلا ممارسة محدودة أو فردية لاتعنى هؤلاء الكارهين فى شيء، كما أنها قد لا تهددهم فى شىء، أتصور أن خشية بعض مفكريهم من الحرية الحقيقية التى يمكن أن تتأكد من هذا الموقف التوحيدى يرجع إلى تحسبهم من احتمال كشف الحريات السطحية التى يروجونها. إن هذه التقية تحرم الإسلام من أنقى صوره وأكثرها وعدا بتحرير الإنسان والحفاظ على مواصلة النمو والإبداع المتجدد، سعيا إلى تأصيل العلاقة بالكون والامتداد فى المطلق فردا فردا على طريق تعميق الوعى وحرية الوجود. العلاقة بين هذا النوع وبين النوع السابق “الإسلام الإبداعى” علاقة وثيقة لأن التوحيد الذى يطلق الحرية الحقيقية هو حركية النبض الحيوى الفاعلة للنقد والتشكيل على كل المستويات. وبعـد علينا لكى نفهم حقيقة مشاعرهم، وطبيعة دوافعهم أن نحدد رؤيتنا لجوانب الموقف المختلفة على الوجه التالى: أولا: إن الدعاوى المطروحة على الساحة الآن لتبرير الصراع والإغارة والعدوان، فالقهر والإبادة والتبعية، على عدو من صنعهم أسموه “الإسلام” هى دعاوى زائفة مضللة، لها أغراض أخرى وتبريرات أخرى. ثانيا: إن اختلافنا عنهم إن لم يكن موجها فى النهاية لنفع كل الناس وترقية نوع وجود البشر كافة وحفز تطورهم، فإن علينا أن ندفع ثمن جرجرتنا إلى الاستقطاب، فالصراع، وما قُدِّر يكون. ثالثا: إنهم إذ يروجون للخوف والإخافة، ومن ثم الكراهية فالعدوان فالإبادة، تحت زعم اختلافات دينية أو عقائدية يحركون العالم أجمع نحو هاوية لن ينجو منها أحد. رابعا: إن التسويات الرمادية المائعة تحت زعم نزع الكراهية وادعاء قبول الآخر وتحمل الاختلاف يمكن أن تكون تسكينية تحرم المختلفين من فرصة جدل حقيقى. خامسا: إن كراهية الأقوى للأضعف إن سمح بها ليتحمل مسئوليتها ينبغى أن تكون حافزا لإعادة الرؤية ومعاودة المحاولة، كما أن كراهية الأضعف للأقوى لا تفيده فى مسيرته نحو قبول التحدى والانتصار لكليهما إلا إذا كانت بداية للتعرف على أسباب الضعف من ناحية، ثم للإسهام فى تجاوز الاستقطاب والانغلاق والتعصب من ناحية أخرى، ان حقنا وواجبنا فى ممارسة كراهيتنا لهم يلزمنا – رغم ضعفنا- بمسئولية أكبر نحونا ونحوهم. سادسا: إن اختلاف تجليات ما هو إسلام تلزم المسلمين بمحاولة استيعاب هذه الاختلافات للتعرف على ما بها من إيجابيات، والحذر مما بها من سلبيات، ثم محاولة قبول الاختلاف فيما بيننا وبين بعضنا قبل أن نطالب غيرنا بقبولنا. [1] – مجلة سطور: (عدد أغسطس – 2002) وكان العنوان الأصلى:”كن عبدى وإلا قتلتك” هذا المقال يكاد يكون ردا على التساؤل الأمريكى “لماذا يكرهوننا” يبين أن الأقوى يحتقر، ولا ينفصل حتى بالكره، وأن الأضعف قد لا يملك إلا أن يمارس “الحق فى الكراهية” مع الاشارة إلى خطورة التعميم، فليس كل أمريكى أمريكى. والمقال يرفض فى النهاية التسويات الرمادية المانعة التى تحرمنا حق الكراهية، وفى نفس الوقت ينبه على أن كراهية الأقوى للأضعف إنما نكشف زيف قوته وهشاشة موقفه. [2] – الأمريكى القبيح تأليف وليم ريدرر، 1958، ترجمة ميشيل تكلا، مراجعة إبراهيم جمعه، تقديم محمد عطا، المؤسسة المصرية العامة للنشر والتوزيع والطباعة يزعم أفلاطون أنه “مثل الفرد مثل الدولة”، وهو حين رسم جمهوريته بكل ما لها وما عليها، يشير إلى أنه إنما يرسم النفس البشرية أساسا، ولكنه مضطر أن يقوم بتكبيرها حتى تبدو جمهورية لعله يستطيع من خلال رسم طبقاتها وعلاقاتها ببعضها البعض أن يوصـّـل فكرته – عن النفس – من خلال هذا التكبير المضاعف، ثم إنه راح يتحرك بين الفرد والدولة، جيئة وذهابا معظم الوقت، تهربا أو إيضاحا. خطر ببالى مؤخرا أن البدء بالعكس يمكن أن يكون أولى، وذلك بعد ما وصلنا كم من المعارف عن النفس الانسانية يمكن أن نجعله قياسا لما يجرى خارجها، على مستوى الجماعة و العالم. أعرف ما يؤكد عليه علم نفس الجماعة وعلم النفس الاجتماعى من ضرورة التمييز بين قوانينهما وبين قوانين علم النفس الفردى، ومع ذلك فإننى ما زلت أميل إلى تصور أقرب إلى الحدس الأفلاطونى منه إلى هذا التحذير المميز. إن التطور الأحدث لمفهوم الذات يشير إلى عدة مبادئ لا غنى عن سردها فى البداية ونحن بسبيلنا إلى نقد فكر “التصالح” التسوياتى للتحذير من الاستسلام لفكرة “الحلوسطية” سواء مع الذات أو مع الآخر، أو حتى بين الدول، أتعمد استعمال هذا اللفظ المنحوت “الحلوسطية”، لما يصلنى منه من قبح “القص واللصق”. خداع التسكين بالتصالح كثر الحديث مؤخرا عن التصالح، والتسوية، والحوار، وقبول الآخر، وهو حديث دمث يبدو وكأنه يمكن أن يريح جميع الأطراف، لكنه فى عمقه قد يثبت أنه حل باهت لا يدفع حركة ولا يحدد موقفا، بل إنه كثيرا ما يكون خدعة لصالح الأقوى الذى هو ليس بالضرورة الأفضل، يبدأ مثل ذلك فى شكل مفاوضات أو حوار فى جو من افتراض حسن النية، وشىء من الحذر، وما تيسر من حسابات الممكن، وينتهى بالمعاهدات أو البيانات أو المواثيق التى تعلـن أن “الجميع بخير وعمل لهم اللازم، ما دامت”السلامة أولا”، وليس هذا هو التصالح المأمول. تساؤلات حول التصالح مع الذات هل يملك أى منا ذاتا واحدة، أم عدة ذوات؟ وما هى حكاية البحث عن الذات ؟ لإقرارها؟ هل الذات هى كيان محدد مفقود نبحث عنه فنجده، أم أنها مشروع نسعى فى اتجاهه فـنخلـّـقه؟ وهل المطلوب – إذن- كما يشاع فى معظم العلم، وعند أغلب العامة ـ هو تحقيق الذات أم تواصل إبداع الذات، امتلاءً وتجديداً وامتداداً؟ إن أوهام أن يكون لك ذات محددة، جاهزة، (أو بالتعبير الأحدث: سابقة التجهيز( Pre-fabricated)، متميزة عن الآخر وما عليك إلا أن تجدها أو تحققها هى شائعات شبه علمية لا أكثر. **** إن البديل الأحدث لهذا الزعم الذى اهتز مؤخرا يمكن أن نلخص خطوطه العريضة فيما يلي: أولا: يولد الإنسان وهو يحمل مشروعا متكاملا لشخص متميز فعلا من واقع برامج الجينات التى يحملها من والديه الذين يبلغونه - بإنجابه وتحميله برامج أجداده البيولوجية – تاريخ أجداده الأقربين (تمييزا عن سواهم من البشر) والأبعدين (تمييزا عن سواهم من الأحياء جميعا). ثانيا: مشروع الذات المتفردة هذا ليس تخطيطا مبرمجا مؤمنا عليه بداية ونهاية، لكنه مشروع مرن: له بداية محددة ونهاية مفتوحة، نهاية قابلة للتفرع، والتجدد، والتخليق باستمرار. ثالثا: يقوم الـوسط المحيط (الأسرة فالمجتمع بما فى ذلك الدولة) بالاعتراف بهذا المشروع من حيث المبدأ، وذلك بتقديم الرعاية الأولية، والفرص الأساسية.كل بحسب درجة نموه ووفرة إمكانياته. رابعا: مع تمادى حصول الفرد على الفرص الضرورية، أو الحرمان منها، يتولد الوعى الخاص بالتدريج وبشكل غير منتظم بالضرورة، لتتواصل مسيرة النمو باستمرار Always in – the – making خامسا: إن هذه الذات المتخلقة التى لا تكتمل أبدا فى صورتها الفريدة تبدو وكأنها اكتملت مستقرة فى بعض فترات النمو، فترات تطول أم تقصر، لتبدأ من جديد فى دورة نمو جديدة، وهكذا. سادسا: لا توجد للشخص الواحد ذات واحدة، إن ما يبدو على ظاهر الوعى والفعل أنه هذا الشخص ليس إلا إعلان أن إحدى الذوات دون غيرها – فى لحظة بذاتها- هى التى تقود وتوجه جماع الذوات الأخرى الكامنة فى تلك اللحظة. سابعا: إن مفهوم تعدد الذوات (تعدد حالات الذات) فى الشخص الواحد، يتجاوز ويصحح المفهوم التحليلى النفسى التقليدى، الذى يقوم بتشريح النفس (إلى: ما هو”أنا، وأنا أعلى، و”هو”) إن النفس البشرية هى عدة ذوات معا وليست مجموع أجزاء، مغلفة بما يسمى “الأنا”. ثامنا: يتم التبادل بين الذوات المختلفة بشكل تلقائى: إما بطريقة إيقاعية بيولوجية منتظمة (كما ينظمها الإيقاع الحيوى بين النوم والحلم واليقظة)، وإما حسب المواقف والمتطلبات المتنوعة فى كل حال، ووسط، ومطلب، فتسود الذات الطفلية، مثلا فى اللعب الحر والإجازات، وتسود الذات الوالدية فى المواقف التى تستدعى الحنو والرعاية (حتى حنو الطفلة على دميتها العروسة)، كما تسود الذات اليافعة للقيام بأداء الالتزامات لكسب العيش وحسابات الواقع مثلا. تاسعا: إن هذا التبادل، مع ضرورته وروعته، ليس نهاية المطاف، ولا هو غاية المراد، ولكنه الوسيلة الطبيعية (البيولوجية/ النفسية) التى تسمح بأن يتخلق – باضطراد- مشروع الذات النامية الدائبة السعى إلى مزيد من التكامل مفتوح النهاية. عاشرا: إن بعض مظاهر تكامل الذوات قد يتجلى مؤقتا عند من تتاح له الفرصة، ويحذق الأدوات، فى شكل إبداع أصيل، ويظل هذا الاحتمال واردا بديلا عن التكامل الوجودى النامى، أو تسهيلا له. التصالح مقابل التكامل أين يقع التصالح مع الذات فى كل هذا ؟ وكيف يمكن أن يكون التصالح تكاملا؟ التصالح عمل إيجابى من حيث المبدأ، شريطة ألا يكون تنازلا ساكنا، أو حلا دائما خاملا، إن الترويج لمسألة التصالح هذه بشكل غير دقيق، وغير تفصيلى تحتاج منا إلى وقفة ومراجعة. على العكس من ذلك فإن التكامل هو تفاعل إيجابى دائما حيث يتم من خلاله تفعيل مواجهة كل مستوى مع المستوى الآخر فى حيوية متصاعدة، إنه تصنيع متضفر لجديد يتشكل من خلال العلاقات المتفاعلة مع بعضها البعض. لا يمكن أن يصل بنا الحذر من سكون التصالح لدرجة رفضه كلية باعتباره العملية الأدنى الأقرب إلى السلبية. إنه قد يكون التمهيد الضرورى للتكامل، أى أنه قد يكون خطوة أساسية لا تتم الخطوات التالية نحو التكامل إلا بالمرور بها، ولو على فترات متباعدة، حسب إيقاع دورات النمو. أشكال للتصالح سوف أقصر حديثى المبدئى أساسا على مراحل التصالح فالتكامل بين الذوات، ثم أحاول تطبيقها على نماذج الجماعة، فالدول، فالعالم. لا يتم تصالح إيجابى إلا من خلال الحركة والتغير معا، إن الحركة وحدها لا تكفى حيث لا تعتبر إيجابية وبناءة إلا إذا كانت فى سياق يحقق التمهيد إلى، ثم تحقيق، التغير الذى لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحركة. من هنا يكون التصالح الساكن (الحلوسط) هو التجمد المضاد لحتمية النمو ومتطلباته، حتى لو بدا السطح ساكنا أو راضيا، فهو ليس تصالحا، وإنما هو خمود وتسكين لصالح الأقوى عادة. أما التصالح الذى يتفق مع الحركة فيحقق التغير فهو الذى يتم بالتبادل والتناوب والتفاعل أولا، تمهيدا للتكامل، وليس بالتنازل أو بالانتقاص من كل من الطرفين. لكن: لو أن التبادل ظل مجرد إعادة الأدوار كما هى، فإن الحركة مهما تستمر، لا تساهم فى التكامل، ومن ثم فإن “التصالح بالتبادل” لا يكون إيجابيا إلا إذا كان تمهيدا لخطوات التكامل حيث الأطراف المتبادلة ليست منفصلة فى دوراتها المتلاحقة. إن ما يسمى “الصراع” ليس مرضا أو عيبا، إنه إعلان مرحلة صعبة ضرورية وهو لا يحله التصالح الساكن، أو التنازل الحلوسطى، وإنما يـُحل باحتواء شقيه فيما يسمى ”جدل المواجهة” الذى يهدف إلى تخليق المستوى الأعلى بما يحقق من اضطراد مسيرة النمو. تصالحات ساكنة مرفوضة (1) سوء فهم “النفس المطمئنة“: شاع مؤخرا تفسير للنفس المطمئنة باعتبار أنها النفس الهادئة الساكنة حتى أكاد أقول الآسنة، حتى فهم البسطاء من العامة أن النفس المطمئنة هى الراضية المرضية بمعنى السكون الصامت. إن هذا التفسير السلبى الذى ارتبط بالآية الكريمة، يكاد يتجاهل أن هذه الدعوة للنفس المطمئنة إنما أطلقت فى سياق ختام رحلة العودة “إرجعى إلى ربك”، وأن على هذه النفس أن تمر على ”عباد الله سبحانه” بأن “تدخل فيهم”، “أدخلى فى عبادى”، وهى فى طريقها إلى الجنة ”وادخلى جنتى”، إن كل ذلك بالإضافة إلى ما نعرفه من جهاد النفس الذى هو أكبر من الجهاد الظاهر فى الحرب مثلا، ينبه إلى أن المفهوم التسكينى للتصالح هنا هو ضد حركية التكامل. إن النفس المطمئنة تكون كذلك بقدر اتساقها مع هارمونية الجماعة ومع لحن الكون الأعظم فى رحاب الله، وليس بقدر سكونها واستكانتها. من هذا المنطلق تصبح الدعوة إلى أن تكون النفس مطمئنة، هى دعوة إلى اتساق نغمتها المنفردة مع اللحن الأشمل، وليس إلى سكينة استقرارها فى الرضا المستسلم. (2) قبول الآخر: حين يكون هدف الحوار بين الأنا والآخر هو التنازل لتجنب الدخول فى مناطق الاختلاف، وهو ما شاع أخيرا باسم “قبول الآخر”، فإن الناتج هو تباعد ساكن لا أكثر، الأمر الذى أتصوره مثل تعقيب أولاد البلد حين تحاول صديقة إقناع صديقة لها بقبول خطيب ثقيل الظل، بأن تعصر عليه ليمونة. إن قبول الآخر بهذا المعنى هو تأجيل لمعركة أصعب، وربما أقذر، إنه كما سيضيع مفعول عصيرالليمون من على الخطيب الثقيل بمرور الأيام، سوف تنكشف أية معونات أو رشاوى أو وعود عن تلفيقات التصالح بين الجماعات والدول بمجرد بداية اختبارها بمرور الزمن .حينئذ سوف تتصادم المصالح وتتناطح الأيديولوجيات والأديان، لحساب الأقوى دائما. (3) سلام السلامة: إن السلام بمعنى فض الاشتبكاك الساخن لالتقاط الأنفاس بهدف التفرغ للتوجه لإعادة البناء هو تصالح يمكن أن يقبل فى سياق تفاهم شامل ممتد متغير تحت مظلة العدل. أما السلام الذى يكون هدفه الحفاظ على الأرواح (أو الأجساد بلا أرواح) بأى ثمن، فهو التصالح الذى يحتاج كل الحذر، إن معاهدات السلام ما لم تكن بداية جهاد أكبر بزخم التكامل وحركيته، تصبح تسكينا مخادعا من الأقوى للأضعف. (4) الصحة بالبلاهة: إن غلبة الترويج – فى مجال الطب النفسى المعاصر – للحصول على نوع من الصحة عن طريق تعاطى المهدئات المطمئنة، ومزيلات الألم إنما يقدِّم نوعا من الصحة الخامدة، وهى التى تروج لها شركات الدواء ليل نهار، إن هذا النوع من الهدوء الظاهرى يصل أحيانا إلى معادل الموت النفسى رغم لافتات التعافى والخلو من الأعراض. (5) تفريغ ما بالداخل: على الجانب الآخر، نجد أن المفهوم الشائع عن التحليل النفسى (والعلاج النفسى)، بمعنى التفريغ، والفضفضة، واسترجاع نقط التثبيت المؤلمة لتسكينها، هو أسلوب مبنى على نوع من التصالح الذى يقال له أحيانا فك العقد، هذا النوع قد يحقق خفض التوتر، لكن التوقف عنده هو ضد حقيقة إطلاق مسيرة النمو للتكامل. (6) الوسطية التلفيقية: إن التركيز على ما يسمى الوسطية، فى شرح بعض الأديان، يمكن أن يكون تصالحا ظاهريا أكثر منه تكاملا واعدا، مثال ذلك ما ذهبت إليه كثير من التفسيرات التلفيقية لما يعنيه التنزيل الحكيم من وصف أمة المسلمين بأنها “أمة وسطا”. لقد وقع توفيق الحكيم فى هذه التصالحية الخامدة فى الطبعة الأخيرة لما أسماه “التعادلية”، فراح يلصق بالإسلام فلسفته الباهتة الخامدة، وكأنه أتى بالجديد، حتى كدت لا أصدق أنه هو هو المبدع الخطير الذى استوعب السيرة النبوية حتى حدثها فى مسرحيته الرائعة “محمد”. (7) الحل الثالث: على نفس المنوال ظهرت حلول اقتصادية، وأحيانا سياسية، تحت مسميات تشترك فى تسميتها بـ”الحل الثالث”، إن كثيرا منها ليس إلا تسويات حلوسطية مائعة، لا تحمل إبداعا يقدم حلا أصيلا فعلا. التكامل جدل إبداعىّ مستمر * الذات ليست كيانا مفقودا نبحث عنه فتجده، بل مشروع نسعى فى اتجاهه لنكونه ونتشكل به فنجده باستمرا. التصالح مع الذات، لا يتم بطغيان وعى ظاهر على “لاوعى” كامن، ولا بطغيان النصف الطاغى من المخ (النصف الأيسر فى الشخص الأيمن مثلا) على النصف المتنحى، ولا بطغيان العقل الأحدث (الرمزى/التجريدى/ المنطقى/ الحرفى) على العقول الأقدم (الكلية/الصورية/ذات المعرفة الكلية)، وإنما يتم بتنشيط آليات التفاهم والتبادل والجدل بين النصفين الكرويين نحو تكامل محتمل. لا يمكن للأحدث أن يستوعب الأقدم بإلغائه أو تهميشه أو كبته، وإنما بالتبادل معه اعترافا، واحتياجا، ثم بالتفاعل، ثم بالجدل، ثم يتخلق الأحدث منهم معا. إن هذا التكامل المحتوِى يشمل تصالحا حتميا دون إلغاء أو إهمال أى من جانبى الصراع والمواجهة. طريق التكامل الفردى فى نظرية التحليل النفسى التفاعلاتى Transactional analysis (إريك بيرن (Eric Berne يستمر التبادل بين الذات الطفلية والذات الوالدية والذات اليافعة طول الوقت، نحو أن يتكون قرب اكتمال النضج مشروع ذات نامية تسمى اليافع المتكامل Integrated Adult هى ذات تقترب من النضج الذى لا يتحقق خلال حياة الفرد أبدا باعتبار أنها عملية مفتوحة النهاية دائما. هذه الذات الناضجة تحتوى سمات إيجابيات الفطرة (الذات الطفلية)، وقد أسماها إريك بيرن Pathos، بما يمكن ترجمته إلى “الوجدانية” (وليس الانفعالية)، كما أنها تشتمل على سمات والدية أقرب إلى الحكمة الواقعية (الذات الوالدية) دون وصاية أو موقف فوقى نصائحى، وقد أسماها إريك بيرن Ethos مما يمكن أن ننحت له كلمة مناسبة مثل “الحـِـكـْـمـَـوية” إن هذا الناضج المتكامل يظل فى دورات نمو مستمرة، أى فى تخلق باستمرار Always in-the-making وهذا هو التصالح الحقيقى المتجدد الذى هو تكامل يتخلق باستمرار. من الفرد إلى العالم استلهاما من أفلاطون، يمكن أن نتخذ ما يجرى للنفس الإنسانية من أطوار: نمو نموذجا قابلا للتحقق على مستوى العالم. إن الفشل الذى يمكن أن يلحق بالعالم هو أن تتصور أمريكا السلطة- مثلا- أنها بحصولها على أدوات السيطرة وآلة الحرب القادرة تستطيع أن تحقق تصالحا مع العالم بفرض نموذجها الحديث المتفوق على الجميع (على المستويات الأدنى كما ترى، أو مستويات الشر حتى لو لم تسمـّـه كذلك)، نحن لسنا فى حاجة إلى أن نرفض هذا النموذج الأقدر المتقدم أو أن نضيع وقتنا فى تعداد عيوبه حتى نثبت قصوره، كما أننا لا نحتاج أن نعلى من شأن نموذجنا المتخلف وكأنه البديل القادر على أن يحل محل هذا هذا النموذج المتغطـرس الأعمى. إن صح القياس على مسيرة تكامل النفس النامية، فإن الأمل ليس فى تصالح يتنازل فيه الأضعف عن سيادته وقيمه مقابل رشاوى المعونات، و التلويح بمغريات الرفاهية، ولا أن يتنازل الأقوى والأقدر عن أدوات تفوقه فيوزع فيض ناتجه وآلياته على الأدنى والأضعف. كما أن الحل لن يكون فى استمرار ما يزعمون من حوار بين هذا وذاك، حوار ليس فيه عدل أو تكافؤ أو جدل حقيقى، رغم مزاعم التصالح والتسويات والسلام. فكيف نستلهم الحل من التكامل الفردى؟ التكامل فى عولمة إنسانية هل يكون الحل فى أن نحذو حذو النفس البشرية على درب التطور الدائم؟ هل يمكن أن تعطى الفرصة للقديم الأضعف وهو يحتفظ بنوعية ما يميزه، لكنه يتبادل فى دورات يظللها العدل تتبادل بانتظام مع الحديث القادر؟ هل نأمل أن يكون فى ذلك فرصة ليستكمل الأول ما ينقصه، ويشتمل الثانى ما يحتاج إليه.؟ هل ثم سبيل أن يتم تحديث القديم الرخو، فى نفس الوقت الذى يجرى فيه ترويض وتشذيب الجديد المتغطرس؟ إن معطيات التكنولوجيا مؤخرا تلوح بتعاون قد يسمح بمثل ذلك ولو لم تظهر تفاصيله فى الأفق القريب. دعونا نتصور أننا نستعد لتخليق عالم واحد جديد وأننا أيضا فى حالة تخلق مستمرAlways in – the – making ونحن نستعد لجدل قادم مع عوالم متكاملة أخرى تتخلق فى كواكب أخرى. هذا إذا لم يتماد الأقوى فيما هو فيه حتى ينتحر، ويأخذنا معه، وهم السابقون فى لعبة الانتحار الجماعى. إننا نرتقى بهم وبنا، إذا رحمناهم من أنفسهم، ولم نستسلم. **** [1] – مجلة سطور: (عدد سبتمبر 2002) آسف: قد يجد القارىء بعض التكرار لما جاء فى مقالة “الاعتمادية الإيجابية تحت عباءة أكبر” ص 75 وقد تركت التكرار عامدا ربما لأننى أريد التأكيد عليه. “إن الدنيا بالخارج تمطر حامض “دنا” DNA على شفة قناة أوكسفود، أسفل حديقتى ثمة شجرة صفصاف كبيرة، وهى تضخ فى الهواء بذورا ذات زغب. ويتحرك الهواء بلا نظام، فتنجرف البذور إلى الخارج من الشجرة فى كل اتجاه …….، … هذه مقتطفات من فقرة طويلة نسبيا، لم أقتفطها من قصيدة حديثة، ولم أرتبها من شطح خيال مريض فصامى يسمح له أن يرى حامض دنا وهو ينزل رذاذا كالمطر الطل، ليمطر الطبيعة بالمعلومات الجينية المبرمجة. إنها نص ما جاء فى مقدمة الفصل الخامس من كتاب علمى عن “الجديد فى الانتخاب الطبيعي”([2])، ما الحكاية بالضبط؟ ما هو الفرق بين الفطرة والبدائية والعشوائية؟ وما الفرق بين البرنامج والمنهج ؟ وهل لا بد أن يكون المنهج معلنا حتى نعترف به، ونستطيع تقييمه ؟ وهل لا بد أن نعى بالفكر الظاهر: أى منهج نتبع؟ وهل يمكن أن نعرف المنهج “الذى كان” من خلال النتائج حتى لو لم نعرف المقدمات؟ إن تعليل تخلفنا المتمادى المهدد لوجودنا، والمعوق لمسارنا بغياب المنهج وتمادى ما يسمى العشوائية هو أمر يحتاج إلى نظر طويل. روعة التطور وقوانينه إن تاريخ التطور الحيوى، فيه حل لألغاز كثيرة، إن الإنسان بكل ما يميزه، (وما يعيبه) هو هذا الناتج الرائع لمسيرة التطور عبر ملايين السنين، ومع ذلك فهو الذى راح يسخر معظم جهوده بأذكى أنواع الغباء لإنكار تاريخه صراحة أو ضمنا، إنه لم يتخلق هكذا إلا بناء على قوانين محكمة جعلته يظهر حالا بهذا التركيب الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بأدق القوانين وأسلمها عبر التاريخ. إن مراجعة بسيطة لتاريخ التطور من أى نوع إلى نوع أرقى، سواء بالتشريج المقارن، أم بعلم الأجنة المقارن، أم بالنظر فى ترتيب مستويات الدماغ هيراركيا وتراجع الأحدث أمام الأقدم فى خبرة الجنون، أم بالتفهم اللائق لخيال دارون وولاس الذى حل لغز بزوغ هذا التصميم البديع المركب من تلك البساطة البدائية الرائعة، إن كل ذلك لا بد أن ينبهنا أن ما نسميه فطرة أو تلقائية أو حتى عشوائية ليست إلا إعلان عن جهل مركب بالقوانين الأعمق والبرامج الأذكى البعيدة عن إدراكنا المباشر حالا. إن التدهور الذى قد يلحق بجماعة من البشر، أو بكل البشر، حسب المخاطر المتزايدة حديثا، لا يكفى أن يفسر ببساطة بأن القوانين التى أوصلتنا لما نحن فيه قد بطل مفعولها بانتهاء عمرها الافتراضى، إن ثم تدخلا لاحقا يجرى حاليا يتدخل فى هذه القوانين ليفسدها ويعطلها. إن البداية الحقيقية للبحث عن أسباب التدهور المحتمل، تستلزم محاولة الاستفادة الجادة من فهم هذا السبق الرائع لانتصار الحياة التى صنعت هذا الإنسان الذى يحاول- مؤخرا بغباء منقطع النظير- أن ينكر تاريخه بسيطرة ظاهر وعيه. محنة الوعى البشرى حين امتحن الإنسان بمحنة الوعى، أصبح التخطيط بمنهج ما، والالتزام بتنفيذه من ضمن امتحانات البقاء التى طرحت سؤالا لم يسبق لما نعرف من الأحياء أن واجهوه، يمكن صياغة هذا السؤال على الوجه التالى: هل نجح الوعى البشرى الظاهر، بفضل اتساقه مع الفهم والتخطيط والتدبير وتصميمات الأناقة البيولوجية التطورية المركبة، هل نجح أن يستوعب تاريخه وهو يضع برامجه، ويحدد المناهج التى يوجه بها فكره ليحدد مساره؟ أم أنه ضل الطريق حين أصبح وصيا على قوانين البقاء الطبيعية ؟ هذه هى الإشكالة التى تواجه البشر هذه الأيام بحدة غير مسبوقة. إن تلقائية التطور قد نجحت عبر ملايين السنين بمنهج تلقائى محكم، قضى على من قضى، وأبقى على من أبقى. لكن الذى يحدث الآن – بعد أن تدخل الإنسان بروعة خطيرة فى منهج التطور- أن حسابات أخرى أصبحت تتدخل فى كل من صياغات المنهج وتنفيذه. هذه نقلة تطورية بلا أدنى شك، لكن من قال إن كل نقلة تحمل ضمان نجاحها؟ إن من الطفرات ما يمكن أن يقضى على جنس بأكمله. القضية الآن، ولعلها ترجع إلى عشرات القرون، أن الإنسان يتصور أنه امتلك أدوات التخطيط لمساره ومصيره، (تحت مسميات متعددة حسب المجال واللغة، مثل: علوم المستقبل، ودراسات الجدوى، والتخطيط، والهندسة الوراثية، وعلم تحسين النوع…إلخ) مع انتباه أقل إلى وحدة الزمن التى يلزم أن نتعامل بها فى هذا الصدد، والتى لا يمكن أن يتحقق تطور إلا من خلالها، وأيضا: بأقل قدر من الاستفادة من تاريخ التطور الرائع. لم يقتصر غرور الإنسان الحديث وهو يخطط مساره ليحدد مصيره على توفير ما يحافظ على استمرار الحياة للبشر، أو لبعض طبقاته، وإنما امتد إلى التخطيط لنوعية التواجد على هذه الأرض، بل وتمادى مؤخرا للتخطيط بالتدخل فى نوعية البشر أنفسهم (بالهندسة الوراثية الرائعة المخيفة)، ثم لتحديد موعد وشكل”نهاية التاريخ” طفرة خطيرة نحن لا نعرف فى تاريخ الحياة، بما فى ذلك مملكة النحل، أن طبقة خاصة من نوع من الأحياء قد اختصلت بالتخطيط لسائر نوعها حفاظا على استمراره، إن كل فرد من أفراد جنس ما كان دائما وأبدا مسئولا – دون وعي- عن سائر أفراد جنسه. وقد ظل الجنس البشرى طول تاريخه ينقسم على نفسه إلى طبقات وعناصر تتصارع أكثر منها تتآلف حتى كادت تودى بالجميع فى بعض فترات تطوره، لكن الثابت حتى الآن أن الأمور سارت إلى ما حافظ على استمرار الإنسان ضمن من استمر من أحياء وهو يؤكد تفوقه. لكن حسابات أحدث راحت تلوح بقفزة تطورية غير مسبوقة، وفى نفس الوقت بخطر الانقراض نتيجة لخطإ متسارع بشكل غير مقصود، ذلك أن الإنجازات الأحدث التى أتاحت فرص تضاعف قفزات التطور لصالح الأرقى، هى هى التى قد تسمح بخطورة تمادى الأخطاء بسرعة لا يمكن اللحاق بها قبل تمام الدمار الشامل. البشر الآن يتصلون ببعضهم البعض دون إذن، وهم فى نفس الوقت يرضخون لتشويه مبرمج دون اختيار.، ومع تمادى محاولات السيطرة على ناحية، وتزايد المقاومة رغم ضعف إمكانياتها على الناحية الأخرى : يكاد العالم ينقسم إلى قسمين رئيسيين بطريقة غير مسبوقة، فـ”الذى يستطيع” “يفعل”، وما يفعله قد لا يكون هو الصواب، مهما بدت حبكة منهجه، وهو قد يضر نفسه بل وقد يعجل بنهاية نوعه، و”الذى لا يستطيع” يصيح أو يرسم أو يغنى أو يقوم بمظاهرة هنا أو ينظم مؤتمرا هناك، وقد ينتحر احتجاجا أو يأسا أو إنذارا، فيبدو لأول وهله أنها معركة خاسرة للطرفين، فالأقوى هو الأغبى والأسرع، والمتخلف، وبرغم قربه للطبيعة، هو عاجز تماما. “الذى يستطيع” يزعم أنه صاحب منهج محكم، ورؤية مبرمجة، وخطة كاملة ترسم التاريخ حتى نهايته، لصالح فئته ورؤيته ومثـله التى اصطنعها لنفسه، ولم يستلهمها من تاريخ الحياة، فى حين أن”الذى لا يستطيع” يتهم بالفوضوية والتخلف والعشوائية، وهو لم يعد قادرا على الاحتماء بقوانين الطبيعة التى أوصلته إلى هذا المركز المتفوق على الأحياء المعروفة، لأنه تنكر لها خفية إن الطبيعة لا تقاوم من ينكر قوانيها لكنها تلفظه فينقرض، كما أنها لا تدعم من يكسل عن اتباع قوانينها حتى العجز، وهى تلفظه أيضا بنفس الحسم. النتيجة أن “الذى يستطيع” يتخلى عن الطبيعة أو هى تتخلى عنه، لتتركه مسجونا فى منهج شديد الإحكام والنجاح، لكنه يفتقر الاتصال بالأصل الذى أوصله إلى قدراته تلك، فهو يتنازل عن تاريخه الممتد ليتسلح بغروره المهلك، ثم هو يقود العاجز إلى حيث لا يدرى. وبرغم كل ذلك، فمهما بلغ الشك فى المنهج المحكم المغلق الجاهز القامع، فإنه لا يمكن أن يكون مبررا لأن يقف أى واحد ليدافع عن غياب المنهج، أو ليقف بجانب العشوائية (كيفما اتفق). إن منهجا زائفا صلبا وقاهرا مهما بلغ طغيانه وغباؤه هو أفضل – مرحليا – من اللامنهج، فالمنهج الزائف يحمل مقومات هدمه من واقع زيفه، كما أنه قد يستثير ضده ليحل محله. أما (تصور) اللامنهج – مع الانفصال عن الطبيعة- فهو يتيح عمل مناهج خفية مدمرة، بلا أمل فى رصدها لتجاوزها. قياس حذر يمثل المرض النفسى من منظور تطورى فرصة نادرة للتعرف على تاريخ التطور الحيوى، وتكبيره والنظر فيه حالا، بعد أن يتعرى الغطاء الأحدث، كما يمثل تاريخ تطور الطب النفسى نموذجا مصغرا يمكن القياس عليه بحذر شديد. لقد مر الطب النفسى الحديث أثناء تطوره بمرحلة خطيرة، حين ظهرت وتمادت الحركة المناهضة للطب النفسى المسماة “ضد الطب النفسى”،Anti-Psychiatry بدأ ذلك فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى أكثر من بقعة فى العالم معا (مثلا: فى إنجلترا: هـ .لانج، د.كوبر، وفى أمريكا: ت. زاس، وفى إيطاليا: بازاجليا….إلخ) ثم بالغت هذه الحركة فى البحث عن “معنى للجنون” باعتباره موقفا احتجاجيا ضد الاغتراب المعاصر واعتبرت أن هذا الاغتراب هو الذى أدى ضمن مضاعفاته إلى الحرب العالمية الثانية. وأن العجز عن مواجهته هو التفسير المناسب لغلبة هذا الاحتجاج المبرر (الجنون). لكن هذه الحركات التى حاولت البحث عن الغاية والمعنى وراء ”تناثر العقل وتفكك الذات” حتى الجنون (فالقتل الجماعى) تمادت فى موقفها العدمى”ضد” المنهج و”ضد” السلطة و”ضد” العقاقير، حتى كاد المتابع لسرعة انتشارها يعلن – ولو فى تردد – أن “الجنون هو الحل”. ومثل كل حركات الأضعف، التى يغلب فيها الحماس على التخطيط، والنفى على الإبداع، انتهت إلى فشل ذريع، ليس لأنها خطأ مطلق، ولكن لاعتمادها على الهجوم على منهج جامد زائف دون (أو قبل) وضع منهج بديل، إن ثورة المجنون فى بداية الرفض هى ثورة ما فى ذلك شك، لكنها فى النهاية تحطيم على مبدأ “علىَّ وعلى أعدائي”، وفى كثير من الأحيان تكون النتيجة هى “علىّ دون أعدائى”. لا يمكن إنكار أن للمجنون منهجه الخاص فى الاحتجاج. فهو مهما بدا متناثرا مفككا على السطح، إلا أن الممارس للعلاج العميق مع هذه الفئة التى نتصور أنها تمثل قمة عشوائية تناثر العقل، لا بد أن يتعرف وهو يغوص مع مريضه إلى أعماقه على مدى صلابة عناده، وقوة أسلوبه المتمادى فى تحطيم ذاته وهو يتصور أنه يحطم عدوه المتسبب فيما صار إليه. إن تمسك المجنون بالحل الفاشل لا يعادله إلا تمسك المغترب بالحل الزائف. الذى يحدث عبر العالم الآن هو نموذج أشبه بهذا الحل بالجنون مقابل الضياع بالاغتراب، الحل بالتفكك فى مقابل التشويه بالزيف، وكلاهما يحمل منهجا خاصا به، وكلا الطريقين يشتركان فى تهديد الجنس البشرى بالانقراض. يكاد التخلف المهترئ الذى يعيشه العالم الأفقر (الذى لم يعد محدودا بجغرافيا أو بتاريخ بذاته) أن يكون أقرب إلى الالتزام بمنهج الاحتجاج السلبى بهدف تحطيم العالم الذى يسحقه، ولا مانع عنده أن يتحطم معه. كما أن التقدم الزائف الذى يتطاول كل يوم فى البنيان بعيدا عن الأوطان والحكومات بل وحتى الأفراد، يبدو وكأنه قد نسى هدفه تماما، فراح يتمادى “فيما يفعل فقط”. يتمثل ذلك فى المسار الذى تمثله ما يسمى الآن “الشركات العابرة للأوطان، ثم للقارات، ثم لأصحابها”. أصبحت القوى المتحكمة فى العالم تسخر كل الأدوات والمناهج، بما فى ذلك المناهج العلمية، والتجريبية والمعلوماتية وحتى الدينية (الأصولية والمستحدثة جميعا) لصالح “ما لا تعرف”. وللأسف، مثلما هو الحال فى الجنون، تواجه قوى الاحتجاج الأضعف كل ذلك بإحياء العصبية البدائية، والتسليم لمنهج التفكيك دون أية قدرة على إعادة البناء. وقد ترفع أثناء ذلك شعارات لافتة صحيحة لا فائدة منها، رغم حكمتها (مثل “حكمة المجانين”) شعارات مثل: الرجوع للأصل والتمسك بالفطرة، والفخر بالقديم، وضرورة العدل… إلخ..(راجع بيانات قمة الأرض مؤخرا) . إن هذا الموقف الصعب ينبهنا أن علينا ألا نرجع باللائمة على أحد الطرفين دون الآخر، نحن نحتاج إلى نظر أعمق من مجرد التراشق بالاتهامات. إن فروضا قديمة ينبغى أن تتجدد، كما أننا نحتاج إلى فروض حديثة تسهم فى جلاء الموقف أكثر فأكثر، ومن ذلك: الفروض أولا: إن معظم الأحياء التى حافظت على بقائها تؤكد من خلال ذلك أنها اتبعت منهجا ممتازا ناجحا سمح لها بذلك. ثانيا: إن المنهج لا يحتاج دائما أن يكون معلنا، إنه قد يوجد سواء عرفناه قبل البدء فى الفعل أم استنتجناه بعد تحقق فاعليته. إن المنهج يمكن أن يُستـَنـْتَجُ بنتائجه، بقدر ما يمكن أن يُختبر بمقدماته. ثالثا: إن الوعى الذى ابتلى به الإنسان قد ميزه وشرفه، وفى نفس الوقت قد وضعه فى مأزق خطير، فهو يلزمه أن يتبع منهجا يتفق مع ما يمتلك من فكر وخيال وإبداع، ويمده بأدوات تقنية ومعلوماتية تضاعف قدراته على التحكم فى التطور، لكنه يحمله مسئولية الوقوع فى خطأ قد يكون كافيا لانقراضه. رابعا: إن التدهور الذى نعانيه نحن وأمثالنا لا يمكن أن يعزى -ببساطة- لغياب المنهج، بل إن الأصوب أن نبحث عن منهج خفى نمارسه فى إصرار (بعناد مجنون) ونحن نتمادى فى التحطيم والتدهور، فى حين نتصور أننا نحتج ونختلف. إن المسئول ليس مجرد غياب المنهج، بل اتباع منهج مدمر، حتى لو لم نتبين معالمه بوضوح كاف. خامسا: إن المدخل الصحيح هو إعادة النظر فى علاقتنا بالطبيعة الآنية وأيضا، وربما أهم، هو حسن مراجعة التاريخ الطبيعى للأحياء، لعلنا نتدارك الأمر باستكشاف ماذا حفظ، و يحفظ، البقاء الحقيقى للأحياء بما فى ذلك الإنسان بما حقق من تميز وقيادة وريادة ووعى وإبداع. الإنسان والطبيعة إن الممارسة الحياتية الآنية بكل أخطائها إذا ما نظر إليها من خلال دروس التاريخ الحيوى، وصولا إلى التاريخ البشرى، لا بد أن تؤكد لنا أن الفرصة ما زالت سانحة للتجمع والتواصل لتدارك الخطأ قبل فوات الأوان. المطلوب هو البحث عن المنهج الذى يصالح الإنسان على تاريخه، وفى نفس الوقت يحافظ على استمرار تنمية كل ما أسهم فى نجاح رحلته التطورية حتى صقل أحدث مناهجه وأدواته من خلال قدراته ووعيه الفائق الحديث. ليس معنى اكتسابنا للوعى أن ننفصل عن الطبيعة ثم نكتفى بالاهتمام بتنظيفها بعد تسميتها “البيئة” لحساب استمرار ما نتصوره، إن التعامل الأسلم مع الطبيعة هو التعمق لاستخراج منهجها الذى أفرزنا بفضل الله. إن الطبيعة هى المنبع، والطبيعة هى المصب، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا وذاك. إن الطبيعة ليست محيطا منفصلا عنا مثل بيت نسكنه ونحن نحرص على ترتيبه على مزاجنا. إنها ليست مجالا خارجا عنا يتلوث أو يـنظف حسب حرصنا على ما نلقى فيه أو ننفث عبره، الطبيعة هى نحن شخصيا. لا يمكن أن نمنع تلوث الطبيعة بالتعاقد مع شركات مثل شركات النظافة فى الإسكندرية أو القاهرة، المطلوب هو التصالح مع الطبيعة والحوار المتصل وإياها لتواصل مسيرتها لصالح ما تعد به كما علمنا التطور. المواجهة والأمل كما جاء فى المقدمة، فإن ما يمر به الإنسان من تهديد بالانقراض ليس جديدا، وحتى لو كانت الأدوات المتاحة تنذر باحتمال التسارع بالنهاية قبل المراجعة، فإن نفس هذه الأدوات هى القادرة على رأب الصدع وتعديل المسار. الأمل هو أن نرفض التفسيرات المتعجلة مثل تبرير تخلفنا بافتقارنا إلى المنهج والتمادى فى العشوائية، أتصور أننا نمارس منهجا لا تجارى كفاءته لتحطيم أنفسنا، إن ما يجرى فى “داخلنا” ليبرر الكسل والتقاعس وإلقاء اللوم على غيرنا (التفسير التآمرى) كما يبرر التأجيل والبيانات والاكتفاء بالتصريح والتلويح بالفعل دون الفعل، وغير ذلك، هو من معالم هذا المنهج السلبى الخفى القادر على تدميرنا، دون أى جهد منهم. وهم أحوج ما يكونون إلينا. إن الزعم بأن ما آل إليه حالنا إليه هو نتيجة للافتقار للمنهج وليس نتيجة لممارسة منهج خفى مدمر، يبدو وكأنه دعوة ضمنية لاتباع منهج مستورد حسب احيتاجاتهم لاستعمالنا، لتحقيق ما يتصورونه نموذجا لغاية ما يمكن للإنسان أن يحققه (نهاية التاريخ). لا مانع أن نكون خدما إذا كنا غير قادرين على غير ذلك، ولا ما نع أن نتبع منهجهم إذا كنا لا نملك إلا منهج تدمير أنفسنا بأنفسنا، لكن ليكن هذا معلنا بدلا من استسهال التفسير بغياب المنهج، مع التلويح بوعود لتحقيق أهداف لم نـشترك فى صياغتها، ولا هى تنفعهم، ولا هى تحقق ما هو نحن أو ما خلقنا الله له. إذن ماذا؟ ليس عندى أية رغبة فى المغامرة بعرض منهج بديل، لعجزى عن ذلك من جهة، ولأن أى منهج لا يمكن البدء فى تطبيقه الآن، يصبح – على أحسن الفروض – يوتوبيا معطـلة. كل ما أستطيع تقديمه هو أن أعرض خطوطا عريضة مستلهمة من تاريخ التطور الحيوى الرائع. إن أى منهج يهتم بجزء دون الكل، أو ينمى مستوى من الوعى على حساب آخر، حتى لو كان هذا المستوى هو الأحدث قد ينجح فى تحقيق مهمته المحدودة، لكنه أبدا لا يحقق إنسانية الإنسان كما خـلق. إن ما يبدو من افتقارنا – نحن المتخلفين- إلى منهج واضح ينبغى ألا يلهينا عن حقيقة أننا نسهم فى إتباع منهج مدمر يسرع باستبعادنا وهلاكنا أولا، ثم يحرمهم من جدل محتمل قد ينقذنا معهم من تدهور حتمى إذا اقتصر الأمر على زيفهم الأوحد. ومع ذلك فإنه من الأفضل لنا أن نتقن منهجا زائفا من أن نخدع أنفسنا باحتجاح عدمى ميت. أو نتصور أننا لا نمارس منهجا أصلا، فى حين أن جهدنا كله موجه -فى الخفاء – للاستمرار فى ممارسة مناهج سلبية تقوم بالواجب فى تسهيل تحطيمنا وتهميشنا، وتوفر عليهم جهد محاولة الخلاص منا إذا ما يئسوا من استعمالنا. (ملحوظة: هم، ترجع إلى أهل الزيف العابر للقارات والبشر والتاريخ، و”نحن” ترجع إلى المستضعفين فى الأرض، ظالمى أنفسهم، من كل جنس ولون ودين) إن المنهج الذى نحتاجه، بل ويحتاجه كل البشر، يبدأ من إعادة النظر للتعمق فى فهم كيف نجحت مسيرة التطور حتى الآن. إن وضوح علاقتنا بالطبيعة، وتحديد طريقة ممارسة هذه العلاقة بالفن والإيمان المبدع وشحذ العبادة، واحتمال تنمية هذه العلاقة بالممارسة الحقيقية عبر تربية متكاملة، هى التى تجعل للمناهج المحكمة الأحدث معنى وقيمة فى إثراء الحياة واستكمال مسار التطور الحقيقى الذى يعد به تاريخ هذا الجنس البشرى الرائع. الأمل الآن هو أن يحقق الانقسام الذى حدث فى العالم ما بين القوى المسيطرة على ما لا تعرف، وبين القوى المقاومة لذلك، هو أن تسهل وسائل التواصل والتوصيل فى تحديد أهداف جديدة للجنس البشرى تليق بتاريخه، أهداف يمكن أن تقاس بمحكات جديدة غير المحكات الكمية الاستهلاكية، وبالتالى يمكن أن نحققها بمناهج جديدة. كان الإنسان قديما يحتاج بين الحين والحين إلى وحى من السماء يصحح مساره كلما انحرف، وكانت رحمة الله ترسل له الرسول تلو الرسول يحقق ذلك فى بقعة جغرافية بذاتها، ثم تنتشر أو لا تنشر رسالته بقدر ما لم تتشوه ولم تستول عليها حركات مضادة باسمها، ثم ختم الله النبوات بمحمد عليه الصلاة والسلام ليحمل الإنسان مسئولية تعديل مساره دون انتظار نبى جديد أو دين جديد، وحين وصلتنى هذه الرسالة من فيلسوف الإسلام الشاعر محمد إقبال قلت فى كتابى “حكمة المجانين” (لسنا فى حاجة إلى دين جديد ولكننا فى حاجة إلى ملايين الأنبياء). الفرصة الآن أرحب بعد أن أصبح الناس من كل حدب وصوب، على كل دين ولون، قادرين على التواصل لرفض وصاية المناهج المغلقة، ورفض الاقتصار على غلبة وعى كمى، ورفض التسليم لنوعية حياة رخوة أو لذية بحتة، ورفض الانخداع بتصور غياب المنهج وفى نفس الوقت أصبح الناس قادرين على التعاون فيما بينهم لابتداع مناهج جديدة، حتى لا يقعوا فى مأزق يشبه مأزق الجنون الذى يقتصر على الرفض دون البديل. ****
[1] – مجلة سطور: (عدد أكتوبر 2002)، كان العنوان الأصلى: “ثورة المجنون واحتمالات مآلها الإيجابى!” لكننى فضلت العنوان الحالى. [2] – تأليف ريتشارد وكنز، وهو كتاب كتب بحب شديد للحياة واحترام بالغ للتطور، ترجمه د.مصطفى فهمى إبراهيم، بنفس الحب والجمال، وقد حذفت بقية المقتطف لصعوبته البالغة. من يراجع مسار الإنسان فردا ونوعا، بكل تاريخه الحيوى، ثم ينظر إلى ما يحدث بنا، ولنا، ومن حولنا مما يبدو مناقضا للمنطق الظاهر والعقل السليم. لا بد وأن يتوقف مذعورا وهو يستشعر نكسة شاملة تحتاج إلى يقظة كل فرد من هذا النوع البشرى طول الوقت. إن التطور البيولوجى الذى لم نعرفه إلا استنتاجا من التشريح المقارن، وعلم الأجنة المقارن، وخيال بعض المبدعين من العلماء (أمثال داروين وولاس) المدعم ببعض الملاحظات الناقصة، هو المفتاح الذى أحاول أن أفك به شفرة طلاسم ما آل إليه حال البشر حالا. كل المزاعم المعلنة، من القابعين أعلى الدرج، تدعى أنها تسعى إلى الأمان أو السلام للعالم. كل القائمين بهذا القتل والتشريد والاستغلال والاستعباد. يرفعون شعار السعى إلى مجتمع حر آمن من شر الإرهاب، (يقصدون: من شر الاختلاف مع الذين أنهوا التاريخ لحسابهم). ما الحكاية بالضبط؟ هل الأمان بمعنى ضمان الأمن والسلامة هو غاية الحياة، أم أنه الوسيلة لاستمرارها؟ وإذا كان مجرد استمرار الحياة عند الكائنات الأدنى هو غاية المراد للحفاظ على النوع، فهل هو كذلك عند الإنسان بعد أن امتحن بالإسهام فى تقرير مساره ومصيره بدرجة ما من الوعى اليقظ؟ وما هو نوع الأمان الذى يمكن أن يحافظ على حياة نوع على حساب نوع آخر من الأحياء ؟ هل هو نفس نوع الأمان الذى يسمح بارتقاء الإنسان إلى ما يمكن أن يكونه ؟ وماذا لو عجز النوع الأرقى (مثل البشر) عن تحقيق أمان لائق بما وصلت إليه مرحلة تطوره (من اكتساب الوعى وفرص الحرية وشرف المسئولية) ؟ هل يرتد إلى نوع سابق من الأمان؟ أم يواصل السعى إلى ما هيأته له مكاسبه على مسار التطور؟ وهل فى محاولة الإجابة على هذه الأسئلة ما يفسر بعض ما يجرى؟ فشل التقمص وضرورة البحث لا أتعرف على مرضاى بتعليق لافتة عليها اسم مرض. أنا أتعرف عليهم بالتقمص، مما يعرضنى لهزات ليست عابرة، لكنه يمكننى من فهم معنى ما اضطرهم إلى ذلك (إلى آن يختاروا المرض حلا خائبا!)، كما أحاول أن أترجم لغتهم الخاصة إلى ما عجزوا عن التعبيرعنه بلغة الكافة. أفعل ذلك بسهولة بسبب طول المران، لكننى أعجز حين أحاول نفس المحاولة مع من يسمون “الأسوياء”. حين بدأت فى محاولة تقمص بعض الأفراد المسئولين عن الجارى فى الدنيا هذه الأيام، كان موقف السيد دبليو الأمريكى أصعبها علىّ رحت أتساءل: ماذا يمكن أن يكسبه هو شخصيا من هذا القتل بالجملة لأبرياء لا يعرفهم، بل لم يسمع عنهم أصلا، وحتى إذا سمع عنهم فيبدو أنه لا، ولن، يفهم موقعه – الإنسانى – منهم، أو موقعهم منه.؟ هل يمكن تفسير كل هذا الذى يجرى بمجرد رغبة فرد، هو وبطانته، أن تمتد فترة شغلهم للبيت الأبيض أربع سنوات أخري؟ هل هذه السنوات من المنظرة والسيطرة والرئاسة والخطب التى لا يعرف هذا الدبليو كيف يلقيها، والأوامر التى ليس له دور إلا فى تسميعها وترديدها وهو لا يعرف مصدرها، هل كل هذه الوظائف والنشاطات كافية لتبرير موقفه وهو يواصل بكل العمى كل هذا القتل والذبح والإذلال والإبادة؟ هل هذه الحروب التى أتاح لنفسه ولذويه فرصة خوضها بفضل 11 سبتمبر، الذى لا يستبعد أن يكون هو أو رجاله من أهم صـُـنـّـاعه، بشكل مباشر أو غير مبشار، هل سيعود عليه كل ذلك هو شخصيا بآى فائدة تستأهل كل هذا النكوص والقتل والردة؟ هل ممارسة كل ذلك بكل هذه الضراوة هنا وهناك ستجعله – فردا أجمل أمام نفسه، أو أمام ابنته، أو زوجته، أو صاحبته، أو حتى أمام كلبـته؟ لم أستطع أبدا أن أنجح فى تقمص شيخ خفراء العالم الغشيم هذا (أو شيخ المنسر) أكثر من ذلك. من أسهل السهل أن نعزو غزو أفغانستان ثم التخطيط لغزو العراق، والاستمرار فى إبادة الشعب الفلسطينى بكل ما يصاحب ذلك من تقتيل وتشريد وإذلال وإبادة، من أسهل السهل أن نبرر كل ذلك بمصالح شركات البترول والسلاح والدواء والمعلومات، وهذا ما أفعله – مثل غيرى – مكررا، سواء كانت تلك هى الحقيقة أم أنها جزء مما يسمى التفكير التآمرى. لكن هذا التفسير،الذى يبدو لأول وهلة وجيها مقنعا، احتاج منى أن أنتقل خطوة أخرى حين رحت أتصور ما يمكن أن يعود على هذه الشركات من فائدة، لا باعتبارها كيانا اعتباريا يسير بالقصور الذاتى نحو التراكم الكمى دون هدف موضوعى، لكن بتجسيدها فى أفراد من البشر لهم أسماء وجوازت سفر وأطفال وأحلام، وحين لم أتمكن من رصد ما يعود على أى فرد بعينه من فائدة تفسر لى ما يجرى من حولى، تأكدت حاجتى إلى تفسير آخر. نحن لا يمكن أن نستسلم للتفسيرات السطحية الشائعة ونحن نرى العالم وكأنه يدار بواسطة شخص يصفه عضو حزب العمال البريطاني”آلان سمبسون” قائلا: ” بحزن، أعتقد أن بوش سيضرب العراق بالطريقة التى يضرب بها ثمل قـنينة المشروب” (النيوزويك 5 أكتوبر 2002). أمان وأمان إن الإنسان بعد أن اكتسب القدرة على الاختيار والتخطيط لم يعد يناسبه أن يحقق الأمان بنفس الطريقة التى نجح أجداده فى اللجوء إليها عبر التاريخ الحيوي.، يتحقق الأمان فى الأحياء الأدنى بوسائل دفاعية لا حصر لها، نكتفى هنا بالإشارة إلى نوعين دون التطرق إلى تفاصيل مضامينهما. أولا: الأمان بالتكاثر، والاحتماء بالقطيع. ثانيا: الأمان بالافتراس والتخلص من المختلف. النوع الأول من الأمان تحققه البكتريا – كمثال- بالتسارع بالانقسام وتكوين المستعمرات الخاصةcolonies، (ربما لهذا فرحت حين عرفت أن حديث “تناسلوا تكاثروا….إلخ” لا وجود له فى كتب الأحاديث المعترف بها) أما النوع الثانى فهو يتحقق فى الغابة عادة بين طبقات الحيوانات المفترسة، الأقوى فالأقوى. وفى كلا الحالين يتم الحصول على الأمان البدائى عن طريق إلغاء “الآخر” “المختلف”، اللهم إلا فى بعض الصفقات البيولوجية، الطفيلية عادة. الأمان البشرى أمان الإنسان، له مواصفات أخرى تتجاوز الأمان البدائى بالتكاثر، أو بالقطيع، أو بالافتراس. (1) بما أن الإنسان لا يكون كذلك (إنسانا) إلا مع، وفى حضور إنسان آخر من نفس نوعه، إنسان آخر مختلف وموضوعى وماثل طول الوقت فى الواقع و/أو فى الوعى. فإنه لا يتحقق الأمان البشرى بدون الجدل الحيوى مع هذا الآخر البشري. (2) إن مجرد تواجد الإنسان مع إنسان آخر لا بد أن يمثل تهديدا متجددا. حتى فى الزواج الرسمى، يمكن أن نلحظ أن مجرد اقتحام آخر لدائرة الوعى بهذه الطريقة اللصيقة، يولد تهديدا رائعا وخطيرا فى آن. (3) إن قبول هذا التحدى (التهديد بالاختلاف مع حتم الاستمرار معا) يخلق نوعا من “اللاأمان الموضوعي”، الذى هو الطريق إلى الأمان البشري. (4) إن هذا اللاأمان الموضوعى لا يمثل قهرا يدفع إلى الإسراع بالتخلص منه، ولا هو عكس الأمان الذى تسلحت به الأحياء فى المراحل السابقة للنمو أو التطور. إن هذا اللاأمان الموضوعى هو هو الحافز لحركية جدلية مع الآخر (وليس لمجرد “قبول الآخر” كما يشيعون) ليحققا معا نوعا أرقى من أمان إبداعى، دون تحقيقه، لأنه مفتوح النهاية. (5) إن جدلية الإيمان سعيا إلى وجه الحق سبحانه وتعالى، (وهى الموقف المرادف لمسيرة النمو مفتوحة النهاية) إن صحت ممارستها واقعا آنيا، هى التى تحافظ على زخم حركية متصاعدة، دورية إيقاعية بطبيعتها، متجهة نحو أفق مفتوح، لا يلغى اللاأمان، ولا يستسلم له فى نفس الوقت. (6) يتوقف نجاح الإنسان فى تحقيق هذا الوجود الصعب على ماتتاح له من فرص نمو سليم فى مجتمع يستوعب مراحل النمو البشرى كما يليق. إن درجة نمو المجتمع البشرى المحيط، بدءا من الأسرة امتدادا إلى العالم أجمع، هى التى تتيح للإنسان الفرد، فى كل موقع، أن يكون إنسانا. الردة الذى يجرى الآن يشير إلى أن طريقة الحياة، وطريقة التربية، وخدع السياسة، وكذب الشعارات (بما فى ذلك شعارات الديمقراطية الزائفة، وحقوق الإنسان الموثقة على الورق فقط، للتطبيق الانتقائي) كل ذلك يشير إلى أن أغلب الذين يجلسون على القمة ليديروا المجتمع البشرى فى الوقت الراهن، لم يعودوا يحتملون أن يواصلوا مواجهة هذه الصعوبات الرائعة، لتهيئة الفرصة للإنسان أن يكمل مسيرته إنسانا.لقد فشلوا أن يحققوا الأمان البشرى، فارتدوا إلى أمان القتل والتكاثر والقطيع. قياسا على النمو الفردى (1) لايوجد أكثر أمانا من جنين فى رحم أمه تحيطه جدران الرحم وهو يترجح فى السائل الأمنيوتى بعيدا عن مخاطر البيئة الخارجية وعن اختلاف الناس وعن عشوائية المظالم. هذا الموقف يشير إلى نوع من الأمان ليس فيه “آخر” أصلا. ويسمى ”الموقف االمنفرد” أو بالتعريب، وهو أفضل هنا، الموقف الشيزيدى Schizoid Position وهو موقف نمائى عند كل الناس، ليس خاصا بالفصاميين. (2) بمجرد أن يولد هذا الطفل ينتقل من موقف الأمان الأولى (الموقف الشيزيدي) إلى مواجهة حقيقة لم يكن يعرف عنها شيئا وهو فى بطن أمه، وهى أنه ليس وحده فى هذا العالم. فهو يشعر بالتهديد من أى كائن آخر، من أى ممن هو “ليس أنا”. تبدأ علاقة الرضيع مع العالم الخارجى (الذى يتمثل حتى ذلك الحين فى أمه أساسا) باعتبار أن كل ما يقع خارجه – بدءا بأمه- هو خطر صرف: [“كل من “ليس أنا” هو تهديد لوجودى، لأماني]، وهذا ما يسمى “الموقف البارنوي”([2]) Paranoid Position (وهو ليس علاقة مباشرة أيضا مع مرض البارانويا). فى هذا الموقف تكون علاقة الطفل بالآخر بمثابة علاقة حربية معلنة، باعتبار أن أى آخر هو مصدر تهديد بالإغارة. هذا الموقف يعترف بالآخر بعكس سابقه الذى يلغيه تماما، لكنه يعلن باعترافه هذا: أن كل ما هو ليس أنا (not me) ، هو تهديد ينبغى التخلص منه (هل تذكر تعبير بوش وبطانته وتابعه أنه من ليس معنا فهو ضدنا هذا الشعار هو إعلان الردة لإبادة المختلف باعتباره يمثل تهديدا ينبغى إزالته؟؟) (3) يتواصل نمو الطفل بعد ذك (كما تواصل التطور من قبل) لتبدأ مرحلة حضور الآخر متكاملا متناقضا فى الوعى، وفى الواقع على حد سواء، وهو ما يسمى: الموقف الاكتئابي(Depressive Position) هذاالموقف بالذات، الذى ليس له علاقة مباشرة بمرض الاكتئاب، هو مرحلة حتمية فى النمو لنكون بشرا، وهو المرحلة المميزة لما حققه الإنسان المعاصر الأرقى من جدلية نتيجة للوعى والحرية والإسهام فى تخليق ذاته مؤخرا. وهى هى نفس المرحلة التى يحرموننا منها بفضل السياسة، وسوء استعمال أدوية السعادة المدغدعة واليقين المصنوع، والتدين الساكن المتجمد. تفسير الجارى بقياس حذر خطر لى أنه يمكن تتبع مراحل الأمان البدائية على مستوى الدول قياسا بما قدمناه على مستوى تطورالأحياء ومراحل نمو الفرد، فجاءت قراءة الجارى على الوجه التالى: كانت الخطة الباكرة لأمريكا (الدولة) هى الاستغناء عن العالم الخارجى حيث بدأت بالتراجع أولا إلى العزلة (السياسية والاقتصادية، التى أسمتها الاستكفاء الذاتى، بما يعنى الاستغناء الذاتى، وهو ما يقابل الموقف الشيزيدي). ثم انتقلت أمريكا بعد أن امتلكت أدوات التخلص من كل المخالفين، انتقلت إلى مرحلة الهجوم الوحشى على كل من هو ليس أنا: وهو ما يقابل الموقف البارنوى (للفرد والنوع معا). موازيا لهذا وذاك عجزت أمريكا عن أن تحتمل وجود الاتحاد السوفيتى مختلفا، فكانت النتيجة، بعد أن أسهمت فى انهيار الأخير، أن الولايات المتحدة طغت وتغطرست وتنازلت عن مواصلة المسيرة البشرية إذ استفردت بالأمر والنهى والحساب والعقاب، فى حين سلم الاتحاد السوفيتى نفسه لصفقات ربما تحفظ ماء وجهه، ولكنها تنفى وجوده آخرا مختلفا([3]). على الجانب الآخر راح الشرفاء والمبدعون من أمريكا الناس، مع كل الناس، راحوا يواصلون مسيرتهم إلى غاية البشر الواعدة. راحوا يبدعون، ويتحملون، ويحاورون، ويحتجون، حتى كان آخر ما سمعنا من إعلان الألفى مفكر ومثقف أمريكى وهم يصيحون فى وجه هذا الدبليو أنك لستَ نحن، وأنه قف عندك يا غبى، (وهذا ما قد يقابل الموقف الاكتئابى، وهو الموقف الإنسانى الجدلى الممتد). فروض من منظور التطور من هذا المنطلق التطورى خطرت لى سلسلة من الفروض لتفسير الجارى على الوجه التالي: أولا: فشل اليقين المصنوع” (من الجانبين: الدينى المتجمد، والوصاياتى الأحدث) فى الحفاظ على الاستمرار للاستمرار، ربما لأنه كان لصالح فئة محدودة على حساب سائر أفراد النوع. ثانيا: رأت الشركات التى تمثل قمة الاغتراب الكمى المعاصر، والتى لم تعد تنتمى لوطن أو دولة أو مبدأ أو بشر، أن بقاءها واستمرار عملقتها، مرتبط بقواعد ونزعات وغرائز بدائية لا ينبغى أن تغيب عن وعى الناس حتى تضمن استمرار مسيرتها اغترابا وتراكما كميا. فراحت تسلك الطريق الأضمن لها بأن تثير فى الناس بطول الدنيا وعرضها رعبا بدائيا يدفعهم إلى النكوص إلى مراحل كانوا على وشك تخطيها. ثالثا: لعلها –الشركات- هى التى دبرت، أو استغلت يطريق غير مباشر، حادث 11 سبتمبر لتحقيق ذلك، وبعد تمثيليات الاتهام والأشرطة والغزوات والتقتيل، راحت تنفخ فى لهيب اللاأمان البدائى بشكل متواصل لا يقتصر على الحادث اياه. ردة محسوبة إن هذه الفروض لا تفسر فقط ما جرى حتى الآن من حروب وقتل وتدمير، لكنها تفسر – أيضا – كيف أنه كلما تصور أصحاب المصلحة الخبيثة الجاثمة أن الإنسان الأمريكى (والأوربى، ثم كل الناس) قد نسى، أو يمكن أن ينسى ما جرى فى ذلك اليوم (11 سبتمبر)، ألقوا بكرة مشتعلة، أو سكبوا مزيدا من البترول على نار اللاأمان حتى لا تهمد، وذلك ليحافظوا على استمرار الشعور بالهلع البدائى طول الوقت. يفعلون ذلك: مرة بالمبالغة فى حكايات جمرة الأنثراكس، ومرة بإشاعة العثور على قنبلة قذرة تحوى مواد نووية، ومرة بتلفيق امتلاك قنبلة ذرية لمن لا يملك قوت عياله. إن كل ذلك يسخر ليؤدى إلى الحفاظ على دفع اللاأمان البدائى حتى يبرروا مواصلة الكر فالإغارة لـنفى الآخر، للحصول على أمان زائف منفرد ساكن، يمارسون من خلاله اغترابهم الكمى المتزايد. هذا الأمان الزائف البدائى الساكن هو الذى يظهر تحديدا فى موقف: ” كن معى والإ قتلتك!!”، وهو الذى يتطور تدريجيا إلى ” كن تابعى وإلا أبدتك”، فتكون النتيجة بعد نجاح القتل والإبادة هى إلغاء الآخر جملة وتفصيلا، سرا أو علانية. الأضعف يستجيب بنكوص مقابل استجابة لهذا الموقف من الأقوى صاحب المصلحة فى الردة والنكوص، يجد الأضعف نفسه فى موقف الضحية الذى لا يملك أبسط الوسائل للدفاع عن النفس، فهو يستجيب لقهر الأقوى بالانسحاب فالتسليم، أو بالانتحار (لا أعنى العمليات الاستشهادية، وإنما أقصد الكسل واليأس) أو بالتكاثر منفصلا عن كل من خالف قطيعه، فضلا عن الذهول بالجمود. يضاعف هذا الموقف أن حكام هؤلاء المستضعفين يبدون وكأنهم قد تحالفوا سرا مع الأقوى لإذكاء نار اللاأمان البدائى بدورهم، فكأنهم يمارسون تفويضا – محدودا -للعب نفس دور القوى الناكصة الأعلى. إنهم يلعبون مع شعوبهم المقهورة نفس الدور الذى يلعبه الأقوى مع المختلـفين عنه عبر العالمم. ثم تتفاقم المصيبة حين تشارك الشعوب الأضعف فى الإسهام بدورها فى تمادى نكسة الردة، إذ تدرك أنه لم يعد مسموحا لها إلا بالصياح والتظاهر (وأحيانا كتابة الشعر)!! دور المقهور هذا وهو يلغى نفسه يذكرنا بجدل العبد والسيد (هيجل) حين يحرم العبد سيده من إنسانيته بطاعته المطلقة فيعدم نفسه “آخرا” فيستحيل على السيد أن يكون إنسانا (إذ لا إنسان بدون آخر). مخاض أكيد وولادة غير مضمونة برغم كل ذلك، فإن العالم يعيش مخاضا جديدا خليقا بتاريخ الجنس البشرى. إنه التحدى الحقيقى لاستمرار البشر- كل الناس – وهم يحافظون على ما أوصلهم إليه تاريخهم الرائع. إن كل القوى الابداعية فى كل العالم ترصد هذا النكوص الجارى على السطح لتقاومه بمحاولة الاحتفاظ بما حققته البشرية عبر تاريخها، ومن ثم الانطلاق منه. إن حركات المقاومة من عامة الناس، ومن المبدعين خاصة، التى لاتقتصر على إصدار البيانات أو القيام بمظاهرات، هى الأمل الحقيقى فى وقفة تفجر كل طاقات البشر لمراجعة كل الجارى، والإسهام فى وقف التمادى فى النكسة، وتحمل آلام وروعة ماوصل إليه الإنسان من صعوبات ليس أجمل منها إلا التعامل معها بما تعد وتبدع. الأمر يحتاج من كل فرد أن يقبل مراجعة كل البديهيات دون اسثناء مهما بدت الشعارات التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه براقة ومريحة. ليس معنى مراجعة البديهيات والمقدسات أن نحطمها قبل أن نجد البديل، إن المراجعة غير التراجع، إن الاعتراف بأن البديهيات الشائعة لم تكن حلا نهائيا، لابد وأن يصاحبه اعتراف بدورها الإيجابى فى مرحلة كنا نحتاجها فيه. أسئلة وتحديات لم أكن أقصد وأنا أضع هذه الفروض أن أقدم إجابات، ولكننى عنيت أن أطرح تساؤلات أصبحت محاولة الإجابة عليها فرض عين على كل إنسان حريص على أن يستمر نوعه بما أنجز ويعد. أولا: كيف نسعى إلى الأمان المفتوح النهاية، بالحفاظ على “اللا أمان البشرى” الإيجابى الناتج عن التواجد مع آخر مختلف فعلا. ثانيا: كيف نوقف خدعة “قبول الآخر” التى ليست إلا فض اشتباك لصالح الأقوى، ليحل محلها “الجدل مع المختلف” لتخليق ما يمكن منهما معا ؟ ثالثا: كيف يمكن تحقيق الحرية الحقيقية من خلال التنازل عن أوهام الديمقراطية، دون أن نقع فى الاستسلام لشمولية تتربص. رابعا: كيف يمكن أن نحافظ على حقنا فى ”الحزن” الذى هو الدليل الطبيعى على وعينا بمأزق الاختلاف دون أن يعطونا حبوب السعادة متهمين إيانا بالمرض؟ إن الحزن الموضوعى هو علامة الاعتراف بضرورة معايشة اللاأمان الموضوعى دون الإسراع نحو تحقيق أمان ساكن بإلغاء الآخر بالكر أو بالفر، بالعزلة أو بالإبادة. الخلاصة إن الانسان لايكون إنسانا بأوهام امتلاك قوى ساحقة، أو بالأمل فى خلود زائف، أو برفع شعارات قصيرة عمرها الافتراضى. أو بزعم محاولة توحيد العالم تحت راية شعارات ومذاهب تخص فئة دون سائر البشر. إن الإنسان يكون إنسانا بالحفاظ على ما وصل إليه من وعى وحرية، هما السبب المباشر فى استمرارية اللاأمان الموضوعى المصاحب بالاكتئاب الحيوى الضرورى لمواجهة الواقع، والذى هو – برغم اسمه – ضد اليأس ومع الفرحة بكوننا قادرين على اقتحام الغيب إيمانا به واحتسابا، ساعين إلى وجه الحق سبحانه، وهو – تعالى – ليس كمثله شىء. **** [1] – مجلة سطور: (عدد نوفمبر 2002) – وكان العنوان الأصلى: “الثمن الغالى لتطور الإنسان” [2] – تطور فكرى بعد ذلك من منطلق تطورى إلى التعامل على هذه المراحل ليس باعتبارها موقفا أو موقعا يعود إليه الكائن البشرى عند الضغوط أو النكوص أو المرض وإنما باعتبارها أطوار فى دورات الإيقاعحيوى المنتظمة الدائمة تنشط بالتناوب باستمرار، ويحد نشاطها وعند الحاجة إليها فى الصحة والمرض. [3] – كان هذا حتى كتابة هذا المقال سنة 2002 “لا دائم إلا الحركة. هى الألم والسرور. عندما تخضر من جديد الورقة، عندما تنبت الزهرة، عندما تنضج الثمرة، تمحى من الذاكرة سفعة البرد وجلجلة الشتاء” هذا ما قاله نجيب محفوظ وهو يكشف لنا عن دورات الإيقاع الحيوى لنبض الحياة فى “ملحمة الحرافيش”. إن دوام الحركة لا يعنى استمرارها بقدر ما يشير إلى حتمية دورانها الذى يشمل طورا من الكمون يبدو وكأنه السكون، لكنه فى الحقيقة يتبادل مع طور الحركة فى جدل يتمادى نحو التكامل المفتوح النهاية. لا الحركة مطلوبة لذاتها، ولا السكون دائم الارتباط بالهمود والجمود والموات. إن طرح بعد الحركة والسكون للنظر، هو دعوة للتساؤل حول الوجود والعدم، هذه الدعوة، فى ذاتها، هى من المصائب التى ابتلى بها الجنس البشرى دون من نعرف من الأحياء حالا، وتاريخا، إن إشكالة الحركة والسكون قد حلتها قوانين الوجود عبر التاريخ الرائع لتطور الأحياء، ولم تكن هناك حاجة إلى خدمات هذا الوعى البشرى الذى قد يجانبه الصواب وهو يتخبط مع لهاث الآلات التى اخترعها، وسط فيضان المعلومات التى غمر نفسه بها حتى تكاد تعجزه عن العوم، أو حتى عن مجرد الإمساك بالدفة لتحديد التوجه. إن مجرد الحديث عن الحركة وعقلنة الوعى بها- (مثله مثل الحديث عن الجدل)، هو ضد الحركة (وضد الجدل). هذه بديهية ينبهنا إليها صلاح جاهين بحدسه الفائق حين يقول: “… تشوف رشاقة خطوتك تعبدك، بس انت لو بصيت لرجليك، تقع”. هذا الوعى المعقلن بديلا عن تلقائية التطور قد أصبح إشكالا فى ذاته، صحيح أنه لم يعد من الممكن الاطمئنان لتلقائية التطور بعد أن تدخل الإنسان مع سبق الإصرار والتعقل فى تنظيم نوع وجوده، لكن صحيح أيضا أنه ليس فى الإمكان التسليم لغلبة الجزء الطافى من وعينا العاقل دون تاريخه وأعماقه. يزداد هذا الإشكال إذا تذكرنا احتمال ما يمكن أن تحدثه الإنجازات التكنولوجية الأحدث، إذ هى تضاعف من الخطأ كما تضاعف من الصواب بسرعة قد نعجز عن اللحاق بها. هذا الوعى الإنسانى يصبح مسئولية خطيرة إذا كانت قضيته هى “الحركة والسكون”. لهذا، وبالرغم من هذا، فإن التنظير الفلسفى والرياضى و العلمى لم يكف عن تناول بعد “الحركة/السكون: ظاهرا وباطنا، جوهرا ومظهرا، بالقوة وبالفعل. ويزداد الأمر تعقيدا حين نتبين كيف أنه لا يمكن تناول هذا الإشكال بعيدا عن إشكالة الزمن. الحركة تشكـل الزمن، والزمن يحتويها. ولا حول ولا قوة إلا بالأول والآخر، الظاهر والباطن، البدء بالموت/حركة حين واجه الوعى البشرى هذا الإشكال المعقد عن الحركة والجمود- الحياة والموت، لجأ إلى لغة الفن والأسطورة التى تستوعب أقدر وأرحب مما يمكن أن تستوعبه لغة العلم والعقلنة . وهكذا راح محفوظ يعلمنا فى الحرافيش أن الوعى بالموت هو الدافع للحياة، وأن وهم الخلود (ليس بالمعنى الدينى المعروف) هو الموت الجمود (=الموت بالغطرسة، والعزلة على القمة، والرتابة، والظلم، واللانهاية، والثبات). من هذا المدخل قدم لنا محفوظ الموت ليس باعتباره “ضد الحياة” بل كجزء لا يتجزأ من إيقاع الحياة النابض، هكذا قرأت رسالته فى الحرافيش: “..إن الحياة، مجرد الحياة، ليست هى المرادف الحقيقى لما هو: ضد الموت.. الموت،…، هو حركة ، بعكس الشائع عنه أنه عدم وسكون. (“الموت لا يجهز على الحياة، وإلا أجهز على نفسه” – ملحمة الحرافيش)([2]). من هذا المنطلق راح محفوظ يظهر كيف أن الوعى بالموت هو المبرر والدافع لاستمرار الحركة المسئولة عن إعادة التخلق وتفجر الوعي. هكذا نجد أنفسنا أمام تساؤل يقول: إذا كان الاحتمال الأكبر هو أن يتضمن السكون حركة كامنة، وأن يدفع الوعى بالموت إلى حياة زاخرة، فما هو الذى ضد الحركة إذن؟ وما هو الذى ضد الحياة؟ قدم نجيب محفوظ (مازلنا فى الحرافيش) عدة احتمالات لما هو “ضد الحياة”، منها على سبيل المثال: رمز”التكية ، ومنها الخلاء ، وأحيانا الظلام، والظلمة ، وأقل من ذلك الفراغ. ثم أكثر من ذلك وأخطر: التوقف عن التغير الحقيقى بفرض سلطة غاشمة جاثمة لا تتنازل عن موقعها إلا بمعركة (بين الفتوات) إما أن تصيب ، وإما أن تخيب. لكنه ظل يؤكد فى كل نبض دوراته، أن حسن نية الفتوة المنتصر، ليست ضمانا لتحيزه للحركة ضدالجمود، أو للعدل ضد الظلم. ثم إنه حدد موقفه تماما فى فصل “جلال صاحب الجلالة” (الحكاية السابعة من ملحمة الحرافيش) حين قدم نموذجا للجمود اللاغى للحركة فى صورة “وهم الخلود” باعتبار أنه الرتابة المفرغة من الأمل والغد ومن المفاجأة. هذا الخلود الذى يمثل العدم المفرغ اللزج ، تلك الصورة المرعبة التى شاعت عند الغالبية مرتبطة بالموت كما يتصوره الكافة، وليس بالخلود كما صوره محفوظ. . وكأن الملحمة تريد أن تقول: أن الأولى بنا … أن نخاف هذا الخلود لا أن نخاف الموت ،” (حفز الحياة). مرة أخرى: ليس الخلود بالمعنى الدينى، ولكن بمعنى العزلة والاستغناء القاسى باضطراد رتيب. استحالة السكون حتى لو بدا كذلك من هذا المنطلق: أبدأ بافتراض أن السكون (مثله مثل الإلحاد) هو استحالة بيولوجية، بمعنى أنه زعم عقلانى لا يتفق مع استمرار الخلايا الحية التى لا بقاء لها إلا بالحركة فى تناسق الهارمونى المتصاعد مفتوح النهاية إلى ما لا نعرف (الغيب) حتى نتوحد فى المطلق ، بل إن العدم نفسه هو مقولة نظرية لا يمكن التحقق منها (فهو استنتاج تجريدى أكثر منه عيانا ماثلا). إذا كان الأمركذلك، فعلينا أن نبحث بحدس أكثر يقظة فيما يملأ الصمت، ويغمر بياض الصفحات، وينبض فى عباءة السكوت. يعلمنا صلاح عبد الصبور كيف أنه “فليتكلم عنى صمتى المفعم” (ليلى والمجنون) ، كما يعلمنا نجيب سرور كيف يكون السكوت مشروع كلام (- “الكلام ممنوع يا ست”، (= ….) – والسكات ممنوع يا ست (= السكات ممنوع كمان ؟) – السكات مشروع كلام. (نجيب سرور . آه يا ليل يا قمر) . من هذا المنطلق الجديد يمكن أن نستوعب كيف أنه لكل طور حركته وسكونه اللذان يميزانه، كما أن البراعم المغلقة هى التى تنضج فى الشتاء لتتفتح الزهور فى الربيع: (الدنيا من غير الربيع ميته، ورقة شجر ضعفانة ومفتفتة، لا يا جدع غلطان تأمل وشوف: زهر الشتا طالع فى عز الشتا) صلاح جاهين. إذا كان الأمر كذلك، فإن الفرض الحالى يكتمل بالتنبيه إلى كيف أن الإنسان (المعاصر أكثر) يبذل جهدا منظما، وملاحقا، لإعاقة الحركة الطبيعية التلقائية التى هى سر الحياة وأساس التطور. فربما ننتبه أولا بأننا لسنا فى حاجة إلى أن نشغل أكثر بمحاولة إطلاق حركة الحياة والتطور والإبداع، فهى منطلقة بطبيعتها، لكننا فى حاجة أن نوقف القهرالمنظم الذى يعوق هذه الحركة الطبيعية خصوصا بعد أن امتلك هذا القهر أدوات تكنولوجية تكاد تكتسب استقلالها عنه. تعرية ومواجهة من هذا المنطلق، دعونا نقرأ بعض مظاهر ما يحيط بنا فى محاولة إعادة تحديد ما هو حركة زائفة، وما هو سكون ظاهرأو كامن وراء كل مظهرخادع. صورة مجسدة لزخم حركة زائفة سوف أغامر بأن أسترجع صورة زاهية من الألومبياد الأخيرة، أقرأها لكم كما وصلتنى شخصيا ، بعد الانبهار، ومع فائق الاحترام: التنافس الأولمبى قديم قدم محاولة الإنسان الاحتفاء باختبار قدراته البدنية متنافسا مع أخيه الإنسان، وأيضا منذ تصور إمكانية أن تقوم الرياضة بوظيفة التسامى بالعدوان إلى صورة متحضرة. لا يوجد واحد يمكن أن يمنع نفسه من الإعجاب بهذا الإنجاز البشرى المتفوق وهو يشارك أكثر من مليار من البشر يتابعون بعض بنى جنسهم وهم يسبحون راقصين فى الهواء، وهم يطوون الأرض طيا كنفاثات بشرية، وهم يرفعون الأثقال وكأنهم يرفعون هموم الإنسان المعاصر بلا طائل، وهم يصوبون كرة اليد داخل المرمى وكأنهم يرجمون الشر المتربص بالأبرياء، إلى آخر هذا الإنجاز والإعجاز وأنا – مثلى مثل الناس- أشاهد كل هذا وأعجب به أشد الإعجاب وأبلغه، هل توجد حركة أكثر سرعة وإثارة من كل ذلك؟ “ثم ماذا؟” كنت أشاهد أحد أبطال الجرى الذين حققوا إعجازا حتى على أنفسهم، لا أذكر جنسيته (أو قل لا أريد أن أتذكرها، ربما حقدا، وربما خجلا)، كان قد تفوق على الرقم القياسى العالمى السابق، وهو الذى سبق أن حققه هو أيضا سنة 1994، تفوق عليه بمقدار ثلاثة من مائة من الثانية (0.03). رحت أطالع هذا الفتى العظيم وقد ارتسم على وجهه شعور ليس له اسم، شعور أكبر من الفرحة، وأعمق من الفخر، تذكرت وصف باتريك زوسكيند فى روايته الرائعة “العطر”([3])، وهو يصف شعور بطلها”القاتل” جان باتيست غرنوي” بعد أن خلق عالمه من الروائح السرية المبتكرة، كان قد انفصل عن العالم والبشر بروائحهم الخاصة والمثيرة والمقززة، فخلق لنفسه عالما ملأه بالقتل الذى حقق له شهوة لا مثيل لها واصفا فعله هذا بأنه “.. هذا الفعل الماحق للقضاء على الروائح القذرة كلها، فعلا مريحا جدا ..لأنه يوفر الشعور بالإرهاق الناتج عن الإنـجاز”، لم أفهم آنذاك كيف يكون الإرهاق الناتج عن الإنجاز مريحا بكل هذا السحر إلا وأنا أشاهد وجه هذا الفتى الأولمبى بعد أن تفوق على نفسه بعد ست سنوات، فحطم رقمه القياسى بفارق ثلاثة من المائة من الثانية !! انتبهت إلى أننا (نحن البشر) نمارس طقسا منذ آلاف السنين نقدس من خلاله هذا الإنجاز التنافسى الكمى المهاراتي؟ وكأنه غاية المراد من رب العباد؟ هذه حركة ليس كمثلها حركة -العدو بسرعة نفاثة – لمجرد الوصول إلى “خط النهاية”، يفعلها البطل - أدام الله عليه الصحة – فنتبعه منبهرين متقمصين إنجازه حتى نصل معه إلى هدفه!!. إن مجرد مراجعتنا لكيفية استعمال تعبير “خط النهاية” قد يصلح لتنبيهنا إلى ما تسوقنا إليه مثل هذه الحركة اللاهثة. نحن -عبر العالم – لم نتبين زيف كل ما هو نهاية مغلقة مثلما تبيناه من شطح وغرور فوكوياما وهو يعلن “نهاية التاريخ” ،قبل أن ينتبه إلى ما هو نهاية أخطر (نهاية الإنسان). إن أظهر ما تظهر فيه الحركة الزائفة هى حلبة التنافس الفردى المحموم. إن أى واحد خليق أن يكتشف مدى اللاجدوى فى كثير مما يقوم به ويجرى حوله من تنافس يتسارع فيه معظم الناس (إن لم يكن كلهم) . هذه طبيعة بشرية مفيدة فى الأغلب، لكن أن تقتصر حركية حياتنا على ذلك، فهذا ما أردت التنبيه إليه مطولا فى هذا المثال الصارخ من الأولمبياد!! على غرار إعادة قراءة هذا المثال المطول يمكن أن نراجع كثيرا من أنواع التنافس التى نمارسها بكل إخلاص، لنحقق منها قدرا من القتل “الجميل” بالإنجاز المرهق:!!! يبدو أن ذلك الإرهاق الناتج عن الإنجاز. هو شعور مريح جدا بحيث يمكن أن يفسر لنا كثيرا من نشاطاتنا وحركتنا، فى كثير من المجالات. وفيما يلى سوف أحاول أن أقدم بعض أمثلة أكثر لما هو: الحركة الجمود، ثم التسكين بالحركة. الحركة الجمود 1- إن السعار الاستهلاكى، على ما به من تنافس وأصوات ، ودعاية، وإغراءات ملاحقة تكاد تجرى وراءك وأمامك وحولك طول الوقت، ليس إلا حركة زائفة لأنه لا يؤدى إلا إلى “تراكم الامتلاك” إلا مزيد من المزيد المزدحم. 2- إن تعملق السلطة لتثبيت وضعها واستمراره، يحتاج حركة هائلة تصل إلى حد إشعال الحروب، وهو ليس إلا حيلولة منظمة ضد حركية الجدل وتفاعل وحدات الحياة. 3- إن كثيرا من مظاهر ما يسمى البحث العلمى، ليست سوى حركة فى المحل إذا ما رضى الباحث أن يسجن فى منهج قديم مصمت، ناهيك عن النشاط المحموم الذى يكون هدف البحث منه مجرد النشر، أو تحقيق متطلبات الترقى، لا حفز الكشف وإرواء الدهشة. إن بحثا بلا فرض ينشأ من حيرة فى مواجهة الواقع والقديم، أو بحثا بلا مراجعة للمنهج جنبا إلى جنب مع قراءة النتائج، هو حركة زائفة لا أكثر. فهو الجمود والضياع. 4- حتى الحركات الثورية التى تهدف بكل وضوح إلى التغيير الجذرى الذى عجزت قوانين الواقع السائد عن تحقيقه، يمكن أن تنتهى إلى حركات مجهضة هامدة، لا تحمل مقومات جدل النمو الحيوى. التجميد المنظم أعرج بعد ذلك لعرض بعض أنواع ما أسميته التجميد المنظم ونحن نمارسه طول الوقت باسم آخر. (1) تجميد استلهام النصوص المقدسة الحاملة للوحى الإيمانى بالاقتصار على التفسيرات الثابتة. (2) قتل تطور اللغة بتقديس المعاجم التى ليست إلا مرحلة تاريخية محدودة من تطور اللغة (ولا يخفى كيف أثر هذا القتل التسكينى على ما جاء فى (1). (3) التسكين الأيديولوجى المعلن والخفى من خلال جمود مذهب، أو عقيدة، (حتى لو تسمى بأرق الأسماء وأشرفها: مثل التنوير أو الديمقراطية، أو حقوق الإنسان… إلخ) (4) الانغمار بالمعلومات دون تدريب كاف على الانتقائية، حتى تسـد مسام التلقى بالتشبع فالشلل. (5) العرقلة بالتخمة الاستهلاكية. (6) الاستسلام النشط لرفاهية اليأس حتى التوقف. (7) النفخ فى نفير المستقبل طول الوقت تأجيلا لحمل مسئولية اللحظة الراهنة. إفاقة ومحاذير ومحكات بعد كل ذلك، تجدر الإشارة إلى بعض ما يعيننا أفرادا وجماعات على التمييز بين الشحم والورم، بين الزيف والحقيقة، بين الناس وأشباههم، بين حكومات الظل الظاهرة كأنها تحكم، وحكومات الفعل الخفية التى تفرض كل شروطها فى دهاليز المال. أى بين الحركة الحقيقية والدوران فى المحل فالتدهور والتناثر. أولا: إن فرط الوعى بظاهر الحركة، أو تحديد مسارها ابتداء، هو ضد كل تاريخ التطور، المطلوب إذا شئنا أن نتجنب خداع الجلبة الخاوية والسير فى المحل، هو أن نعرف كيف نميز زيف الحركات المخاتلة والمعطلة من حقيقة الحركة النابضة الجدلية المبدعة. ثانيا: إن خوض تجربة الحياة – أفرادا وجماعات وشعوبا- يتطلب استيعاب حركية الوجود فعلا ماثلا على أرض الواقع. علينا ألا نقصر حماسنا على تدارس وتكرار تجارب بضعة آلاف من السنين نعرف بعض ما جرى فيها عن البشر ومنهم، علينا أن نطلق لخيالنا، وحدسنا، وإبداعنا وعلومنا العنان لاحتواء كل تاريخ الإنسان من إيمان وأساطير وإنجازات ومبادئ، دون السماح باحتكار فئة من الناس كتابة “جدول ضرب الحياة التنويرية الديمقراطية الحربية المعاصرة”، إن الاقتصار على استلهام دروس حياتنا من خلال الرجوع إلى بضع آلاف من السنين المكتوبة على الورق قد يحرمنا من استلهام تاريخنا الحقيقى المثبت فى الدنا DNA بطول تاريخ الأحياء كلها. ثالثا: علينا أن نتذكر دور الإيقاع الحيوى Bio-rhythm فى تنظيم الكون طولا (تاريخا) وعرضا (من أول إيقاع التفاعل البيوكيميائى حتى دورات الأفلاك، مرورا بأوضح صوره العضلية مثل: نبضات القلب المنتظمة، وأيضا بأكمل وأجمل صوره المرتبطة بالوعى أى: دورات اليقظة/ النوم/ الحلم/ الإبداع)، إن هذا البعد فى أصل جدله إنما يؤكد لنا أننا بقدر ما نحتاج إلى الحركة (دفع القلب للدم مثلا فى طور الانقباض أو البسط (Systole) نحن نحتاج للاسترخاء المتلقى الذى يبدو سكونا (ما يقابل دور الانبساط أو الامتلاء فى دورة القلب (Diastole) إن هذا القانون هو الذى يصالح الحركة الدافقة مع السكون الممتلئ، هو الذى يصالح الثورة مع فترات استيعاب آثارها، ومع التمهيد للثورة التالية ، وقديما كان نفس قانون الإيقاع الحيوى يمكن أن يستوعب دورات الحرب والسلام (لولا أن أسلحة وميزان القوى أصبحت أخطر من أى طبيعة تطورية). إن الحركة الحقيقية، والسكون الضرورى، لا يمكن استيعابهما إلا من خلال حركية هذا الإيقاع الحيوى الذى يعلمنا أن “السكون/الامتلاء” هو الذى يعطى للحركة إيجابياتها، وأن “الحركة/البسط” هى التى تستوعب ما امتلأ به الوعى تاريخا وحاضرا. رابعا: إن الحركة لا تكون إيجابية بدوام التقدم الخطى إلى أمام، إن الحركة الطبيعية فى النمو والتطور هى تحقيق لما يسمى برنامج (رحلات) الدخول والخروج (أو الذهاب والعودة(In-and-out program ، إن تأكيد هذا المفهوم هو جدير أن يسمح لنا بالعمل الإيجابى الاستيعابى حتى ونحن على ضلع التراجع، كما أنه هو هو الذى يحدد إيجابية الحركة ليس باستمرار اضطرادها، إلى الأمام دائما ولكن بأن يكون ضلع التقدم أطول من ضلع التراجع فى كل دورة. خامسا: إن تقييم إيجابية الحركة من سلبيتها أو ثبوتها لا ينبغى أن يكون تقييما كميا فحسب، بمعنى أن التقدم لا يقاس بقدر ما نحققه كميا مما نتصوره إيجابيا (الرفاهية أو السعادة أو الاستهلاك أو القوة..إلخ)، ولكن تكتمل إيجابية الحركة بمدى التغير النوعى الذى يتحقق فى كل دورة نبض حيوى (دورة نمو). ليس معنى هذا أن يكون التغير النوعى وحده هو المقياس، ذلك لأن التغير النوعى يأتى نتيجة لتراكمات كمية متفاعلة تمهد له حتى يظهر. سادسا: أن نتذكر أن للسكون والتجمد دورا دفاعيا هاما حين يكونا للحفاظ المؤقت على الحياة. هذا ما تفعله الحرباء حين تسكن بجوار صخرة لها نفس ألوانها، حتى يحسبها المهاجم صخرة أخرى بلا حراك، فيرجح أنه لا فائدة من مهاجمتها، وهو نفس الجمود الدفاعى الذى وصف فى الحرب العالمية الأولى حين كان الجنود يتجمدون كالأصنام من هول القذف بما سمى “صدمة التقوقع” Shell Shock وهو هو ما يفسر التصلب الكاتاتونى Catatonia الذى قد يلجأ إليه المريض الفصامى أساسا كنوع من الدفاع ضد التفسخ والتحلل والعدم. بعد إفاقته، وصف لى أحد أصدقائى من المرضى ما كان يغمره من هول الخوف أثناء نوبة تجمده بالكاتاتونيا، وكيف أنه كان يشعر بالموت ماثلا كأن “الآخر” غول سوف يلتهمه إذا هو هم بتحريك عقلة إصبعه، أو حتى إذا هو زاد فى تعميق شهيقه، لم أملك إلا أن أتقمصه حتى عشت كيف يكون الجمود مناورة تأجيل ناجحة تحفظ الحياة وتمنع التناثر حتى يلملم الكائن الإنسان نفسه ما أمكن ذلك. بلغ من تقمصى صديقى الكاتاتونى هذا أن كتبت قصيدة على لسانه بعنوان “أخاف همس الصمت” أدافع فى النهاية عن حق الإنسان فى التجمد مؤقتا حتى يستعيد نفسه. هذا أفضل من أن يلف فى مدار غيره الذى رسمه هذا الغير بكل غباء التدهور لضياع الكل، وكذلك أفضل من وهم الحركة ونحن ثابتون فى النقطة غير الحصينة، أو ونحن ننسحب إلى الخلف ذاهلين. وقد جاء كامل هذا النص فى مقال لاحق “أخافُ همس الصمت” (عدد أبريل 2005) ونشر كاملا مع هذه المجموعة). **** [1] – مجلة سطور: (عدد ديسمبر 2002) [2] – نجيب محفوظ:”ملحمة الحرافيش”، مكتبة مصر، سنة 1985. [3] – باتريك زوسكيند: “العطر” ترجمة: د. نبيل الحفار، دار المدى للثقافة والنشر، سنة 1997. كنت مستغرقا فى قراءة هذا الكتاب ” وهو مترجم بأناقة ودقة بالغتين (د. فاطمة نصر) ضمن سلسلة إصدارات “سطور”. وفى نفس الوقت كنت أقوم بمهام ثلاث ارتبطت -بالصدفة – بهذا الملف الذى بين أيدينا فى هذا العدد. المهمة الأولى: عن “مفهوم أحدث للصحة النفسية” مما دعانى إلى إعادة مواجهة الأوهام التى يروجها المخدوعون من العلماء من ضحايا شركات الدواء عن علم اسمه السعادة، والتى تسوقها مراكز أبحاث لترويج البلادة تحت عنوان الصحة، الأمر الذى يستلزم أن تبرمج عقول الأطباء لتكون مهمتهم الأولى هى ملء خزانة تلك الشركات (الثانية بعد شركات السلاح فى تسيير السياسة فى العالم). أما المهمة الثانية: فكانت دعوة لتطبيق “المنهج العلمى فى الحياة اليومية” حيث أعدت اكتشاف الأوهام المحيطة بتقديس كثير مما يسمى المنهج العلمى. أما المهمة الثالثة: فقد استلزمت مراجعة التاريخ الأحدث لما يسمى “العلم المعرفي” الذى أعلن هرطقتين متتاليتن اعتبرتا تجديفا فى “دين التفكير المنطقى الخطى الرمزي”، وكذلك فى: “دين العقل الوصى الظاهر: الهرطقة الأولى: التفكير ليس بالرموز فحسب. والهرطقة الثانية : المعرفة ليست فقط فى الدماغ- (تعبير هرطقة ليس من عندى، هذا ما اتهم به العلم المعرفى من العلم السلطوى). هكذا وجدتنى محاصرا بعدد من الأوهام الحديثة لم أعرف من أيها أبدأ. غير أننى فجأة نظرت فى أوهامى الشخصية، فانتبهت إلى حقى فى التمسك بها رغم كل شيء!! ما الحكاية؟ من هنا جاءت فكرة المقال. الوهم، والحلم، والخيال، والإبداع لابد أن نفرق ابتداء بين الاستعمال الشائع للفظ ما، والاستعمال الموضوعى والاستعمال المغرض، لنفس اللفظ. الاستعمال الشائع لكلمة “الوهم” يشير إلى المعتقد أو المدرك الذى يفيد ما هو غير حقيقى، وكأننا نعرف بوضوح تعريفا جامعا مانعا لما هو “حقيقي” بما يسمح لنا أن نعد وهما ما هو “ليس كذلك”. والاستعمال الشائع للفظ الخيال يشير إلى أنه النشاط الفكرى الذى يتجاوز التفكير الذى يعرف عادة بأنه “حل المشاكل”، فالخيال -بصفة عامة- هو نشاط أشبه باللعب العقلى المتحرر من التزامات الواقع، وأيضا هو نشاط غير ملتزم بالتوجه إلى استكمال لعبه بالتجمع فى تركيب جديد (الخيال بما هو كذلك، ليس ملزما بإكمال المسيرة إلى ما هو : إبداع). والاستعمال الشائع للفظ “الحلم” يشير إلى ما يحدث أثناء النوم مما قد نلتقط بعضه عفوا قبيل اليقظة، فنصيغه ليعوضنا ما لا نجرؤ على صياغته أو مواجهته فى يقظتنا الكاملة، وهو (الحلم) يقوم بتقليب وتشكيل مواقف وجودنا (ثم إنه إذا أضيفت إليه صفة اليقظة،”حلم اليقظة” فإنه يشير إلى ضرب من الخيال.) كل ذلك يحتاج إلى مراجعة على الوجه التالى: الوهم ليس كله ضد الواقع، ولا هو غير الحقيقى، فهو حقيقة نفسية مصنوعة، ومفيدة أحيانا، بل وضرورية فى كثير من الأحيان. والخيال ليس لعبا حرا صرفا، بل هو تخطيط بديل، حتى لو لم ينته لتوه إلى حل لمشكل أو تخليق إبداع حالا. والحلم ليس هو ما نحكيه بعد يقظتنا، ولا هو حلم اليقظة الخيالى. الحلم وعى آخر. هو واقع ممتد إلى ما بعد اللحظة الراهنة المعروفة لوعى اليقظة، ليس بغرض التأجيل فى مزاعم مستقبلية، وإنما بمعنى معايشة إرهاصات استكمال مسيرة التطور والنمو. يحدث هذا فى النوم، واليقظة، والثورة، والإبداع على حد سواء. حق التأجيل، وحق العمى لا يمكن بداهة أن أتناول كل هذه المراجعات بالتفصيل فى هذا الحيز المحدود، فأكتفى بأن أشير ابتداء إلى أننا يمكن أن ندافع عن الحق فى الحلم، والحق فى الخيال، باعتبار أن الأول “واقع آخر”، والثانى “تمهيد للإبداع”، ولكن هل يمكن أن يكون ثم حق فى الوهم ؟ الإجابة هى بالإيجاب، نعم: من حق الإنسان أن يعتقد، بل ويؤمن، بغير الحقيقة، بل إنه ليس حقا فقط، بل قد يكون هو السبيل الوحيد للتوجه الجاد المثابر نحو الحقيقة، لا أحد يصل إلى الحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يقترب منها إلا إذا مر بسلسلة من الأوهام، يقشرها الواحد تلو الآخر، وهو يتعرى بشجاعة عشاق الحياة ممن قرروا خوض تجربتها، فيقترب أكثر، كلما قشر أوهامه المشروعة أكثر، لكنه لا يصل أبدا إليها وصولا نهائيا. شروط الوهم الإيجابى نحن نتكلم الآن عن مسيرة الأفراد على طريق النمو والتطور، وحقهم المشروع فى الأوهام، ولا نتكلم عن تشويه الجماعات بالإيهام المصدر من متاجر الاستغلال والاستعباد والاغتراب. الوهم ضرورة نمائية للفرد فى أى من مراحل نموه ، وهذا شيء آخر غير الأوهام المفروضة من خارجه لأغراض مشبوهة . يكون الوهم حقا دفاعيا للفرد إذا توفرت فيه الشروط التالية : (1) أن يكون تلقائيا نابعا من احتياج الفرد فى مرحلة معينة من مراحل نضجه. (2) أن يكون عائده لصالح استمرار الفرد (متكيفا مع من حوله، منتجا لاحتياجاته، مواصلا لمساره). (3) أن يكون الفرد غير واع بحقيقته الأعمق (حيث جذوره هى راسخة فى مستويات الوعى الآخر أساسا ) (4) أن يكون الفرد مقتنعا هو شخصيا بحقيقة ظاهر هذا الوهم الغائر. (5) أن يكون هذا الوهم احتمالا واردا عند الناس الذين يمرون بمثل مرحلة النضج هذه. (6) أن يكون مرحليا، بمعنى أن يرتبط عمره الافتراضى بأداء مهمته الدفاعية، فى تلك المرحلة فقط، وبالتالى فهو عرضه للنقد فالتغير بعد انتهاء مرحلته. مقاومة مشروعة لا أحد منا يريد أو يستطيع أن يتصور أنه يمكن أن يبنى وجوده وتماسكه على أساس خاطئ مهما قدمنا تبريرات لذلك، خذا المثل العامى الذى يقول معناه “لو أعادوا توزيع عقول الناس فلن يقبل أحد إلا عقله، ولو أعادوا توزيع الأرزاق فلن يرضى أحد برزقه”. هذا المثل يفيد أن كل واحد يعتقد أنه على صواب مطلق، وبالتالى فحين نلوح له أنه من الممكن أن يكون قد أوهم نفسه، ولو بما يفيده، ولو بغير وعى، فإنه يرفض عادة ، وقد يحتج ويهاجم. الحاجة إلى الوهم ألمحنا حالا إلى أن مواجهة الحقيقة المطلقة مستحيلة، بقدر ما أن الحقيقة نفسها مقولة لا تعدو أن تكون فرضا واعدا لا أكثر. من هنا يمكن فهم لماذا يحتاج الإنسان إلى سلسلة من الأوهام يدبر بها حاله إلى أن يحين الحين الذى يستطيع فيه أن يتحمل أكثر فأكثر جرعات من الكشف أوضح وأقسى، أثناء سعيه فى اتجاه حقيقة محتملة، هذا هو قانون النمو الأزلى، إن تاريخ الحياة كلها ليس تاريخ الصدق أو العدل أو الفكر السليم، إنه تاريخ التأقلم مع المحيط. ومن هنا فإن أى وسيلة تساعد الكائن الحى على التأقلم مع محيط ما، فى زمن بذاته، هى وسيلة مقبولة وجيدة حتى لو كانت ضد الحقيقة، أو ما نتصوره حقيقة. إن القبول بظلام مرحلى هو السبيل إلى الوصول إلى نور نسبى، ثم سرعان ما نكتشف عجزنا عن الاستمرار فى تحمل بهر الحقيقة، فنطفئ بعض أنوارها بأوهام جديدة، حتى نتمكن من مزيد من الرؤية لاحقا، وهكذا. ولكن كيف يتطور الأمر من الوهم إلى التعرى إلى المواجهة إلى وهم أرقى، وهكذا ؟ ”…هل يعرف أحدكمو كيف يضل الانسان؟ كيف يدافع عن نفسه، إذ يغلق عينيه وقلبه؟ إذ يقتل إحساسه؟ كيف يحاول بالحيلة تلو الأخرى، أن يهرب من ذاته، ومن المعرفة الأخرى، كيف يشوه وجه الفطرة، إذ يقتله الخوف؟ كيف يخادع أو يتراجع؟ وأخيرا يفشل أن يطمس وجه الحق..، إذ يظهر حتما خلف حطام الزيف؟.”([3]) هذا بعض ماكتبته فى مقدمة محاولتى أن أرسم ما يمثل مراحل و أزمات تطور الفرد، وهو يتراوح بين العمى المشروع والرؤية المؤلمة التى قد تحتد إلى حد المرض. كان ذلك فى ديوانى: “سر اللعبة” الذى قمت بشرحه فى أطروحتى الأساسية عن “دراسة فى علم السيكوباثولوجي”. بالرجوع إلى نفس المتن، نجد إيضاحا أكثر لهذا الاضطرار المبدئى للجوء إلى الوهم قبل أن يستنفد أغراض المرحلة فتحدث التعرية، وياهول الرؤية، ثم من جديد . يقول نفس المتن: ”مذ كنت وكان الناس …، وأنا أحتال لكى أمضى مثل الناس، كان لزاما أن أتشكل، أن أصبح رقما ما، ورقة شجر صفراء، لا تصلح إلا لتساهم فى أن تلقى ظلا أغبر، فى إهمالٍ فوق أديم الأرض، والورقة لا تتفتح مثل الزهرة، تنمو بقدر، لا تثمرْ، فقضاها أن تذبل، تسقط، تتحلل، تذروها الريح بلا ذكرى. كان علىّ أن أضغط روحى حتى ينتظم الصف، فالصف المعوج خطيئة، حتى لو كانت قبلتنا هى جبل الذهب الأصفر، أو صنم اللفظ الأجوف، أو وهج الكرسى الأفخم، كان علىّ أن أخمد روحى تحت تراب”الأمر الواقع”، أن أتعلم نفس الكلمات..، وبنفس المعنى، أو حتى من غير معان” (انتهي) ثم تكون الأزمة حين يتعرى جزء من الوهم ليواجه الإنسان طبقة أعمق من جوهر حقيقته، لتصل الأزمة أحيانا إلى ما قد يسمى مرضا، وإن كان ليس بالضرورة كذلك : ”… ترتطم الأفلاك السبعة، يأتى الصوت الآخر همسا من بين قبورٍ عَفِنَهْ، …يتصاعد … يعلو … يعلو… كنفير النجدة. وأمام بقايا الإنسان، أشلاء النفس ورائحة صديد الكذب وآثار العدوان، تغمرنى الأسئلة الحيرى : لم ينشق الإنسان على نفسه؟ لم يحرم حق الخطأ وحق الضعف وحق الرحمه؟ لم يربط عقله،.. بخيوط القهر السحرية؟ يمضى يقفز يرقد يصحو .. بأصابعهم خلف المسرح، ويعيد الفصل الأول دون سواه، حسب الدور المنقوش، فى لوح حجر أملس، رسمته هوام منقرضه، فيضيع الجوهر، ويلف الثور بلا غاية، وصفيح الساقية الصدئة، يتردد فيه فراغ العقل، وذل القلب، وعدم الشيء …… ، ونضيع؟ ….. لكن هواء مثلوجا يصفع وجهى، يوقظ عقلى الآخر، ويشل العقل المتحذلق، يلقى فى قلبى الوعى، بحقيقة أصل الأشياء …. يا ويحى من هول الرؤية” المفروض أن هذه الرحلة تتكرر أثناء النمو بانتظام، خلاصتها تقول :”إنه بقدر ما أن الوهم ضرورى، فهو مرحلى، إن كان لمسيرة النمو أن تستمر”. كل هذا على مستوى الأفراد،بعيدا عن دائرة الوعى (فى مستوى وعىِ آخر)([4])، أغلب هذه الدفاعات التى تبعدنا عن الحقيقة هى أقرب ما يكون إلى ما يسمى “الحيل النفسية Mental Mechanism وميزتها(وعيبها أيضا) أنهاتحدث خلف دائرة الوعى الظاهر. لو أن أى واحد منا تعمق قليلا، بشجاعة متوسطة (لا سيما وهو نصف يقظ) فسوف يكتشف أنه يؤمن بعدد من الأوهام لا يمكن أن يتصور أنه فعلا يعتنقها، وهو عادة لا يستطيع أن يصرح بها ولا حتى لنفسه، فهى تحفظ له ماء وجهه أمام نفسه، وقد تبرر بعض فشله، أو تهدئ سره، حتى تمكنه من الاستمرار إلى أن تأتى فرصة أفضل للتعرى، والألم الإيجابى، فالاستيعاب الجديد. سوف أعرض فيما يلى بعض الاحتمالات التى يمكن أن تكون داخـلـك – مثلى عزيزى القارئ – نعتنقها دون أن ندرى، كل ما أرجوه هو ألا تسارع بالإنكار الفورى، وحتى لو سارعت بهذا الإنكار الذى هو حقك، فأرجو أن تلاحظ أنك قد تتمادى إلى أن تقول: “يجوز، قد يكون كل الناس كذلك، إلا أنا”، لا مانع. إليك بعض المعتقدات المحتملة التى لا يبرئ الكاتب نفسه - طبعا – من الاعتقاد فيها، وقد تبين له ذلك وهو يضبط نفسه متلبسا ببعضها أو بأغلبها، بدرجات مختلفة، فى أوقات متغيرة، بفضل مرضاه فى الأغلب: (1) كل الناس يحبوننى (2) أنا أحب كل الناس (3) لا أحد يحبنى (4) لا أحد يرانى (5) أنا وحيد رغم كل هذا (6) أنا مظلوم لم آخد حقى كما ينبغى (7) لو أتيحت لى الفرصة لكنت أفضل من ذلك بكثير (8) “لا أحد يحبنى إلا لغرض (9) لا أحد يريدنى (10) لا أحد يرانى كما أنا (11) “لا يوجد من يعرفنى على حقيقتى (12) لا شيء يعين (13) لا يهمنى فى هذا العالم إلا ما يخصنى (14) هذا العالم مخلوق لى (15) هذا العالم لا يصلح لى (16)”حتما .. سيتركوننى ولا يعودون ..”(17) لا أحد يتألم مثل ألمى (18) أنا وحدى الذى أعرف الحل (19) ليس صحيحا ما يظنونه فى (20) إن رسالتى فى الحياة أكبر من كل تصوراتهم. (أكتفى بهذا القدر.) [آسف عزيزى القارئ، هذا أنا ليس أنت،”جرب أنت بنفسك، واحدة واحدة، واكتشف من أوهامك ما تشاء، وارفضنى كما تشاء] التفرقة واجبة إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للفرد، وكانت مثل هذه الأوهام أمر طبيعى بالشروط التى ذكرتها حالا، (أن تكون مفيدة، وخفية ومرحلية) فهل مثل ذلك يصلح للمجتمع عامة؟ بمعنى: هل تحتاج مجاميع عامة الناس فى مراحل نموها المختلفة أن تعتقد فى معتقدات خاطئة، لكنها مفيدة، وربما مرحلية، وهل تمثل الأيديولوجيات عبر التاريخ([5])، وربما بعض الأديان (الأرضية خاصة) مثل ذلك أحيانا؟ وإذا كان الأمر كذلك فما خطورة الأوهام الجماعية بصفة عامة، ولماذا نصر على المبادرة بشجبها، ومحاولة نزع الأقنعة عنها، والاستغناء عن خدماتها؟ بالنسبة للمجموع دون الأفراد؟ يبدو أن الجماعات - مثل الأفراد- قد اخترعوا أوهامهم من واقع احتياجهم، ومن إفرازات ثقافاتهم المختلفة عبر التاريخ، فتولدت الأساطير التى أدت وظيفتها كأروع ما يكون، حتى حلت محلها الأساطير الحديثة الألمع بريقا، برغم أنها أقصر قامة، وأكثر جفافا، وأكبر غرورا، وأكثر خفاءً بعض هذه الأساطير الحديثة هى الأوهام المـُـعـَـوْلمـة المطروحة حاليا، لكنها بعكس الأساطير القديمة، لم تنشأ من نسيج وعى ثقافة بذاتها، ولم تنضج على إيقاع زمن هادئ قادر على استيعاب احتياجات وعى الناس على مستوياته المتعددة فى مرحلة بذاتها، إنها أوهام جديدة مقحمة لا تتصف بأى صفة من الصفات التى تجعلها آليات دفاعية مثلما كانت الأساطير عند أجدادنا،أو مثل الحال عند الأفراد حتى الآن وهم يستعملون الحيل الدفاعية، ويعيش كل منا أسطورته الذاتية دون أن يدرى([6]). فيما يلى محاولة لتمييز بعض الأوهام الجماعية الأحدث (تمييزها عن الأوهام الفردية المشروعة): أولا : هى مصنوعة، وليست دفاعات تلقائية. ثانيا: هى مفروضة من ثقافة مفتونة بذاتها، سجينة غرورها، ثقافة لا تتميز إلا بقوة أسلحتها، وعلو صوتها. ثالثا:هى مدعمة بأساليب تقنية حديثة تحافظ على بقائها، بل على دوامها (فهى مغلقة النهاية!!). رابعا:هى مغرضة تخدم السلطة التى أصدرتها فقط. خامسا:هى صادرة عن جزء محدود من الوعى البشرى (العقل الظاهر المبرمج) دون سائر مستويات الوعى الممثلة لتاريخ التطور ونجاحات صراع البقاء. سادسا: ثم إنها تبدو لأول وهلة حسنة المظهر والسمعة (تتسمى بكلمات آسرة مثل الرفاهية، والوفرة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسعادة والحرية !!). سابعا: هى نتاج عقول فردية مسخرة لغيرها، وليست نتيجة شبكة وعى جماعى، ثقافى، حيوى، متداخل، متفاعل، حريص على بقاء النوع وتطوره. ثامنا: هى سريعة الإيقاع منقضّـة الإغارة. تاسعا: هى تتغذى من نفسها لنفسها بنفسها، فهى تتضاعف بالقصور الذاتى والنمو الأسى المتمادى. عاشرا: هى تـغذى بعضها بعضا، كما أن وسائل كل منها تدعم بعضها بعضا: (أكاذيب الإعلام تغذى ألعاب التكنولوجيا، وعصف المخ بالإعلان يؤجج أوهام السوق، وتعصب العلم المؤدلج يغذى أوهام الرفاهية، وأموال شركات الدواء والسلاح، وفلسفات نهاية التاريخ، وأفكار صراعات الإبادة، تغذى إقفال دورات النمو كل يوم مع إقفال بورصات الأوراق المالية !!) حادى عشر: إنها أوهام تتأبى أن، أو تراوغ حتى لا توضع موضع الاختبار المناسب فى الوقت المناسب، وبالتالى فهى عصية على التعديل بما يسمى “المردود”Feed-Back ، مما يثبّت مضاعفاتها. هذه التفرقة الحاسمة بين مشروعية وضرورة الوهم الفردى الدفاعى المرحلى (فى صورة الحيل الدفاعية)، فى مقابل خطورة الأوهام الجماعية (الكوكبية الـمؤمركة خاصة) المصنوعة المغرضة، هى شديدة الأهمية فى الوقت الحاضر إذا كان لنا أن نأمل فى أى خلاص من ورطة تعملق جزء من الوجود البشرى، ومن الدماغ البشرى ، ومن التاريخ البشرى، على حساب الكل الحيوى طولا وعرضا. إذا كان ثم أمل فلا بد أن تكون لدينا الشجاعة أن نـراجع كل ما نحن فيه، وما هم فيه، وخصوصا ما يتمادى منه ذاتيا بالرغم من انتباه أغلب الناس إلى مخاطره. (التكنولوجيا العمياء، والعلم المقدس، والإعلام المغرض، والإغراق بالمعلومات دون تمييز..إلخ) فضل لا شكر عليه أشعر بالامتنان الشديد لبعض الفكر الخائب حين أتصور أنه قدم لنا، على الرغم منه أهم ما ينبغى أن نلتفت إليه، مثل فكر عمنا “فوكوياما” الذى أعلن بالأصالة عن نفسه، والنيابة عن سادته أن التاريخ قد انتهى بفوز الأقوى والأثرى. هذا الوهم اليقينى تم تفعيله بشكل عار حين أتيحت الفرصة للسيد دبليو أن يمارسه بفجاجة ذكائه المتواضع، فقام بتفعيل وتعميم غطرسة القوة بأقسى وأغبى أساليب أحاديى النظرة، هذا وذاك- عندي- من إنذارات الانقراض. العلم وهم مشروع،([7]) إلا إذا… على النقيض من أوهام السياسة العاتية خاصة المرتبطة بضحايا الحروب الغبية والاستغلال البشع، يمكن أن ننظر إلى العلم نظرتنا إلى الأوهام الفردية باعتباره وهما مشروعا مادام قابلا للتفنيد فالمراجعة فالتجديد. لا يكون وهم العلم خطرا إلا حين تنقلب المعطيات العلمية إلى مقدسات لتصبح دينا متجمدا ليس أقل جمودا من تقديس أوهام التسلح مع اليقين بعدم جدوى استعمال السلاح، أو أوهام الديقراطية مع تسليم مفاتيح اتخاذ القرار للقوى السرية، أو أوهام حقوق الإنسان المكتوبة دون المـُـمـَـارَسَة، أو أوهام الحل التكنولوجى المتضاعف أسـِّـيًـا فى ذاته بذاته . شعار مختزل = وهم محتمل حين يصل الإلحاح على تقديس النظريات السياسية والاقتصادية وحتى الفكرية إلى حد الإجماع (كما يريد المعولمون لحساب أمريكا) يتطلب الأمر مراجعات كثيرة، وقوى مضادة عليها أن تتجمع – دون كلل- لإنقاذ البشر من غوايات القوة والتبعية معا. إننا أحوج ما نكون إلى نقد لايتوقف عند تعرية الأوهام بل يطرح بدائل قابلة للتنفيذ. علينا أن ننتبه ألا نلقى السلة بالطفل الذى فيها. ليس معنى أن نعرى التكنولوجيا أننا نريد التخلص منها أو أننا نستطيع الاستغناء عنها. تبدأ اليقظة من التوصية بأن نعتبر أن “أى شعار مختزل: هو وهم محتمل”. خذ عندك: “العلم هو الحل”، “التكنولوجيا هى الحل”، “الهندسة الوراثية هى الحل”، “الصحة النفسية هى الحل”، “الإسلام هو الحل”، “التراث هو الحل”،”الفطرة هى الحل”… إلخ. بمجرد أن تسمع مثل هذه المقولات، لا بد أن تمد يدك إلى سلاح وعيك الناقد، استعدادا لممارسة جهاد إبداعك قبل أن يفوت الأوان، أنا لا أعرف حلا، ولكننى أتسلم الرسالة مع تكرار مشاهدة السيد بوش على الشاشة([8])، أو قراءة تصريحاتهم عن إرسال المدرسين الخصوصيين لتعليمنا مبادئ الديقراطية والسلوك السياسى المهذب. من ذا الذى يستطيع أن يتلقى هذه الرسائل دون أن ينفخ فى نفير التعبئة العامة لإنقاذ البشر؟ خاتمة إننا أحوج ما نكون لمعرفة أن خوض تجربة الحياة الذى يسمح للأفراد أن يحتموا بأواهمهم المرحلية، هو هو الذى يلزم الجماعات بالإسراع بهز أوهامهم قبل أن يفوت الأوان. إن تصارع أوهام الأفراد وجدلها مع بعضها البعض البعض هو الذى يقوم بتصنيع نسيج الثقافة الخاصة بكل جماعة فى مرحلة تاريخية بذاتها، هذا النسيج القادر على استيعاب أوهام الأفراد لتصبح واقعا متحركا فى حلم قابل للتحقيق فى صحوة ممتدة. لكننى أخشى أن نستبدل بالأوهام التى يفرضها علينا من لا ينتمى إلينا وإلى البشر، أوهاما أخرى أكثر تخلفا وأشد تصلبا، أوهاما دينية جامدة أو سلفية ثابتة، إننا إذا فعلنا ذلك فنحن – بقصد أو بغير قصد – نساهم فى تماديهم فى السيطرة والتفوق لحساب انقراض الجنس عامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا ينبغى أن يقتصر دورنا على المطالبة بحقنا فى استعمال أدوات التقدم لنصنع بها ما نستطيع من وجهة نظرنا. المطلوب هو أن نـتخذ نحن وهم معا موقفا نقديا من كل هذه الأدوات، والفلسفات، والتقنيات جميعا ، نحن معهم فى خندق واحد، خندق التهديد بانقراض النوع البشرى، وقد بدآوا فعلا هذا النقد الجاد (مئات المخلصين المرعوبين من الجارى الواعين بالمأزق (من أمثال جاك إيلول “خدعة التكنولوجيا” و جوزيف كامبل “سلطان الأسطورة” وجورج لاكوف “الفلسفة فى اللحم الحى”) والدعوة عامة لكل البشر. هذا هو الجهاد الأكبر. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد يناير 2003) [2] – “خدعة التكنولوجيا”، تأليف: جاك إيلول، ترجمة: د. فاطمة نصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004 [3] – يحيى الرخاوى ديوان “سر اللعبة” (ط1، 1978)، (ط2: 2017)، منشورات جمعية الطبنفسى التطورى. [4] – لا أميل إلى استعمال مصطلح “اللاشعور” [5] – يحيى الرخاوى: “الطب النفسى: بين الإيديولوجيا والتطور”، جمعية الطب النفسى التطورى، 2019 [6] – يحيى الرخاوى: “الأسطورة الذاتية: بين سعى كويلهو، وكدْح محفوظ” دورية نجيب محفوظ – العدد الثانى: ديسمبر 2009 – المجلس الأعلى للثقافة [7] – بعد كتابة هذا المقال سنة (2003) أطلعت على كتاب “ضلال العلم” سنة 2012 The Science Delusion وهو يعمق ويدعم هذا الفرض Rupert Sheldrake: “The Science Delusion Freeing the Spirit of Enquiry” , First published in Great Britain in 2012 by Coronet, An imprint of Hodder & Stoughton, An Hachette UK company [8] – فما بالك بمشاهدة ترامب الآن (2019) وقد مضى على كتابة هذا الكلام ستة عشر عاما!! عبر التاريخ، لم تتوقف الحروب، ولا محاولات الإبادة، ولا التطهير العرقى، ولا حملات الاستعمار بالجيوش، ثم الاستعمار الاقتصادى، فالاستيطانى، بطول التاريخ وعرضه لم تتوقف الكوارث الطبيعية،وامتحانات القدر غير المفهومة. كل ذلك كان محدودا جغرافيا بمكان بذاته، وبزمن له بداية و نهاية من حيث أن نزوات أوغزوات الدمار تنتهى بانتهاء العمر الحقيقى أو الافتراضى، سواء عمر الطاغية أو النظام، كما كانت الكوارث الطبيعية مؤقتة مهما تفاقمت آثارها. الجديد فى الأمر هو الانتباه إلى احتمال “شمولية” هذه الجرائم والمآسى حتى تبدو فعلا ماديا مع أن آثارها تصل إلى التهديد بالإبادة الجماعية، أى: انتحار النوع. ظل السيد بوش وفرقته يكررون على مدار ساعات اليوم والشهر والسنة نغمة: التخلص من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بالتبادل مع نغمة القضاء على الإرهاب (كما صنفوه)، وبغض النظر عن فشلهم فى إثبات ما يدعون هنا أو هناك، فإن الذى ينبغى أن يرسخ فى وعينا هو هذا التنبيه على احتمالية “شمول الدمار حتى الانقراض” !! شكرا يا سادة، وإن كنتم لا تقصدون. متى يكون الدمار شاملا؟ شمول الدمار لا يقاس بعدد القتلى، ولا بغباء (أو ذكاء) القاتل، ولا بمدى فتك السلاح المستعمل. يكون الدمار شاملا حين يتمثل فى سلوك أو إجراء مستمر، ومتماد ومتسارع، بحيث يفوق فى تسارعه وامتداده، كل القوى التصحيحية والمعادلة التى تحاول أن تحول دون الهلاك الجماعى للنوع البشرى. من هذا المنطلق يمكن الزعم (بل الجزم) أن مقتل بضعة آلاف من الأمريكيين فى مركز التجارة العالمى، أو حتى بضعة مئات الآلاف من الأفغان والعراقيين، سواء بسيف الطغيان أو بغباء التخلف، أو بذكاء أطنان القنابل، أو بالتجويع، أو بالإذلال، كل هذا ليس دمارا شاملا، لأنه لا يهدد مجمل الوجود البشرى طولا وعرضا، طول الوقت. إن ما حدث ويحدث الآن من قتل للأبرياء، وإحياء للاستعمار القديم، واستغلال للموارد، واستعمال لفئة من البشر باعتبارهم أدنى، هو النتيجة الطبيعة لسوء استخدام آليات ووسائل بعض إنجازات العقل المنطقى البالغة القدرة، لتزييف منظم للوعى البشرى، إن هذا التزييف يتم بالذات من خلال الإعلام والتعليم (تصور!!)، يحدث ذلك لصالح خدمة قلة تملك من مقدرات الحياة ووسائلها أكثر بكثير مما تستطيع أن تستعمله، أو أن تتحمل مسئوليته، هذه القلة هى التى تسخر أروع الإنجازات لأخطر الأغراض، وهى تكاد تعمى، وهى تدفع بالمسيرة البشرية إلى “انتحار شامل”، تعمى حتى عن موقعها وهى فى مقدمة هذا الطابور الذى تجذبه (لا تدفعه) معها إلى هاوية الانقراض. لا جديد إلا الشمول إن الذى فعله ويفعله الأمريكيون فى أفغانسان والعراق هو جريمة مسبوقة ليس فيها جديد، إلا معالم شمولها، حتى وراثة الطغيان والإجرام القاتل تحت شعارات خادعة، له سوابق تاريخية تكاد تكون طبق الأصل من حيث المزاعم والنتيجة جميعا. ليس جديدا ما يفعله بوش الإبن بعد الأب، أو ما فعله عـُـدَىّ وقـُـصـَـى مع والدهما الطاغية المجرم. التاريخ يذكرنا كيف أن الإسكندر تولى الحكم وهو فى العشرين بعد اغتيال أبيه “فيليب” الذى مارس الغزو والقتال والإبادة طولا وعرضا، ثم إنه حين اغتيل وتصورت اليونان أنها قد استراحت من شره، إذا بابنه الاسكندر يجتاح المدينة، يذبح كل سكانها..، ثم يعبرها، ليهزم جيوش الفرس، ويندفع إلى سوريا ومنها إلى مصر ثم يعود إلى بابل، ويأمر بذبح سكان مدينة بأكملها لأنهم من الإغريق، ويموت فى الثانية والثلاثين من عمره([2])، وبرغم كل هذا فإن ذلك لا ولم يعد دمارا شاملا، هذه الأفعال كانت طغيانا محدودا، حتى لو تم من خلالها محو مدن بأكملها، أو إبادة قومية عن بكرة أبيها. الذى كان يحدّها آنذاك هو محدودية قدرات فتك السلاح المتاح من جهة، وصعوبة انتشار الوباء القاتل من جهة أخرى، أى تواضع صناعة السلاح، وبدائية التوصيل والتواصل، بتغلب البشرية على هذه الصعوبة وتلك، أصبح الدمار أكثر شمولا، والانقراض أكثر احتمالا. النذير: إذا أردنا أن نقرأ الأحداث الأخيرة بمسئولية مناسبة، وبرغم الألم والانكسار، علينا أن نكف قليلا أو كثيرا عن النعى والنعابة، لننظر فى حقيقة وعمق معنى الأحداث باعتبارها نذيرا للبشرية كافة. النذير الذى ينبغى أن يتماثل أمام كل الناس الآن لا يكمن فقط فى إدراك مدى تعملق القوى الكمية التدميرية المغتربة، ولا فى ما آل إليه تسويق وتقديس قيم الإستهلاك للاستهلاك، والتميز بالمال لندرة لا تعرف كيف تنقفه، النذير ليس فقط فى إعلان النكسة البشرية التى عادت تبرر أن يصنف البشر إلى “أدوات وعبيد” مقابل ماهو “ناس وأسياد”، ولا فى أن الديمقراطية المزعومة لا تمثل لا العدل ولا الحرية، ولا فى أن الدين أصبح مطية للساسة والسياسة بدلا من أن يكون دافعا للإبداع وحافزا للتطور، إن كل مثل هذه المخاطر جديرة بالانتباه والمواجهة، لكن الأحداث الأخيرة تنذر بما هو أهم وأخطر، تعالوا ننصت لها وهى تقول: (1) إن ثمة أسلحة شديدة الخطورة أصبحت فى متناول عدد متزايد من الناس هنا، وهناك.(حكومات، وأهالى، قطاع عام، وقطاع خاص !!). (2) إن كثيرا ممن يمكن أن يحوزوا هذه الأسلحة لا يحسنون حمل مسئوليتها (يستوى فى ذلك صدام،وبوش، و شارون، و بن لادن). (3) إن الخطأ الذى قد يرتكبه أى من هؤلاء أصبح “شاملا” لأنه يهدد كل النوع البشرى بالانقراض،وليس بالمعنى الذى يردده بوش، وهو يعتبر جرح إصبع مواطن أمريكى أخطر “شمولا” فى ما يعنيه من تدمير البشرية، من إبادة مئات الآلاف مجهولى الهوية عبر العالم. الفرض: فرض هذه المداخلة يقول: “إن ثم خطرا أساسيا أكبر يكمن وراء تلاحق هذه الأحداث الكوارث، هو أكبر بكثير من الضرر الذى أصاب أفغانستان، والعراق ، أو الذى يمكن أن يصيب أى قطر يغزوه هؤلاء الغزاة تحت زعم التعمير أو التحرير أو التنوير، هذا الخطر هو: “تزييف الوعى البشرى بما يخالف طبيعته، أى طبيعة وقوانين التطور، الأمر الذى يسمح بمثل ما يجرى، ثم يبرره ليتمادى بما يهدد بانقراض الإنسان”. أخطاء التطور ثـَـمـّـة أخطاء جسيمة ترتبت على سوء حسابات قوانين التكيف لصالح مزيد من التطورالبشرى، مثل هذه الأخطاء واردة عبر تاريخ التطور. كل الأحياء الباقية صححت أخطاءها أولا بأول بشكل أبقى على استمرارها، أما الأحياء التى لم تستطع أن تصحح مسارها فقد انقرضت، إن أى ناظر فى التاريخ والحاضر، يمكنه أن يدرك بوضوح أن الإنسان مسئول-ربما دون سائر الأحياء- عن انحراف مسار تطوره، وأنه، وليست الطبيعة، هو السبب فى ذلك، وفى نفس الوقت نلاحظ أنه أيضا لم يكف أبدا عن محاولة تصحيح أخطائه، وتعديل مساره. أزمة الوعى، ومحنة العقل: الخطر الذى يهدد الإنسان أكثر فأكثر ينبع من نفس الميزة (الميزات) التى تميز الإنسان بها على سائر الأحياء، ذلك أن هذا الخطر هو ناتج من اكتساب الإنسان ذلك القدر من “الوعى بالذات وبالزمن”، وأيضا من تميزه بتلك الآلية المسماة “العقل”، نتيجة لهذا وذاك، أصبح مستقبل الإنسان، دون سائر الأحياء المعروفة،غير قاصر على الناتج التكيفى الطبيعى للتفاعل مع البيئة والمحيط، بل أصبح تحت رحمة نجاح أو فشل هذا الوعى وذاك العقل حيث تدخل كل من هذا وذاك، سلبا، وإيجابا، بالتخطيط لبقائه، أو بالوقوع فى أخطاء تهدد بانقراضه. تزييف الوعى: يبدو أن ما انتهت إليه البشرية من إنجازات فى كل المجالات (الإبداعية والتقنية والعلمية خاصة) هو أكبر من قدرتهاالحالية على استيعابها لصالح تطور نوع البشر، بل إن المردود كان معكوسا فى كثير من الأحيان، حيث تم توظييف هذه الإنجازات لتزييف الوعى، لا لحماية النوع وحفز التطور. يتم تزييف الوعى بشكل متماد، سرا وعلانية من خلال سلطات رسمية، أو منظومات خاصة، يتم بوسائل شديدة التنوع والإلحاح نكتفى بمجرد الإشارة إلى بعضها، دون تناول أى منها تفصيلا، ومن ذلك: الإغراق، والتهميش، والتجزىء، والإحلال، والإلهاء، والتعتيم، والتدين الشكلى، وادعائه، والترغيب، والترهيب، والاستقطاب، والتأجيل،..إلخ. أبسط وأحدث الأمثلة للإلهاء والإغراق والإزاحة معا هو ظهور هذا الكم الهائل من الإذاعات، والمحطات الفضائية والمحلية، خذ- مثلا – المحطتين اللتين ظهرتا مؤخرا تذيعان أغان خفيفة طوال 24 ساعة، ما هى المساحة التى تبقى فى وعى، أو وقت، أو ذاكرة، أى شاب أو فتاة أو شخص لأى شىء آخر، مثل هذا الإجراء لا يحشر معلومات مغرضة بذاتها فى أمخاخ المتلقين، لكنه يكتفى بشغل كل شىء بأى شىء([3]) أو حتى بلا شىء، وبالتالى تصبح مساحة ما تبقى من الوعى سلبا خالصا جاهزا لتلقى أى شيء، يمكن الرجوع للمزيد فى “خدعة التكنولوجيا([4]). حركية المواجهة: على الرغم من كل ذلك، فإن الناس تتجمع على الجانب الآخر دفاعا عن حقهم فى البقاء، الناس من كل لون وجنس، دون استبعاد بعض عامة ومبدعى الأمريكيين والإنجليز وغيرهم من الجنوب والشرق من الشرفاء الذين ينتمون للناس لا للسلطة، إن تشكيل مستويات الوعى البشرى بما يخدم أحد الفريقين أصبح فى متناول كل من يحذق مخاطبة المستويات المختلفة معا. لم تعد المسألة مجرد إقناع عقلى بفكرة (أو أيديولوجيا)، ولا دغدغة لعاطفة أو تلويح بلذة، وإنما المسألة تخطت كل ذلك إلى مخاطبة الغرائز البشرية (الأصلية، والمصنعة) بما يناسب خدمة الغرض الواعد أو المتربص، بوعى أو بدونه، إنْ تطورا ، وإنْ فناء. غرائز وغرائز: إشكالة الحديث بلغة الغرائز عامة هى إشكالة حديثة قديمة، لكن المتابع لحقيقة مسارات التطور لا يستطيع أن يتجاوز حتمية مواجهة البدء من غرائز البقاء حتى لو لم يجرؤ على الاعتراف بغريزة الموت، (مع أنها أيضا تخدم بقاء النوع)، علينا أن نكتسب الشجاعة الكافية التى تسمح لنا بالحديث عن الغرائز السياسية، والغرائز الدينية، وغريزة القطيع، ونحن نحاول أن نرصد المعركة الدائرة بين تزييف الوعى، وتحريك الإبداع، بل إنه علينا أن نتقدم خطوة أخرى فى محاولة احترام فرض يدعو إلى رصد تخليق غرائز جديدة، حسنة أو سيئة . لعل هربرت سبنسر هو القائل “إن عادات اليوم هى غرائز المستقبل”. من أمثلة الغرائز السلبية الجديدة التى تكونت حتى كادت تصبح جزءا من الطبيعة البشرية المصنعة: “غريزة الاستهلاك لما لا حاجة لنا به، وغريزة امتلاك ما لا نستعمله، وغريزة الوعد بما لا نقدرعليه“، بل ولا نعرفه أو نعرفه (مثلا: الحرية)، وغريزة قصر النظر، وغريزة القتل عن بعد لمن لا نعرف (غريزة سلبية هنا = كل سلوك أصبح مسلما به رغم ضعف، أو عكس، عائده الإيجابى. وياليت الأمر اقتصر على تشكيل تلك الغرائز المصنعة، بل إن تزييف الوعى والسلوك والتعلم، راح يتعامل مع غرائز البنية الأساسية (إن صح التعبير) لنفس غرض التدمير والردة، ذلك أنه يجرى اختزال: غريزة الجنس للجنس (دون التناسل أو التواصل) واختزال غريزة العدوان للقتل (دون الإبداع)، واختزال غريزة الجوع للإذلال (دون الشبع والأمن)، وتحوير غريزة القطيع (الانتماء للمجموع) إلى ما يسمى الديمقراطية لخدمة أى أحد إلا مجموع القطيع. العمى أحد أهم شروط الانقراض: لا يوجد نوع من الأحياء، دون استثناء الجنس البشرى، سعى أو هو يسعى للانقراض بوعى أو بغير وعى، لا بوش ولا ستالين، لا الديناصورات، ولا اليمام، لا الفيلة ولا النمل، لا البكتريا ولا الفيروسات، بل إن الانقراض ذاته لم تتوحد أو تتحدد أسبابه لكل من انقرض من أحياء ([5])، قد يحدث الانقراض بمحض الصدفة (حظ سىء)، وقد يحدث نتيجة خطأ تطورى جسيم، أما وقد اكتسب الإنسان ذلك الوعى الفائق، فقد تراجعت الصدفة نسبيا أملا فى أن تحل محلها المسئولية. الذى حدث فى الاتحاد السفيتى ليس مجرد خطأ تطبيق أفكار أغلبها (إن لم يكن كلها) صحيحة، والذى يحدث الآن فى أمريكا وفى العراق على حد سواء، ليس مجرد شهوة حكم أو مصالح شركات، الذى حدث ويحدث من بن لادن ليس مجرد تعصب أعمى، أو انحراف عن الدين الحقيقى، كل هذه الأحداث تتشابه فى كونها تعلن عن خطأ تطورى يتمادى فيه الجنس البشرى بشكل منذر. لماذا لا نتعلم؟ الخطر الأساسى باختصار شديد: هو أن الجزء الأحدث من وجودنا (الوعى الظاهر، والعقل الخطى) قد تعملق حتى طغى فألغى كل، أو معظم إنجازات التاريخ الحيوى، لصالح تفوق ما يسمى العقل، وهو يلتحف بما أسماه الديمقراطية، معلقا لافتة كتب عليها حقوق الإنسان، لا شك أن الأحدث أقدر، لكن الذى حول هذا الأحدث الأقدر ليصبح خطرا جسيما هو ما تورط فيه من زعم بأنه قادر وحده على دفع عجلة التطور. نحن لم نتعلم من انهيار الاتحاد السوفيتى إلا ما أسميناه “صحة الفكرة، وخيبة التطبيق”، إن الذى حدث فى الاتحاد السوفييتى وأوربا الشرقية هو الاعتماد على فكر حديث صحيح على حساب وعى غائر أثبت نجاحه فى الحفاظ على التطور عبر تاريخ الحياة. إن الذى يحدث الآن على الجانب الآخر هو نفس الشيء تقريبا: لو تمادت أمريكا- ومن إليها- فى اتباع ما يتصورنه غاية المطاف من أفكار ديمقراطية (بديلا عن ممارسة جوهر الحرية) وحقوق إنسان مكتوبة على الورق، لا بد أن ينتهى بها إلى ما انتهى إليه الاتحاد السوفيتي. لكن ثم فرقا هاما: حين انتهى الاتحاد السوفيتى قفز خصمه شامتا وهو يتصور، ويصور لنا، أنه الصحيح الأوحد المتبقى أمامنا لاختياره!!. لكن كل الدلائل التالية، آخرها هذا النذير من برج التجارة ثم أفغانستان فالعراق، تشير إلى أن انهيار ما تمثله سلطات أمريكا الحالية سوف يكون أكثر دويا وأخطر أثرا حيث لا يوجد بديل جاهز قادر بعد. المواجهة الأساسية: نحن نعيش الآن مواجهة أعمق من كل المواجهات التى عاشها الإنسان عبر التاريخ، لم تعد المواجهات فئوية أو قومية أو حتى دينية، نحن جميعا، بما أتاحته لنا وسائل الاتصال الحديثة، نعيش معا فى مواجهة تحديات البقاء ضد الانقراض، قد تحدث حروب جديدة، وقد تتجدد حروب قديمة، وهذه أو تلك إنما تعلن بقايا الاستقطابات القائمة، أو الماضية: من إسرائيل ضد العرب، حتى الكاثوليك ضد البروتستانت (أيرلندا)، مرورا بالشيعة ضد السنة (كما يجرى فى باكستان أو الهند وغيرهما)، فضلا عن المواجهات الاستقطابية الفكرية المتعددة فى كل المجالات (مجالات: الاقتصاد، والتطبيب، والأيديولوجيا،…إلخ). لكن تظل المواجهة الأساسية، التى كانت طول عمرها قائمة، هى شغل الوعى البشرى، ما دام قد تصدى للتدخل فى مسار تطوره. إن حسن استعمال آليات الاتصال الحديثة، مع بالغ خطورتها، هو الأمل فى تصحيح شطحات وصاية الوعى البشرى الظاهر (وكذلك تصحيح أخطاء وغرور العقل البشرى المنطقي)، البادى على السطح حتى تاريخه، هو استعمال هذه الآليات الأحدث لتزييف الوعى البشرى وتشكيله لصالح أقلية فقدت بصيرة انتمائها للنوع، لكن الجارى أيضا، وبشكل مواز، قطعاً أهم، هو محاولات الإبداع المستمر لتصحيح المسار على مستوى البشرية، خاصة وقد أتيحت الفرصة لكل الناس أن يسهموا فى المهمة، كل من موقعه، وبأدواته المتاحة!!. مستويات المواجهة كل الناس عبر العالم، يبحثون عن منهج أقدر، عن ديمقراطية أصدق، عن علم أشمل، عن علاقة بالطبيعة أكثر تناغما، عن وعى فائق يحتوى كل ما كان، ليكون به وبعده، لا على حسابه. الناس يحاولون أن يتجاوزوا الخلاف حول المحتوى (أى دين وأى أيديولوجى، وأى نظرية)، ليتفاهموا حول المنهج (كيف نكون، وكيف نفعل، كيف نتواصل)، لتحقيق إنسانية الإنسان وحفزه إلى ما يعد به. إن مواجهة أخطاء التطور التى زعمتها لا تتم على المستوى الأكاديمى أو المتخصص فحسب، ولا حتى على المستوى السياسى المتحكم، بل هى جارية طول الوقت عند كل الناس، (بما فيهم من يسمون المجانين، بل: وخاصة من يسمون المجانين). الذى حافظ ويحافظ على بقاء نوع النمل والنوارس ، ليس المجلس الأعلى لبقاء النمل، ولا الحكومة المنتخبة لجمهورية النوارس، ولكنهم كل النمل، وكل النوارس. فيما يلى إشارة محدودة إلى خطوط بعض تلك الأخطاء التطورية الجارية (مجرد مثالين). الخطأ (المثال) الأول: إن اللغة الرمزية قد حلت محل اللغة الكلية (الجسدية، والحشوية، والجينية، والتجاوزية) مستويات المواجهة ومحاولة التصحيح: (1) مستوى الخاصة: العلم المعرفى، والعلم المعرفى العصبى، وعلوم الشواش والتركيبية، والإبداع التشكيلى، وبعض الإبداع الحداثى، وما بعد الحداثى. (2) مستوى العامة: شك الناس فى البيانات الكلامية، وعدم اقتصارهم على الحوار اللفظى، مع التفضيل أحيانا للحوار الجسدى، والاعتراف بالعرف مع أو بدون القوانين المكتوبة، والاعتماد على التجربة قبل التنظير (الطب غير التقليدى ، مثلا) ..إلخ. (3) المواجهة السلبية: العودة للخرافة وبعض الجنون الخطأ (المثال) الثانى: إن الفكر الظاهر قد حل محل، الوعى الغائر أو استبعده([6]) مستويات المواجهة ومحاولة التصحيح: (1) مستوى الخاصة: مدارس تعدد الذوات، وتعدد مستويات الوعى، وهيراركية تركيب الجهاز العصبى والنفسى، والتحليل التركيبى، وعلم النفس والطبنفسى التطورى، والتفسير الغائى للسلوك (فى الصحة والمرض)، وفنون الحكى، وفنون التشكيل، فنون الدراما (فى المسرح خاصة). (2) مستوى العامة: إحياء معايشة التراث الشعبى، واستلهام واحترام الوعى الشعبى، الذى يتعامل تلقيائيا مع هذا التعدد فى الكيان البشرى، سواء اتخذ لغة الحكمة الشعبية، أو اللغة الدينية، أو اللغة التصوفية، أو الممارسات الحدسية الشعبية المتجاوزة لأحادية الظاهر. (3) المواجهة السلبية: إسقاط هذه الذوات المتعددة داخلنا إلى الخارج فى صورة عالم الجان، و.. وبعض الجنون أيضا. والباقى أكثر: أوقف نفسى قسرا خشية التمادى فى هذا الإيجاز المخل فى عرض أمثلة أخرى أكثر تحديا وأخطر أثرا، إن الإفاقة الواجبة تحتم علينا أن نعيد النظر أيضا فيما انتهى إليه ما هو “عقل”، و”تفكير” ثم “دين” و”إيمان” … ، مرورا بهز آلهة جديدة مثل إله ما ”يسمى العلم”، وإله زعم ”الديمقراطية”…إلخ، إن ما يهمنى فى هذه المقدمة هو مجرد التنبيه إلى أن مستويات المواجهة الثلاث (خاصة، وعامة ، وسلبية) هى جارية على قدم وساق فى محاولة هز كل هذه المقدسات، خذ إشارة عابرة إلى: كيف يواجه الناس تقديس الديمقراطية بالعزوف عن المشاركة فى الانتخابات أصلا (أحيانا أكثر من 50% فى البلاد المتقدمة التى تقدس الديمقراطية) ما معنى ذلك؟، أو خذ مثلا كيف يواجه العامة السلطة الدينية المغتربة عن الإيمان بما يسمى الدين الشعبى، وهكذا. خلاصة القول: (1) إن الإنجازات العلمية والتقنية الأحدث تستعمل، فى نهاية النهاية للأسف: فى تزييف الوعى أكثر من مساهمتها فى تحريك الإبداع لإنقاذ النوع. (2) إنه يمكن تفسير الممارسات النكوصية التى ظهرت مؤخرا على مستوى الفكر والحرب جميعا (من “نهاية التاريخ” إلى “11 سبتمبر” إلى “حكم صدام” إلى “غزو العراق”) باعتبارها النتيجة الطبيعية لهذا التزييف المنظم لـ”الوعى العالمى المفبرك الجديد”. (3) إن محاولة تصحيح تلك الأخطاء التطورية جارية على كل المستويات بشكل تلقائى عنيد ، وإن كانت النتائج شديدة التواضع ومهددة بالإجهاض من القوى المتربصة. (4) إنه كما تتولد غرائز سلبية جديدة من خلال تزييف الوعى، لا بد أن نعمل على توليد غرائز إيجابية جديدة لتحل محل الفشل المنتظر قريبا لهذا التعملق الزائف الآيل للسقوط بما يحمل من مقومات هدمه لنفسه. (5) إن قضية الوجود البشرى هى قضية بقاء النوع وتميزه قبل وبعد أى أيديولوجية أو دين أو نوع حكم أو شخص حاكم، فهى قضية كل فرد دون استثناء. وبعد الدفاع عن البقاء لدفع التطور هو فرض عين فى نهاية النهاية، إذا قام به البعض لايسقط عن الباقى. وإلا ….، فالانقراض لا يستثنى. **** [1] – مجلة سطور: (عدد سبتمبر 2003) هذا المقال هو قراءة فى الأحداث الجارية بعد حرب العراق وهو يقدم فرضا يقول “إن ثم خطرا أساسيا أكبر يكمن وراء تلاحق هذه الأحداث الكوارث، هو أكبر بكثير من الضرر الذى أصاب أفغانستان، والعراق، أو الذى يمكن أن يصيب أى قطر يغزوه هؤلاء الغزاة تحت زعم التعمير أو التحرير أو التنوير، هذا الخطر هو: “تزييف الوعى البشرى بما يخالف طبيعته، أى طبيعة وقوانين التطور، الأمر الذى يسمح بمثل ما يجرى، ثم يبرره ليتمادى بما يهدد بانقراض الإنسان”. [2] – د. فوزى فهمى “عار العالم” – مكتبة الأسرة – 2003. [3] – كان ذلك قبل انتشار سرطان التواصل الاجتماعى عبر الفيس بوك ومثله 2019 [4] – جاك إلول “خدعة التكنولوجيا” ، ترجمة: د. فاطمة نصر، طبعة مجلة سطور، سنة 2002. [5] – “الانقراض جينات سيئة أم حظ سيىء”، تأليف: دافيدم. روب، ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمى، المجلس الأعلى للثقافة سنة 1998. [6]– حتى الفكر الذى اعترف بوعى كامن، استعمل النفى لوصفه، (اللاوعي)، مع أنه لم يهمشه (التحليل النفسي) أى شخص عادى هو “مشروع بطل” منذ الولادة بقدر ما هو أسطورة واعدة قابلة للنماء والتطور. إننا بحسن استعمال أدواتنا الأحدث وبمواصلة استثمار تواصلنا الحر يمكن أن تكون فرص كل منا فى الاقتراب من أسطورته الذاتية أكبر وآمن ومن ثم فى إطلاقها إلى ما تعد به من تواصل وإبداع، إن صح ذلك فإن فيه ما يغنى عن صناعة الأبطال حتى نسقط عليهم ما عجزنا عن تحقيقه بأنفسنا لأنفسنا وللناس. مسيرة التطور تعلمنا كيف أن وسائل الحياة تغير الأحياء الذين يصنعونها فيرتقون بها إلى ما تعد به فطرتهم ليتجاوزوها ثم يبدعون ما هو أقدر إلى ما هو أرقى فأرقى، هذا إذا كان للنوع ألا ينقرض، إن ما أتيح للإنسان المعاصر من أدوات حديثة كادت تصبح امتدادا لتركيبه البيولوجى قد غيرت وتغير فى تشكيلات وعيه وطبيعة علاقاته ومنظومات قيمه، لا شىء يدوم إلا الحركة، علينا أن نواكبها بإعادة النظر نقدا ثم تصحيحا فانطلاقا. لعل فى هذا ما يدعونا إلى مراجعة كل ما هو نحن أو ما نتصور أنه نحن بجهد لا يكل. إن تاريخ “البطل” و”البطولة” يمثل منظومة محورية عبر تاريخ الحياة البشرية برمتها يتجلى ذلك بوجه خاص فى الملاحم الكلاسيكية والشعبية على حد سواء كما يتجلى فى الأسطورة وفى واقع الحياة معا، إن المـُـراجع لما آلت إليه قيمة ما يسمى البطولة قد يتبين احتمال قرب انتهاء عمرها الافتراضى ليحل محلها ما لا نعرف مما يـَـعـِـدُ بما يمكن. نبدأ من التاريخ ما هى حقيقة حكاية الأبطال الذين يحكى عنهم التاريخ هل وجدوا فعلا بهذا الحجم على تلك الصورة أم أننا نحن الذين صنعناهم للقيام بدور محدد يغطى حاجتنا إلى أن نتصور أن مثل هذا الشخص “التاريخى” إن لم يوجد بيننا الآن فقد وجد من قبل وبالتالى فلا مانع أن نحلم بأن نكونه أو على الأقل أن يكون بيننا مستقبلا؟ السير الذاتية لمثل هؤلاء الأبطال هى أقرب إلى الملهاة، أما السير التاريخية فهى لا تعدو أن تكون اجتهادات تقريبية مهما بلغت دقة التوثيق. أصبح من الضرورى أن ننتبه إلى حقيقة ما يصلنا حين نقرأ سيرة بطل ما (تحت أى مسمى وفى أى حقبة تاريخية)، مجرد أن نتدكر أن مثل هذا البطل كان إنسانا ينام ويصحو ويتكلم وينسى ويحلم ويلهو ويأكل ويـُـخرج….إلخ يمكن أن يجعل نظرتنا تختلف إليه وربما يتغير تقديرنا له، أنا لا أزعم بذلك أنه سوف يبدو اقل من حجمه بالضرورة وإنما أتصور أنه سوف يتمثل لنا بشكل مختلف، أميل فى هذه المداخلة التى لا يمكن أن تتجاوز إشارات محدودة إلى قضية بهذا الحجم أن أتجنب الاستشهاد بأسماء بذاتها حتى لا أستدرج إلى حوار توثيقى مع أو ضد أى اسم لبطل محدد، تكفينى الدعوة لقراءة الروايات المختلفة حول أى من “اخناتون” أو “عمرو بن العاص” أو “الإسكندر الأكبر” أو “نابليون” أو غيرهم نقرأهم “بما هم” ما أمكن ذلك وليس كما نحب أن نراهم أو كما زيفهم التاريخ لأغراض ليست كلها سيئة. كثير من الأبطال كان لهم دورهم الإيجابى وإنجازاتهم الرائعة وقد نالوا عليها ما يستحقون وما لا يستحقون: شكرا وذكرى وتقديسا أحيانا لكن الأوان قد آن للنظر إلى الجانب الآخر من الحكاية. مجالات التجليات عبر التاريخ وحتى الآن: لم يعدم الناس وسيلة لتخليق الأبطال ما وجدوا إلى ذلك سبيلا فإن لم يتمكنوا من ذلك على أرض الواقع فإنهم يصنعونهم صناعة فيما يمارسون من فنون مختلفة على مستويات متعددة: من أول الملاحم الشعبية حتى التصوير التشكيلى مرورا بفن الحكى طولا وعرضا. الأمثلة أشهر من أن يشار إليها تفصيلا (مثلا: الزناتى خليفة وأبو زيد الهلالى من أبطال الملاحم الشعبية)، ثم إن الإبداع الحكائى قد تناول القضية من أبعاد أروع وربما أكثر مصداقية من توثيق التاريخ (راجع فتوات نجيب محفوظ عموما ثم خاصة فى ملحمة الحرافيش) ثم بدا مؤخرا أنه لم تعد هناك حاجة أصلا لأن يركز أى عمل إبداعى على بطل فرد أو يتمحور حول بطل بذاته. ثمة منطقة أخرى بدت لى أكثر مقاومة للتنازل عن استعمال ما قدرت أنه بطولة ألا وهى منطقة التميز الفائق فى مجالات المهارات الرياضية خاصة والذهنية أحيانا، إن أكثر ما تستعمل فيه ألفاظ “البطولة” فى أيامنا هذه هى مجالات تبدو أقل قسوة وأهون خداعا وربما أكثر تحضرا وأقرب إمتاعا لكنها أبهت ظلا وأسطح خيالا، لا يمر يوم علينا حاليا إلا ونحن نسمع عن “بطولة” الدورى “وبطل” ألعاب القوى ثم “بطل” الشطرنج “وبطل” البريدج ثم بطولة المجموعات على المستوى الإقليمى حتى العالمى. ترى هل يعنى ذلك أننا أزحنا كلمة البطولة من مجالات استعمالاتها التاريخية الأصلية إلى مجالات يمكن أن تحتوى حاجة الناس إلى خلق أبطال المهارة والتنافس الذين يسيرون على الأرض من حولنا مثلنا. بطولات “مضروبة” إن من أهم أفضال ما يسمى الديمقراطية أنها حين طبقت بشكل جيد حدت من إلحاح ظهور ودوام دور ما يسمى “البطل” (الزائف عادة)، أثبتت الديمقراطية الصحيحة أنها قادرة - إذا مورست بشكل جاد وعملى- على أن تلغى من قاموس البطولة صورتين متميزتين هما: صورة “الزعيم البطل- الأوحد” وكذلك صورة “الزعيم -البطل- الخالد (وليس فقط خالد الذكر) أضف إلى ذلك أن ما يسمى “الشفافية” وهى إحدى آليات الديمقراطية راحت تلاحق هؤلاء الأبطال أولا بأول فتخفف أو تحول دون تقديسهم أو هى تسارع بتعريتهم بعد ذلك بقليل. ومن ثم تحول دون تمنطقهم أنواط البطولة بلا مؤهلات. هكذا لم تعد البطولة ترتبط بالسلطة تلقائيا. مؤخرا حلت ألاعيب الإعلام الأحدث عبر الفضاء محل الملاحم الشعبية كما حلت القنابل الذكية محل الفروسية، كذلك حلت الشعارات البراقة محل الإغاثة والشهامة والإجارة، ترتب على ذلك أن ظهرت بطولات براقة زائفة ولو لفترة قصيرة لكنها سرعان ما تتعرى أمام خبطات الواقع فضلا عن ملاحقة الوعى الشعبى (من خلال الشفافية)، لا يمكن لمثل كلينتون خاصة بعد حكاية الست مونيكا بتفاصيلها أن يستحق لقب البطولة مهما بلغت جاذبيته الجنسية أو احتد ذكاؤه أو خف ظلـــه، كما لا يمكن لمثل دبليو بوش أن يصبح بطلا وهو بهذا الغباء الذى ملأت أخباره صحف العالم بتعليقاتها ورسومها الكاريكاتيريه بما حال ويحول دون أن يعتلى كرسى البطولة الذى يحلم به، مهما بلغ عدد ضحاياه فى أفغانستان أو العراق أو فلسطين وحتى إذا نجح أحد هؤلاء الأبطال أن يفلت من قبضة الفضائح والشفافية والنقد الملاحق، فإن تحديد مدة جلوسه على كرسيه بفترة محدودة فى البلاد المتحضرة سرعان ما سينزله عن عرشه المزعوم برقة دستورية وإلا لما سمعنا عن رؤساء سابقين فى بلد مثل أمريكا يزرعون الفول السودانى أو يعملون كمقدمى برامج تليفزيونية أو يسترزقون من كتابة مذكراتهم بعد رحيلهم. الأمر يختلف فى البلاد المتخلفة مثلنا، فما أن يعتلى أى عابر سبيل كرسى السلطة حتى تظهر عبقريته التى كانت كامنة فى الظل ثم تتلاحق معجزاته، ويحتد حدسه ويتفرد حضوره الذى ليس كمثله شيى، ومع ذلك فالوعى الشعبى يلاحقه بالنكات والنقد حتى لا يتمتع طويلا بصورته المصنوعة، اللهم إلا إذا قضى فى لحظة باكرة تناسب هشاشته ومع ذلك فقد ينصب بطلا تاريخيا تكملة للحلم الذى كان يمثله. لماذا احتاج ـ و يحتاج ـ الناس إلى تصنيع الأبطال؟ آن الآوان أن نعرج قليلا إلى جذور حاجة الناس إلى خلق أبطال أكثر من التركيز على حاجة البطل أن يكون كذلك، سوف أكتفى فى هذا الصدد بثلاث مداخلات لتفسير حاجتنا إلى تخليق البطل. 1) الحاجة إلى الاعتماد الكائن البشرى لا يكون كذلك إلا فى حضور وعيه فى مواجهة وعى “آخر” من نفس نوعه على أرض واقعهما معا.. يستتبع ذلك ما يمكن أن يسمى حق الاعتمادية (المتبادلة فى النهاية). نحن عادة لا نعترف بهذا الحق ظاهرا وتماما حين يتمادى فريق منا فى الأخذ والتبعية دون العطاء والمسئولية بالتبادل، ومع إقرار حقيقة الاختلافات الفردية فإن الناتج الموضوعى هو أن أى جماعة من الناس سوف تفرز قائدا لها تعتمد عليه، ولو فى مجال بذاته، ولو لفترة معينة، .يتخلق القائد أو الرئيس بطلا بعد ذلك حين يتسع مجال تأثيره، وتتعدد مجالات نفوذه، وتطول مدة الاعتماد عليه. 2) دور الأسطورة الذاتية فى صناعة البطل لكل منا أسطورته الذاتية وهى منظومة تكونت وتتكون من التاريخ الشخصى ممتدا فى النوع، وهى منظومة غائرة غامضة وإن كانت راسخة متمادية مبدعة أبدا (أنظر بعد)، هذه المنظومة تقترب من الوعى وتبعد عنه بقدر نشاط عملية النمو الفردى وسلامة خطواتها، إلا أن معظمنا فى غالب الأحوال يتعامل معها بالحيل المناسبة مرحلة تلو الأخرى بحسب زخم إيقاع مسيرة نموه، ودفع نبض حركية إبداع ذاته،([2]) من تلك الحيل التى نلجأ إليها حين نفشل فى التعامل مع أسطورتنا الذاتية أن نسقطها خارجنا على بعض من يمكن أن يمثلها أو يرمز لها ليس فقط بما هو وإنما أيضا بما نتصوره فيه، فينشأ البطل. 3) وهم الخلود من بين ما يدعونا إلى تخليق البطل واتباعه إلحاح داخلى (وخارجى أحيانا) بأننا كيانات باقية، أو لابد أن تظل باقية، نحن نعجز عن تحقيق ذلك فى واقعنا الشخصى (وحتى فى مخيلتنا) من هنا يصبح البطل مسقطا مناسبا ليس فقط لأسطورتنا الذاتية، وإنما لخلودنا الملوح مع استحالته فينا حالا، البطل من هذا المنطلق يقوم باللازم حيا وميتا (تذكر أن أبطال التاريخ يوصفون عادة بالخلود، وإن كانت الصياغة قد تلتوى لنستعمل تعبير “خالد الذكر” بدلا من “الخالد”). التعرية: تعرت صورة البطل تاريخا حين اكتشفنا أكثر وأكثر أن البطولة فى عدد غير قليل من الحالات تـُـقـَـيـَّـم بعدد القتلى (الذين يقتلهم البطل)، أو عدد النساء اللائى يسبيهن (أو يتزوجهم،)، البطل، أو عدد (وحجم) المفاجآت التى يـبهــر بها البطل تابعيه، أو مساحة الأراضى التى يغتصبها البطل (أو يغير عليها)، أو عدد الأكاذيب التى يروجها البطل (أو يروجونها عنه)، أو عدد الحيل التى يحذقها البطل، أو عدد البلهاء الذين ينخدعون فى البطل، أو عدد الوعود المؤجلة التى يلوح بها البطل، أو كل ذلك أو غير ذلك. على الجانب الآخر انكشف البطل المعاصر حين عجز عن القيام بإشباع تلك الاحتياجات المسئولة عن تصنيعه وتقديسه والحفاظ عليه، أضف إلى ذلك حقيقة أنه لم تعد مرحلة الإنسان الحالية تسمح بتفريخ أبطال قادرين على استيعاب حاجتنا إليهم بالصورة التى تحققت عبر التاريخ وسجلت أساسا فى الملاحم والأساطير. .. شعارات ومهارب لما وصل الأمر إلى هذا التعرى والموضعة قفزت إلى السطح عدة محاولات :بعضها أقرب إلى الهرب، وبعضها يلوح كبديل، وبعضها يـَـعـِـدُ بحلٍّ ما: أول هذه المهارب كان الإنكار المباشر الذى عادة ما يعلن من جانب البطل نفسه فى صورة شعار يطلقه البطل وهو يعلن (فى زهو متواضع!!) أنه “ليس بطلا ولا حاجة!!” يريد أن يقنعنا أنه مثله مثل عامة الناس جدا، فيبدو ذلك أقرب إلى النكتة، خاصة حين يصدقه الناس أو يزعمون ذلك، كذلك كثيرا ما تعلو الأصوات زاعقة (خصوصا لإخفاء الهزائم!!) أن “الشعب هو البطل” ليتم الإخفاء بالتجريد والتمويه ولا أحد يعرف شخصا اسمه “الشعب” لينصبه بطلا يعتمد عليه، ولا الشعب نفسه “عنده فكرة”. كذلك نلاحظ كيف يتصاعد الحديث بين الحين والحين (مثل هذا المقال ) أنه لم تعد بنا حاجة إلى البطل أصلا، ذلك لأن “الفرد العادي” هو الجدير بلقب البطل دون منازع !!فيتحقق بذلك نفس الخداع والتمويه. ومن ذلك أيضا تلك الإعلانات (الشعارات) التى تختصر آلام حياتنا بكل مشاكلها إلى زعم وثقانى سحرى يلوحون به أنه الحل، مثل أن “الإسلام هو الحل” أو “التنوير هو الحل” أو “الديمقراطية هى الحل” أو “العلم هو الحل” أو “المعلومات هى الحل” هذه الكلمات السحرية أصبحت تقوم مقام البطل إذ نسقط عليها - أيضا- ما نعجز عن تحقيقه على مسار تطورنا الذاتى. بدائل مصنوعة بعد أن انكشف دور البطل بهذه الصورة التى تكاد تعلن انتهاء (أو قرب انتهاء) عمره الافتراضى، ومع عجز الشعارات والمهارب والحيل عن طمس حاجتنا إلى تصنيع أبطال ينوبون عنا فى تحقيق أسطورتنا الذاتية، ظهرت بدائل جديدة لاتدعى البطولة بشكل مباشر، لكنها تقوم بدورها المعدل إذ نتوجها بتاج البطولة باستعمال الجديد من الألعاب والحيل الأحدث، من ذلك أن نختلق بطلا آليا أو تقنيا أو حتى رمزيا فى صورة تقديس ما يسمى المعلومات، أو الروبوتات الأحدث فالأحدث. وبعد هذه المهارب جميعا تبدو وكأنها نقلة نوعية تحاول أن تعلن الاستغناء عن تخليق البطل خارجنا، وأن الدور الذى كان يمكن أن يؤديه البطل قد انتهى باعتبار أن الإنسان المعاصر قادر على أن يسير أموره دون بطل أو بطولة، هذا غير صحيح طالما أننا لم نهيئ له بعد فرص اعتمادية أخرى، وخلود آخر، ومسار أخر لتخليق فتحقيق أسطورته الذاتية (أنظر بعد). من الجلى أن عمر هذه البدائل قصير لأن أى وهم مصنوع أو مجرد، مهما بلغت دقته أوحذقت مهارته أو لوح بوعوده، لا يمكن أن يكون بديلا مناسبا لتخليق أسطورتنا الذاتية التى تتكون عبر السنين من الحوار والتفاعل والجدل الذى مارسته الأحياء طول الوقت مع المحيط والكون بكل مستوياته، ثم توجهه الإنسان بوعيه وعقله وإبداعه. تحقيق الذات أم تخليقها إبداعا ممتدا؟ اقترن زعمنا بانتهاء دور البطل بحلمنا ومحاولتنا أيضا أن نؤكد ما يسمى “تحقيق الذات”، شاع هذا المفهوم كأنه غاية المراد نتيجة للإعلاء من قيمة “الحرية الفردية” على مستوى الوعى والسلوك الظاهرى، فكانت النتيجة هى تعميق الاختلافات الفردية بشكل مستعرض، على حساب إبداع ما هو ذات تتخلق باستمرار مع ذات وذوات أخرى فأخرى: إبداعا وتطورا. إن التركيز على ترسيخ الحدود الفردية تأكيدا لتحقيق الذات يكاد يفترض أن لكل منا ذاتا قائمة، ما عليه إلا أن يؤكدها ليحدد معالمها أكثر فأكثر من خلال ممارسة حقوق مكتوبة، غلب هذا الاتجاه خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينيات تقريبا حين بدأت المراجعات تتمادى (مع أنها لم تكن جديدة تماما) بدءا من كارل جوستاف يونج وصولا إلى سيلفانو أريتى ثم امتدادا إلى مدارس عبر الشخصية فى علم النفس والطب النفسى، فاتضح أن ما يسمى تحقيق الذات ليس إلا مرحلة متواضعة مؤقتة على مسار أطول وأعمق يؤكد حيوية الجدل الحيوى والنبض الحيوى، ثم راح يتأكد أكثر فأكثر أن الذات لا تتحقق إلا لتمتد، ولا تتحدد معالمها إلا لتعيد النظر فى هذه الحدود وتلك المعالم دورة نمائية بعد دورة، وإبداعا نابضا بعد إبداع، انطلاقا من “مشروع وجود” كل منا وهو ما أطلقت عليه اسما استعرته من “جوزيف كامبل” وهو “الاسطورة الذاتية”. الخلاصة: إن البطل يتخلق ويتنامى ثم يقدس ليخلد، بقدر عجزنا عن تخليق أنفسنا، بإبداع مفتوح النهاية، انطلاقا من أسطورتنا الذاتية، وكلما زادت فرص تخليق أسطورتنا لنكونها فى جدل متنام (بالإبداع والتصوف والإيمان واستمرار النمو الذاتى) تراجعت حاجتنا إلى تخليق أسطورة البطل خارجنا إسقاطا فتقديسا. مسار النمو من الأسطورة الذاتية إلى إبداع الذات المتجدد لا يمكن فى حدود هذه المقدمة إلا أن نكتفى بالإشارة إلى الخطوط العريضة لتلك الفروض التى نرجو من خلالها أن نفسر تراجع دور البطل من ناحية، مع زيادة فرص الإبداع لتخليق ذواتنا باستمرار من ناحية أخرى: أولا: يحمل كل منا تاريخ الحياة برمتها منذ ملايين السنين. ثانيا: تتوج هذا التاريخ بتطور الإنسان نوعا واعيا له عقل، ووعى، وحرية (بدرجة ما). ثالثا: استوعب الإبداع المحكى والمسجل فى الأسطورة التاريخيه بشكل خاص، بعض معالم هذا التاريخ الذى ظهر فى شكل الملاحم والعقائد وغيرها. رابعا: تطورت الأساطير بالذات بما احتوت من زخم البطولات لتعلن بعض هذا التاريخ خارجنا وعلينا أن نتعامل معها كمرحلة لا أكثر حتى لا تحل محل حركية وإبداع أسطورتنا الذاتيه حالا. خامسا: ظل كل واحد - برغم ذلك وبسببه- يحمل أسطورته الذاتية كامنة وواعدة، ثم متخلـِّـقة فى جدل دائم مع الواقع ونبض الكون. سادسا: زادت أدوات المعرفة وفرص الإبداع وتقنيات التواصل حتى صار الإنسان أقدر على مواصلة تخليق أسطورته المتنامية باستمرار ليس له نهاية. سابعا: نتيجة لذلك تراجعت حاجة الانسان لتخليق أبطال خارجه يسقط عليهم ما عجز عن تحقيقه بنفسه كيانا متطورا ناميا متصوفا مؤمنا مبدعا جميلا. خاتمة وأنا أنهى المقال تذكرت ما أستلهمته يوما من أحد أصدقائى (المجانين) أثبته فى كتابى “حكمة المجانين” قائلا: “لسنا فى حاجة إلى دين جديد لكننا فى حاجة إلى ملايين الأنبياء” كان ذلك سنة 1979 أستطيع أن أعدل الرقم الأن إلى “بلايين الأنبياء” هذا بعض ما استنتجه أيضا محمد اقبال تفسيرا لختم النبوه بمحمد عليه الصلاة والسلام. **** [1] – مجلة سطور: (عدد مارس 2003) [2] – تناول الكاتب هذه القضية لاحقا بنقد مقارن بين السيميائى وابن فطومة فى دورية نجيب محفوظ،” الأسطورة الذاتية: بين سعى كويلهو، وكدْح محفوظ”، العدد الثانى: ديسمبر 2009 المجلس الأعلى للثقافة مدخل تساءلت، ومازلت أتساءل، عن: ما الذى يدفع شخصا ما (دون استثناء نفسى) أن يجمع أكثر من حاجته للأكل والشرب والسكن وبعض الترفية الممكن فى الزمن المتاح، بالإضافة لما يتـيسر له من إمكانية بعض الفعل الحر فى مساحة مناسبة مهما ضاقت.؟ جاءتنى بعض الإجابات المنطقية (من داخلى وخارجى)، وكان أغلبها فى حدود المعقول، كانت معظم الإجابات تدور حول: إن الجمع هو بهدف التأمين ضد حوادث الزمن ومفاجآته، قد يكون ذلك مقبولا فى حدود أن يجمع هذا الشخص ضعف ما يحتاج، أو بضعة أضعاف ما يحتاج أو مائة ضعف ما يحتاج. ليكن! لكن ما الذى يجعله يجمع أكثر من ذلك: ألف ضعف، وألف ألف ضعف، ثم أكثر فأكثر وأكثر، مما أعجز عن مجرد تخيل أصفاره على الورق؟ من عمق معين يصعب الفصل بين البحث عن الغذاء و الحرص على توفيره لإرواء غريزة الجوع، وبين البحث عن الأمن، إن عدم الثقة الأساسى Basic mistrust يمثل الجذر الأعمق لكثير من السلوك الاغترابى المتعلق بالجمع المتمادى بغير نهاية. من الخبرة المهنية والتقمص بدأ انتباهى إلى هذا الاحتمال أثناء تأملى فى ظاهرةٍ يصاب بها المريض الوسواسى، نسميها غالبا الجمع التكرارى القهرى، كما يصاب المريض الفصامى بعَرَض مواز نسميه عرض “التخزين” Hoarding. المريض الوسواسى المصاب بالجمع التكرارى لا يكف عن الجمع والتخزين لنوع معين من الأشياء، مع أنه يوقن أنها لا لزوم لها، وأنه لا يحتاجها، وأنه لن يستعملها، وقد يكون ما يجمع نوعا واحدا يركز عليه، وقد يكون أكثر من نوع. مثل هذا المريض يعرف جيدا خطأ وشذوذ ما يفعل، لكن بصيرته لا تنفعه فى أن يمتنع عن هذا الفعل القهرى مهما قاوم، فهو دائما أبدا يعجز عن إيقافه. المريض الفصامى تتجلى فيه ما يكافئ هذه الظاهرة، ولكن دون بصيرة ودون مقاومة الفصامى المصاب بعرض التخزين قد يجمع كل شئ دون تمييز، ودون سبب واضح، ودون فائدة عادة، فهو قد يجمع غطاء زجاجة كوكاكولا، مع فردة حذاء قديمة، مع فازة ثمينة، مع صفحات ممزقة من صحيفة مهملة، مع صندوق بلاستك فارغ، مع قطعة جبن جافة، ثم إنه – خاصة إذا كان من نوع الفصامى المتفسخ – قد يجمع كل ذلك ويخزنه بطريقة عشوائية فوضوية تمتد من تحت السرير إلى فوق الصوان، ومن وراء الباب إلى جوار المدفأة. المهم أن هذا الفصامى قد يصاب بهياج عارم إذا ما اقترب أحد من حجرته مثلا للتخلص من بعض ما يشوهها، أو حتى مما تعفن فيها، وهو قد يثور نفس الثورة إذا ما حاول أحدهم مجرد تغيير موضع شىء مما جمعه وخزّنه. فى كثير من هذه الحالات نكتشف عمق “عدم الأمان”، ونحن نكتشف عدم الثقة والرعب المتجدد أبدا، رعبا كامناً لحوحاًًً ليس من عدوِّ مهاجمٍ بذاته، وإنما هو خوف من نفاد ما يملك من زاد (أو ما يعادله)، مما يترتب عليه تصوره أنه إذا ما نقص ما عنده أى نقصان، ولو كان رمزيا، فهو الهلاك، ومن ثَمَّ تتقِد بداخله معايشة باطنية، تنذره طول الوقت “من الموت جوعا!!”. هل يمكن أن يكون وراء الاستحواذ على السلطة وجمع المال بلا نهاية عند الأسوياء، نفس الرعب من الموت جوعا، تماما مثل الوسواسى أو الفصامى؟ من لحظة إشراق خاطفة ذات لحظة، وبدون سبب، وبلا أزمة خاصة، ضبطت نفسى متلبسا بهذا الخوف (من الموت جوعا). كان ذلك خلال إحدى أسفارى الطويلة البعيدةَ. أتاحت لى هذه اللحظة آنذاك أن أرجح أن هذه المسألة كامنة داخل أعماق الإنسان، بغض النظر عن تجلياتها الصريحة أو الرمزية فى حالات المرض، ربما كان هذا الخاطر هو الذى جعلنى أُفْرِدُ فصلاَ بأكمله باسم “الجوع” فى الترحال الثالث من ترحالاتى، (ما بين السيرة الذاتية وأدب الرحلات)([2]). رجعت إلى هذا الفصل وأنا أكتب هذا المقال فإذا بى قد جمعت فيه كثيرا مما نضح منى وتسَمّى باسم “الجوع” مباشرة أو مجازا، وإن كان تجريدا لجوع أعمق إلى “الآخر” تمثل لى شعرا مثل: …. “أنا ما طرقُت البابَ إلا بعدَ أنْ نادَتْكِ كُّل خلايا جوعى. جوعى إلى عينٍ ترانى، جوعى إلى أمّى تهَدْهِدُنِى، جوعى إلى بِنْتِى تزّملنى تدثرنى” … اكتشفت أننى قبل ذلك بسنوات طويلة خاطبت ابنى الأكبر فى نهاية قصيدة إليه قائلا: .. “أعذرنى ولدى أتضوُر جوعاًً مَّتهَماًً بالبطنة”… ([3]) وفى موقع آخر وجدتنى أقول بالعامية (ديوان: أغوار النفس) ([4]) … ”من كُـتْر ما انَا عطشانْ باخاْف أشرْب كِدَهْ من غير حسابْ، لكنْ كمانْ: مش قادر اقول لاَّهْ، وانا نِفْسِى فى نِدْعةْ مَيّهْ من بحر الحنان، يا هلترى: أحسن أموتْ من العطش ولاّ أموت من الغَرقْ ؟” من هذا المنطلق المهنى والشخصى، مع تنويعات تجليات الجوع الذى لا يرتوى والذى يخشى أن يرتوى فى نفس الوقت، تجرأت أن أراجع مسألة “عدم الأمان” هذه، واحتمال اتصالها بغريزة الجوع، ومن ثم بضلال “الرعب من الموت جوعا” لعل هذا أو ذاك أو كليهما يفسر لى بعض ما غَمُضَ من ظاهرة التكاثر الاغترابى، الذى يتميز به سلوك معظم أصحاب المال المتزايد طول الوقت على حساب حرمان الأفقر فالأفقر من الحد الأدنى مما يشبع نفس الغريزة. كيف وصل الأمر بالبشر إلى هذا التناقض الصارخ المهدد لأقصى الطرفين؟ مراجعة رحت أراجع تطور الغرائز على الوجه التالى: الغرائز هى الأصل، حافظتْْ وتحافظ على الحياة (حتى قبل أن تتميز إلى غرائز نوعية محددة)، ثم إنه حين اكتسب الإنسان الوعى ثم تزين بالعقل، لم يتنكر لغرائزه بشكل عام، وإن كان قد تعامل معها بشكل آخر، وبآليات أخرى، لا يصل نشاط غريزة ما -عادة- إلى الوعى البشرى إلا إذا لم يـُـشبع، يتجلى هذا النشاط فى الوعى بشكل مباشر: الشعور بالجوع مثلا، كما قد تتجلى آثاره وبدائله بما يشير إلى كيف أن الغريزة قد تتحور، وتتخفى، أو تزاح، وتستبدل كما أنها قد تُشَوَّه وتنحرف…إلخ ثم إن البعض يتصور أنه يمكنهم أن ينكروا بعض الغرائز مثلما ينكر بعض غلاة المتطهرين من الرهبان وغيرهم نشاط غريزة الجنس، ربما من منطلق أخلاقى أو دينى، حتى حاول بعض هؤلاء المنكرين أن يقصروا وظيفته على التناسل دون التواصل، حدث مثل ذلك وأكثر لغريزة العدوان حين أنكر بعض الاجتماعيين أن يكون العدوان غريزة أصلا، باعتبار أن الإنسان يمارس العدوان جملة وتفصيلا لظروف لاحقة مكتسبة، وهم بذلك ينكرون دور العدوان تاريخا فى الحفاظ على البقاء فضلا عن دوره المحتمل فى الإبداع([5]) مثل هذا الإنكار نادرا ما ينجح بشكل عام. إن ما يحدث أكثر فى نفس اتجاه اضطراب التعامل مع غرائزنا، وهو ما يخص هذا المقال عن الجوع وتجلياته المباشرة والمجازية، هو أن الغريزة قد تنفصل عن غايتها البسيطة الأولية، أى تفصل عن فعل إشباعها، فتنقطع دائرة “النداء فالاستجابة” فتظل الغريزة نشطة أبدا فى دائرة مفرغة، مما يترتب عنه ما أسميته “الوجود المثقوب” الذى لا يُملأ أبدا مهما وضع فيه (وهو ما يقابل التعبير الشائع: “شرب الماء المالح”): … “يتلمظ بالداخل غول الأخذ، فأنا جوعان مذ كنت، بل إنى لم أوجد بعد. ……. من فرط الجوع التهم الطفل الطفل، فإذا ما أطلقتُ سعارى بعد فوات الوقت، مـَـلـَـكـَـنـِـىَ الخوف عليكم، فلقد ألتهم الواحد منكم تلو الآخر دون شبع“ ….. ”يا من تغرينى بحنان صادق فلتحذر، …. إذ فى الداخل: وحشٌ سلبْى متحفز، فى صورة طفل جوعان…”.([6]) ([7]) هذا الفشل لدائرة “الاحتياج/الإشباع” يحدث فيترتب عليه مضاعفات مباشرة وصريحة مثلما يحدث من تكرار العلاقات الجنسية والعاطفية، دون أن تترك إشباعا يغنى عن مواصلة تكرارها اللحوح (ظاهرة الدونجوانية)، ومثلما يحدث بالنسبة لغريزة الجوع حين لا يوقفها الشبع أبدا، ومن ثم مضاعفات فرط البدانة ..إلخ . وقد تمتد تجليات هذا الفشل (بين النداء والإشباع) إلى معظم عمليات الأخذ والجمع للاحتواء بالداخل (الالتهام الاستحواذى). يترتب على هذا الفشل غير الطبيعى استثارة غريزة الخوف، وبالذات الخوف من الهلاك، ومن ثم يتحرك دافع البحث عن الأمان، الذى لا يتحقق أبدا، ما دامت الدائرة تدور. يتجلى هذا السلوك فى أبلغ صوره فى مجالى جمع الثروة، والاستحواذ على السلطة، كما قد يظهر فى مجال الحب والشوفان وغير ذلك. الفرض الفرض الذى أقدمه فى هذه الاطروحة هو أن ظاهرة التخزين التراكمى أوالتكاثر (التى تكمن وراء الرأسمالية المغتربة مثلا) يمكن أن تـفسر كالتالى: 1- إن ثم ضلالا لا شعوريا عند هؤلاء يهددهم “بالموت جوعا”. 2- يتبع ذلك رعب لا ينتهى من احتمال الهلاك إذا لم يواصل الإشباع بلا توقف. 3- يتم نتيجة لذلك الفصل بين غريزة الجوع وبين إشباعها، مما يجعل أى مكسب أو أى جمع أو تخزين لا يؤدى وظيفته الحقيقية لسد الحاجة، وبالتالى لا يقلل من الرعب الدائم خوفا من الهلاك اغتراب مُهْلِكَّ هنا، وهلاكْ وارد هناك لو صح هذا الفرض الذى وضعناه لتفسير الخلل الذى يصيب غريزة الجوع بما هى، والذى يتجلى فى سلوك الالتهام والتخزين والتكاثر على المستوى الفردى، لو صح أن هذا الفصل بين الغريزة وإروائها لا يسمح بالتوقف للنظر فيما جُـمِعَ أو تَرَاكَمَ فلم يحقق الشبع أبدا، فإن وظيفة هذه الغريزة تخرج عن نطاق تاريخها لخدمة البقاء، بقاء الفرد أولا ثم بقاء النوع عامة، لتعمل بلا انقطاع بشكل مباشر وغير مباشر فى كل اتجاه، بلا جدوى، بل بمضاعفات متزايدة، هى الهلاك نفسه، فتصبح سلبية انقراضية تماما. وبعـد ربما كان ذلك فى عمق تصور الكاتب قبل أن يتجسد له هذا التنظير، حين تقمص أحد هؤلاء المتكاثرين (أو لعله كان هو) قائلا: أخاف ألتهمْ، حسبتُ أن الثقبَ سوف يلتئمْْ، أزِاحُم الأعدادَ أنتقمْ، تعلو جبال موج الرعب والنهمْ، أغوص فى غيابة الظلام والعدم، أدوس أشلاء الأجنهْ، أرتطمْ. تخثَّـر الوعىُ المغلفُ بالغباءِ والندمْ. تمزَّق النغمْ. إن نتاج هذا السعار التخزينى المتمادى يتم على حساب حرمان إشباع نفس الغريزة (الجوع) بالحد الأدنى من احتياجاتها عند مجاميع أكثر فأكثر من البشر (عشرات الملايين المتزايدة) مما يترتب عليه ما نعرف من فقرٍ فمجاعةٍ فموتٍٍ الأصغر فالأصغر والأفقر جوعا وهزالا. الوعى الإنسانى بحركية الغرائز وتطورها إن التطور الطبيعى للغرائز يتم – أو ينبغى أن يتم – فى اتجاه معاكس تماما: مع اكتساب الإنسان مستويات أرقى فأرقى من الوعى، ومع ارتقاء الغرائز وهى تتكامل مع بعضها، يختلف حضور الغرائز فى الوعى بما يترتب عليه اختلاف التعامل معها على مستوى أرقى كما يلى: 1- تتطور وظيفة بعض الغرائز حتى تتجاوز وظيفتها الأصلية دون إلغائها، فتصبح وظيفة كثير من الغرائز، إن لم يكن كلها، موجهة “لحفظ النوعية” التى تميز ما هو “إنسان” جنبا إلى جنب مع “حفظ بقاء النوع”، (هذا غير التسامى الفرويدى). فى بحث سابق([8]) للكاتب بيـّن كيف تطورت وظيفة الجنس من التناسل إلى التواصل، وفى بحث أسبق وضع الكاتب فرضا لاحتمال الارتقاء بغريزة العدوان([9]) ذاتها (وليس على حسابها أو تساميا بها) إلى الإسهام فى حركية الإبداع. 2- تتكامل الغرائز مع بعضها البعض فيتوارى التناقض الظاهر تدريجيا وباطراد، فلا يعود العدوان بالضرورة ضد الجنس مثلا، (يظهر بعض ذلك فى تجليات المجاز فى الإبداع عامة، والشعر خاصة). 3- يتوسع مفهوم ونشاط ما هو غريزة حتى يمكن أن يتصف سلوك أرقى بأنه غريزة وأن يعامل نفس المعاملة من حيث الوعى به، وآليات تحويره واحتمالات مضاعفات سوء استعماله.. (مثلا: الحديث عن غريزة النزوع إلى التناسق مع الوعى الكونى: غريزة الإيمان).([10]) 4- يصبح الوعى بنشاط الغرائز جزءا من الوعى الإنسانى الأرقى، فلا يعود مجرد دراية ومعرفة، بل يصبح إشباعه تحريكا لحيويته لا إطفاء لنشاطه، إذْ يتجلى حضورا حركيا خلاقا بما هو فى ذاته (أنظر بعد). الوعى بالجوع ويقين العطش الفرض المقدم فى هذه الأطروحة يقول بأن الوعى بالغرائز على هذا المستوى الأرقى المشار إليه فى نهاية الفقرة السابقة، هو بديل عن عقلنتها من ناحية، كما أنه يبدو وسيلة لاستبقاء حركيتها الأرقى التى قد تغنى عن ملاحقة الاقتصار على إروائها، ناهيك عن إطلاق سعارها إلى مالا نهاية (نتيجة لانفصالها السابق عن فعل إشباعها مما سبق الإشارة إليه). فى دراسة نقدية لرواية إدوار الخراط “يقين العطش”([11]) تناول الكاتب مناقشة هذا الاحتمال بالتفصيل حيث قام بوضع فروض متلاحقة عن “العطش” الذى تناولته الرواية باعتباره: “جوعا إلى العلاقة بالآخر كموضوع حقيقى” وليس مجرد ميكانزم ذاتى يصبح المحبوب من خلاله مجرد مجال لإسقاط احتياج المحب، وقد تم تناول هذا الفرض لتوضيح كيف أن “العطش إلى الآخر” (الممتد حتى موضوعية المطلق) هو دافع موجود “ليبقي” وليس فقط “ليرتوى”. استشهد إدوار الخراط ابتداء فى تصدير روايته تلك بقول الجنيد … “أما من مات على العطش فهو أفضل منهم يقيناًً” (أفضل من رجال مشوا على الماء) قرأ الناقد، كاتب هذا المقال، مقولة الجنيد باعتبار أن من “مات على العطش هو من عاش بالعطش”. فكيف يمكن أن نعيش بالجوع والعطش، بدلا من أن نخاف طول الوقت من الهلاك من فرط الحرمان من إشباع أى منهما؟ وبدلا من الوقوع فى دائرة مغلقة نتيجة لانفصال الإشباع عن الوعى وعن نشاط احتياج الغريزة ذاتها؟ مستويات الوعى بالغريزة بعد أن بينا كيف أن الغريزة تعمل لاشعوريا أساسا فى الإنسان، نحدد من جديد ما يميز مستويات الوعى، بنشاط أى غريزة، فنفترض لذلك ثلاثة مستويات : المستوى الأول: الشعور بإلحاحها طلبا لإروائها (مثلا: الشعور بالجوع طلبا للأكل)، أو تمهيدا لإرجاء إشباعها للفرصة المناسبة. المستوى الثانى: الشعور بنشاطها الأعم غير المتعلق بإروائها لذاتها مما يترتب عليه احتمال عقلنتها أو إزاحتها (مجازا أو إبدالا أو كليهما) لتشمل الجوع إلى ما لا يؤكل مثل الجوع إلى الشوفان، أو الجوع إلى الحب، أو الجوع إلى الآخر، أو الجوع إلى المعرفة، أو الجوع إلى الحرية .إلخ المستوى الثالث: الشعور بحركيتها الغامضة المتجددة إذ تشارك فى حركية غيرها من الغرائز بعد أن تتقارب معاً نحو التكامل، وهذا يوظّفَ للحيوية والإبداع ضمن الاشباع الذى لا يطفئ نشاط الغريزة فى الوعى، بل يجددها لتواصل تكاملها الخلاّق مع غيرها. الوعى بحركية الغريزة ليس إلحاحا لاشباعها هذا المستوى الأخير هو ما أريد التأكيد على وظيفته فى هذه الأطروحة إن هذا النوع من الوعى بحركية الغريزة، غير الموظف مباشرة لتحقيق إشباعها، وفى نفس الوقت متجاوزا لعقلنتها، هو إعلان عن طور أرقى من التكامل البشرى حيث أنه يحقق كلا مما يلي: 1- إظهار كيف أن الغريزة عند البشر لا تنشط فقط لمجرد إشباعها بما هى (أى بما تعلن عن طلبه) 2- إن الوعى بحركية غريزةٍٍ ما، لا ينفصل عن الوعى بحركية غرائز أخرى تنشط معها، دون طلب الإرواء المباشر والفورى. 3- إن الوعى بنشاط الغريزة دون الإلزام بإروائها حالا، بالطريقة المختزلة، قد يحول دون آلية انفصالها عن إشباعها، (وهو ما أشرنا إلى أنه ما يكمن وراء كل من ضلال الخوف من الموت جوعا، وما يترتب عليه من سعار التكاثر الاغترابى). 4- إن احتواء نشاط الغرائز معا، يُنَشِّط التوجه الضام، فى حركية التكامل، فى اتجاه نهاية مفتوحة نحو المطلق. 5- إن مثل هذا التكامل قد يتناسب مع الفرض الخاص بأن النزوع إلى التناغم مع الكون الأعظم (راجع مقولة الجنيد عن “الموت على العطش”) هو غريزة تكاملية جيدة. الخلاصة - إن قبول هذا الفرض يجعل تعاملنا مع غرائزنا أرقى وأكثر تناسبا مع مرحلة تطور الإنسان المأمولة، حيث لا يصبح الجنس مثلا- هو ممارسة مغتربة لذية فحسب أو مسألة معقلنة بديلة، بل يصبح الوعى بالجنس هو إعلان لتوجه نشاط الوعى البشرى نحو قبوله فى توجه إبداعى يسمح بممارسته محتويا كلا من التناسل والتواصل واللذة والإبداع والتكامل. - على نفس القياس يمكن تصور أن الجوع، إذا ما عومل على نفس المستوى، فإن ضلالات الخوف من الموت جوعا المصاحبة لعدم الأمان تقل بشكل أو بآخر مما يترتب عليه الحد من سعار التكاثر. - إن حل هذا النوع من الوجود المثقوب (شرب الماء المالح) نتيجة لفصل غريزة الجوع عن فعل إروائها، هو لصالح “المغترِب التكاثرى” (صاحب السلطة أو المال، الذى لايشبع) بقدر ما هو – فى النهاية- لصالح المحروم المهدد بالهلاك، نتيجة للحرمان الأولى. - إن هذه النقلة لتوظيف الرقىّ بالغرائز من خلال الوعى الفائق بأبعاد حركيتها فى ذاتها، إذا ما تعمق سلوكيا لصالح النوع البشرى (الهالك اغترابا، والمهدد بالموت جوعا، معا) يمكن أن يصير مْنطَبَعا بيولوجيا مبرمَجَاً يعمل لحفظ النوع، ضد ما يهدده من تمادى كل من الاغتراب والمجاعة جميعا. **** [1] – مجلة سطور: (عدد يونيو 2004) [2] – يحيى الرخاوى: الترحال الثالث: “ذكر ما لا ينقال” الفصل الثانى “الجوع” (ص 40 إلى ص 72) [3] – يحيى الرخاوى: “من باريس للطائف وبالعكس”(ط1 1983) (ط2 2017) “الحاجة والقربان” ص 21 [4] – ديوان أغوار النفس (بالعامية) (ط1 1978) (ط2 2017) قصيدة ‘الترعة سابت فى الغيطان” ص130 [5] – يحيى الرخاوى: الإبداع والعدوان (الإنسان والتطور) عدد يوليو ص: 49-80 (1980) [6] – يحيى الرخاوى: “ديوان سر اللعبة” (ط1 1978) (ط2 2017) قصيدة: “جلد بالمقلوب”. [7] – يحيى الرخاوى: “دراسة فى علم السيكوباثولوجى” (1979) ص299 – 306 [8] – الوظيفة الجنسية: من التكاثر إلى التواصل (كتاب الثقافة العلمية) ص: 105- 130 [9] – انظر هامش رقم (70) [10] – يحيى الرخاوى “الأسس البيولوجية للدين والإيمان” (قراءة فى الفطرة البشرية) محاضرة ألقيت فى المجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 18/5/2004 [11] – يحيى الرخاوى: “صراع الوحدة وجدل العلاقة البشرية انطلاقا من رواية: “يقين العطش”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، 2019 الجـزء الأول: ماذا آل إليه حال الدين؟ عن أينشتاين أنه قال: من أقوال ابن عربى: من مواقف النفرى: (ومن موقف المطلع) (موقف وراء المواقف) أسئلة وإجابات ناقصة نبدأ بمحاولة متواضعة للإجابة على بعض الأسئلة الأساسية منعا لخلطٍ محتمل. السؤال الأول: هل هناك فروق جوهرية بين الأديان؟ الإجابة الظاهرة التقليدية أنه لا توجد فروق جوهرية، وهى إجابة ناعمة هروبية كاذبة غالبا، كما أنها إجابة تـُـستـَـعمل حاليا، فى أغلب الأحيان للتأجيل والتسكين والخداع، ذلك لأن الواقع المعلن، والواقع الخفى يؤكدان وجود هذه الفروق بشكل صارخ لا يمكن إنكاره. صحيح أن إعلانات الاجتماعات، وادعاءات الحوارات، تعلن غير ذلك، لكن صحيح أيضا أن فتاوى المفتيين المعلنة والمغلقة تؤكد أن الفروق الحالية فى واقع الممارسة، من خلال وعود وتهديد المستقبل، أكبر من كل حسابات. لكن ثم قاسم مشترك حقيقى يمكن أن يمتد حتى إلى الأساطير أيضا([2]). السؤال الثانى: هل ثم فرق بين الدين والإيمان؟ الفرق موجود، ومعترف به، وهام . فمن ناحية هما ليسا مترادفين، “قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ”. ومن ناحية أخرى هما ليسا متلازمين: فَثَّم متدين هو ليس فى عمق أعماقه مؤمن (الآية الكريمة السابقة)، وثَمَّ مؤمن لا ينتمى إلى دين بذاته (وهذا ليس مجال تفصيله حالا)، وبرغم هذه التفرقة الواضحة فإن العلاقة وثيقة بينهما، فالأغلب أن الدين أو (التدين) هو المظهر السلوكى والعقائدى لما يسمى الإيمان الذى عادة يترسخ فى صورة خبرة أو معايشة أو موقف وجودِ غائر. السؤال الثالث: ما علاقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ يعترف الكاتب بأن تناول مسألة الروح (التى هى من أمر ربى) ليست واردة فى هذه المداخلة بالمعنى الشائع عن كلمة “الروحانية”، ومع ذلك يبدو أن المشتغلين بمحاولة التوفيق بين الأديان قد جعلوا ما أسموه الروحانية، نسبة إلى الروح كما صوروها أو تصوروها، هى القاسم المشترك الذى يجمع بين المتدينين. باختصار: إن الروحانية هى مفهوم كامن فى غور كل من الدين والإيمان، لكنه قد يكون اغترابا عنهما أحيانا، بل وأحيانا أخرى يكون اغترابا عن الواقع المعيش، وعن الجسد، وعن البيولوجيا . من هنا لزم التنويه أن الفرض المقدم فى هذه المداخلة هو من منطلق أبعد ما يكون عما يسمى “الروحانية” كما يتناولها الدعاة المحدثون مؤخرا. السؤال الرابع: ما هى علاقة السلطة الدينية بالدين والإيمان؟ واقع ما آل إليه حال معظم الأديان، حتى تاريخه، هو نتيجة محاولة مقاومة استيلاء ما يسمى السلطة الدينية على حق تفسير الأديان باعتبارها من الملكية الخاصة، لهذه المؤسسة الفوقية، وقد استسلم أغلب المتدينين لهذا الترادف حتى ابتعدوا، بغير قصد غالبا، عن حقيقة وظيفة الدين وحقيقة الإيمان، ثم إن السلطة الدينية من جانبها قد استمرأت هذا الترادف فعينت نفسها وصية ليس فقط على الدين والإيمان، وإنما أيضا على وعى الناس المتدينين (وغير المتدينين). كثيرا ما يتردد الحديث عن الوصاية على ضمائر البشر، وهذا أمر وارد من جانب السلطة الدينية، لكن ثمَّة وصاية أخطر هى الوصاية الداخلية على حركية الوعى، فهى أكثر قهرا حيث أنه يترتب عليها منع معايشة خبرة الإيمان إلا بالمقاييس التى يضعونها، وليس فقط منع التفكير الحر أو منع إعلان الهرطقة. السؤال الخامس: هل ثمة علاقة بين الدين والغرائز؟ الشائع فى ظاهر الأمر، مع التعجل فى الحكم، أن التدين يقف على طرف نقيض من الغرائز، كذلك الإيمان، وذلك باعتبار أن الغرائز بدائية فجة، وأن الدين التزام منضبط، أو أن الغرائز دوافع دونية فى حين أن الإيمان هو روحانية راقية. هذا الشائع يحتاج إلى مراجعة مسئولة، حتى بالنسبة للغريزة الجنسية (بما فى ذلك مقولات فرويد) وكذلك بالنسبة لغريزة العدوان (الذى قد تساهم إيجابياته فى الابداع)، من باب أولى: علينا أن نستوعب ابتداءً كيف أن هذا الاستقطاب غير وارد أصلا فى تناول مسألة الدين والايمان وجذورهما البيولوجية، الغريزية. الغرائز هى أصل الوجود، والارتقاء بها، وليس على حسابها، هو التكامل الطبيعى على مسار التطور. وبعـد: أين يقع ما هو “دين” فى منظومتنا الحياتية الآن؟ إن إمعان النظر فيما آل إليه حال التدين فى الممارسة الفعلية فى عالمنا المعاصر يحتاج إلى وقفة مراجعة نوجزها على الوجه التالى: 1) عَجَز التدين التقليدى عن الوفاء باحتياجات الإنسان وسعيه إلى الإبداع والتطور. 2) لم يستطع العلم (خاصة بمنهجه التقليدى المحكم) أن يحل محل الدين والإيمان، حتى بعد أن أصبح له (للعلم) كهنته وطقوسه ومفتييه الجاهزين للحكم بالهرطقة على كل من خالف العلم (كما يرونه). 3) فشلت محاولات اختزال الدين إلى ما أتى به العلم كما فشل حبس العلم فيما يقره الدين. 4) فشلت أغلب محاولات التخلص التام من الدين، أو تهميشه، لصالح ما يسمى العلمانية، كما فشلت محاولات إنكاره كلية تحت زعم أن الدين مخدر للشعوب. (الشيوعية التقليدية) 5) فشلت محاولات تفسير التدين والإيمان باعتبارهما مجرد ميكانزمات لسد حاجة شعور البشر بنقصهم فى مواجهة قوى ساحقة أوغامضة. (التحليل النفسى التقليدى) 6) فشل ترويج تفسيرات تعتبر الدين بمثابة موقف أخلاقى لتحسين العلاقات فى المجتمع (أو حتى باعتباره ديكورا أخلاقيا يزين حقوق الانسان) 7) ثُم إن محاولات تحديث الدين- بإعادة تفسير نصوصه من منطلقات أحدث بدت وكأنها تسويق للدين بلغة معاصرة، وليست استلهاما لدوره المحورى المتكامل. 8) أما ما يسمى تثوير الدين، باعتباره دافعا مناسبا لاستعادة كرامة وإنسانية الإنسان (مثلا: الكنيسة اليسارية، واليسار المسلم، وبعض الأفكار الشيعية الثورية) فإنه انتهى إلى اختزال الدين إلى أداة سياسية لجمع الناس لرفع الظلم، أو حتى لاستلام الحكم أملا فى دفع الظلم أو تسلحا بما يدفع الظلم. 9) ظهرت محاولات انقلابية وطرْفيه (شاذة) تعلن ما يشبه الثورة، على الدين التقليدى بإحلال أديان حديثه لكنها – لظروف معاصرة – بدت بدعاً انقلابية أكثر منها أديان بديلة، ومن ذلك: (أ) إحياء ديانات قديمة شاذة (ب) ابتداع ديانات خصوصيه (من الكنائس الجديدة جداً حتى عبادة الشيطان) (جـ) نشاطات فيها سرِّية ما، تتهم بأنها ديانات (كما اتهمت الماسونيه – والروتارى) (د) طرق صوفية خاصة جدا : قديمة أو جديدة (هـ) تدين كيميائى (تجلى فى “ثقافة الإدمان”)([3]) بحركيتها فى الوعى، وطقوسها رغم سلبية نتائجها. (و) ظهرت أيديولوجيات بديلة، لها نفس مواصفات ما هو دين، برغم أنها قد تكون مبنية على إنكاره، وقد حسب أصحابها أنها يمكن أن تقوم مقام الدين وتؤدى وظيفته، ومن ذلك المناهج العلمية المغلقة اليقينية (دين العلم) وكذا المناهج التنويرية المتعصبة (دين التنوير) أو المناهج السياسية العقائدية (الماركسية التقليدية)، كل ذلك دار فى فلك العقل الممنطق، لكنه اتصف بكل المواصفات التى يمكن أن يدرج بها تحت ما هو “دين”. رأىٌ، ورؤية؟ (1) إن كل (أو أغلب) محاولات الاستغناء عن الدين نهائياً أو استبداله، قد فشلت بشكل أو بآخر. (2) إن الأديان جميعا، قبل أن تشوه تكاد تتفق فى بداياتها، وإن اختلف المحتوى، لكنها تعود تتفق – إلى درجة ما وغالبا – فى غايتها. (3) إن الإيمان ليس هو الدين، وإنما هو قبله، وبعده، وقد يكون مع التدين، (وقد لا يكون). (4) إن العلم ليس له علاقة – مباشرة – بالدين. (5) إن الدين ليس نشاطا ترفيهيا اختياريا. بعض ما آل إليه استعمال (أو سوء استعمال) الدين حاليا عبر العالم: إذا كانت أغلب محاولات التخلص من الدين قد فشلت مما ألزم بالعودة إلى شكل من أشكال الدين والتدين هنا وهناك، فإن هذه العودة لم تكن خالصة لوجه الحقيقة، وإنما بدت – غالبا – كنوع من المناورة على أنفسنا أساسا، حتى نبدو وكأننا اعترفنا بفشل تلك المحاولات، ومن ثم نحاول الإبقاء على التمسك بما يسمى “الدين” بأى صورة والسلام!. إن الناظر المتمعن فى هذه المحاولات التوفيقيه لا بد أن يعذر أصحابها بدرجةِ ما، حين يتبن أنها لم تكن محاولة للتخلص من الدين والإيمان، بقدر ما كانت محاولة للتخلص من سوء استعمال السلطة الدينية لكل من الدين والإيمان لصالح كل ما هو عكس الدين والإيمان. إن ما يقال عن العودة إلى الدين ليست عودة خالصة ولا مخلصة، وإنما هى تمثل نوعا أخر من التهميش والاختزال، على جانب، كما تمثل نوعا من الردة والنكسة على الجانب الآخر. بعض ما صار إليه استعمال الدين (أو ما يقال عنه دينا) 1- يستعمل الدين كمسكن كلما لزم الأمر، (وحتى إذا لم يلزم الأمر). هذا هو ما التصق بنوع من السكينة يحققها التدين الاستسلامى أو التسليمى. ارتبط هذا المفهوم بمقولة “النفس المطمئنة” بمعنى السكون والتسليم، أنه مثلما يحدث فى الطب النفسى، فإن تحقيق السَكينة يمكن أن يتم بنوعين من المعالجة: إما بتهميد الجزء المفرط النشاط من الدماغ أو من النفس بتعاطى بعض العقاقير القادرة على ذلك، ومن ثم بالعمل على إزاحة هذا الجزء أو قمعه كبتا دائما، وإما باحتواء هذا الجزء الناشر فى كلية قادرة على استعادة هارمونية التوازن الكلى بإشراك هذا الجزء فيه، الذى حدث فى حالة استعمال الدين مسكنا أو مخدرا هو أنه قد بولغ فى التركيز على مفهوم جزئى للنفس المطمئنة كغاية فى ذاتها، تكاد ترادف فعل التدين، إن المبالغة فى تصوير دور الدين فى تحقيق السكينة بالمعنى السلبى هو اختزال يخل بالمعنى الذى تقدمه حركية الدين كدْحا إلى الإبداع (الايمان). 2- يستعمل الدين بعض الوقت، غالبا فى نهاية الأسبوع، (أشبه ما يكون بنشاط ترفيهى). هذا استعمال غربى توفيقى طيب، فهو يسمح للمتدينين (وغير المتدينين) بقضاء فترة محدودة يمارسون فيها نشاطا اجتماعيا ناعما، مع جرعة مناسبة من الود والحلم، يتم ذلك فى دور العبادة فى نهاية الأسبوع عادة، أو كلما عَنَّ لهم ذلك. إن من يمارس أو يوصى باستعمال الدين بهذه الصورة يؤكد مكررا أن الدين أمر شخصى تماما حتى يصبح – من واقع الممارسة – أقرب إلى “الهواية الدمثة”، هذا استعمال قد يؤدى دورا اجتماعيا مفيدا، لكنه أسطح من دور الدين والإيمان فى تحقيق بشرية البشر من حيث عمق الجذور البيولوجية التى تجلى ويتجلى من خلالها الإيمان عبر التاريخ حتى قبل أن تكون الديانات أديانا. 3- يستعمل الدين كوسيلة لغيره، وبالذات للوصول إلى السلطة السياسية (بأى وسيلة بما فى ذلك الديمقراطية) الأمر فى هذا الصدد لا يحتاج إلى دليل بعد ما جرى مؤخرا فى الولايات المتحدة، وبعد ما يجرى حاليا فى أغلب البلاد الإسلامية التى يستعمل فيها النظام الحاكم، أو النظام الذى يريد أن يحكم، يستعمل الدين وهو يتصور أنه باستعماله سلطة الدين سوف يغير نوعية الحياة إلى كيف خلقها الله كما قرر هو وليس بالضرورة كما أرادها الله. 4- يستعمل الدين كوسيلة للتربح والاحتكار وقفل دائرة التعامل على أهل دين بذاته. هذا من أشهر ما يربط أفراد الأقليات الدينية خاصة، وهو جائز وجارٍ أيضا بين بعض فرق المسلمين الأحدث وأمثالهم، ولعل قيام ما يسمى بالبنوك الإسلامية هو من هذا النوع من الاستعمال بشكل ما. 5- يستعمل الدين تبريرا للاستيلاء على أوطان الغير، وطرد أهلها- وقتل الأطفال. وهل يحتاج الأمر للإشارة إلى الدولة العبرية أو إلى أمريكا وأفغانستان والعراق؟ أو إلى الأندلس قديما؟ فى مراحل معينة من التاريخ يصبح الدين من أقوى الدوافع لإفناء البشر من الديانات الأخرى تحت زعم هدايتهم، أعنى هداية من تبقى منهم، إلى دين بذاته. 6- يستعمل الدين تبريرا لما يسمى صراع الحضارات الحضارات تتعاون، وتتتابع، وتٌتَـوارث لا تتصارع بالضرورة، هذا هو المفروض. إن صح ذلك فى سائر الحضارات التاريخية فهو يصح أكثر فى الحضارات المؤسسة على أديان إيمانية فعلاً. من باب أولى فإن الأديان الحقيقية لا تتصارع لأنها حضورٌ دائم متجدد، وليست تاريخا جامدا قامعاً. إن الذى يتصارع هو أهل حضارات وأديان لم يعودوا أهلها. 7- يستعمل الدين لتفسير بعض العـلوم والمعلومات، وبالعكس فى لوثة أخيرة شاعت حتى بدت أنها الحق، انتشر ما يسمى “التفسير العلمى للنصوص الدينية”، وهو نشاط جاد بعضه، حسن النية أغلبه، سطحى كله. ذلك لأنه يدل على جهل خطير بكل من الدين والعلم على حد سواء. الدين – خاصة بالمعنى الذى تتناوله هذه المداخلة – هو أقدم تاريخا وأرسخ قدما، ولعله أكثر عمقا وإفادة لتأكيد ماهية الإنسان حتى منذ عهد الأساطير الجيدة،أما العلم فهو فى حركية دائبة متجدده، لا يعنيه أن يستمد مصداقيته من غيره. 8- يستعمل الدين كوسيلة لقهر أو وأد الإبداع. إن قياس كل ما يصدر من جديد (فى الفكر أو فى العلم أو حتى فى الاقتصاد والسياسة) بتفسير جامد (قديم عادة) بنص دينى معين هو من أكبر الإهانات التى يمكن أن يجهض – فى نهاية النهاية أية محاولة لإعادة وضع الدين والإيمان فى موضعهما التطورى المناسب. إن الإبداع الذاتى خاصة (خبرة الكدح إلى وجه الحق تعالى باستمرار) هو السبيل الأساسى لتواصل النمو الذاتى، ومن ثم اطراد تطور النوع البشرى بعد أن اكتسب الوعى، فكيف -يقف الدين فى وجه أى نظرية للتطور؟ “الدين”؟ (كمفهوم ومنظومة) آن الأوان أن نخطو خطوة أخرى نحو التعرف على ما يطلق عليه “دين” من أكثر من زاوية ومنطلق، ولكن علينا أن ننبه ابتداء أن هذا التحديد ليس له علاقة مباشرة بالتفسير الدينى التقـليدى للـَّـفظ نفسه. يمكن أن نعدد الأبعاد التى تميز مفهوم “الدين” كممارسة حياتية على النحو التالى: 1- هو منظومة “كيانية- فكر- وجدانية” يستعمل هذا اللفظ المركب “فكر- وجداني” للإعلان الضمنى ان فصل الفكر عن الوجدان هو أمر مفتعل فى أغلب الأحيان. وليس معنى أنه مفتعل أنه خطأ أو سىء، لكن المقصود أنه ليس مطلوبا دائما، وليس سليما دائما، ثم إن هذا الفصل لا يخدم المداخلة الحالية تحديدا. الدين بهذا الوصف يتجاوز الاعتقاد الفكرى (العقلى) الخالص، ليحتوى ما هو وجدان فى نفس الوقت، أما إضافة صفة ثالثة (صفة كيانية) ليصبح المفهوم أكثر تركيبا (وليس أكثر تعقيدا بالضرورة) فإن ذلك جاء اجتهادا ليؤكد تجاوز الدين لكل من الفكر والوجدان ليحتويهما معا وهو يعلن “موقف وجود” كلى، يكاد يستحيل فصله إلى مكوناته الجزئية. إلا على حساب حقيقته. 2– وهذه المنظومة هى شعورية جزئيا “فقط” (الجزء الأقل غالبا). بعد الإنجازات الأحدث فى دراسات العقل والتفكير من خلال العلم المعرفى، والعلم المعرفى العصبى بوجه خاص أصبح من المسلم به أن التفكير هو لاشعورى أساسا (وليس تماما)، إن ما يظهر فى الشعور ويقاس هو نوع واحد من التفكير أو مستوى واحد منه، يترتب على ذلك أن علينا أن ننظر فى هذه المنظومة المسماة الدين بما يناسبها من حيث أنها لا تقاس بنوع التفكير الظاهر (الذى يسمى عادة التفكير المنطقى أو العقلى وهى تسميات قابلة للمراجعة أيضا)، وإنما بما يناسبه من أنه وعى كلى غائر غائى فى نفس الوقت، يدفعنا هذا إلى التنبيه إلى أن محاولة قراءة ما هو دين (باعتباره تفكيراً آخر) من خلال شفرة ما هو منطقى عقلى ظاهر هى محاولة محكوم عليها بالفشل من ناحيتين: الأولى اختزال الدين إلى ما يسمح به هذا العقل الظاهر، والثانية هى اختزال العقل إلى ما استعملناه فيه مستبعدين ما هو غير ذلك. 3- منظومة الدين تجيب – إجمالا عادة – عن كثير من تساؤلات الوجود الغامضة. للإجابة على مثل هذه التساؤلات مستويان (على الأقل) المستوى الأول: هو المستوى الجاهز بالإجابات التفصيلية التى يصدرها عادة المفسرون والمفتون والمفكرون العاديون، ثم مؤخرا بعض من يحاول أن يجعل بعض معطيات العلم تفسيراً للدين وبالعكس، أما المستوى الثانى فهو مستوى الإجابات من خلال التفكير الأعمق المتصل بالوجود والوجدان من ناحية، والمتناغم مع الكون والإيقاع الحيوى من ناحية أخرى. هذا المستوى من الإجابة أصبح – بفضل العلم المعرفى والحدْس الإدراكى – قادراً على إعطاء إجابات أكثر كلية وأعمق نبضا. ظل المتصوفة يقولون بهذا المستوى المعرفى عبر التاريخ، لكنهم لم ينجحوا فى أن يشرحوا ماهيته لغير من خـَـبـَـره، إلا أن الأمر الآن يبدو أقرب إلى الإقرار بفضل ما استحدث من مناهج معرفية لا تستبعد آليلت الرصد والتشابك العملاقة. 4- وللمنظومة (المسماة الدين) تجلياتها فى السلوك (طقوس/ عبادات) لم يقتصر أى دين، بل وما هو مكافئ للدين قبل ظهور الأديان، على أن يكون “منظومة فكر وجدانية” دون أن يتجلى فى سلوك يعلن وجوده، وليس بالضرورة محتواه الفكرى، لكل أسطورة طقوسها، ولكل دين عباداته، الأصل أن تكون ثمة صلة وثيقة بين المظهر السلوكى للدين إذ يتجلى فى عباداته، وبين الحضور المعرفى الغائر فى الوعى المتوجه إلى غايته، (متجاوزين وصاية العقل الظاهر). واقع الحال يعلن فى كثير من الأحيان أن هذه الصلة قد تكون – أو تبدو – واهية، أو منقطعة، أو حتى معكوسة. 5- وهى (المنظومة: الدين) تفى ببعـض احتياجات صاحبها (كلُّ دين يـُرضى أتباعه) إن وجود هذه المنظومة لا يستمر، وقد لا يجد له مبررا حقيقيا، ما لم يقم بسد بعض (أو كل) احتياجات أصحابها. تختلف هذه الاحتياجات باختلاف درجة نضج صاحبها: من أول الانتماء إلى من يشبهه، حتى الوصول إلى مرحلة الإبداع الذاتى المفتوح على الوعى الفائق بلا نهاية، يقع ما بين هاتين النقطتين عدد هائلا من الاحتياجات الدفاعية البسيطة (الميكانزمات: مثل الإنكار والإزاحة والإسقاط …إلخ) إلى الاحتياجات المتوسطة (مثل الطمأنينة والاعتمادية المشروعة والحفاظ على الأمل). 6- كما تعد الطيبين منهم بجزاء طيب “مستقبلا” عادة (لا سيما بعد الموت) حتى الآن، لا يوجد دين، حتى الأديان غير السماوية لا يعد معتنقيه بالخلاص والتكامل والروعة الفائقة الانسجام. تختلف تفاصيل هذه الوعود من دين إلى دين، أغلب هذه الوعود يختص بها المخلصون للدين المتبعون لتعاليمه المؤدون لعباداته، كما يُحَرُم منها كل من خالف صاحب الدين المعنى، يتضاءل ربط معايشة هذه المنظومة (الدينية) بهذا الوعد المستقبلى مع اطراد النمو الفردى فى اتجاه الوعى الفائق والتناغم مع المطلق، لعل هذا هو ما يفسر تنازل كثير من الصوفية عن الحرص على الجنة مثلا فى مقابل رؤية وجه الحق سبحانه وتعالى (رابعة العدوية من أشهر الأمثلة وإن لم تكن أعمقها). 7- وينتمى إليها جماعة من البشر لكى يكون الدين دينا، خصوصا بالمعنى الشائع، لا بد أن ينتمى إلى نفس المنظومة التى يمثلها عدد من البشر، إن من أهم الوظائف الإيجابية لما هو دين هو حضور “الآخر” الموضوعى فى الوعى، وفى الواقع، على حد سواء. لا يكون الإنسان بشرا إلا بأن يكتسب الوعى بالآخر، فلا يتحقق وجوده إلا مع “آخر” من نفس الجنس، إن هذا الانتماء له ميزاته، كما أن له مخاطره: فمن ناحية هو يحقق للمتدين بعضا مما يسمى “المصداقية بالاتفاق”، إلا أن هذه الحاجة نفسها قد تشتد حتى تظهر سلبياتها باستبعاد من لا ينتمى إلى نفس المنظومة، من وعود جنته، حتى لو توجه إلى نفس الهدف المشترك. وبعد؟ أسئلة جديدة أولا: هل يكفى أن نرضى بتطبيق ما ذهبنا إليه فى تحديد أبعاد ما هو دين لفهم كيف ظلت الأديان راسخة فى مستويات وعى الانسان كل هذا التاريخ؟ ثانيا: ألا يحتاج الأمر لمزيد من البحث الأعمق، فى جذور ما هو دين وإيمان، مما يمكن معه أن نكتشف أن تكون تلك الجذور منغرسة فى عمق ما هو بيولوجى فى تناغمه مع الكون الأسع، بما يوازى ويدعم ذلك التناغم الإيمانى الخلاق فى الخبرة الايمانية خاصة (وفى مجال التصوف والإبداع بشكل أخص)؟ ثالثا: ألا يمكن أن يكون هذا البعد الأعمق (بالبحث عن الجذور الحيوية للدين والإيمان) هو المدخل الأمثل لفهم إيجابيات الدين والايمان بلغة تسمح باستيعابهما لصالح التطور والإبداع توجها إلى وجه الحق سبحانه وتعالى؟ رابعاً: إذا صح ذلك، أو بعض ذلك، ماذا يمكن أن يترتب عليه هذا ما سوف أحاول تقديمه لاحقا. ****
[1] – مجلة سطور: (عدد يوليو 2004) أصل هذه الورقة هو (من ثلاثة أجزاء)، قدمّت بشكل مبدئى فى مؤتمر عالمى فى سانت كاترين (اكتوبر 2003)، ثم قدمت فى مركز ابن خلدون (فبراير 2004) ثم موجزة فى اجتماع خاص للجنة الثقافة العلمية المجلس الأعلى للثقافة، ثم فى منتدى ابو شادى الروبى الذى تنظمه نفس اللجنة فى (18 مايو 2004) مقتصرة على الجزء الثانى منها، أما هذا الجزء الأول فهو مقدمة لما آل إليه حال الدين حتى وقتنا هذا. [2] – إن ما جاء فى هذه الفقرة يسرى على الأديان السماوية والأديان غير السماوية معا، مع زعم أو حقيقة أن الأديان غير السماوية أقل تعصبا، وإن لم تكن –غالبا – أقل استعلاء من الأديان السماوية. [3] – يحيى الرخاوى (بعض ما يجرى داخل المدمن: ولمحات من ثقافتنا الشعبية) منشورات جمعية الطبنفسى التطورى 2017 لكلمة اللعب سحر خاص ودلالات متنوعة حسب السياق الذى ترد فيه. فى بداية كتاب “خدعة التكنولوجيا” (الذى صدرت طبعته الرخيصة هذا الصيف: مكتبة الأسرة ترجمة د. فاطمة نصر)، ينبه المؤلف “جاك إيلول” إلى أن “لعبة الحقيقة تنطوى على مخاطر، كما أن لعبة الديمقراطية تنطوى على مخاطر وكذلك لعبة الثورة، كما أن تأدية هذه الألعاب مجتمعة تنطوى على مخاطر”، ماذا تبقى بعد ذلك لا ينطوى على مخاطر؟ وأى نوع من المخاطر تلك التى تنطوى عليها كل تلك الألعاب، ولماذا أسماها إيلول بالألعاب ؟ حتى تلك المسرحية الجيدة – برغم الصوت العالى – المسماة “اللعب فى الدماغ”([2]) لم تنجح إلا لأنها كانت تصور اللعب فى مساحة أكبر وأعمق وأشمل للعب: كانت أقرب إلى ما أريده بهذا العنوان “اللعب فى الوعى” (على خفيف: خفة الدم، وخفة التناول!) كلمة “لعب” لها استعمالها الخاص فى وصف الحياة أو التكتيك أو العبث أو المناورة حسب السياق، فإذا استعملناها فيما يتعلق بالحياة والموت، أو ببقاء النوع أو فنائه، فإن الأمر يصبح خطيرا. ثم إن مفهوم “الوعى” أيضا هو من أكثر المفاهيم عرضة لسوء الفهم، هذا إذا نجا أصلا من الإهمال والاختزال. فما هى الحكاية؟ إن ما يتعرض له الوعى البشرى خاصة فى العقدين الأخيرين على مستوى العالم برمته من خلال الإعلام خاصة أصبح لعبة من أخطر ما تعرضت لها البشرية عبر تاريخها. لو صح ما أراه جليا متماديا من أن خطرا تطوريا يحيق بالجنس البشرى فى طوره المعاصر، فإن أهم آليات التمادى فى ذلك هو أن تملك القوة المتسببة فى تفاقم هذا الخطر كل أسلحة الانقراض الشامل، تبثها، وتروج لها، وتستعملها لأغراضها الخاصة، وهى لا تدرك مخاطرها التدهورية على مستوى العالم دون استثناء من يستعملها. المسألة تتعلق بخطأ تطورى جارٍ يهدد الجنس البشرى برمته، وقد استطاع بعضنا – نحن البشر – بفضل ما تميزنا (وامتُحنّا) به من “وعى”أن ندرك طبيعة وحجم وسرعة هذا الخطر. المصيبة أن نفس هذا الوعى الذى يمكن أن ينقذنا من خطر الانقراض هو ما يتعرض الآن للبرمجة المغرضة، والتشويه المنظم بألعاب الإعلام، وتفاهة التربية، وسوء التديّن، وغير ذلك. “الوعى” أشمل وأخطر مما يسمى “العقل” بالرغم من الترادف الأحدث لاستعمال لفظ العقل محل الوعى([3]) إلا أننى لن أغير ما جاء بالمقال سنة 2005 لأسباب لا تخفى. الوعى هو غير العقل وغير التفكير وغير الذكاء وغير الإدراك وإن شملها جميعها. الوعى البشرى، بما صار إليه، وما تمكن منه، هو الذى جعل أغلب ما كان يتم عند أسلافنا الحيوانات بطريقة آلية لحفظ البقاء، يجرى عند الإنسان وهو متاح للمراجعة والتخطيط والتعديل إذا لزم ذلك، أقول مرة أخرى: إنه الوعى وليس العقل على الرغم من أن أغلب الناس يفضلون الحديث عن عقل الإنسان وإنجازاته كأهم علامات ما وصل إليه من تطور، حتى أنهم اختزلوا الإنسان إلى ما يسمى “الحيوان العاقل”…، إن من أهم ما يميز الإنسان، بعد رحلته الرائعة حتى الآن، هو أن وعيه قد تطور حتى صار منظما بهيراركية بالغة الدقة متشعبة الإحاطة. حين تصورنا أن نشاط العقل هو العامل الأرقى جدا فى تنظيم حياة الإنسان كان الأمر قاصرا على إضافة نشاطات العقل المعرفية والمنهجية فى مجالات بذاتها، لكن العقل الظاهر البرمجىّ حين تحالف مع إنجازات التكنولوجيا والعلم ليصبح أداة قصدية للإسهام فى تشكيل وعى الجنس كله عبر العالم، أصبحت الحسبة أعقد من المنطق الظاهر، وأدعى للنظر والمراجعة. كان الخطر قائما طول الوقت عبر التاريخ المعروف لما هو إنسان، إلا أن التباعد الجغرافى، والاختلافات العرقية والإثنية والدينية والثقافية بين مجاميع الناس، كانت تحول دون أن يمتد الخطر التدهورى الذى يظهر فى بقعة جغرافية ما، أو فى حقبة تاريخية بذاتها، إلى الجنس البشرى كله بسرعة غير ملحوقة، كانت مثل هذه المخاطر محدودة بمحدودية إمكانات الانتشار (وأيضا بالحروب والإبادة وصراعات البقاء بين المجموعات المختلفة المتباعدة)، الأمر اختلف الآن خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى أحرج وقت عرفته البشرية عبر تطورها، الخطر الآن أصبح أشبه بالطاعون حين يعم الوباء العالم كله من خلال الآليات الأحدث المفروض أنها ظهرت لتسهل انتشار المعرفة والتواصل بين البشر، فإذا بالسلطة الواحدة التى تحكم العالم تستعملها ضد كل تاريخ الحياة عامة، وضد الإنسان بما وصل إليه وما تميز به. أخطر الخطر الآن أن تلك السلطة التى تحكم (وتتحكم فى) العالم هى أولا: خفية، ثانيا: غبية. ثالثا: أحادية. ورابعا: ناشز عن المجموع (لم تعد هى سلطة الدولة ولا حتى سلطة أفراد بعينهم مثل السفاحين والطغاة الذين عرفهم التاريخ). هذه السلطة الغامضة الناشز، بهذه المواصفات الأربعة، تحكم العالم وهى تتحكم فى معظم أسلحة الانقراض الشامل. إنها برغم خفائها وغبائها تمتلك كل الوسائل الأحدث لخدمة أغراضها الخاصة، غير مدركة – كما أشرنا – أن اللعب الجارى إذا ما تمادى حتى حقق ما ينذر به، لن يستثنيها من الفناء. “الوعى” كما أتناوله فى هذه الأطروحة هو الوظيفة الأشمل للوجود البشرى بيولوجيا ومعرفيا ووجدانيا على مستويات متعددة. هذا الوعى هو الذى مكّن الإنسان من احتواء تاريخه بشكل غير مسبوق، مثلا: هو الذى احتوى غريزة الجنس حتى لم تعد مقتصرة على حفظ النوع بالتكاثر، بل امتدت لتؤكد خاصية أخرى، لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها، ذلك أن الكائن البشرى لا يكون إنسانا إلا وهو مع – فى علاقة – إنسان آخر: مختلفٍ مواكبٍ متفاعلٍ مبدعْ. الوعى الذى أتحدث عنه ليس نقيض اللاوعى (اللاشعور باللغة الفرويدية) بل هو كل منظومة بيولوجية وجودية ظاهرة أو كامنة قادرة على التشكيل والتشكّل لتحقيق هدف معلن أو خفى. نحن لا نملك الوعى فى مقابل ما هو “لا وعى”، نحن نعيش بمستويات متعددة من الوعى تتبادل وتتجادل وتتشكل طول الوقت (برغم أن دانيال دينيت يسميها “العقول”) هذا الوعى البشرى هو أعظم ما أنتجه التطور بشكل واعد بما يتخلق منه أروع مما تخلق به، وهو هو الذى يتعرض فى الآونة الحالية لمأزق تطورى حرج، ذلك أن الإنسان المعاصر قد حقق إضافات علمية وتقنية رائعة هى التى يستعملها فى التعامل مع الوعى البشرى بكل مستوياته، فتصيغه فى تشكيلات وتنويعات غير مسبوقة بسرعة لا تسمح باختبارها: هل هى لصالح تطوره أم لمزالق فنائه. من خلال هذه الآليات أمكن للسلطات المتحكمة فى هذه الآليات أن تؤثر فى تشكيلات الوعى بطرق متعددة تبدأ من تعديلات وتنويعات تكاد تشبه ما علمنا إياها الحاسوب ولا تنتهى عند ما نعلم، إن هذه السلطات السياسية المالية الظاهرة والخفية (وغيرها من وسائل التعليم والإعلام) يمكنها أن تضيف للوعى، وتحذف منه، وتعيد تشكيله، وتوسع ذاكرته، وتسرع من حركته، تماما مثلما نتعامل مع تحسين أو تحديث أو تخريب أى حاسوب (شىء أشبه بإضافة سعة ذاكرة الحاسوب كذا ميجا بايت، أو إضافة قرص عتاد خارجى يحمل آلاف المعلومات اللازمة، أو إضافة مفاعل للسرعة يسهل الإنجاز ويعمقه). أصبح من الممكن بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أو بسوئها – أن ندخل إلى الوعى برامج مقحمة ليست بالضرورة لصالح التطور أو الوجود الأرقى أو الجمال أو الإبداع، أصبح من الممكن تخليق غرائز استهلاكية قاتلة، وإقحام غرائز أيديولوجية زائفة، وتجميد غرائز دينية راسخة، أصبح من الممكن حشر معلومات اغترابية مدمرة، تماما مثلما يفعل الساديون أو العابثون حين يقحمون فيروسا مهلكا فى الكمبيوتر. لكن ثم جانب آخر لهذه الميزة التقنية الحديثة فى تعاملها مع الوعى إذ المفروض أنها تقوم فعلا بتوفير الوقت، وتسريع التربيط، وتسهيل التوثيق، وتشجيع التنويعات… إلخ، ثم إن آلية التواصل الممتد بين البشر قد أتاحت الفرصة لمد شبكة العلاقات الإنسانية عبر القارات، وعبر الأديان، وعبر الألوان، وعبر الأجناس، النتيجة البدهية لهذا وذاك كان ينبغى أن تكون كالتالى: أن يصبح الإنسان أكثر إنسانية، وأعمق وعيا، وأرق تراحما، واقل تعصبا، وأجمل إبداعا. فهل حدث ذلك؟ نعم، حدث فى قطاع محدود عبر العالم، محدود جدا، قطاع ما زال يمثل أقلية غير مؤثرة فى مسيرة ومصير البشرية، قطاع يملك سلامة الوعى وحدة البصيرة ومثابرة الإنتاج والإبداع، لكنه لا يملك السلطة القادرة على التغيير الواجب لتحقيق ما تعد به مسيرة التطور. هذا القطاع هو فئة المبدعين نقدا وإنشاء، الذين استوعبوا حركة التطور ورصدوا إنذارات الانقراض فراحوا عبر العالم يتواصلون أسرع، ويتعمقون أكثر، ويبدعون أجمل فى كل مكان. ليس من الضرورى أن يحذق كل أفراد هذا الفريق تفاصيل مهارات التواصل والتوصيل الأحدث، لكن كل واحد منهم يدرك بحدسه ووعيه ما يجرى حوله فى العالم، فيسهم بما تيسر. لكن الواقع الماثل يقول: إنه فى غفلة من الزمن، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى (مرة أخرى)، وجد العالم نفسه وقد سلم قيادته – غير مختار– لتيار يسير فى عكس الاتجاه تماما، ذلك أن الذى أمسك بزمام السلطة (فى المجالات الفاعلة:المالية والسياسية والإعلامية والتربوية أساسا) فريق يمكن أن يعتبر “طفرة شاذة سلبية من النوع البشرى”. إن الانقراض لم يستأذن أيا من الكائنات التى انقرضت قبل أن تفنى، الأمر يختلف فى حالة الإنسان بعد أن تمتع (أصيب) بمزية (محنة) الوعى، ذلك الإنسان أصبح قادراً على الحيلولة دون انقراضه، كما أنه قد يساهم فى الإسراع بفناء نوعه. الفرض الذى يطرح نفسه على كل ذى بصيرة من البشر الآن يعلن: إن الانقراض وارد اليوم أكثر من أى يوم مضى، وبالتالى فعلى كل فرد من أفراد هذا النوع (البشرى) أن يتحمل مسئوليته، لعله يسهم فى الحيلولة دون الفناء الجماعى. ليست مؤامرة، بل خطأ مرعب أقر وأعترف أننى لا أزعم وجود مؤامرة بالمعنى الذى استعملت فيه هذه الكلمة عبر التاريخ، لكن ثم “خطأ تطورى جسيم” سوف يدفع ثمنه الجميع برغم أن المسئول عنه هم نتاج طفرة سياسية اجتماعية شاذة فقدت قدرتها على الانتماء للحياة الممتدة فى نوعها فعلا. لقد تحولت أهم إنجازات الإنسان التكنولوجية المعلوماتية العلمية الأحدث فى أيدى هذه الفئة إلى آليات تسمح لها أن تلعب فى وعى كافة البشر ضد قوانين البقاء والتطورٍ. لا مجال فى مقال بهذا الحجم أن أطرح بالتفصيل ما يدعم هذا الفرض المنذر بالانقراض، سوف أكتفى بالإشارة إلى معالم آليات اللعبة كمجرد عناوين، ثم أعرض نموذجا خبراتيا من الواقع، لعله يبين بعض ما يجرى. بصفة عامة: إن ما يجرى بشكل منظم، أو حتى عشوائى، يبدأ باللعب فى الإدراك ، إن الإدراك – برغم شيوع استعمال الكلمة- هو مدخل المعلومات إلى الوعى، الإدراك يحدث بشكل سريع جدا، وعلى أكثر من مستوى، لدرجة لم تسمح بدراسته بما هو كما ينبغى. وذلك برغم كل محاولات دراسة الإدراك البصرى خاصة (نفسفسيولوجيا psycho-physiological)، مؤخرا دراسات العلم المعرفى العصبى Neuro-cognitive science وخاصة لعملية اعتمال المعلومات Information processing)، برغم كل ذلك نحن مازلنا بعيدين عن التعرف على ماهية الإدراك كما ينبغى مع أنه من أهم وسائل المعرفة حتى رؤية وجه الحق سبحانه تعالى. لعلنا نتذكر أن إدراك الإنسان المعاصر مصلوب أمام التليفزيون (ثم النت والفيس بوك) لعدد من ساعات النهار والليل طول الوقت بما يسمح لمن يريد أن يلعب فيه ويلعب به أن يفعل ما يشاء. اللعب فى الإدراك يتم بالتشتيت والتقطيع والتشويش، حتى تكاد الحصيلة طولا وعرضا تصبح أشبه بالفيديو كليب المشوه (ليس فقط فى مجال الأغانى). لن أطيل فى شرح كيفية اللعب فى الإدراك أو الوظائف الأخرى التى يشملها الوعى. أذكّر فقط بأن: اللعب فى الانتباه يجرى بالجذب والكذب والوعود ودغدغة الغرائز منفصلة، ثم يتمادى إلى قطع مثابرة الانتباه بالإغراء والتشتيت حتى يكاد لا ينتهى مشاهد أى موضوع إلى غايته إذا كانت له غاية، فتشل آلية مشاركته فى اتخاذ أى موقف أو حسم أى قرار. اللعب فى الوعى يشمل أيضا آليات الإغراق، بالإلحاح المتمادى والتكرار المتنوع والملاحقة، وهو (اللعب) يتعمد الإلهاء بالتهميش لتحل الهوامش والتفاصيل محل المتن، كما أنه يستعمل الأرقام (سواء دعمت بمعادلات إحصائية مشبوهة أو لوحت برأى عام غير ممثـِّل للمجموع) لإشلال الفكر العملى والمنطق البسيط، ثم خذ عندك ذلك الاستغراق فى التحليل التاريخى أو التبرير التاريخى دون أن يصب التاريخ لا فى الحاضر ولا فى المستقبل وكأن الرسالة تنتهى عند ألعاب الحذق وحل ألغاز شطرنج لوحات التاريخ، أو على أحسن الأحوال: تزجية الوقت مع حلّ “المعلومات القديمة المتقاطعة” (قياسا على ألغاز الكلمات المتقاطعة). عندك أيضا التمادى فى عرض القضايا الزائفة (مزاعم قبول الآخر مثلا) لتحل محل القضايا الجوهرية (مثل شرف الجدل لتخليق ما يمكن من الاختلاف الحيوى)، وأخيرا وليس آخرا تقديم المقدسات الجديدة بشكل يجعل منها كهنوتا جاثما، أو صنما راسخا، أو أيديولوجيا مغلقة (من أول الديمقراطية بديلا عن الحرية حتى حقوق الإنسان المكتوبة بديلا عن حقوق الإنسان المعيشة..إلخ) المثال: الغضب، وعروض العنف والقتل والقهر ما معنى، وهدف، ونتيجة تقديم هذا الكم الهائل من مناظر العنف والهدم والطرد؟ ثم مناظر الدماء والجثث والأشلاء والجنازات؟ ثم مناظر التجريس والإهانة والتعذيب؟ ثم مناظر الشماتة والتبلد والافتراء لمن يقومون بكل ذلك؟ لماذا؟ ما هو عائد كل هذا الذى يعرض على الإنسان العادى عبر شاشات التليفزيون بوجه خاص ثم التواصل الاجتماعى غير المسئول؟ ماهى الرسالة المراد توصيلها للناس من خلال مواكبة القتل (لا القتال) والإذلال (لا مجرد الهزيمة) والإبادة (لا الاستعمار فقط)؟ قيل إن مثل هذا الإعلام “الشفاف” قد أسهم بشكل رائع فى إشراك المواطن العادى فى متابعة المذابح (لا المعارك) لحظة بلحظة، لم يعد الأمر يحتاج أن ننتظر سنوات لنتعرف على ما حدث فى الميدان الغربى فى الحرب العالمية الأولى من رواية إ.م.ريمارك “كل شىء هادئ فى الميدان الغربى”، إن قارئ تلك الرواية على مهل (بعد انتهاء الحرب) قد استطاع أن يستوعب معنى الحرب وبشاعتها، ولست متأكدا إن كان ذلك قد أسهم فى تأجيل الحرب العالمية الثانية أم لا، الأمر الآن لا يحتاج إلى رواية لاحقة تكشف عن الفظائع التى نعيشها بالصورة والصوت أولا بأول، وقد لا تكون هناك فرصة أصلا لقيام حرب عالمية ثالثة، بين من؟ ومن؟ لقد حاولت تلك السلطة العمياء الناشز التى تحكم العالم أن تبتدع ما يجعلنا نتصور احتمال صراع قادم بين الحضارات، أو بين القارات، أو بين الأديان، فجاءت المحاولة أكثر خيالا وغرابة من الخيال العلمى عن الحرب بين الكواكب، وأيضا من الخيال الدينى أو السياسى الذى يقسم العالم إلى محور للشر وآخر للخير، إن مواكبة كل هذا العنف والقتل والتدمير ليس له عائد يخدم الشفافية أو يحفز المقاومة ما دام يجرى بكل هذا الإصرار والتحيز والتكرار والبلادة. إن الناتج قد يكون غير ما تصوره لنا الدعايات عن الشفافية وكيف تخدمها تكنولوجيا الإعلام ومن ذلك: تصورت أن الناتج يمكن أن يتراوح بين التبلد، والتعود، واليأس، والعجز، والإهانة، والتهميش. أتاحت لى قناة النيل الثقافية (المصرية) فرصة إعداد وتقديم برنامج باسم “سر اللعبة” أحاول أن يتم من خلاله بعض الكشف التلقائى الخبراتى، فالتدريب على التفكير النقدى وتحريك الوعى بعيدا عن النصح والفتاوى وعبارات التلقين و”فى الواقع…”، وفى “الحقيقة”، منذ أسبوع بالتمام كنا نلعب فى هذا البرنامج لعبة “الغضب”، (تواكب ذلك مع استكتابى هذا المقال للاشتراك فى هذا الملف، وكنت قد أعددت الألعاب قبل ذلك بيوم أو أكثر، وكان التسجيل يوم 4 أغسطس 2004). اللعبة تتمثل فى جملة ناقصة يكملها الضيوف الأربعة، وشخصى، بأكبر قدر من التلقائية، ثم نتحاور حول استجاباتنا، لعبة بلعبة. كانت اللعبة الخامسة (التى علينا نحن الخمسة أن نكمل عبارتها الناقصة) تقول: “هُمَّ بيورّونا الدم والهدم والقتل دا كله فى التليفزيون ليه؟ عشان نغضب؟ ولا عشان نتعود عليه؟ دانا حتى...” كان على الضيف المشارك أن يكمل الجملة بأسرع ما يمكن مع أقل قدر من التفكير، جاءت أغلب الاستجابات كما توقعت: دالة تلقائية مؤلمة خطيرة، أذكر منها على سبيل المثال إجابة ضيفة رقيقة، أكملت: “… دا انا حتى ما عنتش باحس باللى باشوفه”، أما إجابتى شخصيا فأذكر أننى قلت “..دانا حتى ما عنتش بافتح التليفزيون من أصله…”. كان ذلك قد حدث فعلا من سنتين، امتد الأمر من تجنب مناظر الدم والقتل والعنف فحسب، إلى الأخبار الأخرى فالأغانى فالتليفزيون كله، وقد أسفت لما حدث لى هكذا دون ادعاء احتجاج أو رفض، فقط: لم أعد أستطيع، هذا كل ما فى الأمر. أصبح التليفزيون بالنسبة لى مثل “الفزاعة”، ثم تطور حتى كدت أرى أشلاء الأطفال وحرائق المخيمات وتجريف الأرض، حتى حول الصغيرة عجرم وهى تغنى، إذا لمحتها عابراً، ولم ينفعنى أننى مازلت محتفظا بسلامة البصيرة طول الوقت. هذا الحل الفردى (الشخصى) الهروبى الانسحابى ليس حلا أصلا، ومع ذلك، فلعل فيه احترام لأمرين: عدم القدرة على التحمل أكثر، والعجز – ولو مرحليا – عن الرد أو إبطال الجارى أو توجيه الغضب إلى الفعل. فى هذه الحلقة أيضا كانت هناك لعبة تقول: “الواحد حا يغضب على إيه ولاّ على مين، أنا أحسن لى…..” وكان على المشاركين أن يكملوا، وجاءت الإجابات دالة أيضا تعلن أن الأغـلبية أكملوا ما يفيد أن الأحسن لهم أن يتمادوا فى “التبلد” أو “التطنيش” (الطنبلة)… الخ كل هذه الآليات الدفاعية، حتى الانسحاب، هى لحمايتنا من الألم، وقد أظهر النقاش، حولها بعد اللعبة أنها مجرد خدعة مؤقتة، فانتبهنا إلى أن كل ما نفعله إزاء ما يعرض علينا (أو يراد بنا) هو أننا نكتم ما يعتمل بنا حتى لا ننفجر الآن، ننجح ظاهرا مرة فمرة فمرة فمرات حتى نتبلد أو ننسحب أو نتكلم فى التاريخ، أو فى الآراء ووجهات النظر، ودمتم. فى لعبة أخرى – فى نفس حلقة الغضب أيضا – قرب نهاية البرنامج كانت العبارة الناقصة تقول “أنا لو سمحت للغضب إللى جوايا إنه ينطلق لآخره يمكن…“ واحد منا قال “يمكن انفجر” الآخر قال “يمكن أطُبّ ميت…” وأذكر أنى قلت: يمكن أقتل.. إلخ. إن ما وصلنى من هذا ومثله، هو أننا نتعامل مع هذه الرسائل الإعلامية الدموية “الشفافة”على أكثر من مستوى، وأن ما نعترف به ونقره هو ما يسمح به مستوى وعينا الظاهر لا أكثر، أما تشكيلات الوعى على مستويات أخرى فهى عرضة لأن تمارس أشكالا من البرمجة والكمون والعكس إلى ما لا نهاية له من تشكيلات، ليست فقط على مستوى الذاكرة الخفية والميكانزمات الدفاعية، وإنما هى قد تغوص حتى تصبح انطباعا بيولوجيا غائرا (مشوِّها فى الأغلب). إذا تمادى مثل ذلك، وانتشر عبر العالم، وغاص، وتثبت فى البيولوجى فعلا، فإن الإنسان لن يعود إنسانا أصلا، هذا إذا بقى على هذه الأرض دون انقراض. أكتفى بهذا المثال، وإن كنت لا أستطيع أن أنهى المقال دون الإشارة إلى مثال آخر يحتاج لمقال مستقل، ذلك أنه يتعلق بمقدس نتصور أنه أبعد ما يكون عن اللعب (بالوعى أو بغيره)، إن مايسمى البحث العلمى حين تتولى أمره تلك السلطة النشاز المضادة للتطور، لم يعد – فى كثير من المجالات – بحثا ولا علميا، بل لعبة أخرى تخدم نفس التوجه نحو الانقراض. فى مجال التطبيب والتداوى، يتم اللعب فى وعى الأطباء بشكل يبرمج أداءهم كله تقريبا ليكون فى خدمة سوق الدواء لا أكثر ولا أقل، بل إنه يتم صرف مليارات الدولات لحجب الأبحاث التى تبين أضرار ومضاعفات الأدوية الجديدة الباهظة الثمن، والنتيجة: ليست فقط حرمان الأفقر من التداوى حتى الموت أحيانا، وإنما يمتد الخطر إلى تشكيل وعى الأطباء بعيدا عن الطبيعة وعن العلم الحقيقى وعن مرضاهم وعن أنفسهم، ثم إن الخطر لا يقتصر على ما يلحق بوعى الأطباء من تشويه تحت ما يسمى “البحث العلمى” ولا ما يلحق المرضى من مخاطر التداوى الخاطئ والمضاعفات، بل إن الأمر يمتد إلى دور شركات الدواء (مع شركات السلاح) فى الإسهام فى القرارات السياسية المدمّرة، وتدعيم آليات الانقراض الشامل، ذلك أن أمثال هذه الشركات هى من أهم أعضاء السلطة العالمية النشاز والخفية التى اشرنا إليها فى بداية المقال. **** [1] – مجلة سطور: (عدد سبتمبر – 2004) [2] – مسرحية “اللعب فى الدماغ” قدمت على مسرح الهناجر بدار الأوبرا فبراير 2004 بالقاهرة. [3] – يتأكد ذلك فيما ذهب إليه دانيال دينيت فى كتابة “أنواع العقول” فى محاولة فهم “الوعى” حتى كاد يرادف بين “العقل والوعى” وهذا جائز شريطة تبيان ذلك فى منطلق بذاته كما فعل المؤلف . Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness Daniel C. Dennet 1996 الحق فى الخوف ”نظرت فى ظلمات الماضى فـرأيت وجه حبيبتى يتألق نورا بعد أن دام غيابها خمسين سنة، فسألتها عن الرسالة التى أرسلتها لها منذ أسبوع فقالت إنها وجدتها مفعمة بالحب ولكنها لاحظت أن الخط الذى كتبت به ينم عن إصابة كاتبه بداء الخوف من الحياة وبخاصة من الحب والزواج، ولما كنت مصابة بنفس الداء فقد عدلت عن الذهاب إليك وفكرت فى النجاة فلذت بالفرار”. (نجيب محفوظ “نصف الدنيا عدد 777 - 2 يناير 2005”) أنظر كيف عرى محفوظ الخوف من الحياة، ومن العلاقة بالآخر (الحب) هكذا وهو فى هذه المرحلة مع كل الإعاقة والصعوبة! كيف كثف الزمن قفزا عبر نصف قرن! كيف عمم هذا الخوف بين الطرفين بهذه الدقة؟ كيف كان الهرب هو الحل فى مواجهة هذا الخوف المتبادل! نجح نجيب محفوظ أن يلغى الزمن وأن يختزل خمسين عاما ليتواصل الحوار: خطاب العتاب من أسبوع، والفراق من نصف قرن، والرد المؤجل “الآن”. انطلاقا من هذا الحدس الإبداعى ألا يجدر بنا أن نتدارس هذه الظاهرة فى جذورها الأعمق بدءا من الخوف من الآخر ومن الحب ومن الحياة إلى الخوف من الحرية، والخوف من الإبداع، بديلا عن الدعوة المسطحة الشائعة أنه “لا تخف”، “ودع القلق وعليك بالسعادة”، وما شابه؟. هذا بعض ما سوف تحاوله هذه المداخلة بداية البداية هل الخوف عاطفة سلبية علينا أن نتخلص منها بأى وسيلة؟ وبأسرع ما يمكن؟ هذا إذا سمحنا لها أصلا بالظهور؟ لماذا هذا التسارع فى النهى عن الخوف؟ كيف ذلك؟ من قال هذا؟ أو بلغة أهلى “بأمارة إيه؟ يقول المثل العامى المصرى: “مِـْن خـَـافْ سـلـم”، ويقول مثل أقل شيوعا “خافْ وخـَـوِّف”. على الناحية الأخرى: يروج المتدينون التقليديون للبسطاء أن النفس المطمئنة عليها أن تكون خالية من الخوف، خالصة للرضا الأبله، ناسين ضرورة كدحها كدحا لتلاقيه سبحانه وتعالى، وتكمل علينا شركات الأدوية وهى توزع الأقراص الساحرة التى تخفى الخوف من أصله، وهى تخترع علما تسميه “علم السعادة”، وتوظفه لترويج بضاعتها. كيف لا نخاف؟ من أبسط ما يبرر اعتبارنا أن “الحق فى الخوف” هو من حقوق الإنسان الأساسية هو أن نستعمل المنطق البسيط فى مواجهة الحقائق الجارية حولنا وقد أصبحت فى متناول الجميع ونحن نتساءل: * كيف لا نخاف وقد امتلك مقاليد القوة والسلطة أبعد الناس عن حمل مسئولية استمرار النوع البشرى؟ * كيف لا نخاف وقد امتلكت هذه السلطات كل أدوات الدمار التى تصوبها عن بعد لمن يخالفها أو يقف فى طريقها، ولا يستطيع أحد أن يحاسبها عن مصداقية معالم طريقها (الذى تفرضه علينا باعتباره الأوحد) المزعوم، أو عن مآله؟ * كيف لا نخاف وقد تدنى الإنسان فى عدوانه إلى افتراس أفراد وجماعات من بنى جنسه وهو يقتل من لا يعرف عن بعد، دون معارك أصلا، الأمر الذى لا يمارسه أغلب الحيوانات؟ * كيف لا نخاف وقد انفصل العلم ونتائجه عن الأخلاق والوعى المسئول عن الحفاظ على النوع البشرى واكتفى بالإسراع فى الإنجاز لتوفير الرفاهة فحسب؟ * كيف لا نخاف وقد تجمد الدين فى أيدى سلطات لم تعد تتحرك إلا لتثبت ما سبق تصور إثباته خطأ أم صوابا * كيف لا نخاف وقد تراجع المنطق البسيط جدا، عن تغيير الظلم الشديد جدا، ومساندة الحق الواضح جدا؟ * كيف لا نخاف ونحن قادمون من تاريخ بقائى تطورى مزدحم بكل تجليات الخوف وفضله ومخاطره ودوره؟ ثم: كيف نتعلم كيف نخاف؟ إذا كان الخوف مشروعا إلى هذه الدرجة فعلينا أن نبحث بجد حقيقى فى كيف نتعامل مع هذه المشروعية بمسئولية حذرة، علينا أن نتساءل: كيف نخاف لنستمر أرقى، وننتج أجمل، ونعرف أشمل، ونبدع أكثر أصالة، نبدع أنفسنا كما نبدع الجديد والجميل؟ كيف نخاف لنزداد يقظة وحرصا ليس فقط على جماعتنا الخاصة (وطنا أم دينا أم مذهبا) الآيلة للذوبان فى طوفان البشر المتقارب اختيارا واضطرارا، نتيجة لفرص التواصل والرعب المشترك؟ كيف “نخاف جميعا معا” حرصا على استمرار هذا الجنس الرائع المسمى “البشر”؟ كيف نخاف على إنجازات هذا الكائن البشرى المجتهد عبر التاريخ حتى لا تظل هكذا احتكارا لمن لم يعد يهمه أن ينتمى إلى فضائل هذا الكائن المسمى “الإنسان”، بما تميز به من تاريخ مليء بالجدل والإبداع، حتى أفرز هذا الحضور الجميل القادر؟ هل ثمة عواطف سلبية فى ذاتها؟ إن كل ذلك يجعلنا نرجع إلى أسئلة أسبق تقول: هل ثمة عواطف سلبية وأخرى إيجابية فى ذاتها؟ هل المطلوب للإنسان المعاصر أن ينفصل عن تاريخه الحيوى بهذه الدعاوى المسطحة التى تزعم أنه أفضل من أجداده ـ دون وجه حق؟ علينا أن نتساءل بادئ ذى بدء: هل ثم حق لنا فى الخوف أم أنه عيب ومرض ومرفوض من أصله؟ أى الموقفين أصدق؟ أو قل أى الموقفين أقرب إلى الطبيعة البشرية؟، بل الطبيعة الحيوية؟ ومن ثم إلى حفظ الحياة، وحفز التطور، فالإبداع؟ أقر وأعترف أننى لم أنتم للفكر التطورى نتيجة قراءات موسوعية، أو نقد ممنهج، وإنما علمتنى الخبرة العملية خلال نصف قرن أن أعايش أجدادى من خلال نكوص مرضاى، كما سمحت لى مواكبتى لرحلتهم تدهورا وجدلا علاجيا (استعادة مسار النمو) أن تلطمنى صراعات ذواتهم، فتتعتعنى حتى أرى أكثر من احتمال فى كثير من الأحيان. هذا هو المصدر الأساسى لهذه المداخلة. لا يوجد انفعال سلبى فى ذاته وآخر إيجابى لأنه كذلك. الانفعال، من منظور تطورى، هو آلية دفاعية مبرمجة، تقوم بدورها بكفاءة إذا توفر لانطلاقها كل من الجرعة المناسبة والموقف الداعى لإطلاقها. إننا نطلق لفظ الانفعال (ثم العاطفة والوجدان) على هذا الدفق الدافعى الدفاعى النمائى الخاص، وكأنه غريزة جزئية موجهة، تؤدى وظيفة بقائية معينة، يستتبع ذلك أنه علينا أن نعامل انفعالاتنا جميعها ـ من حيث المبدأ ـ بقبول مبدئى دون أن نصنفها إلى سلبى أو إيجابى، إن الانفعال (والعاطفة والوجدان) يصبح سلبيا فقط فى حالة ما إذا زادت الجرعة أو اختل توافقها مع ما يطلقها من مواقف. بتطبيق هذا المنطلق بشأن الخوف، علينا أن نبدأ بالاعتراف به انفعالا طبيعيا، بل ضروريا، باعتبار أنه الجانب الواعى للتهيؤ للهرب، أو التحضير للهجوم، ثم تنتقل مهمتنا بعد قبوله، إلى ضرورة استيعابه، مما يتطلب تحديد وظيفته ثم ضبط جرعته، وحساب تناسبه، فإذا حقق الخوف وظيفته التحذيرية، ثم الدافعية، بالتنبيه والانتباه والفهم فالاستعداد للمجهول بما فى ذلك التهيؤ للكر والفر، فهو جدير بموقعه التطورى الضرورى. الخوف ليس واحدا الخوف ليس واحدا لا فى اللغة، ولا فى السواء، ولا فى المرض. ”ليس فى اللغة مترادفات تامة”، نشأت المترادفات ليكمل بعضها بعضا فى محاولة الإلمام بظاهرة ما من هذه البداية، ومع أن المعاجم ليست وصية على واقع اللغة وتطورها، إلا أننا نلاحظ أن للخوف تجليات عديدة ظهرت فى شكل ألفاظ مختلفة، يصح هذا فى اللغة العربية، كما يصح فى لغات أخرى (ربما جميعها)، فى العربية مثلا نجد ألفاظ: الفزع و الهلع والرعب ثم الخشية أو الرهبة..إلخ وفى الإنجيلزية نلاحظ ربطا ما بين الخوف والإدراك الفاهم فى لفظ Apprehension. وهكذا. فى السواء: نقابل تجليات متعددة حتى التناقض فيما بينها مثلا: الخوف الجبان، والخوف المتحفز، والخوف اليقظ، والخوف الحاسب المستبصر، والخوف من الفقد، ومن القـُـرب، ومن البعد، ومن الحب، ومن الآخر، ومن الحياة، ومن الموت، ومن المجهول، ومن الحرية ..إلخ، أما فى المرض فنجد الخوف الغامض (القلق)، والخوف المزاح والمسقط، والخوف المحدد غير المنطقى (كل ذلك بعض ميكانزمات الرهابات بأنواعها: مثل رهاب المرتفعات، ورهاب الأماكن المغلقة، والمتسعة (أنظر بعد)، كذلك زاد تواتر ما يسمى نوبات الهلع (التى تأتى فجأة ويصاحبها خفقان شديد حتى الشعور باقتراب الموت). تلك النوبات تواترت حتى كادت تحل محل “القلق المتماوج الغامض”، وكأنها تعلن زيادة كبت الخوف بما هو، وأيضا كبت القلق المألوف بشكل ما. هكذا يتراكم الخوف فى الداخل حتى ينقض فى نوبات الهلع تلك. كما أن من أعراض المرض أيضا: الخوف المفرط من الجنون ومن الضياع، ومن فقد السيطرة غير ذلك. ثم إن الخوف قد لا يظهر بنفسه عرضا مباشرا وإنما تظهر آثاره فى صورة ضلالات المراقبة والاضطهاد والتنصت، حتى التبلد يمكن أن يعتبر مظهرا لتجنب وإنكار الوعى بالخوف، وكذلك يمكن قراءة التفسخ الفصامى باعتباره فض اشتباك تجنبا للوعى المرعب. الحق فى الخوف فى مرحلة ماقبل الإنسان كان الهرب (وهو سلوك نابع من الخوف ومرتبط به) من أهم الوسائل التى تحافظ على بقاء الكائن الحى، و حين بدأ “الوعى بالانفعال” يصاحب ظهور الوعى عامة عند ما هو إنسان، ظهر انفعال مصاحب للهرب أساسا سمى “الخوف”، ثم لم يعد قاصرا على مصاحبات الهرب. للخوف إذن أساس بقائى والوعى به ظاهرة بشرية: “أنا أخاف فأنا منتبه” “أنا أخاف إذن فأنا يقظ” “أنا أخاف فأنا أتحرك” وقد يصل الأمر إلى: “أنا أخاف إذن أنا موجود”. إلا أنه حين يطغى الخوف، استجابة لمثير عادى أو أقل، أو بدون مثير على الإطلاق، فإنه يشل القدرة حتى على الهرب، وهذا عكس وظيفته الدفاعية، فى هذه الحال قد يصل الشلل خوفا لدرجة التصلب حتى التجمد، وهذا أيضا هو دفاع بدائى وإن بدا فى ظاهره معوقا للهرب، يلجأ الحيوان إلى هذا الدفاع حين يدرك بغريزته أن العدو المفترس المهاجم قد يتعرف على مكان وجوده من مجرد حركته، فيتجمد سكونا دون أى حراك لخدعة المهاجم المفترس لعله يعتبره جمادا لا حياة فيه، هذا هو ما يقابل ما يحدث فى الإنسان فى مرض (أو عرض) يقال له “الكاتاتونيا” (التصلب التخشبى) حيث يبدو الجسم البشرى بلا حراك، لكن دون فقدان الوعى، بل على العكس فقد يصاحب هذا التصلب درجة ما من فرط الانتباه، مما يؤكد المعنى الدفاعى لهذا التصلب حتى التخشب الجمادى برغم فرط الانتباه. إنكار (كبت) الخوف ومع ذلك فإن الإنسان المعاصر راح ينكر على نفسه “الحق فى الخوف” (تحت عنوان “لا تخف” ([2]) مثلا) وهو بذلك إنما يكبت ما يشبه الغريزة الدفاعية، ومن ثم يفتح السبيل إلى تراكم غير مضمونة آثاره، ذلك لأنه إذا لم يكف هذا الكبت المباشر لقهر وإخفاء الخوف، فإنه يتم اللجوء إلى استعمال مزيد من”الحيل النفسية” لضبط وحبس الخوف فى الداخل (تماما مثلما يحدث مع كبت غريزة الجنس من منظور التحليل النفسي). الكبت ليس مرفوضا من حيث المبدأ، كل الحيل النفسية (وأولها الكبت) يستعملها الإنسان تجنبا للمواجهة التى قد تفوق طاقة احتماله فى لحظة بذاتها أو مرحلة بعينها، أما إذا بالغ فى ذلك لأى سبب، فإنه إنما يعرض نفسه إلى خطورة الإنفجار من الداخل، فى شكل مرض أو غير ذلك، يسرى هذا على كبت الخوف مثلما يسرى على كبت الجنس والعدوان ..إلخ الفرض (1) الخوف انفعال بقائى ضرورى مرتبط بدرجة ما ـ مهما ضؤلت ـ بإدراك اقتراب أو وقوع خطر ما، بما يستتبع ذلك من استثارة آلية “الكر والفر” الدفاعية. (2) يتميز الإنسان بدرجة خاصة من الوعى بحيث يصبح الخوف انفعالا فى ذاته حتى لو لم يرتبط بالكر والفر حالا. (3) يتميز الإنسان أيضا بتعدد مستويات وجوده (وعيه) حتى أنه يمكن أن يعى خطر الداخل (الحقيقى أو المتخيل) بنفس آلية إدراك خطر الخارج، وإن لم يكن بنفس درجته. (4) من أبرز تجليات إيجابيات هذا الوجدان (الخوف) فى الإنسان: حدة الانتباه وتحضير الجسد والفكر لمختلف الاحتمالات، وحشد الآليات الدفاعية الجسدية والنفسية الآن ومستقبلا. (5) إن إنكار هذا الانفعال/الوجدان من حيث المبدأ هو نوع من الكبت الذى إذا زاد قد يؤدى إلى التعامل مع هذه الغريزة بدفاعات وميكانزمات مشوهة أو معطلة أو منحرفة. (6) تجاوزا للتعامل بالميكانزمات، ومع اضطراد النضج، يجرى التعامل مع الخوف كما يجرى مع أى غريزة فى مسارها المتنامى، وذلك: بالقبول والاعتراف، فالاحتواء والتخطيط والإبداع. (أ) بضبط الجرعة (الوعى المناسب). (ب) وتوجيه الطاقة (الفعل المناسب). (جـ) وإعادة التنظيم (إبداعا للذات أو إنتاجا لخارجها) (7) كلما كان الخوف منفصلا عن سائر العواطف، وسائر الوظائف النفسية الأخرى وخاصة الوظائف المعرفية، والإرادية (اتخاذ القرار)، كان أقرب إلى اللاسواء (المرض) (8) تزداد إيجابية الخوف بازدياد مساحة ترابطه الهادف مع سائر العواطف والوظائف (خاصة المعرفية) حتى يمكن ألا يعود خوفا بالمعنى الشائع أصلا. متدرج الخوف: أول انفعال يعايشه الطفل حديث الولادة هو ما يمكن أن يسمى انفعال “البهر” Orientation وهو انفعال عام يمكن أن نعتبره: خليطا من: الدهشة والقبول والرفض والتحفز، وهو لا يصل إلى ما يسمى خوفا عادة، وهو يرتبط باستقبال الحواس للجرعات الأولى للإدراك الحسى (رؤية وجه الأم مثلا، على مسافة) مما يسمح (ويهدد) بالتمييز بين ما هو “أنا” وما هو “ليس أنا”، ومن ثم “بهر الدهشة” من أن العالم ليس قاصرا عليه، لأن ثم “آخر” هناك بكل ما يحمل من تهديد ووعود وعطاء وأخذ، فهو الخطر. تنقلب الدهشة البدئية هذه إلى عدد من التجليات أثناء النمو الطبيعى كما يلى: أ) متى أصبح وجود “الآخر” منفصلا قائما وضروريا، وفى نفس الوقت صار مصدر تهديد فى ذاته (وهو ما يسمى الموقف البارنوي)، ومن ثم تصبح العلاقة بالآخر هى علاقة الحذر والتوجس، وتصبح الاستجابة هى “بالكر والفر” أساسا. ب) يتقدم التعرف على الآخر (الأم أساسا) ليصبح الآخر ليس مصدر تهديد فقط، بل مصدر الحياة (الرضاعة) والأمان (الدعم والثقة) أيضا، وهنا ينقلب البهر المبدئى ليس فقط خوفا من هجوم من “آخر مختلف”، ولكن أيضا خوفا من الترك (الهجر)، ويصعـب الأمر أن المصدر (الآخر) المهدد بالترك هو هو مصدر الحياة والأمان، وهذا هو مايسمى الموقف “الثنائى الوجدانى” Ambivalence وهو الموقف “الاكتئابى”. وبرغم التسمية: الموقف البارنوى فالاكتئابى([3]) ـ فإن ذلك لا يعنى لا بارانويا ولا اكتئاب بالمعنى المرضى، بل على العكس تعتبر هذه المواقف هى من أساسيات خطوات حركية النمو الدائبة، والمعاودة فى تصعيد نوبى إيقاعى متصل. مما سبق نرى كيف أن الخوف الإنسانى مرتبط بتميز “الأنا” عن “اللاأنا” من ناحية، وأنه يتغير ويتشكل بحسب مرحلة وطبيعة العلاقة بالآخر. تشكيلات ومستويات من هذا المنطلق أيضا يمكن عرض تشكيلات / مستويات (لا تصنيف) مبدئية لبعض تجليات الخوف: أولا: الخوف الانفعال الفج: حين يتخلى الخوف تماما عن (أو هو لم يرتبط بعد بـ) وظيفته المعرفية (الدهشة فالإدراك فزيادة أبجدية التعرف)، تقتصر تجلياته فى المصاحبات الجسمية (التى تظهر أساسا من خلال الجهاز العصبى الذاتى مثل خفقان القلب والعرق وارتفاع الضغط واللهاث ..إلخ) وأيضا يظهر فى الوعى المرعوب بأشكاله التى تتجلى فى صورة الهلع أو التجمد بلا حراك. ثانيا: الخوف الدهشة (الإدراك): حين تكون الدهشة هى الانفعال الذى يستقبل المؤثرات الجديدة بمزيج من الرغبة والحذر والمغامرة جميعا، وهى تنقلب خوفا صريحا إذا ما اتسعت المسافة بين جرعة الإدراك، وآلية التشكيل (اعتمال المعلومات (Information Pocessing) وهكذا يتطور الخوف الدهشة إلى الخوف المعرفة فالخوف الفعل الخلاق، حيث يتجاوز تشكيل المدركات الداخلية والخارجية من مرحلة “اعتمال المعلومات” إلى فعل “إعادة تخليقها وصياغتها” فى كلٍّ جدلى جديد، وهنا تحتوى الإرادة المبدعة طاقة الخوف الدهشة، وكلما كان الإبداع أصيلا كان احتمال خوض غمار بحور الخوف خطيرا (يتحدث كثير من المبدعين، من الشعراء خاصة، عن هذا المأزق المرعب أثناء ممارسة الإبداع وكأنهم بين الموت والحياة قبيل وفى بداية خوض معمعة الخلق) ([4]). بعض تجليات “طيف” الخوف من البديهى أنه لا مجال فى هذا الحيز أن نعرض لتشكيلات وتجليات الخوف كما تظهر فى الصحة والمرض على حد سواء فنكتفى بعرض “متن” لهذه التجليات بأقل قدر من التعليق كما أوردها الكاتب سابقا ([5]) ومن ذلك: (1) الخوف البدئى (فقد الأمان الأساسى من الأم/الأسرة) ”…وانتشلونى أتعلم فى مدرسة الرعب: فن الموت العصرى وتعلمت: أن أحذف من عقلى كل الأفكار الهائمة الحيرى: ألا أتساءل “لم” أو “كيف” فـ “لماذا” تحمل خطر المعرفة الأخرى” (2) الخوف من السلطة /الأب (فالتوحد بها: ضياعا ) ”…فى الغابة: أكل الطفل من لحم أبيه الميت هربا منه إليه. يا أبتى إن زاد القهر: فسألتهمك إذ يسحقنى الخوف لن تؤلمنى بعد اليوم فأنا القاتل والمقتول وسر وجودى أنك مت تختلط ضمائرنا تتبادل فسأمضى تمضى نمضى… نحو سراب وجود عابث” (3) الخوف من الداخل يسقط على الخارج فيتكون “الرُّهاب”: فى الداخل كهف الظلمة والمجهول وتفتيت الذرة، والخارج خطر داهم، ………… يبدو أن الرعب من الخارج أرحم، ولكن … لكن … شئ ألمسه بيدى، يلهينى عن هول الحق العارى، عن رؤية ذاتى. أفليس الظاهر أقرب؟ والخوف عليه أو منه يبدو أعقل؟ هو ذاك: أخشى أن أمشى وحدى، حتى لا تخطف رأسى الحدأة([6]) أما بين الناس…فالرعب الأكبر: أن تسحقنى أجسادهم المنبعجة، اللزجة، والممتزجة،([7]) أخشى أن يـُـغلق خلفى الباب ..، أو أن يـُـفتحْ فالباب المقفول هو القبر .. أو الرحم أو السجن، والباب المفتوح يذيع السر. …… أخشى أن أنظر من حالق، …. أو أن يأكل جسمى المرض الأسود، أو أن أقضى فجأة، أو أن أفقد عقلى، أو أتناثر….،…، (4) فشل الدفاعات والتهديد برؤية الداخل (فالجنون المحتمل): لم يعد الرعب من الخارج يكفى أن ينسينى الداخل، فاقتربت نفسى منى حتى كدت أراها،…..، وحقيقة أصل الأشياء تكاد تطل،…..، (5) تكوين الوسواس الاجترارى دفاعا ضد الوعى بخوف الداخل: ويظل التافه يملؤ وجه الساحة يخفى الخطر الأكبر فالتافه آمن: فليشغل بالى أى حديث أو فعل عابر، ولأمسك بتلابيبه وليتكرر …. وليتكرر …. وليتكرر… وليتكرر أكثر؛ نفس الشئ التافه، دون النظر إلى جدواه، فلأحفظ ْ أرقام العربات، أو عدد بلاط رصيف الشارع، أو درج السلم، أو أصبح أنظف، لكن من فوق السطح، هذا غاية ما يمكن، (6) الوسواس القهرى خوفا من مواجهة الداخل أيضا: صور لى العقل المتحذلق: أن السارق ضابط شرطة، فإذا بالمصيدة الكبرى… تمسكنى من ذنبى : حتى أمضى سائر عمرى فى عد القضبان، أو لمس الأشياء على طول طريق حياتى؛ دون الغوص إلى جوهرها، أو جمع الأعداد بلا جدوى، أو إغلاق نوافذ بيتى، ونوافذ عقلى تتبعها، وحديد التسليح يكبل فكرى. (7) الخوف من تعرية الذات وبعض آثاره من التجمد والمطاردة: …. فتحت أبوابى، رق غشائى، قـلبت صفحات كتابى، وتناثرت الأسرار، (…..): فى يوم الرعب الأول: لما غادرت القوقعة المسحورة، صدمتنى الدنيا: نار الحقد قد اختلطت بجفاف عواطف ثلجية، فتجمد تمثال الشمع المنصهر: صور لى خوفى أن الكل يطاردنى(100) . (8) الرعب من العلاقة بالآخر (الخوف من الحب / الحياة): ”….. والثور الأعمى فى فلك دائر، يروى السادة بالماء المالح، فى رأسى ألفى عين ترقبكم، تبعدكم فى إصرار. أمضى وحدى أتلفت، … لكن حياتى دون الآخر وهم: صفر داخل صفر دائر، لكن الآخر يحمل خطر الحب، إذ يحمل معه ذل الضعف، يتلمظ بالداخل غول الأخذ، فأنا جوعان منذ كنت، بل إنى لم أوجد بعد، من فرط الجوع التهم الطفل الطفل، فإذا أطلقت سعارى بعد فوات الوقت، ملكنى الخوف عليكم إذ قد ألتهم الواحد منكم تلو الآخر، دون شبع، …. لكن بالله عليكم: ماذا يغرينى فى جوف الكهف، وصقيع الوحدة يعنى الموت؟ لكن الموت الواحد: … أمر حتمى ومقدر أما فى بستان الحب، فالخطر الأكبر أن تنسونى فى الظل، ألا يغمرنى دفء الشمس، أو يأكل برعم روحى دود الخوف. فتموت الوردة فى الكفن الأخضر، لم تتفتح، والشمس تعانق من حولى كل الأزهار،. هذا موت أبشع، لا.. لا تقتربوا أكثر، جلدى بالمقلوب والقوقعة المسحور، تحمينى منكم. (راجع حلم محفوظ فى البداية، وكيف كان الهرب هو الحل نتيجة للخوف المتبادل من الحياة، ومن الحب، (من العلاقة!!!). (9) عود على بدء: الرعب البدئى “يـكبت” فى جوف الصمت: ”… قربان المعبد طفل، يرنو من بعد، لا يجرؤ أن يطلب، أو يتململ، أقعى فى رعب فى جوف كهوف الصمت،……، لم يعرف أى منهم أن صلابته هى من إفراز الضعف وحصاد الخوف، لم يسمع أحدهم نبض أنينه والطفل الخائف يقهره البرد الهجر. لم ملكنى الرعب؟ هل خشية أن تنفجرالذرة، أن أقتحم المجهول؟ أن أطلق روحى فى روح الكون؟ أن أتحرر؟ وبـعـد بالنظر فى الفقرة الأخيرة تطل علينا إشكالة الخوف من الحرية، الأمر الذى أولاه إريك فروم عنايته ليخرج لنا كتابا بأكمله هو “الخوف من الحرية” ([8]) وقد تناول مسألة الحرية كاتب هذه المداخلة أيضا فى عملين منفصلين،([9])،([10]) هذا بالإضافة إلى الخوف من الإبداع، والخوف من الخوف، (الخوف كأنه كلب سد الطريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت: صلاح جاهين ([11]). وكل هذا يحتاج إلى حديث آخر. -الخلاصة * طالما أن هناك مجهول فالخوف قائم ونحن نطرق باب هذا المجهول أو نخطو فيه أو إليه. * طالما أن هناك حركة فالخوف وارد وعلينا أن نفرق بين الحركة فى المحل (بلا خوف) والحركة إلى ما لا نعرف (لنكتشف ما نضيف ونحن فى خوف بديع). * طالما أن هناك جديد فالخوف طبيعى حتى نتعرف عليه بأكبر قدر من التحمل. * طالما أن هناك وعى فالخوف يقظة تشحذ هذا الوعى حتى يتعمق ليستوعب أكثر، ويخاف أبدع. * طالما أن هناك آخر حقيقى مختلف، فالخوف مواكب لمحاولة إنشاء علاقة حقيقية مبدعة مغيرة معا. * طالما أن لنا داخل لا نعرف أغلبه يهدد بالظهور أو التعرى فالخوف ضرورة مصاحبة لأى كشف له، أو حتى تهديد بكشفه. * طالما أن هناك تهديد بالانقراض فالخوف فريضة حياتية بقائية تطورية معا. خلاصة الخلاصة إن التمتع بحق الخوف لتشغيله فى اتجاه اليقظة، والتخطيط، والحرص، والإبداع، لا ينبغى أن يفهم على أنه دعوة للترحيب به فى ذاته منفصلا عن سائر الوجدانات والوظائف وحركية التطور والإبداع. دعونا نأمل أن نتحمل مسئولية تاريخ تطورنا، لعلنا نتمكن من أن نكمل المسيرة بما تعد، لا بما نفرض عليها من زيف مصنوع، ينتهى إلى ما قاله عبد الصبور: “.. لا .. لا أملك إلا أن أتكلم يا أهل مدينتنا هذا قولى انفجروا أو موتوا رعبٌ أكبرُ من هذا سوف يجىء لن ينجيَكم أن تعتصموا منهُ بأعالى جبل الصمت.. أو ببطون الغابات لن ينجيَكم أن تختبئوا فى حجراتكمو أو تحت وسائدِكم.. أو فى بالوعات الحمّامات لن ينجيَكم أن تلتصقوا بالجدران إلى أن يصبح كل منكم ظلاً مشبوحاً عانقَ ظلاً لن ينجيَكم أن ترتدُّوا أطفالاً لن ينجيَكم أن تقصر هاماتكمو حتى تلتصقوا بالأرض أو أن تنكمشوا حتى يدخل أحدكمو فى سَمِّ الإبرة لن ينجيَكم أن تضعوا أقنعة القِرَدة لن ينجيَكم أن تندمجوا أو تندغموا حتى تتكون من أجسادكمُ المرتعدة كومةُ قاذورات فانفجروا أو موتوا انفجروا أو موتوا صلاح عبد الصبور (ليلى والمجنون). **** [1] – مجلة سطور: (عدد فبراير – 2005)، كان العنوان الأصلى: “كبت الخوف وتسطيح البشر” [2] – “لا تخف” د.ادوارد سبنركولز، ترجمة: د. أمير بقطر 1949 [3] – سبق أن أشرت كيف تطور فكرى لتجاوز هذه التسمية من “الموقف” أو “الموقف” إلى “الطور” لتساير فكرى الإيقاعحيوى التطورى المستمر انظر هامش رقم (47) [4] – خالدة سعيد، حركية الإبداع عن أنس الحاج، دار العودة بيروت، 1979 [5] – يحيى الرخاوى (كتاب دراسة فى السيكوباثولوجى) عام 1979 [6] – Agoraphobia [7] – Claustrophobia [8] – إريك فروم (الخوف من الحرية) ترجمة عبد المنعم مجاهد، والناشر دار الكلمة [9] – يحيى الرخاوى: (مستويات الحرية والإبداع) (مجلة فصول المجلد الحادى عشر العدد الثانى عام 1992)، ثم فى كتاب حركيى الوجود وتجليات الإبداع، المجلس الأعلى للثقافة 2007 [10] – يحيى الرخاوى: حركية (حرية) العملية الإبداعية تحرر ناتجها (محاضرة فى ندوة الحرية الفكرية فى مصر) ديسمبر 2003 - لجنة الكتاب والنشر ـ المجلس الأعلى للثقافة. [11] – صلاح عبد الصبور: “ليلى والمجنون”، الهيئة المصرية العامة، 1970. -1- أخافُُ همسَ الصمت أخاف من تموّج الأحشاءِ، من نثْـرة الأجنّةْ، من دوْرةِ الدماءِ، ومن حَـفِـيفِ ثْـوبـِىَ الخَـشِـنْ -2- أخافُ من نساِئمِِ الصباحْ من خَـيْـطِ فجرٍ كاذبٍ، أو صَـاِدقٍ من زَحْـفِ ليلٍ صامتٍٍ أو صاخبِ أخافُ من تَـنَـاثُـرِ الذَّرَّاتِِ فى مَـدَارِها أخافُ مِـنْ سَـكوِنَها -3- أخافُُ لاََ حراكْ. … موتٌٌٌ تمطّى فى تجلّط الدماءْ فى مـَأتـَم الإباءْ الخوفُ أَنْ أموتَ إن حييتْ. الخوفُ أن أعيشَ لا أموتْ. -4- يا وِحدتى الشقيةْ، يا وِحدتى الأبيَّة، صَـفَـقْتِ بابَـهمْ خوفاً من المَـودَّة اللعوبْ، من كذبة طليهْ، من مِلحة ذكيهْ، من كُـلَّ شئ ـَّ هـــمَّ أن يكونْ، من كُـلَّ شئ لم يكن، من كل شئٍ كَـانََ.. ما انقضَـى، من كـلَّ شَـئْْ. -5- تفجّر السكونُ فى قوالبِ الجليد، ولم تدوِّ الفـَرْقـَعـَهَ. تحرّكتْ أشلائِـىَ المجمَّده، تفتـَّت الجبلْ، فطارتْْ العَـرَائسْ، تكسّرتْْ حواجزُ الأصواتْ، تخلّقتْ… تطاولتْ، فأُجهِضتْ، وضجّت السكينةْ. ومادتِ الرواسى فى هـُـوة الضّـياع والضَّعة. 23/4/1982 [1] – مجلة سطور: (عدد أبريل – 2005) -1- قالوا يعنى، بحسن نيةْ: “لا تخف” دا مافيش خطرْ طب لماذا؟ هوا يعنى انا مش بشر؟ حِيثْ كده، احنَا نقولَّك: “خافْ وخوِّف”! فيها إيه؟ -2- لو ماخفتش مش حاتعمل أى حاجهَ، فيها تجديد أو مغامرة لو ما خفتش مش حاتاخد يعنى بالكْ، حتى لوْ عاملين مؤامرة لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للبر دُكْهَهْ خايف انْ تْبِلّ شعركْ لو ما خفتش يبقى بتزيـّف مشاعرك -3- بس برضه خللى بالك إوعى خوفكْ يلغى شوفكْ إوعى خوفك يسحبك عنا بعيدْ، جوّا نفسكْ إوعى خوفك يلغى رِقّةْ نبض حسَّكْ إوعى خوفك ان بكره شرّ حامِلْ يمنعك إنـَّـك تحاولْ **** “الخوف” شعر بالعامية المصرية (الجزء الثانى) -1- بس فيه خوف شكل تانى قصدى يعنى الجبن إللى يفضِّـى روحك مالمعانى هوا دا الخوف اللى يمنعنا نعيش تلقى نفسك كتلة جامدة دايرهْ حوالين المَافيشْ – يعنى اخاف ولاّ ما اخافشى؟ = إنت حر – يبقى اخاف بس ما اخافشى!!!!. = هوا دا قصدى، وما تقولِّيش يا سيدى: “يعنى إيه”. – يعنى إيه ؟!!! -2- إحنا بنخاف ان بكره يبقى أخطر، فيها إيه ؟ ما احنا برضه حانبقى أقدر طب ما نتصرف كِويسْ إلنهارده ييجى بكره، يلاقى نفسه: إلنهارده بتاع “غداً” يا حلاوة، تبقى مليان باللـى جَـىّ مقدماً -3- يعنى بكره عمره ما يكون ملكنا إلا باللَى بيجْرَى حالا، أى “هنا” يبقى خوفنا يتقلب كدا رعب ليه؟!!! إحنا خلقة ربنا، يالله نتوكل عليه..! يعنى يالله نخاف وهوّأ معانا يهْـدِى سرّنا مش نخاف منّه وننسى إنه غاية قصدنا ربنا بحق وحقيق، إللى بيورّى “الطريق”
[1] – يحيى الرخاوى: ديوان للأطفال “أغانى مصرية عن الفطرة البشرية للصغار والكبار وبالعكس”، جمعية الطب النفسى التطورى، 2017 أصل الحكاية ومسيرة التطور: الجريمة هى نغمة نشاز فى سيمفونية الفطرة، وتفاقم الجريمة المتصاعد هذه الأيام، وقد دعمته السلطات العملاقة العالمية، العلنية، والسرية، فرادى وجماعات حتى حروب الإذلال والاستعمال والإبادة الجماعية، هو إنذار خطير على مسار التطور. الجريمة ليست هى النشاز الوحيد الذى قد يفسد اللحن الإنسانى تجاوبا مع لحن الطبيعة. إن أى خروج عن السياق الكلى، أو التوجه الجدلى، هو نشاز مختلف الحدة والخطر، فالمرض العشوائى، والقبح النافر، والإنكار غير الإيمانى، والجمود المغترب، هى تشكيلات أخرى من النشاز الذى يفسد اللحن البشرى حتى يكاد ينفيه. الإنسان فى محاولة الحفاظ على مكاسبه وقد احتل مقدمة مسيرة التطور حتى تاريخه، حاول ويحاول أن يتخلص من هذا النشاز أو يفشله أو يحتويه بكل الوسائل المتاحة، حتى لا ترجح كفته فيفسد اللحن حتى التوقف (الانقراض). حين سـَـنَّ الإنسان القوانين مكتوبة، كان قد طبقها قبل أن يكتبها، كان ذلك هو السائد فى مرحلة غلبة الحضارة الشفاهية، ثم كتبها، وبتقدم المدنية (الذى لم يواكب بالضرورة – ولا طول الوقت – تحضر الإنسان)، حلت الكتابة محل الممارسة، وكان ذلك لازما بعد أن كثُرت أعداد الناس فازدحمت الارض بمن عليها، وفى حين تقاربت إمكانيات التواصل بين البشر عبر التكنولوجيا الأحدث، تباعدت المسافات الحقيقية العميقة فيما بينهم، فكان لا مَفَرّ من وضع قواعد وترتيبات لتنظيم العلاقات بين الناس وبعضهم، وبينهم وبين السلطة. هذا هو ما سمى “القانون”، ومن ثمّ تصدر مبدأ الشرعية الذى يقول أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، تصدّر حق تصنيف الجريمة فاختزلها إلى ألفاظ نصّية مثبتة فى أوراق رسمية، لا تتغير إلا ببطء شديد، ليس بالضرورة إلى أحسن. فارتاح المجرمون الأذكى، والأعتى، والأخفى، وراحوا يترصدون لأى نص قانونى جديد، لينقضوا عليه تحايلا، وتخريجا وتأويلا، لصالح استمرار وتطوير جرائمهم المعفاة من العقوبة، ليست لأنها لا تُعَدّ ضمن الجرائم الخطيرة والمؤذية والمهلكة والمبيدة، ولكن لأنهم عرفوا كيف لا ينطبق عليها نص حرفى مكتوب فى كتاب رسمى. محاولات المواجهة وانحراف المسار لم تتوقف الفطرة البشرية عن محاولة تجاوز كل ذلك، فراحت تحرص بتلقائية طبيعتها أن تحافظ على نقائها وبقائها، ربما أسوة بمن تبقى من أحياء قبلها ومعها بدون قانون مكتوب، ولا تجديد نصّى لما هو “شرعية”، فلا إبن آوى كتب قانونه، ولا النوارس، ولا حتى النمل، أو السحالى حددت نصا يبين أبعاد “الشرعية”، فطرتنا البشرية ليست بدعا مختلفا عن فطرة الطبيعة والأحياء، فهى تحرص على أن تواصل عزف اللحن التطورى المتواصل، وأن تتخلص من (أو تحتوى) أى نشاز (وخاصة نشاز الجريمة) مما يمكن أن يعطل لحن المسيرة الأساسى. استلزم ذلك الاستعانة باللحن الأكبر فالأكبر من سيمفونية الكون الأعظم، حيث تفضل رب العالمين على من انتقى من عباده بأن يكلفهم أن يعينوا سائر خلقه على تنقية فطرتهم لتتوجه لما خلقت له، تفضل سبحانه على من اجتهدوا لشحذ طبقات وعيهم حتى استطاعت أن تتلقى رسالة رحمة ربهم، هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان عليهم أن يعينوا سائر الناس الذين حملوا الأمانة دون استعداد كاف، يعينوهم على مواصلة الحفاظ على فطرتهم، لتتوجه إلى ما وعدت به، هكذا أدت الرسالات السماوية وغير السماوية دورها، وعليها أن تواصل أداءه، وكان لزاماً عليها أن تضع حدودا ومواصفات لضمان السعى إليه، من بينها أنها سمت النشاز فى هذا المقام “الحرام” ونهَتْ عن فعله، كما أطلقت الحلال على ما هو غير ذلك كله. ثم حدث للحرام والتحريم أن تولى أغلب أمره الملفظِنون المعقلِنون المغرِضون والغافلون (رؤوف علوان فى حلم سعيد مهران، وقد تولى إدارة تفسير حديث للقرآن الشريف) فراحوا يبتدعون ما يشبه مبدأ الشرعية حتى كاد يصبح أنه “لا حرام ولا رذيلة إلا بنص”، فانتقل مبدأ التحريم من الإسهام فى تنقية الفطرة لترسيخ وتطوير لحنها الأساسى، إلى استعماله سيفا فى يد أى سلطة دينية أو سياسية أو اقتصادية، لترسيخ مكاسبها على حساب أى شىء وكل شىء، وكل حق، وكل عدل، وكل إنسان ضعيف. إذا كنا، فى مسألة التجريم مضطرين، للتسليم مرحليا بسيادة القانون المكتوب، ولا مؤاخذة، فالأمر ليس كذلك تماما فى مسألة التحريم. إنك بمجرد أن تُنبه أن التحريم ليس من حق السطة الدينية الرسمية فحسب، يصوّرونك بلا إبطاء أنك تريد أن تُحل الحرام، حتى تصبح المسائل سائبة فى خدمة الشيطان، ولا يخطر على بالهم أى احتمال فى الاتجاه الآخر، وهو أنك تريد تنمية قانون داخلى/خارجى معا، إن توسيع دائرة التحريم التلقائى حتى تشمل الجرائم الأخطر (غير المحرمة قانونا) مثل: التخلى عن مسؤولية الحياة، وتحيز الإدراك، ومسؤوليه العجز عن الفعل، واللامبالاة، واستغلال البشر فى ظل ألفاظ قانون غبى أو منحاز، وعمى البصيرة استسهالا، ونسيان ما لا ينبغى أن يُـنسى، إن كل هذا الذى لا يندرج تحت لافتة التحريم الرسمى يمكن أن يكون السبيل الأفضل لفهم معنى تجريم ما لا يجرمه القانون. الإبداع نبوة الإنسان المعاصر أستشهدُ كثيرا بتفسير فيلسوف الإسلام “محمد إقبال” لحكمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فقد رأى إقبال أن هذا يعنى أن على كل إنسان أن يتحمل مسئولية وحيه الخاص، ولا ينتظر بعد ذلك وحيا ينزل على نبى جديد. أولياء ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم المبدعون على اتساعهم، ولأنهم ليسوا أنبياء، هم كـُثْـرٌ، وفى كل مجال عبر العاَلم، لكن مجموعهم يقوم بدور الأنبياء المعاصرين، لا من حيث تبليغ الرسالة أو تنظيم الحلال والحرام، وإنما من حيث توسيع الوعى، وتشكيل الجمال ونفى القبيح والنشاز، لتصبح الفطرة البشرية أقدر فأقدر على تمييز الحلال والحرام. انتبه الإبداع بشكل فائق لهذا التباين الشاسع والضار بين المستويين للتحريم والتجريم، بين المستوى الرسمى والحقيقى: بين المكتوب والجارى، بين الحلال بالاستبعاد (ما ليس حراما) والحلال إقبالا: بالعمل، بين المعلن الظاهر وجوهر الجارى، بين ألعاب الكلام، ومحور العدل. لم يتوقف الإبداع عن الإسهام فى كشف كل ذلك، وإن كان لا يملك من أدوات السلطة، ولا من إمكانات الواقع ما يطرح به بديلا، ناهيك عن أن يفرض به نظاما عاما، إلا أن ما يقوم به من إسهام فى تشكيل الوعى، يمكن أن يسمح لنا أن نأمل فى نظام قد يخفف من مضاعفات ما وصلنا إليه، إلى أن نجد قوانين أرقى مكتوبة وغير مكتوبة تحافظ على بقائنا معا، لننطلق بنا إليه. عينات من جهاد الإبداع الأعمال الإبداعية التى تناولت التحريم والتجريم والتأثيم، نقدا وتعرية، ومراجعة هى بلا حصر، رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ تطرح قضايا تتساءل: بأى مقايس نقيس الجريمة الظاهرة والخفية؟ ومن هو المجرم الحقيقى؟ ومن يُنزل العقاب بمن؟ وما هو عقاب السلطة؟ وما هو جحيم الذات،..إلخ؟ نجيب محفوظ فى هذه الرواية أثار وتناول معظم هذه القضايا، وقد أدان المجتمع من ناحية، كما أدان المثقف المزيف من ناحية أخرى، لكنه لم يُعْفِ السرقة الفعلية من المسؤولية. محفوظ عاد فتناول هذه القضية باقتحام إبداعى مرعب فى ليالى ألف ليلة بالذات، كما تناولها بتنويعات مختلفة، فى أغلب أعماله، مثلما أطلت فى أصداء السيرة الذاتية بشكل متباعد، لتظهر أكثر تواترا فى أحلام فترة النقاهة، ديستويفسكى تناول فكرة “التأثيم” باكرا حين قدم التأثيم الذى كان يمارسه بطرس الكسندروفيتش، بكل بلادته وتصنعه ونزواته وغروره، ليغذى شعورا وهميا بالذنب عند زوجته ألكسندرينا، الأمر الذى رصدته الطفلة نيتوتشكا نزفانوفنا([2]) (الفطرة) ورفضته حتى أعلنت ثورتها وكأنها تمثل الضمير القاضى الذى يحاول تأكيد حق الإنسان فى “الحق فى الحب”. الطفولة قادرة على رصد القانون ونقده، وأيضا مناقشة حدود الدين التقليدى والأوصياء عليه، فى رواية إيمانويل شميث أعلنها الطفل موسييه صريحة بعد أن استشار القاموس (لاروس) فى معنى كلمة “صوفى” التى حسبها مرضا أصاب به صديقه مسيو إبراهيم البقال المسلم الذى يشرب الخمر ويعلمه الغش أحيانا، (مسيو إبراهيم وزهور القرآن)([3]) يقول موسييه بعد بحثه عن معنى الكلمة فى معجم “لاروس”: “الصوفية … تعارض حرفية القوانين، وتولى أهمية كبرى للعقيدة الداخلية للدين” ثم: ” ..ومن محاولاتى المستميتة لفهم جميع كلمات هذا التعريف، اتضح فى النهاية أن مسيو إبراهيم بمشروبه الكحولى يؤمن بالله …، ولكن بطريقة يبدو أنها تعتبر من الخارجين على الدين، إلا أن فكرة معارضة القوانين أقلقتنى بعض الشىء، فإذا كانت حرفية المطلوب هى اتباع القوانين بكل دقة كما يقول أصحاب القاموس، فإن لذلك معان مقلقة مؤداها أن مسيو إبراهيم غير شريف، لأنه لا يتبع القانون حرفيا، وأننى بذلك أخالط ناسا لا يجب علىّ مخالتطهم، لكن فى الوقت نفسه إذا كان التزام القانون يعنى أن يصبح المرء مثل والدى وأن يكون عابس الوجه وأن يملأ البيت كآبة، فإنى أفضل أن أعارض حرفية القانون مثل مسيو إبراهيم”. هل يحتاج هذا المقتطف إلى تعليق؟ عودة إلى ديستويفسكى مقارنة باللص والكلاب نجد أن نجيب محفوظ يحاكم المفكر لا الفكرة، ويجّرمه أكثر مِن مَن قام بتنفيذ الفكرة وتفعيلها على أرض الواقع، بما يترتب عليها، فى حين أن ديستويفسكى يحاكم الأفكار ذاتها وينقدها، أبطال “الإخوة كارامازوف” هم فى جانب منهم ضحايا أفكارهم أو أفكار سواهم. القاتل فى “الجريمة والعقاب” يقضى على المرابية مدفوعاً بأفكاره ويذهب إلى السجن ليكفر عنها. والمحقق، حتى المحقق، لا ينبش فقط فى حيثيات المشتبه به وظروفه بل فى أفكاره أيضاً، استطاع دويستويفسكى فى الجريمة والعقاب أن يشعرنا بالجريمة بكل كياننا حتى نكاد نصدق منطقها، لكنه يعود فيحاكمها ولكن بطريقة مختلفة بعد أن قلب وجوهها، وغاص فيها حتى القاع. البطل «راسكولنيكوف» ليس عقلانياً فهو لا يعرف حتى النهاية لماذا لا يجوز ان يقتل المرابية، ونحن معه لا نفهم بالعقل والمنطق حالته الوجدانية ويصعب علينا تقييم عمله لكننا بكل كياننا نشعر وبوضوح بضرورة كل التسلسل الذى أدى إلى هذه الجريمة. فى «الإخوة كارامازوف» تمتد المراجعة إلى ظاهر الدين وباطنه([4])، ومستويات الأخلاق وما بعدها، مما يؤكد لنا مدى محاولة الإبداع لخوض غمار هذا التحدى. كل ما سبق من أمثلة – مجرد أمثلة – ينبهنا أن مبدأ الشرعية، وحدود النص الدينى الذى نعتز بهما، ولاينبغى أن نفرط فيهما، هو مبدأ قاصر، ومحدود، وملتبس فى آن، وفى نفس الوقت يظهر لنا علاقات متشابكة بين التجريم والتحريم، وأيضا هو يشير إلى احتمال تجاوزهما إلى ما يشوه الفطرة أو ينحرف بها إذا نحن اكتفينا بالحدود المعلنة، أو تحايلنا عليها. التحريم والتأثيم لا يوجد دين لا يرسم حدودا للحرام (دع جانبا الحلال فهو كل ما ليس حراما، هكذا يقولون)، وإلا ضاعت معالمه وتفككت قواعده، لكن المسألة تتعقد بمجرد أن تتوالاها سلطة دينية عاجزة عن التعمق والتطور إذ تروح تمسك سيف التحريم المنصوص عليه ألفاظا وتتوقف عنده تماما، وكأنه وحده هو الدين لا أكثر ولا أقل، ثم إنها تتجاوز التحريم إلى التأثيم المستدام (الإشعار بالذنب طول الوقت). يتم ذلك من خلال المبالغة فى التحريم على أساس دينى، او اجتماعى، أو تراثى أو غير ذلك، مما يكاد يجعل الشعور بالذنب مبررا للوجود كما تناوله سارتر فى”الذباب”([5]). أنظر حولك الآن لترى التطورات التى يمر بها مجتمعنا لعلك تتبين قدر ما يصل الناس من تأثيم (أكثر منه تحريما) طول الوقت، من أول تحريم لبس معين (حتى تجريمه متى استطاعوا) إلى الترهيب والإرهاب بكل تلك الأقاويل عن عذاب القبر وكل أنواع التعذيب المنتظرة للأطفال قبل الكبار. النتيجة هى أن عملية التأثيم تحل محل التحريم، حتى تكاد تصبح الحياة نفسها إثما يستحسن أن نستغفر الله لارتكاب ذنب الاستمرار فيها، نفعل ذلك حتى لو ادعينا عكسه، حتى خطاب الرحمة والعفو والغفران عادة ما يبدأ بالتأثيم بشكل متضخم ومرعب، بحيث تتضاءل معه مساحة وفاعلية الرحمة مهما اتسعت وشملت. كلما امتد النص ضاقت حركية الإبداع سوف أكتفى هنا بمثال واضح من واقع مهنتى أدلل به على ما يجرى من ابتداع نصوص قانونية محكمة، لا تخدم فى نهاية النهاية إلا تراكم المال الغبى عند قلة مغتربة، ذلك أنه يتم حرمان المرضى من حقهم فى العلاج الممكن، وأيضا حرمان الأطباء من حركتهم الفنية الإبداعية لمساعدة مرضاهم ، وذلك بتوالى إصدار قوانين وقواعد ملزمة، على حساب سحب الثقة الأساسية بين المريض والطبيب، حدث هذا فى الخارج تحت شعارات كثيرة من أول الاقتصار على حقوق الإنسان المكتوبة إلى ما يسمونه لوائح تنظيم المهنة لصالح المرضى، النتيجة أن زميلنا الطبيب هناك يشعر أنه “مدير آلة الطب”، وليس طبيبا، وذلك بعد أن حرمه القانون من أى حركة “خارج النص” (ولو كانت لصالح مريضه بما فى ذلك إنقاذ حياته) يفعل الطبيب ذلك وهو يقوم بدوره مختنقا خوفا من أن يخرج عن المكتوب، فيرتكب جريمة تلزمه بالتعويض إن لم يكن بما هو أكبر. أصبح الطبيب هناك – كما سيحدث هنا – يمضى أكثر وقته فيما يسمى “أعمال الورقPaper work بدلا من أن يمضيه فى أعمال التطبيب وفن اللأم، وذلك ليحمى نفسه أولا، ثم إن الملاحظات العلمية والفنية المسجلة فى أوراق المرضى قد تضاءلت لأقل من 10%، بعد أن أصبح من حق المريض ومحاميه أن يحصلوا على الملف الأصلى للمريض فى أى وقت ولو بعد سنوات، فتراجع الأطباء عن تسجيل أية ملاحظات جادة، أو حتى علمية قد تفيد مستقبلا، واكتفوا بالملاحظات الشكلية الروتينية، خوفا من أن يتصيد محام شاطر ملاحظة غامضة هنا أو هناك تجرّم الطبيب بالسلامة!! القانون غير المكتوب مُلزم أكثر من موقع شخصى، توقفتُ عن المشاركة فى الامتحانات بكل مستوياتها، من طلبة البكالوريس حتى درجة الدكتوراة، ذلك لأننى مع وبعد كل امتحان، كنت أصاب بأرق وغم مزعجين، كنت أشعر أننى قاض فاشل، وأن الله سيحاكمنى على جريمة أنى أجيز طالبا لمجرد أنه أتقن الانحناء تحت سقف نصوص أنا أعرف لماذا تقزمت وكيف أحُكمت، حتى التشخيصات الإكلينيكية اصبحت محددة بقائمة من الأمراض والتفاصيل دون ربط ذلك بتنويعات العلاج واحتمالات استخدامه، كل هذا يـُـسـَـخـَّـرُ لخدمة أغراض تجارية وقانونية تأمينية وتعويضية على حساب المريض والعلاج. ليس معنى أنى اعتذرت عن عدم المشاركة فى الامتحانات أننى توقفت عن التدريس على كل المستويات، لكننى لجأت إلى وسيلة طريفة لأبين للدارسين على مختلف مستوياتهم أن هناك قانونا آخر، غير المكتوب، لا بد أن يحاسبوا أنفسهم به، وهو الذى سوف يحاسبهم ربهم به، قانون حمل المسؤولية ونفع الناس حقيقة وفعلا، قانوناً نطبقه ونحن نستعمل مقاييس ثقافية محلية محددة، وعلمية منطقية مؤكده. أدت هذه الخبرة إلى أننا كنا ننتهى من عرض الحالة أثناء الدرس، لنتساءل: ما هو التشخيص الذى ينبغى أن نقوله لننجح فى الامتحان، وما هو التوصيف الذى سنقوله لربنا حين نلقاه ويسألنا عن الوقت، والجهد، والمقابل، والمنطق الذى تعاملنا به مع المريض لصالح صحته؟ بدت المسألة فى أول الأمر أشبه بطـُـرفة، لكن بالإصرار ومواصلة المحاولة والتصحيح، استطعنا أن نتبين معا كيف أن تقديس نص “دليل علمى” (هكذا اسمه بالضرورة) موصى عليه سرا من شركات الدواء، قد يكون فى النهاية – شعوريا أو لا شعوريا – جريمة تخدم شركات الدواء على حساب المرضى. بالغتْ شركات الاستغلال أيضا فى زعم الإعلاء من قيمة وتكاليف الأبحاث التى تقوم بها لصالح مكاسبها وليس لصالح المرضى، من أول الأبحاث التى تبالغ فى الأعراض الجانبية للأدوية التقليدية الرخيصة، حتى الأبحاث التى تتبنى نظريات وفروضا كيميائية ميكانيكية مختزلة، فيقفز ثمن عقار من عشرة جنيهات إلى عقار آخر يعمل عمله لكن ثمنه هو ثمانمائة (800 جنيه إلى ثلاثة آلاف) فقط لا غير، ولا يأتى العقار الجديد بنفس النتيجة أو قد يأتى بنفس النتيجة مع فارق السعر، والطبيب الذى يساهم فى هذا التوجه يشارك فى جريمة ليست مُجَرّمة، وقس على ذلك حين يتم التخويف من مخاطر الأجهزة القديمة الناجحة لدرجة تجريم استعمالها، ليقفز ثمن الجهاز، “القانونى” الأحدث – باتفاق بين الشركات وبعضها – إلى ما يدور حول المائة ألف جنيه، فى حين أن ثمن مكوناته لا تزيد عن مائتى جنيه مثلا. هذه الجرائم المبرأة من العقاب، والتى تسهلها وتبررها نصوص قانونية تحت مزاعم شبه علمية هى أخطر وأبشع من جريمة فردية تقع تحت طائلة القانون. أصول مستويات المحاسبة إذا سمح لك القانون بحدود معينة تتحرك داخلها وترضى بها، أو تضطر إلى الالتزام بمداها، فعليك أن تعرف أنها ليست هى غاية الحدود التى عليك أن تقف عندها، أمام نفسك، وأمام ربك، الآن، أو فيما بعد، إن أردت أن تغامر باستلهام النص مباشرة، فثمة آيات بينات كثيرة تعلن بوضوح أن المسألة ليست هى كما تظهرها نصوص القوانين أو الأحكام الشرعية الرسمية. إن حسابك الحقيقى (كما قال الشيخ الجنيدى فى اللص والكلاب) هو حسابك لنفسك، وأمام الله، وليس بالمادة كذا من القانون الفلانى، أو الفقرة كيت، من المرجع العلانى، حتى لو كان هذا المرجع هو تفسير التفاسير، أو فتوى الرسميين. اكتشفت شخصيا أن ثمة مستويات ثلاثة عليك أن تتذكرها، هى موجودة فى معظم الأديان غالبا، لكننى أستشهد بدينى الذى أتعرف عليه مجددا وباستمرار. (طبعا يوجد غيرها لكننى أكتفى بها)، هاك مجرد عناوينها: 1) “إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا”. “وكلهم آتيه يوم القيامة فردا” أنت قاضى نفسك، ليس لك محام يتلاعب بالحجج والإجراءات ، ثم إن المحامين سوف يكونون مشغولين بقضاياهم الخاصة “لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ” . 2) “بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره” ولن يعفيك أن يكون عندك عذر قانونى أو تفسيرى (لنص مقدس)، فكل التفاسير قد تكون من باب المعاذير التى إذا ألقيتها لتخفى جريمتك الحقيقية، فستـُلقى فى وجهك أمام الله، بل ستكشفها بصيرتك أنت بنفسك. 3) “ِاذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا ..” إن الذين أفتوْا لك أية فتوى، (أكرر أية فتوى دينية أو علمية) بالتجريم أو التحريم، لهم الحق أن يتبرؤوا منك إن كنت قد اتبعتهم دون إعمال رأى، أو تحمل مسؤولية. الورطة والبداية الفردية لأول وهلة، تبدو المسألة كما أوضحناها هنا حتى الآن، أنها قد تسيبت حين يصبح كل واحد قاضى نفسه، فتسيح الأمور، ولا يكسب فى هذه الحال إلا الأخبث والأقوى، هذا تنبيه طيب وحقيقى، ومع ذلك فلا مفر من التمسك – ولو من حيث المبدأ – بكل ما جاء فى المقال. قد نُضطر ونحن نحسبها بالعقل والممكن أن نكتفى مرحليا بالتجريم الرسمى، والتحريم السلطوى التفسيرى الاحتكارى، هذا على المستوى العام، الذى لا بد سوف يتغير ويجد حلولا أقدر وأعدل مع تطور الوعى البشرى أفرادا فجماعات، لكن هذا لا يعفى أى واحد منا من مسئوليته الفردية المطلقة، هى مسؤولية كل واحد على حدة، خاصة وأننا لن نحاسَب (هنا أو هناك) جماعات، أو دولا أو جنسيات، أو بالتوكيل الجماعى الرسمى فى الشهر العقارى، وإنما الحياة بالنسبة لكل منا فى البداية والنهاية هى مسئولية كل واحد فرض عين. ما العمل؟ لنتذكر أولا أن النمل والنحل والسحالى والقردة لم ينقرضوا بعد، برغم أننا نزعم أننا تطورنا منهم. لا بد أن سبب بقائهم، هو تنظيم لمسألتى التجريم والتحريم بغير قانون مكتوب، أليس كذلك؟ وما دمنا نزعم أننا أرقى منهم – والله أعلم – فلا بد ونحن ننظم حياتنا بما هو مكتوب، أن نتحمل مسئولية ما هو ليس مكتوبا، هذه واحدة، الثانية – حتى لو كررنا – هى مسألة أن علينا أن نتذكر طول الوقت أن تنظيم الدولة شىء، وتنظيم الذات شىء آخر، صحيح أنه إذا كان نظام دولة ما هو أقرب إلى العدل، وأحرص على تنمية الفطرة، بالإبداع والاختلاف والجدل، فإن ذلك سوف يسهل مهمة كل منا أن يكتشف فطرته، وأن يحافظ عليها فى مواجهة أى تشويه أو ترهيب أو فتوى أو تبرير، لكن: حتى وإن افتقر نظام الدولة إلى هذين البعدين: العدل، و فرص تنمية الفطرة، فعلى كل واحد أن يجتهد فى موقعه، لأنه سيحاسب نفسه الآن، وغدا إذ يلقاه، فردا، بلا معاذير، ولا محام، وسوف يتخلى عنه من أفتى له مهما بلغت مرتبته، فقد لا يكون إلا “رؤوف علوان” فى عالم “سعيد مهران”. محكات ليست مثالية هل ثم محكات لتقييم المحاسبة الذاتية، وقياس الفطرة النقية؟ طبعا توجد محكات ومقاييس، لا يتسع لها هذا المقام ولا هذا المقال، وسوف أكتفى بمجرد تعداد علامات قد تبدو مثالية، وهى أبعد ما تكون عن ذلك، وهذا بعض عناوين ما خطر لى: نفع الناس وحساب النفس: والمنطق السليم ، ثم المنطق الخاص، ثم كلاهما، والجدل بينهما، والحفاظ على القدرة على الدهشة، والتمتع بالجمال، والقدرة على تجميل القبيح، والحركة المتجددة، وإعادة التشكيل ما أمكن ذلك (الإبداع)، والتواجد مع “آخر” حقيقى، والقدرة على تركه لتعود إليه، أو لا تعود، والبدء من جديد مهما كان الزمن أو تعملق الخطأ، والعدل حتى لو بدا مستحيلا، وحمل هم الناس (ناسك وغير ناسك) حتى آخر الدنيا، وآخر الزمان (دون نعابة أو بطولة)، والنوم الجميل مع كل أنواع الأحلام الممكنة، والجنس الحوار التكاملى، بلا عجز أو استعمال أو توقف، والفرحة بالنفس آخر النهار، وأول الليل، ثم أول النهار، وآخر الليل، والألم الحقيقى لك ولهم دون محو الفرحة ومعها. هذا يكفى حاليا، والحق سبحانه وتعالى هو المستعان على ما يصفون. **** [1] – مجلة سطور: (عدد مارس 2006) [2] – يحيى الرخاوى:”التفسير الأدبى للنفس: نيتوتشكا نزفانوفنا، وهامش من “البطل الصغير” ديستويفسكى. مجلة الإنسان والتطور الفصلية عدد اكتوبر سنة 1982 ص 71-137، ثم فى “تبادل الأقنعة: سيكولوجية النقد“، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2006 [3] – إريك إيمانويل شميت “مسيو إبراهيم وزهور القرآن” 2001 ترجمة محمد سلماوى 2005 دار الشروق [4] يحيى الرخاوى: “من استحالة الإلحاد إلى تناسق الإيمان الواعد” فى الإخوة كارامازوف: ندوة جمعية دار المقطم للصحة النفسية مايو 1991،” تبادل الأقنعة: سيكولوجية النقد”، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2006 [5] – تناول الكاتب “إشكالة الشعور بالذنب” فى دراسة مطولة الإنسان والتطور عدد ابريل – سبتمبر1988: الموسوعة النفسية “ذنب”. “يا عبد، عذرتُ من أجهلتُه بالجهل، مكرتُ بمن أجهلتُه بالعلم” (“النفـّـرى: مخاطبة 9) أمرٌ بالكتابة رعبٌ حقيقىٌّ، بفرحة! ! حين طلبت منى صاحبة الفضل رئيسة التحرير أن اشارك فى هذا الملف، (سعيا إلى الله) كدت أعتذر، لكن الإبن الشاعر الكريم نائبها تناول الهاتف، ذاكرا كيف أننى ما انشغلت خلال نصف قرن بأكثر من انشغالى بهذه المسألة بشكل أو بآخر. كيف عرف؟ أحسست أن أحدهم قد خلع عنى ردائى دون إذن، وصلنى الطلب من جديد أمرا كريما، فـفـرٍحْتُ فزِعا. تذكرت أمرا قديما بالكتابة أنار لى بعض ما هو واجب لحمل الأمانة. و“قال له”: ” أكتب من أنت، لتعرف من أنت، فإن لم تعرفْ من أنتَ، فما أنت من أهل معرفتى” (النفّرى: موقف الأمر) وصلنى أنه أمرٌ لى شخصيا، ثم ها هو يتجدد الآن، من عرف نفسه أدخله سبحانه بين أهل معرفته، فعـَـرَفَه. استجبت آنذاك([2]) بما عدّلت بعضه الآن هكذا : “.. أمرك مطاع، مع أننى لا أفهمه ولا أريده، ..حذّرتَنَا من قبلُ من الكتابة والحساب، ففهمتُ حتى خـِفتُ من الـرموز والتراكمْ. رُعبتُ من الحرْف والقوليةْ، فلماذا الكتابة ؟ وكيف؟ لكنه أمرك. كتبتها (نـّفسِـى) على قدر علمى، ثم قرأتها، فعرفتُ لماذا َ أمرتَنى بكتابتها. قلتُ لها، (لى) … إن كانت منفصلة عنك، فلا حاجة بى إليها، وإن كانت بديلة، أو تجرأتْ فتجاوزت الوسيلة، فهى ليست الطريق إليك، أنتّ الذى كتبتنى، كتبتَها، فلمَ عدت تأمرنى أن أكتبها؟ لعلك تأمرنى أن أقرأ كيف كتّبْتّنى، لعلّك تُفهمُنى أنَّ علىّ أن أشكِّلُنِى بعد ما كتبتنى أنتَ فطرة واعدة، ها أنذا أكتبنى من جديد، فى حين أننى لا أكتب، بل أقرأ كيف كتبتنى، كل ما علىّ هو أن أحافظ عليها، لِـما تعد به. فهل تسمح لى أن أكون من أهل معرفتك؟ “ماذا آل إليه حال الدين” كتبت مرارا مبينا كيف فشل تهميش الدين أو إلغاؤه أو اختزاله (الفرض؟! فى هذا العمل)، ثم صار أغلب ما تبقى منه ليس هو، السلطات بأنواعها عبر التاريخ (بما فى ذلك السلطة الدينية، بل: وخاصة السلطة الدينية) لم تكف عن محاولات الاستيلاء على الدين لما ليس هو، لما ليس له، وذلك: بالفصم، والاحتكار، والإحلال، والتشويه، والتقزيم، والاستعمال من الظاهر لعكس ما أراد، كاد الأمر ينتهى إلى أن تكون مهمة هذه السلطات هى أن يعيدوا صياغة الدين بما يحول بيننا وبين الطريق إليه، سبحانه، فانعكست وظيفة الدين. الطريق إلى الله لنلاقيه هو طريق كدح معرفىّ بالغ الجدية يليق بتتويج رحلة الأحياء التى يقف على رأسها هذا الكائن الذى اسمه “الإنسان” بكل نبله، وغروره، وإبداعه، وغبائه، بعد التورط فى اكتساب الوعى، ثم الوعى بالوعى، أصبح الطريق إلى الله فى حاجة إلى إقدام يبرر المخاطرة التى يتوارى معها كل ما شاع من دعوات التخدير والطمأنينة السهلة المسطحة، تلك الدعوات التى يروّجون بها الدين الخفيف مثلما يسوقون حبوب التهدئة، فلا يحققون إلا البُعد عن الله بالاسترخاء العقلى، وطمس الوعى، مع التراوح بين التأثيم والتأجيل والتواكل، كل ذلك أصبح حائلا – ناعما أو شائكا– بين العبد وربه، الطريق إلى الله هو الطريق إلى المعرفة، الطريق إلى الله يحتاج كل وسائل الحركة فى النفس إلى الكون، إليه تعالى، وبالعكس، وباستمرار، العقل – كما شاع عنه – هو مجرد أحد المطايا إلى ذلك، وهو أكثرها عرضة للخلل والانحراف، الطريق إلى الله له بداية منذ أن نولد، لكنه ليس له نهاية، حتى بالموت. كلما “عرف” الإنسان أكثر، اقترب منه أكثر، ليكدح إليه كدحا لا ينتهى، كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، الرعب الذى يغشى الساعى فى هذا الطريق هو فـزع من دهشة البهْـر، هو إعلان يبين حجم مسؤولية حمل الأمانة التى تصدّيْـنا لحملها عندما عرضها سبحانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، تلك الأمانة التى إن لم نحملها بحقها، فلسنا إلا كما نبَّه ربنا المتقاعسَ منا: فكان “ظلوما جهولا”. حين يدرك الذى غامر ليحملها بحقها مدى ثقلها، يتمنى – من هول المسؤولية – أن يتراجع، ألاّ يكون ما حدث هو ما حدث. لكنه، و بنفس القدر، يتمنى ألا تتحقق أمنيته. سجّلتُ مثل هذا الموقف الصعب يوما: “يا ليتنى طفوتُ دون وزنِ، يا ليتنى عبرتُ نهر الحزنِ، من غير أن يبتل طرْفى فَـرَقَا. يا ليت ليلى ما انجلى، ولا عرفتُ شفرة الرموز والأجنّةْ. …. إِى، هجرة الطيورْ فى الشاطئ المهجورْ: عفوا فعلتُها. … فكَ القيودَ صـلّت السلاسلْ طارت يمامةٌ من الخمائل العمرُ بعد ما انقضى !!! العمرُ بعدُ ما بدا. …. أشلاؤُها تفجَّرتْ مضيئةْ، نرى ندورُ ننكفئ.ْ …تناثرتْ، تخلّقتْ، تحدّتْ وماتتْ التمائمْ … يا هوْلـَـهُ الصراخ دون صوتْ يا رُعبها ولادةٌ كموتْ يا حظَّ من لم يحمل الأمانةْ، يا ويل من صاحَبَهَا فى خدرها أو عاش ملتفـًّا بها، وحولها …. … يا مِقودَ الزمان لا تُطلقـْـنى ثقيلةٌ ومرعبهْ،: قولةٌُ: “كـُـنْ”. لو “كان”: بِتُّ بائسا، لو “كان”: طِرتُ نوْرسا، لو كان دُرتُ حول نفسى جذَلا . السعى إليه لا يكون إلا بالسعى إليه، والعقل أحد السبل إلى ذلك شريطة ألا يقتصر مفهومه على تلك القلنسوة اللامعة المصنوعة تماما من الرموز والأبجديات الساكنة، “العقل القلنسوة” لا يمكن أن يُثبت وجود الله، لكنه وبنفس منطقه الخائب، لا يمكنه أن ينفيَه. نحن نحتاج إلى إعادة التعرف على مفاهيم كثيرة شاع استعمالها قاصرة بعد أن تجمدت فلم تعد كما وعدتْ، وفى مقدمة ذلك: العقل، والوعى، والعلم، والواقع. الوعى والعقل فى كتابه عن “الطريق لفهم الوعى” والمسمى “أنواع العقول”([3]) تناول دانيال دينيت تصنيف العقول ومراحل تطورها باعتبارها مراحل فطبقات من الوعى، منذ ما قبل الإنسان. هذه الأنواع من العقول هى مستويات وجود متصاعدة تم برمجتها بذكاء فطرى حافظ على بقاء كل نوع إلى مداه. العلوم النفسية الأحدث لا تتناول ما هو “وعى” بما ينبغى من جدية ومثابرة. علم السلوك ينفيه أو يهمشه، والتحليل النفسى التقليدى يضعه قشرة شعورية فوق، وحوْلَ، مجهولٍ غامض مراوغ اسمه “اللاشعور”، والطب النفسى التقليدى والعلوم العصبية تختزله إلى وظيفة لجهاز عصبى شبكى صاعد، يقوم بوظائف الانتباه واليقظة وما إلى ذلك. الوعى غير كل ذلك، مع أنه يشمل كل ذلك. مستويات هذه البرامج الحيوية ترتبت هيراركيا بطريقة شديدة الإحكام ترجع عادة إلى تاريخ حيوى أقدم كثيرا من ظهور الإنسان، ثم اشتملها الإنسان لتحمل تاريخه ليتكامل. الوعى المشتمِل هو أداة السعى إليه، وفى نفس الوقت هو هدف السعى الذى لا يتوقف، هو “عملية” حركية جُماع العقول التشكيلية الكلية الهيراركية المتناغمة الفاعلة الذكية. لا يجوز، والأمر كذلك، أن يحل العقل الظاهر أو الشعور (الفرويدى) محله بحال. واقع، وواقع، وواقعْ… فى نفس الوقت، أدى الرعب من الخرافة إلى إنكار الغيب برمته، مع أن الغيب هو واقع آخر. احتكَر الواقع الظاهر كَّل ما يسمى الواقع، فاحتل أرضا هى أرحب بكثير من أن يشغلها، هذا الواقع الملموس أزاح كل واقع آخر سواء بالداخل أم بالخارج، سواء أمكن رصده أو رصد آثاره أم اقتصر الأمر على استشرافه فالإيمان به يقينا من خلال إيقاع الحركية إليه. بداية الطريق هى الإقرار بأن الواقع هو واقع وواقع وواقع، وكثير، تماما كما أن الوعى هو وعى ووعى ووعى ، وكثير، إليه واحدا أحد. قبول التحدّى المعرفة الشاملة، والاجتهادات المنهجية، والإبداع المغامر، لا يمكن أن يتوقف أى من ذلك عند مرحلة متوسطة مهما بدا أن لها ما يبررها، لهذا يتحرك النقد العلمى الأحدث، وتتنشط المراجعات المنهجية، لتتولد علوم جديدة، تسد النقص وتتجاوز الوقفة، وتحول دون اختزال الإنسان إلى عقله أو إلى وعيه الظاهر أو إلى علمه المحكم المنغلق على معلوماته. حركية هذه المواجهة تحول دون فصل الإنسان عن تاريخه من جهة، وعن الكون من جهة أخرى، هذا هو ما سمح للعلوم الجديدة أن تكشف عن نفسها: مثل العلم المعرفى، وعلوم الشواش والتركيبية. حضَـَرنا العلم المعرفى مؤخرا باعتباره منهجا بديلا فى مواجهة الخرافة من ناحية، ومواجهة ديانات العلم المصنوعة، وديانات التعقلن المغلق من ناحية أخرى، فضلا عن مواجهة جمود السلطة الدينية واحتكارها لحق التفكير تحت زعم التفسير. تمادت كل من هذه المنظومات فى تكفير بعضها البعض، حتى ظهر هذا “العلم/المنهج” وهو يكشف عن نفسه ليعلن أنه إذا كان لهذا اللمعان والاستقلال والسيطرة والاحتكار التى تمنظرت بها كل منظومة من هذه المنظومات ما يبررها حين ظهورها، فإنه آن الأوان لإيقاف هذا التمادى حتى لا نبتعد عن أنفسنا أكثر، فنبتعد عن الله. جمّاع الوعى الفطرى العام، عبر العالم، عبر التاريخ، لم يتنازل عن أىٍّ من قنوات المعرفة التى حافظتْ على علاقات الإنسان الخفية بتاريخه الأسطورى، والدينى، ومن ثمَ: التوجه الكونى، والغيب، وإن كانت المبالغة والتسرع العشوائى فى هذا الاتجاه قد أديا إلى ظلمة مستنقعات الخرافة أحيانا كثيرة. هرطقات جديدة بدلا من أن تواكب السلطات الدينية وعلماؤها هذه التحولات الثورية فى المنهج والعلم والمعرفة، توقفت عند ما تصورتْـهُ نهاية المطاف لما يسمى “العلم” أو “العقل” كما يشاع عنهما وليس كما تطورّا مؤخرا. لم تعرف هذه المراجع الدينية، أن كثيرا مما تبقى تحت الشائع من هذه المسميات انتهى إلى أن يكون مؤسسات مقدسة جاهزة جامدة لا تقبل جديدا، حتى أنها راحت تتهم هذا العلم المعرفى بالهرطقة، تماما مثلما فعلت كنيسة العصور الوسطى معها (مع تلك العلوم التقليدية) آنذك، كانت: الهرطقة الأولى للعلم المعرفى هى موقفه ضد الكنيسة الحاسوبية العظم : حين أعلن أن التفكير ليس فقط بالرموز، أما الهرطقة الثانية: فحين أعلن أن المعرفة ليست فقط فى المخ أو بالمخ مهدِّدا بذلك كهنة معبد المخ البشرى. هذه الصدمة المنهجية المعرفية ليست أقل صدْما من عديد من الصدمات المعرفية عبر التاريخ مثل صدمة دوران الأرض والشمس (كوبرنيكس). يحدث ذلك فى الوقت الذى تـُواصل فيه السلطات الدينية التقليدية التمسح بهذه الأديان (العلمية التقليدية) الموضوعة التى تجمدت فى عقرها، أهل السلطة الدينية لم ينتبهوا أنهم باستشهادهم بعطايا هذه الأديان (العملية) المصنوعة، وتمسّحهم بمعلوماتها، ينفون حركية الديانات الأصل، وبالتالى يحُـولون دون مسيرتها وحفزها للوعى البشرى أن يواصل سعيه إلى وجه الله سبحانه وتعالى. النتيجة أنه تم تحالف خفى بين السلطة الدينية التقليدية، والسلطة المنهجية المعقلنة المتوقفة عن التطور، على حساب التطور البشرى، والحركية الإبداعية الولافية نحو التناغم مع الكون إلى وجه الحق سبحانه. استمرار المواجهة كل ذلك زاد من مسئولية النقد الأحدث والمواجهة المنهجية فى اتجاه إعلان وتأكيد وإثبات أن للمعرفة مناهل متعددة، وقنوات ومستويات متوازية، ومتكاملة فى آن، وأنه لا ينبغى أن تحتكر إحدى هذه القنوات حق المعرفة، وأنه على “الأحدث” ألا يلغى “الأقدم”. بل عليه أن يحتويه ويتكامل به، ظلت الأحياء تتعرف على المحيط حولها، وتنظم وتطور قوانين بقائها، وتنجح، قبل أن يكون ثَـمَّ عقل مثل هذا الذى توّج مسيرة الإنسان، ثم أحكم قبضته عليها دون غيره، وقبل أن يكون ثَـمَّ علم مثل هذا الذى انتفخ مؤخرا حتى كاد ينفجر فى محله. كلُّ الأحياء كان لها وعيها الخاص الذى تتعرف به على المحيط (فالكون- ربما) قبل ظهور المخ عضوا رئيسا متميزا، وقبل اكتساب ثروة الرموز المتنوعة. لا أحد يستطيع أن يجزم أنْ ليس للاحياء الأدنى من الإنسان نزوعا إيمانيا معينا. لولا الخوف من فهم استشهاداتى لغير ما أريد، لكنت أوردت من القرآن الكريم نصوصا بلا حصر لدعم ما أقول مما ورد فيه عن الطير والجبال وكافة ما بين السماء والأرض وهى تشارك فى عزف هذه الهارمونية الكونية بما يسمى باللغة الدينية: تسبيحا!!. تكامل قنوات ومناهج المعرفة علينا أن نقر أن مفهوم العلم قد تطور بقدر اتساع مناهجه. العلم لم يعد قاصرا على ما يَثبتُ بالتجربة وما يدعم بالمقارنة، وما يمكن إعادته فيأتى بنفس النتيجة، كما اتسع مفهوم التفكير حتى تبين أن أغلبه يجرى بعيداً عن الوعى الظاهر، كذلك استعاد الوعى موقعه المحورى فى الوجود البشرى، فلم يعد مجرد وساد للوظائف المعرفية المحددة، بل أصبح مشاركا فعالا فى عمليات المعرفة المختلفة، ثم إن الجسد عاد ليأخذ موقعه كمساهم إيجابى فى حركية المعرفة أيضا بصفة عامة([4]) كل ذلك بفضل الإنجازات الأحدث فى المنهج والتقنيات التى أتاحت ظهور علوم جديدة مثل العلم المعرفى وعلوم الشواش والتركيبية كما أشرنا . “وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“([5]) يقرأ بعض الطيبين هذه الآية الكريمة باعتبارها دعما لالتماس رحمة ربنا ورضوانه عن طريق التبرك بالأولياء والدعاء فى رحابهم، وتوسيطهم للشفاعة مثلا، أو عن طريق اتباع مشايخهم، كل فى طريقته. ليكن، لكن إذا قرأنا هذه الآية الكريمة كدعوة لطرق كل أبواب المعرفة حتى نسلك كل دروبها المتاحة بما يوصلنا إليه، إذن لهـُـدينا إلى صراط مستقيم مفتوح النهاية. لم يعد مناسبا أن تُختزل ظاهرة مثل ظاهرة الإيمان والدين، ناهيك عن السعى إلى الله، إلى ما نتناولها به مما يسميه أغلبنا عقلا فى حدود ماشاع. حين يفخر الفقهاء حسنو النية بأن “الإسلام (أو أى دين) هو دين العقل” (مثلا) لا ينتبهون إلى أنهم بذلك يقزّمون الإسلام (أو أى دين) فى حدود العقل كما يعرفونه، وحين يقولون إن النص الإلهى لا يفسَّر إلا من خلال تعريف ألفاظ المعاجم للمعانى التى كانت حين نزوله، يحبسون رسائل الله داخل صفحات المعاجم فى لحظة تاريخية معينة، مع أن لغة النص المقدس قادرة أن تنزّل وحيا حافزا جديدا على عباده طول الوقت من يوم نزولها إلى يوم القيامة، لكنهم بما يفعلون يحبسونها فى أصنام ألفاظ المعاجم الساكنة، بدلا من أن يطلقوها فى رحاب حركية لغةٍ تتطور كل يوم لتنبض بالحركة إليه. هم يتحدثون عن الثوابت بجمود مطلق مع أن الدين الثابت ليس دينا، وإلا فلماذا الكدح؟ كما أن العلم الثابت ليس علما، وإلا فلماذا البحث؟ إن إثراء الدين وحركيته لا يعنى تبديله، ولا اختراع دين جديد. إن الثابت بالضرورة بفرمان سلطوى، لا بد أن يخنق الحركية الساعية إليه لتتحرر به، والتى بغيرها لا يكون الكدح كدحا. انتبه بعض الطيبين من العلماء والمتدينين إلى هذا المنزلق فقللوا من حماسهم وفخرهم بأن الإسلام – أو أى دين – هو دين العقل، ثم اتجهوا إلى الناحية الأخرى يفترضون أن ما هو دين أو إيمان هو مسألة عاطفية خاصة، لها وظيفتها الرقيقة المكِّملة للعقل لمن شاء أن يمارسها بعض الوقت، فتم بذلك تهميش الدين واختزال دوره إلى اختيار شخصى عاطفى رقيق، يُستعمل من الظاهر، بعض الوقت، كلما احتاج صاحبه إليه. هذا الفريق بدوره اقترف خطأ أدى إلى نفس النتيجة من طريق آخر، وهى توقف السعى كدحا متصلا إليه، فضلا عن تهميش الدين حسب الظروف تحت الطلب. افتراضات أساسية بأية آلية معرفية من بين كل ما أشرنا، يمكننا أن نتعرف على الله ونحن نسعى إليه كدحا لنلاقيه؟ بالتفكير؟ بالعقل؟ بالمنطق؟ بالإدراك؟ بالفهم؟ بالوعى؟ وأى دفع يدفعنا إلى ذلك؟ العاطفة؟ الخوف؟ الضعف ؟ الكسل العقلى؟ التبعية؟ الاستسهال؟ دع الدوافع جانبا الآن لأنها ليست موضوعنا اليوم. ابتداءً، ينبغى التنبيه إلى أن السعى إلى المعرفة هو طريق بلا نهاية، وأن السعى إلى الحقيقة هو الحقيقة الممكنة، وأن السعى إلى الله سبحانه وتعالى كدحا لنلاقيه، هو غاية ما يستطيعه بشر. من خلال هذه الخطوط العريضة نكتفى بالتنبيه إلى بعض الافتراضات الأساسية التى تتيح لنا فرصا أكبر فى مساحة أرحب، للسعى نحو وجهه تعالى، ومن ذلك: إنه سبحانه يُدرك ولا يـُـفهم، يُدرك بالحواس كلها (وبدونها وبغيرها)، وأنه لا يمكن الإحاطة به أو حتى ببعض جوانبه بالتفكير المُسبب الخطى الحتمى المرموز، وأنه جل شأنه لا يمكن إثباته بعقولنا الظاهرة دون بقيتنا، ولكن يمكن السعى إليه” بكل ما هو نحن” وعْياً فى رحاب وعىٍ أكبر فوعى أكبر فوعى أكبر بلا توقف، وأن هذا السعى ليس حدسا عشوائيا هذر مذر، لكنه سعى يحتاج إلى تدريب للحواس والعقل والوجدان جميعا كلٌّ بطريقته، وإذا كان الجسد قد استعاد دوره فى المعرفة، فإنه أولى بالقيام بدوره فى المشاركة فى لحن السعى الوجودى الفردى فالجمعى فى الكون، الأمر الذى يتجلى بوجه خاص فى العبادات والطقوس المنتظمة، دون حاجة إلى ترجمتها إلى ما يقوله العقل الظاهر وصيا عليها، ثم إنه سبحانه ليس كمثله شىء، وليس له كفوا أحد، “لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ” كما أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض، وهو غايةٌ لا تُدرك تحديدا، وإن كانت تجذٍب بوجودها الحقيقى كل جاد يكدح إليه اكدحا ولا يتوقف إلا ليعاود، دون أن يصل، مع أنه وصَلَ منذ بدأ ما دام مستمرا، إن “حتْمَ الحضور بالنفى” هو وسيلة معرفية إيجابية تكمـّل وتتفوق أحيانا على الحضور بالإثبات . كل هذه الافتراضات تبدو نظرية، وكثير منها سوف يُحتج عليه بأنه غير مفهوم، لأننا نريد أن نفهمها بالعقل الذى اعتدنا أن نحل به “مسألة حساب” أو “تمرين هندسة”، وليس بالوعى والجسد (فى العبادات – والهجرة- والجنس)، وسط جموع الناس (مثل الجمعة، الجماعة، الحج، وما يقابلها عند غيرنا)، إنه إبداع الذات فالحياة فى كل مجال. إن الشخص الأمّى يمكن أن يصل إلى كل ما أشرنا إليه حالا دون حاجة إلى هذا التنظير. إن هذه الافتراضات كلها لا تدخل إلى وعينا المعرفى بالحجج والبرهان، وإنما بالمعايشة والتدريب والممارسة، إن التعرف عليها يستلزم منا أن نفهم معنى تدريبات الوعى وحركية الجسد للمعرفة، مع توثيق علاقتنا بوعى الطبيعة فالكون فى رحلات “الذهاب والعودة”، دون توقف. شحذ كل أدوات الإدراك، تسليك منافذ الوعى المسألة ليست تنظيرا بديلا يعرض رأيا أرجح. هى إشارات إلى ضرورة نقلة نوعية فى التربية والنمو، والتدريب، لعلها تسهم فى استعمال واستلهام ومحاولة كل وسيلة إليه دون تمييز، ودون احتكار. إن شحذ أدوات الإدراك ومنافذ الوعى من خلال كل دين حقيقى لم يتشوه، هو أمر وارد، بل هو أمر واجب، يجرى هذا جنبا إلى جنب مع حركية الإبداع فى كل مجال، بهذا يتحقق التوازن بين مناهل وقنوات المعرفة من جانب، وأيضا بين أدوات ووسائل السعى إليه “معا” من جانب آخر. خذ مثلا تنمية العلاقة بالموضوع (ببعضنا البعض) فى رحاب وعى أشمل (اجتمعا عليه، وافترقا عليه) بديلا عن التماهى الثنائى وجها لوجه، أو خذ مثلا حين يصبح الجنس عبادة وإبداعاً تحت مظلته، أو خذ الإيمان بالغيب تدريبا وحفزا للإبداع، أو خذ تجاوز الحواس الخمس دون الوقوع فى خرافة الحدس العشوائى، أو خذ حركية مواكبة الإيقاع الحيوى للطبيعة توازيا مع الإيقاع الحيوى للعبادات، أو خذ آثار تغيير الوعى مع تنويع رسائل وعى الكون من خلال الحركة والترحال، أو خذ الموقف النقدى فى كل تجلياته دون استثناء، وهو موقف يشمل تحمل الغموض، والقدرة على التأجيل، فالإبداع النقدى. أغلب النظم التربوية المعاصرة، ليس لها وظيفة إلا طمس أغلب ذلك. موقف شخصى ولدتُ مسلما. لم أستطع أن أدعى أن الإسلام دون غيره هو الذى تسمح تعاليمٌه بتنمية كل من الوعى والإدراك والإبداع سعيا إلى ربنا كما وصلنى، لكننى أيضا لا أستطيع أن أنكر فضل إسلامى على ما وصلت إليه. ثم إنه تصادف أننى امتهنت مهنة أتاحت لى أن أعايش الوعى البشرى فى تناثره، ورِدَّته، ومحاولة إعادة تشكيله، الأمر الذى لم أتمكن من أن أمارسه إلا بالمشاركة المسؤولة بوعيى الشخصى مشتبكا مع وعى بشرى آخر، مستهديا ببعض العلم والخبرة. إن بعض ما وصلنى من إسلامى ومهنتى هو ما هدانى إلى معنى حتمية الحركة، تحت مظلة الرحمن إليه. أنا لا أستطيع أن أفصّل أيا مما بلغنى من حضور التوحيد فى حياتى ومهنتى تحريرا من كل اغتراب، أو فضل ما بلغنى من سورة الفاتحة علىّ وعلى مرضاى، أو دلالة التفرقة بين الشهادة والاعتقاد فى “شهادة” أنه “لا إله إلا الله”، وغير ذلك كثير. مسك الختام فى المخاطبة “9” التى استهللنا بها المقال، يقول تعالى مخاطبا النفرى: “يا عبدُ، عذرتُ من أجهلتُهُ بالجهل، مكرتُ بمن أجهلته بالعلم” ربنا سبحانه، وهو خير الماكرين، يلقى فى قلب النفرى هذا التحذير الواضح، لننتبه إلى ما نبَّه إليه. إن كل ما نصل إليه بأنفسنا سعيا إليه، أو عن طريقهم وهم يبلغوننا رسائله لهم، يحتاج إلى مراجعة نقدية جادة مسؤولة، كلٌّ على قدر كدحه. نحن نقرأ النفرى لا لنستسلم لما يصلنا من معانى الألفاظ كما اعتدنا أن نستقبلها، ولكن لنتحمل صدمة التحريك التى يحركنا بها إليه، “بين يديه”: “فقال لى إن أسلمتَ ألحدتَ، وإن طالبتَ أسلمتْ، فرأيتُه فعرفـتُـه ، ورأيت نفسى فعرفتك، فقال لى أفلحت، وإذا جئت إلىّ فلا يكن معك من هذا كله شىء. ***** [1] – مجلة سطور: (عدد يونيو – 2006) [2] – يحيى الرخاوى – إيهاب الخراط (مواقف النفّرى بين التفسير والاستلهام) عام2000، (ص 91) [3] – انظر هامش رقم (4)، قام المترجم د. مصطفى فهمى، (المكتبة الأكاديمية: 2003) ربما تسهيلا على القارئ العربى بترجمة العنوان إلى “تطور العقول” برغم أنه ترك العنوان الفرعى مشكورا وهو “الطريق إلى فهم الوعى” . [4] – Philosophy in the Flesh : The Embodied Mind and its Challenge to Western Thoughts (in English Copyright 1999) By George Lakoff and Mark Johnson “الفلسفة منغرسة فى الجسد”. تأليف جورج لاكوف , مارك جونسون [5] – سورة المائدة – الآية 35 العنف هو أحد صور الإعتداء (العدوانية) على الآخر (أو الذات) بما يلحق به الأذى دون جريرة. حين طلب منى أن أكتب عن العنف المعنوى ترددت فى تحديد مفهوم كلمة “المعنوي” وتصورت أن المراد هو العنف غير المادى، أى الذى يلحق الأذى بطريق غير مباشر دون إستعمال أدوات الإيذاء الملموسة أو حتى اللفظية، لكننى وجدت هذا التعريف ليس كافيا، فتصورت أن المقصود هو العنف “الخفي”، وأقصد به إلحاق الأذى بقصد ظاهر أو خفى، ولكن بطريقة ملتوية لا تُظهر أداة الأذى، حتى تبدو أحيانا أنها عكس ما يسمى عنفا، لكل ذلك فضلت أن أتحدث عن “العنف الخفي”. وقبل الدخول فى تصنيف هذا النوع من الإيذاء يجدر بنا أن ننتبه أنه ليس كل عدوان عنفا، وقد سبق أن أوضحت فى مجال آخر كيف أن العدوان غريزة بقائية، وأنه أقدم وأحيانا أهم من غريزة الجنس، وكيف أن العدوان الإيجابى يمكن أن يكون خطوة ضرورية فى سياق الإبداع حيث يبدأ الإبداع بتحطيم القديم لإعادة التخليق، وأضيف هنا أن ثمة عنفا مشروعا بل ومطلوبا إذا كان دفاعا عن النفس (أو العرض أو الأرض)، أو كان موجها لرد عدوان أو دفع ظلم، لكل ذلك وجب الحذر طول الوقت من التعميم والتسطيح وفرط التداخل، ذلك لأننا لو لم نأخذ هذا الحذر لدمغنا حركات التحرير بالعنف، ولأطلقنا على الإضراب المشروع صفة العنف (الخفى أو المعنوى.. إلخ). إذن، فسوف يقتصر حديثى على العنف بمعنى الإيذاء الظالم دون مبرر، دون خلط بالمعنى الإيجابى للعداون أو بالصور المشروعة للعنف. والعنف سواء كان ماديا أو معنويا هو لغة بكل معنى الكلمة، وبالتالى فقد تستعمل هذه اللغة فى حوار ما، وإنما يلجأ الإنسان إلى مثل هذا النوع من الحوار الخطر حين يفتقر إلى وسائل الحوار الأخرى التى تسمح له بعرض الرأى أو المناقشة أو الإقناع أو الاقتناع، أو المطالبة بالحق أو السعى إلى تحقيقه. والعنف الخفى قد يأخذ أشكالا متعددة منها العنف بالإغفال (فالإنكار) والعنف بالحرمان، والعنف بالترك، والعنف باللافعل، والعنف بالإعاقة، والعنف من خلال البراءة الكاذبة. أولا: العنف بالإغفال (فالإنكار) هذا النوع هو أخفى أنواع العنف، وقد يمارس من بداية الحياة، منذ الولادة، فالأم التى لا تستقبل وليدها بما ينبغى من إقرار فرعاية، وتظل تراه بما تسقطه عليه “موضوعا ذاتيا صرفا”، إنما تحرم طفلها من نمو سليم، بما يلحق به أسوأ أنواع الإيذاء، ومن ثم يضطر الطفل أن يحتوى أمه “كيانا سيئا” أى “موضوعا بشعا،” ويظل هذا الموضوع الداخلى كالجسم الغريب فى تركيبة نفس الفرد مدى الحياة، هذا إذا لم تأت الفرصة فى أزمات النمو اللاحقة، ومن خلال الأحلام أو العلاج لهضم هذا الجسم الداخلى وتمثله واستيعابه. وصور العنف بالإنكار تتكرر بشكل متواتر فى الحياة العامة، فى معاملات الكبار فمثلا، حين، يُعامل شخص مَا كفضلةٍ، لا تضيف ولا تنقص (إن حضر لم يستشر، وإن غاب لم يسأل عنه). وتتمادى صور الإنكار حتى يمكن أن تصيب شعبا بأكمله، مثل إنكار أن هناك شعبا إسمه الشعب الفلسطينى، إنكار وجوده على أرض فلسطين حتى قبل أن تنشأ إسرائيل رسميا، ثم إنكار وجوده الآن برغم كل ما هو جار، وهذا الإنكار الحالى هو عنف أقسى من العنف المادى فى شكل سجن هذا الفرد أو قتل هذه الجماعة المحدودة. ثانيا: العنف بالحرمان: وهذه خطوة لاحقة، حيث أنه يمكن أن يتم الاعتراف بوجود “الآخر”، فينتفى الإنكار المبدئى، إلا أن هذا الاعتراف قد لا يتبعه اعتراف بالحقوق الأساسية، ولا سعى إلى توفيرها: بدءا من الأكل والشرب (الرضاعة) حتى المسكن وصحبة الآخر، وهذا الحرمان الذى يصدر عادة من السلطة تمييزا عنصريا أو قهرا مؤسساتيا لا يكاد يرصد باعتباره عنفا أصلا، مع أن ما يترتب عليه هو أقسى وأخطر. ثالثا: العنف باللا أمان وحتى حين يحصل الفرد على الاعتراف بوجوده، وحتى حين تتوفر له حاجاته الأولية، لكنه لا يملك حق الاحتفاظ بها، ولا يأمن لاستمرارها، ثم هو يهدد باختفاء أو هجر مصدرها، فإنه يلحق به أذى بالغا، هو من أعنف أشكال العنف أيضا. رابعا: العنف بالإعاقة: وحتى تكون الإعاقة عنفا معنويا أو خفيا لابد أن تكون إعاقة غير مباشرة مثل: أن يحمل والد (أو رئيس) إبنه مهمة أكبر من قدراته حتى يعجز ويحبط، أو مثل أن يستولى صاحب سلطة على مكان أو منصب هو لا يحتاج إليه بالقدر الذى يستحقه صاحبه، أو غير ذلك من مظاهر الإعاقة. خامسا: العنف باللافعل: وهذا أقرب إلى ما يسمى العصيان أو الخـُـلف، وهو وسيلة من وسائل احتجاج الأضعف أحيانا حين يكون مقصودا وموجها كما نشاهده أحيانا فى شكل مظاهر العصيان المدنى، كما أن له صورا متعددة فى الأحوال الفردية أو رد بعض أمثلة لها كما نقابلها فى الممارسة الكلينيكية: فالطالب المتفوق الذى صاغه أبوه على أنه آلة تحصيل دراسى لا أكثر، قد يفيق وهو يبحث عن ذاته الحقيقية فيكتشف أن ما فعله أبوه به هو أنه ألغاه وأحل محله كتابا مصقولا أو شهادة لامعة، فيوجه هذا الابن إلى أبيه عنفا خفيا بأن يعطل أو يفسد هذه الآلة- آلة التحصيل الدراسي- التى حلت محله فيكف عن التحصيل، ويتوقف عن الدراسة، على الرغم من أنه هو الذى يشكو ويعانى من هذا التوقف عادة، فيكون عنفا موجها للوالد أصلا، لكنه لا يتم إلا إذا لحق بالذات (علىّ وعلى من ألغائى) والمرأة التى لا تملك أن ترفض زوجها رفضا صريحا، قد توجه عنفها إليه بالبرود الجنسى. وهكذا. سادسا: عنف تحت غطاء البراءة وقد بلغ حذرى من صور العنف الخفى ورفضى لخدعة الدماثة الكاذبة، بلغ هذا وذاك درجة نيتشوية حتى كدت أرفض كل أنواع الرقة والليونة التى يمكن أن يتخفى خلفها العنف، وامتد هذا الرفض إلى أشكال متعددة من البراءة، فأنكرت هذا النوع من البراءة البدائية التى تحمل فى طياتها كل العنف السلبى والقسوة الباردة، مما يمكن أن يدرج تحت العنف الخفى، فقلت “فى هجاء البراءة”: -1- براء ة ممتهنة، تنازلت عن حولها والقوة -2- براءة باهتة قد حال لونها وظلـلت بالسهو والعمى أحمالى الثقال -3 - براءة قاسية تقتل بالإغفال والمسالمه وتلصق الجريمه بموتِىَ اليقظ - 4 - براءة ساكنة تقطعت أطرافها، فساحت الحدود مائعة مرتـَـجـَّه - 5 - براءة زاحفة مبتلة قد سيبت مقابض الأفكار براءة سارقة من فطرتى عبيرها وبعثها - 6 - براءة جبانة غبية،…وكاذبة قد لوحت لمثــــلنا بالجنة الموات والسكينة فناء ظهرنا بكدحـنا ومادت السفينة - 7 - براءة مخاتلة، وتاجرة تطل من بسمتها المسطحة، معالم المؤامرة والصفقة الخفية - 8 - براءة مشلولة تنتف ريش نورس محلـق معاند تحشى به الوسادة تزين القلادة -9- تكاثـر الجراد جــحـافل البــشـر كـالــدود والجـــــذور تغوص فى اشتياق فى الطين والعفن أنواع أخرى أخفى: وقبل أن أختم كلمتى أود أن أشير إلى ثلاثة أنواع خاصة من العنف الخفى أو المعنوى. النوع الأول: هو العنف الموجه إلى الذات وهو ينشأ أساسا مرتبطا بما أشرنا إليه من احتواء “الموضوع البشع” (الأم القاسية أو المهملة مثلا) فى داخل تركيب الذات، وبالتالى يوجه العنف إلى هذا الموضوع الداخلى الذى هو داخل الذات فلا يتحقق إلا من خلال إيذاء الذات والتهوين من شأنها، أو بالحيلولة دون أن تنجح أو تنجز، وقد يصل الأمر إلى حد الانتحار المعنوى. النوع الثانى: هو العنف المـُـقـْـحـَـمْ، ويتم هذا النوع بأن يستعمل شخص ذو شخصية طاغية متفوقه أحد الأقربين إليه، المتعلقين به، المعتمدين عليه (مثل أخ أصغر أو إبن أو زوجة..إلخ) يستعمله – بطريقة لاشعورية- ليقوم عنه بفعل الإيذاء الموجه للآخرين، بما يتضمن إيذاء الشخص المستعـْـمـَـل (الأداة)، وذلك دون أن يدرك هذا الشخص التابع أو ذو الشخصية التابعة أنه يقوم بما يقوم به من إيذاء نيابة عن هذا الطاغى الذى أقحم دوافعه وقسوته إلى داخل تابعه ليقوم عنه بالإيذاء، وكأن التابع قد أصبح الأداة التى يؤذى بها الناس. النوع الثالث: هو العنف الناتج عن التقمص بالمعتدى، بمعنى أنه حين يزيد القهر من الخارج، ولا يستطيع الكيان المقهور أن يقاومه أو يرده، فإنه يتقمص المعتدى فيحقق بذلك عنفا ذا شقين: الأول عنف على نفسه بإلغاء ذاته المستقلة، والثانى: عنف على الغير بأن يمارس نفس القهر الذى كان يمارس عليه، (مثلما تقمصت اسرائيل النازى) وليس خافيا أن الجزء الأول من هذه الحيلة الدفاعية وهو جزء إلغاء الذات هو ما يخص هذا المقال بمعنى أن التقمص – فى النهاية – ليس الإ عنفا خفيا موجها للذات المنسحقة، حتى لو ترتب على ذلك عنف مرتد صريح نحو الآخرين، خاتمة: لا يفوتنى التنويه فى النهاية أن عكس العنف ليس هو التسامح أو الرقة أو اللين أو الطيبة أو البراءة، ولكن عكس العنف هو العدل، والحوار، والعدوان الايجابى الخلاق. ****
[1] – مجلة سطور: (عدديوليو – 1997) – هذه المقالة هى الوحيدة التى أضفتها إلى هذه المجموعة (مجموعة سطور) وهى سابقة لها عشرون عاما تقريبا، ثم تحديثها بعنوان: “طاقة العدوان وحركية الإبداع” المجلد العاشر- العدان الثالث والرابع – يناير1992 – مجلة فصول. وقد فضلت ألا أعيد ترتيب المقالات فتركتها تتوالى حسب تاريخ نشرها اللام إلا المقالة الأولى “العنف الخفى” فقد فضلت أن أجعلها الأخيرة لأقدم قبلها أطروحتى عن “العدوان والإبداع” وهى سابقة لكل هذا ظهرت بمجلة الإنسان والتطور عدد يوليو 1980 وذلك تمهيد الكلام عن العنف.الحراك الاجتماعى والحراك التطورى والطبقة الوسطى
الحراك الاجتماعى والحراك التطورى والطبقة الوسطى
إحياء التراث بالجدل
إحياء التراث بالجدل
[2] – أضيف مؤخرا بعد كتابة هذا المقال حقيقة نيوروبيولوجية جديدة رائعة وهى أن المخ يعيد بناء نفسه باستمرار.
الحقيقة هى الحركة المرنة المتخلقة فى اتجاه الحقيقة
الحقيقة هى الحركة المرنة المتخلقة فى اتجاه الحقيقة
الحلم ...الحرية البديلة
الحلم ...الحرية البديلة
الخروج من مصيدة العصر حركية الإيقاع بين التعتيم والتغيير
الخروج من مصيدة العصر حركية الإيقاع بين التعتيم والتغيير
(5) أما تطبيق دورات الإيقاع الحيوى على مدى التطور الحيوى كله فهو أساس جوهرى فى فكرة “نظرية الإستعادة([2])” Recapitulation Theory وبالتالى هو أساس ما أسميته “النظرية التطورية الإيقاعحيوية”، وهى النظريات التى تعتمد القياس المتوازى المستعاد الذى يفترض أن تطور الفرد يكرر تطور النوع (نظرية الاستعادة: هيكل)، ومن ثم يفترض أن كل طور من أطوار النمو (الإيقاع الحيوى عامة) يكرر مراحل ودورات تطور النوع، فالفرد، على فترات مضطردة، تتكامل الواحدة بعد الأخرى .
[2] – يحيى الرخاوى: “مستويات الصحة النفسية: من مأزق الحيرة إلى ولادة الفكرة” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، (ص 97) سنة 2017.
استرجاع دور الجسد وعياً متعينا
استرجاع دور الجسد وعياً متعينا
جذور الخوف ولزومه
جذور الخوف ولزومه
الاعتمادية الايجابية تحت عباءة أكبر
الاعتمادية الايجابية تحت عباءة أكبر
اللعبة والملعوب
اللعبة والملعوب
التاريخ والبيولوجيا فى مواجهة التفكير المعقلن: القيادة بالتبادل
التاريخ والبيولوجيا فى مواجهة التفكير المعقلن: القيادة بالتبادل
تشكيلات أخرى لملعوب الهجرة
تشكيلات أخرى لملعوب الهجرة
يأتى الدولار بما لا يشتهى البشر
يأتى الدولار بما لا يشتهى البشر
تصالح مع الذات؟ أم تكامل الذوات؟
تصالح مع الذات؟ أم تكامل الذوات؟
تاريخ التطور الحيوى فى مواجهة مناهج الاغتراب والتفتيت والتدهور
تاريخ التطور الحيوى فى مواجهة مناهج الاغتراب والتفتيت والتدهور
شيخ خفراء العالم الحديث
شيخ خفراء العالم الحديث
الإيقاع الحيوى بين الحركة والسكون
الإيقاع الحيوى بين الحركة والسكون
الوهم الأكبر: وهم اللاوهم
الوهم الأكبر: وهم اللاوهم
”….. فلو أن لدينا أدنى فرصة أن نجد منقذا من ذلك المستنقع البشع الذى هو مستنقعنا، فعلينا، قبل كل شى، أن نتحاشى خطأ الاعتقاد أننا أحرار…”([2])
تزييف الوعى البشرى، وإنذارات الانقراض
تزييف الوعى البشرى، وإنذارات الانقراض
من تقديس البطل إلى تخليق الذات والأسطورة الذاتية
من تقديس البطل إلى تخليق الذات والأسطورة الذاتية
التكاثر: رعبا من الموت جوعا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
التكاثر: رعبا من الموت جوعا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
قراءة فى الفطرة البشرية الأسس البيولوجية للدين والايمان
قراءة فى الفطرة البشرية الأسس البيولوجية للدين والايمان
اللعب فى الوعى/الدماغ وأسلحة الانقراض الشامل
اللعب فى الوعى/الدماغ وأسلحة الانقراض الشامل
... عن الحق فى الخوف، وتسطيح الوجدان!
... عن الحق فى الخوف، وتسطيح الوجدان!
أخافُ همس الصمت
أخافُ همس الصمت
الخوف شعر بالعامية المصرية الجزء الأول
الخوف شعر بالعامية المصرية الجزء الأول
الفطرة بين التجريم والتحريم والتشويه والتأثيم
الفطرة بين التجريم والتحريم والتشويه والتأثيم
... كدحا إليه لنلاقيه لا أعلم من العقل..، ولا أجهل من العقل
... كدحا إليه لنلاقيه لا أعلم من العقل..، ولا أجهل من العقل
العنـف الخـفى
العنـف الخـفى
المحتوى
المحتوى
العنوان
صفحة
الإهداء
3
مقدمة
5
”الحراك الاجتماعى” و”الحراك التطورى”و”الطبقة الوسطى”
7
إحياء التراث بالجدل
17
”الحقيقة” هى الحركة المرنة المتخلقة فى اتجاه “الحقيقة”
27
الحلم …الحرية البديلة
33
الخروج من مصيدة العصر!(حركية الإيقاع بين التعتيم والتغيير)
43
استرجاع دور الجسد وعياً متعيناَ
53
جذور الخوف ولزومه
63
الاعتمادية الايجابية تحت عباءة أكبر
75
اللعبة والملعوب
87
التاريخ والبيولوجيا فى مواجهةالتفكير المعقلن: القيادة بالتبادل
103
تشكيلات أخرى لملعوب “الهجرة”
117
يأتى الدولار بما لا يشتهى البشر
127
تصالح مع الذات؟ أم تكامل الذوات؟
139
تاريخ التطور الحيوى فى مواجهة مناهج الاغترابوالتفتيت والتدهور
149
شيخ خفراء العالم الحديث
161
الإيقاع الحيوى بين الحركة والسكون
173
الوهم الأكبر: وهم اللاوهم
185
تزييف الوعى البشرى، وإنذارات الانقراض
199
من تقديس البطل إلى تخليق الذات(والأسطورة الذاتية)
211
التكاثر: رعبا من الموت جوعا”أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ”
221
قراءة فى الفطرة البشرية (الأسس البيولوجية للدين والايمان)
233
اللعب فى الوعى/الدماغ وأسلحة الانقراض الشامل
247
… عن الحق فى الخوف، وتسطيح الوجدان!!!
259
أخافُ همس الصمت
275
الخوف (شعر بالعامية المصرية)
279
الفطرة: بين التجريم والتحريموالتشويه والتأثيم
283
… كدحا إليه، لنلاقيه”لا أعلم من العقل..، ولا أجهل من العقل”
295
العنـف الخـفى
309
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى