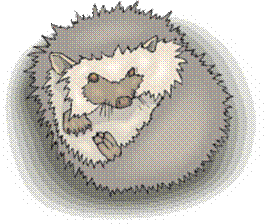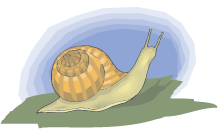نشرت فى روز اليوسف
9 – 9 – 2005
سلسلة الإنسان
أ.د. يحيى الرخاوى
تمهيد
هل يمكن أن يجد أحد نفسه فى موقف يرغمه أن يختار- فى عمق وجوده- بين الحب والحياة؟ هل يمكن أن يعلمنا الإبداع الأعمق معنى آخر لما لا نكف عن ترديده حول الحب والثقة والكره والقتل؟ هل يمكن أن يسعى الإنسان بعد طول رحلة تطوره إلى نوع آخر من العلاقات؟ نوع أعمق، وأخطر، وأجمل، وأصعب؟.
فى فقه العلاقات البشرية (1)
كيف يكون الاختيار بين الحب والحياة ؟
 فى الأسبوع الماضى، فى نفس العدد الذى يصدر فيه هذا الباب، أطلّت علىّ إطلالات متفرقة، متباعدة من حيث المبدأ، لكنها اجتمعت عندى حول ضرورة المغامرة بفحص طبيعة وصعوبة العلاقات البشرية، فانفتح على ملف هذا الإشكال الذى كنت أزمع تأجيله.
فى الأسبوع الماضى، فى نفس العدد الذى يصدر فيه هذا الباب، أطلّت علىّ إطلالات متفرقة، متباعدة من حيث المبدأ، لكنها اجتمعت عندى حول ضرورة المغامرة بفحص طبيعة وصعوبة العلاقات البشرية، فانفتح على ملف هذا الإشكال الذى كنت أزمع تأجيله.
تنقلت فى عدد الجمعة الماضى ما بين الخطاب السياسى (سعد هجرس: بناء الثقة، ومحمد هانى: الشخصية الغائبة) إلى خطاب الحب والتبات والنبات (بؤرة الرجولة فى دماغ الأزواج : أمينة خيرى)، إلى خطاب الفن (رواية العطر: تحدى هوليود الأكبر) فحضرنى هذا الهاجس حول هذه القضية.
بعض عنوان مقال سعد هجرس “بناء الثقة” كان إشارة إلى ما نحن أحوج ما نكون إليه الآن فى مسألة علاقة الحاكم بالمحكوم، قدم تعريفا للسياسة بدقة ورفاهة، برغم أن المفروض أنه بديهى، باعتبارها “علم وفن إدارة الصراع والمتناقضات بين الأطراف المختلفة فى المجتمع بصورة سلمية” بديلا عن “حلبة مصارعة الثيران وحديقة الحيوان المفتوحة”، كما قدم اقتراحات عملية لإجراءات ممكنة تتعلق بوقائع قائمة تحتاج قرارا واضحا، فتنبنى الثقة. هذا طيب كله: بسيط، واضح، عملى، وممكن، ومفيد. لكن المسألة التى أثارها العنوان ابتعدت عن كل ذلك وأنا أتساءل عن العلاقة بين بناء الثقة بنا، بداخلنا، فيما بيننا، وبين المناخ السياسى الذى يتطلب ذلك وينبنى عليه بشكل أو بآخر.
 نبهنا محمد هانى، فى عاموده فى نفس اليوم إلى افتقارنا إلى (وحاجتنا لـ) نوع الشخصية التى تكسب وتجعل الآخرين يكسبون، وهى الشخصية الغائبة عن مجتمعنا فى الحياة السياسية والاجتماعية على حد سواء، وأنه لكى تنمو هذه الشخصية لا بد من توفير “… مناخ يسمح لها بهذا، أهم ملامحه الحرية، والقضاء على الفساد والعدل الاجتماعى” ..إلخ، شكرت له رؤيته وتصنيفه. لكن التساؤل تزايد عندى حول العلاقة بين كل ذلك وبين ما نربى عليه أطفالنا، وما نمارس من خلاله علاقاتنا الحقيقية، والحميمة”.؟
نبهنا محمد هانى، فى عاموده فى نفس اليوم إلى افتقارنا إلى (وحاجتنا لـ) نوع الشخصية التى تكسب وتجعل الآخرين يكسبون، وهى الشخصية الغائبة عن مجتمعنا فى الحياة السياسية والاجتماعية على حد سواء، وأنه لكى تنمو هذه الشخصية لا بد من توفير “… مناخ يسمح لها بهذا، أهم ملامحه الحرية، والقضاء على الفساد والعدل الاجتماعى” ..إلخ، شكرت له رؤيته وتصنيفه. لكن التساؤل تزايد عندى حول العلاقة بين كل ذلك وبين ما نربى عليه أطفالنا، وما نمارس من خلاله علاقاتنا الحقيقية، والحميمة”.؟
وجدت نفسى فى صفحة التبات والنبات الذى تحرره أمينة خيرى، وقد تزين بتعبير رائع هو “بؤرة الرجولة”، فقدرت من جانبى أنه ليس وراء هذا “الورم الرجولى الزائف” إلا اهتزاز ثقة الرجل بوجوده كيانا مرغوبا فيه، الأمر الذى يضعه – تطـوريا ووجوديا – فى وضع أدنى كثيرا من امرأة ممتلئة بنفسها، دون غرور، فخورة بطبيعتها دون نقص، قادرة على التلقى الذى هو نفسه عطاء يتكامل فى نفس الوقت.
وأخيرا جاءت الإشارة –فى نفس العدد – إلى رواية العطر ومشروع تحويلها إلى فيلم سينمائى بمغامرة فنية أتمنى لها النجاح، وإن كنت أشك فى قدرة السينما على توصيل الرسالة التى وصلت للناس من تلك الرواية الرائعة.
العطر
من رواية “العطر: تأليف باتريك زوسكند 1997(ترجمت إلى أكثر من 20 لغة)
هى رواية تتناول فى جوهرها الطبيعة البشرية فى سجن وحدتها، وحتم حركتها نحو كسرها، وفى نفس الوقت فى سعيها الفاشل المرعب نحو تواصل شاذ مستحيل لا يستبعد القتل سبيلا إليه، وهى تضع الحب نقيضا للحياة بالنسبة لمسيرة بطلها، عكس ما نعرف ويشاع، وقد غاص فى هذا التحدى كاتب الرواية حتى النخاع، وخرج منه بما يضيف إلينا ما ينبغى معرفته عن طبيعتنا البشرية الرائعة الغاضة، أعمق وأكثر اختراقا من إسهامات العلم.
المقتطف
…. كان غرينوى شديد المقاومة كالبكتيريا المنيعة، وقنوعا كقرادة ضئيلة تقبع مستكينة مكتفية بقطرة الدم الوحيدة التى اقتنصتها قبل أعوام. كان جسمه قادراً على الاكتفاء بالحد الأدنى من الغذاء والملبس، أما روحه فلم تكن بحاجة لأى شئ. فالطفل غرينوى كان بغنى عن الشعور بالأمن والدفء والحنان والحب، أى عن كل هذه التسميات التى يزعم البعض أن الطفل بحاجة إليها. ولكن يبدو لنا أنه قد تعمد الاستغناء عنها منذ البداية، كى ينجو بحياته. إن الصرخة التى اطلقها عقب ولادته، من تحت طاولة السلخ والتى دعا بها نفسه الى الحياة وأمه إلى المقصلة، لم تكن صرخة غريزية بحثا عن الشفقة والحب …. اراد بها الوليد الجديد أن  يحسم أمره ضد الحب ولصالح الحياة. وفى ظل الظروف المهيمنة لم يكن هذا ممكنا دون ذلك….. لقد كان شنيعاً منذ البداية، فاختياره الحياة كان نابعاً من إحساسه بالتحدى والكراهية فحسب.
يحسم أمره ضد الحب ولصالح الحياة. وفى ظل الظروف المهيمنة لم يكن هذا ممكنا دون ذلك….. لقد كان شنيعاً منذ البداية، فاختياره الحياة كان نابعاً من إحساسه بالتحدى والكراهية فحسب.
إنه لأمر بدهى مفهوم أن غرينوى لم يمارس عملية الاختيار، كما يفعل البالغ الراشد الذى يستخدم إرادته؟ ، …. إنما كان اختياره نباتياً، أى كالحبة المرمية التى عليها أن تختار بنفسها، إما أن تنمو أو تموت، أو كحشرة القرادة القابعة على جذع شجرة، والتى ليس لدى الحياة ما تقدمه لها سوى النجاة المتكررة من كل شتاء، ……. ومثل غرنوى كمثل هذه القرادة الوحيدة، المتكورة على نفسها فوق شجرتها، صماء بكماء عمياء وهى تتشمم فحسب، تتشمم وعلى مدى السنين والمسافات ودم الحيوانات العابرة والمتجولة …. هذه القرادة العنيدة المتعفنة والمقرفة تصر على الحياة وتنتظر. تنتظر حتى تسوق لها الدم، صدفة عجيبة، فى صورة حيوان ما، الى تحت شجرتها تماما. حينئذ فقط كانت تتخلى القرادة عن تحفظها، فترمى بنفسها فوق اللحم الغريب لتتكالب عليه وهى تعض وتنهش…
والطفل غرنوى كان مثل هذه القرادة، فقد عاش متكيسا على نفسه بانتظار الزمن الأفضل. لم يقدم للعالم من ذاته سوى غائطه، لا بسمة ولا صرخة ولا التماعة عين، ولا حتى رائحته…
القراءة
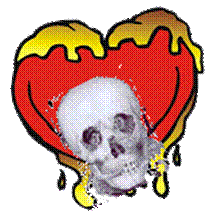 غرينوى، بطل الرواية، هو لقيط أُنقذ بمحض الصدفة من أن تقتله أمه فور ولادته، وأعدمت أمه بتهمة قتل أولادها غير الشرعيين الواحد تلو الآخر، ولد بلا رائحة تجذبه إلى البشر أو تجذب البشر إليه، (بالمعنى العيانى والمجازى معا). هذه الحقيقة تكتشفها المرضعة تلو الأخرى، ثم تبلغه فتبدأ رحلته المتحدية، غرينوى بعد أن لفظته أمه حتى قبل ولادته. الاختيار الغريب الذى تطرحه الرواية منذ البداية هو أنها تضع الحب ضد الحياة، كما ذكرنا فى البداية، التحدى الأكثر إبداعا هو أنها تظهر لنا كيف أن قرار الحياة يتم تحقيقه عن طريق الكره بإرادة خفية أقرب إلى إرادة الحياة، نهاية الرواية تؤكد هذا التوجه أيضا.
غرينوى، بطل الرواية، هو لقيط أُنقذ بمحض الصدفة من أن تقتله أمه فور ولادته، وأعدمت أمه بتهمة قتل أولادها غير الشرعيين الواحد تلو الآخر، ولد بلا رائحة تجذبه إلى البشر أو تجذب البشر إليه، (بالمعنى العيانى والمجازى معا). هذه الحقيقة تكتشفها المرضعة تلو الأخرى، ثم تبلغه فتبدأ رحلته المتحدية، غرينوى بعد أن لفظته أمه حتى قبل ولادته. الاختيار الغريب الذى تطرحه الرواية منذ البداية هو أنها تضع الحب ضد الحياة، كما ذكرنا فى البداية، التحدى الأكثر إبداعا هو أنها تظهر لنا كيف أن قرار الحياة يتم تحقيقه عن طريق الكره بإرادة خفية أقرب إلى إرادة الحياة، نهاية الرواية تؤكد هذا التوجه أيضا.
الرواية تدعونا إلى أن نفكر كيف نتجاوز المألوف فى فهم العلاقات البشرية. إن تصويرنا للتربية المثالية، والعلاقات الجميلة، والحب الرائق، والسياسة الناجحة، بشكل سلسل أمِل إنما يصلح لمستوى معين من التواصل التكيفى بين البشر، أو لتنظيم الأسرة وترتيب المجتمع، أو لتحديد الحقوق والواجبات، أما حقيقة العلاقات البشرية فلها عمق آخر لا مفر من مواجهته بإبداع منشئ، ثم إبداع ناقد، فاختبار فتعديل فتطوير لا ينتهى.
إن وضع غرينوى فى هذه الرواية لا يمثل تنويعا مقبولا من الوجود البشرى. إنه الجانب الأعمق الذى يتجادل مع الشائع الذى نعرفه، ونروجه، وبدون هذا الجدل لا يمكن أن نعرف الإنسان على حقيقته. إن الرواية تقدم الطبيعة البشرية الأعمق فى صورتها الشرسة المنفصلة التى تجعل الحياة تتواصل بالقتل والكراهية، بقدر ما تظهر الحب وكأنه هو الخطر الحقيقى على الحياة إذا كان مسطحا أو ملتهما أو خاملا أو لاغيا.
من منطلق آخر، فإن غرينوى فى العطر – من أول الرواية حتى آخرها_ بدا نيزكا منفصلا عن الناس والكون معا، فتجاوز الناس إلى التأله الفاشل، لكنه لم يتجاوزهم فقط بالاستغناء عنهم، بل تجاوزهم أيضا بأن يستعمل بعضهم، ويتحدى جمعهم، ثم يقتل من تيسر منهم ممن يظن أنهم يحملون “رائحة” الحياة الأصل، كما يريدها ويتصورها ليؤلف من تشكيل عطورهم عطره الخاص الفريد ليتأله به. ومع أنه تنازل بذلك عن بشريته التى لا تتحقق إلا بالتواصل مع بشر آخر، ومع أنه قد حقق ألوهيته الزائفة عن طريق قتل العذارى الواحدة تلو الأخرى، فإنه حين نجح فى ذلك وفاح منه عطره النقى الساحر المتفرد الذى ليس كمثله عطر، جاءت نهايته عدما فى بطون أكلة لحوم البشر الذين حين فعلوها “..كانوا فخورين إلى أقصى حد، فلأول مرة فى حياتهم فعلوا شيئا عن حب”.
ماذا يقول العلم موازيا؟
لا يوجد شىء فى العلم الأحدث يزعم أن كل ما يحتاجه الطفل ليحصل على الثقة ويواصل المسيرة: هو الرعاية الحانية والحماية التسكينية، ندع فرويد جانبا فقد صاغ الصعوبة بطريقته الخاصة (أوديب والخصاء، والتنافس المحارمى…إلخ) التى لم تعد كافية.
إريك إريكسون هو الذى أضاف فى كتابه الرائع “الطفولة والمجتمع” ما يفيد أن الإنسان يولد من جديد فى كل دورة نمو من الولادة حتى الوفاة (ثمان عصور – ولادات- لكل منا على الأقل)، وأنه فى كل ولادة جديدة يجد الواحد منا نفسه بين منطلقين يبدوان على طرفى نقيض. يكفينا هنا أن نتوقف عند المرحلة الأولى جدا عقب الولادة مباشرة ، وهى مرحلة لا تختفى أبدا مهما لحقتها مراحل أنضج فأنضج (مثل سائر المراحل). هى مرحلة تسمى “الثقة فى مقابل اللاثقة ” Trust versus Mistrust.
إذا كان لنا أن نتحدث عن ضرورة توفير الثقة كأساس صلب للوجود البشرى، فلا بد أن نقبل أن الثقة الحقيقية الجدلية البناءة إنما تتولد من اللاثقة، ثم إنه من خلال هذا الجدل المبدئى، تتحرك عملية النمو إلى ما تعد به من مراحل تالية كلها فيها نفس الفكرة.
فى مدرسة أخرى هى مدرسة العلاقة بالموضوع Object relation theory (المدرسة التحليلية الإنجليزية) يمر الطفل بعد الولادة بقليل بموقف توجسى حذر”، وذلك لأنه حين يتعرف على العالم، وأن هناك يوجد كيان آخر غيره، يتوجس من ذلك الشر فيستعد له بالتوجس والشك والحذر، ومن ثم بالكر والفر، هو لا يستغنى عن هذا الأخر فهو لا يكون إنسانا إلا به، وفى نفس الوقت هو لا يأمن له ويخشى الاقتراب منه خوف الالتهام. من هنا نواجه حتمية الشك وحتمية اللاثقة، تلك الحتمية القادرة على أن تتفجر منها الثقة –دون إلغاء ضدها- من خلال جدل خلاق.
برغم صعوبة هذه اللغة على القارئ العادى إلا أننى أشعر أنها ضرورية إذا ما أردنا أن نكشف عن بعد أعمق من الطبيعة البشرية، بعد قد يجعلنا أقدر على فهم طبيعة ما هو علاقة نحاول إرساءها فيما بيننا بشكل أعمق وأبقى وأكثر إثراء ونبضا وجمالا. هذا الموقف التوجسى المبدئى الذى تبدأ به حياة البشر يبدأ بإعلان أن حضور الآخر فى وعى الإنسان (الطفل النامى أساسا) هوضرورة مواجهة بداية الطريق نحو تأنيسه (أن يكون إنسانا).
إن “الآخر” لا يكون آخرا بالنسبة لى إلا إذا كان كيانا مستقلا عنى، عن ذاتى أنا، أى كيانا “حقيقيا”، الأمر الذى نزعم أننا نمارسه حين نتكلم عن الحب وعن قبول الآخر وعن الثقة، فى حين أننا قد نكون فى خدعة أننا لا نعمل علاقة إلا باحتياجاتنا نحن، وإسقاطاتنا نحن. إن حضور هذا الآخر فى وعينا يبدأ – طبيعيا – باعتباره أنه خطر يهدد وجودنا، خطر بمعنى أنه قد يسحقنا فيلغى وجودنا لحسابه، أو قد نلتهمه نحن احتياجا أو خوفا، فنلغى وجوده، وفى نفس الوقت نحرم أنفسنا منه، ومن هنا يضطرد الجدل.
إن هذا النوع من العلاقة ، وهى تسمى علاقة الكر والفر Fight Flight إنما يعلن أن وجود الآخر هو الخطر بعينه، لكنها مرحلة لا تدوم وإن كانت تكمن جاهزة للتنشيط، فهى تسمح لنا بأن نستدعيها كلما احتجنا إليها (أى كلما لزم الأمر للكرّ والفرّ)، وأحيانا تقتحم الوعى الظاهر – خاصة بعد كبت طويل – دون استئذان وبعنف، فى شكل مرضى.
فى هذه المرحلة يعتبر الحب تهديدا، ويعتبر أى اقتراب أكثر من المسافة التى تسمح بمواصلة “الكر والفر” الآخر غير مرغوب فيه، لعل فى هذا ما يفسر موقف غرينوى السالف الذكر : “الحياة ضد الحب ” النص التالى يوضح ذلك تفصيلا
النص : من “ديوان سر اللعبة“
-1-
إذ أنـّـي:
ألبس جلدى بالمقلوبْ،
حتى يُـدمى من لمسٍ ‘الآخرْ’
فيخاف ويرتدْ
إذ يصبغُ كـفذـيْـه نزفٌ حىْ
وأعيش أنا ألمى،
أدفع ثمنَ الوحدة.
-2-
……………..
أهرب منكمْ،
فى رأسى ألفىْ عينٍ ترقبكمْ،
تبعدكْم فى إصرارْ.
أمضى وحدى أتلفتْ.
-3-
… لكن حياتى دون الآخر وهم:
صفر داخل صفر دائر
….
لكن الآخر يحمل خطرَ الحبْ
إذ يحمل معه ذل الضعفْ
…..
يتلمظ بالداخل غولُ الأخذْ
فأنا جوعان منذ كنتْ
بل إنى لم أوجد بعدْ
من فرطِ الجوعِ التهمَ الطفلُ الطفلْ
فإذا أطلقت سعارى بعد فوات الوقتْ،
ملكنى الخوف عليكمْ.
اذ قد ألتهمُ الواحَ منكمْ تلو الآخرْ،
دون شبعْ.
-4-
يا من تغرينى بحنانٍ صادقْ ، فلتحذرْ،
فبقدر شعورى بحنانك:
سوف يكون دفاعى عن حقى فى الغوصِ الى جوف الكهفْ،
وبقدر شعورى بحنانك:
سوف يكون هجومى لأشوِّه كلَّ الحبِّ وكلَّ الصدقْ،
فلتحذرْ
إذ فى الداخلْ
وحشٌ سلبىٌّ متحفـزْ
فى صورة طفل جوعانْ
وكفى إغراءَا
وحذارِ فقد أطمعُ يومًا فى حقى أن أحيا مثل الناسْ
فى حقى فى الحبْ .
ألبسُ جلدى بالمقلوبْ
فلينزفُ إذ تقتربوا
ولتنزعجوا
لأواصلَ هربى فى سردابِ الظلمةْ .
نحو القوقعةِ المسحورةْ
……
 لكن بالله عليكم: ماذا يغرينى فى جوف الكهف،
لكن بالله عليكم: ماذا يغرينى فى جوف الكهف،
وصقيعُ الوحدة يعنى الموتْ؟
لكنَّ الموتَ الواحدْ: … أمرٌ حتمىٌّ ومقدرْ،
أما فى بستان الحبْ،
فالخطر الأكبرْ:
أن تنسونى فى الظلْ،
ألا يغمرنى دفء الشمسْ
أو يأكل برعم روحى دود الخوفْ.
فتموت الوردةْ فى الكفنِ الأخضرْ،
لم تتفتح
و الشمسُ تعانقُ من حولى كل الأزهارْ،
هذا موتٌ أبشع .
لا..
جلدى بالمقلوبْ
والقوقعةُ المسحورةْ
تحمينى منكمْ .
هذا ما فعله غرينوى، تقريبا بالضبط، فقد لجأ فى الرواية إلى كهف الجبل (القوقعة المسحورة) يحتمى به من البشر، من روائح البشر، لكنه خرج من كهفه أكثر ضراوة وشراسة وبدائية وقتلا، وحين نجح أن ينفصل تماما برائحته الخاصة الألوهية، التهمه أكلة لحوم البشر فى مقبرة “الأبرياء” فى باريس ليعلن الكاتب المبدع بذلك فشل الانفصال النيزكى حتى لو كان مفروضا على صاحبه منذ البداية، كما يعلن أيضا فشل تجاوز ما هو نيزك إلى ما هو إله، دون مرور بجدلية العلاقة مع بشر حقيقيين مهما كانت روائحهم.
كان غرينوى فى العطر يريد أن يخلق لنفسه عطره الخاص، لا ليستمتع به داخل الغار أو داخل القوقعة، ولكن ليفرض نفسه على الآخرين يشمون رائحته متفردا، وحين نجح فى ذلك حتى أسكرهم نشوة وانبهارا ، سُحروا انجذابا، فالتهموه إعداما، وهم يعلنون أنها المرة الأولى التى يعملون فيها شيئا عن حب.
إن اقتراب الآخر منا ونحن فى هذا الموقف التوجسى للكر والفر حتى الاختفاء، فتحسس الظهور، فالعودة الحذرة، فالاختفاء، يصاحبه تساؤل لحوح عما إذا كان هذا الآخر يرانا حقيقة وفعلا، أم أنه لا يرى إلا ما يريده منا، أم أنه يستعملنا فقط، وهو فى جميع الأحوال قد يلغينا بالعمى، أو يستعمل جزءا منا دوننا، أو يستعبدنا من فرط جوعنا بعد أن يتمادى فى تعجيزنا. إن تردد المحبين أصحاب الوعى اليقظ فى تقبل الحب السهل، ومواصلتهم التساؤل عن طبيعة العلاقة، وذهابهم وعودتهم بلا كلل، هو مظهر من وظاهر هذا الجدل الحى، دون ضمان بنهاية واثقة بدرجة كافية، لان ذلك هو موقف بلا نهاية، برغم حتميته، وألامه، وروعته، ووعوده. يتجلى كل ذلك أو أغلبه فى نص آخر بالعامية المصرية هذه المرة
قراءة فى من “ديوان أغوار النفس”
النص:
القط يشمشم اللبن،
 ويختبئ تحت الكرسى الـ”مش باين”
ويختبئ تحت الكرسى الـ”مش باين”
والعين الخايَفَةْ اللى بْتِـلْمَعْْ فى الضَّلْمَهْ
عمّالة تِختبرِ الناسْ:
بِتقرّب من بَحْر حَنَانْهُمْ،
زى القُطّ ما بـَيـْشـَمـِْشمْ لَبَن الطفل بشاربُهْْ.
عمّالَـهْ بْتِسْأَل:
عـــايزينّى؟
طبْْ ليه؟
عايزينَّى ليه؟
إشـِمعنى الْوقْـِتـِى؟
بـِصحـِيحْ عـَايـْزِنَّـى؟
بقى حـَدْ شايـِفـْنـِى يـَا نـَاسْ؟
مِـشْ لازم الواحـِدْ منكم يعرفْ:
هوّه عـَايـزْْ مـِينْ؟
بقى حد شايـِفـْنـِى أنا؟
أنا مينْ؟
أنا أطلـع إيه؟
وازاىْ؟
طبْ لـِيه؟
الله يسامـِحْـكُمْْ. مـِشْ قصدِى .
(2)
 أنا قاعـِدْْه راضيه بْخوفِى المِـشْ راَضـِى.
أنا قاعـِدْْه راضيه بْخوفِى المِـشْ راَضـِى.
أنا قاعده لامّه أغـْراَضـِى.
أنا قاعده راصدْه حركاتكْمْ،
قاعده اتْـصنـَّتْ، على همس المِـشْ شايفينِّى ،
وأسَهّيهم، واتمَسّح فِ كْـعوب رجليهم.
أخطف همسةْْ “أَيـْوَهْْ”،
أو لـَمـِسـَةْ ْ “يـِمـْكـِنْْ”.
واجرى اتدفَّى بـْ “يَعْنِى”،
وانسَى الـْ “مـِشْ مـُمْكـِن”.
(3)
وأُبصلْكمْْ مِن تَـحْـتِ لـْتَـحْـت،
واستَـخـْوِنـْكُـمْْ،
واتعرّى يـِمـْكـِنَ اطـَفـَّشـْكُـمْ،
وأبويَا النِّمر يفكّركمْ:
زى ما هوَّه بياكل التعلبْ،
أنا باكل الفارْ.
لكنى لمّا بقيت إنسانهْ:
باكـُـلْ نفسِى
وباحَلـِّى بميّةْ نارْ،
(4)
ما تخافُوا بقى منَّى وتتفضّوا
مِنـتــِظْرينْ إيه؟
.. لسّه الحدوتةْ ما خُــلـْصـِتْـشِى؟
”ما لْهاش آخر”؟
(طب قولىّ كان فين أولها ؟…،
أو مين كان أصـْلهُ اللى قايلها؟)
بتلوّح بالحضن الدافى ؟
طبْ هِهْْ …!!
راح اسيبْ.
(6)
أنا جِسمى اتبعزقْ،
زىّ فطيرة مشلتتة لسّهْ ما دخلتشِى الفرنْ.
…….
يا حلاوةٍٍ الحنّيةْ الهاديةْ الناديةْ:
لا بْتسألْْ مينْ؟ ولاَ ليهْ!!
وانا برضه نسيت أنا فينْ،
… وانا إيهْ؟
ولا عادْْ لى إيدْْ ولا رجلْ
ولا عارفه اتـــلمْْ.
(7)
ولإمتى كده؟؟
لأ مش قادِره.
أصـْل انـَا خايفه
أنا خايفه موتْ،
إخص عَــلىَّ،
خايفهْ من إيه؟
من لمس أْْيدين أيها واحدْ.
بيحب صحيح !
أهى كِـدا باظتْ،
باظت منّى،
رِجعتْ “لكـنْ”:
رجعت “لأّه”،
رجعت “مش ممكن”، “لأ لسَّه”
خايفه تِـفْـعـَصـْنـِى يا روح قلبى،
وتقولّـّـى باحبْ !!
ما هو كل الناس بيقولو زيك، قال إيه:”بنحبْ”
ولا واحد فيهم يقدر يسمع دقة قلب
إيش عرّفكمْ باللِّى ما كانشِى،
باللِّى ما لُوهشِى،
باللِّى ما بانْــشىِ.
عمّاله باحـْسبْْ هـَمـْس حـَفِيفـْكـُمْ.
باحـْسـِبْ خوْفكُـمْ.
خوفـِى مـِنْـكُـمْْ.
مخّى مصـَهـْللِ، وبـْيـِتـفرّج،
ولا فيش فايدة.
(8)
نـطـّ منّى، غصب عنّى،
بص برّقْ؛ بيعايرنـِى
“…سِـبْتي ليه ..؟؟؟؟!!! “
هوّا مين ؟
هوّأ إيه ؟
شككنى فى الكُـلْ كليـِلهْ.
رجّعنى للوِحدة النيلة!
لمَّيـْتـنِى، وياريتْنِى لقيتْنى.
(9)
فينك يا مّه؟
نفسى اتكوّم جوّاكى تانى،
بطنك يامّه أَأْمـَنْ واشرف من حركاتـْـهم.
– وانْ ما قدرتيشْْ؟
=”إلموت أهون”.
– وان ما حصلشِى؟
= تبقى الفُرجَة، وْشـَكّ الغُــرْبـَة، وشـُوكِ الوحـْدهْ.
– طب ليه !!!؟؟؟ طب ليه ؟؟!!! ؟
= ” أهو دا اللى حصلْ”.
(10)
راجعه ْ “كما كُـنْـتْ”
قاعْده استنى،
وانا باتمنى،
….
اخطــفْ حتة ْ نظرةْ ْ،
أو فتفـُوتـِةْ حُـبْ
لا حافتـّش فيها،
ولا حاسأل مين اللى راميها
واجرى آكلها لوحدى
تحت الكرسى الـْ”مِش باين”.
ما هو كله ضلام فى ضلامْ
والكدْب ما لوش عنوانْ
وبعـد
هذه التعرية الصارخة، لا ينبغى أن تشككنا فى قدرة الإنسان على الحب، هى فقط تنبهنا لصعوبة المسيرة، وضرورة احترام أصل الحكاية.
ثم ها نحن نرى كيف تتكامل النصوص بكل لغة ومن كل مصدر، لتعلن نفس الموقف، ربما تحفز إلى حركة أصوب، حتى ولو كانت فى اتجاه أصعب، لكنها المعرفة الأعمق.
إن التركيز على الجانب الظاهر لما نريد، دون التعمق فيما وراءه من ضرورة أحتواء أصل الجدل الحيوى والتطور الخلاق، لا يحقق نموا بشريا، ولا واقعا متطورا ، ولا إنسانا جميلا، لكن علينا أن نتقبله، ونفرح به، دون أن نركن إليه، أو نتوقف عنده، فهو لازم حتما لتنظيم جمعى فوقىّ ضرورى بشكل أو بآخر.
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى