نشرت فى روز اليوسف
7 – 10 – 2005
سلسلة الإنسان
أ.د.يحيى الرخاوى
أما قبل
“فطرة الله التى فطر الناس عليها”. وصلتنى تلك الحقيقة من كل مصدر، حتى تيقنت أن الإيمان هو أصل فى الوجود البشرى البيولوجى الكيانى الممتد. الفطرة لغة هى”..الطبيعة السليمة لم تُـشَبْ بعيب ..” (الوسيط). هذه الفطرة تتجلى فى الأديان عبادات وعقائد : المعتقد يخاطب العقل الظاهر كما نعرفه، أما العبادات فهى تحرك نبض الإيمان مباشرة من خلال الجسد والحركة والجماعة، تفعل ذلك بانتظام وتكرار لتنقية الوعى السليم نحو ما خلق به، وما خلق له. من هنا يمكن القول: إنه لا فائدة من العبادة إلا العبادة نفسها، وما يترتب عليها من رحابة وتسامح وإبداع وتواصل إلى غاية ما تعد به الفطرة فى رحاب الكون الأعظم نحو وجه الحق تعالى، الذى ليس كمثله شىء، وهو السميع البصير.
 مناسبة تكرار ذلك الآن هى محاولة التذكرة بأننا نصوم لأن ديننا قال ذلك، لا أكثر، نحن لا نصوم إذن، من باب الرجيم أو لتقوية الإرادة أو لخفض السكر فى الدم أو لعلاج آلام المفاصل…..، الناس تحتاج إلى الإيمان لتصوم، كما تحتاج للصوم لتزداد إيمانأ، هذا هو كل ما فى الأمر.
مناسبة تكرار ذلك الآن هى محاولة التذكرة بأننا نصوم لأن ديننا قال ذلك، لا أكثر، نحن لا نصوم إذن، من باب الرجيم أو لتقوية الإرادة أو لخفض السكر فى الدم أو لعلاج آلام المفاصل…..، الناس تحتاج إلى الإيمان لتصوم، كما تحتاج للصوم لتزداد إيمانأ، هذا هو كل ما فى الأمر.
حكايات وأغانى: عن الفطرة والأطفال(1)
“ربّى كما خلقْتَنى…!!”
لابد أن نفرق ابتداء بين تصويرنا للطفل كيانا بريئا ساذجا غُفْلا، وأحيانا أبلهاً، وبين حقيقة الطفل مشروعا بشريا واعدا يتجاوزنا – كبارا – نموا وتطورا؟ لابد-كذلك- أن نتذكر أننا إذ يتقدم بنا العمر، لا يتقدم على حساب ما هو طفُل فينا. المفروض أننا لا نحذف طفولتنا لنحل – كبارا- محلها، وإنما أن نتقدم فى العمر بأطفالنا فينا، فى جدل مستمر، وليس مجرد تبادل نوْبى.
وأخيرا: فإن البدائية غيرالفطرة، بل تكاد تكون عكسها، البدائية تشير إلى مرحلة كامنة قديمة قابعة متربصة بين جنباتنا، بقدر ما هى خارجنا عشوائية فجة تتمثل فى مجتمعات مغلقة مهملة منسية، وملغاة فى مكان جغرافى ما، على جانب من الدنيا الواسعة. وهى – البدائية – يمكن أن تنقض علينا فى أى وقت منفصلة عن باقى ما هو نحن. أخطر أنواع البدائية هو ما لبس ثوب المدنية القاتلة القاسية الميكانيكية العمياء المتعملقة (فى العراق أو فلسطين أو أفغانستان مثلا)، مثلها فى القبح والخطر: البدائية التى تدعى لبس ثوب الدين، وهى تختبئ وراء دروع تفسير خاص لكلماته، لتنفجر فى نفسها وفى الآخرين، غباءً، وفناءَا.
الفطرة السليمة عكس ذلك تماما، الفطرة هى “المشروع البشرى التطورى”. هى البرامج البيولوجية الجاهزة للجدل، الحاضرة نبضا فى الإيقاع الحيوى طول الوقت، طول العمر. الفطرة هى أصل وقوانينَ وبرامجُ ونبضُ وحركةُ وجدلُ معا.
لكل هذا نقول: إن الإيمان إنما يتجلى فى انطلاق الفطرة السليمة : “فطرة الله التى فطر الناس عليها”.
 كل هذا يبدأ منذ الطفولة الباكرة.
كل هذا يبدأ منذ الطفولة الباكرة.
 السؤال العملى الذى يطرح نفسه بإلحاح بعد هذه المقدمة يقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف نرعى الطفل الذى يمثل هذه الفطرة أكثر، وكيف نحافظ عليه حتى يصير وعينا “بنا-إليه” هو سبيل الإيمان السليم؟
السؤال العملى الذى يطرح نفسه بإلحاح بعد هذه المقدمة يقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف نرعى الطفل الذى يمثل هذه الفطرة أكثر، وكيف نحافظ عليه حتى يصير وعينا “بنا-إليه” هو سبيل الإيمان السليم؟
الطفل يولد وهو يحمل كل يقين برامج فطرته القادرة على بسط نفسها فى الاتجاه الصحيح . فى الحديث الشريف “..ما ن مولود إلا يولد على الفطرة، وأهله ..إلخ” . إذن: كيف نحسن الاستماع إلى تلك الفطرة، بدلا من أن نشكلها قسراً فيما هو ضدها من أوهامنا وضلالاتنا؟ كيف نحافظ على سلامة خطى أطفالنا “بها/نحوها” برغم أننا نزعم أننا نخاف عليهم، فى الحقيقة نحن نخاف منهم؟ نخاف منهم أن يحركوا أطفالنا داخلنا؟ أطفالنا الذين قتلناهم أو نسنياهم أو شوهناهم.
نستمع إلى هذا الطفل أولا وما دار بينى وبينه بعد حادث الأقصر الإرهابى المشئوم.
حكاية(1): الله أكبر
النص: (نشر النص فى 26/11/1997)
(حين سمعت خبر الاعتداء على السائحين بالأقصر) ” … هبطت بى الأرض جزعا وكأنى أتكوم، حططت على أريكة غاصت بى حتى كدت أنفذ من قعرها، وضعت يدى على خدى وصمتّ، ولاحظت زوجتى ما حل بى فسكتت، فهى تعرفنى حين أحزن هذا الحزن فلا أنبس، لكن حفيدى “على” (أربع سنوات) -… تقدم و قال لى فى حذر:”جدى إنت زعلان؟”, رددت فى اقتضاب “أيوه”, فلم تكفه الإجابة إذ يبدو أن جلستى ووجهى بيّنا له درجة من الحزن فوق تصوره، فتمادى:”إنت زعلان قوى؟” , فكررت ردى بنفس الاقتضاب ومازالت يدى على خدى، والأرض تغوص بى أكثر فأكثر: “أيوه”, لم تكفه الإجابة برغم أن صوتى كان أعلى، يبدو أنه لم يَخَفْ، فمضى يقول:”إنت زعلان أكتر من كل حاجة ؟”, قلت بنفس الطريقة، و بصوت أعلى :”أيوه”, وكدت أزيحه بيدى بهدوء بعيدا عنى حتى لا أضطر إلى نهره جدا. يبدو أن حزنى كان أوضح وأشد من أن يجعله يدعنى وحدى، فاستمر مندهشا متعجبا: ” إنت زعلان أكبر من كل حاجة؟ يعنى أكبر من ربنا ؟” فقلت مفحما: لا “, فقال على الفور: أيوه كده، عشان ما فيش حاجة أكبر من ربنا . فهدهدت ظهره ولم أستطع تقبيله، لكن رسالته وصلتنى. ….
القراءة
.. حين قرأت هذا النص الآن بعد ما يقرب من عشر سنوات رحت أتساءل عما نفعله بأطفالنا الذين يقولون بتلقائية مثل هذا الكلام فى سن 4 سنوات، ثم نراهم عكس ذلك تماما بعد خمسة عشرة عاما أو عشرين؟؟ لم أربط آنذاك بين حفيدى فى الرابعة من عمره، وبين “القتلة /الضحايا” الذى دارت حولهم هذه الحكاية. ألم يكونوا يوما ما أطفالا مثل هذا الطفل؟. ما الذى يجرى لهذا الطفل حين يكبر؟ لماذا لم تصل هؤلاء الشباب القتلة تلك الحقيقة البسيطة التى أوصلها لى “على” أن “الله أكبر”، فخفف عنى بكل يقين، لقد كان أحرى – لو وصلهم مثل ذلك- أن يكونوا غير ذلك. “الله أكبر” !!! تلك الكلمات نقولها فى الأذان، وفى كل تكبيرة صلاة، ومع كل ركعة، وسجدة، وفى حروب التحرير، وعند مواجهة الظلم، لكن يبدو أننا نقولها ونحن منفصلون عنها. هؤلاء الشباب القتلة من الأقصر إلى شرم الشيخ قد يكونون قد قالوها مئات الآلاف من المرات دون أن تصلهم أصلاً، بل ربما هم قالوها وهم يطلقون رصاصهم،أو يفجرون أنفسهم. الله أكبر فى المكبرات ربما تخترق الليل ولا تصل إلى وعيهم، تخترق الظلام لكنها لا تضيئ بصيرتهم لأنها تصلهم مغتربة عن حركية الفطرة إلى وجه الله. “، الله أكبر المفرغة من معناها وفاعليتها تخترق السكون فلا تحركه، وإنما تجمده فى تعصب متشنج جاهز للتفجر فالقتل، فى حين أن “الله أكبر” التى قالها لى حفيدى، والتى نرددها فى كل صلاة، وفى كل أذان يحترم الناس ليلا ونهارا، ، هى أكبر من كل ذلك ومن غير ذلك.
حكاية (2)
نتعلم منهم ونحن نعلمهم
فى تجربة جديدة، طلب منى أحد الزملاء الأصغر أن اكتب له تقديما لكتيب للأطفال من سن 8-12 كان يعلمهم من خلاله دروساً بسيطة عن بعض أساسيات الوجود البشرى والسلوك والعلاقات (ملحوظة: هذا الإبن الزميل هو مسيحى جميل). خطر ببالى أن أستلهم من كل فصل كتبه، ما يشبه الأغنية، ربما يرددها الطفل، أو تصله كما تصله، أنا لست أعرف كيف ملأ وعى حفيدى “على” أنه لا يوجد ما هو أكبر من ربنا، هل يا ترى من حكايات أمه، أم من تكبيرات الأذان؟ هل لاحظ تكبيرات الصلاة من أهله الذين قد يكونون أقل انتباها منه إليها؟ الأرجح عندى أن الأطفال تصلهم أنغام وإيقاع وتراتيل الكلمات مع وبدون معانيها اللفظية الموصى عليها، لا أستثنى من ذلك قراءة القرآن الكريم بل لعلها أولى بذلك، لابد وأن ذلك الإيقاع النابض – إن كان فطريا إيجابيا – يحرك الوعى فى اتجاه ما خلق له، سواء فهمنا الألفاظ تحديدا، أم لامست الوعى فى سلاسة كما حدث لحفيدى مع “الله أكبر”، ثم هى تشرق فينا لاحقا حين نحتاجها.
حين حل شهر رمضان، تذكرت هذه النصوص التى كتبتها للأطفال، وتصورت أنها يمكن أن توصل للأطفال بداخلنا (و خارجنا) ما يساعد على تنقية الوعى فى اتجاه إطلاق نبض الفطرة كما خلقتْ لما خلقت له.
الاقتراح الذى أقدمه للقارئ معى هو أن نقرأ النص ونحن ندندنه بأقل قدر من الفهم، نقرأه بأطفالنا داخلنا، ثم بعد ذلك يمكن أن نقرأ النقد الموجز (القراءة) بعقولنا المتحفزة لفهم أكثر تفصيلا، أعتقد أنه لو أيقظ النص المنغم أطفالنا فينا بدرجة كافية، ربما لا نحتاج لقراءة النقد بعده، وربما كان هذا أفضل.
النص:
الكلام الحلو عمره ما يبقى حلو،
لو فضل دَشّ وخلاص
الكلام الحلو هو عهدنا،
مع ربنا
نفسى احافظ عَالأمل
والكلام الحلْو، عمره ما يبقى حلو،
إلا لمّا يتعملْ
شفتنى إبنك، لكنك لسّه إبنى
يبقى ممكنْ إحنا نتصاحب ونِبْى
ويّـا أولادى وأحفادى وبناتى
ويـّا شوَفَانى، وأَّيامى، وآهاتى
……………………..
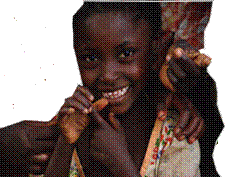 كنت قرَّبت أقول ما عادْشى فايدة
كنت قرَّبت أقول ما عادْشى فايدة
إنما لْقيت العيالْ، ويّا البناتْ: همّا الفراودة
قلت يالله – رغم كله- ناخدها جـَـدْ
ما لقيتشى الحارة سدْ
ياللا نعملها سوا : بكره وِ بعُدهْ
مِالنهارده، الحلوِ برُضهْ،
لو نحطّه على بعضُـهْ،
القراءة
هل لاحظتم معى ذلك الكم الهائل من الكلام والنصائح والمواعظ الذى نغرق به – نحن الكبار – وعى أطفالنا بمناسبة، وبدون مناسبة؟ هل زاد كل ذلك الآن فى مناسبة رمضان مثلا ؟ .نحن نفعل ذلك ونحن لا ندرك محدودية فعل الكلمات الخطابية إن هى ظلت كلاما عاليا معادا فحسب. إن الطفل إذا لم ير الكلمات حراكا ماثلا أمام وعيه تصبح الكلمات عبئا عليه لا هاديا له “الكلام الحلوعمره ما يبقى حلو، إلا لمّا يتعمل”، طفلنا لا يتوقف عند ألفاظنا وخطبنا ونصائحنا، هو يغوص فى أعيننا فيقرأها هى وما وراءها، وهو يستنشق روائحنا، وهو يحدس ما بضمائرنا. فى رمضان – مثلا – يستمع الطفل إلى حديثنا عن فوائد الصوم وأنه يذكرنا بجوع الفقراء..الخ، ثم لابد أنه يحتقر هذا الكلام – وربما يحتقرنا – حين يرى ما يراه على مائدة الإفطار.
الإشارة الثانية الواردة فى النص، والتى قد لا ينتبه إليها معظم الكبار هى أنه: لو أحسن الكبار الإنصات لما يقوله الأولاد والبنات (الإنصات الحقيقى، باحترام حقيقى، وبلا تفويت من أعلى)، فلربما يكتشفون ما أكتشفه عادة مع أحفادى (ومرضاى)، حين أتعلم منهم، فيكونون هم الوالدين وأنا الأصغر، لكن علينا ألا نبالغ فى هذا الاتجاه ، فننسى حاجتهم المتجددة إلى الدعم الأبوى الصريح ، من هنا لا بد من الاستدراك، “شفتنى إبنك لكنك لسه إبنى” ، ..إلخ
كذلك، ومن منطلق إنصاتٍ آخر لحركية انطلاق الأطفال، يمكننا أن نعالج اليأس الذى يلاحقنا وهو يلوح لنا برفاهية الانسحاب، وخدر “اللاجدوى”. فطرة الأطفال الجاهزة للحركة والنماء تحت كل الظروف، لم يصلها خبر خيبتنا أو استسهالنا الذى يبرر لنا اليأس والتبلد. لتكن البداية منهم (همّا الفراودة) احتراما لحقيقة بسيطة “أنهم ولدوا” (أحلى حاجة فيها هيّا إنى عايش).
إن الذى يجعل الكلام، العلاقات، وتبادل الأدوار، حقيقة ممتدة، هو أن يجمع كل ذلك قاسم مشترك عام يتجمع إليه الكبير قبل الصغير . هذا القاسم المشترك هو أشبه بالعقد الإيمانى الاجتماعى معا الذى يتجلى فاعلا حين يستشعر الجميع أن التعاقد هو بين البشر كافة، لأنهم بشر، وليس بين طرفين فحسب، هو عهد مع الحق سبحانه وتعالى، بمشاركة الأطراف المعنية، هذه العلاقة فيها ما يذكرنا بالفرق فى نوع التواصل تحت مظلة أكبر وبين نوع التواصل الثنائى المنغلق، وكأن العلاقات البشرية المحدودة بين اثنين أو جماعة متماثلة تصبح أقوى وأجمل حين تمتد للأكثر ، كذلك هى تصبح أكثر أمانا وثقة حين تكون أنغاما فطرية خلاقة، فى لحن كونىٍّ ممتد، أظن أن هذا هو المعنى الذى يصلنى حين أتذكر كيف يجتمع اثنان “على الله”، ويفترقان “على الله” (اجتمعا عليه، وافترقا عليه)، المسألة لا تحتاج إلى تفسير أكثر من ذلك، أتصور أن هذا نوع من العلاقات الأجمل لنغمات الوجود البشرى الذى لم يشوه (الفطرة) وهى التى تتجمع فى لحن الكون الممتد تلقائيا -عبر البشر- إلى كرسيه تعالى الذى وسع السموات والأرض.
حكاية (3)
أسئلة الأطفال فلسفة عملية
 توارت الفلسفة الفعل، الحقيقية، وراء ما تسمى الفلسفة الكلام وشبه الفلسفة، توارت فى صفحات الكتب، وأحيانا فى قاعات المحاضرات، أو فى بعض الرسائل الأكاديمية. الأطفال ليس لهم شأن بكل ذلك، هم ما زالوا يسألون نفس أسئلة الفلاسفة الأصيلة، يسألون عن الحياة، وعن الموت، وعن الأصل، وعن المصير، نحن عادة نجيبهم بأجوبة حاسمة ومطلقة، وبيقين لسنا نحن على يقين منه، نحن نتصور (ربما دون أن ندرى) أننا نستطيع أن نخدعهم كما خدعنا أنفسنا فى أعماق أعماقنا، لكنهم يعلمون ذلك دون تصريح منا أو منهم، نحن لا نعلم – غالبا – أننا لا نعرف حقيقة ولا يقينية الأجوبة التى نجيبهم بها عن تسائلاتهم الطفلية الفلسفية المقتحِمة.
توارت الفلسفة الفعل، الحقيقية، وراء ما تسمى الفلسفة الكلام وشبه الفلسفة، توارت فى صفحات الكتب، وأحيانا فى قاعات المحاضرات، أو فى بعض الرسائل الأكاديمية. الأطفال ليس لهم شأن بكل ذلك، هم ما زالوا يسألون نفس أسئلة الفلاسفة الأصيلة، يسألون عن الحياة، وعن الموت، وعن الأصل، وعن المصير، نحن عادة نجيبهم بأجوبة حاسمة ومطلقة، وبيقين لسنا نحن على يقين منه، نحن نتصور (ربما دون أن ندرى) أننا نستطيع أن نخدعهم كما خدعنا أنفسنا فى أعماق أعماقنا، لكنهم يعلمون ذلك دون تصريح منا أو منهم، نحن لا نعلم – غالبا – أننا لا نعرف حقيقة ولا يقينية الأجوبة التى نجيبهم بها عن تسائلاتهم الطفلية الفلسفية المقتحِمة.
حين قرأت النص التالى تصورت أننى كتبته مجيبا عن بعض أسئلة الأطفال اللحوح، مثلا:
ما هى الحياة؟ ما هو أهم شىء فى الحياة ؟ هل صحيح أن المصريين طيبين؟ كيف نواجه مرارة الحياة ؟ لماذا نخاف من المجهول؟ إلى أى مدى يمكن أن نرى داخلنا (نتعرى أمام أنفسنا؟)، مالذى نخافه أكثر: أن نتحرك ونحن لا نعرف إلى أين؟ أم نطل منَّومين مفضلين الأمان الساكن؟ هل نحن الذين نتحرك فى الحياة أم أن الحياة تحركنا بطبيعتها؟ ما هى حقيقة علاقتى – فردا – بالأخر، بالناس؟ كيف أكون نفسى وأكون فى نفس الوقت معتمدا على غيرى؟ الله أكبر كبيرا إلى ما لا أعرف ولا أتصور، إلا أننى أشعر به قريباً جدا جدا، أشعر به يملؤنى، “هنا والآن” !! كيف؟
(طبعا تحضرنى كل تلك الأسئلة بعد أن كتبت النص من شهور، تحضرنى بأثر رجعى!!)
إن ما جاء فى بداية النص إنما يعلن أن أهم ما نحتاجه كبنية أساسية فى الوجود هو تحديد أنها “حياة”، وأننا نحياها: “أحلى حاجة فيها هيّا إنى عايش”.
بصراحة: وأنا أقرأ ما بعد هذا البيت ، لم أستشعر أن شرط شعورى بالحياة هو أن أكون “وسط ناسْنا الطيبين”، ويبدو أننى انتبهت فى النص إلى أننى لا ينبغى أن أبالغ فى تقديس هذا الشرط، بل تصورت أن من نتصور أنه ليس طيبا تماما، هو أيضا طيب بشكل ما، وأننى أيضا، وبالذات، نـُصْ نـُصْ…. الخ.
النص
الحياه هىّ الحياهْ
أغلى حاجه فيها هيّهْ،
إنّى عايشْ:
وِِسْط ناسْنا الطيبينْ
حتى ناسنا النـُّـًصْ نُصْ
همّا ناس حلوين بشَاكْل
هما برضه طيبين.
ما انا منهم،
يبقى لازم زيهمْ،
حلو خالصْ
نصْ نصْ،
قلت أتعلم ، وابُصّ:
***
الحياة الحلوهْ حلوهْ
حتى لو مُرّة وتْتأَمِّل شويهْ
راح تشوفْ مرارتها حلوةْ
الحياة مش هيصهْ سايبه منعكشَةْ
الحياة حركة جميلةْ ْ مدهشةْ
بس بتخوّف ساعاتْ
لمّا بتعرِِّى الحاجاتْ
باترعب من خطوتى الجايّة ، ولكنْ
باترعب أكتر لو انّى فضلت سـاكنْ
كل ما بالـْقانى ماشى: ما بَـنَاتـْـكُمْ، : أنبسطْ.
إيدى ماسكة فى إيديُكم، بابقى خايف إن واحدْ ينفرطْ
داللى حلو ليَّا بيكمْ،
برضو حلو ليكو بيَّا
يا حلاوة لو تكون الدنيا ديَّه
زى ما ربى خَلَقْناَ: هِيّا هيّهْ،
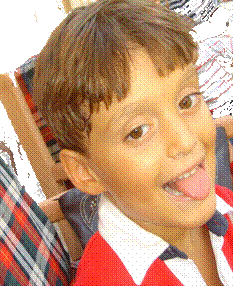 تبقى رايح نحوها، تلقاها جايَّه.
تبقى رايح نحوها، تلقاها جايَّه.
***
الحياة الحلوة تِحلى بْكُلّنا
إنتَ وانَا
كل واحد فينا هوّا بعضنا
بس مش داخلين فى بعض وهربانين
زى كتلةْ قَشّ ضايعةْ فْ بحر طين
كل واحد هوّا نفسُه، بس نفسُه هىّ برضه كلنا
مالى وعيه بربّنا
حين كتبت هذه النهاية لهذه الأغنية أو القصيدة لم يكن يحضرنى الحديث القدسى الذى يكرم البشر بهذا الشكل المباشر. لعل خير ما نختم به هذه الحكايات والأغانى هو بعض هذا الحديث الشريف الذى يقول:
إن الله تعالى يقول: ابن آدم، لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك، ولايزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى احبه، فأكون أنا سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ولسانه الذى ينطق به، وقلبه الذى يعقل به،………”.
صدقونى:
الطفل يعرف معنى هذا الحديث، وحقيقة مصداقيته دون أن يقرأه
فطرته تهديه إليه
الصوفى، الذى استعرت منه عنوان هذا الموضوع يتقرب إلى ربه بذكرٍ يردده قائلا “ربى كما خلقتنى ” “ربى كما خلقتنى” ربى كما خلقتنى”، حين سألته عن ما يعنيه، لم يرد. حين تأملته وجدته يعنى تماما ما يقول دون أن يعرف تفاصيله، رأيته يسعى ” بكل ما هو” إليه، يسعى بدون “ماذا”، ولا “إذن ماذا”؟ يردد مثل هذا النداء كل ساع إلى المعرفة آلاف المرات، دون أن يحدد كيف، ولا “إذن ماذا”، ولا إلى أين “ربى كما خلقتنى”.
ألا ترى معى فى ذلك تفعيلاً للفطرة دون إلغاء العقل. “ربى كما خلقتنى”، ألا يشير هذا الترديد الهادئ المتزايد عمقاً إلى بعض تجليات ما جاء فيما سبق.
هل تجّرب قبيل الإفطار؟ أو بعده؟ دون أن تملأ بطنك لو سمحت ؟
هيا …..
عذرا: ….
وكل عام وأنت وأنا ونحن : كما خلقنا الله
ما أمكن ذلك.
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى
