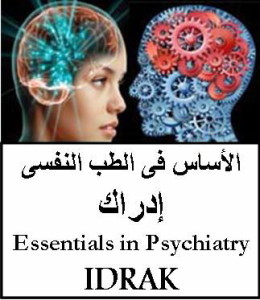نشرة “الإنسان والتطور”
7-2-2012
السنة الخامسة
العدد: 1621
الأساس: الكتاب الأول: الافتراضات الأساسية (47)
الإدراك (8)
الحوار يتواصل حول الإدراك (5)
د. محمد يحيى الرخاوى
يـرد
مقدمة:
أنا الذى أشكرك ليس فقط لأخذك المسألة بكل هذا الجد والإتقان، ولكن بما أتعلمه منك رغم صعوبتى الأزلية فى التلقى تلميذا (إلا من مرضاى، غالبا لأنهم لا يقصدون تعليمى).
مرة أخرى ، قررت أن أنشر ردك مستقلا ليملأ نشرة اليوم كاملا دون تعليق، علما بأننى لا أعرف إن كنت أستطيع التعليق على كل ما جاء فيه أم لا، أخشى ما أخشاه، أن ينصرف الأصدقاء – إن وُجِدُوا- ويعتبروننى قد خرجت عن الخط كعادتى، حتى لو كنت أتمحك بك لألتقط أنفاسى، قبل الدخول فى الفروض الأصل.
ثم أذكر أنك أنت الذى أسميتها “ورقة”، علما بأنى لا أحب هذه الترجمة من Paper الانجليزية، لأن الورقة فى العربية هى ورقة كتابة أو ورقة شجر، ربما أفضل كلمة “مداخلة” أو “أطروحة”، لست متأكدا ولا متمسكا.
لكن بصفة عامة فقد أفرحتنى ردودك حيث وصلنى منها كل هذه الشجاعة والمرونة والأمانة والدهشة ومواصلة السعى،
ثم إنى رحبت بحضور مولانا النفرى وإن كنت يا محمد أخجل وأتحرج كلما استشهدت به أو ألمحت إليه برغم أن “موقف الإدراك” كان من دواعى تساؤلى “من أين نبدأ“، لكنه حين يتكلم عن الحرف مثلا أتوقف عن ترجمة أى لفظ من ألفاظه إلى ما يحضرنى حتى لو كانت كلمة “لغة” أو “مسافة” وأنت لك الفضل أن نبهتنى باكرا إلى العدول عن تفسيره هذا التفسير شبه العلمى وأنا الذى أنهى عن حكاية تفسير أية منظومة بآخرى لكل منهما حضورها المستقل المتميز، خاصة إذا كانت منظومة مقدسة، علما بأننى أعتبر مواقف ومخاطبات النفرى فى مثل هذه المرتبة.
ولكن دعنى أقدم ردك الأول اليوم، ثم الملحق غدًا (الأربعاء) فقد وصلنى متأخراً، ثم نرى.
(يا ترى يا محمد هل سيحضرنا أحد؟)
* * * *
1- الشكر واجب، ومهم، على كل هذا الاحترام والتقدير والتواصل مع مداخلتى التى أتحفظ على تسميتها ورقة على ما فى ذلك من تقدير؛ إلا أن ما هو “ورقة” فى نظرى كان يحتاج إلى جهد تنظيم وبناء وصياغة أكثر كثيراً مما فعلت أو نويت أن أفعل فى تلك المداخلة.
2- وبالتالى، فإننى أتراجع، وبسهولة، عن كثير من التفاصيل والألفاظ التى تحفظتم عليها فى ردكم. على سبيل المثال:
– كلمة “إعطاء” فى “إعطاء معنى” ليست مناسبة ولا معبرة، وإن كنت قد تعاملت معها واستعملتها أساساً لتوجيه النظر إلى دور المدرك فى خلق المعنى، فى مقابل تصور الإدراك بوصفه محض استقبال محايد أو موضوعى، وسواء فى “إعطاء أو وهب، أو إضافة” فالقصد واحد، ولكن أخذنى الحماس.
وأثناء التفكير وكتابة هذا الرد الذى أخطه لكم حالاٍ، كدت أستدرج للخوض فى تراجعات وتصويبات وتوضيحات أخرى، لدرجة أننى تصورت أننى سأكتب الرد فى صورة الحوار الذى تكتبونه، ولكننى أحسست أن هذا سيضيع منا كلاً من: انتباه القارئ ومتابعته، أصل الموضوع، وربما إنتاجية الحوار نفسها. لذلك فضلت أن أقدم لكم –فيما يلى- بعض الإشارات التى تتضمن درجة من محاولة التوضيح، وربما الحوار، وجميعه مازلت لا أسميه ورقة، حتى لو أشرت فيها لبعض ما أعتبره من أفكارى الأساسية.
3- عن التعريفات واللغة: ربما تكون مشكلة التعريف (ومنها تعريف الإدراك بالطبع) هى أكثر المشكلات إبرازاً لمشكلة اللغة، خاصة اللغة العلمية فى العلوم الإنسانية، وكل لغة تحاول صياغة المعنى بشكل شفرى، حرفى، مباشر. المشكلة فى تعريف الإدراك باعتباره “إعطاء معنى” لا تكمن فى كلمة “إعطاء” فقط، بل إن مشكلة كلمة “إعطاء” أهون كثيراً من مشكلة تعريف “المعنى”. وحتى إذا تخلصنا من هذه الصيغة وعرفنا الإدراك بأنه “تعرف على البيئة أو المحيط”، فما هو “التعرف”؟ كيف نعرف “التعرف”؟ دع عنك إعادة النظر الجوهرية التى تنوونها فيما يخص تعريف البيئة أو المحيط أو الواقع، دع عنك العالم أو الوجود أو الكون أو ..إلخ.
دعنى أشير الآن إلى ممارسة لا أتصورها شخصية بل عامة، عامة أكثر بكثير مما نتصور، ولكننى على الأقل أعى أننى أمارسها، وأحياناً بقصد (وهى أيضاً من بعض متضمنات نظرية التعالق).
فى ظل الاعتراف باستحالة الصياغة اللغوية، استحالة التعريف، أنا (كلنا) أمارس درجة كبيرة جداً من “حسن النية” التلقائى تجاه صياغات يمكن نقدها بكل سهولة. على سبيل المثال: كلمة “إعطاء” (أو وهب أو إضافة) لا تعبر، ولكن دلالتها تشير إلى “اتجاه عام” هو ما أوافق عليه، هو ما آخذه منها (هو ما يهمنى لأننى أعتبره الأكثر “تعالقاً”). إنها تشير إلى الاتجاه الذى يتضمن أن الإدراك عملية يقوم فيها المدرك بفعل إيجابى على ما يدركه ليصوغ له معنى، وأن الإدراك لا يكتفى بما هو موجود ليصوره تصويراً كالفوتوغرافيا. هذا الاتجاه العام هو ما يهمنى.
مثال آخر يخص مصطلح “البادى” فى تعريف الإدراك بأنه “إعطاء البادى معنى”. يشير مصطلح “البادى”، فى سياقه الأصلى، إلى ما هو فى متناول الجهاز المعرفى للفرد، سواء كان حاضراً حضوراً لحظياً فى بيئته المعرفية المباشرة، أو كان يمكن الاستدلال عليه مما هو حاضر فى هذه البيئة. حين تعاملت مع المصطلح فى المداخلة السابقة، كان من بين بين قصدى أن أمتد بهذا الذى يشار إليه بـ “يمكن الاستدلال عليه” إلى آخر مداه، وكل مداه، وبالنسبة لى، فإن هذا المدى لانهائى أو مطلق. بالطبع ليس هذا هو قصد المؤلفين الأصليين، وبالطبع لا بد أن أتراجع عن التعريف الذى طرحته فى المداخلة السابقة، ولكننى سأظل لا أتنازل عن حسن نيتى فى القراءة والفهم إلا عندما يتخلى المتواصل معى (الواقعى أو المفترض) عنها.
من الممكن أن يحمل هذا الموقف تهديدات بالتوقف عن النقد والمراجعة وإعادات الصياغة والحوار مع النصوص إلخ، بل قد يهدد أيضاً بالتنازل اليائس عن “اللغة”، إنتاجاً وربما تلقياً. هى تهديدات واردة بالفعل، كثيراً ما أستشعرها حتى فى نفسى شخصياً. إلا أنه أيضاً موقف يحمل تجاوزاً للحوارات الخطية (Linear) وللغة الحرفية، فى اتجاه ما هو إبداع على إبداع، أو ما هو قراءة مثرية مولدة، وهو ما أعرف أنكم تمارسونه بإبداعية فائقة فى قرءاتكم النقدية خاصة، حتى وصفكم البعض أنكم كثيرا ما “بتعمل من الفسيخ شربات”، وأنكم تستنطقون النص ما لا ينطق به. تكفى نظرة سريعة على منهج قراءة تدريبات نجيب محفوظ. ومع ذلك: ولو. فحتى لو كان النص فسيخاً؛ فسيظل الشربات شرباتاً، وسيظل من حق القارئ/المدرك أن يعطى للنص معنى.
بالطبع هذا ليس تعاملاً علمياً مع اللغة. ولكن هل نجح التعامل العلمى؟؟ هل يمكن أن ينجح أم أنه لا بد من تجاوزه حتماً؟؟ هذا السؤال ينطوى على استكمال لتحفظى الأول فى مداخلتى السابقة، والخاص بكثرة تأجيلكم “الدخول فى الموضوع”. فلكأننى أستشعر أن بعض هذا التأجيل يرجع إلى موقف غير محسوم، أو حائر، تجاه اللغة (والمصطلحات والمفاهيم والإبستمولوجيا والتواصل). أستشعر أن هناك تردداً بين تعامل مع الكلمات (كلمات الآخرين وكلماتك نفسها) وكأنها يمكن أن تعبر وأن تصوغ، وعليها أن تفعل بدقة، وتعامل آخر (غير غريب عليكم ولا على لغتكم أبداً) بوصفها “تخليقاً للمعنى” ولحيوية الوجود نفسها، وهو بالنسبة لى تخليق منفتح على وجودية المعنى وواحديته فى آن واحد، تخليق لا تهم فيه دقة الصياغة (بمعنى مطابقتها للمعنى)، حتى وإن كانت “التواصلية” شرطاً جوهرياً لنفى الجنون (هذا موضوع هائل آخر).
دعنى أذكر القارئ الكريم بأمثلة تشير إلى كارثية فقر الوقوف عند الألفاظ والمفاهيم، أمثلة دالة تعرفونها تمام المعرفة. يقول النفرى:
وقال لى: القرب الذى تعرفه مسافة، والبعد الذى تعرفه مسافة، وأنا القريب البعيد بلا مسافة.
أليس هذا خروجاً على الألفاظ والحروف ومنها. إنه يقول فى ذلك:
وقال لى: العلم الذى ضده الجهل علم الحرف، والجهل الذى ضده العلم جهل الحرف، فاخرج من الحرف، تعلم علماً لا ضد له، وهو الربانى، وتجهل جهلاً لا ضد له، وهو اليقين الحقيقى.
أى معنى يمكن أن يصوغه القارئ/المدرك لمثل هذا؟ كيف يمكن إدراكه/ صوغ معنى له؟، هل يمكن إدراكه؟ وماذا يعنى الإدراك عندئذ؟؟ كيف يمكن التعبير عنه “علمياً”؟؟
4- عن المعرفة الهشة (واللغة أيضاً): دعنى أستغل فرصة الحديث عن اللغة العلمية وعن دقة الصياغة لتوضيح درجة اهتمامى واعترافى واتفاقى العميق معكم فى أهمية المعرفة الهشة بتعبير آرييتى، والذى أراه تعبيراً أجمل من المعرفة الضعيفة لسبيربر وويلسون، ولكنه ليس بالضرورة أجمل من المعرفة المبهمة الذى أستخدمه [الله!! موش قلنا الألفاظ موش مهمة قوى يعنى؟؟!!]. بل سأحاول استغلال ذلك لأمتد إلى الاتفاق معكم حول الفروق بيننا وبينهم (المتقدمين العلميين الأفاضل)، على الرغم من أننى دائماً ما قاومتكم فى هذه المنطقة خاصة.
سأضرب مثالاً تافهاً، كثيراً ما استخدمته من قبل فى سياق الدراسة الأكاديمية:
-عايزة تخشى كلية إيه بعد الثانوية؟
– كلية الهندسة وكده
فلأنظم الأمر بأن أقول إنه ثمة 3 مستويات لقراءة إجابة الفتاة:
المستوى الأول: بالنسبة للتعامل التقليدى مع [وكده]، لم تكن نظريات اللغة والتواصل ترى فيه إلا إساءة استخدام للغة، لم تكن ترى إلا هلهلة معلوماتية وضعفاً بلاغياً وعجزاً فكرياً وفائضاً لفظياً لا معنى له(1). فى أفضل الأحوال كان يمكن القول إنه نوع من الحشو الخالى من المعنى ولكنه يساعد المتكلمة على استجماع أفكارها لتنتقل إلى صياغة المنطوق التالى (غير المتوافر فى حالتنا هذه حيث إن المتكلمة قد أنهت كلامها بالفعل بـ [وكده])، ولكنه حشو يظل -فى كل الأحوال- خالياً من المعنى.
فى الدراسة الأكاديمية، أظهرت أولاً أن تجاهل [وكده] مستحيل، حتى من منظور هذا التعامل التقليدى كما يتجلى فى نظرية المعلومات تحديداً. وكان علىّ أن أقدم تفسيراً آخر، وهو ما فعلت كما يلى:
المستوى الثانى: إن ما تفعله [وكده] هو أنها تخلق انطباعاً قوياً بأن هناك “كلا” لم تغطه أو تنقله عبارة [كلية الهندسة] وحدها، وأن هذا الـ “كل” لم يتمفصل فى ألفاظ الخطاب وبنيته. صحيح أن سؤال السائل كان –تحديداً- عما ترغب محدثته فى دراسته، ولكن من الصحيح أيضاً أن دراسة الهندسة هى جزء من كل “معرفى” أكبر، كل غير متمايز مكانه تلك المنطقة المتسعة وغير المحددة والتى ربما تصوغ فيها المتكلمة أحلامها وآمالها فى المستقبل. لقد أكدت [وكده] تلك الكلية المبهمة غير المتمفصلة، لقد أكدت ما هو معروف ضمناً من أن [كلية الهندسة] هى جزء من المجال المعرفى الذى يحضر فى ذهن المتكلمة وهى تنظر لمستقبلها، تمثل دراسة الهندسة جزء من المستقبل الذى تأمله المتكلمة وليست كله، وقد برزت هذه الحقيقة فى المنطوق فلم تنفصل فيه إجابة السؤال [كلية الهندسة] عن كلية المجال المعرفى الحاضر –ولو بضعف وإبهام- فى ذهن المتكلمة عن مستقبلها [وكده].
يرى علماء النفس الجشطلتيون أنه:
“فى كثير من المواقف؛ تستمد الأجزاء طبيعتها ووظيفتها من الكليات التى تندرج فيها، ولا يمكن فهمها بعيداً عن هذه الكليات. كما لا يمكن أيضاً فهم تلك الكليات الدينامية بوصفها مجموعاً (حاصل جمع) لمكونات موضعية مستقلة. إن العمليات التى تحدث فيهما (الكل وأجزائه) هى دوال للتفاعلات الحادثة فى المجال الإجمالى المتعالق.” (Wolman, 1973: 159)
وهكذا نتوقع -فى العديد من مواقف التواصل اللفظى خاصة- أن نواجه بحاجة ملحة لتواصل هذا الكل, أو على الأقل للإشارة إليه؛ وإلا فلن يحيط المنطوق بالمعنى المعيش فى الخبرة الشعورية للمتكلم فى كليتها واكتمالها، لن ينقل المنطوق أو يصوغ أو يعبر عن “المعنى الدقيق والكامل” كما هو حاضر فى الخبرة الشعورية الكلية. وفى المثال الذى نتناوله لم يكن التلفظ [كلية الهندسة] كافياً للمتكلمة لكى تشعر أنها تواصلت الكل الذى تشعر به، أو الجشطلت بالتعبير الاصطلاحى. لم ينجز تلفظ [كلية الهندسة] وحده تعبيرها عن الكل الذى تعيشه ويشكل إجابتها (أو استجابتها) عن السؤال المطروح، ذلك الكل الذى هو أكبر من مجموع أجزائه، أما [وكده]، فما فعلته هو أنها أشارت إلى هذه الحالة، حتى وإن كانت الإشارة شديدة الإبهام.
المستوى الثالث: كان ما سبق (فى المستوى الثانى) هو أقصى صياغة أستطيعها فى السياق العلمى الأكاديمى، وكان علىَّ ربطه ودعمه بمفاهيم علمية أخرى عديدة. ولكننى الآن أرغب فى الإشارة إلى مستوى ثالث لا أستطيع تجاهله.
تقتصر حدود وصف اللغة العلمية لمتضمنات [وكده] على مجال معرفى يمكن وصفه (مستقبل المتكلمة) وتصور بنوده، أى تصور حضوره ولو بإبهام، ولو بضعف. أرغب الآن فى استغلال رحابة هذا الموقع (أقصد موقعكم الإنترنتاوى هذا)، واستعداده للمغامرة، وإبداعيته المتواصلة، لأشير إلى المستوى الثالث الذى لم أستطع الإشارة إليه فى الأكاديميا:
فى هذا المستوى؛ تشير [وكده] إلى انفتاح لانهائى على المشترك التواصلى الذى يتم إنجازه من خلال اشتراك كلا المتواصلين فى “الاستمتاع” بها، أى بـ [وكده]، وفهمها (أياً كانت طبيعة هذا الفهم). هنا انفتاح على خبرة هذا “الوجود المشترك غير الاصطلاحى”، هى لحظة وجود مشترك سابقة ولاحقة على الاصطلاح (أى على التشفير اللغوى). هى لحظة انفتاح لانهائى لا يتوقف عند عناصر وبنود مستقبل المتكلمة، حتى ولو كانت ضعيفة ومؤجلة، فالكل الذى تعيشه المتكلمة ليس مستقبلها وحسب، إنه “كل” الوجود الذى نشترك فيه جميعاً، كل شىء، الكون كله، والله أيضاً. بالنسبة لى (وهذا تواضع من باب الحذر) يمكن أن تمثل [وكده] محاولة لغوية/تواصلية، “استعانة” لغوية/تواصلية لإدراك [اللحاق بـ هو من معانى الإدراك أيضاً] لحظة تتحقق فيها الأبدية (كما يقول كيركجارد) من خلال هذا المشترك التواصلى غير الاصطلاحى. نجاح أو فشل هذه المحاولة يحتاج لسرد ممتد آخر.
ما علاقة هذه المستويات الثلاثة بالإشارة التى تصدرت هذا القسم (رقم 4) عن رؤيتكم للفرق بيننا وبينهم، وعن موقفى الذى –أحياناً ما- يقترب منكم فى هذا الشأن رغم تكرار مناكفتى لكم؟
أتصور أنهم “لا يحبون” هذا “المستوى الثالث”، وأتصور أن هذا الكره هو –على الأقل- محصلة عامة وسائدة لمجمل توجهات ثقافتهم، وفى هذا يبدو أننى مضطر للاقتراب من موقفكم منهم. ولكن علىَّ أيضاً أن أعترف لهم بتقدمهم التراكمى نحو إدارك علمى للمستوى الثانى، على الرغم من قصوره.
ربما ينبغى أيضاً الإشارة لدريدا، فى حدود فهمى له. يبدو أنه حاول الكشف (من خلال تحليله أو تفكيكه/قراءته لنصوص فحولهم) عن فشل هذه الثقافة فى هذا المسعى للتعامل مع اللغة بوصفها قادرة على الوصف (حتى على المستوى الثانى). أتصور أنه كشف هذا الفشل بأن كشف الانفتاحات اللانهائية، والتضمين غير الممكن تجنبه لـ “الميتافيزيقا” فى الخطاب الغربى. ولكن أيضاً: يبدو أن مسعاه يتوقف عند هذا الكشف والتفكيك، بينما نحن، أو نحن كما ترانا، أو ربما أنت خاصة ترى أنه علينا “البدء من هنا“، بدليل العنوان الذى يحتوى على السؤال: من أين نبدأ؟.
5- تساءلتم -فى ردكم- عما وراء حرصى على توحيد مستويات الإدراك فى إطار وظيفة واحدة [اعتبار أن إدراك أن هذا “كوب”، وإدراك “معنى الكون” يندرجان فى إطار الوظيفة نفسها: الإدراك].
الحقيقة أن هذا الأمر ليس ثانوياً على الإطلاق بالنسبة لتفكيرى. إن إعادة النظر فى تقسيم الوظائف ينطوى على مراجعة جوهرية لفهمنا لها من الأساس. كذلك أعترف: الأمر لا يتعلق بتوحيد مستويات الإدراك فقط، بل أجد فى نفسى ميلاً للتوحيد بين كل الوظائف المعرفية (الإدراك – التفكير – الفهم – الانتباه – اللغة – الإبداع، وحتى الإيمان)، عدا “الذاكرة”.
لا أسعى لنفى التمايزات المفاهيمية وربما ولا الوظيفية بين هذه التجليات المتباينة للنشاط المعرفى، ولكننى أسعى للتركيز على ما يجمع بينها، والذى أتصور أنه يقع فيه، وفيه فقط، ما تبحثون عنه وتحاولون صياغته، أو ربما ما أبحث عنه أنا. أسميه “المعنى”، أو هو –على الأقل- “السعى للمعنى”.
ما “المعنى”؟، وكيف يمكن أن يجمع هذا المصطلح بين معنى “الكوب” ومعنى “الكون”؟
استُدْرِجت فى اليومين الماضيين لمحاولة صياغة إشارات يكفيها المقام لما هو “معنى”، ولكننى وجدت أنها محاولة مسيئة وضارة باختزالها وتعجلها. فقررت الاكتفاء –فى هذا السياق- بضرب أمثلة توضيحية بسيطة، عن الإدراك تحديداً، مهما قصَّرت.
ببداهة لغوية منطقية مباشرة: يشترك إدراك معنى الكوب وإدراك معنى الكون فى “البحث عن المعنى”. فيم يمكن أن يفيدنا هذا الاشتراك؟؟ أستبق بالقول: إن تبصرنا بأن “إدراك الكوب” هو تكوين أو بناء لمعنى، يجعلنا ننتبه إلى فارق هائل بين الإدراك والتذكر/التعرف، فارق أظنه يهمكم بشكل خاص.
التصور المختزل (السائد باستسهال) عن الإدراك ينتمى لإبستمولوجيا الشفرة. هو تصور تسمياتى، اصطلاحى، تصنيفى/سطحى، وصفى، خارجى، لاإبداعى، ناتج عن مغالطة المطابقة (أى عن تصور أن الصورة التى نكونها عن العالم مطابقة لحقيقته). على سبيل المثال: ما الذى يحدث عندما أنظر الآن للكوب فأعرف أنه كوب؟؟ إننى “أتعرف” عليه. قد “أستدعى” أن اسمه كوب، وقد “أستدعى” أنه وعاء للشرب، وقد أقارن خامته بما هو موجود فى الذاكرة فأعرف أنها زجاج، وربما تذكرت أن الزجاج مادة قابلة للكسر. كل هذه صفات ومعان للكوب ولكنها موجودة أصلاً فى الذاكرة، أستدعيها وأطابقها (أو بعضها) عندما أرى الكوب. من الأسهل والأسرع (والأكثر تعالقاً) أن أستدعى كل هذا من الذاكرة، أو “أتعرف” عليه، دون بذل جهد فى “إدراكه” من جديد، أى دون بذل جهد فى بناء المعنى. هو نوع من التعرف على المعروف، فهل نحن نتكلم حينئذ عن “إدراك” أم عن “ذاكرة”؟ (بالمناسبة: التعرف هو الترجمة السائدة لـ Recognition).
فى المقابل، هب أن طفلاً حديث الولادة، ظلت أمه تعطيه السوائل فى كوب بلاستيكى أزرق. مع الأيام والتكرار “أدرك” الطفل الكوب: إنه الشىء الذى يستعمل فى الشرب، الذى “يعنى” الشرب، الذى يرتبط بالشرب. لقد أنشأ الطفل علاقة بين مظهرين من مظاهر العالم (الكوب والشرب). لقد صاغ نظرية عن العالم. لننتبه أيضاً أنها نظرية تحوى أكثر بكثير من أن الكوب هو ما نشرب فيه. هى نظرية تتضمن أيضاً أن فى العالم نظاماً يجعل من الممكن التوقع، هذا النظام الذى يربط باضطراد بين الكوب والشرب (وكثيراً ما يعنى حضور النظام درجة من الأمان). أتصور أنه لا يمكن أن تجاهل أن إدراك النظام فى العالم جزء لا يتجزأ من إدراك معنى للعالم.
أما بعد ذلك، ومع مزيد من التكرار، لم يعد الطفل فى حاجة لإعادة اكتشاف وظيفة الكوب، إنها تستقر وترسخ فى الذاكرة ولا تحتاج إلا استدعاءها الذى هو أكثر اقتصاداً فى جهد المعالجة من إعادة اكتشافها. أتصور أنه من الأفضل أن نقول إنه “يتعرفrecognize ” على الكوب من أن نقول إنه “يدرك” الكوب: إلا فى حالات خاصة، كأن يشترك الكوب فى عملية إدراكية لصياغة نظرية جديدة (لتكوين معنى جديد)، أو أن يتسبب ظرف –وجدانى مثلاً- فى أن يعيد المرء تفاعله الإدراكى مع المدرَك بطزاجة وحيوية تتجاوزان الساكن فى الذاكرة (لإعادة اكتشاف/معايشة معنى).
هب مثلاً أن هذا الطفل، ومنذ ولادته، لم يُستعمل فى شربه إلا هذا الكوب البلاستيكى الأزرق، ولا مرة، هب أيضاً أنه لم ير غيره يشرب من أى كوب آخر، ولا مرة. وفى سن سنة ونصف –مثلا- تعرض الطفل لحادث شرب من كوب آخر، ولكنه هذه المرة كوب زجاجى شفاف. ثمة اكتشاف جديد هنا: “هناك شىء آخر فى العالم يمكن أن يستعمل للشرب”، العلاقة التى سيبدأ الطفل فى إدراكها (وهى ليست علاقة تجريدية فى هذه السن: راجع فيجوتسكى) هى فى حقيقتها جزء من نظرية جديدة (بمعنى لاشعورى/معرفى للنظرية)، أو هى بالأحرى تنطوى على تهديد وربما مراجعة للنظرية القديمة (الشرب مرتبط بالكوب الأزرق)، وعلى الرغم من أنه تهديد فإن له معنى، معنى يتسرب لوعى الطفل، ويمكنه أن يساهم فى إعادة النظر لطبيعة إدراكه/معايشته لانتظامية العالم. هذا الحدث الإدراكى الخلاق أولى بنا أن نرصده عبر مستوياته المتعددة جميعاً فى إطار الوظيفة المعرفية/الحيوية/الوجودية نفسها.
دعنى أضرب مثالاً آخر: إدراك شجرة. كل يوم تصادفنى أشجار بلا عدد، وقد أنظر لإحداها فأعرف أنها شجرة، وأنها كائن حى، وأن بها خشباً وأوراقاً، وأنه يمكننى التظلل بها …إلخ. فى العادة أنا لا أفكر فى “معانى” هذه الصفات والألفاظ كلها، لا أعايشها، ربما تكفينى الألفاظ عن استدعاء صورة أو حيوية المتضمنات. أقول إنها كائن حى، ولكننى لا أفكر فى معنى “الحياة” ولا متضمناتها. أقول إن بها خشباً وأوراقاً ولكننى لا أنفعل بهذا ولا بذاك، ولا أفكر فى تداعيات إضافية، ولا ينضاف على وعيى جديد. إنه كله موجود بالذاكرة ولا يحتاج لإعادة معالجة حية/آنية. كيف أجمع هذا التذكر/التعرف على الإدراك؟
فى حالات أخرى، وهو ما يحدث كثيراً فى حالة السفر خاصة، حين تتحرك الشهوة المعرفية للوجدان، يمكن أن أنظر للشجرة فيفاجئنى طعمها الجديد فى عينى، إنه طعم مختلف، قد أدهش من طولها، وأحترم جذعها الشامخ، وأتعجب من طول عمرها وصبرها على المكان نفسه طول هذا العمر، وتعتمل فىّ مقارنة طبيعة حياتها بطبيعة حياتى، ألا يجمعنا معاً مفهوم/فعل الحياة، وقد أفكر فى علاقتها بالجنس، وربما أجرب أن أتخيل أن لها شخصية، وأن لها تفردها … إلى ما لا آخر له.
يمكن أن يقال إنه حتى الآن لم يوجد “إدراك” حيث لا صياغة لنظرية أو معنى، وأن ما هو موصوف هنا إنما هى استجابات وتداعيات متناثرة لا يجمعها إدراك. أتصور أننا نحتاج لإعادة النظر. فمن ناحية، لا يمكن تجاهل أن طولها، وجذعها، واستنتاجى الخاص بطول عمرها، وتسميتى لما أسميته صبرها …إلخ، كل هذه مفردات إدراكية، وما يجعلها إدراكية هو أنها أولاً لم تأت من الذاكرة، وثانياً هى تحمل “إدراك” معانى الطول، والجذع، والعمر، والحياة، والصبر، وكلها معان/إدراكات تعتمل فىّ بطزاجة متجددة، كما أنه لا يمكن تجاهل أنها قد تعمل أيضاً كمقدمات لبناء إدراكات جديدة يتحقق فيها إبداع نظرية أو معنى. على سبيل المثال: إعادة معايشة إدراك أننى لست وحدى فى الحياة (وهو إدراك، وهى نظرية، وهو معنى، حتى ولو لم يصغ فى لغة)، أو ببساطة أكثر: محض إدراك أن هذه الشجرة حية، ولكن مع معايشة ما تحمله صفة “حية” من معنى لا يقتصر على صفات الحياة الموجودة فى الذاكرة (التى عادة ما لا تستدعى أصلاً). إنه إدراك لا يمكن أن ينفصل عن الانفعال الوجدانى/المعرفى بما هو “حياة”، أى عن إدراك الحياة.
أظنها عمليات مرتبطة، لا يمكن فصلها عن السعى لإدراك معنى الكون، بعض النظر عن مستوى بساطته أو تركيبه وتعقده.
والحديث طال، ولا يمكن أن ينتهى، ولابد أن ينتهى، وما زلت لا أشعر أن هذه الأمثلة تحديداً معبرة بكفاءة، ولم أشر بعد للمجاز فى الإدراك، أو للإدراك المجازى، ولا لدور تكامل المدركات/المعارف فى كل من الإدراكات البسيطة والجسيمة، ولا لعلاقة الإدراك بكل من الحقيقة والتكيف، ولا لتفاعل الإدراك والذاكرة، ولا لإمكان تقسيم الإدراك إلى مستويات (كلها إدراك)، ولا إلى دلالة عامل السرعة فى التفرقة بين الإدراك والتفكير (مثلا)، ولكننى أشكركم فعلاً على هذه الفرصة.
ملحوظة أخيرة: بلغنى من بعض الأصدقاء، أثناء إنهائى لكتابة هذا الذى أكتب، أنكم أشرتم فى حوار الجمعة إلى هذا “الحوار” بعض الإشارات المهمة، ولكننى كنت على وشك الانتهاء، وكنت شعرت بالإطالة الزائدة، فقررت أن أرسل هذا لكم دون قراءة حوار الجمعة، خاصة وأنه ليس تحت يدى الآن. أرجو عذرى وتقبل دعائى.
محمد الرخاوى
* * * *
ملحوظة:
استقبلت دعاءك لى فى نهاية هذه الرسالة بفرحة واثقا أن الله سيستجيب ضرورة وحين كررته فى نهاية ملحقك الذى سوف ينشر غدًا مع إضافة “كثيرا”، تأكدت أن الله استجاب فعلا.
[1] – ثمة احتمال تفسير يجب استبعاده لكى نتمكن من المضى قدماً فى تحليل المثال، وهو أن المتكلمة عنت [أرغب فى دراسة الهندسة أو أى دراسة مشابهة (تكنولوجيا مثلاً)]. واستبعاد هذا الاحتمال يقوم على أكثر من أساس؛ فمن ناحية توفر اللغة وسائل لتحقيقه [مثلا: كلية هندسة أو حاجة زى كده]، ومن ناحية ثانية استعملت المتكلمة حرف العطف [و] وليس [أو]، ومن ناحية ثالثة فإن هذا الاستعمال للتعبير [وكده] متواتر فى عدد كبير من الأمثلة التى لا تحتمل التفسير الذى نرغب فى استبعاده [مثل: عايزين ناكل وكده] أو [رحنا الكلية وكده]، [امبارح اتفسحنا وكده] وهى من الأمثلة الطبيعية
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى