نشرت فى روز اليوسف
7- 4 – 2006
سلسلة الإنسان
أ.د. يحيى الرخاوى
أما قبل
 فرحت بغياب هذه الصفحة عن عدد الجمعة قبل الماضى لسببين: أن ذلك قد أتاح لى فرصة أن أتمهل وأراجع نفسى، لعل الجرعة زادت عن تحمل القارئ الذى ما زلت لا أعرفه، حين بالغت فى تعرية ما يسمى الحب، حتى أصبح بعضه موتا، وبعضه التهاما، وبعضه إلغاء، وكثير منه صفقات خائبة، وأغلبه جوعا، أما السبب الثانى فهو أن الذى حل محل هذا المقال المؤجل، كان مقتطفات من شعر المرحوم الدكتور إبراهيم ناجى، وهو شاعر أحبه، له وعليه: يرق حتى يذوب سامعه فى همس رقته، ويخف حتى “لا تُحتَمل خفته”. الحديث عن الرومانسية وضرورة العودة إليها حديث يستأهل وقفة احترام، وأيضا نظرة ناقدة. إلى أى حد أستطيع أن أوفق بين مسؤولية إبلاغ الناس بعض ما وصلنى من المستوى الأعمق للعلاقات البشرية، وأهمها ما يسمى الحب، وفى نفس الوقت أدافع عن حقهم – حقنا – فى الغفـلة، واللطف, والرقة، والذوبان، والذى منه؟ كل تلك الرومانسية التى أطلت علىّ من شعر ناجى الجميل، والنصف نصف، هى من أطيب ما يضحك البشر به على أنفسهم، ليكن، هذا حقهم، حقنا، ضحكُ مشروع على أنفسنا، خصوصا حين تكون الأمور قد وصلت بهم (بنا) إلى هذا الحد من “قلة الرومانسية” بتلك الجرعة من “قلة الأدب”، قلت هى فرصة جاءت بالمصادفة، أتحجج بها وأنا أقفل ملف الحب، ولو مؤقتا، لأفتح ملفا أقرب إلى تخصصى، هو “ملف الجنون”، وربنا يستر.
فرحت بغياب هذه الصفحة عن عدد الجمعة قبل الماضى لسببين: أن ذلك قد أتاح لى فرصة أن أتمهل وأراجع نفسى، لعل الجرعة زادت عن تحمل القارئ الذى ما زلت لا أعرفه، حين بالغت فى تعرية ما يسمى الحب، حتى أصبح بعضه موتا، وبعضه التهاما، وبعضه إلغاء، وكثير منه صفقات خائبة، وأغلبه جوعا، أما السبب الثانى فهو أن الذى حل محل هذا المقال المؤجل، كان مقتطفات من شعر المرحوم الدكتور إبراهيم ناجى، وهو شاعر أحبه، له وعليه: يرق حتى يذوب سامعه فى همس رقته، ويخف حتى “لا تُحتَمل خفته”. الحديث عن الرومانسية وضرورة العودة إليها حديث يستأهل وقفة احترام، وأيضا نظرة ناقدة. إلى أى حد أستطيع أن أوفق بين مسؤولية إبلاغ الناس بعض ما وصلنى من المستوى الأعمق للعلاقات البشرية، وأهمها ما يسمى الحب، وفى نفس الوقت أدافع عن حقهم – حقنا – فى الغفـلة، واللطف, والرقة، والذوبان، والذى منه؟ كل تلك الرومانسية التى أطلت علىّ من شعر ناجى الجميل، والنصف نصف، هى من أطيب ما يضحك البشر به على أنفسهم، ليكن، هذا حقهم، حقنا، ضحكُ مشروع على أنفسنا، خصوصا حين تكون الأمور قد وصلت بهم (بنا) إلى هذا الحد من “قلة الرومانسية” بتلك الجرعة من “قلة الأدب”، قلت هى فرصة جاءت بالمصادفة، أتحجج بها وأنا أقفل ملف الحب، ولو مؤقتا، لأفتح ملفا أقرب إلى تخصصى، هو “ملف الجنون”، وربنا يستر.
أنا واحد ولاّ “كتير”؟ (13) ملف الجنون (1)
حين ينقلب الـ “كتير” فينا جنونا!!
استدرجتنا حلقات “أنا واحد ولا كتير” الإثنى عشر (هذه هى الحلقة الثالثة عشر) إلى احتمال التسليم أن كلامنا هو “كتير” فعلا، وأن ذلك أمر طبيعى، وغير مرفوض، وأنه – بداهة- ليس جنونا؟ مع أن الشائع أننا كنا بمجرد أن نلاحظ تصرف شخص يترجّح بين النقيض والنقيض، نصِفُـه بالجنون، وبالذات بالفصام، حتى وصل الأمر أن نصف شعبنا المرة تلو الأخرى بهذه الصفة ونحن نتصور أننا بذلك نفسر تخبطه وتشتته. وهذه كلها إهانات للجنون أكثر منها تسهيلا لفهم التناقض.
إن الكثرة فينا، قبل أن نفهم طبيعتنا، هى كثرة مخيفة من حيث المبدأ، حيث أن ظهور هؤلاء الكثير معاً يقترن عندنا غالبا بما نسميه جنونا، ربما لهذا نحن نقاوم الفكرة أصلا، اللهم إلا إذا كان الجانب الإيجابى منها قد اتضح بدرجة كافية مما سبق أن قدمناه، وغيره.
فماذا عن الجانب السلبى؟

نتذكر أولا ما بيّناه سابقا من أن المجال (الملعب) الذى يتحرك فيه الكثير فينا هو الأحلام، كما أشرنا فى استطراد ضرورى من أنه إذا حرم هؤلاء الكتير فينا من الانطلاق فى الحلم بسب الحرمان من النوم، مرضا أو تجريبا أو مصادفة، فإن هؤلاء “الكتير” يخرجون على سطح وعى اليقظة فى صورة تشبه الجنون، وهذا هو أصل ما يسمى الهلوسة، إن ظهور “الكتير” الذين فى داخلنا أمام حواسنا هكذا ونحن فى حالة اليقظة هو من أهم مظاهر الجنون. إن مجرد أن يقول الواحد أنه رأى شخوصا لا يراها غيره أو أنه سمع أصواتا لا يسمعها غيره، هو الذى يقول ذلك أو قد ينبهه من حوله إلى أنهم لا يرون ما يرى، وأنهم لا يسمعون ما يسمع، متى حدث ذلك: فنحن أمام حالة يظهر فيها “الكتير” من داخلنا رغما عنا بطريقة غير مألوفة. فهو الجنون.
إن ما يظهر من تعددنا من داخلنا فى الحلم، هو هو ما يظهر من تعدد فى الجنون التناثرى التفسخى خاصة، وهو الذى ينتج أساسا من فقد قدرتنا على إحكام “حدود الذات” التى تمنع الكثير بداخلنا من مثل هذا الظهور العشوائى فى دنيا اليقظة. فى هذا الجنون قد يصل التمزق إلى تفتيت “الواحدية” ليس فحسب إلى مكوّناتها من “ذوات متعددة”، ولكن يتمادى التمزق إلى الجسد واللغة حتى تتحول الوحدة البشرية ذاتا، وجسداً، ولغةً إلى وحدات متناثرة متباعدة، سواء ظهرت فى تشتت الكلام والأفكار، أم أسقطت على تمزق الجسد وانفصال أجزائه عن بعضها البعض، أم تبدت فى خصام الفكر مع العاطفة مع الفعل، أم غير ذلك. هذا النوع من الجنون هو الجنون الأساس الذى يظهر كما هو، أو يتخفى وراء أنواع أخرى تحاول أن تغطى التفسخ أو تلمّه بدرجات وتشكيلات مختلفة.
نستمع إلى بعض ما تقمصتُه من مرضاى فصِغْتُهُ فى النص التالى:
النجدهْ!
إياكم والنجدهْ!!
……..
السوطُ، السوطُُ، السردابْْ.
المسمارُ الثقبُ البابْ
الوجهُ قفاىْ.
لا أحد يريد أن يتمزق أو يتفرق إلى أبعاضه، حتى المجنون بعد أن يفعلها، لا يكاد يفعلها. فهو يستنجد هنا صائحا “النجدة”، لكنه يطلبها (ليس بالألفاظ) لا لنلحقه فعلا، لكن لإعلان أن داخل داخله قد تَبَيَّنَ الورطة، وفى نفس الوقت فإن ثمَّ آخرا بداخله أيضا وخارجه أحيانا، يسارع بأنه: “إياكم والنجدة”، عادة فى مثل هذه الحال ما إن تُحسن الاستماع إلى صيحة المجنون من داخله طالبا المعونة (ليس بالألفاظ) فتسارع إليه، حتى يقابلك برفض مطلق، فلا تملك إلا أن تستنتج أن مَن صاح “النجدة” هو غير من أخرج لك لسانه يرفضها، هذا التناقض لا يفسره إلا تعدد الذوات حيث تأخذ أكثر من ذات موقع اتخاذ القرار، ولو بالتبادل العاجز تردداً.
المقطع التالى هو إعلان تفاصيل الموقف الذى أدى إلى الاحتجاج المبدئى، ثم وصفُ للضياع الجنونى:
تاريخى ليس بواقعْْْ
وملامح وجهى تشويهٌ فاقعْْْ
والقلبُ المهزوُم يئـِنُّ بحشرجةٍ ثْكلى،
وَحروف الكلمات بتجويف الفمْ،
تَأْبَى أن تَنْعى اللَّفْظَ الميِّت-
تقفز منى الكلمات
ألاحِقُهَا.
ألحقـُهَا،
لا ألحقـُها.
إنكار الواقع جنبا إلى جنب مع إعلان أن ذاته السابقة التى كانت معروفة بملامحها المألوفة، ليست إلا تشويها لحقيقته التى لم يتعرف عليها أحد أصلا. هو إعلان “أنهم صاغوه كما تصوروه، وليس “كما هو” (وملامح وجهى تشويه فاقع)، ولا كما يمكن أن يكون. الموت الذى يعلنه هنا هذا المستغيث الرافض الاقتراب، هو موت قلبٍ يحتضر. الملامح الزائفة المصنوعة من تصوراتهم تـرفض أن يحل محلها ملامح حقيقية تدل عليه بما هو، هكذا يحتضر القلب بحشرجة ثكلى، وتتفكك الكلمات إلى أحرف مشلولة حتى عن نعى المحتضر. أحرف تسعى شاردة فى تجويف الفم عاجزة عن أن تتجمع فى كلمة، أو تتوجه إلى غاية، كما أنه عاجز عن ملاحقتها، أو اللحاق بها، رغم ما تلوِّح به من إمكان ذلك.
يتمادى التفكك والتشتيش إلى الجسد نفسه، لتصبح أجزاء الجسم كيانات مستقلة، وفى نفس الوقت هى ضالة بلا غاية أيضا، وهى تسير لكنها لا تبرح مكانها.
والسيقان العمياء تسير بغير هدًى،
آثار الأقدام تشير إلى طرقٍ شتَّى،
فأسير بكل منها شوطاً.
حين تصل المسألة إلى هذا العجز الظاهرى، تختفى كل المشاعر وراء تمثال بلا ملامح، وفى نفس الوقت لا يظهر الوعى الجديد (إعادة الولادة)، فهو برغم أنه جنين بعد، إلا أنه مُجهض يلفظ أنفاسه قبل أن يولد. الألفاظ التى تناثرت مستقلة تعود وكأنها تتخلق أطفالا من جديد، لكنها لا تجد لها مكانا بين أكوام الغث الفارغ من كلمات ملأت معاجم حواراتنا المسترسلة حول أصنام ثابتة:
الوجْهُُ الأْملسُ،
والذَّنَبُ المقطوعْْ.
وجنينُُ الوعىِ المجهضِ، يلفظُُ أنفاسَهْ.
والألفاظُُ الأطفالْ،
تبحثُ عن مْأوَى.
…لا جدْوَى.
غُصَّتْ صفحاتُ شروحِ المُعْجَمْ.
حين تمتلئ قواميس أدمغتنا بتحديد صارم لكل معانى كل ما ننطق به ، وما لا ننطق به، من كلمات، يموت الإبداع، وتصبح الحياة سجينة جدران هذه الشروح الجامدة، والتعريفات المغلقة ، فتصبح الكلمات الميتة سجنا يحول دون حركية حياتنا، يترتب على ذلك أن تصبح الثروة التى كانت فى الأصل وسيلة غنى لحيوية حياتنا، تصبح عبئا يثقل ظهورنا حتى تشل حركتنا حيث نحن، بلا حراك ظاهرى، لكن هذا لا يحول دون قلق الداخل وتمادى تحفزه.
تعدد الذوات والكيانات (كتير) يظهر فى الداخل ومن الداخل فى أحوال أخرى حين يفقد المجنون حدود ذاته، تعبيرحدود الذات يعرفه الأطباء أكثر من غيرهم، لكن المرضى يعرفونه أكثر من الأطباء، حدود الذات هذه هى التى تجعل أيّا منا فى لحظة بذاتها “واحداً” (ليس كتير). “فقد حدود الذات”، loss of ego boundaries يجعل هذه الكثرة بداخلنا عرضة للكشف والإعلان معاً، “شفافية حدود الذات” ego boundary transparency، تعرى ما بالداخل قبل، أو بدلاً عْن، اقتحام الحدود. ذات مرة تقمصت مريضا آخر يشرح هذا على الوجه التالى:
حين يشفّ جدارُ النفس يصيرُ النظر إلى المرآة جريمة
فلماذا نظروا هم من ثقب الباب؟؟
- 2 -
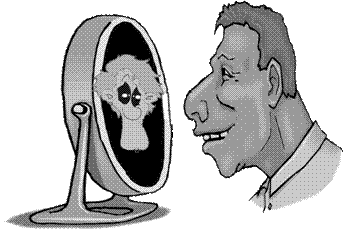 كان الداخل ملكى رغماً عنّي،
كان الداخل ملكى رغماً عنّي،
لم أستلم السَّـنَدَ من الوالدِ قطّ.
أوصى قبل وفاتهْ:
أن أبحث عنه فى صندق الجدْ
سلـّمَ مفتاح خزائنه لامرأتهْ،
ماتتْ.
وأشيع بوسْط الجمعِ الحاشدِ
- القادم للمعزى والفـُرجه -
أن الداخل مِلكى دون منازعْ،
وبوضع اليدْ
يدُ . . من؟
البداية كما نرى هى أن هذا المجنون الرائع، اكتشف كثرته من خلال الشعور بتجريم النظر إلى مرآته بعد أن اقترب داخله منه. “مرحلة المرآة” فى نمو الطفل مرحلة ذات دلالة خاصة، يتعرف الطفل على ذاته من خلالها حين يرى شخصا شبيها به، وهو لم يتعرف على معالمه هو شخصيا بعد. المجنون ينتبه إلى أن أول إعلان لشفافية حدود الذات، أو فقدها، هو أنه –شخصيا- أصبح مُهددا بأن يرى بنفسه ما بداخله، ذواته الأخرى، وهو يرعب من احتمال كشفٍ لأكثر مما هو مسموح به، وكأنه يقترب من فاكهة محرمة. هذا “الكتير” الذى بداخلنا لا يأتى فقط من احتوائنا للمدركات التى تصلنا من حولنا، ولكنه موروث أساسا عبر تاريخ الحياة كلها، لتختتم هذه الرحلة بالوراثة القريبة من الأسرة القريبة الممتدة فى الأجداد إلى ما نعرف أو ما لا نعرف. نحن لا نختار ما نرثه، وبالتالى فإن هذا الداخل هو مزعوم بأنه ملكنا، رغما عنا، وفى نفس الوقت هو الذخيرة التى يمكن أن تصنعنا حيث لا بديل من أن نبدأ منه، لكن لا نتوقف عنده ، نحن لانكونه هو فقط، تعتمد مسيرتنا إلى أنفسنا على الاعتراف به ابتداء، ثم الجدل معه طول الوقت، طول العمر، فلا يكون الداخل (بكثيره وقليله) ملكنا بمجرد أننا استلمناه “بوضع اليد”، لأن آخرين يستطيعون “وضع اليد” عليه أسرع وأنذل. هو يكون مشروع ما هو نحن بأن نتعهده، لنتمثله منطلقين منه إلى ما يمكن أن نكونه به. الذى يحدث أن هذه العملية هى كل حياتنا، ومن ثـمّ نبدأ بإعلان قبولنا للملكية ولو بوضع اليد، حين نبنى ذلك السور الذى نتصوره أنه نحن، لنستر ما بالداخل، ليس فقط عن أعين الناس، ولكن عن أعيننا نحن أيضا.
أبنى حول المِلك السائب أسوار الستر
أضع بأعلى السور شظايا الصد
هكذا نظل مطمئنين إلى أن ما بالداخل سيظل بالداخل، وأنه يمكن أن يخرج بطريقة إيقاعية منتظمة أثناء النوم، حيث تقوم الأحلام باستيعاب ما تيسر منه، وقد يقوم الإبداع بتحمل مسؤولية ما يصلنا منه بجرعات محتملة، فإن لم يتحقق هذا وذاك بقدر كافٍ، فالتهديد قائم، والانهيار محتمل، والتسريب جائز، والفضيحة على الأبواب!!!:
فلماذا رقـّتْ جدرانه؟
ولماذا نحلت شطآنه؟
من أكل البحر؟!!!
لا يكفى أن تضعف معالم الذات الظاهرة ليتعرى الداخل، ذلك أن ما بداخلنا حين نحرمه من حركيته، ونأبى أن نستوعبه ولو بدفعات متدرجة، يمتلئ بشحنة متزايدة جاهزة للانطلاق الخطير خصوصا بعد أن تهتز حدود الذات، فيقفز الداخل بكل عنفوانه دون استئذان.
يقفز منى،
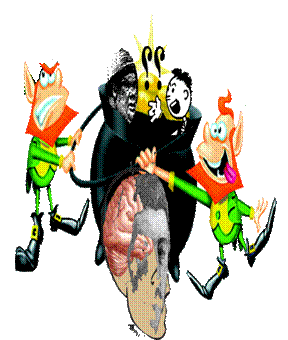 يتحفز،
يتحفز،
يطلب حق النصف
غير النصف الموقوف
على حفظ السر
………
الموروث يطالب بالإرث !؟!
وأنا لم أملك سند الملكية قط
الإعلان هنا أن فقد أو شفافية حدود الذات لا يهدد فقط بالكشف عن المستور، بل إنه يعلن تنافسا بين الذوات على من يملك حق أن يكون الممثل الشرعى لمن هو”أنا” (الموروث يطالب بالإرث!). كل هذا يضعف من مناعة ومتانة السور القناع، فتظهر الأعراض المرضية التى تصف هذه المرحلة من التعرى غصْباً واقتحاماً، ومنها: “قراءة الأفكار”، وإذاعة الأفكار” والتجسس على الأفكار، و”زرع أو إقحام الأفكار، وسرقة الأفكار”، تعبير الأفكار هنا مجازى بقدر كبير، وذلك اعتمادا على الفرض الذى أشرنا إليه سابقا حين تمادينا فى التأكيد على أنه: حتى الأفكار هى ذوات قادرة على الاستقلال أحيانا، وعلى التوليف كثيرا. قراءة الأفكار هكذا بعد انهيار أو شفافية حدود الذات لا تهدد المجنون فقط بإذاعة سره، ولكن بإعلان فراغه، فهذا الكثير هو لا يعنى شيئا ولا أحدا فى النهاية.
لم يخجل أى منهم من لعبة خلع الفكرة تلو الفكرة
ملهى العرى المشبوه
ماذا يبقى إن عرفوا مكنون السر؟
وتجاه السهم؟
وفراغ القفص من الطائر ؟
رغم تناثر حب البرغل؟
ماذا يبقى إن كشف تبصصهم
أن الباب المقفول
ليس وراءهْ:
إلا عجز الفعلْ؟
إلا حُسن القصد؟
- أو سوؤه-
فالأمر سواءْ!؟!!
الفراغ هنا ليس فراغا بمعنى الخلاء، ولكن بمعنى أنه إن لم يتم التضفر فالتوليف، فحصيلة ما بالداخل مهما تعدد وكثر، هى صفرٌ كبير:
ماذا وجدوا فى الداخل بعد تمام الجرد؟
الطفلة تحبو؟
جثة أمٍّ تتكلم. .؟
وعصا عمياء؟
ومضارب مكسورة؟
وبقايا علبة سردين مفتوحه؟
فيها قول مأثوريـُرجع أصل الإنسانْ
للسمكِ المحفوظِ بعلبةِ ليل؟
ماذا فى الداخل يستأهل دسّ الأنف؟
رجلٌ عنين يتدلى منه العجز؟
حبل شنَـقَ الآخر بالحكم الفوْقي؟
آثارُ الخضرهْ
ورياح خماسين الفكرةْ
وجهٌ متآكل؟
وبقايا عين؟
وشطائر مخٍّ؟
وحوايا قلب؟
هذا الوصف المؤلم هو فى حقيقته احتجاج صريح أكثر منه اعتراف مستسلِـم. الجنون – من حيث المبدأ- هو هزيمة لصاحبه، لكنه هزيمة تتحدى. يبدو أن المجنون ينهزم علانية ليعلن خيبتنا قبل خيبته. كل هذا الذى يحكيه المجنون بعد أن فتح داخله على مصراعيه يبدو آثار معركة ليس فيها منتصر أصلا، كل المشاركين فيها يخرجون بقايا متناثرة مهزومة. المجنون، برغم كل ما لحقه، وما استسلم له، لا يكف عن أمل بعيد غائر فى ولادة جديدة، من وسط بقايا آثار العدوان. لكنه يعرف تماما كيف يقف المتربصون السلطويون له بالمرصاد لإجهاض هذه الولادة:
هتكوا عرض الفكرة،
لم تولد
رصدوا الرغبةْ، أُجهضت الطفلهْ،
وتراجعت الدائرة الدورهْ،
………….
حين هممتُ أقولْ
قالوها بدلاً منى
بلسانى،
فتسرَّب خدْرٌ كشماتهْ
وتبسّم طفل فى خبث أصفر
التراجع إلى الطفولة نكوصا غير إعادة الولادة انبعاثا، الطفل المبتسم هنا فى خبث أصفر، هو الطفل الخبيث الذى ينتهز فرصة التفكك لينطلق عبثاً وتراجعا، حين يحدث ذلك يكون الجنون رِدّة اعتمادية تخلت عن حفز النضج تجنبا لآلام جدية، أو مسؤولية مشروطة.
التمسك بالجنون فى كثير من الأحيان (يبدو أكثر فى صوره رفض أو مقاومة العلاج)، يؤكد مشاركة إرادة المجنون الخفية فيما آل إليه، شىء أشبه بـ “عـلىّ وعلى أعدائى”، لذلك يسمى الجنون أحيانا “الحل الذهانى”، حيث يحل أزمة الوجود سلباً، بمثل هذا التحلل والتناثر:
كنت سعيدا بالسلب النهب
بشيوع الأمر
بذيوع السر
لم يكن الداخل مِـلْكِـى يوما‘
والمفتاح المزعوم خرافهْ‘
والباب بلا مزلاجْ‘
والمتهم برئ مجهول الإسم
قيل له “ذاتي”
إسُم للشهره،
مفعولٌ به،
لم يحفظ ما لا يملك.
ما دافعَ عنهْ.
ما ”كان”!.
منطق المجنون الذى يبرر به اللجوء لهذا التحطيم والتراجع والنكوص هو أنه لم يوجد أصلا، لم يعترفوا به أساسا، ما أورثوه إياه كان عبئا عليه بدلا من أن يكون ذخيرة نموّه.
حين نصيغ أولادنا باعتبارهم ملكا لنا، لمجرد أننا سبب وجودهم، فنحن بذلك لا نسلمهم العهدة (الموروثة أو بالتربية) ، بل نمتد فيهم لحسابنا نحن. النص هنا يعلن أنه: “لم يكن الداخل ملكى يوما ما”، ذلك لأنهم لم يسلموه مفتاحه أصلا، لم يفشوا له كلمة السر لأنهم لا يعرفونها غالبا، ومع ذلك صوروا له أنه ذاتاً منفردة لها معالمها الخاصة (ذاتى)، مع أنه ليس إلا صدى فارغا لذواتهم، الفارغة بدورها.
كيف يحرص أحد على ما لم يملك أصلا برغم بنائه سورا هشا حوله، سورا سرعان ما ينهار حين يضغط عليه “الكثير” المكبوت تعسفاً فى الداخل؟
وبعـد
هكذا نرى كيف أن الـ “كتير” الذين هم فينا، فى كل واحد منا، هم خطر داهم إن لم نستثمرهم باعتبارهم ثروة حقيقية، تثرينا، وتدفع نمونا، وتشكلنا من جديد، هذا لو وضعت فى مكانها، لو تسملنا عهدتها، لو سمحنا بتبادل الأدوار معها، ولو فى الحلم، لو استوعبنا حركيتها توليفا فإبداعا.
دعونا نأمل أن نفعل ذلك من خلال محاولة التعرف على حقيقة “الإنسان” فى هذه المتابعات المتواضعة. لا
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى

