نشرة “الإنسان والتطور”
الأثنين: 19-6-2017
السنة العاشرة
العدد: 3579 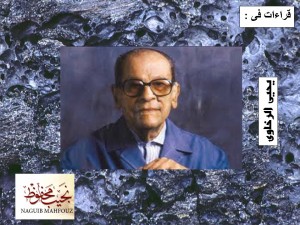
جذور وأصول الفكر الإيقاعحيوى (9)
مقتطفات من نقد كتاب:
“قراءات فى نجيب محفوظ” (3)
مقدمة
كلما تقدمت فى مراجعة أعمالي النقدية هالنى هذا الكم الهائل من المعرفة الطبنفسية التى وصلتني من خلال هذه المحاولات دون ربط باكر بما ترتب عليها من تنظير علمى أدى إلى ما وصلت إليه عن أصول هذا الفكر الإيقاعحيوى التطورى، وكأنى حين كنت، وما زلت إلى درجة أقل، أصر فى مسشفى المجتمع العلاج (دار المقطم) على أن تكون الندوة الشهرية فى نقد نص أدبى أو شعرى، كنت دون قصد ظاهر، أدعو زملائى وأبنائى وبناتى إلى النهل من هذا المنهل الذى أثرانى بهذا القدر، والذى فى مقدمته يقع نجيب محفوظ وديستويفسكى
ذكرت أمس أننى وجدت نفسى وأنا أراجع أصول كتابى الأول فى نقد نجيب محفوظ، لإعادة طبعه وعنوانه “قراءات فى نجيب محفوظ”، وجدت أن كثيرا مما وصلنى منه يتفق مع ما أسميته إرهاصات لهذا الفكر الإيقاعحيوى التطورى، علما بأنه عمل حديث نسبيا مقارنة مثلا بـ “عندما يتعرى الإنسان”، فهو ليس إرهاصات بالمعنى التاريخى التوليدى، وإنما هو بمثابة معرفة موازية، أو بتعبير أصدق “المعرفة الأصل”
توقفنا أمس عند مقتطف من مجموعة رأيت فيما يرى النائم، يلّح بالدخول إلى عرض ومناقشة ما هو: “غريزة المعرفة”، وقبل أن ارصد المقتطفات المشيرة إلى ذلك بأقل قدر من التعليق كما تعودنا، أود أن أتقدم بنبذة موجزة عن هذه الغريزة الأصل فى كل الوجود، التى كدت أعتبرها سابقة وأساسية لاستمرار الحياة بما هى إلى وعودها، هو عبر منظومة التطور، بفضل الله.
التطور يتم أساسا عن طريق هذه الطاقة المعرفية الجاهزة المنغرسة فى (الدنا) DNA لكل الأحياء، فهى ليست معرفة الحفظ من الكتب، ولا معرفة المنهج العلمى معرفة اثبتْ لىِ، اثبت لك، ولا معرفة القراءة والكتابة، ولا مؤاخذة، لكنها معرفة برامج البقاء التى أودعها الله فى كل الأحياء، ولا دليل على أن أى من الأحياء قد حذق قراءة أبجديتها، وتنفيذ تعلمياتها إلا “البقاء” ومقاومة الانقراض، غريزة العدوان التى تبقى على الفرد على قيد الحياة حتى ينتهى عمره الافتراضى، وغريزة الجنس التى تحافظ على النوع عبر التكاثر، هى غرائز لاحقة لغريزة المعرفة التى تحافظ على النوع من خلال ما هو حى للحياة، الطيور تعرف أعشاشها بهذه الغريزة, وتطير معا بهذا الغريزة، وتفقس بيضها بهذه الغريزة، وتُسَبَّحُ ربها بهذه الغريزة، فتبقى، بل إن الأميبا تتعرف على السائل المحيط ودرجة حموضته الصالحة لبقائها أو المهددة لوجودها بهذه الغريزة، إذن فالمعرفة الأصل ليست حكرا على الإنسان من ناحية، وهى أكثر نفيا لسيطرة واحكتار النصف الطاغى من المخ (ولا مؤاخذة) لما هو معرفة.
المبدع يمارس هذه الغريزة بدرجة أكثر نشاطا وبإرادة أعمق غورا، وبالتالى يتجاوز المعرفة المرموزة، والمفاهيمية، والثابتة، والمنغلقة، دون إهمال أى منها فيضيف لنا ما فتح الله عليه من تشكيلات جديدة ، كل بلغته (لغة المعمل، أو اللون، أو الخط أو اللفظ أو اللحن… الخ)
تعالوا نرى كيف تعلمت من هذا العمل وأنا أقوم بنقده عن هذه الحقائق
المقتطف الرابع (من نقد “رأيت فيما يرى النائم”)
……………..
……………..
….إذن، فهذا البحث المستمر عن الأصل فى الماضى أو عن الغاية فى المستقبل إنما يمثل عمودا محوريا عند نجيب محفوظ فى هذه المجموعة، ناهيك عن بقية أعماله، وهو بحث يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من طبيعة الحياة، لدرجة تبرر لنا أن نتقدم خطوة لنكشف عن البعد التالى فى هذه المجموعة وهو ما أفضـل أن أناقشه تحت ما يمكن أن يسمى” غريزة المعرفة”.
رابعا: غريزة المعرفة، ومخاطر المحاولة
يمثل هذا الدافع فى أعمال نجيب محفوظ محورا لازما يكاد لا ينفصل عن الأحداث، وإن لم يبد ظاهرا على السطح فى كل الأحوال، وقد خيل الىّ أن محفوظ قد اعتنى – تلقائيا – بهذا الدافع الذى لا ينتبه إليه الكثيرون والذى أطُـلِـق عليه لفظ “غريزة” لتأصيل جذوره البيولوجية وإلحاحه الحتمى، أقول اعتنـَى محفوظ به حتى ليمكن وضعه فى مقدمة رؤيته لحفز رحلة الإنسان الواعى، ولم يهمل محفوظ بقية الدوافع الأساسية وخاصة الجنس والعدوان، إلا أنه جعلها فى موقعها المتواضع بالقياس الى هذا الدافع المحورى الأساسى، بل إن هذه الدوافع الأخرى قد تصب فيه وتخدمه، فكثيرا ما نجده يدمج الجنس باستكشاف جديد، أو يتخذ العدوان وسيلة للمعرفة أو مواكبا لها أو ناتجا عنها، وهذا وغيره يحتاج إلى مراجعة شاملة واستقصاء أعم، قبل الجزم بالنتائج، ونكتفى هنا بالتركيز فى إيجاز نقول به: إن المعرفة الغريزة ليست مجرد استزادة معلومات أو إضافة رؤى، وإنما هى أساسا مخاطرة اكتشاف (1) وتخطى حواجز بما يصحب هذا وذاك من مضاعفات وما ينتج عنه من تشكيلات.
ثم دعونا نرى بعض ذلك فى هذه المجموعة:
فى قصة “أهل الهوى” نرى محاولات التذكر والتفكير فى مقابل الرفاهية والاعتمادية، وقد اعتدنا فى بعض الشائع من أعمال أدبية أن نلتقى بتقابلات واستقطابات سطحية بلا غور، مثل: الجنس الشهوى فى مقابل الحب الرومانسى أو العذرى، أو تُقَابُل فجاجة الغريزة مع النضج الاجتماعى، أما نجيب محفوظ هنا، فقد قابل الغريزة الفجة (البراءة العمياء) بالغريزة المعرفية، وهذا جديد وأصيل ومتحد، وهو بعض ما دعانى إلى ما وصلت إليه فى كل ما رأيت وسجّلت ونَظّرت فى المجالات التى خضتها دون استثناء.
لابد أن أذكر هنا ما أعنيه بالغريزة بالمعنى التركيبى (البنيوى) حيث أقصد بذلك ‘التركيب الجبلِّي-أساسا- المهيأ للبسط Unfolding، المندفع إليه تلقائيا مع مسيرة النضج النابض وتحت الظرف الملائم، وهو يحتوى طاقته فى طبيعة تنظيمه، ومع أنه عرضة للقمع والشجب الا أنه متاح له فرصة الاضافة والتكامل فى “الكل”، وإعادة التنظيم باستمرار، وفى هذا تستوى دوافع/غرائز الجنس والجوع والعدوان والدافع للمعرفة، وهذا الأخير مرتبط بأول الدوافع الفطرية وهى ما يبدأ بالوجدان الأول: الحفز إلى التطلع Orientationأو “البّــهـْر” (نشرة 8-9-2014 “من عاطفة ” البَهـْـر” إلى تخليق الإبداع”).
وقد تحركت “الحاجة إلى المعرفة” (فى هذه القصة: أهل الهوى) جنبا إلى جنب مع اعتدال حدة الحب الشهوى والإفراط فى الجنس، ومع بداية الاهتمام بما “بعد ذلك” أو بما “بجوار ذلك”: “فخلطا أحاديث الهيام بهموم الوكالة والحارة” (ص27). ثم جرى الأمر كما ينبغى أن يجرى: شكوك – تساؤل – تفكير- مراجعة – توقف – عجز- ثم الموت.
ومع نغمة اليأس الحتمى فى نهاية المطاف لم تـطرح أية اشارة فى هذا العمل (أهل الهوى) لمسار آخر بديلا عن الموت، وأعترف أن المبدع غير ملزم باعطاء البديل، فالعمل الإبداعى ينتهى بحدوده، ولكنى أخشى أن نتصور أن غريزة المعرفة مكتوب عليها هذا المصير، وقد كان “عبدالله” يعلن- رغم حاجته القصوى إلى هذا البديل- أنه يطرق طريقا محظورا قد لا يلقى وراءه إلا الندم “ترى هل الندم هو الجزاء الأوحد لمعرفة المجهول من حياته” (ص33).
ويؤكد محفوظ الطبيعة التلقائية (الفطرية الجبـِلـّيَة…الخ) لحركة هذا الدفع الى المعرفة “.. وزاد من قلقه أن التغيير ينبثق منه” (ص34)، وتبلغ قمة روعة الحدس الإبداعى حين ينجح فى أن يصف تدرُّج وأطوار نضج غريزة المعرفة (هذا الذى ينبثق منه):
فهى تأتى فى البداية فى شكل إرهاصات سريعة مجهضة: “وانطفأت بروق كثيرة تحت عباءة العادة الثقيلة” (ص34).
ثم تفرض نفسها كوجود ملح مزعج: “فاستيقظ الفكر وخبت شعلة العواطف والغرائز” (ص34)،
وسرعان ما يطل الشعور بالذنب تجاه ظهور هذه الغريزة الجديدة، وإلحاحها،
يبدو أن غريزة المعرفة، هى هى التى أخرجت آدم (عليه السلام) من تناسق الجنة إلى مسئولية الوعى، ومع ذلك، نحن نعيشها أو نستشعر حركيتها فى مواجهة عدم تناسب القدرة المحدودة ..مع الآفاق الممتدة، كما قد نشعر بالذنب حين نخاطر بإطلاقها، وكأننا نقول: ياليتنا ماعرفنا، إن حدس محفوظ يقدمها هنا كما عايشتـُها فى نفسِى وتخصّصى على حد سواء، يقدمها كغريزة بيولوجية أصيلة، وبدْئية، تقابل فى هذا القياس ما يشعر به المراهق مع ظهور بوادر الجنس: “وخاف أن يقف كالمتهم بين يديها“(ص34).
وقد بين محفوظ أن هذا الدافع إلى المعرفة قد ينبعث أساسا من مجرد أن الانسان له “ماض” له تاريخ، وكأن المعادلة الطبيعية تقول: إننا نتعرف ابتداء على بعض ما اضطـررنا – بحكم التطور- لإخفائه مرحليا… أو على ما سبق تنظيمه – تركيبا- أثناء نمونا نوعا أو أفرادا، ثم بعد ذلك يصبح الدافع المعرفى قوة فى ذاته، ليستمر بلا توقف.
بل يبدو أنه من فرط إلحاح قوة هذا الدافع على الكاتب فى صورة عبدالله (أو غيره)، أنه مدّ فى أجله، أو فى أمله، إلى ما بعد حدود الذات المفردة زمنا، فاذا احتد اليأس من إمكان اكتمال المعرفة فى هذه الدنيا “قلبى يحدثنى أنى لن أعرف شيئا ما دمت هنا” (2) (ص47)، فانه لا يغلق نهائيا ولكنه يطل من “هناك” كبديل محتمل.
وفى قصة “من فضلك وإحسانك” يأخذ هذا الدافع المعرفى مسارا آخر، فهو يظهر ويحتد بعد الإحباط والحرمان، فيتفجر الألم فى جوف الفراغ الناتج من هذا الإحباط، ولكنه حين يعاود ظهوره سرعان ما يكتمل بقفزة مرعبة، إذ هو لا يتدرج مثلما كان الحال فى أهل الهوى، فيصف لنا محفوظ هذه الفورة المتدفقة فيما أسماه” تجربة طارئة” حين: “التحم بأثاث حجرته التحاما غريبا جنونيا”(ص65).
وكان لهذا الالتحام خصائصه المتعلقة بما نزعم من غريزة للمعرفة، فالالتحام بالشئ الجامد – الجماد- قد يولـِّد سكونا هامدا أو امحاء، ولكنه على العكس من ذلك قد يكون غَوْصاً الى أعماقه الأصل “مباشرة” بحيث يبعث فيه حياة مقحَمَة، بما يفيض عليه من دفقات الوعى الفائق ليصبح الرائى هو هو نفس ما يرى فى مخاطرة لإحياء المحتوى، ثم “يعود” ليعرف عنه ما “كانـَه” فيعيد اكتشاف الأشياء البسيطة بجدة متفجرة: “وكأنه يكتشف لأول مرة الفراش الخشبى ذا اللون البنى الغامق”.
“وبإدامة النظر إلى الفراش ومحتوياته، دبت فيه- الفراش- حياة من نوع ما”.
“ونفذ ببصره الى الأعماق فرأى القطن المكدس وراح يعد خيوطه الملتفة المضغوطة” (ص65).
وقد يحلو لبعض الأطباء النفسيين و المختصين أن ينكروا هذه الخبرة كواقع محتمل، وأن يسموها ببعض أسماء أعراضهم أو أمراضهم، إلا أن هذا يستحيل أن يحجر على احتمال صدق حدس الكاتب المبدع بما يشمل الكشف عن طبيعة هذا النشاط الدافق من سعى معرفى الى النفاذ والتعرية نتيجة لإطلاق (بسط Unfolding) دافع غريزى كامن متحفز، وقد تم هذا الإطلاق بعد التمهيد له بالإحباط، ثم الإفساح أمامه بما يشبه تناثر الجنون
اكتفيت هنا بالتركيز على ما يتعلق بإطلاق غريزة المعرفة من خلال هذه الخبرة “الجنونية”، وقد أغفلت جوانب أخرى ‘ للإحياء ‘ أدت إلى الحوار بين الكتب والبدل داخل الدولاب، ومع صورته فى المرآة.. وهذا كله مرتبط بما أعرض هنا الا أن له مدخلا آخر ليس هذا مكانه.
ومع قوة هذا الإطلاق لدافع المعرفة المخترق، فإن المثير له، والظروف المحيطة به، لا تسمح باستثماره إلى معرفة مسئولة، وصياغة جديدة (إبداع)، وحين تشتد حدة نشاط غريزة ما دون ناتج ملموس أو فاعلية معلنة أو صاحب يصدقها، لابد أن تنطفئ وأن تتراجع إلى نشاط متناثر، يعطل مسارها، بل وقد يرتد حتى يعطل “الإنجاز العادى”” قبل تفجيرها، فكل ما أصاب فكر “عبد الفتاح” ونشاطه العقلى بعد ذلك: كان فشلا، وإن كان نسبيا، تتخلله بعض “أثار الرؤية” كجزر سراب وسط محيط من الظلام والعجز، فإن “الكون لم يغب عنه تماما” (ص66)، وتتواكب هذه الإلماحات المغرية بانطلاق معرفى مطلق تجاه ما هو أكبر من الكتاب والدرس… تتواكب مع ما يلزم من تحريك مجهض (أيضا) لا ينجح إلا أن يذكــره “بحزنه المخزون المؤجل” (ص66).
ولكن إلى متى التأجيل؟، وما مصير هذا الدفع إلى المعرفة الأخرى- فى هذه الظروف- هل يا ترى هو التناثر المُشــل؟
إن العجز عن مواصلة هذا الدفع إلى اتجاه بذاته، قد يوحى باليأس الذى يبعث على طمأنينة السكون، إلا أن المسألة لا تنتهى عند هذا الحد “عليه ألا يركن إلى الطمأنينة العابرة الخادعة، وان يفكر فى المستقبل بجدية” (ص68)، ولكن هذه الجدية لا تعنى إلا صدق الدفع دون الالتزام بالنتائج “ملتزمة وثبة قوية غير معقولة”، …..”طفرة غير متوقعة وغير منطقية” (ص68).
ولكن الرتابة والأيام والاستسلام المتدانى سرعان ما تأتى على كل تدفق أو نشاط، فينتهى إلى الرضا الميت، دون أن ينسى أن ثم “هدفا” غير ما يبدو ظاهرا ما زال يكمن وراء “الانحراف” أو “السفر الاسترزاقى“.
وفى قصة “العين والساعة“: نواجه غريزة المعرفة وهى تنطلق مكثفة كاسحة أيضا، فى لحظة بذاتها، وبدون سابق إنذار، لكنها بدلا من أن تدفع صاحبها للالتحام بغور الأشياء حتى النخاع، فإنها تذهب تخترق الوعى الظاهر لتغوص فيما وراءه من تراكيب تمتد بالذوات الأخرى فى التاريخ حيث يختلط الأمل بالماضى، بالرؤيا..، باليقين: “إنه ليس بالغريب، وإننى أراه وأتذكره معا“(ص111).
وفى وسط أرضية حافلة بالنشاط والهيام والطرب، وموحية بالإلهام والجذل “شع نور الباطن فتجسد فى مثال” (ص110).. ثم يدور الحوار ليعلن عدم تحمل الرؤية” الآن”..وربما كان ذلك ممكنا بعد حين، ربما حين يلوح فى الأفق إمكان التنفيذ فلا “يحسن الاطلاع عليه قبل إخفائه” (ص111)، حتى لا “يحملك ذلك على التسرع فى التنفيذ قبل مضى عام فتهلك” (ص111)، إذن فالرؤية السابقة للإعداد خطر، والتنفيذ المتجاوز للإمكانيات والقدرات أخطر، ومصيبة غريزة المعرفة أنها إذا انطلقت بجرعة مفرطة “قبل الآوان” أصبحت عاملا مــشلا لا حافزا هاديا.
وفى المقابل فإن خطورة التأجيل هى التمادى فيه إلى ما لا نهاية… وهنا يكمن المأزق المعرفى الخطر، وكل المحاولات الجارية للتحايل على الخروج من هذا المأزق باللجوء الى الرمز والفن والتجزئ والإسقاط وسائر الحيل هى محاولات مرحلية لا يضمن لها النجاح أى حتم تطورئ، لأنها إذا استقرت أعاقت، واذا تخلخلت هدَّدَتْ، ومع ذلك – ولذلك- فالمخاطرة تبدو بلا بديل “لعلى أعثر على الكلمة التى طال رقادها” (ص113)، ويبدأ “الحفــر” فيما يلى شباك “المنظرة” ولا أحب أن أطيل فى دلالات كلمتى الحفــر والمـنظرة فهى ظاهرة.
وبعد
تعمدت ألا أقاطع وأعقب أولا بأول، فأوردت ما جاء فى نص النقد الذى قمت به لهذا العمل،ولا أعرف هل يصح أن أذكّر القارئ من الأصدقاء النفسيين عامة والأطباء النفسيين خاصة أن كل ما ورد فى هذه النشرة وما سيرد من مثلها هو “نقد أدبى” وليس “طبا نفسيا” أو علاجا نفسيا، ومع ذلك أرجوهم أن يتصوروا أنه كذلك (شكرا)
وبرغم أن الموضوع لم ينته إلا أننى أود أن أوضح بضع نقاط فيما يتعلق بعلاقة ما أوردناه بالطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى:
(1) المعرفة هى أصل فى إدراك برامج التطور، ومنطلق اتباعها هو ضرورة للبقاء
(2) المعرفة تتطور آلياتها، وتختلف أبجديتها فى كل مستوى من مستويات تاريخ التطور حسب الحاجة، والتجربة، والتواصل بالأصل، والتلاؤم مع المحيط
(3) المعرفة تبدأ من بداية البداية وتمتد حتى ما بعد النهايات المعروفة والمحتملة
(4) الوعى بالمعرفة ليس شرطا لإقرار دورها أو تحديد مواصفاتها، فكل الأحياء التى “بقيت حتى الآن” تمارس نوعا من المعرفة بنوع غائر من الوعى ونوع غامض من التواصل وإلا “ما بقيت حتى الآن”.
(5) إن أسبقية غريزة المعرفة على بقية الغرائز، تلزمنا بالنظر فى أولوية دورها وطرق تنشيطها دون تهميشها، أو اختزالها إلى المعرفة المفاهيمية أو المرموزة لما فى ذلك من مخاطر على الكائن الذى اسُتدْرج – بخطإ تطورى – إلى مثل ذلك
(6) إن الممارسة الطبفسية تحتاج إلى تنشيط هذا التواصل بين مستويات الوعى لأن المعرفة الأصل، بقدر ما تحتاج إلى حفز مواصلة المسيرة إلى دوائر الوعى الأوسع فالأوسع، مما سوف يظل فى حكم المجهول أو الغيب أكثر فأكثر كلما تقدمنا أنشط فأنشط، وفى نفس الوقت هو يحتاج إلى يقين جوهرى بتحمية الجهل به (الغيب) دون انتظار لتحديد دوره تفصيلا، فهو الكدح إيمانا.
وكل هذا من أساسيات الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى
ونكمل الأسبوع القادم
[1]- يمتلئ وعى نجيب محفوظ بما تعنيه ‘السببية الغائبة’ التى ينطلق فيها الدفع الحياتى والإبداعى نحو غاية محددة بالتركيب وحركة التاريخ وليس بالأسباب التفصيلية وجزئيات المحتوى، ويمكن مناقضة هذا الموقف مع “السببية الحتمية” عند فتحى غانم حيث يغلب عليه الفكر الفرويدى المبرر للأحداث والمفسر لها بشكل ملح (راجع الانسان والتطور عدد أكتوبر 1983) دراسة عن “الأفيال”
[2] – يؤجل بعض الصوفية مشاهدة وجه الله تعالى (قمة الكشف المعرفى) إلى المرتبة الأعلى من الجزاء فى الآخرة، وما السعى فى الدنيا إلى ذلك إلا لمجرد ضبط الاتجاه، لا طلبا للتحقيق العاجل.
 يحيى الرخاوى طبيب نفسى
يحيى الرخاوى طبيب نفسى

